الظمأ الإبستمولوجي في كتاب "الدين والظمأ الأنطولوجي"
فئة : قراءات في كتب
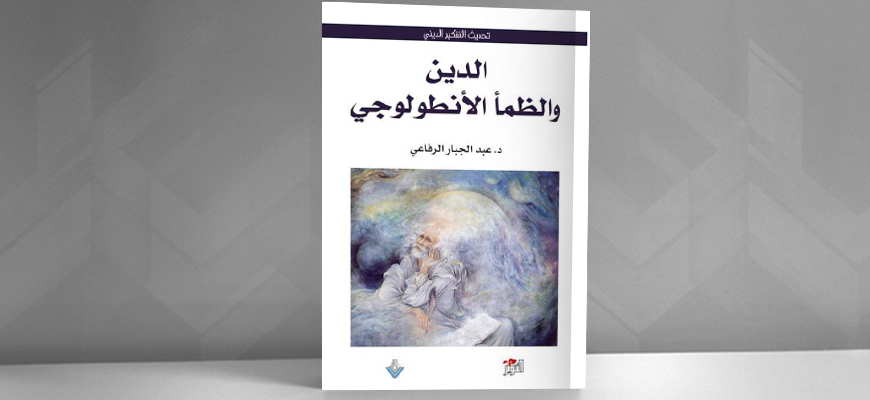
ثمّة ظمأ إبستمولوجي في كتاب (الدين والظمأ الأنطولوجي)[1] للمفكر "عبد الجبّار الرفاعي"، لناحية أنه يترك أطروحة الظمأ الأنطولوجي دونما إرواء إبستمولوجي، بما يجعلها غير تأصيلية على المستوى النظري، فهي أطروحة تتأسّس على تجربة شخصية أكثر منها على أُسس عقلية، لذا أمكنني تسمية الظمأ الأنطولوجي في الكتاب آنف الذكر بـ (الظمأ الذاتوي)، سيجد إرواءه في تجربة شخصية لدى الكاتب، يسعى عبرها إلى التأشير على أهمية الدين في حياته الشخصية، ليس على المستوى المعرفي فحسب، بل على المستوى الوجودي أيضاً.
ولربما كان الفصل الثاني الذي عنونه بـ (نسيان الإنسان)[2] هو الأكثر تعبيراً عما أراده من كتابه آنف الذكر، فهو يسرد -على شكل نص أدبي- ما آل إليه على المستوى الشخصي والديني أيضاً؛ تدرجّاً من صغره إلى لحظته الراهنة، بما تتضمن هذه السردية الجميلة من لحظة تنوّر على المستوى الوجودي، عبر الإضاءة الدينية. لذا لا يمكن سحب التجربة الرفاعية ـ نسبة إلى عبد الجبار الرفاعي- خارج سياقاتها الذاتية، لأنه يموقع نظرته الأنطولوجية للكون في سياق أنماط دينية إسلامية، يفترضُ أنها التجسيد الأمثل لهذه النظرة، والمواضعة الأعرق لعلاقة الإنسان بالمقدّس[3]. ويقيناً، لن تكون نظرته هذه نظرة موضوعية بقدر ما هي نِتاج تجربة ذاتية، قد يختلف معها كثير من الناس حتى من داخل الحقل الديني، لأنّ ثمة اختلاف جوهري على المواضعات التي يمكن للدين أن ينتقل بموجبها من مرحلة (الطوبى) والرؤية المثالية، إلى مرحلة الواقع العملي.
في الفصل إياه (الفصل الثاني)، وتحت عنوان حياتي الروحية الأخلاقية، يكتب عبد الجبار الرفاعي:
"خلاصي من سطوة التراث ليس بمعنى الخروج على الدين، أو الخروج من الدين، أو التحلل من التدين، والتبجح الزائف بما يجرح الضمير الديني للناس، مثلما يفعل بعض المتنطعين المراهقين*؛ تعلمت من التراث والواقع أنّ الدين أبدي في الحياة البشرية"... حياتي الروحية الأخلاقية هي أثمن رصيد أمتلكه، يمكنني التفريط بكلّ شيء إلا بالإيمان، والأخلاق، والإنسانية، إنها ثوابت شخصيتي الأبدية. تفكيري بكلّ شيء في حياتي يخضع للتحول والتغيير، ذلك أنّ عقلي لا يكفّ عن التساؤل والمراجعة والنقد والتقويض والغربلة، لكن ضميري الديني يتمثل في هذه العناصر الثلاثة المتضامنة: الإيمان والأخلاق والإنسانية، انطفاء أيّ منها يعني انطفاءها بتمامها...، كلما اتسعت خبرتي بالنصوص الدينية أشرق إيماني، وتنامى حسي الأخلاقي، وتعمقت نزعتي الإنسانية. بالرغم من احترامي لأصحاب التجارب الدينية كافة، غير أني لا أتذوق حلاوة الإيمان، ولا تضيء التجربة الدينية روحي، من دون أداء الصلاة والتمسك بالتقليد الطقوسي المستمد من الإسلام وشريعة نبيه. الصلاة والعبادات التي أؤديها هي معراج وصالي مع الحق، وهي جسر عبوري إليه في مدارج التسامي والصعود. وحسب تعبير المتصوفة والعرفاء: الشريعة توصلنا إلى الطريقة، والطريقة تقودنا إلى الحقيقة، فحين نتخلى عن الشريعة لا ننال الطريقة، وبالتالي لا نتذوق الحقيقة".[4]
ويقول في موضع آخر:
"حسب فهمي الذي استقيته من مطالعاتي المتنوعة، وتجربتي الدينية، وخبرة حياتي الروحية، انتهيت إلى ما يلي: لا يُمتلَك الإيمان ويتكرّس بلا مواظبة وإدمان على العبادات والطقوس. تكرار العبادات والطقوس يسقي الإيمان بماء الحياة، ويُرسّخه ويجذّره. الإيمان شعور حي يقظ فوّار، وهو من جنس الحالات، وكلّ ما هو من الحالات هو أمر تكويني، لا يتحقق من دون روافد يستقي بها وجوده، وتتجدد حياته. إنه جذوة مشتعلة، وهذه الجذوة بلا صلاة وطقوس تظل تذوي شيئاً فشيئاً حتى تنطفئ، ما لم تتكرر الطقوس والصلاة في سياق تقليدي عباديٍّ مرسومٍ، يذبل الإيمان فيصير حطاماً".[5]
لِنَعُد خطوة إلى الخلف، ونرى ما هي الأطر التي احتكمت إليها نظرة عبد الجبار الرفاعي لما أسماه بالظمأ الأنطولوجي، ونربطه بما ذكرته آنفاً. في مقدمة الكتاب الموسومة بـ (الدين والظمأ الأنطولوجي للمقدّس) يكتب عبد الجبار الرفاعي:
"أعني بالظمأ الأنطولوجي الظمأ للمقدّس، أو الحنين للوجود، إنه ظمأ الكينونة البشرية، بوصف وجود الإنسان وجوداً محتاجاً إلى ما يثريه، وهو كائن متعطش على الدوام إلى ما يرتوي به...، لكل موجود نمط كماله الذي هو من جنس كينونته، ويتسق مع سنخ وجوده. الظمأ الأنطولوجي إنما هو الفقر الوجودي، وارتواء الظمأ هو الغنى الوجودي. أي أنّ هذا النقص لا يكتمل إلا ببلوغ الكائن البشري طوراً وجودياً جديداً، يضعه في رتبة أعلى في سلّم التكامل الوجودي. الدين هو ذلك السلّم الذي يرتقي عبره هذا الكائن صعوداً للكمال، ويرتوي من خلاله ظمؤه الوجودي".[6]
حقيقة، هذا كلام مُنمّق، إلا أنه يفتقد إلى إطار منهجي يقوم على: تعريف المقدَّس، ممّا يجعله مفارقاً للمُدنَّس ومطلوباً بعينه، بصفته تعطشّاً إنسانياً لغاية التحقّق الأنطولوجي. فالالتباس الحاصل على المستوى البنيوي بين المقدّس والمدنّس، سيجعل من الإنسان نهباً لهواجس شتّى تجعله في حيرة من أمره، وهو يقارف هذا الوجود. فذاك الإنسان البدائي الذي تمثّل مُقدّسه على هيئة حيوان طوطمي، وذاك الإنسان الذي تمثّل إلهه على هيئة آلهة عديدة بما تحتمله من ملابسات مع الواقع العياني، أليسَ في تمثّلاته ظمأ أنطولوجي هو الآخر، أمكن فيه الاختلاط الحميمي بين المقدّس والمدنّس؟ أليسَ في التباسات (المقدّس/ المدنّس) نزوع ناحية ظمأ متعالٍ لا يمكن له أن يتحقّق إلا بمعاقرة الدَنَس والامتزاج به؟.
تعريف الظمأ الأنطولوجي، فالمحمول المفاهيمي لهذا المصطلح يشي بالقليل، رغم أنّ وعود الكتاب وعود كبيرة. فالظمأ الأنطولوجي هو ظمأ للمقدّس كما جاء في الفقرة أعلاه، إلا أننا رأينا ما يفتقد إليه التعريف السابق من كشف للمقدّس أساساً، لذا تبقى الثغرة المفاهيمية قائمة، لأنها لا تشبع نهم القارئ على المستوى العقلي.
تعريف الدين، إذ لم يقل لنا الكاتب ما هو الدين الذي يمكن أن يردم الهوّة الأنطولوجية التي تقف عائقاً أمام الطموح الإنساني للتسامي والارتقاء، ويتحوّل إلى قنطرة يمكن للإنسان أن يعبر من خلالها إلى مُقدّسه، ويتمثّل خلاصه الكبير بالتالي.
في حالة الافتقاد إلى تعريف المقدّس، سنكتشف أنّ المُراد به كما جاء في كتاب (الدين والظمأ الأنطولوجي) هو الله على الأغلب، لا سيما الله الخاص بالمسلمين، وليس الإله الكلّي أو فكرة الإله التي شغفت العقل البشري منذ بواكير نشاطه الديني. بما يجعل من الكتاب آنف الذكر كتاباً ذاتوياً يستند إلى تجربة شخصية، لا إلى تجربة إبستمية تسعى إلى إضفاء نوع من الشرعية العقلية على فكرة المقدّس عند الإنسان المُطْلَق، وقدرتها على منحه ارتواءً إبستمولوجياً يحدّ من ظمأه التكويني.
وفي حالة الافتقاد إلى تعريف الظمأ الأنطولوجي، سنكتشف أنّ فكرة الظمأ في ذهن الكاتب، هي فكرة جمالية أكثر منها فكرة معرفية، فالقارئ يقرأ الاستفاضات التي جاء بها الكاتب حول الظمأ الأنطولوجي وحاجة الإنسان إليه، لكنه سيبقى على ظمئه الإبستمي، لأنّ ذاك الظمأ لن يُلحّ على الكاتب إلحاحاً معرفياً، بقدر ما سيسعى إلى تفجير كوامنه الجمالية، التي صاغها في الفصل الثاني، عبر اعترافات أدبية جميلة، لا يمكن أن تنطبق حيثياتها إلا على الكاتب نفسه.
وفي حالة الافتقاد إلى تعريف الدين، ستتعزّز فكرة البوح الذاتي الجميل، الذي يعني الدين الإسلامي على نحو خاص، ومواضعاته في الحوزة العلمية على نحو أخصّ، بصفتها الإطار المرجعي للكاتب، بما يفضي إلى اقتصار الظمأ الأنطولوجي على الكاتب وحده، فهي تجربة تنوّر على المستوى الذاتي، وإفضاء بمكنون النفس بما يعتمل داخلها من حنين إلى عالَم آخر، أبرز صفاته أنه عالَم يروي عطش الظامئ، ويمنحه استقراراً على المستوى الأنطولوجي.
وإذا كان للكاتب أن يعترف بأنّ الإيمان خيار شخصي[7] كما جاء في الفصل الأول الذي يفترض به أن يكون إطاراً نظرياً لأطروحته حول الظمأ الأنطولوجي، فإنه يفصح عن غير ذلك في الفصل الثاني، إذ يقول: "كذلك لا أزعم أني أمتلك ما يكفي من روح المجازفة والمغامرة والشجاعة، لتدوين ما يخدش الحياء، أو ينتهك التابوات المتجذرة في عالمنا، خاصة وأني ما زلت منتمياً للحوزة، ومتساكناً مع الإسلاميين بألوانهم واتجاهاتهم كافة، وحريصاً على حماية ذاكرتي المشتركة معهم، وعدم التضحية بعلاقاتي التاريخية، بل أعمل على تعزيزها، وعجزي عن الانفصال والخروج والانشقاق على المحيط الاجتماعي، ذلك أنّ من يعترف بخطئه في مجتمعاتنا يغامر بفقدان هويته، ويكون الطرد والنفي واللعن مصير كلّ من ينتقد قبيلته وطائفته وحزبه".[8]
بما يجعل الفصل الثاني، فصل الاعترافات ـ إن جاز هذا الوصف- فصلاً محورياً في الكتاب، يمكن أن يُعبّر أكبر تعبير عن هاجس الظمأ الأنطولوجي كما عبّر عنه "عبد الجبار الرفاعي"، ومَوْضَعة هذا الظمأ في دينٍ بعينه، ألا وهو الدين الإسلامي. مع ما تحتمله هذه المواضعة من حالةٍ التباسية تجاه الأديان الأخرى، فمن جهة أمكن اعتبارها حالة إكراهية تجاه تلك الأديان، لأنّ الخلاص ذاتوي هَهُنا ولا يمكن له أن يتحقّق إلا عبر عبادات وطقوس بعينها، غير موجودة لدى أتباع الديانات الأخرى. ومن جهة ثانية لربما شكلّت هذه الرؤية حالة انفتاحية على الأديان الأخرى، فكما ترى الذات خلاصها في خُلاصاتها الدينية، أمكن اعتبار الخلاصات الدينية للذوات الأخرى بمثابة خلاص ذاتي لها، على المستوى اللاهوتي.
إذن، نحنُ أمام كتاب يحمل بين طياته أطروحة جميلة، لا أطروحة عقلية، بما يُصدِّر خيار الذاتية ويقدّمه على خيار الموضوعية في مقاربة ما جاء في هذا الكتاب، لناحية إبقائه في إطار الخُلاصات الفردية التي تسعى إلى خلاصها الأنطولوجي وفقاً لاستحقاقات تجربتها الذاتية، بما يعني ـ من ضمن ما يعني- عدم انعكاسها على الخلاص الغيري، نظراً لعدم انسجام تِلْكُمُ التجربة مع تجارب الخلاص الأخرى، فهما تجربتان لا تلتقيان على أرض معرفية واحدة، يمكن الاتفاق على أسسها التكوينية، بقدر ما تفترقان في رؤية العالم وفقاً لمقتضيات التجربة الذاتية المحضة.
[1] الرفاعي، عبد الجبار، الدين والظمأ الأنطولوجي، مركز دراسات فلسفة الدين، بغداد، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، مصر، تونس، ط1، 2016
[2] يمتدّ هذا الفصل من الصفحة 29 إلى الصفحة 101، بما يمنحه حضوراً طاغياً على بقية الكتاب، الذي توزّع على ستة فصول أخرى، هي: 1- نسيان الذات 2- علي شريعتي: ترحيل الدين من الأنطولوجيا إلى الأيديولوجيا. 3- التجربة الدينية والظمأ الأنطولوجي للمقدس. 4- أية دولة بلا حياة روحية أخلاقية. 5- لا خلاص إلا بالخلاص من أدلجة الدين. 6- تحديث التفكير الديني.
لربما كان الخط الواصل بين هذه الفصول، خطّ التجربة الشخصية للكاتب، لا خط الوصل المعرفي بينهما، رغم تأكيده في مقدمة كتابه أنّ معظم نصوص هذا الكتاب هي شروح ومعالجات لموضوع الظمأ الأنطولوجي وإن من زوايا مختلفة.
[3] يتحدّث في الفصل الرابع (ص ص 151- 181) عن التجارب الصوفية بشغف كبير، لكنّ هذا الحديث الجميل لا يمكن أن يطفئ ظمأ الإنسان الأنطولوجي إلا إذا مارس التجربة وخاض غمارها، بما يعزز فكرة أنّ عبد الجبار الرفاعي يتحدث عن تجربة ذاتية لا عن أطروحة عقلية في كتابه الدين والظمأ الأنطولوجي.
* أليسَ في اتهام الآخرين بالمراهقة والتنطّع، لأنهم يخالفون السائد على المستوى الديني، انزلاق خطير ناحية تقديس الموروث والحفاظ عليه، تحت شعار الحفاظ على مشاعر المسلمين؟ ماذا عن مشاعر أولئك المراهقين المتنطعين ـ بحسب تعابير عبد الجبار الرفاعي ـ؟ أليس في إجبارهم على السكوت ومجاراة السائد، نوع من الحَجْر على حريتهم المعرفية، وضرورة إخضاع ما هو فردي لما هو جمعي، بما ينسف تجربته الدينية الشخصية من أساساتها؟.
[4] الرفاعي، عبد الجبار، الدين والظمأ الأنطولوجي، مصدر سابق، ص ص 71- 72
[5] المرجع السابق، ص 75
[6] المرجع الساق، ص ص 5- 6
[7] المرجع السابق، ص 25
[8] المرجع السابق، ص ص 33- 34






