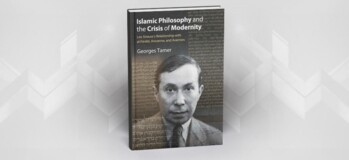العمل الديني وتجديد العقل: طه عبد الرحمن
فئة : قراءات في كتب

قراءة في كتاب العمل الديني وتجديد العقل
طه عبد الرحمن([1])
يُعدّ كتاب (العمل الديني وتجديد العقل) أحد أهمّ مؤلّفات المفكّر المغربي، الدكتور طه عبد الرحمن، ونحن، إذا ما تأمّلنا المشروع الفكري لطه عبد الرحمن، نقول: إنّ الكتاب أحد مكوّنات مشروع فكري متكامل الأجزاء (كتب طه عبد الرحمن)، يسعى، من خلاله، عبد الرحمن إلى بناء رؤية فكرية جديدة للفكر الإسلامي، ولعلاقة الإنسان بالدين، وبالعقل.
ينطلق طه عبد الرحمن من تعريف مخصوص مؤدّاه أنّ الإنسان كائن متقرّب، وقد ارتأى تتبع أبعاد هذه الرؤية، بالنظر في ثلاثة ضروب من ضروب العقل، وهي: العقل المجرّد، والعقل المسدّد، والعقل المؤيّد، فكان صاحب الأوّل (مقارباً)، وصاحب الثاني (قربانياً)، وصاحب الثالث يوسم بــــ: (المقرِّب).
وتقوم الضروب الثلاثة على مبدأي الاتصال والانفصال، فالعقل المسدّد، والعقل المؤيّد، كلّ منهما أخذ، عن السابق لهما، ما حسُن، وحذف منه ما قبح، فكان العقل المؤيّد أكمل العقول، ومطلب المؤمن، ذلك أنّ العقل التجريبي يقوم، بالأساس، على التحليل الملموس للواقع. أمّا العقل المسدّد، فيقوم على الاشتغال الشرعي، في حين يكون العقل المؤيّد عقلاً متجاوزاً للعقلين السابقين، جامعاً لمطالب الروح، ومقتضيات العقل، ومتطلباته.
وهي قراءة تقدّم تصوراً جديداً للعقل يتجاوز الأطروحات المتداولة، ويبسط، على البحث العلمي، رؤية جديدة تدفع إلى التفكير في المسائل بعين ثاقبة متفحصة لا تأخذ بالمسلمات، بقدر ما تُسائلها، وتروم مراجعتها مراجعةً نقدية تفهمية.
صدر كتاب: العمل الديني وتجديد العقل، للمفكر المغربي طه عبد الرحمن، عن المركز الثقافي العربي، (الدار البيضاء - المغرب، بيروت - لبنان)، سنة تسع وألفين (ط4)، ويتكوّن من مئتين وأربع وعشرين صفحة من الحجم المتوسط (قياس 17 سم 24 سم)، ويتشكّل الكتاب من فهرس المحتويات (ص5-8)، ومقدمة (ص9-12)، وأبواب ثلاثة، اختار الباحث أن يتطرّق فيها إلى الإشكاليات الآتية:
الباب الأول: العقل المجرّد وحدوده (ص17-53).
الباب الثاني: العقل المسدّد وآفاته (ص55-116).
الباب الثالث: العقل المؤيد وكمالاته (ص117-220).
وأتبع هذه الفصول بخاتمة وَسَمَها بــــ (موجز في قوانين مراتب العقلانية). أمّا فيما يتصل بمحتويات الأبواب، فنلاحظ قيامها على بنية واحدة واضحة، تتمثل في الشكل الآتي:
مقدمة/تمهيد (نشير إلى أنّ الباحث لم يشر إلى وجودها في الفهرس العام، أو في فاتحة كلّ باب)، وفصل أول، وفصل ثانٍ، وفصل ثالث، وخلاصة (باستثناء الباب الثالث).
و قد قامت فصول الأبواب الثلاثة على منطق مخصوص؛ تدرّج فيه الباحث من أصناف العقل، فشرع في بسط حدود العقل المجرّد، ومقدمتيه، وبيّن محدوديته الخاصة والعامة؛ لينتقل، في الثاني، إلى صنف جديد من العقل، هو العقل المُسدّد، وفي هذا الباب، حدّد مقدّمتي العقل المسدد، وبيّن تأثير الممارسة الفقهية والممارسة السلفية فيه، وما ترتّب على تلك الممارستين من آفات خُلُقية وعلمية طالت العقل المسدد. أمّا الباب الثالث، فخصصه للنظر في العقل المؤيّد وكمالاته، وفي مقدّمة هذا الباب، حافظ الباحث على التمشي نفسه؛ الذي اعتمده في البابين السابقين، فبسط المقدمتين المميزتين للعقل المؤيّد، مبيّناً منزلة الممارسات الصوفية، والكمالات التحقيقية والتخليقية له (العقل المؤيّد).
ونحن، إذا ما تأمّلنا توزيع الصفحات، حسب الأبواب والفصول، ألفيناها على النحو الآتي:
الباب الأول خَصص له الباحث نحو أربعين صفحة.
الباب الثاني خَصص له أكثر من ستين صفحة.
الباب الثالث خصص له نحو مئة صفحة.
فالباب الثالث، من حيث الحجم، يعادل نصف الكتاب تقريباً، وهو ما يؤكّد أهمية العقل المؤيد بالنسبة إلى الباحث، وهو أمر يؤكّد ترتيب العقول في الكتاب، وما أفصح عنه الباب في خاتمة الكتاب. أمّا فيما يتصل بالعنوان، فإنّه يقوم، في مستوى التركيب اللغوي، على مركب بالعطف (العمل الديني/تجديد العقل)، وقد جاء المركب الأول مركباً نعتياً. أمّا الثاني، فجاء مركباً اسمياً بالإضافة (تجديد العقل).
ويمثل الجمع بين العمل والعقل مدارَ الأطروحة؛ التي يشتغل بها طه عبد الرحمن، وفيما يتصل بهذه المسألة، نقول: لئن حدّد طه عبد الرحمن مجالات العمل بوسمه بالعمل الديني، فإنّ تجديد العقل يظلّ في المستوى النظري غير معلوم، فلا ندري ما المقصود بالعقل هل هو العقل الديني أم...؟
وإذا ما كان المقصود بالعقل العقل الديني، فهل يعني ذلك أنّ طه عبد الرحمن يراهن على إمكانية تجديد آليات اشتغال العقل الديني، انطلاقاً من العمل الديني من جهة، ومن جهة أخرى، أيدلّ الجمعُ بين العمل والعقل، في عنوان الكتاب، على وجود انفصال بين الحقلين، أم أنّه دالّ على اتصالهما اتصالَ السبب بالنتيجة، على نحوٍ يجعل من العمل الديني مسلكاً لتجديد العقل؟
تلك أسئلة يطرحها علينا العنوان، ويقتضي الأمر منّا أن نفكّر فيها على نحو مخصوص يتطلّب بالضرورة تحديد ماهية العمل الديني، وماهية العقل، وطرق تجديده.
صدّر طه عبد الرحمن الكتاب بآيات قرآنية هي قوله تعالى، في سورة الذاريات51/56 -59: {وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاّ لِيَعْبُدُونِ *ما أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَما أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ *إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ *فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحابِهِمْ فَلا يَسْتَعْجِلُونِ}.
وفي هذه الآيات الثلاث، لاسيما الأولى، تتجلى الغاية من الخلق في مفهومه العام، فمدار الخلق، في الآيات القرآنية، على العبادة، بيد أنّ تحديد مفهوم العبادة، في الفكر الإسلامي، لم يقتصر على التعبّد، بقدر ما قام على التفكير والتأمل، فالآيات القرآنية حدّدت، في شكل تأليفي، العمل الذي يعتزم طه عبد الرحمن إنجازه، والذي وصفه باليقظة الدينية في العقود الأخيرة، التي تأسست على قاعدتين هما: «الغلوّ في الاختلاف المذهبي، والخُلوُّ من السند الفكري» (ص9).
ومن هذا المنظور، يرمي الكتاب - وفق تصوّر صاحبه - إلى «بيان الشروط التكاملية والتجديدية التي تجب في تيقظ هذه اليقظة الدينية» (ص9).
المقدّمة:
حدّد طه عبد الرحمن، في المقدّمة، أسباب التأليف، ودواعيه، فإذا بالبحث يسعى إلى فهم أبعاد «مشكلة اليقظة العقدية» (ص9)، وتجاوز نقائصها. وفي هذا السياق، يصبح الكتاب (العمل الديني وتجديد العقل) بياناً للشروط التكاملية والتجديدية؛ التي تجعل من اليقظة العقدية متناغمة الأوصال، متكاملة الأجزاء، متجدّدة غير متحجرة، أو جامدة. وفي هذا المجال، يرى طه عبد الرحمن أنّ مدار اليقظة على مفهومين رئيسين هما: (التجربة)، و(التعقّل)، فالمفهوم الأول موصول بالتجربة الإيمانية القائمة، بالأساس، على التخلّق المؤدّي إلى سلوك طريق الأخذ بأسباب الألفة والتفاهم لا عكسها. أمّا المفهوم الثاني، فقوامه تنظيم التجربة الإيمانية، وشدّ أسّها بأقوى المناهج العقلية.
وبهذا المعنى، تكون العلاقة بين التعقل والتجربة علاقة الوجه بالقفا، وعلى هذه الرؤية، بنى المؤلّف البحث، فكان الباب الأوّل في (العقل المجرّد وحدوده)، وفي مقدمة الباب، بيّن طه عبد الرحمن أنّ الإلمام بالعقل المجرد يتطلّب الإلمام بعقل أرفع منه منزلة وأعلى، من جهة، ومن جهة أخرى، بيّن أهم المصطلحات والمفاهيم التي اعتمدها أنصار العقل والعقلانية، عاداً العقلَ المجردَ محلاً للإثبات، والنفي، والخطأ، والصواب، وبهذا المعنى، يصبح العقل المجرّد - في رأي المؤلّف - العقل الجامع، فلا سبيل للإحاطة بالتراث، ما لم نتبين حدود العقل المجرّد.
الفصل الأوّل: مقدّمتا العقل المجرّد:
رسم المؤّلف، في هذا الفصل، حدود العقل المجرّد، وذلك بالتمييز بين الحدود الخاصة والحدود العامة، مقراً بأنّ العقل المجرّد يقوم على مقدمتين، تتمثّل الأولى في (الصفة الفعلية للعقل المجرّد). أمّا الثانية، فهي (محدودية العقل المجرّد)، ففيما يتصل بالمقدّمة الأولى، بيّن أنّ «العقل المجرّد عبارة عن الفعل، الذي يطلع به صاحبه على وجهٍ من وجوه شيءٍ ما، معتقداً في صدق هذا الفعل، ومستنداً، في هذا التصديق، إلى دليل معيّن» (ص17).
ويلاحظ، أيضاً، أنّ العقل بمعنى الفعل قد اتخذ صوراً وأشكالاً عديدة، منها صورة الربط؛ أي: إدراك القلب لعلاقة بين معلومين، وصورة الكف، وذلك بمنع العقل صاحبه من إتيان ما يضرّ به. أمّا الصورة الثالثة، فهي الضبط؛ أي: إمساك القلب لما يصل إليه حتى لا ينفلت منه. وبهذا المعنى، العقل هو الفعل؛ أي: فعل القلب، على أنّ للعقل، عند المسلمين، استعمالات أخرى، منها عَدُّ العقل جوهراً؛ أي: ذاتاً قائمة بالإنسان، وهو المعنى المستفاد من التراث اليوناني. ومن شأن هذا التصور أنْ يؤدّي إلى التشيئة والتجزيئية، وغير ذلك تعدد للذوات، وهو ما يعدّ باطلاً.
ومن أهم الأشكال، أيضاً، عَدُّ العقل الجامع بين الفعل (فعل القلب) والجوهر، وفي هذا الإطار، حُمل العقل على معانٍ عديدة، منها الدلالة على الفعل المحصّل بالعلم، ومنها الدلالة على معنى الغريزة، التي بها نحصّل العلم، ونناله، ومنها حمل العمل على المعنيين معاً، وهي السمة الغالبة على الفكر الإسلامي؛ الذي جعل العقل جامعاً للفعل والجوهر، بيد أنّ المعنى الأول (الفعل) كان الأصل، في حين كان الثاني الدخيل (الجوهر).
وقد مثل تعارض الأصل والدخيل السبب الرئيس وراء ظهور الاجتهاد في الأصول وعلم الكلام، فأغلب الاجتهاد كان محاولة لتجاوز التعارض، وذلك باعتماد آليات متعدّدة منها (إدخال تمييزات جديدة)، و(حذف بعض السمات الدلالية)، ومن وجوه المحاولات، التي رامت رفع التناقض - في تصوّر طه عبد الرحمن - جعل العقل (القوة الغريزية)، بدلاً من أنْ يكون (الوجود المستقل)، ومن شأن اعتبار العقل قوة غريزية أن يؤدّي إلى نفي الاستقلال بالنفس عنه.
وقد ترتب على هذه التصنيفات القول بأنّ العقل قد يحسن، وقد يقبح، شأنه، في ذلك، شأن الأفعال والأوصاف، ولا يقتصر التشابه بين العقل والأفعال والأوصاف على هذا الجانب، وإنّما يشمل، أيضاً، مبدأ التحوّل؛ الذي يُعدُّ الجامع بينها، فبمقتضى هذا المبدأ يمكن توجيه القلب، والتأثير فيه.
ويضيف طه عبد الرحمن إلى ذلك نتيجةً على غاية من الأهمية تتمثّل في أنّ «الوصف العقلي؛ الذي تميّزت به المعرفة العلمية النظرية، ليس وصفاً ذاتياً لازماً للقلب، وإنّما عملت على اتصاف أو تخلّق القلب بأسباب ظرفية، وملابسات عرضيّة كان بالإمكان أن تقوم مقامها أسباب وملابسات أخرى تفضي إلى إنشاء وصف عقليّ مميز لمعرفة علمية مغايرة» (ص21).
أمّا المقدّمة الثانية، فمدارها على (محدودية العقل المجرّد)، وفي هذه المقدمة، نظر في (الخصوصية النظرية للإلهيات الإسلامية)، و(طلب المشروعية للإلهيات)، ذلك أنّ المباحث الإلهية هي أكثر شعب المعرفة المبرزة لحدود العقل المجرّد في الممارسة الإسلامية، ففيما يتّصل بالمسألة الأولى يقرّر الباحث أنّ مبحث الإلهيات هو أحد العلوم النظرية؛ التي تتوسل بالعقل المجرّد في التحصيل والتبليغ، وهو ما يجعل من الضرورة بمكان الوقوف على الحدود الخاصة بهذا العقل المجرّد في مستوى الممارسة الإلهية في المعرفة الإسلامية العربية.
أمّا بخصوص المسألة الثانية، فذهب الباحث إلى القول: إنّ تطرّق المسلمين للإلهيات قام على اجتهاد منهم في منح هذا المبحث مشروعيةً عقديةً اختلفت، في وجوهها، ومظاهرها، وتوجهاتها، بيد أنّها اشتركت في الرؤية والتصور؛ الذي مفاده أنّ «كتاب الله العزيز (القرآن الكريم) [...] يشتمل على المادة اللغوية/ع، ق، ل/في صيغها الفعلية، مع تكرار ذكرها مثل (عقلوه)، و(نعقل)، و(يعقلون)، و(تعقلون)، ولا وجود، في هذا النص، لصيغة اسمية من هذه المادة، كاسم المصدر «عَقْل من عَقَلَ»، أو المصدر (تَعَقُّل من الفعل تَعَقَّلَ)». (ص22).
ويُستدل من ذلك أنّ صيغ الفعلية/الصيغ القرآنية قد اتّصلت بالحديث عن الكلام في الغيبيات، وأمور الملكوت، وهو ما دفع بالعلماء المسلمين إلى الاستدلال بقدرة العقل المجرّد على فهم عالم الغيب، وتأسيس مباحث فيه وُسِمت بــــ: (علم الإلهيات). وفي المقابل، أشار الباحث إلى أنّ العقل المجرّد عند القدامى قد عُرف بــــ: (النظر)؛ الذي يدلّ، فيما يدل، على الفعل الإدراكي؛ الذي يطلب شيئاً معيّناً للظفر به، والمقصود عندهم (استفادة تقرّب من الله)، وهو ما وُسم بــــ (المقاربة)، وسمّي القائم به (المُقارب).
أمّا، في الفصل الثاني، فتوقف الباحث على (الحدود الخاصة للعقل المجرد)، وفيه تطرّق إلى مسألتين هما (مسألة الألوهية ومسلك المقاربة) (ص25)، وفي هذا المبحث، توسّع طه عبد الرحمن في أبعاد دلالة مفهوم «النظر»، مستخلصاً أنّ حدّ النظر الإلهي «يشتمل على معنيين أساسيين هما: العقلانية والاقتراب» (ص25)، فالأول يتمثّل في إثبات النظر الإلهي، بالدليل العقلي، الحقائقَ الإلهية، التي يدعو إليها.
أمّا مبدأ الاقتراب، فيتمثّل في اجتهاد «الناظر الإلهي»، بعقله، في السير نحو المطلب الإلهي، وطيّ المسافة بينه وبينه، ومن شروط الاقتراب أن يتزايد كلّما تزايدت وسائله، وتكاملت فيما بينها، ويبلغ أعلى درجاته متى أخذ بوسائل تناقلها النظّار الإلهيون فيما بينهم، وحصل يقينهم بها» (ص25).
وعن اكتمال المبدأين، واستيفاء شروطهما، يتحقق النظر الإلهي، أو المقاربة الإلهية؛ التي حلّل طه عبد الرحمن خصائصها، فإذا هي (رمزية لا وجودية) و(ظنية لا يقينية)، و(تشبيهية لا تنزيهية)، ومن خلال الخاصية الأولى، بيّن أنّ اللغة؛ التي تعد الوسيلة التي بها يتوسّل الناظر الإلهي رمزية صورية، لا تنقل «إلينا الأشياء ذاتها بسماتها الخارجية ومعالمها الوجودية» (ص26)، وهو ما دفعه إلى الإقرار باستقلال مستوى اللغة عن مستوى الوجود، ولكي يبيّن أبعاد المسألة، تناول بالتحليل اسماً من أسماء الصفات الإلهية، وهو اسم (الرحيم)، وقد قاده البحث في هذا الاسم إلى استخلاص نتيجة مهمّة تتمثّل في أنّ اجتماع صفتي (القدم)، و(الوحدانية)، «يسلّم المخاطب به من غير أن يستفيد هذا التسليم من مجرّد البنية اللفظية للاسم» (ص27).
وبهذا الشكل، فإنّ الممارسة اللغوية تؤدي إلى تجاوز حدودها الرمزية، فالقول بالوحدة والوجود في حقّ الخلق، أو القدم والوحدانية في حقّ الخالق، أمور لا تطيقها الطبيعة الرمزية للغة. أمّا الخاصية الثانية (ظنية/لا يقينية)، ففيها بيّن أنّ «أدلة الوجود الإلهي [ليست] صوراً استدلالية مجرّدة، وإنّما هي صور مشخّصة؛ أي: صور تحمل مضامين، كلّما كانت صلتها بالمعتقدات والمقاصد ألصق، كان تأثيرها في المخاطب أعمق» (ص28).
ومن هذا المنظور، إنّ الحجج الجدلية المقنعة أنفع من البرهان الصحيح غير المقنع؛ ذلك أنّ المسألة موصولة، في الأساس، بالقيمة التداولية، قبل كلّ شيء، وهو ما يعني أنّ البناء النظري يقوم على صور منطقية برهانية يراها المستعمل لها يقينية، لا سيما في مجال النظر الإلهي، ومأتى هذا الاعتقاد قدرتها على التأثير في المخاطب.
في حين تتمثّل الخاصية الثالثة في أنّ (الإلهيات النظرية تشبيهية لا تنزيهية)، ومؤدّى هذه الخاصية أنّ اعتماد التشبيه والمقارنة شكل من أشكال الفهم والإفهام، ومن شأن الاعتماد على هذين الأسلوبين أنْ يوقع الناظر «في الإلهيات [...]، شاء أم أبى، تحت وطأة الأساليب التشبيهية، في تقريبه للمطلوب الغيبي، وتقديره لصفاته» (ص30)، وهو تشبيه وَسَمَه الباحث بالتشبيه الاضطراري، مميزاً إياه من (التشبيه الاختياري)؛ الذي يؤدّي إلى التعطيل (التسوية بين الخالق والمخلوق/الموجود والمعدوم)، والتأويل بما هو عدول بالألفاظ عن معانيها الحقيقية، والإثبات والنفي، فالناظر لا مفرّ له من التشبيه، ولكنْ عليه أن يظلّ مشبهاً مضطراً لا مخيّراً.
أمّا فيما يتصل بالأسماء الحسنى والتقرّب بالتسمية، فإنّ العلاقة بين (الحسن) و(الاسم)، وبين (الحُسن في الاسم)، و(الدعاء بالاسم) هما مدارا البحث في أسماء الله الحسنى.
وقد انطلق طه عبد الرحمن، في معالجته لهذه المسألة، من مسلّمة مؤداها أنّ «ما كان من المعاني من إنتاج العقل المجرد» (ص34). فالمعاني الموصولة بالأسماء الحسنى، وإنْ كانت دالة، عند المفسرين، على صفات العلو والشرف، فإنّ ذلك لا يمنع من التمييز بين اسم الجلالة (الله) باعتباره اسم ذات، والأسماء الحسنى بما هي أسماء صفات.
وقد بيّن أنّ الدعاء هو تسمية للذات الإلهية، بما لها من صفات وأفعال مميزة لها تختصّ بها، وهو ما جعل الدعاء بالأسماء الحسنى ليس مجرّد التعيين/التسمية، بقدر ما هو محاولة لتحقيق التقرّب، ذلك أنّ التسمية لا تقتصر على التعيين، وإنّما تتجاوزه لتشمل التقليب، والنداء، والوصف.
فالأسماء الحسنى تدخل في دائرة التقرّب، الذي يتجلّى في ركنين أساسيين هما: العقلانية والإحسان، فالتقرب يدفع بالمسمّى إلى اتخاذ مسلك عقلي مجرّد يطلب، من خلاله، معرفة الأسماء، فالأسماء ومدلولاتها من قبيل المعقولات. أمّا الإحسان، فيتمثل في أنّ الأسماء «تُحسن لمن طلب معرفتها بطريق العقل المجرّد، ولا شيء يمنع من أن يُحمل معنى الحُسن في الأسماء الحسنى على الوجه الذي تُحسن به هذه الأسماء لمن دعا بها، أو ذكرها، وأحصاها» (ص35).
ليخلص، بعد النظر في ركني التقرب بالتسمية، إلى أنّ نظرية التقرب بالأسماء نظرية وصفية في الأسماء، وهي تقوم على الدعاء بالاسم، وبأن الاسم يمكن ردّه إلى مجموعة من الصفات؛ التي يختصّ بها المسمّى، وبأنّ أسماء الصفات المعرفة (بالألف واللام أو بالإضافة) مرتبطة ارتباطاً مباشراً بــــ: (الوجود)، و(الوَحدة).
وبناء على ذلك، يخلص إلى أنّ تعدد الأسماء لا يتنافى ووحدة الذات، على أنّ هذا التقرب يظلّ - في تصور طه عبد الرحمن - قاصراً؛ ذلك أنّ الدعاء بالأسماء الحسنى يقوم، في الأساس، على ذكر المسمى باسمه، يضاف إلى ذلك أنّ المعرفة الحاصلة في الأسماء تظلّ معرفة قائمة على جملة من التصوّرات الذهنية والمعاني العقلية، على أنّ أهمّ وجوه القصور - في تقديره - يتمثّل في أنّ التقرب بالأسماء الحسنى يؤدي، بالضرورة، إلى الوقوع في التشبيه الاضطراري والخفي؛ لينتهي إلى أنّ مسألة حدود العقل المجرّد، فيما يتعلق بمسألة الألوهية وأسماء الله الحسنى، متعلقة، في الأساس، بأوصاف ثلاثة، وهي الوصف الرمزي، والوصف الظني، والوصف التشبيهي.
أمّا الفصل الثالث، فخصّصه الباحث للنظر في (الحدود العامة للعقل المجرد)، وتنقسم الحدود العامة، عند طه عبد الرحمن، إلى الحدود المنطقية، والحدود الواقعية، والحدود الفلسفية، فالأولى تتفرّع إلى عدم البتّ وعدم التمام من جهة، والعجز عن رفع الحدود المنطقية من جهة أخرى. أمّا الحدود الثانية، فهي تقوم على النسبية، والاسترقاقية، والفوضوية، في حين تُبنَى الحدود الفلسفية (الثالثة) على مادية العقلانية المجرّدة (التظهير/التحييز/التوسيط)، وملازمة العقلانية للعقل المجرّد (تجاوز النظريات العلمية بعضها لبعض/خلوّ بعض الأنساق من الضوابط المشهورة للعقلانية/إباحة الضرورة العلمية للأخذ بالمتناقضات)، وعدم وجوب العقلانية المجرّدة (الصفة العرضية للموروث الفكري/الإمكان المبدئي لقيام عقلانية غير مجرّدة).
وقد قاد البحث، في شأن الحدود الثلاثة، طه عبد الرحمن، إلى القول: إنّ الحدود المنطقية لا تمكّننا من إخضاع الواقع لعقلنة كاملة، ذلك أنّ ثمّة حقائق لا سبيل، البتة، إلى تعقّلها. أمّا فيما يتصل بالحدود الواقعية، فهي تؤكّد أنّ قوانين العقل المجرّد غير مشتركة، وهي غير كلية من جهة، ومن جهة أخرى، إنّ امتلاك الإنسان للتقنية لم يحقّق له السعادة والرخاء، بقدر ما أوجد «كوناً تقنياً» (ص45) يحكمه مبدآن؛ مبدأ عقلاني يتمثل في أنّ (كلّ شيء ممكن)، وآخر لا أخلاقي يتمثل في (كل ما كان ممكناً وجب صنعه). فإذا بالإنسان يتجاوز الموانع الأخلاقية، ويتحول إلى عبد للتقنية، وعن ذلك تنتج الفوضوية. أمّا الحدود الفلسفية، فهي تؤكّد أنّ العقل المجرّد هو «أقرب إلى طبيعة تمديدية (أي: يصبغ الأشياء بصبغة مادية) منها إلى طبيعة تجريدية» (ص47).
الباب الثاني: العقل المسدَّد وآفاته:
ينتقل طه عبد الرحمن، في الباب الثاني، من دراسة (العقل المجرد وحدوده)، إلى دراسة (العقل المسدّد وآفاته). وفي مقدّمة هذا الباب، سعى إلى تبيّن وجوه تنقيح العمل للعقل المجرّد من جهة، ومن جهة أخرى، وقف على الآفات التي تلحق بالعقل المنقّح، الذي وسمه بالعقل المسدّد، عادّاً الممارسة الفقهية والممارسة السلفية أهمّ أشكال (العمل الشرعي)، وهما، عنده، ينطويان على آفات عديدة تتمثّل في وضع حدود جديدة، تجلّت في وضع الممارسة الفقهية لــــ (آفات خلقية)، في حين كانت الممارسة السلفية، في منزعها السياسي ومسلكها العقلاني، مؤسسة لــــ (آفات علمية).
وقد خصّص الباحث الفصل الأول للنظر في مقدّمتي العقل المسدّد، وهما: (الصفة العلمية)، و(دخول الآفة) على العقل المسدّد، ففي الأول عرّف المقصود بالعقل المسدّد، فهو يقوم على القول: إنّ «الفعل المعتبر فيه ليس أيّ فعل كان، وإنّما هو فعلٌ شرطُه أن يتّصف بالأوصاف الثلاثة [..]، وهي: الموافقة للشرع، واجتلاب المصلحة، ثمّ الدخول في الاشتغال» (ص58).
وقد قاده هذا التصوّر إلى التمييز بين العمل الشرعي والعمل غير الشرعي؛ الذي يقوم، بالأساس، على صفات ثلاث، وهي: الصفة المادية، والصفة السطحية، والصفة الذاتية، وهي صفات تحول دون (الدخول في الاشتغال)، بما هو «خروج من وصف النظر إلى وصف العمل» (ص61)، وللاشتغال/الممارسة وظائف أربع هي: التشخيص، والتشريف، والتوسيع، والتصحيح، وهي تؤكّد أنّه (الاشتغال) تجسيد للعمل، وتصحيح للسلوك.
أمّا المقدّمة الثانية، فدارت على الآفات الناشئة عن الممارسة العقلانية الإسلامية، في الجانب الفقهي، والجانب السلفي، فالعقل المسدّد بدا، في الممارستين، «العقل المجرّد، وقد دخله العمل الشرعي» (ص67).
وقد توسّع الباحث في أبعاد هذه الآفات ومظاهرها في الفصل الثاني الموسوم بــــ: (الممارسة الفقهية والآفات الخلقية للعقل المسدّد)، والفصل الثالث الموسوم بــــ: (الممارسة السلفية والآفات العلمية للعقل المسدّد)، ففي الفصل الثاني، يرى طه عبد الرحمن أنّ الاشتغال بالفرائض جعل عملية التقرّب تتخذ شكلاً (قربانياً)، وبهذا الشكل، أصبحت الممارسة الفقهية ممارسة مُؤسسة لآفات خُلقيّة تجلّت في آفات: التظاهر، والتكلّف، والتزلّف، والتصرّف (تعظيم أعمال الذات/تحقير أعمال الغير)، والتقليد، وهي آفات تؤدّي إلى التساهل في صدق الأعمال، وهو ما يحرم المتقرّب من التوفيق الإلهي. أمّا الممارسة السلفية، ففي مواجهتها للطرق الصوفية، أنتجت جهازاً مفهومياً يقوم على التبديع؛ الذي انتهى إلى تجــميد الأمّة، وظهور آفة التجريد، وآفة التسيس، بما هي ترك للأخذ بالمعاني الروحية، وترك للعمل بالقواعد الأخلاقية، وترك للاستقامة.
أدّت الدعوة إلى الرجوع إلى السلف إلى الإخلال بمبدأ التوازن بين العوامل الدينية، والنظرية السياسية، فالعقل المسدّد، في مستوى الممارسة الفقهية والممارسة السلفية، يقوم على الأفعال الاعتقادية؛ التي تؤدّي إلى تفاوت بين العمل والمقاصد، أو الوقوع في التقليد حيناً، وإلى قصر التأمّل في النصوص على العقل المجرّد حيناً آخر.
إنّ العقل المسدّد، وإنْ كان أعلى منزلة من العقل المجرّد، وذلك بالنظر إلى أنّ الممارسة الشرعية الإسلامية تسعى، في المستوى الفقهي والمستوى السلفي، إلى تجاوز حدود العقل المجرّد، فإنّ العقل المسدّد «لا يستنفد كلّ الإمكانات والاستعدادات العقلانية؛ التي تبقى في مقدور الإنسان» (ص115).
وفي هذا السياق، يرى الباحث أنّ العقل المسدّد، متى نزّلناه في حيز التجربة الحيّة، غدا عقلاً جديداً وَسَمَه بالعقل المؤيّد، باعتباره تجاوزاً للحدود والآفات، وتحقيقاً للكمالات.
وقد خصّص، للنظر في (العقل المؤيّد وكمالاته)، الباب الثالث، الذي بيّن فيه كيف يتدارك العقل المؤيّد الآفات الخلقيّة والعلمية؛ التي يقع فيها العقل المسدّد، وذلك من خلال النظر في الممارسة الصوفية؛ التي تقوم على الاستغراق في الاستعمال الشرعي، فالممارسة الصوفية قائمة على الصفة التجريبية، التي ترتكز على مقدّمتين أساسيتين، وهما العينيّة والعبدية، وهو ما يمكّن العقل المؤيّد من تجاوز العقل المجرّد؛ الذي اقتصر على معرفة الصفات، والعقل المسدّد القائم على معرفة الأفعال، وذلك بطلب معرفة الذوات، التي لا يمكن الوصول إليها بالنظر أو الاشتغال (العمل)، وإنّما باجتماعهما وتكاملهما، وهو ما يمكّن المتقرّب من بلوغ مرتبة الإخلاص؛ التي تتطلب، بالضرورة، التخلّص من (طلب الانتفاع بالعمل)، و(الرغبة في تعظيم العمل)، و(الميل إلى إسناد العمل إلى الذات)، و«هي أمور تنتهي بالمتقرّب إلى إدراك تقدّم المنّة الإلهية، ودورها في سداد العمل الشرعي، ووظيفتها في التحقّق الخلقي للأفعال، [وهو ما يجعله يــــ]أخذ في التوجّه إلى الاستقلال عن التبعية العلمية، والتقيّد بالتبعيّة الأصلية» (ص138)، ومن شأن نوال المتقرّب درجة العبدية أنْ يُخرجه من الافتقار إلى الغنى، ومن الاضطرار إلى الاقتدار.
وبهذا المعنى، إنّ العقل المؤيّد يتيح للإنسان القدرة على اتّقاء الآفات الخلقية والعلمية، وهو ما يجعل التجربة الصوفية تجربة حيّة توفّر له (أكمل طريق في التعقّل)، ولا يكون التعقّل كاملاً إلا إذا استوفى [شروطاً ثلاثة تتمثل في] تلازم العلم والعمل من جهة، وأنْ تكون معرفة موضوع أيّ علم (نابعة) من معرفة الله من جهة ثانية، وأنْ تكون في «الممارسة العقلية متّسع للاستزادة الدائمة» (ص149)، من جهة ثالثة.
فالتجربة الصوفية - في تقدير طه عبد الرحمن - تتجلّى في جانبين هما: التحقيقي والتخليقي، ولكي يبيّن المؤلّف وجوه تميّز العقل المؤيّد من العقل المسدّد، أو العقل التجريبي، نظر في الموضوعين اللذين سبق أن تناولهما أثناء التطرّق إلى العقل المسدّد، والعقل التجريبي، وهما مسألة الألوهية، ومسألة (الأسماء الحسنى).
وقد أدّى النظر في خصائص الممارسة الصوفية، والكمالات التحقيقية للعقل المؤيّد، إلى القول: إنّ التصوف يقوم على المحبّة؛ التي توفّر للصوفي القدرة على إدراك أعيان الأشياء، عن طريق إدراك الذات. وبهذا المعنى، يكون الاستدلال على الألوهية بغير طريق النظر المجرّد، ومن شأن الممارسة الصوفية أنْ تجعل الصوفي ميّالاً إلى الكسب؛ «لأنّه محفوظ من التملّك، الذي يتطرّق إلى الكسب لدوام انشغاله بالقرب، ولا الميل إلى ترك الإصلاح؛ لأنّه محفوظ من التسيُّس؛ الذي يطرأ على الإصلاح» (ص182).
أمّا الفصل الثالث؛ الذي عنوانه (الممارسة الصوفية، والكمالات التخليقية للعقل المؤيّد)، ففيه انتهى الباحث إلى أنّ التقرّب بوساطة العقل المؤيّد أفضل من التقرّب بالعبادة القائمة على العقل المسدّد، ذلك أنّ الاستغراق في العمل يجعل الصوفي متحققاً ومتخلّقاً.
وهو ما يجعل المتقرّب أنموذجاً يُقتدى به، وذلك بالإتيان بعمليتين متداخلتين هما: التطهير العيني، والترسيخ العبدي، وذلك بقصد تجاوز الصعوبات، والعوائق التجريبية والمعرفية، سعياً إلى بناء تكامل بين المادي والروحي. أمّا الوسيلة، فتتمثّل في التعبير الإشاري؛ الذي يتجدّد بتجدّد النموذج.
إنّ التصوف يتأسّس على صفة إلزامية بين العلم والعمل، ومعرفة الأشياء، ومعرفة الله، وهو ما يجعل من التجربة الصوفية تكليفاً بمهمّة التخليق؛ الذي يرتقي إلى مرتبة الأمانة، ذلك أنّ التخليق فعل اضطراري للمقرّب، ومظهر من مظاهر المحبّة، فــــ «التخليق مهمّة تكليفية، بمعنى أنّ المقرّب يؤدّي الوظيفة بقهر الإيجاب [... أمّا] من ينهض إلى التخليق بغير إيجاب، وبمحض الاختيار التجريدي، أو بمحض القرار التسديدي، فإنّما يكون قد اغتصب هذه الوظيفة اغتصاباً» (ص209).
1 نشر ضمن مشروع "تجديد الفكر الإسلامي مقاربة نقدية (2) محاولات تجديد الفكر الإسلامي مقاربة نقدية"، تقديم بسام الجمل، مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث.