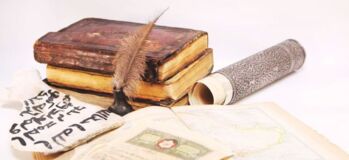المنهج في الفكر العربي المعاصر: من فوضى التأسيس إلى الانتظام المنهجي عبد الله أخواض
فئة : قراءات في كتب
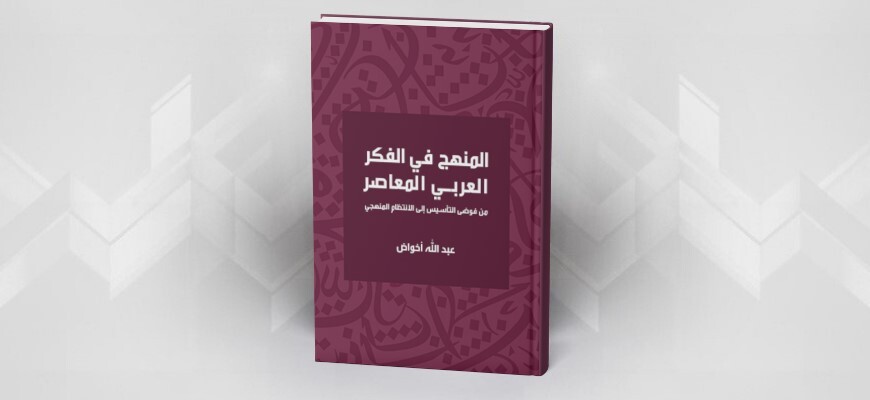
المنهج في الفكر العربي المعاصر: من فوضى التأسيس إلى الانتظام المنهجي
عبد الله أخواض
فكرة الكتاب
سيجد قارئ هذا الكتاب مقاربة منهجية للمدرسة الاتجاه القومي العربي في قراءة التراث، مع التركيز على الخلفيات الفكرية والمنهجية ومختلف المنطلقات المعرفية، التي توسل بها ومن خلالها لمقاربة موضوع النهضة في الفكر العربي؛ وذلك بالوقوف عند نموذج المثقف المغربي محمد عابد الجابري، بصفته من أبرز المفكرين الذين اشتغلوا على موضوع العقل العربي، مقدما هذه المقولة عن مقولة الفكر الإسلامي، وقد كان هذا سبب خلاف بينه وبين أمثاله من المثقفين الذين ارتأوا القول بمقولة العقل الإسلامي؛ لأنها مقولة شاملة وجامعة وتنطوي تحتها مجمل الأجناس غير العربية، من قبيل الفرس والأتراك والأمازيغ والأكراد... التي ساهمت في بناء الحضارة الإسلامية. ويعد محمد أركون من بين المثقفين الذين قدموا صيغة العقل الإسلامي عن العقل العربي، وله كتاب تحت عنوان العقل الإسلامي نقد واجتهاد.
القارئ للكتاب سيجد وجهة نظر في طبيعة تبني الفكر العربي لمقولة العلمانية، وهي مقولة أثير حولها الكثير من الجدل والنقاش، إلى درجة أن هناك من جعل من مقولة العلمانية والإسلام مقولتين متضادتين، وقد ارتأى الجابري وغيره تجنب استحضار مقولة العلمانية في مشروعه، وقد حل محلها مقولة العقلانية؛ إذ لا علمانية دون عقلانية، بينما نجد محمد أركون يصرح بتبني مقولة العلمانية في قراءة وتأويل التراث الإسلامي؛ لأنها شرط من شروط الدخول في عصر الحداثة الفكرية والمعرفية.
وقد توقف الكتاب عند نموذج تم وصفه، بالمدرسة الحداثية البنائية في الفكر العربي المعاصر، ويتعلق الأمر بمشروع كل من طه عبد الرحمن و"دعوته إلى تأصيل المفاهيم، ووجوب الاستقلال عن المرجعيات الخارجية، في تدبير إشكالاتنا المعاصرة، وتجديد آليات الاشتغال المنهجي من خلال مقومات الأمة (الإسلام، واللغة، والتراث) مع الانفتاح الراشد على إبداعات الآخر، وفق منظوره القائم على الاختلاف، والتقريب التداولي الذي يسعى إلى جعل المعرفة المنقولة موصولة بباقي المعارف الأصلية؛ أي جعل المنقول موصولًا ومأصولًا"[1] كما توقف عند مشروع عبد الوهاب المسيري، الذي يتصف بالدعوة للمراجعة والنقد في التعاطي مع الفكر الغربي، بهدف بناء بديل معرفي منهجي اجتهادي توليدي، تركيبي تراحمي يستجيب للبعد الفطري في الإنسان.
موضوعات الكتاب
يضم الكتاب ثلاثة محاور، وهي: محور المدرسة القومية في الفكر العربي المعاصر: الأسس المرجعية والمُحدِّدات المنهجية. ومحور المدرسة العلمانية في الفكر العربي المعاصر: الأصول المرجعية والمنهجية. ومحور المدرسة البنائية التأصيلية في الفكر العربي المعاصر: الرؤية والمنهج.
الفكر العربي وإشكالية المنهج في التعامل مع التراث
عرف النصف الأخير من القرن العشرين، ظهور حزمة من المشاريع الفكرية في الوطن العربي، في المشرق وفي المغرب، وجلها مشاريع ارتأت أن تشتغل على سؤال التراث والحداثة، الأصالة والمعاصرة، نذكر بهذا الشأن الطيب تزيني وحسن حنفي ومحمد عابد الجابري وعبد الله العروي ومحمد أركون وطه عبد الرحمن... واللائحة طويلة، ولا شك أن هذه المشاريع وغيرها قد خلفت جدلا واسعا في المجال الثقافي العربي، نظرا لما نتج عنها من نقاشات طويلة، بالنظر لمختلف المؤتمرات والندوات العلمية التي صاحبتها، ولا شك بأن جزء من تلك النقاشات والكتابات التي صاحبتها تجمع ما بين ما هو أيديولوجي وبين ما هو معرفي ونقدي، وهناك من استثمر تلك النقاشات من أجل استقطاب فئة معية من الجمهور والقراء.
الكتاب الذي نحن بصدده يقرب القارئ من الفكر العربي في هذه الحقبة، وقد قسم مختلف تلك المشاريع إلى اتجاهين بارزين: يمثل الاتجاه الأول "المقاربة التاريخية الجدلية التي تبنَّاها اليسار الماركسي العربي، الذي يرى في التحليل المادي التاريخي المُخلِّص الحقيقي للأمة من سكونها، وركودها التاريخي، وتجاوز المنهجيات التي ظلت رهْن النظرات، والمواقف المثالية «الميتافيزيقا» التي يحكمها خطٌّ عامٌّ مشترك، ورؤية أحادية الجانب، ومستقلة عن التاريخ وقاصرة عن كشف العَلاقة الواقعية الموضوعية غير المباشرة بين القوانين الداخلية لعملية الإنجاز الفكري، وبين القوانين العامة لحركة الواقع الاجتماعي، باعتبار هذه الرؤية تمثل طريق الوضوح المنهجي، وتملك عناصر قادرة على تقويم التاريخ وتجاوزه، فنظرت إلى تاريخ الأمة وفق تراتبية منهجية أملتها عناصر المقاربة المعتمدة في أفق الانتقال من مجتمع إقطاعي رأسمالي متخلف إلى مجتمع اشتراكي".[2] ويتمثل الاتجاه الثاني في "المقاربة الإبستمولوجية التي مثَّلها ثُلَّة من المفكرين العرب، على اختلاف مداخل التبني، الجابري، ووقيدي، وأركون…إلخ، التي انتهجت هي الأخرى منطق الاستبعاد والاستبقاء على مستوى الاختيارات المنهجية، أو على مستوى قضايا ونماذج التطبيق لهذه المقاربة، إلا أنها هي الأخرى مسَّها مَسُّ الاختزال والفشل في تحقيق الحلم، إذ مارست التفكيك لآليات العقل العربي الإسلامي، لكنها لم تقوَ على البناء والتركيب والتوليد."[3]
الحقيقة أن مشروعات التعاطي المنهجي مع التراث عرفت نوعا من التعدد المنهجي، لكن التدقيق في طبيعة المنهج وأسئلته، بمعزل عن الثقل الأيديولوجي، كانت واضحة بشكل جلي عند محمد عابد الجابري، فهو حريص كل الحرص أن يقرأ التراث قراءة يحضر فيها الفصل والوصل معا، الفصل بقراءة التراث من خلال محيطه الخاص الذي ظهر وتبلور فيه، والوصل بأن نجعل المقروء من التراث معاصرا لنا على صعيد الفهم والمعقولية، بنقل المقروء إلى مجال اهتمام القارئ قصد توظيفه في إغناء ذاته وبنائها، [4] وهذا الحرص صاحب الجابري طيلة حياته، وشكل مجال للمناقشة والجدال بين مخالفيه، من بينهم جورج طرابيشي وطه عبد الرحمن، فاختلاف هؤلاء الثلاثة ليس اختلاف حول التراث، بقدر ما هو اختلاف حول سؤال المنهج في التعامل مع التراث، فاختلاف المنهج يترتب عنه الاختلاف من جهة الفهم والتأويل والقراءة، فالوعي بأهمية المنهج خفف كثيرا من مختلف القراءات الأيدلوجية باسم السلفية أو الماركسية.
في هذا السياق، نستحضر النقد الذي قدمه الجابري لأصحاب القراءة السلفية للتراث و"يتعلق الأمر هنا بالتيار السلفي في الفكر العربي الحديث والمعاصر، التيار الذي اشتغل أكثر من غيره بالتراث وإحيائه واستثماره في إطار قراءة أيديولوجية سافرة، أساسها إسقاط صورة (المستقبل المنشود) المستقبل الأيديولوجي، على الماضي، ثم (البرهنة) انطلاقا من عملية الإسقاط هذه، على أن ما تم في الماضي يمكن تحقيقه في المستقبل"[5] وكان شعارها هو لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ومن أبرز ممثلي هذا التيار جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده اللذين لبست دعوتهما لباس حركة دينية تنادي بالإصلاح، فترك التقليد في نظر هؤلاء يعني إلغاء كل التراث المعرفي والمنهجي المنحدر إلينا من عصر الانحطاط والحذر في الوقت ذاته من السقوط فريسة للفكر الغربي. أما التجديد في نظرهم، فينبغي بناء فهم جديد للدين عقيدة وشريعة، انطلاقا من الأصول مباشرة[6].
سؤال النقد المنهجي الذي مارسه الجابري على سابقيه لم ينج هو الآخر من لدن منتقديه، ونستحضر هنا انتقادات طه عبد الرحمن، فمشروع هذا الأخير دخل في اشتباك منهجي مع مختلف طروحات الجابري، التي يرى فيها بأنها طروحات تتصف بالقراءة التجزيئية، وبكونها اهتمت بمضامين التراث دون النظر في الآليات التي انتجت مختلف تلك المضامين، فطه عبد الرحمن صرح بالقول: "إنّ نموذج الجابري في تقويم التراث يقع في تعارضين اثنين، أحدهما التعارض بين القول بالنظرة الشمولية والعمل بالنظرة التجزيئية، والثاني التعارض بين الدعوة إلى النظر في الآليات وبين العمل بالنظر في مضامين الخطاب التراثي في الآليات"[7] ونتيجة الحرص على أهمية المنهج في قراءة التراث يرى طه أن "قراءة الجابري (الإبستمولوجية) أتت من العثرات المنهجية والثغرات في المعلومات، ما قد يرفع عن قراءته في التراث القيمة العلمية المزعومة، ويُشكك في صلاحية استثمار مقرراتها في مجال الدرس التراثي".[8]
يقدم الكتاب الذي بين يدينا نظرة شاملة عن مختلف القضايا المنهجية لدى المفكرين العرب في نظرتهم إلى التراث من قبيل القضايا التي جئنا على ذكرها، كما أنه لا يقف عندها بل يسعى جاهدا للربط والتركيب فيما بين نتائجها بقصد اجتراح نموذج معرفي لقراءة التراث قادرا على استثمار واستحضار مختلف التجارب السابقة، بدل الاصطفاف مع طرف منها اتجاه طرف آخر، فهو يقول بهذا الشأن: "وقد كان هاجسنا في هذا العمل البحث عما يجمع هذه التيارات لا ما يُفرِّقها، لهذا تجنبنا السقوط في التحليل الاختزالي الذي يرى المخالف شرًّا مستطيرًا، ومن يشترك معه في تحيُّزاته الصواب والحق، وإنما تحيُّزنا في هذا العمل كان إلى جانب الإطار المرجعي العام للأمة للمنهج والرؤية التي ينبغي أن تنطلق منها في نهضتها. فنحن لا نؤسس لرؤانا وتصوُّراتنا على انتظار فشَل الآخرين أو لعيوب في فلسفاتهم، بقدر ما نؤسس على تراكم خبرات وتجارب الأمة على اختلافها وتنوُّعها."[9]
[1] عبد الله أخواض، المنهج في الفكر العربي المعاصر: من فوضى التأسيس إلى الانتظام المنهجي، مؤسسة هنداوي، المملكة المتحدة، ط.1، 2022م، ص.11
[2] نفسه، ص.9
[3] نفسه، ص. 10
[4] محمد عابد الجابري، نحن والتراث؛ قراءة معاصرة في تراثنا الفلسفي، ط .6، المركز الثقافي العربي، 1996
[5] نفسه، ص.12
[6] نفسه، ص.13
[7] طه عبد الرحمن، حوارات من أجل المستقبل، دار الهادي، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى، 2003م، ص.29
[8] نفسه، ص.25
[9] المنهج في الفكر العربي المعاصر، م.س. ص.12