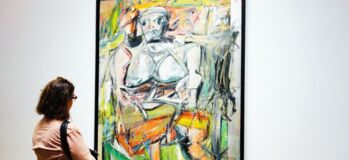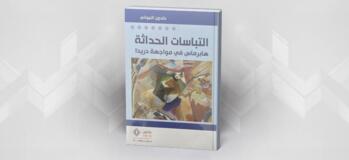تأويلات القوة والضعف بين اللاهوت والأدب: قراءة فلسفية مقارنة بين شخصية غريغور سامسا والنبي يعقوب
فئة : مقالات

تأويلات القوة والضعف بين اللاهوت والأدب:
قراءة فلسفية مقارنة بين شخصية غريغور سامسا والنبي يعقوب
ملخص باللغة العربية:
تهدف هذه الدراسة إلى رصد الكيفية التي أصبح بها اللاهوت العبراني-المسيحي مؤثرًا على حقول معرفية تبدو للوهلة الأولى بعيدة عن سياقاتها التأويلية الأصلية. ومن خلال مقاربة الكتاب العبري/العهد القديم بوصفه نصًّا أدبيًّا، وتحاول الدراسة إبراز أثره العميق في تشكيل المخيال الأدبي والفني الأوروبي الحديث. كما تبحث في كيفية مساهمة هذا التفاعل بين اللاهوت والأدب في تجاوز المعايير الجمالية والفكرية التقليدية وصولاً إلى آفاق ما بعد الحداثة، مع اتخاذ فرانز كافكا نموذجًا دالًّا على هذا التحول، على ضوء التأويلات الممكنة للقوة والضعف.
مقدمة:
استرعت موضوعات اللاهوت العبراني-المسيحي اهتماما واسعا في ميادين تبدو في الظاهر غريبة عن سياقاته القرائية والتأويلية. وبلغ مبلغ الغرابة مداه لما باتت الأرضية التي يستند إليها اللاهوت الإبراهيمي ذاك، نصوصا تقرأ بحسبانها أدبًا، نقصد هنا العهدين القديم والجديد، بل باتت من بين مصادر إلهام ألمع النصوص الأدبية والمسرحية والفنية في أوروبا الحديثة[1]، وأضحت بعد حين الدافع الأساس لتجاوز معاييرها الإستيتيقية والفكرية في زمن ما بعد الحداثة، نركز في هذه الدراسة على مسار تشكل أسلوب فرانز كافكا نموذجًا للاستشكال والبحث والمقارنة.
تعنى هذه الدراسة، من بين ما تعنى به، البحث عن التقاطعات الممكنة بين أرضية اللاهوت وما شابهها من أرضيات كتابية أخرى، من قبيل الفلسفة والأدب. وقد يستعصي هذا البحث من دون الاهتداء بمفهومين أساسيين، على مدى مسار تشكلهما، هما القوة والضعف. إن المستند الدلالي للقوة في سياق هذه الدراسة هو الPossest، ويتأسس مبناه على مفردتين أصلهما لاتيني؛ الأولى هي posse ومقابلها في اللسان العربي يحيل إلى "القدرة". أما الثانية، فهي est ويمكن نقلها إلى اللسان العربي ب "الكائن"، يعود هذا المفهوم المركب إلى الفيلسوف نيكولاس دا كوسطا Nicolas de Cuses 1401-1464[2]. بالمقابل يستند الضعف إلى محمولات معنى العجز، التسليم، الاستلاب.
استنادًا إلى هذين المعنيين، بوصفهما منبعين لأنماط وجود لا حد لها، وتستل منها، بالتبعية، إمكانات معنى. تحاول هذه الدراسة اختبار مدى إمكانية تقاطعهما في السياقات النصية للاهوت والأدب، من خلال التأمل في شخصيتي النبي يعقوب في نص العهد القديم، وغريغور سامسا في نص المسخ لفرانز كافكا.
ويهتدي هذا الاختبار بالسؤال الآتي: بأي معنى يمكن اعتبار قصة النبي يعقوب وغريغور سامسا تجسيدًا للقوة أو الضعف؟
نتساءل ابتداء عن الأرضية المشتركة بين أصناف النصوص، أجناسها، أساليبها، مواضيعها، طرائق اشتغالها، موضوعاتها ومنهجياتها. ونفترض استنادا إلى تساؤلنا، أن الأرضية المشتركة هي الكتابة؛ الكتابة من حيث كونها ممارسة إنسانية صرف، من صميم كل تناقضاتها، عنيت في لحظاتها الأولى بمشاغل تنظيمية من قبيل: الحساب، التقويم، الترتيب، التنظيم، الترسيم، تخليد أسماء الملوك[3]. نتج عن تلك المشاغل التنظيمية العملية، تاريخ من محاولة استيعاب العالم المادي المحيط، في عملية معقدة نصفها بمحاولة تجميد المتحرك، تبسيط المعقد، توحيد المتعدد.
تنطوي هذه العملية على ثنائيات، ونزعم أن كل هذه الثنائيات، المشروط وجودها بالكتابة، هي محاولة لفهم الواقع بتجميده. وكلما اتسع مجال إمكان تجميد الواقع -بتطوير آليات الكتابة من خلال تنظيم الصوت، الرسم، النحو[4]- كلما تشكلت، بالموازاة، عملية أخرى متعلقة بتصنيف وظائف الكَتَبَةِ، سواء أ كان التصنيف ذاك لسبب موضوعي (البنية السلطوية للجماعات) أو لسبب ذاتي (نزوع كل فرد نحو موضوع، أو ميله لصنف من الكتابة أو أسلوب).
تصير بالتالي الكتابة واقعًا مستقلا، يدفعنا بمكر إلى فهم منطقه، بتحليله، بتأويله، أو بتمثيله، والبحث عن إمكانات استئناف الواقع المنفلت من خلاله. شمل هاجس استئناف الواقع المنفلت من قدرة تذهن وتصور الإنسان للعالم، من طريق الكتابة والترسيم، كل تراثه التعبيري، الشفهي التخييلي: المقصود هنا الأسطورة. في حال تساءلنا ثانية عن موضوعة الأسطورة الأساس، نلفي، حسب ما تتواضع على تأكيده الدراسات التاريخية المهتمة بالأسطورة، البداية والنهاية، الخلق والبعث. تمثل الثيمة-الموضوعة تلك، محاولة جريئة وطموحة لحد الوجود البشري بين نقطتين، وبالتالي تأطيره، وفي ذلك عزم على استضافته إلى ذهن البشر.
في حال بحثنا عن المقابل الممكن لتلك الثيمة في لغة النقد الأدبي المعاصر، مع رولان بارت Roland Barthes 1915-1980 بالتحديد، ألفيناها مسألة الافتتاح، أي افتتاح النص؛ "إن الافتتاح منطقة خطرة في الخطاب؛ ابتداء الخطاب فعل عسير. إنه الخروج من الصمت (...) إن هذه القواعد (حول مفتتحات السرد) مرتبطة بالإحساس بوجود حبسة متأصلة في الانسان، وأن الكلام صعب، وأنه ربما ليس هناك ما يقال، ونتيجة لذلك يلزم مجموع من الترتيبات والقواعد للبحث عما ينبغي قوله quid dicas"[5]. بين الخلق والبعث ثمة مسار حياة تُنحت إثره صورة الكائن الحي المدرك لوضعه الوسط؛ البين بين؛ في امتداد مساحة بداية نص ونهايته ثمة شخوص، ثيمات، مبادئ، مفاهيم تبنى باستمرار، ما المشترك الممكن بين السياقين؟ نفترض مسألة الذات والهوية، مشتركا تنسج في ثناياه معاني القوة والضعف بوصفهما إمكانات وأنماط وجود مختلفة ومتقاطعة في الآن عينه.
المقصود من خلال تأويل الواقع، أو تمثيله، اعتبار الفلسفة والرواية بحسبانهما المجالين الحيويين لتأويل إمكانات الكتابة/اللغة -وهي خاصة الفلسفة- بإعمال المبادئ ونحت المفاهيم، أو بتجسيد قوة الكتابة/اللغة، بواسطة إبداع الأسلوب ونحت الشخوص -وهي خاصة الأدب والرواية- وهما المجالان المتمسكان بالقدرة على رصد ونظم أنماط وجود مختلفة، ومبتكرة باستمرار. يمكن تعزيز حقيقة تاريخية في هذا السياق، تتمثل في اعتبار الأسطورة -وأدب اللاهوت على أنقاضها فيما بعد- هما المنبعان والمشترك الإبداعي بين الفلسفة والرواية. فإن قامت الأسطورة وأدب اللاهوت على حد الوجود بتفسير وقائعه استنادا إلى فكرة الخلق والبعث، كانا بالتالي، بشكل من الأشكال، يعيدان تشكيله (الواقع) في أذهان البشر المنصتين لذلك التراث أولا، والقارئين له فيما بعد. أو ليست الفلسفة، بدورها، تهتجس بنفس الهاجس؟ سواء من باب الفهم أو من باب التغيير (فهم العالم أو تغييره)؟ أو ليست الكتابة الروائية هي تشكيل لعوالم مفترضة؟ أوليس السرد وسيلة مشتركة بين الأسطورة وأسفار التكوين والأدب لمحاكاة سيرورة الواقع المتحرك؟
نفصل أكثر في ثنايا هذه الأسئلة، من خلال التفكير في مسائل جعلناها عناصر لهذه الدراسة، يتصل الأول منها بالنموذج الذي جعل الشخوص مقابلا مباشرا للمفاهيم في رواياته، وهي تقنيته الفريدة وميزته، نقصد ميلان كونديرا Milan Kundera 1929-2023 . أما العنصر الثاني، فرصدت مساحته لمحاولة مقارنة تطبيقية بين صنفين من الشخوص، في إطار صنفين من النصوص، تفصلهما مسافة زمنية هائلة، من خلال المسافة تلك يمكن ملامسة إمكان مقابلة شخصيتيهما الرئيستين، نحيل في هذا الخصوص إلى نص من سفر التكوين: الصراع مع الملاك، وشخصية يعقوب الفاعلة في أحداثه، ونص المسخ لفرانز كافكا Franz Kafka 1883-1924، من خلال الوقوف عند نحت السارد لشخصية غريغور سامسا. نستشكل في العنصر الختامي كيف استقامت الكتابة في أحد مضان اللاهوت والأدب عن القوة والضعف، من باب هذا السؤال: هل القوة والضعف خاضعان لحدود الكتابة أم إنهم يندرجان فيما يسمه رولان بارت ب: "يوتوبيا اللغة"؟
أولا- نموذج الرواية الفلسفية (ميلان كونديرا)
لعل المدخل الممكن للتفكير في العلاقة الرابطة بين الفلسفة والرواية يتجلى في التوقف عند واو العطف، فمنه نتبين إمكان قراءة متيقظة، نرى من خلالها المفاهيم الفلسفية شخصيات روائية، لها حياة ومسارات، لحظات ضعف وعقم، ولحظات قوة، توهج وإنتاج. كما يمكن رصد البعد المفهومي في شخوص الروايات. نتوقف هنا عند ميلان كونديرا؛ إذ نحسبه أبرز من امتاز بالاشتغال على هذا التمفصل بين الفلسفة والرواية في اللحظة المعاصرة. يفتتح ميلان كونديرا كتابه فن الرواية[6] بهذا المعنى: "عالم النظريات ليس عالمي. هذه التأملات هي تأملات ممارس لفن الرواية. فمجموع أعمال كل روائي تنطوي على رؤية ضمنية عن تاريخ الرواية وعن ماهيتها. هذا التصور عن الرواية المحايث لروايتي هو الذي جعلته يفصح عن نفسه في هذا الكتاب"[7]. إن نفور الروائي من التنظير ليس حدثًا فكريًّا فريدًا، ومثيرًا للانتباه، لسبب واضح وجلي، الرواية عمل تطبيقي، محاولة دؤوبة للإمساك بمظاهر المتحرك الحيوي المحجم عن الكلام، لإلحاقه بشبكة رموز تتشكل باستمرار بين القارئ والكاتب، تمثل تلك العلاقة إمكان تجدد المعنى وديمومته، وبالتالي ديمومة ذلك العصي دوما على المثول في ذهن الإنسان. الرواية هي المجال الممكن لهذا العمل التطبيقي، هذا التأمل الحثيث والمضطرب في الآن عينه، للإمساك بالواقع المستحيل[8]. يعمل كونديرا في تصوره عن الرواية، على نحت شخصيات تمثل شرط الأنا وإمكاناته في هذا الوجود. قَلمَا نجد روائيًّا يحاول استشكال شخصيات رواياته، بتحليلها وتركيبها بمعزل عن سياقها الأول؛ أي الرواية وحبكتها، ونحسب ميلان كونديرا نموذجًا عمليًّا ودقيقًا في هذا الباب. يكتب في هذا المعنى: "إن كل روايات كل الأزمنة تنكب على لغز الأنا. بمجرد ما تبتكر كائنا متخيلا؛ أي شخصية روائية، تجد نفسك، على نحو آلي، في مواجهة هذا السؤال: ما الأنا؟ بم يمكن إدراك الأنا؟ إنه سؤال من بين الأسئلة الجوهرية التي عليها تنهض الرواية، بما هي رواية"[9].
تشكل هذه الأسئلة الأساسية مستندًا لاستيعاب الشرط الإنساني، والمنبع الخصب لتفرع وتعدد الاتجاهات الروائية الأدبية، ومن خلالها يمكن أن نفسر عملية التناص، الانعكاس، القلب؛ وسط كل هذه المسارات الأسلوبية الأدبية يقف الأنا مفكرا في سياقاته الرمزية من جهة، وفي شرطه المادي الملموس في هذا العالم، تتسع مساحة هذه التقاطعات وتأثير الأسئلة الأساس التي بسطها كونديرا أعلاه، لتحتاز الألفاظ ذاتها، فتلحقها بشبكة الرموز المستعملة لتكثيف معنى ما، أو لإخفائه. يكتب رولان بارت في هذا المعنى ما يلي:
"... الاقتباس (...) هو نوع من الإحالة الخفية على نص لانهائي، هو النص الثقافي للبشرية. وينطبق هذا خصوصا على النصوص الأدبية، المنسوجة بتراكيب مسكوكة متنوعة للغاية، وحيث تتواتر بوفرة ظاهرة الإحالة والاقتباس والاستشهاد عن ثقافة سالفة أو راهنة"[10].
لئن كانت عملية الكتابة، أرضية مشتركة، ومجالا حيويّصا للتناص والاقتباس، فلن يغدو للروائي المبدع إلا أن يبتكر منظوره الخاص، الفريد، لإعمال هذا المشترك، بحثًا، أو تشكيلا لأنا لم تتحقق بعد، بل بعيدة عن التحقق حتى. الرواية وفق هذا المعنى هي سعي مستمر خلف سراب الأنا، ملاحقة لسراب وجود مستحيل، بإرث رمزي مُلْزِم، لا يقوى سوى على جعل ذلك المستحيل منظوما في أسطر، لوصف حالات كينونات الشخوص ونحتها بتؤدة. يذهب كونديرا إلى الحدود القصوى ليجعل الشخوص مرادفًا لألفاظ، ومشروطة بدلالاتها، وفي ذلك تأزيم للوضع الراهن، بإمساكه كي لا ينفلت، بكتابته، بجعله معنى يُتَأَمل، يُقرأ، بغض النظر إن كان موضوعًا للمتعة. أوليس أثر مارسيل بروست، البحث عن الزمن المفقود، علامة فارقة على ذلك؟
أن ذلك الراهن، هو السبيل نحو النفاذ إلى حياة الإنسان الباطنية[11]، تصير بالتالي حياة الشخوص، تفاصيلها، في سياق الرواية، ثانوية. أما الأساسي، فهي اللحظة الراهنة، وحالة الكينونة خلالها.
"ليس ثمة، فيما يبدو لي، شيء يكون بدَهيًّا ومحسوسا وواضحا أكثر من اللحظة الراهنة. ومع ذلك، فإنها تنفلت تماما منا. وهنا يكمن حزن الحياة كله. تسجل حواسنا، البصر والسمع والشم، في ظرف ثانية واحدة (بصورة واعية أو غير واعية) كتلة من الأحداث، ويمر عبر ذهننا فيض من المشاعر والأفكار. كل لحظة تمثل عالما صغيرا، يتم نسيانه نهائيا في اللحظة التي تليها"[12].
ثمة وضع غير مريح في الرواية، من جهة السارد، كما من جهة المتلقي، هنالك شيء على شفا الانفلات، والسقوط في هوة سحيقة، يجب إنقاذه من الضياع - بل إنقاذنا من ضياعه- تأطيره، قراءته، أو على الأقل إدراك وجوده، بل ينبغي على القارئ أن يتنازل عن كبريائه، ليرضى فقط بإحساسه بذلك الوجود[13]، ويعترف بأنه شيء لا ينقال، هو الصميم الممتنع، الأنا الكامن في النصوص الخالدة.
"لكن، إذا كانت الأنا وفرادته غير قابلين للإدراك في حياة الإنسان الباطنية، فأين وكيف يمكن إدراكهما؟ (...) إن البحث عن الأنا انتهى وسوف ينتهي دوما بنقص مفارق ولا أقول بإخفاق، لأن الرواية لا يمكن أن تتجاوز حدود إمكاناتها الخاصة بها، ثم إن الكشف عن هذه الحدود يعد سلفا اكتشافا هائلا، وعملا ذهنيا باهرا"[14].
ليس الإقرار بالاستحالة هنا كناية عن استحالة الكتابة، أو الإحجام عنها، أو التسليم بالعجز -كما هو معلوم في سيرة أغلب الأقلام الروائية العبقرية في لحظات متفرقة من مسار دربتهم- بل هو وعي عميق بضرورة جعل الكتابة مجال الاستحالة الآمن، هي ملاذ فتح الحياة الإنسان الباطنية على ما لا يعد من الإمكانات. الكتابة وفق هذا المعنى استحالة تُقْرَأْ، تزعج، تربك، لكنها تستأنف إمكانات الوجود اللامتناهية. يستحضر ميلان كونديرا نموذجا لكتابة الاستحالة هذه:
"...في تاريخ الرواية الذي صغته، أرى أن كافكا هو من يفتتح هذا التوجه الجديد: توجه ما بعد-بروستي. فالطريقة التي بها يتصور كافكا الأنا غير متوقعة تماما. بم تم تحديد شخصية ك. كائنًا متفردًا؟ ليس بمظهره الجسدي (لا نعرف عليه أي شيء)، ولا بسيرته (لا نعرفها)، ولا باسمه (ليس له اسم)، ولا بذكرياته وميولاته وعقده. أتم تحديده بواسطة سلوكه؟ إن المجال الحر لأفعاله محدود على نحو يبعث على الشفقة. أتم تحديده بواسطة فكره الباطني؟ أجل. إن كافكا يتبع باستمرار أفكار ك.، لكن هذه الأفكار موجهة نحو الوضعية الراهنة فقط: ما الذي ينبغي فعله هنا وعلى الفور؟"[15].
نلاحظ في هذا الخصوص أن شخصية ك. شخصية مستحيلة، بما أنها بلا ملمح ولا ميسم ولا سجية، هي شخصية/فكرة خالصة. وبما أنها كذلك، أتى بها كافكا ليمثل بها الوضع بشري في العالم المعاصر
"...ليس هذا ما يدهشنا من كافكا، فهو لا يتساءل عما هي الدوافع الباطنية التي تحدد سلوك الانسان. إنه يطرح سؤالا مختلفا جذريا: ما هي إمكانات الإنسان في عالم أصبحت فيه المحددات الخارجية ساحقة إلى حد لم تعد معه الدوافع الباطنية ذات تأثير إطلاقا؟"[16].
في حال تجاوزنا أثر الكلمات وتراكيبها، أي انبهارنا بجمالية النصوص، بتقنيات الحبكة والسرد، وفي حال أدركنا استحالة الأنا، وانفلاتها المستمر، ما الذي يتبقى إذن من الرواية؟ عزمها البطولي على التمسك بوجودها، وبالتالي وجود إمكانات الأنا من خلالها؛ ذلك ما يفسر نفور ميلان كونديرا من كل الكلمات الرنانة، النظرية، لوصف أثره الروائي، أو في تعليقه على تاريخ الرواية عمومًا؛ لأن وضع الرواية، وحياة الإنسان الباطنية من خلالها، لا تحتمل المزيد من التعقيد، من "اللغة العالمة"، الرواية هي المجال المشترك والمربك في الآن عينه لكل القراء، بصرف النظر عن خلفياتهم وقدرتهم على فك سنن المكتوب.
الرواية وفق هذا المعنى هي مجال المستحيل المنفلت، والمقروء في الآن عينه. "لا تبحث الرواية في الواقع، بل في الوجود. والوجود ليس هو ما وقع، الوجود هو حقل الإمكانات الإنسانية، هو كل ما يمكن أن يصيره الإنسان، هو كل ما يكون الإنسان قادرا عليه"[17].
ثانيا- المنظور محركا للكتابة
مقارنة بين شخصية يعقوب وغريغور سامسا
يظهر إمكان التفكير في منطقة ظل مشتركة، أو الهاجس الذي يشكل تمفصلا بين الكتابة الفلسفية والكتابة الروائية، وأدب اللاهوت على ضوئهما، من حيث كون هذه الأرضيات كتابة أولا، ومن حيث تشاطرها للحظة عسيرة، متصلة أساسا بافتتاح النص، الشروع في الكتابة؛ البدء. نتساءل مع بارت في هذا الخصوص عما كان ويكون قبل البدء؟ البدء في الكتابة. لعلها الذات في بحثها عن مرايا الهوية[18].
نرى البدء الأرضية الخفية لاشتغال المفاهيم الأساسية التي أحلنا إليها في المحور السابق. أحلنا أولا إلى الذات/الأنا، والهوية، القدرة والقوة، ثم إلى الواقع، والوجود. ما العلاقة الممكنة بين هاته المفاهيم؟ وكيف يمكن أن نقارب على ضوء دلالاتها شخصية النبي يعقوب في سفر التكوين، وشخصية غريغور سامسا في نص "المسخ" لفرانز كافكا؟ أو ليست تحكمها دلالة مفهومي القوة والضعف؟
نتوقف باقتضاب عند العلاقة المفهومية الممكنة بين الأنا، الهوية، الواقع، والوجود؛ تتمثل العلاقة تلك في فعل الانعكاس، انعكاس إمكان الكتابة في تفاعل المعنى الناتج بين المفاهيم الأربعة، تتكثف عملية الانعكاس المرآوي[19] في مفهوم المنظور la perspective؛
تقوم كل رواية على السرد، ولكل روائي منظور، ولكل الروايات شخوص ذوات منظورات متقاطعة، ينظمها تركيب سطري، وتقنيات الكتابة، وقواعد اللغة؛ تلكم معجزة الأدب وقوته. إلى أيّ حد يمكن أن نستسهل توضيب كل هذه الانعكاسات والتقاطعات اللامتناهية، المُشَكِّلَةِ للمنظورات في عملية سرد تحافظ على أوجه تعدد مفاهيمها المحركة-القبلية؟
ينفلت فعل الانعكاس من داخل السياقات النصية المنفصلة، ليصير فعله عابرًا، أفقيًّا، ومن خلاله يتشكل المنظور الواحد، الشخصية الواحدة، متجددين، عبر الكشف عن أبعادها المختلفة، غير المتوقعة تماما، وقد يحدث ذلك بين نصوص تفصلها مسافة زمنية هائلة كما أشرنا إلى ذلك آنفا. ننفتح في هذا السياق على مقارنة بين إحدى شخصيات سفر التكوين وشخصية كافكا (يعقوب – غريغور سامسا).
*- ملاحظة أولى حول نص الصراع مع الملاك (يعقوب):
انفصال مؤقت عن المقربين. "أخذهم وأرسلهم عبر الوادي من كل ما كان له. وبقي يعقوب وحده، فصارعه رجل ..."[20]
نتبين من هذا المقطع أن يعقوب آثر أن يخوض تجربة ذاتية صرف؛ وذلك عن طريق الانفصال -العزلة- بوصفه الشرط الأساس للتجربة تلك، بل يمكن قراءة إلحاح يعقوب على الانفصال - إبعاد ذويه لمسافة كافية للانفراد بتجربته/صراعه الخاص- بوصفه استجابة، من جهة ثانية، لشرط ظهور "الرجل".
يتسم الرجل، من بين السمات التي يتسم بها، أنه الشخصية المحركة لسرد نص الصراع مع الملاك، ونلفي أنه ليس رجلا بالطبع، بل استخدمت مفردة "رجل" للإحالة إلى وجوده الرمزي في لحظات النص، بوصفه طرفا في الصراع.. سيظهر فيما بعد أنه صراع مادي لانتزاع قيمة رمزية تتمثل في فعل "المباركة": "ولما رأى الرجل أنه لا يقوى على يعقوب في هذا الصراع ضرب حق وركه فانخلع. وقال ليعقوب: "طلع الفجر فاتركني، فقال يعقوب: "لا أتركك حتى تباركني"[21].
ارتبط فعل المباركة، حسب متن النص، بالتسمية. ونلاحظ في الآن عينه أن فعل المباركة رُهِنَ في سِيَرِ الأنبياء الآخرين بالسؤال عن أسمائهم، أو التسليم بتغيير التراكيب الصوتية لأسمائهم (مثال: أبرام، إبراهيم) أو بتغيير أسمائهم جذريًّا. إن ما يثير الانتباه في هذا المقطع، أن الرجل الذي لا اسم له، هو الرب، وتم تأويل هذا المعطى لاهوتيًّا. في هذا المقام من التأويل، تم تحديد منطلقات وحدود الصراع في فعل المباركة والتسمية، بل تم رفع مستوى الصراع إلى سؤال الهوية، ووضع الصراع الأصل، وسياقه (تجربة عزلة يعقوب وانفراده)، في درجة ثانوية.
بلغ مدى الصراع السابق مبلغ تخلي الرب عن علمه بالأسماء كلها، حين سأل يعقوب عن اسمه، لكن بعد الهدنة استرجع "الرجل" سلطانه -معرفة الأسماء كلها- ليغير اسم يعقوب باسم إسرائيل، ومعناه "الذي صارع الله". لئن استرد الرجل سلطانه، فإنه زكى القوة من خلال يعقوب، تاركًا له رمزًا.. اسما، يقترن به، يذكر يعقوب ودويه، بالليلة المشهودة حيث صارع الرب... مطلق القوة. انفصل يعقوب مؤقتا عن ذويه، فبات اسمه إسرائيل. فهل انفصل عنهم حقا بصيغة مؤقتة، أم إلى الأبد؟ يبدو أنه يعقوب انتفى شرط وجوده بتغيير اسمه.
*- نقوم بالعملية ذاتها، مع شخصية غريغور سامسا، في نص كافكا:
"حين أفاق غريغور سامسا ذات صباح من أحلام مزعجة، وجد نفسه وقد تحول في فراشه إلى حشرة ضخمة. كان مستلقيا على ظهره الصلب الذي بدا وكأنه مصفح بالحديد؛ وحين رفع رأسه بعض الشيء استطاع أن يرى بطنه الأسمر".[22]
بعد صراع مع جسده الجديد، الصادم، المزعج؛ إذ ألف غريغور أن ينام على جانبه، الوضعية التي صارت مستحيلة في جسم حشرة ضحمة، صلبة الظهر
"... انزلق من جديد إلى وضعه السابق. وفكر: هذا النهوض الباكر من الفراش يجعل المرء أبله تماما، إن الانسان ليحتاج إلى رقاده"[23].
نلاحظ في هذا المقطع وضعية سامسا: استمتاعه بالعجز. "...وفكر قائلا في ذات نفسه "ما الذي أصابني؟" لم يكن ذلك حلما. إن غرفته، وهي حجرة نوم بشرية نظامية، وإن تكن صغيرة أكثر مما ينبغي، لتقع تماما داخل الجدران الأربعة المألوفة"[24].
بعد حلول الساعة السابعة إلا ربع، ساعة استيقاظ سامسا للذهاب للعمل، بادرت الأم أولا للاستفسار عن سبب عدم خروجه من غرفته، ثم الأب، أجاب سامسا لكي يطمئنا على حاله، بإخفاء تغيرات صوته الطفيف بسبب بنيته الجسمية الجديدة. انضمت الأخت للمشهد، غير مطمئنة
"... لكن الأخت همست: "غريغور، أناشدك أن تفتح الباب". لكن غريغور لم يفكر في فتح الباب بحال من الأحوال"[25].
نقسم المشهد إلى ثلاثة أبعاد رئيسة، ونقارن من خلالها، شخصية سامسا مع شخصية يعقوب في النص السابق:
- أولا: المكان، المجال هنا محدد في الغرفة، بدقة أكثر في السرير.
- ثانيا: الزمان، الصباح الباكر، بعد ليلة من الأحلام المزعجة، بل تم تحديد الساعة بدقة، السابعة إلا ربع.
- ثالثا: الوضع، عزلة مطبوعة بالحصار، سامسا محاصر في غرفته، وفي جسده المربك الجديد، واستفسار أهله عن سبب عدم خروجه من الغرفة كما جرت العادة.
في قصة يعقوب مع "الرجل"، نلاحظ، على ضوء الأبعاد الثلاثة ما يلي:
- المكان غير محدد.
- الزمان مشار إليه بعد نهاية أحداث القصة: ليلة طويلة.
- أما الوضع، فهي العزلة المطلقة، إبعاد الأهل، الصراع الصاخب لليلة بكاملها.
ثالثا- تفكير في تجليات القوة والضعف في وضعيتي النبي يعقوب وغريغور سامسا
يظهر من خلال رصد شخصية سامسا، ويعقوب، أن ثمة ملامسة للحدود القصوى[26].
استفاق سامسا على وضع مغاير لم يألفه قط[27]، جسم جديد، وضع مربك، صراع مع المجهول؛ لأنه في نهاية المطاف ليس هنالك خصم مجسد في شخصية، هو صراع مع وضع قائم -مع كينونة طارئة- يدفع إلى الإحساس بالعجز والتسليم به، في مستوى أولي للقراءة، إثر حصار خارج الغرفة من طرف الأهل، والعالم الخارجي (وجد سامسا حيلة للتهرب من الذهاب إلى العمل المضجر والمنهك).
أما في قصة يعقوب، فنلاحظ في مستوى أولي للقراءة، حرية مطلقة، صراع مع المطلق، إحساس بالقوة وتجاوز الذات، بل فنائها. وبالتالي الفوز بمباركة الرب، بتغيير الاسم، هو انفصال اسميnominal أبدي عن الأهل، بل عن نفسه؛ إذ أصبح اسمه إسرائيل وليس يعقوب، وفي المقابل نجد انفصال سامسا الجسمي عن نفسه وعن أهله؛ لأنه أصبح في جسم حشرة ضخمة. يظهر فعل الانعكاس، وتأثيره على تفاعلات الذات مع الواقع والوجود، في كون يعقوب وسامسا، يمثلان الحدين القصيين للوجود، قدرة مطلقة، وعجز مطلق، لكن في مستوى أعمق من القراءة نتحفظ من إقران القدرة المطلقة أو العجز المطلق بيعقوب أو بسامسا.
تركيب:
يظهر يعقوب، في القراءة الأولية، بوصفه الإمكان المستحيل لسامسا. وهذا الأخير، هو الانعكاس الارتكاسي ليعقوب، بعد تاريخ مديد يفصل نصيهما، بل يبدوان كأنهما الحدان المستحيلان للإنسان، استطاعت الكتابة الإمساك بهما، وتشخيصهما بدقة من خلال منظورين مختلفين. يبدو على ضوء الشخصيتين، أن الكتابة في عالمنا المعاصر، تُعْنَى بملامسة هذه الحدود القصية، بإدراك الاستحالة في الكتابة، والبحث عن الدرجة الصفر لها، حيث يصبح الأدب أطوبيا اللغة[28].
ترصد الكتابة من خلال هذه الدراسة، استحالة تجميد القوة والضعف في شخصية أو وضعية، ففي حال أمعنا النظر في قصة يعقوب، نلفي أن يعقوب انتفى، سادت مباركة الرب لتنفي يعقوب الاسم، والكينونة، بتعويضها باسم آخر يؤكد وجود الرب، ويضمن بقاءه في الذاكرة. أما حامل الاسم، فبات ذكرى، علامة على وجود آخر يفوقه، يتعالى على إمكانات وجوه، ومشروط بقدرته.
بالمحصلة، عاش يعقوب تجربة استلاب ساحقة لوجوده، فيبدو في صورة شخصية ابتلعتها قوة النص. في حين نستشف من قصة غريغور سامسا، أن الأنا قد تصير سيدة عجزها، في صورة شخصية قررت أن تحتفي بعجزها بمعزل عن كل العوامل الخارجية الساحقة، لتتحكم في مسارات السرد في النص، يستحيل امتداد المعنى فيه من دون السيادة على العجز بل التمسك به، بجعله نمط وجود قائم بذاته قد يقرأ بحسبانه إمكان قوة.
المراجع المعتمدة:
- جاك مايلز، سيرة الله، ترجمة ثائر ديب، دار الحوار الطبعة الأولى 1998
- جان بوتيرو، بلاد الرافدين، الكتابة، العقل، الآلهة، ترجمة: الأب ألبير أبونا، مراجعة وليد الجادر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1990
- عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، ترجمة: محمد بنيس، منشورات الجمل بغداد-بيروت 2009
- رولان بارت، التحليل النصي، تطبيقات على نصوص التوراة والانجيل والقصة القصيرة، ترجمة وتقديم: عبد الكبير الشرقاوي، منشورات الزمن، 2001
- ميلان كونديرا، فن الرواية، بحث، ترجمة: خالد بلقاسم، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، 2017
- جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، ترجمة: أ. كميل داغر، المنظمة العربية للترجمة. الطبعة الأولى، بيروت، 2005
- فرانز كافكا، الامساخ، ترجمها عن الألمانية إبراهيم وطفي، دار الكلمة ودار الحصاد، 2014
- جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، ترجمة: أ. كميل داغر، المنظمة العربية للترجمة. الطبعة الأولى، بيروت، 2005
- رولان بارت، الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، دار العين للنشر، الطبعة الرابعة 2009
- Les cours de Gilles Deleuze, 1978-1981, www.webdeleuze.com, de «la puissance et le droit naturel classique à «la polarité qualitative des modes d’existence».
- Roland Barth, Leçon, Editions du Seuil, 1978, p : 22
- Vladimir Jankélévitch, Le je ne sais quoi et le presque rien, Ed Points Essais, 1981
- F. Kafka, La Métamorphose, Edition Gallimard, 2000, p : 59
[1] جاك مايلز، سيرة الله، ترجمة ثائر ديب، دار الحوار الطبعة الأولى 1998، ص: 23-25
[2]-Les cours de Gilles Deleuze, 1978-1981, www.webdeleuze.com, de «la puissance et le droit naturel classique à «la polarité qualitative des modes d’existence».
[3] جان بوتيرو، بلاد الرافدين، الكتابة، العقل، الآلهة، ترجمة: الأب ألبير أبونا، مراجعة وليد الجادر، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1990. ص: 77-89
[4] "لقد كانت الكتابة مرتبطة، في بداية الثقافة الإنسانية، بالخاصية المادية للإيماء والخط، وارتكز مجمل تاريخها على تقليص تعدد أصواتها حتى انتظمت داخل تركيب سطري" - عبد الكبير الخطيبي، الاسم العربي الجريح، ترجمة: محمد بنيس، منشورات الجمل بغداد-بيروت 2009، ص65
[5] رولان بارت، التحليل النصي، تطبيقات على نصوص التوراة والانجيل والقصة القصيرة، ترجمة وتقديم: عبد الكبير الشرقاوي، منشورات الزمن، 2001، ص: 37
[6] ميلان كونديرا، فن الرواية، بحث، ترجمة: خالد بلقاسم، الطبعة الأولى، بيروت لبنان، 2017
[7] المرجع نفسه، الصفحة الأولى.
[8] Roland Barth, Leçon, Editions du Seuil, 1978, p : 22
«… soit qu’avec Lacan on le définisse comme l’impossible, ce qui ne s’atteindre et échappe au discours, soit qu’en termes topologiques, on constate qu’on ne peut faire coïncider un ordre pluridimensionnel (le réel) et un ordre unidimensionnel (le langage)».
[9] المرجع نفسه، ص:31
[10] رولان بارت، التحليل النصي، المرجع مذكور سابقا، ص ص 34-35
[11] ميلان كونديرا، فن الرواية، المرجع مذكور، ص: 33
[12] المرجع نفسه، ص: 33
[13] Vladimir Jankélévitch, Le je ne sais quoi et le presque rien, Ed Points Essais, 1981
[14] ميلان كونديرا، فن الرواية، ص: 33
[15] ميلان كونديرا، فن الرواية، ص: 34
[16] المرجع نفسه، ص: 34
[17] ميلان كونديرا، فن الرواية، ص: 52
[18] جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، ترجمة: أ. كميل داغر، المنظمة العربية للترجمة. الطبعة الأولى، بيروت، 2005
[19] جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، المرجع مذكور سابقا، ص: 15
[20] رولان بارت، التحليل النصي، المرجع مذكور سابقا، ص: 55
[21] المرجع نفسه، ص:55
[22] فرانز كافكا، الانمساخ، ترجمها عن الألمانية إبراهيم وطفي، دار الكلمة ودار الحصاد، 2014، ص: 11
[23] نفس المرجع، نفس الصفحة.
[24] نفس المرجع، نفس الصفحة.
[25] نفس المرجع، ص: 14
[26] جان فرانسوا ماركيه، مرايا الهوية، الأدب المسكون بالفلسفة، المرجع مذكور سابقا، ص: 393
[27] نجد تعبيرا دقيقا في الترجمة الفرنسية لرواية كافكا:
«Il était sur maintenant que personne n’entrerait chez Gregor avant le matin; il avait donc un bon moment pour méditer à son aise sur la nouvelle organisation de son existence».
-F.Kafka, La Métamorphose, Edition Gallimard, 2000, p : 59
[28] رولان بارت، الدرجة الصفر للكتابة، ترجمة محمد برادة، دار العين للنشر، الطبعة الرابعة 2009، ص:119