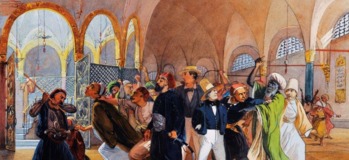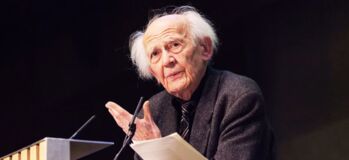الحداثة بين الترميم والتجاوز مقاربة في فكر سمير أمين
فئة : مقالات

الحداثة بين الترميم والتجاوز مقاربة في فكر سمير أمين
تتوزع مواقف المفكرين حول الحداثة وما بعدها على خارطة فكرية معقدة ومتشعبة، تعكس اختلاف مشاريعهم الفلسفية، وتباين سياقاتهم التاريخية والثقافية، وتفاوت مواقفهم من قضايا التقدم، والهوية، والمعرفة، والسلطة، وإذا حاولنا تركيب هذه الرؤى المتنوعة، أمكننا أن نصنفها في ثلاثة اتجاهات كبرى، مع الوعي بالتداخلات والتقاطعات التي تجمعها أحيانًا.
الاتجاه الأول هو اتجاه الدفاع النقدي عن الحداثة؛ الذي يرى فيها مشروعًا إنسانيًّا تحرريًّا لم يكتمل بعد، وأن المطلوب ليس هدمها أو تجاوزها، بل تطويرها وتصحيح مسارها من الداخل، يمثل هذا التوجه ألان تورين، الذي وصف الحداثة بأنها مشروع يقوم على تحرير الإنسان من القيود التقليدية والدينية، ومنح العقل دورًا مركزيًّا يوحد بين مجالات ثلاثة: الإنتاج العلمي، والتنظيم القانوني، وحرية الفرد، ويرى أن إخفاق بعض تجليات الحداثة لا يعني انهيارها، بل يستدعي إعادة التفكير فيها لضمان اتساقها الأخلاقي والإنساني([1]). وعلى النهج ذاته، يقف يورجن هابرماس الذي يرفض طروحات ما بعد الحداثة بوصفها مشاريع هدم عقيم، ويقترح بديلاً يقوم على العقلانية التواصلية؛ أي الحوار والتفاهم الحر في الفضاء العام بعيدًا عن منطق السيطرة والأداتية، ساعيًا إلى ترميم الحداثة عبر توسيع فضاءات المشاركة العقلانية في إنتاج المعرفة والمعايير الأخلاقية ([2]).
أما الاتجاه الثاني، فهو اتجاه النقد الجذري للحداثة الذي لا ينطلق بالضرورة من منظور ما بعد حداثي، بل يكشف من داخل الحداثة نفسها حدودها وتناقضاتها وسياقاتها التاريخية المرتبطة بالهيمنة والاستعمار، ويمثل هذا التوجه ميشيل فوكو، الذي رأى أن الحداثة لم تكن مشروع تحرير كما تزعم، بل مشروعًا للضبط والسيطرة؛ إذ تحولت المعرفة إلى أداة لإخضاع الذات، وغدا مفهوم الحقيقة مشفرًا ومتعدد الطبقات لا يُنال إلا عبر تفكيك دائم للخطاب([3]). أما جان بودريار، فقد انتقد الحداثة من زاوية مختلفة، معتبرًا أنها تنتج صورًا وأفكارًا توهم بالتغيير بينما تُعيد إنتاج التقليد خلف واجهة حديثة، فتجعل المجتمعات تبدو وكأنها تتقدم بينما تبقى عالقة في أنماطها القديمة ([4])، ويقارب داريوش شايفان هذا النقد من منظور حضاري، فيرى أن الفجوة بين الغرب والعالم الإسلامي ليست تأخرًا أو عجزًا، بل اختلافًا جوهريًا في المسارات الثقافية وتصورات الزمن، وأن فرض الحداثة الغربية أنتج حالة من التوتر والازدواجية في وعي المثقف المسلم([5])، ويضيف فؤاد زكريا بُعدًا آخر حين يكشف مأزق العقل العربي الممزق بين التعلق غير الواعي بالتراث والانبهار غير النقدي بالغرب، مما يجعل من الصعب تأسيس مشروع حداثي حقيقي يوازن بين الهوية ومتطلبات الحاضر.([6])
أما الاتجاه الثالث، فهو اتجاه ما بعد الحداثة؛ الذي يعلن تفكيك السرديات الكبرى التي قامت عليها الحداثة، ويرى أن مفاهيم مثل التنوير، والعقل، والتقدم لم تعد قادرة على تأطير المعرفة والحياة، ويُعد جان فرانسوا ليوتار أبرز منظريه؛ إذ رأى أن انهيار تلك السرديات أفضى إلى واقع معرفي جديد يتسم بالتشظي والتعددية، حيث تقوم المشروعية على الكفاءة والإنجاز لا على الحقيقة أو العدالة، ويقترح بديلًا يتمثل في "البارالوجيا"؛ أي المعرفة التي تقبل التناقض والاختلاف دون محاولة فرض وحدة نهائية ([7])، بينما يرى تيري إيغلتون أن ما بعد الحداثة ليست قطيعة كاملة مع الحداثة، بل استمرار لها في صورة أكثر التباسًا وتفككًا، محذرًا من النسخ السطحية لما بعد الحداثة التي تروّج للتفكيك دون عمق نقدي ([8]).
وفي قلب هذه الخريطة الفكرية المتشابكة، يبرز سمير أمين بوصفه مفكرًا نقديًا حداثيًا من موقعه في الجنوب العالمي، إذ اعتبر الحداثة مشروعًا مفتوحًا للتحرر الإنساني يجب استكماله، لا رفضه، ورأى فيما بعد الحداثة خطابًا تبريريًا للعجز والرضوخ لمنطق الرأسمالية، يُغذي السلفيات والانغلاق بدل أن يفتح أفقًا للتقدم، ومن هنا تتجلى خصوصية موقفه، الذي يربط بين نقد العولمة الرأسمالية والسعي لبناء حداثة بديلة تنبع من حاجات وتطلعات شعوب العالم الثالث.
ففي مقالة بعنوان "نقد الحداثة أم تطويرها" وخلق بديل جديد يسمى ما بعد الحداثة، يوضح سمير أمين أن تحليل الاقتصاد السياسي يستلزم فحص التطورات التي أدت تدريجيًّا إلى تفكيك مفاهيم الحداثة التي سادت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويؤكد أن الادعاء بأن الحداثة قد أصبحت مفهومًا متجاوزًا لا معنى له من حيث المبدأ؛ إذ إن جوهر الحداثة يكمن في أن الإنسان هو من يصنع تاريخه، وهي فكرة لا يمكن تجاوزها أو التخلي عنها، ومع ذلك يرى أن الأزمات الكبرى – مثل التي يشهدها العالم حاليًا – تدفع بالمجتمعات إلى التراجع نحو الماضي، مما يؤدي إلى انتشار الخطاب الذي ينكر قدرة الإنسان على صناعة تاريخه، ويزعم أن التاريخ ليس إلا نتيجة لقوى خارجة عن إرادته([9]).
ويشير أمين إلى أن هذا المنظور يفترض أن التاريخ لا يسير وفقًا لأهداف النشاط البشري الواعي، بل يُفرض على المجتمعات من خلال قوانين لا يمكنها التحكم فيها، ونتيجة لذلك يصبح أقصى ما يمكن تحقيقه هو محاولة فهم تلك القوانين والتكيف معها، بدلًا من السعي إلى توجيه التاريخ أو تغييره، وهكذا يتم الترويج لفكرة أن السياسة يجب أن تقتصر على إدارة الواقع القائم وإجراء إصلاحات سطحية دون التفكير في أهداف طويلة الأجل أو في إمكانية إحداث تغيير جذري، وهو ما يعني في نهاية المطاف القبول بسيادة السوق والخضوع لمنطق الاقتصاد الرأسمالي دون السعي إلى تطوير بدائل حقيقية([10]).
ويفسر أمين هذا الاتجاه كنتيجة مباشرة لانهيار المشروعات الكبرى للعصر السابق، مثل بناء الاشتراكية أو تأسيس الدولة الوطنية، وهو ما أدى إلى حالة من الشك العام في إمكانية تحقيق تحولات كبرى، ومع ذلك، فإن إدراك الأسباب التي قادت إلى هذا الوضع لا يعني الاستسلام له باعتباره أمرًا نهائيًا، وهو ما تحاول أطروحة "نهاية التاريخ" الترويج له، فالزعم بأن ما بعد الحداثة تمثل تجاوزًا للحداثة ما هو إلا قبول ضمني بالعجز عن تغيير التاريخ، لكن الحداثة وفقًا له لا تعني أن البشرية تمارس عقلانية تامة في كل لحظة من تاريخها، أو أن المشاريع المجتمعية دائمًا ما تكون فعالة، بل إنها تفتح المجال أمام إمكانية إعطاء معنى تحرري للتاريخ، حتى وإن كانت هذه المحاولة محفوفة بالمخاطر([11]).
كما يرى أمين أن الموقف السلبي الذي تتبناه نظريات ما بعد الحداثة لا يمكن الدفاع عنه على المدى الطويل، لأن المجتمعات لا تقبل عمليًا الاكتفاء بإدارة الواقع القائم دون محاولة تغييره، ولهذا السبب يلاحظ وجود تلازم غريب بين انتشار خطاب ما بعد الحداثة في المجال الأيديولوجي، وبين بروز تيارات اجتماعية تدعو إلى العودة إلى ما قبل الحداثة، فالسلفيات الدينية والإثنية التي تزدهر اليوم ما هي إلا دليل على استحالة التمسك بمقولات ما بعد الحداثة، ويضرب أمين مثالًا بالسلفية الإسلامية، التي يعتبرها نموذجًا متطرفًا لهذا التوجه؛ إذ إنها تنكر حق البشرية في وضع القوانين بحجة أن التشريع يجب أن يكون حكرًا على الخالق، وهو يرى أن هذا الخطاب لا يعبر فقط عن رفض للحداثة، بل إنه نتيجة لهزيمة تاريخية كبرى جعلت المجتمعات تتراجع أمام التحديات بدلًا من مواجهتها بإبداع فكري وسياسي، غير أن هذا التراجع لن يؤدي إلا إلى مزيد من التهميش والتدهور، مما يعمق العجز في مواجهة النظام العالمي المعاصر([12]).
ولا تقتصر مظاهر ما بعد الحداثة على هذا الشكل المتطرف بل تتجلى أيضًا في أشكال أخرى مثل النزعات القومية المتطرفة أو الهويات الإثنية الضيقة، وعلى الرغم من أن أنصار ما بعد الحداثة يزعمون أنهم يدافعون عن الديمقراطية كما يصف سمير أمين، فإن هذه الممارسات تتناقض مع مبادئ الديمقراطية الحقيقية، لأنها تعزز العصبيات الجماعية والتقاليد الجامدة بدلًا من تعزيز قيم الانفتاح والمشاركة، وهكذا فإن ما بعد الحداثة بدلًا من أن تمثل تجاوزًا للحداثة، تتحول إلى شكل من أشكال العودة إلى أنماط اجتماعية وفكرية سابقة عليها([13]).
وبذلك يؤكد أمين أن ما بعد الحداثة ليست سوى تجلٍّ يوتوبي سلبي، على العكس من اليوتوبيات الإيجابية التي تدعو إلى تغيير العالم، وبدلًا من تقديم بدائل جذرية تكتفي هذه النظريات بالخضوع لمنطق الاقتصاد السياسي الرأسمالي، مع الوهم بأن من الممكن إدارته بأسلوب إنساني، وهو ما يعتبره أمين وهمًا خالصًا. ويشير إلى أن أصحاب هذه النظريات يبدؤون خطابهم بالإعلان عن "فشل الحداثة"، لكنه يرفض هذا الادعاء، ويرى أنه ناتج عن نظرة سطحية وغير دقيقة للتاريخ؛ فالعصور الحديثة رغم انتكاساتها هي أيضًا العصور التي حققت أعظم إنجازات الإنسانية، سواء في معدلات النمو الاقتصادي، أو تراكم المعرفة العلمية، أو حتى في التطور الديمقراطي والاجتماعي والأخلاقي، فالحداثة هي التي كرست مفهوم الفرد ككائن مستقل، وأكدت على حقوق الإنسان، ورسخت فكرة السعادة كهدف مشروع للبشرية ([14]).
ومن قراءة مؤلفات سمير أمين نلاحظ تصوره أن مفهوم "التقدم" قد اختفى من الفكر المعاصر المهيمن، رغم أن التقدم لم يكن أبدًا مسيرة مستقيمة، بل كان دائمًا محفوفًا بالصراعات ومحاولات الردة إلى الماضي، لكنه يشدد على أن كل انتكاسة تاريخية تحمل في طياتها جرائم اجتماعية كبرى، ما يجعل التخلي عن التقدم خيارًا غير مقبول. لذك، فإنه يرفض المقولة القائلة إن "الماضي كان أفضل"، ويرى أن النضال من أجل التقدم لا ينبغي أن يتوقف بسبب العقبات ([15]).
ويواجه أمين الحجج التي تزعم أن الحداثة فشلت لأنها أنتجت أفظع الجرائم، مثل معسكرات الإبادة النازية، فهو يؤكد أن هتلر لم يكن نتاجًا لفلسفة التنوير، بل كان عدوًّا لها؛ إذ إنه ألغى المواطنة والديمقراطية لصالح نظام يقوم على الطاعة العمياء للجماعة، وبالتالي فإن النازية لم تكن امتدادًا للحداثة، بل كانت عودة إلى أنماط ما قبل الحداثة، ويرى أن الحداثة ليست مشروعًا له "نهاية"، بل هي عملية مستمرة تتطلب تجاوز حدودها في كل مرحلة تاريخية، وفي الوقت الحالي فإن تجاوز الحداثة يستلزم تجاوز الرأسمالية نفسها، وهو ما تفشل نظريات ما بعد الحداثة في إدراكه ([16]).
وكما يشير أمين في تحليله إلى أن الرأسمالية لم تعد تمثل مرادفًا للتقدم، بل أصبحت في أزمة عميقة، وهو ما يجعل الخيار الحقيقي اليوم ليس بين الرأسمالية وما بعدها بل بين الاشتراكية أو الهمجية، ومع ذلك، فإن نظريات ما بعد الحداثة ترفض الاعتراف بهذا الواقع، وتخلط بين الرأسمالية وفلسفة التنوير، مما يجعلها عاجزة عن تقديم أي رؤية حقيقية للمستقبل. وبالنسبة إليه، فإن الخطابات الكبرى التي دافعت عن التحرر، رغم تباينها تتشارك جميعها في الاعتقاد بأن الإنسان يصنع تاريخه، لكنه يميز بين الخطاب الديمقراطي البرجوازي الذي يدعو إلى تحرير الإنسان دون المساس بجوهر الرأسمالية والخطاب الاشتراكي الذي يسعى إلى تجاوز هذه الحدود. ومن هنا، فإن الخلط بين هذه الخطابات وإعلان فشلها جميعًا هو خطأ جوهري، فيرى أن فشل المشروعين البرجوازي والاشتراكي لا يعني التخلي عن فكرة إعطاء معنى للتاريخ، بل يستدعي العمل على تطوير الحداثة وليس التراجع عنه([17]).
وعلى الرغم من اختلاف الحقول المعرفية التي ينطلق منها كل من هابرماس وسمير أمين، فإنهما يشتركان في رفض الطروحات ما بعد الحداثية التي تكتفي بالنقد والتفكيك دون تقديم بدائل بنائية، فكلاهما يرى أن الحداثة مشروع لم يُستنفد بعد، وأن الأزمات المرتبطة بها لا تبرر إعلان نهايتها، بل تستدعي إعادة صياغتها وتجديدها. غير أن نقطة الالتقاء هذه تتباين في المدى والمنظور: فهابرماس من موقعه في الفلسفة الأوروبية، يسعى إلى إنقاذ التنوير من الداخل عبر إعادة تعريف العقلانية على أسس تواصلية تجعل الحوار والمشاركة الديمقراطية محورًا للتوافق الاجتماعي والمعرفي، في المقابل ينطلق سمير أمين من نقد جذري للاقتصاد السياسي العالمي، مؤكدًا أن استكمال مشروع الحداثة لا يمكن أن يتم دون تجاوز الرأسمالية ذاتها وبناء حداثة بديلة من موقع الجنوب، تُحرر الشعوب من التبعية وتفتح أفقًا لمشروع تحرري كوني، وهكذا بينما ينشغل هابرماس بترميم البنية الفلسفية للحداثة الأوروبية، يتجه أمين إلى توسيع معناها التاريخي والاجتماعي ليجعل منها مشروعًا عالميًا، يربط بين العدالة الاجتماعية والتحرر من الهيمنة الإمبريالية.
[1]- ألان تورين "نقد الحداثة"، أنور مغيث (مترجم)، (القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، 1997)، ص47-53
[2] - ألن هاو، "النظرية النقدية"، ثائر ديب (المترجم)، (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2015)، ص231-233
[3] - ميشيل فوكو، "جنيالوجيا المعرفة"، أحمد السطاتي (مترجم)، عبد السلام بتعبد العالي (مترجم)، (الدار البيضاء، دار توبقال للنشر، 2008)، ص 46 -49
[4] - جان بودريار، "جان بودريار: الحداثة - انسكلوبيديا أونيفرساليس"، محمد سبيلا (مترجم)، مجلة الكرمل، العدد 36-37، 1990.، متاح على https://www.democratsudan.com/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B1/
[5]- داريوش شايفان، "الهوية: الجماعة، والجماعات"، مجلة المواقف، العدد: 65، 1 إبريل 1991، ص57 -59 https://archive.alsharekh.org/Articles/11/15766/351398
[6] - فؤاد زكريا "الصحوة الإسلامية في ميزان العقل"، (يورك هاوس، مؤسسة هنداوي، 2024)، ص49-50
[7] - جان فرانسوا ليوتار، "الوضع ما بعد الحداثي"، أحمد حسان(مترجم)، (القاهرة، دار شرقيات، 1994)، ص 23-25
[8] - تيري إيجلتون، "أوهام ما بعد الحداثة "ثائر ديب (مترجم)، (اللاذقية، دار الحوار، 2000)، ص7-9
[9] - سمير أمين، "تجاوز الحداثة أم تطويرها"، مجلة الكرمل، العدد51، 1997، ص27
[10] - المرجع السابق، ص ص27-28
[11] - المرجع السابق، ص29
[12] - المرجع السابق، ص30
[13] - سمير أمين، "ما بعد الرأسمالية المتهالكة"، فهيمة شرف الدين وسناء أبو شقرا (مترجم)، (بيروت، دار الفارابي، 2003)، ص223
[14] - المرجع السابق، ص 224
[15] - المرجع السابق، ص224
[16] -سمير أمين "تجاوز الحداثة أم تطويرها “، مرجع سبق ذكره، ص ص28-29
[17] - سمير أمين، "في نقد الخطاب العربي الراهن"، (القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2015) ص29-31