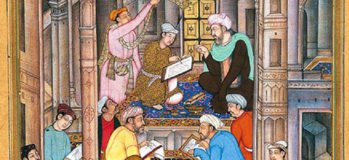تاريخ التشريع الإسلامي للمستشرق ن. ج. كولسون: تاريخية التشريع أم إمكانية التحيين
فئة : قراءات في كتب

مدخل:
يعتبر كتاب المستشرق الأنجليزي في تاريخ التشريع الإسلامي من أهم الكتب التي تناولت بعناية دراسة الفقه الإسلامي، وبحكم اختصاصه القانوني كانت معالجته لتاريخ التشريع تتسم بالطرافة والإضافة، وهو يعتبر نموذجا في الدراسات الاستشراقية التي التزمت خط الموضوعية في التعامل مع التراث الإسلامي. وقام بترجمة الكتاب والتعليق عليه الدكتور محمد أحمد سراح وراجعه الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، وصدر في طبعته الأولى عن المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1992.
1- خطة الكتاب واستراتيجية التحليل:
تضمن الكتاب ثلاثة أبواب إلى جانب مقدمة وخاتمة.
خصص الباب الأول لدراسة الفقه في طور التكوين، ويمتد على خمسة فصول تهتم بالتشريع القرآني والواقع التشريعي في القرن الأول الهجري، وتطرق إلى نشأة أصول الفقه والمدارس الفقهية الباكرة، ثم الشافعي وعلم الأصول ومرحلة توقف النمو. ومن الواضح أن الكاتب اتبع في هذا الفصل منهجية تاريخية ترصد تطور التشريع منذ البدايات مع الرسول، ثم فترة الخلفاء الراشدين والعهدين الأموي والعباسي الذي وقف فيه على تطور التشريع خلال العهدين العباسيين. ومن الجلي أن الكاتب يقيم لحظة مركزية في تاريخ التشريع، وهي لحظة تطور علم الأصول مع الشافعي الذي اعتبره مؤسس أصول الفقه، وهكذا يرصد فترة سابقة عن الشافعي، وأخرى لاحقة تميزت بقبول الأخذ بالأصل الثاني لعلم الأصول، وهي السنة والحديث النبوي واستئناف الدفاع عن حجية الحديث.
أما الباب الثاني، فخصص لدراسة الفقه في العصور الوسطى بين النظرية والتطبيق، وجاء في خمسة فصول، هي على التوالي: النظرية الأصولية التقليدية ثم الاتفاق والاختلاف في الفقه والنظم الفقهية للفرق الإسلامية والحكومة الإسلامية والفقه، والفقه والمجتمع الإسلامي، وخصص الفصل للبحث في مرتكزات النظرية التقليدية التي تستند إلى مصدر إلهي، فاعتنى بالتشريع القرآني والسنة والقياس والإجماع، ثم بحث في الاتفاق والاختلاف والمنافسات بين المدارس الفقهية، وعلى رأسها مدرسة الكوفة ومدرسة المدينة، وتطرق إلى الاختلاف حول القياس والاجتهاد وإعمال الرأي أو الاعتماد المطلق على النص والموقف المتشدد من العقل، وأغلب هذه التجاذبات حدثت إثر اكتمال نظرية الشافعي واختلاف المواقف منها. أما الفصل الثامن المخصص للنظم الفقهية للفرق الإسلامية، فتناول فيه موضوع الفقه السياسي ومواقف الفرق من الخلافة والإمامة وخاصة أهل السنة والشيعة والخوارج. وتطرق كولسون لموضوع الحكومة الإسلامية والفقه؛ فدرس الصلة بين الفقه والسلوك وتطبيق الأحكام في القضاء، خاصة خلال العهدين الأموي ثم العهد العباسي. أما علاقة الفقه بالمجتمع، فتناول فيه الأحوال الشخصية وقانون الأسرة وأحكام المعاملات أو ما سماه بـ"الأحكام المدنية".[1] وخصص كولسون الباب الثالث للتشريع الإسلامي في العصر الحديث، فتناول في الفصل الأول التأثير الأجنبي والأخذ بالقوانين الأوروبية، ويتعلق الفصل بتطور التشريع في الفترة الحديثة وما رافقه من تغيرات على مستوى المحاكم والقوانين، كإدخال القانون الأوروبي الجنائي والتجاري إلى بلاد الخلافة العثمانية في القرن التاسع عشر،[2] واستلهام روح القوانين الغربية، كالقانون التجاري الفرنسي والقانون الجنائي الفرنسي.
وركّز الفصل الثاني عشر على موضوع تطبيق الشريعة في البلاد الإسلامية في الوقت الحاضر، وتعرض فيه إلى مختلف التجارب القضائية والقانونية في البلاد الإسلامية، كالجزائر وباكستان وشبه القارة الهندية التي تميزت بالمزج بين التشريع الإسلامي والقانون الإنجليزي وأنتج ذلك القانون "الأنجلو إسلامي".[3] (Anglo Mohammedan Law) . وفي الفصل الثالث والعشرين، تطرق كولسون للتقليد والتجديد في الفكر التشريعي، وتركز التفكير على تطوير الأحكام بحسب المذاهب. وفي الفصل الرابع عشر بحث كولسون في ما وصفه بالاجتهاد الجديد، وأشار بوضوح إلى جهود محمد عبده الذي دعا إلى إعادة المبادئ المتضمنة في نصوص الوحي الإلهي واعتمادها أساسا على الإصلاح التشريعي، وقد أيد تلك الدعوة محمد إقبال. ويختم كولسون كتابه بخاتمة تدور حول الفقه والتقدم الاجتماعي للمسلمين، وينتهي إلى وجود منحيين أساسيين يسترعيان النظر في أنشطة المجددين التشريعية: أولهما أن الصياغة التشريعية الحالية، قد أسسها الفقه وأدت إلى ازدواج تشريعية في القانون، ولئن كانت الاستفادة واضحة من القوانين الغربية في القانونين الجنائي والمدني، فإن الأحكام الشرعية التقليدية ما زالت مهيمنة على مجال الأحوال الشخصية. أما الملمح الثاني للتشريع الإسلامي الحديث، فيتمثل في أن عددا كبيرا من التجديدات الأساسية فيه، تبدو مجرد حلول مؤقتة أو تسويات جزئية. ولا يعني ذلك إنكار فعالية التحديث بقدر ما هي بداية لمسايرة التطور الحضاري الذي تمر به المجتمعات الإسلامية واليقين بعدم قدرة المقررات الفقهية التقليدية على مواكبة التطور التاريخي. وظل التشريع الإسلامي يواجه مشكلة أساسية قديمة ومتجددة، تتمثل في "الحاجة إلى تحديد العلاقة بين المعايير والقيم التي يمليها الإيمان الديني، ومتطلبات الحياة المادية المحركة للمجتمع".[4] وقد فرضت هذه الحالة ضرورة التفكير في حلول ناجعة، ولذلك رأى البعض من أنصار النظرية الفقهية التقليدية أن الحل يكمن في العودة إلى أوامر الشرع وحده والتقيّد الحرفي بمبادئه والانطلاق منها، لصياغة نظام شامل وصارم من الواجبات والحقوق المهيمنة على سلوك المجتمع والمعاملات. ومال البعض الآخر إلى "العلمانية" التي اختزلت المعايير الدينية في مجال الضمير الفردي، وتمنح العوامل الاجتماعية وحدها سلطة تحديد شكل القانون وصياغته. ورأى كولسون أن الحلين غير مناسبين؛ فالأول غير واقعي أو طوباوي والآخر غير إسلامي غريب عن التربة والبيئة الإسلاميتين. أما الحل الصحيح، في نظره، فيكمن في التوفيق بين الحلين المتطرفين.
* منهجية كولسون وحدود طرحه:
بنى كولسون أبواب كتابه وفصولها وفق رؤية منهجية تاريخية، تروم الانسجام والتكامل في تناول تاريخية التشريع الإسلامي ورصده لأهم المنعرجات التي مر بها، مؤكدا على أهمية المرونة في تطبيق القوانين، وفي ذلك يكمن سر النجاح. ومن أهم المسائل التي يسرت على كولسون تناوله لتاريخ التشريع الإسلامي هو تمكنه من مصادر الفقه ومنهجيته القانونية، وهو مدخل يشير بوضوح إلى أهمية النظر القانوني في التشريع، وفي ذلك إشارة إلى صلاحية التشريع للتطبيق في العصر الحديث، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار "روح القانون" ومقاصد الشريعة. ورغم هذه المزايا، فإن أستاذه المستشرق شاخت، رأى أن كولسون لم يكن على صواب حين نظر إلى الفقه بمنظار قانوني معاصر، لا بمنظار الباحث في الشريعة الإسلامية. ويجزم شاخت أن التشريع الإسلامي وصل إلى لحظات الجمود ونهايته المحتومة التي لم يعد استئنافها ممكنا، إلا أن كولسون بدا متفائلا و"مسرفا في الخيال" حسب شاخت. لكن ذلك التوصيف ليس صحيحا، فلم يكن غير واقعي، بل كانت له أسسه النظرية والعملية في حكمه على التشريع الإسلامي، ولهذا يرد على أستاذه مؤكدا أنه حان الوقت لدراسة الشريعة على مستوى متخصص في الاقتصاد أو الاجتماع أو السياسة، وعلى الباحث في الشريعة أن يميل إلى التخصص والأخذ بروح العصر. ويختلف كولسون في الموقف من تطبيق التشريع الإسلامي عن الباحثين المسلمين المنادين باستئناف تطبيق التشريع. فمحور نظر كولسون يكمن في أن مهمة الفقه الأساسية هي بحث في علاقة الإنسان بخالقه، وبحث في علاقة الإنسان بالإنسان، لكن البحث في هذه العلاقة قد انحصر في تأثيرات تلك العلاقة في الضمير الفردي وفي محاسبة الأفراد في الآخرة. وأدى ذلك إلى غياب شبه تام لمباحث القانون العام التي تعنى بتحديد نظام الدولة ومؤسساتها. ويقيم تحليله للفقه الإسلامي على أساس آخر يتمثل في أن الأحكام الشرعية يغلب عليها الطابع الخلقي والقيمي، مما أضعف فيها الحس القانوني، وطغى التمسك بحرفية النص، فغاب الاجتهاد الذي لم يكن مقننا في بدايته وخلال القرنين الأولين، فتأخر تقنينه إلى لحظة الشافعي الذي ضبطه بالقياس.
وعلىالرغم من نقاط الاختلاف بين كولسون وشاخت، فإنهما يتفقان في العديد من النقاط، لعل أهمها تعريف الشريعة بأنها "جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من جميع وجوهها، وهي تشمل أحكام خاصة بالعبادات والشعائر الدينية كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية (بالمعنى المحدود) وعلى تفاصيل آداب الطهارة وصور التحية وآداب الأكل وعيادة المرضى."[5]فالشريعة قانون مصدره إلهي منزل عن طريق الوحي الإلهي، ويحدد هذا القانون مسائل العبادات والمعاملات والأخلاقيات. ولكن ما يجب التنبيه عليه هو الفرق بين الأحكام ذات المصدر الإلهي والتأويلات أو القراءات البشرية للنص القرآني والاجتهادات البشرية. ويؤكد شاخت على العلاقة المتينة بين الشريعة والقيم الأخلاقية والدينية، لذلك يذكّر بأنه "لا ينبغي أن ننسى أن المضمون التشريعي في حد ذاته هو جزء لا يتجزأ من نظام القواعد الدينية والأخلاقية."[6] وهذا يعني عدم إمكانية الفصل بين الأحكام في القرآن والمنظومة القيمية الأخلاقية والدينيّة. وكان الوعي بالفرق بين الشريعة والفقه محل اتفاق بين شاخت وكولسون الذي نظر في تطور الشريعة ومال إلى عدم اعتبارها ظاهرة تاريخية على صلة متينة بتطور المجتمع، دون إنكار تدرج الكشف عن أحكام الله.[7] وقد حصر الفقه الإسلامي مفهوم الشريعة في الأحكام التشريعية الخاصة بالمعاملات، مستبعدا العبادات والأخلاقيات.[8] وقد قصر الفقه الإسلامي لفظ شريعة على الأحكام القانونية، وفي فترة لاحقة أصبح معنى الشريعة يشمل آراء الفقهاء والفتاوى. فأمام ضغط الحاجة، لاستنباط أحكام جديدة تواكب التغيرات والمستحدثات لم يجد الفقهاء مناصا من الاجتهاد في ما لا نص فيه. ونشأت تبعا لذلك مدارس فقهية واكبت تطور الأوضاع، وسعت لتشريع العديد من الأحكام حرصا على تجسير الهوة بين النص والتاريخ. ففي الاتجاه السني، نجد أربعة مذاهب هي المذهب المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي. وفي الاتجاه الشيعي نجد المذهب الجعفري والزيدي وغيرهما.
2- تاريخية التشريع الإسلامي:
مثلت التشريعات القرآنية إضافة حاسمة في حياة المجموعة المؤمنة التي كانت خاضعة لرابطة القبيلة والقرابة والقوانين العرفية، وهي قواعد غير مكتوبة ولكن متعارف عليها وتحظى بالاحترام، ولم يكن غياب أي نوع من أنواع السلطة التشريعية أمرا مستغربا في تلك الفترة. وبمجيء الإسلام تغير الوضع التشريعي، ومثل تأسيس الجماعة المؤمنة بالمدينة نواة جديدة لمجتمع جديد وقيم بديلة، وبدأ الوحي القرآني يتبلور ويشق طريقه لإزاحة قواعد العرف القبلي وتأسيس قيم جديدة تدير الحياة. واستند التشريع القرآني إلى قيم وحقوق إنسانية شاملة وطالب بترجمتها وتأكيدها في الواقع، مثل قيم الرحمة والعدالة وحسن السلوك في المعاملات. وترد هذه المفاهيم في القرآن، باعتبارها معايير السلوك القويم الواجب التحلي به. واتجهت العقوبة إلى المراوحة بين الدنيا والآخرة. وكانت التشريعات القرآنية تتجه بشكل مباشر إلى الجماعة المؤمنة، وهي جماعة قليلة العدد نسبيا لا تحتاج إلا إلى قواعد قليلة وبسيطة وموجزة ومتنوعة. ولم يقتصر القرآن على التوجيه الخلقي، بل انتقل إلى ضبط الوقائع العملية، لكن المحتوى القانوني للقواعد الخلقية ظل متواصلا. فقد وضع القرآن في القصاص والجروح معيارا للعدالة، وهو "النفس بالنفس والعين بالعين"، وهذا يتناقض مع ما كان سائدا قبل الإسلام من تغليب مفهوم الثأر عند التعامل مع مثل هذه الجنايات. وقد وجد المسلمون في شخص النبي وسيرته نماذج حية للفصل في العديد من المشاكل الطارئة.
وبعد وفاة النبي استأنف الخلفاء من بعده الفعل التشريعي، وعملوا على تطبيق الأحكام القرآنية بالأسلوب ذاته الذي غرسه فيهم النبي. وخلال العهد الأموي وجد المسلمون أنفسهم أمام العديد من المشاكل الحادة التي تهم التنظيم الإداري للمناطق المفتوحة، فضلا عن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، هذا بالإضافة إلى المشاكل السياسية الداخلية؛ فكان اللجوء إلى استيعاب التوجهات القرآنية في إطار الأعراف القانونية السائدة. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تشريعات الرسول واجتهادات الخلفاء الراشدين من بعده، فإن العهد الأموي يعتبر عهد تكوين تنظيم جديد لأمور القضاء، وظهر تفكير تشريعي فقهي إسلامي، ومن خلاله ظهر القانون الإسلامي، وكانت تلك النتائج استجابة لتغييرات عميقة في الروح الإسلامية وقوة الدين خلال فترة الحكم الأموي؛ فقد أدت حركة الفتوحات والتوسع إلى الإحساس بقوة السلطة المبنية على الأرستقراطية الأموية والقيم القبلية، رغم أن الخلفاء الأمويين مارسوا سلطتهم باسم الإسلام، ولكن بأسلوب يختلف عما كان لدى الخلفاء الراشدين. وعمل الأمويون على التعامل بمرونة مع النص القرآني، فاجتهدوا في تطويع المادة الأساسية للقانون العرفي المحلي لتتناسب مع التشريع القرآني، ومزجوا تلك المادة بالسنن الإدارية والمحلية والأجنبية. وبهذا كان تطور التشريع يقوم على المزج بين عناصر متنافرة الأصول، ولم يخضع لخطة واضحة. ولم يكن من السهل استيعاب تلك التغيرات ومواكبتها إلا بالتنسيق الدقيق بين الأصيل والوافد، وإدغام مصادر التأثير المتنوعة في العمل الفقهي الذي ركزه الأمويون. وإثر سقوط الحكم الأموي وظهور الدولة العباسية، حاول العباسيون أن يجعلوا التشريع الإسلامي القانون الوحيد للدولة، فاستوجب ذلك منح الفقهاء دورا واسعا في التشريع لسبل إدراة المجتمع والدولة. وقد استفادت المدارس الفقهية بدورها من هذا الحدث، فتطورت بسرعة في ظل الرعاية السياسية. ولئن نجح العباسيون في إلزام القضاة في حكمهم بالعودة إلى قانون الشريعة الإسلامية، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق التطابق الدائم بين النظرية والممارسة الفعلية، وبين الحكم والشريعة. ثم أبعد التشريع شيئا فشيئا عن السياسة والحكم لكن ذلك لم يحل دون سلطانه على عقول المسلمين وتوقيرهم إياه، واستطاع التشريع الإسلامي الحفاظ على استقراره وثباته بعد الابتعاد عن السياسة.
وفي العصر العباسي الأول تطور المنهج الفقهي وظهر اتجاهان : الاتجاه الأول سعى إلى إضفاء التناسق والترابط على النظر الفقهي واعتماد القياس من أجل ذلك. والاتجاه الثاني يؤكد على اعتماد القرآن والسنة. وكشف الفقه مع الشافعي (ت204هـ) عن مرحلة جديدة فحقق تقدما وأفصح عن منهجية عميقة في النظر الفقهي، وتركز عمله على توحيد الفقه ومحاصرة الاختلاف بالتوسل برؤية متماسكة تحدد المصادر التي يستوجب استنباط الأحكام منها. ولا تكمن إضافة الشافعي في اجتراح مفاهيم جديدة، بل في "إعطاء الأفكار القائمة ألقى جديدا بإبرازها وإقامة ضرب من التوازن بينها، وصهرها جميعا في إطار منهجي متكامل خاص بأصول الفقه على نحو لم يحدثمن قبل."[9] وقامت رؤيته على التوفيق بين دور الوحي الإلهي والاجتهاد البشري، وقصد بذلك الدمج التوسط لحل الخلاف الأصولي بين أهل الحديث وأهل الرأي.
وشهد الفقه الإسلامي فترة يمكن وسمها بفترة توقف النمو، وخاصة بعد وفاة الشافعي وتنوع المواقف من السنة التي أصّل لها الشافعي. ووفر الحديث مادة مهمة للتشريع الفقهي، فاعتبر الحديث النبوي بمثابة الوحي الإلهي، وتعذّرت معارضة متن الحديث، فاتجه التمحيص والنقد لسلسلة الرواة أو الإسناد واتخذ العلماء ذلك معيارا للتثبت من صحة الحديث. وأسهم اعتماد الحديث النبوي في تشكيل مدارس فقهية جديدة، غالت في الاعتماد على النص وعدم اعتبار العقل الإنساني مصدرا تشريعيا، وكل حكم تشريعي يمكن أن يجد حجته اللازمة في الوحي الإلهي من القرآن والسنة. لكن الاعتماد المبالغ فيه على النقل والحديث بشكل خاص أنتج نوعا من الجمود الفقهي، وانحسر الاجتهاد نتيجة المحاولات التي تلحق مختلف الأحكام بالحديث النبوي، وشيئا فشيئا ساد الركود التشريع الفقهي، وبدأ اجترار الأحكام وطغى التقليد.
3- تطوير التشريع الإسلامي في العصر الحديث:
على الرغم من الاستفادة السياسية من المقولات الفقهية وتوظيف الفرق الكلامية للفقه في الدفاع عن وجاهة رؤيتها وتبرير السائد، فإن التشريع الإسلامي ظل عاجزا عن مواكبة التغيرات الحضارية العميقة. وقد اهتم كولسون بتتبع آراء الفرق الدينية، وخاصة الفرق السنية والشيعية وفرق الخوارج، وتتبع الخلافات الكلامية حول قضية الخلافة والإمامة، ولم تكن الأحوال الشخصية غائبة عنه؛ فقد ركز على زواج المتعة عند الشيعة وما يرافقه من مشاكل تشريعية، واستنتج أن الفقه بقي في إطار البحث عن تبرير للسائد السياسي، وتأثر بالركود الثقافي والسياسي والفكري الذي عرفته الدولة الإسلامية. أما في الفترة الحديثة فبدا واضحا التأثر بالقوانين الغربية، وخاصة في القانون العام والمدني. ورغم التطورات التشريعية، فإن بعض البلدان الإسلامية وبعض الأنظمة لا تزال تنادي بتطبيق الشريعة وتغليب الأحكام التقليدية، وإنشاء محاكم إسلامية في شبه القارة الهندية وفي الشرق الأوسط بشكل خاص. ولم ينكر كولسون وجود بعض الجهود الإصلاحية في بعض الأحكام الخاصة بالأسرة والمواريث، وأشاد بدعوة محمد عبده، لاستلهام مبادئ الوحي القرآني أساسا للإصلاح التشريعي، وتبعه في ذلك محمد إقبال وغيره من المجددين. وبدأ الاجتهاد الجديد من الجمع بين الأحكام التقليدية والاتجاهات الجديدة، فنشأت مرحلة تتوسط التقليد والاجتهاد بالمعنى الحقيقي ودعاها بـ"الاجتهاد الشكلي غير الحقيقي".[10] وركز كولسون بشكل على وضعية المرأة في التشريع الحديث في مسألتي الزواج والطلاق على وجه الخصوص.
خاتمة:
من أهم النتائج التي يمكن الاهتداء إليها في نهاية هذا التقديم هو منهجية كولسون في التناول، باعتباره رجل قانون، وقد مكنه ذلك من الوقوف على العديد من التفاصيل والدقائق التشريعية التي يعسر على الباحث التفطن لها. وما زاد من أهمية بحثه هو اتصافه بالتكامل والانسجام بين القضايا المطروحة من الناحيتين الزمنية الكرونولوجية التي تولي أهمية قصوى لتاريخية الظواهر؛ فعالج تطور التشريع وخصائصه منذ عهد الرسول مرورا بتجربة الخلفاء الراشدين، ثم في الدولتين الأموية والعباسية وصولا إلى العصر الحديث وما فرضه من إشكاليات جديدة، كانت استجابة للتطور الحضاري والانفتاح على القانون الغربي. ومن ناحية التكامل بين المواضيع. أما في السياق الحديث، فما ننتهي إليه هو المراوحة بين الفقه التقليدي والتأثر بالقانون الأوروبي وظهور تيار متشدد ينادي بالاحتكام إلى الأصول أو تطبيق الشريعة وتيار آخر متفتح و"علماني".
ومن مزايا الكتاب، جمعه بين التحليل النظري واستقراء التجارب في مختلف البلاد العربية الإسلامية والتركيز على خصائص كل تجربة واختلافها عن غيرها؛ فالدعوة إلى تطبيق حدود الشريعة تثير العديد من المشاكل وتتصل بالفهم الحرفي للنص، لكن الأحكام القرآنية تتخذ صفة المعايير الأخلاقية التي بإمكانها أن تدعم الأبنية القانونية الحديثة، لأن تلك الأحكام تتسع للعديد من التفسيرات، ما يجعلها مواكبة للتغيرات إذا ما روعيت المرونة في التنفيذ. ولهذا، ما على التشريع الإسلامي إلا أن يتخلص من المفهوم التقليدي للقانون الديني المتمثل في القواعد المتحكمة الجامدة. وهكذا يمكن مواكبة التغيرات الاجتماعية والسياسة التي أنتجها سياق الحداثة.
[1]- ن. ج. كولسون، في تاريخ التشريع الإسلامي، ترجمة محمد أحمد سراج، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 1992 ص181
[2]- المرجع نفسه، ص 201
[3]- المرجع نفسه، ص 218
[4]- المرجع نفسه، ص 286
[5]- جوزيف شاخت، وبوزورث، تراث الإسلام، القسم الثالث، ترجمة حسين مؤنس وإحسان صدقي الصمد، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ديسمبر 1978 ص 9
[6]- المرجع نفسه، ص 9
[7]- ن. ج. كولسون، في تاريخ التشريع الإسلامي، ص 18
[8]- محمد سعيد العشماوي، الشريعة الإسلامية والقانون المصري، ط1، مكتبة مدبولي الصغير،القاهرة1996
[9]- كولسون، المرجع نفسه، ص 88
[10]- المرجع نفسه، ص 265