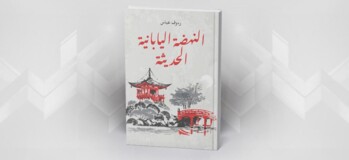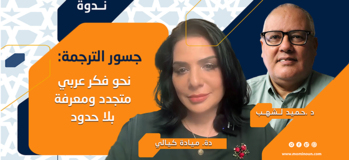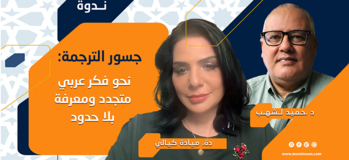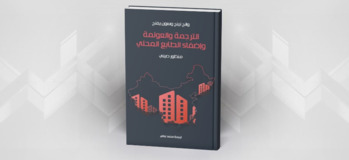حوار مع د. حميد لشهب بعنوان "الترجمة جسرًا بين الثقافات"
فئة : حوارات

حوار مع د. حميد لشهب بعنوان
"الترجمة جسرًا بين الثقافات"
المعرض الدولي للكتاب الرباط – المغرب -2025
د. حسام الدين درويش:
مساء الخير مرةً أخرى في ندوة جديدة ومتميّزة من سلسلة ندوات مؤمنون بلا حدود، من المعرض الدولي للكتاب والنشر في الرباط، في المغرب. اليوم معنا ضيف عزيز: الدكتور حميد لشهب. وهذه هي الندوة الثانية التي نقيمها معه عن الترجمة، ولن تكون الأخيرة. وعنوان ندوة اليوم هو: الترجمة جسرًا بين الثقافات. وقد تحدّثنا في ندوة سابقة عن مسألة الترجمة، وكيف يمكن أن تكون فاعلة بين الثقافات، واليوم سنتوسّع أكثر، سواء من الناحية الشخصية أو المهنية أو من خلال الترجمات، حيث سيكون النقاش أوسع وأغنى.
وللقرّاء أو المتابعين الجدد، نُعرّف بالدكتور حميد: حاصل على درجة دكتوراه قسم الفلسفة، علوم اللغة والتواصل وعلوم التربية، جامعة ستراسبورغ الفرنسية. له الكثير من الكتب والدراسات والترجمات والمقالات في الفلسفة والفكر والبيداغوجيا والسيكولوجيا والسياسة والهجرة، نُشرت في مجلات متخصصة وجرائد في العالم العربي والعالم الجرماني. حاور العديد من المفكرين والفلاسفة العرب والجرمانيين، كما حاورته العديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. نال العديد من الجوائز منها "الجائزة العالمية إريك فروم لسنة 2004"، والميدالية الإقليمية لمحافظة الفوغالبيرغ النمساوية عام 2009، و"الجائزة العالمية للترجمة "جيراردو دي كريمونا" كـ"مترجم الضفة الجنوبية للمتوسط" عام 2019". فهو مغربي - فرنسي - نمساوي، ويمكن القول إنه يحمل خصلة إنسانية كونية. له العديد من الكتب والدراسات والترجمات، وهو موضوع حديثنا اليوم. لكن، لعلّ صفة "المترجم المتميّز" تطغى أحيانًا على صفة "المفكّر"، في التعريف به، رغم أنّ له أيضًا نتاجات فكرية متنوعة ومهمة، سنحاول الإلمام ببعضها اليوم. مرحباً بك دكتور حميد، شرفتنا، وشكرًا جزيلًا على تلبية الدعوة.
د. حميد لشهب:
ألف شكر دكتور حسام، وألف شكر لمؤسسة مؤمنون بلا حدود، ولأخي وصديقي وأبي مهيار.
د. حسام الدين درويش:
شكراً جزيلاً لك. بالنسبة إليك، الترجمة ليست مهنة، وليست عملًا تقوم به، وإنما هي ذات بعدٍ إنساني دائم، يتجلّى في اختياراتك، وفي علاقاتك مع المؤلفين الذين تترجم لهم، ومع دور النشر التي تتعامل معها، والمضامين التي تنقلها. دائمًا ثمة بعد إنساني، وبعد قيمي، يتجاوز الجانب المهني بالمعنى الضيق للكلمة. لنبدأ بهذه المسألة.
د. حميد لشهب:
أعود إلى مسألة قلتها وأعيدها: الترجمة بالنسبة لي هي نوع من الحبّ الصوفي، اختيار شخصي غير مهني، لكنه في جودته قد يفوق أحيانًا ما هو مهني، إذا كنّا نقصد بالمهني تلك الترجمات التي تضع نصب أعينها الجانب المادي فقط. ما يهمني هو الإنسان بصفته إنسانًا. أحبّ الإنسان، أحبّ الإنسانية، أحبّ كل ما هو حيّ، حتى الحيوانات والنباتات. وفي هذا الإطار، فإن الترجمة عندي هي فعل لمعرفة الآخر، لفتح الأفق على معرفة أخرى، ليست مجرد معرفة سطحية كما نعرفها اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بل معرفة أنطولوجية؛ بمعنى أن ما يحرّكني في نهاية المطاف هو جمع الناس حول موضوع يهمّ الجميع. الترجمة هي فعل « La traduction est un acte »، إنها ربط الجسور بين مختلف مكوّنات المجتمع الإنساني. لم أعد أتحدث عن مجتمع عربي أو مغربي أو قومي، بل أرى الإنسانية في بعدها الكوني. أكرّر: الترجمة بالنسبة لي هي فعل حبّ، فعل يتجاوز نقل الكلمات من لغة إلى أخرى، لتفعل فعلها في ثقافة أخرى. إنها في النهاية تمرير الناس للتعرف على أناس آخرين.
د. حسام الدين درويش:
ممتاز، ممكن أن نسمّيها علاقة حب، كيف بدأت عمليًّا؟ وكيف يمكن أن نقول إنّها بدأت نظريًّا؟ بمعنى: متى قرّرتَ، أو ارتأيتَ أنّه من المناسب لك، أو من الواجب عليك، أو من المحبّب لك، أن تبدأ بالترجمة؟ لنحكِ عن البدايات.
الترجمة، وخاصةً من الألمانية، لم تكن الخيار الأوّل؛ إذ كان بإمكاني أن أترجم من الفرنسية إلى العربية، وكان ذلك سيكون أسهل وأسرع. لكن عندما اكتشفت الثقافة الجرمانية؛ أي الثقافة الألمانية، اكتشفتُ في الوقت نفسه أنّنا مبتورو الجذور في معرفتنا بالغرب عمومًا، وبأوروبا خصوصًا.
نحن، في المغرب، كنّا نختزل الغرب وثقافته بحكم الفترة الاستعمارية في فرنسا. كانت فرنسا هي النموذج الذي يُقتدى به عندنا. لكن عندما درستُ في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أدركتُ أنّ هناك جناحًا جرمانيًّا آخر، واكتشفتُ أيضًا قصور معرفتنا بالآخر وحدودها. وفي تلك المرحلة كنت أتهجّى اللغة الألمانية، بفعل أنّني أقمتُ لمدة سبع سنوات في منطقة فرنسية ذات جذور جرمانية، فتعلّقتُ باللغة الألمانية، وكان لا بدّ لي أن أتعلّمها. قضيت سنواتٍ وأنا أتهجّاها في فرنسا، لكن عندما انتقلتُ، في إطار مساري الدراسي، إلى مدينة إنسبروك النمساوية، اكتشفتُ وجهًا آخر من الجرمانية، وجهًا طبع حياتي الفكرية بأكملها. هناك تعرّفتُ على الفيلسوف والمحلّل النفسي إريك فروم من خلال مؤلفاته، وأدركتُ أنّ الحاجة إلى التعمّق في دراسة اللغة كانت بالنسبة لي، إذا صحّ التعبير، قرارًا صوفيًّا. شعرتُ بنوع من المسؤولية تجاه أبناء قومي. فعندما هاجرتُ، لم تخترني الهجرة، بل أنا الذي اخترتها. كان بإمكاني أن أبقى في البلاد وأتبع مسارًا أكاديميًّا عاديًا مثل أصدقائي، لكنّي اخترت في ذلك الوقت أصعب الطرق: الهجرة.
عندما اكتشفتُ العالم الجرماني (ألمانيا، النمسا، الشمال الشرقي لسويسرا، إمارة الليكتنشطاين، أجزاء من بلجيكا إلخ)، واكتشفتُ اللغة الألمانية، تبيّن لي قصور معرفتنا بالآخر، حتى ما كنّا نقرأه عن الألمان في الفلسفة، وعلم الاجتماع، وعلم النفس، والعلوم الإنسانية عموماً، كان يصلنا عبر الترجمات الفرنسية أساسًا، بالنسبة لنا نحن المغاربة. أدركتُ أنّ هناك إمكانية، لو أُتيحت، للتعرّف على النصوص الألمانية مباشرة، لكيلا يكون النقل عن لغة وسيطة كالفرنسية أو الإنجليزية. وهذا هو الأمر الذي كان يهمّني بالأساس: محاولة نقل الفكر والفلسفة الجرمانية، أو جزء منه، إلى العربية نقلاً مباشرًا من النصوص الأصلية؛ لأنّ كل ترجمة عن لغة وسيطة تؤدّي إلى هدر وخسارة، سواء لغويّة أو في المضامين. وقد تطلّب ذلك منّي تعلّم الألمانية أكثر من خمس سنوات حتى أتمكّن من ضبط جزء منها. ولا يمكنني أن أقول إنني أتقن الألمانية كالألمان أنفسهم، لكن عندما وصلتُ إلى ما يقارب ثمانين في المئة من ضبط اللغة قررت أن أبدأ، وبدأتُ فعلاً عملي في الميدان. عندها علمت أنّني أحمل رسالة، رسالة للانتقال إلى الفعل في الترجمة.
د. حسام الدين درويش:
بدأنا بتشبيه، أو بالقول إن علاقتك بالترجمة هي علاقة حبّ. الآن سنتحدث عن كونها علاقة زواج. وربما، من ناحية ما، هناك من يقول إن علاقة الحب تنتهي بالزواج، وهناك من يقول إن علاقة الحب متمايزة تمامًا عن علاقة الزواج. ففي الزواج، يمكن التمييز بين من يريد الزواج، فيبحث عن فتاة، ومن يحبّ فتاة، فيتزوجها. هل بدأتَ الترجمة؛ لأنك وجدت كتابًا رأيتَ أنه يستحق الترجمة، فمارستها، أم إنّك قررت أن تترجم، فصرت تبحث عن كتاب؟
د. حميد لشهب:
هذا تمييز دقيق وجميل جدًّا، فيه بُعد فلسفي عميق. بدأت بقصة حبّ في قراءتي للألمانية، وأكررها مرة ثانية: عندما اكتشفتُ اللغة الألمانية اكتشفتُ الإرث الفكري لإريك فروم، وكانت تلك هي العلاقة الأولى، علاقة الحب بالترجمة. اخترته لأنه يكتب بأسلوب في متناول الجميع، أسلوب أكاديمي غير اختزالي، لكنه واضح وقريب من اهتماماتي الفكرية والمهنية. إذن اخترتُ، في البداية، الاهتمام بنصوص إريك فروم، حتى كتمرين لتعميق معرفتي باللغة الألمانية. وبعدها، في إطار عملي، اكتشفتُ آنذاك، وكان يدير المعهد العالمي للفلسفة الصديق البروفيسور سايفرت، موضوعاً آخر أحببته كثيراً، هو موضوع الدين، وكيف يشتغل فيلسوف غربي على هذا موضوع. وكانت الانطلاقة، فكان أول عمل ضخم بدأته هو ترجمة كتاب البروفيسور سايفرت: الله: دليل على وجود الله، في إطار اشتغالي معه في الأكاديمية العالمية للفلسفة في إمارة الليطتنشطاين.
د. حسام الدين درويش:
بالأمس، كنا نتحدث مع الدكتور يوسف أشلحي، وتحدّث عن أهمية هذا الكتاب، وعن التعريف بمؤلفه حتى هنا في المغرب، وقال إن بداية تعرفه إليك كمترجم وشخصية كانت مع هذا الكتاب. إذن هذا هو الكتاب الأول. فلنتحدث عن أبرز المحطات. أنت ترجمتَ أكثر من خمسة وعشرين كتابًا، لكن ما أبرز المحطات التي ارتبطت بترجمتك، لنُعطي صورة عن طبيعة ومضامين الترجمات التي قمت بها؟
د. حميد لشهب:
نعم، الانطلاقة كما قلت كانت مع سايفرت. بعدها، وما لم أقله منذ البداية، هو أنّني، في بداية اهتمامي بفعل الترجمة، كنت أريد أن تكون هناك انتقائية في ما أترجمه، فلا يُفرض عليّ ما أترجم. بما أنّ الترجمة عندي هي حبّ، فإذا لم أحبّ كتابًا أو توجّهًا ما، فلن أترجمه. اخترتُ اتجاهات أربعة في الفلسفة الجرمانية المعاصرة: الأول، فلسفة الدين. الثاني، الفلسفة النضالية من أجل الحقوق؛ أي فلسفة القانون وفلسفة العدالة الاجتماعية، ويمثلها حاليًّا الفيلسوف النمساوي هانس كوكلر، في إطار ما كان يحدث آنذاك على مستوى السياسة العالمية وعلاقتنا بالغرب. الثالث، الفلسفة الإنسانية التي يمثلها إريك فروم. والرابع، الفلسفة البيئية، التي ينصبّ اهتمامي عليها حاليًّا؛ لأنني أبحث فيها عن "حبّ جديد". فأنا أعي أنّ الفلسفة البيئية ما تزال غائبة، بل "غابرة" كما نقول في المغرب في الساحة الفلسفية العربية. وهي مهمة بالنسبة لنا كشعوب وبلدان تستهلك أكثر مما تنتج. هذه الاتجاهات الأربعة هي التي اخترتها منذ البداية في ممارستي للترجمة، وكان الحب الكبير هو الذي دفعني لتقديمها إلى الساحة العربية.
د. حسام الدين درويش:
ذكرتَ في شرحك للترجمة أنّ لديك، إلى جانب علاقة الحب، بُعد الرسالة. فهنا: هل تبحث عن الرسالة التي تراها مناسبة أم تبحث عن الرسالة التي تراها منسجمة مع رؤيتك القيمية، ورؤيتك الفكرية والفلسفية للعالم وللعلاقات بين أجزائه المختلفة؟
د. حميد لشهب:
الرسالة التي أقصدها هي رسالات الحب التي كنا نعرفها منذ فترة الشباب؛ الرسالة التي أقصدها هي رسالة المفكرين والفلاسفة الجرمانيين، الذين يحاولون مثلي أن يروا بعين إيجابية للإنسانية، على الرغم من كل المشاكل التي تعيشها. فهناك مبدأ يجمع الإنسانية بأكملها: مبدأ الحب، ومبدأ السلام، ومبدأ التعارف، مبدأ الحوار، مبدأ الالتقاء؛ هذه هي الرسالة التي أريد أن أُفصح عنها في اهتماماتي الترجمية. وما عدا ذلك لا يعنيني؛ لا تهمني الفلسفات الكبرى، ولا الأنساق الفلسفية الضخمة، ما يهمني ما يمكن أن أنجزه في حياتي الآنية، في حياتي داخل هذا العالم. ولا يعنيني ما قد يغير العقليات، إنما أحاول وأسعى إلى تغيير قلب الإنسان، إلى أن تنفتح القلوب البشرية على الحب الحقيقي؛ أي على السلام وحب الخير لبعضها البعض.
د. حسام الدين درويش:
أودّ هنا، لحفظ حق الملكية، أن أشير إلى أنّ عنوان الندوة اليوم كان من وضعك أنت، أعني "الترجمة جسرًا بين الثقافات". لكن، كيف وبأيّ معنى تكون الترجمة جسرًا (بين الثقافات)؟ وما الذي يَعبر من خلال هذا الجسر؟ هل هي المعرفة وحدها لنعرف الآخر؟ أم إنّ المطلوب أكثر من ذلك، أن يكون هناك تأثيرٌ وتأثر متبادلان؟ ليس فقط أن نعرف، بل أن نفهم، أن نتأثر، أن نتشارك، أن نتفاعل. فبأيّ معنى ترى أنت أنّ الترجمة كانت، أو ينبغي أن تكون جسرًا بين الثقافات؟
د. حميد لشهب:
نعم، هذا سؤال جوهري في طرح قضية الترجمة. القنطرة أو الجسر الذي أعنيه في ترجماتي هو نوع من حمل هموم ثقافة إلى ثقافة أخرى، وحمل أفراح ثقافة من ثقافة إلى أخرى، في الاتجاهين معًا. وهذه "الجسرنة" إن صح التعبير، بين الثقافات، هي قبل كل شيء إتاحة فرصة لتواصل الإنسان مع الإنسان، من لحم ودم. لذلك، في كلّ ترجماتي، لا أذكر أنني ترجمت لشخص لا يزال حيًّا ولم يرافقني للمغرب في إطار لقاء علمي حول موضوع ما. مثلاً لو كان شوبنهاور على قيد الحياة، لكنت أقنعته بمرافقتي للمغرب بعد ترجمة كتابه حول نقد كانط. كلّ من ترجمت لهم، كان من الشروط الأساسية التي التزمت بها أن أعقد لقاءات بين هؤلاء المفكرين والجمهور المثقف في المغرب، سواء في الكليات أو في المعاهد أو في غيرها. وآخرها كانت مع كوكلر، بل وحتى في ما قمنا به في الأيام الأخيرة، فأنت جئت من الشرق ومعك رصيد كبير من الثقافة، وعملت معك الأمر نفسه، حتى وإن لم أترجم لك نصوصًا، فقد ترجمتك كإنسان.
د. حسام الدين درويش:
وكنتَ أنت الجسر بهذا المعنى؛ فلنعد إلى مسألة المترجم والمفكر: ألا ترى أنّ حضورك كمترجم قد طغى أو غلب على حضورك كمفكر، بمعنى ما؟ طبعاً، كنا نتحدث عن إيجابيات الترجمة، وهي كثيرة؛ إذ ليس هناك حضارة وُجدت إلا عبر التثاقف والتفاعل، فالحضارة التي تنغلق على ذاتها، إنما تُعلن موتها. حتى في العصور الوسطى، أنت تعرف دور الترجمة وحضورها. إذن، إيجابياتها كثيرة. لكن، يمكن الحديث أيضًا عن سلبياتها أو عن معاناة الترجمة، ومحنتها أيضًا. وقد ناقشنا ذلك في اللقاء الأول. أمّا الآن، فسأتحدث عن شيء آخر: هل ترى أنه ينبغي للمترجم أن يكون مجرد وسيط لا يؤثر؛ أي إن دوره أن ينقل الفكر من لغةٍ إلى أخرى بصدق ونزاهة؟ هذه قراءة أولى. في المقابل، يمكن النظر إلى الترجمة بوصفها إعادة كتابة، أو إعادة تأليف. فكيف ترى أنت مسألة الترجمة ودور المترجم: حضوره أو غيابه؟
د. حميد لشهب:
لقد حاولت في كلّ ترجماتي أن أعمل في الظل، أن أترك المؤلف أو الاتجاه الفلسفي الذي أترجم عنه يتكلم، وأن أبقى أنا في الظل، لا كجسر فحسب، بل كان ذلك قرارًا شخصيًّا مني، سعيت فيه إلى نوع من الحياد حتى لا أؤثر في مضمون ما أنقله من لغة إلى أخرى. لكن الترجمة فتحت لي أبوابًا أخرى، واستفدت منها كثيرًا؛ إذ كانت تحفزني على التفكير في مواضيع لم أكن ألتفت إليها. فمثلاً، وضعت كتبًا في "الكانطية الجديدة"، في العالم العربي لا نكاد نعرف عنها إلا القليل. وقد فتحت لي الاتجاهات الأربعة، باب "الكانطية الجديدة" فألفت فيها. الأمر نفسه فيما يخص الوضعية المنطقية، حيث ألّفت كتابًا في هذا المجال نُشر على نطاق واسع، وكانت ردود الفعل حوله إيجابية جدًّا. كذلك ألّفت في مواضيع أخرى، حتى في موضوع "الله"، وهو موضوع لم أكن لأفكر فيه، لولا أنّ أول كتاب ترجمته كان متعلقًا به. كما ألّفت في إبستمولوجيا علوم التربية، وإبستمولوجيا علم النفس. ولو لم أكن قد قرأت لإريك فروم، لما اهتديت إلى مثل هذه المواضيع.
د. حسام الدين درويش:
إذن، بدل أن يكون هناك تعارض، كان هناك تكامل؟
د. حميد لشهب:
هناك تكامل وهناك فتح الآفاق؛ فكل مشروع ترجمة يفتح آفاقاً أخرى، شخصية وفكرية، سواء باختيار ترجمة كتاب جديد أو بالتأليف في موضوع يثير الانتباه داخل عملية الترجمة.
د. حسام الدين درويش:
كان هناك استمرار في استخدام استعارة أو رمز "الجسر"؛ بمعنى أنّك في دورك كمترجم تفتح جسرًا بينك وبين المؤلفين. أظن أنّه غالبًا لا توجد هذه العلاقة الودية المباشرة بين المترجم والمؤلف، لكنني أعلم أنّك كنت حريصًا وناجحًا في إقامة علاقات شخصية مع معظم الذين ترجمت لهم. إذن من ناحية أولى مهنيًّا فهذا جيد، وقد أشرتَ إلى هذه المسألة مع ستيفان فايدنر وكوكلر وغيرهما، فهذا يساعدك على أن تضبط الترجمة وتفهم المقصد وتعبّر عنه. لكن هناك مسألة أكبر من ذلك، وهي مسألة إنسانية؛ فأنت حريص أيضًا على أن تقيم علاقات إنسانية مع من تترجم لهم، فيتحولون بالفعل إلى أصدقاء. حدّثنا عن هذه العلاقة؟ كيف هي من الناحية المهنية، ومن الناحية الإنسانية؟
د. حميد لشهب:
نعم، من الناحية المهنية، ما جمعني بأكثر الذين ترجمتُ لهم هو الشروع في مشاريع ضمن مؤسسات أكاديمية في المناطق التي أسكنها، سواء في الكليات أو في المعاهد المتخصصة. على هذا المستوى، كانت علاقاتي بزملائي طيبة وودّية؛ لأنني عندما أنهيت دراستي، لم أرَ نفسي وكأنني اكتملت، بل كأنني بدأت شيئًا جديدًا في حياتي؛ إذ إن البحث الأكاديمي لا يتوقف عند الأطروحات، بل إن البحث الأكاديمي الحقيقي والجدّي يبدأ بعد أن يحصل الإنسان على شهادة جامعية تخوّله أن يعدّ نفسه باحثًا. قبل ذلك، يكون الإنسان طالبًا. إلى حدّ الآن أنا باحث طالب، لا أعدّ نفسي مفكرًا خارقًا للعادة، لكنني أبحث عمّا يرضيني ويرضي ضميري الإنساني في أعمالي.
وهذا ما وجدته مع زملائي الألمان عمومًا، سواء في النمسا أو في سويسرا أو في ألمانيا؛ كان هناك كرم من جانبهم، والجميل الذي وجدته فيهم هو أنهم عندما يدركون أنّ الإنسان يطلب العلم يشجعونه ويحثّونه على ذلك. وهذا ما عشته معهم على المستوى الإنساني؛ لأن الترجمة فعل تواصل، ولأن اللغة لا تبوح بأسرارها دائمًا، فكان لزامًا عليّ أن أتواصل معهم إنسانيًّا، كأشخاص وأصدقاء. وبفعل تكرار التواصل معهم أصبحوا يعدّونني قريبًا من أقاربهم. وهذا رأسمال لا أضيّعه، ليس فقط من أجل العلاقة الإنسانية مع الآخر، بل لأنه يسهل عليّ عملي ويمنحني الثقة في الترجمة الجادة؛ إذ لا أستحيي أن أطرق باب أحدهم أو أهاتفه لمناقشة تعبير أو جملة أو فقرة أو جزء من كتابه.
د. حسام الدين درويش:
بالنسبة إلى العلاقة الإنسانية، فأنت - ما شاء الله - محبوب الجماهير هنا، في المغرب، ومحبوب النخبة المفكّرة. لديك علاقات كثيرة وقوية مع مختلف الأقسام الأكاديمية والجامعية، في المغرب وأوروبا. وبهذا المعنى، أنت بالفعل جسر، لا مجرد مترجم؛ أنت جسر بين هذين الطرفين. وأنت نظّمت أحيانًا لقاءات، كما فعلتَ مع ياسين عدنان، ونظمت نشاطات فكرية في النمسا. فأنت بشخصك، بأفعالك وخطابك وفكرك، مارستَ هذا الدور؛ أي أن تكون جسرًا بين أطراف متعددة. لقد كنتَ جسرًا لي أيضًا، أو رفيقي وصديقي البديع في رحلة الربيع التي نقوم بها، وهناك خطط لرحلات قادمة. فكيف ترى أهمية هذا الدور، من حيث التشبيك الفكريّ والمهنيّ؟
د. حميد لشهب:
ما أحاوله فعله في هذا الإطار، هو انتشال المفكر من برجه العالي، ومن دوره كمنظّر، إلى دوره كفاعل في المجتمع الذي يعيش فيه. فإذا لم يكن هناك التقاء مباشر بين المفكرين والمفكرات، من الضفتين مثلاً، فإن الأمور تبقى أكاديمية صِرفة، تبقى نظرية إلى حدٍّ ما. وهذا لا يهمني، ما يهمني هو أن ينزل الفكر إلى الواقع، لا بالضرورة لتغيير الواقع، بل لتغيير ذهنيات وقلوب الآخرين.
أؤمن بالحبّ الإنساني، وأؤمن أنّ هناك حبًّا حقيقيًّا. لو تخلّينا عن أنانياتنا المختلفة، يمكن أن يكون ذلك مثاليًّا. لكنني أمارسه، وأحاول أن أفتح آفاقًا جديدة للمفكرين لكي لا يبقوا في أبراجهم العالية، ولكي لا تستمر العداوة لهذا الاتجاه أو ذاك. لذلك، في اختياري لمشروعي الترجمي اخترتُ اتجاهاتٍ أربعة مختلفة لأبيّن لأصدقائي ولعشيرتي في المغرب وفي العالم العربي، أنّ هناك إمكانيةً للانفتاح على الآخر، حتى لو كان مختلفًا عنّي. ما لا أحبّه ولا أُمارسه هو الاختلاف؛ يمكن أن أختلف مع شخص في أفكاري أو في سلوكي أو في معاملاتي، لكن أرفض الخلاف؛ أنسحب عندما يكون هناك خلاف بمعنى الخصام، أنسحب بروح رياضية كما نقول، أنسحب لكي تبقى الساحة الفكرية العربية حاضنةً لكلّ الأفكار. إلى حدّ الآن، ما نلاحظه في مجموع العالم العربي هو نوع من النزاعات، نوع من محاولة قيادة الساحة الفكرية أو الميدان الفكري والثقافي، حيث يعدّ كل واحد نفسه فارس العلم، كما نقول، الوحيد الذي يعرف، ول الآخرين جهلة. وهذا شيء لم أجده مثلًا في الثقافة الجرمانية؛ فهناك ثقافة اعتراف، لا يهمّ على أي موضوع يشتغل الإنسان، لكن فيه ثقافة اعتراف وتشجيع متبادل. هناك تنافس بالكاد، لكن ليست هناك حساسيات شخصية بين المفكرين، وانتقاد من أجل النقد، بهدف تبخيس الاجتهاد الفكري للآخر. وهذا الجسر الذي أريد أيضًا أن أبنيه في ميدان الثقافة العربية هو ثقافة الاعتراف، ثقافة الانتقال من ثقافة القبيلة، من توجه ثقافي أو فكري أو فلسفي معيّن، إلى رحابة الفكر، إلى رحابة الساحة الثقافية العربية، وهي ما شاء الله واسعة، وتتّسع لكل الأفكار ولكل الاتجاهات.
د. حسام الدين درويش:
إذا تابعنا مسألة العلاقة الإنسانية، فهي أيضًا محدّدة أو متضمّنة في علاقتك مع دور النشر. وقد كنا نتحدث، في رحلتنا البديعة، عن المشاريع المقبلة، وذكرتَ لي كتابًا مهمًّا جدًّا في مسألة وضع المرأة في العالم العربي أو في المغرب إلى آخره، وأشدتَ بالكتاب، وأنك كتبتَ عنه لكن لم تنشره إلى الآن. لماذا؟ قلتَ لي إنك إذا نشرته، فستكون هناك مطالبات بأن تترجمه، وأنك لا تستطيع أن تلتزم بترجمة شيء إلا إذا كنتُ قادرًا على الوفاء بهذا الالتزام. وأعرف أيضًا - برؤية العين وبالأخبار- أنّ هناك أكثر من دار نشر تتمنى أن تترجم لها. وهذا ليس فقط ثقةً في مهنيّتك، بل أيضًا بسبب العلاقة الطيّبة التي تجمعك بها. حدّثنا عن علاقتك المهنيّة والإنسانية بدور النشر والفاعلين فيها.
د. حميد لشهب:
أختار في ترجماتي مفكّرين أعرفهم وأتعامل معهم شخصيًّا، وأختار الناشر كذلك؛ لأن ترجماتي تعدّ من صُلبي، وأحاول اختيار الناشر الذي يحترم هذا البعد. فإذا لم تحدث علاقة حبّ إنسانية بيني وبين ناشر أو ناشرة، فلا أقدِّم كتابًا من أجل نشره. قد أنشر على حسابي، لكن عندما أعرف بما أسميه شخصيًّا حدسًا إنسانيًّا - وهذا أمر جدّ مهم عندي -، بأن هذا الناشر أو هذه الناشرة لا يهمّه الربح المادي في المقام الأول بقدر ما يهمّه فهم رسالتي في الترجمة، فإن علاقة الحب التي أكررها دائما غالبًا ما تقوم بيننا.
إذا اتصل شخص بي وأغراني بأن يعطيني ويعطيني، فأنا أعلم أنّ من يعطي هو الله، وأن البشر لا يعطون شيئًا. لكن إذا اهتم ناشر أو ناشرة بموضوع الكتاب في حدّ ذاته، وهناك شيء إضافي هو المعاملة الإنسانية بين الناشر أو الناشرة والمترجم أو المؤلف، فهذا أمر مهمّ جدًّا عندي. فالتواصل مع الناشر أو الناشرة، لا بدّ أن يكون على مستوى إنساني راقٍ، فيه حبّ واحترام، فيه تبادل، فيه نقاش، يمكن ألّا يكون المرء متفقًا على أشياء كثيرة، لكن في النقاش يمكن أن تتضح مسائل كثيرة. هذه العلاقة الإنسانية أمارسها حتى في علاقتي العادية مع الناس؛ فعندما أحبّ شخصًا، فإنني أحبه، ولا أكره أحدًا.
د. حسام الدين درويش:
أنا رأيت وأعرف علاقتك مع دور نشر أخرى، لكن سأتحدث الآن عن دار نشر "مؤمنون بلا حدود" تحديدًا؛ لأننا الآن في حضرتها، ولأنني أعرف البعد الإنساني في العلاقة مع هذه الدار، ليس فقط مع توجهاتها واحتضانها للاختلافات لتكون جسرًا بين الاختلافات والثقافات، لكن هناك أيضًا علاقة إنسانية مباشرة. وقد ذكرتَ أن البداية كانت من خلال تواصلك مع العزيز مهيار، وبعدها كان هناك تأكيد العلاقة الإيجابية أيضًا مع الدكتورة ميادة كيالي، التي كانت عاملًا من العوامل التي جعلتك مرتاحًا في هذه الدار ومستمرًّا معها. حدثنا أول شيء عن علاقتك بهاتين الشخصيتين، ومن ثم نتحدث عن علاقتك بمؤسسة "مؤمنون بلا حدود".
د. حميد لشهب:
أولًا: "مؤمنون بلا حدود" كنت أعرفها قبل هذا، وهي مؤسسة نشيطة في المغرب، وكنت أعرف أصدقاء كثيرين نشروا فيها، لكن ما كان حاسمًا بالنسبة لي في "مؤمنون بلا حدود" هو الجودة. وعندما أقول "جودة" لا أعني جودة الكتاب فقط، بل هي جودة متميزة جدًّا في العالم العربي بأسره، وهذا ليس انحيازًا. أعني الجودة في الإخراج، الجودة في مصادر النص، في تصحيح النص، في التدقيق اللغوي للنص، وهذه جودة عالية. لكن الجودة الأخرى هي جودة الشهرة. ماذا أعني بالشهرة؟ ليس بالمعنى الدعائي؛ أي "الماركوتينغ"، بل بجديّة الناس الساهرين عليها. ومن بين هؤلاء، وعلى رأسهم، الذي أقنعني بالتعامل مع "مؤمنون بلا حدود" الأخ مهيار.
مهيار تواصل معي بطريقة غريبة، وسحرني. نحن معروفون بأننا نسحر العالم، لكن مهيار سحرني؛ في نبرة صوته التي تحدث بها معي أول مرة، عرفت أنه تجاوز الإنسان التجاري، وتجاوز الإنسان الذي يريد استقطاب مفكرين للدار، ووصل إلى مرحلة، حتى أظن في حياته، لا يرى فيها إلا الخير للآخرين. ونزعة الخير أو الخيرية في هذا الإنسان الضعيف الذي أمامي هي التي جعلتني أقول له بعد ساعة من المكالمة، على ما أعتقد: "سأرجع إلى الكتاب، أقرأه، إذا جذبني سأرجع إليك، وإذا لم يجذبني فلا تحاسبني". دائمًا هذا هو المعيار؛ ولأن اسمه مهيار، فهذا هو المعيار. بعد ذلك، قرأت شتيفان فايدنر ثلاث مرات في ظرف أقل من شهر، واتصلت بالأخ مهيار، وقلت له: الكتاب يهمني؛ لأنه يمشي في التصور نفسه الذي أشتغل عليه. ومن خلاله اكتشفت، بطبيعة الحال، فايدنر نفسه، وكان بالنسبة لي رهانًا؛ لأنني أعرف أن فايدنر يجيد العربية، وكان ذلك رهانًا بالنسبة لي لأخوض نوعًا جديدًا من المغامرة في الترجمة؛ لأنني كنت أعرف أنه سيقرأ ترجمتي لكتابه، وستكون له ملاحظات، إلى غير ذلك.
بعدها، ومن خلال ترجمتي الأولى في "مؤمنون بلا حدود"، تعرفت على النجم الساطع في الدار، الأستاذة الدكتورة ميادة، التي أقنعتني بنوع من الفيض، فيض الحبّ للآخر، ورفضها للتطرف من كل جوانبه، وفتحها الباب لكل من يريد أن يسهم، من اليمين أو من اليسار، أي محاولة، في الطريق نفسه الذي أشقه: محاولة جمع الشمل للمضي قدمًا إلى مستوى آخر في ثقافتنا العربية. لنختلف، لكن لابد أن ننهي ثقافة الخلاف. وهذا ما جعلني أثابر، وأحاول أن أقترح ترجمات مفيدة لساحتنا الثقافية. وبطبيعة الحال، ولكي لا أطيل، اكتشافي للعبد الضعيف الذي أمامي، واكتشافي أننا نتقاسم الهمّ نفسه في الهجرة، جعلني أحبّك. أحبّك بمرارة. أحبّك كإنسان. اكتشفت فيك، عندما كانت بيننا مكالمات، أنك، تبارك الله، كما تقولون في المشرق، مؤسسة، فيك مؤسسات مختلفة: مؤسسة تواصل، مؤسسة فكرية ما شاء الله، يمكن أن تحاضر بثلاث أو أربع جمل تحضّرها في خمس دقائق قبل اللقاء. وهذه كفاءة عالية لا يمكن أن يتمتع بها إلا إنسان يقرأ كثيرًا، يناقش كثيرًا، يتواصل كثيرًا. وبطبيعة الحال، ما اكتشفته معك هو حبّك للآخر.
د. حسام الدين درويش:
لك مني جزيل الشكر. ولنقل لحسن الحظ إن الحب ليس من طرف واحد. عندما تتحدث أنت ومهيار تتبادلان مشاعر الود التقدير والاحترام. ومع الدكتورة ميادة أيضًا. لم يتوقف الأمر إذن عند كتاب "ما وراء الغرب" ولا عند كتاب "التقنية والديمقراطية: حوار الثقافات"، بل هناك كتاب على وشك الصدور. حدثنا عن سير التعاون مع "مؤمنون بلا حدود" بخصوص الترجمات.
د. حميد لشهب:
المشروع الذي أشتغل عليه، والذي اقترحته، وهذا جميل أيضًا في "مؤمنون بلا حدود" والثقة المتبادلة بيننا، -لا أريد أن تُقترح عليّ ترجمات، بل أختارها بنفسي- هو ترجمة كتاب أو كتابين لـ "سايفررت"؛ لأنني أعرف أهمية هذا المشروع. إنه تقريبًا تكميل لمشروعه الفكري أو الفلسفي حول براهين وجود الله أو الدفاع عن براهين وجود الله. الكتاب الذي تحت المراجعة، هو حول الاعتراضات على براهين عدم وجود الله. سايفرت فيلسوف مسيحي، ولا ينظر إلى المادية وإلى الداروينية وكل الاتجاهات الوضعية بمنظار آخر، من غير أنها ساهمت في هدم روحانيات الغرب. الكتاب الثاني الذي سيتبعه، أنا بصدد ترجمته، هو حول ما سماه هو "وداعًا باي باي داروين". في الحقيقة، سبق هذا الكتاب الاعتراضات. عندما قرأت؛ أي عندما أنهيت ترجمة الاعتراضات، اكتشفت أنه ترك جانبًا الكتاب الذي تسبب في الاعتراضات، وقلت له: لماذا لم تقترح عليّ هذا الكتاب؟ فقال لي: لأنك قرأته وتعرفه، لكنك لم تهتم به. قلت: لا، نسيت أنني قرأت الكتاب.
على فكرة، المفكرة الألمانية التي تحدثت عنها، والتي كتبت كتابًا بالألمانية، أترجمه الآن بسرعة، هو كتاب عن النسوية العربية، وليس الجندرية العربية. النسوية العربية تتناول موضوع النساء وحقوقهن وتعرضهن للاضطهاد إلى غير ذلك في العالم العربي. وقد عنونته بعنوان جريء: "لسنا كما تعتقدون". قامت بدراسة ميدانية لوضع المرأة في الأردن، ومصر، والمغرب، وتونس إلخ. ومن طبيعة الحال، الكتاب موجه أساسًا إلى القارئ والقارئة الغربيين، وبالخصوص الناطقين بالألمانية. إنه محاولة منها لتغيير النظرة النمطية التي لدى الغربيين عن المرأة العربية. فحتى وإن لم تحاول القول إن أوضاع المرأة العربية مثالية، لكنها تحاول أن تظهر للغرب أن المرأة العربية تناضل من أجل حقوقها وتفرض وجودها، سواء في الجامعات أو في الوظائف العليا، أو حتى على السلم الاجتماعي الأدنى. تحاول بكل طاقتها أن تخرج من المستنقع الأبيسي الذي حصرها فيه الثقافة العربية بصفة عامة. هذا الأمر بالنسبة لي جد مهم، ليس فقط لأنني أعرف شخصية الكاتبة، لكن لأن الموضوع مهم جدًّا وفيه تجديد لمحاولة إعطاء المرأة حقها في الدفاع عن نفسها وعن حقوقها. أعلم أن المرأة لا تنتظر أن يعطيها الرجل (إن شئنا الذكر، لقلة الرجال في الحقيقة) حقوقها. إنها تقاوم وتحققها بنفسها. والرسالة التي تريد كلاوديا ميندي إيصالها في هذا الكتاب تتمثل في الدفاع عن الأطروحة الأساس في الكتاب: إن الصورة التي لدى الغرب عن المرأة العربية غير دقيقة. هناك نساء مناضلات، يحاولن تحسين أوضاعهن، ليس بالضرورة على النمط الغربي، ولكن ندرك أن هناك مقاومة لتفكير قديم في ثقافتنا، وأن المرأة هي التي تدافع عن حقوقها، ولا تنتظر لا إذن ولا مباركة أو بركة الذكر.
د. حسام الدين درويش:
يمكن لمسائل النسوية، والنسوية الإسلامية، وأوضاع المرأة، أن تكون من بين المواضيع التي يحصل فيها التعاون بينك وبيننا، في مؤمنون بلا حدود، وبين أطراف كثيرة أخرى، لتنظيم بعض الفعاليات ونشر بعض النصوص المؤلفة والمترجمة. بما أنك تحدثت عن ثقافة الاعتراف، اسمح لي أن أمارسها معك: نحن – في مؤمنون بلا حدود – ممتنون وشاكرون لك جدًّا هذه الروح الطيبة، في تعاملك الودود والمحترم دائمًا مع الآخرين، ونقدّر عاليًا هذه الفلسفة الأخلاقية والرؤية المعرفية لمسألة الترجمة. الترجمة ليست مجرد مهنة أو ارتزاق بالمعنى السلبي للكلمة، ليست مجرد عمل أو حضور فقط، وإنما هي رسالة، رسالة أخلاقية تمارسها. فشكرًا جزيلًا لك، أيها المترجم القدير والصديق العزيز.
د. حميد لشهب:
شكرًا لك كذلك، وأتمنى من كل القلب أن تتكرر رحلة الربيع إلى بلاد البديع.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا، وإلى ندوة قادمة. أطيب التحيات.