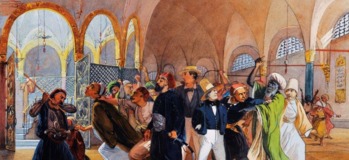مفهوم الإسلاميات التطبيقية عند محمد أركون
فئة : أبحاث محكمة
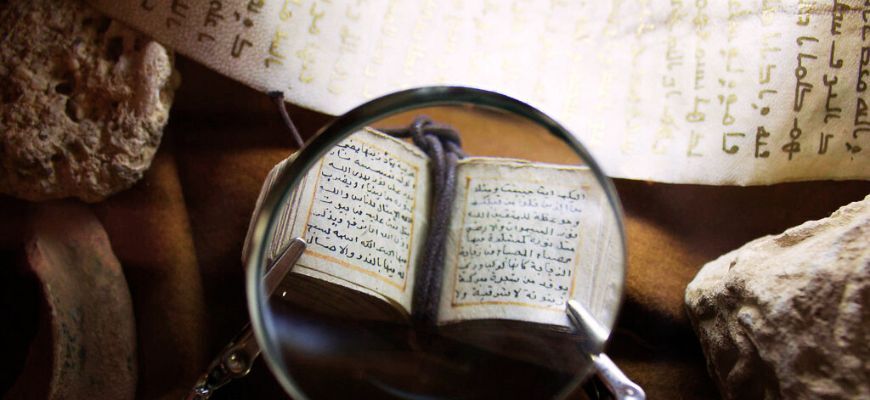
مفهوم الإسلاميات التطبيقية عند محمد أركون
ملخص:
يتناول هذا البحث مفهوم "الإسلاميات التطبيقية" عند محمد أركون، بوصفه محاولة لتجديد الفكر العربي الإسلامي، وهدفه تجاوز حالة الفقر المنهجي والمعرفي التي طبعت خطاب الإسلاميات الكلاسيكية لفترة طويلة؛ وذلك من خلال إرساء استراتيجية معرفية متعددة الأبعاد للتعامل مع التراث، ترمي إلى تصحيح وضعية موروثة عن الإسلاميات الكلاسيكية، المنغلقة داخل دائرة مؤطّرة ومسيَّجة.
ويرتبط تأسيس محمد أركون لمبحث الإسلاميات التطبيقية بنقد للمعرفة التي أنتجها المستشرقون عن الإسلام، سواء في بعده العقائدي، أو الديني، أو الثقافي-التاريخي. ويهدف من خلال ذلك إلى بناء مقاربة موضوعية للتراث العربي الإسلامي. فالإسلاميات هنا "تطبيقية"؛ لأنها تتضمن دعوة صريحة من أركون إلى تجاوز الخطاب الاستشراقي الضيق، والاهتمام بالنصوص مع دراسة الواقع، بدل الاكتفاء بدراسة إسلام فوق-تاريخي موجود فقط في الكتابات الرسمية، وليس في الحياة اليومية للمسلمين.
مدخل إشكالي:
لا يَستقيم الحديث عن مظاهر التجديد في فكر البَحاثة المُقتدر محمد أركون دونما احتفالٍ بالثورة المنهجية والمعرفية التي رام إحداثها في ميدان الدراسات الإسلامية، من خلال التنظير لِمبحثه الحديث العهد "الإسلاميات التطبيقية"، الذي أبصر النور في ستينيات القرن المنصرم، كمبحث معرفي تتقاطع فيه عدة تخصصات ورؤى تنويرية بالأساس. وهو مشروع يتغذى على التراث من جهة، ناهلاً من جهة ثانية من منابع الحداثة وما جادت به من مناهج ورؤى حديثة.
سَنسعى إذن، في هذه الورقة إلى الوقوف عند مفهوم الإسلاميات التطبيقية لدى محمد أركون، التي، حاول من خلالها كما أشرنا سابقا، تجاوز حالة الانسداد المنهجي والمعرفي الذي طبع خطاب الإسلاميات الكلاسيكية لمدة طويلة، من خلال إرساء استراتيجية معرفية متعددة الأبعاد والرهانات للتعامل مع التراث، تروم تصحيح وضعية موروثة عن الإسلاميات الكلاسيكية المنغلقة داخل دائرة مؤطرة ومُسيجة.
لعل هذا الفقر المنهجي ليس بالشيء الغريب عن الإسلاميات الكلاسيكية، بما هي كما عرفها محمد أركون ظلت خطاباً غربياً برّانياً عن الإسلام؛ بمعنى أن المستشرق، نقول هذا الكلام على سبيل الذكر لا الحصر، وبما أنه برّاني عن التراث الذي يدرسه، فهو لا يشعر بنوع من التفاعل ولا الانخراط في القضايا والإشكالات التي يثيرها التراث الإسلامي، ومن ثم فهو لا يكلف نفسه إعادة توظيف المناهج المعاصرة لقراءة التراث العربي الإسلامي تماماً كما يفعل مع تراثه، وإنما يكتب بطريقة محايدة وباردة تريح المسلمين وفي نفس الوقت تبعد عنه تهمة القدح في تراثهم. يقول محمد أركون في هذا السياق: «يمكن الاستنتاج، بشكل تبسيطي، بأن الإسلاميات الكلاسيكية تحصر اهتمامها بدراسة الإسلام من خلال كتابات الفقهاء المتطلبة من قبل المؤمنين. يبدو هذا الاختيار للوهلة الأولى، مفروضاً من قبل هاجس الصحة والموضوعية. ذلك أن عالم الإسلاميات(l’islamologue) يعرف جيداً بأنه أجنبي عن موضوع دراسته، ولذا، ومن أجل أن يتجنب كل حكم تعسفي، فإنه سيكتفي بأن ينقل إلى إحدى اللغات الأجنبية محتوى كبريات النصوص الإسلامية الكلاسيكية...إن عالم الإسلاميات يتصرف كدليل بارد (كتيم) في متحف»[1].
سننطلق من فرضية مفادها أن الباعث وراء إرساء محمد أركون لمبحث الإسلاميات التطبيقية هو نقد المعرفة التي أنتجها المستشرقون عن الإسلام، عقيدةً ودينًا وتاريخًا ثقافيًا؛ وذلك بهدف بناء مقاربة "موضوعية" للتراث العربي الإسلامي. ومن ثَمّ، وُصفت هذه الإسلاميات بـ"التطبيقية" لأنها تنطوي على دعوة صريحة من الراحل محمد أركون إلى تجاوز الخطاب الاستشراقي الضيق، والانتقال إلى دراسة النصوص في ارتباطها بالواقع، بدل الاكتفاء بتصوّر إسلام "فوق-تاريخي" لا وجود له في الحياة اليومية للمسلمين، وإنما في الكتابات الرسمية فقط.
لتجاوز هذا الوضع المنهجي المأزوم، يعيد أركون قراءة الدين والتراث الإسلامي بمفاهيم الأنثروبولوجيا الدينية والثقافية وعلم الاجتماع، من باب حرصه الشديد على ضرورة إعادة الاعتبار للتجربة الدينية، سواء داخل المجتمعات العربية الإسلامية أو الغربية.
للإجابة عن هذه الفرضية، سننطلق من الأسئلة الإشكالية التالية:
ما هي طبيعة هذا المبحث المعنون "بالإسلاميات التطبيقية"؟ وما مهامه ورهاناته؟ ما الفرق بين الإسلاميات التطبيقية والإسلاميات الكلاسيكية؟ وكيف يمكننا القبض على معنى الإسلاميات التطبيقية والتمكن من ناصيتها؟ وهل استطاعت الإسلاميات التطبيقية فعلاً أن تحلّ إشكالية التراث العربي الإسلامي؟ بِمعنى آخر هل تمكنت من تعيين ورصد مواطن الخلل في التراث العربي الإسلامي؟ أين تكمن معالم هذا الإصلاح المنهجي؟ وهل تمكن محمد أركون من خلال توظيفه لمجالات واسعة من قبيل الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع وعلم الأديان المقارن من تجاوز الفقر المنهجي الذي يصفه به الإسلاميات الكلاسيكية؟ وهل النص التراثي نص مِطواع يستطيع تحمل كل ما جادت به علوم الإنسان والاجتماع من مناهج معاصرة أم أن توظيفها يظل سطحياً ولا يلامس العمق؟
في سياق بحثنا عن تحديد معالم هذا المبحث المعرفي الحديث في ثنايا المتن الأركوني وتجاويفه، وقفنا عند ملاحظة يتقاسمها جملة من الباحثين؛ نذكر منهم: محمد الفجاري مدارها أن أركون لم يُقدم تعريفًا نظريًّا للإسلاميات التطبيقية من حيث هي (ماهية)، إنما كان كلما وجد نفسه في حاجة إلى تعريفها، سعى إلى إبراز مهامها النقدية وتقديم بعض سماتها وخلفياتها الفلسفية[2]. وعلى الرغم من هذا مبدئيًّا يُمكن الإشارة إلى بعض أصول هذا المفهوم الذي استعاره أركون من الأنثروبولوجي الفرنسي روجيه باستيد، وعلى وجه التحديد من كتابه الأنثربولوجية التطبيقية Roger Bastide: L anthropologie appliquée ليضخ فيه حمولة جديدة؛ مثمتلة ــ في مقام أول ــ في شد نظر الدارسين العرب والغربيين إلى ضرورة دراسة الإنسان العربي المسلم في كافة أبعاده؛ أي ككائن طبيعي واجتماعي ولساني وسياسي وتاريخي ونفسي ومتخيل وعاطفي، وفي مقام ثانٍ: الاهتمام بالمجتمعات غير الحضارية بالمعنى الأنثروبولوجي لكلمة حضارية والابتعاد عن النظرة الازدرائية المُوجهة من طرف بعض الأوساط الغربية لهذه المجتمعات. وهذا ما يميز الأنثروبولوجيا كعلم سعى إلى دراسة كل المجتمعات، وبخاصة منها غير الصناعية للوقوف عند التعبيرات الثقافية لهذه المجتمعات، سواء كانت هذه الثقافة مكتوبة أو غير مكتوبة.
لعله من نافل القول إن الإسلاميات التطبيقية تتنزل من المشروع الأركوني منزلة القطب من الرحى، فكل المتن الأركوني جاء ليؤسس لهذا المبحث المعرفي الحديث العهد والمتعدد الاختصاصات، فلا يكاد يذكر اسم محمد أركون حتى يتبادر إلى الذهن مفهوم الإسلاميات التطبيقية؛ فقد حصل اقتران بين الرجل ومبحثه، وباتت الإسلاميات التطبيقية بهذا المعنى هي نواة المُحركة للمشروع الأركوني برمته.
يَرسم أركون لِمبحثه المعرفي خارطة طريق يضع فيها مجموعة من الرهانات التي تصبو الإسلاميات التطبيقية إلى تحقيقها:
في مقام أول، يتمثل أحد أول رهانات الإسلاميات التطبيقية في الخلخلة والكشف عن التوظيفات الأيديولوجية للرأسمال الرمزي للدين، التي أمست تعج بها الأوساط المعرفية والسياسية في العالم العربي، فقد صار الإسلام "يلعب دورًا من الطراز الأول في عملية إنجاز الأيديولوجيات الرسمية"[3]. نظرًا إلى هذا الوضع الصارخ بَات على الإسلاميات التطبيقية التدخل العاجل من أجل فهم علمي لِلرسالة القرآنية من جهة، والكشف عن مظاهر الاستغلال الأيديولوجي الذي أصبح يمارس باسم الدين من جهة أخرى، وبالتالي يمكننا القول إن ما نبّه أركون إلى هذا هو الأحداث السياسية المتصارعة نذكر من جملتها الثورة الإيرانية والثورات القومية، هذا بالإضافة إلى عامل آخر يتجلى في ظهور موجة الحركات الأصولية المتشددة بسبب "شيوع التفسير الحرفي للنص الديني وبتر الآيات عن سياقاتها وتحويل آثار المعنى إلى معنى حقيقي مطلق لا يطاله التغيير"[4]، والتي كان من نتائجها تفجيرات الحادي عشر من سبتمبر 2001م التفجيرات التي تحمل ـــ في نظر أركون ـــ أكثر من دلالة عن كيفية تحول الدين الإسلامي من عقيدة وعلاقة حميمية بين العبد وربه إلى أداة تستعمل لتعبئة الجماهير وشحذ الأنفس لأغراض أيديولوجية بعيدة كل البعد عن جوهر الرسالة القرآنية، وبهذا تكون مهمة الإسلاميات التطبيقية "رصد ظاهرة الإسلام السياسي ونقدها، وإبراز عوامل نشأتها"[5].
ثاني رهانات الإسلاميات التطبيقية، التمييز بين نظام معرفي قروسطوي ونظام معرفي حديث، والذي نبه أركون إلى هذا التمييز شيئان؛ الثورة المعرفية الجديدة في حقل العلوم الإنسانية التي هزت كيان العقل الإنساني، وكيف وُظِفت مكتسباتها خاصة في المسيحية وتمييزها لسمات النظام المعرفي القروسطوي الذي من سماته كما يحددها محمد أركون "الخلط بين الأسطوري والتاريخي ويعلن تفوق القيم الدينية والأخلاقية للمسلمين على غيرهم، وتأكيد تيوليوجي لتفوقية المؤمن على غير المؤمن والمسلم على غير المسلم وتقديس اللغة، ثم التركيز على قدسية المعنى المرسل من قبل الله ووحدانيته بالإضافة الى عقل أبدي يخلط التاريخي بغيره؛ لأنه مغروس في كلام الله ومجهز بأساس أنطولوجي يتجاوز كل تاريخية[6]". من هذا المنطلق، تتحدد مهمة الإسلاميات التطبيقية المتمثلة بالأساس في تعرية هذا الإبيستيمي الذي ما يزال يسيطر على تفكير المسلمين، وفي الوقت عينه تفسير سبل ومعضلات الانتفال من النظام المعرفي القروسطوي إلى الحديث.
ثالثها انصراف الإسلاميات إلى تقديم معرفة جديدة عن الإسلام، "معرفة كفعالية علمية داخلية للفكر الإسلامي...وكفعالية علمية متضامنة مع الفكر المعاصر كله[7]"، نحن أمام نوع جديد من المقاربات التي يتطلع أركون إليها، وهي مقاربة مزدوجة إن صَح التعبير فمن ناحية هي داخلية لِكون أركون يتطلع لمقاربة التراث الإسلامي مقاربة داخلية تصبو إلى الكشف عن البنيات التحتية الناظمة والمُشكلة للتراث الإسلامي في محطاته التأسيسية من خلال عمل تفكيكي للعقل الإسلامي المُتجسد في الكتابات التراثية التي تعبر بدورها عن النسق المُوجه لعمل العقل الإسلامي؛ وذلك بتجاوز التقليد التبجيلي والتمجيدي للتراث وتجاوز في الوقت نفسه النظرة العدائية للآخر، ومقاربة خارجية لِسعيها الإسهام في إنجاز أنثروبولوجيا دينية عن الدين الإسلامي لجعله ينتظم في نفس المسار الذي صارت عليه الدراسات الأنثروبولوجية التي أنجزت على نصوصٍ دينية كاليهودية والمسيحية، مُتوسلة مناهج كل من اللسانيات والسيميائيات، التاريخ المقارن، الهرمنوطيقة الدينية...
يرمي أركون إلى إعادة التفكير في ظاهرة الوحي بوصفها ظاهرة إنسانية ترتبط بالشرط الإنساني في جميع مجتمعات الكتاب كما يسميها أركون (اليهودية والمسيحية والإسلامية). لكي يبين «كيف أن الفكر التيولوجي المنبثق عن كل واحد من هذه الأديان قد اشتغل حتى الآن كنظام ثقافي رافض للآخرين»[8]؛ بمعنى أن الميكانيزمات التي يكرسها الوحي هي نفسها مشتركة بين الأديان التوحيدية الثلاثة، وهذا يفترض بالضرورة ــــ في نظره ــــ الانخراط في هذه الأنثروبولوجية الدينية الكونية بالإضافة إلى تشديده على أولوية الدراسة النقدية للإسلام التي «تتناول الإسلام في عوامله كافة؛ التاريخية والاجتماعية والسيكولوجية، وفي مشاكل العلاقة بين الروحي والزمني، من منظور إسلاميات متعددة الاختصاصات»[9].
رابعها، انصراف الإسلاميات إلى "دراسة اللامفكر فيه ضمن الفكر الإسلامي "وهي دراسة سيحاول أركون من خلالها تغطية مساحات في الفكر الإسلامي لم يُفكر فيها بعد، وإثارة قضايا وإشكالات كانت مِما يُتحاشى التفكير فيها سابقا»[10]، مُنطلقاً من مبدأ» أن كل تراث فكري مُشكل سابقا سوف يصطحبه بالضرورة لا مفكر فيه. ومستحيل التفكير فيه" واللامفكر فيه هو "كل موضوع أو مسألة حجب الاهتمام بها مواقع فكرية أو سياسية في المجال الإسلامي، من قبيل الاكتفاء بمعطيات المعرفة التقليدية، وترديدها بوصفها الممكن المعرفي الوحيد المتاح[11]؛ فاللا مفكر فيه بهذا هو ممكن من حيث المبدأ، لكن المانع وراءه هو عامل معرفي بالأساس، لِيتحول بفعل الزمن إلى مستحيل التفكير فيه، تمنع التفكير فيه إما السلطات السياسة أو الدينية، نأخذ مثالا ساطعا في تاريخ الثقافة الإسلامية، وهو قضية خلق القرآن التي أثارها المعتزلة في وقتها، وكيف تحولت بفعل الزمن من قضية ممكن التفكير فيها إلى قضية مستحيل التفكير فيها بفعل منع كل من الدولة والدين التفكير فيها، وهكذا «طمست أطروحة المعتزلة تحث ركام التاريخ وطبقاته السفلية، وبالتالي ينبغي أن نحفر عليها أركيولوجياً، وننبشها من تحت الأرض»[12]؛ فقد تحولت من مسألة كان آنذاك يُمكن التفكير فيها ومناقشتها بين المذاهب الإسلامية بكل حرية ومن دون أي شَائبة إلى مسألة الآن يستحيل التفكير فيها. كمثال ثانٍ يمكن أن نقف عند قضية ما تزال أرضًا بِكراً في نظر أركون، وهي "مشكلة وجود الله وكيفية تصور هذا الوجود عبر التاريخ...بمعنى أَنَّ كيفية تصور الله والعلاقة معه تختلف في العصور الوسطى عما هي عليه في العصور الحديثة"[13] فالله في تصور المسلمين موجود في كل مكان من الأمكنة العامة في المجتمع وكل العلاقات الإجتماعية: العلاقات الإقتصادية، السياسية، القانونية، الشيء الذي لا نجد له نظيرًا في المجتمعات الغربية الحديثة، حيث لم يعد ذلك التصور عن الله كما كان عليه في العصور الوسطى سائدا عندهم وطبعًا هذا ما لا يستطيع المسلمون المعاصرون أن يفهموه؛ لأنهم غير قادرين على مواجهة التساؤل الفلسفي المتعلق بوجود الله. إنهم غير قادرين على طرح مشكل الله أو وجود الله كإشكالية مطروحة على التساؤل"[14]، في نظر أركون ما لا ينتبه إليه المسلمون اليوم هو أن هذا الله الذي يتكلمون عنه وعن وجوده في كل مكان وزاوية من الحياة البشرية ليس الله في ذاته، إنما الصورة التي تكونت لديهم بوساطة الفقهاء وعلماء الكلام، إذن تصور الله يتم عبر وساطة يعتقد علماء الدين أو قل يتوهمون أنهم بإمكانهم من خلالها الإمساك بهذه الحقيقة المتعالية والفوق بشرية، ومن ثم فرضها على الجمهور والحال أن هذا غير ممكن؛ لأن "الله يتعذر على المنال، الله يتعالى عن كل شيء، ولا يحق لأحد أن يتحدث باسمه، ولا يمكن للبشر أن يتوصلوا إليه بشكل مباشر، وإنما يقدمون عنه تصورات مختلفة بحسب المجتمعات والعصور، ثم يتخيلون أن هذه الصورة هي الله ذاته».[15] من هذا المنطق، فالمسلم عندما يتحدث ساخرا من المجتمعات الغربية مُفتخراً في الوقت عينه بمسألة حضور الله في كل مكان في المجتمعات الإسلامية، في حين أن الله غائب في المجتمعات الغربية ومحشور داخل الكنيسة فقط، يُسقط أهم شرط، وهو شرط التاريخية، تاريخية التصورات التي تشكلت عن الله بوصفها إنتاجات بشرية مرتبطة بسياقات معينة أُنتجت داخلها.
في العلاقة بين الإسلاميات التطبيقية والإسلاميات الكلاسيكية
يُشكل نقد أركون للاستشراق واحدة من أبرز حلقات مسلسل المقاربة النقدية التي خاض فيها جمهرة من المفكرين العرب، اللائحة طويلة لهذا سنقف عند أنور عبد المالك وإدوارد سعيد لنرصد انصرافهما الطويل إلى مساءلة الاستشراق عن علاقة الصلة التي انتسجت بينه وبين الاستعمار، وبخاصة ما نجده عند إدوارد من اتهام للخطاب الاستشراقي بأنه خطاب استعماري، انبثق بالأساس لِيقدم السُخرة كلها للمشروع الكولينيالي الذي تشكل بعد الثورة الفرنسية بأربع سنوات، والحال أنه لايملك المرء هنا تجاهل حقيقية تاريخية تثمل بالأساس في اللحظات الأولية التي قَعدَت لعلم الاستشراق في بدايات القرن التاسع عشر كعلم ارتبط بالأساس بِتشكل مدرسة اللغات الشرقية الحية بفرنسا سنة 1795[16] تحت رئاسة شيخ المستشرقين الفرنسيين سيلفستر دي ساسي ANTOINE ISAAC SILVESTRE DE SACY(1758-1838)[17] فهذه الأخيرة أُنشئت بقرار من المجلس الثوري حتى يكون لنابوليون في غزوه للشرق معرفة واسعة بِلغات الشرق وثقافته وحضارته. وهذا أمر طبيعي، فقد كانت الدول الاستعمارية الأوروبية بحاجة إلى بوصلة تهتدي بها إلى الداخل الاجتماعي للبلدان المُستعمَرة، وبهذا فالقوى الاستعمارية كانت في أمس الحاجة إلى تكوين فرق على دراية بِلغات الشرق لمساعدتها على قراءة أرشيفات السلاطين وموارد الدولة، والإحاطة بالثقافة الدينية لهذه المجتمعات، إذن، ارتبط تأسيس الخطاب الاستشراقي في بداياته بغاية استعمارية، غير أنّ المؤكّد هو أنّه ليس جميع المستشرقين قد خدموا الاستعمار.
يتفق أركون جزئيًّا مع هذا الطرح موضحًا: "راح الهدف العملي للمعرفة "الاستشراقية يميل إلى الزوال بنهاية عهد الاستعمار»[18]، وإن كان هذا النقد في مرحلة ثانية من مساره الفكري بعد مرحلة أولى كان يفكر فيها من داخل المنهج الاستشراقي. لهذا، فمنهجه النقدي قام بالأساس على هدم المناهج الكلاسيكية التي لا تخرج عن اثنين من جهة هناك المنهج الاستشراقي والمنهج الإسلامي الكلاسيكي أو التقليدي، وقد تَمَيز نقد أركون لهاتين المنهجيتين بالتأكيد على حدودهما وضيق أفقهما وعدم قدرتهما على نقد العقل الإسلامي في كافة تجلياته، وهذا ما دفعه إلى رصد مواطن الخلل في مناهجهما ورؤيتهما، لكن ما يميز الرؤية الأركونية للمنهج الاستشراقي رصانتها العلمية وإلتزامها بالنقد المعرفي والعلمي الصارم البعيد عن ضوضاء السجلات الأيديولوجية، فقد ظل وفيا لمبدأ النقد العلمي وهذا ما حمله على اجتراح تسمية للخطاب الاستشراقي فأطلق عليه اسم الإسلاميات الكلاسيكية من باب مجاوزة وتخطي الحمولة الإيديولوجية التي تحتويها كلمة الاستشراق بِسبب سجلات المثقفين العرب مع المستشرقين، حيث أمست كلمة استشراق مليئة بالعداء والحساسية إلى حد اتهام الخطاب الاستشراقي بأنه ليس مجرد خطاب استعماري، وهذا أمر لا يخفي على لبيب، ويعلم أركون جيدا أن جزءًا من الاستشراق قَدًّم السُخرة للاستعمار، لكن ليس كله ومن أجل هذا يصبو إلى رفع الغموض واللبس عن هذا الخطاب، حتى لايبقى هذا الخلط عائقًا ذهنيًّا أمام استيعابنا لمكتسبات هذا الخطاب وفتوحاته المعرفية قصد إعادة استثمارها في قراءتنا لتراثنا العربي الإسلامي.
يقول أركون معرفًا الاستشراق: "هو خطاب غربي حول الإسلام يهدف الى تطبيق العقلانية على الإسلام"[19] نفهم من هذا الكلام أن الإسلاميات الكلاسيكية خطاب ينتسب حسب أركون للعقل الغربي في محاولةٍ منه لاكتشاف عالم الشرق الذي ظل الغرب مهووسًا به مند قرون وقرون قبل أن يضمحل نجم الحارة العربية الإسلامية، "وهذا يعني أن الإسلاميات الكلاسيكية في نظر أركون ترجع معرفيا إلى العقلانية الغربية وتسعى فكريا إلى غايات أوروبية "[20].
نستشف من هذا الكلام أيضا مدى تهافت الخطاب الاستشراقي على التحلي بالعقلانية والعلموية، وهوسه المُفرط بالعقلانية ليس بالغريب بمأنه سليل العقلانية العلموية التي سيطرت على الوعي الأوروبي طيلة القرن التاسع عشر، هذا التلازم الذي اندغم بين الفكر الوضعي والخطاب الاستشراقي ترتبت عنه جملة من العوائق المعرفية والمنهجية التي حَدَّت من مساهمة الاستشراق في إنتاج رصيد علمي رصين، وأهمها تهميشه لمفهوم المُتَخيل الديني في الثقافة العربية الإسلامية بسبب تأثره وتشبعه بفكر النزعة الوضعية التي تنظر إلى كل ماهو خيالي نظرة سلبية وتعتبره ينتمي إلى مرحلة ما قبل العقلانية، بالإضافة إلى هذا يعيب أركون على الخطاب الاستشراقي موقف الحياد البارد الذي طبع معظم عمل المستشرقين، وهذا ما يشدد عليه أركون، فيقول: "الإسلاميات الكلاسيكية تحصر اهتمامها بدراسة الإسلام من خلال كتابات الفقهاء المتطلبة من قبل المؤمنين [21] بمعنى أن الإسلاميات الكلاسيكية وتَحْث ذريعة التحلي بالموضوعية بحكم برانيتها عن الموضوع المدروس، فإنها كانت تكتفي بنقل ما دون من معارف في الكتب الفقهية الرسمية، وهذا ممكن في نظرنا؛ لأن المستشرق يعرف نفسه أنه لا ينتمي إلى هذه الجماعة الدينية التي يدرسها (المسلمين) وبالتالي فتراثُهَا ليس تراثُه ولكي يتجنب اتهامه بأنه يحْقِد على هذه الجماعة حِقْداً أو يَقدحُ فيها يلجأ إلى مُحاباتها؛ فيكتب عن الإسلام بشكل يريح المسلمين، ويرفع في الوقت عينه من قدر المستشرق في أعينهم، فيكون بهذا مُلزم بدراسة الإسلام فقط من خلال كتب الفقهاء بمن همه فقط نقل المعرفة العربية الإسلامية إلى القراء الغربيين. في نظر أركون الأمر ليس كما يبدوا عليه فوراء ادعاء الخطاب الاستشراقي الحياد دليل أوضح على محدوديته وتأزمه وعدم قدرته على سبر أغوار الثقافة العربية الإسلامية، وعجزه عن الإلمام بمختلف مكونات الإرث العربي الإسلامي، وهذا ينم على عدم مسايرة الخطاب الاستشراقي لروح الانقلابات المعرفية والمنهجية التي حدثت داخل الأوساط الأكاديمية والجامعية الغربية، ونخص هنا بالذكر الثورة المعرفية التي أحدثتها أعمال ميشيل فوكو وتمييزه الذي أصاب فيه كبيرَ نجاحٍ بين تاريخ الأفكار الوقائعي الذي يعتمد على الوصف الخطي للأحداث والوقائع، وتاريخ الإبيستيميات أو النظم المعرفية المكونة لثقافة ما، ولتشكلها في حقبة تاريخية معينة أي "منظومة المبادئ النظرية التي تنبني عليها تقافة ما في زمن معين، وتكون موحدة لكل الممارسات الخطابية مهما اختلفت، ولهذا ما كان لِإغفال الخطاب الاستشراقي لِهذه الَرجّة المعرفية إلا أن أغفل معها الخيط الناظم للفكر، لما كان هذا الأخير يتولى في جوهر موضوعه البحث عن الأصول النظرية التي يرجع لها فكر ما بكل أبعاده وتفرعاته العلمية على امتداد عهد زمني معين؛ لأننا عندئذ نصطدم بالخط الأحمر للتساؤل؛ أي بالخط الذي يستحيل تخطيه أو تجاوزه، بالمستحيل التفكير فيه"[22].
بعد هذا يضع أركون يده على وجهٍ آخر من وجوه الخلل التي تعتور المنهج الاستشراقي يتعلق الأمر هذه المرة بِتجاهل الإسلاميات الكلاسيكية لما يسميه أركون "المعيش" في الثقافات العربية الإسلامية واعتمادها وتركيزها فقط على المكتوب من هذه الثقافة، ولعل الباعث وراء هذا الإقصاء للمجتمعات الشفهية والثقافة الشعبية هو النظرة العقلانية ـــ كما سبق الذكرـــ الحاكمة للتقليد الاستشراقي فتحمله على استبعاد الأسطورة والخيال تحث سَطوة العقل، ولقاء هذه النظرة فقد أهملت الإسلاميات "الممارسة المعيشية أو التعبير الشفهي للإسلام خصوصًا عند الشعوب التي لم تكن لها ثقافة مكتوبة مثل البربر والأفارقة، وبشكل عام الجماهير الشعبية، إهمال المعاش غير المكتوبة وغير المقال حتى عند هؤلاء الذين يستطيعون أن يكتبوا...إهمال المعاش غير المحكي"[23]، ما يقصده أركون بمفهوم الثقافة العالمة غير المكتوبة التي تندرج في جملة الثقافة الشفوية من ذلك هو ما نجده مثلا في خُطب الجمعة والدروس الدينية في المساجد كل هذه التعبيرات تدخل في إطار الثقافة العالمة، لكن الشفوية. سيكون علينا التأكيد هنا أنه إذا ما كان أركون قد انتقد هذا الإقصاء للثقافة غير المكتوبة، فإنما من باب الدفاع ورفض أي اختزال لهذه الفئات التي لم يكن لها اهتمام "لا عند مفكري الإسلام في العهد الكلاسيكي ولا عند الباحثين الغربيين، فهي تقع خارج أفق اهتمامهم، وإذ يقول أركون هذا فهو مقتنع تمام الاقتناع بأن الإسلام الجدير بالدراسة هو الإسلام المحكي في اللقاءات اليومية والاجتماعات والمؤتمرات والدروس المُلقاة في المساجد أكثر دلالة من إسلام مكتوب ولكنه غير معاش.إلى جانب هذا الإهمال يُعين أركون موطناً آخر من جملة المواطن التي طالها درب من الإهمال من قبل علماء الإسلاميات الكلاسيكية يتعلق الأمر هذه المرة "بإهمالها للكتابات المنظور إليها على أنها غير تمثيلية أي غير رسمية ونموذجية"[24].
إن نقد أركون موجه بالتحديد للمستشرقين الذين لا يهتمون إلا بكتابات الإسلام الأرثوذكسي؛ أي إسلام الأغلبية وهذا خاضع للمناطق المُتواجِد بها المستشرقون مثل شمال أفريقيا، حيث تهيمن النسخة السنية في الأعم الأغلب، بِحسبان المنظور الأركوني هم بهذا أهملوا الإسلام الشيعي الأكثر غنى عقائديا، فلم يُسلط عليه الضوء إلا بواسطة جهود حديثة. ولم يُهملوا هذا فقط، بل أهملوا "الأنظمة السميائية غير اللغوية التي تُشكل الحقل الديني أو المرتبطة به مثل الميتولوجيات والشعائر الدينية والموسيقى وتنظيم الزمكان وتنظيم المدن وفن العمارة وفن الرسم والديكور والأثاث والملابس وبنى القرابة والبنى الاجتماعية..."[25].
نستشف بناءً على ما سبق، اتهام أركون للخطاب الاستشراقي باختزاله الظاهرة المدروسة واكتفائه بالخطاب العقلاني الذي أنتجه العقل الفقهي والكلامي والفلسفي مما آل به إلى بلورة رؤية مثالية عن الفكر الإسلامي غير مُبالٍ فيها إلا بما تُضُمِّنَ في الكتب الرسمية، ولم يكلف الخطاب الاستشراقي نفسه عَناء البحث والخوض في القضايا الكبرى التي يَطرحها الإسلام كمنظومة دينية رمزية، وما يجعله يستمر في حالة ألامبالاة هذه كما يصفها أركون هو وقوعه تحث تأثير كلٍ من النزعة التاريخانية والنزعة المركزوية الأوروبية "ذلك أن ممارسيها بقوا متضامنين مع الرؤية التاريخانية والمركزوية الأوروبية"[26]. سيكون علينا قصد فهم هذا الموقف أن نقف ابتداءً عند مفهوم المركزوية الأوروبية التي يرى فيها أركون عائقًا في وجه التجديد المنهجي الاستشراقي، فهاهنا حقيقية ليس بِمُكْنٍ المرء تجاهلها، وهي أن الغربي حتى ولو تعاطف مع موضوع دراسته الذي هو الإسلام، وكان نزيهًا وموضوعيًّا ولم يكن في نفسه أي غرض آخر سوى الهَمُّ المعرفي، فإنه وبشكل غير موعى به ينطلق من إطار بيئته الثقافية؛ أي الأوروبية للنظر إلى الآخر، وهو لا يستطيع التحرر من هذه التأثيرات الثقافية التي تجعله يشعر بالاختلاف، فينطلق من معيار أن النموذج الأوروبي هو الأرقى سياسيًّا وثقافيًّا واقتصاديًّا، غير أنه لا يمكننا تعميم هذه القاعدة على كل المستشرقين فالأنصبة تختلف من مستشرق لآخر وحتى التسليم بوجودها يمكن أن نحدد فيه نوعين من النزعات: نزعة مركزوية مُنظر لها ومُفكر فيها، وهي الأخطر، ونزعة غير مُوعى بها تتسرب إلى ذِهن الدارس بشكل غير مُوعى به، لكن الأنصبة تختلف حسب كل عالم من علماء الإسلاميات. لهذا، فمنهم من يستثنيه أركون من هذه الدائرة ويحتفي بإسهامه، نقف على هذا أثناء حديث أركون عن إسهام البروفيسور الألماني جوزيف فان إيس من خلال كتابه الضخم في ستة أجزاء عن اللاهوت والمجتمع في العصور الأولى للإسلام؛ إذ يشدد أركون كل التشديد على هذا الكتاب مُعتبرًا إياه حدثاً مهمًّا في تاريخ الدراسات العربية الإسلامية؛ «لأنه أكثر من مهم. إنه حاسم بالنسبة للفكر الإسلامي. ولن يستطيع أن يتجاهله بعد اليوم أي باحثٍ يحترم نفسه.. ينبغي أن يعرف المثقفون العرب والمسلمون أن حدثاً فكرياً كبيراً قد حصل في ألمانيا ويخص تراثهم بالذات. وأنه لمن العار ألاّ يُترجم إلى اللغة العربية في أقصى سرعة ممكنة وبأفضل صيغة ممكنة»[27]. يَعلم أركون جيدًا حجم بعض الدراسات الاستشراقية الجادة من قبيل ما نجده لدى مُعلمين كبار من أمثال دوسلان، دوغوج، سنوك مرغرونج، بروكلمان، نولدكه، ماسينون، مارسيه، الذين استطاعوا أن يصحبوا نصوصًا ذات أهمية كبرى من نسيانٍ طويل وأوضحوا مجالات للبحث أساسيه[28]. إذا كان أركون يقول هذا الكلام، فمن باب الاحتفال المنصف بما حققه المستشرقون في ميدان العلم بعيداً عن السجلات الأيديولوجية، وهو إذ يقول ما قاله، فلأنه راسخ الإيمان بأن أول من نَبًه العرب والمسلمين إلى غنى ثقافتهم هم المستشرقون عندما أخرجوا آلاف الكنوز الفكرية من حُكم المجهول إلى حُكم المعلوم مثل بعض المخطوطات والمؤلفات التراثية التي كانت قد نُقلت إلى المكتبات الأوروبية أثناء فترة الاستعمار[29]، ليعاد نشرها بذلك مُحققة من طرف مُستشرقين كبار، يقول أركون في هذا المِضمار: «إننا لن نستطيع أن نقدر بما فيه الكفاية أهمية الباحث الذي يعطي الأولوية حتى الآن، لاستصلاح النصوص وإنجاز الطبعات النقدية والفهارس ومعاجم الألفاظ حتى الموجزة»[30]، لا يمكن أن ينسى المرء عملهم الجبار، حيث كان يتطلب المخطوط الواحد من صاحبه أزيد من عشر سنوات من العمل لتحقيق النص وفق المنهج الفيلولوجي حتى يصبح نصًّا مقروءًا قابل للقراءة بعد ان يتم تنقيطه ووضع معجم الألفاظ والأماكن والفهارس، إضافة إلى كون نصوص القدامى كانت خالية من التنقيط وتقسيم الجمل، بالإضافة إلى هذا كانت توجد فيها عشرات الصفحات الممسوحة بفعل الزمن. لهذا كان المخطوط يتطلب من صاحبه جهدًا مضاعفًا من أجل التأكد من صحة النص من خلال مضاهاة كل نص مع باقي النسخ التي يجدونها مشتتة في مختلف المكتبات الدولية، كل هذا لإنتاج نص سليم، نذكر من هذه النصوص التي ثم تحقيقها وأعيد نشرها، ما حققه ثم أعاد نشره المستشرق النمساوي(1774-1856) JOSEF VON Hammer-purgstall؛ تحقيقه ونشره لكتاب أطواق الذهب للزمخشري، HEINRICH Ferdinand WUESTENFELD(1808-1899) فستنفلد حقق ونشر معجم البلدان لياقوت الحموي وكتاب المعارف لابن قتيبة، "السيرة" لابن إسحاق برواية عبد الملك ابن هشام، أخبار مكة للأزرقي، طبقات الحفاظ لابن الذهبي، نشر ديوج فتوح البلدان للبلادي، وتاريخ الأمم والملوك للطبري في تسعة أجزاء، بالإضافة إلى كتاب الخراج لابن جعفر، كما ارتبط اسم المستشرق ماسينون بالحلاج، فقد حقق ونشر كتاب عذاب الحلاج في ثلاثة أجزاء دون أن ننسى العمل الذي قام به ديترصيFRIEDRICH [31]DiEtERICI(1821-1903) بنشره لديوان المتنبي مع الشرح الواحدي، كما نشر "آراء أهل المدينة الفاضلة" للفارابي، ونشر مُختارات من "رسائل إخوان الصفا"، دون أن نغفل كذلك العمل الضخم لنولدكه في كتابه "تاريخ القرآن" الذي عُدَّ من أعظم الكتب التي كُتبت عن القرآن؛ ففيه فهم حقيقي للخطاب القرآني واهتمام مُوسع بِتاريخ تحول القرآن من خطاب شفهي إلى خطاب مدون، ونجاح كبير في الإلمام بتاريخية بعض العبارات القرآنية بالنظر إلى غياب معجم لفظي شامل للغة العربية القديمة؛ فالرجل كان ضليعًا في جميع لغات الشرق واللغات السامية على وجه التحديد من فارسية عبرية وسريالية كلدانية ولاتينية...، بالإضافة إلى مئات الكتب التي لم تكن تحث تصرف المسلمين كما عليه الحال اليوم إلا بفضل جهود المستشرقين، فكان المرء لا يعرف عنها سوى الاسم، إلى أن أعيد نشرها بعدما ثم تحقيقها من طرف المستشرقين.
روافد الإسلاميات التطبيقية:
لعل ما حمل أركون على الخوض في مشروعه النقدي، الذي يَسِمُه "نقد العقل الإسلامي، إنما تسلحه بِعُدَّة منهجية متنوعة ورفيعة في الوقت عينه خولت له الاستمرار في فتوحاته المعرفية، لِبناء صرح أفكاره وتشييد بنيان عمرانه الفكري؛ فإعادة قراءة التراث الإسلامي بتوسل أحدث المناهج وأجد الرؤى تتخذ بالنسبة إليه ضرورة قصوى ومستعجلة؛ لأنها وحدها تُمكننا من رصد مكامن الخلل التي تعوق التحاق العرب بقطار الحداثة والتاريخ، لكن تحقق هذه المهمة مشروط بامتشاق المنهج النقدي، لهذا تجده يقول بهذا الخصوص» المهمة العاجلة تتمثل في ما يلي: إعادة قراءة كل التراث الإسلامي على ضوء أحدث المناهج اللغوية، والتاريخانية، والسوسيولوجية، والأنتروبولوجية... ثم القيام بعدئذ بتقييمٍ فلسفي شامل لهذا التراث»[32]. فما عاد ممكنًا اليوم التفكير خارج مناهج علوم الإنسان التي صارت المصدر الأولى التي تتغذى عليها كل الدراسات الإنسانية والاجتماعية، فكل بحثٍ لايستقيم أمره إلّا متى كان ناهلاً من مناهج العلوم الإنسانية المعاصرة، والنص الأركوني لم يَحِد عن هذه القاعدة. إنه نص يتغذى على معارف ومناهج العلوم الإنسانية الحديثة والمعاصرة. وفيما يلي عرض للتوظيفات الأركونية لبعض من هذه المناهج:
المنهج الألسني: تذكر هذه المنهجية بالمشروطية اللغوية للنص، بما في ذلك نص الوحي، فهو مكتوب بلغة بشرية معينة، وخاضع لإكراهاتها النحوية والصرفية واللفظية والبلاغية.[33] لهذا تتعين علينا إعادة قراءته على ضوء هذا المنهج الألسني، وهو إذ يعيد قراءة النص القرآني ينطلق من عدة مستويات، منها مستوى التحليل اللغوي النحوي المتعلق بصائغي الخطاب والضمائر...، أو على مستوى تركيبته المجازية وبنيته السيميائية.
المنهج التاريخي: يُسعفنا هذا المنهج حسب أركون في تكوين صورة تاريخية عن مرحلة الإسلام الأولى أثناء تشكل المصحف ودولة المدينة الأولى والخلافة. كما يدعونا إلى دراسة سيرة النبي وشخصيات الصحابة الأساسيين على ضوء علم التاريخ الحديث؛ وذلك لفرز العناصر التاريخية فيها عن العناصر التبجيلية التضخيمية [34]، فوحدها القراءة التاريخية بهذا المعنى تُجيز لنا الخروج من النظرة اللاتاريخية الأسطورية واللاعقلانية للتراث، باتجاه نظرة تعقليه علمية نقدية، تتخذ مسافة نقدية من كل الوقائع التي حدثت في خضم التجربة التأسيسية مع النبي والصحابة نظرًا إلى ما دُسَّ آنذاك خاصة في كتب السيرة من أحاديث مَوضُوعة غَارقة في الخرافات التي لا يقبلها العقل. بالإضافة إلى هذا، نجد الخطاب الأركوني ينهل كذلك من علم تاريخ الأديان، عندما يتحدث مُستعمل مصطلح الأرثوذكسية طبعا هو لا يعني به الاتجاه الصحيح والمستقيم بالمعنى المسيحي دائماً، بل يعني به الآلية الفكرية الصلبة والمنغلقة على ذاتها أو المخطِئة والمُكفرة للآخرين. وقد وسعه أركون ليشمل كل المجالات المعرفة المنغلقة والمتمركزة حول ذاتها، والأمر عينه يسري على مفهوم "الدوغمائية" أو "السياج الدوغمائي" ويقصد به أركون مجمل العقائد الدينية والتصورات والمسلمات والموضوعات التي تتيح لنظام من العقائد واللا عقائد أن يشتغل بعيدا عن كل تدخل نقدي، سواء من الداخل أو من الخارج. فالمؤمنون المنغلقون داخل السياج الدوغمائي يتبعون استراتيجية معينة هي استراتيجية الرفض أي رفض كل ما لا ينسجم مع العقائد التي يحتوي عليها السياج الدوغمائي المغلق؛ لأن الشخص داخل هذا السياج يشعر بطمأنينة ومتعة كبيرة، حيث يردد نفس العقائد ونفس الحكايات والأساطير والقصص التبجيلية أو المعجزات الخارقة للعادة، وهذا الاطمئنان يتحول إلى عصبية؛ لأن صاحبه يصبح مستعدا للتضحية بنفسه من أجل هذه العقيدة المنغلقة على ذاتها.
المنهج السوسيولوجي والأنثروبولوجي: الهدف وراء توسله للمنهج السوسيولوجي يكمن بالأساس في تقويض الفكرة الشائعة لَدَى السواد الأعظم من المسلمين، حيث يعتقدون بِتعالي الإسلام عن الأمور الدنيوية التاريخية والمُتحولة، فينظرون إليه بصفته يؤثر على كل شئ ولا يتأثر، والحال أنه العكس فالإسلام كباقي الظواهر يؤثر على الناس ويتأثر ويكفي أن ننظر مثلاً إلى إسلام المسلمين الذين يقطنون في البوادي ومُقارنته بِإسلام المسلمين القاطنين في المدن. غير هذا نجد النص الأركوني نص ثري يستلهم عدة مصطلحات من علماء سوسيولوجيين كبار من قبيل ما نجده عند استعارته لمفهوم "رأس المال الرمزي" ويقصد به أن كل ثقافة تتأسس، إنما تبدأ بوضع رأسمال معين من الرموز التي تشكل بنيتها العامة اللغوية والدينية والاجتماعية والنفسية.. وهذا ما فعله الإسلام مثلا تجاه الجاهلية وهذا ما فعلته الثقافة الوضعية الحديثة تجاه الثقافة اللاهوتية[35]. هذا في ما يخص المنهج السوسيولوجي. أما الباعث وراء توظيفه للمنهج الأنثروبولوجي، فيكمن في رغبته في مقاربته للظاهرة الدينية كظاهرة تعيد إنتاج نفسها على نفس المنوال في كافة المجتمعات؛ بمعنى آخر اعتبار الظاهرة الدينية جزءًا من التاريخ البشري وليست عقيدة روحية نجدها في مجتمع ما ودين ما فقط، بل تشمل كل الإنسانية، بالإضافة إلى هذا ينبهنا أركون إلى الدور الكبير الذي لعبته التحريات الإتنوغرافية والأنثروبولوجية في تسليط الضوء على الأصوات المهزومة في التراث الإسلامي؛ منطلقا من فرضية أن التاريخ الرسمي يكتبه الظافرون والمنتصرون، وأما أصوات المهزومين فتضيع أصداؤها في ليل التاريخ العميق، فبفضل تحريات المنهج الأنثروبولوجي يمكن إثارة كل المسائل التي يتحاشاها المؤرخون الرسميون وطمسوها أو حذفوها أو شوهوها، فصوت الفئات المنبوذة والمهزومة في التراث الإسلامي لن يتيسر سماعها إلا بتوسل المنهج الأنثروبولوجي. دون أن يفوتنا الوقوف عند أهم وأقوى المفاهيم التي استلهمها من حقل الأنثروبولوجيا، وحاول استنباتها في حقل الدراسات الإسلامية المعاصرة للتراث، ويتعلق الأمر بمفهوم "المتخيل الديني" في الثقافة العربية الإسلامية، بوصفه غير مفكر فيه في البيئات العلمية ومرفوض؛ لأنه يعبر عن الوهم والخرافة والانحراف، لكن هذا المفهوم تطور استعماله وبات يتغذى بدوره من الخطابات الإيديولوجية السائدة، فهو منتوج من صنع الفئات الاجتماعية المتنافسة من أجل الهيمنة على الرأسمال الرمزي، بهذا بات مفهوماً حيويًا يستدعي استدراجه عند دراسة المجتمعات الإسلامية.
في الختام، لا يفوتنا من باب الاعتراف القول إن أركون حاز في نقده للخطاب الاستشراقي على صرامة علمية ومعرفية لم يحد عنها؛ فالرجل ظل بعيدًا عن السجلات الأيديولوجية التي تروج لجملة من النعوت والاتهامات باتجاه الخطاب الاستشراقي، والتي لا محل لها من العلمية في نظر محمد أركون. لهذا تراه يوجه دعوة إلى مجاوزة مثل هذه الممارسات «ينبغي أن تَنتهي مرحلة النقد الأيديولوجي الموجه ضد التنقيب والبحث الاستشراقي...إننا لن نستطيع أن نقدر بما فيه الكفاية أهمية الباحث الذي يعطي الأولوية حتى الآن لاستصلاح النصوص وإنجاز الطبعات النقدية والفهارس ومعاجم الألفاظ حتى الموجزة، إن الإسلاميات التطبيقية لن تتمكن ـــ كما سنرى بعد قليل ـــ من أن تتصدى لمهامها العديدة، بغياب أدوات العمل التي لا يمكن انجازها إلا من قبل فرق بحث عالم».
نحن أمام مقاربة أركونية يمكن وصفها بأنها مزدوجة: من جهة يُثمن عمل المستشرقين، فلا يُهمل الإسهامات المهمة لهذا الخطاب، إلا أنه من جهة ثانية يحدد مواطن النقص فيه، فهو إذن بِقدر ما يثمن عملهم بقدر ما يَشْتد عليهم ويعدّ عملهم غير كافٍ، ويتعين تكملته أو تعميقه باستدخال واستدراج كل ما جادت به علوم الإنسان والمجتمع من معارف ومناهج في الآونة الأخيرة. عمليًّا يمكن النظر إلى هذا النقد الأركوني للعمل الاستشراقي في جوهره كدعوة له لتجديد عُدته المعرفية والمنهجية؛ ذلك أن النقد الأركوني يتخذ شكل مقترحات لتحسين قيمة المعرفة الاستشراقية على النحو الذي تصبح فيه علمًا مُزودًا بِالعدة المنهجية الكافية لكي تُضاهي المجالات المعرفية الأخرى المزدهرة في البيئات الأكاديمية الغربية.
قائمة المراجع
أركون، محمد، (1996) تاريخية الفكر العربي الإسلامي ترجمة هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، بيروت، الطبعة الثانية، ص55
أركون، محمد، قراءات في القرآن، ترجمة: هاشم صالح، الدار البيضاء، دار الساقي، الطبعة الأولى 2017
أركون، محمد، القرآن من التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ترجمة: هاشم صالح، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الثانية 2005، بيروت.
أركون، محمد، الفكر الإسلامي نقد واجتهاد، ترجمة: هاشم صالح، بيروت دار الساقي، الطبعة السادسة 2012
الفجاري، المختار، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، بيروت، دار الطليعة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى 2005.
عبد الإله بلقزيز، نقد التراث، مركز دراسات الوحدة العربية، ط الثانية: بيروت، فبراير 2016
نصر حامد، أبو زيد، الخطاب والتأويل، المركز الثقافي العربي، ط الرابعة، الدار البيضاء.
مجموعة من المؤلفين، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري: ندوة فكرية، منتدى المعارف، الطبعة الأولى، بيروت 2011
[1] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، مركز الإنماء القومي، الطبعة الثانية 1996، بيروت، ص52
[2] محمد الفجاري، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، ص42
[3] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص55
[4] ندوة الفكرية، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، ص 31
[5] المرجع نفسه، ص 30.
[6] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص55
[7] المصدر نفسه، ص 56
[8] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 57
[9] عبد الإله بلقزيز، نقد التراث، ص 373
[10] المرجع نفسه، ص 379
[11] المرجع نفسه، ص 379
[12] محمد، أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص278
[13] المصدر نفسه، ص 274
[14] المصدر نفسه، ص 274
[15] المصدر نفسه، ص 277
[16] عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، ص335
[17] المرجع نفسه، ص334
[18] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص54
[19] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص51
[20] المختار الفجاري، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، ص25
[21] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 52
[22] المختار الفجاري، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، ص 27
[23] محمد، أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 52
[24] المصدر نفسه، ص 52
[25] محمد، أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 53
[26] المصدر نفسه، ص 53
[27] محمد، أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص306
[28] محمد، أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 54
[29] المصدر نفسه، الصفحة نفسها.
[30] المصدر نفسه، الصفحة نفسه.
[31] عبد الرحمان بدوي، موسوعة المستشرقين، ص 336
[32] محمد، أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص 292
[33] مجموعة من المؤلفين، قراءات في مشروع محمد أركون الفكري، ندوة فكرية، ص 115
[34] محمد، أركون، قضايا في نقد العقل الديني، ص 293
[35] المختار، الفجاري، نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، ص 175
[35] محمد أركون، تاريخية الفكر العربي الإسلامي، ص 54