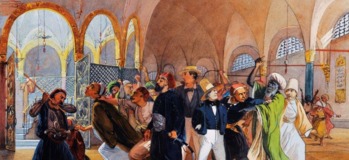ديالكتيك التبعية: المزراحيم ومأزق الصهيونية
فئة : أبحاث محكمة

ديالكتيك التبعية: المزراحيم ومأزق الصهيونية
ملخص:
لا زالت الدولة الإسرائيلية، رغم ادعاءاتها بالديمقراطية والحداثة وتسويق نفسها بأنها دولة حاضنة لكافة يهود العالم، غارقة في إشكالات بنيوية عميقة ترتبط بجذور استعمارية واستشراقية تشكل أساس الأيديولوجيا الصهيونية. فبدل أن تكون إسرائيل وطنًا جامعًا لكل اليهود، كما تدّعي، كرّست عبر بنيتها الفكرية والسياسية تمايزًا صارخًا بين اليهود الأشكناز (الأوروبيين) واليهود المزراحيم (الشرقيين)، مما جعل من المزراحيم فئة تابعة ومهمشة داخل الدولة التي من المفترض أن تحتضنهم.
إن تحليل علاقة الصهيونية باليهود الشرقيين يكشف عن براديغم الصهيونية والاستشراق وعلاقتها بالكولونيالية؛ إذ نجد أنها أعادت إنتاج منطق استعماري يضع الأوروبي في مركز التقدم والتحضر، ويُقصي كل ما هو شرقي أو غير أوروبي، حتى وإن كان يهوديا طالما أنه قادم من الشرق. ولعل عودة المزراحيم إلى واجهة النقاش داخل إسرائيل في شكل احتجاجات وانتفاضات اجتماعية، يكشف عن مأزق الهوية الذي يعتري البنية السياسية والثقافية للدولة العبرية، وعن فشلها في بناء نموذج وطني جامع ومتساوٍ.
إن أهمية هذا البحث تنبع من محاولته الكشف عن البُعد اللاشعوري الاستعلائي المتغلغل في المشروع الصهيوني، وعن استمرار اشتغال منطق التمييز الطبقي والعرقي داخل الكيان الإسرائيلي نفسه. كما يسلط الضوء على ضرورة مساءلة الخطاب السياسي الرسمي في إسرائيل بوصفه امتدادًا لمنظومات كولونيالية لم تنقطع، بل أعادت تشكيل نفسها داخل سياقات جديدة باعتبار أن ليس الفلسطينيون والعرب هم ضحاياه فقط، بل حتى اليهود أنفسهم. فأي مشروع نهضوي حقيقي لليهود داخل إسرائيل – أو أي دولة تدّعي الحداثة والمواطنة – يستدعي إعادة النظر في تشكل الفضاء السياسي والثقافي، وفضح آليات الهيمنة التي تسهم في إنتاج الهويات التابعة وإقصاء "الآخر الداخلي"، كما هو الحال مع المزراحيم.
مقدمة:
لطالما سعت الأيديولوجيا الصهيونية منذ نشأتها في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر ومن بعدها الرواية الرسمية الإسرائيلية إلى التأكيد أن إسرائيل هي دولة لكل اليهود في العالم، وأنها الوطن الآمن الذي سيقطع مع ثقافة الشتات، ويؤسس لمرحلة دولة اليهود القومية على أرض فلسطين. ولكن في الجهة المقابلة، نجد أن هنالك العديد من الأصوات المتعالية من الداخل الإسرائيلي التي تعطي صورة مغايرة تماما عن الصورة الوردية التي تسعى دولة الاحتلال تسويقها عن نفسها. والعجيب أن هذه الأصوات لا تأتي من الداخل العربي أي عرب ال 48 بقدر ما تأتي من اليهود أنفسهم أو الذين تسميهم إسرائيل باليهود الشرقيين أو المزراحيم[1] الذين باتوا يشعرون، وعلى مدار عقود بدءًا من لحظة استقرارهم على الأراضي الفلسطينية في سنة منذ بداية القرن الماضي بأنهم مواطنو درجة ثانية، أو بالأحرى أقلية تتحكم فيها نخبة برجوازية أشكنازية قابضة على مفاصل الحكم والدولة. فهذه الأقوال من شأنها أن تقدح، بل أن تقوض أصل السردية الصهيونية التي تقوم عليها دولة الاحتلال بوصفها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. بما ينجر عن ذلك من كونها امتدادا لمشروع ما بعد كولونيالي غربي أو حتى استشراقي ليس فقط تجاه العرب بمختلف طوائفهم، وإنما تجاه اليهود الشرقيين. كل هذا كان بمثابة الدافع لكتابة هذا البحث وطرح مجموعة من التساؤلات المتمثلة في التالي: كيف أدت الأيديولوجية الصهيونية القائمة على أسس أوروبية استعمارية إلى تهميش المزراحيم واعتبارهم مواطنين من الدرجة الثانية؟ وكيف يمثل ذلك "مأزقاً" للرواية الصهيونية التي تدعي التحرر لجميع اليهود؟
أولا: الصهيونية كمشروع كولونيالي اسشتراقي
إن المتأمل في تاريخ نشأة الحركة الصهيونية لن يخفى عليه الارتباطات التي تجمع هذه الحركة بعصر بروز القوميات والاستعمار الأوروبي الذي ارتبط أساسا بالاستشراق ومعاداة السامية؛ إذ يرى جوزيف مسعد أن أهمية المسألة الفلسطينية تكمن في ارتباطها كتسمية بتاريخ أوروبا بـ "المسألة الشرقية"، والتي كانت تشير إلى تعامل أوروبا مع الإمبراطورية العثمانية؛ أي مع شرقيين موجودين خارج أوروبا، وارتباطها كذلك "بالمسألة اليهودية"، والتي كان من مقوماتها الرئيسة اعتبار يهود أوروبا آسيويي الأصول أو شرقيين، ومسألتهم كانت تعني تعامل أوروبا مع الشرقيين داخلها. ففي البداية كان ينظر لليهود داخل أوروبا بوصفهم امتدادا للآخر الشرقي المغاير للأنا الأوروبية المسيحية البيضاء. ومن ثم، أصبحت المسألة اليهودية تكتسب صبغة عرقية في إطار الكولونيالية الأوروبية. ولكن الأمر لم يدم طويلا، ففي منتصف القرن التاسع عشر، بدأ الترويج لفكرة توطين اليهود الأوروبيين في فلسطين ضمن إطار مشروع استعماري ذي طابع حضاري، كما يظهر في كتاب إرنست لآران "مسألة الشرق الجديدة: إعادة بناء القومية اليهودية" (1860)، حيث اعتبر أن استيطان اليهود في فلسطين سيحقق مكاسب اقتصادية لأوروبا، مؤكداً أن الشعب اليهودي سيكون أداة لفتح طرق جديدة للحضارة الأوروبية. وقد تبنّى تيودور هرتزل، مؤسس الحركة الصهيونية، هذا التصور، وطرح في كتابه "”Der Judenstaat دولة اليهود” رؤية لدولته المأمولة بوصفها "جزءاً من متراس أوروبا في مواجهة آسيا"، وموقعاً متقدماً للحضارة في مواجهة ما وصفه بـ"البربرية". ولم يكن هذا التصور مقتصراً على اليهود، بل شارك فيه الأوروبيون من يهود وغير يهود؛ إذ رأوا في اليهود الأوروبيين عنصراً أوروبياً خالصاً فقط حينما دخلوا في المشروع الكولونيالي. وقد عبّر هرتزل عن هذا بوضوح في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الصهيوني الأول، حين قال إن من مصلحة الأمم المتحضرة إقامة محطة كولونيالية في فلسطين، وإن اليهود، بوصفهم حملة للثقافة، مستعدون لبذل أرواحهم من أجل هذه المهمة. وعلى هذا النهج، تبنّى المسؤولون الأوائل عن المستوطنات الزراعية اليهودية في فلسطين أفكاراً كولونيالية مشابهة لتلك التي اتبعها موظفو الخدمة الاستعمارية الفرنسية تحت شعار "المهمة الحضارية".[2] أدى كل هذا فيما بعد، إلى عقد الصهيونية النية على مشروع آخر متمم للاندماج، ألا وهو إقامة دولة يهودية عبر الاستيطان الاستعماري لمنطقة واقعة تحت السيطرة الإمبراطورية الأوروبية (فلسطين)؛ إذ إن الصهيونية بهذا الفعل، سوف تتمكن من تسويق مساعيها الاستعمارية بوصفها مساعي لنشر الثقافة الأوروبية المسيحية على يد اليهود كناقلين لها؛ ذلك أن الصهيونية، بانتحالها الهوية الأوروبية المسيحية واللاهوتية وأنطولوجيتها وأبستمولوجيتها المتكافئتين، خاضت مشروعاً لأخرنة الذات حول الهوية اليهودية الأوروبية بطرائق لم تخطر على بال أحد من قبل، حيث أصبحت المعتقدات التي كان يحملها اليهود الألمان المندمجون عن يهود أوروبا الشرقية، أو ([3]ostjuden)، وثقافتهم "المتخلفة" تُستخدم الآن لنعت «أخرى أوروبا» عموماً، سواء أكانوا يهوداً أم غير يهود، فيما تذوّت اليهودي الأوروبي الجديد، بالزي المسيحي، ومن خلال الصهيونية، بالنظرة العالمية (weltanschauung) الأوروبية المسيحية والتي اعتبرت غير الأوروبيين أدنى منزلة. وبهذه الخلفية السابقة على تأسيس دولة إسرائيل، كان اليهود غير الأوروبيين قد تحدوا خطابياً بشكل مسبق كآخر أدنى لليهود الأوروبيين، ولذلك فهم بحاجة للحضارة الأوروبية التي وفرتها الصهيونية لليهود الأوروبيين أنفسهم.[4] هذا الاقتباس من جوزيف مسعد يبين لنا كيف أن تحالف الصهيونية مع الحركة الاستعمارية الأوروبية سيؤدي بنهاية المطاف لإنشاء وطن قومي لليهود باعتبار أن اليهود القادمين من أوروبا سيجلبون معهم مشعل الحضارة للشرق الأوسط. ولن تقتصر هذه المهمة التمدينية على العرب من فلسطينيين، وإنما ستشمل كما سنرى لاحقا اليهود الشرقيين أنفسهم. ولذلك، استمر الخطاب النقدي البديل الذي يتعلق بإسرائيل وبالصهيونية حتى الآن، وإلى حد كبير على اعتبار إسرائيل دولة مصطنعة، ومتحالفة مع الغرب ضد الشرق؛ دولة قائمة في أساسها على إنكار الشرق والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني؛ [5] إذ تزعم الصهيونية وإلى الآن بأنها حركة تحرر لجميع اليهود، ولكنها في الواقع، كانت، أساسًا، حركة تحرر لليهود الأوروبيين وبصورة أكثر دقة لتلك الأقلية الصغيرة من اليهود الأوروبيين (الأشكناز) القاطنين بإسرائيل فعلاً. ومع أن الصهيونية تزعم أنها تقدم وطناً إلى جميع اليهود، فإن ذلك الوطن لم يُقدَّم إلى الجميع على المستوى نفسه. فقد جيء باليهود المزراحيم في البداية إلى إسرائيل من أجل استكمال المشروع الاستيطاني والذي كان يخدم بالأساس الأشكناز بالدرجة الأولى. ثم جرى التمييز بين الأشكناز والمزراحيم، بصورة منهجية ومؤسساتية، من قبل الصهيونية التي بذلت طاقاتها ومواردها المادية لمصلحة اليهود الأوروبيين الدائمة، وللأذى الدائم لليهود الشرقيين.[6] فهذا التمييز لم يطل الفلسطينيين وحدهم، بل طال اليهود القادمين من دول العالم الثالث، فباتوا يشكلون أمة شبه مستعمرة داخل أمة.[7] إن هذا الوضع الدوني الذي سيؤول إليه اليهود العرب أو الشرقيون ليذكرنا بالمقارنة التي عقدتها الباحثة العراقية اليهودية إيلا شوحط فيما يتعلق بتشابه وضع الفلسطينيين مع الأمريكيين الأصليين، وبين المزراحيم والسود الذين جلبهم المستعمرون البيض للقارة الأمريكية. فقد مثّل اليهود الأوروبيون، كما بيّن إدوارد سعيد للأوروبيين البيض، الشرق داخل أوروبا، ليصبح اليهودي العربي فيما بعد "شبحهم المخيف"، إلا أن هذا الخطاب الصهيوني المعرفي يسبغ على الأشكناز وضعية بيضاء فخرية إزاء اليهود من غير البيض. وإن هذه الوضعية بالذات كبيض فخريين هي التي تمنح اليهود الأوروبيين الامتيازات على اليهود العرب. [8] فإسرائيل بحسب تصوّراتهم وأهدافهم، ابتكار مشروع شامل لأوربة زبائن الصهيونية من اليهود غير الأوروبيين؛ إذ يصوّر هذا الخطاب الذي يضع الأوروبيين في موقع الراشدين الذين قاسوا من طفولة متخلّفة في طريقهم نحو التطور، على أنهم أصبحوا قادرين الآن على "مساعدة" أطفال العالم الثالث لتحمّل معاناة آلام النمو، من أجل بلوغ هدف الحضارة على النمط الأوروبي كهدف نهائي محدّد لعملية النضج. وبهذا شكلت هذه الفلسفة التطورية الأساس لسياسات الدولة الإسرائيلية نحو اليهود الشرقيين، واستمدت جميع هذه السياسات شرعيتها منها، [9] غير أن الدولة الناشئة وقعت في مأزق التأسيس المتمثل في الأعمار؛ فاليهود الأوروبيون الأشكناز ليسوا مؤهلين بنظر تلك النخبة البورجوازية لتحمل مشقة التعمير والإنشاء. ولذلك، انصب الجهد الصهيوني الأوّل على ضخ يهود غير أوروبيين؛ وذلك لجلب ألفي مهاجر يمني إلى فلسطين ما بين أعوام 1910 و 1914، وقد تم اقتراح هجرتهم عام 1907 خلال مناظرة حول استخدام العمالة العربية الفلسطينية في المستوطنات الأشكنازية، عندما شدّد الصهاينة من مدّعي "الاشتراكية" على مبدأ “عبودا عبريت”(العمالة العبرية) حصريّاً كشرط لـ "تطبيع" اليهود كشعب؛ وذلك لأنّ الصعوبة التي واجهت العديد من المستوطنين الأشكناز الأوائل في فلاحة الأرض دفعتهم إلى تشغيل عمالة عربية فلسطينية رخيصة الأمر الذي اعتبر مفسداً للمثاليات والأهداف الصهيونية. فقد أعلن الصهيوني الأشكنازي شموئيل أفنيئيلي في سياق هذا الجدل، بأن العمالة اليهودية اليمنية "قد تحل محل العرب"، ملبياً بذلك متطلبات “عبودا عبريت”[10]. وهكذا يحل اليهود العرب أو الشرقيون محل الأفارقة السود الذين استعان بهم البيض في "تنفيذ مشروعهم الاستيطاني في الأمريكيتين" بدل أن تحررهم من ذلك الشرق "المعادي للسامية". وفي سبيل التأكيد على تفوق الأشكناز على اليهود الشرقيين، نجد أن فلاديمير جابوتنسكي الذي ويا للمفارقة تتلمذ على يده والد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، كان ينكر وجود أي ارتباط بين اليهود الأوروبيين والمشرق؛ وذلك عندما صرّح عام 1926 بأن "اليهود والحمد لله، لا يمتون للشرق بصلة، لذلك يجب أن نقضي على أيّ مسحة من روح الشرق في يهود فلسطين. وكان قد اعترض في مقالة سابقة بعنوان "يهود الشرق"، على الزيجات المختلطة مع اليهود غير الأوروبيين، وخلق شعب يهودي واحد، مضيفاً بأنه يعترض على الاندماج؛ لأنه لم يكن يعلم ما إذا كان سيسفر عن "شعب ذكي أو عرق غبي، لذلك يجب على اليهود الأشكناز الحفاظ على وضع الأغلبية في المجتمع الإسرائيلي في فلسطين. فيقول: "نحن ذاهبون لأرض إسرائيل، بالأساس، من أجل راحتنا القومية، وثانياً، كما قال نورداو، في سبيل توسيع حدود أوروبا، حتى نهر الفرات". بكلمات أخرى، في سبيل كنس كل مخلفات "الروح الشرقية" من أرض إسرائيل وبشكل جذري، في كل ما يخص اليهودية فيها - حاضراً ومستقبلاً. "وفيما يخص العرب في أرض إسرائيل، فإن الأمر متروك لهم؛ ولكن إذا كان بمقدورنا أن نسدي لهم معروفاً فسيكون كالتالي: مساعدتهم على التحرر من "الشرق"[11]، بل امتد الأمر للنقاشات الدائرة حول اللغة الرسمية للدولة العبرية، فقام بوضع توصيات عن كيفية نطق العبرية الحديثة، حيث أفاد في مقالته "اللهجة العبرية"، بأن هناك بعض المختصين ممن يعتقدون بوجوب تقريب لهجتنا من اللهجة العربية، لكن ذلك خطأ، فبالرغم من كون العبرية والعربية من اللغات السامية، إلّا أن هذا لا يعني بأن آباءنا قد نطقوا بـ "لهجة عربية"... نحن أوروبيون وميولنا الموسيقية أوروبية، على غرار روبنشتاين، ومندلسون، و بيزيه"[12] وهذا يؤكد تماهي اليهود الأشكناز مع الثقافة الأوروبية واحتقارهم لكل ما هو شرقي، بل وإنكار وجود مصطلح يهودي عربي؛ إذ يرى ييراخ جوفر أن مصطلح يهودي عربي يجسد مفاهيم السيولة والتهجين، ويلمح إلى وجود تاريخ جماعي مشترك، مما يُشكّل تهديدًا للنزعة القومية الضيقة ذات الطابع الأوروبي في إسرائيل أي تهديد للنقاء والتفوق الأشكنازي باعتبار أن هذا هو الأساس الذي قامت عليه دولة إسرائيل. ونتيجة لذلك، فإن الطريقة التي تعامل بها التيار الصهيوني مع اليهود غير الأوروبيين قبل وبعد قيام دولة إسرائيل تعكس معاملته للفلسطينيين؛ إذ تم اختزال الفلسطينيين إلى "مجرد عرب" في محاولة لنزع الشرعية عن مطالبهم السياسية كشعب له حق في أرض فلسطين، في حين تم تجريد اليهود العرب من أصولهم وهوياتهم العربية بنفس الأسلوب، ليُصبحوا "مجرد يهود" بهدف دمجهم في الجماعة المهيمنة المعروفة بـ"اليهود الأوروبيين الإسرائيليين[13]. ومن ثم، كان وجود فئة من "اليهود العرب" يؤرق النخبة الأشكنازية؛ لأنها شكّلت تهديدًا لنقاء المشروع الصهيوني – كمشروع غربي وحداثي – وهدّدت "الانقسام الكبير" الذي سعت الصهيونية إلى ترسيخه بين اليهود والعرب، باعتبار أن المزراحيم لديهم انتماء ثقافي وتاريخي ولغوي مشترك مع العرب. وهكذا، في حين ظل اليهود الأوروبيون فئة شرعية من حيث الهوية، تم تحويل اليهود العرب من قبل الدولة والمفكرين الصهاينة إلى فئة "عيدوت هَمِزراح" أو "الجماعات الشرقية"، وهي فئة تشير إلى مجموعة عرقية داخل الإطار اليهودي. ويرى جوزيف مسعد بأنه في السياق الإسرائيلي، يحمل مصطلح عيدوت دلالة تقييدية؛ لأنه يقوم بإفراغ الإثنية من بعدها السياسي ويجعلها حكرًا على الفولكلور والتقاليد. وتتضح صلة هذه السياسيات بالاستشراق عندما يوضح يهودا شنهاف الذي كرس معظم دراساته وأبحاثه في دراسة التقسيم الطبقي والعرقي في إسرائيل بأن "تحويل اليهود العرب إلى عيداه (فئة) أو مجموعة شكّل فعلًا من أفعال الاستشراق، أتاح طمس وإنكار عروبتهم، لكنه في الوقت ذاته تأسّس على التمييز بين الشرق والغرب، فيقول: "كان الوعي الصهيوني ينظر إلى اليهود العرب في سياقين نموذجين مختلفين. فمن ناحية، كان ينظر إلى هؤلاء اليهود بصفتهم عرباً، وبالتالي بوصفهم "آخر" غير أوروبا والصهيونية. ومن ناحية أخرى، كان ينظر إليهم على أنهم هم اليهود القدماء، وبالتالي فهم الأعيان السامية والمقدسة في الخطاب القومي-الديني الصهيوني. وقد أثارت هذه الثنائية نظرة مشوشة يطغى عليها التنازع للواقع القائم. فمن وجهة النظر الكولونيالية، كان ينظر إلى تدين اليهود العرب على أنه ضحل. ومن وجهة نظر قومية، كان ينظر إلى هذا التدين على اعتباره عتيقا وأصليا.[14] ويقف المرء على عمق التماهي الاستشراقي مع الكولونيالية الأوروبية في الملاحظات التي ساقها إسحق غرونباوم، وهو عضو في المجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية، في الاجتماع الذي عقد مع ممثلي شركة "سوليل بونيه" في مقر الوكالة اليهودية في القدس، حيث قال إنه يوجد نوعان من السكان في فلسطين: "نحن اليهود شعب القرن العشرين في أوروبا، بينما السكان العرب لا يزالون يعيشون في مستوى التنمية الذي كان سائدًا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر". و"بما أننا شعب أوروبا، تحدونا الرغبة في إقامة اقتصاد أوروبي هنا. ونحن نعتقد بأنه يتحتم على حكومة الانتداب أن تدير شؤونها بناءً على وجهة النظر التي ترى بأن فلسطين هي بلد أوروبي مثل إنجلترا أو الأقاليم الواقعة تحت هيمنتها". ومع ذلك، وحسبما رأينا أعلاه، كان يُنظر إلى اليهود العرب بوصفهم يهودًا وعنصرًا أصيلاً في النموذج الصهيوني. وبذلك، لم يكونوا بمثابة "آخرين" غير أوروبا، وإنما "دخلاء" قريبين من الصهيونية الأوروبية[15]. لقد كانت هذه حالة واضحة من الاستشراق، حيث عملت جماعة يهودية واحدة على شرعنة جماعة أخرى، ولا يعدّ ما قام به اليهود الأوروبيون من شرعنة اليهود العرب دخيلاً على الصهيونية. فقد تصادفت بدايات هذا الفعل مع انعتاق اليهود في أوروبا، ووجد التعبير عنه في تحويل اليهود "الشرقيين" إلى "الآخرين" المنحدرين من أوروبا (وبالتالي إلى "غير المحدثين"). لقد صقلت اللقاءات مع اليهود العرب المواقف الاستشراقية التي ولدت في ظروف سادها الحكم الكولونيالي، وتجسدت هذه المواقف في العلاقات التي شكلت بفعل تصنيفات الشرق والغرب. وبدل أن يصبح اليهود أمة واحدة داخل إسرائيل، تم تحويل اليهود العرب إلى "الآخر الداخلي"، ومن ثم أصبحوا يُفترضون داخل الإطار الإسرائيلي تحت مسمى "سفاراديم"، ولاحقًا "مزراحيم"، للإشارة إلى جميع اليهود غير الأشكناز؛ أي جميع اليهود من أصول غير أوروبية. وقد ترافقت هذه المحاولة لإعادة التسمية – والتي أدت إلى إزالة "العروبة" عن هوية هؤلاء – مع حملة منهجية لإزالة الطابع الثقافي العربي، وهي حملة فهمتها المؤسسة الصهيونية كعملية ضرورية للتطهير، "من أجل القضاء على أي تهجين، وتعزيز الانقسام التام بين العرب واليهود[16].
ثانيا: المزراحيم كنموذج عملي للعنصرية الصهيونية
ترى الباحثة إيلا شوحط، أستاذة الدراسات الثقافية في جامعة نيويورك، أن الصهيونية أسهمت في خلق قمع مزدوج تجاه كل من الفلسطينيين واليهود العرب (المزراحيين)، حيث تعرضت هاتان المجموعتان للتهميش من قبل النخبة الإشكنازية المهيمنة على المشروع الصهيوني. فقد سعت هذه النخبة إلى طمس الثقافة الشرقية اليهودية، عبر فرض نمط ديني واجتماعي مستورد من أوروبا، لا يمت بصلة إلى تقاليد اليهود في الدول العربية وشمال إفريقيا. وفي هذا السياق، تؤكد ايلا حبيبة شوحط أن اليهود الشرقيين أو العرب لم يقوموا أبداً بتأدية الصلوات العبرية بلهجة إشكنازية - غربية، ولم يقوموا بطقوس دينية على الطريقة الإشكنازية؛ فأبناء هذه الطوائف (الرجال) لم يغطوا أجسامهم بثياب السواد التي مصدرها في بولندا، ما قبل بضع مئات من السنين. وعلى نحو مشابه، لم تلبس النساء الشرقيات مطلقاً (باروكات) الشعر، حيث يتماهى غطاء رؤوسهن مع نمط اللباس المحلي في مناطقهن، مثل "الشكشة" على رؤوس النساء العراقيات اليهوديات[17]. وهنا وللمرة الأولى بدأ اليهود العرب في مواجهة مسألة الوجود والهوية: أن يكونوا أو لا يكونوا يهوداً.. أن يكونوا أو لا يكونوا عرباً. وفي هذا السياق، تروي إيلا شوحط معاناة أسرتها المهجرة من العراق، فتقول: "في العراق كنا يهودًا".. - قال أبي وأمي عندما وصلا إلى إسرائيل في العام 1950.. وفي إسرائيل نحن عرب".. وهذا يعكس لنا مدى جسامة المأزق الوجودي الذي يعيشه اليهود الشرقيون منذ لحظة انفصالهم عن أوطانهم العربية والشرقية، غير أن هذا المأزق الوجودي الذي سعت النخبة الأشكنازية إلى تعميقه، بل وخلقه ابتداء أثر حتى على الخطاب الثقافي الغربي الذي بات لا يعترف سوى بالصلة القائمة بين اليهودية والمسيحية، ويتغاضى كلياً عن الصلة التي تربط بين اليهودية والإسلام، بل ويراها من المضادات التي لا يمكن أن تتقابل في جملة واحدة إلا بوصفهما ضدين متنافرين. وبناءً على ذلك، نجد أن اصطلاح "الثقافة اليهومسيحية" رائج في البحث الأكاديمي، في حين يُنظر إلى مصطلح الـ "يهود - إسلامي" كأمر غير ممكن.[18] وفي إطار المهمة الحضارية التي يضطلع بها الاشكناز تجاه المزراحيم تعين على اليهود الشرقيين التماهي مع النظرة اليهودية الأوروبية حتى يتم الاعتراف بهم داخل هذه الدولة الوليدة "فقد تعلم الكثيرون منا شطب جسدهم.. لقد أضحى الجسد الشرقي عدواً لنا.. اللون، المنظر، اللباس، الرائحة، لهجة الكلام.. فمظهرنا الخارجي كان في الغالب يومئ إلى هويتنا، الأمر الذي جعل الكثيرين منا يستوعبون "النظرة" الأشكنازية التي تسخر منا، والاقتناع بحقيقة صورتنا البشعة المنعكسة في المرأة الأوروبية الإسرائيلية.[19] تتجلى السياسات العنصرية التي انتهجتها إسرائيل تجاه اليهود الشرقيين (المزراحيم) في العديد من المظاهر التي كشفت عن تمييز واضح بينهم وبين اليهود الأشكناز القادمين من أوروبا. فمع بدايات الهجرة المنظمة ليهود شمال إفريقيا، وخصوصاً من الجزائر والمغرب، إلى إسرائيل، تم التعامل مع هؤلاء المهاجرين بشكل يعكس نظرة دونية متجذرة في الوعي الصهيوني الأوروبي. فعلى سبيل المثال، كانت ظروف المعسكرات التي وُضع فيها اليهود المغاربة والجزائريون قبل نقلهم إلى إسرائيل سيئة للغاية، الأمر الذي انعكس سلباً على رغبة الجاليات اليهودية في شمال إفريقيا بالهجرة. وقد أشار مبعوث من الوكالة اليهودية إلى أن "أول ما يلاحظه المرء الآن هو النفور الواضح من الذهاب إلى إسرائيل"، بل وأضاف أن "الناس كانت تُحمل عنوة إلى ظهر البواخر"، في إشارة إلى أسلوب التهجير القسري الذي رافق هذه المرحلة، بل إن بعضهم غادر المعسكرات للعودة إلى المغرب. وفي اليمن، أدت الرحلة عبر الصحراء، التي تفاقمت بفعل الأوضاع غير الإنسانية في معسكرات الانتقال الصهيونية، إلى المجاعة والمرض والموت الجماعي، الأمر الذي أدى بدوره إلى نوع قاس من "الانتقاء الطبيعي". وفي ظل القلق بشأن عبء العناية بالمرضى اليمنيين، طمأن يتسحاق رفائيل (من الحزب الديني القومي) زملاءه أعضاء الوكالة اليهودية إلى أن "لا حاجة إلى التخوف من وصول عدد كبير من المرضى المزمنين؛ إذ لا بد من أن يسيروا على أقدامهم نحو أسبوعين، وأن المصابين بمرض شديد لن يستطيعوا السير". إن الاحتقار الأوروبي - اليهودي لحياة اليهود الشرقيين وحساسياتهم - الذي انتقل، أحياناً، إلى المزراحييم عبر "خبراء" أشكنازيم زعموا أن الموت للمزراحي شيء "عادي وطبيعي"[20]. لقد عبّر ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء لإسرائيل، بشكل صريح عن المعتقدات العنصرية تجاه اليهود الشرقيين، عندما وصفهم في عام 1949 خلال اجتماع مع مثقفين وكُتاب بأنهم "يبدون كالمتوحشين، ولم يقرأوا كتاباً في حياتهم، ولا حتى كتاباً دينياً، ولا يعرفون كيف يتلون صلواتهم"، مضيفاً أن لديهم، رغم ذلك، إرثاً روحياً يهودياً لا شعورياً. وفي مقالة كتبها في العام نفسه للكتاب السنوي الإسرائيلي، أكد بن غوريون أن الصهيونية هي في الأساس حركة لليهود الغربيين، وأن يهود أوروبا وأميركا هم "المرشحون الأوائل للمواطنة في دولة إسرائيل"[21]، وهو ما يدلّ بوضوح على إقصاء متعمد لليهود الشرقيين من الهوية الوطنية الإسرائيلية المنشودة. ولم يكن بن غوريون وحده في هذه النظرة، بل شاركه قادة صهاينة آخرون الرأي ذاته. فقد صرّح يعقوب روبين، مسؤول دائرة الشرق الأوسط في الوكالة اليهودية، قائلاً: "أولئك ربما ليسوا اليهود الذين نتوق لرؤيتهم قادمين إلينا، ولكن ليس بمقدورنا أن نقول لهم بألا يأتوا". هذا التردد في القبول لم يبق محصوراً داخل إسرائيل، بل امتد إلى الدبلوماسية الإسرائيلية نفسها، كما يظهر في حديث موشي شاريت، وزير خارجية إسرائيل آنذاك، مع فيشنسكي نائب وزير الخارجية السوفييتي، حيث قال: "المسألة ليست بالكم، وإنما بالنوع... لا يمكننا الاعتماد على يهود المغرب لبناء البلاد، فهم غير مؤهلين ثقافياً لذلك... نحن بحاجة إلى أناس يتمتعون بالصلابة والمقاومة، ويهود أوروبا الشرقية هم ملح الأرض".
أما من حيث الممارسة الفعلية، فقد تم رش المهاجرين الشرقيين، فور وصولهم إلى إسرائيل، بمادة الـ "دي. دي. تي" (DDT) تحت ذريعة تطهيرهم من القمل، في ممارسة مهينة تعكس تصورات مسبقة عنهم بصفتهم ناقلي أمراض أو غير نظيفين[22]. وفي ذات السياق، يصف هذا السرد المباشر لامرأة بغدادية لوصولها إلى إسرائيل بوضوح خيبة الأمل والإذلال الذي عانى منه المهاجرون الجدد: "كنا نرتدي ملابس السبت الخاصة بنا. اعتقدنا عند هبوط الطائرة أن إسرائيل سترحّب بنا بحرارة. لكن، يا إلهي، كم كنا مخطئين! عندما هبطت الطائرة في مطار اللد، اقترب منا عامل ورشّنا بالكامل بمبيد الـ "دي. دي. تي"، كما لو كنا مصابين بالقمل. أي نوع من الترحيب هذا؟ شعرنا أنهم يبصقون في وجوهنا. عندما نزلنا من الطائرة، دفعونا إلى قطار، كان مزدحمًا لدرجة أننا كنا ندوس على بعضنا البعض وتلوثت ملابسنا الفاخرة. [...] أخيراً وصلنا إلى مخيم "شعار العلياه" وتم استقبالنا مع عائلات أخرى، ثم كتبوا أسماءنا و"أعطونا" أسماء عبرية جديدة. أصبح "سعيد" "حاييم"، و"سعاد" أصبحت "تمار" وأنا أُعيدت تسميتي "أهوفا" وهكذا دواليك، ثم اضطررنا للانتظار في طوابير الطعام الطويلة، كما لو كنا متسولين. لم يكن لدينا أدنى فكرة عما سيحدث لنا.[23]
وقد عبّر الخطاب الصهيوني الأوروبي عن هذا التمييز من خلال ثنائية "التمدين والرفع"، أي السعي إلى رفع المستوى الثقافي لليهود غير الأوروبيين ليواكب ما يعتبر "المواصفات الأوروبية"، دون الانحدار إلى ما وصفوه بـ"الثقافات البدائية". وكان بن غوريون واضحاً في هذا السياق، عندما صرّح بأن اليهود المغاربة "استمدوا الكثير من عاداتهم من العرب المغاربة، وأنا لا أرغب بوجود ثقافة المغرب هنا... لا أرى أي إسهام يمكن أن يقدمه اليهود الفرس الحاليون... لا نودّ أن يُصبح الإسرائيليون عرباً، لذلك علينا محاربة روح الشرق التي تفسد الأفراد والمجتمعات".[24] ومع تزايد أعداد المهاجرين من الدول العربية وتفوقهم عدداً على المهاجرين من أوروبا، رأت النخبة الأكاديمية الأشكنازية في إسرائيل أن في الأمر "مشكلة جديدة"، فدعت المجلة الفصلية "ميجاموت" خمسة من كبار أساتذة الجامعة العبرية في القدس – وجميعهم من أصول أوروبية – لدراسة الظاهرة. وقد اتسمت مقالاتهم بلغة أبوية ازدرائية، حملت عناوين مثل "كرامة الإنسان" و"معايير مطلقة"، لكنها انتهت إلى نتائج تُجذّر التمييز. فقد كتب كارل فرانكنشتاين بأن "علينا أن نعترف بالعقلية البدائية للعديد من المهاجرين القادمين من البلدان المتخلفة"، واقترح لفهمهم مقارنتهم "بالتعبيرات البدائية للأطفال وذوي الإعاقات العقلية". أما يوسف جروس، فاعتبر أن المهاجرين يعانون من "النكوص العقلي" و"خلل في تطور الأنا"، فيما ناقش زملاؤه "طبيعة البدائية" بإسهاب، في إجماع واضح على دونية المهاجرين الشرقيين[25]. إن المجتمع الإسرائيلي الحديث ما يزال يضع السفارديم والمزراحيين في موقع دوني مقابل "الأشكنازي" المفترض بأنه لا عرقي، والذي يُعدّ ممثلًا للثقافة والهوية اليهودية الأصيلة". فالاصطلاح "أشكنازي" أو "أشكنازيم" أصبح مرادفًا لـ "الإسرائيلي"، ما أدى إلى استعمار جميع الهويات اليهودية الأخرى وبالنظر إلى أن غالبية يهود إسرائيل اليوم من أصول غير أوروبية، فإن إسرائيل ليست فقط ليست دولة مواطنيها غير اليهود، بل أيضًا ليست حتى دولة غالبية مواطنيها اليهود.[26] فبحسب جدعون جلعاتي: إنَّ الفرق الاقتصادي الرئيس بين البلدات التطويرية ومناطق الأحياء الفقيرة كان جغرافياً واقتصاديا؛ إذ وقعت البلدات التطويرية في الريف، وزوَّدت المستوطنات الأشكنازية بالعمالة الرخيصة، بينما شكلت الأحياء الفقيرة حزاماً حول المدن الكبرى، وزوّدت الرأسمال الأشكنازي (بما فيه الكيبوتسات والموشافيم الأشكنازية) بالعمالة الرخيصة. واتّسم الوضع في الأحياء الفقيرة بالازدحام نظراً لانعدام المساكن، وبضعف الخدمات التعليميّة، وبارتفاع معدّلات البطالة، فيما تحوّلت غالبية النساء والفتيات في هذه الأحياء الفقيرة إلى جيش من العمالة المنزلية الرخيصة.[27] بالإضافة إلى وجود نظام تعليمي قائم على الفصل وعدم المساواة، إلى حد كبير، والذي يعيد أيضاً إنتاج الانقسام الإثني للعمل عبر نظام متسلسل يوجه باستمرار الطلبة الأشكنازيم نحو مواقع مهمة لذوي الياقات البيض، والتي تتطلب إعداداً أكاديمياً قوياً، بينما يوجه الطلبة المزراحييم نحو المهن المنخفضة المستوى لذوي الياقات الزرق. وللأشكنازيم تمثيل في مهن الياقات البيض يبلغ ضعف ما للمزراحييم. كما تتمتع المدارس في الضواحي الأشكنازية بتسهيلات أفضل، وبمدرسين أفضل، وبمستوى أرفع. وللأشكنازيم، على العموم، ثلاثة أعوام من التعليم الأكاديمية يعادل 2.4ضعف، كما يبلغ خمسة أضعاف في الجامعات مقارنة بالمزراحيم.[28] كل هذا التهميش والتمييز أدى إلى ظهور انتفاضات من قبل المزراحيم من بينها انتفاضة الفهود السود1971 وانتفاضة وادي الصليب 1959، وهما من أشهر الانتفاضات والحركات الاجتماعية التي شهدتها إسرائيل داخل الأوساط اليهودية الشرقية. فمعظم اليهود الشرقيين كانوا يقيمون في البلدات التطويرية والموشافيم. وانحدرت كذلك قيادة الفهود من هوامش المجتمع الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن نصيبهم من التعليم كان قليلاً. فكان الأشكناز يقيمون في المدن التي تتمتع بازدهار اقتصادي مثل تل أبيب، بينما كان المَزراحيون والسفارديم يُقيمون في المناطق الحضرية الهامشية التي تعاني من التدهور، ومع ذلك، وجد عدد كبير من السفارديم والمزراحيين، الذين قدّر عددهم بنحو 600,000 بعد تأسيس الدولة، أن الوعود البراقة التي بشَّر بها المشروع الصهيوني لم تكن تتطابق مع الواقع المُعاش، حيث حُرموا من الفرص المساوية، وكانوا ملزمين بأعمال ذات مكانة اجتماعية متدنية ومرتبات متواضعة.[29]
الخاتمة:
إن التنظيرات الصهيونية منذ نشأتها كانت ولا زالت تخاطب الأوروبيين البيض بوصفهم ناقلين للحضارة الأوروبية وامتدادا جغرافي لأوروبا حتى نهر الفرات. ومن ثم، لم يكن هذا الخطاب مدافعا كما يدعي عن اليهود أو حتى تحريرهم من الشتات، وإنما على النقيض من ذلك سعى إلى تشريقهم وتنميطهم واخضاعهم لسلطة الأشكناز وإنكار جذورهم وإجبارهم على التماهي مع مشروع حضاري كولونيالي مشبع بخطاب استشراقي انتهى به المطاف إلى تحويل هذه الفئة إلى آخر أو شبح شرقي داخل الدولة العبرية، الأمر الذي يقوض الخطاب الإسرائيلي الرسمي، ويضع اليهود العرب في مأزق وجودي يؤدي إلى تفسخ في هويتهم وإدراكهم لأنفسهم.
لائحة المصادر والمراجع:
حليحل، علاء. (2001). الشرقيون يتهمون. قضايا إسرائيلية، (2).
شوحاط، إيلا. "الشرقيون في إسرائيل: الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها اليهود". مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد 36، 1998
حليحل، علاء. (2001). الشرقيون يتهمون. قضايا إسرائيلية، (2).
مسعد، جوزيف. (2009) ديمومة المسألة الفلسطينية. بيروت: دار الآداب.
شنهاف-شهرباني، يهودا. (2016). اليهود العرب: قراءة ما بعد كولونيالية في القومية والديانة والإثنية. عمان: الأهلية للنشر والتوزيع.
Giladi, G. N. (1990). Discord in Zion: Conflict Between Ashkenazi and Sephardi Jews in Israel. New York: Interlink Pub Group Inc.
Scholtes, Nora. "'Bulwark against Asia': Zionist Exclusivism and Palestinian Responses." PhD diss., University of Kent, 2015
Smooha, Sammy. Israel: Pluralism and Conflict. Berkeley: University of California Press, 1978
Segev, Tom. (1986). 1949: The First Israelis. New York: The Free Press.
[1] البعض يسميهم بالسفارديم.
[2] جوزيف مسعد، ديمومة المسألة الفلسطينية، ص 48، 2009.
[3] كلمة ألمانية تعني ألمان الشرق.
[4]. جوزيف مسعد، المرجع السابق، ص 143
[5] إيلا شوحط، اليهود الشرقيون في إسرائيل: الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها اليهود، مجلة الدراسات الفلسطينية، عدد36، 1998، ص3
[6]. ايلا شوحط اليهود، المرجع السابق، ص4
[7] المرجع السابق.
[8] جوزيف مسعد، المرجع السابق، ص201
[9] جوزيف مسعد، المرجع السابق، ص156
[10] جوزيف مسعد، المرجع السابق، ص139
[11] علاء حليحل، الشرقيون يتهمون، قضايا إسرائيلية، ص 1
[12] جوزيف مسعد، المرجع السابق، 141
[14] يهودا شنهاف شهرباني، اليهود العرب: قراءة ما بعد كولونيالية في القومية والدين والاثنية، ص 136
[15] يهودا شنهاف شهرباني، المرجع نفسه، ص 135، 2016.
[16] يهودا شنهاف شهرباني، المرجع السابق، ص 139
ايلا شوحط، هويات ممزقة تأملات امرأة عربية يهودية، ص 68، قضايا إسرائيلية،
[17] ايلا شوحط، هويات ممزقة تأملات امرأة عربية يهودية، ص 68، قضايا إسرائيلية،
[18] ايلا شوحط، المرجع السابق، ص 69
[19] اايلا شوحط، المرجع السابق، ص 70
[20] ايلا شوحط، المرجع السابق، ص71
[21] Ben Gurion, Nestah Yeisrael, 14, cited in Segev, 1949, 147
[22] Nora Scholtes, "'Bulwark against Asia': Zionist Exclusivism and Palestinian Responses," PhD diss., University of Kent, 2015, 149
[23] Nora Scholtes, 149
[24] جوزيف مسعد، المرجع السابق، ص 149
[25] Nora Scholtes, p 141
[26] Nora Scholtes, p 144
[27] Giladi, Discord, 149
[28] Sammy Smooha, Israel: Pluralism and Conflict, 1978, pp. 178-179
[29] https://megazine.ultrasawt.com/منقولات/الفهود-السود-والأقليات-جذور-التمييز-في-إسرائيل.