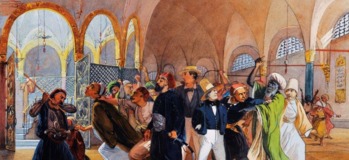بين الثقافتين العربية والألمانية: حوار مع شتيفان فايدنر ورضوان السيد وميادة كيالي
فئة : حوارات

بين الثقافتين العربية والألمانية:
حوار مع شتيفان فايدنر ورضوان السيد وميادة كيالي
حاورهما د. حسام الدين درويش
د. حسام الدين درويش:
مرحبًا شتيفان، نحن سعداء بوجودك معنا مرة أخرى باسم مؤسّسة "مؤمنون بلا حدود"، ونرحّب بك مجدّدًا، ونبارك لك صدور الترجمة العربية، لكتابك "ما وراء الغرب: من أجل تفكير كوني جديد". سؤالي الأول لك سؤال عامّ، فقد سبق أن أجرينا معك حوارًا حول هذا الكتاب، لكن نودّ معرفة المزيد عن أهمية ترجمة الكتاب إلى اللغة العربية، من منظورك، وعن ماهية شعورك أو انطباعك عن صدوره باللغة العربية؟
أ. شيفان فايدنر:
أنا سعيد جدًّا بصدور هذا الكتاب أخيرًا باللغة العربية. في الحقيقة لم أكتبه للألمان وحدهم، بل كتبته لكل من يهمهم الامر عمومًا، ولا سيما للعرب. والحقيقة أنني حين كتبتُ هذا الكتاب، استفدتُ كثيرًا من كلّ تلك السنين، أو بالأحرى من كلّ العقود، التي كان لي فيها تعاونٌ واحتكاكٌ مع العرب؛ إذ ما كان بإمكاني أن أكتب هذا الكتاب لولا الأصدقاء العرب، ولولا تلك الرحلات العديدة إلى البلاد العربية، ولولا الأدب العربي والمفكرون العرب الذين قرأتُ لهم ودرستُ أعمالهم. لذلك، عندما يصدر الكتاب بالعربية، فإنني أشعر أنه يصل إلى وطنه.
د. حسام الدين درويش:
هذه جملةٌ مؤثرةٌ جدًّا، وأشكرك عليها جزيل الشكر؛ الكتاب يصل إلى وطنه.
دكتور رضوان، أنت اطلعتَ على الكتاب باللغة الألمانية، وراجعتَ النسخة العربية المترجمة. ما رأيك في ترجمة مثل هذا الكتاب، من حيث مضامينه، ومن حيث أهمية ترجمته إلى اللغة العربية؟
د. رضوان السيد:
كما قال المؤلف، فهو يعرف إشكالية الغرب في الفكر العربي، بحكم اطلاعه الواسع على الثقافة العربية، وعمله في نطاقها لمدة ثلاثين عامًا أو أكثر، مع أنه ليس كبير السن نسبيًّا. أما أنا، فعمري خمس وسبعون سنة، ولا شك أن اليابانيين لديهم إشكالية مشابهة، وكذلك الصينيون، وآخرون. لقد جئت إلى ألمانيا، وعمري اثنان وعشرون سنة، للدراسة في الجامعة.
يتضمن الكتاب قراءةً عميقةً من مفكّرٍ ألمانيٍّ لديه معرفةٌ كبيرةٌ، بالفعل، بخلفية الإشكالية، إشكالية الغرب عند العرب. وقد كتب هذا الكتاب، وهو ألمانيٌّ قُحٌّ، يعرف كيف يفكر الألمان في السر، وكيف يفكرون في العلن، وكيف صاروا أكثر باطنيةً، بعد الحرب العالمية الثانية، وكيف أصبحوا مكشوفين أكثر، لأنهم باطنيّون، أو يحاولون أن يكونوا باطنيين، أو يتظاهرون بأنهم أذكياءٌ أو خُبثاءٌ، كما يبدو الآن في الأزمة الحالية. كيف يبدو الأمر؟ الأمريكيون يسمحون بالتظاهر أمام الكونغرس وأمام قصر الرئاسة؛ أي أمام البيت الأبيض، بينما الألمان لا يسمحون بتظاهر بضع مئات من الأصوات العربية.
هذه الإشكالية العميقة، والعميقة جدًّا، يعبِّر عنها هذا الكتاب، بطريقةٍ متعددة الأبعاد: في الفكر الفلسفي، في التاريخ، في الاقتصاد، وفي الاجتماع، في تناول أسئلةٍ مثل: ما الإنسان؟ كيف يفهم الألماني الإنسان؟ وكيف يشتغل على الإنسانوية مع الآخرين، من العرب وغيرهم؟ وهو يعرف الآثار العربية جيدًا. ما كنتُ أعرف أنه يعرف التراث العربي القديم إلى هذا الحد، إلى درجة أنه ترجم المعلقات. وهو يعرف أيضًا الحداثة العربية، عبر أبرز أعلامها. وهو يضيف إلى معرفته منذ زمن، وإلا فكيف يُقبل على ترجمة المعلقات؟ وتجدر الإشارة إلى أن فريدريش روكرت Friedrich Rückert ترجم المعلقات إلى الألمانية شعرًا، قبل أكثر من مئتي عام، والآن هل ترجمها شتيفان نثرًا؟
أ. شيفان فايدنر:
نعم، ترجمةٌ حديثةٌ معاصرةٌ، لكن لها إيقاعٌ، لها أحيانًا قوافٍ، لكن ليس بأسلوب روكرت؛ لأن أسلوبه صعبٌ وغير معاصرٍ بالنسبة لنا.
د. رضوان السيد:
حاولتُ أن أقرأها مع البروفيسور مانفريد أولمان Manfred Ullmann، لا هو فهم، ولا أنا فهمت. فهذا الرجل، بعمقه الألماني والعربي، عرض، في هذا الكتاب، تجربةً شخصيةً وعلميةً وبحثيةً تتناول عمق الغرب وليس ألمانيا فقط؛ أي بروح أمريكا، وبروح إنجلترا، ولكن، بصورةٍ أخص ألمانيا وأمريكا، بحكم ما بعد الحداثة ومسألة التفكير في الدين في أمريكا، وتأثيرات الدين، وما ينعكس في أمريكا أكثر إبستيمولوجيًّا لدى الفرنسيين ولدى الأمريكيين أكثر من الإنجليز.
فأنا شديد الإعجاب بهذا الكتاب، وتخدمنا كثيرًا ترجمته إلى العربية؛ لأنه يمثل تجربةً لواحد من الألمان، ومنّا في الوقت نفسه؛ إذ يتنقل في الكتاب ذهابًا وإيّابًا بيننا وبين ألمانيا، بالألمانية العميقة، والهوية العميقة التي يتمثلها بطرائق كبيرةٍ وحديثةٍ وإنسانيةٍ.
د. حسام الدين درويش:
هذه شهادةٌ جميلةٌ جدًّا، فالكتاب والكاتب أشبه بالجسر بين الثقافات، إذن، فهو ألماني جدًّا، لكنه، في الوقت نفسه، عربيٌّ جدًّا، من حيث الثقافة والاطلاع والمعرفة. وهذه مسألةٌ غايةٌ في الأهمية، ولا سيما في الوقت الحالي، حيث نشهد تخندقًا بين أطرافٍ مختلفةٍ: فهذا يقول إنه ألمانيٌّ فقط، ولا يريد أن يكون إلا ألمانيًّا، وذاك يقول إنه عربيٌّ، لا يريد أن يكون إلا عربيًّا.
سؤالي كان أيضًا عن أهمية هذا الكتاب: هل له قيمة كلاسيكية، بحيث لا يكون مهمًّا في هذه اللحظة فقط، بل يكون مهمًّا في كل اللحظات. وبهذا المعنى يكون الكتاب عابرًا للتاريخ؟ ولا ينفي ذلك، طبعًا، أن الكتاب يحظى بأهمية خاصة في هذه اللحظة الحالية، حيث نشهد هذا الانقسام الاستشراقي والاستغرابي بين شرق وغرب، فيُظن أنهما لا يمكن أن يلتقيا، وأن لا وجود لخطابٍ مشتركٍ أو منظومة قيمٍ مشتركةً بينهما؟ ما رأيك، بشكل عام، أو بأيّ تفصيلٍ تراه مناسبًا، في أهمية هذا الكتاب في هذه اللحظة، حيث هناك هذا الخطاب بين شرق وغرب، وكلٌّ منهما له قيم مختلفة وعالم مختلف، ودائمًا صراعٌ فقط، من دون أيّ لقاءٍ أو حوارٍ؟
أ. شتيفان فايدنر:
صحيح، يعني ما نحتاج إليه هو أن نصل إلى وجهة نظر مشتركة، رغم كلّ الصراعات والتخندق، كما قلت. وهذا ما حاولت أن أشير إليه، إلى وجهة النظر هذه من خلال الكتابة. طبعًا، هذا مشروع طويل المدى، لكنني حاولت أن أقوم بالخطوات الأولى في اتجاه هذه النتيجة، وجهة النظر المشتركة هذه. لذلك، اخترت هذا العنوان، الذي يمكن ترجمته، من ناحية، ما وراء الغرب، ومن ناحية أخرى، ما بعد الغرب، أو ما خارج الغرب؛ يعني كلّنا، لا سيما أننا نحن، هنا في أوروبا، نتكلم عن الغرب، ونحن الغربيون. لا أعرف ما هو الغرب، لكن في النهاية، الغرب مفهوم محدود جدًّا. هناك هيمنة، هناك رأسمالية، هناك إمبريالية، وهناك استعمار؛ يعني مفهوم محدود للغرب. لذلك، حاولت أن أشير إلى كونية أوسع؛ أي إلى مفهوم كوني حقيقي. لذا، كتبت هذا الكتاب محاولًا السير في هذا الاتجاه، وأنا أرى أنه ضروريٌّ. لا أريد أن أقول إن الكتاب ضروريٌّ، بل المحاولة ضروريةٌ، على الأقلّ.
د. حسام الدين درويش:
وانطلاقًا من كون المحاولة ضروريةً، فإن الكتاب، بوصفه نتيجةًً لتلك المحاولة، ضروريٌّ أيضًا. وإذا سرنا في الاتجاه نفسه، دكتور رضوان، قبل ذلك، قلنا، في الكواليس، إن هذا الكتاب ضروريٌّ، فأين تكمن ضرورته؟
د. رضوان السيد:
هو وصفٌ لحالة التخندق الألماني والغرب، ووصف هذه الحالة هو محاولة للخروج منها، ومثل هذه المحاولات فشلت حتى الآن، سواء من جانب الفلاسفة والمفكرين، أو حتى من جانب الإنسانويين. العنوان بالألمانية يشير، كما قال شتيفان، إلى "ما وراء"، و"ما بعد" … إلخ. وباﻠ "ما وراء" يعني "كيف نشأ؟" و"ما هي أصوله؟". واﻠ "ما بعد" تعني أن الظواهر الإنسانية قابلةٌ للتغير والتجاوز، مهما كانت عميقةً. فهو اشتغل على الحفر، على الحفر في هذا العمق، عمق الشخصية الذي تسمي نفسها غربيةً، أو تدرك ذاتها هذا الإدراك. حفرٌ وكشفٌ بطريقة البحث الدقيق والحفر الدقيق، كأنه يحفر صخرةً بإبرةٍ.
على فكرة، في مؤلفاته السابقة، اشتغل على المشكلة نفسها، ولكنه كان يشتغل عليها كما بدت للمثقفين العرب وللروائيين العرب. أما الآن، فهو يشتغل عليها بوصفها ظاهرةً غربيةً، وبوصفها أمرًا غربيًّا. هذا اﻠ "West"، أو الغرب، ليس وهمًا صاغه العالم الثالث: العرب واليابانيون والصينيون…إلخ؛ بل، هو حقيقةٌ، هذا الغرب حقيقةٌ. ما فعله إدوارد سعيد، كان فيه مبالغة، ولكنه لم يكن مزيفًا في هذا الإدراك للاستشراق. وما يفعله، الآن، اليساريون المتطرفون هو إنكار الغرب كله، وإنكار حضارة العالم بوصفها غربيةً. هو يشتغل على الظاهرة نفسها، ولكن، بوصفه الغربي الذي لا يتبرأ من هويته؛ أي يحاول، وهو في داخلها، أن يفهمها، وأن يقرأها قراءة نقدية جذرية، ويتطلع، في محاولاتٍ لاحقةٍ بحثيةٍ أيضًا وعميقةٍ، إلى إمكانية إقامة تواصلٍ إنسانيٍّ أعمق مع العرب ومع الحضارات الأخرى، بشكلٍ عامٍّ.
د. حسام الدين درويش:
إذا استخدمنا لغة ماكس فيبر، يعني هو نزع، جزئيًّا، على الأقل، السحر من العالم، من الغرب. يعني أنه ينبغي ألا نبقى مسحورين برؤية الغرب بهذه الطريقة؟
د. رضوان السيد:
التشبيه غير دقيقٍ؛ لأن السحر عند ماكس فيبر هو سحر الدين؛ ونزع السحر يعني الخروج من الدين، لا. هو ليس مهتمًّا بهذه المسألة. هو مهتمٌّ بمسألة الهوية؛ يعني يُفهِم الغرب بقدر ما يُفهِمنا ما المشكلة بيننا وبين الغرب. الغرب كذا وكذا وكذا، وكلّ المحاولات للخروج لم تنجح حتى الآن، أيها العرب وأيها الآخرون. وهو يعتمد على ما يفهمه عمومًا، وما فهمه من صدمة الغرب عند المثقفين العرب. هذه هي المشكلة، كما أفهمها. وواضح من شرح ما فعله أنه سيتابع البحث.
د. حسام الدين درويش:
نزع السحر؛ بمعنى إزالة الفتنة المتمثلة في الاعتقاد بأن هذا الغرب عظيم، لكن من دون الوقوع في هذه الثنائية.
د. رضوان السيد:
لا، هذا قام قبله كثيرون بإزالة السحر عن الغرب، وفي نقد الغرب، وفي شتيمة الغرب، ما تركوا مصيبةً إلا وربطوها بالغرب.
د. حسام الدين درويش:
هنا الفرق، هو لا يشتم، ولا يقع في هذه الثنائية الاستشراق الاستغراب بين شرقٍ وغربٍ، وأن هناك قطيعةً ولا يمكن أن يلتقيا، على الطريقة التي ذكرت منذ قليلٍ. ولا يقول، على طريقة وائل حلاق مثلاً، إن هناك تمايزًا أو تغايرًا جذريًّا بين الإسلام والحداثة.
د. رضوان السيد:
عنده، الإنسانية واحدة، والتخندق الغربي، أو التخندق العربي، أو التخندق الأمريكي، أو التخندق الياباني، كلها أمورٌ غير مفيدةٍ، وتسبب نزاعاتٍ وحروبًا عبثيةً. هذه هي الأوهام، أنك أنت متميز، ولذلك عليك أن تشنّ حربًا.
د. حسام الدين درويش:
هنا تكمن أهمية الكتاب، في هذه اللحظة، أو في هذا الوضع الراهن.
د. رضوان السيد:
وهذه أهمية ترجمته إلى العربية، ليقرأه العرب، ويعرفون أن هناك تفكيرًا حقيقيًّا حافرًا، وأن عليهم أن يحفروا في نفسياتنا، وفي مشكلاتنا أيضًا، بتفكيرٍ تامٍّ. ولا نكتفي لا بالشكوى ولا بالإدانة، بل نحاول أن نفهم هذه العقد التي عندنا، ومع الآخر، وكيف يمكن الخروج منها.
د. حسام الدين درويش:
شكراً جزيلاً لك. هل لديك كلمة أخيرة، تريد أن نختم بها الحديث عن هذا الكتاب؟
أ. شتيفان فايدنر:
أود فقط القول إني شاكرٌ وممتنّ، وأتفق معكما، وأشكركما.
د. حسام الدين درويش:
ما الذي تقولينه لنا، دكتورة ميادة، عن ترجمة هذا الكتاب؟
د. ميادة كيالي:
أودّ أولاً أن أوجّه تحية خاصة للأستاذ حميد لشهب الذي تولّى الترجمة، وقد أسعدني كثيرًا أن أسمع من الدكتور رضوان هذه الشهادة الإيجابية في حق عمله.
وأتوقف هنا عند قضية الترجمة بحضور المؤلف والمترجم؛ فهي لم تكن تجربتي الأولى في الإشراف على مشروع من هذا النوع؛ إذ سبقتها تجربتي مع أستاذي الراحل الدكتور محمد شحرور، حين أشرفت على ترجمة أفكاره إلى الإنجليزية مع المترجم أندرياس كريسماس. كانت النقاشات بينهما عميقةً وقويةً. وأذكر كيف ساعد هذا التفاعل على خروج الترجمة بصورةٍ دقيقةٍ ووفيةٍ للفكر الأصلي. ومن هنا، أدركتُ مبكرًا أن نجاح الترجمة يتوقف على حضور المؤلف ومشاركته، إلى جانب المترجم والمُراجع المتخصص.
في هذه التجربة الثانية مع كتاب شتيفان فايدنر، تكرر المشهد بصورةٍ مختلفةٍ، لكن بالعمق نفسه: المؤلف حاضرٌ وفاعلٌ، والمترجم الأستاذ حميد لشهب قدّم جهدًا متميّزًا، ثم جاءت مراجعة الدكتور رضوان السيد لتمنح الترجمة ثقلها العلمي. تابعتُ هذه المراحل عن قربٍ، وحرصت على أن تحظى الترجمة أيضًا بحقِّها من التدقيق والتحرير الأكاديمي، لتكون، في صورتها النهائية، على مستوى مضمون الكتاب وقيمته الفكرية.
د. حسام الدين درويش:
كيف تم اختيار الكتاب للترجمة؟
د. ميادة كيالي:
اختيار الكتاب جاء بناءً على نصيحةٍ من الصديق الأستاذ مصطفى سليمان، عضو لجنة جائزة الشيخ زايد للكتاب. كنا نتابع إصدارات دار "هانسر"، وألمانيا كانت، آنذاك، ضيف الشرف في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب عام 2021. لفت انتباهي العنوان فورًا، وعندما أكد لي الأستاذ مصطفى أنه عمل يستحق الترجمة، ازددت اقتناعًا. وقد كانت نصيحةً ثمينةً بالفعل، حيث فتحت أمامي فرصةً مميزةً للتعرف عن قرب إلى فكر شتيفان فايدنر، وإلى نظرته العميقة، وعلاقته الخاصة بالشرق. وبالنسبة لي، كانت هذه التجربة من أجمل التجارب التي جمعت بين حسن الاختيار وثراء التعاون.
د. رضوان السيد:
عندما أخبرتني بذلك، قلت: هذا غير ممكن؛ لأنني كنت قد قرأت الكتاب حديثًا. وعندما استشارتني قالت لي: "حميد متحمّس جدًّا جدًّا جدًّا"، فقلت لها: "توكلي على الله، خلاص، مادام حسمتِ أمركِ، فلماذا لا تترجمين كتابًا عظيمًا ينبغي أن يعرفه العرب؟"
د. حسام الدين درويش:
وبعدها بدأت تتابع الترجمة العربية؟
د. رضوان السيد:
يا سلام! كم هي رائعةٌ هذه الترجمة التي قام بها حميد؛ في الحقيقة لم أجد فيها إلا قليلًا جدًّا من الملاحظات، وكانت ممتازةً.
د. ميادة كيالي:
والحقيقة، ساعدنا فريق التدقيق اللغوي والتحرير الأكاديمي، وكان الفريق أيضًا ممتازًا؛ فقد انتبهوا إلى الكلمات الصعبة التي ترجمها الدكتور حميد، وقالوا لي إنها ربما لم تكن مفهومةً كثيرًا، وهذا ما ساعدنا، ثم أكمل معنا الدكتور رضوان، الذي استطاع تجاوز جميع الصعوبات المتعلقة بالكلمات الصعبة.
د. حسام الدين درويش:
كانت الكلمات كثيرة وبُذلت جهودٌ كثيرةٌ.
د. رضوان السيد:
أعطتني نسخة مصورة من الكتاب الألماني، خوفًا من ألّا يكون متاحًا لديّ، وصوّرنا أول 150 صفحة، لأعرف محتوى العمل، وقارنتها بدقةٍ مع الترجمة، فتبيّن لي أنه دقيقٌ ولا يُسقط شيئًا. فصار تركيزي، بعد الصفحات الـ 150 الأولى، على الصياغة العربية ودقة المصطلحات.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا جزيلًا لكم جميعًا.