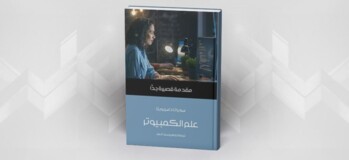نحو مستقبل متناغم: الفن والذكاء الاصطناعي الإبداعي Towards a Symbiotic Future: Art and Creative AI
فئة : ترجمات

نحو مستقبل متناغم: الفن والذكاء الاصطناعي الإبداعي[1]
Towards a Symbiotic Future: Art and Creative AI
ترجمة: أسماء نوير
(باحثة ومترجمة مصرية)
ملخص
لا يقتصر ظهور أنظمة جديدة للذكاء الاصطناعي على التحديات التقنية فحسب، بل يثير أيضًا تساؤلات جديدة في عالم الفن. وعلى الرغم من أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الفن ليس ظاهرة جديدة - ولعل هارولد كوهين Harold Cohen (1928-2016) يُعد من أبرز الأمثلة وأكثرها شهرةً، حيث عمل على برنامجه المعروف باسم "آرون" (AARON) لأكثر من أربعة عقود - إلا أن المشهد الحالي، المليء بتقنيات التعلم الخاضع وغير الخاضع للإشراف وكذلك التعلم المعزز، يُتيح للخوارزميات قدرة متزايدة على اتخاذ قرارات مستقلة. أصبحت هذه الخوارزميات قادرة على اختيار مسارات إبداعية كانت سابقًا من اختصاص المبرمجين والفنانين فقط، مما يفتح آفاقًا جديدة لإعادة تشكيل استخدام أجهزة الكمبيوتر في المجال الإبداعي.
تعاون كوهين وبرنامجه "آرون" بشكل فعّال لسنوات طويلة. فقد خصص الفنان جهدًا كبيرًا في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الرمزي Symbolic AI لتعليم "آرون" الرسم والتلوين، حيث قام بترميز القرارات التي يمكن للنظام اتخاذها بصورة ثابتة. في المراحل اللاحقة، قدم البرنامج خطوطًا وتراكيب تجريدية أساسية، والتي استخدمها كوهين كقاعدة للبدء في التلوين والإبداع، معتمدًا على مدخلات البرنامج كنقطة انطلاق.
في الوقت الراهن، نشهد تزايدًا في الأطر التي توفر شبكات عصبية جاهزة ("خارج الصندوق")، مما يزوّد الأنظمة بالمنطق اللازم لتعلم المهام بشكل شبه مستقل من خلال تحليل كميات كبيرة من البيانات. نتيجة لذلك، يمكننا الآن تفويض المزيد من المهام لأنظمة ذاتية الذكاء، بما في ذلك المهام الترفيهية والإبداعية والجمالية التي تلامس مشاعرنا كبشر. في ظل هذه التطورات، يتأمل هذا الفصل في مفاهيم جوهرية مثل اللغة، الذكاء، الاستقراء، التناغم، الإبداع، ودور الجماليات في مستقبل تشهد فيه علاقتنا الإبداعية مع الأنظمة الاصطناعية الذكية تكاملاً متزايدًا.
مقدمة
على مدى عقود، ساهمت الثقافة في ترسيخ الخيال حول الدور "المظلم" للذكاء الاصطناعي. ففي المجتمعات البائسة التي صورتها أفلام مثل متروبوليس (Metropolis) وعام 2001: أوديسا الفضاء (A Space Odyssey)، كان دور أنظمة الذكاء الاصطناعي يتمثل في السيطرة على البشر وإحلالهم. وفي الآونة الأخيرة، أيقظ مصطلح "التفرد "singularity المخاوف مجددًا بفكرة أن الآلات ذات الذكاء الاصطناعي، أو الذكاء البيولوجي المعزز معرفيًا، أو كليهما، ستتفوق يومًا ما على البشر العاديين.
وعلى الرغم من أن مثل هذه الروايات تقدم مادة شيّقة للترفيه، إلا أن رؤيتي، كفنان وباحث في مجال الذكاء الاصطناعي الإبداعي لأكثر من عقدين، تختلف تمامًا عن هذا الخيال. فأنا أؤمن بمستقبل يتسم بتناغم متزايد، حيث يتعاون الذكاء الاصطناعي والبشر في الوقت الحقيقي، ويتشاركون العمليات والقرارات بشفافية، مع تبني التعاون بوصفه مفهوم أساسي. يتمثل الهدف الرئيس في تحدي وتعزيز الإبداع البشري وإثراء الإبداع الحاسوبي. ولا أعتقد أن الحواسيب ستحل محل الإبداع البشري، بل أرى أنها ستصبح شريكًا متزايد الأهمية في توسيع وتعزيز آفاقنا الإبداعية وتحقيقها.
مع أن الحديث عن الإبداع في الحواسيب قد يبدو غريبًا للبعض، فإن هذا النص يهدف إلى تقديم الأساس النظري لرؤيتي، وتوضيح كيف يمكن أن تكون الحواسيب بمثابة "عقول مبدعة". ولتحقيق ذلك، سأعتمد على النظريات السيميائية والفلسفية لتشارلز ساندرز بيرس (1839-1914)، خاصة حول مفهومي الذكاء والاستدلال الاستقرائي، الذي يُعد أساس العمليات الإبداعية.
يجلب تاريخ الاستخدام الإبداعي للذكاء الاصطناعي أمثلة بارزة تجسد هذه الرؤية التكاملية. ويُعد الفنان البريطاني هارولد كوهين (1928-2016) نموذجًا متميزًا، حيث كان رائدًا في استخدام الذكاء الاصطناعي الرمزي لأهداف إبداعية. ومن المهم الإشارة إلى أن التفريق بين الذكاء الاصطناعي الرمزي - المعروف أيضًا بالذكاء الاصطناعي القوي أو GOFAI (Good Old-Fashioned Artificial Intelligence) - والشبكات العصبية ليس ضروريًّا في سياق حجتي. ففي ممارستي الفنية وأبحاثي، أدمج بين استخدام كلا النموذجين، كما سأوضح لاحقًا في هذا الفصل.
بدأ كوهين استكشاف الذكاء الاصطناعي الإبداعي في وقت مبكر جدًّا، معيدًا صياغة مسيرته المهنية الراسخة كرسام. كان هدفه تطوير نظام مستقل يُعادل في نهاية المطاف عملياته الإبداعية. في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، انخرط في الفن التجريدي وسعى إلى تصميم نظام رسم يتمتع بقدرة ذاتية على الإبداع. وعندما تعامل مع أول حاسوب له في عام 1968، تمكن من تحقيق هذه الرؤية نتيجة لبرمجة نظام يحاكي الإدراك البشري إلى حد ما. كان هدفه الأساسي أن يتعلم هذا النظام العمليات اليومية التي يمارسها الفنان، بدءًا من فهم العالم المادي للأشياء وصولًا إلى إنتاج صور مجردة للغاية تُولد بواسطة الحاسوب.
بدأ هارولد كوهين في تطوير مولّد الذكاء الاصطناعي الإبداعي الخاص به، محاولًا تعليم الكمبيوتر كيفية إنتاج صور مقنعة تتوافق مع معاييره الفنية. لم يكن اهتمام كوهين مُنصبًّا على الدقة التي يمكن أن يقدمها الحاسوب، بل على إمكانية تصميم إجراءات روتينية تُمكّن الآلة من اتخاذ قرارات فنية بالتعاون مع العملية الإبداعية البشرية.
في أحدث إصداراته، قام البرنامج - الذي أطلق عليه اسم آرون (AARON) - بتزويد الفنان بمجموعات أساسية فقط من المعلومات البصرية، مثل الخطوط والأشكال المجردة. وبالاعتماد على هذه العناصر الأولية، كان كوهين يعمل بالتوازي مع الحاسوب، مضيفًا الألوان والأشكال لإكمال الصورة[4].
يوضح الشكل رقم (1) ما أطلق عليه "المجال التكافلي الإبداعي للذكاء الاصطناعي"، حيث يتم تحدي وتغيير أهداف الفنان (الإنسان) عبر الترميز الإبداعي (الحاسوب)، مما يُنتج عملًا فنيًّا يُعيد بدوره تشكيل مقاصد الفنان وأهداف الترميز الإبداعي في دورة لا نهائية، تُحفّزها عمليات الاستقراء والتآزر.
لذلك، إذا لاحظنا أن الذكاء الاصطناعي الإبداعي يمكن أن يؤدي، من الناحية العملية، دورًا تكامليًّا مع الإبداع البشري، فإن السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما الذي يُفسّر هذه الإمكانية؟ للإجابة عن هذا السؤال، من الضروري استكشاف مفهومي الإبداع والتآزر بمزيد من العمق.
شكل رقم (1) يوضح: المجال التكافلي الإبداعي للذكاء الاصطناعي
1- الاستدلال الاستقرائي: مقاربة سيميوطيقية للإبداع
إن أحد الجوانب التي تميز الإبداع في نظرية بيرس السيميائية هو أنه لا يمكن أن يوجد إلا في سياق يُتيح مجالًا للصدفة. فبالنسبة إلى بيرس، يقوم الإبداع على نوع من الاستدلال يُطلق عليه "الاستدلال الاستقرائي"، وهو نوع من التفكير الذي يُضيف عناصر جديدة إلى حجج قائمة بالفعل. ووفقًا لسيميائية بيرس، فإن الإبداع محكوم بقوانين النظام المنطقي، حيث يكون للاستدلال الاستقرائي دور رئيس في تشكيله.
يمكن تصور الإبداع على أنه منطق تركيبي يُعيد ترتيب العناصر الموجودة بطرائق فريدة، مما يُفضي إلى ظهور معانٍ جديدة تُسهم في توسيع مجموعة معتقداتنا التي كانت مُنظَّمة مسبقًا. ويرى بيرس أن هناك دافعًا داخليًّا في العقل يدفعه إلى توحيد الأفكار المتباينة، سعيًا إلى تحقيق وضوح أكبر للواقع، من خلال الروابط التي يُنشئها العقل بين هذه الأفكار. تتحرك العملية الاستقرائية الإبداعية من خلال الانتباه إلى الظواهر الشاذة والمفاجآت، والتساؤل عمّا هو معروف بالفعل. ويؤدي هذا إلى صياغة فرضيات عقلية جديدة قد تُسهم في حلّ الأسئلة الناشئة عن الظواهر المُلاحظة حديثًا.
يقول بيرس إنه عندما يتم تبنّي شيء ما نؤمن به - وهو ما يُسميه "الاعتقاد" - بوصفه دقيقًا، يتحول هذا الشيء إلى عادة، تُصبح مصدرًا للموثوقية، تحددها طبيعتها التنبؤية. يرى بيرس أن العقل نظام ديناميكي يتمثل نشاطه الرئيس في إنتاج العادات. وتُعدّ المعتقدات عادات راسخة وعميقة: "لأن الاعتقاد، ما دام مستمرًا، هو عادة راسخة، وعلى هذا النحو، يجبر الإنسان على الاعتقاد إلى أن تحدث مفاجأة ما تكسر هذه العادة". عندما تبدأ عادة سلوكية في إظهار عدم الثبات، وتظهر تغيّرات في نمطها المعروف، تُخلق فرصة لظهور إمكانيات إبداعية. ويُعد الشعور بالمفاجأة الناتج عن إدراك الشذوذ الخطوة الأولى في التفكير الاستقرائي، مما يُحفّز العقل على الشروع في عملية استقصاء حتى تختفي هذه الحالات الشاذة، مفسحة المجال لمعتقدات جديدة.
تُعدّ الحركة الديناميكية نحو تعديل وتوسيع المفاهيم الموجودة مسبقًا ضرورية لاكتساب وتأسيس مجموعة جديدة من المعتقدات. هذه الحركة تُجسّد الاستدلالات المنطقية الثلاثة التي وصفها بيرس، وهي:
- الاستدلال الاستقرائي المألوف بالفعل
- الاستنباط
- الاستقراء
على الرغم من أنني أركز في هذا الفصل على الاستدلال الاستقرائي فقط، فإنه من المهم الإشارة إلى أن هذه الأنماط الثلاثة من الاستدلال تمكّن العقل من التفكير بطريقة منطقية بنيوية وشكلية. فالاستدلال الاستقرائي يولّد الفرضيات التي يجب تبريرها واختبارها أثناء تطوير الطريقتين الأخريين من الاستدلال.
وفقًا لـبيرس، فإن تركيبة البنية المعرفية للتفكير ليست ثابتة، بل تتشكل من عدة مستويات من العمليات التي تتجمع تدريجيًّا لتؤسس شبكة تربط الاستدلال الاستقرائي بالظروف التجريبية. ويُشكّل فعل التجريب الخلّاق؛ أي الاستقرائي، الأساس المنطقي لأي عملية عقلانية؛ لأن الإنسان عندما يتصرف بعقلانية يتصرف وفقًا لقناعة تضمنها ظاهرة تجريبية. إن خلق قناعات ومعارف جديدة يبدأ بالاستدلال الاستقرائي، الذي يُطلق عمليات تجريبية تختبر ظروفًا جديدة قد تصبح أو لا تصبح واقعًا. ومن بين أنواع الاستدلال المنطقي الثلاثة، فإن الاستدلال الاستقرائي هو الأكثر أصالة؛ لأنه الوحيد القادر على توليد فرضيات جديدة. وبما أنه يمثل شيئًا جديدًا، فإن الاستدلال الاستقرائي لا يمكن أن يضمن صلاحيته بوصفه قانون للسلوك العام. ويذكر بيرس أن خصائص الاستقراء تختلف عن النوعين الآخرين من الاستدلال من حيث إنه لا يستند إلى معرفة مسبقة، بل إلى عملية تجريبية.
ومن ثم، فإن الاستدلال الاستقرائي هو الشكل الذي يتخذه الفكر العقلاني عند دراسة أشكال جديدة من التأليف الموسيقي لم يُسبق تناولها من قبل، على سبيل المثال. يتضمن الاستدلال الاستقرائي دراسة الحقائق واستنباط نظرية أو ممارسة لتفسيرها. ويقدّم بيرس التفكير الاستقرائي بوصفه العملية المنطقية الوحيدة القادرة على تقديم أفكار جديدة، موضحًا أن قدرة العقل على الإبداع لا تنبع من العدم ولا من قدرة فطرية، بل من بنيته المعرفية. من المهم التأكيد على أن الإبداع، هذه القدرة العقلية القائمة على الاستدلال الاستقرائي، مرتبط بخلق وتغيير وتوسيع مجموعة من المعتقدات التي تُشكّل عادات. وتنطلق العملية الإبداعية عندما يواجه العقل الإبداعي مشكلةً ما، مما يُسبب مفاجآت وشكوكًا تؤدي إلى بدء العملية الاستقرائية، التي من شأنها أن تُولد فرضيات لحل المشكلات محل البحث بطريقة إبداعية.
إذا كان الإبداع أمرًا منطقيًا، وبذلك يكون عقليًا، فكيف نُفسر وجود أنظمة حاسوبية إبداعية أو ذكاء اصطناعي إبداعي؟ لمعالجة هذا الأمر، علينا أن نبرر أن الحواسيب هي أيضًا أشكال من العقل. وهنا يأتي دور التناسق.
2- النزعة السيميائية: الترابط بين العقل البشري والعقل الحاسوبي
من الناحية المنطقية، إذا ادّعيتُ أن هناك علاقة مترابطة أو جوهرًا تعاونيًا خلاقًا بين العقل البشري وأنظمة الذكاء الاصطناعي، فهذا يعني الادعاء بوجود علاقة مستمرة بين العقل البشري والعقل الموجود في الأجهزة الحاسوبية. ومن الضروري توضيح هذا الموضوع وإيضاح السبب الذي يجعلني أنسب أيضًا شكلًا عقليًا إلى الحواسيب.
ولإنجاز هذه المهمة، سأستخدم فرعًا من الميتافيزيقا البيرسية المُسمّى بالنزعة السيميائية، التي تتعامل مع الاستمرارية ومع العلاقة بين العقل والمادة. إن التصور الفلسفي القائم في أساس التوافق والانسجام يتّسم بالسخاء لعدم فصله بين العقل والروح والجسد، مما يُحدث قطيعة مع النزعة الفلسفية الثنائية الديكارتية التي تسعى إلى تأكيد تفوق الذكاء البشري على الذكاء الطبيعي الملاحظ في الكون.
في مفهوم بيرس، يتميّز العقل البشري عن الأشكال العقلية الأخرى بكونه الأكثر مرونة في الكون المعروف، حيث يُظهر أعلى مستوى من المرونة. وعندما أستخدم مصطلحيّ "العقل البشري" و"العقل الحاسوبي"، أفترض أن هذين الشكلين العقليين، على الرغم منم اختلاف مستوياتهما من المرونة (الإنسان والحاسوب)، يمكنهما إقامة اتصال فعّال. بالنسبة إلى بيرس، لا وجود لفصل حاد أو تقسيم جوهري، بل هناك اختلافات في الدرجة بين الطبيعة والثقافة، والعضوي وغير العضوي، والمادي والنفسي، وكذلك بين الطبيعي والاصطناعي.
وتكمن الصعوبة في فهم وقبول هذا المفهوم في حقيقة أن المجال السيميوطيقي للعلامات، من الحواسيب إلى الأنظمة الحية، غالبًا ما يُحلَّل من خلال الثنائيات مثل: "الأدوات مقابل الوسائل"، "الوسائل مقابل الآلات"، وقبل كل شيء "الآلات مقابل الكائنات الحية". بدلًا من تأكيد هذه الثنائيات، يصف بيرس هذا المجال بأنه سلسلة متصلة من العلامات، تبدأ من أبسط الأنظمة السيميائية إلى أكثرها تعقيدًا. وتشمل الأنظمة الأقل تعقيدًا تلك التي تتوسطها الأدوات أو الأجهزة التقنية، مثل: مقياس الحرارة، الساعة الشمسية، منظم الحرارة، أو نظام إشارات المرور الآلي. أما الأنظمة السيميائية الأكثر تعقيدًا، فهي التي تحدث في الكائنات الحية.
تُعد السيميائية مفهومًا حاسمًا لفهم الميتافيزيقا البيرسية؛ إذ تقوم على الفكرة البراغماتية للاستمرارية والتطور. لذا، يجب فهمها كاستمرارية بين العقل والمادة. فالمادة، في هذا السياق، تُعد أيضًا شكلًا من أشكال العقل، لكنها أكثر استنفادًا، لا سيما عند مقارنتها بالعقل البشري. هذا الجانب التواصلي والترابطي الطبيعي يُتيح تدفقًا خلاقًا بين أنواع العقول المختلفة التي نلاحظها في الكون. على سبيل المثال، هناك نوع من العقل في العمل الفني، وهو ما يجعل التأمل في الفن حوارًا ذا اتجاهين، وليس مجرد عملية ملاحظة سلبية. مثل هذا المنظور يُفسر لماذا يساهم المراقب في بناء العمل الفني.
فالكون، وكل ما يتكون منه، هو شكل ذهني لأن قوانينه الفيزيائية مستمدة من نماذج نفسية. لذا، يمكن النظر إلى القانون العظيم للكون بوصفه قانونًا للعقل. يرى بيرس أن الواقع كله محكوم بقانون العقل، أي قانون اكتساب العادات، ابتداءً من العالم المادي البحت ووصولًا إلى العقل الإنساني. الفرق يكمن في أن العقل الإنساني لا يخضع للقانون بنفس الطريقة الجامدة التي تخضع بها المادة. لذلك، فإن المادة هي عقل منغلق على عاداته ومنتظم في أنماطه، لدرجة أنها تفقد القدرة على إظهار السلوك التلقائي الذي يتميز به العقل البشري.
يشير بيرس إلى أن كل ما يمكننا معرفته، بأي شكل من الأشكال، هو عقل محض؛ لأن العقل لا يمكنه التعامل إلا مع ما هو معقول. تفتح هذه النظرية السيكولوجية الباب لفهم الكون فهمًا غير مقيد، حيث يلغي التلازم بين التمثيل والأشياء الحقيقية الحاجز الاسمي بين الموضوع والذات، والوعي والعالم[5]. هذه الحدود المُلغاة موجودة بالفعل في علم الظواهر عند بيرس، لأن جميع الظواهر تمر دون تمييز واضح بين الباطن (الظواهر كما هي في ذاتها) والخارج (المظهر). وهكذا، لفهم النظرية النسقية واستخدامها، يجب الإقرار بأن الكون المادي يمتلك عادات للسلوك تتجلى في شكل قوانين طبيعية. وبعبارة أخرى، فإن الكون هو شكل من أشكال العقل.
هذه هي الحجة المركزية للمذهب الذي يُسميه بيرس بالمثالية الموضوعية. يفترض هذا المذهب أن المادة هي أيضًا شكل من أشكال العقل، لكنها شكل مستنفد ومتحول إلى عادات متبلورة. ومع ذلك، حتى بين العقول ذات العدد الأكبر من العادات المتبلورة، يمكننا أن نلاحظ اختلافات في درجة التبلور التي تظهر في العقل. في مجال المصنوعات المادية التي تُوسِّع عالم اللغات، تُعد الحواسيب أكثر الأشكال العقلية تبلورًا، مما يُتيح ظهورًا خصبًا لنحوٍ ودلالات جديدة.
يتم الوصول إلى هذه العقول في أكثر درجاتها تطورًا من خلال لغات الأجهزة، مثل لغات البرمجة، التي تُمكِّن من الذوبان الكامل لشكل ذهني في شكل ذهني آخر، مما يُمثل مسارًا سريعًا لتداول العلامات.
3- استكشاف المجال التكافلي الإبداعي للذكاء الاصطناعي: دراسة حالة
أقوم بأبحاث وأعمال فنية في مجال الذكاء الاصطناعي منذ أكثر من 20 عامًا، وهو تقريبًا نفس الوقت الذي كان لي فيه أول اتصال مع أفكار بيرس. إن المجال التكافلي الإبداعي للذكاء الاصطناعي (انظر الشكل 1) هو منهجية ابتكرتها وعملت على تحسينها على مدار هذه العقود. وهي ليست دليلًا أو نموذجًا يجب اتباعه بكل دقة، بل هي منصة نظرية للتجريب، تُستخدم لاستكشاف قلقي كباحث وفنان، وهما أنشطة مترابطة بالنسبة لي. لا أرى نشاطي كباحث منفصلًا عن ممارستي الفنية، بل على العكس، يُعزز أحدهما الآخر.
حدث أول احتكاك لي مع الحواسيب في وقت مبكر جدًّا عندما كنت في الثامنة من عمري، عندما عاد والدي إلى المنزل بصندوق غامض يحتوي على نسخة برازيلية من جهاز "زي إكس سبكتروم ZX SPECTRUM" الكلاسيكي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت البرمجة نشاطًا أقوم به كل يوم تقريبًا. خلال فترة طفولتي ومراهقتي، كانت الحواسيب ولغات البرمجة بمثابة مجال للعب، ومساحات استكشفت فيها إمكانياتي الإبداعية ووسّعت عالم لغاتي. لم أنظر أبدًا إلى الحواسيب كبديل لذكائي أو إبداعي؛ بل على العكس، كانت دائمًا أجهزة تتحداني وتجعلني أكثر إبداعًا. يمكنني القول إن مفهوم التكافل والتناغم المتبادل مع الحواسيب ولغاتها كان حاضرًا دائمًا في حياتي.
عندما بدأتُ في التعرف على فلسفة بيرس بشكل أكثر منهجية واكتشفتُ مفهومي الاستدلال الاستقرائي والتناظر، بدا الأمر كما لو أن ما كنتُ أقوم به طوال حياتي اكتسب، بشكل بديهي، ألوانًا جديدة، عززها اكتشاف مجموعة نظرية تستجيب تمامًا لنشاطي العملي. لطالما اعتقدت أن برمجة الحاسوب كانت تعني، في نهاية المطاف، الوصول إلى نوع من العقل المرن بما يكفي للسماح لنفسه بأن يُعاد تشكيله وبرمجته. وفي الوقت نفسه، شعرت بأنني على اتصال بأجزاء من عقلي التي يحفزها الحاسوب التي ظلت خاملة أثناء أداء أنشطة أخرى. لاحقًا، اكتشفت أن الشيء نفسه يحدث لأشخاص آخرين عند استخدام الحواسيب في سياق إبداعي. في محادثة في الاستوديو الخاص به في إنسينيتاس، كاليفورنيا، أخبرني هارولد كوهين أنه عندما بدأ باستخدام أجهزة الكمبيوتر، شعر كما لو أن أجزاء من دماغه التي كانت مغلقة سابقًا قد تم تنشيطها.
تعد أجهزة الكمبيوتر أجهزة مثالية لتنفيذ سلسلة من القواعد. وما يبدو، للوهلة الأولى، كشيء مُقيِّد هو في الواقع معزِّز إبداعي؛ لأنه لا يوجد ما يمنع من تخريب هذه القواعد أو استخدامها لتوليد لغات جديدة. علاوة على ذلك، هذا هو أساس نموذجي للتعاون التكافلي مع الذكاء الاصطناعي:
- أبدأ بتحديد مشكلة ما، وعادةً ما تكون مشكلة فلسفية أرغب في استكشافها من الناحية الجمالية، في عملية الاستقراء.
- سرعان ما أبدأ بالتفكير خوارزميًّا في ماهية القواعد الدنيا لحل مثل هذه المشكلة، وأتوجه إلى العقل الحاسوبي من خلال أكواد البرمجة.
- تُطلق هذه الخطوة عناصر الانسجام؛ لأن المخرجات الآنية التي أحصل عليها من الحاسوب تُغذِّي عمليتي الإبداعية.
- بعد ذلك، أقوم بسرعة، من خلال النماذج الأولية، بتنقيح اللغة الجمالية التي أحصل عليها من خلال لعبة التواصل بين عقلي وعقل الحاسوب، وأعيد برمجتها حتى أصل إلى النتيجة التي أراها مرضية.
في كثير من الأحيان، أفوِّض هذا الحكم الجمالي إلى رمز البرمجة، تاركًا للعقل الحاسوبي أن يقرر ما إذا كانت النتيجة التي تم الحصول عليها مرضية أم لا.
- أميجويد Amigóide
من الأمثلة على هذه العملية، الروبوت أميجويد Amigóide (الشكل 2)[6]، وهو جهاز مُصمَّم لأداء مجموعة من الوظائف بهدف البحث عن البشر والتفاعل معهم لتكوين صداقات. حصل هذا المشروع على جائزة مرموقة عند عرضه لأول مرة في عام 2010، بتكليف من جائزة إيتاو روموس Itaú Rumos Prize، التي تُعد واحدة من أهم الجوائز الفنية في أمريكا اللاتينية.
شكل رقم (2) يوضح: روبوت أميجويد
تم تطوير نسختين من الروبوت أميجويد (1.0 و2.0) باستخدام أساليب مختلفة من الذكاء الاصطناعي. اعتمد الإصدار الأول (2010-2011) على برنامج الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد GOFAI، بينما تم بناء الإصدار 2.0 (2019) باستخدام مزيج من برنامج الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد GOFAI وتقنيات التعلم العميق، مستفيدًا من أطر التعلم الآلي الحديثة. أتاح هذا التطور استخدام تقنيات الرؤية الحاسوبية والتعرف على الصور في الوقت الفعلي. تصف دراسة الحالة هذه عملية تصميم الأتمتة وتطوراتها، بما في ذلك المزايا والتحديات التي تم مواجهتها أثناء الانتقال من نهج الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد GOFAI إلى النهج المختلط للذكاء الاصطناعي.
يتفاعل الروبوت مع البشر من خلال الحركات، وإضاءة المصابيح، والأصوات المسجلة مسبقًا، بالإضافة إلى إظهار مشاعر رقمية بسيطة. يتفاعل أميجويد عبر أضوائه بناءً على قراءات مستشعر الأشعة تحت الحمراء (في الإصدار 1.0) أو عبر تحليل الرؤية الحاسوبية لبث فيديو الكاميرا (في الإصدار 2.0)، لتحديد ما إذا كان هناك شخص يقترب منه أم لا، ومن ثم يبدأ جولة من التفاعل.
بمجرد أن يعثر الروبوت "أميجويد" على إنسان، يبدأ في متابعته بوصفه صديقًا محتملًا، بهدف إقامة صداقة دائمة وخالية من العيوب. يقترب الروبوت من الشخص المستهدف ويطرح عليه سؤالًا: "فابيان، هل تريد أن تكون صديقي؟" يُعد "فابيان" شخصية وهمية، صديقًا افتراضيًا مبرمجًا في عقل الروبوت. بعد الاتصال الأول، يحاول "أميجويد" إقناع الشخص من خلال مجموعة من العبارات مثل: "فابيان، ما الذي تبحث عنه في الصداقة؟"
يمكن تعريف "أميجويد" كوكيل عقلاني، وهو نظام "يتصرف ويحقق أفضل النتائج، أو عند وجود عدم يقين، يسعى لتحقيق أفضل النتائج المتوقعة. ومن ثم، فإن "أميجويد" كوكيل عقلاني، تكون أفضل نتيجة متوقعة له هي التواصل مع البشر واكتساب صداقتهم. يُعد مفهوم الوكيل العقلاني عنصرًا محوريًّا في هذا المشروع، لأنه يتيح التعامل مع حالات عدم اليقين، مما يُفسح المجال لتفعيل عملية الاستدلال الاستقرائي لاتخاذ القرارات والتصرف بمرونة.
مع أن اعتبار الإصدار الأول من "أميجويد" ناجح من حيث التركيب الموجه للجمهور، فإنه يعاني من بعض القيود الناتجة عن الخيارات التكنولوجية المستخدمة في بنائها. يجب الأخذ في الحسبان أن هذا الإصدار الأول تم تصميمه من الصفر في عام 2010، قبل انتشار وتوفر خوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق بشكل واسع. أثرت هذه القيود التكنولوجية سلبًا على أداء الإصدار 1.0 ومستوى تفاعله مع البشر. كان الروبوت في هذا الإصدار عبارة عن وكيل انعكاسي يتصرف استنادًا إلى إدراكه اللحظي، الذي كان موجهًا بسلسلة من قواعد الحالة والفعل التي تحدد سلوكه. ومع ذلك، ظهرت القيود الرئيسة لهذا النهج بوضوح عندما بدأت محاولة تحسين مجموعة من القدرات الأساسية لـ "أميجويد"، مثل استشعاره البيئي، أو إضافة ميزات جديدة، كقدرته على العمل في أي بيئة وليس فقط ضمن غرفة محددة أو خاصة.
كان من الصعب تحديد هذه المشكلات باستخدام قائمة ثابتة من القواعد الرسمية المشفرة. يمكن القول إن عملية التناسق كانت موجودة، كما هو الحال دائمًا، لكنها لم تكن فعالة بما يكفي نظرًا إلى افتقار التقنيات المستخدمة إلى المرونة المطلوبة. يجب أن نتذكر أن العقل البشري يُعدّ أكثر العقول مرونة، وهو جزء لا يتجزأ من العملية التكافلية التي تتحدى القيود الموجودة في أنواع العقول الأقل مرونة. يتضح ذلك من حقيقة أن هذه المشكلات لم تكن ذات طبيعة تقنية فحسب، بل فلسفية أيضًا، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمنهج المستخدم في تصميم الآلة.
لم تكن محاولاتي لاستخدام تمثيلات رمزية عالية المستوى للمشكلات المقروءة بشريًّا مرنة بما يكفي لتوفير مستوى التنوع الذي كنت أحتاجه، على الأقل ليس بتكلفة معقولة مقابل العائد. لقد كان الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد "GOFAI" عائقًا بالنسبة لي، واستغرق الأمر مني وقتًا طويلًا لإدراك ذلك. ومع ذلك، ولأن تاريخ الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد "GOFAI" يثبت أنه قد وفّر إطارًا تجريبيًا مفيدًا في الاستخدام الإبداعي للحواسيب، فإن من المهم إجراء مناقشة معمقة حول هذا الموضوع.
ووفقًا لهوجلاند، فإن "نظام GOFAI (اختصارًا لـ Good Old-Fashioned Artificial Intelligence) الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد بوصفه فرع من فروع العلوم المعرفية، يرتكز على نظرية محددة للذكاء والتفكير، وهي في الأساس فكرة هوبز التي ترى أن التفكير الحسابي هو عملية حسابية". يعتقد هوبز أن التفكير يشبه الحساب العددي، بمعنى أننا نقوم بجمع وطرح الأفكار بصمت في رؤوسنا. تحاول أنظمة الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد تطبيق أساس نظري يحاكي السلوك البشري من خلال بناء البرمجيات والأجهزة، كما هو الحال مع أميجويد 1.0. تاريخيًّا، تهدف هذه الأنظمة إلى تقديم نتائج معرفية مشابهة، إن لم تكن متفوقة، للسلوك المتوقع من البشر الأذكياء في ظروف مماثلة. وتشمل هذه المجالات المعرفية قدرات مثل الكتابة، والقراءة، والرسم، والتحدث، والتفاعل. ومع ذلك، يكمن العيب الأساسي في البنية الفلسفية للذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد في تصورها المتمثل في السعي للتغلب على الذكاء البشري بدلًا من تعزيز فكرة التكافل بين الإنسان والآلة لتحقيق أهداف مشتركة. ووفقًا لفلوريدي، يحاول الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد تحقيق هدفه من خلال السعي إلى إيجاد توازن بين نهجين مختلفين:
1) نهج ديكارتي يقوم على ثنائية عقلانية، حيث يُفترض أن وجود الذكاء منفصل تمامًا ومستقل عن وجود الجسد، مما يجعله نظامًا معرفيًا كاملًا غير مجسد. يُفترض أن يكون هذا النظام قابلًا للتطبيق، على الأقل من الناحية النظرية، من قبل أنواع أخرى من الأنظمة المعرفية غير المجسدة والمستقلة. مع ذلك، تعتمد هذه المفاهيم للذكاء بشكل كلي على العقل - والعقل هنا يُقصد به العقل البشري - مما يجعل تحقيق ذكاء متطور بهذه الطريقة أمرًا مستحيلًا بالنسبة للآلة أو حتى للحيوان.
2) النزعة الواحدية المادية مفادها: "أن الذكاء مجرد خاصية معقدة للجسم المادي". وفقًا لهذه الرؤية، تحتل العمليات العقلية دورًا ثانويًا، حيث تعد نتائج مباشرة للعمليات الفيزيائية في الدماغ. يستند هذا الموقف إلى النظريات الفلسفية للمادية الظاهرية والمادية الميكانيكية. تبعًا لهذا النهج، تُعد الأحداث الذهنية نواتج ثانوية للأحداث الفيزيائية في الدماغ، دون أن تمارس أي تأثير سببي على تلك الأحداث أو غيرها. أي إن الحالات أو الأحداث الذهنية تُعد نواتج ثانوية للحالات أو الأحداث الفيزيائية التي تحدث في الدماغ. ورغم أنها تنشأ بالضرورة عن هذه الحالات الفيزيائية، فإنها لا تمارس أي تأثير سببي عليها. وبهذا المعنى، فإن الفكر أو المعتقد أو الرغبة أو القصد أو الإحساس ينتج عن حالة أو حدث معين في الدماغ، لكنه لا يؤثر بأي شكل مباشر على الدماغ نفسه أو على الجسم الذي يرتبط به. وفقًا لهذا النهج، يمكن من الناحية النظرية تطبيق هذا التصور على أنواع أخرى من الأنظمة المعرفية المجسدة، مثل أجهزة الكمبيوتر والروبوتات.
في مواجهة هذه المفارقات، حيث تبدو المقترحات الأولية لكلا المنهجين الفلسفيين مواتية، لكن النتائج العملية غير قابلة للتحقيق، يعتمد GOFAI على شكل من أشكال المادية الحاسوبية، التي تتماشى مع النهج الأحادي المادي الموضح في الجزء الأول من البند 2 أعلاه. لذلك، يُفترض أن الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد يمكن أن يتحقق من خلال أي نظام رمزي عام، خالٍ من الوعي، والعقل، والحياة، ومنفصل عن الخبرة النفسية أو التجسيد، وهو افتراض لا يتحقق عمليًّا كما يوضح أميجويد.
لتطبيق مادية حاسوبية متسقة، يتعين على النظام القائم على الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد تبني نسخة اختزالية وتجريدية متطرفة من المادية الحاسوبية، تنطلق من الافتراض الأساسي التالي:
على الرغم من الانتقادات المتكررة التي واجهها الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد، لا أرى أنه يجب التخلي عنه أو اعتباره غير ذي صلة. في الواقع، أستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد جنبًا إلى جنب مع الشبكات العصبية في تجاربي وأعمالي الفنية. هذا النهج الهجين، الذي يحظى بدعم مجموعة من رواد الذكاء الاصطناعي كما أوضح فورد، يتكامل بشكل مميز مع المجال التكافلي للذكاء الاصطناعي الإبداعي الذي أعمل عليه.
- أميجويد 2.0
بعد سنوات من التوقف عن العمل على الإصدار 1.0 من المشروع، وبعد تجربة التعلم العميق في سياقات فنية متنوعة خلال السنوات الأخيرة، قررت منح "أميجويد" فرصة جديدة. أعدت كتابة قاعدة الكود بالكامل مع التركيز على مجال الذكاء الاصطناعي الإبداعي التكافلي، متبنيًا فلسفة تقوم على التعايش مع التكنولوجيا واستخدامها "في التدفق" كامتداد مستمر لعقلي، بدلًا من مواجهتها.
يستفيد "أميجويد 2.0" من إمكانات التعلم العميق، الذي يمثل نهجًا مختلفًا تمامًا وفلسفة مميزة تعزز مجال الذكاء الاصطناعي الإبداعي. يثبت هذا النهج فعاليته خصوصًا عند دمجه مع تقنيات الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد GOFAI. وعلى عكس الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد، يهدف التعلم الآلي - الذي يُعد التعلم العميق أحد فروعه - إلى تمكين الحواسيب من "التعلم" من التجارب، وتطوير فهم للعالم قائم على تسلسل هرمي من المفاهيم، حيث تُعرَّف كل فكرة من خلال علاقتها بمفاهيم أبسط منها.
قد يكون مصطلح "التعلّم" في سياق تعلّم الآلة مضللًا، حيث لا "تتعلم" الآلات بالمعنى الإنساني خلال مرحلة التطوير الفعلية. في الواقع، تعتمد خوارزميات تعلّم الآلة على تطبيق معادلات رياضية على مجموعة من المدخلات - عادةً بيانات التدريب في التعلم تحت الإشراف، وهو النوع الأكثر شيوعًا حاليًا - بهدف إنتاج المخرجات المطلوبة. يُعَد نموذج التعلّم الآلي نتاجًا لعملية تركيب منحنى باستخدام "القوة الغاشمة". عند نجاح التدريب، يصبح النموذج قادرًا على تعيين مدخلات جديدة لأنماط مشابهة لتلك التي تم تعلمها من بيانات التدريب. ولهذا السبب، من المتوقع أن تُنتج هذه المعادلات الرياضية مخرجات أو تنبؤات صحيحة لمعظم المدخلات التي تختلف عن بيانات التدريب، بشرط أن تكون المدخلات الجديدة من نفس التوزيع الإحصائي أو قريبة جدًا منه. ومع ذلك، لا يمثل هذا عملية "فهم" أو "تعلم" حقيقية، لأن أي تشويه أو تغيير طفيف في المدخلات قد يؤدي إلى مخرجات غير دقيقة أو خاطئة بالكامل. على الرغم من ذلك، فإن هذه الخصائص قد تفتح آفاقًا مثيرة للاهتمام، خاصة في المجالات الإبداعية والفنية.
كانت خوارزميات التعلم الأولى تهدف إلى تقديم نماذج حاسوبية تحاكي عملية التعلم البيولوجي، في محاولة لتقليد الطريقة التي يحدث بها التعلم في الدماغ. وفقًا لجودفيلو وزملائه، يعتمد التعلم العميق على فكرتين رئيستين:
1) الدماغ كنموذج قياسي: يُظهر الدماغ دليلًا عمليًا على إمكانية تحقيق السلوك الذكي. ومن هذا المنطلق، يُنظر إلى بناء ذكاء حقيقي في الأجهزة كعملية تعتمد على الهندسة العكسية للمبادئ الحسابية الكامنة في الدماغ وتكرار وظائفه.
2) فهم الدماغ والذكاء البشري: تساهم نماذج التعلم العميق في تعزيز فهمنا للدماغ والمبادئ التي تقوم عليها آليات الذكاء البشري. لا تقتصر فوائد هذه النماذج على الإجابة عن أسئلة علمية أساسية حول عمل الدماغ، بل تمتد أيضًا إلى حل المسائل الهندسية ودعم التطبيقات الفنية والإبداعية.
يتوافق مفهوم "التعلم العميق" كنهج فلسفي بشكل أكبر مع طبيعة التعلم العميق مقارنة بمفهوم "الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد" (GOFAI). ورغم محدوديته، تمتاز خوارزميات التعلم الآلي بقدرتها على جمع المعرفة وتحليلها من التجربة، مما يُغني عن الحاجة إلى أن يحدد المشغلون البشريون جميع المعارف اللازمة للنظام بشكل رسمي، على عكس النموذج الوصفي الذي يتبناه الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد.
كقرار جمالي، تم الاحتفاظ بالأسطوانة السوداء البلاستيكية بوصفها أداة رئيسة، مما جعل الإصدارين متشابهين من الناحية العملية. أما من حيث المنطق الداخلي، فقد تم توليد المخرجات الجديدة باستخدام خوارزميات التعلم العميق، التي تكاملت مع بنية الذكاء الاصطناعي التقليدي الجيد مبسطة تشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة في الإصدار الأول. كانت النتائج العملية لهذا النهج في الإصدار الثاني من "أميجويد 2.0" ملموسة. ورغم أن السلوك الأساسي لـ "أميجويد 2.0" لم يختلف كثيرًا عن "أميجويد 1.0"، إلا أن طبيعة العلاقات المتصورة مع النظام شهدت تحولًا ملحوظًا. أرجع ذلك إلى استمرارية التفكير المستمدة من نماذج التعلم الآلي، والروابط التكافلية التي ولّدتها هذه النماذج داخليًا. بينما تظل الحاجة قائمة لإجراء المزيد من التجارب، يبدو أن اعتماد نهج التعلم الآلي يمثل حلًا واعدًا للتحديات التي واجهتها في "أميجويد 1.0"، ويشكل المسار الصحيح للمضي قدمًا.
4- الاستنتاج
في حين يظل العقل البشري أكثر أشكال الذكاء مرونة في الكون، فإن مفهوم "العقل في المادة" الذي تقدمه النزعة التوافقية يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإبداعي بين البشر والذكاء الاصطناعي. تُعرّف التوافقية بوصفها عقيدة ونظرية ميتافيزيقية تؤكد أن كل ما هو موجود متصل كجزء من كيان كوني موحد، حيث لا يوجد جزء مستقل أو منفصل تمامًا، بل إن الكون، وفق هذا المنظور، يتطور باستمرار نحو مزيد من التعقيد والترابط من خلال السيميائية والقوة الجوهرية للعلاقات الشمولية التي تدمج الركائز وتوحدها.
عندما ندمج هذا التصور مع نظرية بيرس للاستدلال الاستقرائي، التي تشكل الأساس النظري لفهم الظواهر الإبداعية، يتكون لدينا إطار نظري وعملي قوي يكسر الحاجز الديكارتي الذي طالما قيد العالم الحديث في إدراك الإمكانات المتعددة للتعاون. في عالم تكافلي، تتلاشى الفكرة البسيطة القائلة بأن شيئًا ما يجب أن يحل دائمًا محل آخر - مثل الذكاء الاصطناعي الذي يحل محل الإبداع البشري - لتحل محلها رؤية أكثر تعقيدًا وشمولية للكون، حيث تتشابك جميع العناصر في شبكة من العلاقات المتواصلة والمتكاملة.
المراجع المعتمدة:
A Walk to Meryton (2022). https://aeigenfeldt.wordpress.com/a-walk-to-meryton /
2001: A Space Odyssey (1968) Directed by Stanley Kubrick [Film]. MGM, USA.
Floridi L (1999) Philosophy and computing: an introduction. Routledge
Ford M (2018) Architects of intelligence. The truth about AI from the people building it. Packt Publishing
Goodfellow I, Bengio Y, Courville A (2016) Deep learning. MIT Press, Cambridge, MA
Haugeland J (1993) Artificial intelligence: the very idea. MIT Press, Cambridge, MA
Metropolis (1927) Directed by Fritz Lang [Film]. UFA, Germany
Poltronieri F, Hänska M (2019) Technical images and visual art in the era of artificial intelligence: from GOFAI to GANs in ARTECH 2019: Proceedings of the 9th international conference on digital and interactive arts. Article No.: 38, pp 1–8
Poltronieri F (2021) Dreaming of utopian cities: art, technology, creative AI, and new knowledge in the Routledge international handbook of practice-based research In: Vear C (ed) Routledge, London
Russel S, Norvig P (2016) Artificial intelligence: a modern approach. Pearson, Essex
Shanahan M (2015) The technological singularity. MIT Press, Cambridge, MA
[1] Fabrizio Poltronieri. "Towards a Symbiotic Future: Art and Creative AI", In: Vear, C., Poltronieri, F. (eds) The Language of Creative AI. Springer Series on Cultural Computing. Cham: Springer, 06 Nov 2022, pp. 29–41 https://doi.org/10.1007/978-3-031-10960-7_2
[2] فابريزيو بولترونيري Fabrizio Poltronieri (1976- ): فنان ومصمم وباحث حاصل على جوائز في مجال الحوسبة، يتميز باهتمامه الخاص بالعلاقة بين الفن، التصميم، الوسائط الرقمية، والتكنولوجيا. تتركز خبرته في تطوير الترميز الإبداعي وعلاقته بالقضايا الفلسفية.
[3] باحثة دكتوراه ومترجمة في فلسفة العلم – كلية الآداب – جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية. asmaa.newir1993@gmail.com
[4] الهدف هنا ليس تقديم تفاصيل شاملة عن أعمال هارولد كوهين، وهو موضوع تم تناوله في ببليوغرافيا موسعة، بل الإشارة إلى أن العلاقة بين كوهين وآرون كانت بالفعل علاقة تكافلية.
[5] باختصار، الأسمية هي فلسفة تؤكد أن الأشياء التي تحمل نفس الاسم لا تشترك في أي صفات أخرى سوى ذلك الاسم. يرتبط هذا المبدأ غالبًا بالفكرة القائلة بأن كل ما يوجد هو أفراد محددون، مما يعني عدم وجود شموليات. فمثلاً، ما يجمع جميع الكراسي هو أنها تُسمى "كراسي". في المقابل، يتبنى بيرس وجهة نظر واقعية قوية، حيث تعد الطبيعة ذاتية الطائفة مستقلة عن الإرادة البشرية أو اللغات.
[6] المصطلح "Amigóide" مأخوذة من الكلمة البرتغالية "Amigo"، والتي تعني "صديق".