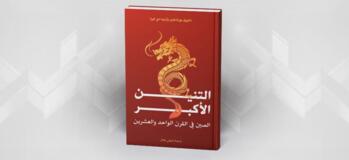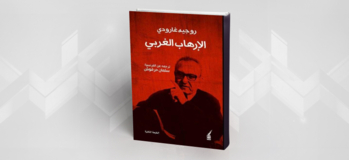أنثروبولوجيا الاقتصاد بين الهبة والسوق قراءة في إسهامات مارسيل موس وكريس هان وكيث هارت
فئة : أبحاث محكمة
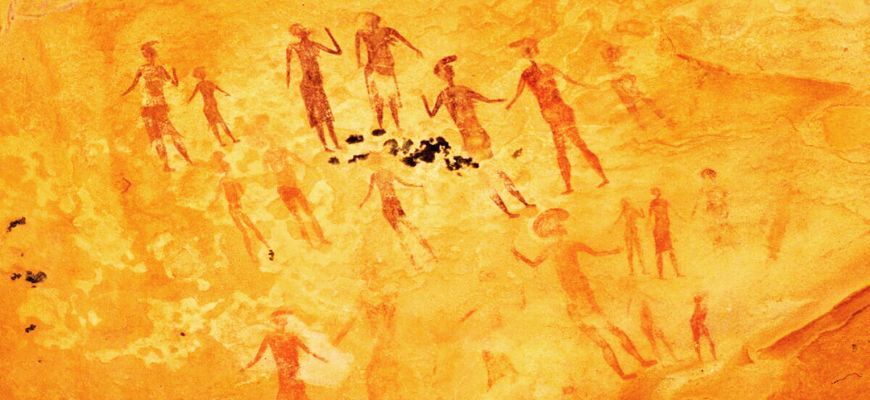
أنثروبولوجيا الاقتصاد بين الهبة والسوق
قراءة في إسهامات مارسيل موس وكريس هان وكيث هارت
ملخص:
تطرح هذه الورقة البحثية إشكالية مركزية تتعلق بمدى قدرة النظريات الأنثروبولوجية المختلفة على تفسير طبيعة الاقتصاد في المجتمعات التقليدية والمعاصرة؛ وذلك من خلال مقارنة نموذج الهبة، الذي قدمه مارسيل موس، بمفاهيم الاقتصاد غير الرسمي والتعددية الاقتصادية كما طرحها كيث هارت وكريس هان. ففي المجتمعات التقليدية، كانت العلاقات الاقتصادية متجذرة في النظم الاجتماعية، حيث لم يكن التبادل مقتصرًا على تحقيق الربح المادي، بل كان جزءًا من شبكة من الالتزامات الأخلاقية والاجتماعية التي تعزز التضامن والتكافل. ومع ذلك، فإن التحولات الاقتصادية العالمية، التي جاءت مع العولمة والرأسمالية الحديثة، لم تلغ بالكامل هذه الأشكال التقليدية من التبادل، بل أفسحت المجال أمام تداخل الرسمي وغير الرسمي، حيث أصبحت الأسواق فضاءات معقدة تتشابك فيها الشبكات الاجتماعية مع آليات السوق.
تمهيد:
إذا كان هدف علماء الأنثروبولوجيا هو الكشف عن مبادئ التنظيم الاجتماعي على المستويات كلها، من أكثرها خصوصية إلى العام منها، فإن هدف الأنثروبولوجيا الاقتصادية هو تناول العلاقات الاقتصادية داخل المجتمعات من زاوية كونها شبكة من التبادلات المترسخة في النظم الاجتماعية. ففي القرن التاسع عشر، حتى قبل أن تتشكل على هيئة "علم اقتصاد الإنسان البدائي" نجد أن من بين أهداف الأنثروبولوجيا الاقتصادية هي اختبار الزعم القائل بوجوب قيام نظام اقتصادي عالمي على المبادئ التي قام عليها المجتمع الصناعي الغربي، لهذا تتباين مقاربات أنثروبولوجيا الاقتصاد ومن يدرسها في ضوء التحولات الحديثة للاقتصاد العالمي... ومن ثم، فالأنثروبولوجيا هي الطريقة الأشمل للتفكير في الممكنات الاقتصادية.[1]
وفي هذا الإطار، تمثل كل من أعمال مارسيل موس من جهة، وكيث هارت وكريس هان من جهة أخرى، نماذج مختلفة لفهم الظواهر الاقتصادية وفق سياقات زمنية وثقافية متعددة، حيث يطرح مارسيل موس في مقالة الهبة (1925) تصورًا للاقتصاد القائم على فكرة التبادل غير السوقي؛ إذ يرى أن الهبة عملية اجتماعية تخضع لقواعد الإلزام المتبادل، وتعزز العلاقات الاجتماعية والسياسية داخل المجتمعات التقليدية[2]. في حين أن الاقتصاد حسب موس لا ينفصل عن البعدين الأخلاقي والديني، حيث لا يقوم التبادل على مبدأ الربح المادي وحده، بل على ديناميات العطاء والالتزام ورد الجميل، التي تؤسس لنظم معقدة من التضامن والتكافل الاجتماعي.[3]
في المقابل، يركز كل من كيث هارت وكريس هان على مقاربة معاصرة للاقتصاد، والتي تأخذ بعين الاعتبار تأثير الرأسمالية والعولمة على التفاعلات الاقتصادية. يسلط هارت الضوء على مفهوم "الاقتصاد غير الرسمي"، حيث يشير إلى أن الأسواق ليست مجرد مؤسسات رأسمالية، بل فضاءات اجتماعية تنشأ فيها علاقات اقتصادية موازية للاقتصاد الرسمي، تعتمد على الثقة والشبكات الاجتماعية بدلا من القوانين الصارمة للسوق. من جانبه، يطرح هان مقاربة التعددية الاقتصادية، معتبرا أن الاقتصادات الحديثة لا تلغي تماما الأشكال التقليدية من التبادل، بل تدمجها في إطار أشمل يوازن بين العادات المحلية وآليات السوق العالمي.
لهذا، سنسعى من خلال هذا العمل إلى استكشاف أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الرؤى، ومدى قدرتها على تفسير الاقتصاد في المجتمعات التقليدية والمعاصرة على حد سواء.
فهل تمثل الهبة بديلا مستمرا للعلاقات السوقية كما يرى موس؟ أم إن الأسواق المعاصرة هي فضاءات اجتماعية تتداخل فيها الرسميات مع غير الرسميات بالنسبة إلى هارت وهان؟
أولا: حول مقالة الهبة لمارسيل موس
يعد كتاب مقالة في الهبة: أشكال التبادل في المجتمعات القديمة وأسبابه" للمؤلف مارسيل موس. ترجمة محمد الحاج سالم: والذي نشر عن "دار الكتاب الجديد" عام 2013، من أهم الدراسات في الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، حيث أثر في العديد من النظريات حول الاقتصاد والهدايا والعلاقات الاجتماعية. يتناول الكتاب تحليلا لأنظمة التبادل والهبات في المجتمعات التقليدية، موضحا كيف أن العطاء يتجاوز كونه مجرد معاملة اقتصادية، بل يشمل أبعادًا اجتماعية وثقافية تلزم المتلقي بالرد بالمثل.
الإطار المفاهيمي:
يستند الأنثروبولوجي الفرنسي مارسيل موس في هذا العمل إلى جهاز مفاهيمي ذي صلة بالحقل الأنثروبولوجي، غير أنها بحسب موس مفاهيم ذات أبعاد مختلفة، دينية، اقتصادية، جمالية... ويرد ذلك إلى أن الظاهرة الاجتماعية عند مارسيل موس، لا يمكن فهمها إلا من خلال النظر إليها من زاوية الشمولية والكونية.
مفهوم الهبة:
يعدّ مفهوم الهبة من المفاهيم المركزية في أعمال مارسيل موس، لاعتبار الهبة تشكل مدخلا أساسيًّا لفهم الظاهرة الاجتماعية في كليتها، ولكون الظاهرة الاجتماعية تنطوي على أبعاد دينية واقتصادية، وبالتالي تتجاوز الأبعاد الأحادية التي حددها علماء الأنثروبولوجيا من قبل. لهذا انتقل مفهوم الهبة عند موس من مجرد نشاط اقتصادي لا يعدم بعدًا اجتماعيا إلى درجة الظاهرة الاجتماعية، ويتمثل هذا المفهوم حسب مارسيل موس من خلال الترابط القائم بين ثلاثة التزامات: الهبة، وقبولها، والرد عليها بإعادة الشيء الموهوب ذاته أو ما يوازيه أو ما هو أثمن منه، وهذه الالتزامات المترابطة تدفع الهبات، أشياء كانت أم شخصاً، عاجلا أو آجلا نحو العودة إلى نقطة انطلاقها.[4]
مفهوم التبادل:
يفتتح مارسيل موس هذا العمل بقوله: "إن التبادلات والتعاقدات في الحضارة الإسكندنافية، كما في عدد كبير من الحضارات، كانت تتم تحت شكل تبادل للهدايا بصفة اختيارية في الظاهر، والحال أنها كانت تتم في الواقع بصفة قسرية؛ إذ تستلزم كل هبة الرد عليها بأخرى".[5] تناول موس هذا المفهوم ليبين أن للتبادل دلالة أشمل وأوسع من مفهوم الهبة، فحتى لو كانت الهبة شكلا قديما للتبادل في الاقتصادات والتشريعات القديمة، فإن التبادل حسب موس ليس مجرد معاملة اقتصادية، بل هو نظام اجتماعي يقوم على التزامات متبادلة تفرض على الأفراد والجماعات ثلاثة واجبات: العطاء، القبول، والرد بالمثل. فالهبة ليست فعلا مجانيا، بل تحمل في طياتها إلزاماً اجتماعيا يجعلها دينا يجب رده بهدية مساوية أو أعظم. ويظهر هذا التبادل القسري في أنظمة مثل "البوتلاتش"، حيث تتنافس الجماعات في تقديم الهدايا لإثبات المكانة والقوة. من هنا، يصبح التبادل وسيلة لبناء العلاقات وتنظيم التفاعل الاجتماعي، مما يجعل الاقتصاد مرتبطا بالبعد الأخلاقي والثقافي أكثر من كونه مجرد تبادل مادي.
المنهج المعتمد:
لقد توخينا منهجا مقارنا دقيقا. فحصرنا دراستنا، كما اعتدنا دائما، في مجالات مختارة: بولينيزيا وميلانيزيا والشمال الغربي الأمريكي، وبعض منظومات القوانين الكبرى، وبالطبع لم نختر من بين المنظومات القانونية إلا تلك التي تسمح الوثائق والعمل الفيلولوجي بالنفاذ من خلالها إلى ضمير المجتمعات ذاتها... وهو ما أبعدنا عن المقارنة الجامدة التي تختلط فيها الأمور وتفقد فيها المؤسسات خصوصياتها المحلية، كما تفقد فيها الوثائق نكهتها.[6]
اعتمد مارسيل موس في "مقالة في الهبة" على المنهج الأنثروبولوجي المقارن، حيث يستند إلى دراسات لمجتمعات تقليدية مثل الماوري في نيوزيلندا والكواكيوتيل في أمريكا الشمالية لفهم أنظمة التبادل غير الرأسمالي. كما يوظف المنهج السوسيولوجي المتأثر بدوركايم لتحليل البعد الاجتماعي والوظيفي للهبة، معتبرا إياها فعلا يولد التزاما متبادلا يعزز الروابط الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، يستعين بالمنهج التاريخي لتتبع استمرارية ممارسات الهبة عبر الزمن، ويعتمد على المنهج الوظيفي لتوضيح دور الهبة في بناء التحالفات والتماسك الاجتماعي. يجمع موس بين هذه المناهج لتقديم تحليل شامل للهبة كنظام اقتصادي واجتماعي، يختلف عن التبادل التجاري القائم على المنفعة الفردية، ويبرر هذه المناهج المعتمدة في هذا العمل بقوله: "ومن باب المقارنة لقياس مدى قرب أو بعد مجتمعاتنا من هذه الأنواع من المؤسسات المسماة "بدائية"، فهي وقائع لها قيمة سوسيولوجية عامة؛ إذ تمكننا من فهم لحظة من التطور الاجتماعي، لكن الأهم من ذلك أنها لا تزال مؤثرة في التاريخ الاجتماعي، فقد تمكننا تلك الوقائع بالفعل من الانتقال إلى الأشكال التي نعايشها نحن في القانون والاقتصاد، ومن هنا تكمن أهميتها ودورها في فهم مجتمعاتنا فهما تاريخيا"[7].
الأطروحة العامة:
يتكون هذا العمل الذي نحن بصدد الاشتغال عليه من أربعة فصول رئيسة تمهد الطريق لكل باحث في حقل الأنثروبولوجيا لفهم كيف انتقلت الهبة من مجرد صفة لنشاط اقتصادي إلى مرتبة "الظاهرة الاجتماعية الكلية"، وهذا هو المفهوم المركزي في عمل مارسيل موس الذي انصب اهتمامه في فهم الظاهرة الاجتماعية في شموليتها؛ ذلك أن مقاربة مثل هذه الظواهر الاجتماعية في كليتها تمكننا من النظر إليها بوصفها ظواهر عامة متمايزة عن المؤسسات ذات الطابع العرضي أو المحلي.
وهذا هو مشروع موس في هذا الكتاب الذي يستلهم قيمته من كونه أشهر نص في حقل الأنثروبولوجيا وأكثرها كثافة معرفية؛ ففيه محاولة لفهم الدوافع التي تجعل الناس ملزمين ليس بالوهب فحسب، بل بقبول الهبة والرد عليها أيضا. وفي صلب هذا الكتاب، يركز موس على الهبة بوصفها شكلاً قديما للتبادل في الاقتصادات والتشريعات القديمة في عدد من الحضارات (الهندوسية، الرومانية، الجرمانية، الهنود الحمر، جزر المحيط الهادي، العرب، إلخ…) ليخلص إلى أن التبادل المعتمد على الهبات وإن كان لا يدخل في إطار الاقتصادات النفعية التي تسودها "العقلية الذاتية الحسابية" في المجتمعات المعاصرة، إلا أنها لا تزال حاضرة في الكثير من المظاهر، كوهب الهدايا في الأعياد وإقامة الولائم، إلخ…وهو ما يسميه مارسيل موس باقتصاد التقدمات وأخلاقياتها، وهي الهدايا التي يقدمها البشر إلى الآلهة والطبيعة كما هو الحال في البوتلاتش وحفلات الإسكيمو بألاسكا.[8]
إن المجتمعات الرأسمالية المعاصرة تذهب إلى الاعتقاد بأن الهبة والتبادل شكل من أشكال التفاعلات الاقتصادية التقليدية، إلا أن التفاعلات الاقتصادية للحداثة حسب موس لا زالت قائمة على التبادل القائم بدوره على مبدأ الهبة (المساعدات الدولية، الحماية الاجتماعية، التضامن ...
من جهة أخرى، يقدم مارسيل موس رؤية أخلاقية للاقتصاد تختلف عن النموذج الرأسمالي الكلاسيكي الذي يعتمد على المنفعة الفردية والمصلحة الذاتية. وبدلا من ذلك، يركز موس على البعد الأخلاقي والاجتماعي في عمليات التبادل، حيث يرى أن الاقتصاد في المجتمعات التقليدية يقوم على مبدأ الهبة والإلزام المتبادل، وليس فقط على مبدأ الربح والسوق الحرة؛ فالعلاقات الاقتصادية ليست مجرد عمليات بيع وشراء، بل ترتبط بمجموعة من القيم الاجتماعية والأخلاقية، مثل التضامن، الشرف، والاحترام المتبادل...، ففي مجتمعاتنا لا يزال هناك جزء كبير من أخلاقنا ومن حياتنا نفسها يسبح في نفس هذه الأجواء المفعمة بالهبة والالتزام والحرية، وأنه ما يزال للأشياء قيمة عاطفية، إضافة إلى قيمتها السوقية.[9]
إن الهبة حسب موس مبدأ كوني، ولا ينبغي لمجتمعات السوق المنخرطة في المنظومة الرأسمالية المعاصرة التغافل عنها. ويرد ذلك إلى اعتبار الظاهرة الاجتماعية لدى موس ظاهرة مركبة، فجميع الظواهر هي في الوقت نفسه ظواهر قانونية واقتصادية ودينية، بل وحتى جمالية وشكلية... فهي قانونية لتعلقها بالمسائل القانونية العامة أو الخاصة وبالأخلاقية المنظمة والشائعة، سواء منها الملزمة بالصرامة أو المحمودة أو المذمومة فحسب؛ أي الأخلاقية السياسية والمنزلية في الوقت نفسه، ناهيك عن تعلقها بالجانب الديني نظرا لتعلقها بالدين والسحر والعقلية الدينية الشائعة، وهي اقتصادية لأن أفكار القيمة والمنفعة والفائدة والثروة والتملك والمراكمة من جهة، والاستهلاك كل ذلك حاضر في كل مكان.[10] لذا، فالدور الريادي لعالم الاجتماع يكمن في ملاحظة ردود الفعل الكاملة والمعقدة لكميات عددية محددة من البشر، ووصف سلوكهم كجماعة ومن ثم فهم السلوك في كليته.[11]
إن دراسة السلوك البشري في كليته هو ما جعل من هذا العمل يعد مرجعاً أساسيًّا في حقل الأنثروبولوجيا الاقتصادية، لا سيما أنه يتناول مفهوم الهبة بوصفها أكثر من مجرد تبادل اقتصادي، بل فعلا اجتماعيا وثقافيا يعكس التزامات متبادلة بين الأفراد والمجتمعات، بل أكثر من ذلك تقوم على مبادئ أخلاقية وإنسانية.
الإطار النظري والنقدي:
ينتقد مارسيل موس في كتابه "مقالة في الهبة" وباستناده إلى أعمال بواس ومالينوفسكي، الفكرة السائدة في الاقتصاد الحديث التي تفترض أن البشر يتصرفون دائما بدافع المصلحة الشخصية، وأن كل تبادل اقتصادي يجب أن يكون مبنيا على الربح والمنفعة المتبادلة. ومن خلال دراسة المجتمعات التقليدية، أثبت موس أن التبادل لم يكن مجرد عملية بيع وشراء، بل كان وسيلة لبناء العلاقات الاجتماعية، وتعزيز المكانة، وحتى فرض النفوذ. في طقوس مثل "البوتلاتش" لدى بعض الشعوب الأصلية، كان الأفراد يقدمون هبات ضخمة ليس بدافع الكرم فقط، بل لإثبات قوتهم وإلزام الآخرين بالرد، مما يخلق نوعا من المنافسة القائمة على العطاء وليس الاكتناز.
إن الحداثة بحسب مارسيل موس شوهت مفهوم التبادل، حيث فصلت بين الاقتصاد والقيم الأخلاقية، فجعلت المال والربح محور التعاملات، وأضعفت الروابط الاجتماعية التي كانت موجودة في الأنظمة التقليدية. في الماضي، كان العطاء والتبادل يحملان بعدًا مقدساً وأخلاقيا. أما اليوم، فقد تحولت المعاملات إلى أرقام باردة في الأسواق والبنوك. لذلك، يقترح موس أن إعادة التفكير في بعض أشكال التبادل غير الربحي، مثل الهبة والعمل الجماعي، قد يساعد في مواجهة الجشع والفردانية المتزايدة في المجتمعات الحديثة.
خلاصة تركيبية:
إن التبادل في المجتمعات التقليدية لم يكن مجرد معاملة اقتصادية، بل كان فعلاً اجتماعياً وأخلاقيًّا تحكمه التزامات متبادلة تلزم الأفراد بالعطاء والقبول والرد بالمثل. فالهبة ليست مجانية كما قد يبدو، بل تحمل في طياتها نوعا من الإلزام الاجتماعي الذي يجعلها دينا يجب رده بهدية مساوية أو أعظم. من خلال دراسته لطقوس مثل "البوتلاتش"، يوضح موس أن العطاء لم يكن مجرد كرم، بل أداة لإثبات المكانة وتعزيز الروابط الاجتماعية وحتى فرض السيطرة. لهذا ينتقد موس النظرة الاقتصادية الحديثة التي تفصل الاقتصاد عن القيم الاجتماعية، معتبرا أن المجتمعات القديمة كانت أكثر انسجاما مع فكرة الاقتصاد الأخلاقي، حيث كان التبادل وسيلة للتضامن والتكافل، وليس مجرد عملية تجارية قائمة على الربح. كما يؤكد أن مبدأ الهبة لا يزال حاضرًا في مظاهر عديدة مثل الهدايا، المساعدات الدولية، والتضامن الاجتماعي، مما يثبت أن العلاقات الاقتصادية لا يمكن فصلها عن الروابط الإنسانية.
ثانيا: حول كتاب الأنثروبولوجيا الاقتصادية، التاريخ والإثنوغرافيا والنقد لكريس هان وكيث هارت، ترجمة عبد الله فاضل.
نشر كتاب "الأنثروبولوجيا الاقتصادية: التاريخ والإثنوغرافيا والنقد"للمؤلفين كريس هان وكيث هارت باللغة العربية من طرف المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات سنة 2014، ترجمة عبد الله فاضل. وتعود فكرة تأليف الكتاب إلى ورقة بحثية معمقة وضعها المؤلفان كرس هان وكيث هارت عام 2006 حول وضع الأنثروبولوجيا الاقتصادية، مع تركيز خاص على أفكار كارل بولاني.
يعد هذا الكتاب من المراجع الأساسية في دراسة العلاقات الاقتصادية من منظور أنثروبولوجي، كما يتناول تطور الأنثروبولوجيا الاقتصادية عبر التاريخ، ويستعرض المناهج الإثنوغرافية التي اعتمدها الباحثون في تحليل النظم الاقتصادية في المجتمعات المختلفة، مع تقديم نقد معمّق للنظريات الاقتصادية السائدة.
الإطار المفاهيمي للكتاب:
الأنثروبولوجيا الاقتصادية:
غالبا ما ربطت الأنثروبولوجيا الاقتصادية بالآباء المؤسسين للنظرية الاجتماعية الحديثة، ولا سيما ماركس وفيبر ودوركايم، وفي بعض الأحيان كان تاريخها يعاد إلى علماء الاقتصاد السياسي في عصر التنوير، تتناول الأنثروبولوجيا الاقتصادية مسائل الطبيعة الإنسانية والرفاه، غير أن هذا الاعتقاد قديم جدًّا، فالأنثروبولوجيا الاقتصادية اليوم قادرة على استقصاء هذا الاقتصاد الإنساني في الزمان والمكان، كإبداع للإنسانية جمعاء، إن الأنثروبولوجيا الاقتصادية هي الطريقة الأشمل للتفكير الأشمل في الممكنات الاقتصادية.[12]
الاقتصاد الإنساني:
إذا كان الاستخدام السائد لمصطلح "اقتصاد" منذ أواخر القرن التاسع عشر يحيل إلى مجموع السلع والخدمات المبتاعة والمباعة في إقليم وطني، فإن الاقتصاد لم يعد يرتبط بالسلع فقط، بل حتى بالإنسان أو ما يسمى بالاقتصاد الإنساني، والذي يشير إلى الرفاه وإلى إشباع الحاجات الإنسانية كلها، لا تلك التي يمكن تلبيتها عن طريق معاملات السوق الخاصة وحدها، بل أيضا الحاجة إلى السلع العامة، كالتعليم والأمن والبيئة الصحية والكرامة.[13]
الأنثروبولوجيا النقدية:
تشتق كلمة أنثروبولوجيا من الإغريقية القديمة، مثلها مثل "إيكونومي = اقتصاد". والأنثروبولوجيا (أنثروبوس = إنسان) هي أي دراسة منهجية للإنسانية بكليتها. أما الاستخدام المسيطر في العصر الحديث، فيشر إلى الفرع المعروف في بريطانيا بالأنثروبولوجيا الاجتماعية، وفي الولايات المتحدة بالأنثروبولوجيا الثقافية، لكن ما يهما نحن هو الأنثروبولوجيا النقدية التي لها جذورها في الثورات الديمقراطية وفلسفة القرن الثامن عشر العقلانية. في حين أن النقد هو تفحص أسس الحضارة المعاصرة على أساس المحاكمة العقلية، والمحاكمة بدورها هي القدرة على تكوين رأي على أساس التفكير الدقيق، وأبعد من ذلك هي القدرة على تبين العلاقات التي تربط الأمور الخاصة بأكثر المبادئ عمومية.[14]، ويستشهد المؤلفان بجان جاك روسو بصفته مصدرًا بارزًا من مصادر الأنثروبولوجيا النقدية؛ إذ جمع بين بطريقة خاصة بين نقد الحضارة الفاسدة ورؤية كيفية معالجة التفاوت العالمي، مبينا أن رفض اعتبار الأشياء كما هي يتطلب منا بالتأكيد أن نبتكر طرائق جديدة للدراسة والكتابة عن الحاضر العابر.[15]
الأطروحة العامة للكتاب:
يتبين من خلال القراءة المتأنية لكتاب الأنثروبولوجيا الاقتصادية، التاريخ والإثنوغرافيا والنقد، أن المؤلفين كريس هان وكيث هارت ركزا في حقل الأنثروبولوجيا الاقتصادية، على إسهامات مارسيل موس وكارل بولاني؛ لأن كليهما استمد معلوماته من الاقتصاديين في التركيز على آليات التداول لا التبادل فحسب، فيما عرضا بقوة فرضياتهم ونتائجهم الرئيسة، وفسرت مقالة موس الشهيرة عن الهبة، تفسيرًا ضيقا جدًّا على أنها مساهمة في نظرية التبادل، حيث اعتبرت الهبة تحت ستار تلك النظرية جانباً من جوانب التباين بين الهبات والسلع، وهو تباين يعدّ غالبا حالة مثالية من الانقسام بين الغرب وبقية العالم، وفي الحقيقة كان غرض موس هو حل المعارضة بين الهبات المحض والعقود الأنانية من أجل كشف المبادئ الكونية للالتزام المتبادل والتكامل الاجتماعي. وعلى الجانب الآخر يشدد كارل بولاني على لحظة من الزمن، وهي الثورة الصناعية ليقيم نظرية عن انقسام كبير وقاده ذلك، وقاد أتباعه على نحو خاطئ، إلى التخلي عن دراسة الاقتصادات الحديثة وتركها للاقتصاديين، في حين أن علماء الاجتماع وجدوا أن مفاهيم بولاني المركزية عن التبادلية التي اعتمدها في تحليله لمبدأ السوق في كتابه "التحول الكبير"، أنها أشكال من التكامل بين الاقتصاد والمجتمع. [16]
لقد كان الغرض من انفتاح المؤلفان على إسهامات مارسيل موس وبولاني هو إبراز مدى انشغالهم بكيفية إقامة المجتمع على مزيج من المبادئ الاقتصادية الموزعة على نطاق واسع في الجغرافيا والتاريخ، والتي يمكن مزجها على نحو متغير لتعطي دافعا واتجاها جديدًا للشؤون المشتركة، إضافة إلى اهتمامهما بالتجارب الاجتماعية المعاصرة التي جرت باسم الماركسية، تلك التجارب التي اختزلت المجتمع في الأسواق الرأسمالية، ورأيا أن الاقتصاد يشد في اتجاهين: يتمثل الأول في تأمين الضمانات المحلية لحقوق الجماعة ومصالحها، والثاني يكمن في التعويض عن نواقص العرض المحلي عبر الاشتراك مع الآخرين على نحو أشمل من خلال وسيط المال والأسواق.
"إن إسهامات بولاني ومارسيل موس أقامت جسورا فكرية بين الحياة اليومية والتاريخ والإثنوغرافيا والنقد".[17]
هكذا يقدم المؤلفان في كتاب "الأنثروبولوجيا الاقتصادية: التاريخ والإثنوغرافيا والنقد" رؤية مختلفة لكيفية فهم الاقتصاد، بعيدًا عن الأرقام والنماذج المجردة، ليكشفا عن علاقته العميقة بالثقافة والمجتمع. يناقش المؤلفان كيف أن الأنظمة الاقتصادية ليست مجرد وسائل للإنتاج والتبادل، بل هي نتاج لتاريخ طويل من التفاعل البشري والقيم والعادات. من خلال دراسات إثنوغرافية متنوعة، ويوضح فيه المؤلفان كذلك كيف تختلف الممارسات الاقتصادية من مجتمع إلى آخر، منتقدا النظريات التقليدية التي تفترض أن الجميع يتصرف وفق منطق السوق الرأسمالي. الفكرة الأساسية هنا هي أن الاقتصاد ليس مجرد معادلات وحسابات، بل هو نسيج من العلاقات الاجتماعية والثقافية.
قراءة في فصول الكتاب:
يركز المؤلفان كريس هان وكيث هارت في هذا الكتاب على أهمية أفكار كارل بولاني في العالم المعاصر، وقد جاء هذا العمل نتيجة تأثير أحدث أزمات الاقتصاد العالمي وأشدها خطورة، وهي الأزمة المتعلق بالاقتصاد في العالم المعاصر. لهذا، حاول المؤلفان تسليط الضوء في فصول الكتاب على مجموعة من القضايا ذات صلة بالتاريخ والأنثروبولوجيا والاقتصاد؛ ففي الفصل الأول تناولا تاريخ فكرة الاقتصاد من منطلق جذورها في حوض البحر الأبيض المتوسط القديم، ومن منطلق التقليد الأرسطي والأفلاطوني إلى العالم المعاصر الذي تجري فيه نسبة كبيرة من المعاملات الاقتصادية عبر طرائق أكثر تقدما. غير أن الاقتصاد ليس مجرد نظام رقمي أو مالي، بل هو جزء من البنية الاجتماعية والثقافية لأي مجتمع. يناقش المؤلفان كيفية تطور هذا المجال منذ دراسات المجتمعات البدائية حتى الاقتصاد العالمي المعاصر. وتم الانفتاح في هذا الفصل على أفكار كارل بولانيي، الذي جادل بأن الاقتصاد متجذر في العلاقات الاجتماعية، ومارشال سالينز، الذي ناقش مفهوم "المجتمعات الوفيرة"، وآدم سميث، كمؤسس للفكر الاقتصادي الكلاسيكي.[18]
ليتناولا في الفصل الثاني، تاريخ الأنثروبولوجيا الاقتصادية في ثلاث مراحل، منطلقين من التساؤل حول كيف تطورت الرؤى الاقتصادية في الدراسات الأنثروبولوجية، مع التركيز على الانتقال من المجتمعات التقليدية إلى المجتمعات الرأسمالية. يناقش المؤلفان أفكار "إميل دوركايم" حول التضامن الاجتماعي، وماكس فيبر في تحليله لدور الأخلاق البروتستانتية في تطور الرأسمالية، بالإضافة إلى "ديفيد غريبر" الذي ينتقد بعض المفاهيم السائدة حول نشأة المال.[19]
بينما تم التركيز في الفصلين الثالث والرابع على كيفية عمل الأنظمة الاقتصادية في المجتمعات غير الصناعية، مثل الاقتصادات القائمة على التبادل والهدايا؛ وذلك على ضوء تحليل أفكار مارسيل موس حول "الهبة"، حيث يرى أن التبادل ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل هو عملية اجتماعية تحكمها قواعد الشرف والالتزام. كما تمت الإشارة إلى أعمال بيير بورديو حول رأس المال الاجتماعي ودوره في تنظيم العلاقات الاقتصادية، ليتم الانتقال إلى الوقوف على كيف تطورت الأسواق والأنظمة النقدية، متجاوزا الرؤية التقليدية التي تفترض أن المال نشأ نتيجة لحاجة البشر إلى التبادل. ويستند المؤلفان في هذا الصدد إلى أطروحة كارل ماركس في نقده للرأسمالية، وإلى فريدريك هايك في دفاعه عن الأسواق الحرة، بالإضافة إلى "ديفيد غريبر" الذي قدم قراءة تاريخية تثبت أن الديون كانت أسبق من ظهور العملات المعدنية.[20]
في الفصول الأخيرة من الكتاب، تناول المؤلفان قضايا العمل والإنتاج، العولمة، والنقد الموجه للنظريات الاقتصادية التقليدية بطريقة تحليلية تربط الاقتصاد بالحياة اليومية للمجتمعات.
في الفصل الخامس، سلط المؤلفان الضوء على كيفية تنظيم العمل، موضحين الفرق بين الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي، مثل الوظائف الحكومية والشركات الكبرى مقابل الأسواق غير المنظمة والعمالة الحرة. وقد استعانا بأفكار كارل ماركس حول استغلال العمال، وإستر بوزيروب التي درست كيف أثرت الزراعة على أنظمة العمل، ومايكل بوروي الذي ركز على تأثير الثقافة العمالية في بيئات العمل الرأسمالية.[21]
في الفصل السادس، تم تقديم مقارنة بين الرأسمالية والاشتراكية، حيث أشار المؤلفان إلى أن نجاح أي نظام اقتصادي يعتمد على السياق الاجتماعي والثقافي، وليس فقط على النظريات الاقتصادية. هنا، تتم مناقشة "جون ماينارد كينز" الذي دافع عن دور الدولة في تحقيق التوازن الاقتصادي، وميلتون فريدمان الذي رأى أن الأسواق الحرة هي الحل الأمثل، بينما يطرح إيمانويل والرشتاين تفسيرًا للعلاقات الاقتصادية بين الدول عبر نظريته عن النظام العالمي الذي يقسم العالم إلى دول مركزية، وأخرى هامشية تستغلها الأولى.[22]
أما الفصل السابع، فناقش تأثير العولمة، مؤكدًا أنها لم تقلص الفجوة بين الأغنياء والفقراء كما كان متوقعا، بل في كثير من الأحيان زادت التفاوت الاقتصادي. لقد تناول المؤلفان أفكار "توماس بيكيتي" حول عدم المساواة في توزيع الثروة، وديفيد هارفي الذي يرى أن الرأسمالية المتأخرة عمّقت الفوارق الطبقية، و"أرونداتي روي" التي تنتقد آثار العولمة على المجتمعات المهمشة، حيث تستفيد الشركات الكبرى، بينما يعاني الفقراء من فقدان سبل العيش التقليدية.[23]
يختتم المؤلفان في الفصل الثامن بتحليل نقدي للنظريات الاقتصادية التقليدية، وهما يشيران إلى أن السوق الحرة ليست نموذجا عالميًّا صالحاً لكل المجتمعات، حيث استعانا بأفكار كارل بولانيي، الذي يرى أن الأسواق تحتاج إلى قيود اجتماعية لحماية المجتمعات من التفكك، وبيير بورديو الذي يوضح كيف أن العادات الاقتصادية تتشكل داخل هياكل اجتماعية معينة، "وأمارتيا سن" الذي يطرح رؤية بديلة حول التنمية، معتبرا أن الرفاهية لا تقاس فقط بالنمو الاقتصادي، بل بمدى قدرة الأفراد على تحقيق حياة كريمة.[24]
المنهج المعتمد:
من الواضح أن المؤلفين اعتمدا في هذا الكتاب على منهج يجمع بين حقول معرفية ومجالات علمية مختلفة، كالسوسيولوجيا وعلم الاقتصاد والتاريخ وكذا الفلسفة نظرا لارتباط الأنثروبولوجيا الاقتصادية بفلاسفة عصر الأنوار... لأن تلاقي هذه العلوم على المستوى النظري والمنهجي يسمح من جهة، بعرض تاريخي للأنثروبولوجيا الاقتصادية ونظرة إلى تاريخ العالم، ومن جهة ثانية؛ لأن عرض تاريخ الأنثروبولوجيا الاقتصادية ووضعها الراهن يأتي مساهمة في فهم الحياة الاقتصادية، وهي ميدان يجب أن يوحد فيه علماء كثيرون قواهم، لا علماء الاقتصاد والأنثروبولوجيا فحسب، بل أيضا علماء التاريخ والاجتماع.[25] هذا بالإضافة إلى المنهج الإثنوغرافي، والذي أتاح للأنثروبولوجيين تجميع بنك من البيانات الموضوعية عن الثقافات الأخرى، إلى جانب ما بناه علماء الأنثروبولوجيا من شهادات على إقامات طويلة في مناطق نائية.[26]
الإطار النقدي:
بما أن المؤلفين يستلهمان أفكار كارل بولانيي لتحليل اقتصاد السوق المعاصر مقارنة مع الأسواق الكلاسيكية؛ فكارل بولانيي في كتابه الشهير "التحول الكبير" يرفض حتمية السوق؛ إذ يرى بولانيي أن الأسواق لم تكن جزءا طبيعيًّا من المجتمعات، بل تم فرضها من خلال تدخل الدولة، وهو ما يتناقض مع الرؤية الليبرالية الكلاسيكية التي ترى أن الأسواق تنمو تلقائيا نتيجة السلوك الإنساني الطبيعي. فالسوق نشأ عمليا بتدخل من الدولة، وحتى أيام الثورة التجارية، فإن ما يبدو لنا كتجارة وطنية لم يكن وطنيا.[27]
يرفض كارل بولانيي فكرة "الإنسان الاقتصادي Homo Economicus" وهي فكرة حاول الليبراليون الاقتصاديون الكلاسيكيين (آدم سميث، دافيد ريكاردو، مالتوس) فرضها، فحسب بولانيي أن ما درج الليبيراليون الاقتصاديون على اعتباره، كان مجرد تعبير عن تحيز متأصل لمصلحة نوع معين من التدخل، وهو الذي سيحطم العلاقات غير التعاقدية بين الأفراد، ويمنع إصلاحها عفويا.[28] لذا، فبولانيي كان ضد فكرة أن السوق قادر على تنظيم نفسه بدون تدخل، بعكس ما قاله الاقتصاديون الليبراليون مثل آدم سميث وهايك. هو رأى أن تحويل كل شيء إلى سلعة (الأرض، العمل، المال) دمر المجتمعات؛ لأن الاقتصاد في الأصل جزء من الحياة الاجتماعية، وليس كياناً مستقلًّا يتحكم في كل شيء. برأيه، كلما توسع السوق بلا قيود، زاد الفقر والتفاوت، مما يدفع الناس للبحث عن حماية عبر الدولة أو الحركات الاجتماعية. لذلك، كان يعتقد أن الاقتصاد يجب أن يكون في خدمة الإنسان، وليس العكس، وأن التوازن بين السوق والدولة ضروري حتى لا تنهار المجتمعات بسبب الرأسمالية الجامحة. وبناء عليه، سوف نتعامل على انفراد مع الدفاع عن الإنسان والطبيعة ومنظمات الإنتاج، وهي حركة للوقاية الذاتية من نتيجتها برز شكل للمجتمع أكثر التحاماً.[29]
خلاصة تركيبية:
من خلال ما سبق نستشف، أن فكر كل من كارل بولانيي وكريس هان وكيث هارت يجتمع في اعتبار أن الاقتصاد لا يمكن اختزاله في منطق السوق الحر، بل هو جزء لا يتجزأ من المجتمع. لهذا، ينتقدون هيمنة الرأسمالية التي حولت المال والعمل والأرض إلى سلع، مما أدى إلى تفكيك الروابط الاجتماعية وزيادة التفاوت الاقتصادي. هارت دور الاقتصاد غير الرسمي (الأسواق الشعبية) إلى جانب الاقتصاد الرسمي في تعزيز قيم التضامن والتبادل والتعاون، بينما يسلط هان الضوء على البعد الاجتماعي للمال متبنيا طرح بولاني الذي أكد أن المال الذي تحول بفعل الرأسمالية إلى أداة للربح، هو أداة اجتماعية، وليس مجرد وسيلة لتكديس الثروة، مما يفتح المجال لاقتصاديات أكثر عدالة وإنسانية، وهو ما تم التطرق إليه في مقالة الهبة لمارسيل موس؛ فالاقتصاد غير الرسمي يستلهم روحه من الهبة والتبادلات القائمة على الثقة والكرم قبل العقود التجارية التي جاءت بها الرأسمالية، ليخلصا إلى ضرورة بناء نموذج اقتصادي أكثر إنسانية، يعيد التوازن بين السوق والمجتمع لضمان العدالة والاستقرار.
ثالثا: الأنثروبولوجيا الاقتصادية، مقارنة بين مارسيل موس وكيث هارت وكريس هان و وكارل بولاني
1- على مستوى المنهج وتصورهم للاقتصاد:
1ـ1 مارسيل موس "مقالة في الهبة":
يحتكم الأنثروبولوجي الفرنسي مارسيل موس في دراسته للظاهرة الاجتماعية إلى منهج يمزج فيه بين الحليل السوسيولوجي والأنثروبولوجي، ويرد ذلك إلى أن الظاهرة الاجتماعية حسب مارسيل موس هي ظاهرة مركبة تتميز بالتنوع والتعدد، ولعل هذا المنهج هو قاد مارسيل موس إلى التأكيد أن "الهبة" هي شكل من أشكال الاقتصاد الذي يحكمه الالتزام الاجتماعي وليس الربح المادي، ويحضر هذا الالتزام الاجتماعي على مستوى التبادل الأخلاقي القائم بين الواهب والموهوب له.المجتمعات التقليدية لم تعتمد على الأسواق، بل على أنظمة الهدايا والتبادل المتبادل.
2ـ1 كارل بولاني:
اعتمد كارل بولاني في دراسته للأنظمة الاقتصادية على منهج تاريخي-أنثروبولوجي- نقدي يجمع بين تحليل التحولات الاقتصادية عبر الزمن، ودراسة المجتمعات التقليدية، ونقد الرأسمالية وأسواقها الحرة. في كتابه "التحول الكبير"، أوضح أن الأسواق لم تنشأ بشكل طبيعي كما تدّعي الليبرالية الكلاسيكية، بل كانت نتاجًا لتدخل الدولة من خلال القوانين والإصلاحات السياسية. استلهم بولاني أفكاره من الأنثروبولوجيا، حيث درس مجتمعات لا تعتمد على السوق كنظام اقتصادي رئيسي، مشيرًا إلى أن إعادة التوزيع والتبادل الاجتماعي كانا أساس الاقتصاد قبل ظهور الرأسمالية. كما تبنى نهجا نقديا، حيث يرى أن تحويل العمل والأرض والمال إلى سلع هو كارثة اجتماعية تؤدي إلى تفكيك الروابط الاجتماعية وزيادة الاستغلال. من خلال مقارنته بين الاقتصادات التقليدية والحديثة، كما أوضح بولاني أن الرأسمالية ليست النظام الاقتصادي الوحيد الممكن، بل هي نموذج تاريخي جاء نتيجة صراعات سياسية واجتماعية (الثورة الصناعية، الدولة والبورجوازية، تفكيك الإقطاع في أوروبا، الاحتجاجات العمالية والصراع الطبقي... وهوما أدى إلى تدخل الدولة لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار)، وليس تطورا طبيعيا كما يروج له أنصار السوق الحرة.
3ـ1 كيث هارت وكريس هان:
اعتمد كريس هان وكيث هارت في دراستهما للأنثروبولوجيا الاقتصادية على منهج تاريخي-إثنوغرافي-نقدي، حيث حاولا تجاوز النظرة التقليدية التي ترى الاقتصاد كمجموعة من القوانين الثابتة، وبدلا من ذلك، درسا كيف تتشكل الأنظمة الاقتصادية في سياقات اجتماعية وثقافية مختلفة. ركز هان على المجتمعات ما بعد الاشتراكية، محللا كيف انتقلت من الاقتصاد المركزي إلى اقتصاد السوق، بينما قدّم هارت دراسات ميدانية عن الاقتصاد غير الرسمي في إفريقيا، موضحاً أهمية الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة رسميًّا في دعم المجتمعات. ينتقد الباحثان فكرة أن السوق الحرة هي النموذج الوحيد الفعال، ويؤكدان أن الاقتصاد ليس مجرد معاملات مالية، بل هو جزء من العلاقات الاجتماعية والثقافية، حيث تؤثر القيم والممارسات المحلية على طريقة تبادل الموارد والعمل والإنتاج.
يجتمع مارسيل موس، وكارل بولاني، وكيث هارت، وكريس هان في رفضهم للنظرة التقليدية التي ترى الاقتصاد ككيان مستقل عن المجتمع، حيث يؤكدون جميعا أن الأنظمة الاقتصادية متجذرة في العلاقات الاجتماعية والثقافية. يرى موس أن التبادل في المجتمعات التقليدية لم يكن مبنيا على الربح، بل على الهبة والالتزام الأخلاقي، بينما يوضح بولاني أن الأسواق الحرة ليست تطورًا طبيعيًا، بل نتاج صراعات سياسية أدت إلى تدخل الدولة في الاقتصاد. من جهته، يركز هارت على الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن الأنشطة الاقتصادية تتجاوز الأسواق الرسمية، بينما يحلل هان كيف تتكيف المجتمعات مع التحولات الاقتصادية الكبرى. يلتقي هؤلاء المفكرون في فكرة أساسية مفادها أن الاقتصاد ليس مجرد أرقام وقوانين، بل هو شبكة من التفاعلات الاجتماعية التي تتغير وفق السياقات التاريخية والثقافية.
على الرغم من اتفاق مارسيل موس، كارل بولاني، كيث هارت، وكريس هان على أن الاقتصاد ليس مجرد سوق مستقل، بل هو جزء من النسيج الاجتماعي، إلا أنهم يختلفون في طريقة التحليل والتركيز. يرى موس أن التبادل في المجتمعات التقليدية كان يقوم على الهبة والالتزام الاجتماعي وليس على منطق الربح، بينما يركز بولاني على التحولات الكبرى التي أدت إلى ظهور الرأسمالية، معتبرًا أن الأسواق الحرة فرضت سياسيا ولم تنشأ طبيعيا. من جهته، يدرس هارت الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن هناك أنشطة اقتصادية تعمل خارج السوق الرسمي لكنها تبقى أساسية للمجتمعات، في حين يركز هان على التحولات ما بعد الاشتراكية، محللًا كيف تتكيف المجتمعات مع الانتقال من الاقتصاد المركزي إلى السوق. في حين أن بولاني كان أكثر نقدا للرأسمالية، كان هارت وهان أكثر اهتماما بفهم كيفية تكيف الأفراد مع الأنظمة الاقتصادية بدلًا من رفضها كلّياً.
خاتمة:
على سبيل الختام، يتضح من خلال المقارنة بين إسهامات مارسيل موس وكيث هارت وكريس هان، أن كلًّا منهم ساهم بشكل كبير في تطوير الفهم الأنثروبولوجي للهبة والاقتصاد من زوايا مختلفة، فمارسيل موس ينظر إلى الاقتصاد من زاوية أنثروبولوجية- تاريخية تبرز مركزية العطاء والعلاقات الاجتماعية، بينما يتبنى هارت وهان رؤية تحليلية-معاصرة تسلط الضوء على التفاعل بين الرسمي وغير الرسمي في الأنظمة الاقتصادية الحديثة.
وتتيح هذه الإسهامات لكل باحث في حقل العلوم الاجتماعية، فهم الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية لمختلف أشكال علاقات التبادل والهبة ضمن السياقات الاقتصادية المتنوعة. كما تكشف هذه المقاربات عن دور أنثروبولوجيا الاقتصاد في فهم المال والتبادل ليس فقط كوسائل مادية، ولكن كبنى اجتماعية وثقافية تعكس القيم والعلاقات الإنسانية. فمن خلال دراسة الاقتصاد كعملية متجذرة في النظم الاجتماعية، يصبح من الممكن تحليل كيف تتشكل الأسواق، وكيف تتداخل شبكات الثقة والتعاون.
المراجع المعتمدة:
- الأنثروبولوجيا الاقتصادية، الإتنوغرافيا والتاريخ والنقد. كريس هان وكيث هارت، ترجمة عبد الله فاضل، مراجعة فايز الصياغ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ط1 بيروت، تشرين الأول 2014
- تراث الأنثروبولوجيا الفرنسية في تقدير الممارسة الفكرية لمارسل موس، تنسيق وتقديم يونس الوكيلي، 2016
- مصطفى النحال دافيد غرايبر، الأسس الأخلاقية للعلاقات الاقتصادية مقاربة من منظور مارسيل موس، مؤمنون بلا حدود 2025
- مارسيل موس مقالة في الهبة" أشكال التبادل في المجتمعات الأرخية وأسبابه. ترجمة محمد الحاج سالم، ط1 دار الكتاب الجديد 2014.
- كارل بولاني "التحول الكبير"، الأصول السياسية والاقتصادية لزمننا المعاصر، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة محمد فاضل طباخ، بيروت ط1، 2009
[1] - الأنثروبولوجيا الاقتصادية، الإتنوغرافيا والتاريخ والنقد. كريس هان وكيث هارت، ترجمة عبد الله فاضل، مراجعة فايز الصياغ، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. ط1 بيروت، ص 14
[2] - تراث الأنثروبولوجيا الفرنسية في تقدير الممارسة الفكرية لمارسل موس، تنسيق وتقديم يونس الوكيلي، 2016، ص 07
[3] - مصطفى النحال، دافيد غرايبر، الأسس الأخلاقية للعلاقات الاقتصادية مقاربة من منظور مارسيل موس، مؤمنون بلا حدود 2025، ص 11
[4] - مارسيل موس مقالة في الهبة" أشكال التبادل في المجتمعات الأرخية وأسبابه. ترجمة محمد الحاج سالم، ط1 دار الكتاب الجديد 2014، ص 11
[5] - المرجع نفسه ص 10
[6] - مارسيل موس مقالة في الهبة" أشكال التبادل في المجتمعات الأرخية وأسبابه. ترجمة محمد الحاج سالم، نفس المرجع السابق ص 23
[7] - مارسيل موس، نفس المرجع السابق "مقالة في الهبة "، ص 152
[8] - مارسيل موس، "مقالة في الهبة" أشكال التبادل في المجتمعات الأرخية وأسبابه. ترجمة محمد الحاج، ص 47
[9] - مارسيل موس، "مقالة في الهبة" نفس المرجع السابق ص 201
[10] - نفس المرجع السابق ص 222
[11] - نفس المرجع السابق ص 225
[12] - كريس هان وكيث هارت الأنثروبولوجيا الاقتصادية، التاريخ والإثنوغرافيا والنقد، ترجمة عبد الله فاضل. بيروت ط1، 2014.ص 14
[13] - نفس المرجع السابق، ص 24
[14] - المرجع نفسه، كريس هان وكيث هارت الأنثروبولوجيا الاقتصادية، التاريخ والإثنوغرافيا والنقد. ص 27
[15]- المرجع نفسه، ص 27
[16] - نفس المرجع السابق، ص 32
[17] - المرجع نفسه، ص 34
[18] - المرجع نفسه، كريس هان وكيث هارت الأنثروبولوجيا الاقتصادية، التاريخ والإثنوغرافيا والنقد. ص 37-56
[19] - المرجع نفسه، ص 59-79
[20] - المرجع نفسه، ص 59-83
[21] - المرجع نفسه، ص 84-105
[22] - المرجع نفسه، ص 141
[23] - نفس المرجع، ص 165
[24] - نفس المرجع، ص 189-215
[25] - المرجع نفسة، ص 13
[26] - المرجع نفسه، ص 17
[27] - كارل بولاني "التحول الكبير"، الأصول السياسية والاقتصادية لزمننا المعاصر، المنظمة العربية للترجمة، ترجمة محمد فاضل طباخ، بيروت ط1، 2009، ص 153
[28] - كارل بولانيي، المرجع نفسه، ص 311
[29] - المرجع نفسه، ص 309