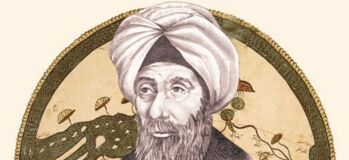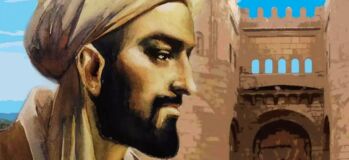ابن خلدون: قضايا مثارة حول مؤسسية علم الاجتماع ومدى مشاركة العرب في النهضة العلمية
فئة : مقالات
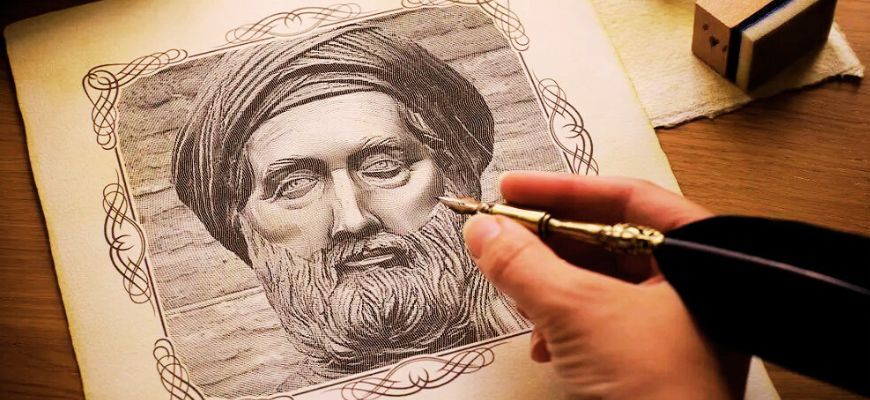
ابن خلدون: قضايا مثارة حول مؤسسية علم الاجتماع
ومدى مشاركة العرب في النهضة العلمية
يأتي اهتمامنا بمفكر كبير هو عبد الرحمن بن خلدون، أحد العقول النيرة في تاريخ الفكر العربي. فقد جمع بين التحصيل الوافر والدقيق لكل العلوم المعروفة في عصره، وبين أصالة الفكر ودقة المنهج العلمي، والقدرة على النفوذ إلى جوهر المشكلات العلمية، فضلاً عن أصالة المنهج في الملاحظة والتشخيص والكشف عن الأسباب والعلامات. وكان عالماً بارزاً في الفلسفة، وأسس علم الاجتماع، كما كان مؤرخاً كبيراً ومرموقاً. وقد احتل مكانة بارزة ليس فقط في الفكر العربي، بل وفي الفكر الإنساني عامة. ومثل هذا العلم الفكري يجب العمل على إحياء تراثه الضخم والعناية به نشرًا وتحقيقًا، حتى تستند النهضة الفكرية العربية إلى أعمدة راسخة.
ومن الطبيعي أن دراسة شخصية كابن خلدون يمكن تناولها من جوانب عديدة، ومن زوايا مختلفة تمامًا، ومناهج متباينة في بعض الأحيان، مما كان له أثر بارز في تعمق آراء هذا الرجل، الذي لابد أن تختلف فيه الآراء بقدر ما في فكره من حيوية وخصب وقلق مثار للتساؤل.
وُلد عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن خلدون في تونس في غرة رمضان عام 732هـ (27 مايو 1332م)، وتوفّي بالقاهرة في 25 رمضان سنة 808هـ (19 مارس 1406م). وقد درس المنطق والفلسفة والفقه والتاريخ، وشغل مناصب رفيعة في بلاط السلطان أبو عنان المريني صاحب تلمسان عام 755هـ، حتى وشى به حساده عند السلطان بتهمة التآمر، فزُجّ به في السجن، وظل فيه حتى توفي السلطان فتم الإفراج عنه.
وفي سنة 764هـ سافر إلى الأندلس، فأكرمه سلطان غرناطة وانتدبه سفيراً عنه، ثم عاد بعد ذلك إلى وطنه. وفي سنة 784هـ خرج قاصداً مكة للحج، وعندما وصل إلى الإسكندرية توقف بها، ثم انتقل منها إلى القاهرة، واشتغل بالتدريس في الأزهر، حتى ولاه السلطان برقوق سنة 786هـ القضاء على المذهب المالكي. ثم سافر إلى الحجاز سنة 789هـ، وعاد في السنة التالية إلى مصر، وظل مقيمًا بها حتى وفاته.
ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع أم أوغست كونت؟
من الطبيعي أن يكثر الحديث عن مناط الابتكار الأول في فكر ابن خلدون، وأعني بذلك دوره في إنشاء علم الاجتماع، والتساؤل عما إذا كان ابن خلدون هو مؤسس علم الاجتماع أم أوغست كونت. ويرى عدد من الباحثين أن الذين يقولون إن أوغست كونت هو المؤسس لم يطلعوا على مؤلفات ابن خلدون، ليتمكنوا من تمييز واضح بين ما فعله ابن خلدون وما فعله كونت، حيث إن ابن خلدون سبق أوغست كونت بأكثر من أربعة قرون ونصف. ولذا، فلا مجال للتشكيك في أن ابن خلدون هو أول من أسس علم الاجتماع.[1]
ويبقى بعد هذا أن نحدد فعلاً ماهية علم الاجتماع، حتى يمكن أن نقرر حقًا هل حقق كل من ابن خلدون وأوغست كونت هذه الماهية على السواء. فهنا تكمن فعليًا طبيعة البحث ومحك الفصل.
وقد تناول هذه المسألة-أي تحديد ماهية علم الاجتماع-الكثير من الباحثين، ورأى بعضهم أنه بعد بيان خصائص علم الاجتماع يمكن الدخول إلى بيان دور كل من ابن خلدون وكونت في تأسيسه. وقد ذهب هؤلاء إلى أن كلا منهما رأى ضرورة إنشاء دراسة جديدة للظواهر الاجتماعية، واعتقد أن تكون هذه الدراسة وضعية، تهدف إلى الكشف عن طبيعة هذه الظواهر.
وقد قام كل منهما بإنشاء هذه الدراسة، ولا فرق بينهما في هذا الصدد إلا في ناحيتين:
1- الأسباب التي دعتهما إلى إنشاء هذه الدراسة مختلفة: فالأول دُفع إلى ذلك بسبب أخطاء المؤرخين، والثاني دفع إليه بما رآه أو خيل إليه من اضطراب الناس في فهم الأشياء.
2- درجة الابتكار في الدراسة: فابن خلدون كان صادقًا فيما قرره من أنه لم يسبقه أحد إلى هذه الدراسة، أما كونت فقد خيل إليه أنه أول من قام بهذا المشروع على وجه كامل، مع أن ابن خلدون سبق إليه بالفعل.[2]
أما إذا كان أوغست كونت قد قرأ لابن خلدون، فتُذكر بعض الحجج في هذا الصدد، منها أن كونت كان له طالب مصري يدرس الهندسة في مدرسة الهندسة بباريس.[3] أهدى إليه كونت أحد كتبه، وقد أطلعه هذا الطالب على "مقدمة" ابن خلدون.[4] وقد رأى أحد الباحثين في بحث حديث نسبيًّا الرأي نفسه.[5]
ابن خلدون وقلة نصيب العرب في النهضة العلمية
عندما اتصل العرب بالفرس، نقلوا بعض كتبهم في التاريخ والسير والموسيقى والأخلاق ونظام الحكم والقصص والفلك والغناء. ومن هذه الكتب ما يرجع إلى أصل فارسي، ومنها ما يرجع إلى أصل يوناني. وكان للفرس الذين ترجموا من الفارسية إلى العربية، وللفرس الذين ألفوا بالعربية مؤلفات شتى، جهد عظيم في توجيه الحركة العلمية ودفعها إلى الأمام. ومن الإنصاف أن نعترف بآثارهم ونشيد بفضلهم. ولكن –أيضًا– من الإنصاف للعرب ألا ننسب الفضل كله إلى الفرس، فنغمط العرب حقهم، كما فعل ابن خلدون ومن سار على أثره.
فماذا ادعى ابن خلدون؟
قال:
"من الغريب الواقع أن حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم، سواء في ذلك العلوم الشرعية أو العلوم العقلية، إلا في القليل النادر. وإن كان منهم العربي في نسبته، فهو عجمي في لغته ومرباه ومشيخته، مع أن الملة عربية وصاحب شريعتها عربي".
ثم علل ذلك بقوله:
"والسبب أن الملة في أولها لم يكن فيها علم ولا صناعة، لمقتضى أحوال السذاجة والبداوة، وإنما كانت أحكام الشريعة، التي هي أوامر الله ونواهيه، ينقلها الرجال في صدورهم، وقد عرفوا مأخذها من الكتاب والسنة بما تلقوه من صاحب الشرع وأصحابه. وكان القوم يومئذ عربًا لم يعرفوا أمر التعليم والتأليف والتدوين، ولم يُدفَعوا إليه، ولا اعتادتهم إليه حاجة، فجرى الأمر على ذلك زمن الصحابة والتابعين. ثم احتُج إلى وضع التفاسير القرآنية وتقييد الحديث، وكثر استخراج الأحكام من الكتاب والسنة، وكان اللسان قد فسد، فاحتُج إلى وضع القواعد النحوية.
وصارت العلوم الشرعية كلها ملكات في الاستنباط والقياس، واحتاجت إلى علوم أخرى تكون وسائل لها، من معرفة قوانين العربية، وقوانين الاستنباط والقياس، والدفاع عن العقائد بالأدلة. فصارت هذه العلوم كلها علومًا ذات ملكات محتاجة إلى تعليم، فاندرجت في جملة الصنائع.
وكنا قد قدمنا أن الصنائع من منتحل الحضر، وأن العرب أبعد الناس عنها، فصارت العلوم حضرية وبعيدة عن العرب. والحضر في ذلك العهد هم العجم، ومن في معناهم من الموالي وأهل الحواضر الذين حاكوا العجم في الحضارة وأحوالها من الصنائع والحرف، لأنهم أهل حضارة راسخة منذ دولة الفرس.
فكان صاحب صناعة النحو سيبويه، والفارسي من بعده، والزجاج من بعدهما، وكلهم عجم في أنسابهم، وإنما تربوا على اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب، وصاروه قوانين وفنًا لمن بعدهم.
وكذلك حملة الحديث الذين حفظوه من أهل الإسلام، أكثرهم عجم أو مستعجمون في اللغة والمربى.
وكان علماء أصول الفقه كلهم عجمًا، وكذلك حملة علم الكلام، وأكثر المفسرين. ولم يقم بحفظ العلم وتدوينه إلا الأعاجم. وظهر مصداق قوله صلى الله عليه وسلم: "لو تعلق العلم بأكناف السماء لناله قوم من أهل فارس".
أما العرب الذين أدركوا هذه الحضارة وسلكوا سبيلها، وخرجوا إليها من البداوة، فشغلتهم الرياسة في الدولة العباسية، وما دفعوا إليه من القيام بالملك عن القيام بالعلم، فإنهم كانوا أهل الدولة وحماتها، وأولي سياستها، مع ما يلحقهم من الأنفة عن انتحال العلم حينئذ، لأنه صار من جملة الصنائع. والرؤساء أبدًا يستنكفون من الصنائع والمهن وما يجر إليها، وتركوا ذلك لمن قام به من العجم والمولدين، وما زالوا يرون لهم حق القيام به، فهو دينهم وعلومهم، ولا يحتقرون حَمَلتها كل الاحتقار، حتى إذا خرج الأمر من العرب جملةً وصار للعجم، صارت العلوم الشرعية غريبة النسبة عند أهل الملك، بما هم عليه من البعد عن نسبتها.
وأما العلوم العقلية، فلم تظهر في الملة إلا بعد أن تميز حملة العلم ومؤلفوه، واستقر العلم كله صناعة، فاختصت بالعجم، وتركتها العرب، وانصرفوا عن انتحالها، فلم يحملها إلا المعربون من العجم، شأنها شأن الصنائع."
ومعنى هذا أن ابن خلدون يرى أن حملة العلوم – إلا القليل النادر – من العجم، وبخاصة الفرس، وأن العربي منهم في نسبه أعجمي في بيئته وتعلمه ومعرفته، بل بلغة العجم وأخذًا من علمائهم.
ولقد عمم حكمه هذا على العلوم التي كانت معروفة في ذلك الوقت، ومثل بالعلوم الدينية من تفسير وحديث وأصول وعقائد، وبالعلوم اللسانية من نحو وصرف ولغة، وبالعلوم الكونية التي ازدهرت بعد ذلك.
وأرجع اختصاص العجم بالعلوم وتخلف العرب عنهم إلى ثلاثة أسباب:
الأصل الحضاري: كان العرب أهل بداءة في الوقت الذي كان فيه العجم أهل حضارة، والبداوة لا تقتضي العلوم، بل الحضارة هي التي تقتضيها. فلما دعت الحاجة إلى وضع التفاسير، وتدوين الحديث، واستنباط الأحكام من القرآن والسنة، ووضع قواعد النحو، تقدم العجم على العرب، لأنهم أصحاب ملكات راسخة من قبل.
انشغال العرب بالسياسة: لما تحضر العرب، شغلهم الملك والحكم والسياسة والرياسة عن الاشتغال بالعلوم، فاستقل بها العجم.
استنكاف العرب عن ممارسة العلوم: استنكف العرب – وهم أهل الرياسة – من ممارسة العلوم، لأنها من أنواع الحرف والصناعات، وتركوها للأعاجم، ولم يجدوا في ذلك حرجًا ولا بأسًا، لأن الدين لهم جميعًا، ولأن العلوم أعجمية النسبة.
المسجد الذي درس فيه ابن خلدون في تونس
ومن العجب أن بعض الباحثين وافقوا ابن خلدون على هذا الرأي.
والحق أن هذه الأحكام جائرة، فمن التجني على العرب وغمطهم حقهم أن يتناسى ابن خلدون، والمتأثرون به، جهود العرب العظيمة في مجال العلم، ثم يتدارك حكمه الجائر بقوله: إن المشتغلين بالعلوم من العرب كانوا قلة نادرة، وبهذا عزا الفضل كله إلى العجم.
أما الرد على هذه النظرية، فإنه قائم على عدة أدلة.
-1-
يتبين لكل باحث محايد، بعيدًا عن التعصب، أن العرب وضعوا بعض العلوم وفعلوا فيها قبل أن يتصلوا بالعجم، وأنهم ساهموا بنصيب كبير في التأليف بعد اتصالهم بالفرس وغيرهم.
في العلوم الشرعية:
إذا كان أبو حنيفة فارسي الأصل، فإن الأئمة الثلاثة الآخرون – مالك والشافعي وابن حنبل – عرب خلص. وحسبنا في هذا المجال أن نلاحظ أن أبا حنيفة تلقى أكثر علمه على حماد بن سليمان، وحماد هذا ينتسب بالولاية إلى قبيلة أشعر اليمنية، وقد تلقى حماد عن عربيين يمنيين هما إبراهيم النخعي وعامر الشعبي، وأخذ هذان عن عرب هم شريح بن الحارث الكندي، وعلقمة بن قيس النخعي، والأسود بن يزيد النخعي، ومسروق بن الأجدع الهمداني، وهؤلاء الأربعة تلقوا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وهما عربيان.
أما أشهر تلاميذ أبي حنيفة فثلاثة: أبو يوسف ومحمد وزفر. فأبو يوسف وزفر عربيان، أما محمد بن الحسن الشيباني، فهو من الموالي وينتسب إلى شيبان بالولاية.
كما أن من علماء التشريع والقضاء العرب: عبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل، وأبا الدرداء، والأوزاعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم.
إذن، ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة عرب، واثنان من تلاميذ أبي حنيفة الثلاثة عرب، وأكثر من استقى منهم أبو حنيفة عرب، وكثير من علماء التشريع والقضاء من العرب.
وليس من الإنصاف أن نتناسى مالك بن أنس، وهو أول من ألف في الفقه الإسلامي من العرب.
وإذا كان من علماء الأصول عجم، فإن الذي وضع العلم وسبق إلى التأليف فيه عربي صريح هو الشافعي، حتى ليقال إن نسبته إليه كنسبة المنطق إلى أرسطو، ونسبة العروض إلى الخليل. وإذا كان البخاري فارسيا، فإن مسلم بن الحجاج وابن لهيعة عربيان.
في العلوم اللغوية:
حقيقة، اشتهر من أبناء الفرس: سيبويه، والكسائي، وأبو علي الفارسي، والزجاج، والفراء، وابن جنى، وابن فارس. وكذلك اشتهر بها من العرب: الخليل بن أحمد، والمازني، وابن دريد، والمبرد، والأزهري، والنضر بن شميل، والضبي.
ومن فخار العرب أن الخليل بن أحمد الفراهيدي، العربي الصميم، هو أول من دون كتابًا في النحو، فأملاه على تلميذه سيبويه، وأول من استنبط أوزان الشعر العربي وحصرها في ستة عشر بحرًا، نقلها الفرس إلى لغتهم فيما بعد ونظموا على كثير منها.
الدراسات الأدبية:
وإذا كان من أبناء الفرس من برع في الرواية والدراسة الأدبية مثل أبي عبيدة، معمر بن المثنى، حماد، خلف الأحمر، أبي عمرو الشيباني، التبريزي، والجرجاني، فقد برع فيها كثير من العرب أيضًا، مثل قتادة بن دعامة، أحد رواد العصر الأموي الثقاة، وأبي عمر بن العلاء، أعلم الناس بالعربية والقراءات أيام العرب وأشعارها، والأصمعي، وأبي زيد الأنصاري، والمفضل الضبي، ومحمد بن سلام الجمحى، والجاحظ، وأبي حيان التوحيدي، وأبي الفرج الأصبهاني.
علم الكلام والفلسفة
الكندى
قد يذهب البعض إلى نسب تخلف العرب عن العجم في علم الكلام والفلسفة؛ لأن واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد، وأبا الهزيل العلاف، والنظام، والفارابي، والرازي، وابن سينا، وابن رشد، كلهم أعاجم.
ولكنهم يتناسون علماء عربًا مثل بشر بن المعتمر، والجاحظ، وثمامة بن الأشرس النميري، وجعفر بن مبشر الثقفي، وجعفر بن حرب الهمداني، والحسن البصري، وأحمد بن أبي داود، والكندي، وأبا حيان التوحيدي.
التاريخ
وكان من الفرس مؤرخون كالطبري، وابن مسكويه، والبلاذري، وابن خلكان. لكن أيضًا كثير من المدونين الأوائل للسيرة النبوية كانوا عربًا، مثل: أبان بن عثمان، وعروة بن الزبير بن العوام، وشرحبيل بن سعد، وعبد الله بن البكر بن حزم، وعاصم بن عمر، وابن شهاب الزهري.
كما لا ننسى أن كثيرًا من الذين دونوا التاريخ الإسلامي كانوا عربًا، مثل: أبي مخنف لوط بن يحيى، وسيف بن عمر، والزبير بن بكار، والهيثم بن عدى، الذي سبق الطبري بترتيب الحوادث حسب السنوات. وقد اعتمد الطبري على كتب هؤلاء فيما اعتمد عليه من مصادر تاريخه. وكذلك اشتهر من مدوني الأنساب عرب، مثل: محمد بن السائب الكلتي وابنه هشام، وأبي اليقظان النسابة. كما لا ننسى أمثال ابن هشام، والمسعودي، وأبي فرج الأصفهاني.
-2-
ويبدو أن ابن خلدون والمتأثرين برأيه نسوا أو تناسوا أن العلماء المنسوبين إلى الفرس يرجع كثير منهم إلى أصل فارسي بعيد، إذ صلتهم بنسبهم تعتمد على الجد أو ما بعده، وبعضهم يمت إلى الفرس من جهة أبيه وجده، أو من جهة أمه وحدها، فنصفهم الآخر عربي.
وهؤلاء وأولئك عرب في لغتهم وثقافتهم ودينهم، متأثرون بالمجتمع العربي الإسلامي إلى حد بعيد. ولولا الإسلام، والحرية التي نِعموا بها، والتشجيع الذي كفله المسلمون لهم وحفز عزائمهم، لما أتموا إنتاجهم الذي رفع من قدرهم.
ويكفي أن نضرب المثال بالليث بن سعد، أحد أئمة الفقه في مصر، فلو أن أصله البعيد من أصفهان بفارس، فقد وفد أهله إلى مصر، ثم وُلد فيها في قلقشندة سنة 94 هـ. وتعلم على شيوخ مصر، ثم رحل إلى الحجاز وسمع من شيوخه، وتوجه إلى العراق ودرس على علمائه، ثم عاد إلى مصر واستقر بها. فغَلَبته البيئة العربية في لغته وثقافته وحياته كلها، رغم أصله الفارسي البعيد. وهذا شأن كثير من العلماء الذين يُضرب لهم الأصل العجمي.
-3-
كما أن كثيرين لا يوافقون ابن خلدون على قوله إن العربي من العلماء أعجمي في لغته ومرباه ومشيخته؛ لأنه تناسى أن البيئة لم تكن عربية خالصة ولا عجمية خالصة، بل كانت مزيجًا من هذا وذاك في كثير من مظاهر الحياة. وقد جانبه الصواب في دعواه بأن علماء العرب كانوا أعاجم في لغتهم، لأن أكثرهم لم يكن يعرف غير العربية. وعلى ذلك، فقد ناقض نفسه حين قال إن سيبويه والفارسي والزجاج أعاجم في أنسابهم، ولكنهم ربوا في اللسان العربي فاكتسبوه بالمربى ومخالطة العرب، وصاروه قوانين وفنًا لمن بعدهم. فهو هنا يعترف بأن البيئة متأثرة بالعرب، ويرى أثرها واضحًا رغم أعجمية اللغة والمظهر والأساتذة.
-4-
وإذا كان يمكن موافقة ابن خلدون على بعض تعليله لكثرة العلماء من الأعاجم، فإنه لا يمكن الاتفاق معه في دعواه بأن العرب أنفوا عن الاشتغال بالعلم وتخلوا عنه للعجم؛ ذلك أن للعرب في تاريخ العلم مجدًا متألقًا لا يخبو، فقد عكفوا على التعلم منذ أن شرح الله صدورهم للإسلام، ووجدوا في طلب العلم عبادة واستجابة لدعوة دينهم، وكانوا يقبلون على مناهل العلم إقبالًا شديدًا. ولهذا كانت ثقافتهم في العصر الأموي متعددة الألوان، وكان علماؤهم يملأون الأمصار، ولم يكونوا مجرد ناقلين عن الفرس واليونان والهنود ما له قيمة وتأثير، وهم لم يأنفوا أن يتلقوا العلوم عن بعض الموالي واليهود والأقباط منذ العصر الأموي. وكان بعض الخلفاء والأمراء يباهون بعلمهم ويقربون إليهم العلماء في العصرين الأموي والعباسي، حتى صار تقديرهم للعلماء مثالًا رائعًا في الشغف بالمعرفة وتشجيع العلماء.
فمن أين تأتى لابن خلدون فكرة أن العرب كانوا يأنفون من انتحال العلم، فتخلوا عنه للعجم؟ وتزداد الحقيقة انكشافًا حين ننتبه إلى أن كثيرًا من العلماء عرب خلص، لكنهم نُسبوا إلى بلدان أعجمية، فالتبس نسبهم وخفى على بعض الدارسين وظنّوهم أعاجم. ومن هؤلاء:
*- مسلم بن الحجاج النيسابوري، فهو عربي من قبيلة قشير، لكن أهله كانوا يقيمون بنيسابور فنسب إليه.
*- أبو الفرج الأصفهاني، فهو عربي من بني أمية ولد في أصفهان فنسب إليه.
*- أبو داود السجستاني، مؤلف "السنن"، عربي من الأزد، منسوب إلى سجستان.
-5-
يبقى شيء آخر، أن أولئك العلماء من أبناء الفرس قد اصطنعوا العربية لغة علمية لهم، وألفوا في العلوم العربية نفسها وفي العلوم الدينية، فهم إذن عرب، عرب بلغتهم ومؤلفاتهم، ومن التعصب أن نعدهم غير عرب. وقد كان اليونانيون يحكمون على كل من يتكلم اليونانية بأنه يوناني، فلماذا لا نحكم على كل من يتكلم العربية لغة أصيلة له بأنه عربي؟
إذن، فقد تبين أن ابن خلدون لم يكن دقيقًا في حكمه وتعميمه، وليس يعنينا الدافع وراء هذا الحكم، سواء كان تعجلاً أو تعصبًا على العرب أو تأثرًا بشيء آخر.
أما الحديث الذي ذكره في تمجيد أهل فارس، فليس له صحة في شيء، لأنه مما افتراه أهل العصبية والشعوبية منذ نشوء الصراع الإثني في العصرين الأموي والعباسي.
[1] بن عاشور، ورقة قدمت لمهرجان ابن خلدون، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2-6 يناير 1962
[2] على عبد الواحد، موازنة بين ابن خلدون وأوجست كونت في دراسته لظواهر الاجتماع، بحث القي في مهرجان ابن خلدون، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2-6 يناير 1962
[3] انظر هذا الرأي في عبد العزيز عزت، ورقة مقدمة الى مهرجان ابن خلدون، القاهرة، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، 2-6 يناير 1962
[4] ابن خلدون، المقدمة، الدار التونسية للنشر والدار العربية للكتاب، سنة 1984
[5] انطر فؤاد البعلي في مؤلفه
Ibn Khaldun & Modern Sociology: an Analytical Study, Almada – Damascus 1997.