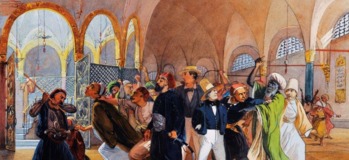الحداثة، والتوتاليتارية، والهولوكوست: باومان يستأنف فكر أرنت
فئة : أبحاث محكمة
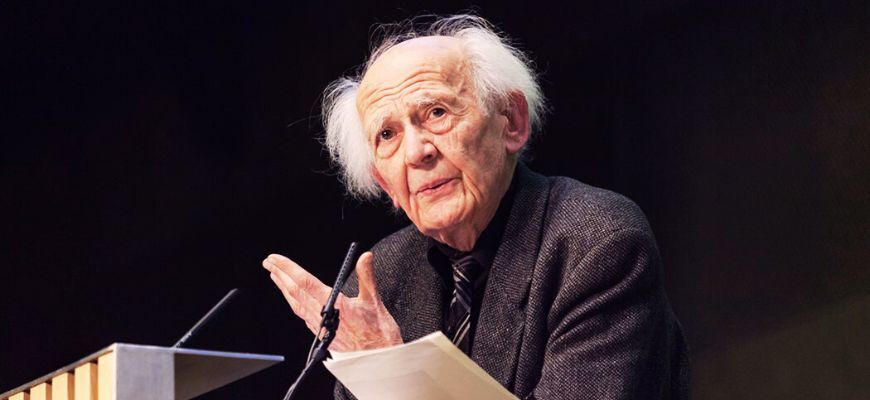
الحداثة، والتوتاليتارية، والهولوكوست:
باومان يستأنف فكر أرنت
الملخص
حمل الزمن الحديث إيمانًا راسخًا بإمكانياته الذاتية في تأهيل الحياة البشرية لتصير أكثر إنسانية ورفاهية، حيث أكدت هذه التطلعات تلك الشعارات المنتشرة في كلّ مكان من البلدان الغربية، والتي بلغت أوجها منذ القرن الثامن عشر، وبذلك أنشد فلاسفة التنوير ومفكريه الحرية والمساواة وحقوق الإنسان للبشرية جمعاء، غير أن الشكوك قد بدأت تتسلل إلى البشرية الأوروبية والعالمية معا حول مصداقية تلك الأحلام منذ مطلع القرن العشرين، الذي افتتح أبوابه بنيران الحرب العالمية المدمرة الأولى، ثم تلتها نشأة الفاشيات والنزعات الشمولية المهووسة بالتسلط والطغيان، وانتشرت بسرعة في وقت وجيز، كما نما في ذات الوقت، وبكيفية موازية، فكر الإمبريالية والتوسع وإقصاء الآخر ونفيه واستعباده أو استبعاده، هو ما أكدته الحرب العالمية الثانية ومشروع الحل النهائي النازي المعروف بالهولوكوست أو المحرقة التي استهدفت اليهود بصورة خاصة؛ إذ يستأنف زيجمونت باومان من جهته التفكير الذي دشنته حنه أرنت مبكرا حول نشأة التوتاليتارية وأسبابها ومدى ارتباطها بالزمن الحديث. إن باومان يؤكد أن الحداثة الأوروبية تحمل وجهين؛ ولم تعرف البشرية إلى حدود القرن العشرين إلا وجها واحدًا هو الحرية والرفاه. أما الوجه الثاني المتمثل في الحرب والإقصاء والطغيان، فقد بدأ يتكشف بوضوح مع النزعات الشمولية ومشاريع الإبادة النازية؛ ذلك أن البربرية في نظر باومان ليست غريبة عن الحداثة، فقد استمرتا معا في الحياة جنبًا إلى الجنب طوال التاريخ.
المقدمة
كانت حنه أرنت[1] Hannah Arendt سباقة، من دون ريب، إلى إنتاج بحوث معمقة حول المسألة اليهودية بوصفها أحد أصول الشمولية، وهو الموضوع المحوري الذي شغلها طيلة حياتها النظرية والشخصية معا، وظهر مصقولًا في مؤلفات كثيرة[2]، حيث راحت الفيلسوفة تزاوج بين التاريخ والعلم السياسي لتقديم صورة حية عن معاداة السامية، وتدقق موقف المجتمع والسياسة الغربية الحديثة منها، خاصة في ظلّ الإبادة التي استهدفت اليهود في القرن العشرين؛ ذلك أن زيجمون باومانت[3] (1925-2017) Zygmunt Bauman، فيلسوف السيولة المتشبع بالرؤية الماركسية، والذي كرس أعمالا كبيرة لدراسة تشظي بنايات المعنى في فترة ما بعد الحداثة؛ إذ يعكف في هذا السياق على تحليل حادثة الهولوكوست The Holocaust في إطار السوسيولوجيا والفلسفة الاجتماعية مسترشدًا بتحليلات أرنت، مستهدفا بذلك تقديم فهم أعمق عن علاقتها بتطور الحضارة الغربية، ومتسائلا في الوقت نفسه عما إذا كانت الهولوكوست هي مجرد حادثة عرضية أو نوبة طارئة حلَّت بالعقل الأوروبي إبان الحكم النازي بسبب أفكار سيئة لدى زعيم مجنون، وبالتالي ستكون الهولوكوست هي شأن يهودي خالص؟ أم إن هذا الحادث الذي راح ضحيته الملايين هو الوجه الثاني الأكثر عمقًا للحداثة الغربية؟ فقد عرفنا الحداثة بوصفها حرية وديمقراطية وعقلانية، ثم جاءت الهولوكوست لتستكمل معرفتنا بأنها أيضا معاداة وحرب وإبادات واستعمار وقنابل ذرية؟ لهذا يبدو باومانت أكثر فلسفة من أرنت؛ لأنه راح يستشكل الحداثة في علاقتها بنتائج العلوم، ويتساءل في الماضي والحاضر، ليجيب عما تكونه الحداثة وما لا تكونه؟
قد يسأل السائل، بكيفية مشروعة، عما الذي يربط أرنت في تحليلها للتوتاليتارية[4] وعلاقتها بالحداثة من الزاوية السياسية بزيجمونت باومانت الذي يشتغل بعيدًا عن نطاق السياسة؟ فالرجل سوسيولوجي بارع، والجواب هو أن أرنت تتقاطع مع باومانت بصورة فريدة في فهم الحداثة ومعاداة السامية ورواية الهولوكست، حيث انتبهت الفيلسوفة بكيفية مبكرة إلى ما يطبع تلك الأحداث والحركات من غرابة وفرادة في التاريخ السياسي الأوروبي؛ ذلك أن أهمية هذه الفيلسوفة ليست فقط في التأليف عن التوتاليتارية وتحليل أسبابها التاريخية والعلمية ونتائجها، وإنما أساسا في وضع مفهوم الشمولية في قلب التفكير الفلسفي عبر استشكال حوادث السلطة ونوباتها، وزيجمونت باومان نفسه يستشهد بأرنت في سياق تعميق البحث في الإشكالية المطروحة. إن باومان يستأنف التقصي الذي بدأته أرنت قبل زمن طويل لفهم معاداة اليهود وقضية الهولوكوست وما تضمره من معاني بالنسبة إلى المجتمع الحديث؛ إذ يتأسف بحسرة شديدة على إهمال الفلسفة والإنسانيات ما قدمه التاريخ من مادة خصبة حول تلك القضايا، من أجل بحثها واستكناه ما تخفيه من دلالات حول الحضارة الحديثة، حيث يقول الفيلسوف في هذا السياق: "إن الفضل يعود إلى المؤرخين في معرفتنا المتزايدة بالكيفية الصحيحة التي حدثت بها الهولوكوست، لكن هناك تأخر شديد في الجهد الذي يبذله المفكرون من أجل فهم المعنى الذي تنطوي عليه تلك المعرفة فيما يتعلق بالصوة التقليدية السائدة للمجتمع الحديث... فلم يبذل أي جهد حقيقي منذ أن نادى بذلك أدورنو وحنه أرنت. لذا عزمت على الانطلاق من النقطة التي وصل إليها أدورنو وأرنت في المهمة التي لم تنته بعد"[5]، فبقيت الإشكالية معلقة تنتظر في سماء الفكر من يأتي ليستأنف التفلسف عنها، حتى جاء باومان فعمق البحث في خضمها بـكتابه "الحداثة والهولوكوست"، المؤلف العميق في طرحه والمفصل في دفاعه وحجاجه، حيث يكفي لوحده أن يكون موضوعًا لرسالة التخرج من سلك الماستر أو أكثر.
1- الحضارة العالمية: واقع أم أسطورة
في تعريفها البديع تقول الأسطورة الغربية: إن الحداثة تحمل سمة انتصار للعقل، وتهشيم التقاليد والمعتقدات القديمة.[6] إنها سيرورة من الارتقاء نحو اكتمال الإنسان والمجتمع في أفق عالم أكثر عقلانية وأرفع أخلاقا وحرية، عالم الحياة المطلقة، يحدها من جهة الرفاه المادي ورغيد العيش الذي يضمنه العامل التكنولوجي، ومن جهة ثانية أن يعيش الإنسان في مجتمع ديمقراطي حداثي يوفر المساواة والحياة السعيدة، ثم أخيرًا أن يحيا في عالم يجد فيه معنى لوجوده من خلال ممارسة الفلسفة والفن والعلم والإبداع. بناء على هذه الرواية تم اعتبار الهولوكوست، التي وقعت في قلب مجتمع الحداثة الأوروبي، أنها مجرد نوبة عارضة أو حادثة استثنائية عابرة، وبالتالي هي انحراف عن مسار الحداثة الغربية مؤقتا، أو مجرد خطأ أو هفوة سياسية غير مقصودة لا يمكن أن نقيس عليها الحضارة العقلانية، التي تظل فوق كل اعتبار أو مراجعة.
كما ترى نفس الأسطورة أن الهولوكوست هي محض مشكلة ألمانية معزولة ومحدودة في الزمان والمكان، وفي الغالب هي مأساة يهودية؛ لأن اليهود وحدهم من استهدفهم التدمير الشامل دون غيرهم من الشعوب الأوربية أو الأقليات التي تعيش بينهم، حيث يروج الجمهور أن أصول المحرقة كانت في هوس هتلر بأفكار محددة، صاحبتها طاعة حاشيته وقسوة مرؤوسيه بسبب فساد قيمهم وتردي أخلاق زعيمهم.[7] وتبعًا لهذا الرأي، فبمجرد إثبات مسؤولية النظام السياسي الألماني وبالتالي إدانته، سينتهي مسار تقصي أسباب الهولوكست ودوافعها، سنكون أمام معرفة وفهم كامل وفقا لهذا المنظور؛ إذ تحاول هذه الأسطورة أن تحصر الأعمال الإجرامية للتوتاليتارية المعاصرة في مجال ضيق لتخليص الغرب وحداثته من المسؤولية من خلال تقزيم الجرائم وجعلها غير مدعاة لربطها بأبعاد أخرى غير تلك الشائعة.
إن باومان نفسه قضى ردحًا من الزمن مستقرًّا في تفكيره على هذه الشائعات؛ إذ كان يرى أن الهولوكوست مجرد مرض خبيث تسلل إلى الجسم الغربي المتمدن خلسة، وهو إذن في حاجة لتصويب أو علاج، حيث يقول عن هذا ما يلي: إنني "كنت أعتقد من خلال افتراض مسبق أن الهولوكست انقطاع التدفق الطبيعي للتاريخ، وورم سرطاني ينهش في جسد المجتمع المتحضر، وجنون لحظي مس سلامة العقل وصحته. هكذا كنت أستطيع أن أرسم لتلامذتي صورة مجتمع سليم العقل والبدن، تاركًا قصة الهولوكست للمحترفين في علم الأمراض".[8]
تقوم الأسطورة ثالثًا على ما تدعيه النظريات الفلسفية والاجتماعية التقليدية من أن الجرائم القرن العشرين ضد الإنسانية، حتى إذا ما تعلقت بمشروع الحداثة، فإنما هي إحباط وقعت فيه الحداثة الغربية، وليست نتاجًا لها، [9] حيث لم تستطع تحقيق أهدافها كاملة لظروف وملابسات خارجة عنها. وهنا تحديدًا يختلف تحليل باومانت عن عديد المفكرين الآخرين ممن تناول الحداثة وراح في تأويل نصوصها وأحداثها الكبرى.
دحض باومان شائعات الثقافة المعاصرة عن الهولوكست، من أجل فهم الحداثة الغربية بصورة دقيقة، حيث يستشهد بريتشارد روبنسن في أن الهولوكست هي شاهد عيان عن تقدم الحضارة الغربية، وليست دليلًا على فشلها أو انحرافها، فالحداثة الأوربية إذ تشير إلى التطبيب والعلاج والوقاية الصحية، والمعتقدات الدينية السامية والفنون والآداب والموسيقى، فإنها تحيل أيضا على الكولونيالية والحروب ومعسكرات الموت، لذلك من غير المقبول تصور أن الحضارة والبربرية نقيضان"[10]، فالبربرية لم تتلاش من الوجود، بل ظلت مصاحبة في وجودها الحضارة جنبًا إلى جنب، لقد استمر الابتكار والتدمير في آداء مهامهما بالتوازي في الحضارة الغربية، أو بتعبير أدق الابتكار من أجل التدمير إذا أخذنا في الاعتبارات الصناعات فائقة التطور التي تنتج أنواعًا رهيبة من الأسلحة لإبادة أناس بلا سلاح كما هو حال غزة لما يفوق نصف قرن من الدمار. إن الاستيطان ومعه الاستغلال المسلط على البشرية الفلسطينية هو جزء من كلّ يمثُل في الوجه المتوحش للبشرية والحداثة الغربيتين، اللذان يتخذان من الاحتلال والاستغلال الطريق الوحيد في معاملة المجتمعات الأقل تقدما وقوة، وكم يمكنك أن تحصي من أنواع الاحتلالات التي دشنها العصر الأوربي الحديث؛ من احتلال شعوب الأسكيمو في كندا الحالية، إلى إبادة الهنود الحمر في أمريكا، ثم تسليط السلاسل على الرقاب في إفريقيا والهند، وصولا إلى احتلال فلسطين والبدء في كتابة تاريخ ثاني.
هكذا استطاعت الهولوكوست أن تظهر الوجه الفظيع للحداثة، ورغم أن معاداة اليهود كانت قديمة في التاريخ لأسباب مختلفة، حتى إن هناك من يعتقد بأن الهولوكوست كانت حصادًا طبيعيًّا لقرون عديدة من العداء والتعصب الديني والاحتقان العرقي والقومي، وهو ما أسفرت عنه في نهاية المطاف حادثة الحل النهائي، فباومان يعتقد بأنه حتى لو كانت هذه المعاداة الموروثة قد لعبت دورًا مساهمًا صاحب التفكير في المحرقة، فمع ذلك إن مجرد المعاداة لليهود لا يمكنها أن تفسر الهولوكست، فالعداء في حد ذاته ليس تفسيرًا مناسبًا لحادثة الإبادة، وقد لا يكون أحد في التاريخ فكر في مسح اليهود من الوجود فقط بسبب العداوة والحقد المتبادل.
علما بأن الصورة الثانية للحداثة كانت قائمة في سيرورة الحداثة نفسها، أسست لها حركات التحديث والاستنارة، فإذا سلمنا بأن العداء لليهود فكرة لاهوتية، كيف نفسر عداء المثقفين والمصلحين الدينيين، ومارتن لوتر واحد منهم، حيث يقول في ذات الموضوع: إن "غريبة الغرائب أننا لا نعلم السبب في حلول اليهود بيننا، وأيّ شيطان جلبهم إلينا...فالطرق السريعة مفتوحة لهم إلى أيّ مكان يريدون أن يرحلوا إليه...وإذا هم اختاروا الرحيل عنا، فنحن مستعدون أن نقدم لهم حسن المعونة، حتى نتخلص منهم. فهم عبء ثقيل علينا في وطننا، بل هم أشبه بالوباء والطاعون"[11]، والأمر نفسه سيحدث مع فولتير، وهو من أشهر فلاسفة الأنوار الذين ساروا في هذا المنحى. إنه فيلسوف القرن الثامن عشر الملتزم، وصاحب أعمال: "رسالة في التسامح" و"المعجم الفلسفي"، والمدافع البليغ عن قضية جان كلاس التاريخية ضد التعصب الديني والسياسي، هو الفيلسوف الذي ساهم في التحضير لثورة الحرية سنة 1789، إذ يبدو في هذا السياق كمحتقر لليهود مثله في ذلك مثل رجال الدين وعموم الطبقات الشعبية. فـفولتير اتَّهم اليهود برذائل عديدة، حيث وصفهم بالجهل المطبق والطمع المرضي، وأشار إلى نزعتهم البارزة إلى الحقد على الجنس البشري كله وكرهه، [12] إلى حد صارت تستخدم بعض نصوصه كذريعة لمعاداة اليهود، [13] هكذا قُدمَ هذا الفيلسوفُ بصفته معاديا للسامية.
لذلك يذهب باومان إلى أن الهولوكوست قد حلت متلائمة مع مبادئ الحداثة الغربية، ومن أجل فهم هذه الحداثة توجه المفكر إلى إعادة قراءة فلسفات الأنوار والنصوص المؤسسة للعقلانية الغربية ومفاهيم الفلسفة العقلانية المادية، التي سارت في تقديسها للعلم والقانون والنظام وجعلته فوق القيم، سارت في تأليه الطبيعة وشرعنة العلم بوصفه الدين الجديد والعلماء بصفتهم الكهنة الجدد. إنها آلهة جديدة شهدت ميلادها في أرض الحداثة العلمانية هي آلهة التقدم والعلم والدولة القومية. إنه ثالوث مقدس بديل: "الأرض" و"الأمة" و"الدولة"[14].
لقد صار بقدرة قادر كل شيء في هذا العالم قابلًا لأن تنجز حوله معرفة دقيقة يقينية، والذي لم يُعرف حاليًّا، سيُعرف فيما بعد بالطريقة التي يريدها العلم، وفي مقابل هذا، لا شيء أبدًا يمكنه أن يحوز الاعتراف به إلا من خلال المعرفة العلمية الموضوعية الخاضعة للمنهج التجريبي، حتى أن جورج موس كان متأكدًا بأنه يستحيل علينا أن نقيم تمييزا بين الخطاب الفلسفي للأنوار حول الطبيعة الفيزيقية وبين فلسفتها الأخلاقية، فمنذ البداية كان العلم الطبيعي والمثل الأخلاقية والجمالية في كفة واحدة.[15]
هكذا ينتهي باومان إلى أن الحداثة الغربية وإن أقامت أمجادها على رفض الانفعالات المتوحشة، فإن مبادئها الأصيلة لا تتعارض مع ميول الاضطهاد أو فكر الإبادة الشاملة، [16] فكلما كانت إمكانية ازدياد العقلانية الخاصة بجودة التفكير والتدبير زاد معه طرديا حجم الدمار واتسعت حدوده، وبذلك يغدو التدمير طبيعيًّا، الذي لم يعد شيئا عارضًا، بل صار أحد مقومات العقلانية السياسية. فالحداثة لم تقض إذن على العنف والاضطهاد؛ ذلك أن كل ما قامت به هو احتكاره وإخفائه في مناطق مظلمة بعيدة عن أنظار المجتمع، فصار عنفا خفيا وجاهزا لتصفية الخصوم والمختلفين والأقليات، وكل من رأى البستاني ضررا في وجوده داخل أسوار الحديقة السعيدة.
2- الحداثة السياسية في بدلة بيروقراطية
إن غاية مؤلف "الحداثة والهولوكوست" هي تكثيف الدروس والدلالات الخاصة بالهولوكوست، من أجل فهم علاقتها بالوعي الذاتي والتجربة الفعلية لمؤسسات المجتمع المعاصر، [17] وهذا يعني أن هناك معاني سياسية وإدارية-بيروقراطية لحادثة المحرقة، ودلالات لسؤال السيادة، وهي كلها مفاهيم ومبادئ يقدسها العصر الحديث. إن واقع الاضطهاد وما نتج عنه من مجازر في حق الإنسانية، لم تكن مدعمة فقط بالوسائل التكنولوجية الحديثة من أجل تسهيل عمليات الإبادة بأقل جهد وفي وقت أسرع، بل كانت الهولوكست، من جهة أخرى، نتاجًا طبيعيًّا بارزًا للكفاءة التنظيمية التي نتجت عن المجتمع البيروقراطي الذي غدا من مظاهر الدولة العلمانية العصرية، تلك البيروقراطية التي سبق لماكس فيبر (1964-1920) أن درس حضورها في المجتمعات المعاصرة، ورصد ما تتميز به من طاعة وخضوع تام لتعليمات القيادة وأوامرها من قبل أولئك الأشخاص أو الموظفين، حيث يكون لديهم الاستعداد الدائم والغير مشروط لتنفيذ الأوامر كيف ما كانت.[18] فمشروع الإبادة اليهودية اقتضى من النظام السياسي الاستعانة بخبرة الدولة في التخطيط والإدارة والدقيق والقدرات البيروقراطية في التنظيم والتنفيذ، كما استعانت بمنظومتها العسكرية المتطورة والسير في التدمير والانضباط في التنفيذ.
يعد ماكس فيبر المنظر البارز للبيروقراطية الغربية، حتى إنه جعل تمجيدها أحد أفكاره المركزية؛ [19] ذلك أنها مثلت لديه الصورة النهائية للتنظيم والعقلنة، والمعبّر العيني عن روح الحداثة، ومفاهيمها الرّنانة التي تشكّلت منذ عصر النهضة، العقلنة والديمقراطية والتنظيم والحرية، حتى إن فيبر ربط التفوق الأوروبي بالتفوّق البيروقراطي والتنظيمي، الذي يقوم في جوهره على الرياضيات والمنهج التجريبي الذي رفع العلوم الطبيعية إلى مرتبة الكونية والموضوعية، حيث يقول فيبر هنا إن "الغرب وحده من استخدم في نشاطه الاقتصادي نظامًا تشريعيًّا وإدارة بلغت مستوى من الكمال التنظيمي والقانوني".[20] غير أن فيبر من جهة ثانية، لم يفوّت الفرصة لإبراز بعض العيوب التي اتضحت له في زمن مبكّر؛ إذ يرى في سياق آخر أن التطور المفرط للبيروقراطية يمكنه أن يجني على كل مكتسبات التنوير والحداثة، وينقلب ضد أهداف الحرية؛ لأن الإدارة البيروقراطية ميالة إلى الإقصاء والشطط، تتخفى من كل ما يمكن أن يعرّضها للنقد أو المساءلة.[21] لهذا كان يحذر من إمكانية تحولها إلى توجه علموي في الحياة الاجتماعية السياسية، يمكن أن يكرس التسلط والديكتاتورية. وهذا ما حدث فعلا في القرن العشرين؛ ذلك أن البيروقراطية الأوروبية من خلال صناعاتها العصرية قد وفرت الأليات والمعدات، ناهيك بالإعداد للحسابات والاقتصاد في النفقات، وتشييد معسكرات بهندسة دقيقة، متوفرة على شروط محكمة للبربرية، بعيدة عن المدن، حيث يمكنها حرق الأشخاص بأقل تكلفة وبالطريقة التي تناسب السلطة، وفي النهاية، يقول باومان، جاء الحزب السياسي للدولة، وأضفى على المنظومة برمتها نوعا من المثالية، العامل الأيديولوجي الذي سيتغنى بأداء الرسالة على أكمل وجه، وفكرة صناعة التاريخ، [22] إن الفكرة الأساسية للحل النهائي إنما كانت في الحقيقة من نتائج الثقافة البيروقراطية...
ذهب بعض المؤرخين إلى أن إعلان الحل النهائي للمسألة اليهودية، وبالتالي تخلص دولة الرايخ من شبح اليهود، قد كانت حقا نظرية هتلر وفكرته الخاصة، رغم أنها أشبعت تطلعات الكثيرين، لكن الزعيم بفكرته تلك لم يعد يخطر بباله كيف سيقوم بهذه العمليات من تلقاء ذاته، حيث يجد نفسه يقف إلى جانب الخبراء والمختصين كواحد من الهواة الذي لا حيلة له، فالسياسي له خطاب وأهداف، ولكنه عاجز عن تنفيذها دون تدخل الدولة الديمقراطية العلمانية، من خلال خبرتها البيروقراطية الراسخة، تتدخل في خط التخلص من اليهود عبر التصفية الجسدية، حيث يتم التنسيق بين مختلف الأقسام والمصالح البيروقراطية، والتخطيط السليم، ناهيك بتحضير التقنيات والوسائل الملائمة لهذه المهمة، والمعدات الفنية، بالإضافة إلى رصد الميزانية الكافية، حيث يرى باومان أن كل ذلك كان مجرد إجراء روتيني بيروقراطي رتيب، [23] فقد كانت عمليات عقلانية إدارية وتقنية، وهي كلها تشكل دراع الدولة الديمقراطية الحديثة في تنفيذ أهدافها.
لذلك يدافع باومان على أن هناك ثقافة بيروقراطية راسخة لدى المجتمع المعاصر، تشكل نظرة البشرية الغربية نحو المجتمع الحديث بوصفه موضوعا للتحكم والإدارة؛ بمعنى آخر أن المجتمع هو سلسلة من المشكلات والعوائق التي تقتضي حلولا مناسبة لها في تنظيم المجتمع كما لو أنه بستانٌ في حاجة لتصميمه والحفاظ على تناغمه بالتصفية الجسدية إذا اقتضى الحال، وعلى ضوء هذا تم تقسيم السكان إلى نباتات نافعة ينبغي العناية بها ومنحها ما تستحقه من الرعاية، ونباتات أخرى أو حشائش لا منفعة من ورائها، بل قد تكون ضارة ومؤذية مثل الطفيليات، ويتعين اقتلاعها وإنهاء وجودها؛ لأنها لا تصلح للمجتمع.
يتبين أن رؤية الحداثة لليهود كانت منذ البداية تعدّهم أصحاب طبيعة فوضوية لا تقبل التهذيب أو الاندماج، ببساطة، حشائش غريبة ومريبة، نمت وازدهرت فوق بساط الأرض الأوروبية، Ahasvérus الوصف الغربي التاريخي بوصفه الأكثر ملاءمة لرصد حضور اليهود كأقلية منبوذة تعيش على هامش المجتمع، إما اختيارا أو إكراها، [24] داخل هذا المجتمع الجديد الذي صُممَ ليكون فردوسا. غير أن سياسة التطهير الألمانية استهدفت حشائش أخرى من طبيعة ثانية، والمتمثلة في الأشخاص المعتوهين والمصابين بالتشوهات والأمراض الخلقية، والمرضى الذين لا يرجى لهم علاج، ولعل النازية قد كانت هي الفلسفة التي تقوم وراء ظاهرة الموت الرحيم الوجودية الرائجة في البلدان الغربية حتى اليوم. بالتالي، فهذا النوع من التفكير هو الذي جعل منه الفيلسوف أساس الثقافة الجماعية التي أدت إلى إمكانية التفكير في الحل النهائي عبر الهولوكوست، ومن ثم المضي في تنفيذها بكل هدوء. فقد تمكن النظام النازي من خلال الدولة الألمانية من تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في استئصال اليهود بصفتهم شياطين أوروبا، عن طريق التوسل بالآليات والوسائل التكنولوجية، وما استقرت عليه الإدارة البيروقراطية العلمية المركزية للدولة، والصناعات المتنوعة، ناهيك بالاستراتيجيات العسكرية؛ بمعنى آخر، فقد تم استغلال كافة الإنجازات الضخمة التي قامت بها الحداثة الغربية.[25]
كانت الاستراتيجية المرسومة في نموذج الهولوكوست أن يتم تأسيس دولة الرايخ التي ستدوم ألف عام، أو ما جرت تسميتها بمملكة الروح الألمانية، حيث تحولت بقدرة قادر من دولة علمانية وريثة الأنوار إلى دولة قومية متعصبة، تعادي الأجانب والشّعوب التي لا قومية لها، وتخطط لمسحها من وجود المملكة التي لا تقبل داخل أجوائها سوى الروح الألمانية، فاليهود وفق هذا المنظور العنصري عاجزين عن تطهير أنفسهم، حيث سيربط هتلر هذا العجز في نظره بالدم والوراثة، أيستوي الشعب الهاوي الفاسد أخلاقيًّا مع الشعب الطاهر الآري؟ كلا طبعا. فقد كانت مهمة الدولة النازية في رأي زيجمونت باومان هي اتباع سياسة حيوية تقوم على مبدإ الحفاظ على الصحة العرقية، فالسياسة العرقية البشعة كلفت النازيين جهدًا ضخمًا وموارد لا حصر لها من أجل تحسين الجيل المعاصر لهم.[26] لهذا يستنتج الفيلسوف خلاصة أساسية مفادها أن العنصرية الغربية قد كانت على الدوام منسجمة مع أهداف الحداثة ومتوافقة مع رؤيتها للعالم.
وحتى المؤسسات السياسية والاجتماعية التي يفترض فيها أن تكون وسيلة لتطبيب المجتمع وعلاج أمراضه ونواقصه، من خلال عملها وفق القوانين، ففي حالة المجتمع الغربي الحديث، لم تكن سوى إشاعة ووهما كبيرين، كما انتبه إلى ذلك غوستاف لوبون؛ [27] إذ تبين له، كما تبين للذين من قبله، أن المؤسسات المعول عليها في التغيير ما هي إلا بنت الأخلاق الجارية وعواطف الجماعات وطبائعهم، بهذا تكون الأجهزة السياسية والاجتماعية هي منتوج خالص للعرق، وعصارة طبيعية لطموح العصر؛ إذ يخلص بأسف شديد إلى أن طباع الشعوب وليس الحكومات هي التي تحسم مصيرها. وعلى ضوء هذا، نقول إن المؤسسات الغربية الحديثة قد صارت تكرس آمال الحقد والعنصرية لدى شعوبها على أرضية الواقع من خلال أنشطتها الإدارية.
هكذا إن معاداة اليهود والحاجة إلى التخلص منهم، إنما هي ظاهرة حديثة؛ بمعنى آخر أن الإبادة فكرة حديثة، حيث لم تكن ممكنة إلا في مرحلة متقدمة من تطور الحداثة الغربية؛ ذلك أن العداء لليهود ولو أنه كان قديمًا جدًّا، فهو مشتق في اللحظة الحديثة من عقلية راسخة أضحت تعبد الحرب وتؤيّد القوة[28] وتمجد البطش كما لاحظ ذلك فيردمان[29] في الحالة الألمانية، التي كانت تنقصها فقط الوسائل الحديثة الملائمة لتحقق أهدافها، ويخلص باومان بالقول إن معاداة السامية الحديثة قد وجدت ضالتها في كفاءة البيروقراطية الحديثة، التي أمدتها بخلاصة التجربة التدبيرية التي أدركها العقل الغربي؛ إذ لم يكن ممكنا تصور تنفيذ هذه المهام بلا البيروقراطية الحديثة، حيث يقول الرجل مؤكدًا هذا الرأي: «فقد كان لا بد من زواج معاداة اليهود الحديثة من البيروقراطية الحديثة، حتى يحدث الواقع المطلوب، وهذا ما حدث في ألمانيا".[30]
المبحث الثالث: حداثة بلا ضمير.
لماذا على الإنسان أن يكون أخلاقيًّا؟ أ لأنه مطلب الحياة الطيبة؟ أم لأن الضمير الإنساني يفرض سلطته القهرية علينا حتى نكون أناساً موضع تقدير؟ أو ربما لأن المجتمع هو الذي يحدد القيم المناسبة لحاجياته وينبذ من خالفها ويبعده، فنكون بذلك أخلاقيين لنكون مقبولين في المجتمع؟ لماذا علينا أن نتحلى بالأخلاق؟ هل يجوز تقديم المصلحة والمنفعة العملية على الضمير؟ هل يمكن أن يتعارض الواجب والأخلاق؟ ثم ما هي طبيعة الأخلاق في نهاية المطاف؟
1. التوتاليتارية والأخلاق الجديدة
رافع روبرت سرفاتيوس[31] في إحدى جلسات المحاكمة الشهيرة في القدس أن موكله أدولف إيخمان إنما ارتكب أفعالا تكون موضع تكريم بالأوسمة والترقيات، إذا ما استطاع المرء أن ينجح في آدائها كاملة، غير أنه ستنصب له المشانق بلا شك، وبلا رحمة، إذا حدث وفشل في تنفيذها أو انهزم؛ ذلك أن هناك صنفًا من الأفعال وجدت في الحياة فقط لننجح في أدائها بلا عثرة أو إخفاق؛ لأن التعثر أو الهزيمة تعني مباشرة الإدانة أو الإعدام. هذه القولة التاريخية التي صدرت في القرن العشرين عن رجل قانون، اعتبرها باومانت عبارة ضخمة خطيرة؛ لأنها زعزعت التفكير وحفزته على المزيد من الاستشكال؛ ذلك أن أول ما تحيل عليه هو أن القوة قد مثلت الأخلاق الحقيقية، وهي ما يصنع الحق؛ أي إن القوة أساس الحقوق ومصدرها الرئيس، أتريد أن تكون في صف الحق، فعليك أن تكون قويا كفاية، فالقوة والأخلاق شيء واحد، وهكذا يكون للضعف والباطل نفس المعنى، فإيخمان لم يفعل شيئا آخر مختلفا عما يفعله الأقوياء والمنتصرون جميعا بكيفية دورية في كل زمان؛ ذلك أن إيخمان قد صار مجرمًا فقط؛ لأن النازية انهزمت وكُتب عليه أن يسقط في قبضة مخابرات ومحاكم إسرائيل، خاصة وأن ما يجعل الأمور أكثر التباسًا، هو أن مشروع الدولة التوتاليتارية وأهدافها الكارثية، سواء في باب الحروب أو في باب الحل النهائي وتصفية اليهود، لم تكن اختيارًا سياسيًّا بيروقراطيا أو حتى مؤسساتيًّا فحسب، بل كانت الدولة ترضي مختلف الأنصار والقوى التقليدية الرجعية في حالة ألمانيا مثلا؛ إذ لم يكن هايدغر استثناء في دعمه للنازية؛ ذلك أن التوتاليتارية الألمانية قد كانت ترضي قوى عديدة؛ منها أساتذة الجامعات والمثقفين، وكذا البيروقراطية، وضباط الجيش والقوات المسلحة، وكبار الصناعيين، فكما يعتقد نيومان أنها لم تكن رغبة معزولة لدى نخبة سياسية مستبدة، وإنما كانت التوتاليتارية مشروعًا مقبولًا من العالم الغربي إجمالا.[32] هكذا فإيخمان بهذا المعنى، لا يصبح شخصًا معزولًا قام خلسة بفعل يجرمه القانون، وبالتالي يتعين عقابه؛ ذلك أن ما أنجزه كان رغبة مكبوتة لدى عصر بكامله.
يؤكد هذا إذن، أن الأفعال التي نقوم بها ليست لها في ذاتها قيمة أخلاقية جوهرية ومطلقة، كما أنها ليست في ذاتها غير أخلاقية؛ لأن حالة إيخمان تبرهن على أن التصنيف الأخلاقي يكون خارجًا عن الفعل المرتكب من الأساس، ويخضع للجهة التي تقوم بالتقييم. وهل يعقل أن نقول هكذا، وندافع عن النسبية الأخلاقية فقط؛ لأن المخالفات ثابتة في حق إيخمان بالدلائل بكيفية لا مفر منها؟ هل يحق لنا أن نبرر ما لا يبرر؟ يربط باومان الشق الأول للوازع الأخلاقي بهيكل مجتمع المؤسسات الديمقراطي، الذي أنتج مفهوم الانضباط المثالي المشروط بالتماهي مع أهداف المؤسسة ومبادئها بالنسبة إلى كل المنتسبين إليها والمشتغلين تحت إمرتها؛ لأن السياق يطرح تناقضًا بئيسًا، فمن جهة أولى يبدو شرط الالتزام الفعلي بالمعايير الأخلاقية تجاه المؤسسة وتجاه شخص الرئيس واجبًا أخلاقيًّا وقانونيًّا، حيث يتعهد المرؤوس بإنجاز كل ما طلب منه من أوامر وتعليمات، حيث يشكل تنفيذها بكفاءة علامة على إتقانه وتميزه بأخلاق الموظف الرفيعة، حتى إنه يستحق التكريم مثل حالة إيخمان وغيره، غير أن الشق الثاني لهذا التناقض الأخلاقي للبيروقراطية السياسة يكمن في أن تعليمات المرؤوس هي في جوهرها معارضة للأخلاق الكونية المتفق حولها قبل مجيء العالم؛ إذ يصير الموظف متعهدًا ومستعدًّا تجاه مؤسسته ورئيسه، لكي يمسح إنسانية الإنسان، تيسيرا لهدف آخر هو محو هوية الضحايا من الوجود بلا تفكير، فيضحي المرؤوس بقيمه الشخصية كإنسان ويعارض ضميره في سبيل إرضاء المؤسسة. لذلك، فالأيديولوجية المؤسساتية الفظيعة، إنما تُفهم في استعداد المنتسب إليها لإنجاز مثل هذا النوع الرهيب من التضحية بالنفس بوصفها فضيلة أخلاقية رفيعة، تعززها بشتى الوسائل، وتعتبر التمسك بها أمّ الفضائل، بل هي أساس شرف الموظف.[33]
فقد تحوَّل المجتمع والعالم معه إلى قبلة أخلاق جديدة، تفرضها سيادة الإدارة البيروقراطية؛ إذ تُوجِّه الموظف إلى إنجاز أعمال مخالفة للقيم للإنسانية، وتكرمهم بالأوسمة، إذا برعوا في الانضباط والإنجاز، على الرغم مما ينطوي عليه العمل من إنكار لمرجعية الضمير الإنساني، خاصة وقد عاش العالم قبل وقت قصير حربًا جديدة في الشرق الأوسط بين الغرب بقيادة أمريكا وإسرائيل ضد إيران؛ بدعوى أن المحطات النووية في طهران تهدد الأمن الإقليمي وتشكل خطرًا عالميًّا. لذلك يتعيّن القضاء عليها وتصفية علمائها المختصين، بينما المراكز النووية في إسرائيل والقنابل الذرية في فرنسا وبريطانيا وأمريكا لا تتضمن أي خطر أو تهديد. إنه الضمير الحداثي والأخلاق الجديدة لعصرنا الخجول؛ إذ يستشهد باومان في هذا الباب بأوتو أوهلندورف، وهو جندي سابق في صفوف النازية، حيث يصف هذه الوضعية أو يبررها بقوله: "لا أعتقد أني في وضع يسمح لي بأن أحكم إذا ما كانت الإجراءات...أخلاقية أو غير أخلاقية، فأنا أخضع ضميري الأخلاقي إلى حقيقة واحدة، وهي أنني كنت جنديا، وأني كنت مجرد ترس بسيط في آلة ضخمة"؛ [34] ذلك أن الإدارة البيروقراطية تعمل على تنمية أخلاق خاصة بها، تزرعها في قلب موظفيها، فيتحول منتسبها إلى ما يشبه الآلة المبرمجة بكفاءة عالية، حتى أنه يصير أكثر فاعلية وخطورة من الآلة؛ لأنه في حالات عديدة ظهر كيف أنه يضاعف من مجهوده وينجز مهمات ضعف ما طلب منه، يكاد يتقمص شخص المؤسسة نفسها، لقد اطلع الجميع في واضحة النهار، في عدة مناسبات احتجاجية سواء لدى فئة الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أو في حالة الاحتجاجات الاجتماعية في أرض الريف أو غيرها، كيف أبان أفرادٌ من الشرطة وكذا من أعوان السلطة –المقدمية والشيوخ-عن أخلاق وضيعة في التعامل مع المحتجين، تنوعت بين العنف اللفظي وآخر جسدي قاسي، والتحرش بالمعتقلين، والتعبير عن غرائز تدميرية بأساليب غريبة، حيث يتحول عمل الإدارة من واجب التسيير الأمثل للقانون إلى وسيلة للابتزاز المقيت، والاعتداء على الجسد وعلى شرف الضحايا، وما خفي لا يعلمه إلا الله، كل هذا يجعلك تقول إن المؤسسة تتيح الفرصة لموظفيها ومنتسبيها ليعبروا عن عدوانيتهم وجنونهم، والجنون فنون كما يقول الغزالي.
2. محنة الأجنبي في دار الحداثة
ربما لم تُعرف المجتمعات الغربية بسمة ما قدر ما عُرفت بميولها الراسخة إلى العنصرية والإقصاء والتمركز؛ إذ لا يستطيع الإنسان الأمريكي حتى يومنا هذا أن يساوي ولو في لا شعوره بين المواطنين البيض ونظرائهم السود، وحتى إذا كانت القوانين الجاري بها العمل في الوقت الحاضر لم تعد تمييزية تكرّس العنصرية كما كانت في الأمس القري، خاصة مع قوانين جيم كرو[35] Jim crow laws، ومع ذلك فإن الخطابات الاجتماعية والسياسية العنصرية التي تستهدف الأجانب واللاجئين ما زالت تجمع حولها الأعداد الغفيرة من الحشود؛ لأنها تعبر بأمانة عن عواطف ومعتقدات بربرية يكنّها المجتمع العصري للغرباء في أوروبا وأمريكا، أولئك الذين ينتمون إلى الهامش وليس المركز.
من أجل فهم العنصرية، يعرض باومان تصور أندريه تاجيف، ويدخل في حوار نقدي معه، هذا المفكر الذي اتخذ من العنصرية في معرض تحليلاته كمقابل للخوف المرضي[36] من الأخرين الغرباء والمختلفين؛ وذلك تحديدًا حينما يرى مجتمع ما في الأجنبي والمختلف مصدر تهديد حقيقي، فيدفعه هذا الوضع إلى انتهاج سياسة عدائية، ويحدد تاجيف في هذا السياق للعنصرية ثلاثة أبعاد أساسية:
أولا، هناك عنصرية أولية، وتتميز بكونها شكلا كونيًّا وعالميًّا لتمييز الآخر المختلف، وبالتالي معاداته، فيعتبرها الرجل رد فعل طبيعي لوجود إنسان غريب أجنبي ومجهول، فهي شكل من أشكال الحياة الإنسانية التي تتميز بالبلبلة والغرابة، المؤدية للكراهية والعدوان.
ثانيا، عنصرية الدرجة الثانية، حيث نما وتطور هذا الشكل من المعادة للآخر في عصر القوميات البارزة في مناطق مختلفة من العالم، فقد سار الناس في الدفاع عن معالم الهوية بلغة التاريخ والتراث والثقافة المشتركة.
أخيرا، هناك عنصرية الدرجة الثالثة، وهي نوع متميز عن النوعين السابقين؛ لأنها تتعلق بما هو سياسي واستراتيجي أكثر من تعلقها بما هو اجتماعي، إنما عنصرية في صورة مختلفة؛ لأنها تخفي في الواقع اختيارات أنظمة الحكم ورهاناتها السياسية الكبرى، مثلما كان عليه حال الاختيارات النازية في ألمانيا القرن العشرين، حينما أداعت العداء لليهود وعززته بوسائل البيروقراطية والدعائية؛ إذ كانت تعيش بكابوس الحل النهائي للتخلص من الأقليات التي لم يعد وجودها يتطابق مع المصالح العليا للبلاد.
إن الإنسان الحديث في تعامله مع الأقليات والمختلفين والغرباء، قد تبنى رؤية البستاني وكفاءته الماهرة في إدارة المجتمعات الحديثة. إنه ذلك الرجل الذي يمتلك تصميمًا خاصًّا للجماعة مثل البستان تماما، حيث يحرص أيما حرص على ألا ينمو أو يكبر أي شيء داخل بستانه الأنيق إلا إذا رغب فيه المجتمع وزرعه ورعاه، هكذا تكون النباتات التي تنمو من تلقاء ذاتها دون رغبة المجتمع، إنما هي نباتات شيطانية ومنحرفة، يصفها باومان بالخطيرة؛ لأنها تهدد النظام العام وتفسده. بالتالي فما هو هذا النظام العام الذي أخذ حيزًا كبيرًا في تصور المجتمع الحديث، وشكل نظرته إلى العالم؟
بصراحة إن مفهوم النظام العام التقينا به بكيفية جادة في الدراسات القانونية؛ إذ يأتي في سياق يتعلق بضبط حركة المجتمع واستقراره، فيرى الفقه القانوني[37] بأن النظام العام هو تحديدا كافة المصالح السياسية والاجتماعية والاقتصادية... ويمكن أن تدخل فيها حتى العرقية رغم عدم إشارة الفقه إلى ذلك بصورة ظاهرة، فهو مجموع تلك الدعامات والأسس المتفق عن تفاصيلها في بناء الجماعة واستمرارها، حيث لا يمكن تصور أن يبقى المجتمع مستقرًّا ومعافى دون الاستقرار عليها. لذا أعتقد بأن النظام العام هو إشكال فلسفي قبل أن يكون مشكلا قانونيًّا؛ لأن الفقه نفسه يعترف بالسمة الإشكالية للمفهوم، ومن ثمة صعوبة صياغة تصور بشأنه يرضي الجميع.
يمكن القول إن فكرة النظام العام قد جاءت بسبب التفكير في حماية الجماعة من كل ما هو غريب عنها وغير مألوف ولا معتاد، بفعل الحساسية الحديثة المفرطة من كل ما هو غريب وغير متجانس. لذلك، يتحول في كثير من الأحيان النظام العام بوصفه مقبرة السياسة وسياجا حديديًّا للمجتمع، يتحسس كل شيء غير مألوف أو جديد، فيعطي الإنذار للتصدي له، مقاومته، ومنعه من اختراق الجماعة، سبيلا للمحافظة على المجتمع المستقر وعلى أعرافه وأخلاقه. في هذا السياق بالذات، يعتقد باومان بأنه مع بداية الحداثة، صارت عزلة اليهود، الكيان الغريب طبعًا، معضلة حقيقية تطرح نفسها على المجتمعات الغربية الحديثة، مما أدى إلى التفكير بجدية في التخطيط لإخضاعها لعمليات التصنيع والتصميم التكنولوجي والرقابة الإدارية والبيروقراطية، بلغة البستان هي حشائش غريبة، تستدعي من البستاني اللجوء إلى ما يمتلك من آلات وسموم لازمة لإبادتها، ومن ثم المحافظة على التنظيم الشامل للبستان وتقسيماته[38]. فالمسألة اليهودية إذن بدت بوصفها معضلة تهدد النظام العام السياسي الاجتماعي، وتزعج مجتمع الحداثة أو تعيق رفاهيته، ومن ثمة كانت الحاجة ملحة لإيجاد حلٍّ نهائيٍّ لها، وهو ما توّجته الهولوكست في القرن العشرين.
إنه تصور يجعله باومان موضع فحص ومناقشة، حتى إنه يرفض ربط العنصرية بالخوف المرضي؛ لأنهما مختلفان تماما في نظره؛ فالعنصرية شعور جماعي يقدم حججا وأدلة في سبيل تأكيد أن أقلية ما لا يمكن بأي حال دمجها في النظام العقلاني مهما بذلنا من جهود، فهناك بالتالي عيوبا معينة راسخة في الجماعة المعنية، أو داء لا يرجى له علاج، مثل السلطان الذي لا يعالج إلا بالاستئصال. فحظها السيء يجعلها غير قابلة للتخلص منه أو تصحيحه، فقدرها أن تبقى على حالها بكيفية دائمة، غريبة ومنبوذة، تعيش على الهامش، ولا تقبل الاندماج بحكم طبيعتها، فعليها أن تبقى غريبة إلى الأبد. كذلك هو حال اليهود؛ إذ تقر العنصرية بأن هذه المجموعة البشرية، إنما هي عبارة عن ورم سرطاني بالنسبة إلى المجتمع الجرماني، وتبعًا لذلك فهي تقضي بطردهم، بصفتهم جماعة مكروهة من أرض الدولة أو تصفيتهم جسديًّا تماما؛ لأن لا أمل يرجى من وراء محاولة علاج اليهود أو إصلاحهم، ولا سبيل إلى تجنب ضررهم والوقاية من شرّهم، إلا بعزلهم وقطع الصلة بهم أو حبسهم خلف الأسوار. فقد قدمت مملكة الروح الألمانية نفسها، بكونها لا تقبل سوى الألمان، ولا مكان لليهود فيها؛ لأنهم عاجزون عن تطهير أنفسهم، والاهتداء إلى روح الشعب الآري الألماني، وهو عجز ربطه هتلر بعامل الدم والوراثة.
خاتمة
يبدو مما سبق، أن البربرية ليست غريبة على المشروع الحداثي الغربي، وهذا لا يعني، بالتأكيد، أن الحداثة لا تنتج سوى الشرور والمأساة، أو أنها لا تكرس إلا الانحطاط السياسي والاجتماعي والعمى الأخلاقي كما يمكن أن يخيَّل للبعض سهوًا. والحال أن زيجمونت باومان في مقاربته لدلالات التوتاليتارية والهولوكوست؛ إذ يسلم بأهمية الزمن الحديث في تحسين الرفاه البشري العام، فلا أحد يمكنه أن يخفي هذا الجانب المشرق في العصر الجديد، غير أن ما يتوقف عنده الفيلسوف مستفيدًا من دروس حنه أرنت الملهمة، هو ذلك الوجه المرعب للحداثة الأوروبية، الذي ظل متخفيًا لزمن طويل، حتى صدّقت البشرية أنه غير موجود، فالوحشية شئنا أم أبينا هي الوجه الثاني لعملة الحداثة، الوجه الذي لا يمكن إنكاره ولا إخفاؤه ولا تبريره.
لهذا سيعتبر بعض الفلاسفة منهم باومان أنه سمة من السمات المتأصلة في الحداثة، ولا يمكن تجاوزه أو استبعاده، بينما هناك من سيرى أن المشروع الحداثي الكبير مع كل ذلك لم يكتمل وظل ناقصًا، ومن ثمة ينبغي اتباع فلسفات واستراتيجيات بنفس عصري، ذات منحى تواصلي، يتجاوز الإقصاء والصراع والاغتراب، إلى مرتبة الاعتراف بجميع دلالاته الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والدينية.
المصادر والمراجع:
ü أرنت، حنه، في معاداة السامية واستحالة الاندماج، ترجمة نادرة السنوسي، دار الروافد الثقافية-ناشرون، بيروث، لبنان، الطبعة الأولى، 2020
ü أرنت، حنه، أسس التوتاليتارية، ترجمة أنطوان أبو زيد، دار الساقي، بيروث، لبنان، الطبعة الثانية، 2016
ü باومان، زيجمونت، الحداثة والهولوكوست، ترجمة حجاج أبو جبر ودينا رمضان، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2014
ü حنين، عماد، الفكر السياسي عند ليو شتراوس، الحمرا، بيروث لبنان، الطبعة الأولى، 2017
ü بوخريسة، بوبكر، ماكس فيبر الدولة والبيروقراطية، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الطبعة الأولى، 2015
ü علاق، عبد القادر، إشكالية تحديد مفهوم النظام العام، المعيار، المجلد العاشر، العدد 4، 2019.
ü فيبر، ماكس، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة محمد علي مقلد، مراجعة جورج أبي صالح، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان.
ü فيبر، ماكس، الاقتصاد والمجتمع والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات، السيادة، ترجمة محمد التركي، مراجعة فضل الله العميري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2015
ü لوبون، غوستاف، سيكولوجية الجماهير، دار الساقي، بيروث، لبنان، الطبعة الأولى، 1991
ü نيومان، فرانز ليوبولد، الدولة التوتاليتارية، ترجمة حسني زينة، مجلة تبين، العدد 1/2، 2013
ü Touraine, Alain, critique de la modernité, Les Éditions Fayard, Paris, 1992
ü Voltaire، essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 1756
ü Traverso, Enzo, La fin de la modernité juive, Histoire d’un tournant conservateur, La découverte, Paris, 2016
[1]- حنه أرنت فيلسوفة ألمانية-أمريكية من أصول يهودية، قادها الاضطهاد النازي إلى الهجرة فرارا من المتابعات التي طالت اليهود، إذ بصمت القرن العشرين بمؤلفاتها الرصينة في الفلسفة والفكر السياسي.
[2]- عُرفت حنه أرنت بغزارة الإنتاج والتأليف، حيث دارت معظم أعمالها حول القرن العشرين في شقه السياسي والسلطوي، القرن الأكثر عنفا، من مؤلفاتها: أصول التوتاليتارية، الذي ينقسم لثلاث أجزاء كلها تعالج، من زاوية علمية-تاريخية، الشمولية والامبريالية ومعاداة السامية...
[3] - زيجمونت باومان فيلسوف اجتماعي يهودي بولندي، التحق بجيش بلده في مجابهة الجيش النازي خلال الحرب العالمية الثانية، وبعد تسريحه تابع دراساته العليا في السوسيولوجيا، وعُيّن كأستاذ محاضر بجامعة وارسو، وذلك قبل أن ينتقل في مستهل السبعينات للعيش في بريطانيا حتى يومه الأخير.
[4] - التوتاليتارية أو الشمولية هي فلسفة قبل أن تكون حركات سياسية اجتاحت القرن العشرين، حيث استمد المفهوم إيتموجيا من الكلية، التي تكشف رغبة الأنظمة السياسية والدول المعنية بها في الهيمنة كليا على الوجود الفردي والجماعي، وإلغاء الحرية بكفية شاملة، فالشمولية تختلف أبدا عن أشكال الاستبداد أو الديكتاتورية التي عرفتها الدول منذ القديم، بوصفها تحكما محدودا، بخلاف الشمولية التي لا تعرف في ظلها السلطة أي حدود.
[5] - زيجومونت باومان، الحداثة والهولوكوست، ترجمة حجاج أبو جبر ودينا رمضان، مدارات للأبحاث والنشر، القاهرة، الطبعة الأولى، 2014، ص. 333
[6] - Alain Touraine، critique de la modernité، Les Éditions Fayard، Paris, 1992, p.09
[7] - يجومونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سبق ذكره، ص. 44
[8] - نفس المصدر، ص. 40
[9] - نفس المصدر، ص. 56
[10] - نفس المصدر، ص. 61
[11] - مارتن لوتر، اليهود وأكاذيبهم، ترجمة محمود النجيري، مكتبة النافذة، مصر، الطبعة الأولى، 2007، ص.51
[12] - https://shorturl.at/AwMlZ
[13] - Voltaire، essai sur les mœurs et l’esprit des nations, 1756
[14] - يجومونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سبق ذكره، ص. 26
[15] - نفس المصدر، ص. 140
[16] - نفس المصدر، ص. 177
[17]- نفس المصدر، ص. 46
[18] - بوبكر بوخريسة، ماكس فيبر الدولة والبيروقراطية، مركز الكتاب الأكاديمي، عمان، الطبعة الأولى، 2015، ص. 157
[19] - الصديق الدهبي، في خذلان الأنوار للأنوار: فيبر وخيبات العقل، مقال على الأنترنيت، مؤمنون بلا حدود، 09 دجنبر 2024
Le Site: https://shorturl.at/X05cA
[20] - ماكس فيبر، الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية، ترجمة محمد علي مقلد، مراجعة جورج أبي صالح، منشورات مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان، ص، 07
[21] - ماكس فيبر، الاقتصاد والمجتمع والأنظمة الاجتماعية والقوى المخلفات، السيادة، ترجمة محمد التركي، مراجعة فضل الله العميري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، لبنان، ط1، 2015، ص، 267
[22] - يجومونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سبق ذكره، ص. 68
[23] - نفس المصدر، ص. 71
[24] - Traverso, Enzo, La fin de la modernité juive, Histoire d’un tournant conservateur, La découverte, Paris, 2016, p. 30
[25] - زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سبق ذكره، ص. 109
[26] - نفس المصدر، ص. 138
[27] - غوستاف، لوبون، سيكولوجية الجماهير، دار الساقي، بيروث، لبنان، الطبعة الأولى، 1991، ص. 104
[28]- الإيمان المطلق بالحياة وتمجيد القوة ليس غريبا عن الفكر الألماني المعاصر، فهناك العديد ممن يربط هذه السمة المميزة للألمان بفيلسوفها نيتشه، الداعي والمبشر بعصرها.
[29] - حنين عماد، الفكر السياسي عند ليو شتراوس، الحمرا، بيروث لبنان، الطبعة الأولى، 2017. ص. 65
[30] - زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سبق ذكره، ص. 151
[31] - روبيرت سيرفاتيوس (1894-1983) هو محامي ألماني شهير، شارك كمحام بعد الحرب العالمية الثانية في محاكمات النازيين منهم أدولف إيخمان في إسرائيل عام 1961، هي المحاكمة حضرت لها حنه أرنت وتابعت فصولها وأنجزت حولها مؤلفا مهما هو: إيخمان في القدس: تقرير حول تفاهة الشر (1964).
[32] - فرانز ليوبولد نيومان، الدولة التوتاليتارية، ترجمة حسني زينة، مجلة تبين، العدد 1/2، 2013، ص. 204
[33] - زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سبق ذكره، ص. 78
[34] - Quoted after Robert Wolf، Putative Threat to National Security at a Nurenberg Defence for Genocide، Annals of AAPSS، no. 450 duly 1980، p. 64
[35]- مجموع قوانين عنصرية، تميز بين البيض والسود في أمريكا، حيث جعلت الأسود مواطنا من درجة ثانية، ويتعين معاملته على هذا الأساس في الفضاءات العمومية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
[36] - نفس المصدر، ص. 132
[37] - علاق عبد القادر، إشكالية تحديد مفهوم النظام العام، المعيار، المجلد العاشر، العدد 4، 2019، ص. 05
[38] - زيجمونت باومان، الحداثة والهولوكوست، مصدر سبق ذكره، ص. 123