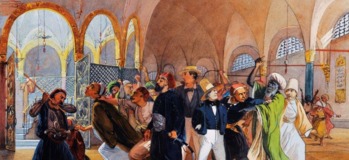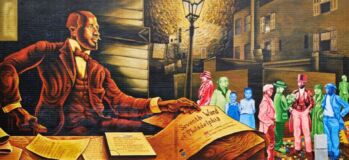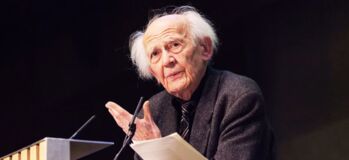السيادة بوصفها عملا للقتل من منظور ما بعد كولونيالي: قراءة في مفهوم سياسات الموت عند أشيل مبيمبي
فئة : مقالات

السيادة بوصفها عملا للقتل من منظور ما بعد كولونيالي:
قراءة في مفهوم سياسات الموت عند أشيل مبيمبي
مقدمة وتمهيد:
تهدف هذه الورقة إلى استعراض المقاربة ما بعد الكولونيالية لمفهوم السياسة الحيوية التقليدي الذي كان يشوبه قصور التمركز حول الغرب، وعدم تسليطه للضوء على الممارسات الكولونيالية الغربية التي كانت تلعب فيها السياسات الحيوية دورا يفوق دورها في مجتمعات الدول المستعمِرة ذاتها. هذا ما يدعونا إلى قراءة في تطور المفهوم عند الفيلسوف الكاميروني أشيل مبيمبي، لتوضيح التحوّل المهم الذي اكتسبه في فكره. يعدّ مبيمبي علامة فارقة في الفكر ما بعد الكولونيالي؛ لأنه علاوة على تطويره لمفهوم السياسة الحيوية، فهو من أهم نقاد الحداثة والنيوليبرالية، وصاحب أطروحات مهمة في الدراسات الاستعمارية، والدراسات الإفريقية، ودراسات الهوية والعرق، إضافةً إلى تطويره مفهوم سياسات الموت أو السياسات النكرووية. يعدّ إسهام مبيمبي إسهامًا جادًّا وراديكاليًّا في مجال السياسة الحيوية، حيث أدخل عليه تطويرات ثقافية نابعة من خبرة ما بعد كولونيالية، ناهيك عن محاولة التعمق في فهم علاقة السلطة بالموت، كعلاقة مباشرة، واضحة بذاتها، بعدما كانت هذه العلاقة تُدرَس في إطار البنية المتعلقة بعلاقة السلطة بالحياة عند منظري السياسة الحيوية من قبله. أما الأهم، فهو أنه أعاد بناء المفهوم بما يلائم الممارسات الكولونيالية، بعدما كان أغلب التركيز قبله منصب على سياسات الدولة القومية.
- السيادة والحداثة:
ارتكز فهم مبيمبي للسيادة على التأسيس الفوكولي لها مع تطويره، فهو لم ينظر إليها في القوالب التقليدية الخاصة بأدبيات العلوم السياسية والعلاقات الدولية التي تعالج السيادة عبر المؤسسات، سواء الخاصة بالدولة القومية أو الفوق وطنية.([1]) فقد نظر إلى السيادة في جوهرها كمسألة قرار وقدرة على تعيين من له الحق في الحياة؛ أي يُمنح العيش، ومن الذي يجب أن يموت، أي يُقتل أو تُنتج له العوامل المؤدية إلى الموت، وهي الحالة التي أسماها ب"الموت المعلق"، وتعدّ هاتان الركيزتان – في فكره - هما حدود وسمات السيادة بشكل أصيل. وهذا ما يظهر في قوله: "أن تمارس السيادة يعني ممارسة السيطرة على الوفيات، وأن تحدد الحياة بوصفها نشر السلطة ومظاهرها".([2])
كعادة المهتمين بمجال السياسة الحيوية، رجع مبيمبي للحداثة التي شكلت نمطًا جديدًا من ممارسة السلطة، ورأى أن السيادة في أواخر حقبة الحداثة ادّعت تأسيس نفسها على مفهوم العقل، لتعبّر عن مجموعة من المعايير العامة المنبثقة عن ذوات متساوية، عاقلة، حرّة وواعية. ومفهوم العقل هو مفهوم جوهري في فلسفة الحداثة، حتى وصفه هيجل بأنه ما يميّز الكينونة الإنسانية. ووفقًا لهذا الفهم، تقوم السياسة بدور جوهره استقلالي، وفي الوقت نفسه، تلعب دورًا يُعرّف ذاته من خلال تمييز نفسه عن حالة الحرب التي يسودها الدمار؛ وذلك بإيجاد الاتّفاق بين هذه الذوات. وبما أن الحداثة تأسست على العقل، فقد أرست تمييزًا قاطعًا – إقصائيًّا - بين العقل وما هو دونه أو خارجه،*([3]) وبوصفه – أي العقل – ركيزة الحداثة؛ تصبح السياسة "ممارسة العقل في المجال العام"؛ وهذه الممارسة هي التي تحقق الذات المنبثقة من العقل، ليصل الإنسان في النهاية للاستقلالية الفردية والحرية.([4])
هذا هو التصور الذي استعرضه مبيمبي عن السيادة أو ما سماه هو بالأحرى "رومانسية السيادة"، بغرض تفكيكه عبر محاولة انتزاع مفهوم العقل الذي رسخه الخطاب الحداثي عن الذات الإنسانية، وإعادة تأسيسها على مفاهيم يصفها بأنها "أقل تجريدًا وأكثر لمسًا" وهذه المفاهيم هي الحياة والموت. ومما لا شك فيه أن مبيمبي أعاد قراءة مفهوم السيادة بالاستعانة بهذه المفاهيم على ضوء التجارب المعاصرة التي وجد السلطة فيها تتعمد التدمير المادي لأجساد البشر.
- التأسيس الفلسفي للسياسة بوصفها عملا للموت (هيجل – باتاي):
لكي يقيم مبيمبي هذا التأسيس الفلسفي، اعتمد على مفهوم التحقق الذاتي عند هيجل الذي أقامه على أساس نفي الإنسان للطبيعة، وهو ما يُعدّ ضروريًّا لخلق العالم الإنساني من خلال سيرورة نفي الطبيعة بالعمل والنضال ضدها،**([5]) وهذه العملية تفترض الموت بشكل مستمر؛ لأنها تعرّض الإنسان للمخاطر، غير أن الذات الواعية، حين تتحقق؛ تعي الموت النابع من هذه المخاطر وتتصالح معه؛ وذلك ما يخلق، وفقًا لهيجل، حياة الروح التي تفترض الموت وتتعايش مع إحاطته. لذلك، فإن التحقيق المستمر للذات يفترض "دعم عمل الموت". وما يهمنا في هذا التأسيس هو أن السياسة التي تدير حياة البشر، والتي تعتبر درجة عليا من درجات نفي الطبيعة، تصبح عملا للموت من أجل خلق الحياة الإنسانية، ولهذا تعتبر السيادة نابعة من "المخاطرة بمجمل حياة الفرد".([6])
ولكي يكمل مبيمبي تأسيسه الفلسفي، استعان بتنظير الفيلسوف الفرنسي جورج باتاي حول السيادة والموت، ورآهما، بعد توظيفه لفلسفة باتاي، على أنهما يلتقيان في الحدود الخاصة بالخوف من الموت؛ إذ تقوم السيادة بتكسير هذه الحدود لتُدخِل الإنسان عالم العنف؛ لأن السيادة لا بد وأن تمتلك "قوة لانتهاك الحظر ضد القتل" على الرغم من أن هذا الانتهاك سيتم تأطيره في منظومة من القيم والعادات والتقاليد، لكنه سيكون موجودًا دائمًا على أي حال. وما يهمنا من ذلك أيضًا هو أن السياسة لم تعد فعلًا نابعًا من العقل، بل هي تجسيد للانتهاك وتخطي الحدود المحظورة التي على رأسها القتل.([7])
- السيادة والعدو المتخيّل والحق المعياري في القتل:
خلص مبيمبي من كل ذلك بنظرته الخاصة للسيادة على أنها في جوهرها لم تكن معنية بتحقيق الاستقلالية كما قدم المشروع الحداثي، بل هي مكينة باطشة ومدمرة، تقوم باستغلال البشر، وتوظيفهم كأشياء في منظومتها التي تتجلى في العالم السياسي. وهذا ما يظهر في تعريفه للسيادة على كونها: "التوظيف الأداتي المعمم للوجود البشري والتدمير المادي للأجساد البشرية والسكان". فالسياسات النابعة من السيادة هي دائما عملا للموت.([8])
ينظر مبيمبي على هذا الأساس إلى السيادة بوصفها صاحبة الحق المعياري في القتل، ولكي يوسّع هذا الطرح، استند إلى تنظير الفيلسوف الألماني كارل شميت حول حالة الاستثناء والمعيار السياسي. وحالة الاستثناء هي الحالة التي يقوم فيها النظام القانوني بتعطيل ذاته لتصبح السلطة السياسية مطلقة. أما المعيار السياسي هو الاعتماد المعياري الذي حدده شميت لتحديد ماهية السياسي، وهذا المعيار عنده هو "العدو والصديق"، ويحدد شميت العدو بأنه ذلك الشخص الآخر والغريب الذي يمكن التنازع معه في الحالات القصوى؛ لأنه يمثل تهديدًا وجوديًّا للأنا، وفي هذه الحالة تتمظهر الحرب لحالة العداء.([9])
وبالاعتماد على المعيار السياسي، يوضّح مبيمبي أن العداوة أضحت الأساس المعياري في القتل؛ وذلك من خلال تعمّد السلطة للعمل في مسارين، الأول هو المحاولة الدائمة والمستمرة لخلق حالات استثناء، وهي الفكرة التي استعارها من الفيلسوف الإيطالي جورجيو أجامبين،([10]) والمسار الآخر الذي يعدّ أحد أهم تطويرات مبيمبي هو العمل على خلق صور متخيَّلة عن العدو، تُعيد تشكيله وفقًا لما تراه السلطة، وتعمل السلطة أيضًا على إعادة خلق هذا العدو المتخيّل باستمرار. ووفقًا لهذا المنطق، فحالة الاستثناء تبيح استخدام العنف، وبناء العدو المتخيّل يبرره ثقافيًا. لكن مبيمبي سيضع يده على ثغرة ستجعله يتخطى من نظّر قبله في هذا الشأن، ألا وهي أن هذه السلطة لا تقتصر على سلطة الدولة – داخليا -؛ وبذلك يجعل المفهوم صالحّا لفهم التفاعلات خارج حيز الدولة القومية، وبالأخص استخدامه لفهم الظاهرة الكولونيالية.([11])
- المقاربة ما بعد الكولونيالية لمفهوم السياسة الحيوية وتحوّلها لسياسات موت:
يستكمل مبيمبي ما بدأه فوكو حول تحّول السياسة إلى سياسات موت بدخول العنصرية إلى مجالها،([12]) لكنه يطور الفهم بإدخال التجربة الكولونيالية في المعادلة؛ إذ نظر لمفهوم العرق كمفهوم مركزي في السياسة والفكر السياسي الغربي، وهذا ما تفجّر مع الظاهرة الكولونيالية التي حكمت من خلالها الدول الأوروبية شعوبا أجنبية عنها، رأتها على أنها منزوعة الإنسانية؛ أي ليست في درجة أقل منها فقط، بل لا يمكنها أن تصل معها إلى نفس مرتبة الإنسان العاقل الذي أنتجته مجتمعات الحداثة بإفرازاتها العقلانية والتنويرية. أرجع مبيمبي هذه النظرة للآخر غير الأوروبي، أو بالأحرى، من يصنّفه العقل الأوروبي كآخر، حتى لو كان منه، مثل اليهود على سبيل المثال، إلى جذور الحداثة التي أنتجت العديد من الخيالات عن الآخر، وجعلت منه محورًا للتشيؤ والتوظيف الأداتي، بل جعلت من وجود هذا الآخر برمته مصدرًا للتهديد الوجودي للأنا، وبالتالي أصبح الحلّ مع الآخر أشبه ما يكون بالحل النهائي النازي للمسألة اليهودية؛ أي "من شأن إقصائه البيوفيزيائي أن يعزز قدرتي على الحياة والأمن"([13]) على حد تعبير مبيمبي.
باستمرار تفكيك المنظومة الحداثية، اعتمد مبيمبي على بعض المقاربات التي تدعم وجهة نظره في تصعيد إنتاج الموت من قبل السلطة للعديد من الأفراد. فبعد أن ارتكزت الحداثة في أوروبا، بدأت تتشكل الأفكار الكولونيالية التي تحمّل تصورًا عن الآخر المتخلف منزوع الإنسانية، الذي يجب استغلاله وجعله متحضرًا في آن. بالإضافة إلى التطور التقني الذي مكّن السلطة من إيجاد آليات سريعة وفعالة في القتل، والذي أُرفق بالعقلانية الأداتية الخالية من القيم التي تعمل بمنطق تلاعبي يهدف إلى إخضاع كل شيء، وبشكل مساواتي مقولب، إلى السلطة حتى يمكن من خلالها اعتبار "الطبقات العاملة والأشخاص عديمي الجنسية في المجتمع الصناعي بالمتوحشين والأغلاظ في العالم الاستعماري" كموضوعات يمكن التلاعب بها وليسوا كذوات عاقلة كالتي أنتجتها الحداثة الغربية.([14])
وأوجد مبيمبي رابطة صلة عميقة بين الحداثة والإرهاب، والبراديم (النموذج) الذي يمكن أن نفهم فيه هذه العلاقة بامتياز هو المستعمرة،([15]) ولأن مبيمبي يحاول أن يقدم مقاربة ما بعد استعمارية لمفهوم السياسة الحيوية بالأساس، رأى أن براديم الحداثة لم يكن المعتقل فحسب، كما رأى أجامبين ومن قبله حنّة أرندت،([16]) بل إن الحداثة قامت في أحد جوانبها الجوهرية على العبودية التي مثّلت أولى المختبرات للسياسة الحيوية ولسلب الذات والموت الاجتماعي،([17]) بذلك فإن المزرعة والمستعمرة هما براديم الحداثة الذي يُمكن من خلاله فهم تجلي للسياسات النكرووية.**([18])
- المستعمرة كبراديم للحداثة:
المستعمرة هي ذلك المكان الذي داعب الخيال الأوروبي بتشكيل رابطة عضوية بين السيادة الأوروبية والخيالات الحداثية عمن هو قابع فيها؛ لتشكّل حيزًا مكانيًّا يمثّل ديمومة لحالة الاستثناء والحق السيادي المطلق، فالمستعمرة دائمًا ما تكون خارج القانون ولا تُحكم بشيء سوى الممارسة السيادية للسيد المُستعمِر. فرق مبيمبي بين الحرب والاستعمار، وفقًا للعقل الأوروبي، من منظور التأسيس الحداثي لهما، ووجد أن الحرب تكون بين دول تمثّل وجود ذوات أوروبية لها صفات المنظومة الحداثية التي ذكرناها مسبقّا، وكونت تلك الذوات هذه الدول العقلانية لتمثّل إرادتها، وبالتالي يمكن لهذه الدول أن تُقيم سلامًا أو تشن حروبًا مع بعضها البعض وفقًا لمنظومة قانونية وقضائية أوروبية. بينما من خارج هذه المنظومة، هو من قابع في المستعمرة، أي في حالة الاستثناء الدائمة؛ لأنه لم يرقَ إلى مرتبة الوجود الإنساني العاقل؛ لعدم بلورة ذاته في التنظيم السياسي الحديث الذي هو داخل حيز المنظومة القانونية.([19]) فهذا الذي يقبع على تخوم الإنسانية، هو الآخر بالمعنى المطلق للغيرية، فهو ليس صديق أو عدو، بل شيء ضمن المنظومة الطبيعية، ينطبق عليه ما ينطبق عليها من عقلانية أداتية حداثية توظيفية، تنزع للسيطرة بهدف التقدم، ناهيك عن العنف المطلق المشروع الذي يجعل حياة أهل المستعمرة كحياة عارية.
لذا، مَن خارج هذه المنظومة العقلانية الحداثية الأوروبية هم "المتوحشون" الذين لا يمكن إقامة سلام معهم؛ لأنهم يقطنون على هامش الحياة العقلانية الأخلاقية، وتعتبر حياتهم ليست إلا شكلًا من أشكال الوجود الحيواني. ويقول مبيمبي عن المستعمرة إنها: "هي المنطقة بامتياز حيث يمكن وقف ضوابط وضمانات النظام القضائي – المنطقة حيث يعتبر أن عنف حالة الاستثناء يعمل في خدمة الحضارة"؛([20]) لذلك نقول المستعمرة عند مبيمبي هي براديم الحداثة التي كانت في جوهرها كولونيالية، حتى لو لم يقلها هو مباشرة. فلم يكن غريبًا أن تكون الحداثة هي منبع الكولونيالية؛ لأنها للمفارقة، قامت على خيالات أسطورية عن الآخر، بالرغم من أن خطابها قد دشّن أُسس العقلانية؛ وبحسب الخطاب الحداثي الغربي، لم يكن ثمة مفر من توظيف الآخر وموارده من أجل خدمة الحضارة الغربية التي عرفت نفسها في خطابها على أنها الحضارة وليست حضارة.
وما يهمنا هنا أن المُستعمرة، بوصفها حيزًا مكانيًّا، هي أكثر الأمكنة في الوجود تُدار بموجب الحق السيادي في القتل، فهي خارج أي ضمانات مهما كان شكلها أو طبيعتها، والقتل فيها لا يخضع لأي معيار أو قاعدة سوى الإدارة المطلقة للمُستعمِر. فغياب القانون الذي يتّحد مع الخيالات الأوروبية الحداثية عن الآخر، يسوغ تبريرات إن لم تكن لقتل سكان المستعمرة، فهي ستكون لاستغلالهم الاستغلال المُذل على الأقل، والذي أرى أنه حلقة من حلقات الموت؛ لأنه يمثّل موت مؤلم بطيء.
وفقًا لذلك العرض الذي يقدمه مبيمبي للمفهوم، تُعبّر السياسات النكرووية عن تحكم السلطة في الموت وإدارته من خلال ممارستها حق السيادة المتعلق بتعيين الحياة والموت. وإدارة السلطة للموت وفقّا لهذا المفهوم لا تكون فقط بالقتل المباشر، بل تتضمن خلق الظروف التي تؤدي إلى الموت أو حتى إهمال بعض الأفراد حال واجهوا ظروف تعرضهم للموت حتى ولو لم تكن مُختلقة من السلطة، فالسلطة تصنع حشود كاملة من البشر يعيشون على حافة الحياة؛ لأن الموت يتربص بهم في كل لحظة. فتلك السلطة لم تعد تخلق الحياة، أو على الأقل أصبحت تعرف لمن تخلق الحياة ولمن تخلق الموت.
ختامًا:
يتضح من خلال ما سبق أن أشيل مبيمبي، عبر مفهومه "السياسات النكرووية"، قد نقل النقاش الفلسفي- السياسي من حيز إدارة الحياة كما صاغه فوكو، إلى حيز أعمق يتعلق بإدارة الموت وتوزيعه كأداة سيادية. فالموت لم يعد مجرد نهاية بيولوجية، بل تحوّل إلى سياسة متعمدة، تُمارس عبر الحرب، والاستعمار، والعنصرية، والفصل المكاني، لتصنع عوالم موت يعيش فيها الأفراد على تخوم الحياة. وبهذا المعنى، فإن إسهام مبيمبي لا يقف عند حدود التوصيف، بل يقدم عدسة تحليلية قادرة على فهم ممارسات السلطة المعاصرة في فلسطين، وأفريقيا، والحدود الدولية، ومخيمات اللاجئين، وغيرها من فضاءات الإقصاء.
إن القيمة المركزية للمفهوم تكمن في إبرازه أن السلطة الحديثة لا تُقاس فقط بقدرتها على حماية الحياة، بل أيضًا بقدرتها على إنزال الموت، أو تعريض فئات معينة لشروط موت بطيء. لذلك، فإن السياسات النكرووية تضعنا أمام إشكالية أخلاقية وسياسية كبرى: كيف يمكن مقاومة أنماط حكم تستمد قوتها من إنتاج الموت؟ وكيف يمكن إعادة الاعتبار للحق في الحياة بوصفه أساسًا لأي مشروع تحرري؟ بهذا تُختَتم الورقة على تأكيد أن مبيمبي قد فتح أفقًا جديدًا في دراسة السلطة والسيادة، أفقًا يجعل من الموت أداة مركزية لفهم عالمنا المعاصر، ويُلزمنا بالبحث عن إمكانات مقاومته بقدر ما يلزمنا بفهم آلياته.
[1] أشيل مبيمبي، "السياسات النكرووية أو سياسات الموت"، أوراق فلسفية، ترجمة: أماني أبو رحمة، عدد 77 – 78، 2021، ص 138
[2] المصدر السابق، ص125
* العاطفة، الخيال، الروحانيات إلخ... وهذا التمييز هو ما فتح الأبواب على مصرعيها للعنف الكولونيالي على الآخر المتخلف غير العقلاني.
[4] مبيمبي، "السياسات النكرووية أو سياسات الموت"، ص 126
** تطويع الطبيعة للصالح الإنساني وتجاوزها بواسطة العمل والثقافة، وهو شيء ضروري في المنظومة الهيجيلية في سيرورة تحقق الفكرة المطلقة وانتفاء الذات المغتربة.
[6] مبيمبي، "السياسات النكرووية أو سياسات الموت"، ص ص 127-128
[7] المصدر السابق، ص ص 128-129
[8] المصدر السابق، ص 127
[9] كارل شميت، "مفهوم السياسي"، ترجمة: سومر المير محمود، (القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، ٢٠١٧)، ص 75-77
[10] جورجو أجامبين، "حالة الاستثناء: (الإنسان الحرام 1.2)"، ترجمة: ناصر إسماعيل، (القاهرة، مدارات للأبحاث والنشر، ط 2، 2024). ص 35-40
[11] مبيمبي، "السياسات النكرووية أو سياسات الموت"، ص 129
[12] ميشيل فوكو، "يجب الدفاع عن المجتمع"، ترجمة: الزواوي بغورة (بيروت: دار الطليعة للنشر، 2003 )، ص 248
[13] مبيمبي، "السياسات النكرووية أو سياسات الموت"، ص 131
[14] المصدر السابق، ص 131
[15] للمزيد انظر: أشيل مبيمبي، "المستعمرة: سرها المذنب وحصتها اللعينة"، ترجمة: دعاء عبد الحميد، أوراق فلسفية، عدد 84، 2022
[16] عامر ناصر شطارة ودعاء جمال محمد نصار، "مفهوم السياسة الحيوية بين ميشيل فوكو وجورجيو اغمامبين"، مجلة تبين للدراسات الفكرية والثقافية، مجلد 10، عدد 40، 2022، ص 105
[17] دعاء عبد النبي حامد، "إشكالية العنف والحرية في ضوء فلسفة ما بعد الاستعمار"، مجلة الاستغراب، عدد 32، 2023، ص 285
** كلمة نكرووية Necro تعني النخر أو الموت، وهي مشتقة من Nocrosis الكلمة اللاتينية التي تشير إلى موت الخلية المبكر الذي ينبع من فعل خارجي وليس لأسباب داخلية، وموت هذه الخلية بهذا الشكل يسبب رائحة كريهة ويستعدي التدخل الجراحي لمعالجتها. (أماني أبو رحمة)
[19] مبيمبي، "السياسات النكرووية أو سياسات الموت"، ص 136
[20] المصدر السابق، ص 137