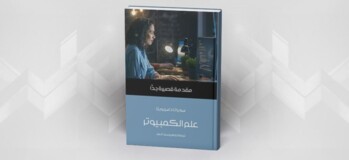الفكر الفلسفي والشرعي وإشكالية إعادة التفكير في الوجود الإنساني أمام تحديات الذكاء الصناعي
فئة : مقالات
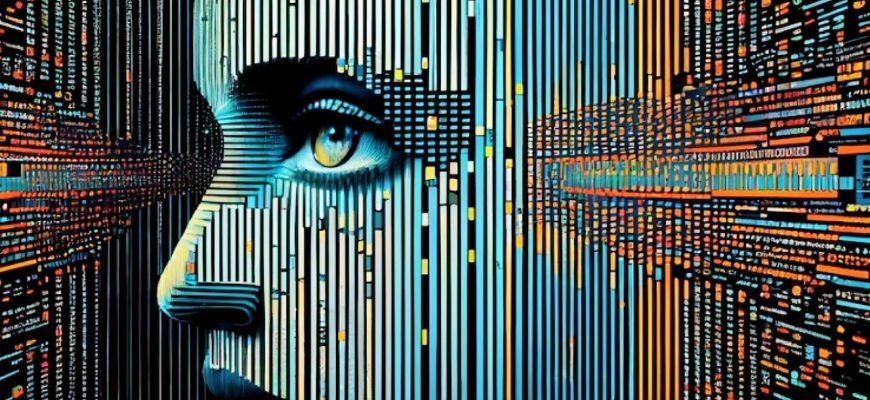
الفكر الفلسفي والشرعي وإشكالية إعادة التفكير في الوجود الإنساني
أمام تحديات الذكاء الصناعي
ملخص:
نتناول في هذا المقال إشكالية تتمثل في تأثير الثورة الرقمية والذكاء الصناعي على هوية الإنسان ووعيه الأنطولوجي، مركزين على مكانة الفكر الفلسفي والشرعي في مواجهة هذه التحولات الجوهرية، فننطلق من فرضية متمثلة في: أن تحول الإنسان إلى "كائن رقمي" قد أضعف ملكاته التأملية والميتافيزيقية، وجعله خاضعًا لمنطق التقنية التي تسعى إلى محاكاة ذكائه بل تجاوزه، الأمر الذي ولد أزمة وجودية وأخلاقية انعكست على المنظومات النظرية للفكر الديني والفقهي التقليدية.
وعليه، فإننا قد اعتمدنا في هذا المقال، منهجًا تحليليًّا تاريخيًّا يقف على الجذور الفلسفية للذكاء الصناعي، بدءًا من أسس المنطق الرياضي والصورنة الفكرية، وصولا إلى إسهامات هايدغر ونيتشه في نقد التقنية، كما سعينا إلى إعادة استحضار جهود ابن رشد في بناء علاقة تكاملية بين العقل الشرعي والفلسفة البرهانية.
وفي الأخير، توصنا إلى أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تحديث المبادئ الفكرية التي تحكم تطور الفكر الشرعي والفلسفي، وإعادة تفعيل المنطق البرهاني، بالاستفادة من مبادئ الفكر الرياضي والعلوم المعاصرة، بما يتيح استعادة البعد الأنطولوجي للإنسان وحفظ تفرده في مواجهة سلطة التقنية.
تمهيد:
لم يعد الإنسان كائنًا اجتماعيًّا بطبعه، بل أصبح حيوانًا رقميًّا منفردًا بعالمه الذي أنشأه بكبسة زر واحدة؛ ذلك ما جعله يفقد جانبه الأنطولوجي الذي تميز به عن باقي الكائنات الأخرى التي قاسمته نفس نمط الوجود، لكن مع التطورات التي شهدها الفكر الإنساني تمكن هذا الأخير من بناء عالم رقمي يسهل عليه الصعوبات التي تعترض حياته، وفي مقابل ذلك اضمحلت قوة الفكر الشرعي خاصة في المجال الفردي والجماعي، وأضحت رمزًا ثقافيًّا يحن إليها الإنسان متى استشكلت عليه المصاعب التي يواجهها خلال مراحل حياته.
إن هذا التطور الذي وصل إليه الإنسان جاء نتيجة حتمية لما راكمه من مبادئ علمية وفلسفية خلال القرون الماضية، حيث كانت البداية خلال العصر الحديث، الذي تشكل فيه الفكر الإنساني من خلال اكتشافه لمفهوم الذات* باعتبارها ذات واعية بموقعها الأنطولوجي، ومتميزة عن باقي الموجودات الأخرى بامتلاكها للفكر، ولكي يطور هذا المسعى كان على الإنسان أن يطور فكره من خلال ابتكار نماذج منهجية تؤطر فعل التفكير، من خلال اتخاذ الطبيعة أنموذجًا للسيطرة والتحكم في قوانينها بغية الإعلان عن ميلاد عالم جديد يطوره الإنسان، ويحكم فيه ويسخره لحل المشكلات التي يصادفها خلال مراحل حياته، فحقق بذلك ثورات علمية وصناعية واقتصادية، أعلت من قدرة الإنسان في إمكانية التحكم في قوانين الطبيعة، بل وخلق قوانين جديدة للفكر تسمح بظهور عالم جديد أساسه المبادئ المنطقية التي قامت عليها الثورة التكنولوجية.
لقد ساهمت الثورة التكنولوجية التي توصل إليها الإنسان إلى ابتكار آلات مفكرة وفاعلة، تحاكي قدرات الإنسان، بل وتفوقه في ذلك من خلال سرعة التنفيذ والحصول على المعلومة أو معالجتها، فاستقل الإنسان عن مملكته ففوضها إلى آلة قادرة على محاكاة أعمال البشر، لكن الخطير في الأمر أن هذه الثورة التكنولوجية وتطوراتها الرهيبة صارت قادرة على محاكاة الذكاء الإنساني من خلال قيامها بالأفعال الإبداعية، كعزف الموسيقى ونظم القصائد وكتابة القصص العجائبية، ورسم اللوحات الفنية... وذلك في دقائق أو ثواني معدودة.
إن هذا التطور الرهيب الذي وصل إليه الإنسان، أفقدته مميزاته الفكرية وخصوصيته الذاتية فجعلته خاضعا للعالم الرقمي الذي احتواه، فتراجع دور الإنسان أمام التقدم السريع للآلات، والتكنولوجيا والذكاء الصناعي الذي خلق عالما رقميا ساهم في تراجع التفكير الإنساني، ليجعله رقما من بين الأرقام الموجودة في عالم البيانات، التي بإمكانها أن تحذف أو تضاف بـ"كبسة زر واحدة".
وأمام هذه التحديات التي طبعت حياة الإنسان وجعلته يفقد خصوصياته الوجودية، بات السؤال عن راهنية الفكر الفلسفي بوصفه فكرًا إنسانيًّا متميزًا عن باقي الكائنات الأخرى، سواء كانت بيولوجية أو رقمية؛ ذلك أن خصوصية هذا الفكر جعلت الكائن الإنساني يشيد كل مرة عالمًا فكريًّا أكثر تطورا من ذي قبل. فمنذ أسطورة الكهف الأفلاطونية إلى سحابة "ألان تورنAlan Turing "* الرقمية، فإن الفكر الفلسفي يزداد قوة في كل مرحلة من مراحل حياة الإنسان، من خلال التشبث بالفكر الأنطولوجي والميتافيزيقي الذي يعد جانبا أصيلا وجوهريا في للفكر الإنساني.
إذن بالرغم من التطورات السريعة للتكنولوجيا والذكاء الصناعي، إلا أنهما لا يستطيعان أن يخلقا عالما أنطولوجيا أو ميتافيزيقيا كالذي تميز به الإنسان الطبيعي؛ فلا يمكن للآلات أن تتفلسف وتتساءل عن نمط وجودها، أو عن أهمية العلوم الشرعية التي رفعت قيمة الإنسان من جهة، وجعلته متفوقا ومدركا لحقيقة الإلهية الخالدة من جهة ثانية؛ ذلك أن الآلات والذكاء الصناعي ينحصر مجال فكرهما واهتماماتهما في الأمور التقنية والمعالجة الحسابية البسيطة منها والمعقدة. أما التفكير الميتافيزيقي والشرعي، فلا يزال مرتبطا بالإنسان بصفته الكائن الوحيد المدرك لأهمية الجانب الأنطولوجي المجرد منه والمعقد.
انطلاقا مما سبق، فإن المسار المنهجي الذي سلكه الإنسان في ظل العصر الرقمي، جعل الذات الإنسانية مغتربة، ولا تنفك أن تفهم أهمية جانبها الأنطولوجي والإيماني الشرعي، فهل أصبح تفكير الإنسان ممكنا في ظل العصر الرقمي؟ أم إنه يجب القبول بنهاية الفكر الفلسفي والشرعي؟ ولماذا يجب إعادة النظر في علاقة الفكر الفلسفي بالشرعي؟ وكيف يمكن لهذه العلاقة أن تبرز الجانب الأنطولوجي في الإنسان بصفته كائنا مفكرا؟
1. مشكلات الفكر الفلسفي في عصر الذكاء الصناعي والإنسان الرقمي
على الرغم من التطور المتسارع للنماذج الصناعية الذكية التي تسعى في هذا العصر إلى محاكاة الذكاء الطبيعي، فإن طبيعة هذه المحاكاة وتطوراتها أفرزت مشكلات تتعلق بعزل الإنسان من إنسانيته الواعية والمدركة لحقيقة وجوده إلى إنسانية منفذة ومستلبة خاضعة لأوامر الآلة ، وهذه النتيجة التي أصبحت واقعًا حقيقيًّا أفرزت مجموعة من المشكلات الفلسفية التي صارت تعرف راهنتيها خلال هذا العصر التكنولوجي المتسارع؛ أي عصر الذكاء الصناعي، الذي تميز بتحويل حياة الإنسان الطبيعية إلى إنسان رقمي خاضع لنظام تقني معلوماتي مخزن في عالم البيانات الرقمية، التي اختزلت قيمة الإنسان وجعلتها تتحدد في طبيعة الرقم الذي يمثله "ولا يسعنا إلا أن نندهش عندما نرى هذا القدر الكبير من الذكاء، والكثير من المعرفة، يوضع في خدمة هدف واحد، وهو الاستثمار الاقتصادي وما باستطاعة الذكاء الصناعي أن يقدمه، لكي يدخل الإنسان في عصر"[1]؛ وذلك من خلال حجم الاستثمارات الاقتصادية التي دخلت عصر المعلومات، فلم يعد الإنسان يشتري المنتوج الذي يحتاجه، بل صار يشتري المعلومات التي قُدم بها المنتوج، ونفس الشيء بالنسبة إلى طبيعة الكائن الإنساني الذي فوض حياته الطبيعية والبيولوجية إلى مجالات للاستثمارات الرقمية والتجارية المربحة، "فقد تمكن المستثمرون من توفير خدمات تخص الخلايا الجذعية وزرع الأعضاء والتحسين الوراثي للنسل والأدوية الجينية، وإعادة البرمجة الوراثية والاستنساخ واستئجار الأرحام، وغيرها من التقنيات التي تعتمدها البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية وطب الجينات"[2]، فلم يعد الإنسان طبيعيا كما كان، بل أضحى خاضعا لعالم صناعي متغير حسب طبيعة العرض والطلب.
إن هذا التطور الرقمي الذي عرفه الإنسان لم ينحصر فقط في جانبه البيولوجي والجيني أو الاقتصادي، بل شمل أيضا الملكات المعرفية التي تميز بها عن باقي الكائنات الأخرى على مدار قرون طويلة من الزمن، حيث أضحت كل أنماط تفكيره وعملياته محددة قبليا من خلال فهم أسس ومبادئ تشكل المعرفة في العقل الإنساني، وهذا ما جعل إمكانية التغير الجذري في حياة الكائن الحي إلى كائن صناعي خاضع لأنظمة معرفية ورقمية، مثل تقنية "النانو التي أبانت عن قدرتها على تنمية القدرات الجسدية والفكرية عند الإنسان؛ خاصة بعد أن أكد مهندسو الذكاء الصناعي وعلماء الأعصاب على انتهاء مرحلة احتكار الإنسان لملكة الذكاء. فأضحوا يتكلمون عن ذكاء صناعي قادر على تعزيز وتعويض الذكاء الطبيعي، وعن ذاكرة رقمية تعوض ذاكرة الإنسان. هكذا سيصبح بإمكان كل واحد منا حماية معلوماته من الضياع والنسيان بإفراغها في وسائط إلكترونية، بل يمكن أن يستغني عن ذاكرة ليعوضها بوسائل لتخزين البيانات"[3]. فأمام هذه التحديات التي صار يواجهها الإنسان في عصر نظام المعرفة الرقمية والذكاء الصناعي، بات لزاما عليه الوقوف للتأمل في المسار الذي قطعته الأنظمة الذكية، وانعكاساتها على الذكاء الطبيعي الذي صار مهددا بالانقراض والاستقلال عن طبيعته الطبيعية معلنا انكماشه في كل ما هو رقمي وسهل وبسيط.
لقد انطلق الذكاء الصناعي من مبادئ نظرية اتسمت بضرورة البحث في قدرات الدماغ البشري على إنتاج الأفكار والربط بينها، وكانت هذه بداية التفكير في محاولة محاكاته انطلاقا من ابتكار آلة وأدمغة إلكترونية الذكاء تحاكي وظائف الدماغ البشري، ولقد كان الهدف من ذلك تسهيل حياة الإنسان العملية والتقنية، وجعله قادرًا على تجاوز التعاملات الصعبة والمعقدة، ومنح المعقولية على الأفعال والأقوال التي تميز الإنسان على باقي الكائنات الأخرى، لكن سرعان ما اكتسحت هذه الآت حياة ذلك الكائن العاقل الطبيعي لتجعله مقعدا أمام الأزرار آمِراً الآلة بتنفيذ الأوامر، لينعزل بعد ذلك عن حياته الاجتماعية، بل ليستقل عنها، معلنا عن هوياته المتعددة داخل عالمه الرقمي.
إن كل هذه النتائج التي صار عليها الإنسان لم تكن صدفة أو عشوائية، بل أسسها تاريخ نظري ومنطقي رياضي ساهم في ظهور أشكال جديدة من التفكير في كيفية تَوخي الدقة في الأقوال والأفعال، وما دام ذلك غير ممكن في ظل النظام الطبيعي تحتم على العلماء والباحثين التفكير في إمكانية خلق عالم جديد تكون له لغة صورية تعبر عن الأفكار الخالصة*، فهي لغة دقيقة ومنظمة تعقلن الأفعال الإنسانية، وتكتسي درجة عليا من الدقة والتنظيم.
ولقد كانت البداية مع غولتوب فريجه الذي شكك في صدقية الأحكام الكانطية، وحاول التفكير في إنشاء لغة صناعية دقيقة تعبر عن الفكر الخالص التي ستلقى صداها في عالمه الجديد الذي تحرر من الدلالات المبعثرة وغير اليقينية إلى عالم دقيقة سيسمى بالعالم الثالث أو عالم المعنى*، لكن لن تتضح معالم هذا العالم وتتصلب إلا بعد ظهور الرسالة المنطقية الفلسفية لـ"لدفيغ فيتغنشتاين" الذي سيضفي المعقولية على اللغة الصورية أي لغة الفكر الخالص ليعيد مشروع فريجه المنطقي إلى الواجهة المطلوبة، لتتحول بعد ذلك أبحاث الفلاسفة وعلماء الرياضيات والمنطق إلى التفكير في إمكانية ربط الرياضيات مع المنطق، بل جعل هذا الأخير أساسا لكل عملية رياضية*.
إن هذا الارتباط سيحيي الأمل في إمكانية تحقيق صَوْرنَة كاملة للرياضيات، وقد توطدت "هذه العلاقة عندما سعى بعض الباحثين إلى إعادة إنتاج سبل التفكير والتدليل عند الإنسان على مستوى الذكاء الصناعي، حيث تم الاقتناع بأنه لا يمكن عزل الصورنة عن الذكاء الصناعي، وعن التفكير ككل. الأمر الذي يبرز الدور الذي لعبه المنطق الرياضي في ظهور المعلوميات؛ خاصة بعد أن تم تصميم الدوائر الإلكترونية الرقمية وتزويد الحواسب بثنائية جورج بول، وتوجه البرمجيات نحور الصورنة"[4].
على العموم، فإن جعل المنطق أسسا للرياضيات وتطور التفكير في إمكانية صورنة اللغة الطبيعة شكلت شروطا أولية لظهور النماذج الأولى للذكاء الصناعي، خاصة بعد أن أعطى "ألان تورينغ" لهذا النسق الفكري طابعا آليا ذكيا يحل كل مبرهنة رياضية أو كل شفرة معقدة.
إن الوقوف عند هذا المسار التاريخي الذي يبين الشروط النظرية لظهور الذكاء الصناعي سيسمح لنا بإعادة النظر في الأسباب التي عزلت الإنسان عن موقعه الاجتماعي الطبيعي، فأضحى خاضعا لعالم رقمي متعدد الهويات والقيم، ناسيا بعده الأنطولوجي الذي تميز به منذ عصور خلت.
والحق أن هذا الخطر الوجودي الذي يهدد الإنسان الطبيعي، ويسلب منه خصائصه الاجتماعية قد سبق للفيلسوف الألماني فردريك نيتشه أن حذر الإنسانية من التهديد الذي ينتظرها في المستقل القريب؛ إذ يقول في كتابه ما وراء الخير والشر: "احذروا التقدم التكنولوجي الذي لا غاية له إلا ذاته، احذروا حركته الجهنمية التي لا تتوقف عند حد، ستلد في المستقبل أفرادا طيعين، خانعين، مستعبدين، يعيشون كالآلات احذروا هذه الدورة الطاحنة للمال ورأس المال والإنتاج الذي يستهلك نفسه بنفسه، احذروا عصر العدمية الذي سيأتي لا محالة، إذ لا يكفي أن تسقطوا الآلهة القديمة كي تحل محلها أصناما جديدة"[5] تغتل حياة الإنسان وتجعله تائها مستسلما للآلة التي تعده بحياة مرفهة، وقيم غير ثابتة.
صحيح أن تطور الذكاء الصناعي قد أنقذ الإنسانية من صعوبة الحياة وتعقيداتها، إلا أنه سلب منها أنماط وجودها وهوياتها وقيمها الأخلاقية، فكل شيء أصبح نسبيا في ظل عالم متغير، وقد انعكس ذلك بالدرجة الأولى على البعد الديني والفكر الشرعي والأنطولوجي للإنسان، نظرًا إلى عدم مواكبة هذه الأفكار للتطورات التي لحقت عصر الذكاء الصناعي والإنسان الرقمي، فبقي حبيس الأنماط الفكرية التقليدية التي تعطي حلولا للإشكالات الوجودية الراهنة، انطلاقا من تجارب واجتهادات ماضية ومقدسة، فيصير الإنسان تائها في بؤس الحياة الاجتماعية من جهة، وتطورات العالم الرقمي والذكاء الصناعي المتسارع من جهة أخرى.
2. إشكالية تأخر الفكر الشرعي في مواكبة عصر الذكاء الصناعي والإنسان الرقمي
إن مسألة إشكالية تأخر الفكر الشرعي ترجع بالأساس إلى اعتمادها على مناهج قديمة، التي لم تعد تستجيب لمتطلبات العصر العلمي والمنطقي الرياضي؛ إذ ينعكس ذلك على النتائج التي يتوصل إليها الباحثون في مجال الفكر الشرعي، حيث لا توجد أي قيمة مضافة للنتائج المستنبطة من الأبحاث التي يتم إجراؤها.
وليتقدم الفكر الشرعي ويُغني نتائجه النظرية، خاصة في عصر الذكاء الصناعي والإنسان الرقمي عليه أن يعود إلى الأفكار المنطقية التي يصير فيها الاستدلال والبرهان ممكنًا على القضايا الشرعية التي تمس نمط الوجود الإنساني، وهذه العلمية المنطقية ممكنة نظرًا إلى الأرضية الموجودة في الفكر الشرعي التي سبق للقدماء أن أسسوها، خاصة بعدما حُلت إشكالية الفلسفة والدين مع ابن رشد الذي استعان بالأساليب المنطقية والبرهانية لإثبات الحقائق الإيمانية من جهة، وتوافق الفلسفة والدين من جهة ثانية.
إن ضرورة العودة إلى تطوير الأساليب الاستدلالية في الفكر الشرعي هي ضرورة منطقية، وانطلاقة جديدة للمناهج الفقهية التي يجب عليها أن تبنى على المنطق الرياضي المعاصر، فهذا ما سيضمن الحوار الجاد مع تجارب الأسلاف والمساهمة في نقد الأخطاء التي بنيت عليها القواعد والمناهج الفقهية، وعدم فعل ذلك يجعل الفكر الشرعي يعرف تأخرًا موضوعيًّا، مما سينعكس سلبًا على حياة الإنسان المعاصر الذي لا يجد ضالته في الأساليب القديمة، أمام التحديات الجديدة التي أنتجتها التطورات السريعة والتي عرفها الذكاء الصناعي؛ إذ سيصبح الإنسان مستلبا وحائرًا بين التشبث بهويته الفكرية والشرعية الثابتة، أو أن يساير تطورات العصر الرقمي الذي فرض نفسه، فأمام هذه المفارقة الوجودية التي يعيشها الإنسان المعاصر صار من الضروري على الباحثين في مجال الفكر الشرعي والفلسفي إيجاد قواسم مشتركة لتوحيد الجهود ومواكبة تطورات الذكاء الصناعي، وما يطرحه من تحديات في ظل عصرنا الحالي، عصر الإنسان الرقمي.
وبالنظر إلى القواسم المشتركة في تراثنا الفكري نجده قد استقر على الحل الإشكالي الذي طرحه ابن رشد للعلاقة المنطقية المبنية على التكامل بين الشريعة والحكمة، وهذا ما يدل عليه قوله: "وإذا كانت هذه الشريعة حقا وداعية إلى النظر المؤدي إلى معرفة الحق، فإنا معشر المسلمين نعلم على القطع أنه لا يؤدي النظر البرهاني إلى مخالفة ما ورد به الشرع: فإن الحق لا يضاد الحق بل يوافقه ويشهد له"[6].
وجلي بالذكر أن المعرفة في الفكر الشرعي لا تقوم إلا من خلال عملية منطقية أساسها استنباط المجهول من المعلوم؛ وهذا الطريق الاستنباطي لا يكون محققا إلا من خلال علميات القياس والبرهان، وقد برهن ابن رشد على طريقة عمل الفكر الشرعي في بناء الأحكام والمعارف بناء منطقيا هدفه بلوغ الحق واليقين فـ "الشرع قد حث على معرفة الله تعالى وسائر موجوداته بالبرهان، وكان من الأفضل (أو) الأمر الضروري لمن أراد أن يعلم الله تبارك وتعالى وسائر الموجودات بالبرهان وأن يتقدم أولا فيعلم أنواع البراهين وشروطها، وبماذا يخالف القياس البرهاني والقياس الجدلي، والقياس الخطابي، والقياس المغالطي، وكان لا يمكن ذلك دون أن يتقدم فيعرف قبل ذلك ما هو القياس المطلق، وكم أنواعه، وما منه بقياس وما منه ليس بقياس التي منها تركب، أعني المقدمات وأنواعها، فقد يجب على المؤمن بالشرع، الممتثل أمره بالنظر في الموجودات، أن يتقدم قبل النظر فيعرف هذه الأشياء التي تنزل من النظر منزلة الآلات من العمل"[7].
يتبن من خلال ما تقدم، أن المسار المنهجي الذي يمكن أن يقطعه الفكر الشرعي، إذا ما أراد أن يطور نفسه ويلاحق عجلة الذكاء الصناعي التي أنتجت عصر الإنسان الرقمي، أن يتشبث بالأساليب المنطقية المتطورة، وأن يثبت نفسه بصناعة قواعد فقهية أساسها عمليات الاستنباط والقياس، وهذه العلمية المنطقية تعد قاسمًا مشتركًا بين جميع التخصصات التي تتوخى اليقين، فما دام ابن رشد قد بين إمكانية قيام الفكر الشرعي على قواعد ومبادئ فلسفية منطقية، وما دام الذكاء الصناعي قد أسس مبادئه على الأنساق المنطقية والرياضية، فإن الفكر الشرعي لا يمكنه أن يطور أطروحات اجتهاداته إلا من خلال القياس والبرهان بكل أنواعهما. وإذا تحقق ذلك، سيكون الفكر الشرعي منفتحا ومتقبلا للمناهج الفكرية المعاصرة، خاصة التطورات التي لحقت بالأنساق المنطقية المعاصرة.
إن أهمية تطوير الفكر الشرعي على ضوء المبادئ المنطقية المعاصرة، ستمكن الفكر الشرعي من ملاحقة التسارع الذي يشهده عصر الإنسان الرقمي، ويبلور على إثرها اجتهاداته النظرية، التي ستنتشل الإنسان من أزماته الوجودية المعاصرة، وتمنح له رؤية شاملة في طريقة تدبير حياته في ظل عصر الذكاء الصناعي والإنسان الرقمي.
3. أهمية العودة لعلاقة الفكر الفلسفي بالفكر الشرعي، لاستشراف النظر الأنطولوجي في عصر الإنسان الرقمي.
لقد سبق لمجموعة من الفلاسفة والمفكرين المهتمين بالفكر الشرعي أن بينوا العلاقة الرابطة بين الفكر الفلسفي والشرعي، حيث استقر رأي الفلاسفة المسلمين على العلاقة التكاملية التي تربط بين المجالين، واستقر رأي الفلاسفة الغربين خلال عصر الحداثة بإنهاء السجال بين الفلسفة والدين بعقلنة هذا الأخير ووضعه في حدود العقل الخالص.
إن القول بالعلاقة التكاملية هو قول له راهنيته الأنطولوجية على اعتبار أن الدين حق، ويبتغي الحق من خلال النظر في الموجودات التي تدل على وجود الصانع، وهذا ما بينه ابن رشد من خلال فصل المقال، وكما بينه أيضا في غير موضع.
والحق أن العلاقة التكاملية بين الفلسفة والدين لم تنحصر فقط لدى الفلاسفة المسلمين، بل امتدت أيضا عند الفلاسفة والمفكرين واللاهوتيين الغربيين خلال العصر الوسيط، حيث يبين إتيان جيلسون من خلال مقارنة أجراها بين موقفين: الأول لتوما الأكويني، والثاني لدان سكوت؛ إذ يتعلق الأمر بالنظر في علاقة الإيمان بالعقل بوصفهما حقيقتين جوهريتين، التي تمت معالجتهما خلال العصر الوسيط؛ على نحو ما "إذا كان هناك مجال في التفكير الطبيعي للتأمل فيما بعد الطبيعة"[8]. ولقد تساءل فلاسفة ذلك العصر "عن إمكانية استفادة اللاهوتيين من الفلسفة"[9]، وفي نهاية القرن الثالث عشر الميلادي تبين إمكانية قيام "مجال الميتافيزيقا والإيتيقا Éthique الطبيعية التي تسمح بمعالجتهما بنفس الطريقة"[10]، ومن خلال ذلك تمكن "توما الأكويني ليس فقط بدحض تصور اللاهوتيين الذين يقرون بعدم إمكانية بلوغ الحقائق الإلهية بالعقل، أو الذين يستبعدون اللاهوت، باعتباره علما بل دحض أيضا التصور الفلسفي الذي يرى في أرسطو كلا شاملا يشمل الحقائق المطلقة من الفيزياء والرياضيات والفلسفة الأولى"[11]، وهذا الرفض سيزعزع الأسس الفلسفية الأرسطية التي تمثل حقيقة مطلقة إلى جانب الحقيقة الدينية، وإن رفض الأكويني لهذا التصور لدعوة منه إلى "ربط الحكمة بدراسة الرسائل المقدسة، بينما يحتفظ الإيمان بالخلاص"[12]، إضافة إلى ذلك، فقد رأى في "العقل إمكانية معرفة وجود الله وبعض صفاته؛ وذلك بفضل النور الفطري المشترك بين جميع البشر، ولكن لا يمكن للعقل إدراك بعض الحقائق الإلهية مثل: التثليث، الخلق في الزمان، التجسيد..."[13]؛ لأن هذا المجال حسب الأكوني يجعل "العقل يسقط في مجموعة من المتناقضات"[14].
والحق أن هذه الحدود الإدراكية للعقل في المسائل الإيمانية جعلت من توما الأكويني يرفع تناقض اللاهوتيين الذين يقرون بعدم إمكانية الفلسفة بلوغ الحقائق الإلهية من جهة، ورفع تناقض فلاسفة العصور الوسطى القائلين باستحالة دراسة أرسطو دون الأخذ به في كل الميادين التي بناها.
وعليه، فقد بين توما الأكوني بأن مجال الحكمة أو الفلسفة هي الدراسة العقلية للرسائل المقدسة الخاضعة للفهم والتفسير والشرح. أما المسائل الإلهية المتعلقة بالخلاص الإلهي، فإن مصدرها الإيمان وبالوحي المقدس، وعلى أساس ذلك يتبين لنا جليًّا وجود علاقة تكامل بين ما أقرت به الفلسفة، وما يدعو إليه الدين، شريطة معرفة حدود الإدراك البشري. نفس الشيء بالنسبة إلى دان سكوت الذي لا يتعارض مع القديس توما الأكوني في إمكانية وجود العلاقة بين الحكمة والشريعة (الميتافيزيقا واللاهوت)، "فبعد أن تلقى دان سكوت الأرسطية من ابن سينا، أقر بإمكانية العقل البشري في البحث عن "ماهية الشيء المعقول"، المتحرر من المادة، لكن هذا الشيء المعقول الموجود، نحن بعيدون جدا عن معرفته وإدراك خصائصه بالرغم من امتلاكنا للنور الفطري، إلا أن فعل ذلك سيظل مجرد خيال محض، مرد عجزنا عن ذلك هو استمرار للخطيئة الأولى"[15] التي ارتكبها الإنسان*. ما يهمنا هنا أنه قد تمت البرهنة على وجود علاقة تكامل بين الحكمة (الفلسفة) والشريعة (الدين)، سواء في الدين الإسلامي كما بينها ابن رشد، أو كما ناقشها ابن سينا؛ الذي استمد منه دان سكوت روح الفلسفة الأرسطية وأعاد النظر في إشكالية الفلسفة والدين، حيث توصل إلى التأكيد على العلاقة التكاملية بينهما شريطة احترام حدود المعقول (الله)، وعدم السعي إلى البحث عن طبيعته وخصائصه والاكتفاء بالتصديق والإيمان بما أتى به الشرع ونص عليه. أما مجال العقل، فهو المجال الذي يبحث في كل ما يعلق بالإنسان وطبائعه.
إن الرهان من بيان هذه العلاقة التكاملية هو إظهار حاجتنا الأنطولوجية لهذا البعد الديني والسعي إلى التفكير في إمكانية فهم جديد للنصوص الدينية في ظل عصر الإنسان الرقمي والذكاء الصناعي الذي حول الإنسان إلى مجرد آلة عابدة للمادة ومتبعا لملذات الحياة، حتى وإن كانت موعودة برفاهية الإنسان الرقمي الذي بإمكانه فعل أي شيء بكبسة زر واحدة، لكن رغم ذلك التطور الهائل في الأفعال الإنسانية، إلا أننا قد فقدنا ذلك الكائن الذي أطلقنا عليه في يوم ما صفة "العاقل"، نظرًا إلى كونه قد تحرر من خصائصه الطبيعية والوجودية، فأصبح مجرد رقم في عالم متغير ومستلب.
إن إعادة النظر في البعد الأنطولوجي للإنسان يعد ضرورة إبستمولوجية لحل مشكلات عصر الإنسان الرقمي، المتمثلة في اغتراب الإنسان داخل عالمه الطبيعي والاجتماعي الذي أضحى فيه غريبا ومغتربا، وهذا ما يتطلب إعادة النظر في نمط وجوده المزدوج (الطبيعي والرقمي)، الذي سيكشف عن الضرورة المعرفية، حيث يجعله يكتسب أساليب جديدة يعقلن من خلالها طريقة عيشه وتفكيره وثقافته، وتشييد نسقا فكريًّا جديدًا يحل فيه إشكاليته الوجودية والمعرفية عبر الارتقاء بالمعيش والعيني إلى مستوى التجريدي المفهومي.
من هنا قد يطرح سؤالًا: ما السبيل إلى جعل الإنسان الرقمي يعي وجوده الأنطولوجي؟
في الحقيقة لهذا السؤال راهنيته الأنطولوجية التي بحث فيها الفلاسفة الذين أعلنوا نهاية الفلسفة وبداية التفكير الإنساني؛ نهاية الفلسفة من حيث كونها تأمل ميتافيزيقي لا حدود له، وبداية التفكير في العيش المشترك، وهذا ما يوضحه مارتن هيدجر من خلال قوله: "حينما قلنا إن الفلسفة صارت أنطولوجيا للحاضر، فإنما نعني بذلك أنها أضحت محاولة لفهم دلالة الحاضر باعتباره تجربة معيشية، ومحاولة الارتقاء بحدث الحداثة من العيني إلى الذهني، أي الارتقاء به إلى مستوى المفهوم واستيعابه على صعيد المبدأ"[16]، الذي يؤسس لعلاقة جديدة بين الفكر والوجود الإنساني المتحرر من كل نزعة تقنية أو رقمية تُقبر الإنسان في براثين اللامعقول واللا طبيعي، وتبعده عن كل ما هو إنساني وأصيل.
إن حديث هيدجر عن المبدأ المنظم، هو حديث ذو بعد إبستمولوجي استمده من تاريخ الفكر الفلسفي والعلمي اللذين شيدا عصر الحداثة والأنوار وفهما الطبيعة الحقيقية للإنسان المفكر والواعي والمدرك لوجوده الطبيعي، وهو في حالة صيرورة دائمة تعقلن حياته، وتجعل العيني والعملي قابلا للصعود إلى المستوى المفهومي المجرد، "إن هذا المبدأ هو ذلك الذي يدرك، ما يكون، وكيف يكون؛ أي أنه يستجلب الوجود بوصفه مبدأ الموجود إلى حالات حضوره، إذ هنا يتجلى المبدأ بوصفه الحضور، وسيتبين زمنه الحاضر في كل مرة وبحسب طريقته ينتج الحاضر في حضوره"[17]، ويكون بذلك مبدأ مؤسسا لطريقة بناء معرفة التي يدرك من خلالها الإنسان وجوده في علاقته بوضعه وعالمه المعيش.
من هنا تظهر حاجة البعد الأنطولوجي في الإنسان بصفته كائنًا واعيًا ومفكرًا ومدركًا لماهيته التي تجعله متميزًا عن باقي الكائنات الأخرى، وهذا ما سبق لـ"بليز باسكال" أن عبر عنه من خلال قوله: "وما الإنسان إلا قصبة، وهي الأضعف في الطبيعة، ولكنه قصبة مفكرة، لا ينبغي للعالم كله أن يتسلح لسحقه؛ فببخار، أو قطرة ماء تكفي لقتله، لكن عندما يسحقه العالم، يكون الإنسان أنبل ممن يقتله؛ لأنه يعلم أنه يحتضر ويُقتل، ولكنه رغم ذلك يظل متميزا عن العالم لأنه يعرف أنه يموت والعالم لا يعرف أنه يقتله"[18].
فالفكر يعجل الإنسان متميزا عن كل كائن موجود، سواء داخل عالم الطبيعة أو عالم الذكاء الصناعي، والرقمي، فبالرغم من التطورات المتسارعة التي يشهدها هذا العالم الأخير، الذي يحاول أن يقبر الذكاء الإنساني، إلا أن الإنسان يظل متفوقا على كل ذكاء ممكن؛ وذلك من خلال وعيه الدائم بالبعد الأنطولوجي الذي ينفرد به عن باقي الكائنات الأخرى من خلال إدراكه له.
إذن يمكن لنا القول إن الإنسان، رغم التحولات الأنطولوجية التي عرفها، والتي وصلت به إلى ظهور عالم رقمي أفقده طبيعته الأصلية، وأدخله في عالم متغير ومتسارع، سلب منه قوة التفكير الميتافيزيقي والأنطولوجي الذي لازمه منذ عصور خلت، فإن ذلك لا يمحي ماهية الإنسان الأصيلة؛ فهو بالرغم من كونه الكائن الأضعف في الطبيعة كما بين "باسكال"، إلا أنه يتميز بالفكر عن باقي الأشياء الأخرى الموجودة في العالم الطبيعي، بل حتى العالم الرقمي الذي خلقه هو بنفسه وخلق معه مشكلات تهدد وجوده المادي والميتافيزيقي كما بينا ذلك إثر حديثنا عن راهنية الفكر الشرعي في عصر الإنسان الرقمي، فراهنية هذا الفكر هي إدراك أهمية العلاقة المنطقية بين الفكر الشرعي والفلسفي، ثم السعي إلى تطويرها من خلال البث في تلك الأسس المنطقية القديمة القائمة على القياس والبرهان، من أجل تطويرها بالانفتاح على المنطق الرياضي المعاصر الذي طور هو الأخر المعرفة الإنسانية والذكاء الصناعي.
ما دامت للفكر الشرعي أسس منطقية وأنطولوجية فما عليه سوى تطوير مباحثه المعرفية كي تتناسب مع متطلبات الإنسان المعاصر الذي أضحى رقميا داخل عالم متغير ومتسارع بامتياز.
وعليه، فإن هذه المحاولة لا يجب أن تكون منعزلة عن التفكير الفلسفي، بل عليها أن تسهم في تأسيس نسق فكري جديد؛ ينطلق من المبادئ الأنطولوجية والأبحاث المنطقية والمساهمة في بناء مناهج فقهية تعنى بحل مشكلات الفكر الشرعي.
خاتمة:
خلاصة القول: إن أهمية الوقوف وإعادة النظر في مسار الفكر الفلسفي والشرعي والتطورات اليومية التي يشهدها الذكاء الصناعي والعصر الرقمي، هي ضرورة ملحة للتفكير في المبادئ المنطقية التي انبنى عليها الفكر الشرعي والفلسفي، ومحاولة تحديثهما لمواكبة المناهج الرياضية والعلمية المعاصرة، فهذا ما سيجعل فكرنا يواكب الحداثة وتطوراتها التي فرضت نفسها، وأقحمتنا في صلب إشكالياتها، فلا يعقل أن نواجه هذه المشكلات الحالية بالأساليب المنطقية التقليدية، أو الانعزال عنها.
إن ضرورة تطوير المناهج والمبادئ التي أسسها القدماء خلال العصر الوسيط ستمكننا من وضع انطلاقة جديدة نستوعب من خلالها إشكالية الحداثة والتحديات التي تواجهنا، خاصة في عصر الإنسان الرقمي والذكاء الصناعي، فما يجب البدء به هو دراسة تراث القدماء، لا بتمجيده والحنين إليه، بل بالوقوف على الهفوات والأخطاء المنهجية واستبعادها، ثم دراسة تراث الحداثة خاصة جانبها العلمي والفلسفي المنطقي، من أجل الكشف عن منطق تطور الأفكار، حيث يكون الانتقال من فكرة لأخرى انتقالًا مشروعًا، ثم السعي إلى الوقوف على المبادئ الإبستمولوجية التي جعلت الفكر المنطقي والعلمي يحرز تقدمه؛ وذلك لأجل العودة إلى التراث الفكري والفقهي الشرعي، لإصلاح مبادئه ومناهجه التي قام عليها.
إن هذه المحاولة المنهجية ستحرك الأفكار الثابتة، وتقف على العوائق الإبستمولوجية، وتحل إشكاليات الوجود الإنساني وتكسبه إمكانية النظر في الأبعاد الإنسانية المتغيرة خاصة في ظل عصر الذكاء الصناعي والإنسان الرقمي.
قائمة المصادر والمراجع بالعربية:
- الباهي حسان، الذكاء الصناعي وتحديات مجتمع المعرفة "حنكة الآلة أمام حنكة العقل"، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء (المغرب)، ط1.
- أبو الوليد بن رشد، فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال أو وجوب النظر العقلي وحدود التأويل (الدين والمجتمع)، تحقيق: محمد عابد الجابري، مركز دراسات الوحدة العربية، 1997، بيروت (لبنان) ط1.
- مارتن هيدغر: نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، ترجمه عن الألمانية: وعد علي الرحية، تقديم ومراجعة: علي محمد إسبر، دار التكوين للتأليف والطباعة والنشر، دمشق (سوريا)، 2016، ط1.
- يورغن هابرماس، التقنية والعلم كإيديولوجيا، ترجمة إلياس حاجوج، منشورات وزارة الثقافة، دمشق (سوريا)، 1999، ط1.
قائمة المصادر والمراجع بالفرنسية:
- BLAISE PASCAL, Les Pensées, préface et introduction de Léon Brunschvicg, (1972), librairie générale française, paris.
- DANIEL COHEN, Homo-numericus: La "civilisation" qui vient, (2022), Éditions: Albin Michel, Paris, (France).
- Encyclopédie philosophique universelle, L'univers philosophique (1980): Volume dirigé par André Jacob, Paris, Presse Universitaire de France, 3 édition.
- MARTIN HEIDEGGER: CHEMINS qui ne mènent nulle part, traduit de l’allemand par Wolfgang Brokmeier,(1962), éditions Gallimard.
* لقد ظهر مفهوم الذات كمشكل فلسفي خلال العصر الحديث؛ بعدما ميز "روني ديكارت" بين الجوهر المفكر والجوهر الممتد؛ وقد أتى ذلك لأجل نزع الطابع السحري عن العالم؛ وإنقاذ المادة من الفكر والفكر من المادة؛ فالمادة لا يمكن لها أن تكون فكرة؛ بل هي مجرد مادة؛ ونفس الشيء بالنسبة للفكر الذي تحرر من المادة فأضحى فكرا خالصا موجودا في عالمه الموضوعي؛ وهذا الفصل بين الجوهر المفكر والجوهر الممتد رسم التاريخ الإشكالي للفلسفة الحديثة من جهة؛ وتم رد الاعتبار للإنسان كذات مفكرة وممتدة في نفس الآن وهذا ما يجعل الإنسان متفوقا عن باقي الموجودات الأخرى التي ينحصر وجودها إما في الفكر الخالص؛ أو في المادة الخالصة؛ وعليه فما دام الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يجتمع فيه الفكر والامتداد؛ فما على "ديكارت" إلا التسليم بكون الإنسان معجزة إلهية؛ وهذه النتيجة الميتافيزيقية التي توصل إليه ديكارت كانت منطلقا للفكر الفلسفي الحديث خاصة مع "جون لوك"؛ الذي استهل بحثه في الفهم البشري انطلاقا من فحص شرعية الأفكار الفطرية الديكارتية؛ لبيين تهافتها وضعفها باعتبارها أفكارا ذات نزعة تبريرة وغير مبررة؛ تنزع الشرعية عن مصدرها التجريبي الحقيقي؛ فالأفكار لا تكون في الذهن بشكل اعتباطي وفطري؛ بل إن مصدرها خارجي أساسه التجربة؛ في شقيها الخارجي (إحساسات) والداخلي (انعكاسات الأفكار وترابطها)؛ وهذا ما منح الشرعية لإمكانية ظهور مفهوم الذات الإنسانية باعتبارها ذات مفكرة وواعية ومدركة لهويتها الجوهرية؛ ومسؤولة عن أفعالها وأفكارها. لكن؛ كيف تفكر هذه الذات وتدرك الموضوع؟ وكيف تنتظم الأفكار في الذهن لتصير المعرفة ممكنة؟ هذا ما سيجب عنه "إيمانويل كانط" في نفد العقل الخالص.
* ألان تورنغ Alan Turing: (1912-1954)؛ هو عالم الرياضيات والمنطقيات؛ اشتهر بأبحاثه الفكرية المتعلقة بعلم الحاسوب وتحليل الشفرات؛ وقد قدم صياغة نظرية لمفهوم الخوارزمية والحوسبة؛ باستخدام آلة تورنغ التي اخترعها سنة: 1936م؛ حيث يُمكن اعتبارها من بينِ النماذج الأولى للحواسيب الذكية؛ ويُنظر إلى تورنغ على أنه «أبو علوم الكمبيوتر النظريّة والذكاء الاصطناعي».
[1] DANIEL COHEN, Homo-numericus: La "civilisation" qui vient, (2022), Éditions: Albin Michel, Paris, (France), p: 46
[2] الباهي حسان؛ الذكاء الصناعي وتحديات مجتمع المعرفة "حنكة الآلة أمام حنكة العقل"؛ أفريقيا الشرق؛ الدار البيضاء/ المغرب؛ ط1؛ ص: 09
[3] المرجع نفسه؛ ص: 09
* ظهر مشروع لغة الفكر الخالص مع غولتوب فريجه بعد أن واجه إشكالية المعنى والإحالة في اللغة الطبيعية العادية؛ ليتوصل إلى ضرورة بناء لغة صورية للفكر تتميز بالدقة المنطقية في الاستدلال وتكتسب شرعيتها من علم الحساب؛ بحيث تعبر عن قضاياها بطريقة رياضية منطقية ودقيقة وقد أطلق عليها اسم: الإديوغرافيا Idéographie.
* يميز فريجه بين الإحالة في اسم العلم وهي شيء؛ والتمثل الذاتي الذي يتعلق به؛ والمعنى الذي يقع بينهما؛ ولتوضيح الأمر يعقد مقارنة بين صورة القمر على شاشة المنظار وصورة القمر على شبكية العين المجردة والقمر نفسه؛ فالقمر بمثابة الإحالة والصورة الحقيقية المرتسمة على عدسة المنظار هي المعنى؛ وأخيرا الصورة في شبكية عين الملاحظ التي تلعب دور التمثل والحدس. وعليه ثمة ثلاثة عوالم: عالم التمثلات والحدس وهو ذاتي؛ وعالم الأشياء؛ وعالم المعاني والأفكار وهو موضوعي ومشترك بين جميع الأفراد؛ ولقد تطور هذا العالم الثالث المثالي إلى العلوم المعرفية حيث وجد فيه المناطقة والرياضيون إمكانية حل أي معادلة رياضية وأي قضية منطقية إلى التمكن من بناء عالم افتراضي وجد صداه في عصرنا الحالي؛ عصر الذكاء الصناعي والإنسان الرقمي.
* وهنا ستأتي مساهمة برتراند راسل الذي سيجعل المنطق أساسا لكل عملية رياضية وسيطور الرياضيات في محاولة منه لتوخي الدقة المنطقية. لقد أتى ذلك المشروع لإنقاذ الرياضيات من أزمة الأسس التي عرفتها خلال القرن التاسع عشر.
[4] المرجع نفسه؛ ص: 233
[5] يورغن هابرماس؛ التقنية والعلم كإيديولوجيا؛ ترجمة إلياس حاجوج؛ منشورات وزارة الثقافة؛ دمشق/ سوريا؛ 1999؛ ص: 05
[6] أبو الوليد ابن رشد؛ فصل المقال في تقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال أو وجوب النظر العقلي وحدود التأويل (الدين والمجتمع)؛ تحقيق: محمد عابد الجابري؛ مركز دراسات الوحدة العربية؛ بيروت (لبنان) 1997؛ ط1؛ ص: 92
[7] المرجع نفسه؛ ص: 88
[8] Encyclopédie philosophique universelle, L'univers philosophique (1980): Volume dirigé par André Jacob, Paris, Presse Universitaire de France, 3 édition, p: 746
[9] Ibid. p: 746
[10] Ibid. p: 746
[11] Ibid. p: 746
[12] Ibid. p: 746
[13] Ibid. p: 746
[14] Ibid. p: 746
[15] Ibid. p: 746
* في اعتقاد المسيحين هناك خطيئة أولى ارتكبها الانسان الأول (آدام)؛ ونتج عنها طرده من الجنة؛ وفي سياق هذا الاقتباس؛ فإن الخطيئة الأولى قد جعلت الإنسان قاصرا في البحث عن المسائل المتعلقة باللاهوت خاصة المواضيع الإلهية؛ أو ما يصدر عنها؛ أي ما صدق به الأنبياء والرسل؛ فالقول بعجز الإنسان عن بالحت في ذلك هو قول يضع حدودا للمعرفة الإنسانية في المسائل اللاهوتية.
[16] MARTIN HEIDEGGER: CHEMINS qui ne mènent nulle part, traduit de l’allemand par Wolfgang Brokmeier,(1962), éditions Gallimard. p: 154
[17] مارتن هيدغر: نهاية الفلسفة ومهمة التفكير؛ ترجمه عن الألمانية: وعد علي الرحية؛ تقديم ومراجعة: علي محمد إسبر؛ دار التكوين للتأليف والطباعة والنشر؛ دمشق (سوريا)؛ 2016؛ ط1. ص: 51؛ 52.
[18] BLAISE PASCAL, Les Pensées, préface et introduction de Léon Brunschvicg, (1972), librairie générale française, paris. p: 85.