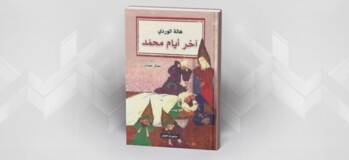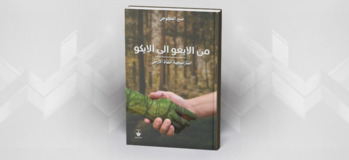قراءة تلخيصيَّة لكتاب: "القِيَم في فلسفة ماكس شِلر"، وفاء عبد الحليم
فئة : قراءات في كتب

قراءة تلخيصيَّة لكتاب: "القِيَم في فلسفة ماكس شِلر"، وفاء عبد الحليم
بطاقة الكتاب:
اسم الكتاب: القيم في فلسفة ماكس شيلر.
اسم المؤلف: د. وفاء عبد الحليم محمود.
تصدير: د. محمد مجدي الجزيري.
الناشر: دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.
رقم الطبعة: ط1، 2015
عدد صفحات الكتاب: 493 صفحةً تتضمن الفهرس والمقدمات والمراجع.
يقع الكتاب في ثمانية فصول يسبقها تمهيدٌ. يتضمن كلُّ فصلٍ تعقيبًا ومناقشةً للمؤلفة.
فصول الكتاب كالتالي:
الفصل الأول: حياة شلر ومؤلفاته واختلاف الآراء حوله.
الفصل الثاني: الفينومينولوجيا عند شلر.
الفصل الثالث: مكانة القيم في فكر شلر.
الفصل الرابع: نقد شلر لنظريات القيمة.
الفصل الخامس: أنواع القيم ومعايير التفضيل.
الفصل السادس: الترتيب الهرمي للقيم وتصنيفها.
الفصل السابع: الرؤية اللاصورية للأخلاق عند شلر.
الفصل الثامن: أبعاد التجربة الأخلاقية والدين.
التمهيد[1]
تتساءل المؤلفة بدايةً عن سبب اختيارها لموضوع القيَم والقيمة الأخلاقية بوجهٍ عام، حيث ترى أن الإنسان منذ بداياتِه الأولى، وهو يحاول التعرُّف على نفسه وعلى مغزى وجوده في العالم. الإنسان هو المخلوق العاقل القادر على خلق الرموز والتعامل معها. يتعامل الإنسانُ مع نفسه وغيره من منطلقات أخلاقية قِيَميَّة. وعلى هذا، يصح القول إنه كائن أخلاقي؛ ذلك أنه القادر وَحْدَهُ على السلوك وفقًا لمجموعة من القِيَم والمعايير الحاكمة. وتُعَدّ دراسةُ القِيَم، وفقًا لهذا، ضرورة مُلحة مستمرة باستمرار الوجود الإنساني نفسه. ولا غروَ، والحاجة إلى قِيم كالجمال والخير والحق تتزايد في عصر ماديّ يُشَيِّئ كل ما حوله.
يقع اختيارُ عبد الحليم على ماكس شلر لأسباب:
1- مجيئه نهاية القرن التاسع عشر، حيث يسود القولُ بالنسبية القِيَمِيَّة.
2- يحتلُّ مبحث القيم مكانةً عُظمَى في فلسفته كما يؤكد دارسوه.
3- محاولة شلر تخليص العقلية الألمانية من صورية كانط.
4- احتياج المكتبة العربية إلى دراسة مستقلة حول هذا الفيلسوف.
5- اختلاف وجهات النظر حول شلر وتضاربها.
تتبع المؤلفة في دراسة شلر المنهج التحليلي النقدي، فتعرض أفكار الرجل بأمانةٍ، ومن ثم تحاول التعقيب عليها بالنقد والمناقشة قبولًا ورفضًا.
1. حياة شلر ومؤلفاته واختلاف الآراء حوله[2]
وُلد ماكس شلر Max Scheler (1874- 1928) في ميونخ Munich الألمانية لعائلة بروتستانتية وأم يهودية. ولعل هذا سر التوترات في شخصيته وأعماله. ولعله يمكن التمييز بين ثلاث مراحل من حياته: (1) المرحلة قبل الفينومينولوجية والفينومينولوجية (الشباب). (2) المرحلة الكاثوليكية (النضج). (3) المرحلة الميتافيزيقية (وحدة الوجود). تأثر شلر، في المرحلة الأولى، بفلسفة الحياة عند برجسون Bergson (1859-1941) ودلتاي Dilthey (1833-1911) وغيرهما، وبالمثالية الألمانية عند كانط Kant (1724-1804) وهوسرل Husserl (1859-1938)، وبالمسيحية الفلسفية عند أوغسطين (354-430). وفي المرحلة الثانية، قام شلر بإعداد أعماله الفينومينولوجية. وبنشوء الحرب العالمية، أصبح مدافعًا عن انغماس ألمانيا في الحرب، إلا أنه تأثر بعد ذلك بالموقف المسيحي الرافض للحرب، فكرهها وارتمى في أحضان الدين. يمكن القول إنه كان في هذه المرحلة مؤمنًا بالله ومؤلِّهًا يؤمن بفكرة الإله الشخصي على المذهب الكاثوليكي. أما المرحلة الثالثة، فكان بدؤها قبل وفاته بثلاث سنوات. ابتعد فيها عن الفكر الكاثوليكي، وقال بفكرة وحدة الوجود. وكان قوله بوحدة الوجود متفائلًا؛ لا يشبه الفكرةَ كما ظهرت عند سبينوزا. نظر شلر، في هذه المرحلة، إلى تطور تاريخ العالم على أنه تَقَدُّمٌ من الدوافع الحيوية العمياء اللامنطقية المُتَّجِه نحو تحقيق المصير الإنساني في عوالم القيمة والوجود الروحي. تعني هذه العملية تجسُّد القوة المقدسة أو تحقق الإله داخل العالم.
وإذا انتقلنا إلى الحديث عن أهم مؤلفاته، فإن شلر ترك أحد عشر كتابًا وعددًا ملحوظًا من الدراسات والمقالات. من أهم هذه المؤلفات: طبيعة التعاطف The Nature of Sympathy (1913)، الصورية في الأخلاق والأخلاق اللاصورية للقيم Formalism in Ethics and Non-formal Ethics of Values (1913-1916)، المركزية الإنسانية في الكون The Human Place in the Cosmos (1928)، وغير ذلك. تُنبِّه الباحثة إلى أن ترجمات ماكس شلر الإنجليزية جاءت متأخرةً ومضطربةً لسببين هما: (1) غموض فلسفته وصعوبة أسلوبه؛ و(2) أخطاء الترجمات.
اختُلف في ماكس شلر اختلافًا عظيمًا: عدّه البعضُ أكبر عقلية فلسفية في الفكر المعاصر، كما عده آخرون شخصية لا تستحق الدراسة لأنه يحاول التأسيس لفلسفةٍ فاشلةٍ ومضطربة.
2. الفينومينولوجيا عند شلر[3]
الفينومينولجيا Phenomenology كلمة مشتقة من اليونانية. تتكون من مقطعين هما: Phenomen وLogos. تعني الأولى "ظاهرة"، والثانية: "علم". وعلى هذا، فهي: علم الظواهر. تُعرِّف الباحثة الفينومينولجيا بأنها: "دراسة الطريقة التي يُدرك الوعيُ بها الأشياءَ وإن كان الوعيُ بها متغيِّرًا".
رأى هوسرل أن الفينومينولجيا يمكن عدُّها علمًا لا بالمعنى المألوف للعلم، وإنما بمعنى أنها تُمَكِّنُنَا من المعرفة الموضوعية للأشياء وفق الخبرة الذاتية للأفراد. الفينومينولجيا، وفقًا لهذا، محاولةٌ وصفية لمجالٍ محايِد هو الواقع المُعاش الذي تتمثل فيه الماهياتُ. ما يميز الفينومينولجيا فكرةَ "القصدية Intentionality" التي تعني الوعيَ بالشيء والتوجه إليه بغض النظر عن الوجود الفعلي لهذا الشيء، فهي قدرة العقل الإنساني على الإشارة إلى الأشياء المحتوية على "صورة" خارج ذاته.
يعتمد المنهج الفينومينولجي، عند هوسرل، على الوعي الإنساني الذي يواجه الواقع بصفةٍ قصديةٍ. يقتصر دورها على ما هو مُدرَك وظاهر قُدَّامَنا. وعند الانتهاء من الوعي بقصديَّةٍ، فإنه ينتقل إلى "تعليق الحكم" من خلال الاحتفاظ بصورة الشيء في لحظةٍ مارَّةٍ. وبعد الانتهاء من عملية "التعليق" وعدم الحُكْمِ والبَتِّ، يمكن للشيء أن يظهر أمامنا كماهيةٍ جوهرية طيِّعةٍ للإدراك والفهم.
أخذ شلر المنهج الفينومينولجي عن هوسرل قُدُمًا وحاول تطبيقه في ميادين متعددة. كان مأخوذًا في هذا بفكرة النظر في الأشياء كما تظهر في الوعي بقصديةٍ على ما هي عليه من تكوين ماهويّ. وعلى هذا، يمكن القول إن شلر هو المطور الحقيقي لهذا المنهج والمُطبِّق الأول له، بينما كان هوسرل منهمكًا في التنظير للمنهج الجديد؛ قام شلر بتطبيقه وإنزاله ساحاتٍ ميدانيةٍ جديدة. لعل هذه المحاولة التطبيقية هي التي حَدَتْ بشلر إلى رفض بعض أجزاء فينومينولجية هوسرل. طبق شلر المنهج على مجال القِيَم كما طبقه في مجالات اجتماعية ودينية متعددة.
من أهم الاختلافات بين هوسرل وشلر أن الأول كان مهتمًّا بالطابع المنهجي لكتاباته؛ بينما كان الثاني مهتمًّا بالعملية التطبيقية. رأى الأول الفينومينولجيا علمًا؛ بينما رآها الثاني فلسفةً مضيئة يمكن استعمالها في استكشاف مناطات وسياقاتٍ فكرية جديدة. وبينما كان الأول يرى ضرورة تعليق الحكم على الظاهرة؛ رأى الثاني ضرورة القيام بعمليه عزل لها وسلبٍ عن واقعها. قام شلر بالاستطراد في المنهج واضعًا بعض العناصر الضروريةِ إليه؛ كالتفريق بين الخطأ والتوهم؛ والتفريق بين الوقائع بتقسيمها إلى: (1) فينومينولجية، و(2) طبيعية؛ وكتقسيمه الفينومينولجيا إلى: (1) وصفية، و(2) ماهوية؛ وإضافةِ نظرية جديدة في الواقع بالنظر إليه على أنه مُقاوَمة. وعلى هذا، كانت الفينومينولجيا عند شلر بمثابة محاولة تطبيقية منسجمة ومتناسقة للانتقال من الرموز إلى الظاهرة، ومن العلم التصوري إلى حياة يمكن اختبارُها، ومعايشتُها، وفهمها حدسيًّا وعاطفيًّا.
3. مكانة القيم في فكر شلر[4]
يرتبط معنى الفلسفة عند شلر بالقيم ارتباطًا وثيقًا؛ ذلك أنه يرى عملية التفلسف عبارة عن استعراضٍ فردانيِّ الذاتيَّةِ لفكر المُتفلسِف؛ نتيجةَ شعور مُعيَّن ينتابه. الذي يعنيه بهذا أن المرء، مهما حاول الحَيْدَةَ، أسيرُ أفكارِه ومشاعرِه الذاتيَّة. الفلسفة، وفقًا لهذا، معرفة تلقائية تتحرر من الافتراضات المُسبَقة وإن كانت محتاجةً إلى ذاتيةٍ شخصيةٍ ذات طبيعة أخلاقية. الفعل الفلسفي، عند شلر، تفرضه محبة المعرفة، ومحبة مشاركة هذه المعرفة مع الأغيار، ومحبة الوجود المُوجَّه بالتعرُّف القصديِّ. ولهذا، كانت للميتافيزيقا مكانةٌ ساميةٌ في فكره. نظر شلر إلى الوجود على أنه صيرورة مستمرة؛ ذلك أن كل شيء في حركةٍ دؤوبة لا تتوقَّف. أجلى ما يُميِّز الوجود أنه ذو صراع ومقاومة. الصراع والمقاومة هما ما يحققان عالمًا حقيقيًّا من الممكن معرفتُه. ولعل السرَّ في اهتمامه بالميتافيزيقا أنها متعلقة بالله الذي هو أسمى القِيَم وأعلاها بصفته المطلقة.
ترتكز فلسفة شلر على القيم والأخلاق أساسًا. يفرق شلر، في سياق دراسته إياهما، بين المعرفة والإدراك. المعرفة أعم من الإدراك وأشمل؛ ذلك أن الإدراك يشير إلى وجود شيء ما يمكن إدراكُه. أما المعرفة، فإنها مشاركةٌ علائقية بين الوجود المُحقَّق والذات العارفة. وهنا يطرح شلر رأيه الذي يمازج بين العالم الخارجي (الظاهري) والعالم الداخلي (العقلي)، فيرى أن العالم الخارجي ما هو إلا مجال ينتج عن عمليات العقل الداخلية أو الباطِنَة.
ولأن القِيَم مرتبطة بالحياة الاجتماعية؛ كان لشلر حديثٌ حول سوسيولوجيا القيم يطول ويقصر. مكَّنه هذا البحثُ من الوصولِ إلى فكرته حول التقاء الشرق بالغرب، وميلاد الإنسان العالَمي، مُوجِّهًا في ذلك نقدًا حثيثًا للحضارة الغربية المعاصرة المُشَيِّئَة للإنسان، والمجانِبة للروح. وفي محاولة شلر التأسيس لإنسانه العالمي القِيَمِيّ صاحب الأخلاق العالمية الشاملة، كان ذا نزعة تفاؤلية بعيدة عن التشاؤم الملموس لدى فلاسفةٍ غيره.
4. نقد شلر لنظريات القيمة[5]
اختلف الفلاسفةُ في المراد من القيمة اختلافًا شديدًا، فهناك القائلون بـ (1) الأكسيولوجيا الاسمية؛ والقائلون بـ (2) الأكسيولوجيا الصورية؛ والقائلون بـ (3) الأكسيولوجيا النسبية؛ والقائلون بـ (4) الأكسيولوجيا الوضعية. يرى أصحاب المذهب الاسمي أن الكليات لا وجودَ مستقلَّ لها كما يرى أفلاطون. هذه الكليات ما هي إلا المسميات الجزئية عند تجريدها من المعنى. وعلى هذا، ينكر أصحابُها الكليات المُعبِّرة عن القيم كـ "حسن" و"جميل"... إلخ. ويرى أصحاب المذهب الصوريّ أن القيم مرتكزة على ما أسموه "أخلاق الواجب"، فالواجب هو ما ينبغي فعله، وهو ما يمليه ضميرُ الشخصِ العاقلِ. ويرى أصحاب المذهب النسبي أن القِيم تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان، فهي ليست ثابتة؛ إذ يعتريها التغيُّر والتبدُّل من حين إلى آخر. ويرى أصحاب المذهب الوضعيّ أن القيم ما هي إلا أمور واقعية يُجريها الإنسان حسب مُجريات الواقع، فإذا تغيَّر تغيرتْ معه القيم وتبدَّلَتْ (ينتهي المذهب الوضعي إلى نفسه النتيجة التي ينتهي إليها المذهبُ النسبي).
يوجِّه شلر سهام نقده لهذه المذاهب جميعًا، وكانت لصورية كانط وأخلاق الواجب حصة الأسدِ في هذا النقد. يرى شلر أن كانط كان متطرِّفًا في صوريته، وهو يعرض لأخلاق الواجب، وحاول تخليص الفلسفة من صوريته. تساءل شلر عن كيفية معرفة الأولي الأخلاقي. كان كانط يرى أن الواجب والوعي بالقانون الأخلاقيّ سابق على القيمة، بينما رأى شلر العكس؛ أن القيمة سابقة على الواجب، وأنها الأساس الذي ينبني عليه الواجبُ والقانونُ. أخلاق شلر، وفقًا لهذا، أخلاق أولية موضوعية لا أساس إمبريقي لها. وكما ذكرنا، حاول شلر في نقده لكانط تخليص الفلسفة الألمانية من صورية كانط المسيطرة، إلا أن الناقدين والمقيِّمين يختلفون حول مدى نجاحه وإخفاقه في إمضاءِ هذا التخليص.
5- أنواع القيم ومعايير التفضيل[6]
ترى الباحثةُ أنّ الأخلاقيات التي قدمها شلر لعلَّها أفضل أخلاقيَّاتٍ وُضِعَتْ بعد كانط. ينطلق شلر، كما أسلفنا، من نقده للنظريات الأخلاقية السابقة عليه، ومن ثم محاولة تحديد ما هو أوليٌّ أخلاقيًّا؛ ذلك أن موقف شلر موقف فينومينولوجي في الأساس، فالقيمة، عند حدس الماهية، لا يمكن أن تُعرَف إلا قبليًّا. يُعرِّف شلر القِيم على هذا الأساس، ويرى أنها أُسُسٌ أوليَّة للعاطفة الإنسانية تتعلق بالشعور وموضوعاته القصدية. يعالج شلر القيم من وعيٍ موضوعيٍّ قائم على فكرة الرفضِ والقبول أو التعارض؛ فمعنى قبول قيمة هو معارضة ما يخالفها. ومعنى أوليَّة القِيم في الشعور المتعلق بموضوعات قصدية أن القيمَ كيفياتٌ مُعطَاةٌ في التجربة المباشرة للوجدان الذي يدرك جمالية شيءٍ أو شجاعةَ سلوكٍ على سبيل المثال. عالم القِيم، بهذا المعنى، عالم ثابت خالد يظهر تاريخيًّا في كل مجتمع من منظور زماني ومكاني محدَّد؛ إذ معنى اختلافِ القيمةِ اختلافُ المناظير التي تتناولها تاريخيًّا لا بسبب أنها متغيرةُ الذاتِ، وهذا فحوى ديناميكيتها.
ولهذا السبب، حاول شلر أن يحدد بدايةً أوليةً أساسيةً للقيم، ورأى أنها لا بد أن تندرج تحت مجموعتين: إما (1) إيجابية؛ وإما (2) سلبية. الصواب القِيَمِيّ كامن في المجموعة الإيجابية، والخطأ القِيَمِيّ كامن في المجموعة السلبية. كما قام شلر بتقسيم القِيَم إلى: (2) عليا؛ و(3) دنيا. العُليا قيم قريبة إلى المطلقات، والدنيا قريبة إلى النسبيات؛ ذلك أن القيم واقعةٌ لديه في هرمية ترتُّبية من الأعلى إلى الأدنى. يتساءل شلر: كيف تُدرَك القيم؟ لا يرى أنها ممكنة الإدراك بالاستقراءِ، وإنما ينبغي إدراكها مثاليًّا وقبليًّا. الجمال، على سبيل المثال، لا يمكن استخلاصُه باستقراء الجميل، وإنما يمكن إدراكه بالمثالِ الجماليِّ السابقِ كلَّ ما هو جميل. القيم، بهذا المعنى، تُدرَك بالشعور القبليّ الذي يمكنه التعرف على القيمةِ ببلوغ ذواتها المُعطاة قصديًّا.
معيار تفضيل قيمة على أخرى، وفقًا لهذا، هو الحبّ والبغض الحادثان من خلال حدسٍ عاطفيّ أوليّ أو قبلي مُعطًى. الحب والبغض أفعال تلقائية تصدر عن الإنسان عند الإدراك الوجداني للأشياءِ قبليًّا. العاطفة لها دورها الأساسُ في إدراك القيمة واكتشافها عند شلر، فوجود القيمة وجودٌ موضوعي يتطلب من الإنسان اكتشافه لا اختراعه؛ يتطلب منه الوقوف في حياضه واستجلاؤه لا إقامته؛ ذلك أن القيم لها خواصها الذاتية في الأشياءِ التي نستحسنها بالشعور القصدي أو نستقبحها. وبهذا المعنى، يختلف الاختيار عن التفضيل؛ ذلك أن الاختيار ليس قبليًّا بل بعديًّا. أما التفضيل، فهو قبلي وأولي: يمكن تفضيل الورد على القرنفل دون التفكير في اختيار ما. وعلى هذا، فوجود القيمة يفترض وجود طَرَفَيْنِ، لا وجود لأحدهما دون الآخر، لأن القيمة لا وجود لها دون فعل التقييم. ونظرًا لأن القيمة ذات خواصّ وترتُّب من أعلى إلى أدنى، فإنَّ معايير تقييمها كالتالي: (1) ديمومتها مدةً أطول؛ و(2) قابليتها للانقسام والتشاركية بين مُدركيها؛ و(3) تأسُّس بعضها على بعض؛ و(4) وعُمق إشباعها للوجدان الإنساني الذي يدركها؛ و(5) نسبيتها تاريخيًّا وفقًا لوجودها الزماني والمكاني عند أشخاص معيَّنين أو مجموعات بعينها.
6. الترتيب الهرمي للقيم وتصنيفها[7]
رأينا أن شلر يُرتِّب القِيَم ترتيبًا هرميًّا؛ ذلك أن القيم كمحمول مستقلة عن حاملها، وأنها تُكتَشف بالحدس العاطفيّ الذي يُدركها في تسلسل من تسلسلاتها. ما هي مراتبُ القيم لدى شلر إذًا؟ يرى شلر أن هناك نظامين مختلفين لمراتب القيم: (1) النظام الصوري، و(2) النظام اللاصوري. النظام الصوري يرتب القيم وفقَ حامِلِيهَا. أما النظام اللاصوري الذي يتبناه شلر، فإنه يرتب القيم وفق القيم ذاتها المترتب بعضها فوق بعض. القيم، بهذا المعنى، يتصل بعضُها ببعضٍ وتستقل استقلالًا ذاتيًّا عن حامليها.
يرتب شلر القيم في خمس مراتب أوليَّة من الأدنى إلى الأعلى على هذا الترتيب: (1) القيم الحسية. (2) القيم المنفعية. (3) القيم البيولوجية. (4) القيم الروحية. (5) القيم المقدَّسة. القيم الحسية تتعلق بكل ما يجلب اللذةَ أو الألم. القيم المنفعية تتعلق بكل ما يُفيد وما يضرّ (يدمج شلر المرتبة الأولى بالثانية أحيانًا). القيم البيولوجية تتعلق بالصحة والمرض، والقوة والضعف، وغير ذلك من أحوال بيولوجية. القيم الروحية تتعلق بأنماط ثلاثة: (1) الجميل والعادل؛ و(2) القيم الثقافية؛ و(3) قيم الإدراك المحض للحقيقة. والقيم المقدسة تتعلق بالمطلق الذي يتراوح هو الآخر ترتيبيًّا بين المقدَّس وغير المقدَّس. لا يكتفي شلر ببيان مراتب القيمة في ذاتها، وإنما يُبِينُ عن مراتب الأشخاص وفقًا لهرمية القيم، فهناك (من الأعلى إلى الأدنى) (1) القديس و(2) العبقريّ في قمة المراتبِ لتمثيلهما للقيم الروحية، والمقدسة. وهناك (3) البطل الذي يمثل القيم البيولوجية والمنفعية. وهناك (4) الفنان الحسي الذي يمثل القيم الحسية بتدرجاتها.
7- الرؤية اللاصورية للأخلاق[8]
حاول شلر في فلسفته القيمية تخليص الفلسفة عمومًا، والفلسفة الألمانية خصوصًا من صورية كانط، وإقامة القيم على أساس موضوعيّ مستقلّ غير صوريّ. وهو في هذا متسق مع فلسفته الفينومينولوجية القائلة بالقبلية والأولية القيمية. الأخلاق، بهذا المعنى، نابعةٌ عن خبرةٍ فينومينولوجية لها علاقة بالفعل الوجداني الشعوري والقلبي.
ربط كانط بين القيم والأغراض التي نسعى إلى تحقيقها، فالقيم لديه تالية على هذه الأغراض المرادة، بينما رأى شلر أن القيم سابقة على الأغراض؛ فالأغراض لا بد أن تتحقق بغض النظر عن الإرادات، فالقيم أولية سابقة على كل غرضٍ ممكن. ولهذا، يُفرِّق شلر بين الشعور وحالات الشعور. الشعور هو الكشف عن قيمة موجودة أصلًا؛ أما حالات الشعور فتعني حضور قيمةٍ ما وفق حالاتٍ وقائعية محدَّدة. استطاع شلر بهذا التفريقِ تثبيتَ قوله باستقلالية القيم، وعدم إمكان ردِّها إلى شيء آخر غير ذاتها كالنفس، أو الأنا، أو الضمير، أو غير ذلك.
يمكن القول، وفقًا لهذا، إن شلر استطاع إقامة بنيانٍ موضوعي (لا صوري) للقيم يتنكَّر كلَّ التنكُّر لصورية كانط. الأخلاق، بهذا المعنى، قائمة على القيم الموضوعية المستقلة عن الأحكام الإنسانية الذاتية، على عكس الأخلاق الكانطية التي تقوم على صورية خالية من الموضوع أو المحتوى القِيَمِيِّ. ينتهي شلر إلى أن الأخلاق غير ممكنة إلا من خلال الكشف الشعوري القصدي عن القيم العُليا المستقلة وغير الصورية، وإدراك درجات القيم وفق ترتيبها الهرمي.
8- أبعاد التجربة الأخلاقية والدين[9]
ينظر شلر إذن إلى القيم نظرة موضوعية لا صورية، لكنَّ الوعيَ بالأشياءِ والعالَمِ الخارجيِّ والآخرين يُعد ردَّ فعل إنساني لحوادث الواقعيات والذوات الحيَّة داخل هذا العالَم. ومن هنا كان حديثُ شلر عن تجربةٍ أخلاقيةٍ ودينيةٍ للإنسانِ بصفته موجودًا داخل العالَم المُعاش.
يفرِّق شلر بين نوعين من التجربة: (1) التجربة الأخلاقية؛ و(2) التجربة الوجدانية. التجربة الأخلاقية مزيج من الانفعال والامتثال العقلي الذي نُدرك به عالم القِيَم. أما التجربة الوجدانية، فهي تجربة مباشرة تُعد نوعًا من الانفعال العاطفي والشعوريّ المحض الذي نُدرك به القيمةَ في كليَّتها كعالَم مستقل، وكوجود مُتراتبٍ.
نأتي الآن إلى الحديث عن النوع الأول من التجربة (التجربة الأخلاقية). يرى شلر أنَّ التجربة الأخلاقية تجربةٌ ذات أبعاد أربعة: (1) البُعد الاتصالي بين الذوات. (2) البُعد العاطفي الفعلي. (3) بُعد المحبة الوجداني. (4) البُعد التفضيلي. يُعنَى البُعد الأول (الاتصال بين الذوات) بإدراك الذوات الإنسانية بعضها بعضًا. يبحث شلر الروابط النفسية الذاتية للخبرة الفينومينولوجية المعنية بتوحيد الأشخاص واتصال بعضهم ببعض؛ ذلك أن هذه الروابط النفسية وما ينبع عنها من تعاطف مُتبادَل هو أساس العلاقة التواصُليَّة بين الأشخاص. أما البعد الثاني (أفعال العاطفة)، فيمنحه شلر أهمية خاصة؛ ذلك أنه أراد إعادة اعتبارها مرةً أخرى من بعد إقصائها على يد كانط ومن تابَعَه. يطبق شلر منهجه الفينومينولوجي على الحياة العاطفية في محاولةٍ منه لتجسير الهُوَّة الواسعة بين العقل والعاطفة، أو بين الاتجاه الإدراكي المتطرف والاتجاه العاطفي المتطرف. يرى هيك أن الحدس العاطفي أو الوجداني هو الوسيلة المؤدية إلى إدراك القيم. هذا الحدس العاطفي ينبغي أن يكون تلقائيًّا، وأوليًّا مِعْرافيًّا cognitive، لا حدثًا عشوائيًّا أعمى ينبغي وضعُه في نظام كالواجب مثلما ارتأى كانط. ولهذا سُمِّي مذهب شلر الفينومينولوجي بـ "العاطفة العارفة". يُعدّ البعد الثالث (المحبة) امتداد لنظريته القِيَمِيَّة المتعلقة بالتواصل بين الذوات. ذلك أنه ما من شيء إلا والمحبة تتخلَّله، فلا نستطيع تناول شيء أو إدراكه إلا بنزوع مُحِب إليه. المحبة هي التي تساعد على خروج الأنا من إنِّيتِها إلى غيريتها، ومن شأنها إدراك القيمة الإيجابية أو السلبية في المحبوب، والعمل على انبثاق القيمة العُليا للموضوع محلّ القصد. تكشف المحبةُ، بهذا المعنى، القيم الذاتية الخاصة للمحبوب دون ربط المحبة بالانفعالات والدوافع، ودون القول إنها نزوع مادي أعمى. يتعلق البعد الرابع (التفضيل) بعملية تفضيل قيمة على أخرى، ومعادلة قيمة بأختها. يُعد التفضيل، بهذا المعنى، خاضعًا للبعد النظاميّ الثالث (المحبة)؛ لأنه يتعلق بعملية يتجاذبها الجذبُ والنفور؛ ذلك أن الأشياء محل القصد يمكنها جذبُ الإنسان إليها، ويمكنها تنفيره منها. وعلى هذا، فإن عملية التفضيل الإنسانية متعلقة بقدرة الإنسانِ على الوصول إلى نظام المحبة الكامن في أصل الأشياء التي تعلن عن نفسها بما تحويه من جذب وتنفير.
البعد الرابع من التجربة الأخلاقية (المحبة) هو أساسُ فلسفة شلر الميتافيزيقية؛ ذلك أن المحبة الإلهية هي أسمى صور المحبة. الله بصفته إلهًا مُشخَّصًا يُحب موجوداته، والإنسان بصفته أحد موجوداته يتعشَّق القيمة العُليَا للمطلق وينحو تجاهها بالمحبة؛ ذلك أن شلر يرى الإنسان لا ينفك باحثًا عن القيمة في كل شيءٍ، فهو في سعي محموم نحو القيمة، فلا يكتفي بقيمة عُليا إلا ويتوجَّه إلى قيمةٍ أعلى منها وصولًا إلى القيمة اللامتناهية التي هي الله. يقلب مفهومُ المحبة، وفقًا لهذا، نظامَ العالَم بصفته نظامًا سماويًّا مقدسًا. يقف الإنسان داخل هذا النظام السماويّ كأفضل الموجودات لما يتمتع به من عقل وحرية وعاطفة قصدية معطاةٍ بالله. الله، بهذا المعنى، هو المركز الأعلى للمحبة، وهو أسمى مرتبة فيها.
على هذا الأساس، يُفرِّق شلر بين معرفتين إلهيتَين: (1) المعرفة الميتافيزيقية؛ و(2) المعرفة الدينية. ويرى بينهما تعالُقًا. المعرفة الميتافيزيقية نوع من التلقِّي الإيجابي للإلهي الموجود في العالم. أما المعرفة الدينية، فهي نوع من التلقِّي السلبي للإلهي المرتبطة بظروف شخصية. الميتافيزيقيّ متسائل باحث عن الإلهيّ بالخبرة والتجربة. أما المتدين، فهو مقلِّد للمثال المُعطَى، وأسمى ما يسعى إليه التحقُّقُ بالقداسة من طريق هذا المثال. وهما متعالقان باعتبار أنَّ المعرفة الدينية خطوة أولى نحو المعرفة الميتافيزيقية، وعلى هذا الأساس، لا ينبغي أن تطغى إحداهما على الأخرى، أو أن تستولي عليها.
نفهم من هذا أن شلر ينظر إلى الله على أنه موجود مُتناهٍ مُشخَّص داخل الزمان لا خارجه، وإلى القيمة المقدسة على أنها ذروة سنام القِيَم. ينتقل شلر إلى ميتافيزيقيته القائلة بالصيرورة ووحدة الوجود بعد مرحلةٍ اعتنق فيها فكرةَ الله على المذهب الكاثوليكي. تسعى فينومينولوجية الدين إلى فهم الطبيعة المطلقة للمقدس، وإلى دراسة مظاهر المطلق في عالم الخبرة الإنسانية. لا يتصف اللهُ، عند شلر، بصفتَي الفكر والامتداد مثلما رأى سبينوزا Spinoza (1632-1677)، وإنما يتصف بالإرادة الشوبنهاورية[10] التي يُثنِّيها إلى الدافع والروح. حياة الوجود المطلق كامنة في هذه الثنائية الفكرية والروحية. هاتان الصفتان هما مكمن التوتر الجوهري بين الله الذي هو الواحد وأغياره. الواحد لا يمكنه التحقق إلا بصيرورة داخل الزمان لا خارجه، فهو نتاج للعملية الزمانية، فلا يمكن الحديث عنه بصفته مفارقًا للزمان أو فوقه. الله، وفقًا لهذا، هو الموجود المُشخَّص القائم بذاته المندمج في العملية الزمانية الصيرورية. يُدرك الإنسان هذه الصيرورة الإلهية من طريق النفس التي تُعد المَحلَّ الأنسب الذي يتجلَّى فيه الإلهُ، فهي جزءٌ من العملية الزمانية هي الأخرى.
خاتمة[11]
تنتهي الباحثةُ إلى نتائجَ نشير إلى بعضها:
1- تَمَيَّزَ شلر بفينومينولوجيته العاطفية القلبيَّة على عكس أستاذه هوسرل الذي تميز بالصرامة والدقة الشديدين.
2- استعمل شلر الفينومينولوجيا استعمالًا تطبيقيًّا، وحاول بها إخراج الإنسانية من نزعتها المادية المتمركزة حول الذات.
3- كان لشلر جهد حثيث ومعجب في التأسيس لـ "سوسيولوجيا المعرفة"، ولعله أول من استعمل هذا المصطلح.
4- رأى البعضُ أن شلر من مؤسِّسي الفلسفة الوجودية نظرًا لحديثه طويل النَّفَس عن العاطفة الإنسانية والعديد من المشاعر الإنسانية كالمحبة والتعاطف والاستياء، إلى جانب حديثه حول التواصل بين الذوات، ونظرته للعالم على أنه مُقاوَمة.
5- حاول شلر برفضه للصورية الكانطية التأسيسَ لمذهب موضوعي لا صوري لا يستبعد الجوانب العاطفية في الأحكام الخُلُقية والقِيَمِيَّة.
6- ردَّ شلر أزمة الحضارة الغربية إلى انهيار القيم، والتكالُب على المادة، وتشيؤ الإنسان.
7- هناك جوانب أخرى من شلر تستحق الدراسة والتحقيق؛ ومنها: علاقة شلر بالنازية، وعلاقته بالفلسفة الوجودية فيما يخص تناوله العلاقة بين الذوات، ومشاعر كالخجل والمحبة ورفض الحضارة الغربية.
[1] ص ص 11-16
[2] ص ص 19-45
[3] ص ص 49-110
[4] ص ص 113-194
[5] ص ص 197-246
[6] ص ص 249-288
[7] ص ص 291-331
[8] ص ص 335-386
[9] ص ص 389-470
[10] نسبة إلى شوبنهاور Schopenhauer (1788-1860).
[11] ص ص 473-480