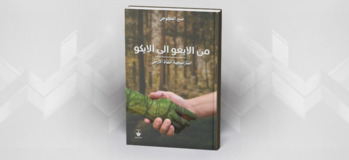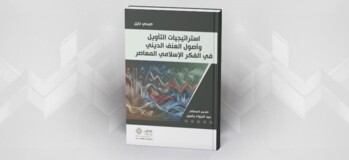"آخر أيام محمد" دوائر الوهم والحلقة الناقصة في التاريخ
فئة : قراءات في كتب
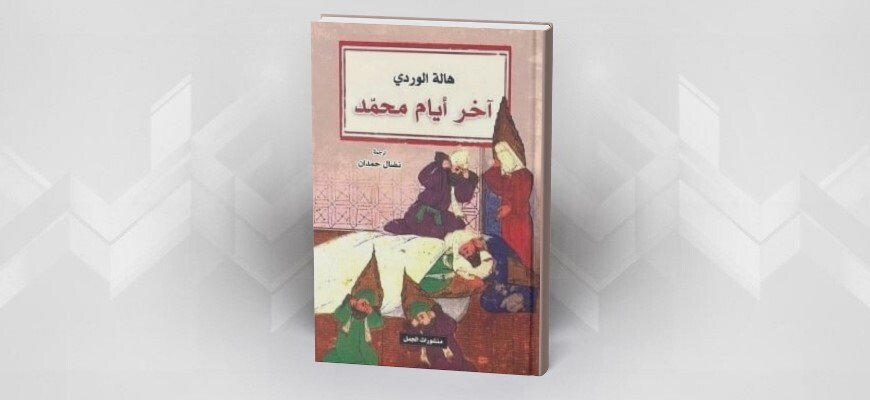
"آخر أيام محمد"
دوائر الوهم والحلقة الناقصة في التاريخ
يبقى التاريخ الإسلامي، وتحديدا ًالتاريخ الذي يخص السيرة النبوية وظهور الإسلام، تاريخًا يلفه الغموض والالتباس والجدل العقيم. فشخصية النبي محمد في الروايات الإسلامية السنية منها والشيعية، لا يمكن من خلالها رسم شخصية محددة وواضحة الملامح، ولا يمكن معرفة الأحداث بتفاصيلها معرفة دقيقة ومُجمع عليها من قبل تيارات الإسلام. ويعود السبب في هذا إلى تباين وتناقض الروايات والمصادر الإسلامية السنية والشيعية، بل إننا يمكن أن نتلمس هذا التناقض والاختلاف داخل المذهب الواحد أو الطائفة الواحدة نفسها. ومن العوامل الأخرى التي تضاف إلى التشكيك الكبير في هذا التاريخ، هو السيرة النبوية التي كتبت بعد قرن ونصف أو أكثر من وفاة النبي محمد. إضافة إلى عدم وجود أي وثيقة تاريخية أو أثر أركيولوجي واضح يخص النبي محمد في الجزيرة العربية، لكن موضوع الأثر الأركيولوجي يمكننا قبوله والعمل به، إذ لم تثبت التنقيبات وعلم الآثار العثور على خيط أو شيء ملموس، يمكنه أن يدلنا على حقيقة وجود للأنبياء الذين نعرفهم في تاريخ البشرية.
لا يملك المسلمون اليوم تاريخا واحداً وثابتاً ومتفقا عليه بين جميع التيارات والمذاهب لسيرة النبي محمد، وبالتالي فإنهم ما زالوا يتحركون ضمن دوائر الوهم والدوغمائية والعصبية القبلية والطائفية، وهي حركة خارج التاريخ تعمل على تغذية العنف وإلغاء الآخر. فالمسلمون اليوم يعيشون خارج الزمن البشري الحقيقي وخارج الحضارة؛ وذلك بسبب هالة التقديس التي تصل حد الألوهة للنبي محمد وأصحابه وآل بيته، ففكرة أن النبي محمد هو نبي آخر الزمان، وهو خاتم الأنبياء، وما جاء في القرآن عن اقتراب نهاية العالم ويوم القيامة ووصف أهوالها المرعبة والكابوسية، جعل المسلم اليوم يعيش حياة من أجل الموت، حياة يغذيها الخوف وانعدام القدرة على التفكير أو حتى استخدام العقل بأبسط أشكاله.
ما الذي ينقص المسلم اليوم، لكي يلتحق بركب الحضارة ويدخل دائرة الزمن؟
ينقصه الكثير جدًّا، لكن ما ينقصه ليس مستحيلاً أو تعجيزيًّا.
ماذا لو حاول المسلم اليوم أن ينظر نظرة بشرية وموضوعية إلى نبيه العظيم محمد، وإلى أصحابه وآل بيته بعيدًا عن سرديات التقديس والملاحم والمعجزات، نظرة بشرية بمعنى أن هذا الإنسان يحيا اللذة والألم كغيره من البشر، إنسان له رغبات وأهواء ومصالح وغرائز، ويحمل نقائض الخير والشر في أعماقه ويتصالح معها. إنسان قادر على المحبة والكره والإبداع والصلاة.
إن النظرة البشرية الخالية من أي بعد تقديسي ولاهوتي إلى النبي محمد هو انتصار للإسلام ونبيه، وقبل كل شيء هو انتصار للإنسان والكرامة الإنسانية على مر التاريخ.
"آخر أيام محمد" المؤامرة والفجيعة
يعدّ كتاب "آخر أيام محمد" للباحثة والأستاذة الجامعية التونسية هالة الوردي، واحدًا من أهم وأجرأ المحاولات في إرجاع نبي الإسلام إلى زمنه البشري، ونزع هالة القداسة التي أحاطت بالصورة الملحمية اللاهوتية لمحمد، تلك الصورة المعصومة عن الخطأ، والتي لا تقبل النقاش والتفكير العقلي المنطقي، مع تأكيدها أن أصحاب النبي وآل بيته وأتباعه لم ينظروا إليه بهذا الطابع من التقديس المصحوب بجمل الصلاة والتبريك التي نذكرها اليوم مع اسم النبي محمد، بل كان محمد ملهماً وشخصية فذة وقيادية ووعياً متجاوزاً لعصره ومعاصريه.
ينطلق الكتاب من نقطة جوهرية وأساسية، وهي الفترة الأخيرة من حياة محمد قبل موته، تلك الفترة التي مني فيها بالهزائم الحربية في معركة مؤتة أمام الروم، ومحاولة اغتياله بعد غزوة تبوك، ووفاة ولده إبراهيم من جاريته أو زوجته ماريا القبطية. إضافة إلى المحور الأساسي المحرك للكتاب، وهو مؤامرة أقرب أصحابه إليه أبي بكر، وعمر بن الخطاب، ومحاولتهم في مواضع عديدة إهانة النبي والطعن فيه والتشكيك في نبوءته. وتتجلى المأساة في يوم رزية الخميس الذي تتفق عليه المصادر السنية والشيعية؛ فالنبي محمد منع من كتابة وصيته عندما قال للجمع الملتف حوله: "اِئتوني بالكتف والدواة، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبداً". فقال عمر بن الخطاب: "حسبنا كتاب الله". وعندما حاول أحدهم إحضار الدواة، قال له عمر: "ارجع، فإنه يهجر". إضافة إلى ذلك، فالنبي محمد ترك ثلاثة أيام من دون دفن، حتى بدأ جسده يتحلل كما تشير بعض الروايات، في الوقت نفسه الذي كان فيه أبو بكر مجتمعا مع الأنصار في سقيفة بني ساعدة، وهو الذي عصى أمر النبي عندما قال له: "أنفذوا بعث أسامة"، فعاد إلى المدينة بعد أن ورده أن النبي على فراش الموت، بل إن المصادر الإسلامية تؤكد أن أبا بكر لم يكن موجوداً طيلة الأيام الثلاثة، ولم يحضر جنازة النبي وتشييعه. وهناك مصادر تشير أنه لم يتم تشييع النبي ودفنه، إلا بعد أن استقام الأمر لأبي بكر كخليفة للمسلمين بعد الانقلاب السياسي في سقيفة بني ساعدة وقبلها أيضاً.
تشير هالة الوردي في كتابها أن احتمال قتل النبي بالسم، هو احتمال وارد وكبير، وهو ما تؤكده بعض الأحاديث والروايات الإسلامية، لكن السم وفقا لتلك الروايات هو من فعل المرأة اليهودية زينب بنت الحارث التي قتل النبي زوجها وعمها وأخاها في غزوة خيبر على حد تعبيرها، والتي وضعته للنبي في كتف الشاة المشوية، لكن هذا كان قبل وفاة النبي بثلاث سنوات تقريباً، فهل هناك سم يمكن أن يبقى أثره لثلاث سنوات؟
وعليه، تدحض الباحثة هذه الفرضية، لتشير أن النبي كان يتمتع بصحة جيدة وجسد قوي، لكنه انتكس فجأة خلال أسابيع قليلة. أما عن الرواية التي تؤكد إصابة النبي بمرض ذات الجنب، فهذا الأمر نفاه النبي نفيا قاطعا عندما قال بما معناه إن الله لا يسلط علينا نحن معشر الأنبياء داءً كهذا.
ومن هنا تشير الباحثة إلى أن السم أعطوه للنبي مع الدواء، وقد أشربوه إياه عنوة، وهو نصف نائم، وبتعبير بعض الروايات التاريخية "لدوه بالسم".
أما طريقة لد النبي محمد بالسم، فالباحثة لا تستبعد تورط، كل من زوجتيه عائشة وحفصة بهذه المؤامرة، وهما اللتان كانتا عينا للتجسس ومراقبة النبي، وإيصال أخباره لكل من أبي بكر وعمر بن الخطاب، إلا أن الباحثة لا تشير بشكل مباشر لهما، ولا تتهم المرأتين بشكل صريح، لكنها تتبع الأثر والدليل، وتحاول فك التناقضات وملء الفراغات التاريخية.
وضمن المقاربة التاريخية المتشابهة في فترة قصيرة، تستذكر أيضا ًحادثة اغتيال الحسن بن علي بالسم عن طريق زوجته جعدة بنت الأشعث، حسن الذي كان أشبه الناس بجده محمد، خلقا وأخلاقاً.
كما أن ذكر النبي ظل مهملا لعقود طويلة في تاريخ الإسلام، بل حتى قبره ظل مجهولا للكثير من معاصريه وأتباعه لفترة من الزمن، وحتى زوجته عائشة التي لم يرد أي حديث عنها عن معرفة قبر محمد، فكان غياب عائشة عن جنازة زوجها هو أكثر إثارة للالتباس والإرباك من غياب أبي بكر وعمر، خاصة وأنها كانت ملازمة للرسول طوال فترة احتضاره، ونقلت أحاديث كثيرة عنه، وعائشة هي نفسها من أقرّت - وفقا للسيرة النبوية لابن هشام- بعدم معرفتها بلحد الرسول، إلا بعد صوت المساحي في السحر.
محمد القديس والإنسان بين الخير والشر
لا يمكن لأيّ قارىء مسلم، معتدلًا كان أم متطرفاً، إلا أن يشعر باستفزاز ونوع من الألم والقهر، وهو يطالع سيرة النبي محمد. لكن لا بد من هذه اليقظة وهذه الهزة في الوعي، كي يستفيق المسلم من سباته ويخلع عنه دوائر الوهم المتراكمة عبر التاريخ؛ فمحمد الإنسان لم يكن يخلو من شرور وجرائم وشهوات بشرية كما تصفه الكاتبة في الفصول الأولى من الكتاب، بل إننا عندما نطالع الكتاب نشعر أننا أمام وصف لقائد سياسي أو ملك أو طاغية في عصرنا الحديث، معتمدة على بعض الروايات عند السنة والشيعة، الضعيفة والقوية منها، وكذلك على روايات من خارج المصدر الإسلامي، بل والحاقدة على الإسلام أيضاً، إلا أن منهج الكاتبة في البحث بُنِيَ على مجموعة من التناقضات، وعلى الشك وتوليد الأسئلة المستمرة، ومحاولة لردم الفجوات وتتبع الأثر. وإن الكتاب برمته يعتمد على الأسلوب السردي المحكم، وعلى البناء الدرامي والصوري، بل أستطيع القول هنا إن الباحثة تميل بكفتها أكثر للأدب وللرواية التاريخية على وجه التحديد.
بالعودة مرة أخرى إلى الكتاب، نرى أن محمدًا يأمر باللصوصية والمجازر كتلك التي أمر بها النبي محمد خالد بن الوليد بخطف ملك دومة الجندل النصراني "أكيدر بن عبد الملك الكندي"، فتم تجريده من ثيابه وحليه النفيسة، ومن ثم إجباره على دفع الفدية خوفا من أن يقتل. وكذلك تلك التي نرى فيها الرسول يطلب من ابن عمه الزبير تعذيب اليهودي تعذيبا ضارياً، حتى يكشف له مخبأ كنز بني النضير. كذلك تعقب الشعراء الذين هجو محمدًا ومحاولة قتلهم وعدم العفو عنهم، مثل الشاعر اليهودي كعب بن أشرف. لكن في الطرف المقابل يتجلى لنا محمد الإنسان والقديس الذي يعطف على الفقراء والمحتاجين والعبيد، ويعفو عن الذي حاول اغتياله عدة مرات. ومن أهم هذه المحاولات هي محاولة اغتياله من قبل مجهولين عند عودته من غزوة تبوك. إن المصادر الإسلامية ترجع في من حاول اغتياله إلى شبكة واسعة من المنافقين، وعلى رأسهم عبدالله بن سلول وغيرهم، إلا أن الكاتبة تحاول أن تفك الالتباس والغموض والفراغ التاريخي لهذه الحادثة، فتحاول أن تمسك بخيوط الجريمة، لتصل إلى أن من حاول اغتياله كان يتمتع بسلطة وجاه ونفوذ أكبر من محمد في الإسلام، بل إن هذه الجماعة هي نفسها قد تكون من دبرت لمقتله بالسم في بيت عائشة. إن الأمر هنا أشبه بسلطة وسلطة مضادة، ومحاولة انقلاب سياسي وعسكري داخل الإسلام نفسه. وامتد الأمر بعد وفاة النبي لمحاصرة بيت فاطمة، ومحاولة إضرام النار في بيتها لإجبار المتخلفين عن بيعة أبي بكر للخروج والمبايعة.
آل البيت والصحابة
لم يخلُ الكتاب من محاولة نزع القداسة عن آل بيت الرسول أيضا، بوصفهم طرفاً في الصراع وأصحاب سلطة أيضاً. إن فاطمة بنت النبي يأتي ذكرها بوصفها أقل حسنا وجمالاً من أخواتها، زينب، ورقية، وأم كلثوم. وإن أباها قد أجبرها على الزواج من علي الذي لم يكن يحبها، بل أحب جويرية بنت أبي جهل الملقبة جميلة، والتي أراد الزواج منها، لكن النبي محمد تصدى له ومنعه من الزواج من بنت ألد أعدائه أبي جهل. في الوقت نفسه، نرى أن السلطة الأبوية تتجلى واضحة في النبي محمد، عندما زوج بناته رقية وزينب وأم كلثوم من أبناء مشركين وبالغي الثراء، فرقية وأم كلثوم تزوجتا من أبناء أبي لهب، وهما عتبة وعتيبة، لكن أجبرا على الطلاق بعد نزول سورة المسد، ليتم تزويجها لاحقا بشخص مسلم وبالغ الثراء والجاه أيضاً، وهو عثمان بن عفان، لذلك لقب بذي النورين. أما رقية، فقد تزوجت العاص بن الربيع التي تكون أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد. تزوجت رقية من ابن خالتها الذي بقي على شركه ولم يغادر مكة، ولم يسلم إلا بعد فتح مكة، عندما أصبح الإسلام موضة رائجة في الجزيرة العربية. يأتي كتاب هالة الوردي على ذكر فاطمة ووصفها بأنها رعناء ولا تحسن التدبير في المواقف الصعبة والمصيرية مقابل عائشة الفتاة اللعوب والماكرة وصاحبة الدسائس التي مهدت الطريق لتسلم أباها ابن أبي قحافة الخلافة السياسية بعد محمد، وكذلك الحال بدرجة أقل مع حفصة ابنة عمر بن الخطاب.
كذلك يتم التطرق إلى علي بن أبي طالب أيضا، بوصفه خاملا وكسولاً وكثير النوم، الأمر الذي يجرده من صفات المحارب والمآثر القتالية المبالغ فيها، فهو إضافة إلى ذلك متهم بالتقصير في سقيفة بني ساعدة، وفي دفاعه عن فاطمة، عندما حاول عمر بن الخطاب اقتحام بيتها، فلم يكن علي يتمتع بأي موهبة سياسية ولا أي خبرة في الحكم والإدارة، والدليل على ذلك الحرب الأهلية التي حدثت في عصره، كما أنه لم يكن جميل الهيئة والمنظر، وتستشهد الكاتبة بذلك عندما دخل الرسول على فاطمة ورآها تبكي، فقال لها مالك تبكين، فقالت له في اهتياج ثورتها "لقد زوجتني ضخم البطن، أعمش العين".
إلا أن تلك الروايات لها ما يناقضها ويكذبها أو يلغيها تماماً، فهذه الروايات هي في الأغلب موضوعة من قبل مصادر أموية، كانت تريد تشويه صورة علي بن أبي طالب وآل بيت الرسول، وكذلك التعتيم والتهميش المتطرف الذي طال سيرة علي بن طالب وآل البيت.
إن الباحثة نفسها تقع في تناقض كبير أيضا داخل الكتاب نفسه، فهي من جهة تؤكد على بيعة علي بن أبي طالب في غدير خم، وعلى مبايعته من قبل أبي بكر وعمر بن الخطاب، وكانت تؤكد كذلك على محبة الرسول لعلي لدرجة أن قربه لمنزلة تشبه منزلة الأنبياء. وهذه العبارة تجمع عليها المصادر السنية والشيعية "ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبيّ بعدي".
إذن، هل يزوج النبي محمد ابنته لشخص خامل كسول، وهل يستخلف على أمته التي كان يخشى من تفرقها ووقوع الفتنة فيها شخصا كثير النوم ومهملا ًومقصراً؟
أما بالنسبة إلى أبي بكر وعمر بن الخطاب، فيمكن القول إنه لا يمكننا أن نلغي أهميتهما السياسية؛ فالعقيدة والوفاء لها، والإخلاص للكفاح الثوري المحمدي هو ذاته الذي كان يجمع الخلفاء الراشدين الأربعة. أما عمر بن الخطاب، فهو شخصية إشكالية متناقضة ومتمردة، فتارة نراه حالماً معتدلا شاهداً على تنزيل آيات القرآن، بل مثقفا يضاهي النبي محمد في الجدال والنقاش، وتارة نراه عنيفاً ومتهوراً وعدوانياً، أو نراه مشككاً في الله ونبوءة محمد في مواقف كثيرة، ومن ضمنها صلح الحديبية الذي تنازل بموجبه محمد عن لقب رسول الله وعن استبدال عبارة "بسم الله الرحمن الرحيم" بعبارة باسمك اللهم، وهنا نتلمس أول بادرة لفصل الدين عن الدولة في الدين المحمدي. وتصف هالة الوردي هذه الوثيقة بأول وثيقة علمانية في الإسلام، وينم هذا الموقف عن ذكاء ودبلوماسية محمد ووعيه الحاد المتجاوز لعصره. إن تشكيك عمر بنبوءة محمد تشبهه هالة الوردي "بالقديس بطرس (أحد حواري عيسى) الذي كان هو الآخر رجلاً مندفعاً عرف الكثير من لحظات الشك. وفي تاريخ المسيحية والإسلام، كان كلا الرجلين صاحب نبي ومؤسسا؛ إذ أرسى عمر بن الخطاب أسس الخلافة الإسلامية، ووضع القديس بطرس أسس الكنيسة". (آخر أيام محمد، ص 373) لكن ما يجدر إضافته هنا، هو أن شك عمر بن الخطاب ليس شكا سلبيا، بل شك نابع من فكره النقدي الذي ما انفك يحاور فيه النبي وآيات القرآن. وثانياً، حرصه الشديد على المبادىء الثورية المحمدية الأولى، وهي مبادىء ظلت ثابتة وراسخة في فترة الخلافة الراشدية، رغم الانقلاب الذي حصل في الإسلام وغيّر مسار التوقعات والتكهنات، إلا أن مسار التاريخ لا يمكن أن يبقى ثابتا أو أن يمشي بخط مستقيم بلا هزات وانعطافات كبرى وتحولات مصيرية؟ إن ما حصل هو بمثابة انشقاق سياسي ساهم في تأسيس الدين الإسلامي كمنظومة أيديولوجية سياسية، لها خطابها المؤثر في مشاعر الشعب المسلم الجديد، خطاب يجمع بين الترغيب والترهيب، ويؤسس لبناء إمبراطورية عربية ستمتد لتشمل رقعة جغرافية واسعة من الأرض، وتؤسس لحضارة جديدة وقيم جديدة تحكم العالم.
الأسطورة والشر
غالبا ًما ترتبط الأسطورة بجانب معين من الشر، وعليه يمكن القول إننا نقبل الجانب المظلم والشرير عند الأنبياء، ولا نحاكمه محاكمة أخلاقية في عصرنا الحديث. فكتب الأساطير والديانات مليئة بالآلهة التي تبطش بالبشر، وبالأنبياء الذين يرتكبون الجرائم والفواحش وزنا المحارم، كذلك الأنبياء الذين خاضوا الحروب وارتكبوا عمليات إبادة جماعية، هذا ما تخبرنا به الكتب السماوية والملاحم والأساطير. فالشر غالبا لم يكن ينفي القداسة عند الأنبياء ولا صلتهم بالله أو الملائكة في السرديات الدينية القديمة. لذلك، فالمحاكمة الأخلاقية للتاريخ تغفل دائما عن نسق الخطاب ونظام المعرفة في كل حقبة زمنية، لتصبح المحاكمة الأخلاقية مجرد محاكمة للنص ورمزيته وفقا لتمثلاتنا الذهنية ومعاييرنا الأخلاقية المعاصرة.
إن أسطورة النبي محمد لم تكن لتنفصل عن جانبها المظلم والشرير، لكن محمد الإنسان كغيره من الأنبياء البشر الذين ابتلوا بالآلام والأمراض والكوارث والمؤامرات، وخيانات أقرب المقربين من الأصحاب. فلينظر التاريخ إلى يهوذا الإسخريوطي، وزوجتي نوح ولوط، وغيرهم من الأنبياء والقديسين. لم يكن محمد بعيدا عن هذه الأجواء التي ترسخ عظمة وجوده بين الأنبياء.
وإذا كان لا بد لنا أن نتأمل مأساة محمد، فلنمعن النظر عميقا في أحاديثه التي تصف حزنه وألمه الداخلي الذي يذكرنا بآلام المسيح، ولنتأمل في دموعه التي ذرفها بين يدي الله صادقاً، ولنتأمل لحظات شكه التي غيّبها التاريخ في أحداثه الكبرى، ألم تساور النبي لحظات شك كغيره من الأنبياء؟
ألم يخاطب الله في أحلك ساعات حزنه وانهياره؟
لقد توالت الأحزان والآلام والفواجع على قلب النبي محمد كقطع الليل المظلمة؛ محمد الذي قال في ساعات كربه وانهياره الوجودي: "اللهم إني أشكو لك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات".
ألم يشبه النبي محمد أيوب، وهو يخاطب جبريل قبيل موته والحمى تلتهم جسده كالنار:
"أجدني يا جبريل مغموماً، وأجدني يا جبريل مكروباً".
وأخيراً، لا بد لي أن أقول إن المسلم الحر هو الذي يؤمن بالأخوة الإنسانية على هذا الكوكب، وهو الذي يرى محمداً ملهما وعظيماً، ما دام في أعماقه ينتصر محمد الإنسان على محمد النبي.