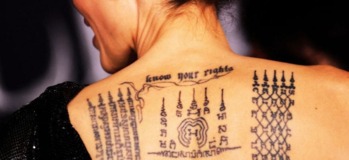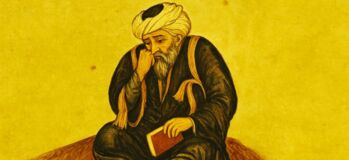لقاء حواري مع د. يونس الوكيلي
فئة : حوارات

لقاء حواري مع د. يونس الوكيلي
حول مجمل أعماله الصادرة عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر والتوزيع
"تخصصي في العلوم الاجتماعية أتاح لي إمكانية أخرى لفهم الإسلام، ليس فقط كنص مقدس، وإنما بوصفه ظاهرة اجتماعية، تتجسد وتتشكل من خلال تفاعلاتها مع الثقافة والسياق الاجتماعي"
د. حسام الدين درويش:
مساء الخير؛ في إطار لقاءات "مؤمنون بلا حدود" المصاحبة للمعرض الدوري للكتاب بمدينة الرباط، يسعدنا أن نستضيف اليوم شخصًا أعدّ نفسي ضيفًا في حضرته، لما له من حضور في المؤسسة، ولخبرته الواسعة فيها. يسعدنا أن نرحب بالدكتور يونس الوكيلي؛ مرحبًا بك دكتور، شرفتنا بحضورك، وأهلاً وسهلاً بك.
د. يونس الوكيلي:
شكرًا جزيلًا على هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى أن تؤتي ثمارها المرجوة. أنا سعيد بوجودي معكم.
د. حسام الدين درويش:
أهلاً وسهلاً بك مجدّدًا؛ اليوم سنتناول موضوعين أساسيين:
أولًا، سنتحدث عن نتاجك المعرفي، لا سيما في إطار تعاونك مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود. بين يديّ هنا أربع نسخ من مؤلفاتك، سواء كنت مؤلفًا أو محرّرًا أو مشرفًا عليها. ومن ناحية أخرى، سنتحدث عن علاقتك بالمؤسسة، وهي كما ذكرت علاقة عريقة وممتدة.
فلنبدأ أولًا بالحديث عن اهتماماتك البحثية التي تقع في إطار العلوم الاجتماعية، مثل السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا، مع ارتباطها بالإسلام، من زاوية المجتمعات الإسلامية وما يتعلق بها من قضايا. ومن ناحية أخرى، أنت تتوسع في المواضيع والمجالات التي تهتم بها في أبحاثك. نودّ أن نسمع منك رؤية عامة حول المواضيع التي تناولتها في كتاباتك، منذ مؤلفك الأول، والذي أظن أنه كان أطروحتك، أو على الأقل "أنثروبولوجيا الشفاء"، وصولًا إلى كتاباتك الأخيرة.
د. يونس الوكيلي:
كان الاهتمام الأول حول العلوم الاجتماعية وعلاقتها بالدين. بطبيعة الحال، كانت نشأتي وبدايات اهتمامي بالدين من خلال النصوص، فكان التركيز منصبًّا على الإسلام وعلى النص الديني عمومًا؛ غير أن تخصصي في العلوم الاجتماعية أتاح لي إمكانية أخرى لفهم الإسلام، ليس فقط كنص مقدس، وإنما أيضًا بوصفه ظاهرة اجتماعية، تتجسد وتتشكل من خلال تفاعلاته مع الثقافة والسياق الاجتماعي.
وقد تبلور هذا التوجه في سؤال مركزي رافقني طوال العشرين سنة الماضية من عملي الأكاديمي: كيف تنظر العلوم الاجتماعية إلى الإسلام؟ هذا السؤال كان بمثابة البوصلة التي وجهتني، وأسفر عن عدد من المشاريع والكتب. أول هذه الكتب هو الذي بين أيديكم الآن، والمتعلق بـ "سوسيولوجيا الإسلام المغربي". وعلى الرغم من أن الكتاب صدر في عام 2013، فإنه كان جاهزًا كمخطوطة منذ سنة 2010، والفكرة الأساسية فيه هي النظر إلى الإسلام من "تحت"، من خلال المجتمع. وهذا المنظور لم يكن مطروقًا في التراث الإسلامي التقليدي، وإنما هو مقاربة بحثية طورها الغرب. وفي هذا الكتاب أسلط الضوء على المدرسة الفرنسية ومؤسساتها البحثية، رغم أنها في لحظة ما كانت منحازة للاستعمار. لكن، وعلى الرغم من هذا التحيز، فإن هذه المدرسة كانت راسخة في تقاليد البحث العلمي، خصوصًا في ميدان دراسة الممارسات الإسلامية.
ركزتُ في هذا الكتاب على حوالي خمسة أو ستة باحثين عملوا داخل الإدارة الفرنسية، وقاموا بدراسات متعددة حول الإسلام في المغرب، وقد أوليتهم اهتمامًا خاصًّا في هذا العمل. وركزتُ كذلك على مفهوم "الإسلام المغربي"، وهو مصطلح من ابتكار الفرنسيين، كما أشار إلى ذلك عدد من الباحثين، خاصة "إدموند بورك"، الذي تحدث عن فكرة "الإسلام المغربي" بوصفه اختراعًا فرنسيًّا؛ بمعنى أن الإسلام، من وجهة نظرهم، له خصائص وملامح مميزة في المغرب، تختلف عن الإسلام في المشرق، أو في إفريقيا جنوب الصحراء، أو في آسيا. وتتعارض هذه الرؤية، بطبيعة الحال، مع المنظور التقليدي الذي يرى الإسلام ككلٍّ موحَّد، متماثل في كل مكان. لكن العلوم الاجتماعية استطاعت أن تُبيِّن أن هناك "إسلامات متعددة"، تختلف في ممارساتها، وفي طرائق فهمها، وفي تجلياتها اليومية، رغم وحدة رموزها الأساسية. هذا كان الكتاب الأول.
ومن تجلّيات هذا المشروع أيضًا الكتاب الأخير بعنوان: "أنثروبولوجيا المجتمعات الإسلامية". في هذا العمل، ركزتُ على المدرسة الأنجلوساكسونية، واهتمامها بالإسلام. ومن أبرز الأسماء اللامعة فيها، والتي اشتغلت في المغرب، كان "ديل إيكلمان"، رغم أنه لم يقتصر على المغرب فقط، بل اشتغل أيضًا في سلطنة عُمان، وآسيا، ومناطق أخرى من العالم الإسلامي. وفي هذا الكتاب، قمنا بترجمة حوالي 12 أو 13 دراسة لم يسبق ترجمتها إلى العربية. هناك بعض كتب "إيكلمان" تُرجمت سابقًا، لكن هذه المقالات كانت جديدة على القارئ العربي. كما أجريتُ معه حوارًا خاصًّا تم تضمينه في الكتاب. ومن الجدير بالذكر أن المدرسة الأنجلوساكسونية في دراستها للإسلام كانت أقلّ توجيهًا بفكر استعماري مقارنة بالمدرسة الفرنسية؛ فقد كان همّها منهجيًّا وأكاديميًّا بالأساس.
من المشاريع الأخرى التي اشتغلتُ عليها ضمن مؤسسة مؤمنون بلا حدود، كتاب حول "الأنثروبولوجيا الفرنسية"، وقد ركزنا فيه على اسمين بارزين: "إميل دوركايم" و"مارسيل موس"، بمشاركة عدد كبير من الباحثات والباحثين. وكان الهدف تسليط الضوء على الكيفية التي أسّست بها هذه المدرسة تقاليد النظر إلى الدين من منظور العلوم الاجتماعية، نظريًّا ومنهجيًّا.
كما أنجزنا كتابًا آخر حول "إشكالية الدين والتدين"، بالإضافة إلى كتاب إلكتروني بعنوان: "مداخل التفكير في الإسلام اليومي". فكل هذه الأعمال كانت تصبّ في إطار واحد، وهو الاهتمام بالإسلام، لا بوصفه نصًّا فقط، بل أيضًا بوصفه ممارسة وتجليات داخل المجتمع، وطرائق فهمه المتعددة وتفاعلاته المختلفة مع سياقاته الثقافية.
د. حسام الدين درويش:
دعني أبدأ ببعض المسائل الأساسية:
في الغرب، نجد أن مقاربة الظاهرة الدينية تنقسم عمومًا إلى نوعين أو اتجاهين أساسيين، بل وحتى تخصصين أكاديميين.
الاتجاه الأول هو الدراسات اللاهوتية، ذات البعد الإيماني. أما الاتجاه الثاني، فهو ما نُسمّيه عادةً بـمقاربات العلوم الاجتماعية، وأنتَ، كما يبدو من مسارك، تميل إلى مقاربة الظاهرة الدينية من زاوية العلوم الاجتماعية. لكن، إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك تكامل- وليس مجرد صراع - بين هذين الاتجاهين؟ بمعنى: هل يمكن أن يسيرا في مسارين متوازيين. وهنا نصل إلى مسألة محورية، من منظور ديني معياري، خصوصًا في السياق اللاهوتي الإسلامي، يُقال إن الإسلام واحد لا يتعدّد، ولا معنى للحديث عن "إسلام مغربي" أو غير ذلك؛ فهذه، بحسب هذا المنظور، ليست إسلامًا حقيقيًّا. ولكن من منظور العلوم الاجتماعية، المجتمعات تعيش الإسلام بطرائق متعددة، وتُنتج "إسلامات" مختلفة، بناءً على التقاليد والثقافات والسياقات المحلية. هنا لا يكون الحكم معياريًّا، بل وصفيًّا وتحليليًّا: نحن نصف الواقع كما هو، بغض النظر عن كونه صوابًا أو خطأً من منظور إيماني.
فهل يمكن أن تحدّثنا عن هاتين المقاربتين؟ وكيف توفّق بينهما في عملك؟ وهل تستفيد من أحدهما في تفسير الأخرى؟
د. يونس الوكيلي:
كما قلتُ سابقًا، في بداياتنا لم نكن نعرف الدين إلا من خلال النص، وكانت حتى التأويلات التي نعرفها أو نتداولها محدودة. لكن حين دخلنا إلى أفق العلوم الاجتماعية، أصبحنا ننظر - كما يقول "إرنست غلنر" - إلى الإسلام "من تحت"؛ أي من الواقع الاجتماعي، من حيث كيفية تفاعل النص مع الفعل البشري، ومع تنوّع السياقات الثقافية الممكنة. وقد كان "غيرتز"، أحد أبرز الباحثين في هذا المجال خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، قد قدّم إسهامًا مهمًّا في كتابه الشهير "الإسلام الملاحظ "(Islam Observed)، حيث قارن بين الإسلام في المغرب، والإسلام في جزيرة "جاوا" بإندونيسيا. وقد خلص في دراسته إلى وجود اختلافات حقيقية بين التجربتين، رغم انتمائهما إلى الدين نفسه. فالأهمية الكبرى لهذا المنظور - منظور العلوم الاجتماعية- تكمن في أنه يُظهر أن الحقيقة الدينية ليست مطلقة أو ثابتة بشكل كلي، بل هي نسبية ومتعددة التجليات؛ إذ لم يعد الإسلام يُفهم كجوهر ثابت، حضوره في رقعة جغرافية معيّنة هو ذاته في رقعة أخرى، بل إن الثقافة المحلية تتفاعل مع النص الديني وتُنتج شكلاً خاصًّا من الإسلام. صحيح أن هناك خصائص عامة مشتركة بين الإسلام في المغرب، وفي إندونيسيا، وفي مصر أو الخليج، ولكن مع ذلك، توجد اختلافات واضحة تفرضها السياقات الاجتماعية والثقافية.
والعلوم الاجتماعية تتيح لنا أدوات فعّالة لفهم هذا التعدد والتنوع. الرهان في هذا التصور هو تنسيب الحقيقة الدينية، والاعتراف بأن الرؤى الدينية تتشكل بالضرورة ضمن بيئة ثقافية معيّنة. وهناك اليوم عدد كبير من الأبحاث والتطبيقات التي تدعم هذا التصور. وأرى أن هذه المقاربة ليست نقيضًا للمقاربة اللاهوتية، بل يمكن أن تكون مكمّلة لها. صحيح أنه، في لحظة من اللحظات، كانت هذه الفكرة مثيرة للرفض، بل للصدمة. أتذكر أنني ساهمتُ في إحدى الندوات داخل جامعة مغربية، أمام طلبة الدراسات الإسلامية، وحين تحدّثتُ عن "الإسلام المغربي"، كان ذلك بالنسبة إليهم أمرًا مستنكَرًا جدًّا. قالوا: "يوجد إسلام واحد، وهذا الذي تقولونه لا يُعقل"، لكن أعتقد أن الأمور بدأت تتغير. ففي السنوات الأخيرة، بدأت ألاحظ نوعًا من الانفتاح التدريجي من قِبل التخصصات اللاهوتية على مقاربات العلوم الاجتماعية، بل وظهرت رغبة في فهم الدين، والممارسات، وأشكال الاعتقاد من خلال أدوات هذه العلوم. وأعتقد أن هذا التحول في طور الترسخ، وقد يُثمر في المستقبل حوارًا أكثر عمقًا بين المقاربتين.
د. حسام الدين درويش:
عمليًّا، أصبح هذا الموضوع موضوعًا مُتناولًا من قبل عدة منظورات مختلفة. كيف يمكن للعلوم الاجتماعية أن تتكامل وتغني العلوم الدينية؟ من منظور علمي، كيف يمكن للعلوم الاجتماعية أن تضيف بُعدًا جديدًا للعلوم الدينية، مثلًا في النقل أو التحليل من منظور لاهوتي؟ وفي المقابل، كيف يمكن للعلوم اللاهوتية أو الإيمانية، التي تدرس الظاهرة الدينية، أن تُثري العلوم الاجتماعية؟ وكيف يمكن أن يكون هذا التكامل فعليًّا، وليس مجرد شعار.
د. يونس الوكيلي:
أعطيك مثالًا بسيطًا جدًّا، وهو الأطروحة التي أنجزتها في الدكتوراه حول أنثروبولوجيا الشفاء والرقية الشرعية وصراعاتها. هذا الكتاب، الذي نُشر في المركز الثقافي للكتاب سنة 2021، يعالج موضوعًا لاهوتيًّا يتعلق بالرقية الشرعية، التي تناقش في جوانبها الطب النبوي وغيرها من الكتابات اللاهوتية في هذا المجال. من وجهة نظر لاهوتية ضيقة، كما نجد في التيار السلفي، هناك العديد من المؤلفات حول الرقية الشرعية. أما في العلوم الاجتماعية، فقد حاولت مقاربة هذا الموضوع من زاوية مختلفة. أولًا، أريد أن أكون واضحًا بأن الرقية الشرعية هي ممارسة علاجية دينية. عندما نعرّفها بذلك، فإنني حاولت أن أبين الأسباب التاريخية التي أدت إلى ظهور هذه الممارسة. فقد لاحظت أن الأيديولوجيا التي نشأت حولها هي الأيديولوجيا السلفية الوهابية؛ بمعنى أن المؤلفين الذين كتبوا عن الطقوس المتداولة فيما بينهم هم بالأساس منتمون إلى هذا الفهم الديني. هذا العمل التاريخي هو نوع من العمل الذي يقوم به عالم الاجتماع أو المؤرخ، وليس رجل الدين أو الفقيه.
إذن، هنا يظهر التداخل بين العلوم الاجتماعية، مثل الأنثروبولوجيا والاجتماع والتاريخ، التي يمكنها فهم الظاهرة من خلال نشأتها. ثانيًا، عندما نتحدث عن كيفية اشتغال الرقية الشرعية في الوقت الحاضر، فقد يتحدث اللاهوتي عنها وفق معايير دينية، مثلما يقولون "يؤمر بكذا" أو "يُنهى عن القيام بكذا"، لكن من وجهة نظري كعالم اجتماع، فإنني أستطيع استخدام الأدوات التي أتوفر عليها، لأكشف كيف تعمل الرقية الشرعية في سياق اجتماعي وثقافي وجغرافي معين. على سبيل المثال، اشتغلت على مدينة الدار البيضاء، وأظهرت كيف أن حامل هذه الممارسة العلاجية الدينية هم السلفيون في هذا الوسط الثقافي. لكنني لم أتوقف عند هذا الحد، بل ذهبت أبعد من ذلك لمعرفة ماذا تعني هذه الممارسة في هذا السياق الثقافي والجغرافي. وهذه الأسئلة لا يطرحها اللاهوتي.
وقد تبين لي من خلال البحث أن هناك صراعًا بين أنماط التدين. فالسلفية الوهابية، التي تحمل معها الرقية الشرعية، تُدخلها إلى فضاء ثقافي جديد، حيث تأتي كبديل عن ممارسات دينية محلية، مثل العلاج بالأولياء في الإسلام المغربي. ومن ثم، هناك معركة بين أنماط التدين، قد لا يلاحظها الناس العاديون، ولكن الأدوات الاجتماعية مكنتني من ملاحظتها، وفهم مسارها التاريخي، وتقديم نماذجها داخل سياق معين، ورهاناتها على مستوى سلوك الأفراد. على سبيل المثال، عندما يُوجه الراقي الشرعي النساء، فإنهن يُطلب منهن تمثيل أجسادهن بطريقة معينة تتماشى مع السلفية الوهابية، فيتصرفن وفق هذا النمط في حياتهن اليومية. وهكذا، يبدو أن الراقي يقدم علاجًا، لكنه في الواقع يمرر نمطًا دينيًّا وحياتيًّا معينًا. مثال آخر هو مفهوم "التحصين" في الرقية الشرعية، الذي هو في عمقه دعوة لتديين الحياة وفق منظور معين، كما يظهر في الكتاب الصغير "حصن المسلم" الذي ينتشر في كل منزل.
إذن، هذه الرقية الشرعية التي قد تبدو لللاهوتي كممارسة عادية، عندما ينظر إليها عالم الاجتماع أو الأنثروبولوجي في سياق ثقافي، تفهم معانيها وتاريخيتها ورهاناتها المختلفة. أعتقد أن هذا هو نوع من التكامل، رغم أنه قد يُرفض من قبل اتجاهات معينة.
د. حسام الدين درويش:
إذا رجعنا إلى الثنائية التي كانت موضوع كتاب لك، وهي إشكالية الدين والتدين، فإن الحديث عن هاتين المقاربتين يقودنا إلى تناول هذا الزوج: الدين والتدين. من ناحية أولى، يمكن القول إن العلوم الاجتماعية أقرب لدراسة التدين؛ أي الدين كما يُمارس من قبل البشر، حيث يؤثر فيهم ويؤثرون فيه. أما العلوم الدينية، فهي أقرب لدراسة الدين كما هو مُتصوَّر من الله، الذي أنزله إلى الأرض ليُرسل للبشر، وبالتالي يتم وضعه كمعيار ثابت. ما رأيك في هذا التمييز بين هاتين المقاربتين؟
د. يونس الوكيلي:
بالنسبة لي، فعلاً، عندما ألّفنا هذا الكتاب بشكل جماعي، حيث كنت منسقًا للأعمال، أعتقد أنه تم في عام 2015 أو 2014. وكذلك الكتاب الآخر الذي هو إلكتروني على موقع "مداخل التفكير في الإسلام اليومي"، كانت الفكرة الأساسية هي أن هناك الدين كما هو في التصورات والمبادئ والاعتقادات لدى الناس، ولكن هناك أيضًا الإسلام كممارسة؛ أي كما يمارسه الناس في حياتهم اليومية.
مثال على ذلك، في هذا العمل أو في العمل الآخر، تحدثنا عن أحد الباحثين التونسيين الذي اشتغل على "إسلام البحارة"، حيث تناول كيف يمارس البحارة إسلامهم، وهم مرتبطون بالبحر أكثر من البر. هذا مجرد مثال للعديد من الأمثلة التي يمكننا أن نذكرها في هذا السياق.
أعتقد أن دور العلوم الاجتماعية هو ملاحظة الإسلام كما يمارسه الناس، ومحاولة تسليط الضوء على هذه الممارسات وفهمها. وفي النهاية، يبقى الرهان الأكبر هو أن الإسلام ليس واحدًا كما يُصوَّر في مفاهيم معينة، كما يقول "الشرفي"، بل هو متعدد بتعدد فهم الناس له. لا أحد يمكنه القول إنه يمتلك النسخة الصحيحة من الإسلام، ويجب على الجميع اتباعها، بل هناك ممارسات متعددة للإسلام، تختلف باختلاف السياقات والأفراد.
د. حسام الدين درويش:
إذا تحدثنا عن الثنائية، فما الذي يمكننا أن نفعله بها؟ على الأقل، يمكن ملاحظتها وتصحيحها. لقد حاولت البحث في الكتابات الغربية عن إشكالية العلاقة بين الدين والتدين، لكنني لم أتمكن من العثور عليها إلا نادرًا. وعندما وجدت شيئًا، كان غالبًا في سياق وصفي، بمعنى كيف يُفهم الدين، وكيف يُمارس. لكن بالنسبة لنا، لا تقتصر المسألة على الثنائية فحسب، بل هي مسألة مثنوية؛ أي معيارية تتضمن تراتبًا وإقصاءً بين طرفين متناقضين؛ وغالبًا ما يُعدّ الدين الأعلى، بينما التدين يُعدّ الأدنى، وبالتالي يتم الحكم على التدين انطلاقًا من الدين "الحقيقي" أو "الصحيح".
من أبرز من كتب في هذا السياق هو عبد الجواد ياسين، الذي قدم فكرة الدين كحقيقة مطلقة. ومن ثم، يتم مهاجمة التدين السياسي بوصفه خارجًا عن ذلك الدين أو تلك الحقيقة أو مخالفًا لهما. إلى أيّ حدّ ترى أن هذه الإشكالية تتعرض للتوظيف الأيديولوجي في الواقع العربي؟ في الدراسات الغربية وفي الفكر الغربي، عمومًا، لا نجد دراسات تتضمن هذا النوع من التوظيف، حيث يُقال: "دينك خطأ" أو "أنت لست على دين الحق".
إلى أيّ حدّ مدى أن هذا التوظيف أصبح ضارًّا حتى على المستوى المعرفي؟ بمعنى أننا لم نعد نسعى لفهم ما هو الدين، أو كيف يُمارس التدين في هذا المجتمع أو ذاك، بل أصبحنا نريد أن نصنف الآخرين ونكفّرهم: "أنت على صواب، وأنت على خطأ". هذا التوظيف للثنائية لدينا هو توظيف معياري لا يساعد في فهم الظواهر المدروسة.
د. يونس الوكيلي:
في رأيي الشخصي، عندما أتحدث عن "التدين"، فإنني أقصده بالمعنى الوصفي-التحليلي، وليس بالمعنى المعياري. وأعرف طبعًا كيف يتعامل عبد الجواد ياسين مع هذه المسألة، لكنني لا أقصده تحديدًا. صحيح أن هناك كتبًا متعددة صدرت في العقدين الأخيرين تدور حول هذه الثنائية، بل ربما عشرات الكتب اليوم باتت تتناول هذه الثنائية وتستخدمها. لكن، في اعتقادي، داخل العلوم الاجتماعية، يُفهم التدين بوصفه ظاهرة تُدرس بشكل وصفي وتحليلي؛ بمعنى أنني لا أُعنى بالدين كمبدأ في ذاته إلا بقدر ما يساعدني على فهم الممارسة الاجتماعية. فمثلًا، حين اشتغلتُ على الرقية الشرعية كممارسة، كان لا بد أن أعود إلى الأصول النصية؛ لأن النص جزء من الممارسة، رغم أن فهم النصوص نفسه يتعدد، وليس هناك فَهمٌ واحد للنص داخل سياق الرقية.
وجهة نظري، أو بالأحرى محور تركيزي، هو الممارسة في حد ذاتها، والرهان دائمًا هو على التحليل، وعلى إبراز التعدد والاختلاف. هذا هو الأهم بالنسبة لي. وسأحكي لك قصة بسيطة: في أول مرة التحقت فيها بالجامعة، كنت متخصّصًا في الدراسات الإسلامية. وأتذكر أنني كنت في أحد ممرات الجامعة عام 2003، فرأيت إعلانًا عن ندوة دولية ستعقد في "مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود" في الدار البيضاء، وكان عنوانها لافتًا: "كيف يُدرَّس الدين اليوم؟". أثار هذا العنوان فضولي، أنا أتيت لدراسة الدراسات الإسلامية، ولكن بزاوية نظر معينة. ففي كليات الآداب والدراسات الإسلامية، أو في كليات الشريعة، ندرس الشريعة من أجل الإيمان بها، أو من أجل تبريرها أو الدعوة إليها. فحضرت الندوة، وشارك فيها مفكرون كبار، مثل محمد أركون، ومحمد الشرفي، ونصر حامد أبو زيد، وغيرهم. وقد خرجتُ من هذه الندوة بفكرة مركزية:
هناك من يدرس الدين ليؤمن، وهناك من يدرسه من أجل دراسته، فهمه، تحليله. هنا حددتُ موقعي: أنا في البداية كنت أدرس لأؤمن، ولأجعل الآخرين يؤمنون. لكن هذا اللقاء عدّل توجهي وأسئلتي. فأدركتُ أن هناك طرائق أخرى لدراسة الدين، سواء كنصوص أو كممارسات، لأجل المعرفة في حد ذاتها. لذلك، في السنة التالية، انتقلت إلى علم الاجتماع، وظلّ هذا هو رهاني المعرفي: أن أدرس الدين كممارسة، لا كقضية إيمانية أو لا إيمانية. وهذا لا يعني طبعًا أنني أنكر أهمية النص في فهم الممارسة، بل أؤمن بأن النص يساعد في توضيح وتفسير سلوك الفاعلين وفهمهم للواقع.
هذا ما أكّده أيضًا كتاب "مغامرة الإسلام" للباحث الأمريكي "مارشال هودجسون Marshall G. S. Hodgson"، حيث يقول إن دراسة الممارسة لا تكتمل إلا بربطها بأصولها النصية؛ لأن النص يمنحك مفاتيح لفهم التصورات المتضمنة فيها. باحثون آخرون، في الدراسات الأنثروبولوجية بالمغرب، يعملون على الممارسات في حد ذاتها، دون الرجوع إلى المرجعية النصية، وهو ما أعتقد أنه ناقص. ولذلك، في أطروحتي حول "أنثروبولوجيا الشفاء"، خصصت فصلًا كاملاً لمفهوم الرقية الشرعية؛ لأنني أؤمن بأن فهم الخطابات حول النص، وتصوّرات الرُّقاة أنفسهم للنصوص، هو جزء لا يتجزأ من الممارسة ذاتها.
د. حسام الدين درويش:
المصطلح "Islamicate" الذي نحتَه "مارشال هودجسون"، قمنا بترجمته إلى "إسلامات" أو "إسلاماتي". والمقصود به تجاوز السؤال التقليدي الذي ينشغل بمدى مطابقة الظواهر للمعايير الدينية: هل هذا إسلامي أم غير إسلامي؟ صحيح أم غير صحيح؟ الهدف من المصطلح هو التركيز على الإسلام بوصفه عاملًا ثقافيًّا واجتماعيًّا يطبع الحياة العامة ويؤثر في المجتمع؛ أي الإسلام كما يتمثّل في الثقافة والممارسة، لا بوصفه عقيدة معيارية نحاكم بها الأمور. من هذا المنظور، فإننا كباحثين لا ندرس الإسلام كعقيدة أو نبحث عن "العقيدة الصحيحة"، بل ندرس تمثّلات الإسلام في الحياة اليومية، في الثقافة، في اللغة، وفي النظم الاجتماعية. من ناحية المبنى، يطرح مصطلح "إسلاماتي" إشكالًا لغويًّا؛ إذ يأتي بصيغة جمع مؤنث، وهو ما لا يتوافق مع قواعد اللغة العربية. أما من ناحية المعنى، فهو مفهوم حاضر بشكل واضح في أعمال وممارسات الباحثين في علم الاجتماع، حتى قبل ظهور المصطلح ذاته. فما رأيك بهذا المفهوم؟ وهل ترى أن المصطلح، رغم إشكاليته اللغوية، ينجح في التعبير عن هذا البعد الثقافي والاجتماعي للإسلام؟
د. يونس الوكيلي:
هذا هو المنظور العام للعلوم الاجتماعية، حيث ينظر علماء الاجتماع إلى الإسلام في الممارسة، وإلى شكل الثقافة التي يعيشون فيها. وكان هذا مهمًّا أيضًا، وربما حتى في جوانب سياسية إلى حدّ ما؛ لأن الباحث دائمًا يسعى احتياطًا إلى عدم التصادم مع عقائد الناس. لذلك، يجب أن يدرس الإسلام من الناحية الوصفية، الموضوعية، والمنهجية الهادئة؛ بمعنى أنه لا يريد أن يصادم عقائد الناس أو يتهمها بالفساد أو البطلان، بل يصف الممارسة كما يمارسها الناس، يحللها، ويبيّن معانيها. وقد عمل عشرات الباحثين في هذا المجال على ذلك.
د. حسام الدين درويش:
إذا أخذنا ثنائية أخرى: المقاربة العربية الإسلامية مقابل المقاربة الغربية التي تُسمّى أحيانًا الاستشراقية. أنت عملت في مجالين، تعاملت مع البحوث والباحثين، وترجمت وكتبت أبحاثًا في هذا الخصوص، سواء الكتابات الغربية التي تُسمى الاستشراقية، أو كتابات أخرى. بشكل عام، نعلم أن هناك نظرية تنميطية أحيانًا تجاه هذه المقاربة الاستشراقية. ما رأيك في هاتين المقاربتين؟
د. يونس الوكيلي:
أنا أتذكر في التسعينيات، اشتهرت مقولة تفيد: من الاستشراق إلى الأنثروبولوجيا. وكان رضوان السيد وأبو بكر بقادر وغيرهما قد اشتغلوا في هذا الجانب، وكانوا يقولون دائمًا إن الاستشراق هو كيف نظر الباحثون الغربيون إلى النص ودرسوه، وهناك باحثون متعددون في هذا المجال. أما الأنثروبولوجيا، فهي الشيء نفسه، عودًا إلى المربع الأول؛ إذ إنهم ينظرون إلى الإسلام من الأسفل، مثل "جيرتز" و"أيكلمان" وغيرهم من الباحثين. وأعتقد أن هناك توجّهًا الآن نحو الأنثروبولوجيا أكثر من الاستشراق، رغم أن الاستشراق أيضًا شهد تحولات كثيرة جدًّا، ولكنهم دائمًا يميزون بين الاستشراق الذي يشتغل على النص، والأنثروبولوجيا التي تشتغل على مجتمع النص. هناك الآن ميل عام إلى استعمال سوسيولوجيا الإسلام أو أنثربولوجيا الإسلام بدل الاستشراق؛ إذ يتبرم بعض الباحثين الغربيين من وصفهم بالمستشرقين، وأعتقد أن باحثين مثل "أرماندو سالفاتوري" أو "براين تيرنر" يعملون على ترسيخ تقاليد متجددة لدراسة الإسلام.
د. حسام الدين درويش:
أنت تعلم أنه حتى عندما نتحدث عن الرؤية الأنثروبولوجية أو السوسيولوجية الفرنسية، فقد تناولت الأمر بمعنى ما من الناحية النظرية أو التنظيرية، وسمّيت استشراقًا في النهاية؛ لأن مفهوم الاستشراق لم يعد مفهومًا تحليليًّا بحتًا، بل تضخمت حمولته المعيارية (السلبية). نحن نعلم أن إدوارد سعيد هو أول من تناول هذا المفهوم، على الأقل بالمعنى المعاصر الذي صار يحمل طابعًا ازدرائيًّا أو تحقيريًّا، والممثل النموذجي لذلك الاستشراق، من وجهة نظر سعيد وغيره، هو برنارد لويس. ثم بعد ذلك، لدينا وائل حلاق، الذي وصف إدوارد سعيد بالمستشرق، معتبرًا عمله استشراقيًّا، مع الإشارة إلى أن هناك اتهامات أخرى. وهناك المختار الشنقيطي، الذي كتب عن الدولة الإسلامية المستحيلة ووصف وائل حلاق بالمستشرق؛ أي إن عمله استشراقي وخارج الإطار، وكل ذلك حكمٌ قيميّ. فكلمة استشراق أصبحت تهمة ومسبة أكثر من كونها كلمة واصفة، وهي أحيانًا موجهة لكل باحث غربي في مسائل "الشرق الإسلامي".
برأيك، هل هذه الثنائية بين الباحث الغربي والباحث العربي أو الباحث الآخر هي ثنائية زائفة؛ بمعنى أنها لا تحدد قيمة معينة؟ هل ترى أن هناك قيمة محددة يمكن نسبتها لهذه الثنائية، حيث نقول إن الغربي بالضرورة لن يفهم أو لن يؤمن، أو أن العربي أو الإسلامي كذلك، ام أن النسب لا أهمية أو دلالة له في هذا السياق؟
د. يونس الوكيلي:
بالطبع، كما قلت لك، في العلوم الاجتماعية عمومًا، المدرسة الغربية بشكل عام، سواء في الأنثروبولوجيا أو في الاستشراق، هي التي بدأت هذا التمشي البحثي في النظر إلى الإسلام والحضارة الإسلامية بشكل عام بأدوات مختلفة ومناظير متنوعة. وبالتالي، بقي عند إدوارد سعيد دائمًا أن هذا النوع من النظر إلى الإسلام استشراقي؛ لأنه مقدمة نحو الاستعمار، وكان يشكل نقاشًا واسعًا في هذا المجال.
بعد ذلك، وجدنا أيضًا أن الباحثين المحلّيين؛ أي الباحث المحلّي، بعدما تمكنوا من الأدوات ودرسوا هذه النظريات وانخرطوا في البحث وقرأوا، أصبحوا ينتجون معرفة حول مجتمعاتهم. فأصبح عندنا الباحث الغربي الذي ينتج أبحاثًا حول مجتمع آخر بوصفه الآخر، وأصبح الباحث المحلّي ينتج معرفة حول مجتمعه؛ أي البحث من الذات. وتشكل نوع من الاستقطاب الحاد في بعض اللحظات، لكني أعتقد أنه يجب دائمًا أن نميز بين التقاليد المختلفة.
د. حسام الدين درويش:
يعني، هذا الغربي ليس واحداً؛ أنت أشرتَ إشارةً معينة إلى الاختلاف بين التقليد الفرنسي والتقليد الأنجلوسكسوني، وربما يمكن أيضاً التمييز بينهما وبين التقليد الألماني. فالسؤال هنا: هل هناك شروحات حول أن "الآخر" ليس واحداً؟
د. يونس الوكيلي:
طبعًا، المدرسة الفرنسية في النصف الأول من القرن العشرين كانت رهاناتها إيديولوجية استعمارية. أنا اشتغلتُ أيضًا على هذا في كتاب الإسلام المغربي. هذه كانت المدرسة الأولى؛ أي كانت البداية مع "جورج سالمون" في البعثة الفرنسية في المغرب عام 1904، وكانت أبعادها دائمًا مونوغرافية، ثم جاء في الثلاثينيات والأربعينيات ضباط المكاتب الفرنسية، وكانوا أيضًا يشتغلون على تقديم تقارير تشبه الدراسات، والتي كانوا يرصدون فيها حركة الواقع والثقافة السائدة واتجاهاتها، وكانت تُقدَّم للإدارة الاستعمارية لتُوظَّف استعماريًّا، إلى غير ذلك. فهذه المعرفة كانت محدودة. حتى مثلًا، في التقليد الفرنسي، كان جاك بيرك معاديًا للفكرة الاستعمارية، وأنتج معرفة ذات قيمة بالنسبة إلى الباحثين حتى اليوم، وغيرُه من الباحثين الذين جاءوا بعده.
وعندما جاءت مثلًا المدرسة الأنجلوساكسونية -وهذا مهم جدًّا - في المدرسة الفرنسية، درس "إدموند بيرك" هذا في كتابه الدولة الإثنوغرافية، وقد سماها بهذا الاسم. وكان دائمًا يمتدح ما قامت به فرنسا من دراسات، دراسات هائلة، عشرات الآلاف من الأبحاث التي غطّت فعلاً العالم الإسلامي كله، وليس فقط المغرب. وكما يقول كاتب ياسين، فإن هذه الدراسات "غنيمة حرب"، لا يمكن أن نتجاهلها، بل يجب أن نتعامل ونتفاعل معها.
طبعًا، في لحظة من اللحظات، كان الباحثون المحلّيون ينطلقون من نزعة وطنية في انتقاد هذه الدراسات. لكن بعد مرور وقت طويل على الاستعمار، أصبح الباحثون يتعاملون مع هذه الدراسات ببرودة، ويستفيدون منها. أمّا المدرسة الأنجلوساكسونية، فكانت مختلفة تمامًا؛ إذ كانت رهاناتها منهجية، ولم تكن لها أهداف استعمارية، ولم تأتِ في هذا السياق، وكانت دراساتها أكثر رصانة وموضوعية.
ثم جاء بعد ذلك، الجيل المحلي؛ فأصبح هناك باحثون متعددون، مثل عبد الله حمودي، الذي انتقد المدرسة الانقسامية في نظرتها إلى القبيلة، وغير ذلك. كما انتقد الفرنسيين، لكنه في الوقت ذاته أعطى قيمة أكبر للملاحظة، وللمناهج التي وفرتها العلوم الاجتماعية عمومًا، والتي استفدنا فيها من الباحثين الغربيين بمختلف مدارسهم. كما أعطى قيمة أكبر للوثيقة المحلية، والتي كانت، من ناحية لغوية، يصعب على الباحث الأجنبي فهمها بدقة. فالباحث المحلي أعطى أهمية للوثيقة المحلية ولمعرفة الناس بواقعهم.
كان هذا تقليدًا في الأنثروبولوجيا؛ أي الاستماع إليهم بشكل أكبر؛ بمعنى أن الباحث لا يرى نفسه في سلطة أعلى من الآخرين. في السابق، كانوا يسمّونهم "مبحوثين"، وليس "مشاركين" في البحث، بينما هم في الحقيقة يشاركون في إنتاج المعرفة. مثلًا، "ديل إيكلمان" له كتاب حول "المعرفة والسلطة"، وقد تحدث عن هذا في كتابه المذكور، وهو كتاب اشتغل فيه مع قاضٍ يُدعى عبد الرحمن المنصوري، في إحدى المدن المغربية الصغيرة. ويؤكّد أن إنتاج الكتاب وإنتاج المعرفة كان على قدم المساواة بينهما. لم يعدّ عبدَ الرحمن المنصوري، الذي كان مصدره الرئيس في قراءة الوثائق العدلية وفهم حياة مثقف في وسط قروي، مجرد "مخبر"، بل قال: "أنا تعلّمت منه، وأنتجنا هذا الكتاب معًا." فبدأنا نلاحظ أن هناك عودة، سواء من الباحثين الأنجلوساكسونيين أو غيرهم - وحتى من المغاربة - إلى الثقافة المحلية، ومنحها قيمة، والنظر إليها من حيث إنتاج المعرفة. وأعتقد أن هذا كان له أثر كبير على الدراسات، واقترابها أكثر من الموضوعية، ومن الإنصات لهموم الناس، وما إلى ذلك.
د. حسام الدين درويش:
طيب، يعني، أنتم متهمون - بحق أو بغير حق - بأنكم فرانكوفونيون، لكن هناك اتجاه أنجلوفوني أيضًا. يعني، لديك توجّه واضح، في هذا السياق، لكن هذا ليس رأيًا ذاتيًّا تمامًا، بل هو مبني على معرفة بالأنثروبولوجيا، سواء الفرنسية أو الإنجليزية، وبالاختلافات بينهما.
إذا رجعنا إلى علاقتك بمؤمنون بلا حدود، متى بدأت هذه العلاقة؟ وما المشاريع البحثية التي أشرفتَ عليها أو اهتممت بها؟ ومن خلال رؤيتك لهذه المؤسسة، ما اهتماماتها البحثية أو المعرفية؟
د. يونس الوكيلي:
في الحقيقة، كنت محظوظًا بأنني رافقت مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" منذ تأسيسها؛ أي منذ عام 2012، بل حتى قبل ذلك، في مرحلة الإعداد لتأسيسها. أول ما كان لافتًا في هذه المؤسسة، هو أنها كانت تحتضن الاختلاف الفكري الموجود، ليس في المغرب فقط، بل في العالم العربي كله. وكان لدينا حرص على أن تظهر جميع الأصوات الفكرية داخل المؤسسة، وكان هذا الحرص نابعًا من قناعة راسخة لدينا. إذا راجعت أرشيف المؤسسة مثلًا في عام 2013، ستجد أن المؤسسة استضافت مفكرين من أقصى اليمين المتحرر إلى أقصى اليسار، بل حتى العلماء التقليديين، فقد استضفناهم في صالون "جدل" الذي كان تابعًا للمؤسسة، وفتحنا المجال أمام جميع أشكال الاختلاف بشكل حقيقي.
وفي الجانب العملي، اشتغلتُ لاحقًا إداريًّا داخل المؤسسة، فكنت رئيس قسم الدراسات الحداثية، ثم أصبحت منسق إدارة الأبحاث. أحيانًا، كان من الطبيعي أن يكون تواصلي مع الباحثين المغاربة فقط، لكنني كنت أحرص على إشراك الجميع، فاستعنّا بباحث تونسي، وباحث مصري، وآخر لبناني، وسوري. فكان هناك حرص دائم على تمثيل متنوع ومتوازن، وهذا الجانب منح المؤسسة مصداقية كبيرة. حتى من كان يتهمنا باتهامات معينة، كان في اليوم التالي يفتح قناة المؤسسة على يوتيوب أو يتصفح الموقع، فيجد ضيفًا من تياره الأيديولوجي. فكان هناك توازن، رغم أن بعض الأطياف كانت ترفض المشاركة.
هذا الانفتاح على جميع الحساسيات الأيديولوجية في العالم العربي، كان يقابله حرص من جهة أخرى على الرصانة في الإنتاج العلمي. أنا شخصيًّا أستخدم كثيرًا عبارة "الرصانة المعرفية"؛ لأنها بالفعل معبرة. كنا نعتمد تحكيمًا ثلاثيًّا لكل المواد، سواء كانت مقالات أو كتبًا أو دراسات. كل شيء كان يخضع للتحكيم، بشكل كبير ومنهجي.
أعطيك مثالًا: حتى المسابقة التي كنت أشرف عليها لثلاث سنوات، لم يكن فيها أي تدخل من جانبنا، ولا يوجد أدنى تفضيل. كانت هناك لجنة تحكيم تطّلع على النصوص دون أسماء أصحابها، وتكتب تقاريرها بناء على ذلك. كان العمل مهنيا شفافا كما تعتمده بروتوكولات التحكيم المتبعة في مؤسسات علمية مهنية.
إذن، كانت هناك رؤية منفتحة على الجميع، ومهنية في الاشتغال، وحرص على إنتاج معرفة دقيقة وعميقة، يتطلع إليها القارئ. وأعتقد أن جميع هذه الإنتاجات الموجودة حاليًّا في المؤسسة تشهد على ذلك.
د. حسام الدين درويش:
تمامًا، هنا يمكنني أن أطرح عليك سؤالًا يربط هذا الحديث بالحديث الأول الذي تطرقنا إليه، وهو مسألة وجود مقاربتين: من جهة، المقاربة الإيمانية اللاهوتية الدينية، ومن جهة أخرى، المقاربة العلمية.
يمكن أن نربط هذا بما يتعلق ﺑ "مؤمنون بلا حدود"، حيث يبدو - بشكل طريف أو غريب - أن المؤسسة تهتم بالفلسفة والعلوم الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى تهتم بالكتب الدينية أيضًا، ككتب التفسير وقراءات المصحف، والفكر الديني بتنوعاته.
إلى أي حد ترى أن هذه الخصوصية مفيدة للمؤسسة؛ بمعنى أنها لا تختزل الأمور في ثنائية: "الفلسفة ضد الدين" أو "الدين ضد الفلسفة"، بل تحاول تجاوز هذا التعارض؟ ونحن، في هذا العام، نركز بشكل أكبر على مسألة العلاقة بين الفلسفة والدين، فإلى أي مدى ترى أن هذه الرؤية مفيدة للمؤسسة وتُعطيها هوية معينة؟
د. يونس الوكيلي:
هو ليس مسألة جمع فحسب، بل هو فكرة المزج بين الدين والفلسفة والعلوم الاجتماعية، وهذا يبقى دائمًا رهانًا وأفقًا يصطدم به واقع التخصص المجزأ أصلًا داخل أكاديمياتنا في العالم العربي. فأنت، مثلًا، قد تحرص على الجمع بين العلوم الاجتماعية، لكن في نهاية المطاف، أنت منفتح على سوق لا يُنتج باحثين في الفلسفة أو في علم الاجتماع أو في العلوم الاجتماعية عمومًا، أو حتى في الدراسات الدينية. هذه كلها داخل الأكاديميات تُعامل كتخصصات متفرقة، ومن الصعب الجمع بينها. وقد كانت هناك محاولات - مثلًا في المغرب - ضمن ما يُعرف بالدراسات الإسلامية، وهي فكرة الجمع بين العلوم الإنسانية والبحوث الدينية عمومًا، لكنها في النهاية تحوّلت إلى "علوم إسلامية" فقط. وكذلك في تونس، كانت هناك تجربة مماثلة، ربما في الزيتونة.
كنا في مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، في البداية نحرص على هذا الجمع، لكن الأمر كان صعبًا جدًّا. أقصى ما كان ممكنًا أن نفعله هو جمع هؤلاء الباحثين في ندوة واحدة في فضاء للنقاش، حيث تحتضن هذه الندوة هذا الاختلاف: كيف ينظر باحث إلى الحداثة من داخل العلوم الإسلامية؟ وكيف ينظر إليها آخر من داخل الفلسفة؟ وثالث من داخل علم الاجتماع؟ فكنّا نحاول خلق نقاط تقاطع. وكان هذا من رهانات مؤسسة "مؤمنون بلا حدود": خلق النقاش، والحوار، والتداول، والتفاعل. فهي منصة للاختلافات بكافة أنواعها في هذا المجال، تعكس ما هو موجود أكثر من كونها تُنشئ واقعًا جديدًا.
د. حسام الدين درويش:
طبعًا، ليس المقصود هو "فلسفة دينية" باسم "مؤمنون بلا حدود"، ولا "دين فلسفي" بهذا المعنى، بل هي منصة لحضور جميع الأطراف: من علوم اجتماعية وفلسفة وغيرها. ونلاحظ أن مسألة الإصلاح الديني تقترب من الجدل الفلسفي، رغم أنها في الأصل مسألة دينية، لكن يمكن دائمًا إيجاد علاقات بين الطرفين. أنت تعرف مثلًا أن مفاهيم الفهم والتفسير والتأويل وما إلى ذلك، كلها تشكّل مجالًا مشتركًا. وحتى الاسم نفسه -"مؤمنون بلا حدود" - يعكس، بمعنى ما، هذه المسألة. فكلمة "مؤمنون" توحي بجانب إيماني، لكن "بلا حدود" تشير إلى أن الإيمان لا يقف عند المعنى الديني وحده، أو يمكن أن يُفهم أيضًا ضمن رؤية فلسفية. فكيف تعاملت أنت مع هذا الاسم؟ أو كيف فهمته؟ وإلى أي حد ترى أنه معبّر؟
د. يونس الوكيلي:
بالمناسبة، منذ عام 2011، كانت هذه التسمية دائمًا تُثير جدلًا؛ أي إنها تثير الجدل لدى كلّ من يسمع بها. فعندما تكون مع أهل الفلسفة، يتفقون مع "بلا حدود"، والمؤمن يتفق مع "مؤمنون". وأعتقد أن هذه التسمية في حد ذاتها كانت تُحدث جدلًا وتخلق حيوية معيّنة، وكان هذا هو رهان المؤسسة: أن تجمع كلا الاتجاهين، باختلافاتنا المتنوعة داخل كل طرف، في مكان واحد للنقاش. وبهذا المعنى، يمكن للدين أن يكون إنسانيًّا دينيًّا، وليس بالضرورة أن يكون هناك صراع بين الإيمان والحرية؛ فذلك صراع مفتعل في لحظات تاريخية معينة، ولكن من الممكن دائمًا أن يكون هناك تواصل بين الجانبين.
د. حسام الدين درويش:
أنت شهدت بعض النقاشات؛ لأنه حتى الآن تُطرح الأسئلة وما إلى ذلك، مثل: كيف "مؤمنون بلا حدود"؟ وبأيّ معنى؟ لكن، برأيي - من منظور تأويلي- أرى أن هذا غنًى كبير من الناحية التأويلية؛ أي إن هذا الجمع بين الطرفين جمعٌ خلّاق. سأُنهي لأنتقل وأسألك عن اهتماماتك البحثية حاليًا. كنت قد أخبرتني بها، وكانت مفاجأة سارّة، فأنت لا تنحصر- بمعنى ما - في قراءة المواضيع الإسلامية فقط، بل لديك الآن اهتمامات بحثية أوسع.
د. يونس الوكيلي:
لديّ اهتمامان بحثيان أساسيان؛ الاهتمام الأول حول السياسات الصحية العمومية في المغرب، ولكن من خلال نموذج بسيط، فرضته واهتممت به على ضوء ما حدث في عام 2020 من جائحة كورونا. فقد اهتممت بقضية ما يُسمّى بحالة الطوارئ الصحية، كحالة معيارية تُقرّر من قِبل منظمة الصحة العالمية، وتتبناها الحكومات الوطنية وتمارسها داخل مجتمعاتها.
هذه الحالة: إلى أيّ حدّ هي حالة معيارية؟ هل هي فعلًا "ثورة صحية" تصلح لجميع الناس؟ هل تستحق أن تُسمّى عمومية؟ مثلًا، عندما نقول: "الحجر الصحي"، هل عاشه الناس الذين يسكنون في أحياء راقية كما عاشه من يسكنون في دور الصفيح؟ الذين لا يتوفرون على سكن مناسب للحجر الصحي؟ أو ليس لهم حتى دخلٌ ثابت لكي يلتزموا بالحجر؟ إذن، لا بد من إعادة النظر في هذه السياسات الصحية المعيارية؛ لأن المستقبل هو مستقبل أوبئة، هذا أمر أكيد. كما جاء فيروس كورونا وفاجأ العالم، قد يأتي وباء آخر في أي لحظة، وقد تتوقف الحياة من جديد، وبالتالي سنُضطر إلى سياسات تكون ملائمة، ويجب أن نستفيد من دروس كوفيد-19. لا بد من الاستفادة منها، هذا هو الاهتمام الأول.
أما الاهتمام الثاني، وبالمناسبة فقد اشتغلت عليه بمنحة من "الصندوق العربي للثقافة والفنون" في بيروت، فهو مشروع له علاقة كبيرة بالعلوم الاجتماعية. يتناول كيف تجسّدت لنا المدينة، وبالأخص مدينة الدار البيضاء، من خلال الرواية الأدبية. سؤالي هو: هل يمكن أن نعدّ الرواية مصدرًا للمعرفة؟ بمعنى: كما يقوم المؤرخ أو عالم الاجتماع بدراسته الميدانية في المدينة، أعتقد أن الروائي، حتى من دون قصدٍ منه، وهو يكتب نصوصه الجمالية، يرصد مناطق لا يراها لا عالم الاجتماع، ولا المؤرخ في المدينة. أنا الآن أحاول أن أجمع هذه النصوص، وأن أستخرج منها رؤية للمدينة من خلال الرواية، وهي بالتأكيد ستكون رؤية جمالية بالأساس.
د. حسام الدين درويش:
ممتاز، لكن هنا نقول إن هذا يجمع بين الأنثروبولوجيا من جهة، والدراسات الأدبية من جهة أخرى. وهذا ليس نادرًا، رغم أنه يبدو طريفًا. حتى الآن، السؤال الذي أودّ أن أطرحه عليك هو التالي:
شيء جميل جدًّا، ما شاء الله، أنك لا تزال في مقتبل شبابك، ومع ذلك لديك هذه الحصيلة من النتاجات المعرفية الرصينة والمهمة فعلًا. لكن، نود أن نقول إنك منذ عام 2012 كنت أصغر سنًّا بكثير، ويُحسب لك بالفعل أن تكون في هذا الموقع، وفي هذا المكان، وداخل هذه المؤسسة. كيف حصل ذلك؟ بمعنى: لم يكن لديك اسم معروف أو مكانة بارزة في ذلك الوقت. صحّح لي إن كنت مخطئًا.
د. يونس الوكيلي:
أنا، لماذا قلت لك في بداية اللقاء إنني محظوظ؟ نعم، كنت محظوظًا. لكن في هذا الحظ جانب أساسي ومهم جدًّا، وهو هذه الرغبة أولًا في التمدد، في مدّ العلاقات مع الباحثين. هذا كان شغفي، كنت أشعر به. والجانب الثاني- وأعتقد أن هذا هو السبب في اختيار مسؤولي "مؤمنون بلا حدود" لي لتلك المواقع التي كنت فيها- هو أنني، كما أؤمن بالاختلاف، أمارسه؛ بمعنى أنه لم يكن يخطر ببالي أبدًا أن أقصي رأيًا لأنه مخالف.
وهذا كان منسجمًا مع الرؤية العامة لمؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، التي تسعى إلى أن تكون فضاء يلتقي فيه الجميع. وقد كنت دائمًا أحاول أن أكون عابرًا للإيديولوجيات، فأتعامل مع الليبرالي كما أتعامل مع اليساري، كما أتعامل مع الإسلامي. وحين نأتي إلى المؤسسة، نوفر فضاءً نتحاور فيه ونتناقش.
د. حسام الدين درويش:
طبعًا، لا شك في كفاءتك، لكن اختيار مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" لهذا الاسم، رغم أنه انطلاق من رؤيتها للكفاءة والقدرة والخبرة، فهذا أمر، لا أقول نادرًا، ولكن بمعنى ما، مميز.
د. يونس الوكيلي:
نزوعي التنويري كان دائمًا حاضرًا؛ فعلى سبيل المثال، أجريتُ حوارًا مع أبي القاسم حاج حمد في عام 2004، وكنت حينها في العشرين من عمري تقريبًا. وقد كان لديّ دائمًا ميل نحو الفكر التنويري، وانفتاح على مختلف الاتجاهات. يمكن القول إنني كنت عابرًا للأيديولوجيات إلى حدٍّ ما في مرحلة عمرية معينة؛ لم أكن أكتفي بالاستماع إلى دعاة اتجاه بعينه، بل كنت أقرأ أيضًا لمخالفيهم، وأتنقّل بين النظرية ونقيضها. وأعتقد أن هذا الأمر كان مفيدًا لي بدرجة كبيرة.
د. حسام الدين درويش:
والآن، اسمح لي أن أتحدّث باسم "مؤمنون بلا حدود"، رغم أنك الأقدر على الحديث باسمها. إنني، على المستوى الشخصي، سعيد جدًّا بالتعرّف إليك وبالحوار معك. وباسم المؤسسة أيضًا، أشكرك جزيل الشكر على كل ما قدمته لها من مساهمات، وعلى نتاجك البحثي المتميز. ونأمل أن يستمر التعاون بيننا، وأن يكون القادم أفضل بإذن الله.
د. يونس الوكيلي:
شكرًا جزيلًا لك، وشكرًا أيضًا على هذه الفرصة الجميلة للنقاش.