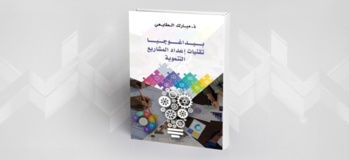المشهدية الأخروية في المخيال العربي الإسلامي
فئة : أبحاث محكمة

المشهدية الأخروية في المخيال العربي الإسلامي
ملخص البحث:
لطالما استرعت خصوبة الخيال الأخروي في الثقافة العربية الإسلامية الباحثين، واستوقفتهم روحه العجائبية المجنحة، وقدرته الخاصة على الإدهاش وإحداث لذة التعجب، وكفاءته في استخدام الرموز الموحية المثيرة للانفعالات. صاغ المخيال الأخروي في شكل أسطوري، عالما هو في الأصل غيبي لا مرئي، فشحنه بالرموز والتمثلات الحسّية، ليُجسم ما جردته العقيدة بفعل عفوية الخيال البشري فأكسبه مشهدية حيّة، جليّة الصور، عميقة الأثر في النفوس، شديدة الرسوخ في الذاكرة. فالميثولوجيا الأخروية وعاء تخييلي يحمل الدين والآلهة، بل هو شرط وجودها. لا يدعونا مخيال الآخرة العربي الإسلامي إلى التأمل إلا بمقدر ما يدعونا إلى المشاهدة والتورط في تجربة حسّية عجيبة تخاطب الحواس جميعها. وهو مخيال مشهديّ يضبط للفضاء تصميما وللعرض إخراجًا، مقدمًا مقترحًا جماليًّا لمتابعة مشاهد متتابعة ينتظمها منطق درامي متصاعد، خالقا فيها شخصيات تلعب أدوارًا.
المقدمة
أنتجت الثقافة العربية الإسلامية تراثا أدبيًّا أخرويًّا زاخرًا، حافلا بالخيال العجيب. وعرف هذا الأدب تطوّرًا وتراكمًا خلال عدة قرون، حتى بلغ درجة من الاكتمال في التصوّرات والأسلوب الفني. ساعدت عوامل عديدة في إثرائه؛ نذكر منها مركزية الآخرة في العقيدة الإسلامية، والانفتاح على تصوّرات الأديان الأخرى، والتسامح مع قواعد علم الحديث مما أتاح، في كثير من الأحيان، اعتماد ما لا أصل له من كلام الرسول كلما تعلق الأمر بالحديث عما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر. لقد ازدهر العجيب الأخروي؛ لأنه وجد بيئة ملائمة، فقد كان هذا الازدهار في مناخ الانحطاط والسقوط تحت نير الأجنبي. فكأن المسلمين لم يعودوا يرقبون شيئًا غير النهاية، وكأن الخيال العجيب يعزيهم[1]. وفي عالم مضطرب يتهددهم فيه الموت من كل جانب يصنعون عالما لا موت فيه. إنه عالم من التصوّرات تتحقق فيه فكرة العدالة الاجتماعية، فهو يفصح عن فكر تعويضي كما يقول حسن حنفي[2]، وقريب من ذلك ما سمّاه وحيد السعفي وسيلة دفاعية[3].
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على السمة المشهدية، والبُعد الفرجوي، بل والطابع المسرحي الكامن في الخطاب الأخروي العربي الإسلامي، انطلاقًا من فرضية أن نصوص الآخرة لا تقتصر على نقل معتقدات مجرّدة، بل تُقدمها من خلال تمثيلات حيّة تجمع بين العناصر البصرية والعناصر الدرامية. فالنصوص الأخروية، بطبيعتها السردية، تخلق عوالم بصرية قائمة على وهم الحضور، حيث تتجسد مفاهيم غير مرئية، كالجنة والنار، أو أهوال يوم القيامة، في مشاهد تامة التصوير مكتملة الرؤية عامرة بالحياة والحركة. إنها تنزع الموت عن العالم الأخروي إذ تسميه بعثا[4].
تشكل الأدب الأخروي من مادة النص القرآني والحديث النبوي أولا، وما لبث مفسرو القرآن أن راكموا في نصوصهم معانٍ متعددة المصادر، ليس أقلها الإسرائيليات التي تسربت لتفسير القرآن الكريم والأحاديث الموضوعة التي أثرت بدورها في تشكيل التصوّرات الأخروية. إلا أننا لن نهتم هنا بتتبع مصادر التصوّرات المعادية الإسلامية ولا بتاريخية تشكلها، ولا بما ترتبط به من مسائل كالثقافة الشعبية والثقافة العالمة. فما يعنينا هنا هو معالم المشهدية وخصائص الجسد والفضاء في بعض نصوص العصر الوسيط التي تأتى محتواها من النصوص المؤسسة مختلطا بغيرها من المصادر الشفوية، لتتحول إلى أدب إسكاتولوجي، لا بد أنه كان أيضا مادة للأداء في مجالس القص والوعظ.
سنكتـفي بالاعتماد على عدد محدود من المصادر المتأخرة التي بلغ فيها المفهوم الأخروي درجةً من النضج والاستقرار. تُعد هذه النصوص من أشهرها وأكثرها انتشارًا، وهي نصوص أفردت لموضوع الموت ويوم القيامة، مما قد يبرر اعتبارها أدبًا أخرويًّا، نذكر منها بالخصوص كتاب التذكرة بأحوال الموتى للقرطبي، والفتن والملاحم لابن كثير، وفيهما يجمعان مــا تفرق حــــول الموضوع في تـفسيرهما للقرآن الكريم، وباب ذكر الموت وما بعده من كتاب الإحياء للغزالي. وسنكتـفي بالإشارة إلى المراجع القرآنية في الهوامش لما للآيات القرآنية من حضور في هذه النصوص، لكننا لن نهتم بتخريج الحديث على حجم حضوره الكبير في النصوص؛ لأننا غير معنيين بالتصحيح والتجريح في هذا المجال. مع الإشارة إلى أن قدرًا لا يستهان به من الأحاديث الضعيفة والموضوعة يرد في هذه النصوص مكونًا أساسيًّا للمخيال الأخروي الإسلامي، ليعكس في نهاية الأمر رؤية مشهدية لبناء مخيالي جمعي ذي معالم أسطورية عجيبة، ينظمها منطق وترابط وتناغم.
Ⅰ- الخصائص المشهدية
عديدون هم الدارسون الذين لمسوا غزارة التخييل الإسلامي في أدب الآخرة. أشاد وحيد السعفي بثراء المخيال الأخروي وكثرة ألوانه وزخرفه[5]. واعتبر كريستيان جوبار أن "مسألة الموت في الإسلام قد مثلت مركز نشاط غزير للخيال".[6] فيما اعتبر الناقد والأكاديمي الانجليزي جون كايسي أن "للاسكاتولوجيا الإسلامية قدرة استثنائية على إيجاد صور بصرية آسرة لأفكار يصعب إدراكها."[7] أما كريستيان لانغ، فيذهب إلى أنها "أحد أكثر مجالات الخيال خصوبة في مجمل الفكر الإسلامي."[8] وذهب عزيز العظمة إلى أن النصوص الأخروية تصف الجنة بوصفها "عالمًا خياليًّا مذهلا"[9]. كان ابن الجوزي الذي عاش في القرن الثاني عشر الميلادي، وهو حافظ وواعظ كبير وذو باع في أدب الآخرة، قد عبّر عن اندهاشه من صفة الجنة وتحيّر عقله في كنهها مع إيمانه العميق بحقيقتها.[10] كانت مرجعيات المتخيّل الأخروي في الإسلام موضوع دراسات عديدة، تبحث في صلة هذا المتخيّل بمصادر سابقة للإسلام من أديان الشرق القديمة وترصد مقومات أصالته. ولا يسعنا إلا أن نقول مع الباحث بسام الجمل أن تفاعل المتخيّل الأخروي في الإسلام مع ما سبقه، إنما هو "تفاعل قائم بين المحاكاة والإبداع"[11] لا يكمن هذا الإبداع في نجاح المتخيّل الأخروي الإسلامي في صهر مرجعيات متنوعة لخلق نسخته الخاصة فقط، ولكن أيضا لكون هذه النسخة الخاصة تنسجم مع مبادئ العقيدة ومنظومة القيم التي تدافع عنها. امتازت الإسكاتولوجيا الإسلامية هذه ببنيتها السردية المتفردة في سرد للوقائع تترابط فيه الأفكار بشكل لافت، ويحلق فيها الخيال الغنيّ بالصور الحسية العجيبة دون حدود. وقد أوجز سيباستيان غونتر التعبير عن عبقرية السرد الفني في الأدب الإسكاتولوجي بقوله إنه "ثري الصور والرموز، ذو شعرية لغوية راقية، قائم على حجج وأدلة مستجدة التركيب، وكل ذلك مندرج في هياكل سردية راقية البناء تامة الصقل."[12]
كان سيد قطب قد كتب منذ الأربعينات كتابا بعنوان "مشاهد القيامة في القرآن"، أكد فيه الطبيعة المشهدية للتصوير القرآني للعالم الأخروي.[13] ولاحظ جومي في الخمسينيات أهمية الجانب التصويري للجزاء والعقاب في القرآن.[14] أما حديثا، فقد اهتم عزيز العظمة بفنيات السرد في نصوص الاسكاتولوجية، ووصف الجنة بأنها "فرجة طوباوية عظيمة"[15] وتحدث كريستيان جوبار عن السيناريو الفردوسي الذي ترسمه النصوص للمؤمن، بخلاف السيناريو الجهنمي الذي ينتظر غير المؤمن.[16] طبعا يمكن أن نذكر المزيد من أمثلة هذه المصطلحات المسرحية التي استخدمها دارسو الأدب الإسكاتولوجي الإسلامي، ولكنها أكثر من أن تحصى. إن حضور هذه المصطلحات يعكس المضمون المشهدي والدرامي الذي تحمله، والذي يبدو أقرب ما يكون من نصوص المسرح الديني مثل مسرح الأسرار والمعجزات. لئن لم تتحول هذه النصوص إلى مسرح في ثقافة لم تعرف المسرح، إلا أنها عرفت نوعا آخر من التمسرح الذي يقوم على الخطابة والحكي في مجالس الوعظ وخطب الجمعة. تبلورت تلك النصوص في شكل سلسلة من المشاهد التي تثير الاهتمام وتلفت النظر بكثافتها العاطفية والبصرية المذهلة. الأنبياء والملائكة والله ذاته، يتحولون إلى شخصيات رمزية، كل منها تلعب دورًا محددًا في ضرب من الدراما الكونية. وضمن إطار سردي متصاعد تخلق نوعا من التوتر الدرامي. على الرغم من عقيدة التوحيد الإسلامية المجرّدة إلا أن التصور الإسكاتولوجي الحسي ينجح في خلق سرد ملحمي وإرساء تصور إخراجي إلهي، ويحوّل القارئ إلى شاهد على الأحداث أو تغمره فيعيشها كتجربة مكتملة حسّيا وروحيا.
1. الغاية المشهدية
تقدم نصوص الإسكاتولوجيا الاسلامية أحداث يوم القيامة على صورة فرجوية بيّـنة من خلال مشاهد متتابعة زاخرة بالتصوير الحسّي والسمات الدرامية. ويظهر البعد التصويري في نصوص الإسكاتولوجيا الإسلامية في وصفها الدقيق للفضاءات والكائنات والأدوات مثل الصراط والميزان والصور وغير ذلك. فتحيط بصفة الموجودات وأعدادها وأحجامها وأبعادها وموادها وألوانها، وتحيط بصفة الكائنات وهيئاتها ومراتبها وأفعالها وأحوالها وحالاتها النـفسية. ونجد التصوير يستوفي كـــل مـــا يدرك بالحسّ، ومنه ما يُبصر كالفضاءات والكائنات والألوان، ومنه ما يُسمع كالصيحة والنداء والبكاء والصراخ، وما يُدرك بالشم كروائح أهل النار التي تكون نتنة وروائح أهل الجنة التي تكون مسكا، وما يُدرك بالذوق واللسان من أطعمة وأطياب لدى أهل الجنة وغساق وطعام ذي غصة لدى أهل النار.
صيغت أحداث يوم القيامة بوصفها مشاهد، وكثيرًا ما تؤكد النصوص أن الغاية من الأحداث الجارية هي كشفها وإبرازها وعرضها على الملأ. وقد نص القرطبي في التذكرة على أن أرض المحشر المسماة بالساهرة[17] إنما هي كذلك لأن الناس "لا ينامون عليها"[18]، فهم مستيقظون طوال الوقت بغاية المشاهدة. وأنكر القرطبي في موضع آخر أن يكون الناس عند قيام الساعة وحدوث الانقلاب الكوني الهائل في حالة موت؛ لأن الغاية من ذلك أن يكونوا أحياء، فينظرون ما يحدث من العظائم فيهالهم ذلك ويفزعهم.[19] وتستهدف فروجوية القيامة تحقيق التغابن بأن يغبن أهل الجنة أهل النار، وأن يبرز فضـل المؤمنين، وأن ينفضح الكفـار وتظهر مساويهم ويتحقق خزيهم. ولولا الغاية المشهدية لما كان من مسوغ لأن تظهر القيامة في النصوص مصورة، متسلسلة أحداثها موصوفة فضاءاتها.
وكثيرًا ما يتواتر ذكر أهمية أن يكون الحدث على الملأ. ويذكر القرطبي أن وزن الأعمال يتم بهدف إظهار فضل المؤمنين، وإذلال الكافرين. يقول القرطبي: "إنما توزن أعمال المؤمن المتقي لإظهار فضله، كما توزن أعمال الكافر لخزيه وذله. فإن أعماله توزن تبكيتا له على فراغه وخلوه من كل خير، فكذلك توزن أعمال المتقي تحسينًا لحاله وإشارة لخلوه من كل شر وتزيينا لأمره على رؤوس الأشهاد."[20] وينال النبي إبراهيم السبق في الكساء عند البعث، مكافئة له على صبره على العري عند رميه في النار، وتكون تلك المكافئة على الملأ. يقول القرطبي: "و جزاه بذلك العري أن جعله أول من يدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد."[21] وتؤكد الملائكة أن الغاية من بعث الحيوانات ليست الحساب البتة، إنما هي شهودها لحساب الكفار فيتعاظم بذلك خزيهم، بأن تكون الحيوانات متفرجة على فضائحهم. قالت الملائكة للحيوانات: "إن الله لم يحشركم لثواب ولا عقاب، وإنما حشركم تشهدون فضائح بني آدم."[22]
2. التهيئة الفرجوية للفضاء
يجري تهيئة الفضاء في يوم القيامة ليشهد عرضا فرجويًّا بالغ الضخامة، فالانقلاب الكوني الشامل والفناء الذي يحل إنما يتم ليعقبه تشكل فضاء جديد سيكون مسرحًا لأحداث عظام تشهدها كل الخلائق. بعد البعث مباشرة يتبدى معالم هذا الفضاء. إنه فضاء واحد ذو سطح دائري لا تضاريس فيه، إنما هي أرض المحشر "بيضاء، قاع صفصف لا ترى فيها وعوجا ولا أمتا، ولا ترى عليها ربوة يختفي الإنسان وراءها، ولا وهدة ينخفض عن الأعين فيها، بل هو صعيد واحد بسيط، لا تفاوت فيه."[23] ويضمن هذا الفضاء الذي تجتمع فيه كل المخلوقات في زحام شديد "ليس للإنسان فيها إلا موضع قدميه"[24] مكشوفين متساوين. ويظهر أيضا أن أرض المحشر دائرية الشكل "كقرصة النـقي"[25].
ويتشكل فضاء القيامة بطريقة مركزية دائرية، حيث تنفتح أقسام الفضاء بعضها على بعض مع التزام مراتبية المنازل. يكون الناس محشورين على متن جهنم، [26] التي تكون كذلك محيطة بهم من كل الجهات باستثناء جهة واحدة تؤدي إلى الجنة. ويكون الصــراط هــو الجسر الذي يعلو بــوابـــة الجحيم، ليمتد إلى أبواب الجنــان. وتكون الملائكة قد سدت أقطار الجو لازمة مصافها حسب ترتيب السماوات التي تنتمي إليها، ويشرف الله على كل ذلك من فوق، وهو على عرشه. وفضـــــاء الحـــدث المركزي هنا هو الوسط التي تحدث في الأحداث وتشد إليه الأنظار. وهو ما بين الجنة والنار، حيث يقف الناس ليسائلهم ربهم ويحاسبهم، وحيث يُنصب الميزان لوزن صحف أعمالهم، فترفع لهم ليقرؤوها. وفي هذا الفضاء المركزي تقع كل الأحداث الفرجوية المهمة مثل عبور الصراط، وكذلك مشهد الأعراف وذبح الموت[27] وكلاهما يتم على سور بين الجنة والنار.
3. الطقوسي والاحتفالي في مشاهد القيامة
ذكرنا أن تهيئة الفضاء وتشكيله في القيامة يكون مشهديا بغية التعبير عــــن دلالات رمزية، ولكن المشاهد وأحداثها، والفضاءات وأقسامها، والأدوات المستخدمة وغيرها من الموجودات والكائنات كلها تكتسي قيمة احتفالية وتخضع لوظائف طقوسية. فضروب التحيّز في الفضاء (علو-سفل) (يمين-شمال) والتفاوت في المنازل وفي القرب من الذات الإلهية، وغير ذلك من الوسائل المستخدمة في الحساب كالميزان وصحائف الأعمال كلها تتحول إلى أدوات تستخدم لتحديد المنازل والمراتب في النهاية.
والتطهير من أجلى مظاهر الاحتفال الطقسي التي نراها في مشاهد القيامة، فنجد أن فضاء الحشر الذي خلق لتوه على أنقاض العالم الدنيوي قد جُعل نقيا طاهرا "لم يُسفك عليه دم حرام قط ولم يُعص الله عليه قط"[28]، ليكون فضاءً طاهرًا للحساب الأخير. والحساب نفسه بما فيه من سؤال وتخاصم ووزن أعمال وقراءة صحف وعبور للصراط، إنما هــو سلسلة طـقـــوس تستهدف التطهير، ليتحقق الفـصـــل الـتـــام بين الطـيـب والخبيث، فتكون الجنة خالصة للخير وجهنم خالصة للشر. ومن طقوس التطهير ما يكون مائيًّا، شأن طقس غسل المؤمن عند موته، تأتيه ملائكة الرحمة بكفن وحنوط من الجنة لتغسيله، بخلاف الكافر الذي تأتيه ملائكة العذاب بكفن وحنوط من النار. ويخضع عصاة المؤمنين لضربين مــــن التطهير أحدهما ناري والآخر مائي، فهم يُعذبون في النار حتى يستكملون عقوبة ما عليهم من ذنوب، فإذا خرجوا من النار اغتسلوا في نهر الحياة الذي يمحوا عنهم آثار الاحتراق ويهيئهم لدخول الجنة. ويحضر في القيامة أيضا طقس تضحية وافتداء يماثل نظيره الدنيوي، ذلك أن الموت يُذبح في نهاية الحساب على سور الجنة على هيئة كبش أملح، في مشهد تكمن رمزيته في إعلان الخلود وانفصال الخير عن الشر. وتكمن احتفاليته في زيادة أفراح أهل النعيم وزيادة أحزان أهل الجحيم.
وتتنوع المواكب ومراسم الاستقبال في القيامة، كما تتعدد فضاءاتها ومناسباتها. وخاصية هذه المواكب أنها دائما استهلالية ترتبط باستفتاح مشهد جديد وفضاء جديد. وللذات الإلهية في القيامة ثلاث مواكب؛ أولها يتم بعد قيام الساعة وفناء كل المخلوقات، "فيطوف الله وحده في البلاد وقد خلت عليه العباد [...] ويهتـف بصوته ثلاث مرات: لمن الملك اليوم ؟ فلا يجيبه أحد فيجيب نفسه تعالى: لله الواحد القهار."[29] وهو موكب يحتـفل فيه الله بمجده منفردا متفردا بخلوده. وبعد بعث المخلوقات جميعها وحشرها في الموقف أربعين عـــامـــا أو أربعين ألف عام ينزل الله في أعظم مواكبه مشرفًا على الكون من عليائه، متجلية عظمته في عِظم ملائكته المالئين آفاق السماوات لازمين مصافهم في انضباط بروتوكولي مهيب، وهم "محدقين بالخلائق منكسي رؤوسهم لعظيم يومهم قد تسربلوا أجنحتهم ونكسوا رؤوسهم بالذلة والخضوع لربهم."[30] ويرافق الموكب الإلهي نشيد تقديسي يلقيه حملة العرش؛ ذلك أنهم ينشدون و"العرش على مناكبهم لهم زجل من تسبيحهم سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان ذي الملك والملكوت سبحان الحيّ الذي لا يموت سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت سُبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى رب الملائكة والروح الذي يميت الخلائق ولا يموت."[31]
أما الضرب الثالث من الموكب الإلهي، فهو يتم في فضاء الجنة وحدها؛ أي إنه موكب خاص بأهل الجنة وهو موكب دوري يتم كل يوم جمعة. وخاصية الدورية في هذا الموكب متفردة في فضاء الفردوس، وهي تعمق البعد الطقوسي من ناحية، وتكسي الزمن الخالد بمعنى التجدد والتواتر. ويمتاز هذا الموكب الإلهي الذي يُسمى أيضا بالزيارة الإلهية وبسوق الجنة باحتفاليته الصاخبة. وفيه يُسبغ الله النعم على أهل جنته حتى يبلغوا تمام الفرح وذروة السعادة. فيبدأ بالأعطيات النفيسة من تحف وخلع وطيب ويزيدهم حسنا وجمالا، ثم يُشرف عليهم فيرونه مباشرة رأي العين، ويزيدهم من نعمه عليهم فيُعلن رضاه الذي يعقبه سخط وتلك أجلُّ الأعطيات الإلهية وأغلاها. ويكتمل للموكب الإلهي ألقه واحتفاله فيحفل بالغناء والموسيقى، وينال منه أهل الجنة أثرا من السحر والوجد والطرب حد الذهول، "فتعزف المزامير المعلقة في أشجار الجنة الألحــان وتغني الحور العين بأجمل الأصوات تمجيد الجبار حتى تطيش العقول من الطرب والوجد [...] ثم يتلو الرب سورة الرحمان فإذا سمعوا قراءة الحق جل جلاله غابوا عن الوجود وطربت الأملاك والحُجُبُ والستــور والقصور والأشجار، وصفقت الأوراق، وغردت الأطيار، وتماوجت الأنهار طربـًـا لقراءة العزيز الجبــــار، واهتز العرش طربًا ومال الكرسي عجبًا، ولم يبق في الجنة شيء إلا واهتز حنينا واشتياقا إلى الله تعالى."[32] يرى جوزيف فان إس أن ظهور الله لأهل الجنة جرى إخراجه مسرحيا بما يذكر بظهور الخليفة العباسي في مناسبات معينة من وراء الستارة، في مشهد يلعب فيه الله دور الملك في حين يلعب أهل الجنة دور الجمهور الذي يتوجب عليه لزوم الصمت واحترام مراتبية معينة في بين أفراده.
"سنتخيّل [الله] من هنا فصاعدا كملك لقومٍ من عالم آخر. ولذلك، لم يعد السعداء يقتربون منه كما كان آدم يفعل في ما مضى، لكنهم على الأقل يستطيعون إدراكه في الرؤية. تم تصوّر هذه الرؤية بوصفها عرضًا مسرحيًّا، حيث ترتفع صفوف من المقاعد كتلك التي تكون في مدرّج العرض، وأفضل المقاعد محجوزة لمن كانوا أكثر ورعًا في حياتهم الفانية. يجلس الله خلف ستار، وهذا الستار يرتفع من حين لآخر. كما يبدو فإن الرؤية الطوباوية لا تدوم إلى الأبد، بل تُمنح على فترات متقطعة. نحن أمام موكب استقبال ملكي، حتى الخليفة العباسي كان يجلس خلف ستار عندما يزوره مبعوث أجنبي ("سفير خاص"). ولكن بخلاف أي موكب استقبال رسمي، لا أحد يتبادل الحديث في الجنة"[33].
Ⅱ- أقسام الفضاء وسماته
1. الفضاء وأقسامه
يقوم التصميم المعماري[34] لعالم القيامة على انقسام حاد بين محورين أساسيين هما محور العلو والسفل من ناحية ومحور اليمين والشمال من ناحية أخرى. لذلك نجد فضاء الجنة بوصفه فضاء الخير والنعيم مندمجا مع السماوات؛ ذلك أن الجنة "عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ"[35] لا يعلوها إلا عرش الرحمان. والجنة أيضا هي على يمين النار دلالة على معاني اليمن والبركة. أما جهنم، فهي فضاء سفلي مندمج في الأرض وطبقاتها السبع، وهي كذلك على شمال الجنة دلالة على الشؤم. أما على مستوى السعة والضيق فالجنة فضاء واسع جدًّا، ومن أمارات اتساعه عِظم الموجودات فيه التي تأخذ أبعادا فلكية مثل المسافة بين دفتي أحد أبوابه التي تماثل المسافة بين مكة وهجر.[36] ومن شواهد اتساع مجال الجنة أيضا حركة أهل الجنة الحرة الطليقة التي لا تكاد تحدها حدود، فأهل الجنة يتراءون لبعضهم البعض كالنجوم والكواكب، [37] ويسير الراكب في ظل أحد أشجار الجنة مائة سنة لا يقطعها.[38] وعلى النـقيض من ذلك، فإن فـضاء جهنم السفلي فــضاء للضيق والظلمــة والاحتباس. ولا تشتمل جهنم إلا على فضاءات التعذيب التي تمتاز بضيقها وعمقها مثل أودية الويل، ولملم، والغيّ[39]، والحفر مثل جب الفلق وجب الحزن.[40]
ولفضائيْ الجنة والنار فضاءات داخلية تخضع بدورها لمحوري العلو واليمين. فالجنة درجات تميّز ساكنيها في ارتفاع منزلة بعضهم على بعض وصولا إلى جنة الفردوس التي هي محل الذات الإلهية ومسكنه. ويكون دخول الجنة عبر أبوابها الثمانية[41] التي يكون الباب الأيمن منها أفضل الأبواب. أما النار، فتنـقسم إلى دركات؛ أي إن منازلها تتمايز في الانخفاض والسفل، ولا يكون الدخول إلى جهنم إلا سقوطا أثناء عبور الصراط. ويعبر الكافرون "فتتلقفهم الزبانية بالخطاطيف والكلاليب"[42] "فتعلوا أرجلهم وتسفل رؤوسهم"[43] فمدخل جهنم عبارة عن حفرة أو هو فوهة عظيمة. أما الأبواب، فهي داخلية يفضي كل قسم من أقسام العذاب إلى القسم الآخر.
وبين الفضاءات العليا اليمينية وتلك السفلى الشِمالية، نجد فضاءات تتوسطها لتحتل مكانًا مركزيًّا في الوسط. وخاصية هذا الفضاءات الوسيطة أنها مؤقتة توجد لوظائف معينة، ثم ينتفي ذكرها بخلاف الفضاءين الدائمين. أولى هذه الفضاءات هو مستقر الأرواح المسمى البرزخ، وهو حاجز يتوسط عالمي الدنيا والآخرة. وفيه يتعرض الأموات لفتنة السؤال، فينال المؤمنين نصيبـا مـــن ثوابهم المستحق لينفتح برزخهم على الجنة. وفيه ينال الكفار نصيبًا جزئيًّا مــــن عذابهم المستحق، فينفتح برزخهم على جهنم. وليس لبرزخ المؤمنين وبرزخ الكافرين من اتصال فيما بينهما، ثم لا يعود للبرزخ من وجود لانقضاء الدنيا وزوال ثنائية عالم الغيب والشهادة. أما أرض المحشر وهي الأرض التي يُجمع فيها الناس ويُعرضون ثم يُحاسبون، فهي كذلك فضاء وقتي لإجراء الحساب الأخير؛ إذ سيغيب ذكرها بعد انتهاء مهمتها. ويبدو أن أرض المحشر ليست بمعزل عن الفضاءين الدائمين، فأرض المحشر هذه على متن جهنم[44] ويبدو أحيانا أنها هي نفسها الصراط الذي يعبر فوقه الناس بعد الحساب.[45] ونجد أن الفضاء الذي يتوسط الجنة والنار هو مسرح الحساب والتخاصم. فميزان الأعمال يُنصب بين يدي العرش بين الجنة والنار، وتكون كفة وزن السيئات كفة ظلمة من تلقاء جهنم. أما كفة وزن الحسنات، فتكون كفة من نور من جهة اليمين أي الجنة.[46] وبحذاء الميزان نجد أيضا صحائف الأعمال التي يُكلف البشر في حسابهم أن يقرؤوها على الملأ. أما الجسر الذي يعبره الناس بعد الحساب، فيمر بعضهم إلى الجنة ويسقط بعضهم الآخر في النار، فهو جسر ممدود فوق فوهة جهنم، [47] وهو أيضا فضاء مركزي في مشاهد القيامة. وسيغيب هو أيضا في النهاية عندما تملأ جهنم بالكفار، فيدخل الله فيها قدمه لتنغلق نهائيًّا على أهلها.
وبمضي الحدث نحو النهاية في مشاهد الحساب، نلاحظ أن أخريات الأحداث التي تقع قد انحصر مجالها أكثر فأكثر بين الجنة والنار، في حين أن أرض المحشر والميزان وصحائف الأعمال قد غابت تماما في الظلام. فآخر الناجين يكون رجلا يمشي فوق الصراط يكبو ويتعثر، فيدنيه الله من الجنة ويرفع له أشجارًا ثم يأذن له في دخول الجنة أخيرًا.[48] ويتم ذبح الموت في مكان ما بين الجنة والنار، حيث يرى أهل الدارين ذلك المشهد إعلانا لخلود الحياة دون أن نعلم الحيّز الذي يتم فيه هذا الحدث؛ إذ يبدو أحيانا أن ذبح الموت يتم على الصراط[49] وأحينا أخرى على سور الذي يفصل الجنة على النار[50]. ويبقى أصحاب الأعراف أولئك الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم يمشون بين الجنة والنار يأتيهم شيء من برد الجنة وشيء من لهيب النار، فهم على سور الجنة حتى يُنعم الله عليهم بدخول الجنان. فكأن المجال قد انحسر في النهاية بين الجنة والنار، ولم يعد من مجال آخر بينهما أو فضاءات أو سواهما، ذلك أنهما الداران الباقيتان. وسور الجنة هو الحاجز المتبقي الذي يفصل بينهما، وسوف نرى أن بهذا السور كوى تمكن أهل الجنة من رؤية أهل النار في عذابهم ومخاطبتهم.
2. سمات الفضاء
-أ- الترابط بين الفضاء الدنيوي والفضاء الأخروي
لاحظ كريستان لانج أن التصوّر الإسلامي يربط الفضاءين الأخروي والدنيوي بصلات ووشائج، ويجعل بينهما قربًا في الزمان والمكان، [51] ويجعل بينهما تشابكا، [52] وينتهي إلى القول بتلاشي الحدود بينهما.[53] يتضح من خلال وصف مشاهد القيامة أن تصوّرًا أسطوريًّا متناغمًا يربط الفضاء الدنيوي بالفضاء الأخروي. فالكائنات الغيبية القائمة على نظام الكون تتخلى عن تلك المهمة عند قيام الساعة. لذا يحصل ذلك الاضطراب الشامل، ومنه أن النجوم تسقط من أيدي الملائكة الموكلين برفعها عند موتهم.[54] وحقيقة كون الماء مبعث الحياة ذي أصل سماوي يتجسم من خلال الصلة بين العالمين في أصل أنهار الدنيا الكبرى (النيل، الفرات، سيحان، جيحان) أنها تنبع من أنهار الجنة.[55] وفي بعض الأحيان يتجسم هذا الترابط بين عالمي الدنيا والآخرة بشكل أكثر تداخلا، من ذلك الاعتقاد أن أرض المحشر المسماة بالساهرة[56] أيضــا هي أرض بالشام.[57] ونلمس هذا التداخل بأكثر جلاء عندما يتعلق الأمر بمستقر الأرواح أو البرزخ الذي هو حاجز بين العالمين، فالغزالي يذكر أن مستقر أرواح المؤمنين "بالجابية، المقصود زمزم خير بئر في الأرض"[58]. أما مستقر أرواح الكفار، فهي "سبخة بحضر موت شر واد في الأرض [...] بئر ماؤها أسود كأنه قيح، تأوي إليه الهوام."[59]
-ب- مادة الأشياء
تمثل جهنم رمزا للشرور التي جُمعت وفصلت عن الخير تحقيقا للعدالة الإلهية، لتكون فضاء العقوبة عن الأفعال المحرمة التي ارتكبت في الدنيا. وتكتسب النار حقيقتها مـــن أعمال الإنسان الآثمة، فهي عين آثـــامــه التي تتحول نارًا وعذابا؛ ذلك أن أهلها هم وقودها. كما أن تشكّل فضاء الجنة وما فيه من آيات النعيم "يحصل بأعمال بني آدم الصالحة"[60] كذلك فإن جهنم "تسعر بخطايا بني آدم التي تقتضي غضـب الله."[61] وتتعيّن جهنم في قيعان الأرض، وينحدر اسمها من الأصل العبراني الذي يدل على البئر البعيد القعر، يقول ابن منظــور "بئر جَهَنـّم وجِهنـّم وجِهِنـّام [...] بعيدة القعر."[62] وتظهر نيران الجحيم كصورة مضخمة مضاعفة عديد المرات للنيران الدنيوية المعروفة، ذلك أن نار الجحيم تعادل سبعين ضعفا من النار التي يوقدها الإنسان.[63] وتتصف النار بالسواد في لونها وبالنتن في رائحتها وبالضيق في مجالها، فهي متكونـــة من أوديــــــة وشعاب وكهوف وحفر. ويدخل الشمس والقمر في جملة النار ليغيب عنها الضياء، وينتفي دورة الزمــــن ويصبح الحال تكرارا دائما للعذاب، وليكون الجرمان السماوايا معبودا بعض المشركين شريكان لهم في العذاب لا يغنيان عنهم شيئا. وتتكون جهنم من الناس الذي يكون بعضهم أحد زواياها، ويملأ القيح والصديد الذي يسيل من أجسادهم أوديتها وكهوفها، ومن الحجارة التي تتكون منها الجبـــال والكهوف والمـــغـــاور، وتتساقط على رؤوس أهل النار وترضخها. وتمتاز حجارة جهنم بسرعة احتراقها وعِظم التهابها وكثرة دخانها.[64] وكل مكونات الفضاء قابلة للاشتعال، فأرض جهنم "الرصاص، وسقفها النحاس وحيطانها الكبريت"[65] وترمز الحجارة للأصنام التي منها تتخذ الآلهة المتعددة، لتــكـــون قرينـــة للمشركين في عذابهم.[66] وتستحيل النار مادة للأودية ومنها تتكون شجرة الزقوم، ومنها أثاث أهل جهنم من فرش وأغطية[67] ومن النار المشتعلة تتكون وسائل التعذيب وأدواته، من أغلال وسلاسل ومقامع الحديد.[68]
أما الجنة، فليست فقط فضاء للخير والنعيم الدائم المشمول بالحضور الإلهي، ولكنها معرض هائل للأشياء النفيسة ومظاهر الفخامة والرفاهية. وكما يقول عزيز العظمة: "إن كل ما في الجنة يتوفر ببذخ لا حدود له."[69] وتبدو الجنة حديقة يانعة يملأها النخيل والأعناب والأنهار، يمثل فيها الماء والنبات رمزًا للحياة والخلود.[70] وهي بالغة الاتساع والرحابة خالية من كل عناصر النجاسة والتلوث. وفي هذه اللوحة النباتية التي تأخذها الجنة، تقوم كل مكوناتها وعمائرها من أنفس المواد وأجودها، وأكثرها دواما وأطيبها ريحا. فالتراب من زعفران والقصور من ياقوت ومرجان، وحصى الأنهار من لؤلؤ وجذوع الأشجار من ذهب.[71] بخلاف ما ذهب إليه جوزيف فان إس، من أن اللون الأخضر رمز الإسلام هو كذلك لون الجنة[72]؛ لأنها حديقة عامرة بالنباتات فإننا نجد عدة نصوص إسكاتولوجيا تذكر أن الجنة بيضاء اللون. فالبياض رمز الطهارة والنـقاء هو اللون الغالب على الجنة وعلى الكثير من مكوناتها، كأرضها[73] ومائها[74] وبعض رواحلها.[75] ويشكل النور مادة بعض موجوداتها، مثل كراسي المؤمنين التي يجلسون عليها. وتتحول نورانية الجنة إلى شفافية تطبع ماديتها، فيبدو أرضها الفضية البيضاء شفافة كالمرآة[76]، أما غرف الجنة، فيُرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. وبهذا التشكيل النوراني الشفاف الذي يطبع مادية الجنـة قارب المخيال العربي الإسلامي صورة "ما لا عين رأت وأذن سمعت ولا خطر بقلب بشر."
-ت- الأبعاد الفلكية
تجري أحداث يوم القيامة في الكون جميعا، لذلك نجد الاضطرابات المؤذنة بالفناء تشمل كل أجزاء العالم من سماوات[77] وأرضين[78] وجبال[79] وبحار[80]، وكل أركانه الصلبة الثابتة التي كانت تشكل معالمه وترعى نظامه، ليشهد الكون إعادة خلق جديدة. وتنسحب الخصائص الفلكية لأبعاد الفضاءات التي تمثل مسارح أحداث يوم القيامة من أرض المحشر وجنة ونار، فتكون الجنة بعرض السماوات والأرض وتكون النار مستوفية لغور الأرضين السبع، فيهوى الحجر من أعلاها إلى قعرها خلال سبعين خريفا. وكذلك تنسحب الأبعاد الفلكية على الأدوات المستخدمة في يوم القيامة، فنجد الصور الذي يُنفخ فيه لإعلان قيام الساعة بالغ الضخامة، بحيث يكون "عِظم دائرة فيه كعرض السماوات والأرض."[81] وذلك أيضا شأن ميزان الأعمال الذي له لسان وكفتان، "و إن كل كفة منهما طباق السماوات والأرض."[82] وتبدو الملائكة كالأجرام السماوية والكواكب في علوها وضخامة أحجامها وتألق نورها، فيكون "بين مشفري أحدهم مسيرة مائة عام."[83] أما صاحب الصور إسرافيل "فكأن عيناه كوكبان دريان"[84] ويتـفرد أهل النار دون أهل الجنة بجسامة أبدانهم التي تتضخم جراء النار والتعذيب، فيبلغ حجم الكافر في جهنم أن يكون أحد زواياها، وضرسه مثل جبل أحد، و"غلظ جلده مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع."[85] إننا في عالم "تحرر من القيود الأرضية للزمان والمكان واندفع فيه الخيال إلى أقصى حد"، كما يقول كريستيان لانغ[86]. ولكن من الواضح أن أبعاد الفضاء الأخروية تتخذ لنفسها مرجعية فلكية أو كوسمولوجية شاملة. فالآخرة إذ تجعل من الكون جميعا مسرحا لأحداثها، تضخم أجسام الملائكة وبعض الأشجار لتجعلها موافقة لسلم هذا المسرح الضخم.
-ث- التشعّب
من أهم معالم العجيب في فضاءات القيامة وموجوداتها وكائناتها تشعّب صورها. وصفة ذلك التشعّب عِظم الشيء في حجمه وكثرة مكوناته وتنوع موجوداته، بحيث يبدو كسلسلة من العناصر المتراكبة بعضها يحتوي بعضها الآخر بصورة سمتها الكثرة والتنوع. من ذلك صورة قصر ساكن الجنة، فهو "قصر من لؤلؤة، في ذلك القصر سبعون داًرا من ياقوتة حمراء في كل دار سبعون بيتًا من زمردة خضراء، في كل بيت سبعون سريرًا، على كل سرير سبعون فراشًا من كل لون، على كل فراش زوجة من الحور العين، في كل بيت سبعون مائدة، على كل مائدة سبعون لونا من الطعام، في كل بيت سبعون وصيفا ووصيفة، ويُعطى المؤمن في كل غداة من القوة ما يأتي على ذلك كله أجمع."[87] فالموجوات النـفيسة تتوالد كاشفة باطراد عن عالم من النفاسة المختبئة في الدور والغرف، وينسحب ذلك التوالد وذلك الاطراد على الألوان التي تصاحب الزمرد والياقوت.
ولا يشذ فضاء جهنم عن مبدأ التشعّب؛ إذ تبدو الفضاءات الكثيرة المتماثلة محتوية على فضاءات أخرى أصغر منها كأنها تتوالد منها لتطّرِد كثرة وتنوعا. ففي "جهنم سبعين ألف واد في كل واد سبعون ألف شعب في كل شعب ألف ثعبان وسبعون ألف عقرب لا ينتهي الكافر والمنافق حتى يواقع ذلك كله."[88] وينطبق ذلك أيضا على الحيّات التي تعذب الكافر في قبره فيكون أعدادهـــا "تسعة وتسعون حيّة لكــــــل حيّة سبعة رؤوس."[89] والملاحظ من خلال المثالين السابقين، وهو ما يهم فضاء الجنة وفضاء النار على حد السواء، أن توالد الكثرة في كل فضاء جديد نلجه من خلال الوصف ينسحب على الأشخاص كالحور العين والوصيفات انسحابه على المكونات التي تؤثثه من غرف وموائد. فتلك العناصر مجتمعة تشكل صورة الفضاء، ويعمق هذا النمط في تصوير الفضاء التناقض بين الجنة والنار، تأكيدا للقدرة الإلهية على خلق ألوان النعيم وصنوف العذاب حد الإذهال.
-ح- الزمن في مشاهد يوم القيامة بين التعاقب والتكرار
يبدو عالم القيامة عالما لا زمنيًّا، فهو يأتي بعد نهاية الأزمان وزوال سنة التحول والدورية التي نعرفها في الدنيا. كما لا نجد فيه آليات احتساب الزمن، ذلك أن الشمس والقمر يُجمعان ويدخلان في النار ليصبحا في جملة مكوناتها، وفي المقابل فإن عالم يوم القيامة هو عالم الخلود والبقاء الأبدي. وتخضع الأحداث في يوم القيامة إلى نظام الترتيب والتسلسل، فينتهي حدث ليعقبه حدث جديد، فيُنـقر في الصور أولا إيذانا بنهاية العالم وموت كل المخلوقات، ثم يُنـفخ فيه للبعث، ويتلوه الحشر ثم العرض ويبدأ الحساب. وتدور أحداث يوم القيامة في خمسين ألف سنة، [90] بما يدل على تطاول الزمن في هذا اليوم، لكن هذا الزمن ليس إلا زمنا نفسيا؛ إذ يشعر الكفار بتطاول الزمن، وهم يُحشرون ممسوخين يُسحبون على وجوههم، يُلجمهم العرق إلجاما، وتُنكل بهم ملائكة العذاب. فيما يتقاصر إحساس المؤمنين بالزمن، فلا يشعرون أن طول يوم القيامة يتجاوز أداء صلاة[91]. واللافت للانتباه أن إشارة زمنية يتكرر ذكرها في مشاهد يوم القيامة للدلالة على المدة الفاصلة بين انقضاء بعض الأحداث وبداية أحداث أخرى. فنجد أن المدة الفاصلة بين نفخة الصعق ونفخة الفزع أربعون سنة[92]، وأن المطر ينزل من تحت العرش قبل البعث أربعين يوما[93]. ويمتد انتظار الناس للحساب في أرض المحشر "أربعين سنة أو أربعين ألف سنة"[94]. ونحن لا نجد دلالة مخصوصة لهذه المدة سوى مُضي قدر طويل من الزمن خاصة أنها غير محددة، فهي أحيانا أربعون يومًا وأحيانا أربعون سنة وفي أحيان أخرى تكون أربعين ألف سنة. ويتكرر ذكر هذه الإشارة الزمنية في مشاهد الجنة والنار لتصوير التناقض بين حال أهل الدارين. فساكن الجنة لا يتحول عن متكئه الوثير حتى يطوي سبعين سنة[95]، فيما ساكن النار تلدغه عقرب فيجد ألم لدغها أربعين خريفا، أو يهوي من جبل "صعود" مقدار أربعين عاما. واعتبر عزيز العظمة "الزمن في الجنة معدوما"[96] فاستدامة اللذة واندماج الرغبة مع تحقيقها قد أفضى إلى تجميد النشاط في لحظة أبدية. والمبدأ نفسه ينطبق على الجحيم، ولكن الزمن يتجمد على لحظة تعذيب قصوى.
Ⅲ - التشخيص
التشخيص من أهم السمات المشهدية في عالم القيامة، ففضلا عن الذات الإلهية والملائكة التي تكون فاعلة متكلمة، نجد أن الجمادات والأعضاء والأعمال كلـهـا تشخص لتصبح متمتعة بالوعي قادرة على النطق، بـــل وكذلك لها انفعالات نفسية. فعند إعلان قيام الساعة تستمهل الأرض وقتـــا لتنوح على نفسها وتبكي القمر والنجوم. وعند البدء في الحساب يؤتى بجهنم على هيئة كائن بشع "لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها"[97] وهي تزفر وتتـغيض، ثم يخرج منها عنق ساطع مظلم يتوعد "هذه جهنم التي كنتم توعدون"[98] (سورة ياسين 63) وبعد ملئها تقول: "تَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ"[99] وتحضر الحيوانات والوحوش فتحشر مع الناس، فتسجد لله وتحمده أنه لم يجعلها مكلفة أو معنية بالحساب.[100] وعند إنكار العبد الكافر لذنبه تبرز أعضائه التي اقترفت تلك الذنوب لتعترف بها وتـقر، فتكون الأعضاء أنطق مــــن الألسنة، فتتكلم الأيـدي والأرجل والجلود.[101].
ولدى القبر تأتي الميت أعماله وقد استحالت شخوصا، فإذا كانت أعماله طيبة صالحة، أتاه آت حسن الوجه والثياب فيهنئه على صنيعه ويبشره بالجنة[102]، وتتحول العبادات من صلاة وزكاة وحج إلى شخوص تذود عنه وتحميه كلما أتاه الملكان من جهة فتقول: "ما قبلي مدخل"[103] أما العبد الكافر، فإن آتيه يكون "قبيح الوجه منتن الريح، قبيح الثياب، فيقول: أبشر بسخط من الله وبعذاب مقيم."[104] وتتحول آفاته وخصاله الذميمة إلى من كبر ورياء وحسد إلى ثعابين لها سبعة رؤوس تخدشه وتلحسه وتؤذيه[105].
وفي ختام أحداث يوم القيامة يُذبح الموت على هيئة كبش أملح، لإعلان الخلود لساكني الجنة والنار. وقد عبّر القرطبي عن فهمه الرمزي لهذا التشخيص بقوله: "لا يتحول الموت إلى كبش؛ لأنه الموت عرض ومحال تحوله إلى جوهر."[106] وقــــد وجدت رجاء بن سلامة في وصف الكبش الرامز لموت بأنه أملح؛ أي إن به سوادًا وبياضا، دلالة الفصل النهائي بين الخير والشر[107].
1. الذات الإلهية
لن نجد في مشاهد يوم القيامة صفة الذات الإلهية التي يبدو حضورها طاغيا في الأحداث، تنزيها لها عن التشخيص والتجسيم. ولكن هذه الذات المطلقة في تعاليها والتي ينبغي أن نتمثلها في أرقى سوامق التجريد لا تبدو في المخيال الأسطوري الأخروي إلا ذات شخصية، فهي الشخصية الأبرز فاعلية في الأحداث، بل إن كل ما يقع من تدبيرها، وهي التي سطرت تفاصيله وكتبت له نصه. ورغم أنه لا يعتد في عرف المفسرين والكلاميين وسواهم من علماء الإسلام بالمعاني التي تخلع الصفة الجسدية على الذات الإلهية من قبيل استواء الرحمان على العرش[108] أو يد الله[109] أو غير ذلك، لدلالتها المجازية لكن هذه المجازات اللغوية التي تقوم على التصوير تنتهي بأن تعطي للذات الإلهية هيئة نتمثلها بها، هي على صورة الذات البشرية، فللعرش وحملته وصف مادي في النصوص ويدا الله مذكورتان بأن كلتيهما يمين. والاستعارة الإنسانية الأبرز المستخدمة في تصوير الذات الإلهية، هي صورة الملك الذي يبرز في أبهته تحيط به أجناده من الملائكة في موكب جليل، فيحكم بين الناس بأمره، فيُنعم ويُهلك حسب مشيئته. وتكون الذات الإلهية متكلمة ناطقة، تشارك في الحوار تخاطب ويقف الأنبياء بفنائها وعند عرشها فتجيبهم، وتحتجب عن الكفار فلا يرونها ولا تقبل لهم وساطة أو شفاعة.
وتتجلى عظمة الذات الإلهية وجلال شأنها في الوقائع الجسام التي يشهدها اليوم عندمـــا تزلزل الأرض[110] وتنسف الجبال[111] وتتناثر النجوم[112] وتكوّر الشمس[113] لتصبح وردة كالدهان[114]. وتتحول الجبال إلى هباء منبث[115] كالعهن المنفوش[116] وتسجر البحار نيرانا موقدة[117]. فذلك الاضطراب الكوني الشامل المؤذن بنهاية العالم، هو من تدبير الله الذي كتب الفناء على كل مخلوقاته، ليتفرد هو بالخلود. وما يلبث كون جديد أن يتشكل هو بدوره فائق العِظَمِ بأحجامه وأبعاده، فالجنة عرضها السماوات والأرض[118] وجهنم مستوفية لسعة الأرضين السبع. وتظهر العظمة الإلهية في عظمة الملائكة التي يكون لها أحجام فلكية، فيكون "بين مشفري أحدهم مسيرة مائة عام"[119] ويبلغ من كبر حجم الملائكة أن يرى الناس موكب نزولهم من السماء، فيظن بعضهم أن الله واحد منهم[120]. ومن أمارات العظمة الإلهية المتجلية في ذلك الموكب، عدد الملائكة البالغ الكثرة مع التزامهم بانضباط محكم في النزول، والمحافظة على المراتبية ولزوم الصمت وإظهار الخوف والإجلال؛ ذلك أن الملائكة يكونون "محدقين بالخلائق منكسي رؤوسهم لعظيم يومهم قد تسربلوا أجنحتهم ونكسوا رؤوسهم بالذلة والخضوع لربهم"[121].
لا يعني ما سبق ذكره، أن الذات الإلهية ممتنعة من كل وصف وتجسيم قابل للرؤية العينية؛ ذلك أن الحالة الأخروية تقتضي سعادة قصوى ينالها أهل الجنة بتحقق رؤيتهم لله بصفة مباشرة. ويكون لهذا التجلّي الإلهي صفة كونية فلكية، فالناس يرون ربهم يوم القيامة كرؤيتهم للقمر؛ أي إن رؤية الله يوم القيامة أشبه برؤية كوكب منير يطل من السماء. وغاية تجسّم الذات الإلهية في الفضاء بصورة تدركها أبصار السعداء، أن تكون نورا متجليًا في الأعلى. فصفة الله المتعالية أنه على عرشه الذي يعلو الفضاءات جميعا ويكبرها جميعا في الحجم والمساحة. ومن عرشه الذي هو فوق الجنة [122]وسدرة المنتهى يشرف الله على أحداث يوم القيامة إشرافا مباشرًا ابتداء من إفناء الدنيا انتهاء بالحساب الأخير متفردا بالمجد. ويظهر في مختلف المشاهد الحوارية التي تجمعه بالملائكة وبالأنبياء وبغيرهم من البشر مخاطبا، فيتوجه بالسؤال مستخبرًا، مجيبًا لدعاء النبي وطلبه الشفاعة، مثنيًا على أعمال الصالحين ومهنئًا لهم بالفوز العظيم، مُبكتا للكفار آمرًا الملائكة بإلقائهم في النار، بل نجد لله أحوالا كالغضب والرضا، ونجده في بعض المواقف مازحا ضاحكا.[123]
2. الكائنات الغيبية: الملائكة والشياطين
في ظل تصور ديني يحصر الألوهة في تصور تجريدي لإله واحد متعال تجتمع عنده كل دلالات القداسة على نحو غير قابل للتجسيم ومنزه عن كل الصفات المادية يكون "مفهوم الإله العظيم الواحد الذي يكمن فيه جوهر الدين هو في الأساس غير أسطوري. وليس على الكائن الأسمى أن يعرف الأحداث ولا محفزاتها. إنه يقبع في معزل عن الأفعال –خارج الحكاية- بعيدا عن تشابك الأعمال."[124] ولكن الخطاب الأسطوري يكتسب غنـــاه مـــع تصور مــــادي ما للألوهة له خصائص مادية قابلة لأن تكون موضوعًا للتخييل من خلال الصور؛ وذلك الكون الأسطوري الديني غير قابل للتحقق دون أن تتعدد أنظمة تصور الألوهة متجسدة في كائنات أخرى تنازع الإله سلطاته وأخرى تساعده.
الملائكة كائنات عظيمة قوية مقتدرة على تصريف شؤون الكون ورعاية نظامه، ولذلك فهي تبدو كأجنـــاد ووزراء يُعهد إليها بتنفيذ المشيئة الإلهية، أو كالحاشية المقربة من الملك، وهي تعمر أقطار السماوات السبع التي تلي العرش في مراتبية لا يمكن خرقها. وهي كائنات مجبولة على الطاعة لله لا تعرف العصيان، تصور دائما بوصفها كائنات نورانية عظيمة الجرم ذات أجنحة. وتختلف أشكالها باختـلاف مراتبها ووظــائـفـهــا. وملائكة جهنم كغيرهم من الملائكة هم كائنات من نور، يسكنون النار دون أن تؤذيهم؛ لأن عنصر النور يغلب عنصر النار زبانيتها. وفيهم بأس وغلظة واقتدار لا يفترون عن التعذيب والتنكيل، وهم متصفون بأبشع الصور الباعثة على الارتياع ورئيس خزنتها التسعة عشر[125] واسمه مالك "رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت راء يحش النار ويسعى حولها."[126] فيهم بأس شديد وغلظة. ولا تظهر حركة ملائكة النار إلا كحركة الجــلاديـــن والزبانية يتخطفون الكفار عند مرورهم على الصراط، ويكبلونهم بالأغلال فيجمعون نواصيهم إلى أقدامهم[127] ويسوقونهم ويسحبونهم ويضربونهم[128] ويصبون عليهم الحميم. وبالإضافة إلى ضروب التعذيب الجسدي يعذبونهم تعذيبا نفسانيا فيؤنبونهم ويذلونهم ويسألونهم مبكتين: "أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ"[129] ولكن زبانية ليست مجرد آلات تعذيب، بل هي شخصيات واعية وهي لا تعذب إلا تنفيذا للأمر الإلهي، ورغم خلوها من الرحمة فهي مثلا تمنع النار من أن تأخذ مواضع السجود من عصاة المؤمنين.
وللقبر ملكان يظهران للموتى في قبورهم "لاستخراج سرّهم بالسؤال، ولتمييز الخبيث من الــطيب."[130] هما فتـّانا القبر ولهم اسمان يدلان على النكر هما منكر ونكير، وكذلك منظرهما هو منكر بشع يبعث على الفزع والارتياع "أسودان أزرقان"[131]، لصوتهما دوي شبيه بدوي الرعد ولبصرهما وميض كوميض البرق[132]، لهما أنياب "كالصياصي، يخرج لهب مـــن أفواههما، ومناخرهما ومسامعهما، يكسحـــان الأرض بأشعــــارهمـــــا، ويحفران الأرض بأظفارهما مع كل واحد منهما عمود حديد."[133]
لسادة الملائكة وكبرائهم هيئات جسمانية ذات أبعاد فلكية، فعندما يُنزلون عرش الرحمان إلى المحشر تمهيدا للحساب الأخير تكون "أقدامهم على تخوم الأرض السفلى، والسموات إلى حُجزهم"[134]. وورد في صحيح مسلم أن للملاك جبريل "سبعمائة جناح يسدّ عظم خلقه ما بين السماء والأرض."[135] أما إسرافيل فله "قوة سبع سماوات [...] وسبع أرضين، [...] وله من تحت قدميه إلى رأسه شعور وأفواه وألسنة، وتلك الألسنة مغطاة بالأجنحة، كل لسان يسبّح لله تعالى بألف لغة[...] ومن عظم إسرافيل أنه إذا صب ماء البحار والأنهار والعيون على رأسه ما وقعت على الأرض منها قطرة منها."[136] والملك إسرافيل صاحب الصور الذي ينفخ فيه إيذانًا بقيام الساعة، هو أحد أعظم الملائكة حجما وقوة له "أربعة أجنحة جناحان في الهواء وجناح قــد تسربل بــه وجناح على كاهله"[137]. فله هيئة جسمانية تضارع الكون بسماواته وأراضيه قوة وحجما، بما يوافق وظيفته ذلك أنه يحمل الصور وينفخ فيه، والصور نفسه عظيم الحجم، حتى إن "عظم دائرة فيه كــعرض السماوات والأرض"[138] والملك إسرافيل هو أبدا في وضعية استعداد للنفخ في الصور، فهو جاث على إحدى ركبتيه محني الظهر، مضاما جناحيه[139] "واضع الصور في فيه شاخص إلى العرش ببصره."[140] وللملك إسرافيل أهمية كبرى في أحداث يوم القيامة؛ لأن مهمته تتمثل في النفخ ثلاث مراث مرات في الصور، تؤذن كل نفخة بطور من أطوار يوم القيامة.
أما الشياطين، فهي رمز الشر والنجاسة، التي تعادي الإنسان وتستهدف تضليله وتزين له المعاصي لتوقعه في الذنوب والمحرمات الموجبة للعقوبة الأخروية. وللشياطين أب مؤسس هو إبليس الذي عوقب بالطرد من الملكوت الإلهي لاستكباره، أما أجناده وذريته فهم القرناء الذين يلازمون الناس في حياتهم، وعند بعثهم ليكونوا شهودًا على ذنوبهم وشركاء لهم في عقوبتهم. والشيطان كائن ناري؛ ذلك أنــه خـــلـــق مـــن نـــار. وترتسم له صورة الكائن الممسوخ المنظر المقبح الشكل، ذلك أنه مُسخ عند استكباره ورفضه السجود لآدم.[141] فنزل إلى الأرض وهو "مشتمل الـصّـمّــاء عليه عمامة أعور في إحدى رجليه نعل"[142] يذكر الثعلبي أن إبليس عندما نزل الأرض كان على رأسه خطاطيف يخطف بها عقول البشر وفي أقدامه خلاخيل يحركها للإنسان حتى يغريه بالغناء[143]. لن نجد تقريبا شيئا من صفته الجسمانية يوم القيامة سوى خصوماته مع سكان الجحيم. وتبرز بشاعة منظر الشيطان في تشبيهه طلع شجرة الزقوم الجهنمية بـــرؤوس الشياطين الـــوارد في القرآن الكـــريم.[144] وللشيطان صورة كونية تجعله متربعا على عرش فوق الماء، [145] وله قرنان تطلع بينهما الشمس.[146] ومن أعظم الملائكة عزرائيل ملك الموت، وهو يبدو في صورة كائن عظيم الخلق هائل المنظر، وهو من الضخامة، حيث تكون "الدنيا بين ركبتيه، وجميع الخلائق بين عينيه، ويداه تبـلغـان المـشـرق والمغرب"[147] ومع أن دور ملك الموت هو الإماتة إلا أن المخيال الديني ينسب إليه أدوارًا في الإحياء، تعكس في النهاية حقيقة الموت وجه آخر للحياة. فعزرائيل هو الذي استطاع أن يأخذ طينا لازبا من تربة الأرض ليُخلق آدم، بعد عجز ميكائيل وجبرائيل عن القيام بهذه المهمة.[148] كما أن له دورا في الإشراف على بعث الناس من القبور. وبعد انتهاء الحساب ودخول الناس إلى مستقراتهم النهائية يتوجب على عزرائيل أن يتذوق طعم الموت، ليتحقق الخلود لأهل النار والجنة على السواء. وبذلك فقط يــعـــاني الكفار عذابات كعذابات النزع والاحتضار دون أن يكون لهم موت.[149] ويأتي مشهد موت ملك الموت في صورة طقسية قربانية؛ إذ يتم تشخيص الموت عندئذ على هيئة كبش أملح يتم ذبحه.[150]
3. البشر
لأجساد المؤمنين في الجنة صورة الخلقة الإنسانية الأولى، كأنموذج للمثالية والاكتمال.[151] والاكتمال الفزيولوجي المذهل؛ [152] إذ تبدو عظيمة في حجمها، ، بطـــول ستين ذراعـــا وعرض سبعة أذرع شاكلة آدم، وفي عمر شباب دائم في الثلاثين، [153] راجعة إلى أبعادها الأصلية في بيئتها الأصلية. وهي أجساد تم تأهيلها بـــقـــدرات وطاقات فائقة على المتعة الحسية، لا تعرف المرض أو التعب[154]، أو الحاجة إلى النوم.[155] كما تم تطهيرها من كل عوامل الخبث والنجاسة، فهي أجساد نزعت منها كل سوءات الجسد الإنساني الدنيوي. وتقنيات جسد ساكن الجنة هي تقنيات ممارسة اللذة والبطالة المترفة، فهي تنقل بين خدور الحور العين، وتقلب بين مجالس قصف ومتكآت وثيرة، [156] وموائد عامرة بألوان الأطياب مــــــن مأكـــول ومشروب. وصنف من النساء لسن من أهل الدنيا، هن الحور العين، ولكنهن من أهل الجنة خلقن فيها ليكن كائنات طرب ومتعة. ورغم طبيعتهن الأنثوية ووظيفتهن الجنسية، إلا أنهن منطبعات بمــا يســــم الفضاء الفردوسي ومكوناته من نورانية وشفافية، يُرى مخ سوقهن من خلال أجسامهن كما يُرى السلك في قصبة الياقوت.[157]
وتبدو أجساد الكفار في مشهدية القيامة مشوهة ممسوخة، معطلة الحواس عن الإبصار والسمع والنطق، أما وجوههم، فتكون سوداء. وللتحريق والتعذيب في النار أثر في تعظيم أحجامهم، حيث يكون "ما بين منكبي الكافر في النار، مسيرة ثلاثة أيام، للراكب المسرع."[158] ويصبح ضرسه في عظم جبل أحد، ويبلغ من حجم بعض الكفار في النار أن يكون أحد زواياها. وتشوه النار الوجوه فتتقلص الشفة العليا حـــتى تـــبـــلــغ الـــرأس، وتسترخي الشفة السفلى حتى تبلغ السرة[159] وتشوه الأجسام فتكون اللحوم ساقطة عـــلى الأعـــقـــاب، [160] وتكون الجلود منسلخة على الأبدان من أثر ملابس القطران، والصديـــد السائــــل عليهم. وتكون أدمغة بعضهم سائلة من مناخرهم، وألسنة بعضهم مجرورة ورائهم، ويجر بعضهم الآخر أمعائه.[161] أما حركة هذه الأجساد في فضاء النار فهي حركة الانقياد والخضوع والمفعولية منـقادة بأيدي الملائكة التي تسلط عليهم صنوف التعذيب والتنكيل. فأجساد الكفار تهوي في النار أثناء عبورها للصراط فتتخطفها خطاطيف بأيدي الملائكة[162] ويُزج بهم في الأدراك السفلية حيث الكهوف والمغور وحفر النار والتوابيت الحديدية الحامية. فتُسحب الأجساد على الوجوه، وتكبّل الأطراف بالأغلال والسلاسل، وترضخ الرؤوس بالحجارة ويُصب عليها الحميم، وتقطع الأشداق بالكلاليب، وتضرب الوجوه والأدبار بمقامع الحديد.[163] وتخضع أجساد الكفار إلى أنواع من التعذيب الذاتي تسلطها على نفسها، من خلال أفعال اضطرارية كأكل طعام الضريع ذي الغصة تحت تأثير الجوع الشديد، وعدم إساغته إلا بالشرب من الحميم، وهو الصديد العكر الأسود المنـغسل من أجسادهم.[164] وتتقلب أجسادهم بين الأوضاع المؤلمة كالهروب من النار المحرقة إلى الزمهرير الذي تنتقض منه العظام، [165] وتكرار الأفعال العقيمة كتسلق جبل صعود، [166] وقتل النفس بالحديد أو الخنق أو شرب السم.
وللبشر صورة جسمية أخرى يأخذونها في فضاء البرزخ هي صورة الطير. ففي مجـــال يتوســـط عالم الدنيا والآخرة تستقر الأرواح - وهي تنتظر البعث - في شكل طيور تكون جسما لها. أما أرواح المؤمنين فتكون في أجواف طير بيض[167] أو خضر[168] والطير جسما للأرواح هي صـــورة لحريـة حـــركتهـا وخفتها وسرعتها وتحليقها. وعلى العكس من الطائر الذي هو روح المؤمن الذي يسرح في الجنة ويحصل فيها رزقه، تكون أرواح الكفار في أجسام طيور سود، "تأكل من النار وتشرب من النار وتأوي إلى جحر في النار."[169]
يُسمّي حسن حفني توافق الجزاء مع الأفعال "بقانون الاستحقاق[170]"، ويصفه بالقانون الشامل الذي يتصف بالدوام والثبات[171] انسجامًا مع فكرة العدل الإلهي، مؤكدا على أنه على طبيعته الأخروية؛ ذلك أن "الثواب والعقاب لا يكونان استحقاقًا إلا في الآخرة[172]". ويعرف قانون الاستحقاق طريقة إلى التطبيق منذ البعث، متجسدًا في الهيئة الجسمانية للبشر الذين جرى إحيائهم. يخضع الناس في هيئاتهم وأحوالهم ومنازلهم لثلاثة عوامل أساسية تحدد وضعهم في يوم القيامة هي مبدأ التوافق بين العمل والجزاء، ومبدأ المراتبية، ومبدأ التعويض.
-أ- مبدأ التوافق
هذا المبدأ هو صورة للعدل يتجلى من خلال موافقة أحـــــوال الناس يـــوم القيامــة وهيئاتهم وصورهـــم، وضروب النعم التي ينالها المؤمنون وأصناف العذاب التي ينالها الكافرون، للأعمال التي اجترحوها في الدنيا فاستحقوا بها مصيرهم. وأول صور التوافق تظهر في بعث العبد على ما مات عليه، فيكون الصنيع الذي ختم به حياته هو نفسه الصنيع الذي يستهل به دخوله على الآخرة. فيُبعث الشهيد في دمائـــه وريحــه المســـك، [173] والذي مات محرما يُبعث ملبيًّا.[174] ويُبعث المؤذن وهو يؤذن.[175] وكذلك شأن من ماتوا وهم يقترفون المعاصي، فيُبعث السكران سكرانا يوم القيامة، [176] وتخرج النائحة عند مبعثها "شعثاء غبراء عليها جلباب من لعنة الله ودرع من نار يدها على رأسها تقول: يا ويلاه ويا ثبوراه ويا حزناه."[177] أما أكلة الربا فيخرجون عند مبعثهم وقد ربت بطونهم وعظمت وثقلت مما أكلوا من أموال الحرام فيسقطون في مشيهم.[178] ومن وجوه ترافق أحوال الكفار عند البعث مع أعمالهم وذنوبهم، أنهم يُمسخون وتُعطل حواسهم وتُقطع أعضائهم. فيُحشر النمّامون على صورة القردة، وأهل السحت والحرام على صورة الخنازير، ويكون المختالون المعجبون بأعمالهم عميا بكما والعلماء الذين يخالف قولهم عملهم يمضغون ألسنتهم والذين يؤذون جيرانهم مقطعة أيديهم وأرجلهم.[179] وفي الموقف عند انتظار فصل القضاء، حيث يكون الحر والزحام شديدين ذلك أن الشمس تكون "قاب قوسين"[180] منهم يكابد الكفار محنة العرق، فيأخذهم العرق على قدر أعمالهم أيضا إلى الركبتين وإلى الحقوين، وإلى الفم وإلى أنصاف الأذنين، ويلجم بعضهم إلجاما.[181] وفي فضاء جهنم نجد الأمر نفسه، حيث تأخذ النار أهلها بما يوافق أعمالهم إلى الكعبين، والركبتين، والسرة، والصدر.[182]
كذلك نجد توافقا بين الأعضاء والذنوب التي اقترفتها في مشهدي الحساب والعذاب، فتتكلم الأعضاء مقرة بالأعمال عندما تنكر الألسنة، ويُسلط العذاب في النار على الأعضاء سواء بسواء. ولا يشذ حال المؤمنين عن مبدأ التوافق بين أعمالهم وجزائهم المستحق، فهم ينالون درجاتهم في الجنة على قـــدر أعمالهـــم الصالحة. وتذود عنهم أعمالهم الصالحة في القبور عند السؤال من تلقاء أعضائهم، فتأتي الصلاة من جهة الرأس لتحمي المؤمن في قبره عندما يهم به الملك من تلك الجهة. وعند دخول المؤمنين إلى الجنة، فهم يدخلون من الأبواب التي توافق العبادات التي كانوا يواظبون عليها في الدنيا، فيدخل المواظب على الصلاة مــــن بـــاب الصلاة والمواظب على الصيام من باب الصيام...إلخ ونجمل قولنا في مسألة موافقة الجزاء للأعمال في مشاهد يوم القيامة في كونها تتجلّى على ثلاثة أوجه، في حال الإنسان وهيئته وصورته وفعله الذي يقوم به، وفي ما يناله من الجزاء تعذيبًا وتنعيمًا، وفي تحيّزه في الفضاء علوًا وسفلا ويمينًا وشمالا.
-ب- مبدأ المراتبية
تبدو فضاءات القيامة كفضاءات متمايزة، تخضع لمراتبية عمودية تحدد المنزل الإنسان، حيث تتوافق مع العمل الموجب لها. وتقاس هذه المراتبية بالنظر إلى قربها من محل الذات الإلهية وهو المحل الأرفع، لذلك نجد الأنبياء والصديقين في الفردوس الأعلى أقرب ما يكونون من الله، ويبدو أحيانا أن الفردوس فضاء يجمع الله بالأنبياء. ويجتمع أهل الجنة في منازلهم في شكل مجموعات لا تداخل بينها، فيكون الأنبيـــاء مــــع الأنبيــــاء، والصديقون مع الصديقين. وتنطبق المراتبية على الملائكة؛ إذ يلتزم كل صنف من الملائكة موقعه في أطباق السماوات السبع، ونرى ذلك في مشهد عروج أرواح المؤمنين إلى السماء بعد موتها، حيث يستقبلها كل صنف من الملائكة في موقعه من السماء التي هو من أهلها. وكذلك تحتفظ الملائكة بمراتبيتها في موكب نزول الجبار لفصل القضاء، فينزل أهل السماء الأولى يليهم أهل السمــــاء الثانية وهكذا. ويكون أهل الجنة في فضاء نعيمهم في درجات فيرى أقلهم منزلة أرفعهم منزلة كـمـــــا تُـــــرى النجوم والأقمار. وحتى في الصور الذي هو مجمع الأرواح عند نفخة البعث، فإن الأرواح فيه تكون في منازل متمايزة "فيه من الأبواب بعدد الأرواح، وفيه سبعون بيتا واحدا منها لأرواح الأنبياء وفي واحد منها أرواح الملائكة، وفي واحد منها أرواح الجن وفي واحد منها أرواح الإنس، وواحد منها أرواح الشياطين وفي واحد منها أرواح الحشرات والهوام والنملة إلى تمام سبعين صنفا أعطاه الله إسرافيل عليه السلام."[183] ويكون لهذه المراتبية أحيانا تفصيلات أدق تفصل بين أفراد المنزلة الواحدة، ليكون داخل نفس المنزلة مراتبية خاصة. ويظهر ذلك بين الأنبياء؛ إذ يتـفاوتون في حجم أحواضهم ونفاسة أوانيها وعدد وارديها.
أما فضاء النار وهو المحل السفلي المحجوب عن الله، فتتدرج منازله نزولا، ولذلك سُميت مراتبه دركات بخلاف مراتب الجنة التي سُميت درجات. والنار سبع دركات يظهر أن مراتبيتها قيست بمدى البعد عن الدين الإسلامي، وأعلى الدركات جهنم وهي مخصصة لعصاة المؤمنين، تليها لظى للنصارى، ثم سقر لليهود، والحطمة للصابئة، والجحيم للمجوس، وسعير للمشركين، وتكون الهاوية أسفل الدركات محل المنافقين.[184]
كما أن منازل الناس متراتبة في فضاءات القيامة، فإن المراتبية تظهر أيضا في مراتبية الجزاء الذي ينالونه وفي أحوالهم في أرض المحشر وأثناء عبور الصراط وفي الدارين الباقيتين. فالعرق الذي ينال الكفار في العرض يتفاوت بينهم؛ فمنهم من يأخذه إلى الركبتين ومنهم من يأخذه إلى الحقوين ومنهم من يلجمه إلجاما.[185] وتأخذ النار أهلها بتفاوت إلى الركبتين والسرة والصدر.[186] وفي عبور الصراط يتفاوت الكفار في طريقة عبورهم؛ فمنهم من يتعثرون، ومنهم من يتخبطون ومنهم من يزحفون.[187] وكذلك شأن المؤمنين، فهم متفاوتون في مراتبهم فيتفاوتون في قدر الكساء الذي يسترهم، وفي المراكب التي تحملهم فيكونون اثنين على بعير وثلاثة على بعير، في حين يركب النبي (ص) البراق عند مبعثه. وتختلف أحوال المؤمنين في عبور الصراط، فمنهم من يعبر كالبرق ومنهم من يعبر كالريح.[188]
-ت- مبدأ التعويض
هو مبدأ خاص في أهل النعيم يوم القيامة لا يهم سواهم، فهو زيادة لهم في الخير مكافئة لهــــم عـــــن العمل والصبر على المحن. وللتعويض ضروب ثلاثة؛ أولها التعويض عن الحرمان والنـقص، وثانيها التعويض عن لذة المحرمات بإباحتها. ونجد ضربًا ثالثًا من التعويض يقوم على الاستثناء من الوقوع في محن لمن وقع فيها من المؤمنين في الدنيا. كما نجد للتعويض أوجها عامة وأخرى فئوية وأخرى فردية. أما التعويض العام لأهل الجنة، فالإباحة لهم ما حُرّم عليهم في الدنيا من شرب للخمر، ولبس للحرير، وتحلّ بالذهب والفضة، وأكل في أواني الذهب والفضة، والاستماع إلى مجالس الطرب والعزف. ومما نجده من تعويض لفئات بعينها، التعويض الذي يناله أصحاب الآفات الجسدية من عمى وصمم وتشوهات خلقية، ويكون التعويض لهم رابيا بأن تُصب النعم عليهم صبًّا حتى يتمنى العلماء لو أن أجسادهم في الدنيا قرضت بالمقاريض ونشرت بالمناشير ليكونوا كهؤلاء. ومن هذا الصنـف من التعويض أسبقية فقراء المهاجرين في ورود الحوض النبوي، فيكونون أول الواردين. ولعل الدافع إلى هذا التعويض أن فقراء المهاجرين كانوا من المناضلين الأوائل في سبيل المشروع الإسلامي، ولكنهم لم يرتقوا اجتماعيًّا ولم ينالوا نصيبًا مجزيا لقاء نضالاتهم. فهم "الشعث رؤوسا، الدبش ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا تفتح لهم أبواب السدد الذين يعطون الذي عليهم، ولا يعطَون الذي لهم."[189]
أما الضـرب الثالث الأخير من التعويض، فهو تعويض فردي يهم أشخاصًا بعينهم، أحدهما للنبي إبراهيم والثاني للنبي موسى. عند نفخة الصعق يُصعق كل المخلوقات باستثناء النبي موسى، فيفيق النبي محمد (ص) أول المبعوثين يوم القيامة فيجد موسى قائمًا بحذاء العرش أو متعلق بالعرش؛ ذلك أنه قد كوفئ بصعقة الطور عندما كلّم موسى ربه، فدك الجبل وخرّ موسى صعقا. فيكون هذا التعويض خاصًّا لموسى في مشهد الصعق تصويرًا لعدالة الله التي تقضي بألّا تجتمع على نبيه صعقتان. أما النبي إبراهيم، فإن التعويض له يكون في مشهد البعث بأن يكون أول من يُكسى ثيابا، سابقا بذلك محمد (ص) أيضا، وعلّة أولوية النبي إبراهيم في الكساء التعويض له عن تجريده من ثيابه عند إلقائه في النار. يقول القرطبي في ذلك "لأنه جُرّد عند إلقائه في النار وكان ما أصابه من ذلك في ذات الله عز وجل فلما صبر واحتسب وتوكل على الله تعالى دفع الله عنه شر النار في الدنيا والآخرة، وجزاه بذلك العري أن جعله أو من يدفع عنه العري يوم القيامة على رؤوس الأشهاد."[190]
الخاتمة
شأنها شأن غيرها من الثقافات الإنسانية، صاغت الثقافة العربية الإسلامية تصوّراتها الدينية عن نهاية الأزمان، فكانت مطبوعة بقيمها الثقافية، حافلة بمخيالها الجمعي، شاهدة على رؤيتها للعالم. ونحن إذ نبحث فيها عن معالم الجسد وصوره، وبُنى الفضاء وهندسته، نعيد تشكيل معالم تمثلات جمالية أسطورية منبثة في طيات الأدب الديني. فما كان في الأصل نصًّا في العقيدة أو في التصوف أو في الوعظ والتذكير، لا يخلو من التخييل الأدبي والعمق الدرامي. إن في استعادة ملامح الفضاءات والجســـد وأبعادها المنبثة، عودة للأصول ونفض للغبار عن تمثلات راسخة في مخيال الثقافة العربية الإسلامية. وما يشدنا لدراسة نصوص الأدب الأخروي بوصفها مدونة التصورات الغيبية هو نجاحها في بناء كون أسطوري متناغم عن عالم لا مرئي، لم يحن بعد أوانه ولكنه حاضر بقوة يملأ السمع والبصر ويصبغ على الطقوس روحانيتها. ويعكس ضروب التخييل الجمعي والتلاقح الثقافي، والتأثير المتبادل بين الثقافة العالمة والثقافة الشعبية.
لا غنى للكون التخييلي عن بنية فضائية، فهي أساس لإنتاج المعنى. ولا يمثل الفضاء مجرد ديكور تقع فيه الأحداث وتتحرك فيه الأجساد، بل إن الفضاء مؤسس للنص وتقنيات الكتابة. والتفاعل بين عنصر الفضاء وعنصر الجسد تفاعل معايشة وتكامل في الخصائص، فالأجساد تندمح بالفضاءات، يعبر أحدهما عن الآخر، ويشكلان معا صورًا مكتملة. فقد صاغت النصوص الأخروية قواعدها الخاصة في خلق التناغم والتكوين البصري، باعثة إلى الوجود صورًا تولد صورا، هي في الواقع الفواعل الحقيقية لما تسرده عن عوالم عجائبية تتجاوب أصداؤها لتخلق وحدة فنية أسطورية.
يطبع التصور الديني الفضاء بطابعه فيرتبط الفضاء المقدس بالعلو وبالطهارة وينعزل على الفضاء المدنس الموسوم بالسفل والقذارة، وهو أيضا رديف للفوضى. ولبنية الفضاء المقدس شبكة من العلاقات الفضائية تنظر للفضاء وأقسامه حسب عدة محاور منها اليمين والشمال، ومرتكز القـداســة في الفـضــــاء، والأنوثة والذكورة. وينتهي ذلك إلى وشائج عميقة بين الفضاء الجغرافي ومنظومة القيم.
الفضاء الأخروي هو فضاء عرض يستدعي إلى المشاهدة؛ إذ يتخذ استراتيجية لتقسيم المــكان والإيهام بالآفاق الأخروية وأداء الأدوار. الفضاء هو مجال الحركة، فالحركة هي الطريقة المتوخاة لشغل الفضاء، وهي التي تعطيه شكله. فالحركة نظام لغوي تعمل من خلال وحدات تـؤدي المعنى. والحركة بما لها من إيقاع، وحجم، وسرعة، تصنع خطابًا. وحركة الجسد في الفضاء هي التي تقسـم الفـــضاء إلى داخلي وخارجي، عام وخاص، مكشوف ومحجوب، بعيد وقريب.
يخضع التشكيل البصري للفضاء والجسد في نصوص الأدب الأخروي الإسلامي إلى رؤية عجيبة تخرق قوانين المادة وتخرج عن دائرة الممكنات، لتبعث كونًا مشهديًّا فوق الخبرة الإنسانية إثباتا للقوة الماورائية المقتدرة عل الإبداع والخلق بما يفوق مجال إدراكنا وخبرتنا حد الروعة والإذهال. ولكن هذا التصوير العجيب لا يبث صوره إلا وفق منطق داخلي خاضعا لقيم ثقافية وجمالية. كما أنه لا يقطع مع المرجعية الدنيوية، بل يمثل إعلاء لها[191]. إنه لا يشكل كونًا خارقًا لقوانين المادية الدنيوية، [192] إلا بقدر ما يخلق كونا ماديًّا فائض الامتلاء، لا يتحيفه نقص ولا يعتريه فساد أو تغير. فالعجيب الأخروي يعكس الاستيهامات البشرية بتجاوز عالمنا الأرضي الفاني توقا إلى الاكتمال والخلود.
قائمة المصادر والمراجع:
*- المصادر:
▪ ابن الأثير، عز الدين أبي الحسن. الكامل في التاريخ، تحقيق سمير شمس، دار صادر، ط 1، بيروت، 2009
▪ الثعلبي، أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم. قصص الأنبياء المسمّى بالعرائس، مكتبة الجمهورية العربية، دت،
▪ الجوزية، ابن قيم. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، دار التأليف بالمالية، مصر، دت،
▪ الحنبلي، ابن رجب. مختصر التخويف من النار، اختصار وتحقيق محمود المصري أبو عمار، دار التقوى، ط 1، 2007
▪ السيوطي، جلال الدين. الدرر الحسان في البعث ونعيم الجنان (ضمن كتاب دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار لعبد الرحيم بن أحمد القاضي)، دار الكتب العلمية، ط 1، بيروت، 1984.
▪ الغزالي، أبو حامد. إحياء علوم الدين الجزء 5، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار صادر، ط 2، بيروت، 2004
▪ القرطبي، محمد بن أحمد. التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، 2002
▪ ابن كثير، أبو الفداء. الفتن والملاحم، دار ابن حزم، ط 1، بيروت، 2005
▪ مسلم، أبو الحسين. صحيح مسلم المسمّى الجامع الصحيح (مجلد واحد)، دار الجيل، بيروت، 2009
▪ المنذري، أبو محمد زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي. الترغيب والترهيب، تحقيق مصطفى محمد عمارة، دار الجيل، بيروت، 1987
▪ ابن منظور، محمد أبو الفضل. لسان العرب، دار الجيل-دار لسان العرب، بيروت، 1988
*- المراجع:
▪ الجمل، بسام. المتخيّل الإسلامي: بحث في المرجعيات. مؤمنون بلا حدود، يونيو 2023
https: //www.mominoun.com/articles/ 449المتخيل-الإسلامي-بحث-في-المرجعيات
▪ حنفي، حسن. من العقيدة إلى الثورة الجزء 4، النبوة – المعاد، مؤسسة هنداوي، 2020
▪ ديتيان، مرسال. اختلاق الميثولوجيا، ، ترجمة مصباح الصمد، المنظمة العربية للترجمة، ط 1، بيروت، 2008
السعفي، وحيد. العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن: تفسير ابن كثير أنموذجا، الأوائل للنشر والتوزيع، سورية، 2006
▪ بن سلامة، رجاء، الموت وطقوسه من خلال صحيح البخاري ومسلم، دار الجنوب للنشر، تونس، 1997
▪ قطب، سيد. مشاهد القيامة في القرآن، دار المعارف بمصر، 1947
▪ محمود، إبراهيم. جغرافية الملذات: الجنس في الجنة، رياض الريس للكتب والنشر، ط 1، بيروت، 1998
▪ Al-Azmeh, Aziz. (2007) The times of history: Universal topics in Islamic historiography, Central European University Press.
▪ Atta, Denkha. (2012) L’imaginaire du paradis et le monde de l’au-delà dans le christianisme et dans l’islam: une étude comparative, thèse de doctorat en Théologie catholique/sciences religieuses, dirigé par François Boespflug, Université de Strasbourg.
▪ Casey, John. (2009) After lives: A guide to heaven, hell, and purgatory, Oxford Universty Press.
Ess, J. V. (2017) Zum Geleit, in: Günther, S. and Lawson, T. (eds), Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam (2 vols.), Leiden: Brill.
▪ Günther, S. (2017) The Poetics of Islamic Eschatology: Narrative, Personification, and Colors in Muslim Discourse, in: Günther, S. and Lawson, T. (eds), Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam (2 vols.), Leiden: Brill.
▪ Jomier, Jacques. (1959) Bible et Coran, Paris, Édition du Cerf.
▪ Joubert, Christian. (2014) La mort en Islam, in: Maurice Godelier (dir.), La mort et ses au-delà, Paris, CNRS Éditions, coll. «Bibliothèque de l’Anthropologie».
▪ Lange, Christian. (2016) Paradise and Hell in Islamic Traditions, Cambridge University Press.
▪ Lange, Christian. (2017), The ‘Eight Gates of Paradise’ Tradition in Islam: A Genealogical and Structural Study, in: Günther, S. and Lawson, T. (eds), Roads to paradise: eschatology and concepts of the hereafter in Islam, Leiden: Brill.
[1] وحيد السعفي، العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن: تفسير ابن كثير أنموذجا، الأوائل للنشر والتوزيع، سورية، 2006، ، ص 727
[2] حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة 4، النبوة – المعاد، مؤسسة هنداوي، 2020، ص 428
[3] وحيد السعفي، العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن، ص 725
[4] حسن حفني، من العقيدة إلى الثورة 4، ص 428
[5] "و إن القصص تجد المادة الثرية فتصوغ بفن منقطع النظير –صور العذاب الأليم، وتلونه بشتى أشكال التلوين."
وحيد السعفي، العجيب والغريب في كتب تفسير القرآن، ص 727
[6] Christian Joubert, La mort en Islam, in: Maurice Godelier (dir.), La mort et ses au-delà, Paris, CNRS Éditions, coll. «Bibliothèque de l’Anthropologie», 2014, p 112
[7] John Casey, After lives: A guide to heaven, hell, and purgatory, Oxford University Press, 2009, p 144
[8] Christian Lange, Paradise and Hell in Islamic Traditions, Cambridge University Press, 2016, p 14
[9] Aziz Al-Azmeh, The times of history: Universal topics in Islamic historiography, Central European University Press, 2007, p 174
[10] "و الله إني لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بصاق ولا نوم ولا آفة تطرأ، بل صحة دائمة وأغــراض متصلة لا يعتورها منغص، في نعيم متجدد في كل لحظة زيادة ولا تتناهى، فأطيش ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه."
ابن الجوزي، صيد الخاطر، تحقيق عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، ط 1، 1992، ص 331
[11] بسام الجمل، المتخيّل الإسلامي: بحث في المرجعيات. مؤمنون بلا حدود، يونيو 2023
https: //www.mominoun.com/articles/ 449المتخيل-الإسلامي-بحث-في-المرجعيات
[12] Sebastian Günther, The Poetics of Islamic Eschatology: Narrative, Personification, and Colors in Muslim Discourse, in: Roads to Paradise: Eschatology and Concepts of the Hereafter in Islam (2 vols.), Brill, 2017, p 182
[13] "إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. فهو يعبّر بالصور المحسّة المتخيّلة عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس والمشهد المنظور، وعن الـــنمـوذج الإنساني، والطبيعة البشرية. ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها، فيمنحها الحياة الشاخـصــــة، أو الحركة المتجددة. فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حيّ، وإذا الطبيعة البشرية مجسمة مرئية. فأمّا الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر، فيردها شاخصة حاضرة، فيها حياة، وفيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار، فقد استوت له كل عناصر التخييل. فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين إلى نظارة."
سيد قطب، مشاهد القيامة في القرآن، دار المعارف بمصر، 1947، ص 6
[14] Jacques Jomier, Bible et Coran, Paris, Édition du Cerf, 1959, p 59
[15] Aziz Al-Azmeh, The times of history: Universal topics in Islamic historiography, op.cit, p 172
[16] Christian Joubert, La mort en Islam, op.cit, p 118
[17] "فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ" سورة النازعات، الآية 14
[18] القرطبي، التذكرة لأحوال الموتى وأمور الآخرة، تحقيق عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، 2002، ص 168
[19] المصدر نفسه، ص 176
[20] المصدر نفسه، ص 274
[21] المصدر نفسه، ص 178
[22] ابن كثير، الفتن والملاحم، دار ابن حزم، بيروت، ط 1، 2005، ص 296
[23] الغزالي، إحياء علوم الدين، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، دار صادر، بيروت، ط 2، ج 5، ص 271
[24] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 274
[25] المصدر نفسه، 220
[26] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 221
[27] القرطبي، التذكرة لأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 378
[28] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 263
[29] المصدر نفسه، ص 175
[30] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 328
[31] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 176
[32] السيوطي، الدرر الحسان في البعث ونعيم الجنان (ضمن كتاب دقائق الأخبار في ذكر الجنة والنار)، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1984، ص ص 38-39
[33] Josef van Ess, Zum Geleit in: Roads to paradise: eschatology and concepts of the hereafter in Islam / edited by Sebastian Gunther, Todd Lawson, with the assistance of Christian Mauder, Volume 1, Leiden; Boston: Brill, 2017, xxiii
[34] استعمل عطا عبارة "التنظيم المعماري" للحديث عن التصور الإسلامي لفضاء الجحيم.
Denkha Atta, L’imaginaire du paradis et le monde de l’au-delà dans le christianisme et dans l’islam: une étude comparative, thèse de doctorat en Théologie catholique/sciences religieuses, dirigé par François Boespflug, Université de Strasbourg, 2012, p 318
[35] سورة الحديد، الآية 21
[36] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 430
[37] المصدر نفسه، ص 437
[38] المصدر نفسه، ص 452
[39] المصدر نفسه، ص 376
[40] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، اختصار وتحقيق محمود المصري أبو عمار، دار التقوى، ط 1، 2007، ص ص 33-34
[41] خصص كريستيان لانغ دراسة كاملة لعدد أبواب الجنة الثمانية، حيث لاحظ شذوذ الرقم ثمانية بالنظر هيمنة الرقم سبعة على التصوّرات الإسلامية التقليدية للكون. واستعرض اجتهادات علماء الإسلام القدامى في تفسير علة ذلك كما بحث في صلاته بمرجعيات فلسفية ودينية قديمة.
Christian Lange, The ‘Eight Gates of Paradise’ Tradition in Islam: A Genealogical and Structural Study, in: Roads to paradise: eschatology and concepts of the hereafter in Islam.
[42] القرطبي، التذكرة لأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 286
[43] المصدر نفسه، ص 444
[44] "هم على متن جهنم" ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 221
[45] "الناس على الصراط" المصدر نفسه، 221
[46] المصدر نفسه، ص 287
[47] المصدر نفسه، ص 221
[48] المصدر نفسه، ص 423
[49] المصدر نفسه، ص 427
[50] القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 378
[51] Christian Lange, Paradise and Hell in Islamic Traditions, op.cit, p 11
[52] Ibid, p 9
[53] Ibid, p 10
[54] المصدر نفسه، ص 181
[55] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص ص 450-451
[56] "فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ" سورة النازعات، الآية 14
[57] القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 168
[58] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 131
[59] المصدر نفسه، ج 5، ص ص 131-132
[60] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 30
[61] المصدر نفسه، ص 30
[62] ابن منظور، لسان العرب، مادة جهنم.
[63] القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 342
[64] المصدر نفسه، ص 354./ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 37
[65] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 26
[66] المصدر نفسه، ص 36
[67] "لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ" سورة الأعراف، الآية 41
[68] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 42
[69] Aziz Al-Azmeh, The times of history: Universal topics in Islamic historiography, op.cit, p 167
[70] إبراهيم محمود، جغرافية الملذات: الجنس في الجنة، رياض الريس للكتب والنشر، بيروت، ط 1، 1998، ص 101
[71] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 439
[72] Josef van Ess, Zum Geleit, op.cit, xvi
[73] ابن قيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، دار التأليف بالمالية، مصر، دت، ص 89
[74] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 447
[75] المصدر نفسه، ص 505
[76] "أرض الجنة مرمرة بيضاء من فضة كأنها مرآة." ابن القيم، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص 89
[77] "إِذَا السَّمَاء انشَقَّتْ" سورة الانشقاق، الآية 1
"فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِينٍ" سورة الدخان، الآية 10
"وَإِذَا السَّمَاء كُشِطَتْ" سورة التنوير، الآية 11
"إِذَا السَّمَاء انفَطَرَتْ. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ" سورة الانفطار، الآية 1-2
"يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاء كَالْمُهْلِ" سورة المعارج، الآية 8.
"فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" سورة الرحمان، الآية 37
"يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا" سورة الطور، الآية 9
[78] "كَلاَّ إِذَا دُكَّتِ الأَرْضُ دَكًّا دَكًّا" سورة الفجر، الآية 21
"إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا" سورة الزلزلة، الآية 1
[79] "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا. لا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلا أَمْتًا" سورة طه، الآية 105-106-107
"وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا" سورة الواقعة، الآية 5-6
[80] "وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ" سورة التكوير، الآية 6
"وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ" سورة الانفطار، الآية 3.
[81] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 154
[82] المصدر نفسه، ص 272
[83] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 276
[84] القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص152.
[85] المصدر نفسه، ص 354
[86] Christian Lange, Paradise and Hell in Islamic Traditions, op.cit, p 131
[87] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 442
[88] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 293
[89] المصدر نفسه، ج 5، 255
[90] المصدر نفسه، ج 5، ص 273
[91] المصدر نفسه، ج 5، ص 274. / ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 224
[92] القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 157
[93] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 189
[94] المصدر نفسه، ص 221
[95] "الرجل في الجنة ليتكئ سبعين سنة قبل أن يتحول." المصدر نفسه، ص 467
[96] Aziz Al-Azmeh, The times of history: Universal topics in Islamic historiography, op.cit, p 173
[97] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 277
[98] المصدر نقسه، ص 278
[99] سورة ق، الآية 30
[100] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 296
[101] "الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ" سورة يس، الآية، 65
[102] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 252
[103] المصدر نفسه، ج 5، ص 449
[104] المصدر نفسه، ج 5، ص 254
[105] المصدر نفسه، ج 5، ص 255
[106] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 112
[107] رجاء بن سلامة، الموت وطقوسه من خلال صحيح البخاري ومسلم، دار الجنوب للنشر، تونس، 1997، ص 80
[108] "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" سورة طه، الآية 5
[109] "لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ" سورة ص، الآية 76
[110] "إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ زِلْزَالَهَا" سورة الزلزلة، الآية 1
[111] "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا." سورة طه، الآية 105
[112] "وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ" سورة الانفطار، الآية 2
[113] "إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ" سورة التكوير، الآية 1
[114] "فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ" سورة الرحمان، الآية 37
[115] "وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا. فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنبَثًّا" سورة الواقعة، الآية 5-6
[116] "وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ" سورة القارعة، الآية 5
[117] "وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ" سورة التكوير، الآية 6
[118] "عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاء وَالأَرْضِ" سورة الحديد، الآية 21
[119] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 276
[120] المصدر نفسه، ج 5، ص 277
[121] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 328
[122] لاحظ كريستيان لانغ أن محل الله في يوم القيامة فوق الجنة تعبير عن تسامي الذات الإلهية وذلك بخلاف التصور المسيحي الذي يجعل الله في الجنة. Christian Lange, Paradise and Hell in Islamic Traditions, op.cit, p 11
[123] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 422
[124] مرسال ديتيان، اختلاق الميثولوجيا، ترجمة مصباح الصمد، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط 1، 2008، ص 75
[125] أمام غموض دلالة عدد ملائكة العذاب يذهب كريستيان لانج إلى امكانية أن تكون التسعة عشر جمعا لعدة الكواكب السبعة وعلامات الأبراج الإثني عشر. ويشير أنها مذكورة في الأدب المندائي باعتبارها الملائكة المسؤولة عن إدارة العالم الذي ينظر له على أنه مظلم وشرير.
Christian Lange, Paradise and Hell in Islamic Traditions, op.cit, p 64
[126] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 29
[127] "يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ" سورة الرحمان، الآية 41
[128] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 44
[129] سورة الملك، الآية 8
[130] ابن قيم الجوزية، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، ص 108
[131] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 258
[132] المصدر نفسه، ج 5، ص 258
[133] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 110
[134] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 176
[135] مسلم، أبو الحسين. صحيح مسلم المسمّى الجامع الصحيح (مجلد واحد)، دار الجيل، بيروت، 2009.، ص 87
[136] السيوطي، الدرر الحسان في البعث ونعيم الجنان، ص 6
[137] المنذري، الترغيب والترهيب، تحقيق مصطفى محمد عمارة، دار الجيل، بيروت، 1987، ج 4، ص 381
[138] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 154. ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 173
[139] المنذري، الترغيب والترهيب، ج 4، ص 381
[140] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص ص 173
[141] "فمسخه الله تعالى شيطانا رجيما، وشوّه خلقه." ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 1، ص 20
[142] المصدر نفسه، ج 1، ص 23
[143] الثعلبي، قصص الأنبياء المسمّى بالعرائس، مكتبة الجمهورية العربية، دت، ص 42
[144] "إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ. طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ." سورة الصافات، الآية 64-65
[145] مسلم، صحيح مسلم، ص 1130
[146] المصدر نفسه، ص 235.
[147] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة. ص 56
[148] ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ج 1، ص 22
[149] "وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ." سورة إبراهيم، الآية 17
[150] "يُجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، فيقال: يــــا أهــــل الجنة هـــــل تعرفون هـــــذا؟ فيشرئبون وينظرون، فيقولون: نعم هذا الموت، ثم يقال: يا أهل النار! هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون، فيقولون: نعم! هذا الموت، قال فيؤمر به فيذبح، قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت." القرطبي، التذكرة، ص 378
[151] Aziz Al-Azmeh, The times of history: Universal topics in Islamic historiography, op.cit, p 172
[152] Ibid, p 174
[153] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 349
[154] "لاَ يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ." سورة الحجر، الآية 48
[155] "النوم أخو الموت وأهل الجنة لا ينامون." ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 480
[156] "الرجل في الجنة ليتكئ سبعين سنة قبل أن يتحول." المصدر نفسه، ص 467
[157] "و إنه ليضع يديه بين كتفيها، ثم ينظر إلى يده من صدرها، من وراء ثيابها وجلدها ولحمها، وإنه لينظر إلى مخ ساقها كما ينظر أحدكم إلى السلك في قصبة الياقوت." المصدر نفسه، ص 472
[158] المصدر نفسه، ص 365
[159] المصدر نفسه، ص 383
[160] المصدر نفسه، ص 383
[161] القرطبي، التذكرة لأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 357
[162] المصدر نفسه، ص 286
[163] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 44
[164] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 361
[165] ابن رجب الحنبلي، مختصر التخويف من النار، ص 28
[166] المصدر نفسه، ص 33
[167] "أرواح المؤمنين في حواصل طير بيض." الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، 252
[168] "ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدلاة في ظل العرش." المصدر نفسه، ج 5، ص 119
[169] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 123
[170] حسن حنفي، من العقيدة إلى الثورة 4، ص 293
[171] المرجع نفسه، ص 335
[172] المرجع نفسه، ص 335
[173] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 158
[174] المصدر نفسه، ص 158
[175] المصدر نفسه، ص 158
[176] المصدر نفسه، ص 158
[177] المصدر نفسه، ص 159
[178] المصدر نفسه، ص 160
[179] المصدر نفسه، ص ص 173-174
[180] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 272
[181] المصدر نفسه، ج 5، ص 273
[182] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 355
[183] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 37
[184] المصدر نفسه، ص 334
[185] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 273
[186] القرطبي، التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 355
[187] الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 5، ص 286
[188] المصدر نفسه، ج 5، ص 286
[189] ابن كثير، الفتن والملاحم، ص 240
[190] القرطبي، التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، ص 178
[191] Denkha Atta, L’imaginaire du paradis et le monde de l’au-delà dans le christianisme et dans l’islam: une étude comparative, op. cit, p 344
[192] "فعجيبها وإن اختلف مرتبة، لا ينقطع عن سابقه الدنيوي، إنما يقوم عليه، وإن غايره قيمة." جغرافية الملذات: الجنس في الجنة، ص 117