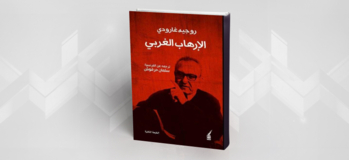الحشد الشعبي في العراق: من فتوى الدفاع إلى أداة للنفوذ السياسي قراءة تحليلية في البنية والوظيفة والتحولات
فئة : مقالات

الحشد الشعبي في العراق:
من فتوى الدفاع إلى أداة للنفوذ السياسي
قراءة تحليلية في البنية والوظيفة والتحولات
مقدمة
شكّل ظهور الحشد الشعبي في العراق عام 2014 لحظة مفصلية في تاريخ الصراع مع الإرهاب؛ إذ جاء في سياق استثنائي تمثل في انهيار مفاجئ ومريع للمؤسسة الأمنية والعسكرية في مواجهة تنظيم "داعش"، وتهديدٍ مباشر لوحدة الدولة ووجودها. وقد استندت ولادة هذا الكيان إلى فتوى "الجهاد الكفائي" التي أصدرها المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، والتي دعت إلى التطوع لمساندة القوات الأمنية في الدفاع عن البلاد. ومع مرور الوقت، تحوّل هذا التشكيل من حراك تطوعي دفاعي إلى جهاز أمني–عسكري موازٍ، يتمتع بتمثيل سياسي وحضور اجتماعي واسع، إلا أنه أثار جدلًا متصاعدًا بشأن شرعيته، ووظيفته، وولاءاته، وتداعيات استمراره بالصيغة الحالية على الدولة العراقية.
تنبع أهمية دراسة الحشد الشعبي من كونه ظاهرة هجينة تجمع بين العقيدة الدينية، والفاعلية العسكرية، والتمثيل السياسي، مما يجعله حالة فريدة في التجربة العراقية الحديثة، تستدعي مقاربة تحليلية دقيقة تتجاوز السرديات السياسية المتضادة. كما أن تداخله مع محاور إقليمية، لاسيما إيران، وارتباط بعض فصائله بالحرس الثوري أو بمشاريع عابرة للدولة الوطنية، يضعه في قلب التوازنات الإقليمية والدولية المتغيرة.
تسعى هذه الورقة إلى معالجة الإشكالية الآتية:
إلى أيّ حد مثّل الحشد الشعبي استجابة وطنية لحالة طارئة، ومتى وكيف تحوّل إلى أداة سياسية–عسكرية تخدم مشاريع سلطوية داخلية وأجندات إقليمية؟
تنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الحشد، وإن كان قد بدأ كجهد شعبي مشروع وضروري، فقد انزلق تدريجيًّا إلى مسارات غير وطنية بفعل الهيمنة الحزبية، وارتباط بعض فصائله بقوى إقليمية، مما جعله جزءًا من أزمة بناء الدولة في العراق، لا من حلولها.
تعتمد الورقة على منهج وصفي–تحليلي، يستند إلى تحليل الوثائق الرسمية، والخطابات السياسية، والتقارير الدولية، فضلًا عن مراجعة الأدبيات المتخصصة في قضايا الأمن والمليشيات والدولة، لتقديم قراءة تفسيرية لأسباب التحول في بنية الحشد ووظيفته، وانعكاسات ذلك على مستقبل الدولة العراقية.
أولًا: النشأة والسياق التأسيسي للحشد الشعبي
ظهر الحشد الشعبي في أعقاب انهيار مفاجئ ومخيف للجيش العراقي في صيف عام 2014، بعد اجتياح تنظيم "داعش" لمدينة الموصل وعدد من المحافظات الغربية، وما تبعه من انهيار أمني شامل وتهديد مباشر لبغداد وكربلاء والنجف. وفي هذا السياق الاستثنائي، صدرت فتوى "الجهاد الكفائي" عن المرجعية الدينية في النجف، ممثَّلة بالسيد علي السيستاني، في 13 حزيران/يونيو 2014، والتي دعت المواطنين القادرين على حمل السلاح إلى التطوع للدفاع عن الوطن ومقدساته، ومساندة القوات الأمنية النظامية.
لم تكن الفتوى تدعو إلى إنشاء تشكيل مسلح موازٍ للدولة، بل أكدت في متنها على ضرورة الانخراط ضمن صفوف القوات الأمنية الرسمية، في إطار مؤسسات الدولة. غير أن الاستجابة الميدانية للفتوى تمّت بوساطة قوى سياسية–عسكرية كانت تمتلك تشكيلات مسلحة قائمة أصلًا، بعضها تشكّل قبل عام 2003 في إيران خلال الحرب العراقية–الإيرانية، وبعضها الآخر ظهر بعد سقوط نظام صدام حسين، مستفيدًا من الفراغ الأمني والفوضى السياسية.
أمام الاندفاع الجماهيري الواسع نحو التطوع، وعدم قدرة المؤسسات العسكرية والأمنية على استيعاب الأعداد الكبيرة، اتُّخذ قرار سياسي بتأسيس "هيئة الحشد الشعبي" كجهاز مستقل يرتبط برئاسة الوزراء مباشرة، وجرى ضم الفصائل المسلحة الميدانية التي قاتلت "داعش" ضمن هذه الهيئة. وبذلك، تشكّل الحشد كمؤسسة هجينة، تجمع بين الطابع الشعبي–الديني والهيكل العسكري–الرسمي، وتخضع لقيادة فعلية من شخصيات تنتمي إلى فصائل حزبية مرتبطة بمحور سياسي–عقائدي يمتد خارج حدود الدولة العراقية.
أضفى هذا التكوين المزدوج طابعًا إشكاليًا على الحشد الشعبي، إذ بات يحمل صفة "الشرعية القانونية" من جهة، لكنه يخضع فعليًا في بنيته وقيادته وتحركاته لمجموعة من القوى التي لا تخفي انتماءاتها السياسية والعقائدية لمحور إقليمي تقوده إيران، وهو ما أدى لاحقًا إلى تشكل "حشد داخل الحشد"، بين فصائل تؤمن بمرجعية الدولة، وأخرى تعمل وفق منطق "الولي الفقيه" وولاية الخارج.
ثانيًا: البنية التنظيمية وتركيبة الولاء داخل الحشد الشعبي
تتكون هيئة الحشد الشعبي من مجموعة فصائل مسلحة غير متجانسة من حيث النشأة، والقيادة، والخطاب الأيديولوجي، ومصادر التمويل والدعم. فمن جهة، هناك فصائل استجابت مباشرة لفتوى "الجهاد الكفائي" وانخرطت في القتال ضد تنظيم داعش ضمن منطق الدفاع الوطني والديني؛ ومن جهة أخرى، هناك فصائل كانت قائمة قبل صدور الفتوى، وبعضها يمتلك سجلًا حافلًا بالارتباطات الإقليمية، لا سيما بإيران، ويُعدّ امتدادًا لمؤسسات أمنية–عقائدية تابعة للحرس الثوري الإيراني.
عدد من هذه الفصائل، مثل "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" و"منظمة بدر"، تعود جذورها إلى تشكيلات تشكّلت خلال الحرب العراقية–الإيرانية أو بعد سقوط النظام السابق في 2003، وتتبنّى عقيدة "ولاية الفقيه" بوصفها المرجعية العليا في العمل السياسي والجهادي. وتُعد هذه الفصائل العمود الفقري لما يُعرف بـ"الحشد الولائي"؛ أي الفصائل التي تُظهر ولاءً صريحًا للقيادة الإيرانية، وتنسّق عملياتها وتوجهاتها وفق هذا الولاء، سواء على مستوى العقيدة أو التموضع السياسي.
في المقابل، ظهرت فصائل أخرى تحت مسمّى "الحشد المرجعي"، تضم متطوعين استجابوا للفتوى، وتشكّلت بدعم وإشراف غير مباشر من مرجعية النجف، وتلتزم بالعمل ضمن مؤسسات الدولة، وتتبنّى خطابًا وطنيًا يُميزها عن نظيرتها الولائية. ومن أبرز هذه الفصائل "فرقة العباس القتالية" و"لواء علي الأكبر" و"أنصار المرجعية".
هذا الانقسام البنيوي يعكس إشكالية الولاء داخل مؤسسة الحشد الشعبي، إذ تُظهر بعض الفصائل انتماءً لمؤسسات الدولة العراقية، في حين تعمل فصائل أخرى كأذرع لحركات وأحزاب سياسية ذات امتداد إقليمي، وهو ما يتسبب في ازدواجية القرار العسكري والأمني، ويجعل من الحشد الشعبي كيانًا متنازعًا عليه بين منطق الدولة ومنطق الثورة.
وقد أدى هذا الانقسام إلى نشوء صراع داخلي ضمن الحشد نفسه، تمظهر أحيانًا في صدامات خفية أو علنية، لا سيما في ظل محاولات المرجعية الدينية في النجف النأي بنفسها عن الفصائل الولائية، ورفضها لاستخدام الفتوى كغطاء لمشاريع سياسية أو ولاءات خارجية. كما برزت مخاوف من تحول الحشد إلى أداة تستخدمها بعض القوى السياسية لترهيب الخصوم، وتحقيق مكاسب انتخابية أو مالية، مستفيدة من الهيبة التي اكتسبها التشكيل بفعل تضحيات أفراده في الحرب ضد الإرهاب.
ثالثًا: القدسية الرمزية والاستثمار السياسي–المالي
أكسبت فتوى الجهاد الكفائي، والتضحيات الجسيمة التي قدمها المتطوعون في ساحات القتال، الحشد الشعبي مكانة رمزية عالية في الوعي الشعبي العراقي، خصوصًا في المحافظات الشيعية. وقد سعت القوى السياسية المرتبطة بفصائل مسلحة إلى ترسيخ هذه "القدسية" في الذاكرة الجمعية، وتوظيفها إعلاميًّا ونفسيًّا، من أجل تعزيز مكانتها السياسية وتحقيق مكاسب انتخابية.
في هذا السياق، لم يعد الحشد مجرد تشكيل عسكري، بل تحوّل إلى رمز ديني–وطني، يضاهي في تمثيله ما تحمله المؤسسات العقائدية من تأثير على المجتمع. وقد غذّت الآلة الإعلامية للأحزاب السياسية هذا الاتجاه عبر الترويج المتواصل لفكرة أن الحشد هو "ضمانة للوجود الشيعي"، و"درع الوطن والمقدسات"، ما أضفى عليه حصانة من النقد أو المساءلة، وعزز من مشروعية الفاعلين المرتبطين به في المجال السياسي.
وقد أفضى هذا الاستخدام الرمزي إلى توظيف الحشد في مشاريع سياسية وانتخابية، حيث شُكّلت أحزاب وتحالفات انتخابية تحت يافطة "الحشد" أو باسم "شهدائه"، وتمّت تعبئة الناخبين على أساس عاطفي–ديني، لا على أسس برمجية أو إصلاحية. كما جرى استخدام الحشد في التهديد والترهيب ضد الخصوم السياسيين، وبرزت مؤشرات على تورّط بعض فصائله في عمليات قمع للمتظاهرين والنشطاء، ولا سيما خلال احتجاجات تشرين 2019.
ماليًا، أصبح الحشد الشعبي مصدر تمويل غير مباشر لعدد من الأحزاب والفصائل، من خلال آليات قانونية مشوبة بالفساد، مثل تخصيصات الموازنة العامة التي تُوزّع على أسماء منتسبين "فضائيين" (وهميون)، أو من خلال العقود الممنوحة لشركات ومكاتب اقتصادية تابعة لهذه الفصائل تحت غطاء الهندسة والخدمات اللوجستية. وتشير تقارير رقابية محلية إلى أن نسب المنتسبين الوهميين في بعض التشكيلات قد تصل إلى 50% من العدد المعلن، وهو ما يُعبّر عن بنية اقتصادية ريعية–موازية تتغذى من المال العام باسم "المقاومة".
رابعًا: الحشد الشعبي والدولة: حماية السلطة أم حماية الوطن؟
تطوّر الحشد الشعبي من جهاز طارئ إلى مؤسسة دائمة ذات نفوذ متصاعد، لكنه بات يؤدي أدوارًا تتجاوز نطاق الدفاع الوطني، ليتحول تدريجيًّا إلى أداة لحماية النظام السياسي القائم ومصالح القوى المهيمنة عليه. ويُلاحظ أن بعض فصائل الحشد لم تنخرط فقط في العمل العسكري ضد الإرهاب، بل تجاوزت ذلك إلى التأثير في العملية السياسية، وضبط المجال العام، وفرض إرادتها على المجتمع المدني وخصومها السياسيين، وحتى داخل مؤسسات الدولة ذاتها.
في هذا السياق، صرّح رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض في لقاء متلفز أن "الحشد كيان عسكري ببعد سياسي، وهو قادر على حماية النظام السياسي العراقي"، في تأكيد صريح على الوظيفة السياسية–النظامية التي بات يضطلع بها الحشد، وهو تصريح يعزز من المخاوف المتعلقة بتحوّل الحشد إلى قوة حارسة للسلطة لا للوطن.
هذا الدور المزدوج يثير إشكالية عميقة تتعلق بتوازن السلطات، وخضوع المؤسسة العسكرية للقيادة المدنية، ومبدأ احتكار الدولة للعنف الشرعي؛ إذ أضحت بعض تشكيلات الحشد تتصرف كوحدات مستقلة القرار، تابعة فعليًا لقيادات حزبية–عقائدية، لا تخضع لرقابة البرلمان، ولا تتقيّد بالتعليمات الحكومية، وهو ما يُقوّض مشروع بناء دولة القانون والمؤسسات، ويُعيد إنتاج النموذج الفاشل للدولة العميقة.
من جهة أخرى، ينظر الكثير من الناشطين والمدنيين العراقيين إلى الحشد بوصفه أداة قمعية تُستخدم في الداخل لإخماد التظاهرات الشعبية، وقمع المعارضين السياسيين، وملاحقة المدونين، في استنساخ لنمط الحرس الثوري في إيران، أو ما يشبه الحرس القومي في عهد البعث. وهذا الاستخدام الأمني الداخلي للحشد يُعد انحرافًا خطيرًا عن الهدف الذي أُسّس من أجله، ويكشف تحوّله إلى ذراع سلطوي لا وطنية.
خامسًا: الحشد الشعبي في المعادلة الإقليمية والدولية
إن الطابع الولائي لبعض فصائل الحشد الشعبي يُضعف من حيادية العراق في صراعات المنطقة، ويجعل من الحشد أداة ضمن محاور إقليمية تقودها إيران. فقد شاركت بعض تشكيلات الحشد في معارك خارج الحدود، وارتبطت تنظيميًّا وإعلاميًّا بمحور "الممانعة"، الذي يضم حزب الله في لبنان، والنظام السوري، والحوثيين في اليمن. وهذا التموضع الإقليمي يعكس طموحًا لتوسيع النفوذ الإيراني عبر وكلاء محليين مسلحين، على حساب سيادة الدول الوطنية.
وقد انعكس هذا الوضع سلبًا على علاقة العراق بالدول العربية والمجتمع الدولي، حيث بات يُنظر إلى الحشد كمؤسسة غير منضبطة تهدد الأمن الإقليمي، وتُستخدم كأداة ابتزاز دبلوماسي من قبل طهران. كما أدى هذا الارتباط إلى فرض عقوبات على بعض قادة الفصائل، وتقييد العلاقات العراقية–الأمريكية، وتعقيد جهود إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية العراقية.
وبهذا، يُعاد إنتاج تجربة "الحرس الثوري" الإيراني في العراق، عبر نسخة محلية تتمثل بالحشد الشعبي، الذي تحوّل من مشروع إنقاذ وطني إلى جهاز سياسي–أمني يخدم بقاء منظومة فاسدة، ويُشكّل عقبة أمام مشروع الدولة المدنية–الوطنية في العراق.
خاتمة واستنتاجات
تبيّن من خلال التحليل أن الحشد الشعبي، رغم نشأته الضرورية في سياق طارئ، قد تحوّل لاحقًا إلى ظاهرة معقدة تتقاطع فيها الأبعاد الوطنية بالعقائدية، والعسكرية بالسياسية، والداخلية بالإقليمية. وهو اليوم كيان ذو حضور مزدوج: في الوجدان الشعبي كرمز للتضحية، وفي الواقع السياسي كأداة للسلطة.
إن استمرارية هذا الوضع دون إصلاحات جذرية ستُبقي الدولة العراقية رهينة لسلطة موازية، تُمثّلها قوى مسلحة خارج السياق الدستوري، ما يهدد سيادة الدولة، ويُقوّض السلم الأهلي، ويُطيل أمد الفساد والاستبداد.
ومن هنا، فإن إعادة هيكلة الحشد الشعبي، وحصر السلاح بيد الدولة، وفصل الفصائل المسلحة عن العمل السياسي، تُعد من أولويات مشروع الإصلاح الحقيقي في العراق، إذا ما أراد هذا البلد الخروج من أزمته البنيوية والانطلاق نحو دولة مواطنة مدنية عادلة.
المراجع
- السيستاني، علي. (2014). نص فتوى الجهاد الكفائي. موقع العتبة العباسية.
- مركز كارنيغي للشرق الأوسط. (2020). الحشد الشعبي: مؤسسة واحدة أم عدة تشكيلات؟
- إبراهيم، ياسر. (2021). الولاءات المتصارعة داخل الحشد الشعبي. مجلة السياسة الدولية.
- هيومن رايتس ووتش. (2019). قمع التظاهرات في العراق: دور الفصائل المسلحة.
- BBC Arabic. (2019). من يسيطر فعليًا على الحشد الشعبي في العراق؟
- مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأمريكية – السليمانية. (2022). تحليل ميزانية الحشد الشعبي.
- الفياض، فالح. (2023). مقابلة تلفزيونية: الحشد كيان عسكري ببعد سياسي. قناة الشرقية نيوز.