الفكر العربي والقطيعة الإبستمولوجية
فئة : مقالات
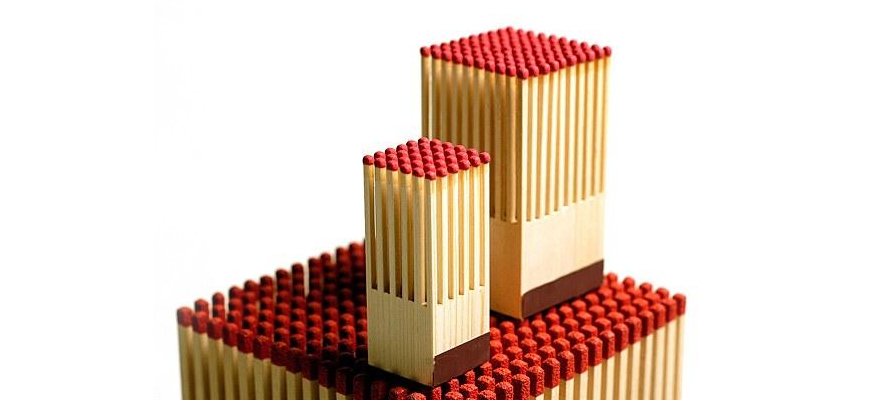
الفكر العربي والقطيعة الإبستمولوجية
يمكن القول، إن الغرب اللاتيني المسيحي شهد، منذ عصر النهضة في القرن السادس عشر، جهودا متواصلة هادفة إلى تحرير الفكر من هيمنة الوحي الديني المسيحي، الخارق للعادة، بغية تشكيل معرفة وضعية تجريبية، محسوسة، قائمة على البرهان والعيان فقط. وكلما، راحت العلوم الفيزيائية الدقيقة تبرهن على فعاليتها، في اكتشاف قوانين الطبيعة، وتفسير الواقع الموضوعي، راحت العلوم النظرية، وبخاصة علم اللاهوت، تعاني من الاحتقار والازدراء، بصفتها علوما ذاتية غيبية، لا قيمة موضوعية لها. وقد استمر هذا التوجه الفكري في الصعود، حتى وصلنا في القرن التاسع عشر إلى النزعة العلموية الوضعية المتطرفة؛ أي عبادة العلم، والاعتقاد بأنه قادر على كل شيء، وليس فقط تفسير قوانين الطبيعة. وقد أدى ذلك إلى حذف الدين في أوروبا، بعد أن كان مصدرا للحقيقة العليا المعصومة التي لا تناقش طيلة قرون وقرون، وإحلال العلم الفيزيائي أو الطبيعي محله.
ثم زادت من حدة هذا التوجه الوضعي، تلك النجاحات الصارخة التي حققتها الحضارة الصناعية والتكنولوجية في القرن العشرين. انظر الآلات والمخترعات الباهرة في كافة المجالات، وقد خففت من الجهد العضلي، وأراحت الإنسان إلى أقصى حد ممكن؛ فكيف يمكن ألا يحب العلم، بل ويعبده عبادة؟ وهكذا أصبح العقل الحديث مضادا كليا للعقل القديم الذي ساد العصور الوسطى في الجهة الإسلامية، كما المسيحية. ولكن هل ينبغي أن نحتقر كل الفكر والمعارف التي سادت في العصور الوسطى، لكي نكون حديثين؟ ألا ينبغي أن نتواضع قليلا، ونعطي لكل ذي حق حقه؟ أليست المعرفة الدينية أو الروحية تتموضع على مستوى آخر، غير المعرفة العلمية الفيزيائية الموضوعية؟ ألا يمكن القول بأنهما تتكاملان، بدلا من أن تتناقضا وتحذفا بعضهما بعضا؟ لماذا نريد أن نحذف الدين بحجة العلم؟ نقول ذلك، وبخاصة أننا ندعو إلى الفهم المستنير للدين، لا الفهم الظلامي القديم.
في الواقع، إن العصور الوسطى المسيحية عانت من هذا الاحتقار العلمي، إن لم نقل العلموي، تماما كما عانت منه العصور الوسطى الإسلامية. وبالتالي، فالغرب لم يفعل ذلك فقط من أجل النيل من الإسلام وتراثه، كما يتوهم الكثيرون عندنا. (انظر الهجوم العنيف على الاستشراق الأكاديمي؛ وهو هجوم ظالم في رأيي. وحده الهجوم على الاستشراق المسيس الرخيص مبرر ومشروع). وإنما فعل نفس الشيء مع تراثه المسيحي، كما ذكرنا. وبالتالي، فقد هاجم العلم الغربي، الواثق من نفسه إلى حد الغرو، كل الأديان، وليس فقط الإسلام. فالكتب التي تنقد المسيحية، وتهاجمها في الغرب، لا تحصى ولا تعد، بل وبعضهم يشكك بوجود المسيح ذاته، ويعتبره شخصية أسطورية، لا تاريخية. نعم، لقد أصيب العقل الغربي بالغرور، بعد أن حقق كل هذه الاكتشافات المذهلة في كافة الميادين، وأعتقد أنه قادر على كل شيء. وعندئذ، راح يحتقر كل المعارف السابقة للبشرية. وبلغت هذه النزعة ذروتها عنده، إبان القرن التاسع عشر، وحتى منتصف القرن العشرين؛ أي أثناء سيطرة العرقية المركزية الأوروبية، والعقلية الاستعلائية للبورجوازيين الفاتحين.[1]
فيما يخص العصور الوسطى، ينبغي العلم بأنها تشمل كل تاريخ الإسلام من بدايته، وحتى القرن التاسع عشر؛ أي حتى دخول الحداثة الأوروبية إلى تركيا، عن طريق الإصلاحات أو ما يدعى "بالتنظيمات"، ثم إلى مصر والعالم العربي، عن طريق حملة نابليون بونابرت، بل إن العصور الوسطى لا تزال متطاولة، وموجودة لدى شرائح عديدة من مجتمعاتنا حتى اليوم. انظر القطاعات التقليدية في المجتمع الأفغاني، أو الباكستاني، أو سواهما، بل إن دولة الطالبان كانت تشكل العصور الوسطى الحالكة الظلام حتى أمد قريب. أما العصور الوسطى الأوروبية، فقد انتهت منذ القرن السادس عشر، ثم بالأخص التاسع عشر. وقد احتقرت من قبل العصر الوضعي الظافر، بصفتها تمثل العقلية البدائية المتخلفة. ولكن المؤرخين الفرنسيين أعادوا الاعتبار مؤخرا للعصور الوسطى، وأثبتوا أنها لم تكن كلها ظلامية متخلفة جاهلة، وإنما شهدت تيارات فكرية عقلانية، وعلمية وفلسفية أيضا، وإن كان الطابع الغالب عليها هو ديني لاهوتي بالطبع، وليس علميا، ولا تكنولوجيا. والواقع أنه توجد عصور وسطى مستنيرة نسبيا، وعصور وسطى انغلاقية ليس فيها أي بصيص نور تقريبا. فالقرون الستة الأولى من عمر الإسلام مثلا، أدت إلى تشكيل حضارة رائعة، ومن الظلم نعتها بالقرون الوسطى، بالمعنى السلبي للكلمة. إنها تمثل العصر الذهبي للحضارة العربية الإسلامية[2]، ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن القرون الوسطى الأوروبية بعد القرن الثاني عشر؛ أي بعد ترجمة العلم العربي والفلسفة العربية. وبالتالي، فهناك قرون وسطى منخفضة، وقرون وسطى عالية، ولا ينبغي الخلط بينهما. ولكن يبقى صحيحا القول، بأن الحداثة تجاوزت العصور الوسطى كلها، بخيرها وشرها.
الملامح الأساسية للعصور الوسطى:[3]
بعد طرح الإشكالية العامة على هذا النحو، لننتقل الآن إلى مرحلة جديدة في البحث، ولنطرح السؤال التالي: ماهي المسلمات المعرفية أو المبادئ الفكرية الكبرى التي تحكمت بالفكر في العصور الوسطى الإسلامية، كما المسيحية؟
المبدأ الأول، يقول بأن المناخ العقلي للإنسان في القرون الوسطى، لم يكن هو ذاته المناخ العقلي لإنسان العصور الحديثة الذي يعيش اليوم؛ أي نحن بالذات؛ ففي تلك العصور القديمة، كان الدين يسيطر على المناخ العقلي للإنسان، من أدناه إلى أقصاه بشكل كامل، وكانت فكرة الله الحي الخلاق، المهيمن الجبار تسيطر عليه من كل النواحي. أما اليوم، فلم يعد لذلك من وجود، على الأقل في المجتمعات الغربية المتقدمة، أو قل إن وجوده محصور بفئات قليلة وهامشية، ممن ظلوا مسيحيين تقليديين، لا مسيحيين ليبراليين. وهذه الهيمنة للدين، كانت توسع من الأفق المعرفي للإنسان، أو تضيقه وتقلصه طبقا لنوعية المؤلفين والحالات التاريخية؛ فالإيمان بالله مثلا، لم يضعف من عقلانية المعتزلة أو ابن رشد أو التوحيدي أو الجاحظ إلخ...، على العكس. ولكنه ضيق إلى أقصى الحدود من عقلية الحنابلة الذين فهموا الدين بشكل آخر: أي كمضاد للعقل والتأويل، والرأي والقياس...إلخ. انظر الحركات الإخوانية والسلفية الناتجة عنهم حاليا. نفس الظاهرة حصلت في المسيحية؛ فإيمان توما الأكويني مثلا، غير إيمان الكهنة المكتفين بالمعرفة التقليدية المسيحية، وغير القادرين على فهم الفلسفة الأرسطوطاليسية... وقس على ذلك..
المبدأ الثاني، الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار، إذا ما أردنا أن نفهم عقلية أناس القرون الوسطى، بل وحتى قسم كبير من مسلمي اليوم، وبخاصة الأصوليين الذين ظلوا منغلقين داخل السياجات الدوغمائية المغلقة هو أن عقلانية الناس آنذاك، كانت تتحرك داخل زمكان مقدس ورمزاني، حيث لا يتدخل القياس العلمي إلا بطريقة عابرة، جزئية، ناقصة؛ فالعلم آنذاك، كان قائما على النوعية، لا على الكمية، ولا يمكن لأي علم أن يتشكل، ويأخذ مكانته في مجتمع تلك العصور، إن لم يكن على علاقة وثيقة مع الكتابات المقدسة، ومع العلوم القديمة لليونان والرومان. بمعنى آخر، ينبغي أن يخضع العلم، حتى الفيزيائي منه، لرأي رجال الدين، حتى لو كانوا غير متخصصين أبدا في الفيزياء والفلك. انظر محاكمة غاليليو من قبل كهنة، يجهلون كليا أصول علم الفلك والفيزياء، ولا يعرفون إلا علم أصول الدين. في حين أن العلم الحديث قطع مع كل ذلك، بدءًا من كوبرنيكوس في القرن السادس عشر.
أما المبدأ الثالث، الذي كان يتحكم بمعرفة القرون الوسطى؛ فهو التالي: المعرفة في مثل هذا المناخ العقلي، تتخذ طابع الأحلام التأملية، كما يقول غاستون باشلار. ولكن هذه الأحلام كانت منظمة ومنطقية، وقادرة على تغذية فكر الإنسان، وتوجيه سلوكه وعمله. كانت ترتفع بالروح حتى درجة التأمل بالحقائق الجوهرية، أو حقائق الأمور، كما يقول مفكرو العرب والإسلام في القرون الوسطى؛ وهذا ما يتيح له إشباع رغبته في الأبدية والخلود. وبالتالي، فمن الخطأ، بل ومن الخطر أن ندرس علم القرون الوسطى، وكأنه المقدمة التي مهدت لعلمنا الحديث. لماذا؟ لأن العلم الحديث لم يهدف إلى التأمل في الطبيعة، وإنما إلى محاولة فعلية للسيطرة عليها، والتحكم بها بعد اكتشاف قوانينها. يقول ديكارت في عبارته الشهيرة: ينبغي أن نصبح أسيادا على الطبيعة، ومالكين لها. وهذا الشيء، لم يكن يخطر على بال العلم والعلماء في القرون الوسطى. كان إنسان القرون الوسطى يهدف فقط، إلى العثور على التناغم والتناسق الموجود في الخلق، أو الكون والإعجاب به، والتأمل فيه، وليس إلى استخدام المادة والطبيعة لغايات عملية محضة، كما يفعل الإنسان الحديث.
المبدأ الرابع، الذي كان سائدا في العصور الوسطى، يخص مفهوم التقدم، الذي لم يكن معروفا أبدا في القرون الوسطى؛ هذا مفهوم خاص بالعصور الحديثة فقط، وهو يعني إمكانية تحقيق التقدم للبشرية إلى ما لا نهاية، عن طريق العلم والاكتشافات الحديثة والتكنولوجيا. أما في العصور الوسطى، فالتقدم كان يعني العودة إلى الوراء؛ أي إلى ماض مثالي يتجاوز كل الأزمنة، ويعلو عليها، لأنه يمثل لحظة الوحي والنبوة، وهي لحظة تفوق كل اللحظات. لهذا السبب، فإن مفهوم التقدم مرفوض من قبل الأصوليين المعاصرين؛ فهو يعني الابتعاد عن الماضي المقدس، لا العودة إليه أو الاقتراب منه. إنه شر في شر وضلال في ضلال. وبالتالي، فمفهوم التقدم غريب جدا على عقلية القرون الوسطى اللاهوتية، مسيحية كانت أم إسلامية، ولا معنى له بالنسبة لها، أو قل إن معناه سلبي جدا. والدليل على ذلك، أن التقدم بالنسبة لجميع السلفيين يعني العودة إلى الوراء كما قلنا، إلى زمن السلف الصالح، وليس التقدم إلى الأمام. ونفس الشيء ينطبق على السلفيين المسيحيين بطبيعة الحال.
المبدأ الخامس، الذي ينبغي التذكير به لكي نفهم عقلية القرون الوسطى، هو التالي: لا ريب في أن العلم العربي الإسلامي عرف العقلانية، والملاحظة العيانية المباشرة للوقائع، والتجريب أيضا. وحقق العلم العربي آنذاك، نتائج باهرة في كافة الميادين، وهو ما يدرسه رشدي راشد مثلا، في فرنسا، ويكرس له عمره المديد. ولكن، كل ذلك كان مرتبطا بسياقه التاريخي الذي يهيمن عليه الدين والإيمان بالغيبيات. وبالتالي، فلا ينبغي فصل العلم العربي عن سياقه العام، والاعتقاد بأنه كان يهدف للتوصل إلى المعرفة المحضة، واكتشاف قوانين الكون، كما يفعل العلم الحديث. هناك قطيعة إبستمولوجية تفصل بين علم القرون الوسطى والعلم الحديث. وهذه القطيعة ابتدأت مع كوبرنيكوس، ولكنها ترسخت على يد غاليليو وكيبلر وديكارت ونيوتن، ولا يمكن المقارنة إطلاقا بين العلمين:أي العلم الأرسطوطاليسي – البطليموسي من جهة، والعلم الحديث من جهة أخرى؛ فالعلم الحديث ألغى كليا علم القرون الوسطى، وأحدث معه القطيعة الإبستمولوجية الكبرى في القرن السابع عشر الأوروبي. عندئذ حصلت ثورة العلم الحديث التي جبت كل ما قبلها. وبالتالي؛ فكفانا إسقاطا لمفاهيم الحاضر على الماضي، كفانا ارتكابا للمغالطات التاريخية، والخلط بين العصور. ينبغي أن نأخذ مفهوم القطيعة المعرفية أو الإبستمولوجية على محمل الجد في العالم العربي، وإلا فإننا لن نفهم شيئا، وسوف نظل متعلقين بتراثنا بطريقة تبجيلية، وطفولية، وتعظيمية زائدة عن اللزوم؛ وهذه النقطة وضحها لي العالم الفرنسي جيل غاستون غرانجيه، في مقابلة مطولة أجريتها معه في مكتبه بالكوليج دو فرانس. ويمكن للقارئ أن يطلع عليها في كتاب صدر لي عن دار الطليعة ببيروت عام 2008، تحت عنوان: "مخاضات الحداثة التنويرية. القطيعة الإبستمولوجية في الفكر والحياة". وفيه أيضا توجد المقابلة المطولة التي أجريتها مع رشدي راشد، منذ سنوات لم أعد أتذكرها، أو قل أخشى أن أتذكرها من كثرة طولها... العمر يمر، والزمن يمر، ولا أستطيع أن أوقف الزمن!..ولو استطعت لأوقفته عند تلك اللحظة الجميلة، لأسباب شخصية لا علاقة لها بالعلم، وإنما بشيء آخر يتجاوز كل علم ويعلو عليه...إنها لحظة سرقت، رغم أنف الدهر والحساد، سرقة... إنها لحظة دفع ثمنها ابن زيدون يوما ما غاليا، بل وغاليا جدا... وهو وحده يعرف معناها وقيمتها؛ إذ أقول هذا الكلام، فإني لا أخرج إطلاقا على موضوع القطيعة الإبستمولوجية. على العكس، فإني أوسع من دائرته لكي يشمل القطيعة الغرامية أيضا. هنا أيضا يحصل نزيف حاد؛ فالقطيعة مع الحبيبة الغالية، لا يقل خطورة عن القطيعة مع العصور الوسطى، والتربية الدينية التي تغلغلت في ربيع الطفولة إلى روحنا، إلى عروقنا وشراييننا. في كلتا الحالتين القطيعة شاقة وعسيرة. وقد عبر ابن زيدون في قصيدته الشهيرة عن هذه القطيعة، كأعظم وأجمل ما يكون:
وقد نكون وما يخشى تفرقنا
فاليوم نحـن وما يـرجى تلاقينا
نكاد حين تناجيكم ضمائرنا
يقضي علينا الأسى لولا تأسينا
بل ووصل به الأمر في رفض القطيعة، وفي عدم قدرته على تحملها، إلى حد إلغائها في العالم الآخر، من خلال هذا البيت الذي لا يضاهى:
إن كان قد عز في الدنيا اللقاء بكم
في موقف الحشر نلقاكم وتلقونا
وهكذا ضرب معها موعدا فيما وراء الموت؛ فإذا كانت قد أفلتت منه في هذا العالم، فإنها لن تفلت منه في العالم الآخر!.. شيء رائع من ابن زيدون... وهذا يعني أنها حرقت قلبه حرقا، لهذا السبب فكرت يوما ما في تأليف كتاب بعنوان: من القطيعة العاطفية إلى القطيعة الإبستمولوجية[4]، أو العكس.
لكن، لنعد إلى صلب الموضوع بعد هذا الفاصل الغرامي القصير...
المبدأ السادس والأخير، الذي ينبغي أن نأخذه بعين الاعتبار، لكي نفهم عقلية القرون الوسطى، يتعلق بالانغلاق اللاهوتي الطائفي، وهو ما يدعوه أركون "بالسياج الدوغمائي المغلق أو بالسجن العقائدي"، كلنا تربينا عليه وترعرعنا داخله في طفولتنا الأولى؛ لذلك، يصعب أن نقطع معه أو نتخلص منه. ولهذا السبب، فان الطائفية التي تمزق المشرق العربي حاليا، تمثل مشكلة رهيبة وحقيقية. ومعلوم أن هذه الانغلاقات التراثية موجودة في المسيحية، كما في الإسلام وبقية الأديان الكبرى؛ فالعداء الذي كان مستحكما بين الكاثوليكيين والبروتستانتيين في أوروبا الغربية، أسال الدماء أنهارا. ولكنهم تجاوزوه عن طريق حركة التنوير الفلسفية، ثم عن طريق الفهم العقلاني والليبرالي للدين. وهنا ينبغي أن نقول ما يلي: لكي نحدد بشكل صحيح، الدور الذي لعبه الدين في التطور العام للفكر النظري والعلمي، ينبغي علينا أن نأخذ بعين الاعتبار ذلك المناخ من التنافس الحاد، والحذف المتبادل الذي مارسته مختلف فرق الأمة، ضد بعضها البعض. فاللعنات اللاهوتية كانت متبادلة على قدم وساق، بين الفرق السنية والشيعية والإباضية. وهنا ينبغي أن نعيد تقييم كل الفئات، وكل المؤلفين والمفكرين القدماء؛ فالفرق الإسلامية التي قضي عليها أو محيت من كتب التاريخ المتحيزة للسلطة والمذهب الرسمي، ينبغي أن نعيد إليها اعتبارها. وفي ذات الوقت ينبغي أن نقلل من أهمية المدافعين عن "الإيمان الصحيح" أو المدعو كذلك، والذين أخذوا أهمية مبالغا فيها داخل التراث. ينبغي أن نعيد قراءة كتب "الملل والنحل" من جديد، على ضوء علم التاريخ المعاصر. وينبغي أن نفكك كل مقولاتها ولعناتها اللاهوتية، وتكفيراتها للفرق المضطهدة أو المحاربة على مدار التاريخ. كل ذلك ينبغي أن نموضعه ضمن سياقه التاريخي، ونأخذ مسافة فكرية وعاطفية وإبستمولوجية عنه، لكي نفهمه على حقيقته؛ بمعنى آخر: لا ينبغي أن نأخذ كل ما قالته كتب الملل والنحل التقليدية، وكأنه حقائق منزلة؛ فهو مرتبط بعصره، ومصالح السلطة السائدة، والصراعات السياسية الدائرة آنذاك، أكثر مما نظن. ينبغي أن نقرأ كل ذلك على ضوء الحقيقة التالية: وهي أن كل الفعاليات الفكرية في القرون الوسطى، كانت مرتبطة بصراعات وأهواء المدينة الأرضية، ضمن مقياس أنها تستخدم حجج ومقولات المدينة السماوية، لتبرير ذاتها أو خلع المشروعية الإلهية على نفسها. بمعنى أنها تستخدم اللاهوت الديني، لتصفية حساباتها مع منافسيها على هذه الأرض؛ فالارتباط بين السماء والأرض في القرون الوسطى، كان مباشرا وقويا جدا، ولم يكن قد انقطع حبل السرة بينهما، كما حصل بعد انتصار الحداثة في أوروبا. ولهذا السبب نقول: لا معنى لتحرير الأرض قبل تحرير السماء! فالمجتمعات، ما دامت محكومة بلاهوت القرون الوسطى أو فقهها القديم، وفتاواه التكفيرية، لا يمكن أن تستقيم فيها الأمور، ولا أن تدخل الحداثة وتتطور وتتجدد. ولكن إعادة الاعتبار لما هو مطموس في التاريخ، أو مضطهد على مدار التاريخ، لا تعني الوقوع في الخطأ المعاكس؛ أي اضطهاد الأغلبية السائدة! ينبغي أن يظهر فكر جديد قادر على احتضان الجميع، أقلية كانوا أم أكثرية، دون أي استثناء أو إقصاء. فمن الواضح، أن فكر القرون الوسطى أصبح ضيقا علينا، ولا يستطيع أن يستوعبنا جميعا، أو يحل مشكلتنا، بل إنه هو الذي أصبح مشكلتنا! والدليل على ذلك، ما يحصل حاليا من انتعاش هائل للعصبيات الطائفية والمذهبية القديمة. ينبغي على الفكر العربي أن يتجرأ يوما ما، على إحداث القطيعة الإبستمولوجية مع مناخ العصور الوسطى وأفكارها القديمة، التي عفا عليها الزمن[5]. ولتحقيق ذلك، ينبغي تفكيك كل الانغلاقات التراثية المتحجرة، أو السياجات الدوغمائية المغلقة، من سنية وشيعية، وعلوية ودرزية، وإسماعيلية وإباضية، بل وحتى مسيحية عربية. وذلك، لأن المسيحية الشرقية لم تتعرض للتفكيك التاريخي والفلسفي، كما حصل للمسيحية الأوروبية التي شبعت تفكيكا ونقدا. من هذه الناحية سوف أفاجئ الكثيرين، إذ أقول بأن المسيحيين العرب في أغلبيتهم، أقرب إلى المسلمين، منهم إلى المسيحيين الأوروبيين الليبراليين، الذين هضموا كل الثورات العلمية والفلسفية المتعاقبة؛ قلت أقرب إلى المسلمين، لأنهم لا يزالون محكومين بنفس الباراديغم القروسطي للدين والتدين. في حين، أن المسيحيين الليبراليين الأوروبيين اعتنقوا الباراديغم التنويري؛ أي باراديغم الحداثة أو حتى ما بعد الحداثة.[6]
[1]- انظر الكتاب التالي للمؤرخ الفرنسي شارل مورازيه: البورجوازيون الفاتحون، منشورات كومبليكس، باريس،1999
Charles Moraze: Les bourgeois conquerants.Editions Complexe.Paris.1999
هذا الكتاب يدرس كيفية صعود الطبقة البورجوازية الصناعية في أوروبا إبان القرن التاسع عشر، وكيف نشرت في كل أنحاء العالم مبتكراتها العلمية والتكنولوجية، كيف عممت الحداثة على العالم، ثم كيف استعمرت العالم أو سيطرت عليه. عندئذ بلغت العنجهية الأوروبية ذروتها بسبب التفوق الكاسح ليس فقط على العرب المسلمين، وإنما أيضا على الصين والهند وكل الأمم الأخرى. ولكن الصين ابتدأت تنتقم الآن من ذلك الإذلال التاريخي الكبير. أما العرب...
[2]- ينبغي العلم بأن مسارنا التاريخي معاكس للمسار الأوروبي. فعندما كنا نعيش عصرنا الذهبي في بغداد وقرطبة كانوا هم يغطون في ظلمات العصور الوسطى المسيحية، المعادية لنور العلم والفلسفة. وعندما ابتدأوا ينهضون ويستيقظون بدءًا من القرن الثاني عشر، ابتدأنا نحن ندخل في ظلمات العصور الوسطى الانحطاطية، التي لم نخرج منها حتى الآن.
[3]- كنت قد تحدثت عن ذلك مطولا في كتاب: مدخل إلى التنوير الأوروبي، دار الطليعة.بيروت،2005، الفصل الأول بعنوان: عقلية القرون الوسطى، ولكني أضيف هنا أفكارا جديدة إلى ما سبق.
[4]- لتوضيح فكرتي أكثر، سوف أقول ما يلي: إن القطيعة مع التراث الديني القروسطي، الذي تربينا عليه منذ نعومة أظفارنا مهولة ومخيفة، وتسبب نزيفا حادا وآلاما مبرحة تماما، كالقطيعة الغرامية أو العشقية. لماذا؟ لأن هذا التراث متغلغل في أعماقنا النفسية. ولكن لا بد مما ليس منه بد.أعتقد أننا كعرب وكمسلمين، مضطرون في السنوات القادمة لأخذ القطيعة الإبستمولوجية مع التراث على محمل الجد. سوف نضطر لإحداث القطيعة معه، مع مناخاته النفسية وفتاواه الفقهية الانغلاقية، التي لم تعد تتناسب مع العصر. بل إنها تسبب لنا مشكلة ليس فقط مع أنفسنا، وإنما مع العالم كله. ولكن هذه القطيعة مع الباراديغم اللاهوتي للقرون الوسطى لا تعني نهاية الإسلام! فالإسلام باق حتى يرث الله الأرض ومن عليها. وإنما تعني نهاية تأويل معين للإسلام أكل زمانه، كما يقال وظهور تأويل جديد يشبه في بزوغه الشمس الساطعة. وهو الذي سينقذنا من المغطس الذي وقعنا فيه. نقصد بذلك ظهور باراديغم الإصلاح الديني وباراديغم التنوير الإسلامي أيضا.عندئذ سوف يتجلى الإسلام على حقيقته بحلة جديدة، عندئذ سوف يتبدى بكل رونقه وبهائه، بعد أن يتخلص من ركام العصور الانحطاطية وغبار القرون..عندئذ سوف يظهر عصر ذهبي آخر طال انتظاره...
[5]- ينبغي العلم بأن القطيعة مع تدين القرون الوسطى تكلف غاليا. وتجربة أوروبا تقف أمامنا كأكبر شاهد على ما أقول.
فقد شعر الأوروبيون بأنهم أصبحوا يتامى بعد تهاوي المسيحية التقليدية أو القروسطية التي عاشوا عليها أبا عن جد، منذ مئات السنين. كيف يمكن أن تقطع مع المقدس الأعظم الذي تربيت عليه أو تشربته مع حليب الطفولة؟ هذا هو معنى القطيعة الإبستمولوجية أو المعرفية. إنها ليست فقط معرفية أو فكرية، وإنما أيضا وبالدرجة الأولى نفسية وجودية. إنها ساحقة للروح، ولم يستطيعوا إقامة الحداد على المسيحية إلا بعد محاولات عديدة وعذابات كبيرة. وعندئذ حل الشاعر الكبير أو الفيلسوف محل الكاهن أو رجل الدين، لكي يقدما التعويض المعنوي عن الدين الذي كان يدخل السكينة والطمأنينة إلى النفوس. على هذا النحو حل مثقفو الحداثة العلمانية محل الكهنة المسيحيين تدريجيا. ولكن هذا لم يكن كافيا. فلم تهدأ النفوس تماما إلا بعد أن ظهر تأويل جديد للدين، وكذلك ظهور طبقة مستنيرة من رجال الدين. حول هذه المسألة الحساسة، يمكن استشارة مؤلفات الناقد الفرنسي الكبير بول بينيشو التي لم تترجم بعد إلى العربية على حد علمي.
Paul Benichou
[6]- أحيل بهذا الصدد إلى مؤلفات عالم اللاهوت السويسري الشهير هانز كونغ؛ فهو مبلور مصطلح الباراديغمات اللاهوتية التي تتالت على المسيحية الأوروبية؛ أي باراديغم القرون الوسطى،ثم باراديغم الإصلاح الديني الذي دشنه كل من لوثر وكالفن،ثم باراديغم التنوير والحداثة، ثم باراديغم ما بعد الحداثة.انظر بهذا الصدد كتابه التالي: من أجل لاهوت جديد يليق بالقرن الحادي والعشرين أو بشكل كامل: لأجل لاهوت يليق بالألفية الثالثة: نحو انطلاقة جديدة للتقريب بين المذاهب المسيحية والأديان الكبرى للبشرية.الترجمة الفرنسية.منشورات سوي.باريس.1989
Hans Kung :Une theologie pour le 3 millenaire :Pour un nouveau depart oecumenique.Seuil.Paris.1989
هذا الكتاب يشرح لنا كيف يمكن تضييق الشقة اللاهوتية بين المذاهب المسيحية الثلاثة:أي الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية. ولكنه لا يكتفي بذلك، وإنما يشرح لنا كيف يمكن إحداث التقارب بين الأديان الكبرى للعالم، وفي طليعتها الإسلام والمسيحية والبوذية والهندوسية والكنفشيوسية الخ..للأسف لم يترجم بعد هذا الكتاب إلى لغتنا العربية.






