على هامش كتاب: "الصدمة: يسوع/ محمد"
فئة : قراءات في كتب
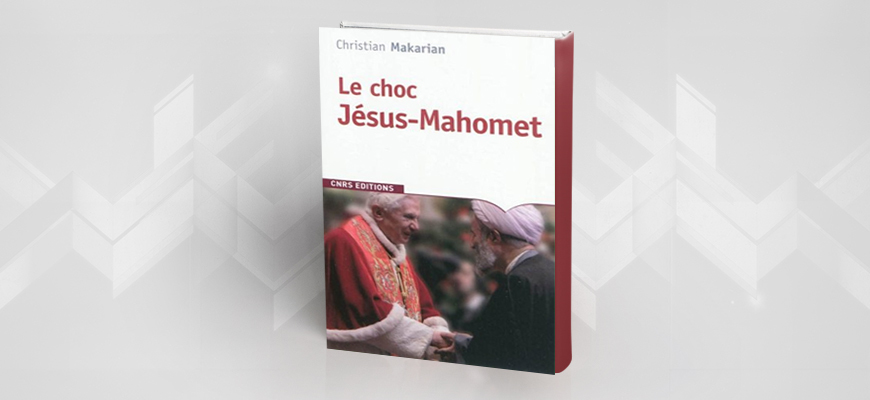
على هامش كتاب: "الصدمة: يسوع/ محمد"
تأليف: كريستيان مكاريان[1]
مؤلف هذا الكتاب هو الباحث كريستيان مكاريان المتخصص في الشؤون الدينية ونائب رئيس تحرير مجلة الإكسبريس الفرنسية، وهو يرى أن الخلاف بين الغرب والعالم الإسلامي ليس سياسيًا فقط، وإنما دينيًا بالدرجة الأولى، ولكن الجميع يحاولون طمس هذا البعد الأساسي في الصراع بين الغرب والشرق، وهم يجيشون ضد النظرية الاختزالية لصدام الحضارات كل طاقاتهم لتضييق الفجوة بين الإسلام والغرب، أو حتى عدم الاعتراف بها. والعديد من المثقفين الغربيين والقادة السياسيين يحاولون البرهنة على وجود توافق عميق بين الدين الإسلامي والمسيحية، ويحاولون جاهدين، في الوقت ذاته، بغية محاربة نفوذ الأصوليين الإسلاميين، البرهنة على أن الإسلام يدعو أولاً وبالدرجة الأولى إلى التسامح والسلام، فما هي حقيقة الأمر؟ هل كلامهم صحيح أم مجرد وهم؟ نلاحظ أثناء الإجابة عن هذا السؤال أن المؤلف يعود الى أصل الأديان وجذورها العميقة؛ أي إلى أصل المسيحية وأصل الإسلام على حد سواء. إنه يعود إلى حياة يسوع وحياة محمد، وإلى رسالتيهما وتأثير كل منهما على المجتمعات التي انتشر فيها هذان الدينان الكبيران العالميان. ويخلص في نهاية المطاف إلى النتيجة المزعجة التالية ومفادها أن كلاً من يسوع ومحمد لا يتحدثان بالضرورة عن نفس الإله ولا عن نفس القيم الدينية العليا، وبالتالي فالخلاف ديني قبل أن يكون سياسيًا بين الإسلام والغرب؛ فالإسلام في رأي المؤلف يختلف عن المسيحية جذريًا فيما يخص مسائل أساسية كمسألة السلطة، والدولة المدنية، والحب، والحرب، والمرأة، والحرية الفردية، بل فيما يخص مسألة النجاة في الدار الآخرة. ولكن البعض يحاول إيهامنا بأنهما ينتميان إلى جذر واحد هو أديان الكتاب أو الديانة التوحيدية الإبراهيمية. وبالتالي فما يجمع بينهما، بحسب رأيهم، أكثر مما يفرق. ولكن هذا ليس صحيحًا على الإطلاق، في رأي مؤلف الكتاب، فصحيح أن المسيحية تؤمن بكتاب هو الإنجيل، والإسلام يؤمن بكتاب هو القرآن، ولكن شتان ما بين الكتابين؛ فالأول مسالم جدًا، والثاني مليء بآيات القتال. وفي نهاية المطاف، فإن المؤلف يزعم بأن كتابه يتحدث عن الحوار الحقيقي؛ أي ذلك الذي يعترف بالخلافات الأساسية بين الدينين بدلاً من طمسها أو إنكار وجودها أو غض الطرف عنها. فهو يرى أن يسوع ومحمدًا لا يتحدثان عن المثل الدينية نفسها.
وقبل أن نتابع تصفح الكتاب نسجل ملاحظة اعتراضية أولى، وهي: يبدو أن منطلقه يشبه منطلق المحافظين الجدد من حيث تبخيس قيمة الإسلام والرفع من قيمة المسيحية بشكل مسبق وأيديولوجي. وهذا شيء مؤسف في الواقع، لأن الكتاب يحتوي على صفحات مضيئة وجيدة فيما عدا ذلك، فحديثه عن مقاومة الأصوليين الغربيين للنقد التاريخي المطبق على المسيحية واليهودية صحيح، وحديثه عن الإصلاح الإسلامي الذي ابتدأ منذ القرن التاسع عشر صحيح أيضًا، وتصوره لهذا الإصلاح وآفاقه المستقبلية لا غبار عليه.
ويرى الباحث بأنه يهدف من هذا الكتاب إلى تبيان الدور الذي يلعبه العامل الديني في الشقاق بين الغرب والشرق، ولا زال الباحثون إلى الآن يركزون على العامل السياسي ومرحلة الاستعمار ويهملون عامل الدين، وهذا خطأ كبير في رأيه؛ فالاختلاف الديني يلعب دورًا كبيرًا في تشكيل الهوة السحيقة التي تفصل بين الغرب من جهة، والبلدان العربية ثم الإسلامية ككل من جهة أخرى. ويرى أنه من الخطأ القول بأن الأصولية الإسلامية ليست إلا الشبيه المطابق للأصولية المسيحية وهيجاناتها إبان المرحلة الصليبية قبل ألف عام. وبالتالي فمن الوهم الاعتقاد بأن تقدم الشعوب الإسلامية سوف يؤدي إلى نهاية المشكلات، وتعود الأمور إلى نصابها، وهذا خطأ كبير وخطير في رأيه، ولا نعرف لماذا؟ لا نعرف لماذا تكون الأصولية الإسلامية مزعجة وخطيرة على عكس الأصولية المسيحية أو اليهودية التي تفتك الآن فتكًا ذريعًا في فلسطين؟ هل نسي محاكم التفتيش؟ هل نسي الحروب المذهبية الكاثوليكية البروتستانتية؟ هل نسي التعصب الديني الأعمى الذي حاربه فولتير، والذي عصف بالقارة الأوروبية قبل أن تتحضر وتستنير؟ مرة أخرى نعترض ونجد أنفسنا عاجزين عن الفهم، ومع ذلك سنتابع.
أما الخطر الثاني في رأي المؤلف، وأوافقه الرأي هنا، فيتمثل في ترك التيارات المتعصبة في الغرب تقوى كرد فعل على الأصولية الإسلامية النامية حتى في بلدان المهجر الأوروبي، فهو يحذرنا قائلاً وبحق: لا ينبغي أن نهمل تزايد تيار غربي متطرف شديد المعاداة للإسلام دينًا، فهو يزداد قوة في فرنسا وبقية أنحاء أوروبا وأمريكا. والواقع أن هناك تيارين في الغرب: التيار الإلحادي الذي يعادي الإسلام بصفته آخر الظلاميات الأصولية بعد أن تم القضاء على الأصولية المسيحية سابقًا. وبالتالي، فهذا التيار معادٍ لكل الأديان وليس للإسلام فحسب. وأما التيار الغربي المحافظ أو اليميني المتطرف، فيصور العالم الإسلامي على أساس أنه موجة هاجمة علينا تريد أن تكتسح حضارتنا وتدمرها. وعلى الرغم من أن هذين التيارين يكرهان بعضهما بعضًا إلا أنهما يتفقان بشكل لا إرادي على اعتبار الإسلام العدو المشترك في القرن الحادي والعشرين. إنهما يعتبرانه العدو الأساسي لأسباب مختلفة أو حتى متضادة.
ويقول المؤلف في مكان آخر: كان فولتير يعتقد عام 1778 بأن الكتاب المقدس؛ أي التوراة والإنجيل، سوف يندثر بعد قرن واحد فقط، ولن يعود أحد يجده إلا إذا بحث عنه لدى تجار العاديات القديمة والآثار. ولكن نبوءته لم تتحقق، فلا يزال الكتاب المقدس منتشرًا في كل مكان ومترجمًا إلى لغات العالم كلها. ولكن فاته أن يقول بأن هذا الكتاب المقدس لم يعد قمعيًا ملزمًا بشكل حرفي كما كان في السابق. لماذا؟ لأن المسيحية الليبرالية انتصرت على المسيحية الأصولية المتزمتة بفضل فولتير وسواه من فلاسفة الأنوار. وهذا ما لم يحصل في الإسلام حتى الآن، إلا في الأوساط الضيقة للمثقفين الحداثيين. أما جماهير الشعب، فلا تزال في جهة المشايخ التقليديين والنظرة القديمة للدين.
ما معنى الأصولية اليهودية المسيحية؟
يرى المؤلف أن اليهود الأرثوذكس والمسيحيين التقليديين الماضويين والبروتستانت الأصوليين يعتبرون كل سطر وكل كلمة من التوراة والإنجيل، كأنها حقيقة إلهية لا تناقش. إنهم في الواقع، يطبقون على الكتاب المقدس تحديدًا قريبًا جدًا من التحديد القرآني في قوله تعالى: "ذلك الكتاب لا ريب فيه" (البقرة، 2). ولكن القراءة النقدية التاريخية تفرق بين الأسطورة والحقيقة الفعلية عندما تقرأ قصص التوراة والإنجيل، وهذا ما لا يستطيع أن يفهمه المسيحي التقليدي أو اليهودي الأرثوذكسي، فهو يأخذ كل شيء على حرفيته، ويخشى أن يفقد إيمانه وكل قناعاته إذا ما طبق التفسير الحديث على كتابه المقدس. من هنا جاء رد الفعل العنيف على المناهج الحديثة من طرف المؤمنين التقليديين. إنهم قد يضربوك أو يغتالوك إذا ما فسرت التوراة والإنجيل بطريقة لغوية تاريخية، إنهم يعتبرون ذلك عدوانًا عليهم، وذلك يزعزعهم في الصميم، الشيء نفسه يحصل بالنسبة للمسلمين الأصوليين. وبالتالي فلا يوجد أي فرق هنا بين موقف الأصولية اليهودية، أو الأصولية المسيحية، أو الأصولية الإسلامية، فجميعها تتخذ الموقف المتشنج نفسه من الحداثة الفكرية والمنهج التاريخي، ونتفق هنا مع صاحب الكتاب، فالظاهرة الأصولية الانغلاقية هي ذاتها في كل الأديان. ثم يردف المؤلف قائلاً: تقتضي الأمانة الموضوعية منا الاعتراف بوجود تكرار كثير في الأناجيل، بل تناقضات ونواقص وإضافات واختلافات في الأسلوب والمفردات المستخدمة. نعم، هناك اختلافات وتناقضات بين إنجيل متى وإنجيل مرقص وإنجيل لوقا وإنجيل يوحنا، ولكن يصعب على الكنيسة الكاثوليكية أن تعترف بذلك، وكثير من الأصوليين المسيحيين التقليديين لا يزالون مخلصين للتفسير القروسطي التبجيلي الخرافي القديم، إنهم يرفضون التفسير التاريخي العقلاني الحديث. وضمن هذا الجو اندلعت الأزمة الحداثية في فرنسا وعموم أوروبا بداية القرن العشرين عام 1908. وهذه الأزمة راحت تزعزع الكاثوليكيين طيلة عدة عقود، وكل ذلك كان ناتجًا عن الثورة الصناعية التي قلبت الشروط المادية والفكرية لحياة الشعوب الأوروبية. وبسبب الحداثة واندلاع ثورة المواصلات والأفكار، فإن الكتاب المقدس شهد من الزعزعات النقدية والتأويلية طيلة الخمسين سنة الماضية ما لم يشهده طيلة 1900 سنة من تاريخه. وعندئذ ولد لأول مرة التفسير التاريخي النقدي للكتب المقدسة، وهذا التفسير النقدي يرتكز على العقل، وينفصل بالتالي عن الرؤيا الساذجة من جهة، وعن التفاسير التقليدية الموروثة من جهة أخرى. ومعلوم أنها كانت مسيطرة على عموم اليهود والمسيحيين منذ مئات السنين. وإن اللاهوتي الفرنسي المحترم ألفريد لوازي وأبطال المنهج التاريخي كانوا يريدون تطبيق العلوم الإنسانية على المقدسات اليهودية والمسيحية، وكانوا يبغون التوصل إلى التفسير التاريخي للنصوص المقدسة من توراة وأناجيل، وكانوا يريدون أن يستكشفوا بشكل واقعي محسوس سيرة مؤلفيها، والبيئة التي ظهروا فيها، والعصر والزمان والمكان واللغة والسياق السياسي لتلك الفترة...إلخ. وقد تمخضت هذه العملية عن معرفة علمية تاريخية بهذه النصوص المدعوة بالمقدسة من توراة وأناجيل، وهي فعلاً مقدسة بالنسبة لأصحابها ولكنها ليست مقدسة بالنسبة للبوذيين أو الهندوسيين أو المسلمين مثلاً، والعكس صحيح أيضًا. على أي حال، فإن هذا التفسير العلمي التاريخي الحديث أفضل بكثير من التفاسير التقليدية التبجيلية الموروثة، ولكن الكنيسة الكاثوليكية قاومت هذا التيار التجديدي لعدة عقود، واضطهدت العلماء المجددين وفي طليعتهم ألفريد لوازي[2] قبل أن تستسلم له أخيرًا إبان الفاتيكان الثاني 1962-1965. والشيء الذي صعق المسيحيين واليهود هو ذلك الاكتشاف المذهل للعالم البريطاني جورج سميث[3]. فقد ألقى في المتحف البريطاني محاضرة عصماء بتاريخ 3 دجنبر من عام 1872؛ أي في أواخر القرن التاسع عشر. ويقول فيها إن قصة طوفان نوح الواردة في سفر التكوين التوراتي منقولة حرفيًا تقريبًا عن ملحمة غلغامش الآشورية الشهيرة، وهذا يعني أن الكتب السماوية ليست سماوية إلى الحد الذي نتصوره، إنها أفقية أرضية لا شاقولية عمودية كما توهمنا منذ قرون، وليست كلها نازلة علينا من فوق إلى تحت، بل لها محايثات أرضية عديدة ابتدأ العلماء باكتشافها تدريجيًا، وهذا الاكتشاف زلزل الوعي الإيماني في الصميم.وهذا يعني أن ما كانوا يعتقدون أنه نازل من السماء بقضه وقضيضه ليس إلا نسخة أرضية بكل بساطة، عندئذ حارت عقول المؤمنين، بل وجن جنون الأصوليين اليهود والمسيحيين عندما سمعوا بذلك. ويرى المؤلف أن هذا ما ينقص الإسلام بشكل موجع حتى الآن، تلزمه صدمة الحداثة والوعي التاريخي لكي يستيقظ من سباته وجموده، فلم يشهد الإسلام بعدُ ثورته اللاهوتية كما حصل للمسيحية بعد عصر التنوير الكبير، لذا لا توجد حتى الآن إلا التفاسير التقليدية في العالم الإسلامي، ولا يوجد أي تفسير تاريخي أو علمي حديث للقرآن الكريم، وترفض السلطات الدينية الإسلامية بشكل قاطع تطبيق المنهج التاريخي النقدي عليه. من هنا يأتي الانسداد التاريخي لكل العالم العربي والإسلامي. وحده الاستشراق الأكاديمي عوض هذا النقص عندما طبق المنهج التاريخي النقدي على التراث الإسلامي تمامًا كما فعل العلماء الذين ذكرناهم بالنسبة للتراث اليهودي والمسيحي. انظر كتاب نولدكه الشهير عن "تاريخ القرآن" وكيف صودرت ترجمته[4] في بيروت مدينة التنوير العربي.
هل توجد قطيعة بين الفترة المكية والفترة المدنية؟
يقول المؤلف ما معناه أن البعض يعتقد بوجود قطيعة واضحة بين السور المكية ذات الطابع الروحاني الصوفي النبوي والفترة المدنية ذات الاستلهام السياسي الحربي العنيف غالبًا؛ بمعنى آخر فإن الإسلام الطيب المنفتح المتسامح يتوقف عام 622م لكي يفسح المجال لإسلام آخر أكثر قسوة وقمعًا وتعصبًا وانغلاقًا؛ أي أنه إذا ما اكتفينا بالفترة المكية فإننا سنجد قرآنًا آخر، قرآنًا مليئًا بالمبادئ الكونية المثالية المسالمة، قرآنًا قادرًا على التعايش مع أهل الكتاب من يهود ومسيحيين أو حتى مع المسلمين العلمانيين التحديثيين. أما القرآن المدني فشيء آخر. هذه الفكرة راسخة في العقول ومنتشرة جدًا في الأوساط التقدمية للأنتلجنسيا العربية، ولكن في الواقع من التعسف والاعتباط والاصطناع أن نقسم القرآن الى فترتين متمايزتين كليًا، فهو معقد ومتداخل ومتناقض أكثر مما نظن. نعلق هنا على كلام المؤلف قائلين: لقد جانبه الصواب إلى حد ما، إذ رفض الاعتراف بوجود فرق بين السور المكية والسور المدنية، فالثانية تحتوي على آيات القتال على عكس الأولى، والسبب ليس العنف الأزلي للإسلام أو لنبيه الكريم، وإنما أملت ذلك الظروف بشكل إجباري. فقد كانت الدعوة مهددة والنبي لم يحمل السلاح إلا اضطرارًا. والدليل على ذلك، أنه تحمل الأذى والضرر طيلة سنوات وسنوات إبان الفترة المكية، وبالتالي فآيات القتال مرتبطة بظروفها وحيثياتها وليست أبدية، على عكس آيات السلام والصفح والمغفرة والاعتراف بمشروعية الأديان الأخرى. ومعلوم أن المرحوم الشهيد محمود محمد طه كان قد ركز كثيرًا على التفريق بين القرآن المكي والقرآن المدني، وهذا لا يعني بالطبع أن القرآن المدني مرفوض، معاذ الله، ولكنه يعني أنه يتطلب تأويلاً تاريخيًا محررًا فيما يخص آيات القتال التي تشكل جزءًا منه لا كل الأجزاء؛ بمعنى آخر تنبغي تأريخ آيات القتال وتكفير اليهود والمسيحيين: أي ربطها بظروفها التاريخية، لكي تصبح نسبية لا كونية إجبارية دائمة إلى أبد الدهر.
ويضيف المؤلف، على صعيد آخر، الفكرة التالية التي قد تصدمنا: نلاحظ على المستوى اللاهوتي أن القرآن ليس كله عربيًا على عكس ما نظن؛ فالتوراة لعبت دورًا حاسمًا في تشكيل كتاب الإسلام، لقد استعار القرآن الكثير من قصصه وموضوعاته من التوراة والإنجيل، وهو يعترف بذلك صراحة ولا يخفيه، إنه يعترف بأبوة التوراة له، ونضرب على ذلك الأمثلة التالية:
قوله تعالى في سورة الأنبياء الآية 105:"ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون" وهذا نقل واضح عن المزمور 37،29: "والأبرار يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد". وانظر سورة يونس الآية رقم 22، فهي ذات علاقة مباشرة بالمزمور 107،23-30، إذ تقول الآية الكريمة: "هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين".ويقول المزمور التوراتي:
"كانوا يخوضون البحر في السفن يسعون للعمل في المياه الغزيرة
هم الذين عاينوا أعمال الرب وعجائبه في الغمار
قال فقامت ريح عاصفة ورفعت أمواجه
يصعدون إلى السماء ويهبطون إلى الأعماق فتذوب نفوسهم من الشرور
يدورون ويترنحون كالسكران وقد ابتلعت حكمتهم كلها
فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأخرجهم من شدائدهم
حول الزوبعة إلى سكينة فسكتت الأمواج
ففرحوا عندما سكنت وهداهم ميناء بغيتهم"
وأما آية الكرسي التي تقول:"لا تأخذه سنة ولا نوم"؛ فهي في رأي المؤلف ترجمة شبه حرفية للمزمور 121،4 لا أبدًا لا ينعس ولا ينام حارس إسرائيل. وبالتالي، فاستعارات القرآن من الكتاب المقدس لا تحصى ولا تعد، ولكن هل يعني ذلك أن القرآن هو مجرد "فوطوكوبي" أي نسخة طبق الأصل عن التوراة كما يزعم بعض المستشرقين؟ بالطبع لا، وألف لا، نجيب نحن على عكس المؤلف. لأن للقرآن عبقريته الخاصة، صحيح أن فيه كثير من الكتب السابقة له ولكنه أخرج كل ذلك في قالب عربي لا مثيل له، لقد دشن ديانة التوحيد باللغة العربية كما دشنها أنبياء اليهود سابقًا باللغة العبرية وكما دشنها يسوع المسيح بالآرامية، وبالتالي فعبقرية القرآن لا يشك فيها إلا جاهل أو مغرض.
ويرى المستشرق الألماني ذو الاسم المستعار لوكسنبيرغ[5] أن كلمة "نقد" تثير تحفظات لدى المسلمين، لأنهم يرون فيها تهجمًا على القرآن، وهذا خطأ، إذ ينبغي العلم بأن أسلافهم كانوا أكثر نقدًا وحدة في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين؛ أي الثالث والرابع للهجرة، فبعض مفكريهم كانوا يقولون آنذاك بأن القرآن كلام بشري يمكن دراسته بصفته تلك، ولكن الآخرين الذين قالوا بأنه كلام إلهي هم الذين انتصروا وتغلبت وجهة نظرهم في نهاية المطاف. لذا ما عاد بالإمكان بدءًا من القرن العاشر تقريبًا القيام بدراسات نقدية عن القرآن. فما أن ظهر تفسير الطبري حتى أصبح التعليم الرسمي الأرثوذكسي للإسلام، فيما يخصني لا أهدف إطلاقًا إلى مهاجمة القرآن، وإنما إلى تقديم فهم مناسب له، سوف تحصل حتماً حركة إصلاحية في الإسلام يومًا ما، والواقع أن بعض شيوخ الأزهر أعلنوا تمسكهم بالقرآن فقط ورفض كل ما تبقى، بما في ذلك الشريعة والأحاديث النبوية التي يعتبرونها مختلقة وملفقة، وهذا ما يدعى بالإسلام القرآني. ثم يخلص كريستيان مكاريان إلى النتيجة التالية: وهي أن القرآن من وجهة نظر عقلانية يبدو عملاً بشريًا ملهمًا ربانيًا تمامًا كالتوراة والإنجيل، إن الكتاب المقدس لليهود والمسيحيين يعترف بذلك ولكن القرآن يرفض اعتبار ذاته كلامًا بشريًا ذا استلهام رباني، وهذا يعني أنه لا يمكن للمثقف المسلم أن يتخذ مسافة عنه لكي يفهمه على حقيقته ككتاب ظهر في زمن ما وبيئة ما؛ أي في الجزيرة العربية إبان القرن السابع الميلادي. هذا الموقف يشل الروح النقدية ويعطل الأنوار الفكرية في الإسلام على عكس الغرب، ويرى الباحث أن مؤسسي الإسلام اذ خلعوا على القرآن هذا الطابع الإلهي الخارق للطبيعة طامسين بعده البشري التاريخي بالكامل قد أرادوا وضعه فوق الكتب السابقة له؛ أي فوق كتب اليهود والمسيحيين. كما وأرادوا بذلك طمس الاستعارات العديدة التي أخذها القرآن من التوراة والإنجيل. كان ينبغي بأي شكل أن يختم محمد سلسلة الأنبياء بدءًا من إبراهيم وموسى. كان يلزم بأي شكل أن يتجاوز أنبياء بني اسرائيل ويحل محل يسوع، بل وكان يلزم بأي شكل أن يتفوق إنجازه على إنجاز يسوع، فمحمد هو خاتم الأنبياء وهو أعظم الأنبياء في رأي المسلمين. كما كان يلزم بأي شكل أن يفرض الإسلام نفسه ضد الدينين التوحيديين السابقين له. وبالتالي، فالإسلام ولد منذ البداية على هيئة صراع ضد اليهود والمسيحيين.
احترام الآخر أو عدم احترامه من قبل القرآن والإسلام:
نلاحظ أن المشكلة تبلغ ذروتها بين الإسلام والغرب، يقول الباحث بأن استعارات الإسلام من الديانتين التوحيديتين اللتين سبقتاه لا تشكل أية مشكلة تستعصي على التجاوز؛ فالمسيحية نفسها استعارت كثيرًا من اليهودية التي سبقتها، وهذا أمر طبيعي. ومعلوم أن القرآن يمجد النبي موسى تمجيدًا، ويحترم يسوع أو عيسى كل الاحترام، وإن كان يقدم عنه صورة مضادة للصورة السائدة في الدين المسيحي، كما يقدس مريم العذراء أم المسيح، وهي المرأة الوحيدة المذكورة في القرآن. فكيف يمكن أن نفسر اندلاع الصراع بين الإسلام والغرب إلى مثل هذا الحد؟ وهو صراع يضغط على مصير العالم المعاصر بأسره. ويجيب المؤلف قائلاً: لا ريب في أن آثار الحروب الصليبية والاستعمار لعبت دورها في تراكم الأحقاد بين الطرفين. ولا ريب في أن التخلف وسوء التنمية وطغيان الأمية وكل الأشياء الأخرى التي يعاني منها عالم الإسلام لعبت دورها أيضًا. أضف إلى ذلك الصدمة الحاصلة في العالم الإسلامي بين القيم التقليدية والحداثة، وكذلك نأخذ بعين الاعتبار التشنج الهوياتي في مواجهة البلدوزر الكاسح للعولمة الرأسمالية. وينبغي ألّا ننسى عدم وجود حريات في العالم العربي أو تناوب ديمقراطي على السلطة، وألّا ننسى الآثار السلبية الناتجة عن الصراع العربي الإسرائيلي المزمن. كل هذه العوامل حاسمة وتلعب دورًا في زيادة الشقة أو الهوة بين الغرب والعالم الإسلامي. ولكن هناك عامل آخر مهم جدًا نادرًا ما يحظى باهتمام الباحثين ألا وهو: العامل الديني العميق الراسخ الجذور في العقليات الجماعية، ومعلوم أن الأصوليين يستمدون منه قوتهم ومشروعيتهم، بل يستخدمونه بكل فعالية لتبرير التفجيرات والعمليات الإرهابية الدموية.
ثم يضيف الباحث أن أغلبية المثقفين الفرنسيين يرفضون الدخول في الإشكالية الدينية ويركزون على العوامل السياسية التي تفرق بين الغرب والعالم العربي، ولكن هذا خطأ؛ فالعالم العربي والإسلامي كله لا يمكن فهمه دون أن نأخذ تأثير الثقافة القرآنية عليه، وبالتالي فلا يمكن أن نفهم سبب الصراع الجاري بين الغرب والإسلام إن لم نأخذ هذا العامل الأساسي بعين الاعتبار، فالقرآن يتخذ موقفًا حازمًا صارمًا من اليهود والمسيحيين على حد سواء، وإن كان عداؤه لليهود أكبر. ولا يمكن تحاشي السؤال التالي: ما هي مكانة غير المسلمين في الإسلام؟ وبأي شيء يختلف موقفه من الأديان الأخرى عن موقف المسيحية؟ لكي نجيب بدقة على هذين السؤالين ينبغي أن نعود إلى النصوص التأسيسية، إذ يرى المؤلف أن أول شيء نلاحظه هو أن القرآن مليء بالإدانات اللاهوتية لليهود والمسيحيين، في حين أن هذه الإدانات أو اللعنات اللاهوتية غير موجودة في التوراة والإنجيل، فما هو السبب؟ هل ذلك ناتج عن كون القرآن آخر ما ظهر؟ وبالتالي فهو ميال الى اعتبار نفسه الحقيقة النهائية، إذا ما أجبنا بالإيجاب على ذلك فإن هذا يعني عدم الأخذ بعين الاعتبار للعديد من السور التي تتوعد اليهود والمسيحيين بمصير مرعب وقاتم في الدار الآخرة. وكل ذلك بغية البرهنة على أن الإسلام كان هو الدين المرضي عند الله منذ بداية الخليقة وليس فقط منذ بداية ظهوره تاريخيًا. ويقول الأصوليون الإسلاميون بأن كل المؤمنين الإبراهيميين الذين سبقوا محمد خانوا الرسالة الأولية وحرفوها. ويرى المؤلف أنه توجد هنا مشكلة كبيرة جدًا، بل وهنا يكمن السبب الأساسي لاحتدام الصراع بين الإسلام والغرب. وعليه، فالسبب ديني لاهوتي قبل أن يكون سياسيًا، إذا لم نأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار، فإننا لن نفهم شيئاً وسوف يغيب عن بالنا لب المشكلة وجوهرها. وعليه، فإن أساس المشكلة ديني وليس سياسيًا. هنا يكمن المضمون الأساسي لفكر المؤلف والرسالة التي أراد توصيلها لأصحاب القرار وقادة الرأي العام من مفكرين وسياسيين.
[1] عنوان الكتاب بالفرنسية هو التالي:
Christian Makarian: Le choc Jesus – Mahomet
CNRS.Paris.2011
[2] Alferd Loisy: 1857-1940
كان يقول: إذا لم تتركنا الكنيسة الكاثوليكية نطبق المنهج التاريخي على الإنجيل، فسوف نضطر إلى تبني التفاسير البروتستانتية أو حتى تفاسير الملاحدة.وقائل هذا الكلام كان رجل دين.
[3]George Smith: 1840-1876
هو عالم الآشوريات والحفريات الأركيولوجية الشهير مات في مدينة حلب بسوريا
[4] انظر الطبعة الفاخرة لترجمة الكتاب بإشراف الباحث جورج تامر وفريق كامل من الباحثين المترجمين
الطبعة الأولى، بيروت، 2004
مقدمة جورج تامر ممتازة
والكتاب يتجاوز الثمانمئة صفحة من القطع الكبير
وقد نشر بدعم من مؤسسة كونراد- أدناور
[5] Christoph Luxenberg
الاسم المستعار لمستشرق ألماني من أصل لبناني
وهو باحث فيلولوجي لغوي بالأساس: أي يطبق المنهجية التاريخية اللغوية على القرآن مثلما طبقت سابقًا على التوراة والإنجيل. وقد غير اسمه أو اتخذ اسمًا مستعارًا خوفًا على نفسه من القتل، والبعض يعتبر أن نظريته أحدثت زلزالاً في مجال الدراسات القرآنية، ولكن البعض الآخر يعتبر أن فيها تهورًا ومجازفات كثيرة، والله أعلم.






