القرآن ومطلب القراءة الداخلية سورة التوبة أنموذجاً
فئة : حوارات
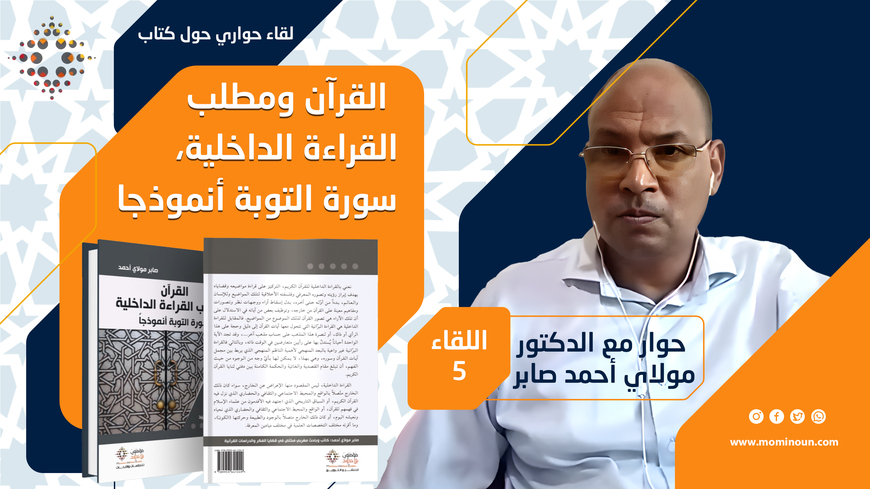
القرآن ومطلب القراءة الداخلية سورة التوبة أنموذجاً[1]
د. حسام الدين درويش
د. رضوان السيد
د. مولاي أحمد صابر
د. ميادة كيالي
د. ميادة كيالي:
أهلاً وسهلاً بكم في حوارٍ جديدٍ من سلسلة الحوارات التي تنظمها مؤسسة «مؤمنون بلا حدود»، حيث نلتقي اليوم لمناقشة كتاب «القرآن ومطلب القراءة الداخلية، سورة التوبة أنموذجاً» للدكتور مولاي أحمد صابر. ومنذ انطلاقة هذه السلسلة، حرصنا على تسليط الضوء على المشاريع الفكرية الحديثة وأحدث الإصدارات، من خلال استضافة نخبة من المفكرين والباحثين. وما يميز هذه السلسلة هو تنوع المواضيع التي تشمل الدراسات الفلسفية والدينية على حد سواء، مما يعكس التزامنا بتقديم نقاشاتٍ غنيةٍ تعمق الفهم وتثري المعرفة.
يسعدني، اليوم، أن أقدم لكم الدكتور مولاي أحمد صابر، الذي تربطني به علاقةٌ مهنيةٌ تمتد لأكثر من خمسة عشر عاماً، حيث بدأت معرفتي به، عندما اخترته للعمل معي في الإمارات عام 2008 في مركز الأبحاث الذي أديره حتى اليوم. ويتوزع الكتاب الذي نناقشه اليوم إلى مقدمةٍ وخاتمةٍ وأربعة فصولٍ رئيسةٍ هي: الفصل الأول: القرآن الكريم والرؤية الأخلاقية إلى العالم، الفصل الثاني: سورة التوبة قراءة وتحليل، الفصل الثالث: الحرية قيمة ومبدأ في الوجود الإنساني، والفصل الرابع: الأبعاد الأربعة في تكوين الإنسان.
يقدم كتاب «القرآن ومطلب القراءة الداخلية» منهجيةً لفهم القرآن الكريم من الداخل، من خلال التركيز على قراءة مواضيعه وقضاياه بهدف إبراز رؤيته المعرفية وفلسفته الأخلاقية. وتسعى هذه القراءة الداخلية إلى فهم القرآن من خلال نظامه الداخلي المتكامل، وتجاوز التفسيرات التقليدية التي تفرض مفاهيم خارجية على النص القرآني.
أدعوكم الآن إلى متابعة الحوار الذي سيديره الدكتور حسام الدين درويش، لمناقشة كتاب الدكتور مولاي أحمد صابر.
د. حسام الدين درويش:
شكراً جزيلاً دكتورة ميادة، مساء الخير للجميع، شكراً لحضوركم، وشكر خاص للدكتور صابر على تلبية الدعوة بحماسٍ، وقد سبق هذا اللقاء نقاشاتٌ تحضيريةٌ كثيرةٌ. وسأبدأ بسؤال يتعلق بموقع هذا الكتاب في أعمال الدكتور صابر عموماً؛ فالكتاب امتدادٌ لكتبٍ سابقةٍ منها: «منهج التصديق والهيمنة في القرآن: سورة البقرة أنموذجاً»، و«الوحي: دراسة تحليلية للمفردة القرآنية»، وكتاب «التداول اللغوي للمفردة بين الشعر والقرآن». وسأستند، في بعض أسئلتي، إلى بعض ملاحظات الدكتور رضوان السيد الذي يشيد، فيها، بهذا الكتاب، في تقديمه له، من ناحية أنه يحقق تقدّماً ملحوظاً، مقارنةً بالكتب السابقة. هل يمكنك، دكتور صابر، أن تحدثنا عن موقع هذا الكتاب؟ وما التقدم وما الجديد الذي تضمنه، مقارنة بالكتب السابقة التي تتبنى الرؤية والمنهجية ذاتها؟
د. صابر مولاي أحمد:
تحية طيبة للجميع، وأنا سعيدٌ كلّ السعادة لحضوري في هذا اللقاء العلمي. شكراً لمؤسسة مؤمنون بلا حدود على نشر الكتاب، وعلى تتبعه منذ بدايته، بتحويله إلى لجنة التحكيم، وقد حكّم مرتين. شكراً للمحكمين، والشكر موصول كذلك للدكتور رضوان السيد على تقديمه للعمل، وأنا سعيد بهذا التقديم. وكل الشكر والتقدير للدكتورة ميادة وعلى هديتها الجميلة؛ الصور التي عرضتها أمام الجمهور، وقد أخذتني إلى زمن جميل ورائع؛ فقد قضيت مع السيدة ميادة وقتاً جميلاً ومثمراً، فيه مساحات راقية من الاعتراف والتشجيع والعناية بالسؤال والبحث المعرفيين. كما أشكرك العزيز الدكتور حسام الدين درويش على الإعداد والأسئلة الجادّة.
في الحقيقة، كتاب «القرآن ومطلب القراءة الداخلية: سورة التوبة أنموذجاً» هو امتدادٌ لما سبقه من الأعمال؛ فقد صدر لي عن مؤسسة مؤمنون بلا حدود سنة 2017م، كتاب «منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجاً»، وهو كتاب يدور حول فكرةٍ عامةٍ مفادها، أن القرآن يتضمن اعترافاً «مصدقاً» بما سبقه من الكتاب. قال تعالى: {وَإِلَى السَّماءِ كَيْفَ رُفِعَتْ *وَإِلَى الْجِبالِ كَيْفَ نُصِبَتْ} (الأعلى). ولم يتوقف القرآن عند الاعتراف «التصديق»، دون أن يربطه بوعيٍ منهجيٍّ مفاده أنه كتاب «مهيمن» على ما سبقه من الكتاب، وأنه خطابٌ للناس جميعاً ورسالةٌ عالميةٌ وكونيةٌ، وليس حكراً على أحدٍ دون آخر. ومصطلح الهيمنة حاضرٌ ومتداولٌ، بشكلٍ كبيرٍ، في العلوم السياسية، فنقول الهيمنة الأمريكية أو الهيمنة الأوروبية؛ بمعنى سيطرة مجموعةٍ على أخرى، أو سيطرة دولةٍ على مجموعة من الدول. أما مفهوم الهيمنة في القرآن فبعيدٌ كلّ البعد عن مفهوم التسلط والسيطرة والتَّحكم، وقريبٌ من مفهوم الائتمان والرحمة والاعتراف. فالله عــــز وجل احتفظ لنفسه بفعل الهيمنة، فلا مهيمنٌ قبله ولا بعده، لكن خص القرآن، فقط، بهذا الوصف، دون غيره من الكتب التي سبقته. وصفة التصديق يشترك فيها القرآن مع ما سبقه من الكتاب. قال تعالى: {وَإِذْ قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْراةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمّا جاءَهُمْ بِالْبَيِّناتِ قالُوا هَذا سِحْرٌ مُبِينٌ} (الصف).
فمفردة «مهيمن» وردت في القرآن مرتين: المرة الأولى: جاءت اسماً لله عز وجل، قال تعالى: {الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ} (الحشر/23)؛ أي الكمال لله في القدرة والفعل والتصرف، وهو المؤتمن على كل شيء. والمرة الثانية جاءت وصفاً للقرآن الكريم. قال تعالى: {وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ} (المائدة/48). فمفهوم الهيمنة يدور في مدار الرحمة والائتمان والاعتراف؛ فالله جلّ وعلا برحمته الواسعة مؤتمنٌ على كلّ شيء في الوجود بأكمله، قال تعالى: {وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ} (الأعراف/156). كذلك هو القرآن مؤتمنٌ على ما سبقه من الكتاب بفعل هيمنته التي تتضمن الاعتراف والحوار مع ما سبقه من الكتب بغاية إظهار وتجلية النور الذي تتضمنه الكتب السابقة عنه. وقد بينت، من خلال كتاب «منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجاً»، كيف يمكن من خلال هذا المنهج، فهم الكثير من المواضيع في علاقة القرآن بما سبقه من الكتاب.
بعد انتهائي من هذا العمل، وجدت نفسي أمام سؤالٍ يدور حول ماهية مفهوم الوحي من داخل القرآن الكريم. وللإجابة عنه خصصت له كتاب «الوحي: دراسة تحليلية للمفردة القرآنية»، وقد صدر عن مؤمنون بلا حدود سنة 2019م. فمفردة الوحي تشترك بشأنها مساحاتٌ كثيرةٌ من الأديان السابقة على الإسلام، وأقصد اليهودية والمسيحية. السؤال، هنا، ما المفهوم الذي أعطاه القرآن لمفردة الوحي؟ هل هو المفهوم نفسه الشائع والمتداول في الثقافة العربية الإسلامية؟ هل الوحي جزءٌ من الثقافة أم منفصلٌ عنها؟ فهذا الكتاب فيه تقريبٌ لمفهوم الوحي؛ بوصفه متصلاً مع الثقافة، ومنفصلاً عنها، في الوقت نفسه. فالقرآن لم ينزل في فراغٍ، بل نزل في واقعٍ ثقافيٍّ، في القرن السابع الميلادي، في جزيرة العرب. كما أن هذا الكتاب يتضمن اشتباكاً، مع طروحات نصر حامد أبو زيد، ومع اتجاهاتٍ فكريةٍ أخرى ارتأت أن تختزل مفهوم الوحي، بشكلٍ كبيرٍ، في كلّ ما هو ثقافيٌّ. وحقيقة الأمر أن الوحي متصلٌ بالثقافة، ومنفصلٌ عنها؛ بمعنى أن الوحي متجاوزٌ للحظته الزمنية. فهو داخل الثقافة وخارجٌ عن الثقافة. وهذه مسألة تأخذنا لموضوع اللغة في القرآن. فهل استعمل القرآن مختلف مفردات اللغة داخل المجتمع العربي في القرن السابع الميلادي، بالحمولات والمعاني نفسها التي كانت عليها؟ أم إن القرآن له نظمه وحمولاته الخاصة لمفردات اللغة من داخله؟ القرآن حاسمٌ في هذه المسألة. ففي الوقت الذي وُصف فيه الرسول بالشاعر، كان ردّ القرآن واضحاً: {*وَما عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَما يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلاّ ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ} (يس) وفي هذا توجيهٌ للعرب حينها بألا يتعاملوا مع القرآن ومفرداته من خلال التعامل ذاته الذي يتعاملون به مع أشعارهم ومفرداتها؛ فالفرق ما بين مفردات أشعارهم ومفردات القرآن يعود إلى اختلاف الحمولة المعرفية لكل منهما. وهذه مشكلةٌ معرفيةٌ ومنهجيةٌ لازمتنا حتى الوقت الحاضر؛ وذلك بإسقاط كلّ ما تضمه معاجم اللغة العربية على فهم القرآن، مع العلم أن جلّ المفسرين قد فسروا القرآن من خلال ما هو واردٌ في الشعر العربي. ونستحضر، في هذا الخصوص، الأثر الذي ورد عن ابن عباس قوله: «إذا قرأتم شيئاً من كتاب الله فلم تعرفوه، فاطلبوه في أشعار العرب، فإن الشعر ديوان العرب. وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فيه شعراً»[2].
دعت كثير من الدراسات والأبحاث اليوم - من بينها طروحات أبو القاسم حاج حمد وفضل الرحمن ومحمد شحرور - إلى بسط رؤىً وتصوراتٍ جديدةٍ في فهم القرآن، من خلال استنباط معاني مفرداته في ضوء حقولها الدلالية الداخلية؛ أي كما وردت داخل السياق القرآني ذاته، دون الاعتماد على أخذ معانيها من خارج الاستعمال القرآني لمفردات اللغة، وعياً منهم بأن دلالة معاني مفردات القرآن دلالةٌ منضبطةٌ وفي غايةٍ من الدقة. وهذه مسألةٌ منهجيةٌ دندن حولها المتقدمون تحت عنوان نظم القرآن؛ فقد ألف الجاحظ (-255هــــ) كتاباً بهذا العنوان، ورأى أن إعجاز القرآن متعلق بنظمه، غير أن هذا الكتاب لم يصلنا مع الأسف. ومن المعروف أن نظرية النظم قد نضجت واستوت على يد عبد القاهر الجرجاني (-471هــــ)، من خلال كتابه «دلائل الإعجاز». كما ألف الراغب الأصفهاني (-502هــــ) كتابه حول «المفردات في غريب القران». وهناك مأثوراتٌ أخرى تسير في هذا الاتجاه.
وبالإمكان التمييز بين معنى مفردة من مفردات اللغة العربية كما هو في المعاجم، أو كما هو في استعمال الأصوليين والفقهاء، واستعمال القرآن وطبيعة الحمولة والدلالة المعرفية التي للمفردة نفسها من داخل النص القرآني. فهذا المعطى المنهجي هو ما طبقته على دراسة وتتبع مفردة الوحي من داخل القرآن، وما ارتبط بها من مفردات أخرى من بينها مفردة الآية والعلم.
الكتاب الذي نحن بصدد مناقشته «القرآن ومطلب القراءة الداخلية: سورة التوبة أنموذجاً» لم يخرج موقعه عن السياق المنهجي العالم للكتب التي سبقته؛ فجديده يتجلّى في استثمار ما خلصتُ إليه في الكتب السابقة؛ إذ اتضح لي، وفق مسارات البحث، ضرورة التعاطي مع قراءة القرآن وفهمه وتأويله من خلال زاوية ما سمَّيته منهجيّاً الرؤية الداخلية للقرآن؛ وذلك بتتبع مفرداته وحمولاتها المعرفية من داخله، مع العلم أن القرآن يتضمن رؤيته الداخلية للعالم وللوجود وللإنسان، وهي رؤية مفارقة لما عليه الثقافة زمن نزوله، الأمر الذي جعل منه نصّاً مطلقاً وغير مقيدٍ بالزمان والمكان، من جهة رؤيته الأخلاقية إلى العالم. وهذا لا يعني أنني أُقصي الخارج، بل أنا على وعي بإمكانية استثمار الخارج من أجل فهم الداخل. وقد يرتبط الخارج بالمحيط التاريخي لزمن النزول، أو بما ورد من فهم في مدونات التفسير، أو بواقعنا ومحيطنا الثقافي. في هذا السياق البحثي، جاء مطلب القراءة الداخلية؛ بمعنى فسح المجال للقرآن لفهم قضاياه ومواضيعه ومختلف القضايا التي تطرق إليها، من داخله. ولا شك أن القرآن يحمل تصوراً للعالم والإنسان والوجود، ومن داخل هذا التصور الكلي، تنتظم الكثير من المواضيع التي تطرق إليها. ولمعرفة نظرته الداخلية لموضوع من المواضيع، يتطلب الأمر الوعي بنظم القرآن، وتتبع مختلف سياقات الموضوع المبحوث بشأنه من داخل القرآن، مع السعي نحو تركيب رؤية كلية لذلك الموضوع، بهدف الاقتراب من رؤية القرآن له، وهذا يعني أننا نتوسل بالقراءة الكلية لمختلف سور وآيات القرآن، بدل الرؤية التجزيئية التي تأخذ بجزءٍ دون آخر.
د. حسام الدين درويش:
كان هذا هو موضوع الفصل الأول. وسنقتصر، الآن، على استعراض الخط الناظم أو الفكرة الأساسية لهذا الكتاب، من خلال إظهار مدى ترابط فصوله مع بعضها البعض من جهةٍ، ومع عنوان الكتاب من جهةٍ أخرى. هذا الترابط لا يبدو واضحاً مباشرةً؛ إذ يتناول الفصل الأول موضوع «القرآن الكريم والرؤية الأخلاقية للعالم»؛ فما الفكرة الأساسية هنا؟
د. صابر مولاي أحمد:
رؤية العالم، أو النظرة إلى العالم، مفهومٌ حاضرٌ في الحقل الفلسفي، ويعدّ فيلهلم دلتاي (-1911م) من أبرز من تحدث عن «رؤية العالم». ونحن هنا لسنا بصدد نقاشٍ فلسفيٍّ لهذا المفهوم. فصيغة «القرآن الكريم والرؤية الأخلاقية للعالم» صيغةٌ مركبةٌ بين الرؤية إلى العالم، وبين البعد الأخلاقي الكامن وراء هذه الرؤية. فرؤيتنا إلى العالم تكون من وراء ما نقبل عليه وما نعرض عنه، ما نقبله وما نرفضه، ما نرغب في العلم به وبمعرفته، وما نغفل عنه، ما نفكر فيه وما لا نفكر فيه. كما تكون من وراء مختلف الأهداف التي نسعى من أجلها. فعلاقتنا بمختلف الكائنات في الوجود وبالآخرين وبذواتنا وبمختلف الأشياء تابعةٌ لرؤيتنا إلى العالم. وعليه، فالرؤية إلى العالم ليست واحدةً. فقد نتحدث عن الرؤية العلمية للعالم، أو الرؤية الفنية للعالم. ونحن هنا بصدد الرؤية الأخلاقية للعالم في القرآن الكريم؛ فالمسألة الأخلاقية في القرآن مسألةٌ في غاية الأهمية؛ لأن القرآن كتابٌ يكتنز بين آياته وسوره فلسفته للوجود والإنسان والعالم، ولم نجد آيةً أشارت إلى هذا الأمر الجليل أكثر من هذه الآية من سورة القلم، قال تعالى: «وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)» (القلم) فصفة الخُلق العظيم، تعود بدرجة أولى على منظومة الأخلاق والقيم التي قال بها القرآن، فهو موطن المنازعة بين الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الذين عارضوا دعوته. وقد أخبرتنا كتب السير بأنه قبل بعثته أطلق عليه قومه صفة الأمين، لكن بعد نزول القرآن عليه بدأت معارضته. فأخلاق محمد قد استمدّها من القرآن، ودعوته في مجملها تدور حول دعوة معاصريه لتبني رؤية القرآن للعالم، والتخلي عن رؤيتهم الوثنية التي وصفها القرآن بالشرك.
الفصل الأول من الكتاب يتصل برؤية القرآن الأخلاقية للعالم. ففي القرآن الكريم مستوياتٌ كثيرةٌ من الخطاب، نذكر من بينها: أنه خطابٌ متصلٌ بالوجود وبالكائنات وبالخلق، وأنه خطابٌ غطى مساحاتٍ متصلةٍ بالزمن الذي نزل فيه. فقد تحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعن أصحابه، وعن الذين عارضوا دعوته. وأنه خطابٌ غطى مساحاتٍ متصلةً بتراث الأنبياء والرسل؛ في حديثه عن الأنبياء وقصصهم وعلاقتهم بأقوامهم، وأنه خطاب غطى مساحات رؤيته إلى العالم والإنسان.
كلّ هذه المستويات من الخطاب وغيرها، تلتقي وتلتحم بنقطةٍ مفصليةٍ ومحوريةٍ، وهي موضوع الأخلاق؛ أي المثل الأعلى، وهو في القرآن لله وحده. قال تعالى: {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (النحل). فكلنا يعلم أن مفردة الجلالة «الله» جلّ وعلا، تشكل مركز ثقلٍ في القرآن الكريم. ونستحضر، في هذا السياق، كتاب الله والإنسان في القرآن لمؤلفه «توشيهيكو إيزوتسو». وتدور حول مفردة المركز «الله» كثير من القيم المتصلة بأسماء الله الحسنى جلّ وعلا؛ الله، العزيز، الكريم، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الباسط، الغفور، الودود، الرحمن، الرحيم. فكل الأسماء الحسنى والصفات تحمل حمولاتٍ قيميّةً وأخلاقيةً من داخل القرآن الكريم. وهذه الأسماء فيها إيحاءٌ ودفعٌ بالنسبة إلى القارئ للقرآن الكريم نحو تحويل تلك الحمولات الأخلاقية إلى واقعٍ عمليٍّ في الحياة اليومية، في علاقة الإنسان بالكون والكائنات وأخيه الإنسان. فمتلقي القرآن الكريم عليه أن ينحو هذا المنحى الأخلاقي في حياته وفي محيطه في علاقته بالإنسان الآخر، وفي علاقته بالكون والكائنات. وبالتالي، إن تمعنّا في هذه الأسماء، وتتبعناها، من خلال علاقتها بمختلف المواضيع التي تناولها القرآن الكريم، فإنها تنطوي على منظومةٍ قيميةٍ أخلاقيةٍ لنظرة القرآن الكريم إلى العالم.
ويعد مفهوم الرحمة مفهوماً محوريّاً ومركزيّاً من داخل القرآن الكريم، من بعد لفظ الجلالة «الله الواحد الأحد». والجميع يعرف أن جُلّ سور القرآن الكريم بدأت باسم الله الرحمان الرحيم، فهذا الافتتاح ليس من باب الصدفةٍ، بل فيه إشارةٌ وتوجيهٌ للقارئ بأن مختلف المواضيع التي عالجتها، وذكرت بها سور القرآن، تهدف إلى بسط قيمة الرحمة والتذكير بها، وبأهمية استحضارها في فهم مقتضيات الحياة والوجود والإنسان. فالعلماء، في مختلف التخصصات الطبيعية، وهم يدرسون مختلف الظواهر والأحداث، وكذلك الباحثون في مجال العلوم الإنسانية، عليهم ألا يغفلوا أنّ رحمة الله كامنةٌ وساريةٌ في الخلق. فالله جل وعلا كتب على نفسه الرحمة، ورحمته وسعت كلّ شيء، وهي تقترن بآياته وحكمته الكامنة في كتاب الوجود بأكمله. قال تعالى: {قُلْ لِمَنْ ما فِي السَّماواتِ وَالأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ لا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ} (الأنعام)؛ فقيمة الرحمة، وفق التوجيه القرآني، ينبغي لها أن تكون مدخلاً ومفتاحاً لرؤيتنا للوجود وللحياة. وكل ما ينضوي تحت هذه القيمة، قد يأتي عارضاً؛ إذ تجد، في مساحاتٍ معينةٍ، أن القرآن تحدث عن القتال مثلاً، وهو موضوعٌ ينبغي أن يُقرأ من داخل هذه الحمولة أو التوجيه المعرفي إلى نظرة القرآن الأخلاقية للعالم.
الرحمة، إذن، غايةٌ من غايات بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: {وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ} (الأنبياء/107). وتتفرع عن قيمة الرحمة في القرآن مختلف القيم من بينها قيمة الحرية، فلا إكراه في الدين، وقيمة الحوار والتعارف والسلم والسلام. والرحمة، كما هي في معاجم اللغة، جاءت من فعل «رحم»، وهو فعلٌ يدلُّ على الرّقّة والعطف والرأفة. يقال من ذلك رَحِمَه يَرْحَمُه، إذا رَقَّ له وتعطَّفَ عليه. وقد سمِّيت رَحِمُ الأنثى رَحِماً، فمنها يكون ما يُرْحَمُ وَيُرَقّ له مِن ولد.
د. حسام الدين درويش:
سنركز على الفكرة الأساسية في كلّ فصلٍ. بعد هذه الرؤية، وبعد هذا التنظير للنظرة الأخلاقية للعالم الموجودة في القرآن؛ هناك شيءٌ تطبيقيٌّ على سورة التوبة، وفي مسألة أن الرحمة هي المفهوم أو المعيار الأساسي. كيف تم الربط بين الفصل الأول والفصل الثاني، الذي اتخذ سورة التوبة أنموذجاً للقراءة الداخلية؟
د. صابر مولاي أحمد:
مادام أن أعلى قيمة في القرآن الكريم هي الرحمة، كما بينت في الفصل الأول، وهي قيمةٌ مفتاحيةٌ في الاقتراب من الرؤية الأخلاقية للعالم، وقع الاختيار على تطبيق هذا المعطى المنهجي على سورة التوبة وهي السورة رقم 9 في المصحف. فلماذا اختيار هذه السورة بالذات دون غيرها من السور؟ هذه السورة متهمةٌ بالعنف عند المتقدمين وعند المحدثين. من قرأ تفسير هذه السورة مثلا في تفسير القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» لشمس الدين القرطبي (-671هــــ) سيجده يستند إلى كثيرٍ من الآثار، مفادها أنه لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأن التسمية رحمةٌ، والرحمة أمانٌ، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف، ولا أمان للمنافقين. ويرى أن جبريل لم ينزل بالتسمية. وفي نظري، ليس من المعقول أن تفتتح جميع سور القرآن بالبسملة إلا هذه السورة. فالتسمية هي النقطة التي تبدأ عندها كل سور القرآن. ومن خلال فاصلة التسمية نفهم أننا أنهينا سورةً وبدأنا أخرى، حسب ترتيب سور القرآن. الاستغناء عن البسملة، في هذه السورة، يجعلها تظهر في القرآن كأنها تكملةٌ لما قبلها؛ أي تكملةٌ لسورة الأنفال، وهذا رأي وارد بشكل غير مباشرٍ. فقد أورد القرطبي ما روي عن عثمان بن عفان أن السورتين (الأنفال والتوبة) تسميان بالقرينتين، فبالإمكان أن تُجمعا وتضم إحداهما إلى أخرى. نحن أمام إشكاليةٍ مفادها لماذا تم الاستغناء عن البسملة في سورة التوبة، وهذه مسألةٌ في حاجةٍ إلى بحثٍ ودراسةٍ، وأنا أميل إلى أن سورة التوبة، مثلها مثل باقي سور القرآن، قد بدأت بالبسملة. وحتى إن لم تبدأ بها، فهي محاطةٌ بالبسملة قبلها وبعدها.
اتهام سورة التوبة بالعنف من لدن الكثير من المتقدمين، أو نقول فهم البعض من المتقدمين لسورة التوبة أنها سورة للعنف، إلى درجة أنها لم تبدأ بالبسملة في نظرهم، ساهم في تشكيل تصورات كثيرٍ من المحدثين في نظرتهم إلى السورة، ونستحضر هنا ما تقوم به الجماعات المتطرفة، وهي تسعى إلى استحضار كل فهم منسدٍّ ومتشدِّدٍ في قتال المختلفين معها.
والسؤال الذي يعترضنا هنا: هل، بالفعل، سورة التوبة سورة للعنف، إلى درجة أنها استغنت عن البسملة؟
من هنا تأتي أهمية القراءة الداخلية للقرآن، ومن هنا تأتي أهمية سورة التوبة كنموذجٍ لهذه القراءة. والمسألة هنا لا تتعلق بالدفاع عن سورة التوبة أو إبعاد شبهةٍ لحقت بها، بل يتعلق الأمر بفتح المجال لفهم السورة وقراءتها، بمعزلٍ عن القراءات الخارجة والبعيدة عن رؤية القرآن الأخلاقية.
نأتي الآن إلى مفهوم الرحمة بوصفه مفتاحاً أساسيّاً بهدف الاقتراب من رؤية القرآن الأخلاقية، فالرحمة تقتضي حرية الإنسان في التصرف، وأنه مسؤولٌ عن أفعاله. فالحرية في القرآن مقرونةٌ بالمسؤولية. ونجد رسالة الإسلام تنفي الإكراه في الدين وتتعارض معه لقوله تعالى: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة)، وقوله أيضاً: {وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنّا أَعْتَدْنا لِلظّالِمِينَ ناراً أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُها وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغاثُوا بِماءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرابُ وَساءَتْ مُرْتَفَقاً}(الكهف). وهذا يعني أن رسالة الإسلام تقرّ بالتعددية الدينية، تبعاً لقيمة ومبدأ الحرية. فالإسلام يسع جميع المؤمنين من مختلف الأديان؛ لأنه من السلم والسلام.
فلا يعقل أن تأتي سورة التوبة أو سورة من سور القرآن الكريم، وتأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتث مخالفيه ومعارضيه أو معارضي الدعوة حينها، وأن يغلق كلّ أبواب الحوار في أوجههم كما تصور البعض. من قرأ مثلا تفسير الطبري (-310هــــ) سيقف عند رأيه، وهو يفسر مطلع سورة التوبة. قال تعالى: {بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ *فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ} (التوبة). قول الطبري: فأمر الله نبيّه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف في من لم يكن بينه وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعةٌ من يوم النحر، أن يضع فيهم السيف أيضاً، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهذا الفهم نجده حاضراً عند ابن كثير.
وهناك من قالوا بآية السيف، وهي صيغةٌ منسوبةٌ إلى ابن عباس، وهي قوله تعالى: {فَإِذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (التوبة)، ولم ترد في القرآن كله مفردة السيف، ووفق تفسير القرطبي أن هذه آية قد نسخت كلّ آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء. وبالعودة إلى المدونات الكبرى في الثقافة الإسلامية، سنقف عند مفهوم دار الحرب ودار الإسلام. ولا شك أن هذا التقسيم السياسي في حاجةٍ إلى مبررات تدعمه وتقويه، وربما هي مسألةٌ سياسيةٌ ساهمت في قراءة سورة التوبة قراءةً تبرر الحرب على المخالفين والخارجين عن السلطة زمن الإمبراطورية الإسلامية.
هناك مشكلةٌ أخرى تتعلق بالآية 28 من السورة. قال تعالى: {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّما الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هَذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة). فقد ربط كثيرٌ من المفسرين النجس بذات المشركين. والأمثلة كثيرةٌ. ونستحضر بهذا الخصوص ما قوّى به الطبري رأيه؛ إذ أورد: ما المشركون إلا رِجْسُ خنزير أو كلب. وهذا قولٌ رُوِي عن ابن عباس من وجه ٍغير حميدٍ، فكرهنا ذكرَه. وأورد الزمخشري (-538هــــ) في تفسيره قوله: وعن ابن عباس رضى الله عنه: أعيانهم نجسة كالكلاب والخنازير. وعن الحسن: من صافح مشركاً توضأ. وأهل المذاهب على خلاف هذين القولين. ومن الغريب أن الطاهر ابن عاشور (-1393هــــ/1973م) في تفسيره للآية، لم يخرج عن هذا الفهم، فقد ربط النجاسة بما هو معنوي؛ فالنجاسة المرتبطة بالمشركين معنويةٌ نفسانيةٌ، وليست نجاسةً ذاتيةً. فالمشرك في نظره نجسٌ لأجل عقيدة إشراكه. وهذه مشكلةٌ تصوريةٌ كبيرةٌ. فكيف نتعامل مع المختلفين في العقيدة، وفي الرأي، على هذا الأساس المفارق لتصور القرآن، وهو يعدّ الذي بينك وبينه عداوةٌ بغض النظر عن دينه كأنه وليٌّ حميم؟ قال تعالى: {وَلا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ} (فصلت). ما قال به الطاهر ابن عاشور وغيره مفارقٌ، بشكلٍ كبيرٍ، لرؤية القرآن وتصوره للإنسان، وهو تصورٌ لا تحيز فيه لمؤمنٍ بدينٍ على حساب من يؤمن بدينٍ آخر.
هذا الفهم الخاطئ الذي نتج عن استحضار الكثير من الآثار من خارج القرآن لفهم جزءٍ منه، نتجت عنه تصوراتٌ تتعارض مع روح القرآن، بوصفه نصّاً جعل من كرامة الإنسان أصلاً من أصول نشأته وتكوينه، قال تعالى: {وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَفَضَّلْناهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضِيلاً} (الإسراء) ومن الفهم الخاطئ فقهيّاً أنه لا يجوز لغير المسلم دخول مكة المكرمة أو المسجد الحرام بشكل عامٍّ، وفي الوقت ذاته، نجد القرآن ينص على أن الحج دعوةٌ للناس جميعاً بمعزل عن ديانتهم. قال تعالى: {*وَأَذِّنْ فِي النّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلَى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ} (الحج). وكيف نفهم ما قاله الرسول عند دخوله مكة: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن». فهو لم يُخرج منها أحداً.
مشكلة المفسرين أنهم فهموا مفردة نجس وفق تصوراتهم المعجمية، دون قراءة هذه المفردة على ضوء رؤية القرآن. فهذه المفردة تنتمي «إلى المفردات الشعائرية للوثنية السامية، والواقع أن [ن. ج. س] التي يعادلها في الأكادية [نجاسو] وفي العبرية [نيجيس] تعبر عن علاقات الإنسان بالإله، وهي علاقاتٌ ماديةٌ ومباشرةٌ تتكون من الدخول إلى المعبد، والدنو أو ملامسة الرموز الإلهية، واستعمال وسائل العبادة، وممارسة البغاء المقدس. من هذا الاتصال المباشر بالمقدس، نشأت التعويذة والحجب [أنجاس]، وظهرت كذلك الصفة التي ألصقت بالكاهن أو العراف أو المشعوذ الذين يوزعون هذه التعويذة؛ أي المنجِّس، والتي هي أحياناً مرادفة للكاهن وأحياناً مرادفة للمعوِّذ».[3] وهذا هو المعنى الذي يقصده القرآن، وهو معنى يتصل بالمحيط الأنثروبولوجي لزمن النزول، ولا سيما أن النبي «كان عازماً على التحرر من كافة الأشكال الوثنية المثيرة للشبهة، لكي يبرز أصالة رسالته وتعالمها»[4].
عند وصفه للمشركين بأنهم نجسٌ، لا يقصد القرآن الكريم ذواتهم، بل يقصد التدين الذي كان عليه الكثير من العرب قبل الإسلام. فمعنى «نَجَسٌ» يتصل بوظيفة اجتماعية، وهي التنجيس بدفع العين والجن؛ وذلك باتباع طقوسٍ معينةٍ. فهذه الوظيفة ترتبط بطبيعة التدين الذي عليه الكثير من العرب قبل الإسلام في صلتهم ونظرتهم إلى البيت الحرام من حيث دخولهم وخروجهم منه، وحجّهم وعمرتهم إليه، وإدارتهم لمناسكه وغيره. وكلّ هذا يرتبط برؤيةٍ وثنيةٍ للعالم. فالقرآن يريد ألا تحضر هذه الرؤية داخل البيت الحرام، في الحج والعمرة والصلاة.
المشكلة المنهجية هنا لا تتعلق بما قال به الطبري وابن كثير والقرطبي وغيرهم، مع العلم أنهم قرأوا القرآن من خارجه، بإسقاط مختلف الروايات والآثار عليه، بدعوى أن كل ذلك فهمٌ للصحابة أو التابعين. فمختلف التصورات والأفهام والتفسيرات الواردة في مدوّنات التفسير وفي مختلف المدونات الكبرى في الثقافة الإسلامية، جلّها معارف لا يمكن أن نعزلها من حيث القراءة عن سياقها المعرفي والثقافي. فهي معرفةٌ مشتبكةٌ مع لحظتها التاريخية، ففيها ما هو منفتحٌ على ما هو كونيٌّ وإنسانيٌّ، وفيها ما هو منحصرٌ في المحلي والذاتي والخاص. ففي جميع الأحوال، لا يمكن أن نزيح تراثاً متسعاً وغنيّاً، في كثيرٍ من الزوايا. فالمشكلة عندما نتعاطى مع المعرفة التفسيرية بأنها مكتملةٌ، ونعول عليها في فهم القرآن. ومع الأسف، هذه مشكلةٌ حاضرةٌ في التعاطي مع فهم القرآن، بشكلٍ مزدوجٍ. فهي حاضرةٌ عند الاتجاهات النقدية، وحاضرةٌ عند الاتجاهات المحافظة وخاصة المتشددة. ففي الوقت الذي ترى فيه الاتجاهات المتطرفة أن سورة التوبة سورةٌ للعنف، معتمدةً في ذلك على مختلف الأقوال التي قال بها المفسرون المتقدمون، نجد بعض المحسوبين على الاتجاه العقلي والنقدي يقولون الرأي ذاته. فسورة التوبة سورة عنيفة في نظرهم. ونضرب مثالاً على هذا الرأي ما كتبه المفكر محمد أركون، وهو يرى أن سورة التوبة خاتمةٌ للرسالة المحمدية، وهي خاتمةٌ تقول بالعنف. فالمشكلة المنهجية عند الطرفين أنهم اكتفوا بالقراءة الخارجية لسورة التوبة، بالاعتماد على ما هو واردٌ في مدونة التفسير. فطرف المتشددين يعتقدون بذلك، بينما أركون وغيره يستنكرون الأمر، ولا أحد من الطرفين سمح لنفسه بقراءة سورة التوبة قراءةً كليةً من داخل القرآن كله. والمثير للاستغراب أن محمد أركون قد خصص فصلاً لسورة التوبة من كتابه: «قراءات في القرآن» تحت عنوان «من أجل قراءة ما فوق نقدية لسورة التوبة». فالمسألة بالنسبة إليه لا تتعلق بالنقد، بل بما هو فوق النقد، وفي الأخير سقط في فخّ تكرار القراءة التراثية بتبني أقوال ومواقف المفسرين. والسؤال هنا: لماذا سقط أركون في تكرار ما ينتقده؟ الجواب بالنسبة لي، بشكل مختصر، أن محمد أركون وغيره لم يولوا اهتماماً لقراءة القرآن من داخل القرآن نفسه، رغم أن كتاباتهم عالية الكعب من جهة ما هو عقلي ونقدي. وأنا أعترف بأنني استفدت كثيراً كغيري من متن محمد أركون وغيره؛ فهؤلاء لهم بصمتهم الكبيرة في الإعلاء من قيمة العقل ليس في العالم الإسلامي، بل في العالم كلّه. لكن في هذه النقطة بالذات أغفلوا فهم القرآن من داخل القرآن نفسه. وفي هذا السياق، أستحضر التقسيم الذي قال به فضل الرحمن في الصفحات الأولى من كتابه «المسائل الكبرى في القرآن». وهو تقسيمٌ ينسجم مع جزءٍ كبيرٍ مما يكتب حول القرآن في العالم الإسلامي، أو ما يترجم إلى اللغة العربية. فهو يرى أن ما يكتب حول القرآن في الغرب يدور في ثلاث دوائر؛ دائرة الأعمال التي تسعى إلى تتبع تأثير الأفكار اليهودية والمسيحية في القرآن؛ دائرة الأعمال التي تحاول إعادة الترتيب الكرونولوجي للقرآن؛ دائرة الأعمال التي تهدف إلى وصف محتوى القرآن، إما ككل وإما بعض من جوانبه. فإذا نظرنا، مثلاً، إلى كتاب محمد عابد الجابري «فهم القرآن الحكيم التفسير الواضح حسب ترتيب النزول»، سنجده فهماً وتفسيراً يحضر معه هاجس الترتيب الكرونولوجي للقرآن، وهي مسألةٌ جعلت منه فهماً وتفسيراً مفارقاً وبعيداً عن الدائرة التي تهدف إلى فهم ووصف محتوى القرآن من داخله. وهذا الهاجس حاضرٌ، كذلك، عند محمد أركون في جزءٍ كبيرٍ مما كتب حول القرآن. وإن شئنا أن نقدم مثالاً للمشاريع التي أخذت على عاتقها همّ فهم القرآن من داخله، يمكننا استحضار مشروع أبو القاسم حاج حمد، وما كتبه فضل الرحمن وآخرون.
نعود الآن إلى سورة التوبة. ففي حقيقة الأمر، هذه السورة، بعد قراءتها قراءةً كلّيةً من داخل القرآن الكريم، جاءت لتؤكد قيم الرحمة والتواصل والإخاء والوفاء بالعهود. فالمشكلة، من خلال سورة التوبة، كانت مع أناسٍ ضربوا عهوداً وتراجعوا عنها. وحتى هذه اللحظة، المجتمعات البشرية أو الاجتماع لابد له أن ينضبط لمنظومة العهود ومنظومة مواثيق، ومنظومة توازنات توافق الناس عليها. والمشكلة هي حين يأتي طرفٌ معينٌ، فينقض العهد، ويكون سبباً في البدء بالعنف وسفك الدماء. وهي مسألة قد تتسع وتعمّ المجتمع، وتهدد قيمة الأمن والسلام بين كلّ الناس. فهذه الحالة لا ينبغي التساهل معها، وينبغي أن يوضع لها حدٌّ، بشتى الطرائق، بهدف ردّ الذين نقضوا عهدهم إلى دائرة الوفاء به.
فالسورة تلفت النظر إلى الاجتماع ككلٍّ، على أن الازدهار والأمن والأمان وإنسانية الإنسان، تكمن في أن يكون وفيّاً بعهوده. وهي بهذا توجيه للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يستمر في عهوده، وأن يقوي مجتمع العهود. وفي زمننا الحاضر، تبذل الإنسانية جهوداً واسعة بهدف بناء مجتمعٍ إنسانيٍّ، يكون أكثر انسجاماً وانضباطاً للعهود التي أخذها على نفسه في علاقته بغيره، حفاظاً على مصير الإنسان وكينونته. صحيحٌ أن هذا مطلبٌ مثاليٌّ لا توفي به المركزية الغربية لاعتباراتٍ يطول شرحها. ولكن هناك اتجاهاتٌ في الفكر الإنساني ككلٌ واعيةٌ بهذا المطلب. القراءة المعرفية للقرآن تفيدنا في تقوية هذه الغاية والهدف.
د. حسام الدين درويش:
للوهلة الأولى، يبدو أنه في الفصلين الأول والثاني، وصل الكتاب إلى غايته، وأوفى بما عبَّر عنه العنوان، بينما هناك فصلٌ ثالثٌ وفصلٌ رابعٌ. تناول الفصل الثالث الحرية بوصفها قيمةً ومبدأً في الوجود الإنساني، وتناول الفصل الرابع الأبعاد الأربعة في تكوين الإنسان: البدن والحواس والنفس والروح. فما صلة هذين الفصلين بالفصلين الأولين اللذين يتحدثان عن الرؤية الأخلاقية للإنسان في القرآن، وعن القراءة الداخلية عموماً، وقراءة سورة التوبة خصوصاً؟
د. صابر مولاي أحمد:
تناولت، في الفصل الثالث، الحديث عن موضوع الحرية بوصفها قيمةً ومبدأً إنسانيّاً. فالأصل في الإنسان هو الحرية. وقد بينت أن هذا الأصل يأخذ كينونته عند الإنسان من مبدأ أخلاقيٍّ. فالحرية قيمة متفرعة عن قيمة الرحمة. وفي الفصل الرابع، بينت الأبعاد الأربعة (البدن والحواس والنفس والروح) في التكوين الإنساني، في علاقة الحرية بمختلف تلك الأبعاد خاصة النفس والروح، فإذا كانت النفس محمولةً بالحواس (الغريزة) فقط، فسيكون للحرية تموضعٌ معينٌ، وإذا كانت النفس محمولةً بالروح، فسيكون للحرية تموضعٌ معين، مع العلم أن النفس موطنٌ التغيير والفعل.
إذا قرأنا القرآن كلّه، فإننا لن نعثر على مفردة «حرية»، لكن سنجد مفردة «تحرير» في سياق الدعوة إلى تحرير رقاب الناس من العبودية، ليصبحوا أحراراً طلقاء وغير مقيدين بسلطة ومصلحة من يملكهم. ولهذا، فالحمولة الدلالية لقيمة الحرية في القرآن وردت بصيغة «تحرير». وهذا فيه إشارة إلى أن قيمة الحرية تكمن في جزء كبير منها في فعل التحرير والقيام به والإقبال عليه؛ أي أن يمنح العبيد القدرة على الفعل من دون أي قيدٍ أو شرطٍ، حيث يصبحون أحراراً. وفي هذا دعوةٌ إلى تأسيس مجتمعٍ يتساوى فيه الناس، حيث يصبحون كلهم أحراراً.
وردت مفردة «تحرير» في القرآن الكريم 5 مرات، منها 3 مرات في سورة النساء من خلال الآية 92. وورود هذه المفردة جاء بغاية تجاوز ثنائية (الحر والعبد) والبقاء على الأصل لدى الأنسان بأن يكون حرّاً؛ وهي ثنائيةٌ سائدةٌ في الثقافة العربية وغيرها من الثقافات. قال تعالى: {وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} (النساء/92) قال تعالى: {لا يُؤاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عقَّدْتُمُ الأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ذَلِكَ كَفّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} (المائدة/89) قال تعالى: {*وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَماسّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (المجادلة/3)
مسألة التحرير في القرآن لا تتوقف عند ثنائية (الحر والعبد)، فهناك مستوى آخر أقلّ من التحرير يرتبط بفك الرقاب من مالكيها وفق ما تقتضيه وتستوجبه الأعراف الاجتماعية، التي يُنظر من خلالها إلى كلٍّ من السيد والعبد؛ أي طبيعة التراتبية الاجتماعية لمجتمع من المجتمعات، وبالتعبير المعاصر، يمكن أن نقول الطبقات الاجتماعية. ومن أهم تلك المقتضيات الاجتماعية دفع قيمةٍ ماليةٍ لسيد العبد. فالقيمة المالية يقابلها فك رقبة العبد من سيده، قال تعالى: {فَكُّ رَقَبَةٍ} (البلد/13). فالقرآن لا يتوقف عند قيمة الفك، بل يذهب بعيداً في اتجاه بسط قيمة التحرير في الأنفس. فتحرير العبيد من أسيادهم يصبّ في تحرير وتحرُّر الأسياد من مختلف تصوراتهم التي ينظرون من خلالها إلى أنفسهم نظرة استعلاء. فالمقارنة مع العبيد لن يصدق عليهم فعل التحرير والتحرر، إلا عندما ينظرون إلى أنفسهم بأنهم مثل أسيادهم في الخَلق. فالحرية أصل في منشئهم وتكوينهم. وفي هذا الصدد، يبدو أن عمر بن الخطاب قد فهم، بشكل عميقٍ، البعد الأخلاقي في رؤية القرآن للإنسان، عندما قال: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً؟». وفي هذا إشارةٌ بينةٌ من سيدنا عمر إلى أن الناس أحرارٌ بطبعهم ومنذ ولادتهم. فصفة العبيد عارضةٌ، وليست أصلاً، كما أن صفة السيد عارضةٌ، وليست أصلاً.
الحرية في القرآن مسألة تستهدف كلّاً من العبد والسيد؛ فكلاهما في حاجةٍ إلى تحريرٍ؛ بمعنى أنها تستهدف كل فئات المجتمع، لكي تتحرر من مختلف العادات والقيود الاجتماعية والنفسية التي تجعل الفرد سجين تصوراتٍ ومسلّماتٍ تعزله عن قيمة الحرية التي تعد أصلاً في منشئه من جهة الخَلق.
فالعبد، وقد فكت رقبته من سيده، إما أن يبقى على الحالة النفسية والشعورية للعبيد، وإما أن يرتقي إلى مستوى التحرر الذي يمكنه أن يكون له رأيٌ وقرارٌ واختيارٌ حرٌّ. وقد ضرب الله لنا مثلاً عن العبد المملوك الذي لا يملك إرادته وقراره، قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْناهُ مِنّا رِزْقاً حَسَناً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرّاً وَجَهْراً هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ} (النحل/75)، بمعنى أن الله جلّ وعلا يريد من الأفراد التي فكت رقابها من مالكيها أن تتصف بالقدرة على امتلاك القرار والرأي؛ وإلا فإنها ستحيا بنفسية العبيد لا تقدر على فعل شيءٍ. وهو الأمر الذي ذكرنا القرآن به، عندما عرض حجة من جعلوا أمورهم في ملكية ساداتهم وكبرائهم، ولم تنفعهم الحجة، قال تعالى: {وَقالُوا رَبَّنا إِنّا أَطَعْنا سادَتَنا وَكُبَراءَنا فَأَضَلُّونا السَّبِيلا} (الأحزاب/67). فما قلناه في حق العبد ينطبق على السيد؛ إذ عليه أن يتحرر من مختلف العادات الاجتماعية الكاذبة التي جعلته يرى في نفسه سيداً على رقاب الآخرين، مع أن هؤلاء يتساوون معه في الخَلق. وإذا نظرنا إلى القرآن في قضاياه الكلية، سنجده جاء محرراً للناس من ثقل وأغلال ثقافة أجدادهم وآبائهم. قال تعالى: {وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا ما أَنْزَلَ اللَّهُ قالُوا بَلْ نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَوَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ} (البقرة/170). في هذا السياق، يبدو أن القرآن، من خلال رؤيته للإنسان ولموضوع الحرية، سابقٌ لما جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن موضوع الحرية. فالحرية قيمةٌ أخلاقيةٌ تتفرع عن القيمة المركزية لرؤية القرآن الأخلاقية للعالم، وهي قيمة الرحمة. فالرحمة تتعارض مع إكراه الناس أو جبرهم وتحميلهم ما ليس في طاقتهم أو في استطاعتهم، أو ما ليسوا راضين عنه. وهذا من صميم رؤية القرآن الأخلاقية للعالم، وهو الموضوع الذي عالجته في الفصل الأول. كما أن له علاقة، بشكلٍ عامٍّ، بما تطرقت إليه في الفصل الثاني حول سورة التوبة وقراءتها من داخل القرآن. فهي تعلي من قيمة الحرية كغيرها من سور القرآن.
نأتي الآن للجواب عن سؤالك عن علاقة الفصل الرابع والأبعاد الأربعة في تكوين الإنسان (البدن والحواس والنفس والروح) برؤية القرآن الأخلاقية للعالم (أي الفصل الأول والفصول الأخرى التي بعده). فالقرآن عندما تحدث عن موضوع تحرير الإنسان، ربط موضوع التحرير بالأبعاد الأربعة في تكوين الإنسان. فحرية الإنسان تعود إلى بعد الروح الكامنة في الإنسان، والروح أمرٌ من أمور الله جلّ وعلا. قال تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاّ قَلِيلاً} (الإسراء) الحرية مسألة لا تتجزأ من كينونة الإنسان ووجوده. والقرآن جعلها مقرونةً بالمسؤولية، وجعل المسؤولية مقرونةً بالأخلاق. أما الحواس في علاقتها بالبدن، وعلاقتها بالنفس، فالنفس يعود تكوينها إلى هذا العالم الذي نحن فيه، عكس الروح. فالحديث عن تكوينها الجدلي ورد في سياق الحديث عن ظواهر طبيعيةٍ في البنائية الكونية؛ إذ يسري عليها الجدل (نهار/ ليل. شمس/ ظلمة. جَلَّاهَا/ يَغْشَاهَا. ارتفاع/ انبساط. بَنَاهَا/ طَحَاهَا. فُجُورَهَا/ تَقْوَاهَا. َ زَكَّاهَا/ دَسَّاهَا) قال تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحاها *وَالْقَمَرِ إِذا تَلاها *وَالنَّهارِ إِذا جَلاّها *وَاللَّيْلِ إِذا يَغْشاها *وَالسَّماءِ وَما بَناها *وَالأَرْضِ وَما طَحاها *وَنَفْسٍ وَما سَوّاها *فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَتَقْواها} (الشمس).
فالنفس يسري عليها قانون الموت، بينما الروح لا تموت، قال تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ ذائِقَةُ الْمَوْتِ} (آل عمران/185). النفس موضوع التغيير. قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ} (الرعد/11). النفس تركيبةٌ جدليةٌ ما بين الخير والشر. فالفعل الإنساني متصلٌ بالنفس؛ والنفس إذا كانت محمولةً بالغريزة (الحواس) داخل البدن، ولظروفٍ تتعلق بها، ابتعدت كثيراً أو قليلاً عن البعد الروحي (موطن الفضيلة والأخلاق والتزكية)، فستكون في حالةٍ ودرجةٍ معينةٍ من الفجور؛ لأنها ستكون مأسورةً ومشدودةً لكل ما هو لحظيٌّ واستهلاكيٌّ. أما إذا كانت متعاليةً نحو ما هو روحي، فذلك اتجاه القيم واتجاه الخير، فسيكون حالها وفعلها على أحسن حالٍ، وستكون في درجةٍ من التزكية والخير. ففي دائرة الروح، تكمن القيم والفكرة الدينية في بعدها الجوهراني، كما تكمن كل القيم الدينية. وهذا أمرٌ ليس فيه تعارضٌ ما بين البعد الروحي للإنسان والبعد البيولوجي الجسدي، وإنما كيف للإنسان أن يعيش حياته، ويرتقي نحو الأعلى بدل أن يشتد إلى أسفل أو إلى ما هو مُتَدنٍّ وهابطٍ، أو أن تستحوذ عليه الأشياء وتملكه بدل أن يكون مالكاً لها. ومن هذه الزاوية، لفتت النظر إلى موضوع الحضارة. فالقرآن الكريم أثار انتباهنا إلى كثير من حضارات الأمم السابقة وحدثنا عنها، ولفت نظرنا إلى كيف يمكن لنا أن نحضر في العالم بحضارة فيها مساحة كبيرة من القيم والارتقاء النفسي والروحي. فعلاقة هذا الفصل (الرابع)، المتعلق بالأبعاد التكوينية للإنسان، بالفصل الأول تبدو واضحةً بلفت النظر إلى كون القرآن يدفع في اتجاه أن يكون الفعل الإنساني فعلاً يعلي من قيمة الأخلاق؛ وذلك بحضور ما هو روحيٌّ ومتعالٍ في مختلف مجالات حياة الإنسان. فهو فصل حاولت من خلاله أن أقدّم قراءةً داخليةً لتصور القرآن للأبعاد الأساسية في تكوين الإنسان.
د. حسام الدين درويش:
لماذا رأيت أن الحديث عن الحرية كقيمة ومبدأ إنساني أمرٌ مهمٌّ في هذا السياق، وليس عموماً؟ فمفهوم الحرية في التراث الإسلامي كان يتعلق بالتضاد مع الرق والعبودية، ويتعلق بالقدرية والجبرية، لكن المفهوم المعاصر للحرية يتعلق، أيضاً وخصوصاً، بالحريات السياسية والاجتماعية، بالدرجة الأولى. ومن ناحية أخرى، تبدو في كتابك مشيداً بقيمة الحرية وبأهميتها من جهةٍ، ومنتقداً لليبرالية أو الرؤية الليبرالية للحرية من جهةٍ أخرى؟
د. صابر مولاي أحمد:
صحيح أنني أشدت بمفهوم الحرية، وحاولت قدر الإمكان الاقتراب من رؤية القرآن للموضوع، وفي الوقت ذاته بينت طبيعة التباين والتمايز بين اتجاه الحرية الليبرالية، واتجاه الحرية كما هي في التراث الإسلامي، واتجاه الحرية أو التحرير كما تحدث عنه القرآن. والمسألة هنا ليست من باب التقابل أو التضاد، ولكن تتعلق بتتبع واستحضار المنطلقات المعرفية لكلا الاتجاهين.
الحديث عن اتجاه الحرية الليبرالية في حد ذاته حديث عن الحضارة الغربية، في نظرتها إلى الوجود وإلى العالم والإنسان والطبيعة، من زاوية تاريخها بدءاً من لحظة الإصلاح الديني في القرن 16م مع مارتن لوثر، ومن تلاه، مروراً بفترة فلسفة الأنوار التي ركزت على سيادة العقل والحواس بوصفها مصدراً أساسياً للمعرفة، ومروراً كذلك بأحداث سياسية واجتماعية، من بينها الثورة الفرنسية (1789م/1799م)، وبطروحات فلسفية أخرى على رأسها الفلسفة الوضعية. لقد ركزت الفلسفة الغربية وبالأخص السياسية منها في تناول مفهوم الحرية، على الذات الفردية التي تتمتع بنوع من الاستقلالية وبالقدرة على التصرف بشكل حرّ يستند إلى العقل فقط؛ فالاقتراب من مفهوم الحرية في الغرب يبدأ من مفهوم العقل. فماهية الحرية تعود إلى العقل، وكلّ تحولٍ معرفيٍّ يطرأ على مفهوم العقل قد ينعكس سلباً أو إيجاباً على موضوع الحرية.
روح الوضعية، إذن، تكمن في حصر مصدر المعرفة في الحس والتجربة، وهذا له تأثيرٌ بيّنٌ وواضحٌ في مفهوم الحرية. فالاتجاه الوضعي (المادي) الذي لا يقبل أيّ حضورٍ لما هو ميتافزيقي في تحديد حرية الإنسان، يرى أن المعرفة والعلم (الوضعي) هما السبيل إلى تحقيق الحرية البشرية، وقد مهدت الوضعية الطريق أمام اتساع العقل الطبيعي، هو العقل الملتصق بالطبيعة إلى درجة أنه لا يؤمن بمصدر المعرفة والقيم والأخلاق خارج إطار المادة وكل ما هو محسوسٌ؛ إذ يجعل من الطبيعة مرجعيته النهائية ينطلق منها ويعود إليها. فالطبيعة، في نظره، مكتفيةٌ بذاتها، وليس هناك عالمٌ قبلها ولا بعدها، وليس هناك غائيةٌ ولا حكمةٌ في نظامها، ويمكن التحكم فيها واستغلالها أكبر استغلال، من خلال معرفة قوانينها. فالعلم بها يؤهل الإنسان ليتصرف فيها كما يشاء، ويسيطر عليها، ويفوز في صراعه معها. فالعقل الطبيعي ومن بعده الحرية عاريان من أي مبدأ ميتافيزيقيٍّ أخلاقيٍّ، وبهذا تحولت الحرية الليبرالية إلى حريةٍ عائمةٍ في ما هو طبيعيٌّ، مفصولةٌ عما هو متعالٍ. فالأخلاقي، بطبعه، يكون متعالياً، ومن الواضح أن الفلسفة الغربية، في بعدها المادي، قد ربطت حرية الفرد بالمنفعة التي ترى في الإنسان كائناً منتجاً ومستهلكاً.
لسنا مع فكرة اختزال الغرب في كل ما هو سيئ، ولا ننكر هنا أهمية العقل والفتوحات التي قام بها العلم في مختلف مجالات المعرفة في حياة الإنسان، وهي فتوحاتٌ حررت الإنسان من الكثير من التصورات الخاطئة عن نفسه وعن العالم؛ فالعلم ميز بين الظاهرة في ذاتها، وبين تصوراتنا حولها، وتقتضي العلمية دراسة الظاهرة كما هي بمعزل عن التصورات القبلية للباحث. فبفضل العلم صارت للإنسان حياةٌ أفضل في مختلف المجالات، في مجال الصحة والتعليم، لكن هذه الحياة الأفضل من سابقتها تنطوي على مشكلاتٍ حضاريةٍ نفسيةٍ ووجدانيةٍ واجتماعيةٍ تضر بكينونة الإنسان، وتنسف ما يميزه عن الكائنات الأخرى.
الإنسان اليوم يملك العلم والتقنية، وفق مبدأ الحرية العارية من أيّ مبدأ أخلاقيٍّ. ففي دائرة العلم، هل كل ما هو ممكن تقنياً اًو يمكن السماح به؟ نتحدث اليوم عن الكم الهائل من الأسلحة التي بإمكانها تدمير كوكب الأرض، نتحدث عن التلوث البيئي، نتحدث عن الأمراض العابرة للقارات. هناك أشياءٌ كثيرةٌ تهدد مصير الإنسان في العالم. ألا يكمن حلّ هذه المعضلات في مربع التفكير والتفلسف والقيم والأخلاق؛ بمعنى ربط حرية العلم والفعل الإنساني بالمبدأ الأخلاقي؟ في هذا السياق، تأتي أهمية الرؤية القرآنية التي يقترب فيها الفعل الإنساني والحرية بالمسؤولية الأخلاقية. قال تعالى: {وَلا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ} (الأعراف). القرآن يضعنا أمام مفتاحٍ معرفيٍّ في ما ينبغي أن يكون عليه العلم والمعرفة. السؤال: كيف ذلك؟ لا شك أن التفكير الفلسفي والأخلاقي سيبدع طرائق ونماذج للتفكير في الأمر. في هذا السياق، نستحضر مقولة مارتن هايدغر «العلم لا يفكر»؛ التفكير والقيمة الأخلاقية يعودان إلى الإنسان.
عندما نتحدث عن الحرية في الاتجاه الليبرالي الغربي، بهذا الحس الذي يحضر فيه نوع من النقد، فإننا لا نقصد البقاء عند مفهوم الحرية، كما هي في التراث الإسلامي، فنحن هنا نمارس بتعبير عبد الكبير الخطيبي النقد المزدوج، للثقافة الغربية وللثقافة الإسلامية. فليس هناك نموذجٌ مكتملٌ. ففي الثقافة الإسلامية قد نجد تجارب حضاريةً متنوعةً جعلت من قيمة الحرية في الاعتقاد مدخلاً للتعايش بين مختلف الأديان والأقليات، ونضرب مثالاً على هذا الوضع بتجربة الأندلس، وتجربة بغداد في العهد العباسي. ومن بين ما ننتقد فيه الثقافة الإسلامية، وهي ثقافةٌ متعددةٌ ومتشعبةٌ ولا يمكن اختزالها في بوتقةٍ واحدةٍ، أنه في القديم كانت هناك فرقةٌ كلاميةٌ تنتسب إلى الإسلام، تؤمن بأن الإنسان مسيّرٌ وليس مخيراً؛ لأنه لا قدرة له على اختيار أعماله. وهذا تصور يتعارض مع روح القرآن. قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ} (البقرة)، وما زال صدى هذه الفكرة حاضراً أحياناً بشكلٍ خفيٍّ.
وبشكلٍ عامٍّ، لم تمضِ الثقافة الإسلامية بعيداً في توسيع دائرة التحرير التي دشّنها القرآن؛ تحرير العبيد والحد من نظام الرق والعبودية، مع العلم أن العبودية كانت متأصلة في الشعوب القديمة. فتاريخ الإمبراطورية الإسلامية في هذه النقطة لا يختلف كثيراً عما سبقه من تاريخ الأمم والشعوب، مثل تاريخ الإمبراطورية الرومانية. فالتاريخ يحفظ لنا نشاطاً واتساع تجارة الرقيق لدى العرب المسلمين؛ وذلك باستقدام العبيد من إفريقيا جنوب الصحراء، واستغلالهم في العمل الزراعي وغيره، في البصرة جنوب العراق زمن الدولة العباسية. وقد أدت المعاملة القاسية للعبيد إلى ثورة الزنوج التي امتدت ما بين (255- 270هــــ) / (869 - 883م). وفيما بعد، تجدد إرث تجارة العبيد بعنفٍ أكبر؛ وذلك بتهجير الأفارقة إلى أمريكا من لدن الدول الأوروبية في القرن 15 الميلادي وما بعده. ولم ينتهِ نظام العبودية بشكلٍ نهائيٍّ إلا بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م.
أما اتجاه الحرية أو التحرير كما تحدث عنه القرآن، فلا ينبغي أن نسقط عليه ما حدث في التاريخ الإسلامي وما كان عليه، فقد بينت بما يكفي رؤية القرآن للإنسان وفق أبعاده التكوينية الأربعة وصلة الحرية بها. وفي تقديري، القرآن يمنحنا مداخل معرفية لإشكالية اقتران حرية الإنسان بالمسؤولية الأخلاقية في الوجود.
د. حسام الدين درويش:
مع أن مفهوم القراءة الداخلية يبدو مفهوماً بسيطاً، لكنه، حقيقةً، غاية في التعقيد. والأطروحة الأساسية في الكتاب، أننا في حاجة إلى عملية إصلاح وتجديد في الفكر الإسلامي، وهذا ما أسميته بالمطلب الواقعي الذي ربطته بمسألة القراءة الداخلية، وقلت إن عملية الإصلاح والتجديد هذه، تحتاج إلى تجديد الفهم، فهم النص المؤسس؛ أي القرآن الكريم. ولتوضيح هذه القراءة الداخلية، ينبغي معرفة صلتها بالنصوص الأخرى؟ ما الذي تعنيه، تحديداً، بالنص المؤسس؟ هل يشمل القرآن فقط، أم يتضمن، أيضاً، الحديث مثلاً؟ وهناك التراث (الفقهي) أيضاً، كيف نتعامل مع هذا التراث؟ أنت في المطلب العلمي تقول إنه يكرر نفسه أو معظمه تكراراً للتفاسير الأولى، فكيف ترى الطريقة المثلى للتعامل معه؟ هل نهتم به، ونقرأه، ونحاوره أم نهمله؛ لأنه من زمن غير صالح لزمننا؟ ببساطةٍ، ما مفهوم القراءة الداخلية؟ وما الخارج المقصود هنا؟ وما علاقة ذلك بالمطالب التي تحدثت عنها، والتي تحثنا على القراءة الداخلية، وهي الواقعية والعلمية والأخلاقية؟
د. صابر مولاي أحمد:
القراءة الداخلية، من وجهة نظري، لا تنحو منحى القطيعة الإبستمولوجية، التي يقول بها البعض مع التراث. فالقراءة الداخلية، بمعنىً ابستمولوجيٍّ، تهدف إلى توظيف البعد المعرفي القرآني في نظرتنا إلى ماضينا وإلى ذواتنا، وفي نظرتنا إلى الآخر، وفي نظرة الإنسان إلى ذاته، وفي علاقة الناس بعضهم ببعض. مع العلم أن القرآن الكريم يضم بين دفتيه إرث النبوات، ومن ثم هو يضم إرث الإنسانية ككلّ، ويلفت نظرنا إلى قراءة تجربة الأنبياء والرسل، وإلى قراءة مختلف تجارب الإنسانية العريقة جدّاً. فهو يبسط أمامنا مداخل معرفيةً في مختلف مجالات المعرفة. والسؤال الذي يبقى مطروحاً هو كيف يمكن أن نستمد من القرآن آلية النظر وآلية التفكير وآلية الفهم، ونحن نتحدث عن التراث؟ فالمشاريع التي اشتغلت على التراث الإسلامي، خصوصاً ما بعد عقد الخمسينيات أو الستينيات من القرن العشرين، كثيرة ومتعددة، نذكر من أصحابها، نصر حامد أبو زيد، الجابري، طيب تزيني، حسن حنفي، وغيرهم من أصحاب المشاريع المتعددة والمتنوعة. اشتغلت على سؤال المنهج في التعامل مع التراث، ولكن بقي السؤال المخبأ من وراء هذا السؤال، ولم يلتفتوا إليه هو سؤال «كيف نتعامل مع القرآن؟». فعاد البعض من أصحاب هذه المشاريع للإجابة عنه في الأخير، كما لاحظنا مع محمد عابد الجابري. فالمنظومة التراثية تشكلت من حول القرآن، والحضارة الإسلامية تشكلت من حول هذا القرآن، ونزول القرآن الكريم قد دشن زمناً جديداً، فمن الأولى منهجيّاً العناية بسؤال النص المؤسس الذي تأسس حوله التراث، وهي مسألة منهجية حاضرة عند نصر حامد أبو زيد من زاوية علوم القرآن. وثمة مشاريع أخرى لها فضل السبق في الاشتغال على القرآن والدخول إليه، ويمكن استحضار مشروع فضل الرحمان، ومشروع أبو القاسم حمد.
أما عن سؤالك «ماذا أعني بالنص المؤسس؟»، فأنا أعني به القرآن الكريم. فلا شك في أنه هو النص المركزي في الثقافة الإسلامية، وقد تشكلت إلى جانبه مختلف النصوص في مدونات الحديث، وفي مدونة الفقه وأصول الفقه والتفسير، وفي اللغة وعلومها، وفي الفلسفة ومعارفها. ومن البديهي، حتى هذه اللحظة، أن القرآن سرديةٌ واحدةٌ ونصٌّ واحدٌ، بينما ما تشكل حوله من النصوص يتصف بالتنوع والتعدد. فبين يدي كلّ الفرق الإسلامية قديماً وحديثاً قرآن (مصحف) واحد. أنا أقول هذا باستحضار ما قال به علم الفيلولوجيا. نص الحديث لا تنطبق عليه مختلف هذه المواصفات، فهو نص متعدد المتون، ما صح منه فهو صحيح على شروط كل محدث، فضلاً عن تباين مواقف بين الفرق الإسلامية في نظرتها إلى هذا الراوي أو ذاك.
أما التراث الفقهي، فقد تشكل مشتبكاً مع نصوص الحديث بدرجة أولى، ومع نصوص القرآن الكريم، وفي سياق هذا الاشتباك وكما هو معروف، يعدّ الشافعي (-204م) أول من قعد لمنهجية طبيعة اشتغال العقل الإسلامي في تعاطيه مع النص المؤسس؛ أي القرآن بهدف بيانه وفهمه من خلال كتابه الرسالة؛ إذ جعل للبيان خمس درجات: (1) بيان لا يحتاج إلى بيان، وهو «ما أبانه الله لخلقه نصّاً». (2) بيان في بعضه إجمال فتكفلت السنة ببيان ما يحتاج منه إلى بيان. (3) بيان ورد كله في صورة المجمل وقد تولت السنة تفصيله. (4) بيان السنة، وهو ما استقلت به هي نفسها ومن الواجب الأخذ به؛ لأن الله قد فرض في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه، «فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل». (5) بيان الاجتهاد ويؤخذ بالقياس على ما ورد فيه نص من كتاب أو سنة.[5] فهذه المستويات من درجات البيان تكشف لنا عن الأهمية المحورية التي أخذها نص الحديث في العملية البيانية عند الشافعي، وقد استحوذ على كل مستويات البيان إلى درجة يصح فيها القول لا بيان إلا مع نص الحديث، فالمسألة هنا تخفي من ورائها أن هناك اتجاهاً في الثقافة الإسلامية يرغب في أن يقيد فهم وتأويل وتفسير النص المؤسس(القرآن) بنص آخر، وهو الحديث. والسؤال هنا هل كل الحديث صحيح؟ فما هو صحيح عند هذه الفرقة قد تضعفه فرقة أخرى!!
ولا يعني ذلك أن النسق الثقافي العام، حينها في زمن الشافعي، متفق وموافق على هذا التقعيد المنهجي الذي قال به الشافعي. فهناك تقليد آخر لم ينل حظه من الحضور، وقد تم تهميشه وإبعاده ربما لأنه معتزلي المذهب. ويتعلق الأمر بما قال به الجاحظ (-255هــــ)، فقد اهتم في كتبه ورسائله بالتنظير لمختلف عناصر الخطاب: المتكلم والنص والمتلقي، وله اهتمام بالغ بالخطاب، الإقناع بدعوته إلى مناظرة الخصوم بالحجة. ونرى أن عنوان كتابه «البيان والتبيين» ليس من قبيل الصدفة. ونرجح بأنه من باب بسط النظر في موضوع البيان الذي سبق الشافعي أن قال فيه برأي. لقد حصر الجاحظ أصناف الدلالة بقوله: «جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أولها اللفظ، ثم الإشارة، ثم العقد، ثم الخط، ثم الحال التي تسمى نصبة»[6]. (1) بيان باللفظ: اللفظ نفسه. (2) بيان بالإشارة: فهي قد ترافق اللفظ وتساعده أحياناً. (3) بيان بالخط: فهو معروف؛ أي الكتاب، فهو يقرأ بكل مكان ويدرس في كل زمان. (4) بيان بالعقد: فهو الحساب، وأهميته لا تخفى، فلولا الحساب لم يتمكن الإنسان من تقسيم الزمان إلى سنين وشهور وأيام، ولا عرف كيف ينظم تجارته وأمور حياته. (5) بيان بالنصبة: «فهي الحال الناطقة بغير لفظ والمشيرة بغير اليد؛ وذلك ظاهر في خلق السماوات والأرض وفي كل صامت وناطق وجامد وتام ومقيم وظاعن وزائد وناقص. فالدلالة التي في الموات الجامد كالدلالة التي في الحيوان الناطق. فالصامت ناطق من جهة الدلالة، والعجماء معربة من جهة البرهان. وبذلك قال الأول سل الأرض، فقل: من شق أنهارك وغرس أشجارك وجنى ثمارك؟ فإن لم تجبك حوارا أجابتك اعتبارا»[7]. وبهذا، فأشياء العالم كلها دالةٌ تبين بذاتها لمن تبينها واعتبرها، بأخذ العبرة منها عبوراً إلى ما بعدها، وهذا لا يتأتى إلا بالفكر والنظر، الذي نص عليه القرآن الكريم في أكثر من موضع.
لدى الجاحظ، للبيان صلة بفلسفة اللغة، وبالقدرات العقلية والذهنية لدى السامع والمتلقي، والكاتب والقارئ، والمرسل والمرسل إليه، على حد سواء. فكلا الطرفين يشتركان في عملية البيان والتبيين؛ أي الدلالة على المعنى والإيضاح. وهذه العملية لا تكتمل إلا بتوظيف علم الحساب. ومن المعلوم أن لهذا العلم، بين سائر العلوم، أهمية قصوى في تطور الإنسان، وفي بناء الحضارة. فأهم الثورات العلمية في تاريخ البشرية، تتصل بهذا العلم، فلولا علم الحساب لما تمكنت البشرية من تبين المساحات والأشكال الهندسية والمسافات والمقادير... إلخ، ولما تمكنت الإنسانية من الإحاطة بجغرافية الأرض. أما الإشارة، فتتأتى من خلال فك رموز الأشياء والظواهر. وهذا كله لا يصدق إلا بتفعيل الفكر والنظر في الموجودات. وتبقى اللغة هي الحاملة لمعاني الموجودات ودلالاتها. وبهذا أصل البيان - عند الجاحظ - هو العقل والنظر والرأي، فهو لم يجعل العقل تحت سلطة النص، بل جعل العقل طريقاً إلى فهم النص. ومن البين أن الجاحظ لم يشغل نفسه بإدراج الحديث في عملية البيان، عكس ما ذهب إليه الشافعي.
إن التقعيد الذي وضعه الشافعي قدر له أن يسهم بشكل كبير في تشكل العقل المسلم في نظرته للنص المؤسس، وهو عقل يتوسل بالحديث والرواية بدرجة أكبر في فهم القرآن. ماذا يعني هذا، ونحن نتحدث عن القراءة الداخلية؟ يعني الاستغناء بشكل كلي أو جزئي عن فهم القرآن من داخله، على حساب كل ما هو خارج عن القرآن؛ وذلك باستحضار مختلف الآثار والروايات في التفسير، وهو الأمر المنهجي الذي اعتمدته المدونات الكبرى للتفسير. إن نظرنا إلى تفسير الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بصفته من أبرز من أرسى التقعيد للتقليد التفسيري، نجد أن مختلف التفاسير التي جاءت بعده بنت محتواها على آرائه وأقواله، وسارت قاعدة بعده. قد نجد من خرج بعض الشيء عما قعد له، ولكن مجمل المدونات التفسيرية التي جاءت بعد الطبري لم تخرج بشكل كامل عمّا قال به. والذي يعتمد آلية المقارنة في البحث بين مختلف مدونات التفسير بعد الطبري، قد يتضح له مدى اتساع مساحة التكرار بين المفسرين لما قال به الطبري. والغريب أن المفسرين الكبار الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر أو في القرن العشرين لم يسلموا من هذه الظاهرة؛ ظاهرة التكرار. نحن هنا لا ندعو إلى القطيعة مع مختلف مدونات التفسير؛ لأن القطيعة ستضعنا في دائرة الغفلة والجهل بما حدث، كما أن التعاطي معها بأنها مكتملة وغير ناقصة، سيسقطنا في فخ إسقاط الماضي على الحاضر الذي نعيشه اليوم، وهو حاضر يختلف في كل شيء عن الماضي. إننا مطالبون بقراءة مختلف تلك المدونات، وفق محيطها الثقافي والاجتماعي والسياسي الذي ظهرت فيه، مع العلم أن البحث في مختلف التفاسير يساعدنا كثيراً على معرفة التاريخ الإسلامي. فمن خلال تفسير المنار لمحمد عبده، نفهم الأبعاد الفكرية والاجتماعية، والتحديات الثقافية والمعرفية التي عرفها العالم الإسلامي في علاقته بمختلف المعارف الأوروبية حينها، وكذلك نفهم من تفسير في ظلال القرآن للسيد قطب، طبيعة الإشكالات السياسية بعد سقوط نظام الخلافة الإسلامية في المشرق 1924م، وانكفاء جماعة من المسلمين على أنفسهم، بتضييق دائرة التفكير الانفتاح على مختلف علوم العصر. ومن خلال موسوعية تفسير مفاتيح الغيب للفخر الدين الرازي (-606هــــ) نفهم طبيعة الاتساع المذهبي والفقهي والكلامي والفلسفي الذي تميزت به الثقافة الإسلامية في القرن السادس الهجري. كما إننا نفهم من تفسير الطبري طغيان النزعة الإخبارية والعناية بالأثر والحديث والرواية في زمانه.
أما عن سؤالك ما مفهوم القراءة الداخلية؟ فموضوع الداخل في القرآن الكريم هو القرآن نفسه، فقراءته وتأويله ينبغي مراعاة الأخذ بمفهوماته الأخلاقية والقيمية المفتوحة على الإنسان، وعلى قيمة العلم والمعرفة والتعارف والحوار وحرية الإنسان، بدلاً من الحمولات والتصورات المرتبطة بأزمنة ولحظات تاريخية محددة، سادت فيها أحكام وتصورات تتصف بالانسداد بدل الانفتاح وبالغلو، أو التصورات الفلسفية التي تستعدي وتستبعد كل ما هو متعالٍ وروحي في الإنسان والوجود. ونشير هنا إلى أن القراءة الداخلية في بعدها العلمي تقدم الكيف عن الكم، ونحن هنا لا نقلل من الكم، ولكن إذا حضر الكم دون كيف فتلك مشكلة منهجية لا يترتب عنها بعد في النظر والإبداع، وقد تسقطنا في دائرة التكرار. فموضوع فهم القرآن ينبغي أن يأخذ منحى آخر بمعزل عن الطريقة التي ترى في التكرار والكم طريقاً للفهم بدلاً عن الكيف. فجلّ المفسرين فسروا القرآن في أجزاء ومجلدات كبيرة الحجم، بينما لم يتجاوز عدد كلمات القرآن 77437، وعدد آياته 6236 آية. فمثلا نجد تفسير «جامع البيان في تأويل القرآن» يضم 24 جزءاً، وتفسير «التحرير والتنوير» يضم 30 جزءاً.
في سياق تقريب معنى الداخل، إذا أخذنا موضوعاً من المواضيع، وأنا قدمت أمثلةً كثيرةً، من بينها موضوع تعدد الزوجات، إذا تتبعنا هذا الموضوع، وقرأناه من داخل القرآن الكريم، سنخلص إلى استنتاجاتٍ ربما لم يصل إليها المتقدمون من كبار المفسرين. والقرآن الكريم قال بالتعدد بهدف حلّ مشكلة اجتماعية تتعلق بمبدأ القسط في اليتامى، وبإيجاد حلّ لمعضلة تعدد الزوجات المفتوح الذي كان عند العرب حينها. فالتعدد في القرآن مقرونٌ، بدرجةٍ أولى، بتعدد أرملات، بهدف القسط والحفاظ على أموال اليتامى، والعناية بمختلف حياتهم الاجتماعية والنفسية، وليس تعدد فتيات صغيرات في السن. وفي الوقت ذاته، إيجاد حل لمشكلة تعدد الزوجات، قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتامَى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاّ تَعُولُوا} (النساء) وقد توقفت عند مفهوم ملك اليمين، وهو مفهوم لا علاقة له بتعدد الزوجات على الإطلاق. فملك اليمين فئةٌ اجتماعيةٌ لا تملك إلا قوت يومها من خلال العمل بيمينها، وقوت يومها ملك ليمين من تشتغل لديهم. هذه الفئة من المجتمع ينبغي التعامل معها والنظر إلى أحوالها مثل باقي كل أفرد المجتمع في الزواج وغيره. إذا عدنا إلى مدونة التفسير، سنجد فهماً آخر ارتبط بالأنثروبولوجيا العربية وبسياقات زمنية معينة، وهو أن التعدد لم يعد مقيَّداً بشرط أمهات اليتامى، وأن ملك اليمين ارتبطت بالجواري والسبايا. وكل هذا يتعارض مع روح القرآن الداخلية.
القراءة الداخلية هي القرآن نفسه في نظرته إلى العالم وإلى المواضيع التي تناولها. خذ مثلاً، كيف ينظر القرآن الكريم إلى الآخر، ستجد من داخل القرآن من البداية حتى النهاية، أن الله جلّ وعلا ربّ الناس جميعاً، ربّ الذين كفروا به، وربّ الذين آمنوا به، فهو رحيم بالجميع، الله رحيم بعباده، قال تعالى: {اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ} (الشورى). وقد تجد في مدونات التفسير وغيرها فهماً يبعد هذا المعطى الكلّي في القرآن، نتيجة وهمٍ وأمنيةٍ أن رحمة الله تخص الذين آمنوا به فقط. والقرآن يبعد المسألة عن مختلف التمنيات، سواء عند أهل الكتاب أو عند المسلمين. قال تعالى: {لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ وَلا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً} (النساء)
لهذا تقتضي القراءة الداخلية قراءة القرآن الكريم من داخله، وتتبع معنى ودلالة مفرداته في علاقتها بالمواضيع التي عالجها، وما الصورة التي قدمها القرآن للأنبياء والرسل الذين سبقوا بعثة محمد عليه السلام. هناك تصور وصورة لعيسى عليه السلام من منظور القرآن. وبعض الدارسين الغربيين - وهم على صواب - يقرُّون بأن القرآن الكريم يتضمن بين طياته سيرةً لعيسى، إلى جانب الأناجيل الأربعة القانونية. وهناك، أيضاً، نظرةٌ إلى نبي الله موسى في علاقته بمحيطه وزمنه. وهناك نظرةٌ إلى قصة قابيل وهابيل، ونظرة إلى قصة الخلق. فهذه كلها مواضيع إذا قرأناها من داخل القرآن الكريم، فإننا سنربح تصوراتٍ جديدة وفهماً جديداً، ليس بالضرورة هو الفهم الذي قال به الطبري ومن سار على نهجه، في مدونة التفسير الكبيرة. والهدف المنهجي، هنا، لا يعني أن ننفي الطبري وكل ما جاء في مدونة التفسير الكبرى، بل الهدف هو العمل على فسح المجال لأنفسنا لكي نقرأ ونفهم القرآن فهماً متجدداً في محيطنا الحضاري. وهذه رؤيةٌ قد تؤهلنا وتساعدنا لعلى الوصول إلى إجابةٍ عن سؤال مفاده «كيف نحضر في العالم؟».
د. حسام الدين درويش:
ليتضح مفهوم القراءة الداخلية، يمكن أن نقول، انطلاقاً من هذا المفهوم الذي قدمته، إنه يتعارض ليس فقط مع قراءةٍ برّانيةٍ مفترضةٍ، وإنما يتعارض مع قراءتين أخريين أيضاً. القراءة الأولى، والتي تسميها القراءة التجزيئية الذرية، والقراءة الثانية هي القراءة الحرفية. وأنت تميز، في القرآن، بين الروح والبدن، بين المحمول والحامل، بين الكلّي والجزئي. هل يمكن أن تبين التضاد أو الاختلاف بين هذه القراءة الداخلية والقراءتين الأخريين اللتين ذكرتهما؟
د. صابر مولاي أحمد:
بعودتنا إلى المدونة التفسيرية وإلى كبار العلماء والمفسرين، نجد أنهم يتتبعون في تفسيرهم القرآن من أوله إلى آخره؛ آية آية، وسورة سورة في عملية التفسير. فمدونة التفسير تتصف بالفهم والتفسير التجزيئي، حتى محمد عبده، وصاحب التحرير والتنوير الطاهر ابن عاشور، ينطبق عليهما الوصف نفسه. لكن لا أجد تفسيراً تناول موضوعات القرآن الكريم بشكل يحضر معه تتبع مختلف مواضيع القرآن من بدايته إلى نهايته، وأنا أقصد هنا القراءة الكلية، والتي تفهم الأجزاء من خلال الكليات، والاقتراب من رؤية القرآن الكريم ونظرته إلى هذا الموضوع أو ذاك. فالقراءة الكلية للقرآن تفسح المجال أمام تفكيرنا ليلتحم بالكوني والعالمي، فالرسول بعث رحمة للعالمين، قال تعالى: {وَما أَرْسَلْناكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ} (الأنبياء)
لقد وضعتنا القراءة التجزيئية في مشاكل كثيرة جدّاً. ومن أبرز تلك المشاكل أننا انتقلنا من القراءة التجزيئية إلى القراءة الحرفية التي همّها هو الحجة والدليل أكثر ما يهمها الفهم العميق، وهو ما يجعلها تسقط في فخ التناقض والتعارض. في تقديري ورأيي المتواضع، نحن اليوم يجب أن نخرج بالضرورة من القراءة التجزيئية التي تجزئ القرآن الكريم آيات آيات، وكلّ واحدٍ يستدل بهذه الآية أو تلك على نصرة انتمائه الطائفي أو انتمائه المذهبي. والغريب أنك تجد الآية الواحدة يتم الاستدلال بها من طرف شخصٍ واحدٍ أو اتجاه واحد في سياقات مختلفة بشكل متناقضٍ ومتعارضٍ. في مجال المعرفة اليوم، هناك من يرى أنه لا يمكن دراسة جزءٍ من الكون أو من الطبيعة بفصله عن مختلف الأجزاء الأخرى. فالكون يضعنا أمام منظومةٍ من الأبعاد، بعضها يرتبط ببعضٍ، وفهم بعضها يتوقف على فهم البعض الآخر. والقرآن الكريم يؤسس لهذه المداخل الكلية في نظرته إلى مواضيعه، وفي الدفع بالإنسان كي ينظر إلى ذاته، وإلى الوجود من حوله، وإلى أخيه الإنسان، بهذا المدخل المتكامل والمتداخل، والذي يترفَّع عن الفهم التجزيئي والفهم الضيق.
ففي الوقت الذي تركز فيه القراءة التجزيئية على الفهم الجزئي، تركز فيه القراءة الداخلية على الفهم الكلي، على أساس أن القرآن الكريم يتضمن ما هو كليٌّ وما هو جزئيٌّ. فما هو جزئيٌّ ينبغي قراءته داخل ما هو كليٌّ، مثلاً: عندما نتحدث عن قيمة العدل فهي قيمةٌ كليةٌ، لا يمكن تجزيئها، في النظر إلى جماعةٍ دون أخرى، حتى ولو كانت تلكم الجماعة معتديةً وظالمةً لجماعة أخرى. فمسألة العدل تتخذ بغض النظر عن خصوصيات المظلوم والظالم، المعتدي والمعتدى عليه. في هذا السياق نفهم قوله تعالى: {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ} (المائدة).
وبقصد الاقتراب من الكلي في القرآن، فقد توقفت عند مسألتين منهجيتين؛ هما: القرآن بين الروح والبدن، والقرآن بين الحامل والمحمول؛ إذ يرتبط روح القرآن بفضاء المعنى والدلالة، وهو فضاءٌ لا متناهٍ، بينما بدنه هو ظاهر أحرفه وكلماته، وهي بطبعها محدودةٌ ومتناهيةٌ: {قُلْ لَوْ كانَ الْبَحْرُ مِداداً لِكَلِماتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِماتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً} (الكهف). وينبغي التمييز في سور القرآن الكريم بين روح السورة وبدنها الذي يضم مجمل المفردات والأحرف التي تتكون منها السورة، كما يضم بدن السورة الحديث عن وقائع وأحداث أو قصص. أما روح السورة، فهي القيم الأخلاقية التي تكمن بين ثنايا السورة في علاقة ذلك بكل سور القرآن الكريم. طبيعة التمييز المنهجي، بين روح القرآن وبدنه، تقتضي الوعي أن هناك حاملاً ومحمولاً في القرآن الكريم. الحامل هو القصص والوقائع والأحداث والتشريع وكل ما تحدث عنه القرآن. أما المحمول، فيكمن في المقصد الأخلاقي والقيمي الذي توخاه القرآن ونحا نحوه. ومن ثم يمكن القول إن القرآن، من أوله حتى آخره، يعد حاملاً ً لقيمٍ إنسانيةٍ راقيةٍ يريد لها أن تسود بين كل الناس، بمعزلٍ عن انتماءاتهم الدينية والمذهبية. هذان المعطيان المنهجيان يجعلان من القراءة الداخلية للقرآن على وعيٍ بأن القرآن لم يتعاطَ مع التاريخ والواقع، وكأنه متوقفٌ في اللحظة الزمنية التي نزل فيها؛ أي القرن السابع الميلادي، بل إنه استوعب ذلك الواقع، وغرس فيه ومن خلاله، توجيهاتٍ أخلاقيةً بقصد أن يتجه التاريخ نحوها؛ بمعنى أن القرآن يضم بداخله تطبيقاتٍ تاريخيةً تتضمن منظومة قيمٍ وأخلاقٍ. فينبغي أن نميز اليوم ما بين التطبيقات التاريخية في القرآن، وهو يتحدث مثلاً عن معارضي الدعوة المحمدية (أي الحامل)، والقيم والأخلاق التي تضمنتها تلك التطبيقات (أي المحمول). فواقعنا اليوم غير واقع الزمن الذي نزل فيه القرآن، كما أن تجسيد القيمة الأخلاقية نفسها، لا يعني أنه سيكون نفس التجسد والتطبيق كما هو في زمن الرسول أو غيره من الأزمنة. فالقراءة الداخلية من هذه الزاوية تحررنا من وهم تكرار التطبيقات بشكلٍ متطابقٍ. فهي تضعنا أمام وعيٍ منهجيٍّ مفاده أن الإسلام واحدٌ من جهة النص المؤسس (القرآن)، ومتعددٌ من جهة الزمان والمكان والتاريخ. وهذا يقتضي أن نخوض تجربة فهمٍ جديدة، وفق محيطنا الحضاري، تستفيد من مختلف التجارب في التاريخ. القراءة التجزيئية والحرفية عاجزةٌ عن أن تستجيب لهذا المطلب؛ أي مطلب ما هو حضاريٌّ.
د. حسام الدين درويش:
لمزيد من التوضيح لمسألة القراءة الداخلية، يبدو أنك، في كتابك، تنوس بين طريقتين أو ثلاث طرائق. فمن ناحيةٍ أولى، أنت تستخدم القراءة التفسيرية، وربما هناك اختلاف بين مفهوم الدكتور رضوان للتأويل ومفهومك للتأويل. والتفسير بالنسبة إليك هو التبيين. أما التأويل، فيحيل على ما يؤول الأمر ويرجع إليه، وهذه قراءةٌ قرآنيةٌ جدّاً. من ناحية ثانيةٍ، أنت تلجأ، أحياناً، إلى استراتيجية التمييز بين المحكم والمتشابه، وتستخدم، من ناحيةٍ ثالثةٍ، أو تقرأ النصوص على أساس ما يسمى بالبعد الأخلاقي والبعد الإنساني العام.، فأنت تنوس بين هذه المقاربات الثلاث أو تحاول الجمع بينها. قبل أن أسألك عن مفهومي التفسير والتأويل، إلى أيّ حد أنت واعٍ بهذا النوس؟ وكيف تحاول ضبط استخدام هذه المقاربات الثلاث معاً، وضبط العلاقات بينها منهجيّاً، ووضع معايير واضحةٍ تحدد متى نلجأ إلى هذه المقاربة أو تلك؟ ومتى وكيف يمكننا أو ينبغي لنا الجمع بينها؟
د. صابر مولاي أحمد:
في تقديري القرآن كله محكمٌ. أما موضوع التشابه، فهو يعود إلى خارجه، وليس إلى داخله. قال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ} (الزمر). فكيف يكون كتاب القرآن كله محكماً، وبداخله تشابهٌ! التشابه هنا تعود على ما هو خارج عن كتاب القرآن، والتشابه بمعنى التناظر. فمشكلة المفسرين وغيرهم من الذين كتبوا في علوم القرآن، أنهم فهموا الآية السابعة من سورة آل عمران بأنها تقسم آيات القرآن إلى آياتٍ محكماتٍ وآياتٍ أخرى متشابهة، وهذا غير صحيحٍ، وقد قدمت قراءةً جديدةً لمفهوم المحكم والمتشابه في القرآن، وتوقفت عند الآية السابعة من آل عمران. قال تعالى: {*هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاّ اللَّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا وَما يَذَّكَّرُ إِلاّ أُولُو الأَلْبابِ} (آل عمران)
المحكم: وصف القرآن نفسه بأنه كتابٌ محكمٌ ودقيقٌ لا تعارض فيه من حيث الموضوعات التي عالجها ومن حيث مفرداته. فموضوعات القرآن ينبغي النظر إليها بأنها متماسكةٌ ومترابطةٌ في ما بينها، من خلال رؤية القرآن الكلية للإنسان، والكون، وعالمي الغيب، والشهادة. القرآن، إذن، كتابٌ محكمٌ، ولا تشابه فيه من داخله. وهذا يعني أن القرآن لا يعترف بأن آياته ينسخ بعضها بعضاً، فبموجب الإحكام، لا نسخ لآيات القرآن بعضها بعضا.
المتشابه: تدور مفردة «متشابه» في مدار يفيد التماثل والتناظر، فآيات الله في كتاب القرآن تماثلها آيات الله في الكون قال تعالى: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ} (الزمر)، فالكتاب المتشابه ورد مقروناً بمفردة «مثاني»، ومن الملاحظ أن مفردة «القرآن» وردة تابعة لمفردة «المثاني» ومعطوفة عليها في سورة الحجر، قال تعالى: {وَما خَلَقْنا السَّماواتِ وَالأَرْضَ وَما بَيْنَهُما إِلاّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ *إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاّقُ الْعَلِيمُ *وَلَقَدْ آتَيْناكَ سَبْعاً مِنَ الْمَثانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} (الحجر) فما المثاني السبع إذن، يجيبنا القرآن بقوله: {*اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْماً} (الطلاق)
كما أن موضوعات الآيات المتشابهات تتصل بيوم البعث والحساب والساعة، وما شابه من قبيل قصص الأنبياء والرسل في القرآن. فهذه الآيات في القرآن «مُتَشَابِهَاتٌ»؛ أي تماثلها ما تضمنته الكتب السابقة عن القرآن (التوراة والإنجيل). وقد نبّه القرآن في مواضع كثيرة إلى معضلة تحريف كلمات الكتاب عن مواضعها وعن موضوعاتها من لدن أهل الكتاب من بني إسرائيل. قال تعالى: {فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمّا يَكْسِبُونَ} (البقرة). فالتشابه هنا تشابه خارجي.
عندما نجد القرآن يسترجع ما سبقته إليه الكتب السابقة عنه، فالسؤال هل نكتفي بما سبقه من الكتاب (التوراة والإنجيل)، ونقول إن القرآن مجرد ناقلٍ، كما يقول بعض الغربيين، أم نقطع مع ما سبقه ونكتفي به لوحده، وهو الموقف الذي اختاره الكثير من المسلمين؟ في هذا السياق نفهم {فَأَمّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ}. فهناك من ينفي القرآن ويستعجل وقوع ما أخبر به من يوم البعث والحساب، أو يكتفي بما سبقه من الكتاب، أو ينفي ما سبقه من الكتاب، وكل هذا بهدفٍ معلنٍ أو غير معلنٍ، يرتبط بالفتنة بدل العلم. والموقف الذي يدفع القرآن في اتجاهه هو القراءة الكلية للقرآن ولما سبقه من الكتاب، وهنا تأتي الأهمية المنهجية لمفردة (كُلٌّ) على لسان «الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» في اليهودية والمسيحية والإسلام؛ إذ تجدهم يقرؤون الكتاب في مجمله ويقارنون بين ما تتضمنه بنية كل كتابٍ. فالبنية التي تتصف بالانسجام والتكامل بدل التضارب والتعارض هي الأقرب إلى الصواب. قال تعالى: {لَكِنِ الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ} (النساء/162). وفق هذه الرؤية يضعنا القرآن في خانة قراءة الكتاب في بعده الكلي، مع العلم أن مفردة كتاب في القرآن تعود على كتاب الوحي (التوراة والإنجيل والقرآن) وتعود على كل كتاب لوحده، كما أنها تعود على كتاب الكون. فكتاب الكون أم (أصل) لكتاب القرآن، وكتاب القرآن أم (أصل) لما سبقه من الكتاب، وفق هذا السياق مفهوم {آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ}. والقرآن قدم منهج التصديق والهيمنة في نظرته إلى ما سبقه من الكتاب كما بينت سابقاً. وفي الوقت ذاته، فهو لا يكره أحداً على الإيمان به، ولكن يطلب من أهل الكتاب من اليهود والنصارى بأن لا يكتفوا بما بين أيديهم من الكتاب. وهو الأمر نفسه مع المؤمنين به؛ إذ من الصعب فهم الكثير مما تحدثت عنه سورة البقرة مثلاً. دون قراءة سفر التكوين من العهد القديم على الأقل. ومن يقرأ مؤلفاتي، سيجد هذه الرؤية لمفهوم المحكم والمتشابه حاضرةً من خلالها.
صحيحٌ ما أشار إليه الدكتور رضوان السيد في تقديمه للكتاب، من أن الكتاب تحضر فيه الأبعاد الأخلاقية والتحليلية والتأويلية والأخلاقية والإنسانية العامة. فهذه المستويات حاضرةٌ بشكلٍ مركبٍ ومتداخلٍ، وليس باللجوء لأحدها دون الآخر؛ فقد حاولت أن يكمل بعضها البعض الآخر. البُعد التحليلي: وذلك بتتبع سياقات المفردات والمواضيع من داخل القرآن، ولا تغفل المحيط الاجتماعي والتاريخي الذي نزل فيه القرآن، أو المحيط الذي فسر فيه القرآن على طول التاريخ الإسلامي، أو الزمن الذي نحن فيه. البعد التأويلي: وذلك باستثمار المعرفة الــــتأويلية قديماً وحديثاً، في كشف معاني القرآن وأبعاده. البعد الأخلاقي: وعياً بأهمية المعطى القيمي والأخلاقي من داخل القرآن، وكشرطٍ من أجل ارتقاء الإنسان في الوجود. البُعد الإنساني العام: وعياً بأن القرآن خطابٌ كونيٌّ وعالميٌّ موجهٌ إلى الناس جميعاً.
د. حسام الدين درويش:
يبدو أن فهمك لمفهوميْ التفسير والتأويل لا يختلف عن الفهم التراثي القديم لهما؛ فالتفسير هو التبيين، والتأويل هو ما يؤول ويرجع إليه؛ مع العلم أن الفهم (الهيرمينوطيقي) المعاصر لهذين المفهومين شهد تغيراتٍ كبيرةً وكثيرةً. أرجو أن تشرح فهمك لهذين المفهومين، ولمفاهيم التدبر، والترتيل، والتفكر؟ فأنت عندما فسرت أو قرأت سورة التوبة، قلت: «هنا لن أقوم بالتفسير، وإنما سأقوم بالتدبر والترتيل والتفكر». لكن ليس واضحاً ما تقصده بذلك؟ وما معنى كل مفهوم من هذه المفاهيم على حدةٍ؟ وبمَ يختلف عن المفاهيم المذكورة الأخرى؟
د. صابر مولاي أحمد:
القراءة الداخلية تأخذنا إلى قراءةٍ جديدةٍ لمفهوم التأويل ومفهوم التفسير، ومفهوم الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول، والمحكم والمتشابه كما بينت، في ما سبق. وهي مراجعةٌ منهجيةٌ لمختلف آليات ومفاهيم علوم القرآن. والهدف هنا ليس نفي علوم القرآن، وما قال به الزركشي والسيوطي، وما قال به العلماء الكبار الذين وضعوا علوم القرآن. فأنا أدعو إلى استثمار ذلك الجهد، وفتح مساراتٍ أخرى للتفكير.
نأتي الآن لمفهوميْ التفسير والتأويل. فحسب قراءتي المتواضعة، مفردة التفسير في القرآن الكريم ذكرت مرة واحدة، قال تعالى: {وَلا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلاّ جِئْناكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيراً} (الفرقان). فموضوع التفسير، هنا نُسِب إلى الحق جل وعلا، ومن ثم، فالتفسير للقرآن، بينما اقترنت مفردة التأويل بالإنسان، فهي مقترنة بنبي الله موسى، ومقترنة بنبي الله يوسف، ومقترنة بالإنسان في موضوع حفظ أموال اليتامى. وقد ذكرت مفردة التأويل مراتٍ متعددةً، وهي متصلةٌ بالفعل الإنساني، وبالتجربة الإنسانية، وبالتجربة النبوية. وإذا عدنا إلى الثقافة العربية الإسلامية، سنجد اختلافاً ما بين المفسرين: هل التفسير والتأويل بمعنى واحد؛ فهناك من ارتأى أن التأويل هو فهم الباطن، بينما التفسير هو فهم الظاهر.
وأنا تتبعت التأويل في القرآن، ووجدت أن مفهوم التأويل في القرآن الكريم يعني ما يؤول إليه الأمر وما يرجع إليه. ووجدت أن القرآن الكريم يلفت نظرنا إلى أن الكثير من الآيات التي تحدث عنها، وهي آياتٌ متصلةٌ بالوجود، أو بسنن التاريخ أو بحياة الإنسان وكينونته وبالنفس، يلفت نظرنا لكي نرجعها ونراها ونقرأها في سياقها المكاني أو الزماني. يعني، لكي نفهم الآيات التي تحدث عنها القرآن الكريم، مثلاً عن البحار وعن الجبال، فذلك يعني قراءتها في الطبيعة. والقرآن يدفعنا في هذا الاتجاه، لكي نلتحم بفهم وقراءة سنن الوجود، ونفهم كيف يتحرك الوجود وكيف تتحرك الحياة وما السنن من وراء الاجتماع، وما السنن المرتبطة بالنفس، وغير ذلك، قال تعالى: {قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}(العنكبوت). بهذا المعنى، يكون التأويل موضوعاً يفتح أعيننا وبصائرنا على قراءاتٍ متعددةٍ ومتنوعةٍ ومتحاورةٍ ومتواصلةٍ فيما بينها؛ لأن موضوع التأويل يهمه المعنى وتهمه الدلالة، ويهمه اجتراح مفاهيم ثقافيةٍ، بينما التفسير ينحو، دائماً وبشكلٍ عامٍّ، منحى الحقيقة والفهم الواحد. اليوم، لا مهرب لنا من التأويل والمعرفة به؛ إذ نجد أمامنا نصوصاً في المعرفة التأويلية مع غادامر وهايدغر وريكور؛ فهؤلاء ارتبطوا بفكرة التأويل وبتأويل نصوصهم الدينية وقراءتها بمعانٍ معينة، كما أن تراثنا مليء بالمعرفة التأويلية مع ابن سينا وابن رشد.
يحضر في عملية التأويل كثير من الآليات، وقد نبّه القرآن إليها. من بينها التدبر والترتيل والتفكر والنظر والعلم والعقل والقلب، بمعنى حضور مجمل ملكات الإنسان. فالفاعل المتحرك في علاقته بالمكان والزمان، والكون هو الإنسان بغاية فهم وتأويل القرآن، وهو نصٌّ صامتٌ. وفي هذا السياق، نستحضر قول علي بن أبي طالب: «وهذا القرآن إنما هو خط مستور بين الدفتين لا ينطق بلسان، ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال». فهذا النطق الذي أشار إليه علي بن أبي طالب؛ أي التأويل، والتأويل هنا مقيد بمختلف آليات التأويل في القرآن، وهي التي أشرنا إليها سابقاً، ومنها آلية التدبر، وهذه المفردة وردت مرتين في القرآن. فتدبير أمر معين، يقتضي فهمه والإحاطة به، واستيعابه في مختلف جوانبه. فمهمة التدبير تقتضي إتقان إدارة الأمر. والإدارة، في جزءٍ كبيرٍ منها، تقتضي تتبع مختلف مدارات ما تتم إدارته وتدبيره، كذلك هو الأمر مع القرآن، ينبغي تدبر أي تتبع مختلف مفرداته ومعانيها ومواضيعه ودلالتها من بدايته حتى نهايته. قال تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} (النساء/82). فالتدبر يرتقي بالإنسان لفهم القرآن في كليته. ويدرك يقيناً أنه نصٌّ واحدٌ متكاملٌ لا تعارض بين نصوصه وحقائقه. وقد حث القرآن على تدبر آياته، في موضعٍ آخر، قال تعالى: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفالُها} (محمد/24).
وتحضر في عملية التأويل آلية الترتيل، فقد وردت في القرآن مرتين، فالقرآن كتابٌ مرتَّلٌ. قال تعالى: {وَرَتَّلْناهُ تَرْتِيلاً} (الفرقان/32) وطلب منا ترتيله قال تعالى: {وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً} (المزمل/4) فالقرآن يشكل شبكةً من المعاني والمفاهيم، وهي مرتبةٌ ومنتظمةٌ بشكلٍ فريدٍ، فعملية الترتيل لا تتوقف عند التلاوة، بل تمتد إلى الفهم باستحضار طبيعة ترتيب تلك المفاهيم المرتبطة بالموضوع الذي تقام عليه عملية التأويل. وتحضر في عملية التأويل آليات التفكر والتفكير، قال تعالى: {قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَى وَفُرادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا} (سبأ/46) وتأخذنا مفردة التفكر إلى مفردة «العقل»، وهي إحدى المفردات المفتاحية في الحقل الدلالي القرآني؛ فقد مجّد القرآن العقل إلى درجة يصح القول معها إن القرآن في جزءٍ كبيرٍ منه دعوةٌ لإعمال العقل؛ إذ وردت هذه المفردة «يعقلون» 22 مرة، ومن الملاحظ أن وصف «لا يعقلون» يأتي بعد الدعوة للنظر والتفكير في الكون والموجودات. ومفهوم العقل في القرآن ملكةٌ وآلية اشتغالٍ ترتبط على مستوى وظيفة الفهم بالقلب، قال تعالى: {لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولَئِكَ كَالأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ} (الأعراف/179) ونشير هنا إلى أن مسألة التأويل تراعي بالضرورة القيمة الأخلاقية من وراء مختلف المواضيع. ونضرب مثالاً على هذا الأمر، قال تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الأَنْعامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمّا فِي بُطُونِها وَلَكُمْ فِيها مَنافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْها تَأْكُلُونَ} (المؤمنون) القراءة والتأويل المختبري في دراسة هذه الظاهرة، في الغالب لا تَعْبر نحو معرفة الحكمة من وراء هذه الآية في الطبيعة، لكن التأويل على ضوء القراءة الداخلية يستوجب الاقتراب من حكمة الله في الوجود، وفي الكائنات في علاقة بعضها مع بعض. وهذه منهجيةٌ تجعل العلم يقترن بالحكمة والأخلاق.
د. حسام الدين درويش:
يتضمن كتابك الكثير من النقد المباشر أو غير المباشر، الجزئي أو الشامل، لما تسميه الحضارة والفلسفة الغربية المادية. وتقول إن في هذا الغرب نسيان الإنسان لنفسه، ودليلك على هذا أنه موجود في القرآن؛ يعني في القرآن موجود أن الإنسان في الغرب الحالي يمكن أن ينسى نفسه. سؤالي هنا، أنت تعرف أن الفكر الإسلامي ينوس أو يتأرجح بين رؤيةٍ تعدّ هذا الغرب كافراً ملحداً عديم الروحانيات، ورؤيةٍ يتبناها مسلمون (وغير مسلمين) تقر بأنه في هذا الغرب روحانياتٌ وأخلاقٌ. ونذكر هنا قول محمد عبده، بعد عودته من زيارة أوروبا عام 1881: «رأيت في أوروبا إسلاماً بلا مسلمين، وأرى في بلادي مسلمين بلا إسلام». وتبدو، في هذا الكتاب، أقرب إلى الرؤية الأولى، رغم أنك تقول أنا لا أتحدث عن كل الغرب، ولا أختزله. هل كان في رأيك من الضروري إظهار إيجابية الإسلام أو الدين الإسلامي، أو الديني من خلال القول «لا رجعة إلا بالله، ولا خلاص إلا بالإسلام»؟ ألا يمكن لغير المسلم أو غير المتدين، وللجميع من حيث المبدأ، الإسهام في الخلاص المذكور، بغض النظر عن كونه مسلماً أو غير مسلمٍ، متديناً أو غير متدينٍ؟
د. صابر مولاي أحمد:
من حيث المبدأ العام، أستحضر هنا حديثاً للرسول صلى الله عليه وسلم، مفاده: «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»، مكارم الأخلاق في كل حضارةٍ وثقافة. لا يمكن وصف الحضارة الغربية بأنها كلها باطلةٌ، هذا كلامٌ غير معقولٍ، ولا يمكن أن نؤسس لقطيعةٍ شاملةٍ معها؛ لأن الغرب ليس واحداً، بل هو متعددٌ ومتنوعٌ. والسؤال هو كيف يمكن استثمار طبيعة التواصل والتحاور مع هذا الكيان الآخر؟ فجزءٌ منه هو منّا، كما أن جزءاً منّا هو منه، نحن نتحدث عن إنسانٍ يتحاور ويتواصل. والقرآن الكريم غنيٌّ بالآيات والمداخل المعرفية والأخلاقية في هذا الاتجاه، قال تعالى: {يا أَيُّها النّاسُ إِنّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَقَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات) التعارف منهجيّاً ليس من باب الاسم، وإنما التعارف من باب القيمة المعرفية. ولهذا، حققت الحضارة الإسلامية، في زمن ازدهارها، تعارفاً مع الإرث الإنساني ككل، مع الحضارة الإغريقية، ومع ما سبقها من الحضارات. الغرب اليوم، حقق نوعاً من التعارف، من خلال علاقته مع مختلف ما سبقه من الحضارات. فهو له معرفة معينة بتراثنا وبحضارتنا. صحيح هي معرفةٌ متحيزةٌ لذاته، وتفتقد كثيراً من الموضوعية، في جوانب متعددةٍ، (الدراسات الاستشراقية) ولكنها، في الأخير، معرفةٌ بالآخر، من وجهة نظر الغرب.
نحن اليوم في حاجةٍ لكي نخلق تعارفاً معرفياً في علاقتنا بهذا الآخر. وهذا التعارف ينبغي أن تحضر فيه قيمة إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعندما نتحدث عن التقوى، فهي التقوّي بالخير والتقوّي بالبحث عن الصواب، والتقوّي بالبحث عن المصلحة العامة. هذا هو السياق والمنحى الذي يدور فيه القرآن الكريم، فضلاً عن أن القرآن نفسه ملك للناس جميعاً، فهو خطابٌ موجهٌ لكل الناس، ولا يمكن أن نحرم من له قراءةٌ أخرى، أو وجهة نظرٍ أخرى للقرآن وتاريخ حضارتنا، أو يطرح أسئلةً تبعاً لسياق ثقافته وحضارته. وأقصد مختلف الدراسات الاستشراقية. إذن، ينبغي أن نقرأ ذلك ونستوعبه، ونطرح أسئلتنا من خلال صيرورتنا الحضارية والثقافية. وأولاً وأخيراً، القرآن لا يُخشى عليه؛ لأن المسألة ليست مسألة دفاعٍ، ولكن هي مسألة إنسانٍ. ولهذا، عندما أنتقد الغرب، وأستحضر قوله تعالى: {وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ} (الحشر) فهذه الآية تعود على الناس جميعاً، فهي مفتاحٌ نفهم من خلاله أن الإنسان، أيّ إنسانٍ، عندما يعرض عن الجانب الروحي المتعالي فيه، فقد يترتب عن ذلك، نسيان لغاية الإنسان في الوجود؛ إذ سيعيش دون هدفٍ ولا غايةٍ، فهو يعيش من أجل العيش ذاته، ويصبح الفن بالنسبة إليه فنّاً من أجل الفن ذاته، ويتعلم من أجل العلم ذاته؛ لأن العلم عنده مفصول عن الوجهة والهدف والمقصد. فيه ما يخدم رفاهيته وإنسانيته، وفيه ما يعود عليه بالدمار، أو يأتي الإعراض عن الجانب الروحي فيه، بالإعراض عن العلم والإقبال على الخرافة، ويقدم حياة الجهل على حياة المعرفة. وبهذا، فهو يستعدي التمدن والحضارة. صحيحٌ، هناك انزلاقاتٌ في الحداثة الغربية، ولكن ثمة مساحاتٌ كثيرةٌ مضيئةٌ فيها، صحيحٌ ثمة مساحاتٌ مضيئةٌ جدّاً في ثقافتنا وفي محيطنا التاريخي، ولكن ثمة مشاكل أخرى. هذه النظرة التي تنظر نظرةً أحاديةً، إما بالأبيض أو بالأسود هي عين المشكلة. هذا ما يمكن أن أقوله باختصار من جهة المبدأ العام حول هذه الفكرة.
فالموضوع، في مجمله، يرتبط برؤىً متباينةٍ للعالم ما بين الغرب والشرق، لا علاقة لها بمسألة أن الغرب ليست لديه روحانيات وأخلاق. على الإطلاق، أنا لم أقل إن الغرب كافرٌ أو ليس فيه أخلاق، وحتى مفهوم الكافر نحن في حاجة لكي نفهمه، بمعزل عن الحمولات التي أخذها هذا المصطلح عبر تاريخ الديانات، بما فيها التاريخ الإسلامي. مفهوم الكافر في القرآن ليس من باب التَّحقير، ولا تعني على الإطلاق بأن الله متحيز للمؤمن على حساب الكافر. فالله ربّ الجميع، وهناك سنن في الكون تسري على الجميع، والله في الأخير هو من يعرف من هو المؤمن ومن هو الكافر. وفي اللغة، الكافر هو الزارع الذي يخفي البذور في الأرض؛ فالكفر في اللغة بمعنى الستر والتغطية، كأن الكافر يخفي وينكر جحوداً منه، ما هو موجودٌ بدواخله بحكم الخَلق والطبيعة والتكوين؛ أي ما هو روحيٌّ ومتعالٍ، هذا على مستوى التصور. أما على مستوى التطبيق، فالقرآن يتحدث لنا عن منظومة قيمٍ، ويصف الذين آمنوا بأنهم يعقلون، يتذكرون، يتفكرون، بينما الكافرون على العكس من هذا. تصور معي أناس من الذين ينظرون لأنفسهم بأنهم مؤمنون، وهم يستعدون العلم والعقل ويحتقرون مختلف المعارف، فهم لا يعقلون ولا يتفكرون ولا رأي لهم ولا نظر. وتجد جماعة أخرى من الذين يوصفون بالكفر يعقلون ويتفكرون ويقدرون العلم. في هذا السياق، يمكن أن نفهم قول محمد عبده بعد عودته من زيارة أوروبا عام 1881م: «رأيت في أوروبا إسلاماً بلا مسلمين، وأرى في بلادي مسلمين بلا إسلام»، وهي قولة تستشعر طبيعة التحول والفرق الحاصل بين الشرق والغرب.
في القرون الوسطى كان الغرب يعيش في ظلام الجهل، كان الشرق الإسلامي حينها يعيش نور العلم. صورة تفوق الغرب العلمي، أدركها الكثير من رواد النهضة في العالم الإسلامي قبل وبعد محمد عبده، من بينهم رفاعة رافع الطهطاوي (-1873م) ورحلته إلى فرنسا، والتي قام بها ما بين سنة 1826م/ 1831م، ونتج عنها كتابه «تخليص الإبريز في تلخيص باريز». ومن قرأ هذا الكتاب، سيستنتج وعي الطهطاوي بالواقع الأوروبي الجديد، وهو واقع يتصف بأخلاق التمدن والنظام والإعلاء من شأن العلم. وفي هذا الصدد، أستحضر ما نقله الرحالة المغربي محمد الصفار (-1881م)، وهو يصف المفهوم الجديد للعلم والعالِم قوله: «والعالِم عندهم هو من له قدرة على استكشاف الأمور الدقيقة واستنباط فوائد جديدة وإقامة الحجج السالمة من الطعن على ما أبداه ورد ما عارضه به من عداه. وليس اسم العالِم عندهم مقصوراً على من يعرف أصول دين النصرانية وفروعها وهم القسيسون، بل ذلك ربما كان عندهم غير ملحوظ بالنسبة إلى غيره من العلوم العقلية الدقيقة»[8]. من خلال هذا النص، الذي أورده محمد الصفار في رحلته إلى فرنسا في بداية النصف الأخير من القرن التاسع عشر، نفهم بأنه أدرك أن مشكلة تأخر العالم الإسلامي تعود بدرجةٍ أولى إلى إهمال وتهميش العلوم العقلية التي كانت سبباً مباشراً في تقدم الأوروبيين. لا أحد من هؤلاء من رواد النهضة اختزل أوروبا في دائرة الكفر والإلحاد، أو اتخذ موقفاً من عدم الاستفادة منها ومن علومها، بل على العكس من ذلك، فقد أحس الكثير منهم أن جزءاً مهمّاً من رؤيتهم للعالم التي تنطلق من المرجعية القرآنية ومن الثقافة الإسلامية، وهي رؤية في بعدها النظري تمجد العلم والمعرفة والنظر والفكر والتفكر قد تجسدت في المجال الأوروبي، في وقتٍ تخلى فيه العالم الذي ينتمي إليه (الشرق) عن العلوم والمعرفة العقلية بشكل عام.
فمقولة محمد عبده تقربنا من مشكلة مفادها أن الغرب قد اكتفى بالعلم بمفهومه الوضعي (لاهوت الأرض)، بينما الشرق اكتفى (بلاهوت السماء)؛ فالعلم بالنسبة إليه محصور في دائرة العلوم الشرعية، ولا حظَّ للعلوم العقلية إلا ما هو قليلٌ ومهمشٌ. والذي يؤكد ما ذهبت إليه أن محمد عبد لم يتخلّ عن انتمائه الحضاري للشرق؛ أي لم يتخلّ عن الرؤية الأخلاقية الإسلامية للعالم، بل سعى إلى تقويم هذه الرؤية وتعديلها؛ وذلك باستقدام كل ما هو عقليٌّ من الغرب (الترجمة)، وإحياء كل ما هو عقليٌّ في الثقافة الإسلامية. فعبده يعود له قصب السبق في وضع اليد على متونٍ مهمشةٍ في الثقافة الإسلامية. وهي متونٌ في غاية الأهمية (ابن خلدون، الشاطبي، مسكويه)، وقد حظيت هذه المتون بكثير من الدراسة والتحليل على طول القرن العشرين.
تصور معي أن يهجر الشرق نصوصه العقلية لقرونٍ، ليعود إليها بدافع تفوق الغرب. فالإسلام الذي رآه محمد عبده في أوروبا يرتبط بشق العلوم العقلية، والمسلمون الذين رآهم في بلاده من دون إسلامٍ هم أناس يحتقرون العقل والنظر، فهم مسلمون بالوراثة وبالهوية والتاريخ، لا بالعمل وأخلاق العلم والمعرفة. فالإسلام في نظر محمد عبده هو إسلام العقل، لا بالمفهوم الغربي للعقل، ولكن بالمفهوم القرآني. من هنا تأتي أهمية تفسير المنار لمحمد عبده، وهو تفسير حاول من خلاله، بقدرٍ كبيرٍ، أن يفتح مجالاً جديداً في فهم القرآن، وتأويله تأويلاً يستجيب لمقتضيات العصر والزمن الذي عاشه.
قولة محمد عبده هذه تنتمي إلى النصف الأخير من التاسع عشر «رأيت في أوروبا إسلاماً بلا مسلمين، وأرى في بلادي مسلمين بلا إسلام». ونحن نعلم أن محمد عبده الذي توفي سنة (-1905م) كان يُنظر إلى العلم الأوروبي في زمنه، نظرة لطيفة. فالعلم لا يأتي إلا بالخير. لم يعش عبده حالة الحرب العالمية الأولى (1914م/1918م) وقد راح ضحيتها حوالي 10 ملايين عسكري وحوالي 7 ملايين مدني، نتيجة الأسلحة المتطورة والقصف بالطيران، ولم يحضر الحرب العالمية الثانية (1939م/1945م) وقد راح ضحيتها (40 مليون مدني، وقتل20 مليون جندي). صحيحٌ، هناك حروب كبيرة في التاريخ، ولكن أن يتورط العلم والتقنية في القتل بهذا الشكل غير المسبوق، فهو أمر ضد العقل، وهذه نقطة من نقط حمق الغرب وجنونه، وإسرافه في القتل. ومن واقعية القرآن قال تعالى: {وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كانَ مَنْصُوراً} (الإسراء). حالة الإسراف المطلق في القتل هذه لم يعشها محمد عبده، لو قدر له وشهد جزءاً منها لقال أمراً آخر. ولا ندري هل محمد عبده على علم بالمذبحة والإبادة الجماعية التي راح ضحيتها 100 مليون من الهنود الأمريكيين الأصليين. فأمريكا كما نراها اليوم أقيمت على أنقاض السكان الأصليين للأرض، وما تقوم به الصهيونية في حق الفلسطينيين، بدءاً من النصف الأخير من القرن العشرين، يشبه هذه القصة.
العالم اليوم يمتلك من أسلحة الدمار الشامل ما يكفي لتدمير الكرة الأرضية. بعد كل هذا؛ أين هو اليوم في أوروبا ذلك الإسلام بلا مسلمين؟ بمعنى أوروبا والغرب الذي رآه محمد عبده حينها أواخر القرن التاسع عشر، ليس هو الغرب نفسه اليوم. ومن ثمَّ، هذه المقولة تنسجم مع زمانها، وينبغي قراءتها في محيطها، وقراءة ما أقول به وفق الزمن الذي يظللنا اليوم. أنا أقول هذا الأمر، ولا أنكر الفتوحات الكبيرة التي قام بها العلم لمصلحة الإنسان في مجال الطب، وفي مختلف مجالات الحياة. فينبغي ألا نغفل أن التقدم في الغرب تقدم مزدوج يجمع ما بين الخير والشر. وللحد من اتساع الشر عبر العالم، يأتي دور الفلسفة والأخلاق والدين والفن. في هذا السياق، تأتي أهمية العناية بالرؤية الأخلاقية للعالم. وهناك الكثير من الكتابات والأبحاث التي عرت الغرب، وكشفت أن المعرفة لديه مرتبطةٌ بالسلطة، وأشير هنا إلى كتابات إدوارد سعيد وغيره كثير، في الشرق والغرب.
أما الاتجاهات التي تختزل رؤيتها للغرب بكونه كافراً وملحداً وعديم الروحانيات والأخلاق، فهذه الاتجاهات ظهرت وتشكلت ما بعد النصف الأخير من القرن العشرين، وهي تستعدي كل ما هو عقليٌّ في الثقافة الإسلامية، وتستعدي كل ما هو عقليٌّ في الثقافة الغربية. والأسباب من وراء ظهور هذه التيارات المتشددة التي تقول بالقطيعة مع الغرب وتكفر كل من هو مختلف معها، متعددة؛ نذكر منها: الجرح التاريخي الذي تسبب فيه الغرب نتيجة احتلال العالم الإسلامي، واتساع دائرة جرائم المركزية الغربية طيلة النصف الأول من القرن العشرين في كل بلدان العالم العربي والإسلامي، وانقسام العالم الإسلامي ما بين معسكرين غربيين (المعسكر الغربي والمعسكر الشرقي) طيلة النصف الأخير من القرن العشرين. ولا نغفل هنا الدور الذي قام به الغرب بزرع الكيان الصهيوني في قلب العالم العربي، وحمايته بكل الطرائق، والاستبداد السياسي في العالم في العديد من دول العالم العربي، فهذه كلها من بين الأسباب التي كانت من وراء اتساع دائرة التطرف التي تستعدي الغرب وترفضه بالكامل. وأنا هنا لا أبرر ظهور هذه الاتجاهات المتطرفة، بل أعطيك بعضاً من الأسباب التي كانت من ورائها. والغريب أن البعض منها اختطف الإسلام وقام بجرائم لا تقل سوءاً عن جرائم المركزية الغربية وعن جرائم الصهيونية.
وحقيقة الأمر، عندما نتحدث عن الغرب، ينبغي ألا نغفل أن هذا الأخير ذات متعددة الأوجه. فهناك الغرب الذي يؤمن بالحرية والتعددية الثقافية، ويعلي من شأن الحوار والتواصل بين مختلف الثقافات، وهناك الغرب المنكفئ على ذاته، والذي ينظر إلى مختلف الثقافات والشعوب بنظرةٍ استعلائيةٍ، فهي في موضع الاتباع وهو في موضع الريادة والقيادة. وهناك الغرب المنتقد لذاته والواعي بضرورة تجديد ذاته من خلال ذاته. ومع الأسف الاتجاه المهيمن والمسيطر، والذي يملك القرار في الغرب هو الاتجاه المتمركز حول ذاته إلى درجة الجنون. ويتجلى هذا الاتجاه في المركزية الغربية، التي بسطت نفوذها على العالم بدءاً من أواخر القرن التاسع عشر. وقد استعملت في سبيل تلك السيطرة مختلف العتاد والأسلحة الحربية، بهدف تكسير أيّ شكل من أشكال الرفض والمقاومة، هذا هو الوجه الذي عرف به العالم الغربي.
ظاهرة الأصولية والتشدد والتطرف في مختلف وسائل الإعلام الغربي، يتم ربطها بالإسلام. وهي صورةٌ يتم تسليط الضوء عليها وتعميمها، كلما سمحت الفرصة طيلة العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين حتى هذه اللحظة. وفي مقابل هذه الصورة، يتم تلميع صورة الغرب، بكونه مجال الحريات والاختلاف والتعددية الدينية والثقافية. وحقيقة الأمر أن «المركزية الغربية» وجهٌ من وجوه الأصولية الغربية، وهي أصولية حبيسة سياقها التاريخي المرتبط بروما. فالرومان كانوا أكثر بربريةً، وورث عنهم الأوروبيون والأمريكيون من بعدهم كل أشكال البربرية والعنف والتسلط على مختلف الشعوب، منذ خروج أوروبا إلى العالم في القرن 15م. نحن «في آخر المطاف نلاحظ اندفاعاً هائجاً لخمسة قرون من البربرية الأوروبية، خمسة قرون من الغزو والاستعباد والاستعمار. [لقد تم] عولمة هذه البربرية الأوروبية»[9].
أكبر خطر يهدد العالم اليوم هو خطر الأصوليات، وهي تشكل خطراً أكبر على مستقبل الإنسانية.[10] كما هو الحال اليوم في غزة التي دمرتها الأصولية اليهودية بمساعدة ورعاية الأصولية الغربية. فما حصل في غزة شبيهٌ بما وقع طيلة القرن العشرين، بقتل المدنيين العزل والأطفال والنساء. وهذا يعني أن غرب القرن العشرين هو نفسه غرب القرن الواحد والعشرين. أمام هذا الوضع، لقرون وعقود من الزمن، اتضح للجميع أن رؤية الغرب متطابقة مع مصالحه على حساب مصالح الغير. فمنذ زمن الاستعمار، تم تهميش التصورات غير الغربية بشكل متزايد، بل تم تدميرها جزئيّاً ومحوها. لقد جعل التغريب العالم أفقر وأكثر رتابةً[11].
الإنسانية اليوم في أمس الحاجة لترى العالم بمعزلٍ عن أي شكلٍ أو لونٍ من ألوان الأصولية. فأصولية الغرب جعلته يتصور نفسه في مقدمة خط السباق، سباق التقدم، وما دونه يتمركز وراءه. السؤال هنا بالنظر إلى مختلف مشكلات وأزمات العالم والحروب التي كان الغرب وراء الكثير منها: هل حلّها يكمن أمام الغرب أم وراءه؟ هل الغرب اليوم مستعدٌ ليلتفت وراءه إلى مختلف ثقافات الشعوب والأمم التي يعتقد أنها وراءه؛ أي الشرق؟ أم إن أصوليته ستحول بينه وبين ذلك؟
أما سؤالك هل كان في رأيك من الضروري إظهار إيجابية الإسلام أو الدين الإسلامي، أو الديني من خلال القول «لا رجعة إلا بالله، ولا خلاص إلا بالإسلام»؟ أقول: لسنا في حاجة لتلميع صورة الإسلام، فالقرآن، كما أشرت سابقاً، نصٌّ من حق الجميع قراءته. فهو خطابٌ للناس جميعاً، والناس أحرارٌ في التعامل معه، ورؤيته الداخلية يتبين من خلالها طبيعة التعامل الصائب أو غير الصائب. أما الإسلام في نسخه التاريخية، فهو قضيةٌ ثقافيةٌ تدرس وتحلل على ضوء مختلف العلوم الإنسانية.
وأنت تسأل: ألا يمكن لغير المسلم أو غير المتدين وللجميع من حيث المبدأ الإسهام في الخلاص المذكور، بغض النظر عن كونه مسلماً أو غير مسلمٍ، متديناً أو غير متديّنٍ؟ وأقول إن العالم اليوم في تحولٍ إلى مجال ثقافي عام شبه موحد، بفعل الثورة الرقمية وعالم الأنترنت والتواصل؛ إذ انهارت فيه مختلف الحدود الجغرافية، والثقافية. فالعالم اليوم يعرف نوعاً من التحول الثقافي من جهة الأكل والمشرب والملبس. فالعولمة الثقافية خلقت اليوم نوعاً كبيراً من التقارب، بين مختلف المجتمعات عبر العالم. فزيارتك مثلا لمختلف العواصم عبر العالم، ستجدها تتشابه في العديد من المميزات، وستجد أمامك الكثير من المنتوجات ذات الماركة العالمية. والحقيقة أن العولمة اليوم قد ساهمت، بشكلٍ كبيرٍ، في خلق نموذجٍ ثقافيٍّ عالميٍّ متقاربٍ. في حقيقة الأمر، العالم اليوم، بشكلٍ عامٍّ، على وعيٍ بالتمييز ما بين المحلي والكوني الذي تشترك فيه مختلف العولمات عبر العالم.
فهذا التطور المذهل يدفع في الاتجاه نحو القول باعتماد نظام «كوزموبوليتانية»؛ أي المواطنة العالمية، وهي الأيديولوجيا التي تقول إن جميع البشر ينتمون إلى مجتمع واحد، على أساس الأخلاق المشتركة، ويسمى الشخص الذي يلتزم بفكرة المواطنة العالمية في أي شكل من أشكالها، كوزموبوليتانيّاً أو مواطناً عالميّاً. وتقترح المواطنة العالمية في الأصل، إنشاء «حكومة عالمية» لجميع الناس عبر العالم. التحدي الكبير هنا أن تتظافر كل الجهود من الشرق والغرب، بغض النظر عن كونك مسلماً أم غير مسلمٍ، متديناً أم غير متدينٍ. فالمهم هو القيمة الأخلاقية الكونية التي تنتصر للإنسان في بعده القيمي والأخلاقي، بمعزل عن تلك الرؤية التي تختزل الإنسان في ما هو بيولوجيٌّ فقط. كل هذا من أجل إنقاذ العالم والإنسان من الهلاك. هناك من هو ضد هذه الرؤية وينعتها بأنها رؤيةٌ تنطلق من الدين، وبأنها ستعود بالتفكير الإنساني إلى الوراء وغير ذلك من الأوصاف الإيديولوجية باسم العلم وباسم التقدم. الزمن كفيل بأن يثبت أنه لا يصح إلا الصحيح. قال تعالى: {فَأَمّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمّا ما يَنْفَعُ النّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الأَمْثالَ} (الرعد/17).
د. حسام الدين درويش:
يتبنى كتابك أطروحة مركزية المسألة الأخلاقية وراهنيتها والحاجة الشديدة إليها، وتقول إن هذه المركزية موجودة في القرآن أصلاً، بل المسألة الأخلاقية فيه هي المسألة الأساسية. ومع ذلك، تشير إلى ثانوية أو هامشية هذه المسألة في الفكر الإسلامي المعاصر وعدم اهتمامه بها، مع إقرارك بوجود استثناءاتٍ تذكر منها: عبد الله دراز، زكي مبارك، يوسف موسى، ماجد فخري، الجابري، طه عبد الرحمن إلى آخره. سؤالي هنا هو: كيف تفهم وتفسر هذه الهامشية؟ لماذا هناك هامشيةٌ في المسألة الأخلاقية في الفكر الإسلامي المعاصر، على الرغم من مركزيتها في القرآن من ناحيةٍ، ومن أنها مسألةٌ ملحةٌ في العالم المعاصر، من ناحيةٍ أخرى؟
د. صابر مولاي أحمد:
هناك من يختزل موضوع الأخلاق في دائرة التركيز على الجانب المرتبط بسلوكيات الأفراد بالحديث عن أخلاق الصدق والصبر والأمانة والاحترام وكل ما اتصل بالآداب العامة، فضلا عما له علاقة بطباع الناس المتعلقة بطريقتهم في التواصل والكلام والأكل والشرب وغير ذلك، مما ينبغي للفرد السوي أن يتصف به، وما ينبغي أن نعلمه للصغار من آداب وأخلاقيات وغيرها؛ وهذه أمور كلها لها أهميتها الخاصة، وهي تتقاطع مع طبائع الناس وثقافاتهم وأعرافهم الاجتماعية.
والحقيقة أن موضوع الأخلاق يمتد إلى طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالكون وبأخيه الإنسان وبالغيب، وهو يرتبط بشكل وثيق برؤيتنا للعالم. فمشكلة الأخلاق عالميةٌ في الزمن الراهن، إن نظرنا إلى مشكلة التلوث البيئي، ومشكلة الحروب الآن العابرة للقارات، ومشكلة أسلحة الدمار الشامل، ومشكلة الأمراض العابرة للقارات مع الكوفيد سابقاً وغيره. فهذه كلّها مشاكل عالميةٌ. وكثيرٌ من الناس اليوم يطرحون سؤال كيف ننقذ العالم؟ ومن ثمَّ كيف ننقذ مصير الإنسان؟ فللأمر علاقة بكينونة الإنسان، فهناك أشياء كثيرة تهدد وجوده. وعندما نتحدث هنا عن الإنسان فله أبعاد في تكوينه (البدن والحواس والنفس والروح). وقد سبق أن بينت هذا الأمر. فتكوين الإنسان وتركيبته الرباعية هذه تجعله نفس الإنسان عبر العصور والأزمنة. فما الثابت والتحول في الإنسان؟ الثابت هو هذه الأبعاد التكوينية، بينما المتحول هو الحضارة والثقافة. مثلا، الإنسان في القرن السابع الميلادي في الجزيرة العربية، أو في شمال إفريقيا، هو الإنسان نفسه اليوم في العالم، المتحول هو الحضارة والثقافة، حضارة اليوم وثقافة اليوم ليست هي حضارة وثقافة الأمس. وعندما نتحدث عن الحضارة، فهناك حضاراتٌ ضاربةٌ في القدم، ما زال العلم والحضارة الحديثة عاجزين عن فهم كيف بنيت تلك الحضارات. فالعلم اليوم لم يعرف بعد؛ بشكل واضح، كيف بنيت الأهرامات في مصر من لدن الإنسان القديم. وهناك حضارات لم نعرف بشكل واضح ما الأسباب التي كانت وراء اندثارها. وما زال الإنسان اليوم، كما هو قديماً، يحب ويكره، صادق ويكذب، يعلم ويجهل، عالم وجاهل، يحقد؛ ينتقم، ويعفو ويصفح، عاقل وأحمق، مغرور ومتواضع...إلخ. على الإنسانية اليوم ألا تعرض عن الجانب اللامتناهي فيها. إنه جانب الروح والأخلاق. قال تعالى: {*يا أَيُّها الإِنْسانُ ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ *الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوّاكَ فَعَدَلَكَ *فِي أَيِّ صُورَةٍ ما شاءَ رَكَّبَكَ} (الانفطار) عندما نستحضر هذه المداخل المعرفي،ة كما هي في القرآن، قد ينزعج البعض، وتقفز إلى ذهنه مختلف التصورات الدينية الطائفية المغلقة باسم الدين، بينما الأمر ليس كذلك. فنحن في حاجةٍ إلى رؤية أسرار العلم عن ماهية الإنسان. ولا نغفل أن الإنسان متجاوز لما هو بيولوجيٌّ فيه. «إننا نمتلك جميعاً ما وراء اختلافاتنا الفردية، والثقافية والاجتماعية هوية ورائية ودماغية، ووجدانية مشتركة»[12].
من هذه الزاوية، ينبغي استثمار القراءة الداخلية، والنظر إلى القرآن الكريم في كيفية تأسيسه لنظرتنا إلى العالم، وكيفية نظرتنا إلى الكائنات، وإلى بعضنا البعض؛ فهناك من يقول إنني منفصلٌ عن الواقع، وأتحدث عن أمورٍ مفارقةٍ ومثاليةٍ. فينبغي ألا نغفل أنه في موضوع القيم والأخلاق مستوى عال من المثالية، وفيه مستوى آخر يرتبط بالتطبيق العملي يكون دائماً نسبيّاً. فعل الإنسان يتحرك بين المثال والواقع، وفي القرآن ترتيب منهجي لهذا الأمر. قال تعالى: {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} (آل عمران) {فَاتَّقُوا اللَّهَ ما اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْراً لأَنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} فالكمال لله وحده، بينما الواقع نسبيٌّ ومعرضٌ للخطأ.
والجواب عن سبب عدم الاهتمام بالشكل الكافي بموضوع فلسفة الأخلاق وبموضوع النظرة القيمية الأخلاقية في الثقافة العربية الإسلامية، لا نقصد أنها منعدمة، فهي موجودةٌ، وفي نظري وتقديري المتواضع، إذا عدنا إلى تراثنا، سنجد أن هناك نقاشاً كبيراً جدّاً حول الإله، وحول صفاته، وأسمائه ما بين الفرق الإسلامية. في المقابل، ليس هناك نقاشٌ كبيرٌ أو علم كلامٍ كبيرٍ كرس جهده لمفهوم الإنسان وطبيعته وما يتميز به وطبيعة سلوكه في العالم، بينما من داخل القرآن الكريم كله نجد دعوةً وتوجيهاً وهدايةً وإرشاداً لكيفية الطبيعة التي ينبغي للإنسان أن يتصور من خلالها الحياة الدنيا، وكيف يمكن له أن يعيش حياته، وكيف ينبغي أن تكون نظرته إلى العالم. المسألة الأخلاقية ملحةٌ في العالم المعاصر، وفي تقديري، مطلب الأخلاق وفلسفة الأخلاق سيكون لها حضورٌ واسعٌ في ما هو قادمٌ بشكلٍ أكبر.
د. حسام الدين درويش:
تقول، في الكتاب، «غير المسلم قد يكون أقرب إلى الأخلاق من المسلم»، لكنك ترى أن المسلم المذكور لا يمثل الإسلام، كما تقول: «القرآن لا يمكن أن يتحيز للمسلم ضد غير المسلم»؛ فما الذي تعنيه بالإسلام، تحديداً، في هذا السياق؟
د. صابر مولاي أحمد:
عندما نتحدث عن الإسلام، نجد أنفسنا أمام سؤالٍ مفاده عن أيّ إسلام نتحدث؟ وقد سبقت أن بينت أن الإسلام واحدٌ، من جهة نصه التأسيسي، ومتعددٌ، من جهة تجاربه التاريخية والثقافية والاجتماعية. وهذه مسألةٌ بديهيةٌ تتعلق بأن الدين واحدٌ والتدين بطبعه متعددٌ. ومن زاويةٍ أخرى، فالله واحدٌ والطرق إليه تتعدد بتعدد أنفاس الخلائق، كما يقول أهل العرفان والتصوف.
هناك إسلامٌ تشكل في التاريخ، ويحضر فيه إرث الدولة الأموية والعباسية. وهناك حديثٌ مفاده أن الإسلام بُني على خمسٍ، وهو يستند إلى حديثٍ الرسول صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» هل هذا صحيح؟ نعم ولا. نعم من جهة الإسلام الذي تشكل في التاريخ، وعندما نقول التاريخ فنحن نلامس الثقافة والاجتماع والسياسة. الإسلام في تصور المذاهب الأربعة عند أهل السنة ومذاهب أخرى عند الشيعة؛ وضعوا له قواعد ومساحة، يتبين معها من هو داخلها ومن خارجها؛ وقد أخرجوا من هذه المساحة من ترك الصلاة، استناداً إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» السؤال هنا هل القرآن بالفعل وضع للإسلام أركان؟ هنا سيكون الجواب بلا؛ لأن الإسلام أكبر من أن توضع له أركان، تحوله إلى دائرة مغلقة على من دخلها، ومغلقة، في الوقت ذاته، على من خارجها. فاحتفال بعض الأئمة والمصلين من ورائهم، خاصة في الغرب، بدخول بعض الأفراد إلى دائرة الإسلام، وهم يقرؤون الشهادتان بين يدي إمام المسجد، هو احتفال بدخولهم إلى دائرة اسلامٍ تاريخيٍّ نحن جزءٌ منه ثقافياً واجتماعياً. أما إسلام القرآن، فهو أمرٌ أكبر بكثيرٍ من دائرتنا التي نحن بداخلها. كيف ذلك؟
لنعد إلى القرآن لنفهم مفردة الإسلام بداخله، فعندما قال الأعراب قال تعالى: {قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الحجرات) القرآن يتحدث لنا هنا عن تجربةٍ اجتماعيةٍ ونفسيةٍ في محيطه التاريخي، عندما اندفع الأعراب وقالوا آمنا، فرد القرآن عليهم أن مشكلة الاجتماع لا ترتبط بالإيمان؛ لأنها مسألةٌ تعود إلى حرية الفرد وإرادته. قال تعالى: {فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ}(الكهف/29). القرآن لم يقل من شاء، فليسلم. مشكلة الاجتماع ترتبط بالإسلام بدرجةٍ أولى، وهي مسألةٌ عامةٌ ومفتوحةٌ في وجه جميع الناس؛ أي إرساء قواعد السلم والسلام، والإعراض عن الحرب والعدوان، وعندما يتم إرساء مجتمع السلام، سيأتي الإيمان على قاعدة الحرية، لا الإكراه. فقد رد القرآن على العرب المندفعين بإعلان إيمانهم، بقوله: {قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ}؛ بمعنى لا إيمان سابق عن للإسلام. فمن هنا نفهم أن اجتهادات المذاهب الأربعة، في حصر الإسلام في أربعة أركانٍ، هو اجتهادٌ يعود على الإيمان، وليس على الإسلام. والحقيقة أن الإسلام على طول التاريخ قد استوعب مختلف الشعوب والثقافات لتنضوي تحته، وفق قاعدةٍ مفادها ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم «المُسلِمُ مَن سَلِمَ المسلمون مِن لسانه ويده». الحديث هنا يقول «سَلِمَ المسلمون». يعني أناس آخرون يرفعون من قيمة السلم في المجتمع، وليس المحاربين والمعتدين على الناس، هذا هو سرٌّ من أسرار جذب الإسلام لمختلف الشعوب. أما حديث «بني الإسلام على خمس» الذي جئنا على ذكره، فهو حديث يقرأ ويدرس ويحفظه ويراعيه الذين انتقلوا من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، فلن نجد جماعة أو دولة على طول التاريخ الإسلامي، اتخذت إجراءً قانونياً مفاده تتبع من يقوم بالأركان الخمسة للإسلام ومن لا يقوم بها، وفي حالة إن وجد ذلك فهو استثناء كما هي داعش ومختلف الجماعات المتشددة. معظم فقهاء الإسلام على وعيٍ وبقناعةٍ مفادها قال تعالى: {لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْها ما اكْتَسَبَتْ} (البقرة/286) مفردة الإسلام تشمل كل من دخل في دائرة السلام والإعلاء من قيمة السلم الاجتماعي والنفسي والروحي بشتى الطرائق والمناهج، بمعزل عن طبيعة الإيمان الذي سيكون عليه؛ إيمان يهودي، إيمان مسيحي، إيمان إسلامي إيمان ديانات أخرى. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالنَّصارَى وَالصّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَعَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} (البقرة). أما عن الاختلاف حول قضايا الإيمان من إيمان إلى آخر، فالحكم فيها موكولٌ إلى الله. صحيحٌ، ومما لاشك فيه، أن القرآن يدفع في اتجاه الحوار بالبرهان ما بين مختلف دوائر الإيمان، على قاعدة السلم والسلام، فلا إكراه في الإيمان، كما بينت سابقاً. فالفصل في المختلف حوله حول الإيمان يرجع إلى الله. قال تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادُوا وَالصّابِئِينَ وَالنَّصارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (الحج).الإيمان في القرآن يقترب بمسلمات قال تعالى: {آمَنَ الرَّسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا سَمِعْنا وَأَطَعْنا غُفْرانَكَ رَبَّنا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (البقرة)؛ بمعنى هناك مسلمون لكن لا يؤمنون بكل الرسل؛ إذ يتوقف إيمانهم برسلٍ دون أخرى.
تدور مفردة «الإسلام» في القرآن، في مدار الرفع من قيمة السلام والأمن والأمان والرحمة؛ فالرسول بعث رحمةً للعالمين، وتلتقي مع مدار مفردة الملة «ملة إبراهيم»، قال تعالى: {مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ} (الحج). فإبراهيم بنى البيت بغاية إقرار قيمة الأمن والأمان بين الناس، قال تعالى: {وَإِذْ جَعَلْنا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَأَمْناً} (البقرة). فمفردة الإسلام تلتقي، مرةً أخرى، مع مدار مفردة الأمن والأمان، وتلتقي مع مفردة العلم. قال تعالى: {فَلَمّا جاءَتْ قِيلَ أَهَكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِها وَكُنّا مُسْلِمِينَ} (النمل). فغاية الإسلام إقامة دار السلام، ففي حضنها يتحقق التعارف، والتقوى، والتعاون والعدل والبر والرحمة، فعندما نقرأ في القرآن: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} (آل عمران/19) ونقرأ:
{وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ} (آل عمران) لا يمكن عزلها عن قوله تعالى: {لا إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لا انْفِصامَ لَها وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} (البقرة). الإسلام يقترن باسمٍ من أسماء الله الحسنى «السلام» قال تعالى: {يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَ السَّلامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} (المائدة) قال تعالى: {وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دارِ السَّلامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ} (يونس). يلتقي مدار مفردة الإسلام مع مفردة الإيمان، قال تعالى: {قالَتِ الأَعْرابُ آمَنّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمّا يَدْخُلِ الإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمالِكُمْ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (الحجرات) الإيمان لا تقوم له قائمة إلا في سياق السلام، لماذا؟ لأن دار السلام -الإسلام- تضم المؤمنين والكافرين (أي التعددية الدينية، فلا إكراه في الدين)، وهي حريصةٌ على إقامة العدل والحد من الظلم والعدوان، قال تعالى: {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ} (المائدة). وفي هذا المدار الواسع لمفردة الإسلام، يتضح أن مدار مفردة القتال يهيمن عليه مدار مفردة السلام؛ لأن القتال في القرآن بهدف الدفاع.
نحن أمام موضوعاتٍ مترابطةٍ، ويتضح بعد التحليل والربط والجمع بين مختلف القضايا والموضوعات من وراء مختلف المفردات المشتبكة المعنى فيما بينها، أن قوله تعالى: {إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الإِسْلامُ} (آل عمران) يأخذ مصداقيته من حرية الاعتقاد والوفاء بالعهود والحرص على حفظ الأمن والأمان والسلم والسلام بين الناس. ومن قرأ كتبي، ولا سيما «منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم»، سيتضح له ما أشرت إليه هنا.
د. حسام الدين درويش:
هناك من مارس، سابقاً، القراءة الداخلية: فضل الرحمن محمد شحرور أبو القاسم حاج حمد، تشوهيكو إيزوتسو؛ فما الجديد في قراءتك الداخلية، مقارنةً بالقراءات الداخلية التي نظَّر لها، وقدمها المذكورون أو غيرهم؟
د. صابر مولاي أحمد:
بصدقٍ ووفق ما أعلم من خلال ما قرأت، لم أجد قديماً أو حديثاً أحد قال بصيغة «القراءة الداخلية للقرآن». وأنا لا أجزم هنا؛ إذ لا يمكن للفرد معرفة كل شيءٍ. وقد خطر لي المصطلح، وفق ما قرأت من كتاباتٍ تعنى بالدراسات القرآنية، وبتفسير القرآن، وبسؤال المنهج في فهم القرآن. ومن يقرأ كتابي «الوحي: دراسة تحليلية للمفردة القرآنية»، سيجد في تقديم هذا الكتاب من لدن المفكر التونسي محمد محجوب، وهو مختص في الفلسفة التأويلية صيغة مفادها «لم أكن أتصور أن الدكتور صابر مولاي أحمد سيمر بهذه السرعة من منطق القراءة الداخلية للقرآن الكريم، وهي القراءة التي كان قد أبدعها في كتابه (منهج التصديق والهيمنة في القرآن الكريم: سورة البقرة أنموذجاً)، إلى منطق القراءة التاريخية والثقافية للوحي»؛ ففي هذا اعتراف بموضوع ومنهج القراءة الداخلية فيما كتبت.
صحيح، مختلف المشاريع التي ذكرتها، فضل الرحمن محمد شحرور أبو القاسم حاج حمد، تشوهيكو إيزوتسو وغيرهم كثير، قد تطرقوا بشكل غير مباشر إلى القراءة الداخلية للقرآن، وهؤلاء مفكرون كبار، وأنا مدين لمشاريعهم الفكرية وقد استفدت منها كثيراً؛ إذ فتحت لي آفاقاً للتفكير والنظر، في تعميق البحث والسؤال والحفر المعرفي. أما عن الجديد لديّ، فإنني حاولت قدر الإمكان أن أستفيد من مختلف هذه المشاريع، وأقول برأيي حول سؤال مفاده كيف نتعامل مع القرآن؟ وأترك الفرصة لعموم القراء أن يقولوا كلمتهم حول ما كتبت.
د. حسام الدين درويش:
دكتور رضوان، أنت مختصٌّ في الدراسات الإسلامية، الكلاسيكية والمعاصرة، وقد اطلعت على الكتاب، وكتبت تقديماً له. فما رأيك به؟
د. رضوان السيد:
نعم، أنا من قدّم للكتاب «القرآن ومطلب القراءة الداخلية» للدكتور صابر، وقد قرأته كله، قرأته مرتين؛ مرة للاستعراض، ومرة لأحدد ما أريد أن أكتبه بشكل موجز. البعد الأخلاقي في القرآن هو بعدٌ واحدٌ، وهو بعدٌ مهمٌّ جدّاً؛ لأنه يتعلق بالتصرف الإنساني. يعني استناداً إلى صفات الله عز وجل، وإلى فهم القرآن للكينونة والوجود، استناداً إلى ذلك، هناك عدة مداخل لفهم القرآن؛ منها الجانب الأخلاقي المهم؛ لأنه يتعلق بشكل أساسي بالعقل العملي والتصرف الإنساني، والتصرف الإنساني يتم عن طريق التأويل. التفسير هو العرض الإلهي لهذه التجربة الكونية والتجربة الإنسانية. والقرآن يذكر التوجهات، التأويل هو الذي يمارسه الإنسان وعلى أساسه يتصرف، التأويل يعني الفهم «Das Verstehen» كما يقول ماكس فيبر ودلتاي وآخرون. ولذلك، قد يكون التأويل صحيحاً، وقد يكون خطأ.
في الحديث عن الأشياء الجيدة التي يقيم عليها هذا الجانب الأخلاقي، يقول الدكتور صابر إن المجتمع الإنساني، أيّ مجتمع، ومجتمع مكة في سورة التوبة، يقوم على العقود وعلى العهود. وهذا الفهم ليس فهم القرآن فقط، بل هو، أيضاً، الفهم القديم للفلاسفة الذين يقولون إن الإنسان لا يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمعاهدة ومعاقدة تجري مع آخرين من بني جنسه، يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن كثير. هذا نص ابن سينا في الإشارات والتنبيهات. فالمجتمع الإنساني، بالمعنى الراقي للإنسانية، هو مجتمع عقود وعهود؛ بمعنى ماذا يعطي الإنسان؟ هو يأخذ ويتصرف على هذا العطاء، وبناء على هذا الفهم التأويلي الذي يتم باستمرار، تفهم كذا ويؤول إليك كذا. ولذلك يتعلق الفهم بجانب التصرف، ويتعلق بالمآلات؛ لأن الإنسان عندما يعمل، قد يعمل مثاليّاً بشكلٍ عامٍّ، ولكنه، في الحقيقة، يعمل حسب ما يفهم مصلحته. وفي مصلحته يراعي الجانب الذي سيقوم به، وإلى ما يؤول إليه العمل؛ يعني النية والمآل. كل هذا تعرضه، حقيقة، سورة التوبة وهي تبدو تجربة؛ طبعاً في ما يتعلق بالسنوات الأخيرة من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تكوين تتمات القرآن الكريم؛ ففهم صابر الأساسي لمسألة التأويل فهمٌ صحيحٌ.
المشكلة، عند المؤلف، أنه أراد أن تكون المحاولة شاملة؛ شاملة للقرآن، وفي نفس الوقت يحكم على أساسٍ منها على الأزمنة الحديثة، ومسألة علاقتنا بالغرب، وهذه مسألة شغلت كل الناس منذ مئةٍ وخمسين سنة، وما تزال تشغلهم بسبب السيطرة الغربية في العالم؛ يعني السيطرة الحالية على نظام العيش ونظام الفكر والنظام العالمي الذي بجوانبه السياسية والاستراتيجية والأخلاقية يحكم العالم. ولذلك، كل الناس، ولسنا وحدنا فقط؛ الصينيون واليابانيون والهنود وجماعة أمريكا اللاتينية، كلهم عندهم هذه الإشكالية يعالجونها بطرائق مختلفة، حسب ما يعتبرون موقعهم من هذه التجربة. ونحن نعتبر موقعنا موقعاً متأزّماً وتابعاً، وتخالطه كثير من التمردات التي لا تنجح، ولكنها تعاد وتستعاد، دونما قدرةٍ على التغيير والتجديد للخروج من مخرج الفشل، وإعادة الفشل وإعادة المحاولة، مثل ما يحدث الآن في حرب غزة.
الذي آخذه على كتابك أستاذ صابر، وهذا لم أذكره في تقديمي للكتاب، هو التناثر. فأنت تعالج الرؤية الأخلاقية للقرآن، وتتخذ نموذجاً لذلك، أو مثالاً على ذلك، العقود والعهود التي يقوم عليها مجتمع أناس متحضرين، فتتابعها في التجربة المكية ومسألة العنف، وهذا أمرٌ مبررٌ وله علاقة وثيقةٌ طبعاً بالأخلاق؛ لأنها عقودٌ وعهودٌ، ولها، من جهةٍ أخرى، مآلات إنسانية تستطيع فيها استخدام القرآن، ولكن بشكل محدود، لكنك لا تستطيع في الحقيقة، أن تناقش، من سورة التوبة بالذات، المشكلة الإنسانية، أو مشكلات علاقة الشرق بالغرب؛ فهذه مسألةٌ أخرى، تستطيع معالجتها وتعتبر القرآن مدخلاً لها، ولكن حتى إنك لم تستطع أن تربط هذه المسألة بالعقود والعهود. عندما لا يجري الوفاء بها هل تكون نتيجتها العنف، كما حصل، مع أنه لم يحصل. يعني فتح مكة، ما كان عنيفاً، وما جرى بعد مكة، فيما عدا وقعة حنين، يتحدثون عن حملات عسكرية، أو عن بعوث أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم أو مضى بنفسه، لكن في الحقيقة، لم تحدث فيها معارك. ثم جاء عام الوفود الذي استقبل كل الجزيرة العربية، وأرسل الرسل قبلها وخلالها إلى الأمراء والملوك، وكلها رسل سلام ورسل تعاقدات وتعهدات. ولم يكن علماء السيرة يعرفون. تروى في الأحاديث النبوية وجلود حمراء، رقوق حمراء، وجد منها حوالي خمسة وأربعين، موجودة في الأحاديث النبوية، لكن لم نكن نفهمها؛ أنه كتب لبني فلان عليه الصلاة والسلام، أو كتب لبني فلان، وكانت هناك طريقة غير طريقة الكتابة للملوك، وكلها عقود وعهود؛ أعهد إليك بكذا، أمنحك كذا. يعني كل أوامر النبي، صلى الله عليه وسلم، كانت، إما أوامر رسالية دعوية، وإما أوامر تنظيمية، وكلها قائمة على مسألة فكرة العقل والتعامل.
أرى أن فكرة الكتاب عظيمةٌ، لكن توزعه للرد على الذين يقولون باستخدام الإسلام أو خواتيمه للعنف، بينما ما معنى اختلفوا في عنوان السورة براءة أو التوبة؛ يعني خاتمة سلام، البراءة هي التطهر؛ لأنهم يحجون ويجتمعون في ما بعد، وتحدث حجة الوداع، والنبي صلى الله عليه وسلم سيغادر هذا العالم. لذلك تحدث البراءة العامة، ماذا يقول العلماء في كتب السير؟ العلماء المسلمون يقولون هل بقوا على البراءة الأصلية؛ يعني براءة حجة الوداع، وبراءة سورة التوبة؟ والتوبة تعني انقضى عهد النزاعات وانقضى عهد الهوان والتفرقة بين الناس. فالذي أردت قوله إن هناك هدفاً عامّاً، وهناك هدفاً خاصّاً، وأنت توزعت بين الهدفين: الهدف الخاص: هو الدفاع عن القرآن، وأنه ليس كتاب عنف، وأن المقاربات التفسيرية تنظر جزئيّاً في الآيات، وليس في السياقات وفي السياق العام. الهدف العام: الأحكام الحضارية والثقافية العامة وعلاقة الشرق بالغرب، فبين الدفاع عن القرآن وأنه ليس كتاب عنفٍ وحربٍ من خلال سورة التوبة التي اشتبه فيها بذلك مع أن اسمها ومضامينها تشهد لغير ذلك أو تقول غير ذلك. وهنا كان عليك أن تفسر ما فعله بعض المفسرين الأوائل، الذين تحدثوا عن مسألة آية السيف وكل هذا الكلام. كانت إمبراطورية عظمى التمسوا تفسيراً لشرعيتها، ولمشروعية الحرب فيها، وظلموا بها القرآن. من المستحيل، طبعاً، أن يقول أناسٌ، في الفترة نفسها، إنهم ضد جهاد الطلب، وهم مع جهاد الدفع فقط، أن ندافع عن أنفسنا، لا أن نغزو الآخرين. والطبري من مفكري الإمبراطورية ليس في تفسيره فقط، بل في تاريخه أيضاً.
أعتبر الكتاب مهمّاً، بل شديد الأهمية؛ لأنه طرح مشكلةً كبرى تتعلق بالقيم الأخلاقية أو الجانب الأخلاقي في القرآن الكريم. والجانب الأخلاقي أول ما يفكر فيه الإنسان العقد والعهد، وهذا واضحٌ في سورة التوبة. الأهداف تتوزع ولا يمكن الإحاطة بها، وهي مسألة هذه المنظومة الأخلاقية في القرآن، وكيف يمكن استخدامها عالميّاً عن طريق التأويل. يعني استنتاجك صحيح، أن التفسير إلهيٌّ، أما التأويل، فهو إنسانيٌّ. والتأويل يعني فهم التجربة الإنسانية العالمية، ومن ثمَّ، كيف يمكن التصرف إزاءها. يمكن الاسترشاد بالقرآن الذي لا يعرض حلولاً تفصيليةً. أنا أعتبر هذا الكتاب مهمّاً، وقد قلت ما الإشكاليات فيه، لا أقول إنها أخطاء، ولكن وزعت الهدف، وبالتالي قلّلت من إمكانية الوصول إلى فهمٍ جديدٍ عن طريق التأويل، سواء لما يرد في القرآن، أو للآراء القديمة والحديثة في مسألة العنف في القرآن، استناداً إلى سورة التوبة. شكراً لكم.
د. حسام الدين درويش:
جزيل الشكر لك دكتور رضوان، وللدكتور صابر، وللدكتورة ميادة، ولكل المتابعات والمتابعين لندوات مؤمنون بلا حدود. وإلى اللقاء في ندواتٍ قريبةٍ قادمةٍ.
[1] - عقدت هذه الندوة عبر الزوم في 23 آب/ أغسطس 2024. وتجدون التسجيل الكامل لها على اليوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=-aQwVO2g4Po&t=1470s كما تجدون النص المنشور على موقع مؤمنون بلا حدود: https://www.mominoun.com/ لقاء-حواري--مع-د-مولاي-أحمد-صابر-في-كتابه--القرآن-ومطلب-القراءة-الداخلية-سورة-9482
[2] - أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني (المتوفى 463 هــــ)، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ج. 1، ط. 5، دار الجيل، 1981، ص 30.
[3] - توفيق فهد، الكهانة العربية قبل الإسلام، ترجمة حسن عودة ورندة بعث، فدمس للنشر، بيروت لبنان، (دون ذكر تاريخ وعدد الطبعة) ص 122-123.
[4] - نفسه، ص 126.
[5] - انظر: محمد، ابن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، مكتبة التراث، القاهرة، 2005، ص. 111 وما بعدها.
[6] - أبو عثمان الجاحظ، البيان والتبيين، - باب البيان-، تحقيق عبد السلام هارون، ج.1، مكتبة الخانجي، ط 7، 1998، ص. 75-76
[7] - نفسه، ص 75-76
[8] - محمد الصفار، رحلة الصفار إلى فرنسا، تحقيق، سوزان ميلار، عرب الدراسة وشارك في التحقيق، خالد بن الصغير، منشورات كلية الآداب جامعة محمد الخامس، 1995م، نقلا عن: محمد الصفار، فقيه في مواجهة الحداثة، خالد بن الصغير، سلسلة، الشخصية المغربية، منشورات، مجلس الجالية المغربية بالخارج، 2016م. ص.21
[9] - إدغار موران، ثقافة أوروبا وبربريتها، ترجمة محمد الهلالي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، ط 1، 2007م، ص 20.
[10] - روجيه غارودي، الأصوليات المعاصرة، ترجمة، خليل أحمد خليل، دار عام ألفين، 2000م، ص. 11.
[11] - شتيفان فايدنر، ما وراء الغرب من أجل تفكير كوني جديد، ترجمة حميد لشهب، مراجعة رضوان السيد، منشورات دار مؤمنون للنشر، بيروت، لبنان، ط 1، 2013م (مقدمة الكتاب).
[12] - نقلاً عن: جابلي، عيسى، الفكر المسيحي الكاثوليكي المعاصر والآخر، دار مؤمنون للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط 1، 2016م، ص 17.






