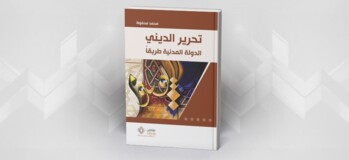في تأسيس الدولة
فئة : مقالات

في تأسيس الدولة
ما دامت المعرفة الفلسفية عند هوبز معرفة استدلالية-عقلية توليدية، فإن الكشف عن ولادة ونشأة سلطة الدولة في فلسفته، يستدعي تتبع سيرورة ولادتها الجنينية-النظرية. ذلك، أن النظر إلى طبيعة الأهواء والدوافع التي تجعل الإنسان في حال حركة مبتغاها الرغبة في البقاء، مع ما يترتب عن ذلك من مظاهر وآثار في حالة الطبيعة؛ بما هي حالة تنعدم فيها الضوابط والقيود المنظمة للعيش المدني الآمن والسالم، يجعلنا في حال اقتناع بأن الذات البشرية تحمل من القدرات والمقومات العقلية ما يجعلها تستنبط مجموعة من المبادئ والقواعد، التي إذا ما تم الاتفاق عليها تصبح بمثابة المقومات التي تستند إليها في تأثيث فضاء للعيش المشترك (أي الدولة). غير أنها مبادئ وقواعد لا ترقى لكي تكون وسيلة للضبط والتنظيم، إلا إذا فوضت إلى «شخص أو مجموعة أشخاص» يكون له أو لهم صلاحية تدبير وتسيير شؤون الناس، بما يتوافق مع ما اتفقوا عليه. بمعنى آخر، فقوانين الطبيعة بوصفها قواعد أو مبادئ العقل، لا يمكن أن تكون وسيلة لتحقيق السلام والأمن في ظل انعدام وجود شخص أو مجموعة أشخاص في قبضته أو في قبضتهم سلطة الحكم والتدبير. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الوقوق عند نشأة الشخص أو مجموعة أشخاص الذي يوكل له أو توكل لهم صلاحية التدبير والتسيير، يقتضي بالضرورة العودة لنظرية التمثيل أو التشخيص في فلسفة هوبز باعتباره من الفلاسفة الأوائل في الفكر الأوروبي الحديث الذي فكروا في فكرة التمثيل السياسي.
ولفهم هذه النظرية التمثيلية أو التشخيصية عند هوبز، نجده يعمل على استحضار أحد المفاهيم الأساسية في تاريخ الفكر الفلسفي؛ أعني مفهوم الشخص (The Person/La personne)، لتبيان دلالته الأصلية، ومن ثم، استنباط ما يمكن أن يسعفه في تحديد كيفية التمثيل أو التشخيص المفضي إلى نشأة سلطة الدولة. فكلمة الشخص تعود إلى الأصل اليوناني (Prosopon) التي كانت تفيد الوجه الخارجي للإنسان، بينما تعود في الاشتقاق اللاتيني إلى كلمة (Persona) التي كانت تدل حسب هوبز: «على التنكر، أو على شكل الإنسان الخارجي المصطنع على المسرح، وأحيانا تدل بصورة أكثر تحديدا على الجزء الذي يخفي الوجه، مثل القناع أو البرقع، ومن المسرح انتقلت هذه التسمية إلى كل من يمثل خطابا أو فعلا، في المحاكم كما في المسارح.»[1]؛ مما يعني، أن الكلمة في أصلها تعود إلى ما كان يرتديه ممثلو المسرح من أقنعة؛ سواء كانت لثاما يخفي الوجه عن الجمهور في تأديتهم لمجموعة من الأدوار والعروض، أم تشخيصا لدور كتمثيل عن شخص آخر، دون لثام أو قناع، الشيء الذي جعل من كلمة شخص تنتقل إلى مؤسسات أخرى، كالمحاكم التي أصبح فيها أشخاصا يمثلون دور شخصا آخرا.
لكن، ما دام تشخيص الأدوار متعدد الجوانب، إذ يمكن أن يكون تمثيل من الذات عن نفسها، مثلما يمكن أن يكون تمثيل من الذات عن الآخرين، فإن ما يترتب عن ذلك، أن الشخص سيكون ذلك الكائن الذي تعتبر كلماته خاصة به؛ أعني أنه يملك كلاما يعبر به عن حاله ووضعه، أو ستكون كلماته لا تعبر عن شخصه، وإنما عن إنسان آخر؛ أعني أنه سيكون ممثلا في كلامه وخطابه لشخص آخر، كما لو كان نائبا عنه. يقول هوبز: «هكذا، فإن الشخص هو تماما كالممثل، سواء على خشبة المسرح أو في المحادثة العادية، والتشخيص هو أداء دور أو تمثيل المرء لنفسه أو لآخر، والذي يؤدي دور الآخر يقال إنه يحمل شخصه أو يعمل باسمه.»[2]. وسواء كانت هذه الكلمات التي يعبر بها شخص الممثل إما عن ذاته، أو عن الآخرين، حقيقية أم خيالية، فإن الذي تمثل الكلمات شأنه الخاص، دون أن يكون له ما ينوب عنه، أو يمثله يسمى حسب هوبز شخصا طبيعيا (Natural Person)، بينما الذي تكون الكلمات تعبيرا ليس عن شأنه الخاص، وإنما تمثيلا لشأن شخصا آخرا، فإنه يسمى شخصا طبيعيا أو مصطنعا (Fancy and artificiel Person)[3]. هكذا، ففي اللحظة التي يعبر فيها الشخص عن ذاته بواسطة الكلمات يكون شخصا طبيعيا، أما حينما يكون التعبير بواسطة الكلمات عن شخص آخر، فإن الممثل هنا يكون شخصا مصطنعا؛ من حيث إنه لا يعبر عن ذاته، وإنما عن الآخر. وهو المعنى الذي نجده عند الفيلسوف «سيسيرون» الذي كان يستعمل مصطلح الشخص بالمعنى الذي يفيد «ما يحمل شخصه أو يعمل باسمه»[4]. وبناء عليه، إن الذي يحمل شخص الآخر أو يعمل باسمه، تكون له أسماء متعددة في الواقع، «مثل مقدم، أو ممثل، أو قائم مقام، أو محام، أو نائب، أو وكيل، أو مؤدِّ، أو ما شابه ذلك.»[5].
وإذا اعتبرنا الشخص يكون مصطنعا في لحظة تأدية دور تمثيلي عن الآخرين بواسطة الكلمات، فإن ذلك يفيد أن الشخص المصطنع أصبح يملك صلاحية (Authority) الفعل، أما الشخص الطبيعي الذي جعل صاحب صلاحية الفعل نائبا عنه، فهو ليس إلا فاعلا (Actor). بمعنى آخر، أنه في حالة وجود شخص مصطنع توكل له مهمة تمثيل الآخرين بواسطة الكلمات، فإنه يصبح لهذا الشخص صلاحية الفعل باسم الذي يمثله، وإذا كان الأمر كذلك، فإن الشخص الطبيعي لا يكون في هذه الحالة إلا فاعلا، وليس صاحب صلاحية الفعل. ذلك، أن الذي يملك صلاحية الفعل هو الشخص المصطنع المفوض له تأدية دور تمثيلي عن الآخرين، بموجب النيابة أو التفويض، يقول هوبز: «ومن الأشخاص الاصطناعية من يملك أعمال وكلمات الذين يمثلونهم. عندئذ يكون الشخص هو الفاعل (Actor)، والذي يملك كلماته أو أفعاله هو صاحب الفعل (Author). وفي هذه الحالة إن صاحب الفعل يؤدي الفعل بموجب صلاحية (Authority).»[6].
لذلك، يقدم لنا هوبز مقارنة مفادها؛ إذا كان في حال الكلام عن الخيرات والأملاك نطلق على صاحبها مالكا أو سيدا كترجمة للكلمة اللاتينية (Dominus) أو الكلمة اليونانية (Kurios)، فإنه في حال الكلام عن الأفعال نطلق على صاحبه، صاحب الأفعال. كما أنه إذا كان الحق في التملك يسمى ملكية، فإن الحق في الفعل يسمى صلاحية (أو سلطة) (Authority). وبناء عليه، إن المعني بصلاحية الفعل هو من يملك الحق في فعل كل شيء، أما ما يتم بموجب صلاحية، يتم بالنيابة أو بالترخيص ممن يملك ذلك الحق، يقول هوبز:
«لذلك، فإن الذي في الكلام عن الخيرات والأملاك-يدعى مالكا- وباللاتينية Dominus، وباليونانية kurios، في الكلام عن الأفعال يدعى صاحب الفعل. وكما أن حق التملك يسمى ملكية، كذلك، فإن الحق في القيام بالعمل يسمى صلاحية. من هنا، فإن المعني بالصلاحية هو دائما من له الحق في القيام بأي فعل، وما يتم بموجب صلاحية هو ما يتم بالإنابة أو بالترخيص ممن يملك الحق.»[7].
يترتب عن هذه المقارنة بين الفاعل؛ أي من يملك الحق الأصلي في فعل كل شيء، وصاحب الفعل؛ أي من يملك حق الفعل بموجب صلاحية أو تفويض، أن عملية التفويض أو التخلي عن صلاحية فعل كل شيء لشخص واحد، تكون له صلاحية فعل أي شيء، يستلزم من صاحب الفعل تصريف ما تم الاتفاق عليه بكيفية ليس في إخلال، كما لو كان صاحب صلاحية الفعل طرفا في العهد أو الميثاق الذي تم التوافق عليه. يقول هوبز: «من هنا ينتج أن الفاعل عندما يقطع عهدا بموجب صلاحية، فإنه يلزم به صاحب الفعل تماما، كما لو كان قد قطعه بنفسه، ويخضعه بالدرجة نفسها لكل عواقب هذا العهد.»[8]. فصاحب صلاحية الفعل بصفته الممثل لدور تشخيصي للحق في فعل كل شيء، يتوجب عليه الالتزام بما اتفق عليه الأفراد، وإن كان ليس طرفا فيه. إن على صاحب صلاحية الفعل، بما هو الشخص الذي يمثل الفاعل أن يلتزم بما تم تفويضه إياه، من حيث إن القيام بعكس ذلك، يجعل الفاعل في وضع غير ملزم لما يتجاوز صلاحيته المفوضة. ذلك، أن الذي «يقطع عهدا مع الفاعل، أو الممثل، دون معرفة الصلاحية التي يملكها، يفعل ذلك على مسؤوليته الخاصة.»[9]. إذ، بما أن عملية التفويض أو التخلي من الفاعل حددت في مسألة الحق في فعل كل شيء لصاحب الفعل لتأدية دور عنه، فإنه «غير ملزم بعهد ليس هو صاحبه، وبالتالي ليس ملزما بعهد قطع بما يتنافى مع الصلاحية التي أعطاها أو خارج نطاق هذه الصلاحية.»[10].
وفي سياق الفصل بين صفة الشخص الفاعل والشخص صاحب الفعل، يضعنا هوبز أمام معضلة يقول فيها الآتي: «وعندما يقوم الفاعل بشيء مناف لقانون الطبيعة، بأمر من صاحب الفعل، إذا كان ملزما بموجب معاهدة سابقة أن يطيعه، لا يكون هو من يخرق قانون الطبيعة، غير أنه ليس فعله هو، بل على النقيض من ذلك، إن رفضه هو أمر مناف لقانون الطبيعة الذي يحرم الإخلال بالعهد.»[11]. مما يعني، أنه إذا كان مصدر الأفعال التي يقوم بها الفاعل هو صاحب الفعل، فإنه ينبغي الالتزام بها، حتى، وإن كانت في بعض الأحيان تبدو منافية لقانون الطبيعة، بحيث إن رفضها بمبرر كونها منافية لقانون الطبيعة، يجعل فعل الرفض في حد ذاته منافيا لقانون الطبيعة الثالث الذي يوصي بالوفاء بالعهود والمواثيق. بيد أنه يجب الانتباه إلى أن هوبز لا يدافع عن كون الممثل سيأمر بأفعال منافية لقانون الطبيعة، بحيث إنه تم التأكيد سلفا بكون صاحب الفعل ملزما بالعهد كما لو كان هو من قطعه بنفسه. يسعى هوبز في هذا الصدد، إلى تعزيز أطروحته حول قيمة الممثل في كونه قد يأمر أحيانا بأفعال قد تبدو منافية لقانون الطبيعة، لكن، بما أن الممثل يملك صلاحية الفعل، أي الحق في فعل كل شيء، فإنه قد يرى فيما يأمر به بكيفية منطقية فائدة ومنفعة تدفع بتحقيق ما تم الاتفاق عليه، وإن بدا ذلك مخالفا لقانون الطبيعة. يقول هوبز: «لا تشك بأن من يملكون السلطان المطلق قد يرتكبون أعمالا غير منطقية، ولكن لن يكون الأمر ظلما أو ضررا بالمعنى الحقيقي.»[12]. لكن، ماذا لو كان العهد بين الفاعل وصاحب الفعل قائما على الوساطة فقط، فهل يكون ملزما كذلك؟
من وجهة نظر هوبز، فالعهد الذي يقوم بين الفاعل وصاحب الفعل على الوساطة دون أن يكون الفاعل على بيِّنة من طبيعة صلاحية الفعل ليس عهدا ملزما. ذلك، أن الفاعل الذي عبر بالكلام عن طريق وسيط تجاه صاحب الفعل، ومن ثم، لم يعبر عن عهده بكيفية مباشرة ومشروعة، لا يمكن أن يعتبر تعبيرا ملزما. لذا، يقول هوبز: «وإن الذي يبرم عهدا مع صاحب الفعل بوساطة الفاعل، دون أن يعلم أية صلاحية يملك-إنما يسلم بكلمته فحسب-إذا لم يتم إثبات هذه الصلاحية له بناء على طلبه، لا يعود ملزما، فإن العهد الذي أبرم مع صاحب الفعل ليس مشروعا(...)»[13]، اللهم إذا كان من يبرم العهد يسعى إلى ضمانة كلمة الفاعل الذي جعله وسيطا بينه وبين صاحب الفعل فقط. ففي هذه الحالة يكون العهد ساريا، من حيث إن الفاعل الوسيط يجعل نفسه في مقام صاحب الفعل، الأمر الذي يعبر عنه هوبز بالقول: «لكن، إذا كان الذي يبرم العهد يعرف مسبقا أنه ينبغي ألا يتوقع ضمانة سوى كلمة الفاعل، عندئذ يكون العهد ساريا، لأن الفاعل في هذه الحالة يجعل من نفسه صاحب الفعل.»[14].
بالمحصلة، إن العهد المبرم بين الفاعل وصاحب الفعل عبر وساطة فاعل ما، لا يلزم إلا الفاعل الوسيط، من حيث إنه قد اتخذ من وساطته مقام صاحب الفعل، لاسيما، إذا كان العهد مزيفا. مثلما أن العهد المبرم بين الفاعل وصاحب الفعل بكيفية واضحة، دون وساطة تذكر، يكون ملزما لصاحب الفعل باعتباره الممثل الشرعي الذي يملك صلاحية قائمة على مبدأ التخلي أو التفويض. يقول هوبز تعبيرا عن هذا التفاوت المبدئي في مسألة التمثيل بين الفاعل حينما يصبح في مقام صاحب الفعل في وساطته لفاعل ما، وصاحب الفعل الذي تم دون وساطة، ما يلي: «لذلك، كما أن العهد حين يلزم صاحب الفعل، لا الفاعل، حين تكون الصلاحية واضحة، كذلك، عندما تكون الصلاحية زائفة، فإنه لا يلزم سوى الفاعل، بما أنه لا وجود لصاحب الفعل سواه.»[15].
وإذا كان الشخص المصطنع هو الشخص الذي يؤدي دورا تمثيليا-تشخيصيا عن الأشخاص الطبيعيين، فإن السؤال المطروح؛ ما الأشياء التي لا يمكن تمثيلها، أو ليس في الإمكان تمثيلها حسب هوبز؟
من بين الأشياء التي ليس في الإمكان تخيل تمثيل لها، نجد الأشياء الجامدة؛ مثل بعض المؤسسات، كالكنيسة، والمستشفى، والجسر. فصحيح أنه يمكن تشخيصها من طرف بعض الناس بمثابة راع أو مشرف أو مدير عليها، لكن، لا يمكن للجماد أن يكون صاحب أفعال، حتى نجد له سبيلا لكي يفوض صلاحيته لممثل، يقول هوبز: «وهناك بعض الأشياء التي لا يمكن تخيل تمثيل لها. فالجماد، مثل الكنيسة أو مستشفى أو جسر، يمكن تشخيصها من خلال راع أو مدير أو مشرف، لكن الجماد لا يمكن أن يكون صاحب فعل، وبالتالي لا يمكن أن يعطي صلاحية لممثليه.»[16]. كذلك، من الأشياء التي لا يمكن أن تفوض صلاحية الفعل إلى ممثل، نجد الأطفال والمجانين، حيث إن هؤلاء لا يملكون العقل الذي بواسطته يمكن تفويض صلاحية فعلهم إلى ممثل، لذلك، إن الذي يتكلف بهم ليس سوى أولياء أمورهم أو الوصي عليهم، غير أنه في هذه الحالة لا يمكن اعتبارهم ذوي أفعال يقوم بها ممثلوهم، اللهم بمقدار ما يحكمون على أنها أفعالا معقولة؛ أي بعد نضجهم العقلي.[17]حتى، وإن كان في حالة العته يمكن للذي يمتلك الحق في الوصاية عليه أن يعطي الصلاحية للوصي، على الرغم من أن ذلك -حسب هوبز- لا يمكن القيام به إلا بعد نشوء الدولة، حيث إنه قبل وجودها، لا يمكن أن تمتد الصلاحية للأشخاص، من حيث إنه لا وجود لتفويض أو تخلي بعد.
من بين الأشياء كذلك، التي لا يمكن أن تكون صاحبة صلاحية، حتى تمثل من قبل شخص ما، نجد الوثن (In idol) أو الآلهة الخاطئة (The False Gods). فبما أن الوثن هو لا شيء (The idol Is Nothing)، فإنه لا يمكن أن يكون له صلاحية الفعل، حتى يكون في وضع تمثيل. لذا، كان مصدر تمثيلها غير نابع من الوثن أو الآلهة الوثنية نفسها، بل من الدول التي كانت متواجدة فيها، يقول هوبز ما يلي: «لكن الوثن لا يمكن أن يكون صاحب فعل، لأن الوثن هو لا شيء. إن الصلاحية كانت تستمد من الدولة، وبالتالي، فإنه قبل إدخال الحكومة المدنية لم يكن من الممكن تشخيص آلهة الوثنيين.»[18]. أما الإله الحقيقي (The True God) حسب هوبز، فإنه يمكن تمثيله؛ لأنه صاحب صلاحية فوضت إلى «موسى» بغية حكم الإسرائيليين الذين لم يكونوا شعبه، بل شعب الله المختار. وهم كذلك، باسم الإله؛ أي بسيادته (hoc dicit dominus)، وليس باسم موسى (hoc dicit moses). كما مُثل من قبل عيسى الذي تحمل عناء رد اليهود وباقي الأمم إلى مملكة أبيه حسب الديانة المسيحية، ليس بصفته الشخصية، وإنما بوصفه مبعوثا من الرب.
يتبين إذن، أن سرد هذه الأشياء التي لا تملك صلاحية التفويض أو التخلي عن حقها لشخص معين بغية تمثيلها، هو للتأكيد أن الذي يمكن أن يكون محل تفويض أو تخل، هو من يملك القدرة على ذلك. لهذا، إذا كنا قد وضحنا إلى حدود الآن الفرق بين الشخص الطبيعي؛ أي الفاعل، والشخص المصطنع؛ أي صاحب صلاحية الفعل، فإن السؤال الذي يطرح؛ كيف ينشأ الشخص المصطنع؟ بمعنى آخر، ما المبدأ العقلي الذي نحتكم إليه في توليد الشخص المصطنع نظريا؟
ينطلق هوبز في الإجابة عن هذا التساؤل من مبدإ أساس من مبادئ العقل الإنساني الذي تولد منذ اللحظة التأسيسية للحكمة في القرن السادس قبل الميلادي مع «طاليس»، أعني بذلك مبدأ إرجاع الكثرة إلى عنصر واحد. فكما هو معلوم أن «طاليس» رد في تفسيره لسبب الأشياء؛ بما هي كثرة في الطبيعة إلى عنصر واحد هو الماء، مما يلزم عن ذلك، أن الكل أصبح واحدا (مبدأ الكل واحد)[19]. فكذلك، اتخذ هوبز من مبدأ إرجاع الكل إلى عنصر واحد، منطلقا في بيان شروط صناعة وتوليد الشخص المصطنع. حيث يعتبر بكون رد الكثرة العددية إلى واحد، تقوم على شرطين أساسيين هما؛ أولهما؛ من شروط رد الكثرة العددية إلى عنصر واحد، أنه لا يصبح الأشخاص الطبيعيون شخصا واحدا مصطنعا، إلا عندما يوجد شخص واحد يمثلهم. يقول هوبز: «إن كثرة من البشر تصبح شخصا واحدا عندما يمثلها إنسان واحد أو شخص واحد.»[20]. ثانيهما؛ من شروط رد الكثرة العددية إلى عنصر واحد، أنه لا يمكن أن يصبح الأشخاص الطبيعيون شخصا واحدا مصطنعا، اللهم إذا كانت هناك موافقة مبدئية من كل شخص طبيعي بمفرده، من حيث إنه الوحيد الذي يملك صلاحية التفويض لصاحب الفعل؛ أي الشخص المصطنع الذي يمثله.
تأسيسا على ما سبق، يتبين أن توليد شخص مصطنع؛ أي إرجاع الكثرة العددية المؤلفة من الأشخاص الطبيعيين إلى شخص واحد يمثلهم، يقوم بالضرورة على وجود موافقة إرادية منهم، ليس فيها إرغام أو جبر، ما دام كل شخص طبيعي يملك سلطة عن ذاته، يجعلها مبدأ الموافقة والتفويض لتمثيله. وبهذا المعنى، فنظرية التمثيل عند هوبز، ليست نظرية استبدادية لكونها تدفع الأفراد للخضوع مثلما يدعي الأنثربولوجي الفرنسي لويس دومون[21]، بقدر ما أنها نظرية تمثيلية تقوم على حرية الاختيار، من حيث إنها تجعل الأفراد مصدر سلطة صاحب السيادة كما يؤكد الفيلسوف الفرنسي فيليب گرينون[22].
بيد أن القول بكون الكثرة المؤلفة من مجموعة من الأشخاص الطبيعيين، لا تصبح شخصا مصطنعا، إلا بوجود موافقة من كل شخص بمفرده، هو دليل على أن الكثرة هي بالطبيعة متعددة، بما يفيد أن الأفراد لا يولدون بالطبيعة جماعة سياسية أو مدنية، بقدر ما أنهم يخلقون بإرادتهم من هذا التعدد ما يجمعهم في إطارها. لذا، يقول هوبز في عملية تحويل الكثرة إلى وحدة ما يلي: «ولأن الكثرة بطبيعتها ليست واحدة بل هي متعددة، فإنها لا يمكن أن تفهم كصاحبة فعل واحد، بل هي كأصحاب متعددين لكل ما يقوله أو يفعله ممثلهم باسمه؛ وكل إنسان يعطي الممثل المشترك سلطة عن نفسه بالذات، ويملك كل الأفعال التي يقوم بها الممثل، في حال أعطي سلطة غير محدودة، وفي الحالات الأخرى، حين يضعون له حدودا فيما يتعلق بكيفية ومدى تمثيله لهم، لا أحد يملك أكثر مما فوضه إلى فعله.»[23].
إن الملاحظ في هذه السيرورة التوليدية لنشأة الشخص المصطنع، أننا صرنا مع هوبز أمام طريق تركيبي؛ أي أنه بعد الكشف عن طبيعة الأفراد ودوافعهم في الوجود كعناصر متفردة، بدأ تشكيل هذه العناصر في إطار وحدة لخلق الشخص الممثل عن ذواتهم. وإذا كانت عملية تحويل الكثرة إلى وحدة طريقا لخلق الشخص المصطنع، فإن ذلك يطرح بعض المشكلات المرتبطة بمسألة الصراع بين الأكثرية والأغلبية في الكثرة العددية. ذلك، أن هناك من سيكون له رأي بخلق شخص مصطنع، وهناك من لا يكون مقتنعا بذلك. مما يترتب عنه، نوع من الاختلاف في الدوافع والمبتغيات التي قد تصل حد الصراع أحيانا في التجمعات البشرية. خصوصا، وأن الأصوات السلبية في كثرتها وتعددها قد تكون مدمرة لرأي الأقلية التي قد تملك رؤى سديدة وسليمة. لكن، على الرغم من ذلك، تبقى الأصوات السلبية، من حيث إنها كثرة عددية صوت الممثل الوحيد، وليس صوت الأقلية، يقول هوبز: «وإذا كان الممثل يتألف من عدة أشخاص، فإن صوت الأكثرية العددية يجب اعتباره صوت الجميع. فإذا نطق العدد القليل، على سبيل المثال إيجابا، والعدد الأكثر سلبا، فسوف تكون هناك أصوات سلبية كافية لتدمير الأصوات الإيجابية. وبالتالي، فإن التفوق العددي للأصوات السلبية دون تناقض، هو صوت الممثل الوحيد.»[24].
أما إذا كانت الأصوات متساوية بين الأفراد، فإنه في هذه الحالة يكون الممثل عاجزا عن الفعل، إذ الذين يمثلهم متساوون في ما يبتغون تمثيلهم إياه. لذلك، يشبه هوبز مسألة التساوي في أصوات التمثيل بمسألة الإدانة والتبرئة في النوازل التي تعترض الفاعل. فمسألة الإدانة والتبرئة ترتبط بمدى وجود أدلة وحجج غير متكافئة، أما غيابها يؤدي مباشرة إلى التبرئة التي لا تدين الفاعل. غير أنه يجب التأكيد أن التبرئة القائمة على وجود أدلة متكافئة، لا يعني أن الفاعل غير مدان، بل هو مُبرأ بكيفية مؤجلة فقط، لكون الدليل غير موجود لحظتها، مثلما أن عدم التبرئة لا يعني أن الفاعل مدانا، بل قد يكون بريئا، اللهم إذا كان الدليل على ذلك مؤجل كذلك. وعليه، إن وجود نوع من التساوي في الأصوات المشكلة للشخص المصطنع، لا يعني أنه ممثل مشروع، كما لا يعني في المقابل، أنه ممثل غير مشروع، بقدر ما أن فعله بصفته صاحب صلاحية مفوضة، يصبح مؤجلا فقط، ريثما يتحقق نوع من التفاوت في الأصوات، يقول هوبز: «والأمر نفسه يحدث في التروي أثناء تنفيذ فعل الآن أو تأجيله إلى وقت لاحق؛ فعندما تكون الأصوات متعادلة، فعدم إقرار التنفيذ هو إقرار للتأجيل.»[25].
لكن، هناك بعض الفئات التي تسعى لكي تكون صاحبة فعل، الشيء الذي يجعلها تقوم بمجموعة من الأصوات لجعل الممثل الحقيقي عاجزا عن تمثيل الأكثرية، من حيث إن الطرف الذي يعارض يملك صلاحية الفعل، مثلما حدث في إنجلترا بين الكنيسة والدولة. فمن حيث كانت الكنيسة طرفا داخل الدولة، كانت لها سلطة في إبطال القرارات التي تصدر عن الملك، الشيء الذي جعل المجتمع الإنجليزي في حالة حرب. يقول هوبز ما يلي:
«أما إذ كان العدد مفردا، كما في حالة ثلاث أشخاص أو جمعيات، أو أكثر، حيث يكون لكل واحد، بفعل الصوت السلبي، السلطة لإبطال نتيجة كل أصوات الآخرين الإيجابية، لا يكون لهذا العدد صفة تمثيلية؛ فهو نتيجة تنوع آراء الأفراد ومصالحهم، يصبح في غالب الأوقات، وفي حالات أخرى، ذات عواقب كبرى، شخصا صامتا وعاجزا عن حكم الكثرة، سيما، في زمن من الحرب، كما هو عاجز عن أشياء كثيرة.»[26].
وبناء على ما سبق، إن الحديث عن الفروقات بين الشخص الطبيعي والشخص المصطنع، مع تبيان كيفية عملية التمثيل التي تنتج عن رد الكثرة إلى عنصر واحد، كان الهدف منه عند هوبز صناعة توليدية لشخص مصطنع يوكل له عملية تسيير وتدبير شؤون الأشخاص الطبيعيين. لكن السؤال، ما الذي يعنيه هوبز بالشخص المصطنع؟ أو بمعنى آخر، ما طبيعة الشخص المصطنع؟
بما أننا قد أشرنا سلفا إلى كون التحولات الفكرية والمعرفية في العصر الأوروبي الحديث، قد أدت إلى ظهور الذات المفكرة التي أصبحت بمثابة منطلق تفسير وإضفاء المعنى على العالم؛ بمعنى أنها ذات أصبحت فاعلة في العالم، مستنطقة له، من حيث إن غايتها لم تعد البحث عن أسباب الظواهر ومظاهرها فقط، بل الكشف عن سيرورة تشكلها وتوليدها، مما يعني أننا أصبحنا أمام صنعة مفهومية للعالم، فإن الذات نفسها ستصبح مبدأ إضفاء المعنى والمعقولية على الدولة والمجتمع[27]، غير أنها معقولية ليست مجردة من الواقع، وإنما هي لصيقة به، من حيث كونها مبدأ تفسيره المادي-الميكانيكي[28]. إن تحديد هوبز لطبيعة الدولة لا يخرج عن هذه النقلة المفهومية التي مست منظومة الفكر الفلسفي ابتداء من القرن السابع عشر الميلادي. والدليل على ذلك، تلك الإشارة البينة التي يقدمها هوبز في مقدمة كتابه «اللفياثان»، حيث يعتبر أن الإنسان سيبث قوانينه في المجتمع والدولة؛ أي سيصنع لنفسه قواما اجتماعيا وسياسيا، كما بث الإله قوانينه في العالم.
ما دامت الطبيعة في تصور هوبز السياسي، لم تهب الإنسان غير قوانين الطبيعة التي لم تحدد له الكيفية التي يمكن أن يكون عليها اجتماعيا وسياسيا، فإن ذلك يستدعي منه صناعة فضاء سياسي واجتماعي يحتوي متطلباته وغاياته في الوجود[29]. وبناء عليه، سيكون عمل الإنسان بمثابة تشبه بالفن الذي خلق به الإله الطبيعة. فإذا كان الإله قد خلق الطبيعة بكلمته «ليكن»، فالإنسان سيخلق لنفسه فضاء سياسيا واجتماعيا بكلمته القائمة على التوافق والتعاقد بين الأفراد. يقول هوبز: «وأخيرا، فإن المواثيق والمعاهدات التي بواسطتها صنعت أجزاء هذا الجسم السياسي في البداية، وجمعت ووحدت تماثل عبارة «ليكن» (Fiat)، أو «فلنصنع الإنسان» التي لفظها الإله في سفر التكوين»[30]. فالعقد والاتفاق هو الجسر الذي نعبر به من حالة الطبيعة إلى حالة المجتمع المدني، وهو تصور نجد له تأكيدا حتى من الفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو في كتابه «في التعاقد الاجتماعي» الذي يشير إلى أن الاتفاق أو العقد هو الوسيلة التي نمنح بها الجسم السياسي الوجود والحياة[31].
وما دمنا قد بينا مع هوبز أن موضوع الفلسفة عامة هو ما نطلق عليه لفظة جسم؛ أي كل ما له وجود حقيقي وفعلي، وقابل للفهم بالعقل والإدراك بالحواس، فإن ما سيبدعه الإنسان لن يكون سوى جسما كذلك. غير أن هذا الجسم لن يكون طبيعيا كما الأجسام التي خلقها الإله، بقدر ما أنها أجسام مصطنعة فقط، من حيث إن كل ما يَنتج عن إبداع الإنسان وفاعليته في الطبيعة لا يمكن أن يكون إلا مصطنعا. وبما أننا نتحدث عن طبيعة الدولة، فهي لن تكون جسما طبيعيا، بل جسما مصطنعا فقط، بما يفيد أنها جسم أو «حيوان اصطناعي»[32]من صنع وإبداع الإنسان الذي هو مصدر إضفاء المعنى والمعقولية على المجال السياسي والاجتماعي[33]. غير أنه صنع فيه نوعا من التقليد أو المحاكاة البشرية لفن الطبيعة الذي أوجد به الإله العالم، يقول هوبز: «إن الطبيعة (أي الفن الذي صنع به الإله العالم ويحكمه) يقلدها الإنسان، كما يقلد أشياء كثيرة أخرى، إلى حد إمكانية صنع حيوان اصطناعي.»[34]. وإذا كانت الدولة جسما مصطنعا أو حيوانا اصطناعيا، فإن ذلك يفيد أن استحضار هوبز لمفهوم الشخص في بيان نشأة وولادة صلاحية أو سلطة الدولة، مرتبطا بكون الدولة ما هي إلا شخصا[35]مصطنعا يحمل شخص الأفراد الطبيعيين[36]، بحيث «يعتمد كل منهم الأفعال المنفذة أو المسببة من الشخص الذي يحمل شخصهم، والمتعلقة بأمور السلام المشترك والأمن، ومن ثم، يقوم جميعهم، كما يقوم كل واحد منهم بإخضاع إرادتهم لإرادته، وأحكامهم إلى أحكامه.»[37].
لذلك، كان الحديث عن إرجاع الكثرة إلى عنصر واحد، مرتبطا بشرط وجود شخص مصطنع يمثل الأفراد الطبيعيين، لكن، شريطة التفويض الإرادي من الفاعل لصاحب الفعل. وبما أننا قد أشرنا في الفصل الأول من هذا الباب إلى أن نشوء سلطة الدولة لا تتم إلا بالاتفاق عبر الكلمات بين الأفراد، فإن الموافقة أو الاتفاق الإرادي يشكل أهمية كبرى في صناعة الجسم السياسي، أي الدولة. يقول هوبز: «ويشكل ذلك أكثر من الموافقة أو الوفاق، إنه نوع من وحدة الجميع الفعلية في شخص واحد، قائمة بموجب اتفاقية كل فرد مع كل فرد، كما لو كان كل فرد يقول للآخرين؛ إنني أخول هذا الرجل أو هذه المجموعة من الرجال، وأتخلى له أو لها عن حقي في أن يحكمني أو تحكمني، شرط أن تتخلى له أو لها أنت عن حقك وتجيز أفعاله أو أفعالها بالطريقة عينها.»[38]. مما يتضح، أن عملية التفويض أو التخلي من الأشخاص الطبيعيين عن الحق في فعل كل شيء، للشخص المصطنع بغية تمثيلهم[39]، يتم بواسطة الكلام الواضح بين الجميع دون استثناء. وبناء عليه، «إن المجموعة المجتمعة على هذا النحو في شخص واحد، تدعى دولة، باللغة اللاتينية (Civitas)»[40].
لكن، بما أنه في البدايات الأولى للفكر السياسي الحديث، كان هناك تأكيد لمكانة وقوة الدولة الوطنية الموحدة، نظرا للمشكلات السياسية التي أدت في العصور الوسطى إلى انعدام الاستقرار السياسي في البلدان والدول المسيحية (كالتهديدات الإقطاعية، والاضطرابات المدنية، والحروب مع القوى الأجنبية)[41]، فإن هوبز يشبه الدولة؛ بما هي شخص مصطنع مؤلف من الإرادات الفردية التي خولت له الحق في الفعل باسمهم[42]، بذلك «التنين» (The Leviathan) المذكور في التوراة على أنه حوت ضخم، كدليل على القوة في السيطرة والدفاع المستميت عن اتفاقات ومعاهدات الأفراد. بل إنه لا يكتفي بهذا الوصف، وإنما يذهب إلى أبعد من ذلك، حيث يعتبر أن الشخص المصطنع؛ أي الدولة، هو إله فان[43]، يقول في هذا الصدد ما يلي: «هذا هو منشأ هذا اللفياثان الكبير أو بالأحرى، (ومن باب الحديث بمزيد من الوقار) هذا الإله الفاني، الذي ندين له بالسلام والدفاع، وهو أدنى رتبة من الإله، غير الفاني.»[44]. وبناء عليه، يشير الفيلسوف الألماني كارل شميت (1888م-1985م) إلى أن الفكر العقلاني القانوني أو السياسي في القرنين السابع عشر والثامن عشر الميلاديين، ليس إلا محاكاة لأحكام الإله المطلق غير الفاني، من حيث إنه فكر نقل السيادة من الإله المطلق إلى الحاكم أي الإله الفاني[45].
يترتب عن ذلك، أن جوهر الدولة يتمثل في كونها إلها فانيا؛ أي شخصا مصطنعا يمكن أن يفنى في أية لحظة، نتيجة مجموعة من الأسباب المرتبطة بالإخلال بالعهود والمواثيق التي كانت أصل نشأته. بيد أن ما يهم في هذا السياق، أن الدولة «(...) هي (من باب التعريف) شخص واحد، ذات الأعمال المنسوبة إلى فاعل، نتيجة الاتفاقيات المتبادلة المعقودة بين كل عضو في المجموعة الكبرى، بغية تمكين هذا الشخص من ممارسة القوة والوسائل الممنوحة من الجميع، التي يعتبرها متلائمة مع سلمهم ودفاعهم المشترك.»[46].
المصادر والمراجع
- هوبز، توماس. اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة. ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب؛ مراجعة وتقديم رضوان السيد. ط. 1. (أبوظبي: معهد أبو ظبي للثقافة والثرات، 2011).
- نيتشه، فريديريك. الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي. تعريب سهيل القش. ط.2. (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1983).
- شميت، كارل. اللاهوت السياسي. ترجمة رانية الساحلي وياسر الصاروط. ط.1. (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018).
- سكينر، كوينتن. أسس الفكر السياسي الحديث، عصر الإصلاح الديني. ج.2. ترجمة حيدر حاج إسماعيل. ط.1. (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2012).
- بيرنز، لورانس. توماس هوبز. ضمن كتاب تاريخ الفلسفة السياسية من ثيوكيديديس حتى اسبينوزا. إشراف ليو شتراوس وجوزيف كروبسي. ترجمة محمود سيد أحمد؛ مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، ط.1. (القاهرة: المشروع القومي للترجمة، 2005).
- دومون، لويس. مقالات في الفردانية، منظور أنثروبولوجي للأيديولوجية الحديثة. ترجمة بدر الدين عركودي. ط.1. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006).
- Dufour, Alfred. Droits de l’homme droit naturel et histoire, droit, individu et pouvoir de l’École du droit naturel à l’École du droit historique. 1eéd. (Paris: presses universitaires de France, 1991).
- Baldin, Gregorio. "A "Galilean Philosopher"? Thomas Hobbes between Aristotelianism and Galilean Science". Philosophies 7. (2022), N°5.
- Warrender, Haward. The political philosophy of Hobbes; history of obligation. 1sted. (oxford: scholary classics, 2000).
- Rousseau, Jean Jacques. Du Contrat social; les classiques des sciences sociales. 1eéd. (Saguenay: les classiques des sciences sociales (bibliothèque numérique), 2002).
- Malherbe, Michel. Thomas Hobbes Ou L’œuvre de la raison. 1eéd. (Paris: Libraire Philosophie J. Vrin, 1984).
- Nay, Olivier. Histoire des idées politique. la pensé politique occidentale de l’Antiquité à nos Jours. 2eéd. (Malakoff: Armand Colin, 2016).
- Crignon, Philippe. "La Pluralité Humaine chez Hobbes et sa lecture par Strauss et Kojéve", Kless-revue philosophique. (2009), N°12.
- Hobbes, Thomas. Du Citoyen. Trad. Philippe Crignon. 1eéd. (Paris: GF Flammarion, 2010).
[1] توماس هوبز. اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة. ترجمة ديانا حرب وبشرى صعب؛ مراجعة وتقديم رضوان السيد. ط. 1. (أبو ظبي: معهد أبو ظبي للثقافة والتراث، 2011)، ص. 167
[2] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 167
[3] المصدر عينه.
[4] المصدر عينه.
[5] المصدر عينه.
[6] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 167.
[7] المصدر عينه.
[8] المصدر عينه، ص. 168
[9] المصدر عينه، ص. 169
[10] المصدر عينه.
[11] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 169
[12] المصدر عينه، ، ص. 186
[13] المصدر عينه، ص. 169.
[14] المصدر عينه.
[15] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 169.
[16] المصدر عينه.
[17] Haward Warrender. The political philosophy of Hobbes; history of obligation. 1sted. (Oxford: scholary classics, 2000), p.15.
[18] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 170.
[19] فريديريك نيتشه. الفلسفة في العصر المأساوي الإغريقي. تعريب سهيل القش. ط.2. (بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1983)، ص. 46.
[20] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 170
[21] لويس دومون. مقالات في الفردانية، منظور أنثروبولوجي للأيديولوجية الحديثة. ترجمة بدر الدين عركودي. ط.1. (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2006)، ص.131.
[22] Philippe Crignon. "La Pluralité Humaine chez Hobbes et sa lecture par Strauss et Kojéve", Kless-revue philosophique. (2009), N°12, p.83.
[23] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 171
[24] المصدر عينه.
[25] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 172
[26] المصدر عينه، ص. 171
[27] لذلك، يعتبر «ألفريد دوفور» أن هوبز كان رافضا للقول بأن الإنسان حيوانا سياسيا بطبعه. أنظر:
- Alfred Dufour. Droits de l’homme droit naturel et histoire, droit, individu et pouvoir de l’École du droit naturel à l’École du droit historique. 1eéd. (Paris: presses universitaires de France, 1991), p.76.
[28] Alfred Dufour. Droits de l’homme droit naturel et histoire, droit, individu et pouvoir de l’École du droit naturel à l’École du droit historique. Op., cit, p.74
[29] Michel Malherbe. Thomas Hobbes Ou L’œuvre de la raison. 1eéd. (Paris: Libraire Philosophie J. Vrin, 1984), p.169
[30] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 18
[31] Jean Jacques Rousseau. Du Contrat social; les classiques des sciences sociales. 1eéd. (Saguenay: les classiques des sciences sociales (bibliothèque numérique), 2002), p.46
[32] إن العنصر الأساس الذي يجمع بين الفيزياء والسياسية في فلسفة هوبز حسب «غريغوريو بالدين» هو الجسم. فنظرة هوبز للجسم جعلته يطبقها على الجسم الطبيعي والمدني. أنظر:
-Gregorio Baldin. "A "Galilean Philosopher"? Thomas Hobbes between Aristotelianism and Galilean Science". Philosophies 7. (2022), N°5, p. 116
[33] يطلق هوبز الاجتماع المدني الذي يتم بواسطة الاتفاق والتعاقد بين الأفراد على مفهوم الدولة، والمجتمع المدني، وكذلك، على الشخص المدني. أنظر:
- Thomas Hobbes. Du Citoyen. Trad. Philippe Crignon. 1eéd. (Paris: GF Flammarion, 2010), p.162.
[34] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 18
[35] لذلك، يشير لورانس بيرنز إلى أن هوبز هو أول فيلسوف عرف الدولة بكونها شخصا. أنظر:
-لورانس بيرنز. توماس هوبز. ضمن كتاب تاريخ الفلسفة السياسية من ثيوكيديديس حتى اسبينوزا. إشراف ليو شتراوس وجوزيف كروبسي. ترجمة محمود سيد أحمد؛ مراجعة وتقديم إمام عبد الفتاح إمام، ط.1. (القاهرة: المشروع القومي للترجمة، 2005). ص.585.
[36] لابد من الإشارة إلى أن المقصود بالدولة كونها شخصا مصطنعا، هو أنها جهازا معنويا ينفرد بتدبير شؤون الأفراد بكيفية قانونية. كما أن وصفها بالشخص المتخيل أو المصطنع، فهو ليس إلا من باب تمييزها عن الأشخاص الطبيعيين، من حيث إنهم مصدر صنعها. كما أن حديثنا عن الدولة كونها شخصا مصطنعا، لا يعني أنها ليست ذات طبيعة واقعية، بل إن قصدنا هو شكلها من حيث التأسيس، أم عملها فيتجسد عبر المؤسسات.
[37] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص ص.179-180
[38] المصدر عينه، ص. 180
[39] Alfred Dufour, Droits de l’homme droit naturel et histoire. op. cit., p.80
[40] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 180.
[41] Olivier Nay. Histoire des idées politique. la pensé politique occidentale de l’Antiquité à nos Jours. 2eéd. (Malakoff: Armand Colin, 2016), p.169
[42] Thomas Hobbes, Du Citoyen. op. cit., p.163
[43] يشير الباحث «كوينتن سكينر» إلى أن الذي وضع اللبنة الأساس لاعتبار الحاكم المطلق إلها أخلاقيا، ندين له بتنازلنا وحفظنا للعهد في مقابل سلامنا ودفاعنا هو «جون بودان». أنظر:
- كوينتن سكينر. أسس الفكر السياسي الحديث، عصر الإصلاح الديني. ج.2. ترجمة حيدر حاج إسماعيل. ط.1. (بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 2012)، ص. 474
[44] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 180
[45] كارل شميت. اللاهوت السياسي. ترجمة رانية الساحلي وياسر الصاروط. ط.1. (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018)، ص.51
[46] توماس هوبز، اللفياثان، مصدر سابق، ص. 180