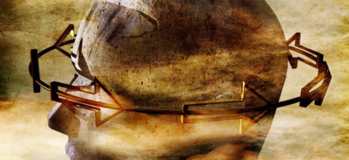في قلب الثورة العلمية الحديثة: التفاعل القوي بين الميتافيزيقا والفيزياء عند ديكارت
فئة : أبحاث محكمة

في قلب الثورة العلمية الحديثة:
التفاعل القوي بين الميتافيزيقا والفيزياء عند ديكارت
ملخص:
يسعى هذا البحث إلى رصد التكامل الفكري العميق بين الفلسفة والعلم في العصر الحديث، وكشف الأهمية الحاسمة التي لعبتها الميتافيزيقا الديكارتية في تشكل الثورة العلمية الحديثة، هذه الأخيرة التي سعت في مستوياتها الميتافيزيقية البعيدة التأسيس الفلسفي لمختلف المفاهيم العلمية، وإلى استغلال العلم الجديد من أجل غايات نظرية وميتافيزيقية بعيدة، تُحول مفاهيمه العلمية الجديدة إلى منطلقات للتفكير الميتافزيقي. فقد أدرك ديكارت أن العلم الجديد لا يمكن أن ينهض دون أرضية ميتافزيقية تضمن له الوضوح واليقين. ولهذا حَوّل المفاهيم الفيزيائية، مثل الامتداد والمادة والمكان والحركة والسرعة والتسارع والفراغ واللانهائي إلى مادة خصبة للتفكير الميتافزيقي، وبحكم أن الفلسفة الديكارتية تأسست كلها على قاعدة بيانات علمية، وعلى إشكالات ذات طبيعة نظرية، حاولنا كشف هذا التفاعل الفلسفي-العلمي من خلال تحليل بعض المبادئ الأساسية المميزة للميتافيزيقا الديكارتية، ترتبط الأولى بتوضيح رفضه لنظرية العلل القديمة والصور الجوهرية والغايات التي ميزتها، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى توضيح تصوره الميكانيكي الجديد للمادة والحركة، وتوقفنا عند أهمية نظرته الجديدة إلى المادة والامتداد الذي يخصها ويعبر جوهريا عنها، لننتهي بنظريته في الحركة والقوانين الأساسية التي قدمها.
تقديم:
قد يبدو الانفصال القائم اليوم بين العلم والفلسفة أمراً واقعا، وقد يبدو التعاون الفكري بينهما ضئيل وتفصلهما هوة سحيقة. والحال أن هذا الانفصال الظاهر لا يخبرنا بالقصة التاريخية الكاملة للعلاقة بينهما، إذ كان التعاون بينهما، لاسيما قبل القرن التاسع عشر، قوياً وعميقاً إلى حد بعيد، وكانا العلم والفلسفة في العصر الحديث (وأيضا في العصور القديمة) جزءا من سلسلة فكرية واحدة، ولم يكن الواحد منهما مميزا عن الآخر، وتاريخهما الطويل والمشترك يتداخل فيه الفلسفي بالعلمي ويشهد على عمق الرابطة التاريخية التي توحدهما، وبحكم أن غايتنا في هذا المقال ترتبط بتوضيح هذا التفاعل في العصر الحديث بشكل عام وفي الميتافيزيقا الديكارتية على وجه التحديد، فيمكن القول إن العلاقة بين الفلسفة والعلم في هذه المرحلة كانت على أحسن ما يرام، والتعاون التاريخي بينهما في هذه المرحلة بالذات كان وثيقاً ومثمراً للغاية، وكما يقول "ألكسندر كويري[*]Alexandre Koyré "(1892-1964) في مقدمة كتابه "من العالَم المغلق إلى الكون اللامتناهي" "أجد نفسي مرغماً على الاعتراف، عديد المرات، عند دراسة تاريخ الفكر العلمي والفلسفي في القرنين السادس عشر والسابع عشر- وهما في الحقيقة متداخلان ومرتبطان وثيق الارتباط إلى حد أنهما غير قابلين للفهم عند الفصل بينهما- مثلما اعْتَرف الكثير من قَبلي، بأن الفكر البشري، أو على الأقل الفكر الأوربي، عاش في تلك المرحلة ثورة عميقة للغاية غيرت أطر تفكيرنا ونماذجها ذاتها، ثورة يمثل العلم والفلسفة الحديثة، في الآن نفسه، مصدرها وثمرتها"[1].
من الجوانب المميزة لهذه الميتافيزيقا الديكارتية المقترحة هنا، كونها تعدّ تاريخياً نموذجاً لهذا التفاعل بين الفلسفة والعلم الذي يهمنا، كما تعد أيضا من المساهمات الفلسفية الحداثية الأولى التي سعت في مستوياتها الميتافيزيقية البعيدة التأسيس الفلسفي لمختلف المفاهيم العلمية، وإعداد الأرضية الميتافزيقية التي ستحتضن هذه الاكتشافات العلمية الجديدة؛ إذ نصّبت نفسها ضمن الروح الفلسفية التي ستعمل من خارج الفيزياء على بلورة الأطر المفاهيمية الأساسية للعلم الفيزيائي، وتكريس مشروعيتها النظرية وتحويل مفاهيمها إلى منطلقات للتفكير الميتافزيقي، ويمكن ملامسة جوانب هذا التكامل المعرفي بين الفلسفة والعلم في الفلسفة الديكارتية في العديد من القضايا والمشكلات، فمن مشكلة الحركة وما يرتبط بها من حديث عن السرعة والتسارع والزمان إلى مشكلات الامتداد والمكان والسّببية .... وانتهاء بمشكلات ميتافزيقية وعلمية ترتبط باللامتناهي والفراغ وفكرة الإله ودوره في العالم...، كلها قضايا وإشكالات يتداخل فيها العلمي بالفلسفي وتشهد على التفاعل الوثيق والتعاون الكبير الذي كان بين العلم والميتافيزيقا في العلم الحديث. ولهذا، وكما يقول ألكسندر كويري "مهما يكن من أمر، فليس غاليلي على كل حال، من صاغ بوضوح وتميز مبادئ العلم الحديث، ومبادئ الكوسمولوجية الرياضية الجديدة، وإنما ديكارت الذي حقق بشكل كلي (هندسة المكان) وحقق حلم رد العلم إلى الرياضيات. وقام في نفس الوقت بشكل مسبق بنوع من المماهاة بين المادة والمكان.[2]
نسعى في هذا البحث إلى رصد جوانب هذا التكامل الفيزيقي والميتافزيقي في النسق الميكانيكي الديكارتي، وتسليط الضوء على الدور الهام الذي لعبته هذه الفلسفة في تحضير الأرضية الأنطولوجية للعلم الفيزيائي الجديد، وتقديم الأسس الفلسفية التي قامت عليها، والكيفية التي حولت بها المفاهيم والمبادئ التي استند عليها العلم الفيزيائي الجديد إلى منطلقات للتفكير الميتافزيقي. وفي سبيل ذلك ارتأينا تكثيف قضايا هذا التفاعل العلمي الفلسفي، وأن نتحدث اختصارا عن ثلاث قضايا أساسية مترابطة في النسق الميكانيكي الديكارتي. أولا الرفض الديكارتي لما يسمى بنظرية العلل بشكل عام واكتفائه فقط بالعلل المادية والفاعلة، وهو الرفض الذي سيساعدنا في العبور إلى المسألة الثانية المتعلقة بالنظرة الميكانيكية الديكارتية الجديدة إلى المادة وطبيعتها والامتداد وأحواله وعلاقته بمفهومي المكان والموضع، على أن ننتهي أخيرا بالحديث عن المعنى الجديد لمفهوم الحركة الذي يتوافق مع طبيعة هذه المادة وخصوصياتها الجديدة وقوانينها الثلاثة الأساسية. فكيف حدث هذا التفاعل؟ وما هو الدور الذي لعبته الميتافيزيقا الديكارتية في ثورة العلم الحديث؟ وكيف ساهم الامتداد الديكارتي وقوانين الحركة في تطور الفيزياء الحديثة وصياغة الفهم الميكانيكي للعالم؟
قبل الخوض في التفاصيل الدقيقة التي تميز الميتافيزيقا الديكارتية، والاجابة بالتالي عن مختلف الأسئلة المطروحة أعلاه، يجب أن نشير بداية إلى السياق التاريخي الخاص الذي نشأت فيه هذه العقلانية؛ إذ تشكلت في سياق نظري وإشكالي خاص، وتشبعت بروح زمانها وتغذت من اكتشافاته ومن تراث علمي وثقافي يضرب بجذور تاريخية عميقة ووقعت فيه نقاشات كثيرة. والجدير بالذكر أن الفكر الإنساني في هذه المرحلة التاريخية بالذات عرف تحولات جذرية عميقة مست مختلف المجالات والميادين، لكن التحول الأبرز الذي كان له وقع كبير على الميتافيزيقا الديكارتية، وعلى مجريات الحداثة برمتها، ارتبط بالقلب والثورة الفلكية الكوبرنيكية التي بدأت بظهور كتاب "دوران الأفلاك السماوية" لنيقولا كوبرنيكN. Copernic سنة 1543، وكما يقول كويري "تُمثل هذه السنة التي نُشر فيها كتاب "دوران الأفلاك السماوية" لنيقولا كوبرنيك (وهي سنة وفاته أيضا) حلقة تاريخية مهمة للغاية في مسار الفكر البشري... إن القطيعة التي أحدثها كوبرنيك، ليست في الحقيقة علامة على نهاية العصر الوسيط وبداية الأزمنة الحديثة، بل هي علامة على نهاية مرحلة تاريخية طويلة تشمل القرون الوسطى والعصور القديمة(اليونانية)، والحدث الذي شكله كوبرنيك أكثر أهمية من سقوط القسطنطينية Constantinople من قبل الأتراك، وأكثر أهمية أيضا من اكتشاف أمريكا من طرف كريستوف كولومبوس Christophe Colomb؛ لأنه مع كوبرنيك فقط لم يعد الإنسان في مركز العالم ولم يعد الكوسموس منظم حوله"[3].
صحيح أن إنجاز "كوبرنيك" الأبرز تمثل في تحريكه للأرض من مركزها، ووضع الشمس بدلا منها. لكن تحريك المواقع بينهما، كانت له دلالات وامتدادات فيزيائية وميتافزيقية هائلة، فرضت تعديلات جوهرية وطرحت قضايا علمية حادة وأزمات ميتافزيقية معقدة، إذ ساهمت في خلق توترات جوهرية ومجالاً واسعاً للطعن حُيال النظريات والمفاهيم العلمية القديمة، كما فتحت أيضا آفاقاً علمية جديدة حبلى بنتائج واعدة دفعت الجميع إلى البحث من جديد عن أجوبة علمية تنسجم من جديد مع الموقع الأرضي المتحرك. لهذا، كان تحريك الأرض من مكانها يقتضي في دلالاته البعيدة تحريك كل شيء، الأرض وما فوقها، من فيزياء وفلك وسياسة ودين أخلاق[†] ... لأن التخلي عن فكرة مركزية الأرض كان يقتضي في المقام الأول التخلي عن الفيزياء المرتبطة بها، وهي الفكرة التي سيلتقطها كل من غاليلي وديكارت ونيوتن وغيرهم من عظماء القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين. لقد اكتشفت هذه النظرية الفلكية الجديدة أن العالَم الذي نراه يومياً وأحببناه ورتبنا فيه وجودنا الأنطولوجي، لم يكن سوى وهم بصري خادع، كما كشفت أيضا من جهة أخرى أن الإنسان ليس استثناء بالنسبة إلى العالَم، وأنه لا يبالي به ولم يُخلق من أجله، وأن موقعه هامشي وثانوي وملقى به في فضاء مفتوح لانهائي، وضمن فوضى متحركة وقوى متصادمة خالية من كل انسجام. وكما يقول "لوك فيري" في وصف دقيق لهذا التحول" ليس الانسان وحده هو "من فقد مكانه في العالَم" كما يقال أحياناً، بل إن العالَم نفسه، أو على الأقل "هذا الكوسموس" الذي كان يشكل إطارا مغلقاً وتناغماً للوجود الإنساني، منذ التاريخ القديم، هو الذي وبكل بساطة تبخر، تاركاً مفكري تلك الحقبة في حالة هلع يمكننا بالكاد تصورها في أيامنا هذه.[4]
هكذا ساهم مكبوت الكوبرنيكية بخلق حالة من التشقق والأزمة في الوعي العلمي العام الحداثي المبكر، وعجل بالانهيار السريع للميتافيزيقا والعلم الأرسطيين، وخلق حالة من اللايقين اتجاه النظريات والمعايير والقواعد، جعل الجميع بشعر بالدهشة والضياع في عالم لامحدود ولا متناهي، وجلب معه هذا التحول العديد من الشكوك والكثير من الأسئلة الفلسفية حول اليقين والمعرفة، إذ ترتب عن فقدان مركزية الأرض وبالتالي مركزية الإنسان فراغ مخيف، وجد فيه الإنسان الحداثي نفسه في مواجهة مباشرة مع الطبيعة، وحيدا مجرداً من الحماية التي كان يشعر بها في ظل الكوسموس الطبيعي اليوناني والإلهي الوسيطي، ومضطرا لإعادة تقييم الطبيعة نفسها وطبيعة المعرفة التي يملكها عنها وآلياتها وأدواتها. كان عليه أن يبتكر طرائق جديدة ومناهج مختلفة لفهم العالَم والتعامل مع ظواهره، وإعادة رسم الصورة العامة للكون من جديد.
كانت رسالة العلم في هذه المرحلة ترتبط منهجياً بإعادة النظر في المعرفة ونظرياتها وأدواتها ووسائلها، وتجديدها وإعادة بنائها من جديد. وضمن هذا السياق النظري العام يمكن أن نفهم الميتافيزيقا الديكارتية التي سعت إلى ترسيخ الأساس الفلسفي القوي الذي يمكن أن يستند عليه العلم الحديث، وأدركت أفول الميتافيزيقا الأرسطية التي يجب عليها أن تنسحب (مادام علمها النظري الذي تتأسس عليه قد تحطم وتم تجاوزه)، ونصبت نفسها ضمن الروح الفكرية العامة التي ستملأ الفراغ المترتب عن انسحاب الفلسفة الأرسطية من المجال النظري. وكما يقول كويري "بالنسبة لديكارت، الفيزياء التقليدية قد ماتت وتم دفنها ويجب تعويضها عبر تأسيس وتطوير فيزياء جديدة تساهم في تقديم صورة جديدة عن العالم، وتقديم تصور جديد للمادة والحركة."[5]
لأجل هذه الغاية الكبيرة، استهدفت الميتافيزيقا الديكارتية بأشكال محددة، ومن خلال يقينياته الخاصة إقامة الأسس الميتافزيقية الضرورية التي يجب أن يقوم عليها العلم الناشئ، واحتلت الفيزياء (بوصفها معرفة بالأجسام وخصائصها) مكانة مركزية في النسق الميكانيكي الديكارتي؛ إذ تمثل جذع الشجرة الديكارتية كما وصفها في المقدمة التمهيدية لـ كتاب "مبادئ الفلسفة"، وهي العلم الذي تعتمد عليه الفروع الأخرى، مثل الطب والميكانيكا.[6] وتتميز هذه الفيزياء الديكارتية ببعض الخصائص العامة التي تجعلها مختلفة بشكل جذري عن المفاهيم الفيزيائية القديمة، وخاصة الفيزياء الأرسطية القديمة وديناميكا الاندفاع التي كانت منتشرة في زمانه:
أولا: تأتي الفيزياء الديكارتية في المرتبة الثانية من حيث الترتيب المنطقي والفكري للعلوم، فهي الجذع الذي يتغذى من الجذور الميتافزيقية العميقة. وهنا يشبه ديكارت المعرفة البشرية بشجرة تتكون من ثلاثة أجزاء رئيسة: أولا الجذور التي تمثل الأسس الميتافزيقية والأرضية الأنطولوجية التي يتوقف عليها البناء النظري كله، وتناظر في هذا المستوى الميتافيزيقا؛ أي التصور العام للوجود الذي يشمل الأسئلة الميتافيزيقية الأساسية، مثل وجود الله وطبيعة الواقع وحقيقة النفس وشكل المعرفة وطبيعتها.... أما جذعها، فيناظر العلوم الطبيعية، والتي ينبغي أن تستند على أسس فلسفية واضحة بخصوص طبيعة المكان والزمان والحركة والفراغ واللانهاية. فهي علوم تسد الفجوة بين النظرية والتطبيق، وتتوسط الأسس الميتافزيقية والعلوم العملية التطبيقية المتفرعة عنها. مثلما تتغذى الجذوع والفروغ من الخصوبة العضوية والفنية التي تتمتع بها الجذور، كذلك تماماً نجد أن حياة العلوم ككل تتوقف على إمدادات الجذور من المواد. وهذا ما يعني أن "المفاهيم الفيزيائية الأساسية مثل "الحركة" و"الامتداد" و"المادة" و"السببية" و"المكان" و"الزمان" و"اليقين" و"الكون".... تستمد جذورها ومشروعيتها من أرضية ميتافزيقية خالصة، وهي مفاهيم مشتركة بين الفيزياء والميتافيزيقا، ويمكن الوصول إليها بشكل قبلي a priori أو بشكل بعدي a posteriori. ومعرفتها تنبع من معرفة الفكر والله أولا وتعتمد عليهما، لهذا، وعلى عكس ما يُتصور، فإن الفيزياء الديكارتية لا تُمثّل مدخلًا إلى الميتافيزيقا، بل تفترضها مسبقاً وتعتمد عليها باستمرار وتمنحها جزءاً من قيمتها ومعناها".[7]
ثانياً: بدلا من أن تكون الفيزياء متميزة عن الرياضيات وفقاً للمبدأ التقليدي الذي كان يفصل بين المعارف والأجناس العلمية والمعرفية، فإنها تحافظ على علاقة جوهرية معها، سواء في الموضوع أو في المنهج. والثقة المطلقة فيها وفي استدلالاتها ونتائجها أحيت الأمل الفلسفي في تحقيق ثقة مماثلة على مستوى خطاب ميتافزيقي تأسيسي، وفي عكس نتائجها على المستوى الفيزيائي.
ثالثا وأخيرا: تتميز هذه الفيزياء الديكارتية بطابعها النسقي الميكانيكي الذي يسعى إلى تقديم رؤية شمولية ميكانيكية للعالم، وذلك من خلال القيام بهيكلة عامة لصورة الوجود وفق مبادئ ميتافزيقية عامة لها انعكاسات على المستوى الفيزيائي. (فكرة الله، فكرة الامتداد، فكرة الروح أو النفس). إذ استهدفت هذه الميتافيزيقا تأسيس فيزياء رياضية واضحة ويقينية ومُبرهنة، واعتبرت أن القضايا الفيزيائية تتبع ترتيباً منطقياً يسير بانتظام من المبادئ إلى النتائج. و"لهذا نجدها تعرض القضايا الفيزيائية وفق نظام منهجي يشبه بشكل كبير المنهج الرياضي، وتظهر هذه الصرامة المنهجية بوضوح كبير في نصوصه، التي يتجنب فيها تقديم إجابات فيزيائية معينة قبل عرض المبادئ الميتافزيقية المؤسسة لها".[8]
تُشكل هذه المبادئ الميتافزيقية الإطار النظري الذي أسس عليه ديكارت رؤيته الميكانيكية للعالم، والتي سعى من خلالها إقامة الأسس الميتافزيقية الضرورية للفيزياء الرياضية الجديدة. ومثلما أن حياة جذع الشجرة تتوقف على إمدادات جذورها، كذلك الأمر بالنسبة لفلسفة الطبيعة أو الفيزياء التي تتغذى من مبادئ وأوليات ميتافيزيقية كبرى تخص المادة والمكان والزمان والحركة والله...غير أن استكشاف جوانب هذا التكامل الميتافزيقي والفيزيائي في النسق الميكانيكي الديكارتي يقتضي تتبع تجلياته في قضايا جوهرية تبرز هذه العلاقة. وبحكم أن الميتافيزيقا الديكارتية تأسست كلها على قاعدة بيانات علمية وعلى إشكالات ذات طبيعة نظرية، فإن الإحاطة بجوانب هذا الفكر وجرد قضاياه العلمية والفلسفية في حدود مختصرة أمراً صعباً للغاية. لذلك، سنتجنب في تناولنا لها الحديث عن كافة التفاصيل العلمية الفيزيائية والرياضية التي ميزتها، وسنكتفي منها بتوضيح رفضه لنظرية العلل القديمة والصور الجوهرية والغايات التي ميزتها. هذا الرفض الذي سيفتح لنا مجالاً للحديث عن مسألة أخرى، تتعلق بالتفسير الميكانيكي الديكارتي الجديد للمادة، سيقوم فيه ديكارت بالفصل الجذري بين نظام الفكر ونظام الامتداد، على أن ننتهي أخيرا بالحديث عن المفهوم الجديد للحركة الديكارتي وطبيعتها وقوانينها.
أولا: رفض نظرية العلل التقليدية
من الجوانب المميزة للميتافيزيقا الديكارتية نجد رفضها لما كان يسمى بنظرية العلل القديمة، والتي كانت تشكل جزءا أساسياً من الفلسفة والفيزياء الأرسطيين. فهي نظرية كانت تفترض أن تفسير الظواهر الطبيعية يتوقف على توضيح عللها الأربعة[‡]: المادية والفاعلة والصورية والغائية. رفض ديكارت هذه النظرية، ورفض مضمونها التقليدي، وخصوصا العلة الغائية والصورية les causes formelles et finales وقام بطردهما من مجال العلم، واكتفى منها فقط بالعلة الفاعلة والمادية المتناسبين مع المفهوم الجديد للمادة والامتداد. بالنسبة له ليس من شأن العلم الفيزيائي ولا يقع في صلاحياته البحث عن العلل الغائية، والتي تتعلق بالأغراض النهائية للأشياء، بل من شأن هذا البحث أن يسقط العقل في استنتاجات وتناقضات خطيرة لا حل لها. كما أن البحث فيها وعن السؤال "لماذا" لن يصل بالذهن إلى نتائج معقولة. وحسب ديكارت فما دام العقل البشري محدود في قدراته وهو متناهي بطبيعته، فإنه بدلا من القفز إلى استنتاجات كبرى حول الغايات النهائية للوجود، يجب على العلم الفيزيائي أن يكتفي بالسؤال "كيف"، وأن يوظف قدرات الفهم المحدودة في فهم العلل المادية والفاعلة فقط causes efficientes et mêmes matérielles. وكما يقول كويري "أما هذا العالَم فهو قد خلقه(الإله) بإرادة خالصة، وحتى وإن كانت له بعض الدوافع للقيام بذلك، فهو وحده الذي يعرف هذه الدوافع وليس لنا، بل لا يمكن أن تكون لنا أدنى فكرة عنها، لذلك لا فائدة ترجى من محاولة معرفة غاياته في الخلق، بل تلك المحاولة لا معنى لها، وليس للتصورات ولا للتفسيرات اللاهوتية مكان ولا قيمة في العلم الفيزيائي، مثلما أنه لا مكان لها ولا معنى لها في الرياضيات كذلك"[9].
معرفة الغايات مستحيلة ليس فقط واقعياً، بل حتى منطقياً، فالأفكار والتصورات عند ديكارت ليست نسخا للأشياء، وهي لا تأتينا من الخارج عبر الحواس، بل لها واقعها الموضوعي objective) réalité)، والبرهنة على وجود شيء ما خارج الذات يقتضي النظر في الأفكار من حيث ما يمثله واقعها الموضوعي. وهي غير متساوية في ذلك، فبعضها له واقع موضوعي أكثر، وبعضها الآخر له أقل، والبحث في الغايات يفوق القدرات المحدودة للعقل، ووجودها الموضوعي يتجاوز بكثير ما يمكن لعقل أن يتصوره كمعرفة حقيقية، فمثلا: فكرة "الجوهر" تمثل شيئاً ما أكثر من فكرة الحال أو العرض، وفكرة "الشيء المفكر" أغنى واقعاً من فكرة الخيال والإحساس[10]. والمقصود بواقعية الأفكار الموضوعية ليس هو أنها توجد خارجاً عني، بل هو أنه لا يمكنني أن أجعلها غير ما هي عليه. ويسمي ديكارت الواقع الموضوعي للفكرة بالكمال أو الكينونة وليس الوجود. وواقعية موضوع ما، هي كماله = أي كينونته وليس وجوده، لهذا، فالواقعية درجات = درجات الكمال أو الكينونة في حين أن الوجود ليس له درجات، إذ لا وسط بين الوجود واللاوجود[11]. وعلى رأس الأفكار جميعا توجد فكرة الله، أي فكرة الكائن الكامل الذي لا تنقصه أقل درجة من درجات الكمال. وفكرة الله تمثل فكرة كائن كل صفاته إيجابية تماما. إذن، فكرة الله = فكرة الكمال.
الدلالة الإبستمولوجية التي يكتسبها هذا المبدأ تستهدف في مستوياتها البعيدة الاعتراف بقدرات الفهم المحدودة وبكونه لا يقدر على الإطلاق أن يتصور غايات وأفكار حقيقية لها درجات من الكمال ما يفوق حدود قدراته، فقدر الكمال في بعض الغايات يفوق قدر الكمال الموجود في بعض أفكار الذهن. ولهذا، لا يمكن للذهن أن يكون مرجعاً لهذه التصورات، فهي من جهة غامضة ومبهمة ولا يمكن أن تستجيب لمطلبي البداهة والاستنباط. ومن جهة ثانية من شأن الإقرار بوجود غايات حقيقية للعالم، أن يسقط المشروع الحداثي ككل، ذلك لأن مشروع السيطرة والتحكم في الطبيعة، ينبني على قاعدة استقلالية الذات ومرجعيتها بالنسبة للمعرفة والقوانين، وإذا كانت هناك غايات حقيقية لا يستطيع الفهم أن يدركها، فلن يصير لمطلب التحكم والسيطرة أي وزن، وسيصير الإنسان ملزماً بأن يحدد موضعه أمامها وأن يطلب انسجامه وخلاصه وفقها. والحال أن رهان الحداثة ككل تأسس على مبدأ تحطيم الكوسموس ورفض البنية المغلقة لنظام العالم.
ثانيا: في الامتداد
يتربع الامتداد على عرش المفاهيم والقضايا الاستراتيجية الكبرى في الفيزياء الرياضية الديكارتية؛ إذ يمثل الركيزة الأساس التي كان يقوم عليها التصور الميكانيكي الجديد للطبيعة، وفهم المادة على أساس الامتداد لم يكن مجرد تعديل بسيط في الفهم العلمي، ولم يقتصر على إعادة تعريف المادة فحسب، بل كان استبدالا جذرياً وتحولاً نوعياً وحّد نظرتنا إلى المادة والمكان والحركة، وفتح الطريق أمام الميكانيكا الكلاسيكية وأمام المزيد من الدقة والقياس والتكميم الرياضي.
حسب ديكارت يعتبر الامتداد الخاصية الجوهرية التي تميز الأجسام، فهو جوهر المادة ذاتها، ولا يمكن تصور مادة دون امتداد، وفكرتنا المتميزة والواضحة عن الأشياء المادية تتمثل في كونها ممتدة في الطول والعرض والعمق[12]، وهي الفكرة التي تشتق منها أفكار أخرى متميزة كتلك الخاصة بالعدد، والشكل والوضع والحركة أي بمعنى التغير في المكان، وكنتيجة فالحركة في المكان تقتضي زمن معين، أي ديمومة (durée) وأفكار أخرى متميزة تظهر بالبداهة، كتلك التي تخص العدد والشكل والحركة. والنتيجة هي أن القضايا الرياضية تعبر عن حقيقة الأشياء الممتدة.[13]
هكذا، فإن فهم المادة على أساس الامتداد قد ساهم في تحريرها من كافة التصورات التقليدية التي كانت ترتبط بها، فهي لا تتحدد من خلال شكلها ولونها ومظاهرها الحسية المختلفة، كما لا تتحدد أيضا من خلال صلابتها وخشونتها وثقلها، بل تتحدد فقط بكونها مجرد امتداد عاطل، وفكرتنا المتميزة عنها تتمثل في أنها ممتدة في الطول والعرض والعمق، [14] وليس في كونها ذات ملمس ولون وصوت ومذاق ...؛ وبعبارة أخرى، وكما يقول كويري "ليس الثقل ولا الصلابة ولا اللون هو ما يُكون طبيعة الجسم، وإنما تُرد طبيعة الجسم إلى الامتداد وحده، والجسم لا يتحدد بكونه شيئا صلباً ولا ثقيلا ولا ملوناً ولا بكونه شيئاً تلامسه حواسنا بأي طريقة أخرى، بل تكمن في كونه جوهرا ممتدا طولا وعرضاً وعمقاً فقط"[15].
من الجوانب الأساسية المميزة لهذا الجوهر(الامتداد)، أن له جانبين أساسيين: الأول هو أن الامتداد يعتبر جوهراً خاصاً بالمادة، يمتلك أحوالا مثل العدد والشكل والوضع والحركة والديمومة durée، وهي قضايا وأحوال يمكن اشتقاقها من فكرة الامتداد نفسها. أما الجانب الثاني، فيتمثل في كون أن الامتداد لا يشترط بالضرورة وجود الأجسام المادية، ولا يرتبط بالوجود الفعلي لها، فهو خاصية رياضية مجردة مميزة لها ومستقلة عنها. ولهذا، يمكن للقضايا الرياضية أن تعبر عن حقيقة الأشياء الممتدة، لكن هذه القضايا وهذه الأحوال لا نتلقاها من العالَم الخارجي ولا نكتسبها من الأشياء الفيزيائية في حد ذاتها، بل نكتشفها من داخل الفهم(العقل) نفسه[16]، لأن المعرفة الصحيحة بالأشياء المادية هي حسب ديكارت لا ترتبط بوجود الأشياء والغاية منها، بل في الحكم على ماهيتها، والفهم وحده هو من ينشئ العلم ويقيم المعرفة، والمهم بالنسبة إلى الفيزياء ليس هو وجود الأشياء، بل المهم هو الحكم على ماهيتها. ولذلك، فالفهم لا يقدم برهانا على وجود الأشياء، (باستثناء وجود الله يمكن البرهنة عليه، لأن وجوده خاصية تنتمي إلى ماهيته، أما وجودي (الأنا المفكر) فهو لا يحتاج إلى برهان لأنه يدرك بالحدس). وعدم قدرته على البرهنة على وجود الأشياء المادية راجع إلى أن البرهان لا يقيم اعتبارا إلا للماهية. مثلا يخبرنا الإحساس البصري بوجود الضوء، لكنه لا يخبرنا شيئا عن ماهيته، إن العلم بحقيقة وماهية الضوء، منوط بالبصريات الهندسية التي تعالج الأشعة الضوئية على أنها خطوط مستقيمة وتقيس زوايا الانعكاس والانكسار. معرفة شيء ما لا تتم من خلال إدراكه حسياً، بل بتصوره تصوراً واضحاً متميزاً، وما نتصوره بوضوح وتميز عن الأشياء الممتدة أو الجسمانية إنما هو موضوع الهندسة والرياضيات الخالصة.[17]
هكذا يظهر لنا بوضوح الكيفية التي ساهم بها الامتداد الديكارتي في تشكيل تصور جديد للمادة ينسجم مع رؤيته الميكانيكية للعالم، فهو لا يحدد المادة من خلال صفاتها الحسية وكيفياتها المتغيرة مثل الروائح والألوان والطعم والملمس، بل يحددها من خلال الامتداد، وبوصفها مجرد امتداد رياضي عاطل؛ إذ لم تعد الأشياء تحضر في مجال الوعي بوصفها صلبة وملساء أو بكونها حاملة للون ورائحة وذات مذاق معين، بل باتت تحضر بوصفها هياكل جامدة وصور وأشكال رياضية ثابتة وموضوعية بشكل مستقل عن انطباعات الذات. أما اللون والخشونة والحرارة والبرودة والمذاق والرائحة، فهي بالنسبة إلى ديكارت مجرد صفات حسية ثانوية متغيرة تحدث نتيجة تفاعل المادة مع حواسنا، وليست جزءا من الطبيعة الموضوعية للأشياء. فالألوان مثلا ليست من طبيعة المادة ومن خصائصها الجوهرية، بل هي مجرد تأثير ناتج عن انعكاس الضوء وانحناءاته، كما أن الحرارة والبرودة هي الأخرى ليست سوى تأثيرات ذاتية ترتبط بالاحتكاك الناتج عن التفاعل مع المادة وخصوصياتها، وتعبر عن الانطباع الذي تمارسه الأجسام على جلدنا. (الماء الساخن يبدو باردا لمن وضع يده في ماء أشد حرارة، ويبدو ساخناً لمن وضع يده في ماء بارد). والشيء نفسه يقال بالنسبة لكافة المظاهر الحسية الأخرى كالخشونة والنعومة والصلابة والمذاق والرائحة.
لهذا السبب، فإن تحرير المادة من مختلف الترسبات الكيفية والصور الجوهرية، كان يتطلب من جهة ثانية القيام بعملية تحرير مماثلة للمكان؛ وذلك من خلال استبدال المكان الحسي المغلق بالمكان الهندسي المفتوح؛ أي تجاوز المكان التقليدي بوصفه حيزا طبيعياً ومكاناً مغلقاً تراتبياً يمتلك صفات محددة مثل "الطبيعة" والطبع" و"المكان الطبيعي" و"الحركة الطبيعية"، نحو مكان آخر مختلف تماماً أصبح فيه فضاءً مجرداً متجانساً وهندسياً؛ أي نحو مكان هندسي لا يحمل صفات وخصائص حسية أو ذاتية، إنه مكان مفتوحاً لا محدداً، (بل ولا متناهياً) وموحداً، ليس فقط في علاقة مع بنيته، بل أيضا من جهة وحدة عناصره الأساسية وقوانينه. مكان تظهر فيه كل مكوناته متساوية في مرتبة أنطولوجية واحدة. وكما يقول كويري" وقع استبدال المكان المتصل الملموس والمتمايز الذي قامت عليه الفيزياء وعلم الفلك قبل الغاليلية بالمكان المتجانس المجرد للهندسة الأوقليدية"[18]، فالعِلم الحديث نجح حسب "كويري" في تحطيم العالَم الذي طالما نظرنا إليه على أنه كل محدود بالغ التنظيم والترتيب؛ أي العالم الذي تجسد فيه البنية المكانية تراتباً قائماً على القيمة والكمال، بتصور آخر يعتبر الكون لا محدوداً ولا متناهياً، لم يعد العالَم موحداً بالتراتبية الطبيعية، بل توحده وحدة قوانينه ومكوناته الأساسية[19].
ثالثا: في الحركة
إن الحديث عن الامتداد والمادة يقودنا بالضرورة إلى الحديث عن الحركة؛ لأنها الوسيلة الوحيدة التي يحدث بها التغير داخل هذا الامتداد. وإذا كان الامتداد كما قلنا هو جوهر الأجسام المادية وخاصية رياضية لا ترتبط بالوجود الفعلي للأجسام في حد ذاتها، فإن هذا يعني أنها مادة لا تملك أي قدرة ذاتية على الحركة. وبالتالي، إذا كانت المادة لا تحتوي في ذاتها على مبدأ الحركة (على خلاف التصور الأرسطي القديم)، فلابد إذن من تفسير الحركة من خارجها، بالاعتماد على الاحتكاك أو الصدمات، أو أي نوع من التماس الخارجي بين الأجسام الممتدة. فالحركة، في التصور الديكارتي، لا تنبع من طبيعة المادة ذاتها، بل من خلال تفاعلاتها الرياضية الممكنة، وكل التغيرات التي تحدث لها يمكن تفسيرها من خلال قوانين الحركة بوصفها تحولاً ميكانيكياً بحثاً.
لهذا السبب، يرى ديكارت أن المادة والحركة لا ينفصلان، لأن الحركة كما رأينا أعلاه هي ذاتها مجرد حال من أحوال الامتداد وتشتق منه، والعالَم الديكارتي لا يتشكل سوى من عنصرين هما: الامتداد والحركة، وكما يقول ألكسندر كويري "إن عالَم ديكارت، ليس هو بأي حال من الأحوال، عالم الأرسطيين المُلون coloré، عالم متعدد الأشكال multiforme ومحدد كيفياً، ...وإنما هو عالَم رياضي ذو شكل واحد بأتم معنى الكلمة، عالم من الهندسة المتعينة الذي تعطينا أفكارنا الواضحة والمتميزة عنه معرفة يقينية وبديهية، إذ لا شيء يوجد في هذا العالَم سوى المادة والحركة، أو بما أن المادة متماهية مع المكان أو الامتداد، فلا شيء يوجد سوى الامتداد والحركة[20].
غير أن الحركة المقصودة هنا "ليست ظاهرة فيزيائية محسوسة ولا تتعلق بالأجسام الواقعية، ولا تحدث في الزمكان، بمعنى أنها ليست سيرورة(Processus) تؤثر على الجسم وفي سير حركته، بل هي حركة هندسية خالصة، حركة نقطة وهي ترسم خط مستقيم، وحركة خط مستقيم وهو يرسم دائرة …، وهي حركة متعارضة مع الحركة الفيزيائية، لا سرعة لها ولا تكون في الزمن.[21] إنها حركة هندسية خالصة، ليس فيها تغير ولا حرمان، وهي (مجرد) حالة état تظل على حالها وتتواصل بشكل دائم على خط مستقيمي في المكان الرياضي اللامتناهي.
الواقع أن اعتبار الحركة مجرد حالة مماثلة للسكون وفي نفس المرتبة الأنطولوجية معه، هو فقط ما يجعلها قادرة على الحفاظ على ذاتها في حركتها المستقيمية المنتظمة ودون حاجة لأي علة تحركها أو قوة تدفعها، وكما يقول كويري" من حيث أن "الحركة" هي مجرد "حالة" يعني أنها لا تفترض مسبقا "علة" ولا تحتاج إلى "محرك"، فهي إن كانت متحركة ستظل كذلك، وإن كانت ساكنة ستظل في سكونها. فالقانون الأسمى الذي يسود العالم حسب ديكارت هو "قانون الثبات أو البقاء"[22]، والأجسام تظل على حالها ليس اعتمادا على ذاتها وقدراتها الخاصة، بل لفعل الخلق المتواصل الذي يقوم به الإله في العالم، فما خلقه الإله يبقيه في الوجود[23]، وهو وحده الذي يحافظ على وجود الشيء الذي خلقه على حاله، وبمجرد خلقه للحركة في العالم، فهو قد بعث فيها كمية معينة لا تزيد ولا تنقص بل تبقى ثابتة، وكما يقول ديكارت "إن الإله هو العلة الأولى للحركة وهو يحافظ دائما على كمية متساوية للحركة في العالم"[24]. ومن ثم، فنحن لا نحتاج للبحث عن العلة الأولى لحركة الأشياء، وإنما يمكننا التسليم ببساطة أن الأشياء بدأت في الحركة في اللحظة نفسها التي خلق فيها الإله العالَم، وبعث فيها كمية الحركة التي أرادها لهذا العالم، وكما يقول "كويري" لما كان ذلك كذلك، فمن المستحيل أن تنقطع حركاتها أبدا، ولا أن يلحقها أي تغير سوى انتقالها من موضوع إلى آخر، وعليه فلن تنقطع حركة الأجسام ولن يفقد العالَم كمية حركته، بل ستظل متنقلة كليا أو جزئيا، من جسم إلى آخر[25].
إن القانون الأول الذي يميز العالم هو قانون هو قانون الثبات والاستمرار، وما خلقه الله يحافظ عليه في الوجود. لذلك، فإن كمية الحركة التي خلقها الله في العالم لا تتغير وتبقى ثابتة في العالم. واستنادًا إلى مبدأ بقاء الحركة يستنتج ديكارت القوانين الأساسية للحركة، ومن بين هذه القواعد التي نجدها في كتابه "العالم":
القاعدة الأولى: قاعدة الثبات والبقاء، وتعني أن "كل جسم من أجزاء المادة يبقى على الحالة التي هو عليها مالم تعترضه أجزاء أخرى فتجبره على تغيير حالته[26]، وذلك يعني أنه لن يغير حالته على الإطلاق، فإذا كان يملك شكلا مربعاً أو مستديرا فلن يغيره أبدا من تلقاء ذاته، وإذا كان متحركاً فسيواصل حركته إلى الأبد وبقوة ثابتة وفي الاتجاه نفسه، وإذا كان ساكناً فسيظل ثابتاً وساكناً في موضعه ولن يغادره أبدا.
القاعدة الثانية: قاعدة التماس أو الاصطدام، والتي تقول أنه عندما يدفع جسم ما جسماً آخر، لا يمكنه أن ينقل إليه أي حركة إلا بقدر ما يفقد ما يعادلها من حركته الذاتية"[27]، وهذا معناه أنه عندما يتصادم جسمان فإن كمية معينة من الحركة تنتقل من الأول إلى الثاني، يفقدها الأول ويكتسبها الثاني، ذلك لأن كمية الحركة في العالم هي ثابتة كما تنص القاعدة الأولى، ولذلك لا يمكن لجسم ما أن ينقل الحركة إلى جسم آخر إلا بالقدر الذي يفقده هو نفسه، فإذا ما دفع جسم A جسم B، فإن كمية الحركة التي يفقدها الجسم A تعادل كمية الحركة التي يكتسبها الجسم B .
القاعدة الثالثة: قاعدة الحركة المستقيمية، ومضمونها أن كل حركة تكون مستقيمة بذاتها بسرعة منتظمة ووفق خط مستقيمي، صحيح أننا لا نعثر على هذه الحركة في عالمنا الطبيعي، بل نجدها دائما حركة منحنية أو دائرية، رغم ذلك، فإن كل جزء من أجزاء هذا الجسم ينزع دائما إلى مواصلة حركته على خط مستقيم، "فإذا دورنا مثلا عجلة حول محورها( أو حجرا في مقلاع)، فإن ميلها يكون في المضي على الاستقامة رغم أن كل أجزائها تتحرك على خط دائري؛ لأنها ملتحمة ببعضها البعض، فلا يمكنها أن تتحرك على نحو مغاير، كما يظهر ذلك بوضوح إذا صادف وانفصل أحد أجزائها عن الأجزاء الأخرى، إذ ما أن يصبح هذا الجزء طليقاً حتى يكف عن الحركة الدائرية ويواصل حركته على خط مستقيم.[28]
استنادا إلى هذه القواعد الثلاث، فالجسم يبقى على الحالة التي هو عليها، ولا شيء ينزع إلى تحطيم ذاته، وما يوجد اليوم سيسعى قدر مستطاعه إلى أن يوجد دائما، وسيستمر على الحالة التي هو عليها، ولن يغيرها إلا بفعل خارجي.
خاتمة:
نخلص من خلال هذه الإطلالة الخاطفة على الميتافيزيقا الديكارتية، ومختلف المبادئ الفزيائية التي قدمتها إلى القول بأن التفاعل العلمي الفلسفي كان وثيقا للغاية في هذه المرحلة التاريخية، إذ سعت الفلسفة الديكارتية من خلال مبادئها الفلسفية والعلمية الأساسية تحويل الاكتشافات الفيزيائية والآثار الحاسمة التي نتجت عنها إلى فلسفة ميكانيكية كونية تستجيب مع مبادئ وانجازات العلم الناشئ الجديد. واستهدفت تطوير فلسفة جديدة تواكب التحول العلمي وتعكس الآثار الجوهرية والثورية للعلم الحديث في ثنايا خطاب ميتافزيقي تأسيسي. لهذا، لم تكن غاية ديكارت تقديم النظريات والاكتشافات العلمية فقط، ولا الانخراط في مسلسل الاكتشافات العلمية، بل سعى إلى تقديم الإطار الفلسفي الجديد الذي يمكن أن يحتضن ويحتوي العلم الناشئ، ونصَّب نفسه ضمن الروح الفكرية العامة التي ميزت عصره لإعادة بناء العلم على أسس ميتافزيقية صارمة والقيام بتثبيت وتعميق الأطر المفاهيمية الأساسية للعلم الناشئ وتحويلها هي الأخرى إلى منطلقات للتفكير الميتافزيقي.
لهذا السبب، رفض ديكارت كما رأينا بشكل منهجي مختلف المفاهيم الفيزيائية التقليدية التي كانت تشكل نواة الفهم الأرسطي، مثل العلل الصورية والغائية وأبعدها بشكل نهائي عن العلم الفزيائي، كما رفض مفاهيم مثل الطبيعة والطبع كمبدأ داخلي للحركة (الطبيعة كقوة فاعلة)، وفكرة المكان الطبيعي والخفة والثقالة، والهيولى والصورة، والتصورات الكيفية الحسية، والقوى الغائية، والصور الجوهرية، والمبادئ والكليات... لقد استبدلت الديكارتية كل ذلك، وسعت إلى تقديم رؤية ميتافيزيقية وميكانيكية جديدة للعالم، تدمج المعرفة الفلسفية والعلمية في إطار متماسك، يجمع بين اليقين الميتافزيقي المعرفي الراسخ والواضح، وبين اليقين العلمي الذي يعكس حقيقة المادة والامتداد والمكان والحركة.... والمنسجم بطبيعة الحال مع رؤيته لليقين والعقل والمعرفة.
[*]يحتل "ألكسندر كويري" في مجال الفكر الفلسفي والابستمولوجيا المعاصرة مكانة رفيعة ومتميزة، إذ يعد أحد كبار مؤرخي الفكر العلمي المعاصر، وبفضل تكوينه العلمي والفلسفي المزدوج، استطاع أن يقدم قراءة جديدة للثورة العلمية الحديثة، وقدم بخصوصها العديد من المؤلفات نذكر منها ما يلي:
Du monde clos à l’univers infini, Gallimard, 1962
La révolution astronomique: Copernic, Kepler, Borelli, paris: Hermann 1962
Etudes Galiléenne ; Hermann, Paris 1966
Etudes newtoniennes ; Gallimard, 1968
Etudes d’histoire de la pensée scientifique, Gallimard, 1973
[†] الثورة الكوبرنيكية أثارت أسئلة علمية وفلسفية جوهرية عديدة، في مقدمتها نجد السؤال الجوهري الأساسي. ما هو الواقع؟ هل هو ما نراه حسياً أم ما نعرفه عقلياً؟ وما هو شكل العالم الذي نعيش فيه؟ وهل له شكل أصلا؟ وهل العالم الذي نراه محدوداً ومتناهياً أم كوناً لا نهائياً ولامحدوداً؟ وإذا كان الكون لا متناهياً، فهل يعني ذلك أنه كون بلا مركز؟ وإذا لم يكن هناك مركز ثابت، فكيف يمكن تصور شكل الكون؟ ... أسئلة جانبية كثيرة تلك التي طرحتها فكرة مركزية الشمس، وتداعيات الحلول كانت أبعد من أن تتيح إمكانية تقدم متواصل، وفرضت ضرورة إحداث قطيعة جذرية عميقة وتعديل بنية العقل وتغيير فرضياته وقوانينه وتربيته وتزويده بمفاهيم جديدة ومعاني مبتكرة لرسم صورة جديدة لوجوده في العالم.
[‡] العلة المادية (ما يتكون منه الشيء ويتولد عنه ويصنع منه وقد تشمل المادة الخام التي تدخل في تركيبة كائن أو ظاهرة) والفاعلة (وما يوجد الشيء بسببه أي القوة الفعالة التي تؤدي إلى حدوث تأثير أو نتيجة معينة) والعلة الصورية (شكل الشيء وهيولته أي صورته وهيكله ونمطه) والعلة الغائية (غاية الشيء وقصده وما يوجد الشيء لأجله وهي أسمى العلل وتحدد الهدف النهائي والغاية النهائية للحركة).
[1] ألكسندر كويري، من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي، ترجمة يوسف بن عثمان، منشورات دار سيناترا، معهد تونس للترجمة 2017، ص39
[3] Alexandre Koyré, la révolution astronomique, Hermann, Paris 1961, p. 15
[4] لوك فيري، تعلم الحياة، ترجمة سعيد الولي، أبو ظبي للثقافة والتراث، ص 151
[5] Alexandre Koyré, Etudes galiléennes, Paris, Hermann, 1966, p.318
[6] Frédéric de Buzon, »Le concept de la physique«, Lectures de Descartes, éditions ellipses, 2015, p. 181
[7] Ibidem
[8] Ibid., p. 182
[9] ألكسندر كويري، من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي، مرجع سابق، ص148
[10] Jean Lechat, Méditations métaphysiques commentaires, éditions Nathan, Paris1996, p.48
[11] Ibid., p.49
[12] Ibid., p.73
[13] Ibid., p.74
[14] Ibid., p. 73
[15] ألكسندر كويري، من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي، مرجع سابق، ص148
[16] Jean Lechat, Méditations métaphysiques, op. cit., p.74.
[17] Ibid. p 89
[18]ألكسندر كويري، دراسات نيوتونية، ترجمة يوسف بن عثمان، المركز الوطني للترجمة، منشورات دار سيناترا، تونس2015. ص 60
[19] Alexandre Koyré, Du monde clos à L’univers infini, op. cit., p.11
[20] ألكسندر كويري، من العالم المغلق إلى الكون اللامتناهي، مصدر سابق، ص148
[21] Alexandre Koyré, Etudes galiléennes, op. cit., p.131
[22] Alexandre Koyré, Etudes newtoniennes, éditions Gallimard 1968 p.98
[23] ألكسندر كويري، دراسات نيوتنية، مصدر سابق، ص.148
[24] المصدر نفسه، الهامش، رقم 3، ص 154
[25] ألكسندر كويري، دراسات غاليلية، مصدر سابق، ص 393
[26] ألكسندر كويري، دراسات نيوتنية، مصدر سابق، ص.150
[27] المصدر نفسه، ص.151
[28] المصدر نفسه، ص.ص152-153