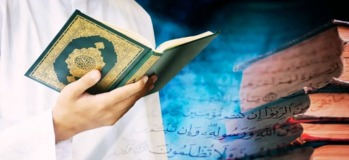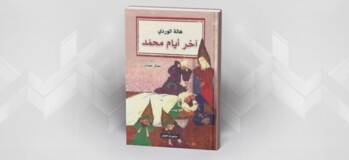قراءة في كتاب استراتيجيات التأويل
فئة : قراءات في كتب
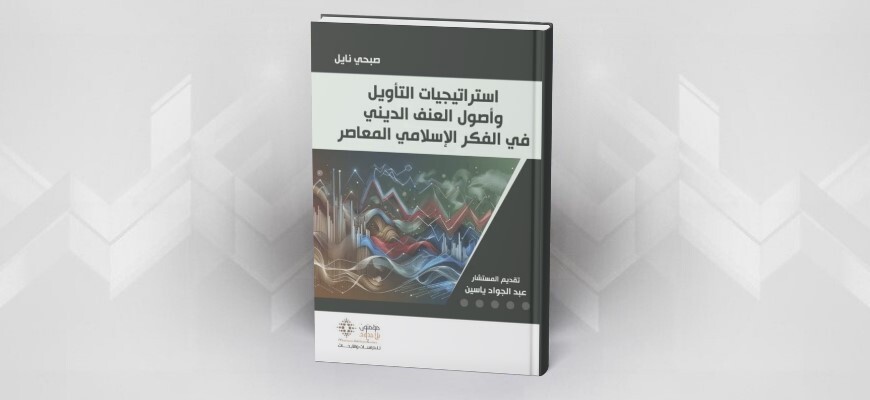
قراءة في كتاب استراتيجيات التأويل
مقدمة
يُقال إن العمل الدقيق يُلخِّصُ عنوانه ما يحتويه، وهذا ما نجده واضحًا أمامنا إذا نظرنا إلى الدراسة التي قدمها صبحي نايل، المعنونة بـ "استراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر". وهو عنوان شَمُلَ كلَّ ما احتواه الكتاب من مفاهيمَ إشكالية، عمل نايل على معالجتها بطريقة مختلفة، ليفتحَ بابًا قد أُغْلِق، ويُكْمِلَ مشروعًا ما يزالُ في طور النمو ولم يصل إلى بلوغ غايته بعدُ.
مشروعٌ ينطلقُ من الواقع لا من النص، يبدأ من الإنسان وينتهي إليه، غايته ما نزل النص أساسً لأجله؛ الإنسان، تلك هي طرائق التأويل/التفسير التي حَلَّلها نايل قديمًا وحديثًا، مستعرضًا كيف بدأت من الواقع والإنسان وانتهت إلى النص، وما الذي حدثَ حتى يُهمَّشَ الإنسان والواقع ويبدأ التأويل من النص وينتهي إليه، وكيف حاول المعاصرون ردَّ الاعتبار إلى الواقع والإنسان كما كان الأمرُ في أصوله. كلُّ تلك النقاط سوف أوضِحُها سريعًا في أثناء عرضي لأهم ما وردَ في هذه الدراسة مركزًا على مفهومي: التأويل والعنف.
التأويل
يرى نايل أن الهرمينوطيقا أو التأويل تُمَثِّلُ بوصفها مفهومًا، "اعترافًا بعدم جواز الفهم النهائي والصحيح للنصوص الدينية"([1]). وفي هذا إثباتٌ لما يُطالبُ به في دراسته، من أن عملية فهم النص مفتوحةٌ لا تنتهي، إلَّا بانتهاء المتلقي، أي الشخص الذي يفهمها، وهو الإنسان، الذي لا يفهم فهمًا مُجردًا معزولًا عن الواقع المادي، بل يفهم ما يتلقَّاهُ فهمًا واقعيًّا، بطريقة يكون فيه الواقع هو البناء الذي يبني عليه فهمه للنص.
وقد دلَّل نايل على ذلك بإشارته إلى دور الفتنة الكبرى الذي تَجَسَّدَ فيه دور الفهم أو التأويل الواقعي تَجَسُّدًا واضحًا، حينما حاولت كل فرقة الانتصار لنفسها عن طريق استخدام النص الديني، لتأييد نظامها السياسي أو طريقتها في الحكم، منقسمين فيما بينهم إلى شيعة عَلِيٍّ والخوارجُ وأنصارُ معاوية وأصحاب الشورى، "وقد وصلت مشكلة قراءة النصوص الدينية وتأويلها، إلى ذُروتها في سياق ميلاد الفرق السياسية وما عُرِفَ بـ (الفتنة)، إذ كانت كل فرقة تبحث عن مشروعية لها من داخل النص الديني. فأصبح الصراع مُتأجِّجًا على تأويل النص الديني وقراءته، وراح فريق ينادي بالمحافظة الشديدة والقاسية على سُنَّةِ الشيخين، وهم الخوارج، وفريقٌ آخرَ ينادي بالإمامة من آل بيت النبي، وهم أشياع عليٍّ، وفريق ثالث يرى في الخلافة مُلْكًا قيصريًّا، وهم معاوية وأصحابه، وآخرون يرون أن يكون الحكم شورى دون وضع حدود لهذه الشورى ولا نظام"([2]). مع ملاحظة أنهم جميعًا كانوا من صحابة رسول الله المُقرَّبين، ورغم ذلك اختلفوا في قراءة النص القرآني وتأويله بِناءً على ما حَدث في واقعهم السياسي، وهو ما يُريد نايل تأكيده من أن الواقع له الأولوية البنائية للمعنى على النص الذي ينطلقُ منه.
لذلك، نجدُ نايل يذكرُ الحادثة التاريخية الشهيرة التي عدَّها نقطة البداية الرمزية التي جعلت النص يخضعُ للواقع الحربي، إذ كانت العودة هنا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون، من الناحية التاريخية، تُعَدُّ أوَّل محاولة رسمية للسلطة للسطو على النص القرآني، في معركة صفين على يد معاوية بن أبي سفيان، عملًا بنصيحة عمرو بن العاص، عندما تراجع جيش معاوية أمام جيش عليٍّ؛ إذ اقترح عمرو بن العاص رفع المصاحف، ليحتكموا إليها، ورفعوها على أسنة الرماح، مما أحدث شقاقاً في جيش عليٍّ([3])، فالواقع الحربي كان سببًا أوَّليًّا للعودة إلى النص، وهنا يؤكدُ أن النصَّ لم يَخْلُقْ الواقع الحربي، ولم يُؤدِّ إليه، فالنص لُغويًّا ثابتٌ في ذاته، ونعود إليه مؤولين ومفسرين؛ استجابةً لما يحدثُ في الواقع من مشاكل، تُثْبِتُ أن الواقع له مركزية تماثلُ تمامًا مركزية النص.
وانطلاقًا من الواقع السياسي يطرحُ نايل السؤال الآتي: "إذا كان ثمة اتفاق على وجود معنىً محددًا وثابتًا للإسلام، تعرفه الفرقة الناجية وتملكهُ، فإن التساؤل عن هذا المعنى يفرض نفسه علينا. فما المعنى المُحدد والثابت للإسلام؟ وأي فرقة هي الناجية؟"([4]) موضِّحًا أن هذا السؤال يفترضُ وجود معنى ثابت داخل النص إذًا عُدنا إليه وجدناه مهما أختلف الزمان والمكان، فأيٌّ من الفرقتين -شيعة عليٍّ وأنصارُ معاوية- كانتا على الحق، هذا السؤال يُشيرُ أيضًا إلى أن عودة الفريقين إلى النص يفترضُ أن إحداهما كانتا على حقٍّ وأن موقفها السياسي إذا احتكمنا للنص وجوده يوافق الحقَّ الموجود في النص، ومن ثمَّ كانت هذه الفرقة هي الناجية، وكان موقفها السياسي هو الموقف الصائب؛ لأنه وافق المعنى الوارد في كتاب الله، لكن من يسأل هذا السؤال ما يزالُ النص يُمَثِّلُ مركزية في معاناه على الواقع، بطريقة تجعل الواقع يعود إليه ليحاكم نفسه بناءً على المعنى الموجود في النص، لكن نايل يرى أن النصَّ هنا -في الفتنة الكبرى- هو من عاد إلى الواقع، لتُعيدَ اللغة تأويل نفسها لتوافق مركزية الواقع السياسي وما فيه من معنى يجبُ على الآيات أن تتفاعل معه لتكتسبَ صلاحيةً جديدةً تضمنُ لها كما عبَّر نايل (البقاء والتأبيد).
وقد استقرَّ المعنى الموجود في الإسلام وقتها على أن الإسلام دين الوسطية، وأن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة لا الشيعة أو الخوارج أو غيرهم من الفرق الأخرى، لينتقل الصراع بعد ثبوت المعنى الحَقّ ومن يُوافقه ويُمَثِّلُهُ إلى ساحة المسلمين بعد ذلك حتى وقتنا الحالي، فتحاول كل جماعة نسبة تأويلها إلى المعنى الثابت الوسطي، ونسبة نفسها إلى أهل السنة والجماعة بوصفهم الفرقة الناجية، لذلك يُجيب نايل عن هذا السؤال بقوله: "أما عن المعنى المُحدد للإسلام فتم الاتفاق على أنه الوَسَطية، والفرقة الناجية هي "أهل السنة والجماعة"، لينتقل الصراع من صراع على معنى الإسلام إلى صراع على الوسطية وأهل السنة والجماعة. فكل فرقة تدَّعي أنها المُمثِّلُ للوسطية وتدَّعي أيضًا اتباعها منهج أهل السنة والجماعة. فقد يصحُّ القول إن هناك على مرِّ التاريخ إسلامين: إسلام سلطوي، يمتلك الحق في تأويل الإسلام الصحيح وتمثيله ويَلْقَى المُباركة من السلطة السياسية التي تتحدث من خلاله، والثاني يكون مناهضًا لخطاب السلطة، مُمثلًا تيارًا ثوريًّا رافضًا لإسلام السلطة، ويتحدث كل منهما باسم أهل السنة والجماعة. إلا أن الإسلام الذي تعرضه السلطة عادة يكون الرسمي، والآخر غير الرسمي، تكون له تفرعات عديدة تُكَفِّرُ كُلُّ واحدة الأخرى، وترى أنها الفرقة الناجية والبقية في النار، فلا يُمكن حصرهم في إسلامين فقط، بل أنماط عديدة لفهم الإسلام"([5]).
تلك الفترة التاريخية -أي الفتنة الكبرى وما تلاها من أحداث- كانت الفترة المؤسسة للمعنى وللفرقة المتماهية مع المعنى الحق الذي وجوده عندما عادوا إلى النص، ومن ثمَّ لاحظ نايل أن آراء هؤلاء الصحابة الذين كانوا في تلك الفترة وما تلاها أصبحت مُقَدَّسةً؛ إذ اكتسبت قداستها تلك من تماهيها مع النص المقدس ذاته، ليؤكد نايل بعد ذلك أن التقديس أصبح آليةً تستخدمها الجماعة المُهيمنة سياسيًّا لتثبيت شرعيتها ومحو الاختلافات التأويلية التي تعارضها، بوصفها تُخالفُ المعنى الحقيقي الذي جاء به النص وفهمه السابقون فهمًا نهائيًّا لا يجوز لأحدٍ من بعدهم إعادة فتح باب الفهم مرة أخرى، "وتُعَدُّ إحدى أهم آليات الاستحواذ: تقديسُ آراء السابقين والنظر إليها بوصفها هِبات مخصوصة أعطاها الله لهم –وليست آراءً بشرية نبعت من داخل السياق الجغرافي والاجتماعي والسياسي، ومن ثم تحمل الانحيازات البشرية الطبيعية– فجيل الصحابة والتابعين قد جاءوا بالمعرفة الدينية والدنيوية بصورة تامة – عملًا بمقولة: "إن الحقَّ يُعْرَفُ بالرجال"([6]).
ومن ثمَّ يُمكنُ فهم ما صار إليه تاريخنا الإسلامي من حالة ركودٍ عقليٍّ، بسبب استخدام السلطة السياسية آلية التقديس التي منعت إعمال العقل في النص، بل حصرت القدرات العقلية في علم الرجال وعلم السند وما شبهها من علوم، وظيفتها التأكد من عدالة الرواة وسلامة السند، لتستطيع السلطة اختيار ما يوافقها من بين الآراء المقدسة التي لا يُمكن رفضها إلَّا بالطعن في الطريق الذي جاءت منه الرواية التي تقول بهذا الرأي لا بالطعن في الرأي نفسه لأنه مُقدَّس. لذلك صارت أُمتنا أمة الحافظ لا الفاهم!
العنف
ذلك كان الجزء الأول من عنوان دراسته وقد وفَّاهُ نايل حقَّهُ، ليبدأ بعد ذلك بتحليل مفهوم العنف والكيفية التي ارتبط بها بالدين، مُحاولًا الإجابة عن السؤال الجوهري في هذه الدراسة: هل النص هو السببُ في العنفِ ليُنْسَبَ بعد ذلك إلى الدين؟ ذلك هو السؤال الذي ينطلقُ منه الباحث محاولًا فهمه قبل الإجابة عنه.
ليُقرَّ نايل بِناءً على ما تَقدَّم، أن النص ذاته أيًّا كان نوعه لا يحملُ داخله معنىً مُحددًا وثابتًا، بل إن المعنى يصنعه المتلقي متأثرًا بواقعه. مُدللًا على مركزية الواقع بما قاله أبو زيد من أن: "الواقع يُسهم بدور كبير في عملية إعادة قراءة النص وتأويله"([7]). مُستنتجًا أنَّ العنف لا يُمكن أن يكون نبتًا دينيًا يختصُّ بدين معين دون آخرَ، منتصرًا للواقع بوصفه الصانع الأول للعنف لا النص.
ولكن يظهرُ سؤالٌ آخرَ فور إجابة السؤال السابق: إذا كان الإنسان وواقعه هما مصدرا العنف لا النص، ما السبب الذي جعل المُتَلَقِّي يُعيد تأويل النص تأويلًا عنيفًا؟ والسبب في ذلك كما يرى نايل، أن الجماعات الإسلامية العنيفة -بوصفها تُمَثِّلُ الجانب الذي يتلقَّى النص- لا ترى هُويتها -الوسطية- تتجسَّدُ في الواقع المعاش الآن، فالمعنى النصِّي الثابت تاريخيًّا مع تبدل الظروف الواقعية التي نشأ فيها وأثرت فيه، صارت لا توافق الظروف الواقعية الحالية، لذلك ترغب تلك الجماعات في العودة إلى الماضي أو بمعنى أدق إرجاع التاريخ واستبداله بالواقع الحالي، ومن الطبيعي أن تلك العملية لا تحدث إلَّا باستخدام العنف، لتغيير الواقع حتى يُلائم تأويل النص المقدس، بعد أن وضَّحَ نايل أن النص هو من كان يلائم الواقع وما يحمله من معاني.
وتنتجُ عن تلك الرؤية الرجعية التي تزعم فيها الجماعات الإسلامية امتلاكها المعنى الحقيقي المُطلق؛ احتقار الذات الإسلامية للآخر الغربي تحديدًا؛ وذلك بسبب مفهومها عن امتلاكها الحق ومن ثمَّ يصيرُ كل ما عداها باطلًا، هذا الباطل -وهو الواقع والذات الغربية التي تُمثلهُ- يسعى في تشويه الذات الإسلامية التي تتماهي مع الحقيقة/النص. ومن هنا يرى نايل أن الجماعات الجهادية تستخدم النص ليكون أداةً تفرضُ به رؤيتها على الواقع عن طريق العُنف، وهم يفعلون ذلك متماهين مع الله، بل مع الرسول وأصحابه، تلك العملية من التماهي هي التي تُكسب رؤيتهم مشروعيتها([8]). ولاحظ نايل أن تماهي الجزئي مع الكلي أو المقيد مع المطلق يجعل بدوره تأويل المقيد مطلقًا بوصفه كلام الله أو الرسول؛ معنى ذلك أن تأويل الصحابة يُصبح مطلقًا، بسبب تماهيه مع المطلق المُتجسِّد في النص، وهو ما يعودُ بنا إلى الكيفية التي تكوَّنت بها آلية القداسة التي وصفها نايل سابقًا.
لذلك يؤكد نايل أن الجهاد المُسلح وما قامت به داعش من أعمال عنيفة، هي أفعال سياسية جعلت من النص مُنطلقًا لأفعالها، لكنها لا تُعَبِّرُ إلَّا عن رؤيتها الرافضة للواقع بسبب عدم قدرتها على التعايش فيه ولذلك تسعى في تغييره بالعنف أيًّا كانت أدواته يقول نايل: "فمهما أعلنت الجماعات انطلاقها من النص، لا يعني هذا أبدًا، أن النص هو العامل الرئيس والمحرك لها"([9]).
ويقفُ نايل عند قضية أخرى: وهي "خلق القرآن" بوصفها تُمَثِّلُ قضيةً رمزيةً تُشبه ما حدث عندما رُفعت المصاحف على اسنة الرماح في أحداث الفتنة الكبرى، فإذا كان القرآن مخلوقًا، فهذا يعني أنه نصٌّ يدخل في علاقة مع الواقع تُكَوِّنُ معناه باستمرار، وإن كان غير مخلوق، فهو يتجاوز الواقع، بل ويتجاوز العقل البشري ذاته الذي جاء في الأصل مُخاطبًا له، ومن ثمَّ يرى نايل أن الأشاعرة فرضوا رؤيتهم السياسية مع الخليفة المتوكل، قائلين بأن القرآن غير مخلوق، "وقد اختفت القراءات المختلفة مع الاتجاه الأشعري بآلية الفرض السياسي، عوضًا عما فعله الشافعي من محاولة التأسيس العقلي -تبعًا لمفهوم العقل حينها- للأصول، وحد ورسم الاجتهاد داخل سياق وسلطة النص وحده، مما أفضى إلى تغافل شبه تام عن أي محاولة فهم للنص، ضمن سياقه الثقافي والاجتماعي الذي جاء مُخاطبًا إياه، واتجاه الدراسات نحو طبيعة النص وتكويناته، مما يجعل النص في نطاق معزول عن الفاعلية التطبيقية داخل السياقات الاجتماعية"([10]). ويضربُ نايل مثالًا على ذلك بالتيار السلفي الذي حَصَرَ النص في ألاعيب اللغة، فكانت اللغة عندهم وفهمها مدخلًا لفهم النص القرآني مُهمشين بذلك الواقع([11]).
ويُكملُ نايل بِناءه المعرفي على ما سبق ويتجه في القسم الثاني من دراسته، ليُحلل الطريقة التي قرأ بها المعاصرون النص القرآني خصوصًا وفسَّروه بناءً على الواقع لا العكس، وسوف أعرض هنا لاثنين من أصل أربعة مفكرين إسلاميين انتقاهم نايل وهما: محمد أركون، ونصر حامد أبو زيد. ليكونوا نماذجَ تُعبِّرُ عن إستراتيجية التأويل التي تجعل الواقعَ مركزًا مؤسسًا للمعنى داخل النص القرآني، متجنبين بذلك استخدام العُنف، وذلك لأنهم يحاولون التماهي مع الواقع المُعاش، لا العكس كما تفعل الجماعات الإسلامية العنيفة التي ترفض الواقع بسبب أنها تتماهى مع ماضٍ مُقَدَّسٍ اندمجَ فيه النص بالواقع اندماجًا يُجسِّدُ الحقيقة الإلهية المطلقة.
تأويلية محمد أركون
وفي مقابل التيار السلفي، يعرض لنا نايل إستراتيجيات التيارات المعاصرة التأويلية في التعامل مع النص، ليخرجوا به من دائرة العنف الضيقة إلى محيط أوسع يشملُ مفاهيم إنسانية أخرى، ومن ثمَّ نجدهُ قد بدأ من إستراتيجية أركون الإنسانية التي جعل فيها النص القرآني نسخةً أرضيةً من كلام الله الأزلي، كي يجعل كُل التفاسير أو التأويلات التي تعاملت مع النصِّ إنسانيةً، نازعًا عنها صفة القداسة التي ألحقها بها السلفيون، يقول نايل مُعَبِّرًا عن منهج أركون: "يرى أركون الوحي نسخةً أرضيةً، ليتمكن من خلال هذا الطرح إلى أنسنة المنتج المعرفي حول الوحي، وإظهار البُعْدِ الإنساني في الوحي، وخضوعه للفهم الإنساني، الذي يُعطيه سِمَةً تأبيدية؛ إذ يكون الوحي نسخة أرضية من كلام الله، وليس كلام الله في ذاته؛ لأن كلام الله في ذاته غير قابل للحصر أو التأطير، وعليه يُعَدُّ الوحي الصورة المفهومة للإنسان من كلام الله"([12]). وبهذا المفهوم الجديد عن طبيعة النص بوصفه وحيًا، حافظَ أركون على النص؛ إذ جعله باقيًا إلى الأبد ما دام الإنسان موجودًا في هذه الأرض يتفاعل متأثرًا بالواقع مع النسخة الأرضية من كلام الله، مُعيدًا قراءتها بما يُلائم حاجاته وموافقًا لما يفرضه عليه الواقع.
كما يُفرِّقُ أركون بين شيئين هما: الدين والأيديولوجيا، فيرى أن الدين هو الإلهي الثابت المطلق، والأيديولوجيا هي الإنسان المتغير الجزئي، "وعلى ذلك يضع للدين معنيين: الأول، المعنى الرُوحي المُنَزَّه المُتعالي، والثاني، الرسمي والسلطوي الذي يخلع المشروعية على السلطات السياسية، وهو ما يصفه بالأيديولوجيا، إذ يكون الدين في هذه الناحية متأثرًا بالحاجات الاجتماعية، متناغمًا مع الحاجات السياسية"([13]). ومن ثمَّ يؤكد نايل أن تأويل أركون كان موافقًا لمركزية الواقع والإنسان في تكوين المعنى داخل النص، ما يُسب النص أبديتهُ.
تأويلية نصر حامد أبو زيد
ويعرض نايل لمنظور تأويلي آخرَ للنص، يجعلُ الحياة الإنسانية هي المركز الذي يستمدُّ النص منه معناه، فيجعل من لغة النص محاولةً دائمة وأبدية للاستيعاب الحياة بجميع تحولاتها، وعن طريق تلك الإستراتيجية يُمكن أن نستبعد التأويلات الأخرى السياسية الواحدية، فالحياة بما فيها من اختلاف وتعدد تمحو أي خطاب كُلياني يسعى في القبض على الحياة وحبسها داخل معنىً ضيق الأطر، "قَدَّمَ أبو زيد رؤية لتأويل القرآن بوصفه سعيًا في صياغة "معنى الحياة"، ومن ثمَّ فليس هناك طريق آخرَ غير بناء "تأويلية حية" مفتوحة تتميز بالاختلاف عن التأويلات "السلطوية" و"الكليانية"، ينطلق من حقيقة فحواها أن الحياة تتمثل في الاختلاف والتنوع النفعي، وما يُفضي إليه ذلك من اختلاف وتنوع في أنماط التفكير والاحتياج، فعلينا السعي في تأسيس تأويلية جديدة، تنطلق هذه التأويلية المفتوحة من حقيقة أن الاختلافات الإمبريقية في المعنى الديني جزءٌ من طبيعتنا الإنسانية القائمة على الاختلاف في معنى الحياة عمومًا"([14]).
وعن طريق آلية التدرج في تشريع الأحكام، ينتقدُ أبو زيدٍ الرؤية التي ترى تأويلات السلف للنص القرآني مُقدَّسةً، مُماهية بينه وبين المُطلق الإلهي، ومن ثمَّ يحرمون إعمال العقل فيه، فقد أظهرت الطريقة التي نزل بها القرآن عن طبيعته التفاعلية مع الواقع بوصفه مركزًا، لتكون تلك الآلية بالإضافة إلى ما رصده نايل من أحداث رمزية أخرى -مثل رفع المصاحف وخلق القرآن- علامات تدلُ على أهمية الواقع وجوهريته في عملية بِناء المعنى داخل النص، "يُقيم نصر أبو زيد نقداً للرؤية السائدة للنص القرآني، بوصفه مجاوزًا لإطار المفكر فيه، قابعًا داخل إطار المطلق والمستحيل التفكير فيه على التدرج في التشريع، فلم يكن التدرج في التشريع سوى أداة كشف عن الطبيعة التفاعلية للنص القرآني مع الواقع المعني بمخاطبته، ويدل على ذلك اقتران آيات التشريع -عادة- بلفظة "ويسألونك" وما تكشفه عن طبيعة الآية، كونها تُمثل ردًّا عن تساؤل وحاجة اجتماعية ملحة وما تكشفه أيضًا عن منهج النص في تغيير الواقع وعلاج عيوبه"([15]).
عبد الجواد ياسين
يبدأ ياسين تحليله من فحص بنية اللغة، ليؤكد ما أكَّدهُ نايل في دراسته، من أنَّ اللُغة التي كُتبَ بها النص، محدودةً،؛ لأنها لغةٌ -العربية- من ضمن لغات أخرى، ولأنها إقليمية، أي لهجة من العربية اختصت بها قبيلة -قريش- واختلفت بنطقها عن باقي القبائل، ومن ثمَّ كانت اللغة التي كُتِبَ بها النص مشروطةً وجزئيةً، وتلك طبيعةٌ تُخالف طبيعة الوحي الإلهي أو كلام الله المُطلق والكُلِّي، لذلك يرى ياسين، "أن اللغة محدودة وإقليمية (أي أنها نسبية)، والنص الشرعي كما أعلن عن نفسه؛ فهو كوني مطلق، وعليه فهي قاصرة عن الإحاطة بالنص الشرعي. ولا بُدَّ من آلية تعاملية أخرى مكافئة لطابع النص الكوني، وهي "مبادئ العقل وحركة النشاط الداخلي" وهي ليست بناءً لغوياً، وإنما هي سمة إنسانية خلقها الله في الإنسان"([16])، لذلك اقترح العودة إلى آلية أخرى تكون أعم وأشمل للتعامل مع النص القرآني، وهي: مبادئ العقل الإنساني، أو باستخدام تعبير ديكارت: العقلُ الذي هو أعْدَلُ الأشياء قِسْمَةً بين البشر.
ولذلك، شدَّدَ ياسين أن اللغة وسيلة أو أداة، أمَّا الإنسان العاقل، فهو المخاطبُ بالوحي، واللغة كانت أحد أدوات الاجتماع البشري في إيصاله، ومن ثمَّ ألْحَقَ ياسين اللغة ببقية الأدوات والوسائل التي نتجت عن الاجتماع البشري، ومنها التأويلات الإنسانية الأخرى التي كُتِبَت عن النص، واصفًا إياها بأنها صورةٌ من صور التدين، "إن الإنسان هو الذات التي تتلقى الدين وتمارسه... من هنا لا سبيل إلى إدراك الدين والتعبير عنه إلا عبر وسائل الاجتماع البشرية وفي مقدمتها اللغة... (فالنص) يُمَثِّلُ نقطة الالتقاء بين الدين والاجتماع التي يُمكن إدراكها ماديًّا، أحد مقومات التدين، ويمتدُّ التدين ليتضمن الرؤى والمفاهيم التي قُدِّمَت حول النص، وأصبحت تقدم نفسها بوصفها مكونات الدين في ذاته... النص هنا ليس هو الدين في ذاته، بل إحدى آليات الدين التي يتفاعل من خلالها مع الاجتماع"([17]).
لأن ياسين مَيَّزَ بين الدين في ذاته: وهو كلام الله الأزلي. والتدين: وهو تأويلات البشر لكلام الله وتفاعلهم معه متأثرين بما يُحيط بهم من ظروف اجتماعية، "ما هو مطلقٌ وثابتٌ: (الله والأخلاق الكُلية) وهو ما يُمكن وصفه بأنه "الدين في ذاته"، وما هو اجتماعي (الشِّقُّ التطبيقي للأخلاق الكلية) نسبي متغير، والتشريع عند ياسين عاجز عن الخروج من الدائرة البشرية الاجتماعية الذي يتعاطى مع الواقع المتغير، ولا يُمكن بطبيعته أن يحمل الصفة الإطلاقية، ومن ثمَّ فإن وروده في النص لا يعني أبدًا أنه مطلق، بل يقع ضمن دائرة التدين"([18]). وبناءً على ما سبق، نراهُ يضم آيات التشريع إلى دائرة التدين، نافيًا عنه صفة الإطلاقية، مؤكدًّا أن وجود آيات التشريع في النص لا يمنحها ما للدين من إطلاقية وقداسة.
لذلك، يستخدمُ ياسين التشريع، ليُدلِّلُ على الديناميكية التفاعلية للنص مع الواقع، فالتشريعُ القرآني لم يَنْزل ثابتًا ومتوافقًا مرةً واحدةً، بل نزل استجابة للواقع الإنساني المتحرك والمتناقض، فجاء موافقًا له حينها، وذلك هو جوهر أطروحته عن الفرق بين الدين والتدين، فحضور الواقع الاجتماعي بوصفه مركزًا أساسيًّا يتفاعل مع اللغة التي نزل بها النص تلك العملية وصفها ياسين بالتدين في مقابل الدين الذي لا يُمكن للقدرات العقلية البشرية الإحاطة به كُليَّةً، "فالنص جاء متحاوراً مع الواقع بشكل آني ومتجدد، وخير دليل على ذلك المرونة الكافية التي يتسم بها الجزء التشريعي؛ فقد جاء متحركاً ومتناقضاً -في بعض الأحيان- بتحرك وتناقض الاجتماع الإنساني يعكس حركة الواقع الاجتماعي وطبيعته. وهذا ما دفعه لطرح رؤيته حول الدين والتدين، ويعلن حضور الاجتماع داخل بنية النص القرآني"([19])
ويفتحُ لنا ياسين استراتيجية تأويلية جديدة نفهم بها ما فعله الفقهاء والسلف -الذين عملوا لتقديم أنفسهم بوصفهم أهل السنة والجماعة والذين فهموا المعنى الوسطي الحق الذي جاء به النص- باستخدامهم آليات مثل: أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، والأحاديث النبوية، فباستعمالهم لأسباب النزول أدخل الفقهاء الواقع الاجتماعي وقتها في بينة النص، أو بمصطلحات ياسين: أدخلوا التدين في الدين، ليمنحوا هذا الواقع الاجتماعي قُدُسِيَّةً مُطلقة تُماثل الدين، كي يوقفوه زمنيًّا، وعن طريق النسخ رفعَ الفقهاء التناقض التشريعي الذي يلاحظُهُ المتلقي عند الجمع بين بعض آيات القرآن، وعن طريق السُّنَّةِ أكملوا الفراغات التي كانت تنقص تأويلاتهم الثابتة للنص المتغير، فالسُّنَّةُ جاءت لتثبيت قراءتهم السياسية للنص وسد الفجوات التي يُمكن للعقل الإنساني أن يَنْشطَ داخلها، ليخلقَ تأويلًا جديدًا خاصًّا به، "فأسباب النزول والنسخ هما بمنزلة الباب الخلفي الذي حاول أن يضع منه العقل السلفي/الأصولي الاجتماع الإنساني ضمن بنية النص، كونه جاء مخاطبًا لهذا الاجتماع مَعْنيًّا بظروفه ومُتعاطيًا مع تساؤلاته واحتياجاته... ويرى أن وضع السنة لتكون مُكَمِّلًا تشريعيًّا للقرآن، واعتمادها مصدرًا نصيًّا جديدًا، وأحد أدوات استكمال النص بأثر رجعي؛ جاءت لسَدِّ حاجات (سياسية، ولاهوتية، وتشريعية) كانت تريد أن تضع نفسها ضمن الإطار الديني"([20]).
علي مبروك
ينطلقُ مبروك كذلك من تحليله للغة التي نزل بها الكلام الإلهي، ليؤكد ما أشار إليه المؤولون المعاصرون، من أن اللغة التي كُتِبَ بها النص القرآني عمومًا، واللهجة القُرَشيَّةُ خصوصًا، كانت أحد العلامات الرمزية للانتصار السياسي القَبَلِي، ليعود مبروك إلى الأصول اللغوية الأولى بوصفها حدثًا سياسيًّا قبل الأحداث السياسية الأخرى -التي ذكرها نايل: حمل المصاحف على أسنة الرماح- ليؤكد دخول الواقع السياسي في علاقة الإنسان بالنص مؤثرًا في تأويليه، منذ نشأة النص القرآني نفسه وتَكَوُّنِهِ في جزيرة العرب على لسان قُريش، "يَتَّفِقُ علي مبروك مع أبي زيد وأركون وياسين على أن التاريخ الإسلامي يُفضي بأن القرآن قبل أن يكون موضوعًا لفعل معرفي كان موضوعًا لفعل سياسي، وذلك حين تم الانتقال -في القرآن- من لغات القبائل العديدة، والتي تَمَثَّلَت في لغة المسلمين، إلى لغة قريش وحدها، وما يُوحي إليه ذلك، بانتصار قريش السياسي وغياب أي نِدِّيَّة سياسية لها، لأن لغة القرآن أصبحت لغتها، ومن ثم أضحى الاختلاف معها اختلافًا مع القرآن".([21])
كما انتبه مبروك إلى شيءٍ آخرَ مُهمٍ، وهو هيمنة الإستراتيجية الأشعرية التأويلية على العقل الإسلامي، فقد سَلَبَت الإنسان القدرة على الفعل ومن ثمَّ القدرة على التأويل، عن طريق استخدامها نظرية الكَسْب، لتجعل الإنسان خاضعًا لإستراتيجيتها التأويلية التي تصفها الأشعرية بأنها مُطلقة ومقدَّسَةٌ لتماهيها مع مُراد النص الإلهي، "وفق رؤية مبروك، فإن نمط الفكر السائد في العقل العربي/الإسلامي المعاصر والتاريخي، هو النمط الأشعري الذي يُعَدُّ أساسه الهيكلي الذي يقوم عليه؛ مطلق الإرادة والقدرة لله وسلبها من الإنسان"([22])
وحتى نتخلَّص من كل تلك الرواسب السياسية ونُحرر النصَّ من التأويلات الجامدة والنهائية، يتقدَّمُ مبروك بإستراتيجية تأويلية تُنادي بعودة القرآن بوصفه نصًّا حيًّا، يكون الإنسان والواقع الحالي مركزهُ، ومن ثمَّ يسعى مبروك نحو المصلحة الإنسانية التي جاء النص ليُحققها، لذلك يقول إن "عودة القرآن الحي الذي تُمَثِّلُ فيه الشريعة إطارًا قيميًا كُلّيًا لا يقتصر على ما هو أخلاقي فحسب، وإنما يتسعُ لمفهوم المصلحة الإنسانية بوصفها مبدأ عامًّا، ووضع مفهوم المصلحة الإنسانية يُعيد الإنسان في المعادلة الدينية، ومن ثمَّ يجعل النص أقل جمودًا وأكثر مرونة وقابلية للتطبيق الواقعي"([23]). بتلك الطريقة يتخلَّصُ النص مما لحق به من تأويلات ماضوية تماهت معه، وجعلته يصطدمُ بالواقع اصطدامًا يتعارضُ معه، ليحاول الذين يتبنون تلك التأويلات تغييره باستخدام أدوات العُنف، ليجبروا بها الإنسان والواقع على أن يكونوا طبقَ تأويلاتهم للنص، وهم بذلك يجعلون تأويلاتهم هي المركز الذي يدور حوله: كلام الله/النص، والإنسان، والواقع الاجتماعي!
خاتمة
في ختام مراجعتي لهذه الدراسة، أذكرُ بعض الملاحظات التي يُمكن للباحث أن يبدأ منها، مُستكملًا ما قدَّمهُ نايل:
1- عرض نايل أربعة نماذج لإستراتيجيات تأويلية للنص بأنواعه بعامة والقرآني بخاصة، انتجت مفاهيمَ أكثر توافقًا مع الواقع في عصرهم -أو على الأقل كانوا يحاولون التوافق مع الواقع- ولا يرفضونه محاولين تغييرة باستخدام أدوات العنف مثلما تفعُل تأويلات الجماعات الإسلامية الأخرى.
2- لم تدَّعِ تلك التأويلات التي قدمها كلٌّ من: أركون وأبو زيد وعبد الجواد ياسين وعلي مبروك. أنها وصلت إلى المعنى النهائي والحقيقي للنص القرآني، مُخالفة بذلك ما ادَّعته الجماعات الإسلامية الأخرى، وبوصف أنفسهم بأنهم أهل السنة والجماعة التي تُمثل الجوهر الوسطي الحقيقي للإسلام، والسبب في ذلك هو المنهج أو الطريقة أو الإستراتيجية التأويلية التي تعاملوا بها مع النص، المُختلفةُ في منطلقاتها عما تنطلقُ منه الجماعات الإسلامية العنيفة الأخرى.
3- تَهدِفُ كلٌّ من تأويليات أركون وزيد وياسين ومبروك، أن تصل إلى نصٍّ ملائم للواقع الحالي، بل ويلائم كل زمان ومكان فعلًا، ما يُكسبه أبديتهُ التي أرادها له الله، لذلك لم يرفضوا الآخرَ ولم يحتقروه كما تفعل الجماعات الأخرى، زاعمةً أنها تمتلك الحقيقة وكل ما عداهم على باطلٍ، بل ولا يكتفون ببقائهم على باطلهم، وإنما يسعون في إضلال أهل الحق، لذلك استخدموا العنف لإجبار الآخرَ وتغيير الواقع. أمَّا الاستراتيجيات التأويلية الأخرى التي عرضها نايل، فلم تفعل ذلك؛ لأنها رأت في الآخر امتلاكه صورة من الحقيقة، وباستخدام مصطلحاتهم، الآخرُ عندهم عنده تأويل مختلف للحياة عمومًا، ومن ثمَّ حاولوا إنتاج استراتيجيات تأويلية أكثر احتواءً لمختلف التأويلات التي الواقعية.
4- يجبُ على كل باحث في الفكر الإسلامي المعاصر أن يُكمل مشروع التأويلات التي تُعيدُ إلى الواقع مركزيته بجانب النص، وهو ما أتمنى أنْ أراهُ في السنوات القادمة، بطريقة تؤسس مدرسة واقعية في قراءة النصوص التراثية، ليصيرَ الواقع هو الأساس الذي يحاول النص استيعابه لا العكس. وبتلك الطريقة يُمكن للمسلمين المحافظة على صلاحية نصهم لكل زمان ومكان.
([1]) صبحي نايل، إستراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، مؤمنون بلا حدود، لبنان – بيروت، الطبعة الأولى، 2024، ص 37
([3]) صبحي نايل، استراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 65
([5]) صبحي نايل، استراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 123
([7]) صبحي نايل، استراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 134
([10]) صبحي نايل، اإستراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 152
([12]) صبحي نايل، استراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 167
([16]) صبحي نايل، استراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 238
([17]) صبحي نايل، إستراتيجيات التأويل وأصول العنف الديني في الفكر الإسلامي المعاصر، ص 247