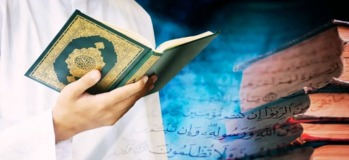مقالة في القص الإبراهيمي
فئة : مقالات

مقالة في القص الإبراهيمي
في حلقة من برنامج "أسئلة صعبة" الذي يذاع على قناة سكاي نيوز عربية كان ضيف الحلقة الدكتور "فاضل الربيعي" يناظر عن أطروحته في قراءة التراث العبراني، تحاوره بذكاء مذيعة مثقفة، ملمة بموضوع المناقشة عكسًا لكثير من العاملين بالإعلام في وطننا العربي.
كان موضوع الحلقة يدور حول الوجود المكاني الحقيقي لمدينة أورشليم التاريخية، ورغما عن ذكاء المذيعة فإن الأسئلة الأشد صعوبة لم تطرح في اللقاء؛ فالباحث يرى أن أحداث التوراة والممالك العبرانية، لم تحدث في أرض فلسطين، وإنما جرت الوقائع خاصتها في اليمن، وما بقايا الهياكل والمعابد والصروح الموجودة هناك إن هي إلا آثار توراتية. من تشابه الأسماء فقط مع النص التوراتي ينطلق الباحث في تأكيد وجهة نظره.
وهي وجهة نظر، وإن كان ظاهرها نفي الاستحقاق الصهيوني المزعوم في أرض فلسطين، فإنها تؤكد بداهة على وجود حق جغرافي في مكان معلوم أيًّا ما كانت هذه المساحة الجغرافية، ما يدعم المخيال العبراني المشبع بالأساطير، والذي يتعامل مع هذه الأساطير بحرفية شديدة كاستحقاق تاريخي غير قابل للمساس، ما يعني أيضا عدم نفي السردية التوراتية من الأساس، واستبدالها فقط بأرض ميعاد أخرى، في عملية إزاحة ليس إلا.
هنا مكمن الخطورة؛ لأن الأسئلة الأشد صعوبة في هذا المضمار، هي أنه إذا كانت التوراة تتحدث عن ممالك وجيوش وصروح وقصور وهياكل ممرجة فما الذي ثبت منها تاريخيا؟ وهل القص التوراتي والسرد الإبراهيمي عمومًا، إن شئنا الدقة هو قص يثبت وقائع تاريخية حقيقية؟ أم هو قص يحلق في أفق المجاز السردي والبلاغي؟
وإذا كانت اللقي الأثرية، والمدونات التاريخية هي وحدها من يعول عليها في الإجابة الحاسمة عن هذا السؤال، فإنه وللآن لا دلالة أثرية، ولا أركيولوجية، ولا حولية دعمت إحداثيات القص الإبراهيمي، وبشكل حاسم لا يقبل الجدل.
هذه السرديات القصصية بدلا من التعامل معها على أنها قص مجازي رمزي أخلاقي بحت، صارت توظف وتتخذ متكأ كحق ووعد إلهي بأرض الميعاد، ما أجج صراعا داخل الخيمة الإبراهيمية نفسها بشقيها التوراتي والقرآني. الخيمة التي تتناص فيها كثيرًا من أدبيات القص مع فروقات غير جوهرية في المتن؛ إذ تدور التفاصيل دائما حول جماعة معاندة لا تستجيب ميتافيزيقيًّا، وتمر بمراحل اختبار وامتحان لتأتي النهاية التطهرية بالتدخل الإلهي الحاسم ضد أعدائه المعاندين، بينما يفوز فريق المؤمنين بالمكافآت الدنيوية والأخروية.
والقصص الواردة عموما - رغما عن اختلاف الأحداث كسرد حكائي- إلا أن الآليات السردية الأدبية متشابهة (بداية محنة/ وسط اختباري/ نهاية تطهرية) ما يعني استنساخ نفس المآلات والمصائر، والمخرجات.
هذا المتن الحكائي القابع في بؤرة التوراتي والقرآني يضعنا أمام خيارين وبكل وضوح:
أولهما: هو الإيمان بشكل حرفي بوقائع المتن الحكائي للنصوص المقدسة -التي لا دليل تاريخي على حدوثها- وهذا الخيار يضعنا في مآزق منها الصدام المباشر مع الحقائق العلمية التاريخية وغير التاريخية، نظرا إلى البنية الأسطورية المشكلة للنص، والتي بني عليها.
ثانيهما: أن يتم تأويل القص القرآني/التوراتي على أنه "أحسن القصص" وكقص مضروب من أجل العظة والاعتبار وفرض المدونات الأخلاقية والسلوكية، وليس تقرير حقائق تاريخية.
اختيار الفرض الثاني، يجعلنا ندوزن عدة مفاهيم تأسيسية لابد منها:
أولها: أن الأديان وبشكل عام هي تمظهرات للمعنى الإلهي عبر جماعة بشرية، لا نستطيع القول بشكل حاسم إنها تمظهرات لعين الذات الإلهية المتأبية على معرفة كنهها الطبيعي والحقيقي بشكل واضح، وما الخلافات على أرثوذكسية دينية واحدة وطبيعة وصفات الإله؛ ما هي إلا خلافات دالة على تعدد تمظهرات الذات الإلهية عبر التاريخ، وعبر الجماعات والحضارات البشرية، التي لا يمكن فهم طبيعة رسالاتها أو إشاراتها إلا عبر التأويل، وإزاحة المعاني الظاهرية للنصوص المقدسة بشكل حرفي، لإنتاج دلالات خاضعة لراهنية الدين المعاصرة وحركة التاريخ.
عند هذه النقطة الفاصلة تتحرر ثنائية الإلهي والأرضي (الناسوت واللاهوت).
وتغدو كل النصوص المقدسة نصوصًا تاريخانية، مرتبطة بسياق المجتمعات البشرية التي نشأت فيها، ما يحرر النص من عبء التحليق الأسطوري والميتافزيقي الملازم للفكر الديني عموما.
ثانيا: "وكفهم عام لميكانيزم القص الذي استخدمته كل الأديان في سبيلها لفرض مدوناتها السلوكية والأخلاقية" لابد من الإقرار بضرورة استخدام هذا المكون، (القص/الحكاية/ الحدوثة) الذي يستخدمه السارد كآلية لفرض العظات والنصائح الإرشادية الثاوية في تضاعيف النص. هذا هو الهدف من استخدام السرد القصصي. من هنا تأتي عمليات فهم الإزاحة بين القص المتلامس مع الميتافيزيقا المتعالية وبين الواقع التاريخي، وهي ظاهرة إن شئنا الدقة موجودة في كل النصوص، سواء النصوص المقدسة، أو النصوص الملحمية أو الأدبية التي تمجد الأبطال، والقبائل، والشعوب، ومعناه مفارقة الحدث بإحداثياته الفعلية والحرفية ليحلق في سماء المجاز فارضًا نفسه كمكون أخلاقي في فضاء النص الديني، أو مكون قومي في سياق الحديث عن ملاحم الشعوب، والأقوام، والإثنيات العرقية، أو ممجدا من شخصيات تاريخية ضافيا عليها صفات البطولة المتأبية حتى على قدرات الذات البشرية نفسها، لتتسرب عناصر هذه البطولة للسير والملاحم بفضل سطوة المجاز والأساطير عبر الحكاية.
الأمر الثالث: وهو خاص بآليات القص التوحيدي الإبراهيمي، بشقيه التوراة/ القرآن، من حيث بداية الخلق، والطوفان، والتكريس البطريركي للأنبياء المؤسسين، وغيرها من آليات ينبغي فهم مجموعة من المفاتيح الكاشفة الأولية لسبر أغوار النص من أجل الفهم والإبانة لتوليد دلالات ومعطيات جديدة؛ ومنها أن القص الإبراهيمي لا يخرج عن نطاق أمرين:
الأول: تأتي فيه الحكاية معلقة في فراغ زمني وجغرافي بحت لا يمكن أبدا معرفة تاريخية حدوثه لا مكانيا ولا زمانيا، ما يضعنا في شبه استحالة أثرية وتحقيبية في إثبات تلك الأحداث، مثل قصة الخلق وقصة الطوفان، والحديث عن تدمير قرى ومدن بسبب الخطيئة، ما يعني فرضا أن هذه المدن مطمورة والوصول إليها أثريا بالإمكان، ومع ذلك لا دلائل تشير إلى شيء في هذا السياق. هذه القصص المعلقة في هذا الفراغ الجغرافي والتاريخي، لا تحتاج مجهودا في إثبات رمزيتها ومجازيتها، فضلا عن أن كثيرًا من هذه السير والملاحم تم تداولها كأساطير لحضارات الشرق القديمة المتعاقبة، وكما ورد في الاكتشافات الأثرية الحديثة والمعاصرة، مثل قصة الطوفان التي يمكن اعتبارها ملحمة عالمية لشعوب الشرق الأوسط والأدنى القديمة كلها، وهو ما سنتناوله بالشرح في مقالات قادمة.
الثاني: هو قص معلق في شبه فراغ جغرافي وتاريخي؛ بمعنى أن النص يتحدث عن ملوك وأحداث تاريخية تتقاطع وقائعها مع الأمم والحضارات الأخرى، سواء المصرية أو البابلية أو الأشورية، وهي حضارات كانت موجودة بالفعل، ومع ذلك ورغمًا عن شبه الفرض هذا، فإن الحقبة الزمنية غير محددة بشكل واضح ويقيني، وكذا المساحة الجغرافية التي وقعت فيها هذه الأحداث غير محددة بدقة، والتي تتحدث عنها النصوص التوراتية والقرآنية كممالك شاسعة بمشاريع شديدة الضخامة، وتوسعات وحروب أهلية، وحروب مع الأمم المجاورة لا يوجد ما يدعمها أركيولوجيا ولا تاريخيا ولا أثريا، ما يحيلنا أيضا إلى تشفيرها كقص رمزي اعتباري.
*مملكة سليمان نموذجا
وإذا كانت القصة المعلقة تماما في الفراغ الزمني والجغرافي لا تحتاج إلى مجهود تأويلي واضح من أجل بيان رمزيتها، فإن بعض القصص شبه المعلقة تحتاج إلى مجهود، لوضعها في إطارها الطبيعي التاريخي، وأيضا لتفكيكها واستجلاء كوامنها ومراميها.
من هذه القصص -وعلى سبيل المثال لا الحصر -قصة النبي/الملك داود وابنه الملك سليمان، القصة الموجودة والمتمددة عبر الفضاء التوراتي والقرآني، والتي تتحدث عن هائلية المملكة السليمانية التي أسسها الملك النبي داود، وورثها سليمان، وهي بالمناسبة ذريعة تتكئ عليها المنظمات الصهيونية العالمية في الاستناد إلى حق تاريخي في أرض فلسطين، بوصفهم الورثة الطبيعيين لهذه المملكة.
هذا الامتداد لهذه المملكة عبر النص التوراتي/ القرآني يشير بداهة في حال التسليم به إلى هذا الحق، -وهو ما يغفل عنه الكثير من الباحثين المسلمين- أما في حال وضع (القصة/الحكاية) في وضعها الطبيعي الرمزي والأخلاقي المجازي ومناقشتها عبر المحكات التاريخية والأثرية الحقيقية يقلص مساحات هائلة من هذا الاستحقاق، كما ينزع الصفة الأسطورية المضفورة فيها.
في هذا السياق تحديدا -قصة المملكة السليمانية- تحررنا الحفائر وطبقات التحقيب التاريخي من عبء القراءة الحرفية؛ لأنها تشير بوضوح إلى أن مملكة إسرائيل التاريخية هي مثال صارخ على توظيف الأساطير، والمخيال الديني الرعوي في الضغط قسرًا على حركة التاريخ المعاصر، وأنه لم يثبت تاريخيا وجود مملكة من النهر إلى البحر، عكسا لطوفان اللقي التاريخية للحضارات القديمة، سواء الصغيرة أو الكبيرة، ما يجعلنا أمام سردية خيالية أسطورية في غالب بنيتها، فبينما يرجح كثير من الباحثين الغربيين عدم وجود تاريخي أصلا، ومن البدء لشخصيات مملكة إسرائيل مثل داود وسليمان ورحبعام وغيرهم، مستندين إلى هذا الفراغ التاريخي الذي لم يعثر على ما يدعمه، ما يجعل وجهة النظر هذه مقبولة، ولها وجاهتها من الناحية العلمية.
وثمة أطروحات أكاديمية أخرى تقر بوجود هذه الشخصيات وهذه المملكة، وحتى مع إقرار هذه الأطروحات بالوجود التاريخي، فإن أقصى ما استطاعت إثباته -حتى لا تفقد وجاهتها العلمية- هو الحديث عن صور بدائية للحكم ومحاولات لصنع دولة مركزية على مساحة محدودة شديدة الصغر زمانيا ومكانيا مجاورة للحضارات القديمة وللأمم الآخر التي كانت لها شراكة في هذه الأرض، وحتى أيضا مع التسليم بهذا الفرضية التي تثبت الوجود التاريخي هذا، فإن هذا الطرح المثبت يحمل سمات مفارقة للنص التوراتي والقرآني، ويضع المروية في حجمها الطبيعي؛ المروية التي تتحدث عن القبائل العبرانية كمجموعات بدوية بدائية انتهجت العمل الرعوي، وليس الاستيطان الزراعي على مرتفعات الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وعاشت فيما يشبه كونفدرالية بدائية لإثنية عرقية تتألف من اثنتي عشرة قبيلة يحكم كل قبيلة قاضٍ بلا قانون موحد، أو هيكلية مركزية لدولة أو شبه دولة، كما القبائل الأخرى المتشاركة معها في الأرض الكنعانية والفلستية وغيرها.
استغلت القبائل العبرانية عدم وجود حكومة ودولة مركزية في ارتكاب جرائم القتل والاغتصاب والسرقة، سواء داخل تجماعاتهم، أو تجمعات القبائل المجاورة لهم.
تحت وطأة الانفلات هذا، أصبح الوجود العبراني في الساحل المتوسطي مهددًا، ما أجبر قضاة القبائل العبرانية على التفكير في اختيار ملك قبلي عشائري يوحدهم، فكان طالوت (شاؤول) الذي وقع عليه الاختيار طواعية، بعد مداولات في شرعية إقامة ملك أصلا أو لا.
زحفت هذه القبائل بعد ذلك، في محاولة توسيع رقعتها نحو مملكة اليبوسين المحلية المجاورة والمتمترسة في "أور سالم" المدينة التي عرفت لاحقا بأورشليم والقدس، والتي سترتفع في عموم المخيال الديني الإبراهيمي كفردوس أرضي دائم الفقد، سواء لليهود أو المسلمين أو المسيحيين.
في المواجهات والصدامات المسلحة مع اليبوسين، ظهر قائد شاب أظهر مهارة حربية وقتالية في المعارك ما أهله لاحقا للانقلاب على شاؤول وانتزاع الملك منه، ودفعه ذلك لاحقا لتوسيع دويلته نسبيا قي الساحل المتوسطى وفي اتجاه الشمال، وبشكل حذر حتى لا يثير حفيظة الأمم المجاورة ذات التراتبية العسكرية شديدة الصرامة والبأس، وحتى لا يلفت إليه الأنظار.
بعد رحيل داود ورث ابنه سليمان مقاليد الحكم، وورث أيضا صفات أبيه الشخصية في الشدة والبأس والتحرر من سلطة القضاة ورجال الدين، وزاد على ذلك وعيا وطموحا، في استنساخ الصروح والنصب والمجسمات كما تفعل الأمم المجاورة، ما جعله يفرض ضرائب باهظة وشديدة القسوة على قبيلته، من أجل إتمام هذه المشاريع التي لم تكتمل لمحدودية موارد الدولة ومحدودية مساحتها أيضا، هذه التماثيل والصروح لم يستطع المخيال الرعوي البدائي تفسيرها سوى أنها من صنع قوى ميتافيزيقية خارقة للطبيعة (الجن)، رغم أن عشرات الصروح والهياكل والمعابد التي لا سبيل إلى مقارنة ضخامتها في الأمم المجاورة بهذه، والتي كانت تقام بكل أريحية، وبلا حديث عن خروقات ميتافيزيقية.
وحتى البناء الذي أقامه سليمان "الهيكل" -لا دليل قاطع حتى الآن على إثبات وجوده أو مكانه يقينا- ومع ذلك، فإنه حسب هذه السردية المثبتة للحكاية، والتي تتحدث عن بناء صغير جدًّا -مقارنة بالمعابد الفرعونية والآشورية والبابلية- بناء لا يتجاوز ثلاثمائة متر مربع لبيت متعدد الآلهة تمارس فيه كل طوائف المدينة الناشئة طقوسها العبادية.
فسليمان وعكس أبيه، توسع في استخدم المكون الديني الإثني لمملكته، كما صاهر قبائل الوثنيين، ومرر إقامة معبد موحد لكافة الأديان، وليس "ليهوه" رب العبرانيين فقط، وعلل ذلك برفض يهوه نفسه إنشاء بيت خاص له بعد سفك كل هذه الدماء من أجل إقامة حكم ومملكة، وهي وسيلة برجماتية اتخذها سليمان متكأ لإنشاء دار عبادة متعددة الآلهة، وأيضا وسيلة سياسية لتجنب الصدامات مع الممالك المجاورة فترة حكمه؛ وذلك عبر السماح لعبادة آلهتهم ضمن طقوس الهيكل الدينية.
برحيل سليمان وتولي ابنه رحبعام مقاليد الحكم، انقسمت الدويلة في عهده إلى إقليمين متصارعين في الشمال والجنوب؛ ما استدعى لفت الأنظار إليها من قبل الحضارات الكبرى المجاورة نظرًا إلى وقوعها في ممراتها الحيوية. لذلك وجهت إليها ضربات عنيفة خاطفة انتهت بتدميرها بالكامل، وسبي كامل لشعبها في ما عرف بالسبي البابلي...
هذا السبي الذي خلق فيه المخيال العبراني المتضخم فيما بعد كل مفردات وأدبيات الحكايات التوراتية -والتي أيضا استخدمها السرد القرآني بتحويرات خفيفة لاحقا- ومنها مملكة سليمان التي خلق منها مملكة عظيمة متسعة الأركان تسيطر على العالم شرقا وغربا، متناسيا أنه لو كانت بهذا الاتساع وتلك المساحة والقوة والعدد البشري، ما كانت دمرت بهذا الشكل، وأنها لم تكن - في أحسن الفروض الداعمة لوجودها من الأساس- سوى مشروع لدويلة محدودة المساحة والزمن، شاء حظها أن تقع في طريق الحضارات الكبرى التي أجهزت عليها بيسر، والتي حاولت استنساخ تجاربها، فلم يسعفها لا الوقت ولا الإمكانيات اللوجستية والمادية لفعل ذلك.
المآلات
هذا نموذج دال لتفكيك حالة واحدة، حُرر فيها النص من عبء التحليق الأسطوري، حيث تكمن أهمية التفكيك هنا، وبشكل عام في فض حالة الاشتباك بين الأديان الإبراهيمية الكبيرة المتنازعة دوما، والساعية كلا منها إلى فرض رؤاها الميتافيزيقية بوصفها حقيقة مطلقة، وأيضا هو مهم لفض حالات الاشتباك داخل الخيمات الدينية الصغرى؛ أي مع أبناء الدين الواحد نفسه، سواء كان يهوديا أم مسيحيا أم إسلاميا، حيث تستنسخ نفس النزاعات الانشطارية بين الفرق المختلفة بلا استثناء.
في الحالة الإسلامية خاصتنا، لا يزال المكون الأسطوري، سواء السني أو الشيعي يلقي بظلاله التاريخية بقوة وشراسة تعيق حاضرنا، وتجعلنا بحاجة إلى إعادة قراءته سوسيولوجيا وأنثربولوجيا وفينومينولوجيا، هذا القراءة وبلا شك ستحرر العقلية الإسلامية، سواء الجمعية أو الفردية المتمركزة في الفترة السحرية للعالم، والتي من خلالها تفسر كل الظواهر بناء عليها، هذا التفسير العجائبي الخرافي الذي يعكس بنية معرفية شديدة الهشاشة تقف سدًّا منيعًا وجدارًا صلبًا أمام طوفان الحداثة الذي أضحى يغطي كل دول العالم، إلا منطقتنا العربية وعالمنا الإسلامي.
بقي أن أشير إلى أن هذا المجهود التفكيكي في بحث النصوص المؤسسة ذاتها (وإن كان بمعزل عن الإثبات أو النفي العقائدي في الأصل)، إلا أن الغاية منه ليس الدخول في صراع مع جوهر الدين وقيمه الترندستالية المتعالية (القيم الأخلاقية المتفق عليها)، وهو ما أكرره دائما ودون اضطرار في نهاية مقالاتي - ربما لإثبات موقفي الشخصي- الرامي إلى تأسيس إيمان عقلاني لا يتعارض مع واقع العصر وقيم الحداثة وآليات المستقبل.