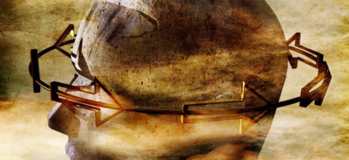مبدأ العطالة والثورة العلمية الحديثة، شروط الإمكان ومسارات التأسيس: ألكسندر كويري نموذجاً
فئة : أبحاث محكمة

مبدأ العطالة والثورة العلمية الحديثة،
شروط الإمكان ومسارات التأسيس:
ألكسندر كويري نموذجاً
ملخص
يمثل قانون العطالة في الفيزياء الكلاسيكية نقطة تحول فارقة في تاريخ العلم، دشن عصراً جديداً وتحولاً جذرياً في طريقة فهم الإنسان للحركة، وساهم في إحداث قطيعة معرفية مع التصورات القديمة للطبيعة. كما أن فكرته عن الحركة المستقيمية فتحت مجالات رحبة وآفاقاً موسعة للتفكير في مفاهيم لم يكن من الممكن قبولها ضمن النسق التقليدي، مثل الفراغ، والامتداد، اللامتناهي، والحركة، والمكان...
إن قانون العطالة، على بساطته الظاهرة، لا يمثل مجرد مبدأ فيزيائي ضمن قوانين الحركة، بل هو ركيزة مفهومية وفلسفية كبرى في بناء الفيزياء الحديثة، وكان ثمرة تحول علمي هائل غيَّر الطريقة التي نفهم بها المكان والحركة والفراغ واللانهاية. وصياغته تطلبت تفكيكاً جذرياً لنظرية الحركة التقليدية ومراجعة جذرية لتصورات ظلت راسخة عن الطبيعة والحركة والمكان.
غايتنا في هذا البحث هي تسليط الضوء من جديد على مبدأ العطالة لا كمجرد قانون فيزيائي، بل كمفهوم نظري يستبطن مجموعة من الشروط العلمية والميتافزيقية التي حددت إمكانيته؛ إذ لا يمكننا فهم الدلالة الحقيقية لهذا المبدأ دون استحضار سياقه التاريخي ودون مراعاة الإشكالات والاعتراضات والمصاعب التي واجهته وقيدت نظرية الحركة لقرون طويلة.
تقديم
لا شك أن العالم المحيط بنا يزخر بأنواع متعددة من الظواهر الفيزيائية وأشكال مختلفة من الحركات. من دوران الكواكب حول الشمس وسقوط الأجسام وحركاتها المختلفة في مجالنا الطبيعي، إلى تحليق الطيور وتطاير الأوراق هنا وهناك وفي اتجاهات مختلفة، وما إلى ذلك؛ إذ ندرك أن بعضها الذي يسقط ويهوي في الهواء أو الماء، قد يصعد ويرتفع في أوساط أخرى (الخشب مثلا الذي يسقط في الهواء ويرتفع في الماء). أما لماذا تحدث هذه الظواهر، ولِمَ تتبع قوانين معينة، فهذا هو الأمر الغامض، ودور العلم والفيزياء تحديداً هو أن يفسر لنا لماذا تحدث هذه الظواهر بهذه الطريقة دون غيرها من الطرق.
إن مهمة العلم بشكل عام والفيزياء على وجه التحديد، ليست فقط في أن ترصد هذه الحركات، بل أن ترد تنوعها الظاهر إلى مبادئ موحدة، وصيغ قابلة للتحقق والتجريب. وتعد نظرية الحركة من النظريات الفيزيائية الرائدة في مثل هذا البحث، فهي واحدة من أقدم النظريات الفيزيائية وأعظمها على الإطلاق، شغلت حيزاً مهمًّا من اهتمامات العلماء والفلاسفة على مر تاريخ الفكر البشري، وتداول على النظر العقلي فيها فلاسفة وعلماء من عصور ومراحل مختلفة، وقد تطلب الأمر زمناً طويلاً لكي نصل إلى النظرية الراهنة للحركة. ومنذ العصور القديمة إلى يومنا هذا ظلت الدراسات الخاصة بالحركة محورية لفهم العالم المادي، وفهم ديناميات الأشياء وتفاعلاتها وحركاتها المختلفة من أبسطها إلى أكثرها تعقيدا، فهي التي دفعت العقل البشري إلى البحث عن الانتظام خلف الفوضى الظاهرة، وعن الثبات في قلب التغير. وتعد قوانين التي قدمتها هذه النظرية أساساً لفهمنا للحركة الفيزيائية والظواهر الطبيعية في الكون، فهي تسلط الضوء على كيفية استجابة الأجسام للقوى المؤثرة عليها، وشروط حدوثها واستمراريتها (أي الحركة) وأسبابها.
يهمنا نحن في هذا البحث، الوقوف عند أحد أبرز القوانين الفيزيائية التي غيرت مجرى التفكير الفيزيائي الحديث؛ وذلك عبر تسليط الضوء من جديد على مفهوم العطالة كأحد المبادئ الجوهرية في الفيزياء الكلاسيكية، والذي مثّل تاريخيًّا نقطة تحول ثورية في فهمنا للحركة. ونسعى إلى توضيحه من خلال استعراض جذوره والتحديات العلمية والميتافزيقية التي واجهها، والدور المحوري الذي لعبه في تطوير النظريات الفيزيائية، وفي تشكيل الثورة العلمية الحديثة. كما سنسعى أيضا إلى إظهار الدور التاريخي المهم الذي لعبه في فتح آفاق جديدة أمام وحدة الميكانيكا السماوية والأرضية. وسنستعين في توضيح هذا المسار التحَولي لنظرية الحركة بالمقاربة الإبستمولوجية المتميزة التي قدمها مؤرخ العلوم الفرنسي المعاصر ألكسندر كويري Alexandre Koyré(1892-1962)، التي توفر لنا مدخلا مهمًّا لفهم الأهمية التي اكتسبها هذا المبدأ، وتوضح لنا بعمق منهجي وفكري الكيفية التي صاغ بها ديكارت مبدأ العطالة، والطابع الثوري الذي ميزه والأبعاد العميقة والمعقدة التي تربطه في علاقته مع المفاهيم الأساسية للفيزياء الكلاسيكية، مثل علاقته مع الفراغ والمكان والهندسة والترييض واللانهاية. فإلى أيّ حد كان اكتشاف قانون العطالة علامة فارقة في تاريخ الفيزياء؟ وكيف ساهم مضمونه العلمي والإبستمولوجي في تحرير الحركة من ترسباتها التقليدية القديمة؟ ثم إذا كان قانون العطالة يفيد بقاء الحركة واستمرارها على نحو مستقيمي. فما الفرق بينه وبين مبدأ حفظ الحركة؟
1- السياق التاريخي لقانون العطالة
لا شك أن المعركة الكبرى للثورة العلمية الحديثة كانت موجهة بالأساس نحو تحرير مفهوم الحركة من مختلف الترسبات الطبيعية والكيفية التي ارتبطت بها تاريخيًّا، وتخليصها من مختلف المفاهيم التقليدية التي قيدتها لقرون طويلة. غير أن طريق هذا التحرير لم يكن مجرد عملية علمية خالصة واستبدال تقني لنظريات قديمة بأخرى جديدة، بل كان شاقًّا وعسيراً، وجانباً مهماً من نهضة فكرية واسعة تشمل العلم والفلسفة واللاهوت. كان تحولاً في نمط التفكير وتغييراً جذرياً في بنية الفكر العلمي التقليدي. وإذا كنا سنتحدث هنا عن قانون العطالة، فعلينا أن ندرك جيدا أنه قد شكل قطب الرحى في التحولات الجذرية التي عرفتها نظرية الحركة منذ بداية العصر الحديث، وكان ثمرة مسار تاريخي طويل وشاق، وكما يقول "ألكسندر كويري" "لم يخرج مبدأ العطالة جاهزاً ومكتملاً من ذهن ديكارت أو غاليلي كما خرجت أثينا من رأس زيوس Zeus، بل إن تشكل التصور الجديد للحركة كان يتضمن ويستلزم تصورا جديدا للواقع الفيزيائي، والذي كان مبدأ العطالة تعبيراً عنه وحاملاً له في نفس الآن"[1]، والذي تم تدقيقه عبر جهد طويل وشاق، ومواجهة عنيفة مع مختلف الإشكالات والاعتراضات والمصاعب التي قيدت مفهوم الحركة لقرون طويلة.
قد يبدو لنا اليوم قانون العطالة، بديهيًّا ومفهوماً بالنسبة إلى الجميع، يعرفه الصغير قبل الكبير، ومن أساسيات ثقافتنا العلمية الحديثة والمعاصرة؛ غير أننا لو عدنا بعكس الزمن بعيداً إلى الوراء لتفحص طبيعة الحركة عبر كل العصور الغابرة والتعرف عليها في كل المراحل، لوجدنا على الفور أن الحركة التي يقصدها هذا المبدأ (أي الحركة المستقيمية المنتظمة اللامتناهية) لم تكتسب مشروعيتها ووضوحها إلا من خلال المجهودات العلمية الهائلة التي قدمها ديكارت وغاليلي. وهذا ما يعني أن سمة البداهة التي تتمتع بها هذه التصورات لها تاريخ محدد، وكما يقول "كويري" لاتزال هذه البداهة حديثة العهد، فلا يكاد عمرها يبلغ ثلاثة قرون، ولم يمتلك (مبدأ العطالة) هذه السمة إلا بفضل غاليلي وديكارت[2]. أما بالنسبة إلى الإغريق وعلماء العصور الوسطى فقد كانت هذه التصورات المرتبطة بالحركة المستقيمية زائفة زيفاً تاماً، بل كانت لتبدو محالات. ولهذا، فالتصورات والمبادئ العلمية التي نصفها عادة بالوضوح والبساطة، "ليست "واضحة" و"بسيطة" في ذاتها وبذاتها، بل إن وضوحها هو خلاصة نظام من المفاهيم والأوليات، وخارج هذا النظام المفهومي لن تكون بسيطة البتة"[3].
مثلت الحركة المستقيمية التي يفترضها هذا القانون نقلة حاسمة من التفكير الغائي الثيولوجي المحدود والمغلق والتراتبي إلى التفكير الآلي الميكانيكي المفتوح واللانهائي؛ لأن افتراض "الحركة في مسار مستقيمي" مسألة في غاية التعقيد وشديدة الخطورة، بل ربما يصح أن نقول إنها تحمل نواة الثورة العلمية الحديثة، وطرحت تحدياً حقيقياً أمام المنظومة التقليدية القديمة، لأن افتراضها كان يعني في المقام الأول تصور جسم يتحرك إلى ما لانهاية في خط مستقيم، دون أن يعترضه شيء، وهي الفكرة التي بدت غير مقبولة بل ومستحيلة داخل النسق الأرسطي؛ لأنها تتعارض إلى حد كبير مع الدعامة الكبرى التي يقوم عليها هذا التصور أو هذا الباراديغم، والتي هي فكرة العالم المغلق والكوسموس المحدود والنهائي. لهذا، تطلبت صياغة مبدأ العطالة جهداً نقديًّا وفكريًّا معقداً، وتغيير زاوية النظر إلى العلم والعالم والحركة ذاتها، وما يبدو اليوم بديهيًّا وبسيطاً، كان في الماضي ثمرة لصراع طويل مع تصورات راسخة، وحسب كويري "إن عدم قدرة الفلاسفة والعلماء على صياغة مثل هذه القوانين الأساسية للحركة التي تُعلم اليوم للأطفال في المدارس، لا تُعزى إلى قصور في الذكاء والبصيرة والنبوغ العقلي، بل لأنهم كانوا بحاجة إلى خلق وبناء الإطار النظري الذي يجعل من هذه الاكتشافات ممكنة".[4] كان عليهم بداية أن يصلحوا الفكر نفسه ويعيدوا تشكيله وتزويده بسلسلة مفاهيم جديدة، وإعداد برنامج جديد بخصوص الطبيعة وبلورة تصور جديد للعلم. وبشكل عام كان عليهم أن يزعزعوا النسق التقليدي من الداخل، وابتكار فلسفة جديدة للطبيعة، وإطاراً نظريًّا معيناً يجعل من القوانين ممكنة ومفهومة. فالتحدي الأكبر لا يكمن في اكتشاف القوانين الجديدة، بل في إصلاح الفكر وتشكيله من جديد وتزويده بمفاهيم جديدة وتصورات مبتكرة بخصوص الزمن والحركة والمكان والتسارع والفراغ ....؛ ولعل أعظم ما قدمه "ديكارت" بخصوص الفيزياء الحديثة، حسب "كويري" هو بدون شك صياغته لمبدأ العطالة وتقديمه في صيغة واضحة وبسيطة[5]. لكن ما دلالة هذا القانون؟
يفيد قانون العطالة، أن الجسم يبقى على الحالة التي هو عليها ساكناً كان أم متحركاً، فإذا كان ساكناً سيبقى في سكونه، وإذا كان متحركاً سيظل متحركاً بشكل مستقيمي إلى ما لانهاية، مالم يتدخل جسم ما فيغير مسار حركته. إنه قانون بسيط للغاية، يؤكد أن الجسم المتروك لذاته يبقى على حاله، يظل في حالة سكون أو حركة، مادامت هذه الحالة لم تتعرض لتأثير قوة خارجية ما وتغير حاله، وبعبارة أخرى، "إن جسماً في حالة سكون سيظل إلى الأبد ساكناً مالم يتم تحريكه، وجسماً في حالة حركة سيستمر في حركته المستقيمة المنتظمة مالم يعق حركته تدخل قوة خارجية[6].
بطبيعة الحال، كانت هذه الحركة كما قلنا أعلاه مستحيلة ومرفوضة بالنسبة للنسق الأرسطي القديم؛ إذ من جهة يستحيل تصور جسم طبيعي يتحرك حركة مستقيمية دون توقف؛ لأن كل حركة هي أثر لمحرك خارجي دائم، ولا تدوم من تلقاء نفسها، فهي تنتهي بانتهاء تأثير المُحرك. وعليه، فإن تصور جسم يتحرك بحركة مستقيمية منتظمة وبشكل لا نهائي، دون الحاجة إلى قوة تبقيه متحركاً، كان أمرا مخالفاً لقواعد العقل والمنطق الفلسفي القديم. وكما يقول كويري: "فإذا كانت الحركة لا تدوم من تلقاء نفسها (لا شيء ضد الطبيعة يمكن أن يدوم)، فإن كل حركة تحتاج إلى مُحرك يُحرّكها ويُحافظ على بقائها واستمرارها، وبزوال العلة يزول المعلول. وهذا التفسير بدوام العلة أو المحرك يكون بالنسبة للحركة "الطبيعية" المرتبطة بطبيعة الأجسام وصورتها التي تسعى العودة إلى مكانها الطبيعي. أما إذا تعلق الأمر بالحركة غير الطبيعية، فهذه تقتضي فعلاً متواصلاً لمُحرك خارجي مقترن بالمُتَحرك أثناء مدة الحركة. فإن بَطُل فعل المحرّك توقفت الحركة، وإن فارق المُحرّك المتحرّك توقفت الحركة كذلك؛ ذلك لأن أرسطو لا يقبل القول بوجود أفعال عن بعد"[7]. لهذا السبب كانت الحركة المستقيمية مرفوضة وغير ممكنة في النسق الأرسطي.
من جهة ثانية، ارتبطت النظرية الأرسطية بشكل كبير بمقولة "المكان الطبيعي"؛ إذ ليس هناك «مكان» يتجه نحوه الجسم المتحرك في اتجاه أفقي، ليس هناك غاية يمكن أن تنشدها هذه الحركة. في حين أن المفهوم الجديد للحركة ينص بالضرورة على فكرة الحركة المستقيمية؛ بل يراها الحركة الوحيدة الحقيقية للأجسام. أما حركات الأجسام في عالمنا، فهي ليست حركة حقيقية؛ لأنها تخضع لمجموعة من القوى، وتتأثر بالعديد من العناصر، كالجذب ومقاومة الوسط (الماء، الهواء) وضغط الكتلة؛ لكن لو أزيحت هذه القوى المقاومة والمؤثرة على سير الأجسام، لرأينا الأجسام تتحرك بشكل مستقيمي وبانتظام وبشكل لانهائي.
هكذا نرى أن صياغة مبدأ العطالة لم يكن مجرد تطور تقني وعلمي بسيط في نظرية الحركة، بل كان ثمرة تحول معرفي عميق تطلبت جملة من الشروط النظرية والميتافزيقية، قطعت مع التصورات الموروثة عن الطبيعة والحركة؛ لأن إمكانية افتراض جسم يتحرك حركة مستقيمية منتظمة دون توقف، اشترطت في المقام الأول نزع الطابع الغائي عن الطبيعة، والتخلي عن فكرة المكان الطبيعي التي كانت مهيمنة على الفكر الأرسطي. كما تطلب الأمر أيضا تطوير تصور جديد عن المكان، لا بوصفه إطارًا حيًّا تجري فيه الأشياء لمستقر لها، بل كمكان رياضي مجرد ومتجانس يمكن أن تتحقق فيه الحركة دون مقاومة أو غاية محددة سلفاً. وعليه يفترض مبدأ العطالة حسب كويري:
vتصوراً جديداً للحركة والسكون، بالنظر إليهما على أنهما حالتان ووضعهما في نفس المرتبة الأنطولوجية.
vتصور المكان الذي صار مماثلاً مماثلة كاملة للمكان المتجانس اللامحدود (اللانهائي) للهندسة الأوقليدية.
vإمكانية عزل جسم معين عن محيطه الفيزيائي، والنظر إليه على أنه متحقق ببساطة في المكان[8].
لهذا السبب بالذات، لم يكن اكتشاف مبدأ العطالة مجرد تعديل جزئي في نظرية الحركة، بل تحولا ثوريًّا وفتحاً معرفياً عميقاً على مفاهيم لم يكن من الممكن قبولها ضمن النسق التقليدي للحركة، إذ تطلبت صياغته، جملة من الشروط المفهومية والفيزيائية، أولها تفكيك التصور التقليدي عن الحركة والنظر إليها بوصفها مجرد حركة رياضية خالصة، كما تطلب أيضا في مستوى ثانٍ توفير فضاء نظري عبارة عن مكان أوقليدي متجانس. هذا علاوة على الإطار النظري الذي يفترضه من حديث عن الفراغ واللانهاية والقوة والوسط والحركة... وهي تصورات لم تكن قائمة، وغير ممكنة ضمن الفيزياء الأرسطية.
2- مسارات التأسيس وشروط الإمكان
انتهينا من المحور السابق إلى أن صياغة مبدأ العطالة في الفيزياء الكلاسيكية لم يكن مجرد اكتشاف فيزيائي وثمرة لتجارب فيزيائية معزولة، بل تطلبت صياغته شروط نظرية وميتافيزيقية تأسيسية، وثورة فلسفية موازية أطاحت بمفاهيم فيزيائية كثيرة، مثل الثقل والخفة والمكان الطبيعي والحركة الطبيعية.... وكل النسق الذي كانت تقوم عليه الفيزياء الأرسطية. وغايتنا هنا في الفقرات المتبقية من البحث أن نكشف طبيعة هذه الشروط التي مهدت له ومساراتها التأسيسية بالنسبة إلى الحركة العطالية.
أ- تفكيك التصور التقليدي للحركة
تطلبت صياغة مبدأ العطالة تفكيك التصور التقليدي للحركة، لأن افتراض بقاء الحركة واستمرارها بشكل منتظم ومستقيمي ولا متناهٍ، يتعارض بشكل جذري مع أهم مبادئ التصور الأرسطي، الذي ينفي إمكانية دوام الحركة إلى ما لانهاية، فكل حركة بالنسبة له هي محدودة ومنتهية[9]. وحسب أرسطو هناك كُلٌّ مُنظم تَتموضع داخله الأشياء وتتوزع، وكل شيء في نظام العالم له مكانه الطبيعي الخاص به والذي يتلاءم مع طبيعته. ولما كان هناك نظام موحد، ومكان طبيعي لكل جسم؛ فمعنى ذلك أن كل جسم سيبقى في مكانه، والذي لن يغادره أبدا من تلقاء ذاته. وعليه فكل حركة هي تعني اختلال كوسمولوجي وخلل واضطراب في التوازن، وهي ذاتها أثر مباشر لانفصال سبَبه قوة ما خارجية وعنيفة [دفعت الجسم للحركة ولمغادرة مكانه الطبيعي الذي فيه يوجد فيه]، وبالمقابل فأثر المجهود المبذول من طرف الجسم، من أجل استعادة توازنه المفقود والمسروق منه، والذي يسمح له بأن يركن ويعود إلى النظام المتشكل، يسمى هذا الجهد ب «الحركة الطبيعية»[10].
لهذا، وبمقتضى هذا النظام، وحيث يكون كل جسم في مكانه الطبيعي، كان طبيعياً أيضا أن يتم اعتبار كل حركة هي بالضرورة «حالة عابرة[11]» «un état passager»؛ أي إنها تتوقف طبيعياً حالما يحصل الجسم المتحرك على غايته أو هدفه، أي «مكانه الطبيعي». ولهذا، فمهما طال أمد هذه الحركة، فهي عائدة إلى ثباتها وبالضرورة، وهذا ما يعني من جهة أخرى أن كل «حركة» هي «حركة نحو غاية معينة» أي نحو مكانها الطبيعي، فهي حركة تؤثر في الجسم المتحرك وتوجهه نحو مكانه الطبيعي حيث يسكن ويرتاح.
وإذا كان ذلك كذلك بخصوص الحركة، فإن الأجسام التي ترقد في مكانها لا تحتاج إلى تفسير، لهذا فليست هناك حاجة لتفسير "سكونrepos " الأشياء، مادام سكونها يترجم طبيعتها، فالسكون الطبيعي لجسم ما في مكانه الطبيعي، وطبيعة الأشياء نفسها هي التي تفسر سكونها، فالأجسام الثقيلة تميل إلى الأسفل والخفيفة تميل إلى أعلى. غير أن هذه الحركة وغيرها لا تدوم من تلقاء نفسها، كما هو الأمر بالنسبة إلى السكون، (السكون= يعني المكان الطبيعي= يعني الاكتمال؛ الحركة= نقصان= الغاية)، فالحركة هي بالضرورة حالة عابرة، فيها يتحرك الجسم تحت تأثير قوة ما أجبرته على الحركة، في حين أن السكون هو لحظة اكتمال، حيث يكون الجسم في مكانه الطبيعي، ولا يحتاج إلى مغادرته، ولهذا ففقدان السبب يعني أساسا فقدان الحركة.[12] لهذا السبب، كانت الحركة المستمرة في خط مستقيم أمرا غير للتفكير أصلا في الفيزياء الأرسطية، وكان لا بد من تفكيك تصوره ومفاهيمه بخصوص الحركة واستبدالها بمفاهيم أخرى جديدة ومبتكرة.
ب- إعادة تعريف الحركة ذاتها
فرضت الثورة الفيزيائية الحديثة ضرورة القيام بعملية مراجعة شاملة وعميقة بخصوص الحركة ذاتها؛ لأن مبدأ العطالة، في جوهره لا يتطابق مع المظاهر الحسية المباشرة التي نراها في عالمنا، والحركة التي يفترضها لا تظهر لنا في العالم كما نختبره حسيًّا، وكان على العلماء أن يفصلوا بين المظاهر الحسية للحركة كما نراها، والحركة كما تجري في غياب القوى المؤثرة، واختراعات غاليلي وتأملات ديكارت واكتشافات كبلر وكوبرنيك قبلهما، قلبت الصورة التقليدية لنظرية الحركة ولمختلف المعاني التي كانت ترتبط بها؛ لم تعد الحركة معهم ترتبط بما تراه الأعين وتلمسه الحواس من مشاهدات ووقائع، ولم تعد تخضع لقواعد مرور أبدية تنسجم مع الكوسموس المنظم، بل باتت تعبر عن نسيج من القوى المتصارعة بدون توقف، ومزيجاً من المكونات المختلفة والمتصادمة مع بعضها البعض والمجردة تماماً من كل معنى.
التصور الجديد يرى أن «الحركة» مجرد «حالة «état» مثلها مثل «السكون «repos، وأن الحالتين معاً لهما نفس المرتبة الأنطولوجية[13]. ولهذا، فالجسم سواء كان ثابتاً أو متحركاً فوضعيته لا تعنيه، وكونه في حالة من الحالتين، لا تمسه بأي شكل من الأشكال، بمعنى لا واحدة من تلك الحالات تؤثر في الجسم أو تغير حالته، ليس هناك تغيير أو تحول في الحركة، والانتقال من حالة إلى أخرى لا يؤثر في الجسم بأي شيء، فمادامت الحركة هي حركة رياضية -حركة الكائنات الرياضية والأشكال الهندسية-فينتج عن ذلك، أنه لا حياة ولا كيف في عالم الأعداد.
المفهوم الجديد للحركة الذي فرض ذاته في العصر الحديث، كان يفترض زوال كافة الاعتبارات التقليدية القائمة على الشرف والقيمة والكمال والتناسق والمعنى والغاية من الفكر العلمي، فأصبحت بذلك كل هذه المفاهيم ذاتية خالصة، purement subjectifs لا يمكن أن تجد لها مكان في الأنطولوجيا الرياضية الجديدة، واختفت باختفائها كل العلل الصورية والغائية من العلم les causes formelles et finales، وتم تعويضها بعلل مادية وفاعلة، les causes efficientes et mêmes matérielles وباتت هذه العلل الأخيرة [المادية والفاعلة] دون سواها ذات أولوية، وهي التي وقع قبولها وقبول وجودها في الكون الجديد للهندسة المجردة[14].
بزوال الاعتبارات الكيفية من عالم العلم، باتت المفاهيم التي تحكم الحركة لا تعبر عن كيانات كيفية وأشياء واقعية، بل صارت مجرد علاقات منطقية ورياضية، فتم بموجب ذلك استبدال منهجي في عالم العلم عبر إحلال عالَم الكَّم محل عالَم الكيف، لعدم وجود كيفيات qualités في عالم الأعداد، ولا في عالم الأشكال الهندسية، فلا مكان للكيفيات الأرسطية في مملكة الأنطولوجية الرياضية الجديدة. وكما يقول "ألكسندر كويري" في العلم الحديث صار المكان الواقعي مطابقاً للمكان الهندسي، ونُظر إلى الحركة على أنها انتقال هندسي محض من نقطة إلى أخرى، ولهذا السبب، فإنها لا تؤثر بأي وجه من الوجوه على الجسم المتحرك. فالحركة أو السكون لا يحدثان أي تغير في الجسم، فسواء كان هذا الأخير متحركاً أو كان ساكناً، فإنه دائماً مطابقاً لنفسه، ويبقى هو هو دون أن يطاله أي تغير، بل إننا عاجزون على أن ننسب الحركة لجسم معين محدد بذاته، فجسم ما في حالة حركة، هو كذلك فقط في علاقة بجسم آخر نفترضه ساكناً. ولهذا، لا يمكننا أن ننسبها إلى أحدهما أو إلى الآخر. فكل حركة هي حركة نسبية.[15]
حتى الخفة والثقالة لم تعودا خاصيتين مطلقتين للأجسام، بل أصبحتا خاصيتين نسبيتين تتحددان من خلال العلاقة القائمة بين كثافة الجسم المتحرك وكثافة الوسط الذي يتحرك فيه، فالجسم يكون ثقيلاً أو خفيفاً، ليس في ذاته [كما كان يعتبر أرسطو]، بل في علاقة خارجية مع الوسط الخارجي وباقي الأجسام، فالثقيل هو ثقيل مقارنة مع جسم آخر خفيف، وهو ذاته خفيف في علاقة مع جسم آخر أثقل منه، والشيء نفسه يقال بالنسبة للخفة، "فجسم ثقيل فوق كفة ميزان يرتفع في اللحظة التي تهبط فيها الكفة الأخرى، وقطعة من الخشب التي تسقط في الهواء، هي ذاتها ترتفع في وسط آخر مائي".[16]
لقد فتحت هذه المراجعة الشاملة لمفهوم الحركة الطريق أمام صياغتها رياضياً، وأمام إمكانية افتراض الحركة المستقيمية المنتظمة التي ينص عليها مبدأ العطالة؛ ومن خلال تحرير مفهوم المكان الذي سنتحدث عنه بعد قليل؛ صارت فكرة حركة جسم ما إلى ما لانهاية في خط مستقيم وبسرعة منتظمة؛ دون أي قوة تؤثر فيه؛ فكرة معقولة ومقبولة؛ بل أحد أهم اكتشافات الثورة العلمية الحديثة، وحسب كويري، "إن الفضل الكبير الذي ينسب إلى الديكارتية في مسار الثورة العلمية الحديثة ارتبط أساساً بقدرتها على صياغة مبدأ العطالة بوضوح فلسفي وعلمي غير مسبوق"[17].
بالنسبة إلى ألكسندر كويري الفضل الكبير في صياغة مبدأ العطالة، لا يعود إلى غاليلي، كما اعتقد ذلك "نيوتن"، بل إلى ديكارت، لأن الديكارتية وحدها من استطاعت أن تعبر بوضوح فكري ومنهجي عن المفهوم الجديد للحركة، باعتبارها مجرد حالة، وكما يقول كويري "من أعظم الأمور التي قدمها "ديكارت" للفيزياء الحديثة، ودون شك، هي تقديمه وصياغته لمبدأ العطالة وتقديمه في صيغة واضحة وبسيطة[18]."والحركة من المنظور الديكارتي، هي حركة بسيطة للغاية، لكنها ليست حركة الفلاسفة، ولا هي أيضا بالحركة التي يقصدها الفيزيائيين، بل أكثر من ذلك، إنها ليست حركة الأجسام الفيزيائية، بل هي أساسا حركة الهندسيين وحركة الكائنات الهندسية المجردة: حركة نقطة وهي ترسم خط مستقيم، وحركة خط مستقيم وهو يرسم دائرة[19]، وهي حركة متعارضة مع الحركة الفيزيائية، لا سرعة لها ولا تكون في الزمن.[20] إنها حركة هندسية خالصة، ليس فيها تغير ولا حرمان، إنها مجرد حالة تظل على حالها وتتواصل بشكل دائم على خط مستقيمي في المكان الرياضي اللامتناهي.
هذا الفهم الرياضي الخالص للحركة، مكّن ديكارت من تحريرها من التصورات الموروثة التي كانت تربطها دوما بفاعل خارجي أو غاية طبيعية، والنظر إليها بوصفها مجرد حركة رياضية بحتة يتم تفسيرها من خلال إحداثيات رياضية وفق قوانين هندسية خالصة. هذا المفهوم الجديد للحركة يتضمن بقاء الحركة الأبدية بشكل لامتناهي، فهو يفترض أن الأجسام المتحركة تستمر في حركتها وفق خط مستقيم وبشكل لانهائي. لكن من الضروري أن ننتبه هنا إلى مسألة أساسية ينطوي عليها هذا المبدأ، وهي ضرورة التمييز بدقة بين "قانون حفظ الحركة"la loi de conservation du mouvement ومبدأ العطالة le principe d’inertie. فعلى الرغم من أن المفهومين متقاربان ظاهريًّا، إلا أنهما يندرجان في إطارين مختلفين. يفيد مبدأ حفظ الحركة وبقائها أن مقدار الحركة لا يفنى ولا يُخلق، وهو مقدار ثابت في العالم. والأجسام في حركاتها المختلفة هنا وهناك تنقل كمية معينة من الحركة من جسم إلى آخر، فهو قانون ينص على استمرارية الحركة وبقائها على نحو أبدي ولانهائي، وفي غياب قوى خارجية مؤثرة يستمر الجسم في الحركة دون توقف، بغض النظر عن طبيعة هذه الحركة سواء كانت حركة مستقيمية أو حركة دائرية على الاستدارة. أما مبدأ العطالة، فهو ينص على أن الجسم يبقى على حاله، في حالة سكون أو يستمر في حركته على خط مستقيم وبسرعة ثابتة مالم تؤثر عليه قوة خارجية.[21]
وباختصار، مبدأ حفظ الحركة يتناول "كمية" الحركة في العالم من منظور فيزيائي، بينما مبدأ العطالة يعالج الحركة من منظور "رياضي" في فضاء مكاني هندسي خالص وفي غياب تام للمؤثرات الخارجية. وحسب "ألكسندر كويري" إن مبدأ حفظ الحركة يرتبط ب إسحاق بيكمان Isaak beekman الصديق المقرب والمعاصر لديكارت الذي تعرف عليه سنة 1618، وكان له دور حيوي في تطوير الأفكار العلمية والفلسفية في عصره، وقدم مساهمات جوهرية في تطبيق الرياضيات على الفيزياء، وفي وتوجيه العديد من الفلاسفة والعلماء مثل ديكارت. لكن إقراره بمبدأ بقاء الحركة إلى ما لانهاية، لا ينبغي فيه الاعتقاد بكونه قد أقر بمبدأ العطالة والقصور، فثمة فرق جوهري بين القانونين، فإذا كان قد اعترف حقيقة أن الأجسام التي تتحرك لا تسكن من تلقاء ذاتها إلا إذا أعاقتها أشياء أخرى، فإنها لا تتوقف إلا بقدر ما يكون العائق أقوى منها، أما إذا كان العائق أضعف منها فهي تواصل حركتها مدة أطول، وسكونها بالتالي لا يكون إلا من خلال عائق يفوق قوتها. غير أن قانون العطالة لا يعني بقاء الحركة فقط، فهو وإن كان يقر ببقائها، لكنها الحركة المستقيمية والمنتظمة وحدها. فمبدأ العطالة يفترض بقاء الحركة على خط مستقيم، أما مبدأ بقاء الحركة فلا يفترض بالضرورة الحركة المستقيمية، وبيكمان كان يتحدث عن بقاء الحركة على الاستدارة ويفسر لنا بقاء الحركة الدائرية.[22]
إن الجسم الذي يتحرك وفق الحركة القصورية يستمر في حركته المستقيمية دائما مالم تعترضه عوائق خارجية تحد من حركته أو تغير اتجاهه. أما قانون بقاء الحركة فهو ينص على استمرارية الحركة وبقائها سواء كانت حركة مستقيمية أو حركة على الاستدارة، والفرق كبير بين القانونين: فقانون بقاء الحركة ينطبق على الحركة المستقيمية والدائرية على حد سواء، وهذا ما يعني أن الجسم يمكن أن يستمر في الحركة المنتظمة أو التسارعية بشكل لا متناهٍ، سواء كان يتحرك في خط مستقيم أو في مسار دائري وسواء أيضا كانت حركته منتظمة أو متسارعة، طالما لا توجد قوى خارجية مؤثرة عليه. أما قانون العطالة، فهو ينطبق فقط على الحركة المستقيمية والحركة المنتظمة، وكما هو معلوم إن الفرق كبير جدا بين بقاء الحركة على الاستقامة وبين بقائها على الاستدارة، لئن كانت الأولى قد تم اكتشافها فقط في العصر الحديث، وكانت مستحيلة بالنسبة إلى العصور الوسطى والقديمة، لأنه لا توجد أمكنة طبيعية تقصدها الأجسام التي تترحك حركة مستقيمية (خصوصا الحركة المستقيمية الأفقية)، وهي أيضا مستحيلة لأنها حركة لامتناهية. فإن الحركة الدائرية مثلت تاريخياً النموذج الأمثل والكامل للحركة، وهي حركة خاصة بالأجرام السماوية" لهذا يقول كويري" إن مبدأ العطالة لا يؤكد البقاء الأزلي لكل حركة، بل فقط الحركة المنتظمة على خط مستقيم mouvement uniforme en ligne droite، فالمبدأ لا يصدق على الحركة على الاستدارة، كما لا يصدق على حركة الدوران، ولعله يمكن القول، لئن كانت فيزياء العصور الوسطى والقديمة تقابل بين الحركة الدائرية، التي تتصورها طبيعية والحركة المستقيمية بوصفها عنيفة، فإن الفيزياء الحديثة قلبت هذه العلاقة، وجعلت من الحركة المستقيمية هي الحركة الطبيعية، والحركة الدائرية أصبحت تظهر بمظهر الحركة العنيفة."[23]
هكذا، يفيد مبدأ العطالة أن الأجسام لا تغير من حركتها بشكل طبيعي ومن تلقاء ذاتها، بل إن الجسم الذي يتحرك يستمر في حركته ما لم تؤثر قوة ما خارجية تغير من اتجاهه أو تلغي حركته. ويرى "كويري" أن الصيغة الصحيحة لمبدأ العطالة، لم يكتشفها غاليلي، كما اعتقد "نيوتن"، بل إن صيغة هذا القانون، تبلورت في ثنايا كتاب "العالم" للفيلسوف الفرنسي "ديكارت"؛ لأن صيغة هذا القانون تفترض أسبقية الحركة على خط المستقيم على الخط الدائري، وسِحْر الحركة الدائرية جعلت غاليلي يعجز عن صياغة مبدأ الحركة القصورية بصيغة واضحة؛ إذ منح غاليلي، حسب "كويري" وضعية متميزة للحركة الدائرية التي تساندها شهادة التجربة اليومية، فحركة جسم كروي فوق مستوى أفقي، هي حركة ليست طبيعية ولا هي بحركة عنيفة، ولا ترفع شيئا ولا تضيف شيئا، إذا قمنا -كما يقول غاليلي-:إذا قمنا بإبعاد كل مقاومة خارجية (فوق مستوى أملس وعلى نحو مطلق، وكرة وأجسام صلبة مستديرة استدارة مطلقة) فإن حركة هذه الأجسام لن تتوقف وستتواصل بشكل لانهائي.[24]
الحركة الوحيدة -عند غاليلي- التي هي ليست بطبيعية وليست بعنيفة، والحركة الوحيدة التي لا ترفع ولا تنزل الجسم، والحركة الوحيدة التي ليس فيها ابتعاد أو اقتراب من المركز هي: الحركة الدائرية. أما الحركة المستقيمة، فيقول غاليلي: "لا وجود لها في هذا العالم، ولا يمكن أن توجد حركة مستقيمية طبيعية؛ ذلك لأن الحركة المستقيمية هي لا متناهية بطبيعتها، ولما كان الخط المستقيم لا نهائي ولا محدود، فمن المستحيل إذن لأي جسم متحرك، أن يتحرك بطبيعته حسب الخط المستقيم، أعني إلى موضع يستحيل أن يبلغه طالما أنه لا وجود لحد في اللامتناهي. والطبيعة لا تفعل عبثاً، ولا تُحرك الجسم إلى موضع يستحيل الوصول إليه.[25]
ليس سحر الحركة الدائرية وحده من جعل غاليلي يفشل في صياغته لمبدأ العطالة، بل هناك حسب "كويري" واقعة أخرى جعلته يعجز عن تحديد الصيغة الصحيحة للحركة القصورية، وهي واقعة الثقل أو الوزن، فالفيزياء الغاليلية تدرس في المقام الأول حركة الأجسام الثقيلة؛ أي حركة الأجسام المحيطة بنا، ومن هذا المجهود الساعي إلى تفسير وقائع وظواهر التجربة اليومية (واقعة السقوط، فعل الرمي) انبثقت حركة الأفكار التي قادته إلى إقامة قوانين هذه الوقائع والظواهر[26]، ولهذا كانت كل الأجسام عنده ثقيلة، وتميل إلى السقوط، ولا ترسم في حركتها تلك، خطاً مستقيماً، بل خطاً دائرياً أو منحنياً.
فغاليلي حسب كويري "منذ لحظة إقامته بمدينة "بيزا" لم يستطيع التحرر من واقعة الثقل التي ظلت راسخة في ذهنه، بوصفها خاصية طبيعية للأجسام الثقيلة[27]، ليست الأجسام الثقيلة وحدها، بل إن كل الأجسام حسب كويري هي "ثقيلةgraves " في الفيزياء الغاليلية، فلاوجود لجسم محروم من الوزن، أو بالأحرى لا وجود لجسم خفيف؛ إذ لا يسلم غاليلي، على خلاف أرسطو، بوجود كَيْف خالص في الأجسام يُسمى "خفّة"، ولهذا، فليست هناك حركة طبيعية إلى الأعلى، ولا وجود لجسم يتحرك من تلقاء ذاته نحو الأعلى؛ وكل حركة صعود، هي حركة قذف وطرد"[28]، فالأجسام عنده لها ثقالتها، وحركتها الوحيدة هي الحركة إلى الأسفل. وكما يقول كويري: "إن فيزياء غاليلي هي فيزياء الأجسام الثقيلة، فيزياء الأجسام التي تسقط وتتجه نحو الأسفل... إلى الحد الذي يمكن تعريفها بكونها فيزياء السقوط[29] physique de la chute، وارتباطها بالواقعة الفيزيائية للسقوط هي التي جعلت غاليلي حسب كويري يعجز عن صياغة مبدأ العطالة صياغة صحيحة، [30] في حين أن صياغة مبدأ العطالة، كانت تقتضي تحرير مفهوم الحركة ذاته من كل محتوى واقعي، والنظر إليها بوصفها مجرد حالة مماثلة لحالة السكون، ومن ثم الإقرار بالاستمرارية الأبدية للحركة، لا للحركة الدائرية، بل للحركة المستقيمة، والتحرر بشكل كلي من واقعة الثقل. ولهذا، فقانون العطالة لم يكتشفه غاليلي كما اعتقد نيوتن، بل ارتبط بالتصور الديكارتي للحركة الهندسية والرياضية الخالية من كل الاعتبارات الفيزيائية.
3- تحرير المكان من طابعه الحيوي وهندسته
لقد ساهمت نظرية الحركة الجديدة التي يقصدها مبدأ العطالة في تحرير المكان الطبيعي اليوناني من طابعه المغلق واللاهوتي الوسيطي وفتحه على العالم المتجانس اللامتناهي. في الفلسفة الطبيعية الأرسطية، لم يكن المكان موحدا، بل متمايزا وكيفياً، وفكرة المكان الطبيعي هي التي كانت تحدد سلوك الأجسام واتجاه حركتها، حيث لكل عنصر من العناصر الأربعة (الماء، الهواء، النار، التراب) مكانه الطبيعي الذي يسعى إليه. غير أن الثورة العلمية الحديثة قلبت هذا التصور رأساً على عقب، عندما أعادت تعريفه بمفاهيم هندسية خالصة، بوصفه مجرد امتداد رياضي متجانس، حيث استبدلت الموضع المتصل الملموس للفيزياء ما قبل غاليلية بالمكان المتجانس للهندسة الأوقليدية. ولم يعد "المكان" طبيعيًّا يعبر عن الفضاء الذي نعيش فيه وتجري فيه الحركات والكائنات، وبوصفه مكاناً حسيًّا يعبر عن مواضع متمايزة وتراتبية من حيث القيمة والشرف والكمال، بل "صار مكاناً هندسيًّا وامتداداً متجانساً ولامتناهياً بالأساس".[31]
منح التفكير العلمي الجديد بخصوص المكان إمكانية هندسته؛ أي تحويله من فضاء نوعي نابض بالحضور والاتجاهات الطبيعية والغايات، إلى فضاء رياضي مجرد، ونسق هندسي خالص يمكن قياسه وبناؤه رياضياً؛ لقد تم تحرير المكان من طابعه اللاهوتي المغلق وتفريغه من كل مضمون كيفي أو غائي، وأصبح يُنظر إليه على أنه إطار هندسي متجانس، قابل للتمثيل بالمعادلات والتقسيم بواسطة الاحداثيات، والقياس بواسطة الخطوط والأسطح والزوايا. ويرى "ألكسندر كويري" أن هندسة المكان* كانت خطوة حاسمة في تحطيم الكوسموس** القديم، وبفضلها تمكن العلماء من تطبيق الرياضيات على ظواهر الطبيعة بطريقة دقيقة وشاملة، من خلال إضفاء معاني مخصوصة عليها وتحويلها إلى شبكة علاقات من نوع خاص وفقاً لتقسيم معين للعالم. فتحولت بذلك معاني الحركة والسرعة والتسارع والخفة والثقالة والوسط وكل المفاهيم الفيزيائية تقريباً، إلى مجرد علاقات رياضية بسيطة، لأنه لا وجود للتغير ولا للصيرورة في عالم الأعداد والأشكال الهندسية. وبهذا التحول أصبح المكان إطار مجرد هندسي ومتجانس وموحد وخاضع لقوانين رياضية واحدة.
4- الحركة اللامتناهية
شكل إدخال قانون العطالة إلى الثقافة العلمية تحولاً ثورياً عميقاً في طريقة فهم الانسان للطبيعة؛ لأن إدخاله اقترن باستعداد نظري للفكر في تقبل مفاهيم أخرى مرتبطة به كالفراغ واللانهائية والتفسير الآلي الميكانيكي، وهي المفاهيم التي لم يكن من الممكن قبولها ضمن النسق الأرسطي القديم، فلكي يتحرك جسم ما حركة مستقيمية منتظمة ودون توقف أو انقطاع، كان من اللازم القبول بوجود «الفراغ» أو وسط خال من المقاومة، يسمح لهذه الحركة بأن تستمر دون توقف. وهذا ما يتعارض جذرياً مع تصور أرسطو الذي أنكر وجود الفراغ مطلقاُ، واعتبر أن الطبيعة تخشى الفراغ. لا يستطع الجسم حسب أرسطو أن يواصل حركته بشكل دائم، فكل جسم له ميل طبيعي نحو مكانه الطبيعي، وهو الميل نفسه الذي يجذبه نحوه. أما الحركة في الفراغ، فهي مستحيلة؛ لأن افتراضها يعني أن الجسم المتحرك سيواصل حركته، ولن يوقفه شيئا آخر؛ لأنها حركة في وسط فارغ من المقاومة، وهذا ما سيجعلها حركة لا متناهية. فالحركة في الفراغ تعني حركة دون مُحرك، حركة لا تقصد شيئا؛ لأن الفراغ ليست فيه أمكنة طبيعية وليست فيه اتجاهات مفضلة. ولذلك، فهي حركة مستحيلة بالنسبة إلى النسق الأرسطي، يقول "ألكسندر كويري" "كان أرسطو على حق، حينما اعتبر أن فكرة الفراغ لا تتوافق مع فكرة النظام الكوسمولوجي، فداخل الفراغ يستحيل أن توجد أوساط طبيعية. في الواقع لا توجد أوساطاً أصلاً، وعلاوة على ذلك فمفهوم الفراغ لا يتوافق مع الحركة بوصفها سيرورة processus، ولا يتوافق أيضا مع الحركة الجسمية والواقعية .... والحال أن افتراض الحركة في الفراغ، يقتضي المعالجة الرياضية والتحديد الرياضي لظواهر الطبيعة، وهو الأمر الذي كان يرفضه "أرسطو" الذي ميز بدقة بين المجالين الفزيائي والرياضي، ورفض الجمع بينهما، فالفيزيائي يفكر في الواقع (الكيفي qualitatif)، والهندسي لا يقدم ولا يتعامل سوى مع المجردات."[32]
إن القبول بفكرة الفراغ ولو كافتراض مثالي، كان من الشروط الأساسية لمبدأ العطالة؛ لأن الحركة التي ينص عليها لا يمكن أن تحدث إلا في فراغ مثالٍ خالٍ من المقاومة، وهي فكرة أساسية لقبول فكرة أن الجسم لا يحتاج إلى نهاية لمساره أو غاية خارجية.
خاتمة:
خلاصة القول مثّل اكتشاف مبدأ العطالة في الفيزياء الكلاسيكية ثورة فكرية شاملة، وفتحاً معرفيًّا على مفاهيم لم يكن من الممكن قبولها ضمن النسق التقليدي الأرسطي؛ إذ فرض كما رأينا ضرورة تحطيم التصور التقليدي للحركة ونزع الطابع الغائي عن الطبيعة، وتفكيك المفاهيم القديمة التي تربط الحركة بالغاية، والسكون بالكمال، والحركة القسرية بالاضطراب، وتأسيس مفاهيم جديدة عن الفراغ والمكان واللانهاية والسرعة والحركة ذاتها. لهذا السبب، يستحيل علينا أن نفهم التعقيد المذهل الذي ميز اكتشاف هذا المبدأ دون العودة قليلا إلى الوراء وتخيل الشروط الواقعية التي حدثت فيها هذه الإنجازات؛ لأن الحركة التي يفترضها كانت مستحيلة وغير مقبولة داخل هذا النسق الأرسطي. لكن مع اكتشافه تحول ما كان مستحيلاً وغير معقول ومخالف لقواعد العقل والتفكير السليم، إلى أساس نظري راسخ في الفيزياء الكلاسيكية. ليس هذا فحسب، بل إن صياغته اقتضت تحرير المكان من طابعه المغلق والحيوي وفتحه على العالم المفتوح واللانهائي، إذ ليس بوسعنا أن نضع حدود للمكان الأوقليدي. وتبعا لذلك، فالمكان الحسي الذي كان يشكل إطار وجودنا وجزء من النظام الكوني للطبيعة وله صلة وثيقة بالكائنات التي توجد فيه (الاتجاهات والغايات الطبيعية)، بات مجرد مكان رياضي وفضاء هندسي خالِ من الخصائص الحيوية والصور الجوهرية. إنه مكان رياضي يعزل نفسه عن الطبيعة الحية التي نعيش فيها، خال من الكيفيات وللطبائع والصور الجوهرية ولا يمكن فهمه إلا من خلال الجبر والهندسة.
باختصار لقد مثلت مسألة الحركة المستقيمية المنتظمة التي يفترضها هذا القانون، ثورة علمية شاملة غيرت نظرتنا إلى الطبيعة والكون والعلم، وتطلبت صياغته مراجعة جذرية للعديد من المفاهيم العلمية مثل الحركة والسكون والطبيعة والغاية والمكان الطبيعي والسرعة واللانهاية والفراغ.... وكما يقول "كويري" لم يخرج مبدأ العطالة جاهزا من ذهن ديكارت أو غاليلي كما خرجت أثينا من رأس زيوس Zeus، بل إن تشكل التصور الجديد للحركة كان يتضمن ويستلزم تصورا جديدا للواقع الفيزيائي، والذي كان مبدأ العطالة تعبيرا عنه وحاملا له في نفس الآن"[33].
مراجع ومصادر المقالة:
v ألكسندر كويري، دراسات غاليلية، ترجمة يوسف بن عثمان، تونس، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، 2015
v Alexandre Koyré, Etudes galiléennes, Paris, Hermann, 1966
v Alexandre Koyré, Etudes d’histoire de la pensée scientifique, éditions Gallimard 1973
v Alexandre Koyré, Etudes newtoniennes, éditions Gallimard 1968
v Alexandre Koyré, Du monde clos à L’univers infini, Galimard 1973
[1] Alexandre Koyré, Études galiléennes, Paris, Hermann, 1966, p.164
[2] Ibid., p. 164
[3] Alexandre Koyré, Études d’histoire de la pensée scientifique, éditions Gallimard, p. 198
[4] Alexandre Koyré, Études galiléennes, op.cit., p.p198-199
[5] Ibid., p.161
[6] Alexandre Koyré, Études d’histoire de la pensée scientifique, op. cit., p;198
[7] Alexandre Koyré, Études galiléennes, op. cit., p.21
[8] Alexandre Koyré, Études d’histoire de la pensée scientifique, op. cit., p 200
[9] Alexandre Koyré, Études galiléennes, op. cit., p61
[10] Ibid., p.19
[11] Ibid., p.20
[12] Ibid., p. 21
[13] Alexandre Koyré ; Études d’histoire de la pensée scientifique ; op. cit., p.200
[14] Alexandre Koyré ; Etudes newtoniennes ; éditions Gallimard 1968, p. 30
[15] Alexandre Koyré, Études d’histoire de la pensée scientifique, op. cit., p. p199-200
[16] Alexandre Koyré, Etudes galiléennes ; op. cit., p.71
[17] Ibid., p.p 127-128
[18] Ibid., p.161
[19] Ibid., p. 131
[20] Ibidem
[21] ألكسندر كويري، دراسات غاليلية، ترجمة يوسف بن عثمان، تونس، المركز الوطني للترجمة، دار سيناترا، 2015، الهامش رقم 01، ص 157
[22] المصدر نفسه، ص 157
[23] Alexandre Koyré, Études galiléennes, op. cit., p.p. 163.164
[24] Ibid., p. 208
[25] Ibid., p. 209
[26] Alexandre Koyré, Étudesd’histoire de la pensée scientifique, op. cit., p.p. 196-197
[27] Alexandre Koyré, Études galiléennes, op. cit., p 229
[28] Ibid., p. 240
[29] Ibid., p. 239
[30] Ibid., p.246
[31] Alexandre Koyré, Du monde clos à L’univers infini, Galimard 1973, p.11
* هندسة المكان la géométrisation de l’espace هي السمة الأساسية التي يقرأ في ضوئها ألكسندر كويري ما سماه "الثورة العلمية الحديثة"، إذ يعتبر أن الثورة العلمية الحديثة لم تكن مجرد تراكم في الاكتشافات، بل كانت انقلاباً في الصورة الميتافزيقية العامة للعالم، وتفيد أن المكان الذي يحوي الانتاجات العلمية والفيزيائية ليس هو المكان الحسي الطبيعي المغلق والتراتبي، بل هو مكان هندسي متجانس ومجرد وموحد.
** تحطيم الكوسموس la destruction du cosmos هي صفة تنظيرية أساسية يصف بها كويري الثورة العلمية الحديثة، وتفيد أن الاكتشافات العلمية الكبرى للحداثة استهدفت تحطيم الكوسموس التقليدي المغلق والمحدود والتراتبي وتعويضه بفكرة الكون اللانهائي المفتوح والموحد، وتحطيم الكوسموس ليست عملية علمية خالصة، بل هي صفة تنظيرية تفاعلت فيها جوانب فلسفية ودينية وعلمية، ذلك لأن تحطيم الكوسموس اليوناني التقليدي وتكسير تراتبيته وتعديل مختلف المفاهيم والتصورات التي ارتبطت به تاريخياً تعبر عن عملية فكرية شاملة، تقاطعت فيها الفلسفة والدين والعلم.
[32] Koyré Alexandre ; Etudes galiléennes ; op. cit., p. 23
[33] Ibid., p.164