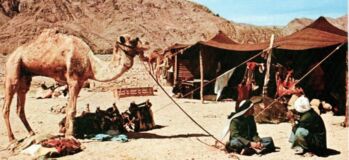نساء شيعيات حكمن المسلمين كالخليفة وهل التشييع أكثر تمسك بالأنثوي
فئة : مقالات
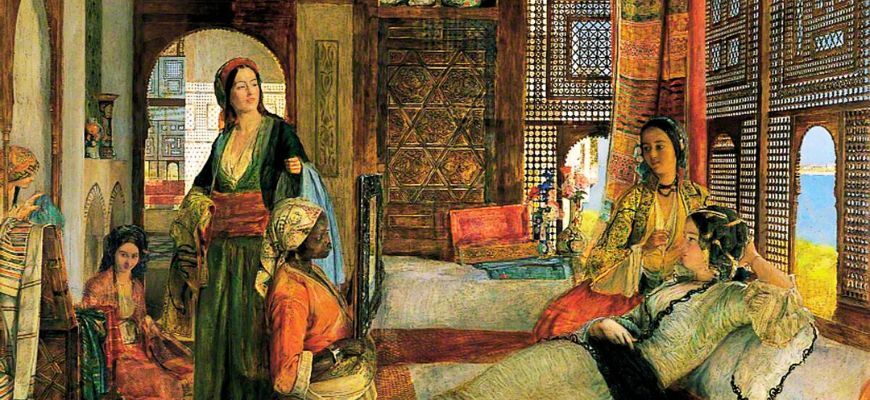
نساء شيعيات حكمن المسلمين كالخليفة
وهل التشييع أكثر تمسك بالأنثوي
تعريف الخلافة
تعرف الخلافة بأنها السلطة السياسية في الدنيا إلى جانب السلطة الروحية. فخليفة المسلمين لا يمثل الحاكم فحسب، بل يقوم أيضًا بدور روحي بصفته الخلف للرسول في الأمة. لذلك، تحيط بالخلفاء هالة من القدسية الروحية والدينية. ولتولي شخص ما منصب الخليفة، هناك عدة شروط، من أبرزها أن يكون الشخص ذكرًا، ما أدى إلى منع صعود أي امرأة إلى سدة الحكم كخليفة للمسلمين طوال فترات الحكم الإسلامي بشكل عام.
فقد كانت المرأة تُعتبر غير مخولة للقيام بالحكم الدنيوي الأرضي حتى كملكة، فكيف لها أن تقوم بدور دنيوي وروحي معًا، كأن تصبح خليفة لله على الأرض؟ لم يكن هذا الموضوع قابلًا للنقاش في ذلك الوقت وسط الصراعات التي كانت تحدث بين الأطراف المتنازعة على السلطة، حيث كانت كل مجموعة تدعي حقها في الخلافة بناءً على قرب نسبها من الرسول، مثل الأمويين والعباسيين الذين كانوا يشاركون النبي في الأعمام والأجداد، أو العلويين من نسل علي بن أبي طالب الذين اعتبروا أنفسهم الأقرب إلى الرسول كونهم من نسله. إلا أن نسلهم كان من ابنته فاطمة الزهراء، التي كانت زوجة لابن عم الرسول علي بن أبي طالب، مما يعني أن النسل هنا كان من الأنثى، فهل بإمكان النساء أن ينقلن السلطة؟
يعد هذا النقاش من أهم المواضيع التي شغلت الساحة الإسلامية في ذلك الوقت (ولا يزال مستمرًا إلى يومنا هذا)، وكان سببًا للعديد من النزاعات بين السلطة السياسية السنية والشيعية. فالحكام السنة كانوا يعترفون حصريًا بسلطة الذكور في الخلافة، بينما كانت المعارضة، التي كانت في الأغلب من العلويين الذين ينسبون أنفسهم إلى السيدة فاطمة بنت الرسول، ترى أن بإمكان النساء تمرير الحكم والخلافة.
التشيع كمعارضة للنظام
شكل التشيع وفهمه قضية مهمة، حيث تم إجراء العديد من البحوث عليها واستغرقت هذه بدورها سنوات طويلة. وهناك العديد من الكتب التي حاولت تفسيره وشرحه، إذ يعتبر التشيع شكلًا قويًا ومستمرًا من المعارضة السياسية والدينية، حيث يرتبط الدين والعنف ارتباطًا وثيقًا. ومنذ بدايته، عرف المذهب الشيعي بأنه معارض لنظام الحكم، غير معترف بالسلطة الدينية أو الدنيوية لخلفاء المسلمين عند السنة، إذ يرى الشيعة أن الخليفة الوحيد للرسول هو علي بن أبي طالب ونسله من أبنائه. وكان لكون الشيعة أعداءً للنظام أثر في تهجيرهم وقتلهم ومطاردتهم، مما جعل التشيع سريًا لفترات طويلة. ولأن أفراده كانوا يعانون من الظلم والتمييز من قبل الحكم الإسلامي، انضم العديد من المظلومين الذين كانت حقوقهم مهضومة إلى صفوفهم.
إذن، من هم الشيعة؟
الشيعة وحسب رأي ابن منظور
في لسان العرب، يُعرّف الشيعة بأنهم "القوم الذين يجتمعون على الأمر، وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم رأي بعض، فهم شيعة". كما يذكر أن "أصل الشيعة المشايعة وهي المتابعة والمطاوعة". والشيعة هم أتباع علي بن أبي طالب، أو القوم الذين يرون أن علي بن أبي طالب هو الأحق بالخلافة. وقد بايعوه بعد وفاة النبي، واعتبروه الحاكم الديني لهم حتى وإن لم يكن الحاكم السياسي في تلك الفترة.
يقول المسعودي في الجزء الثاني، في الصفحة 341 من "مروج الذهب": "لفهم مكانة علي بن أبي طالب عند الشيعة، يجب أن نتذكر موته قبل الحديث عن أي شيء آخر. لقد مات شهيدًا وذهب ضحية اغتيال سياسي رسم بدقة، بعد أن نحاه معاوية عن السلطة. وإثر وفاته، اضطهد أبناؤه وأحفاده شر اضطهاد، وظل اسمه مرتبطًا بالظلم واغتيال الأبرياء، وخلق رسالة الأخوة والمساواة بين المسلمين. وبذلك أصبح رمزًا التف حوله كل الذين حُرموا من حقوقهم وتعرضوا لمعاملة غير عادلة".
يكشف التاريخ الإسلامي في طيات أوراقه العديد من تجاوزات الولاة على المناطق والسكان، الذين بدورهم ردوا على هذا الظلم عبر ثورات قادها السكان المحليون في العديد من المناطق الإسلامية. وكانت هذه الثورات تظهر في كثير من الأحيان كمعارضة دينية أكثر من كونها سياسية فقط.
ففي القرن السابع الميلادي، خلال حكم الخليفة الراشدي الثالث عثمان بن عفان، الذي امتازت فترة حكمه بالأخطاء والتجاوزات من قبل ولاته في العراق ومصر واليمن، أثار هذا الأمر غضب سكان هذه المناطق، مما دفعهم لأن يصبحوا أكثر ثورية ضد النظام. وكان التشييع هو الحاضنة لهذا الغضب، الذي بدوره وجه هذا الغضب كمقاومة للنظام الديني والدنيوي للحكومة السنية.
في الطبيعة الإنسانية المعقدة، عندما تكون مجموعة من الأشخاص فئة مهمشة يتعرضون للظلم وتهميش حقوقهم، يؤدي ذلك في أغلب الأحيان إلى جعل هذه الفئة أكثر تعاطفًا مع الفئات المهمشة الأخرى، حيث يستطيعون الإحساس بما يعانيه الآخرون. فهل كان الشيعة أكثر تعاطفًا مع النساء وأكثر قبولًا لهن في مراكز السلطة؟
الدولة الفاطمية والنسب الى فاطمة الزهراء
بعد العديد من السنوات والدعوات السرية التي كانت تقوم بها الإسماعيلية (إحدى الفرق الشيعية)، استطاعوا في النهاية توجيه ضربة قوية إلى الخلافة العباسية السنية في بغداد. حيث تمكن الشيعة من تأسيس دولة خلافة لهم في القاهرة، وهي الدولة الفاطمية التي كانت مضادة للحكم العباسي السني. امتدت الدولة الفاطمية إلى أراضٍ واسعة، واستخدم الفاطميون نسبهم ليؤكدوا أنهم الأجدر بالخلافة على المسلمين، كونهم الأقرب إلى الرسول ومن نسل ابنته فاطمة الزهراء، التي سميت الدولة على اسمها.
بعدما سمَّى الشيعة دولتهم على اسم امرأة، وافتخروا بالانتساب إليها واعتبروها تورث الحكم، ومع كونهم فئة مهمشة أيضًا، يتبادر إلى أذهاننا سؤال جوهري: هل التمييز بين الإسلام الشيعي والإسلام السني فيما يتعلق بالنساء يعكس تعامل الشيعة بشكل إيجابي مع المرأة؟ وهل هم أكثر تقبلاً للمساواة؟ وكيف سيتعاملون لو حكمتهم امرأة وهم الذين يتفاخرون بنسب النساء؟
قبل كل شيء، يجب الإشارة إلى أن الشيعة يُميزون أنفسهم كمعارضة للسلطات القائمة بجميع أشكالها تقريبًا. ففي الوقت الذي تمسك فيه الشيعة بالأنثوي من خلال النسب النسائي الذي يمتد إلى فاطمة الزهراء وخديجة زوجة الرسول، واللتين تحتلان مكانة سامية ومقدسة عند الشيعة، كانت مكانة النساء تواجه الرفض من الحكام السنيين، الذين يرون أنه من المستحيل أن تورث النساء هذه السلطة. وكانوا يشكلون أن المرأة التي لا تستطيع أن تؤم بالناس في الإمامة الصغرى، لا يمكنها توريث الإمامة الكبرى.
توجد رسالتان بالغتا الأهمية في هذا الشأن تم تبادلهما بين المنصور، ثاني الخلفاء العباسيين (حكم بين 136 و 158 هـ)، وبين معارضه الشيعي الذي كان أحد العلويين وينتهي نسبهم إلى فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب، وكان يسمى محمد بن عبد الله بن الحسين بن الحسن بن علي، الملقب بالنفس الزكية.
يذكر الطبري كيف يتفاخر النفس الزكية في مناظرته بنسبه في النساء، حيث ينتهي نسبه إلى خديجة زوجة الرسول، وهي أول زوجاته وأول من آمن به بعد أن أخبرها بنزول الوحي جبرائيل عليه السلام. وكانت خديجة تاجرة وأنفقت أغلب أموالها لنصرة الدين الجديد، وأول من أزره حين أعلن دعوته. وقد رزق منها الرسول بفاطمة الزهراء التي ينسب الشيعة إليها. ويصف النفس الزكية في رسالته إلى المنصور فاطمة بأنها "أفضل النساء وأسبق الفاضلات إلى الجنة". فكيف كان رد الخليفة المنصور على هذا النسب السامي النسائي؟
دافع الخليفة المنصور عن شرعيته وأحقيته بالخلافة بالانتساب إلى الرسول عبر الرجال، وهو عمه العباس. ورد ببساطة دون تعقيد أو إطالة، لأنه لم يعتقد بأي إمكانية لتوريث النساء للحكم، قائلاً: "بلغني كلامك، فإذا جل فخرك بالنساء… ولم يجعل الله النساء كالعمومة ولا الآباء كالعصبة… ولكنكم بنو بنته (الرسول)، وإنها لقرابة قريبة، غير أنها امرأة، لا تحوز الميراث ولا يجوز أن تؤم. فكيف تورث الإمامة من قبلها؟"
لقد كانت مطامح العلويين في السلطة غير ذات أساس في ذهن العباسيين، ذلك أن انتقال الخلافة عبر الانتساب إلى النساء أمر غير ممكن في تصورهم.
الخليفات الإسلاميات
بالإضافة إلى قصة الملكة بلقيس التي حكمت اليمن قبل الإسلام بوقت طويل، يتميز اليمن عن سائر أنحاء الدول العربية الإسلامية في ذلك الوقت ليس فقط لأن العديد من النساء قد وصلن إلى مراتب عالية في السلطة، بل لكون ملكتين من هذه النساء تم الاعتراف بهما كرئيستي دول بشكل صريح، وهما الملكتان أروى وأسماء. وهذا شيء لم يحدث في أي مكان آخر في البلدان ذات الحكم العربي الإسلامي. كان ذلك في زمن الدولة الصليحية، وهي سلالة إسماعيلية شيعية حكمت اليمن، ويمكن القول إنها كانت امتدادًا للدولة الفاطمية في القاهرة. فوصول الدولة الصليحية إلى اليمن كان ليكون مستحيلًا لولا وصول الدولة الفاطمية إلى الحكم في مصر.
ينقل الزركلي في الجزء الأول من كتابه في الصفحة 279 نصًا من الخطبة التي كانت تلقى أيام الجمعة في الجوامع الواقعة تحت سيطرة الدولة الصليحية في اليمن، والتي كانت تلقى باسم الملكة أروى، وجاء فيها: "اللهم أدم أيام الحرة الكاملة السيدة خليفة المؤمنين".
لم يكن المذهب الشيعي، وخلال فترة حكم ملكات اليمن والدولة الفاطمية، مجرد معارضة متكونة من مجموعة من القبائل والأشخاص المحرومين والمظلومين، بل أصبح التشيع دولة قوية، لها جيشها الذي كان يطمح لحكم جميع المسلمين والإطاحة بالدولة العباسية السنية باسم أهل البيت. كما انتشر المذهب الشيعي إلى أطراف العالم خلال فترة الحكم الفاطمي، بسبب سيطرتهم على الموارد المطلوبة لنشر أفكارهم ومبادئهم.
كانت الملكة أسماء هي زوجة علي الصليحي، الذي كان خليفة الدولة الصليحية، ولكنه كان يثق بها وبمشورتها، فوكل إليها في النهاية إدارة شؤون الدولة في حياته. يذكر المؤرخ اليمني محمد التاور ذلك، فيقول عن الملكة أسماء: "كانت الأكثر شهرة بين نساء زمانها، وكذلك بين الحكام، وكانت كريمة، وكانت شاعرة تنظم الشعر بنفسها. ومن بين الأمجاد التي كان يتميز بها زوجها الصليحي والتي كان يتغنى بها الشعراء هي أنها كانت زوجته، وعندما تحقق زوجها من كمال خلقها، عهد إليها بإدارة الشؤون فلم يخالفها في غالبية الأمور".
بعد وفاة الصليحي، حكمت أسماء كخليفة وحاكمة للدولة الصليحية حتى وفاتها. وبعد وفاتها، حكمت الملكة أروى، التي كانت زوجة ابنها محمد بن علي الصليحي، الذي كان يعاني من المرض، فحكمت الملكة أروى كخليفة للدولة الشيعية. وتميزت الملكة أروى عن الملكة أسماء بأنها أخذت بعدًا روحياً أكبر، فاعتُبرت إحدى الشخصيات البارزة للمذهب الإسماعيلي الشيعي كزعيمة روحية. فلم تكن حاكمة دينية ودنيوية فحسب، بل ساهمت في نشر المذهب الشيعي في آسيا، بطريقة سريعة الانتشار، مما يوضح لنا الصفات القيادية والزعامة التي حصلت عليها الملكة أروى، وكيفية رؤية الناس لها، بشكل أكثر من مجرد حاكم دنيوي.
ويقول الزركلي في كتابه (قاموس لأشهر الرجال والنساء): "أروى ملكة كفؤة، إدارية لا مثيل لها"، كما عدها "من زعماء الإسماعيلية". ففي فترة حكم أروى، بدأت الإسماعيلية تشع في شبه القارة الهندية. ازدهرت الدولة في زمن حكم الملكة أروى وتطورت كثيرًا، فبُنيت الجوامع والطرق والمشاريع العمرانية. كما اهتمت أيضًا في تنشيط المراكز الثقافية والدينية من خلال منح المعلمين والعلماء رواتب مهمة.
كما يذكر المؤرخ عبد الله أحمد محمد التاور أنه إذا كانت هناك ملكتان حكمن بشكل صريح في التاريخ الإسلامي للمنطقة، فإن السؤال يظل قائمًا: لماذا لا يتم ذكر الموضوع؟ هل هناك محاولة لطمسه؟ أم هل فقد المؤرخون الذاكرة أم كانوا يحاولون التناسي؟
النسيان المتعمد
تجيب الكاتبة المغربية فاطمة المرنيسي عن هذا السؤال في كتابها سلطانات منسيات حيث تقول: "تم التغاضي عن هاتين الملكتين ونسيانهما بشكل كامل، فكأنما نُسيتا من ذاكرة المؤرخين، ولا نجد عنهما إلا الشيء القليل، كأنما لا أحد سمع بهما". وتكمل: "لأن فقدان الذاكرة، على ما يظهر، مرتبط بالانتماء الجغرافي والثقافي. فالعرب لا ينسون جميعهم نفس الأشياء، ونسيانهم رهين بالإطار الوطني والذاكرة المحلية. يبدو أن المؤرخين اليمنيين أقل من غيرهم فقدانًا للذاكرة، حين يتعلق الأمر بالمرأة والسلطة، بحيث يعلون على رؤوس الملأ بأنهم عرفوا نساء ملكات في الماضي. فإذا كان المؤرخون اليمنيون المحدثون لا يجدون غضاضة في الاعتراف والاعتزاز بملكة كقائدة دولة عظيمة، ويؤكدون بعد تحليل الوقائع بأنها كانت أكثر كفاءة على المستوى السياسي من عدة أئمة، فلماذا يعاني مؤرخون عرب آخرون من صعوبة في نهج نفس الطريق؟ ما هي النوعية التي تسم علاقة اليمنيين بالنساء كعنصر من العناصر المكونة لتاريخ الجماعة؟ أهي مكانة المرأة في العبادات القديمة؟ أم هي ذكرى ملكة سبأ؟ أم هي ممارسة السبئيين في العصور الغابرة لتعدد الأزواج؟"
ويقول المؤرخ اليمني عبد الله الثور: "يكفي لمؤرخ أمين أن يقارن حكم الأئمة، مقارنة مختصرة جدًا، بالفترة التي حكمت فيها امرأة يمنية حريصة على مبادئها، تحب شعبها، وتظل وفيَّة له، وهي السيدة أروى بنت أحمد الصليحي، التي خلقت المآثر وعمرانًا وطرقًا ومساجد وأشياء كثيرة لم يحققها الأئمة خلال حكمهم الطويل".
وتعود بعدها المرنيسي لمحاولة تفسير هذا النسيان، فتعزوه إلى كونهما شيعيتين. فالحقيقة التي تفسر ظاهر فقدان الذاكرة هذه عند المرنيسي هي أن الملكتين أروى وأسماء كانتا شيعيتين، فتقول: "الطيف المزعج الذي تحيل عليه ذكرى أسماء وأروى هو الشيعة، بصفتها معارضة سياسية مرتبطة بعنف جد خاص، بما أنه عنف يركز على الدين. إنها معارضة تزعزع السلطة السياسية في أساسها، أي شرعيتها ذات الطبيعة المقدسة، باسم الدين. لقد هزت الشيعة، وخلال قرون، أسس الإسلام السني بصفته نهجًا أرثوذوكسيًا استبداديًا. ومنذ اقتحام الشيعة الصاعق للساحة الدولية إثر وصول الخميني إلى السلطة خلال السبعينات والحرب العراقية الإيرانية، لم يعد الوقت ملائمًا لبعث بعض الذكريات، وغدا فقدان الذاكرة أمرًا مرغوبًا فيه أكثر."
وفي النهاية، لا نستطيع الجزم بشكل قاطع ما إذا كان السبب هو الظلم والتهميش الذي جعل الشيعة أكثر تقبلًا لأن تحكمهم نساء، أم لأن الموضوع كان يخدم أغراضهم السياسية في الوصول إلى الحكم. فلو ألغى الشيعة النساء بشكل نهائي، لكانوا قد ألغوا بذلك شرعيتهم التي من خلالها يطالبون بالوصول إلى الحكم والسلطة. ولكن في كلتا الحالتين، استطاعت النساء المسلمات الوصول إلى لقب "خليفة" وحكم أجزاء شاسعة من الأراضي تحت الحكم الشيعي سابقًا. كما يعدّ التشيع المذهب الوحيد في الأديان الإبراهيمية الذي يستمد وجوده من امرأة، وهي الزهراء بنت محمد.