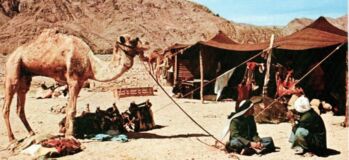خلافة عَلِيّ بن أبي طَالب وخطر الطُّلقاء
فئة : ترجمات

خلافة عَلِيّ بن أبي طَالب وخطر الطُّلقاء
تأليف: د. شون ويليام أنتوني
ترجمة: د. عَبد الكريم مُحَمَّد عَبد الله الوظّاف
مقدمة المترجم
نُشرت هذه المقالة كمسودة عام 2025م تحت عنوان "THE EMIRATE OF ʿALĪ IBN ABĪ ṬĀLIB AND THE MENACE OF THE ṬULAQĀʾ"، في موقع أكاديميا على الرابط https://www.academia.edu/143572616/Tulaqa_pdf.
يُناقش هذا البحث مصطلح أو لفظة "الطُّلقاء"، والتي مدارها وأول من قال بها هو رسول الله مُحَمَّد بن عَبد الله يوم فتح مكة، وأعلن لأهل مكة وقتها، ممن لم يعتنق الإسلام بَعد، بأنهم طُّلقاء أو ما جرى تُسميتهم بعد بمسلمي الفتح.
ربما أن مصطلح "مسلمو الفتح" جاء بديلًا عن "الطُّلقاء" للتخفيف من وقع وأثر من جرى وصفهم بهذا الوصف. يشمل هذا الوصف الأمويين على نحو خاص، وأهل مكة ممن أسلم في فتح مكة كعقيل بن أبي طالب، والعَباس بن عَبد المطلب؛ على الرغم من أن إسلام العَباس المتأخر قد دُحض بادعائيْن: أنه أسلم يوم بدر، والآخر أن من أول من آمن، وكتم إسلامه بأمرٍ من الرسول لغرض التخابر لصالح رسول الله.
يُناقش شون أنتوني مُصطلح "الطُّلقاء"، ويتتبع امتداده على طول التأريخ العربيّ الإسلاميّ، وما جرى عليه، وما أثاره هذه المصطلح من قيود سياسيَّة واجتماعيَّة، وربما اقتصاديَّة، على أصحابه.
وشون ويليام أنتوني هو مؤرخٌ في التأريخ الإسلاميّ المُبكر والأدب العربيّ. بعد حصوله على الدكتوراة من جامعة شيكاغو، في عام 2009م؛ قام بالتدريس في جامعة أوريغون (يوجين) وجامعة ولاية أوهايو، حيث يعمل حاليًا أستاذًا للغات وثقافات الشرق الأدنى. له عدة مؤلفات منها: كتاب الخليفة والزنديق: ابن سبأ وأصول التشيع، The Caliph and the Heretic: Ibn Saba and the Origins of Shiism (2011)، وكتاب الصلب والموت كمشهد: الصلب الأمويّ في سياقه العتيق المتأخر، Crucifixion and Death as Spectacle: Umayyad Crucifixion in its Late Antique Context (2014)، وكتاب مُحَمِّد وإمبراطوريات الإيمان: تشكّل نَّبِيّ الإسلام، Muhammad and the Empires of Faith: The Making of the Prophet of Islam (2020)، وَاَلَّذِي سَبَقَ لِي أَنْ قُمْتُ بِتَرْجَمَتِهِ إِلَى اَلْعَرَبِيَّةِ، وصدر عن دار أبكالو.
إليك أيها القارئ العربيّ أحدث دراسةٍ خرج بها أنتوني، وهي من ضمن الأعمال والأدبيات التي أنتجها الباحثون من الغرب في شأن الدراسات الإسلاميَّة، والتي أحاول فيها نقل ذلك للقارئ العربيّ، وبالله التوفيق.
مقدمة
تتناول هذه الدراسة موضوعًا نادرًا ما يُسلَّط عليه الضوء، والذي يَظهر في الروايات التأريخيَّة المُبكرة عن الصراع بين عَلِيّ بن أبي طَالب (حكم 36-40هـ/656-661م) ومُنافسه اللدود على زعامة الأمة الإسلاميَّة، والي الشام مُعاويَة بن أبي سُفيان، بعد عزل الخليفة عُثمَان بن عفَّان ومقتله سَّنة 36هـ/656م. يبدأ تحليلي بفحص الفكرة كما وردتْ في ثلاث رسائل منسوبةٍ إلى عَلِيّ، والتي وجّهها، بصفته خليفةً، ظاهريًّا إلى مُعاويَة بن أبي سُفيان خلال المدة ما بين الأعوام 565-657م. برزتْ كل رسالة من هذه الرسائل لأول مرةٍ في روايات الدراسات التأريخيَّة التي تعود إلى أواخر القرن السابع الميلاديّ وأوائل القرن الثامن الميلاديّ، مثل كتاب وقعة صفين لنصر بن مُزاحم المِنقريّ (ت. 212هـ/827~728م).
يَعتقد قُراء هذه الأعمال المُبكرة في التأريخ العربيّ أن عَلِيًّا قد كتب أولى هذه الرسائل بعد وصوله إلى الكُوفَة في أعقاب انتصاره على طلحة والزُبيْر في موقعة الجمل في جمادى الأولى (36هـ/ديسمبر (كانون الأول) 656م). كان هدف هذه الرسالة الأولى هو المُطالبة ببيعة مُعاويَة لعَلِيّ بوصفه خليفةً. ظلت الشام، آنذاك، الولاية الوحيدة التي أخفق عَلِيّ في السيطرة عليها حتى ذلك الحين. أُوكلَ تسليم الرسالة إلى والي الخليفة السابق على هَمدان، جرير بن عَبد الله البَجليّ. كان جرير رجلًا يتمتع بعلاقاتٍ طيبةٍ بالأمويين، وكان عَلِيّ قد أعاد تثبيته في منصبه، وكانت لديه فرصةً أفضل من أيّ شخصٍ آخر لإيصال الرسالة بأمان إلى مُعاويَة. في هذه الرسالة، عاتب عَلِيّ مُعاويَةَ قائلًا([1]):
"فإن بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام؛ لأنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر، وعُمر، وعُثمَان على ما بُويعوا عليه؛ فلم يكن للشاهد أن يختار، ولا للغائب أن يرد. وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار([2])، فإذا اجتمعوا على رجلٍ فسموه إمامًا؛ كان ذلك لله رضًا... واعلم أنك من الطُّلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة، ولا تُعرض فيهم الشورى... فبايع، ولا قوة إلا بالله"([3]).
ما يُهما هنا يظهر قرب خاتمة الرسالة: لم يكتفِ عَلِيّ بإعلان أنه يجب على مُعاويَة الإقرار بسُلطانه ومُبايعته؛ وبالتالي، يعترف بشرعيَّة بيعته في المدينة المنورة خليفةً لعُثمَان قبل سَّنة؛ بل ذكّر مُعاويَة أيضًا بأنه هو نفسه غير مؤهلٍ للخلافة وغير مؤهلٍ للمشاركة في مداولات أيّ مجلس شورى مُكلَّفٍ باختيار الخليفة التالي. ما الذي يمنعه من ذلك؟ يقول عَلِيّ إن مُعاويَة مِن الذين يُسمّون "الطُّلقاء"([4])، الذين مُنعوا من تولي مثل هذه المناصب في القيادة السياسيَّة للأمة. لكن من هم هؤلاء الذين يُسمّون "الطُّلقاء"؟
إن تقسيم صحابة النِّبِيّ مُحَمَّدٍ إلى معسكريْن عريضيْن معروفٌ على نطاقٍ واسع: فهناك المهاجرون، وهم أقدم أتباعه من مكة الذين هاجروا للانضمام إليه بعد هجرته إلى يثرب/المدينة المنورة في عام 622م، وهناك الأنصار، وهم الأوس والخزرج، وهما قبيلتان عربيتان من يثرب؛ رحبتا بمُحَمَّدٍ وأتباعه الأوائل في منطقتهما، ووفرتا لهم المأوى من اضطهاد قُريشٍ في مكة، وقاتلتا فيما بعد إلى جانبهم في حروب النِّبِيّ. بيد أن هناك فرعٌ آخر من صحابة النِّبِيّ، وهم أقل شهرةً، وهم من يُطلق عليهم اسم "الطُّلقاء"؛ أي قُريش المُتمردين من مكة الذين لم يُسلموا إلا عقب استسلام المدينة المقدسة للنِّبِيّ في سَّنة 8هـ/629~630م.
وفقًا لأحد علماء المدينة المنورة الأوائل، ابن إسحاق (ت. 150هـ/767م، في بغداد)، كان النِّبِيّ هو من أطلق على المكيين المهزومين هذا الاسم بذاته. فبعد انتصاره عليهم ودخوله مكة؛ جمع أهل الحرم المهزومين في حشودهم ليُبايعوه أمام الكعبة، وعندها أعلن: "اذهبوا فأنتم الطُّلقاء". يُضيف ابن إسحاق: "فاعتقهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كان الله أمكنه من رقابهم عنوةً، وكانوا له فيئًا؛ فبذلك يُسمى أهل مكة الطُّلقاء"([5]).
ومنذ ذلك الحين، أصبح لقب "الطُّلقاء" إهانةً شائعةَ الاستخدام ضد أولئك القُرشيين الذين اعتنقوا الإسلام بعد فتح مكة؛ لأنه كان يُشير إلى حقيقة أنهم كانوا سيظلون مُستعبدين بوصفهم أسرى لو لم يُطلَق سراحهم بموجب عفو النِّبِيّ. كما يُفهم من اللقب، كانوا يتحملون الإذلال الذي لا يُمحى؛ لكونهم مُحرَرين: كانوا عبيدًا سابقين؛ سيتحمل أشخاصهم وأطفالهم بعد ذلك وصمة وضعهم المُستعبد ذات يوم([6]). باختصار، كان المُحرَرون أقل مكانةً من المهاجرين والأنصار من حيث التقوى والمكانة الاجتماعيَّة والسياسيَّة.
يظهر هذا النمط في رسالتيْن أُخرييْن شقتا طريقهما إلى نهج البلاغة الشهير، وهو مُختاراتٌ مُوقرةٌ لخُطب عَلِيّ بن أبي طَالب، ورسائله، وحِكمه التي جمعها الشريف الرضيّ (ت. 406هـ/1015م). يعود تأريخ أول هذه المُختارات إلى سنة 35هـ/657م؛ على الرغم من أنها مكتوبة في وقتٍ لاحقٍ إلى حدٍّ ما بعد الرسالة المذكورة آنفًا، وردًّا على رسالةِ مُعاويَةِ التي يَتهم فيها عَلِيًّا بأنه كان يطمح للخلافة منذ زمنٍ طويلٍ، وأنه لعب دورًا حاسمًا في مقتل قريب مُعاويَة، الخليفة عُثمَان، قبل عام. في رده الذي أثنى عليه الشريف الرضيّ ووصفه بأنه "من محاسن الكتب" (النهج، 1.28.1، Nahǧ, 2.28 1, tr. Qutbuddin, 562-565)([7]):
"وزعمتَ أن أفضل الناس في الاسلام فلان وفلان([8])؛ فذكرت أمرًا إن تم اعتزلك كله وإن نقص؛ لم يلحقك ثلمه. وما أنتَ والفاضل والمفضول والسائس والمسوس، وما للطلقاء وأبناء الطلقاء والتمييز بين المهاجرين الأولين".
مرةً أخرى، يستشهد عَلِيّ بمنزلة مُعاويَةَ الأدنى في مواجهة المهاجرين كونه "طليق" - وهي خطوةٌ بلاغيَّةٌ يستخدمها لتوبيخ مُعاويَة على جرأته على اعتبار نفسه أهلًا لرتبةٍ، ناهيك عن الحُكم على رؤسائه، )وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ( (راجع: سورة التوبة: 100)، الذين ينتمي إليهم عَلِيّ، والذي يُفترض أنه يطعن فيه.
الرسالة الثالثة إلى مُعاويَة كتبها عَلِيّ في خضّم معركة صفين سَّنة 37هـ/657م. يكتبها عَلِيّ رافضًا طلبَ مُعاويَة المتُجدِّد بالحفاظ على ولايته في الشام، مع الحفاظ على استقلاله ودون بيعةٍ لعَلِيّ، وبالتالي، حفاظًا على نصيبه في قيادة الأمة. يرى عَلِيّ بأن هذا الطلب ليس مُضلِّلًا فحسب، بل غير مشروع أيضًا. ويكتب إليه التوبيخ الآتي (النهج، 2.17.1، Nahǧ, 2.17.1, tr. Qutbuddin, 546-549= المِنقري، صفين، ص471):
"فأما طلبك الشام، فإني لم أكن لأُعطيك اليوم ما منعتُك منها أمس. وأما استواؤنا في الخوف والرجاء؛ فإنك لستَ أمضى على الشك مني على اليقين... وأما قولك: "إنا بنو عَبد مناف ليس لبعضنا على بعض فضل"؛ فلعمري إنا بنو أبٍ واحدٍ، ولكن ليس أميَّة كهاشم، ولا حرب كعَبد المطلب، ولا أبو سُفيان كأبي طَالب، ولا المُهاجر كالطليق، ولا المُحق كالمُبطِل. وفي أيدينا بَعدُ فضل النبوة التي أذللنا بها العزيز، وأعززنا بها الذليل. ولما أدخل اللهُ العربَ في دينه أفواجًا وأسلمتْ له هذه الأمة طوعًا وكرهًا؛ كنتم ممن دخل في الدين، إما رغبةً وإما رهبةً، على حين فاز أهل السبق بسبقهم، وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم. فلا تجعلن للشيطان فيك نصيبًا، ولا على نفسك سبيلًا".
هذا المقطع من الرسالة يدحض ويُقوّض مُجددًا ادعاء مُعاويَة بالحق في أيّ دورٍ قياديٍّ في الأمة الإسلاميَّة مِن خلال استحضار مبدإٍ بسيطٍ للغاية. يُقرّ عَلِيّ بأن مُعاويَة هو في واقع الأمر من الفرع القُرشيّ الذي ينتمي إليه نفسه، وبالتالي، فهو قريبٌ يستحق قدرًا ضئيلًا من الاعتبار، وإن كان ضمن حدود؛ لكنه تنازلٌ صغيرٌ يُثبَتُ في نهاية المطاف أنه غير ذي أهميَّة. يُذكّرُ مُعاويَةُ مرةً أخرى بأحد أبرز عيوبه: فهو لم يكن رجلًا، كعَلِيّ، يتباهى بكونه من أوائل المُهتدين إلى الإسلام في مكة، أو حتى مُهاجرًا عانى وناضل إلى جانب النِّبِيّ منذ البداية. بدلًا من ذلك، كان مُعاويَة "مُعتَقًا"؛ حارب النِّبِيّ وعارضه، ورفض اعتناقه الإسلام حتى فتح النِّبِيّ مكة سَّنة 8هـ/630م. ثم يستذكر عَلِيّ بعد ذلك اعتناق مُعاويَة للإسلام في وقتٍ مُتأخرٍ، بل قسرًا.
تُثير حُجج عَلِيّ ضد مُعاويَة في هذه الرسائل الثلاث موضوعًا فرعيًّا مُهمَلًا إلى حدٍ ما في التأريخ العربيّ المُبكر فيما يتعلق بالفتنة الكبرى، والذي سيُتناول بمزيدٍ من التفصيل أدناه. يبدو أن هذا الموضوع بارزٌ على نحوٍ خاص في أعمال أخبارييّ القرن الثاني الهجريّ/الثامن الميلاديّ المعروفين بتعاطفهم مع الشِّيعة، أمثال أبي مِخنف لوط بن يَحيى الأزديّ (ت. 588هـ/610هـ) وعُمر بن سَعد بن أبي الصيد الأسديّ (ت. حوالي 588هـ/610هـ)([9])، ورواياتهم عن صراع عَلِيّ مع مُعاويَة([10])، لكنه يَظهر على نطاقٍ أوسع في أعمال مؤلفين آخرين أيضًا - ليس فقط بوصفه مصدر قلقٍ لعَلِيّ. تسعى هذه المقالة إلى توثيق المواقف المُعبَر عنها ضد من يُسمون بالطُّلقاء في أقدم طبقات التأريخ العربيّ ووضعها في سياقها، واستكشاف الدور الذي لعبه هذا الموضوع الفرعيّ في النقاشات والصراعات حول زعامة الأمة الإسلاميَّة، ولماذا (على الأرجح) كان لهذا الموضوع تأثيرٌ قويٌّ في تطور الذاكرة التأريخيَّة للعلماء المسلمين في القرن الثاني الهجريّ/الثامن الميلاديّ.
⁂
أولئك الذين ازدروا قادة الأمويين ووصفوهم بالطُّلقاء، لمّحوا إلى أنهم، وإن كانوا من قُريش، إلا أنهم كانوا قُريشًا أقل شأنًا - وهي المكانة التي جعلتهم غير جديرين بالخلافة. لكن بطبيعة الحال تمكّن الأمويون في نهاية المطاف من الخلافة. بيد أنه بمجرد أن سيطر الأمويون على الخلافة؛ فإن سمعتهم السيئة كآخر من اعتنق الإسلام جعلتهم كبش فداء سهلٍ لانحطاطهم. ففي نهاية المطاف، كان أجدادهم خصومًا شرسين للنِّبِيّ وأتباعه طوال معظم حياتهم. أبو سُفيان، جد السُفيانيين، لم يَعتنق الإسلام إلا بعد فتح مكة عام 630م، وكان صِدقَ إسلامه موضع تساؤل دائمٍ([11]). كذلك أسلاف المروانيين اللاحقين، مروان بن الحكم (حكم 64-65هـ/684-685م) ووالده الحكم بن أبي العاص، الذي يُقال إن النِّبِيّ لعنه مع ذريتهما([12]).
لكن الأمويين لم يكونوا الطُّلقاء الوحيدين، ولم يكن كل الطُّلقاء أمويين. حتى أعضاء شهيرين من بني هاشم يمكن اعتبارهم، بل كانوا، من ضمن الطُّلقاء. وشمل ذلك أيضًا إخوةَ عَلِيّ نفسه، مثل أم هانئ([13]). ذات مرة، سُئل الإمام جَعفر الصادق (ت. 148هـ/765م) في مجلسه: كيف أمكن للمدينة المنورة أن تُنكر حقوق عَلِيّ بهذه الوقاحة بعد وفاة النِّبِيّ؛ بالنظر إلى قوة بني هاشم وأعدادهم؟! فأجاب جَعفر([14]):
"ومن كان بقي من بني هاشم؟ إنما كان جَعفر [ابن أبي طَالب] وحمزة [ابن عَبد المطلب] فمضيا([15]). وبقي معه رجلان ضعيفان ذليلان حديثا عهد بالإسلام: عَباس [ابن عَبد المطلب] وعقيل [ابن أبي طَالب]، وكانا من الطُّلقاء".
هذه الملاحظات، بطبيعة الحال، لا تنفي مجمل المزايا الجماعيَّة لبني هاشم([16])، لكنها تؤهلهم جميعًا على القدر نفسه من الأهميَّة([17]). لعل الثائر الحَسنيّ مُحَمَّد النفس الزكيَّة يُلّمح إلى هذه المكانة المُـتدنيَّة لبعض بني هاشم عندما يكتب في رسالته الشهيرة إلى الخليفة العَباسيّ المنصور سَّنة 145هـ/762م، "واعلم أني [على عكسك] لستُ من أولاد الطُّلقاء، ولا أولاد اللّعناء"([18]). يبدو أن ذَكَرَ عدم وجود أيّ مولى -أي طُّلقاء - بين أسلافه بمثابة طعنٍ خفيٍّ في جد المنصور، العَباس بن عَبد المطلب. يُمكن إدراك أن ملاحظة النفس الزكيَّة قد مستْ وترًا حساسًا بذكرها للطُّلقاء؛ وذلك في رد المنصور اللاذع؛ إذ ذكّره الخليفة بأنه حتى هو ينحدر من أبي طَالب، وهو رجل مات كافرًا، مُقارنةً بجده العَباس([19]) - على الرغم من المُناقشات الكلاميَّة الشهيرة حول إيمان أبي طَالب([20]).
على الرغم من أن التنديدات بالدور الضار الذي يلعبه الطُّلقاء في سياسة الأمة الإسلاميَّة تَبرز بشكلٍ جليٍّ في روايات حرب عَلِيّ ضد مُعاويَة؛ فإن عدة رواياتٍ تُصوّر خطر تورطهم في الشؤون السياسيَّة للأمة بوصفه الشغل الشاغل للخليفة عُمر بن الخطاب (حكم 13-23هـ/634-644م) أيضًا. ومِن ثَم، تذهب إحدى الروايات إلى أن عُمر رفض بادئ ذي بدءٍ منح المكيين المهزومين عطاءً أو إرسالهم إلى الفتوحات، قائلًا: "هم طلقاء"([21]). كما تذهب روايةٌ أخرى إلى أن عُمر أمر المسلمين: "ولا تنكحوا بناتكم طُّلقاء أهل مكة"([22]). هذا النهي، وإن لم يُثبتْ على نطاقٍ واسع؛ يَظهر في أماكن أخرى. ففي أحد الروايات، تحكي أم هانئ ابنة أبي طَالب كيف أنها كانت مخطوبةً للنِّبِيّ، لكن الزواج لم يُجر بعد نزول الآية 50([23]) من سورة الأحزاب، ولأنها، كما تقول، "فلم أكن أحل له؛ لأني لم أهاجر؛ كنتُ من الطُّلقاء"([24]).
تُشير معظم الروايات المُبكرة إلى أن عُمر بن الخطاب اعتبر الطُّلقاء وأبناءهم غير جديرين بأيّ منصبِ سُلطةٍ أو نفوذٍ. لذلك، نُقل عن عُمر قوله([25]):
"هذا الأمر في أهل بدر ما بقي منهم أحد، ثم في أهل أُحد ما بقي منهم أحد. وفي كذا وكذا. وليس فيها لطليقٍ، ولا لولد طليقٍ، ولا لمسلمة الفتح شيءٌ".
بطبيعة الحال، بَرَزَ بعض الطُّلقاء في خلافة عُمر، وأشهرهم ولدي أبي سُفيان في الشام؛ بيد أن رواية أخرى تذهب إلى أنه عُدَّ ذلك من تندمات عهده؛ إذ يقول([26]):
"إن هذا الأمر لا يصلح للطُّلقاء ولا لأبناء الطُّلقاء. ولو استقبلتُ من أمري ما استدبرت ما طمع يزيد بن أبي سُفيان ومُعاويَة أن استعملهما على الشام".
يظهر نهي عُمر المزعوم لاستبعاد الطُّلقاء من الخلافة أيضًا في سياق الشورى التي انتخبتْ عُثمَان خليفةً في 23هـ/644م. من هنا، أبدى عُمر مخاوفه من أن يتدخل أحد الطُّلقاء المسؤولين عن الجيوش الإقليميَّة، أمثال مُعاويَة في الشام أو عَبد الله بن ربيعة المخزوميّ في اليمن، في إجراءات المجلس إذا أخفق أعضاء المجلس في التوصل إلى اتفاق. فيُعلن: "إن هذا الأمر لا يصلح للطُّلَقَاء ولا لأبناء الطُّلَقَاء"([27]). ويُقال إن عَمر بن العاص، وهو طليق([28])، كان يتوق إلى أن يُدرج في شورى عُمر أيضًا؛ لكن طلبه قُوبِل بالرفض. قال له عُمر: "أطمئن كما وضعك الله، لا أجعل فيها أحدًا حمل السلاح على نَّبِيّ الله"([29]).
تُظهر هذه الحكاية الأخيرة المُتعلقة بمخططات عَمر بن العاص لشورى عُمر، والتهديد المُحتمل الذي يُشكّله الطُّلقاء على الخلافة، في أقدم طبقةٍ موجودة من الذاكرة التأريخيَّة الإسلاميَّة. فقد لاحظتْ نبيهة عبود هذا منذ وقتٍ بعيدٍ مضى في عام 1957م، عندما قامت بتحقيق ونشر برديَّةٍ تعود للقرن الثاني الهجريّ/الثامن الميلاديّ حصل عليها المعهد الشرقيّ Oriental Institute بجامعة شيكاغو، والتي تحمل مقاطع من كتاب تاريخ الخلفاء المفقود لابن إسحاق، وتروي طعن عُمر على يد أبي لؤلؤة وتعيين عُمر لاحقًا للشورى، وهو يحتضر([30]). المقطع المُثير للاهتمام هنا يقول([31]):
"قال ابن إسحاق: فلمّا أمر عُمر بالشورى؛ تطاول عَمر بن العاص؛ فأنظره عُمر؛ فقال: "أطمئن كما وضعك الله، فوالله لا أجعل فيها أحدًا حمل السلاح على النَّبِيّ عليه السلام، ولولا ما طمّعتُ مُعاويَة([32])؛ ما طمعَ فيه طليق. فليعلم الطليق([33]) أن هذا الأمر لا يصلح للطُّلقاء ولا لأبناء الطُّلقاء، ولا لمُهاجرة الفتح. فإن اختلفتم؛ فلا تُطمّعوا فيها الطُّلقاء"".
هنا يُعرِب عُمر عن أسفه لتنصيب مُعاويَة واليًا على الشام؛ مما فتح الباب أمام شخصياتٍ أخرى أقل منه مكانةً لتطمع في لعب دورٍ بارزٍ في الحُكم والخلافة نفسها. في واقع الأمر، اتسعتْ سُلطة ما يُسمى بالطُّلقاء بشكلٍ كبيرٍ في عهد خليفةَ عُمر الأمويّ، عُثمَان بن عفَّان (حكم 23-36هـ/644-656م) بسبب ميله المشين إلى تفضيل أقاربه([34]). في رواية ابن إسحاق، تُنذر تندمات عُمر وتحذيراته على فراش الموت بشكلٍ مباشرةٍ ليس بالاضطرابات والصراعات القادمة فحسب؛ بل أيضًا بالدور الضار الذي ستلعبه طموحات الطُّلقاء التي أثمرتها أفعال عَمر بن العاص ومُعاويَة عندما كان يعملان معًا بالتنسيق مع بعضهما. من الواضح أن الدافع له عهدٌ قديم.
مثل هذه المقاطع ينبغي أن تُؤثِر على كيفيَّة قراءة المرء للازدراء الذي يُوجههُ عَلِيّ تجاه مُعاويَة؛ بوصفه مجرد "مُعتَق" في المقتطفات من الرسائل المُقتبسة أعلاه. لقد أثار الجدل المُبكر حفيظة أنصار مُعاويَة، الذين روّجوا في نهاية المطاف لروايات بهدف تخفيف، إن لم يكن نفيًا قاطعًا، اتهام مُعاويَة بأنه طليق، وبالتالي، استبعاده من الخلافة. على سبيل المثال، يروي ابن سَعد (ت. 230هـ/845م) حكايةً يزعم فيها مُعاويَة؛ بل بالأحرى أنه أسلم أثناء مفاوضات الحديبيَّة سَّنة 6هـ/628م([35]):
"فأسلمتُ وأخفيتُ إسلاميّ، فوالله لقد رَحَلَ رسول الله مِن الحديبية وإني مُصدِّقٌ به وأنا على ذلك أكتمه مِن [والدي] أبي سُفيان، ودخَل رسول الله مكّة عام عُمرة القضية([36]) [سَّنة 7هـ/629م] وأنا مُسلمٌ مُصدقٌ به، وعَلِمَ أبو سُفيان بإِسلامي؛ فقال لي يومًا: "لكن أخوك خَيرٌ منك؛ فهو على ديني"، قلتُ: "لم آل نفسي خيرًا"، قال: فدخل رسول الله مكة عام الفتح؛ فأظهرتُ إسلامي ولقيته؛ فرحّب بي وكتبتُ له".
إن تأريخ اعتناق مُعاويَة للإسلام سرًا عام المفاوضات في الحديبية له دلالةٌ كبيرةٌ: فهو يعني أن مُعاويَة قد يكون من بين أولئك الذين وصفتهم الآية 100 من سورة التوبة: )السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ(، والذين وُعِدوا بالجنة؛ حيث فسَّر كثيرٌ من المفسِّرين هذه المجموعة على أنها كل هؤلاء المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام قبل الحديبيَّة([37]). يروي مؤرخون آخرون من الأوائل، أمثال مُصعب الزُبيْري (ت. 236هـ/851م)، رواياتٍ مُمُاثلةٍ لاعتناق مُعاويَة السريّ المُبكر للإسلام([38])؛ لكن من الواضح أن أقدم كُتًّاب أعمال وأدبيات السِّيرة والمغازي، أمثال ابن إسحاق (ت. 150هـ/767م) وموسى بن عُقبة (ت. 141هـ/758م)، لا يعرفون شيئًا عن هذه القصة؛ بل يروون قصصًا تتناقض معها بشكلٍ مُباشرٍ([39]). ويبدو أن افتراض اعتناق الطُّلقاء للإسلام سرًا، الذين اكتسب أسلافهم اللاحقون شهرةً، كان خدعةً شائعةً([40]). من الواضح أن هذه الروايات هي موضوعٌ ثانويٌّ؛ ابتُكِرَ لمواجهة الجدل الموجه ضد مُعاويَة([41]).
⁂
في التأريخ العربيّ الإسلاميّ المُبكر، تميل قصة القيادة السياسيَّة للأمة الإسلاميَّة المُبكرة إلى أن تكون، في مُجملها، قصةً مأساويةً. تنطبق هذه الملاحظة بغض النظر عمّا إذا كان المرء يُغربل صفحات التأريخ السُّنِيّ، أو الشِّيعيّ، أو الإباضيّ المُبكر. إن القيادة السياسيَّة تأتي بدايةً مِن خلال ينبوع نبوة مُحَمَّد المُشع وتأسيس نظامه السياسيّ في المدينة المنورة وتوسعه؛ لكن بمجرد أن ينجلي هذا النور؛ فإن بريق قيادة الأمة يخبو لا محالة، في المجال السياسي على الأقل. استلزمتْ نبوءة مُحَمَّدٍ أن تؤول القيادة النبويَّة بالضرورة لنوعٍ مُختلفٍ من القيادة - يُطلق عليه بشكلٍ مُختلفٍ "الإمامة"، أو "الإمارة"، أو "الخلافة" - لكن قصة واقعها السياسيّ هي قصةٌ يفقد فيها نجوم الأمة الهاديَّة بريقها بسرعة. بشأن العلماء والمتدينين الذين رووا قصتها ودوّنوا؛ فالإمامة السياسيَّة، على الرغم من أنها كانت ذات يومٍ مؤسسةً مثاليَّةً على غرار النبوة؛ فإنها استمرت طوال معظم تأريخها بمثابة مؤسسةٍ تتخلف حتمًا عن الوفاء بالتزاماتها، وتعيش في حالةٍ من الانحطاط الشديد.
منذ البداية، كانت الإمامة السياسيَّة عبارةٌ عن نظامٍ استبداديٍّ ملكيٍّ، وإن كانت مُقيدةً ظاهريًّا بالشريعة الإسلاميَّة، فإنها كانت تعتمد على القُدرات الشخصيَّة للحاكم.
ومِن ثَم، اعتُمدتْ نزاهة المؤسسة بشكلٍ شديدٍ على كفاءة من يتولى منصبها، وتقواه، وحِكمته، ومعرفته، وكرمه: الخليفة الإمام([42]). علاوةً على ذلك، لم تقتصر قيادته على الجانب السياسيّ فحسب، بل امتدتْ إلى الجانب الروحيّ أيضًا. وبصفتها مؤسسةً أمر الله به وأوجبها؛ فقد طالبت الإمامةُ الأمةَ بطاعةٍ ثابتةٍ. مع الطاعة، لم يأتِ وعدٌ بالعدل في الدنيا فحسب؛ بل جاء أيضًا وعدٌ بالثواب الأبديّ والنجاة في الآخرة([43]). وبالتالي، كانت طاعة الخليفة الإمام أمرًا أثقل بكثيرٍ من مجرد إقامة العدل، أو إعلاء شأن الشريعة، أو الحفاظ على الوفاق السياسيّ: لقد أرشد الخليفة الإمام أولئك الذين قادهم في الدنيا إلى الجنة أيضًا، أما من رفض توجيهاته؛ فقد عرّض مصير نفوسهم الأبديَّة للخطر([44]).
لذا، كانت الإمامة مؤسسةً ذات سُلطةٍ هائلةٍ. وبينما كانت سُلطات الخليفة الإمام الحاكمة مقيدةً نظريًّا بالشريعة النبويَّة، أكانت مُجسّدةً في القرآن أم السُّنَّة؛ فإن السُلطة الهائلة لمنصبه كانت أيضًا مُحمّلةً بمخاطر الظلم والهلاك على حدٍ سواء. فلا عجب إذن أن يسعى الخليفة الثاني عُمر بن الخطاب إلى تهدئة المخاوف وطمأنة المسلمين، قائلًا: "ما أنا بمَلكٍ؛ فأستعبدكم، وإنما أنا عَبد الله عُرض عليّ الأمانة"([45]).
كيف يبدو الحاكم المسلم المثاليّ؟ إلى جانب التزامه بأحكام القرآن الكريم وسًّنَّة النِّبِيّ؛ يتصرف الحاكم المثاليّ، على طريقة المتقين، بوصفه راعٍ لشعبه، لا سيدًا لعبيد مُستعبدين. لذلك، يُقال إن النِّبِيّ مُحَمَّدًا حثّ أتباعه([46]):
"كلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راعٍ عليهم، وهو مسؤولٌ عنهم، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤولٌ عنهم، وامرأةُ الرجل راعيةٌ على بيت زوجها وولدها، وهي مسؤولةٌ عنهم، وعَبدُ الرجل راعٍ على مال سيده، وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤولٌ عن رعيته".
لذا، يُشبّه الحاكم المثاليّ ما قد يعتبره المؤرخون النموذج القديم للملك الراعي([47]). فبقدر ما تكون سُلطة الحاكم رعويَّةً وحميدةً؛ فهي على الدوام خيرٌ في حد ذاتها. إن حكمه يُجسِّدُ ويُنَفذُ تسلسلًا هرميًّا طبيعيًّا؛ يتدفق إلى جميع طبقات المجتمع؛ وبالتالي، يُنظمُ رفاهيَّة الجميع ويَمنحهم الخلاص([48]). وكقاعدةٍ عامة، فهو لا يُمارس سُلطته بوصفه سيدًا يتصرف بنزواتٍ على رعيته لتحقيق مكاسبه الشخصيَّة، بل بوصفه راعيًا عطوفًا؛ يرعى رعيّته جمعًا وفُرادى، برحمةٍ ومخافةِ اللهَ في قلبه، عالِمًا أنه سيُحاسبُ يومًا ما مِن قبل حاكمٍ وقاضٍ أعظم منه بكثير([49]).
بيد أن قد أكدت الحكمة النبويَّة أن معرفة الأمة بحكم هؤلاء الخلفاء الأئمة الخيّرين كانت مُقدّرة أن تكون عابرةً؛ إذ أعلنتْ نبوة النِّبِيّ مُحَمَّدٍ الشهيرة: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون مُلكًا عضوضًا"([50]). ما يفصل الخلافة الحقيقيَّة عن نظيرتها الاستبداديَّة هو تمييزٌ نوعيٌّ أكثر منه مؤسسيّ: من الناحية المثاليَّة، ينبغي للخليفة الإمام أن يقود المسلمين بوصفه مجرد فردٍ منهم، بادئ ذي بدءٍ بين أقرانه، ويعمل لصالحهم؛ لا سعيًا وراء ثرائه وتوسيع نفوذه؛ كما لو كان سيدًا ذا سُلطةٍ لا رجعة فيها، ليحكم رعيته بوصفهم عبيدًا. وهكذا قال الخليفة الأول أبو بكر الصديق (حكم 11-13هـ/632-634م) عند توليه الخلافة([51]):
"فإني قد وُليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنتُ؛ فأعينوني، وإن أسأتُ؛ فقوموني... أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإذا عصيتُ الله ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم".
إن تصريحات أبي بكر لا تعكس نوعًا من التواضع المُصطنع الزائف، بل تعكس نوعًا من القيادة المساواتيَّة التي تعتمد على قدرات الإقناع الخطابيَّة التي يتمتع بها الزعيم بدلًا من القُدرة على فرض إرادته باستخدام القوة الغاشمة، على الرغم من أن القوة الغاشمة يُمكن أن تُستخدم أيضًا إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ كما تجلى في حروب الردة في خلافته([52]). لكن بعد ذلك، حذر أبو بكر أيضًا بقوله([53]):
"ألا إن أشقى([54]) الناس في الدنيا والآخرة الملوك!... إن مِن الملوك من إذا مَلك؛ زهّده الله فيما في يديه، ورغّبه فيما في يدي غيره... وإنكم اليوم على خلافة النبوة، ومفرق المحجة. وإنكم سترون بعدي مُلكًا عضوضًا، وُملكًا عنودًا".
كانت الرسالة واضحة: سيأتي رجالٌ أقل شأنًا لا محالة ليشغلوا المنصب ويُخفّضوا من بريقه.
مَن هم هؤلاء الرجال الأقل شأنًا؟ إذا ما قيس هذا الأمر في ميزان الذاكرة الجماعيَّة المُبكرة للمسلمين؛ كان الجواب جليًّا أنهم الخلفاء الأمويون، أكانوا من فرع السُفيانيين الأوائل أو المروانيين اللاحقين. إن مدة الخلافة التي تنبأ بها النِّبِيّ، والتي استمرت ثلاثين عامًا، جعلت المشاعر المُناهضة للأمويّ في هذا التنبؤ واضحةً بما فيه الكفاية([55])، بقدر ما تبدأ خلافة مُعاويَة بن أبي سُفيان (حكم 40-60هـ/661-680م)، وبالتالي الأمويين، عند انتهاء مدتها([56])، إلا أنه عند نقطة تحولها، وقف أمير المؤمنين عَلِيّ بن أبي طَالب. في واقع الأمر، لقد ذكّر عَلِيّ أن من بين العوامل التي دفعته إلى قبول الخلافة اهتمامه بما يليّ([57]):
"وخلاف مُعاويَة إياك، الذي لم يجعل الله له سابقةً في الدين، ولا سلف صدقٍ في الإسلام، طليقٌ ابن طليقٌ، وحزبٌ من الأحزاب([58])، لم يزل لله، ولرسوله، وللمسلمين عدوًا هو وأبوه، حتى دخلا في الإسلام كارهين مُكرهين".
نجح عَلِيّ في كبح المد طالما سمحت العناية الإلهيَّة بذلك؛ لكن وفاته المُبكرة بخنجرٍ قاتلٍ سَّنة 40هـ/661م، بعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من وفاة مُحَمَّد سَّنة 11هـ/632م، كانت بمثابة النهاية الحاسمة لعصرٍ مثاليّ. مع وفاة عَلِيّ وتنازل ابنه الحَسن عن الحُكم بعد ذلك بوقتٍ قصير، أصبح خصمه الأمويّ، مُعاويَة، الزعيم بلا منازعٍ على الأمة، وانكسرت آخر الجيوش التي كانت تُقيّد جماح طوفان الطغيان الوشيك([59]). وضع ابنه الحَسن طموحات والده جانبًا، ولم يتبع المسار نفسه، وقرر بدلًا من ذلك عقد سلامٍ مع مُعاويَة والانسحاب إلى المدينة المنورة. وهكذا، وبخه أحد منتقدي الحَسن من معسكر عَلِيّ لتركه المسلمين تحت رحمة الطغاة، قائلًا: "تركتَ إِمارتك وسلّمتها إلى رجُل من الطُّلَقَاء وقَدِمتَ المدينة؟!" فأجاب الحَسن بأنه اتبع ضميره؛ خوفًا من مصير حرب المسلمين الأهليَّة: "اخترتُ العارَ على النار"([60]).
كما يُشاع، فقد تحوّل حكم المسلمين في عهد الأمويين إلى نوعٍ من الحكم الوراثيّ لحُكامٍ مُستبدين على غرار أسلافهم الروم والإيرانيين([61]) - أي الطغاة الكفار الذين حكموا المسلمين بوصفهم عبيدًا. أما الخلفاء الأمويون الذين حكموا بعده، فكانوا ضمنيًّا طغاةً وخلفاء مزيفين، من سلالةٍ تُوصف بـ "الشجرة الملعونة" المذكورة في القرآن (سورة الإسراء: 60)([62]). وكما هو الحال في كل قصةٍ جيدةٍ، كانت العلامات، والنذر، والنبوءات معروفةً مسبقًا، حتى لأصحابها. لذلك، يَروي أحد([63]) المتدينين الأوائل([64]):
" أنه كان عند مُعاويَة بن أبي سُفيان، فدخل عليه [قريبه] مروان [ابن الحكم]، فكلمه في حاجته، فقال: "اقض حاجتي، يا أمير المؤمنين، فو الله إن مؤنتي لعظيمة، وإني أبو عشرة، وعم عشرة، وأخو عشرة"، فلما أدبر مروان وابن عَباس جالس مع مُعاويَة على السرير، فقال مُعاويَة: "أشهدْ بالله يا ابن عباس، أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا بلغ بنو الحكم [ابن أبي العاص] ثلاثين رجلًا؛ اتخذوا مال الله بينهم دولًا([65])، وعباد الله خولًا([66])، وكتاب الله دغلًا([67])... فقال ابن عَباس: "اللهم نعم"".
وهكذا، يُستقبل هذا التحول في الأحداث حتى أولئك الذين وقعوا فيه باستسلامٍ مصيريٍّ. عندما يُخبر الأسود بن يزيد النخعيّ عائشةَ، على سبيل المثال، أن رجلًا من الطُّلقاء يُبايع له خليفةً؛ أي مُعاويَة، اكتفت بالرد: "يا بني، لا تعجب، هو مُلك الله، يُؤتيه من يشاء"([68]).
في التأريخ العربيّ المُبكر للخلافة الأمويَّة، أُزيلت أيَّة شكوكٍ مُتبقيةٍ في أن الخلافة قد تحولت بالكامل إلى ملكيَّةٍ استبداديَّةٍ مع توليهم العرش بوفاة مُعاويَة وتولي ابنه يزيد بن مُعاويَة الحُكم سَّنة 60هـ/680م. جلبتْ خلافة يزيد معها حدثيْن صادميْن؛ طالما يَلوحان في ذاكرة المسلمين الجماعيَّة ووعيهم التأريخيّ: استشهاد الحُسين بن عَلِيّ مع عائلته في كربلاء سنة 61هـ/680م، والخضوع الدمويّ للمدنيين بعد معركة الحرة سَّنة 63هـ/683م؛ مما أسفر عن مقتل أكثر من سبعمائة رجلٍ من قادة قُريش، والأنصار، ومُهاجرة العرب([69]). كان من بين الأمور السيئة السمعة على نحوٍ خاص هي شماتة يزيد المأثورة، والتي يُزعم أنه ألّفها أثناء تفكيره في انتصاراته في كربلاء والحرة، حيث قال([70]):
لست من خندف إن لم أنتقم لعبت هاشم بالملك فلا
من بنى أحمَد ما كان فعل خبر جاء، ولا وحي نزل
لما دخل مسلم بن عُقبة المُرّي، والي يزيد الأول، المدينة المنورة على رأس قوةٍ عسكريَّةٍ؛ سعى إلى ترسيخ البيعة ليزيد خليفةً، و"ودعا الناس إلى البيعة"؛ لكنه لم يطلب منهم ذلك بالشروط المُعتادة؛ أي أن يلتزم يزيد بالقرآن والسُّنَّة ويحكم الأمة وفقًا لهما، بل طالب الوالي وأنصارهُ أهلَ المدينة المنورة بمبايعة يزيد بن مُعاويَة، "على أنهم خولٌ([71]) ليزيد بن مُعاويَة؛ يحكم في أهليهم، ودمائهم، وأموالهم ما شاء". أما أبرز أهل المدينة الذين اعترضوا، مفضلين مبايعة يزيد على أساس أنهم أقاربه أو على أساس كتاب الله والسُّنَّة؛ فقد قُطعت رؤوسهم أو أجبروا على الفرار([72]). لم يكن يزيد كأبيه مُعاويَة، مُعتَق، طليق، لكنه كان ظاهريًّا أحد "أبناء الطُّلقاء"، وبالتالي، فهو رجلٌ أقل شأنًا من نسبٍ أدنى، وغير جديرٍ بالمنصب، كما ورد في تحذير رسالة عَلِيّ المذكورة آنفًا. في واقع الأمر، ووفقًا لإحدى الروايات، عندما نصح الأمويّ مروان بن الحكم الحُسين بن عَلِيّ بشدةٍ بمبايعة يزيد أميرًا للمؤمنين بوصفة عبدًا له قبل رحيله إلى العراق؛ رفض الحُسين بشدة، معلنًا: "وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: "الخلافة مُحرمةٌ على آل أبي سُفيان، وعلى الطُّلقاء أبناء الطُّلقاء"([73]).
إن التمييز بين الإمامة ونظيرتها المُنحطة في روايات هذه الأحداث يُذكرنا بالتمييز الهلنستيّ بين الهيمنة، حيث يُحكم رجالٌ أحرارٌ مِن قِبل حَاكمٍ هو مجرد الأول بين المتساوين، مقابل الاستعباد؛ أي الحكم بوصفهم عبيدًا مِن قِبل سيدٍ مُتقلب([74]). كما اتضح، فإن تأريخ تلقي هذا الشعور اليونانيّ في الفكر السياسيّ العربيّ عميقةٌ جدًّا، بل وتسبق ظهور التأريخ العربيّ المُبكر في أوائل العصر العَباسي: فقد ظهرتْ لأول مرةٍ بشكلٍ صريحٍ في اللغة العربيَّة في سياق روايةٍ رسائليَّةٍ شبه أرسطوريَّةٍ؛ تُنسب ترجمتها إلى سالم أبو العلاء، الكاتب الإمبراطوريّ لهشام بن عَبد الملك (حكم 105-127هـ/724-743م)([75]). وفي أحد مقاطعه الشهيرة، ينصح أرسطو الإسكندرَ المقدونيّ بما يلي([76]):
"بينما تُدان رئاسة الاغتصاب لأسبابٍ مُختلفةٍ، فإن أكثر ما يُستحق الإدانة لأجله هو إضعاف سُلطة الحُكم وتشويه سمعته؛ ذلك لأن الطاغية يسود على الناس بوصفهم عبيدًا لا أحرارًا؛ وحُكم الأحرار أشرف من حُكم العبيد".
لقد ربط العرب والمسلمون، مثل الإغريق والروم([77])، مثل هذه الاستعباد القمعيّ بالملكيَّة الإيرانيَّة([78]) - وهو ما يُسميه الفيلسوف أبو الحَسن العامريّ (ت. 381هـ/992م) "كانوا مُضطهدين بسياسة الاستعباد وإيالة الاستخوال"([79])؛ لكن الفكر السياسيّ اليونانيّ في أواخر العصر الروميّ ليس مُناسبًا تمامًا، على الرغم من تأريخ استقباله القوي في الرسائل العربيَّة. لقد أصابت باتريشيا كرون P. Crone الهدف تمامًا عندما لاحظت أنه على الرغم من أن "مسلمي العصور الوسطى... تحدثوا عن الاضطهاد السياسيّ باعتباره استعبادًا ... فإنهم لم يُطلقوا على نقيضه حريَّةً؛ لأن الاختيار كما رأوه لم يكن بين العبوديَّة والحريَّة، بل بين العبوديَّة للكائنٍ الآخر والعبوديَّة الله"([80]).
على الرغم من أن هذا صحيحٌ على نحوٍ عام، فإنه ينبغي لنا ملاحظ الاستثناءات على أيّ حال. في إحدى روايات الحادثة التي رَفض فيها القُرشي المدنيّ يزيد بن عَبد الله بن زمعة المخزوميّ الأمر بمبايعة يزيد بوصفه واحدًا من عبيده الكُثر؛ أجاب الرجل: "{بل}([81]) أُبايع على أني ابن عمٍ حرٌ كريمٌ"؛ لكن هذا لم يُرضِ رجال يزيد؛ فسارعوا إلى ضرب عنقه([82]). في نهاية المطاف، طغت السُلطة الرعويَّة الحميدة التي تمتع بها الخلفاء الأئمة الأوائل على الاستعباد الخبيب الذي مارسه الطُّلقاء وأبنائهم، وهو خطرٌ تنبأ به عُمر وعَلِيّ؛ لكنهما لم يَهزماه كما شاءت العناية الإلهيَّة.
نصوص إضافيَّة:
المِنقريّ، ص63 (= ابن أبي الحديد، 8/66؛ وراجع: أخبار صفين، ص116)
كتب مُعاويَة وعَمرو بن العاص إلى عددٍ من أشهر الصحابة من أهل المدينة المنورة في محاولةٍ لإقناعهم بالانضمام إليهما ضد عَلٍيّ. يدّعي مُعاويَة أنه لا يسعى إلى الخلافة، قائلًا: "أما بعد، فإنه مهما غابت عنا من الأمور، فلن يغيب عنا أن عَلِيًّا قتل عُثمَان. والدليل على ذلك مكان قتلته منه. وإنما نطلب بدمه حتى يدفعوا إلينا قتلته؛ فنقتلهم بكتاب الله، فإن دفعهم عَلِيٌّ إلينا؛ كففنا عنه، وجعلناها شورى بين المسلمين على ما جعلها عليه عُمر بن الخطاب. وأما الخلافة، فلسنا نطلبها، فأعينونا على أمرنا هذا وانهضوا من ناحيتكم، فإن أيدينا وأيديكم إذا اجتمعت على أمر واحد؛ هاب على ما هو فيه". فكتب إليهما ابن عُمر ردًّا عليه: "وما أنتما والخلافة؟ وأما أنت يا مُعاويَة فطليق!"، ويأتي ردٌّ مُماثلٌ من سَعد بن أبي وقاص، الذي كتب مُذكّرًا إياه: "فإن عُمر لم يُدخل في الشورى إلا من يحل له الخلافة من قُريش"([83])؛ مُذكّرًا مُعاويَة بشكلٍ غير مباشرٍ بوضعه غير المؤهل بوصفه حاكمًا.
المِنقريّ، ص201 = الطبريّ، التاريخ، 5/8 (1/3278)، عن طريق أبي مِخنف؛ وابن أعثم، 3/22
يُعدّد عَلِيٌّ من بين العوامل التي دفعته إلى قبول الخلافة هو عناد (خلاف) مُعاويَة - وهو رجلٌ "لم يجعل الله له سابقةً في الدين، ولا سلف صدقٍ في الإسلام، طليقٌ ابن طليقٌ، وحزبٌ من الأحزاب، لم يزل لله ولرسوله وللمسلمين عدوًا هو وأبوه، حتى دخلا في الإسلام كارهين مُكرهين".
المِنقريّ، ص237
أحد أنصار عَلِيّ، سَعيد بن قيس الهمدانيّ، يحشد أنصاره في قُناصرين بالشام بخطبة؛ يُقارن فيها بين عَلِيّ ومُعاويَة، قائلًا: "وإنما رئيسنا ابن عم نَّبينا، بدريٌّ صدق، صلى صغيرًا، وجاهد مع نبيكم كبيرًا. ومُعاويَة طليقٌ من وثاق الإسار، وابن طليق!".
المِنقريّ، ص314
يُعلن عَلِيّ لأنصاره في خطبةٍ: "وأنا من أهل بدر، ومُعاويَة طليقٌ ابن طليق".
المِنقريّ، ص415-416.
يَكتب ابن عَباس إلى مُعاويَة مُذكّرًا إياه بأنه غير صالحٍ للخلافة: "وما أنت يا مُعاويَة والخلافة، وأنت طليقٌ وابن طليق، والخلافة للمهاجرين الأولين؛ وليس الطُّلقاء منها في شيء".
المِنقريّ، ص449؛ وراجع: ابن أعثم، 3/167
قال قيس بن سَعد بن عُبادة الأنصاريّ، أحد أصحاب عَلِيّ، موبخًا رجلًا من الأنصار من أصحاب مُعاويَة، النعمان بن بشير الزُهريّ: "ولكن انظر يا نعمان، هل ترى مع مُعاويَة إلا طليقًا، أو أعرابيًا، أو يمانيًا مُستدرجًا بغرور؟!".
البلاذريّ، 2/87-88 (نقلًا عن أبي مِخنف)؛ وراجع: الثقفيّ، ص ص627-628
كتب عقيل بن أبي طَالب إلى أخيه عَلِيّ، الذي بايعه أميرًا للمؤمنين وغادر المدينة المنورة إلى العراق؛ ليُخبره أنه في أثناء سفره إلى مكة لأداء العمرة، التقى بعائشة، وطلحة، والزُبيْر مُتجهين إلى البصرة، وأنه مر به عَبد الله بن أبي سرح ومعه "في نحو من أربعين شابًّا من أبناء الطلُّقاء".
ابن أعثم، 3/72
يسعى أبو نوح الحميريّ، أحد أنصار عَلِيّ من العراق، إلى إقناع أحد أقاربه من الشام، ذو الكلاع، بأنه أخطأ في تقديم نصرة مُعاويَة: "إنه من الطُّلقاء الذين لا تحل لهم الخلافة".
ابن أعثم، 3/139
أحد شِّيعة عَلِيّ من عَبد القيس، عقيل بن ثُويرة، يُوبخ عَمر بن العاص قائلًا: "أنت تُؤثر مُعاويَة على عَلِيّ، وتبيع دينك بمصر، وتنصر رجالًا من الطُّلقاء على رجلٍ من سادات المهاجرين والأنصار!".
ابن أعثم، 4/213
يُقرّ عَمر بن العاص لأبي موسى الأشعريّ "بأن مُعاويَة من الطُّلقاء، وكان أبوه من الأحزاب"، ثم يُقنعه بعد ذلك بمحاولة خلع عَلِيٍّ لصالح عَبد الله بن عُمر بن الخطاب.
الثقفيّ، 1/317
يصف عَلِيّ أعداءه لأنصاره قائلًا: "إنما تُقاتلون الطُّلقاء وأبناء الطُّلقاء، وأولي الجفاء، ومن أسلم كرهًا".
ابن سَعد، 7/110:
بعد تلقيه كتابًا من عَبد الملك يُلقِب نفسه فيه بأمير المؤمنين، صاح مُحَمَّد بن الحنفيَّة قائلًا: "الطُّلَقاء ولُعنَاء رسول الله على منابر النَّاس!"
قائمة المصادر والمراجع:
أولًا: المصادر والمراجع الأوليَّة باللغة العربيَّة:
1. ابن أبي الحديد، ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 20 مجلدًا، تحقيق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار إحياء الكتب العربيَّة، 1959م.
2. ابن أبي خيثمة، أبو بكر بن أبي خيثمة، التاريخ الكبير: السِّفر الثاني، مجلدان، تحقيق: صلاح بن فتحي هَلل، القاهرة: الفاروق الحديثة، 2006م.
3. ابن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة، المُصنَّف، 25 مجلدًا، تحقيق: سَعد الشطريّ، الرياض: دار كنوز إشبيليا، 2015م.
4. الأصبهانيّ، أبو الفرج الأصبهانيّّ، مقاتل الطالبيين، تحقيق: أحمَد صقر، بيروت: دار المعرفة، دون تأريخ نشر.
5. ابن أعثم، انن أعثم الكوفيّ. كتاب الفتوح، 8 مجلدات، تحقيق: عَلِيّ شيري. بيروت: دار الأضواء، 1991م.
6. ابن بكار، الزُبيْر بن بكار، جمهرة نسب قُريش وأخبارها، مجلدان، تحقيق: مُحَمَّد محمود شاكر، الرياض: دار اليمامة، 1999م.
7. البلاذريّ، أحمَد بن يَحيى البلاذريّ، أنساب الأشراف، مجلدان، تحقيق: والفرد مادلونغ، بيروت: كلاوس شوارتز، 2003م. المجلد الرابع، تحقيق: إحسان عَباس، بيروت: فرانز شتاينر، 1979l; المجلد الخامس، تحقيق: إحسان عَباس، بيروت: فرانز شتاينر، 1996م.
8. "___"، فتوح البلدان، تحقيق: إم جي دي غويه، ليدن: بريل، 1968م.
9. البلخيّ، أبو القاسم الكعبيّ البلخيّ، قبول الأخبار ومعرفة الرجال، تحقيق: حُسين خانصو، اسطنبول: كورامر، 2018م.
10. البيهقيّ، أبو بكر البيهقيّ، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، 6 مجلدات، تحقيق: عَبد المعطي قلعجي، بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1988م.
11. الترمذيّ، أبو عيسى، الجامع الكبير، 6 مجلدات، تحقيق: بشار عوّاد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 1996م).
12. التوحيديّ، أبو حيان التوحيديّ، الإمتاع والمؤانسة، 3 مجلدات، تحقيق: أحمَد أمين وأحمَد الزين، بيروت: دار مكتبات الحياة، 1965م.
13. ابن تيميَّة، ابن تيميَّة، منهاج السُّنَّة النبويَّة في نقد كلام الشِّيعة القدريَّة، 9 مجلدات، تحقيق: مُحَمَّد رشاد سالم، الرياض: جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلاميَّة، 1986م.
14. الثقفيّ، إبراهيم بن مُحَمَّد الثقفيّ، الغارات، مجلدان، تحقيق: سيد جلال الدين المحدث الأرمويّ، طهران، أنجمان-أثر-ملي، 1976م.
15. الجاحظ، أبو عُثمَان عَمر بن بحر الجاحظ، البيان والتبيين، 4 مجلدات، تحقيق: عَبد السلام مُحَمَّد هارون، القاهرة: الخانجيّ، دون تأريخ نشر.
16. "___"، الرسالة في النابتة، في: عَبد السلام مُحَمَّد هارون، تحيق: رسائل الجاحظ، مجلدان، القاهرة: الخانجيّ، بدون تأريخ، 2/5-23
17. ابن حنبل، أحمَد بن حنبل، المسند، 52 مجلدًا، تحقيق: شُعيب الأرناؤوط وآخرون، بيروت: مؤسسة الرسالة، 2015م.
18. خليفة، خليفة بن خياط العصفريّ، التاريخ، تحقيق: سهيل زكّار، بيروت: دار الفكر، 1993م.
19. الزُبيْريّ، مصعب الزُبيْريّ، نسب قُريش، تحقيق: إيفاريست ليفي بروفنسال، القاهرة: دار المعارف، دون تأريخ نشر.
20. ابن سَعد، ابن سَعد الزُهريّ، كتاب الطبقات الكبير، 11 مجلدًا، تحقيق: عَلِيّ مُحَمَّد عُمر، القاهرة: دار الخانجيّ، 2001م.
21. السمهوديّ، نور الدين السمهوديّ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، 5 مجلدات، تحقيق: قاسم السامرائيّ، لندن: معهد الفرقان، 2001م.
22. الشافعيّ، مُحَمَّد بن إدريس الشافعيّ، الأم، 11 مجلدًا، تحقيق: رفعت فوزي عَبد المطلب، القاهرة: دار الوفاء، 2001م.
23. ابن شبة، عُمر بن شبة النُميريّ، تاريخ المدينة المنورة، 4 مجلدات، تحقيق: فهيم مُحَمَّد شلتوت، مكة، حَبيب محمود أحمَد، 1979م.
24. الطبريّ، أبو جعفر مُحَمَّد بن جرير الطبريّ. تاريخ الرسل والملوك، 11 مجلد، تحقيق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة: دار المعارف، 1960م.
25. "___"، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عَبد الله بن عَبد المحسن التركيّ، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلاميَّة بدار هجر - عَبد السند حَسن يمامة.
26. العامريّ، أبو الحَسن العامريّ، الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق: أحمَد عَبد الحميد غراب، الرياض: دار الأصالة، 1988م.
27. "___"، السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانيَّة، تحقيق: مجتبى المينويّ، منشورات آية الشرق.
28. ابن عبد ربه، أبو عَمر، شهاب الدين أحمَد بن مُحَمَّد بن عَبد ربه بن حبيب بن حدير بن سالم المعروف بابن عبد ربه الأندلسيّ، العقد الفريد.
29. أبو عبيد، القاسم بن سلام، كتاب الأموال، مجلدان، تحقيق: أبو أنس سيد بن رجب، القاهرة: دار الهديّ النبويّ، 2007م.
30. أبو العرب، أبو العرب التميميّ، المِحْن، تحقيق: يَحيى الجبوريّ، بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 1983م.
31. ابن عساكر، ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 80 مجلدًا، تحقيق: عمر العمراويّ، بيروت: دار الفكر، 1995-2000م.
32. الكُلينيّ، أبو جعفر مُحَمَّد بن يعقوب الكُلينيّ، الكافي، 8 مجلدات، تحقيق: عَلِيّ أكبر الغفاريّ، طهران: دار الكتب الإسلاميَّة، 1957م.
33. المُبرَد، أبو العَباس المُبرَد، الكامل في اللغة، 3 مجلدات، تحقيق: مُحَمَّد أحمَد الداليّ. بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م.
34. مجهول، كتاب سليم بن قيس الهلاليّ، 3 مجلدات، تحقيق: مُحَمَّد باقر الانصاري، قم: دليل ما، 2005م.
35. المِنقريّ، نصر بن مزاحم المِنقريّ، وقعة صفين، تحقيق: عَبد السلام مُحَمَّد هارون، بيروت: دار الجيل، 1990م.
36. موسى بن عُقبة، موسى بن عُقبة، مغازي سيدنا مُحَمَّد، 3 مجلدات، تحقيق: مُحَمَّد الطبرانيّ، فاس: بن عطيَّة، 2023م.
37. الفاكهيّ، مُحَمَّد بن إسحاق الفاكهيّ، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، 4 مجلدات، تحقيق: عَبد الملك بن عَبد الله بن دهيش، مكة: النهضة الحديثة، 1994م.
38. مُحَمَّد نجاد بن موسى بن مجاد، الأكلة وحقائق الأدلة.
39. النيسابوريّ، مسلم، الصحيح.
*- ثانيًا: المصادر والمراجع الأوليَّة باللغات الأجنبية:
40. Aḫbār Ṣiffīn = Abdul-Aziz Salih Helabi, “A Critical Edition of Akhbar Siffin (Ambrosiana H 129, Berlin, Q.U. 2040),” Ph.d Dissertation, University of St. Andrews, 1974
41. Ibn Hišām = ʿAbd al-Malik ibn Hišām al-Ḥimyarī, Sīrat Rasūl Allāh (Das Leben Muhammed’s nach Muhammed Ibn Ishak bearbeitet von Abd el-Malik Ibn Hischâm), 2 vols., ed. Ferdinand Wüstenfeld, Göttingen: Dieterischsche, 1859
42. Nahǧ= al-Šarīf al-Rāḍī, Nahj al-Balāghah: The Wisdom and Eloquence of ʿAlī: A Parallel English-Arabic Text, ed./tr. Tahera Qutbuddin. Leiden: Brill, 2024
*- ثالثًا: المصادر والمراجع الثانويَّة باللغات الأجنبيَّة:
43. Abbot, Nabia. 1957. Studies in Arabic Literary Papyri I: Historical Texts, Chicago: The University of Chicago Press.
44. Adem, Rodrigo. 2017. “Classical Naṣṣ Doctrines in Imāmī Shīʿism: On the Usage of an Expository Term,” Shii Studies Review 1: 42-71
45. Ansari, Hassan and Nebil Husayn. 2023. Caliphate and Imamate: An Anthology of Medieval Muslim Texts on Political Theology, Cambridge: Cambridge University Press.
46. Anthony, S.W. 2020. Muhammad and the Empires of Faith: The Making of the Prophet of Islam, Oakland: University of California Press.
47. ——. 2025. “The Justly Killed Imam: A Muʿtazilī Defense of the Murder of ʿUthmān ibn ʿAffān (r. 23-36/644-656),” Journal of Abbasid Studies 12
48. Börm, Henning. 2007. Prokop und die Perser: Untersuchungen zu den römisch-sasanidischen Kontakten in der ausgehenden Spätantike. Stuttgart: Franz Steiner.
49. Cook, Michael. 2023. “Is political freedom an Islamic value?,” in Quentin Skinner and Martin van Geldern, ed., Freedom and the Construction of Europe, vol. II: Free Persons and Free States, Cambridge: Cambridge University Press, 283-310
50. Crone, Patricia. 2001. “Shūrā as an Elective Institution,” Quaderni di Studi Arabi 19: 3-39
51. ——. 2004. God’s Rule: Government and Islam. New York: Columbia University Press.
52. Crone, Patricia and Martin Hinds. 1986. God’s Caliph: Religious authority in the first centuries of Islam. Cambridge: Cambridge University Press.
53. Décobert, Christian. “Notule sur le patrimonialisme omeyyade,” in A. Borrut and P. Cobb, ed.,Umayyad Legacies: Medieval Memories from Syria to Spain (Leiden: Brill), 213-253
54. Druart, Thérèse-Anne. 1998. “Le sommaire du livre des “Lois” de Platon (Ǧamwāmiʿ Kitāb al-Nawāmīs li-Aflāṭūn),” Bulletin d’Études Orientales 50/109-155
55. Elad, Amikam. 2016. The Rebellion of Muhammad al-Nafs al-Zakiyya in 145/762: Ṭālibīs and Early ʿAbbāsīs in Conflict. Leiden: Brill.
56. Foucault, Michel. 2007. Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977-1978, ed. M. Senellart, tr. G. Burchell. New York: Palgrave Macmillan, 2007
57. Geoffrey J. Moseley, “Plato Arabus: On the Arabic Transmission of Plato’s Dialogues: Texts and Studies,” PhD dissertation, Yale University (2017), 277-278 (Laws frag. 13).
58. Golder, Ben. 2007. “Foucault and the Genealogy of Pastoral Power,” Radical Philosophy Review 10:157-176
59. Greatrex, Geoffrey. 2022. Procopius of Caesarea: The Persian Wars: A Historical Commentary. Cambridge: Cambridge University Press.
60. Dimitri Gutas, “On Graeco-Arabic Epistolary ‘Novels’,” Middle Eastern Literatures 12 (2009): 59-70
61. Hasson, Isaac. 1998. “La conversion de Muʿāwiya ibn Abī Sufyān,” JSAI 22: 214-242
62. Haubold, Johannes. 2014. “‘Shepherds of the People’: Greek and Mesopotamian Perspectives,” in R. Rollinger and E. van Dongen, ed., Mesopotamia in the Ancient World: Impact Continuities, Parallels (Münster: Ugarit), 245-255
63. Hinds, Martin. 1971. “The Banners and Battle Cries of the Arabs at Ṣiffīn (657 AD),” Al-Abḥāth 24: 3-42
64. Humprheys, R. Stephen. 2006. Mu‘awiya ibn Abi Sufyan, London: Oneworld.
65. Husayn, Nebil A. “Treatises on the Salvation of Abū Ṭālib,” Shii Studies Review 1 (2017): 3-41
66. Kaldellis, Anthony. 2004. Procopius of Caesarea: Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
67. Keshk, Khaled. 2010. “When Did Muʿāwiya Become Caliph?,” JNES 69: 31-42
68. Kister, M.J. 1964. “Notes on an Account of the Shura Appointed by ʿUmar b. al-Khattab,” Journal of Semitic Studies 9:320-326
69. ——. 1984. “… illā bi-ḥaqqihi: A Study of an Early Ḥadīth,” JSAI 5:33-52
70. ——. 2000. “‘The Crowns of This Community’ …: Some Notes on the Turban in the Muslim Tradition,” JSAI 24: 217-245
71. Koebner, R. 1951. “Despot and Despotism: Vicissitudes of a Political Term,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 14: 275-302
72. Liew, Han Hsien. 2025. “‘The Caliphate Will Last for Thirty Years’: Polemic and Political Thought in the Afterlife of a Prophetic Ḥadīth,” Journal of Islamic Studies 36: 38-82
73. Madelung, Wilferd. 1997. The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge: Cambridge University Press.
74. Marlow, Louise. 1997. Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought. Cambridge: Cambridge University Press.
75. Marsham, Andrew. 2009. Rituals of Islamic Monarchy: Accession and Succession in the First Muslim Empire. Edinburgh: Edinburgh University Press.
76. Mouritsen, Hernik. 2011. The Freedman in the Roman World, Cambridge: Cambridge University Press.
77. Moseley, Geoffrey James. 2017. “Plato Arabus: On the Arabic Transmission of Plato’s Dialogues: Texts and Studies,” Ph.D dissertation, Yale University.
78. Murray, Oswyn. 1990. “The Idea of the Shepherd King from Cyrus to Charlemagne,” in O. Murray and P. Godman, eds., Latin Poetry and the Classical Tradition (Oxford: Clarendon Press), 1-14.
79. Nagel, Tilman. 1970. “Ein früher Bericht über den Aufstand von Muḥammad b. ʿAbdallāh im Jahre 145 h,” Der Islam 46:227-262
80. Pellat, Charles. 1956. “Le culte de Muʿāwiyah au IIIe siècle de l’hégire,” Studia Islamica 6: 53-66
81. Petersen, Erling Ladewig. 1964. ʿAlī and Muʿāwiya in Early Arabic Tradition: Studies on the Genesis and Growth of Islamic Historical Writing until the End of the Ninth Century, Copenhagen: Munksgaard.
82. Qutbuddin, Tahera. 2019. Arabic Oration: Art and Function, Leiden: Brill.
83. Richter, Melvin. 1990. “Aristotle and the Classical Greek Concept of Despotism,” History of European Ideas 12: 175-187
84. Sayyid, Riḍwān al-. 1997. Al-Ǧamāʿah wa-l-muǧtamaʿ wa-l-dawlah: Sulṭat al-aydiyūlūǧiyā fī l-maǧāl al- siyāsī al-ʿarabī al-islāmī, Beirut: Dār al-Kitāb al-ʿArabī.
85. Sezgin, Ursula. 1971. Abū Miḫnaf: Ein Beitrag zur Historiographie der umaiyadischen Zeit, Leiden: Brill.
86. Shahin, Aram. 2012. “In Defense of Muʿāwiyah ibn Abī Sufyān: Treatises and Monographs on Muʿāwiyah from the Eighth to Nineteenth Centuries,” in Paul Cobb, ed., The Lineaments of Islam: Studies in Honor of Fred McGraw Donner, Leiden: Brill, 209-233
87. Swain, Simon. 2013. Themistius, Julian and Greek Political Theory under Rome: Texts, Translations and Studies of Four Key Works. Cambridge: Cambridge University Press.
88. Su, I-Wen. 2021. “The Early Shiʿi Kufan Traditionists’ Perspective on the Rightly Guided Caliphs,” JAOS 141: 27-47.
89. Tor, Deborah G. 2019. “The Parting of Way between ʿAlid Shiʿism and Abbasid Shiʿism: An Analysis of the Missives between the Caliph al-Manṣūr and Muḥammad al-Nafs al-Zakiyya,” Journal of Abbasid Studies 6: 209-227
90. Williams, Steven J. 2022. “The Pseudo-Aristotelian Secret of Secrets as a Mirror of Princes: A Cautionary Tale,” in Noëlle-Laetitia Perret and Stéphane Péquignot, ed., A Critical Companion to the ‘Mirrors for Princes’ Literature, Leiden: Brill, 376-402
([1]) نصر بن مُزاحم المِنقريّ، وقعة صفين، تحقيق: عَبد السلام مُحَمَّد هارون (بيروت: دار الجيل، 1990م)، ص9-30 (نقلا عن الشعبيّ عن عُمر بن سَعد)؛ مُقتبسٌ في ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، 80 مجلدًا، تحقيق: عمر العمراويّ (بيروت: دار الفكر، 1995-2000م)، ص59: 128. راجع: أخبار صفين، ص35، Abdul-Aziz Salih Helabi, “A Critical Edition of Akhbar Siffin (Ambrosiana H 129, Berlin, Q.U. 2040),” Ph.d Dissertation, University of St. Andrews (1974)؛ وأحمَد بن يَحيى البلاذريّ، أنساب الأشراف، المجلد 2، تحقيق: والفرد مادلونغ (بيروت: كلاوس شوارتز، 2003م)، ص ص194-195
([2]) يُؤكد هذا المقطع اعتراف عَلِيّ بشرعيَّة الشورى لاختيار الخليفة لدحض الادعاءات القائلة إن عَلِيًّا أخفق في واقع الأمر في عقد شورى بعد مقتل عُثمَان؛ انظر: باتريشيا كرون، الشورى بوصفها مؤسسةً اختياريَّة، Patricia Crone, “Shūrā as an Elective Institution,” Quaderni di Studi Arabi 19 (2001): 16. يبدو أن هذا يتعارض مع الأنساق اللاحقة في المذهب الشِّيعيّ، التي تُؤكد أن الإمامة تتحقق عن طريق النص عليها، وهو أمرٌ جديرٌ بالملاحظة؛ راجع: رودريغو آدم، "مذاهب النص الكلاسيكيَّة في الشِّيعة الإماميَّة: حول استخدام مصطلح تفسيريّ"، Rodrigo Adem, “Classical Naṣṣ Doctrines in Imāmī Shīʿism: On the Usage of an Expository Term,” Shii Studies Review 1 (2017): 42-71، ومناقشة هذه الرسالة تحديدًا من قِبل العالِم المُعتزليّ ابن الملاحميّ (ت. 536هـ/1141م) في كتاب حَسن أنصاريّ ونبيل حُسين، الخلافة والإمامة: مُختارات من نصوص إسلاميَّة في العصور الوسطى في الكلام السياسيّ، Hassan Ansari and Nebil Husayn, Caliphate and Imamate: An Anthology of Medieval Muslim Texts on Political Theology (Cambridge: Cambridge University Press, 2023), 126 ff..
([3]) كرون، الشورى بوصفها مؤسسةً انتخابيَّةً، Crone, “Shūrā as an Elective Institution,” 16-17, 28.
([4]) دائرة المعارف الإسلاميَّة، مادة "طُّلقاء" (سي. إي. بوسورث)، EI2, s.v. “Ṭulaḳāʾ” (C.E. Bosworth).
([5]) أبو جعفر الطبريّ، تاريخ الرسائل والملوك، 11 مجلدًا، تحقيق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف، 1960م) 3/61 (ص1642-1643). تفتقر رواية القصة في تنقيح ابن هشام لـمغازي ابن إسحاق إلى الشرح؛ انظر عَبد الملك بن هشام الحميريّ، السَّيرة النبويَّة، Abd al-Malik ibn Hišām al-Ḥimyarī, Sīrat Rasūl Allāh (Das Leben Muhammed’s nach Muhammed Ibn Ishak bearbeitet von Abd el-Malik Ibn Hischâm), 2 vols., ed. Ferdinand Wüstenfeld (Göttingen: Dieterischsche, 1859), 1.2.821. بيد أن الرأي القائل بأن مكة فُتحت طُلحًا لا عنوً هو الرأي السائد إلى حدٍ بعيد. على سبيل المثال؛ انظر: مُحَمَّد بن إدريس الشافعي، الأم، 11 مجلدًا، تحقيق: رفعت فوزي عَبد المطلب، القاهرة: دار الوفاء، 2001م)، 9/257-258؛ وأبو جعفر مُحَمَّد بن يعقوب الكُلينيّ، الكافي، 8 مجلدات، تحقيق: عَلِيّ أكبر الغفاريّ (طهران: دار الكتب الإسلاميَّة، 1957م)، 3/513؛ وأحمَد بن نصر الداوديّ المالكيّ، كتاب الأموال، تحقيق: رضا مُحَمَّد سالم شحادة (بيروت: دار الكتب العلميَّة، 2008م)، 124. يبدو أن الشافعيّ هو المرجعيَّة الأبكر الرئيس والوحيد الذي يُنكر ادعاء فتح مكة عنوةً؛ انظر: الشافعي، الأم، 9/258-259، "إنْمَا دَخَلَهَا صُلحًا". راجع: مائير جاكوب قسطر، "تيجان هذه الأمة...: بعض الملاحظات حول العمامة في الروايات الإسلاميَّة"، M.J. Kister, “‘The Crowns of This Community’ …: Some Notes on the Turban in the Muslim Tradition,” JSAI 24 (2000): 240.
([6]) مُقارنةً بالليبرتينيّ الرومانيّ؛ انظر: هيرنيك موريتسن، الرجل المُتحرر في العالَم الرومانيّ، Hernik Mouritsen, The Freedman in the Roman World (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 264. يُحاول ابن تيميَّة (ت. 728هـ/1328م) التخفيف من الدلالات السلبيَّة في كتابه منهاج السُّنَّة النبويَّة في نقض كلام الشِّيعة القدريَّة، 9 مجلدات، تحقيق: مُحَمَّد رشاد سالم (الرياض: جامعة الإمام مُحَمَّد بن سعود الإسلاميَّة، 1986م)، 4/381، بأن هذا ليس نعت ذم؛ لكن ادعائه يتناقض بوضوح مع استخدامه الأوسع، وينبغي قراءته في ضوء السياق الجدليّ الذي ورد فيه. راجع أعلاه، وآرام شاهين، دفاعًا عن مُعاويَة بن أبي سُفيان: رسائل ودراسات عن مُعاويَة من القرن الثامن إلى القرن التاسع عشر الميلادييْن، Aram Shahin, “In Defense of Muʿāwiyah ibn Abī Sufyān: Treatises and Monographs on Muʿāwiyah from the Eighth to Nineteenth Centuries,” in The Lineaments of Islam: Studies in Honor of Fred McGraw Donner, ed. Paul Cobb (Leiden: Brill, 2012), 195.
([7]) راجع: ابن أعثم الكوفي، كتاب الفتوح، 8 مجلدات، تحقيق: عَلِيّ شيري (بيروت: دار الأضواء، 1991م)، 2/560. على الرغم من التشابه الكبير في اللهجة والمضمون؛ فإن نُسخ هذه الرسالة في المِنقري، صفين، ص88-91 (نقلًا عن عَمر بن سَعد) والبلاذريّ، الأنساب، 2/251-252 (نقلًا عن أبي مِخنف) تفتقر إلى تهمة كون مُعاويَة من الطلقاء.
([8]) حُذف اسمي أبي بكر وعُمر بن الخطاب هنا على الأرجح من قِبل صاحب المختارات الشريف الرضيّ.
([9]) أورسولا سزكين، أبو مِخنف: مُساهمة في تأريخ العصر الأمويّ، Ursula Sezgin, Abū Miḫnaf: Ein Beitrag zur Historiographie der umaiyadischen Zeit (Leiden: Brill, 1971), 47-48, 123-139؛ ومارتن هيندز، رايات العرب وهتافاتهم في معركة صفين (657 م)، Martin Hinds, “The Banners and Battle Cries of the Arabs at Ṣiffīn (657 AD),” Al-Abḥāth 24 (1971): 5.
([10]) على سبيل المثال، إيرلينغ. إل. بيترسن، عَلِيّ ومُعاويَة في الأدبيات والأعمال العربيَّة المُبكرة: دراسات حول نشأة الكتابة التأريخيَّة الإسلاميَّة ونموها حتى نهاية القرن التاسع الميلاديّ، E.g., E.L. Petersen, ʿAlī and Muʿāwiya in Early Arabic Tradition: Studies on the Genesis and Growth of Islamic Historical Writing until the End of the Ninth Century (Copenhagen: Munksgaard, 1964), 29, 60؛ والفرد مادلونغ، خلافة مُحَمَّد: دراسة في الخلافة المُبكرة، Wilferd Madelung, The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 194 n239, 208-209, 231, 234 n354, 241, 256, 263, 301-302
([11]) على سبيل المثال، أحمَد بن يَحيى البلاذريّ، أنساب الأشراف، المجلد 4/1، تحقيق إحسان عَباس (بيروت: فرانز شتاينر، 1979م)، ص12-13؛ وراجع. آر. ستيفن همفريز، مُعاويَة بن أبي سُفيان، R. Stephen Humphreys, Mu‘awiya ibn Abi Sufyan (London: Oneworld, 2006), 5-7.
([12]) على سبيل المثال، ابن عساكر، 57/265-{270}؛ وأبو القاسم الكعبيّ البلخيّ، قبول الأخبار ومعرفة الرجال، تحقيق: حُسين خانصو (اسطنبول: كورامر، 2018م)، ص168-183. وانظر: شون ويليان أنتوني، الإمام المقتول حقًا: دفاع مُعتزليّ عن مقتل عُثمَان بن عفَّان، S.W. Anthony, “The Justly Killed Imam: A Muʿtazilī Defense of the Murder of ʿUthmān ibn ʿAffān (r. 23-36/644-656),” Journal of Abbasid Studies 12 (2025).
([13]) ابن سَعد الزُهريّ، كتاب الطبقات الكبير، 11 مجلدًا، تحقيق: عَلِيّ مُحَمَّد عُمر (القاهرة: دار الخانجيّ، 2001م)، 10/147؛ وأبو عيسى الترمذيّ، الجامع الكبير، 6 مجلدات، تحقيق: بشار عوّاد معروف (بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 1996م)، 5/267-268 (رقم 3224).
([14]) الكُلينيّ، الكافي، 8/189-190؛ راجع: أبو حيان التوحيديّ، المتعة والمؤانسة، 3 مجلدات، تحقيق: أحمَد أمين وأحمَد الزين (بيروت: دار مكتبة الحياة، 1965م)، 2/73-74، الذي يُشير إلى أن النِّبِيّ عيّن رجالًا من بني أميَّة في مناصب مرموقة أكثر بكثير مما عيّن رجالًا من بني هاشم.
([15]) أي إنهما استُشهدا في معركة قبل وفاة النِّبِيّ: جعفر في مؤتة سَّنة 8هـ/629م، وحمزة في أحد سَّنة 3هـ/625م.
([16]) على سبيل المثال: "إن الأئمة من قُريش، غُرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم" (النهج، 1.142.1)، راجع: رضوان السيد، الجماعة والمجتمع والدولة: سلطة الأيديولوجيا في المجال السياسيّ العربيّ الإسلاميّ. (بيروت: دار الكتاب العربيّ، 1997)، ص64-66
([17]) على سبيل المثال، يصف عَلِيّ أبناء العَباس بأنهم الأفضل بين “أبناء الطُّّلقاء" في دفاعه ضد اعتراضات الأشتر على سياسته في تعيين الكثير منهم ولاة له. انظر ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة، 20 مجلدًا، تحقيق: مُحَمَّد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار إحياء الكتب العربيَّة، 1959)، 15/98-99
([18]) أبو العَباس المُبرَد، الكامل في اللغة، 3 مجلدات، تحقيق: مُحَمَّد أحمَد الداليّ (بيروت: مؤسسة الرسالة، 1997م)، 2/649؛ راجع. الطبريّ، التاريخ، 7/567 (3/210)؛ وإلعاد، ثورة مُحَمَّد النفس الزكيَّة سَّنة 145هـ/762م: الصراع بين الطالبيين والعَباسيين الأوائل، Elad, Amikam. 2016. The Rebellion of Muhammad al-Nafs al-Zakiyya in 145/762: Ṭālibīs and Early ʿAbbāsīs in Conflict. Leiden: Brill, 172 n15، الذي لا يبدو أنه يُدرك أن بعض الهاشميين، وليس فقط الأمويين، صُنِّفوا أيضًا بين الطُّلقاء.
([19]) المُبرَد، الكامل، 2/650؛ والطبريّ، التاريخ، 7/569 (3/212)؛ وراجع. تيلمان ناغل، تقرير مُبكر عن ثورة مُحَمَّد بن عَبد الله في عام 145هـ، Tilman Nagel, “Ein früher Bericht über den Aufstand von Muḥammad b. ʿAbdallāh im Jahre 145 h,” Der Islam 46 (1970): 249, 254، وديبوراه غي. تور، فِراق الطريق بين الشِّيعة العلويَّة والعَباسيَّة: تحليل الرسائل بين الخليفة المنصور ومُحَمَّد النفس الزكيَّة، Deborah G. Tor, “The Parting of Way between ʿAlid Shiʿism and Abbasid Shiʿism: An Analysis of the Missives between the Caliph al-Manṣūr and Muḥammad al-Nafs al-Zakiyya,” Journal of Abbasid Studies 6 (2019): 217-218.
([20]) نبيل أ. حُسين، رسائل في نجاة أبي طَالب، Nebil A. Husayn, “Treatises on the Salvation of Abū Ṭālib,” Shii Studies Review 1 (2017): 3-41.
([21]) مُحَمَّد بن إسحاق الفاكهيّ، أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه، 4 مجلدات، تحقيق: عَبد الملك بن عَبد الله بن دُهيش (مكة: النهضة الحديثة، 1994م)، 3/74؛ وراجع: أبو عُبيد القاسم بن سلّام، كتاب الأموال، مجلدان، تحقيق: أبو أنس سيد بن رجب (القاهرة: دار الهدي النبويّ، 2007م)، 1/340، والذي يُراجع كلمة "الطُّلقاء"، قائلًا: "لا أُحب ذكرها؛ كما ورد في كتاب أحمَد بن يَحيى البلاذريّ، فتوح البلدان، تحقيق: م. ج. دي غويه (ليدن: بريل، 1968م)، ص458
([22]) نور الدين السمهوديّ، وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى، 5 مجلدات، تحقيق: قاسم السامرائيّ (لندن: معهد الفرقان، 2001م)، 1/130؛ وراجع: الأكلة وحقائق الأدلة، مُحَمَّد نجاد بن موسى بن مجاد، ص ص60-61
([23]) وهي: )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا(. (المترجم).
([24]) الترمذيّ، 5/267-268 (رقم 3224)؛ وراجع. ابن سَعد، 10/147
([26]) البلاذريّ، الأنساب، 5/492؛ نقلًا عن الواقديّ (ت. 207هـ/823م).
([27]) ابن سَعد، 6/90. صرّح عَبد الله بن ربيعة بأنه سيرفض الاعتراف بسُلطة عَلِيّ إذا ما انتخبته الشورى خليفةً، وذلك بعد رفض التماسه بضمّه إليها (المصدر نفسه، 6/91).
([28]) المشهور أن عَمر بن العاص أسلم قبل فتح مكة ببضعة أشهر. (المترجم).
([29]) أحمَد بن يَحيى البلاذريّ، أنساب الأشراف، المجلد الخامس، تحقيق: إحسان عَباس (بيروت: فرانز شتاينر، 1996م)، ص492، نقلًا عن الواقديّ.
([30]) شوني ويليام أنتوني، مُحَمَّد وإمبراطوريات الإيمان: تشكل نبي الإسلام، S.W. Anthony, Muhammad and the Empires of Faith: The Making of the Prophet of Islam (Oakland: University of California Press, 2020), 158-160.
([31]) نبيهة عبود، دراسات في البرديات الأدبيَّة العربيَّة 1: نصوص تأريخيَّة، Nabia Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri I: Historical Texts (Chicago: The University of Chicago Press, 1957), 81-82..
([32]) "لولا ما صنعتُ بمُعاويَة" بدلًا من "لولا ما طمّعت مُعاويَة"؛ انظر: م. ج. قسطر، "ملاحظات على رواية الشورى التي عينها عُمر بن الخطاب"، M.J. Kister, “Notes on an Account of the Shura Appointed by ʿUmar b. al-Khattab,” JSS 9 (1964): 321.
([33]) ترى عبود، البرديات الأدبيَّة العربيَّة، Abbot, Arabic Literary Papyri, 82, 85، أن هذا تلميحٌ مُباشرٌ إلى مُعاويَة؛ لكنني أقل يقينًا في ذلك.
([34]) تُصوّر إحدى الروايات مُنشقين من الكُوفَة وهم يُواجهون الخليفة عُثمَان بعدة جوانب من سوء حُكمه، ومن بينها ما ذكروه صراحة: "واتخاذك بطانةً من الطُّلقاء وابن الطُّلقاء دوننا" (ابن أعثم، 2/390)؛ راجع: عُمر بن شبة النُميريّ، تاريخ المدينة المنورة، 4 مجلدات، تحقيق: فهيم مُحَمَّد شلتوت (مكة: حَبيب محمود أحمَد، 1979م)، 4/1169، 1283
([35]) ابن سَعد، 6/16؛ وابن عساكر، دمشق، 56/67
([36]) هكذا جاءت في المصادر. (المترجم).
([37]) على سبيل المثال، الطبريّ، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عَبد الله بن عَبد المحسن التركيّ، بالتعاون مع: مركز البحوث والدراسات الإسلاميَّة بدار هجر - عَبد السند حَسن يمامة، 11/637-638. هناك، بطبيعة الحال، تفسيرات أخرى، بما في ذلك أولئك الذين صلوا إلى القبلتيْن (أي نحو القُدْس أولًا ثم مكة)؛ انظر: المصدر نفسه، 11/638-640
([38]) مُصعب الزبيريّ، نسب قُريش، تحقيق: إيفاريست ليفي بروفنسال (القاهرة: دار المعارف، دون تأريخ)، ص124؛ وراجع: أبو بكر بن أبي خيثمة، التاريخ الكبير: السفر الثاني، مجلدان، تحقيق: صلاح بن فتحي هَلل (القاهرة: الفاروق الحديثة، 2006م)، 1/544؛ وابن عساكر، دمشق، 56/55، 66-67
([39]) يروى، على سبيل المثال، موسى بن عُقبة، مغازي سيدنا مُحَمَّد، 3 مجلدات، تحقيق: مُحَمَّد الطبرانيّ (فاس: ابن عطيَّة، 2023م)، 3/151، كيف انسحب مُعاويَة ووالده؛ على الرغم من وجودهما في حنين، لمراقبة ساحة المعركة من بعيد "ينظرا لمن تكون له الدائرة". راجع: مُعمر بن راشد، كتاب المغازي، Maʿmar ibn Rāshid, The Expedition (Kitāb al-Maġāzī), ed./tr. S.W. Anthony (New York: New York University Press, 2014), 2.3.9 and Ibn Hišām, Sīrah, 1.2: 755, 881؛ وابن هِشام، السيرة، 1/2/755، 881
([40]) أشهر مثالٍ على ذلك هو اعتناق العَباس، الذي، وفقًا لابن إسحاق، اعتنق الإسلام سرًا بعد أسره أثناء قتال المسلمين في بدر؛ لكنه لم يُعلن اعتناقه الإسلام علنًا. انظر: ابن هِشام، السيرة، 1/1/460؛ وابن أبي خيثمة، التاريخ، 1/67؛ وأحمَد بن حنبل، المسند، 52 مجلدًا، تحقيق: شُعيب الأرنؤوط وآخرون. (بيروت: مؤسسة الرسالة، 2015م)، 39/290 (6/9). قد تُفسّر مثل هذه التطورات، جزئيًا على الأقل، تطور التعريف الأوسع للطُّلقاء الذي قدّمه المُعتزليّ ابن أبي الحديد (ت. 656هـ/1258م)، الذي ينص على أنه "وكذلك كل من أسر في حرب رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم امتن عليه بفداء أو بغير فداء؛ فهو طليق" (الشرح، 15/119).
([41]) إسحاق حسون، اعتناق مُعاويَة بن أبي سُفيان الإسلام، Isaac Hasson, “La conversion de Muʿāwiya ibn Abī Sufyān,” JSAI 22 (1998): 227-230؛ وهمفريز، مُعاويَة، Humphreys, Muʿawiya, 39-41.
([42]) راجع: النهج، 1.171.2، "لا يحمل هذا الامر إلا أهل الصبر والبصر والعلم بمواقع الأمر".
([43]) راجع: النهج، 3.237: "وفُرضت الإمامة نظامًا للأمة... وفُرضت الطاعة تعظيمًا للإمامة".
([44]) باتريشيا كرون، خليفة الله: السلطة الدينيَّة في العصور الإسلاميَّة الأولى، P. Crone, God’s Rule: Government and Islam (New York: Columbia University Press, 2004), 21-23. وفقًا لخطبةٍ منسوبةٍ إلى عَلِيّ، "وإنما الأئمة قوام الله على خلقه، وعرفاؤه على عباده، لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه" (النهج، 1.150.2). راجع الحديث النبويّ الشهير "ومن مات وليس في عنقه بيعة؛ مات ميتة جاهليَّة"؛ مسلم، الصحيح، 3/1478 (كتاب الإمارة رقم (33)، حديث 1851). راجع الكُلينيّ، الكافي، 1/377 (نقلًا عن جَعفر الصادق). بيد أن معظم روايات هذا الحديث تقول بدلًا من ذلك، "ومن مات وهو مُفارق للجماعة؛ فإنه يموت ميتة جاهليَّة"؛ انظر أحمَد، المسند، 9/284-285 (2/80).
([45]) الطبري، التاريخ، 3/584 (1/2368).
([46]) أبو عبيد، الأموال، 1/33 (رقم 3).
([47]) راجع: أوسوين موراي، فكرة الملك الراعي من قورش إلى شارلمان، Oswyn Murray, “The Idea of the Shepherd King from Cyrus to Charlemagne,” in Latin Poetry and the Classical Tradition, ed. O. Murray and P. Godman (Oxford: Clarendon Press), 1-14؛ ويوهانس هاوبولد، رعاة الشعب: وجهات نظر يونانيَّة ومن بلاد ما بين النهرين، Johannes Haubold, “‘Shepherds of the People’: Greek and Mesopotamian Perspectives,” in Mesopotamia in the Ancient World: Impact Continuities, Parallels, ed. R. Rollinger and E. van Dongen (Münster: Ugarit, 2014), 245-255.
([48]) يُذكّر هذا المقطع إلى حدٍ ما بأنواع الحُكم الطبيعيّ السبعة لأفلاطون (القانون، Leg. 690-691): حكم الآباء على الأبناء، وحكم السادة على العبيد، وحكم الرجال على النساء، وحكم الأشراف والشيوخ على من هم دونهم، وحكم الأقوياء على الضعفاء، وحكم الفاضل على الناقص، وحكم العالِم على الجاهل. للاطلاع على كيفيَّة تلقيّ هذا المقطع باللغة العربيَّة؛ انظر: جيفري جيه. موسلي، أفلاطون العرب: في النقل العربيّ لحوارات أفلاطون: نصوص ودراسات، Geoffrey J. Moseley, “Plato Arabus: On the Arabic Transmission of Plato’s Dialogues: Texts and Studies,” PhD dissertation, Yale University (2017), 277-278 (Laws frag. 13) = العامريّ، السعادة والإسعاد، تحقيق: {المينويّ}، ص253
([49]) راجع: ميشال فوكو، الأمن، الإقليم، السكان: محاضرات في الكوليج دو فرانس، M. Foucault, Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977-78, ed. M. Senellart, tr. G. Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 126-129؛ وبن غولدر، فوكو وأصل السُلطة الرعويَّة، Ben Golder, “Foucault and the Genealogy of Pastoral Power,” Radical Philosophy Review 10 (2007): 157-176.
([50]) انظر: هان هسين ليو، الخلافة بعدي ثلاثون سَّنة: الجدل والفكر السياسيّ في حديث نبويّ بعد وفاة النَّبِيّ، Han Hsien Liew, “‘The Caliphate Will Last for Thirty Years’: Polemic and Political Thought in the Afterlife of a Prophetic Ḥadīth,” Journal of Islamic Studies 36 (2025): 38-82، في شأن تأريخ التلقيّ التأريخيّ لهذا الحديث.
([51]) ابن هِشام، السيرة، 1/2/1017؛ والطبريّ، التاريخ، 3/210 (ص1829)؛ وانظر: طاهرة قطب الدين، الخطابة العربيَّة: الفن والوظيفة، Tahera Qutbuddin, Arabic Oration: Art and Function (Leiden: Brill, 2019), 337-343
([52]) مائير جاكوب قسطر، "... إلا بالحق: دراسة الحديث المُبكر، M.J. Kister, “… illā bi-ḥaqqihi: A Study of an Early Ḥadīth,” JSAI 5 (1984): 33-52.
([53]) أبو عُثمَان الجاحظ، البيان والتبيين، 4 مجلدات، تحقيق: عَبد السلام مُحَمَّد هارون (القاهرة: الخانجيّ، دون تأريخ)، 2/43-44
([54]) راجع: أفلاطون، محاورة جورجياس، Plato Gorg. 472e.
([55]) لذلك، يُمكن الاستشهاد أحيانًا بهذا الحديث بوصفه دليلًا على التشِّيع. انظر تشارلز بيلّا، ثقافة مُعاويَة في القرن الثالث الهجريّ، Charles Pellat, “Le culte de Muʿāwiyah au IIIe siècle de l’hégire,” Studia Islamica 6 (1956): 58، وآي وين سو، منظور شِّيعَة الكُوفَة المحدثين الأوائل حول الخلفاء الراشدين، I-Wen Su, “The Early Shiʿi Kufan Traditionists’ Perspective on the Rightly Guided Caliphs,” JAOS 141 (2021): 27-47. بيد أن علماء الشِّيعة الإماميَّة رفضوا بشدة؛ نظرًا لتأييد الحديث الضمنيّ لأسلاف عَلِيّ، صحة الحديث؛ انظر: ليو، وستستمر الخلافة، Lieuw, “The Caliphate Will Last,” 55-57.
([56]) على الرغم من الجدل الدائرة حول تأريخ بداية خلافته؛ وانظر: خالد كِشك، متى أصبح مُعاويَة خليفة؟، Khaled Keshk, “When Did Muʿāwiya Become Caliph?,” JNES 69 (2010): 31-42.
([57]) المِنقريّ، صفين، ص201 = الطبريّ، التاريخ، 5/8 (1/3278)، من طريق أبي مِخنف = ابن أعثم، 3/22.
([58]) إشارة إلى قوات الأحزاب المكيين الذين حاصروا المدينة المنورة سّنة 5هـ/627م، والذين سُميت سورة الأحزاب باسمهم؛ راجع ابن أعثم، 4/247، حيث يظهر الطُّلقاء والأحزاب في مقابل المهاجرين والأنصار.
([61]) راجع: كريستيان ديكوبير، حول التراث الأمويّ، Christian Décobert, “Notule sur le patrimonialisme omeyyade,” in Umayyad Legacies: Medieval Memories from Syria to Spain, ed. A. Borrut and P. Cobb (Leiden: Brill, 2010), 243-244 et passim.
([62]) عرّفهم الخليفة العَباسيّ المأمون (حكم 198-219هـ/813-833م) صراحةً على هذا النحو في وثيقةٍ؛ لعن فيها مُعاويَة والأمويين. وأمر الخليفة المُعتضد (حكم 279-290هـ/892-902م) فيما بعد بإعادة نشرها، وإن كان ذلك بصيغةٍ مُنقحةٍ بواسطة أبي القاسم عُبيد الله بن سُليمان، سَّنة 284هـ/897م. وقد بقيت النسخة الأخيرة في الطبريّ، التاريخ، 10/56، 57-58 (3/2168، 2170). راجع: البلخيّ، قبول الأخبار، ص170؛ وابن أبي الحديد، الشرح، 15/265؛ وكرون، خليفة الله، Crone, God’s Rule, 132-133.
([63]) وهو: ابن موهب. (المترجم).
([64]) أبو بكر البيهقيّ، دلائل النبوة ومعرفة أحول صاحب الشريعة، 6 مجلدات، تحقيق: عَبد المعطي قلعجي (بيروت: دار الكتب العلميَّة، 1988م)، 6/507-508؛ وراجع. ابن عساكر، دمشق، 57/252-254؛ وأبو بكر بن أبي شيبة، المُصنَّف، 25 مجلدًا، تحقيق: سَعد الشاطريّ (الرياض: دار كنوز إشبيليا، 2015م)، 21/459-460 (رقم 40، 538)؛ وابن الجوزيّ، مناقب أبي عَبد الله أحمَد بن مُحَمَّد بن حنبل، مجلدان، تحقيق: مايكل كوبرسون (نيويورك: مطبعة جامعة نيويورك، 2015)، 2/138-39 (70.5).
([65]) أي: شيءٍ يتناقل بينهم، انظر: سورة الحشر: 70
([66]) أي: عبيدًا، وإماءً، وخدمًا. (المترجم).
([68]) ابن أبي شيبة، المُصنَّف، 17/104 (رقم 32، 572)؛ وراجع: ابن عساكر، دمشق، 56/145
([69]) أبو العرب التميميّ، المِحن، تحقيق: يحيى الجبوريّ (بيروت: دار الغرب الإسلاميّ، 1983م)، ص 158، نقلًا عن ابن شهاب الزُهريّ (ت. 124هـ/742م)، الذي أضاف أن إجمالي عدد القتلى، بمن فيهم النساء والأطفال، تجاوز العشرة آلاف. وفقًا للبلاذريّ، الأنساب، 4/1/333 (نقلًا عن الهيثم بن عدي، المتوفى حوالي 206-207هـ/821-822م)؛ فإن عدد القتلى كان أقرب إلى ستة آلاف وخمسمئة قتيل. راجع: أبو العرب، المِحْن، ص160-172، وخليفة بن خياط العصفريّ، التاريخ، تحقيق: سهيل زكّار (بيروت: دار الفكر، 1993م)، ص184-192
([70]) الطبريّ، التاريخ، 10/60 (3/2174). وقد صيغت القصيدة على غرار أبياتٍ من القصيدة التي نظمها ابن زبرة للاحتفال بهزيمة المسلمين في أُحد؛ انظر: ابن هشام، 1/2/616، راجع: الجاحظ، النابتة، ص15؛ والبلاذريّ، 4/1/333؛ وأبو الفرج، ص110
([72]) خليفة، التاريخ، ص183. راجع: ابن سَعد، 7/404؛ وأبو العرب، المِحن، ص181؛ والبلاذريّ، الأنساب، 4/1/328؛ والطبريّ، التاريخ، 5/493، 495 (2/420، 423)؛ والزُبيْر بن بكار، جمهرة نسب قُريش وأخبارها، مجلدان، تحقيق: مُحَمَّد محمود شاكر (الرياض: دار اليمامة، 1999م)، 1/467. وانظر: باتريشيا كرون ومارتن هيندز، خليفة الله، Crone, God’s Rule, 67؛ وأندرو مارشام، طقوس الملكيَّة الإسلاميَّة: التتويج والخلافة في الإمبراطوريَّة الإسلاميَّة الأولى، Andrew Marsham, Rituals of Islamic Monarchy: Accession and Succession in the First Muslim Empire (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2009), 92.
([74]) راجع: أرسطو، السياسة، Aristotle, Pol. 7.1333a؛ وأر. كوبنر، الاستبداد والطغيان: تقلبات المصطلح السياسيّ، R. Koebner, “Despot and Despotism: Vicissitudes of a Political Term,” Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 14 (1951): 277-278. وحول مُقارنة الحكم الاستبداديّ بالاستعباد في التراث العربيّ؛ انظر كرون، خليفة الله، Crone, God’s Rule, 45-46, 52, 315.
([75]) ديمتري غوتاس، حول الروايات الرسائليَّة اليونانيَّة العربيَّة، Dimitri Gutas, “On Graeco-Arabic Epistolary ‘Novels’,” Middle Eastern Literatures 12 (2009): 59-70. كان هذا النص بمثابة مقدمة] لكتاب سر الأسرار الأرسطيّ المنحول، الذي تُرجم إلى اللاتينيَّة باسم السر السريّ Secretum secretorum، حيث أصبح الكتاب الأكثر شعبيَّة في العصور الوسطى [الأوروبيَّة] بأكملها"؛ وستيفن ج. ويليامز، سر الأسرار شبه الأرسطيّ بوصفه مرآةً للأمراء: قصة تحذيريَّة، Steven J. Williams, “The Pseudo-Aristotelian Secret of Secrets as a Mirror of Princes: A Cautionary Tale,” in A Critical Companion to the ‘Mirrors for Princes’ Literature, ed. Noëlle-Laetitia Perret and Stéphane Péquignot (Leiden: Brill, 2022), 376.
([76]) سيمون سوين، ثيميستيوس وجوليان والنظريَّة السياسيَّة اليونانيَّة في عهد روما: نصوص وترجمات ودراسات لأربعة أعمال رئيسة، Simon Swain, Themistius, Julian and Greek Political Theory under Rome: Texts, Translations and Studies of Four Key Works (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 198-199 (12.3-4)
([77]) على سبيل المثال، انظر: ملفين ريختر، أرسطو والمفهوم اليونانيّ الكلاسيكيّ للاستبداد، Melvin Richter, “Aristotle and the Classical Greek Concept of Despotism,” History of European Ideas 12 (1990): 176, 180-182؛ وأنتوني كالديليس، بروكوبيوس القيصريّ: الطغيان والتأريخ والفلسفة في نهاية العصور القديمة، Anthony Kaldellis, Procopius of Caesarea: Tyranny, History, and Philosophy at the End of Antiquity (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2004), 128-132؛ وهينينغ بورم، بروكوبيوس والإيرانيون: دراسات حول الاتصالات الرومانيَّة الساسانيَّة في أواخر العصور القديمة، Henning Börm, Prokop und die Perser: Untersuchungen zu den römisch-sasanidischen Kontakten in der ausgehenden Spätantike (Stuttgart: Franz Steiner, 2004), 133-135؛ وجيفري غريتريكس، بروكوبيوس القيصريّ: الحروب الإيرانيَّة: تعليق تأريخيّ، Geoffrey Greatrex, Procopius of Caesarea: The Persian Wars: A Historical Commentary (Cambridge: Cambridge University Press, 2022), 92.
([78]) لويز مارلو، التسلسل الهرميّ والمساواة في الفكر الإسلاميّ، Louise Marlow, Hierarchy and Egalitarianism in Islamic Thought (Cambridge: Cambridge University Press. 1997), ch. 3؛ وميخائيل كوك، هل الحريَّة السياسيَّة قيمة إسلاميَّة؟، Michael Cook, “Is political freedom an Islamic value?,” in Freedom and the Construction of Europe, vol. II: Free Persons and Free States, ed. Quentin Skinner and Martin van Geldern (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 295 n7؛ وكرون، خليفة الله، Crone, God’s Rule, 334-335. وراجع. ابن عبد ربه، 2/9، حيث النعمان بن المنذر عن خُطط خسرو؛ إذ "أراد أن يتخذ به العرب خولًا". كانت المواقف العربيَّة والإسلاميَّة السلبيَّة تجاه الملكيَّة الإيرانيَّة، جزئيًّا على الأقل، مُتسربة في سياق تلقي الأفكار الهلنستيَّة أيضًا؛ على سبيل المثال، انظر ترجمة الفارابيّ (؟) لأفلاطون، أفلاطون، القوانين، Plato, Leg. 697c-699e لدى تيريز-آن دروارت، ملخص كتاب قوانين أفلاطون، Thérèse-Anne Druart, “Le sommaire du livre des “Lois” de Platon (Ǧawāmiʿ Kitāb al-Nawāmīs li-Aflāṭūn),” Bulletin d’Études Orientales 50 (1998): 135 §3.14، التي تفترض أن القانون والحكم لا بد أن يكونا “على طريق الحريَّة؛ لا على طريق العبوديَّة”، ويَعتبر العبوديَّة وتأثيرها المُفسد مثالًا في الإيرانيين: فإن فساد العبوديَّة هو ما ذكره مِن الفُرس في الأمثلة التي أتى بها".
([79]) أبو الحَسن العامريّ، الإعلام بمناقب الإسلام، تحقيق: أحمَد عَبد الحميد غراب (الرياض: دار الأصالة، 1988م)، ص175؛ وراجع. المصدر نفسه، ص164
([80]) كرون، خليفة الله، Crone, God’s Rule, 315. راجع: الحكاية الشهيرة التي يروي فيها بدوي مسلم يُدعى ربعيّ بن عَامر لرستم، القائد الإيرانيّ في القادسيَّة، أن الله قد أرسل العرب إلى العراق "وإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى" (الطبريّ، التاريخ، 3/520 (1/2271)؛ مقتبس في كوك، الحريَّة، Cook, “Freedom,” 289؛ وكرون، خليفة الله، Crone, God’s Rule, 334.
([81]) في الأصل: "أعوذ بالله، ولكني أبايع..."، وما أثبته هو ما وجدته عند مُصعب الزبيريّ في كتابه نسب قريش؛ لا عن ابن بكار في كتابه جمهرة النسب.
([82]) { مُصعب الزبيريّ، نسب قُريش، ص367}.
([83]) الِمنقريّ، ص75؛ وأخبار صفين، ص120