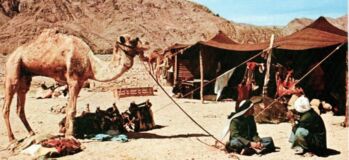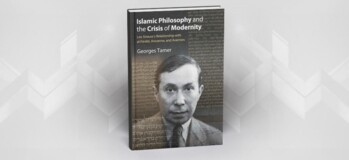الشيخ على عبد الرازق (1888-1966م) في الذكرى المئوية لكتاب الإسلام وأصول الحكم
فئة : مقالات

الشيخ على عبد الرازق (1888-1966م)[1]
في الذكرى المئوية لكتاب الإسلام وأصول الحكم
مقدمة:
تأتي مناسبة هذا المقال فى الذكرى المئوية لكتاب «الإسلام وأصول الحكم» الذي صدر عام 1925م، والذي أحدث ضجة كبيرة داخل الأوساط العلمية والفكرية بسبب رفضه فكرة الخلافة، ودعوته لرفض فكرة الدولة كما صورها التراث الإسلامي، واستأهلت تلك الدعوى للشيخ على عبد الرازق فصله من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف[2]، وإحياءً لتلك الذكرى قام معهد الآباء الدومنيكان للدراسات الشرقية بالقاهرة بعقد مؤتمر بتاريخ 11 إبريل 2025م، دعا فيه أساتذة وباحثون من مشارب ثقافية مختلفة من أجل مناقشة وتحليل للأفكار التي وردت فيه، وكيف يمكن الاستفادة منها من أجل الخروج من هذا الواقع المأزوم الذى آلت إليه أمتنا الإسلامية جرّاء أعمال العنف والإرهاب بدعوي إحياء الخلافة، حيث يسلط الكتاب الضوء على قضية تشكل لبنة أساسية في البناء الإيديولوجي والفلسفي لتراث الأمم ذات النزعة الدينية، وهي النبوة.
سنقوم في هذا المقال باستعراض الفكرة الرئيسة للكتاب وتحليلها، ونقدها أحيانا، وكيف يمكن الانطلاق منها من أجل الاستفادة بها في واقعنا الراهن، ولا شك أننا سنسلط الضوء في هذا المقال على جهود المتدخلين في هذا اليوم الدراسي حول بحث الشيخ علي عبد الرازق، لبيان كيف جاءت محاولاتهم نحو إثراء الفكر بأطروحاتهم المختلفة، وبلورتهم للسياقات التاريخية التي صدر فيها الكتاب.
الإشكالية وغياب المنهج:
يتبلور بحث الشيخ على عبد الرازق وتدور رسالته حول جملة رئيسة أوردها في ثنايا كتابه وهي: (أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن من عمله شيء غير إبلاغ رسالة الله تعالى إلي الناس، وأنه لم يكلَف شيئا غير ذلك البلاغ، وليس عليه أن يأخذ الناس بما جاءهم به، ولا أن يحملهم عليه)[3]، وتلك الجملة جوابٌ صحيح عن إشكالية ربما لم يُوفق في تحديدها، وإيراد الأدلة والقرائن المناسبة للتدليل عليها، حيث نرى أنه كان ينبغي أن ترتكز إشكالية هذا الكتاب بالأساس حول من هو النبي؟ وما هي مهمته بالتحديد في المجتمع الذي أُرسل إليه؟ دون الانطلاق من بحث الخلافة، ومزالقها في تاريخ الإسلام، تلك هي الإشكالية الكبرى التي كان يتحتم عليه أن يُوليها كثيرًا من العناية والاهتمام، فكيف تتلخص تلك المهمة في أمر الوحي؟ وكيف يتلقي النبي عليه السلام رسالته عن الله عز وجل؟
ربما كان على الشيخ على عبد الرازق أن يؤسس بادئ ذي بدء لهذه القاعدة الرئيسة انطلاقًا من دراسةٍ مشتركة بين الأديان، ولم يكن من الواجب أن تُقصر معالجة هذه الإشكالية على شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كان له في هذا مسوغ في التاريخ الحديث، وهو إلغاء نظام الخلافة علي يد مصطفي كمال أتاتورك بتصويت من المجلس الوطني التركي عام 1924م[4].
بالنظر إلي بحث الشيخ على عبد الرازق نلاحظ أنه لم يتعرض فيه لمفاهيم أساسية كان يجب التنويه إليها بالحد في مقدمة بحثه كمصطلح الدين، والعقل، والإسلام، والنبوة، والوحي، والفارق بين النبوة والرسالة، كونها مفاهيم تأسيسية من شأنها تأطير الآفاق الإبستيمولوجية للبحث، بل لقد غاب الحديث في الكتاب عن أصول الحكم الأساسية في الإسلام من حيث ماهي؟ كما أن الكتاب لا يتحدد فيه أي منهجية تبّناها، فبالإطلاع على بحثه يتكشّف أن الشيخ انبري نحو المنهج الخطابي-الدعوى- الذي اعتاده جريًا علي أقرانه من العلماء آنذاك، حيث إذا ما طٌرحت مسألة للنظر ساروا فيها بمنطق الحل والحرمة، والتدليل عليها عبر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية دون ميلٍ صريح إلي تأويل، وهو منطق الفقهاء التقليديين، وليس بمنطق البحث العملي القائم علي طرح الإشكالية، والنظر إليها من زواياها المختلفة، وفقا لمنهج علمي رصين كنا نأمل أن يتم اعتماده في كتاب شيخنا الجليل (رحمه الله).
الجدل والبرهان ومهمة التبليغ:
لا شك أن معالجة تلك الإشكالية كان يستلزم منهجًا تاريخيًا يلج من خلاله الشيخ على حقل مقارنة الأديان، والنظر كذلك بعمق في علم اللاهوت من أجل الوصول إلي تحديد ماهية ومهمة النبي داخل أي مجتمع إنساني كمنطلق أساسي - نؤكد ثانية أنه كان لابد أن يكون هذا لُبّ إشكالية الكتاب، لا البحث في تحديد معنى الخلافة، وتتبع آفاتها داخل دولة الإسلام في صدرها الأول.
إن هذا الطرح الذي اتبعه الشيخ على عبد الرازق في هذا الكتاب لا يتجاوز أن يكون تقليديًا استقرأ فيه حوادث التاريخ الإسلامى، ومر سريعًا على ما حدث في الدولة الأموية والعباسية، ولم يستعرضه بالعمق الذي كان عليه أحد مفكرينا في العصر الحديث، وهو فرج فودة (20 أغسطس 1945 – 8 يونيو 1992) في كتابه «الحقيقة الغائبة»، ثم بدأ بالاستدلال على الإشكالية التي كان يجب أن يكون عليها مدار البحث بآيات قرآنية وحديث أو اثنين أتى بهما من كتابٍ تاريخي بدلًا من العودة إلى كتب السنة الستة المشهورة، لكنه لم يفعل ! فلقد كان أحد أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف آنذاك، وحصل على درجة الدكتوراه من جامعة كامبردج بانجلترا، ولم يعالج تلك الإشكالية من داخل علم التوحيد الإسلامي، أو حتى الانطلاق من حقل الفلسفة العربية، حيث كان أمامه الطريق مفتوح ليستدل بمنهج جدلي سفسطائي علي ماهي وظيفة النبي بالتحديد؟ والتي قصرها الإسلام علي التبليغ فقط، وهنا يجب أن نشير على سبيل المثال لكتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» لابن حزم الظاهرى (30 رمضان 384 هـ / 7 نوفمبر 994م- 28 شعبان 456 هـ / 15 أغسطس 1064م)، والذي استعرض فيه آراء الفرق الكلامية في أمر -عصمة الأنبياء-، ونستنبط منه أنه: وفقا لفرق الإسلام يمكن للنبي (أي نبي) أن يرتكب كبائر المعاصي وصغيرها، وله أيضا أن يكْفر "دون الكذب في التبليغ"، وانطلاقا من دليل تيولوجي اتفق عليه علماء الكلام في كافة الفرق الإسلامية على قصر دور النبي في التبليغ، وهذا لم يذكره الشيخ علي في كتابه، نعم! لقد اختلفت الفرق الكلاميه في إمكانية ارتكاب النبي لنوع المعصية، فنجد الكرامية من المرجئة وأبا الطيب الباقلاني (338 هـ - 403 هـ / 950م - 1013م) من الأشعرية ومن تبعه يصرحون بإمكانية ارتكاب النبي لصغائر الذنوب وكبيرها.
يؤكد ابن حزم هذا قائلا: (وذهبت طائفة إلي أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يجوز عليهم كبيرة من الكبائر أصلا، وجوّزوا عليهم الصغائر بالعمد وهو قول ابن فورك الأشعري، وذهب جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة والنجارية والخوارج والشيعة إلي أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية بعمد لا صغيرة ولا كبيرة، وهو قول ابن مجاهد الأشعري شيخ ابن فورك والباقلاني المذكورين)[5]، كما أن هشام بن الحكم (354 هـ/965 م - 403 هـ/1013 م) يقول بعصمة الأئمة بينما يجوّز المعصية علي الأنبياء؛ لأن الرسول إذا عصي فالوحى يأتيه من قبل الله، فيرده عن خطئه وعصيانه. أما الأئمة، فلا يوحى إليهم، ولا تنزل عليهم الملائكة فهم معصومون، فلا يجوز لهم السهو والغلط[6]، لكن اتفق الجميع في الأخير على أن النبي لا يكذب أبدا في التبليغ، في إشارة إلى أن مهمة النبي في صميمها تكمن في أمر التبليغ فقط، وتلك نتيجةَ توصل إليها الشيخ على عبد الرازق بنفسه، لكن وفقا للطريقة الدعوية التقليدية، كما نلاحظ كذلك أن ابن حزم عالج الأمر على عموميته واشتراكه بين الأنبياء، ولم يقصره في شخص النبي محمد صلي الله عليه وسلم.
لقد عالجت المعتزلة قضية حاجة الناس للرسل في ثنايا كتبهم، وانتهوا إلي وجوب إرسال الله عز وجل للرسل؛ لأنه تعالى لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل قال تعالى: ... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً [الإسراء: 15]. وقال تعالى: ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ [الأنعام: 131]. وقال تعالى: رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا [النساء: 165]؛ وذلك انطلاقا من مبدأ الصلاح والأصلح عند المعتزلة، وهذا خلافٌ حاصل بين المعتزلة، وبين خصومهم من أهل السنة والجماعة، وبالتعمق أكثر في تراث المعتزلة نجدهم يُقصرون دور النبي في تعريف وتبليغ العباد بما هو واجب عليهم من فرائض إلهية من صلاة وزكاة وحج... إلخ، لا أن يكون دورهم إقامة دولة بمفهومها السياسي أو أن يكونوا زعماء سياسيين ورجال دولٍ بالمعنى الحديث[7].
وعن أمر النبوة ومهمة النبي يقول قاضى القضاة عبد الجبار المعتزلي (ت415ھ): (إنه إذا تقرر في عقل كل عاقل وجوب دفع الضرر عن النفس، وثبت أيضا ما يدعو إلي الواجب ويصرف عن القبيح فإنه واجب لا محالة... ولم يكن في قوة العقل ما يعرف به ذلك ويفصل بين ماهو مصلحة ولطف وبين ما لا يكون كذلك، فلابد من أن يعرفنا الله تعالى حال هذه الأفعال، كي لا يكون عائدًا بالنقص على غرضه بالتكليف. وإذا كان لا يمكن تعريفنا ذلك إلا بأن يبعث إلينا رسولا مؤيّدا بعلمٍ معجز دال على صدقه فلابد من أن يفعل ذلك، ولا له يجوز الإخلال به)[8].
كان يمكن للشيخ على عبد الرزاق أن يُسلط الضوء أيضا على الاختلاف الواقع بين المتكلمين في تعريف الإيمان والكفر لدى مدارس الإسلام الكلامية من أجل التوصل بالتحديد إلى: ما الذي تقتصر عليه مهمة النبي؟ فهل يكون مؤمنًا من يكْفر بالأنبياء، أم إن الأمر يقتصر فقط على أن الإيمان هو معرفة الله عز وجل والكفر هو الجهل بالله؟ فنذكر علي سبيل المثال رأي أبو الهذيل العلاف البصري (135-235 هـ/753-850م) الذي يقول: (قوله في المكلف قبل ورود السمع: إنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى بالدليل من غير خاطر، وإن قصر في المعرفة استوجب العقوبة أبدا، ويعلم أيضا حسن الحسن وقبح القبيح، فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل، والإعراض عن القبيح كالكذب والجور)[9]، كما يمكن مطالعة اختلاف الفرق الكلامية في معاني -الإيمان- على ستة أقوال يمكن العودة إليها في كتاب «مقالات الإسلاميين»، وأشهرها هو أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط[10]، عدا أبو حنيفة وأصحابه، وأتباع غيلان بن مسلم الدمشقي يزعمون: أن الإيمان المعرفة بالله والإقرار بالله، والمعرفة بالرسول والإقرار بما جاء من عند الله في الجملة دون التفسير[11].
ومن ناحية أخرى، فإن هناك منهجا آخر يعتمد علي النظر البرهاني داخل إطار حقل الفلسفة العربية كان يمكن للشيخ على عبد الرزاق الانطلاق منه من أجل حل إشكالية مؤَلَفه، وهو فهم فلسفة النبوة وفق ما ارتآه اثنين من فلاسفة الإسلام وهما الفارابي (ت339ھ)، وابن سينا (ت427ھ)، حيث انتهيا إلي نتيجة مفادها أن الإنسان (أي إنسان) متى تصل درجة مخيلته إلي أسمى درجات التخيل يمكنه أن يتلقي المعقولات الأُول من العقل الفعال ويبلغها للناس دون ممارسة أي فعل آخر غير ذلك، أو أن يملي عليه بالجبر أمر يتجاوز إطار التبليغ، فسواء ما إذا كانت النبوة عبر الاصطفاء كما أخبر الشيخ على عبد الرزاق انطلاقًا من صريح القرآن، أو عن طريق المخيلة كما صرح الفارابي وابن سينا، فإن كلَا من المنهجين الكلامي والفلسفي (الجدلي والبرهاني) انتهيا إلي نتيجة واحدة، وهي قصر دور النبي[12] على التبليغ.
يقول الفارابي في مؤلفه: «آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها» عن فلسفة النبوة انطلاقا من نظرية الفيض كرؤية كوسمولوجية للكون: (ولا يمتنع أن يكون الإنسان، إذا بلغت قوته المتخيله نهاية الكمال، فيَقبَل، في يقظته، عن العقل الفعال، الجزيئات الحاضرة والمستقبلة، أو محاكياتها من المحسوسات، ويقبل محاكيات المعقولات المفارقة وسائر الموجودات الشريفة، ويراها، فيكون له، بما قَبِله من المعقولات، نبوة بالأشياء الإلهية، فهذا هو أكمل المراتب التي تنتهي إليها القوة المتخيلة، وأكمل المراتب التي يبلغها الإنسان بقوته المتخيلة)[13].
رسم بياني يوضح طريقة تلقي الوحي عند الفارابي
تلك هي المناهج الأساسية التي كان ينبغي للشيخ على عبد الرزاق أن يتبناها كمنطلاقات أساسية عند كتابته لهذا البحث بدلا من اتباع -المنهج الخطابى-، فتلك طريقة لا تعبر عن مناهج علمية، حيث إن الحوادث التاريخية التي سردها الشيخ في مؤلفه معروفة، ويمكن العودة إليها في كتب التاريخ الإسلامي، والآيات القرآنية التي أوردها داخل كتابه هي أيضا معروفة في القرآن الكريم.
مجهودات المتدخلين:
جاءت مداخلات السادة المشاركين في هذا اليوم الدراسي على النحو التالى:
- أ.د محمد عفيفي، رئيس قسم التاريخ -كلية الآداب- جامعة القاهرة.
عنوان المداخلة: (التاريخ والأسطورة: الإسلام السياسى والخلافة)
- أ.د محمد شريف فرجانى، أستاذ العلوم السياسية والدرسات العربية- جامعة ليون الثانية.
عنوان المداخلة: (مائة سنة بعد معركة الإسلام وأصول الحكم، ما هو مصير الكتاب؟)
- أ. عصام الزهيرى، باحث وأديب مصري مهتم بالقضايا التراثية والتاريخية.
عنوان المداخلة: (الإسلام وأصول الحكم: منهج بحث أصولى يؤدى إلى ثورة تجديدية)
- أ.د عبد الإله بلقزيز، مفكر وأستاذ الفلسفة فى جامعة الحسن الثانى فى الدار البيضاء.
عنوان المداخلة: (فى راهنية مقالة اجتهادية: الديني والسياسي فى أطروحة على عبد الرزاق)
- أ.د عزيز هلال، مدرس فلسفة وعضو بمعهد الآباء الدومنيكان للدراسات الشرقية.
عنوان المداخلة: (الإسلام وأصول الحكم بين إدانة هيئة كبار العلماء ورؤية عبد الرزاق السنهوري.
لاشك أن جهود المتدخلين فى هذا اليوم الدراسى كانت ثرية جدا، حيث ألقت الضوء على نواحى عديدة من النظر عند مطالعة الكتاب، وأمدت القارئ الذي سيطالع الكتاب لأول مرة بمادة علمية جديرة بتوسيع مداركه من أجل فهم ما كتب الشيخ على عبد الرزاق، فالسياقات التاريخية والاجتماعية لا غنى عنها عند معالجة أطروحة ما، واستعراض فكرة دون الالتفات إلى تلك السياقات يحرمها من ثمارها المرجوة منها، لاسيما في حقل الدرسات الإسلامية؛ هذا الحقل الغنى بمادته، والمترامي الأطراف، والذي يمتد على قرابة أربعة عشر قرنا من حياة المسلمين، وكثيرا ما نقول إن التراث لا يعدو أن يكون فكرة اجتهد فيها من شذبها وصاغها كي تصل إلينا، وعلينا نحن الباحثين معالجتها بروية ووفق منهج علمي، كما لا يمكن التغافل على أن الفكرة تمد بجذورها إلى عقل، وفعل العقل دوما نسبي، وبهذا تُوصلنا أفكارنا كأفراد طبيعين إلى واقع ننشد فيه دوما الخير والصلاح.
نحو الحل:
أنهى الدكتور محمد عفيفي مداخلته بسؤالٍ مفاده: كيف يمكن أن نُوقف نزيف الدم الذي خلفته تلك الجماعات الإرهابية المتطرفة؟ ولا شك أن هذا السؤال أثار انتباهى، وألقى بي في الواقع الأليم الذي لا تزال أمتنا العربية تدفع ثمنها الباهظ، وتلّقيته وكأنه موجه إلي؛ فما هو الحل؟
كنت أرى دوما أن الإجابة متوفرة وتسهل بلورتها، فربما تكمن المشكلة في التراث ذاته فيما يتعلق بالمسألة السياسية في الإسلام، لا غير ذلك ! من نماذجٍ لنصوص وردت في «الجامع لأحكام القرآن للقرطبي» (1214-1273م)، وفي «شرح جوهرة التوحيد للبيجوري» (1783-1860م) وفي «اللمع في الرد علي أهل الأهواء والبدع» لأبي الحسن الأشعري (260-324ھ) وفي «منهاج السنة» لابن تيميه (ت 728ھ)، ولنصوصٍ أخرى لا زالت متجسدة في تراثنا حتي اليوم، ولا زال يتم تدريسها كمقرر دراسي يحمل اسم السياسة الشرعية، لا سيما في برامج الدراسات العليا حيث يتم تدريس الطلاب كتاب «الأحكام السلطانية» للماوردي، والتأكيد أن الإمامة: موضوعة لحراسة الدين وسياسة الدنيا وعقدها لمن يقوم بها واجب بالإجماع[14]، ومن شروطها أن يكون قرشيًّا تأكيدا لفكرة العصبية التي لازالت تلعب عليها الجماعات المتطرفة، كما يتم تدريس: أنه لو تغلب علي الحكم شخص قهرًا[15]، وانعقدت له، وإن لم يكن أهلا لها كصبي وامرأة وفاسق وجبت طاعته فيما أمر به أو نهى عنه.
إذن تكمن المشكلة في تراثنا، بل ولا تزال جملة: وواجب نصب إمام عدل بالشرع ..... فاعلم لا بحكم العقل[16]، وأن الإمام لا يُعزل إلا بالكفر موجودة في التراث؛ إذ إن من شروطها التي وضعها فقهاء الإسلام: ألا يليها المرأة، وهذا ما يتربي عليه حتي الآن طلابنا فى الجامعات العلمية ذات الصبغة الدينية، فالخلافة أو الإمامة واجبة بالشرع، ولا شك أن في هذا نقطة التقاء مركزية بين هذا التراث وبين الجماعات المتطرفة، فما تفعله الجماعات المتطرفة في ما يتعلق بالقضية السياسية يؤيده ويعكسه التراث.
نسلط الضوء كذلك على التراث لكن من زاوية أخري، وهي برأيي لم يتم تسليط الضوء عليها داخل الكتاب بشكل كاف، ولا شك أن في تحريرها والوقوف عليها جزءٌ من الحل، وهي المشابهة بين الكنيسة الكاثوليكية في حكمها بالحق الإلهي في عصور الظلام الأوروبي، وبين ما صدر من خلفاء الإسلام فى بواكيره، لبيان ما حدث في تاريخ المسيحية أيضا، حيث نجد في تاريخ الإسلام أبا بكر الصديق (50 ق.ھ- 13ھ) وهو خليفة المسلمين الأول يقول: أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم، ونجد عثمان بن عفان (47 ق.ھ- 35ھ) يصرح عند اشتداد الثورة عليه بالقول: أأخلع قميصا سربلني الله؟ ونجد أن أحد خلفاء الدولة الأموية يصرح قائلا: أنا خازن من خُزّان الله تعالى أًعطي من أعطاه الله وأمنع من منعه الله، ولو كره الله أمرًا لغيره.
يقول القاضي عبد الجبار (359-415ھ) في سياق التزاوج بين السلطتين الروحية والزمانية في بدء الدولة الإسلامية- تحديدا في الدولة الأموية- قائلا: إن: (أول من قال بالجبر وأظهره معاويه، وأنه أظهر أن ما يأتيه بقضاء الله، ومن خلقه ليجعله عذرا في ما يأتيه، ويوهم أنه مصيب فيه، وأن الله جعله إماما وولاه الأمر. وفشا ذلك في ملوك بني أمية).[17]
إن تاريخ الأديان فى تنامي أحداثه واحد ومتشابه، لكن يبدو أن أوروبا قد وعت درس التاريخ، لكن لم يستفد المسلمون من أخطاؤهم التاريخية، ولا تزال داعش الإرهابية تنشد عودة الخلافة الإسلامية على الرغم من أن الشهرستاني صرح بمخاطرها قائلا: (وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سلّ سيف في الإسلام علي قاعدة دينية مثلما سلّ علي الإمامة في كل زمان)[18]، بل لا يزال حكمها داخل التراث الإسلامي يتأرجح بين كونها واجبة بالشرع، وبين أن تكون قضية فقهية كما صرح أبو حامد الغزالي (450-505ھ) في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد[19]، ومنصوص عليها كما صرح الأشعري[20].
خاتمة:
ننوه في نهاية هذا المقال إلى أنه ينبغي مواصلة القراءات لكتاب الشيخ على عبد الرزاق، بالنظر والتحليل، كونه واحد من أهم المحاولات نحو بلورة رؤية جديدة يمكن الانطلاق منها نحو تأسيس واقع سياسي أفضل، ورؤية اجتماعية يمكن أن تتوافق عليها كافة التيارات السياسية والفكرية، ولا شك أن مثل تلك الرؤي الجديدة تُسهم في خلق فضاء جديد خال من براثن الجهل والتطرف الذي استفحل في بلداننا، كما ننوه أن مثل تلك المحاولات يجب أن ترعاها مؤسساتنا الدينية داخل عالمنا العربي، كنوع من نقد الذات في إطار من حرية الفكر والإبداع.
ولا يفوتني أن أتقدم بأسمى معاني الشكر والتقدير إلي معهد الآباء الدومنيكان بالقاهرة للسماح لي ولكثير من الباحثين بحضور هذا اليوم الدراسي، لأخذه كذلك زمام المبادرة بإحيائه الذكرى المئوية لصدور هذا الكتاب، فهو لا شك أحد أعمدة ومؤسسات الفكر والتنوير في العالم.
المصادر والمراجع:
1- محمد رضا عبد الصادق محمد: عضو هيئة تدريس بشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية- كلية اللغات والترجمة- جامعة الأزهر، وباحث سابق بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف.
2- أصدرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف مذكرة تأديبية ضد كتاب الشيخ على عبد الرازق بمقتضى المادة الأولى بعد المائة من قانون الجامع الأزهر والمعاهد الدينية العلمية الإسلامية رقم 10 لسنة 1911 في دار الإدراة العامة للمعاهد الدينية يوم الأربعاء 22 من المحرم سنة 1344ھ (12 أغسطس سنة 1925) برئاسة الأستاذ الأكبر الشيخ محمد أبي الفضل شيخ الجامع الأزهر وحضور أربعة وعشرين عالما من هيئة كبار العلماء، وقد صدر رد هيئة كبار العلماء علي كتاب «الإسلام وأصول الحكم» كهدية مع مجلة الأزهر بتاريخ ربيع الأول 1414ھ، وتقديم الأستاذ الدكتور السيد تقي الدين.
3- عبد الرازق، على، الإسلام وأصول الحكم، تقديم: د. جابر عصفور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مكتبة الأسرة، 1996، ص98 أكد الشيخ على عبد الرزاق هذا المعنى في ص 89 من الكتاب قائلا: (لم يبق أمامك بعد الذي سبق إلا مذهب واحد، وعسى أن تجده منهجا واضحا، لا تخشى فيه عثرات، ولا تلقى عقبات، ولا تضل بك شعابه، ولا يغمرك ترابه، مأمون الغوائل، خاليا من المشاكل. ذلك هو القول بأن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان إلا رسولا إلا لدعوة دينية خالصة للدين، لا تشوبها نزعة الملك، ولا دعوة لدولة، وأنه لم يكن للنبي صل يالله عليه وسلم ملك ولا حكومة، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم بتأسيس مملكة، بالمعنى الذي يفهم سياسة من هذه الكلمة ومردافتها. ما كان إلا رسولا كإخوانه الخاليين من الرسل، وما كان ملكا ولا مؤسسا لدولة، ولا داعيا إلي ملك).
4- Avon, Dominique, Islam et pensée critique en contexte arabe, explorations et obstacles au ХХ ème siècle, 2024
Lien de l’article: https://shs.cairn.info/revue-recherches-de-science-religieuse-2024-4-page-9?lang=fr&tab=premieres-lignes
5- ابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد، الفصل في الملل والأهواء والنحل، تحقيق: سيد سيد أحمد، المكتبة التوفيقية 2003، الجزء الثاني، ص293، انظر أيضا: الأشعري، أبو الحسن علي بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، تقديم وتحقيق الدكتور نواف الجراح، دار صادر بيروت، الطبعة الأولى 2006، ص137
6- النشار، على سامي، نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام، دار المعارف، الطبعة التاسعة 1994، الجزء الثاني، ص194
7- تجدر الإشارة إلى أن هناك من المستشرقين من أطلق لفظة "رئيس الدولة" أو "رجل الدولة" علي النبى محمد صلى الله عليه وسلم وهو المفكر النمساوي جوستاف أ. فون جرونيباوم في كتابه (حضارة الإسلام): يقول: (وكان مركز محمد كرئيس للدولة واشتغاله بالتشريع والإدارة مما أدى بطبيعة الحال إلي تغيير موضوعات ما ينزل عليه من وحي تغييرا بعيد المدي. فذويت عنه قوة شاعريته على مر السنين، وتحول الخائل صاحب الرؤي إلي واعظ، وأصبح النبي لا هوتيا، وصار من كاد يكون رسولا ساذجا لطائفة معينة مشرعا لمجتمع لم يبق بينه وبين الأهمية الدولية إلا خطوة قصيرة. لقد تغيرت تبعاته وتغيرت كذلك طرائقه. فأصبح ربه لا يغفر إلا للمؤمنين: كما أن ما يحتمه دينه من الأصول الاخلاقية أصبح لا يطبق إلا داخل مجتمعه. ولكي يصان الإسلام وتحفظ العقيدة، صارت كل وسيلة -مهما كانت- مشروعة لا غبار عليها): فون جرونيباوم، جوستاف، حضارة الإسلام، نقله إلي العربية: أ. عبد العزيز توفيق جاويد، راجعه: أ. عبد الحميد العبادي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 2014، ص107
8- الهمذانى، عبد الجبار بن أحمد، شرح الأصول الخمسة، تعليق الإمام أحمد بن الحسن بن ابى هاشم، حققه وقدم له د /عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبه، الطبعة الثانية 2010م، ص553
9- الشهرستانى، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، تحقيق أبى محمد محمد بن فريد، المكتبة التوفيقية 2003م، ص71، 72
10- الأشعري، أبو الحسن على بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين، سابق، ص 40، ص52، ص73، ص86، ص89، ص90، ص91، ص92، ص157، 158، 159. انظر أيضا رأي أهل السنة والجماعة في -الإيمان- من كتاب «الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم» لعبد القاهر البغدادي، تحقيق: محمد فتحي النادي، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى 2010، ص382
11- الأشعري، أبو الحسن على بن إسماعيل، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، سابق، ص88 و ص90.
12- ننوه فقط إلى أن هناك من أنكر النبوة في تاريخ الإسلام في العصور الأولي من أمثال ابن الراوندي (827-911م)، أبو بكر الرازي الطبيب (865-925م) وبشار بن برد (714-784م)؛ وذلك على غرار مذهب (الربوبيون Déisme) الذي ظهر في أوروبا في القرن السابع عشر، ولعل من أشهر من مثل هذا التيار الفيسلوف الفرنسي فولتير (1649- 1787م).
13- الفارابي، أبو نصر محمد، آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها، دار التقوى للطباعة والنشر والتوزيع، 2018، ص ص69، 70
14- (الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ عنهم الأصم)، الماوردي، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، تحقيق: عماد زكي البارودي، المكتبة التوفيقية، ص15، كما ذكر البغدادي قائلا إن: (الإمامة فرض واجب علي الأمة). البغدادى، أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن محمد، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم، تحقيق: محمد فتحي النادي، دار السلام، الطبعة الأولي 2010، ص380
15- الماوردى، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الأحكام السلطانية والولايات الدينية، سابق، ص46، انظر أيضا: حاشية الإمام البيجوري علي جوهرة التوحيد، حققه وعلق عليه وشرح غريب ألفاظه الأستاذ الدكتور علي جمعه محمد الشافعي، دار السلام للطبعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولي 2002، ص 325
16- حاشية الإمام البيجورى علي جوهرة التوحيد، سابق، ص 325
17- الهمذاني، عبد الجبار بن أحمد، المغني فى أبواب التوحيد والعدل، طبعة القاهرة، مجلد 8، ص4
18- الشهرستانى، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، سابق، ص37
19- يقول الغزالى: (اعلم: أن النظر في الإمامة أيضا ليس من المهمات، وليس أيضا من فن المعقولات بل من الفقهيات، ثم إنها مثار للتعصبات، والمعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض فيها وإن أصاب، فكيف إذا أخطأ؟ !): الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد بن محمد، الاقتصاد في الاعتقاد، عني به أنس محمد عدنان الشرقاوي، دار المنهاج، الطبعة الثانية 2012، ص290
20- يصرح الإمام أبو الحسن الأشعري في مؤلفه الموسوم اللمع في الرد علي أهل الأهواء والبدع قائلا: وقد نطق القرآن بإمامة الصديق ودل علي إمامة الفاروق، وذلك أن الله تعالي قال في سورة (براءة) للقاعدين عن نصرة نبيه صلي الله عليه وسلم والمتخلفين عن الجهاد معه: { فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ۖ إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ} [التوبة: 83]، وقال في سورة أخري: { سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ} [الفتح: 15]: الأشعرى، أبو الحسن على ابن اسماعيل، كتاب اللمع في الرد علي أهل الزيغ والبدع، صححه وقدم له وعلق عليه الدكتور حمودة غرابه،2015، ص116