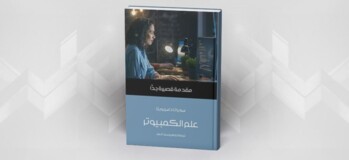الجذور المعرفية والفلسفية لفلسفة العقل
فئة : أبحاث محكمة
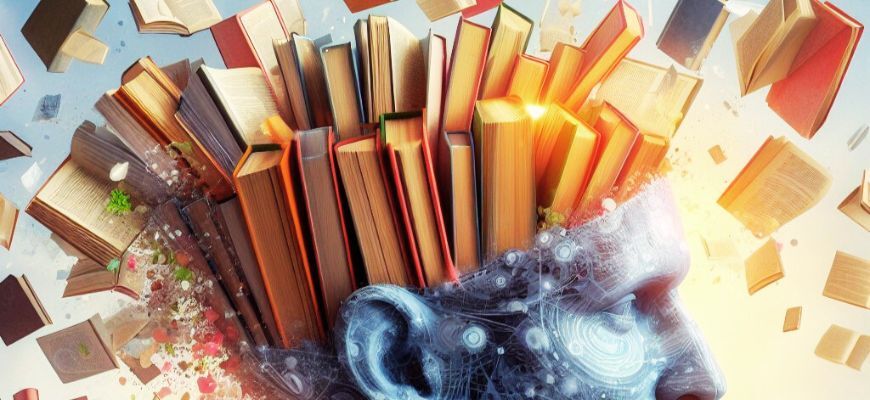
الجذور المعرفية والفلسفية لفلسفة العقل
ملخص البحث:
يروم هذا البحث في جوهره النفاذ إلى الجذور المعرفية والفلسفية لفلسفة العقل؛ وذلك من خلال رصد فحوى دلالة العلوم المعرفية كمبحث فلسفي حديث النشأة، ومدخلا أساسيًّا لفهم السياق العام لفلسفة العقل، عبر النفاذ إلى جذوره التاريخية، وتسليط الضوء على فلسفة العقل كفرع من فروعها. في هذا الخصوص، سنشير إلى مؤلف "مفهوم العقل" ل غلبرت رايل تحديدا كمحاولة للتخلص مما أسماه "الشبح في الآلة"، ناهيك عن التحديد اللغوي والفلسفي لمفهوم العقل بوصفه مفهوما مركزيًّا في فلسفة العقل التي لا يستقيم الحديث عنها بمعزل عن تحديد ماهيته لغويًا وفلسفيًّا، والتطرق أيضا إلى بعض القضايا الشائكة في فلسفة العقل كمشكلة القصدية Intentionality لدى جون سيرل تحديدًا، إلى جانب مسألة الذكاء الصناعي وما قدّمه كلّ من دانيال كوهين ومشيو كاكو بهذا الصدد، على اعتبار الوعي والقصدية من أبرز السمات التي تميّز الإنسان عن الآلة، فضلا عن مسألة الهوية الشخصية التي لا يمكن غض الطرف عنها في إطار الحديث عن فلسفة العقل، ومقاربتها في ظلّ الثورة الرقمية والتقدم الذي بلغه الذكاء الصناعي على وجه الخصوص، وفي الأخير ألقينا أضواءً شارحة على الصلة الوثيقة التي تربط فلسفة العقل بفروع الفلسفة وسائر العلوم الأخرى.
مقدمة
تمثّل فلسفة العقل الإطار النظري الذي يحلّل مفاهيم العقل والوعي، وهي محاولة جادّة للكشف عن آليات التفكير، وسعي إلى فهم العقل البشري وطبيعة اشتغاله، بالإضافة إلى الطرائق التي يتعامل بها وبواسطتها مع المعرفة. فلسفة العقل لا تكتفي بتقديم الإجابات الجاهزة، بل تثير بدورها أسئلة موجّهة للبحث العلمي، وتُعين على تطوير نماذج معرفية أكثر دقة وعمقا، حيث تلعب دورًا حاسمًا في العلوم المعرفية، وتكمن بينهما صلة وثيقة وعلاقة تكاملية تشي بنوع من الترابط والانسجام، وبهذا حقّ القول إنه في ظلّ التطوّرات المتسارعة والمتضاربة أحيانا لفهم الذكاء الطبيعي من جهة والذكاء الصناعي من جهة ثانية، في زمن لم يعد فيه التمييز بين أداء الإنسان وأداء الآلة أمرًا يسيرًا، أضحت العلوم المعرفية أحد المباحث الملحّة خلال الآونة الأخيرة؛ ففهم الوعي الإنساني لا يمكن تحقيقه إلاّ بالعودة إلى فلسفة العقل كفرع من فروع العلوم المعرفية، التي تهدف إلى فهم العمليات العقلية والذهنية لدى الإنسان، وترمي إلى الوقوف عند محدودية بعض المواقف التي تصوّر العقل حاسوبًا والآلة مفكّرة، فهي من شأنها أن تفكّر لكن لا يمكنها أن تشعر إطلاقا، ولا ننسى الدور الحيوي الذي اضطلعت به فلسفة العقل في العلوم المعرفية من خلال تزويدها بعُدَّة مفاهيمية، وأسئلة جوهرية وإجابات دقيقة وشاملة تُرضي الفضول المعرفي. ومن هذا المنطلق، فإن الأسئلة التي تطرح نفسها في هذا المضمار يمكن التعبير عنها بالآتي:
ما هي العلوم المعرفية؟ ما معنى فلسفة العقل؟ وما هي الجذور المعرفية والفلسفية لفلسفة العقل؟
تعدّ العلوم المعرفية مبحثا فلسفيًّا معاصرًا، تسعى إلى فهم العقل البشري بوصفه نظامًا معقّدًا وهي محاولة للكشف عن آليات التفكير، كما تهدف إلى سبر أغوار العقل بوصفه قوة جوهرية تُمكّننا من تفسير العالم والتفاعل معه، وتمثّل بدورها جذعًا مشتركًا لفروع معرفية عدّة تتقاطع فيما بينها، لعلّ أبرزها وأهمها فلسفة العقل والذكاء الصناعي[1]، إلى جانب فلسفة اللغة وعلم النفس والمنطق، علم الأحياء العصبي، اللسانيات، السيميائيات، فلسفة الجسد، علوم الأعصاب[2] ...وهي حقول معرفية بمثابة خيوط ناظمة نظرًا إلى تداخل اهتماماتها وتشابك قضاياها ورهاناتها وتقاطع إشكالاتها ومطارحاتها التي يثيرها التداخل المعقّد والخصب فيما بينها والمستفزّ للعقل الفلسفي المعاصر وحثّه على الدراسة والتحليل[3]. العلوم المعرفية هي علوم موضوعها المعرفة، وتهدف إلى الإجابة عن سؤال جوهري يجد أساسه فيما يمكن التعبير عنه بما يلي: كيف تتم عملية التفكير؟ أو كيف نفكّر؟ حيث تتوسّل بالمنهج العلمي لمقاربة الذهن وترمي إلى فهم كيفية اشتغال العقل البشري والإلمام بجلّ العمليات العقلية والمعرفية كالإدراك والوعي والتذكّر والتمثّل وغيرها. وتجدر الإشارة إلى أن العلوم المعرفية ظهرت خلال نهاية الخمسينيات من القرن الماضي[4]، تحديدًا خلال 11 شتنبر 1956، حيث انعقدت فيه ندوة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT [5]، وهي ندوة جمعت لأول مرة نخبة من الباحثين المعرفيين في اللغويات وعلوم الأعصاب وعلم النفس، يوحّدهم هدف مشترك هو دراسة العقل البشري. علاوة على ذلك، تعمل العلوم المعرفية على وصف القدرات والكفاءات الذهنية للإنسان والعمل على تنميتها، والمتمثلة أساسًا في التفكير والإدراك إلى جانب اللغة والوعي والانفعال، بوصفها منظومة فكرية وعلمية شاملة وواسعة نظرًا إلى تعدّد مشاربها واهتماماتها، وبالرغم من كونه مبحثا يبدو حديث العهد، إلاّ أنه كان محط العناية الفلسفية منذ عهد الإصباح الفلسفي. وثمة ماض حافل بالعطاء[6] وإرهاصات أولى لهذا المبحث كتقليد متجذّر في التاريخ الفلسفي، يتعلّق الأمر بالتأملات المبكّرة حول العقل البشري وكيفية اشتغاله منذ عهد الإغريق القديم[7]، ولقد برز مع آلان تورينغ[8] ولا يزال إلى اليوم، في طور التأسيس والبلورة، ولا أحد يجادل في كون العلوم المعرفية هي علوم تُعنى بإشكالية المعرفة وسيلتها العقل/ الدماغ والنحو الذي يشتغل به العقل البشري، وكيفية التحام العقل بالدماغ كإشكالية تهدف العلوم المعرفية إلى حلّها.
خلال أواسط الثلاثينيات ونهاية الأربعينيات من القرن الماضي، صدر مقالان للعالم الإنجليزي آلان تورينغ سيؤطّران رمزيًّا الفترة قبل التاريخية لظهور العلوم المعرفية، وخلال سنة 1936 سيضع الأسس الرياضية لما سيصبح عليه الحاسوب الإلكتروني خلال العقد الموالي، وفي عام 1950 أعاد صياغة المشروع القديم للآلة الذكية[9] [10]، بيد أن السبرنيطيقا هي التي ستوفر ابتداء من 1943 العناصر الضرورية لتحقيق المشروع الضخم للتفسير المادي والتقييس الذهني كمرجعين أساسيين للعلوم المعرفية، ويتعلق الأمر بالتفكير المتوازي في كل من الدماغ والذهن والآلة، ومن ثم تمّ الإقرار بنوع من التساوي بين الذهن والآلة، وهو ما يجسّد المرحلة الأولى للسبرنيطيقا التي تمثل حصيلة عمل جماعي لم يحظ فيه نربرت واينر بالدّور الريادي، علمًا أن هذا الأخير هو واضع مصطلح السبرنيطيقا، بل سيحظى المفكّر وارين مك كولوش بالدّور الرئيس بدله، حيث ذاع صيته في الأوساط المعرفية، وكان له الحضور البارز والدّور الفعّال، غير أن هذا الزعم يخفي حقيقة مفادها أن السبرنيطيقا، بالرغم من حضورها البارز في الأوساط الغربية، كانت بالنسبة إليهم أمرًا يشوبه ضرب من الغموض والالتباس؛ أي إنها كانت غير واضحة المعالم [11]، الأمر الذي جعل منها عملية في طور التطور والمحاولة المستمرّة لإثبات وجودها من خلال عقد ثلة من اللقاءات العلمية والمحاضرات الدولية والندوات الفكرية والجدالات الواسعة والنقاشات الخصبة، وشكّلت ملتقى مجموعة متنوّعة وواسعة من النخب المثقفة من تخصصات متباينة[12]، تمحورت حول "آليات الوجود" 1946 نيويورك و"الآليات الدماغية في السلوك"[13]1948، وكان لهذه الندوات الدّور الفعّال في نشر السبرنيطيقا، فقد ظهرت ما بين 1945 و1948 الحواسيب الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بريطانيا العظمى، بالإضافة إلى علوم الأعصاب بفضل بعض الأعمال الجادّة التي يأتي في مقدّمتها كتاب "تنظيم السلوك" لعالم النفس دونالد هيب[14] الذي سلّم بأن السلوك الإنساني يتشكّل من خلال الربط العصبي الناتج عن الخبرة المتكررة، والتعلم هو نمو عصبي وظيفي داخل الدماغ.
وجليّ للعيان أن العلوم المعرفية أوروبية الأصل والمنشأ، كانت متجسّدة أساسًا في مدرسة الجشطالت السيكولوجية في ألمانيا، التي ستتخذ من الإدراك كعملية ذهنية وعقلية المرتكز الأساسي للمعرفية، إلا أن معظم مؤسسيها هاجروا إلى الولايات المتحدة الأمريكية فرارًا من النازية الألمانية، وقد ساهموا بدورهم في تطوير السبرنيطيقا وتأسيس علم النفس الاجتماعي[15]، كما أسس جون بياجيه ما يسمى ب "الإبستمولوجيا التكوينية"[16] في جنيف، وهي مدرسة للعلوم المعرفية، ناهيك عن تطور علوم الدماغ في العديد من الدول الأوروبية خلال النصف الأول من القرن العشرين، وهذا التقريب بين مختلف الحقول العلمية أدّى إلى ميلاد العلوم المعرفية[17]، وتحديدا بالعودة إلى الولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ يمكن الإقرار بأن السبرنيطيقا هي التي أدّت إلى ظهور العلوم المعرفية، وقد أسلفنا ذكر ما مفاده أن سنة 1956 تعدّ السنة الحاسمة لظهورها، فضلا عن ذلك شكّلت الحلقة الدراسية التي عقدت خلال السنة نفسها، والتي استمرّت لمدة شهرين متتاليين. وسيلعب الإطار المؤسس لميلاد الذكاء الصناعي[18] دورًا مهمًّا في هذا الصدد، ولا ريب في أن كلّ هذه المحاولات والجهود المضنية والأحداث التاريخية شكّلت بدورها المخاض العسير لولادة العلوم المعرفية Cognitive Science بعد عشرين سنة من العمل الدؤوب، ويظهر ذلك جليًّا من خلال تأسيس كلّ من برينر[19] وميلر[20] سنة 1960 مركز الدراسات المعرفية في هارفارد[21]، وفي سنة 1962 نشر روزنبلات Rosenblatt [22] مؤلَّف بعنوان مبادئ الديناميات العصبية[23] أكّد من خلاله أنّ العمليات العقلية واللغوية يمكن تفسيرها من خلال آليات عصبية تضاهي عمل الدماغ، واقترح نموذجا سمّاه البرسبترون perceptron كتصور جديد لمقاربة الذكاء الطبيعي من جهة، والذكاء الصناعي من جهة ثانية. وخلال السنة نفسها نشر لينيبرغ Lennberg مؤلَّفًا بعنوان الأسس البيولوجية للغة[24] والذي سيعلن عن ميلاد اللسانيات العصبية[25].
لقد عرَفت العلوم المعرفية تطورًا ملحوظًا عبر إنشاء برامج ومراكز متعدّدة التخصصات في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تقف عند هذا الحدّ، بل امتدّت لتشمل معظم الأمم العلمية، وفي عام 1970 ستحتضن ستّ جامعات كبرى[26] العلوم المعرفية وستدعّمها بعض المنظمات الأمريكية لتشجيعها على إنشاء مراكز تُعنى بالعلوم المعرفية ووحدات للبحث وبعض المسالك للتكوين، فضلا عن نشر الموسوعات والمؤلفات في ذات التخصص، وهي خطوة مهمة تعبّر عن إسهام مقدّر. وتجدر الإشارة إلى أنّ العلوم المعرفية خلال سنة 1975 كانت تقتصر على السيكولوجيا والذكاء الصناعي إلى جانب اللسانيات، وتغض الطرف في المقابل عن علوم الأعصاب، إلاّ أنه بعد مرور أربع سنوات؛ أي خلال سنة 1978 سيتمّ توسيع مدار حقل العلوم المعرفية، ليشمل علوم الأعصاب والفلسفة وعلم الاجتماع[27]، لا سيما أن الاقتراني هيأت بدورها المناخ المناسب لعودة علوم الأعصاب إلى الساحة العلمية، حيث تبلورت سنة 1980 مقاربة جديدة عُرفت باسم علوم الأعصاب المعرفية[28] وانضمّت إليها علوم الأعصاب الحاسوبية[29] سنة 1994. وبهذا، عُقد أول مؤتمر لجمعية علوم الأعصاب المعرفية، حيث استقبل آلاف المشاركين ممّا ساهم في انتشار العلوم المعرفية على نطاق واسع.
تثار أسئلة عدة نابعة من فضول معرفي حول ما يقبع خلف الناصية التي يراها الإنسان مرجعًا لأفكاره ووعيه، والسؤال الأهم هو: ما هو العقل؟ وأخرى شغلت الفلاسفة على مرّ العصور، فالعقل كان ولايزال محط استشكال فلسفي؛ فتارة يميل إلى الإيتيقا (الأخلاق) وتارة أخرى إلى الإبستمولوجيا، ففي هذا السياق برزت فلسفة العقل التي تتحدّد بالاجتهادات التي جاد بها الفلاسفة الأنجلوسكسونيون، وتعود إرهاصاتها الأولى إلى اللحظة التي نُشر فيها مؤلّف "بحوث فلسفية" للوديفيج فتجنشتاين و"مفهوم العقل" لغلبرت رايل الذي لا يقلّ أهمية عن الأول، وهي محاولة للإجابة عن أسئلة تحوم في فلك العقل البشري وطبيعة اشتغاله ومحاولة ادراك كنهه. فالعقل يعدّ ملكة إنسانية وواحدة من أعقد القضايا التي أرّقت الأذهان، وعكف الفكر الإنساني على تأملها منذ عهد الإصباح الفلسفي؛ إذ لا يعدو أن يكون الإنسان سوى كائنا عاقلا، والعقل سمة إنسانية تميّزه عن سائر الموجودات، بيد أن التطوّرات التي شهدها العالم خلال القرن الماضي جعلت من كون الإنسان كائنا متفرّدا بعقله ووعيه أمرًا مشكوكًا فيه. إنّه عصر أعاد النظر في مفهوم الإنسان وماهيته، الأمر الذي ألقى بالفلاسفة والعلماء في معترك أسئلة جوهرية تفرض نفسها بقوة داخل الساحة الفكرية والعلمية، وهي دعوة صريحة لإعادة النظر في كلّ ما يبدو للعين وللعقل أمرًا بديهيا، وبهذا يمكن القول إن فلسفة العقل تساهم بدورها في تطور العلوم المعرفية كمرجع لا غنى عنه نظرًا إلى حيويتها كونها تثير أسئلة موجِّهة للبحث العلمي والمضي بالعلوم المعرفية قُدما؛ إذ ثمة علاقة وثيقة تشي بنوع من التكامل بين فلسفة العقل والعلوم المعرفية، وهو ما يعبّر عنه جون هيل[30] بما فحواه "وكثير من فلاسفة العقل يرون أنفسهم علماء معرفيين إدراكيين Cognitive Scientists"[31]، ويُستشفّ من قوله أنّ فلسفة العقل تشكّل فرعًا معرفيًّا من فروع العلوم المعرفية، تهتمّ بطبيعة العقل والوعي الإنساني، وتهدف إلى فهم العمليات العقلية في مجملها.
يُصنّف مؤلف "مفهوم العقل "[32] للفيلسوف غلبرت رايل Gilbret Ryle [33] كأبرز المؤلفات التي حاولت تسليط الضوء على المنزلة التي تتنزّلها فلسفة العقل داخل الأوساط الغربية، وهو مؤلف قدّم من خلاله نقدًا لاذعًا للثنائية الديكارتية الجسد/العقل أو الروح وللإرث العقلاني الديكارتي برمّته القائل إن العقل والجسد جوهران منفصلان، وهو مؤلف يعدّ من كلاسيكيات فلسفة القرن العشرين، وصفه رايل بما مضمونه "عمل تحليلي متواصل Sustained Piece of analytical hatchet work" حول الثنائية الديكارتية، كمحاولة جديرة ومثيرة للجدل للتخلّص مما أسماه "الشبح في الآلة" القائلة إن الجسد والعقل كيانان منفصلان، مؤكّدًا أن النظريات المادية أو الوظيفية الحديثة لا تحلّ اللغز الديكارتي، بل أكثر من ذلك تقبل بعض افتراضاته الأساسية الخاطئة، وتمخّض عن ذلك مشكلات عدّة منها "السببية العقلية" و"العقول الأخرى" "Mental Causation And Ather Minds"، إلى جانب الإرادة والعاطفة، معرفة الذات، الإحساس، الملاحظة، الخيال، العقل وغيرها من العمليات. ومن ثَم يعدّ "مفهوم العقل" عملا فلسفيًّا مميّزًا، عرض من خلاله رايل دراسة معمّقة حول طبيعة العقل والسلوك البشريين، ويُعتقد أنّ رايل قد أنجز مهمتين رئيستين من خلال كتابه هذا:
- أولا، نُظر إليه على أنه وضع المسمار الأخير في نعش الثنائية الديكارتية؛
- ثانيا، يُعتقد أنه جادل لصالح المذهب المعروف باسم السلوكية الفلسفية وأحيانا التحليلية، حيث اقترحه كبديل للثنائية مصرّحا بأن الوظيفية مقبولة إلى حدّ ما في فلسفة العقل وتكتسب جاذبيتها من خلال ظهورها كأفضل تعبير فلسفي عن الافتراضات الأساسية في العلوم المعرفية، ويُعتقد أنها أنقذت واقع العمل من النزاعات الإقصائية أو الخيالية للسلوكية، معتبرًا بذلك أن العقل يرتبط ارتباطا وثيقًا بالمخرجات أو الاستجابة السلوكية[34]، مردّ ذلك أنّ رايل يرى أن العقل ليس شبحًا في آلة؛ أي إنه ليس كيانًا منفصلًا يدير الجسد. ومن ثم، فالعقل ليس جوهرًا خاصًّا بقدر ما هو عبارة عن نماذج من السلوك الإنساني، بالتالي جلّ العمليات العقلية يمكن ترجمتها حسب المعبّر الحقيقي عن السلوكية النفسية إلى مجرّد استعدادات للسلوك، متوسّلا للبرهنة على ذلك بمنهج التحليل المنطقي، وخلُص في الأخير إلى أن مشكلة العقل والجسد كما صوّرتها الثنائية الديكارتية ليست سوى مشكلة زائفة.
ارتبطت الظواهر العقلية والنفسية منذ القدم بالطابع الخرافي والأسطوري، ومع ظهور الفلسفة أضحت ضربًا من البحث الفلسفي، وبعدها جزءا من البحث العلمي، وبتأصيل النظر في مسألة العقل نجد أنها قضية تعود إلى أزمنة غابرة:
العقل لغة:
جاء في "لسان العرب" لابن منظور و"تهذيب اللغة" للأزهري، و"أدب الدنيا والدين" للماوردي ما يلي[35]:
العقل: الحجر والنهى ضد الحمق والجمع عقول، وسمي العقل عقلا؛ لأنه يعقل صاحبه عن التورّط في المهالك أي يحبسه.
ورجل عاقل: هو الجامع لأمره ورأيه، مأخوذ من عقلت البعير، إذا جمعت قوائمه، وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردّها عن هواها، أخذ من قولهم قد اعتقل لسانه، إذا حبس ومنع الكلام والمعقول: ما تعقله بقلبك.
والعقل: التثبت في الأمور والعقل: القلب، والقلب العقل وقيل العقل هو التمييز الذي به يتميّز الإنسان من سائر الحيوان: ويقال لفلان قلب عقول ولسان سؤول، وقلب الشيء يعقله، فهمه.
والعقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى ويقول الله تعالى في كتابه العزيز [<< وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلاّ العالمون >> سورة العنكبوت الآية 43 ].
العقل فلسفيا:
ورد في معجم لالاند الفلسفي[36]:
العقل (ملكة، سبب، علّة) Raison، ويجادل المرء في أقدم معنى لكلمة عقل ration وقيل أنه ورد بمعنى ظنّ، اعتقد، فكر ويبدو أنه كان دالًّا قبل العصر المأثور على حساب وعلاقة بنحو خاص، ويقال العقل تارة على الملكة العقلية أساسا القادرة على تنظيم الاختبارات أو الأدلة، وإقامة براهينه، ويقال تارة على ملكة تقرير المطلق ومعرفة الكون كما هو وأسره إذا جاز القول، وتقديم الأسس وبلوغ الحقائق الضرورية والكافية للفكر وللحياة، في المعنى الأول يكون العقل مجرّد أداة (أداة كلية)، كان يقول ديكارت لخدمة ولمساعدة أو محاكاة إنجاز ملكةٍ حدسية أرفع، وفي المعنى الثاني يؤدي الدّور الأول، فهو يدّعي بصراحة نسبية أنه يعزو قيمة واقعية إلى عمل الفكر النّظري ويرمّم الواقع بواسطة أجزاء مصطنعة من التحليل (م. بلوندل).
ألا يمكن تبسيط مختلف تعريفات العقل، بوصفه "ملكة" وتجميعها حول فكرة مركزية أكثر؟ قد يكون العقل هو منشط الفكر بالذات، منظورا إليه من زاوية جوهره، أو بكلام أفضل هو ما يوجّه هذا المنشط نحو تحققه وكماله، وقد يكون ثمة مجال للتفريق بين وظيفتين للعقل، وطالما أن هناك تجلّيين لنشاط الفكر: في مجال النظر العقلي تنسيق المعرفة وتنظيمها، في المجال العلمي تنظيم السلوك. (أ. لاندري).
يُعرّف العقل إما بوصفه ملكة، أو بوصفه موضوع معرفة، والعقل بوصفه ملكة بهذا المعنى يكاد يكون العقل معتبرًا كأنه خاص بالإنسان، وهو ملكة الحس السليم لدى ديكارت [37].
يتأرجح مفهوم فلسفة العقل بين معنيين أو بالأحرى بين زاويتين؛ الأولى إبستمولوجية أي بمعناه المعرفي ويراد بها الكيفية التي يعرف بها العقل وطبيعة الأشياء التي يعرفها وماهيتها وحدودها، والثانية أنطولوجية؛ أي بمعناه الوجودي تتناول طبيعة وجود العقل وموقعه ضمن الموجودات الأخرى، إلى جانب العلاقة بين العقل والجسد. ومن أهم الأنشطة العقلية، نجد مشكلة الوعي والقصدية، وفلسفة العقل كمبحث فلسفي يُصرف فيه النظر في سؤال ما الوعي؟ وما القصدية؟ والراجح بين الفلاسفة هو أنّ فلسفة العقل تهتم بأنطولوجيا العقل.
وفي سياق حديثنا عن مشكلة القصدية باعتبارها من أهم المشكلات التي تناولتها فلسفة العقل، تجدر الإشارة إلى أن جون سيرل يَعدّ فلسفة اللغة فرعا من فروع فلسفة العقل، وقدّم بذلك دراسة معمّقة لفلسفة اللغة في كتابيه "أفعال الكلام" 1969 و"التعبير والمعنى" 1979، وكان الهدف الذي يصبو إليه من خلال هذين العملين هو التأكيد أن فلسفة اللغة لا تغدو أن تكون سوى فرعًا من فروع فلسفة العقل، مشيرًا بذلك إلى أن أفعال الكلام ليست إلا صورًا للفعل الإنساني وتجسّد العلاقة بين الذات والعالم الخارجي[38]. ولعلّ من أبرز الإشكالات التي تطرحها فلسفة العقل تلك المتعلّقة بعلاقة العقل بالمخّ، وتعد القصدية Intentionality في نظر سيرل الفكرة الجوهرية التي من شأنها أن تقدّم حلاّ لهذه العلاقة المعقّدة بين العقل والمخّ، ويعرّف القصدية بكونها ظاهرة بيولوجية طبيعية مثل كلّ الظواهر الطبيعية الأخرى تخضع للتحليل والملاحظة والسببية إلى آخر ما يميّز كل الظواهر الطبيعية الأخرى، ويصرّح بما مؤدّاه "فلسفة اللغة فرع من فلسفة العقل"[39] مؤكّدًا بذلك أن كلّ قدرة على التعبير أيّا كانت، فهي مستمدّة بشكل أو بآخر من قصدية العقل، فالقصدية تحيل على وعي الإنسان بالأشياء المحيطة به، وعلى قدرته على توجيه عقله، والتوجّه سمة جوهرية للقصدية التي تجسّد العلاقة بين الوعي (الذات) وما يتوجه إليه قصدًا (الموضوع)، ومن ثم فالحالات العقلية لديها وجود قصدي، والقصدية سمة أساسية للعقل، علاوة على ذلك يتّفق سيرل مع الآراء المعاصرة في فلسفة العقل التي تفيد بأن الناس لديهم حالات عقلية قصدية بطبيعتها، وهي حالات قد تكون واعية أو لا واعية، وما يعنيه بالقصدية هي صفة للحالات العقلية والحوادث التي يتمّ بها التوجّه إلى موضوعات العالم الخارجي وأحواله أو الإشارة إليها[40]. وبتدقيق النظر في مسألة القصدية، نجد أنها تجسّد التفاعل بين الإنسان والعالم الخارجي، بصفته كائنًا يملك القدرة على إعادة بناء تجربته الخاصة من خلال الاحتكاك بالعالم الخارجي، ومن ثمّ تعدّ القصدية خاصية إنسانية تميّزه عن الآلة، حتّى وإن كانت هذه الأخيرة تملك القدرة على معالجة المعلومات، إلاّ أنها لا تملك نيّة حقيقية للقيام بالمهام التي تُسند إليها، فهي لا تعدو أن تكون سوى نمذجة للسلوك الإنساني، دون أن تنطوي على أي وعي أو قصدية حقيقية؛ بمعنى أنها عملية تُجرى بشكل آلي خالص لا يرقى إلى مستوى الوعي أو القصدية التي يتمتع بها الإنسان.
حينما تعترضنا مسألة الذكاء الصناعي في إطار الحديث عن فلسفة العقل، نجد أن أول إشكالية تطرح نفسها في هذا المضمار هي تلك المتعلّقة بالآلة، وهو ما يمكن صياغته بسؤال يفيد: هل الآلة تفكّر؟ ومعلوم أن الآلة ما يميّزها عن الإنسان هو افتقارها للحس والشعور، وهو ما يعبّر عنه دانيال كوهين بما مضمونه "ليس للآلة جسد ولا مشاعر، كما أنها تفتقر للروح، فهي لا تملك المخيلة الإبداعية للبشر، وعلى نحو ما أوضحه مارك ميزارد تماما، فهي لا تستطيع تعميم معرفتها على مواقف مجهولة"[41] حيث إن ما يميّز الإنسان هو امتلاكه للجسد، فهو يفكّر بالعقل داخل الجسد كون الإنسان ليس عقلا فقط[42]، بل هو جسد وعقل ووجدان... فنجد على سبيل المثال أنطونيو داماسيو Antonio Damasio يؤكّد أن العاطفة هي السمة الأساسية التي تمنح الكائنات الحيّة إمكانية الفعل والتصرّف "في الجسد يتمّ نقش العواطف، والدوافع والذاكرة طويلة المدى وتتجسّد ذكرى والديّ أو أجدادي"[43] الأمر الذي جعل كوهين يقرّ بأن الآلة ليس لها جسد ولا مشاعر، غير أن ما يميّز الآلة عن الإنسان هو كونها تستطيع إجراء عمليات والقيام بمهام لا يمكن للبشر القيام بها أو إنجازها بالسرعة التي تنجزها الآلة، ويضرب مثالا على ذلك بقدرة الآلة على تقليب ملايين الصفحات في جزء من الثانية بحثا عن اقتباس، وكذلك مثال حالة لعبة الشطرنج أو لعبة "Go" يمكن للذكاء الصناعي أن يعلّمنا في غضون ساعات قليلة استكشاف ميادين من الاحتمالات التي تتجاوز قدرات أفضل اللاعبين في العالم [44]، ومن ثم فالآلة بإمكانها فعل ما يعجز الإنسان أحيانا عن فعله، ويطرح كوهين سؤالا غاية في الأهمية وهو ما عبّر عنه ب من أين يأتي الذكاء الاصطناعي الحديث؟ وفي معرض جوابه انطلق مما سمّاه "المنطق الشبيه بالشجرة" وهو منطق يعمل على تحديد الشجرة، انطلاقا من جميع التركيبات الممكنة "إذا لعبت A فإنه يمكنني حينئذ أن ألعب B أو C، وقبل أن ألعب A يجب أن أفهم معنى B وC، مما يؤدي إلى التفكير أيضا في Dو Eو Fو G والتي تصبح ممكنة بفضل B وC ويشير المتخصصون إلى هذا المشروع البحثي على أنه ذكاء اصطناعي قديم وجيّد Good old Fashioned"[45] وبفضل هذه القدرة المنطقية، فازت الآلة "ديب بلو" على بطل الشطرنج غاري كاسباروف، ويشير كوهين إلى أن الوقت الذي تستغرقه هذه الطريقة الشاقة جعل متخصّصي الذكاء الصناعي يعملون على بذل ما بوسعهم في محاولة لمحاكاة الطريقة التي يعمل بها الدماغ البشري، حيث تمّ ابتكار ما يطلق عليه بطريقة "التعلّم المتعمّق Deep Learning"[46] وهي طريقة مستوحاة من الشبكات العصبية بغية فهم عمليات التعلّم لدى البشر، ومن ثم الفوز في اللعبة والتفوق على الإنسان، بالإضافة إلى تفوّق الذكاء الصناعي الذي صممته شركة باريسية ناشئة تدعى NUKKAI على أفضل ثمانية لاعبي "البريدج" في العالم، في عام 2012 استخدم جيفري هنتون، وهو فزيائي كندي "التعلم المتعمّق" للفوز في مسابقة دولية في التعرف على صور القطط، أشار كوهين إلى أنه تم توظيفه بسرعة بواسطة غوغل في مشروع Google Brain[47]، وفي الأخير نجد يان لوكون يؤكد أن الآلات مهما كانت قوّتها لا تتمتع بفطرة سليمة ولا بوجدان[48] مفاد ذلك أن تفوّق الذكاء الصناعي لا يعني أن الإنسان لم يعد بحاجة إلى ذكائه، بل الذكاء الطبيعي مهما حدث يظلّ تجربة فريدة وسمة إنسانية جوهرية، وما الذكاء الصناعي سوى تجسيد لقدرة الإنسان على ابتكار ذكاء شبيه بالذكاء الطبيعي يُعينه على القيام بالمهام الصعبة.
ومن الملفت للنظر بهذا الصدد، أن تمويل الذكاء الصناعي وصل إلى مليار دولار خلال سنة 1985[49] [50]، وممّا يسترعي الانتباه أيضا تعليق بول إبراهام، وهو طالب بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT قائلا: "يبدو وكأن مجموعة من الناس اقترحت بناء برج يصل إلى القمر، في كل عام كانوا يشيرون بفخر إلى علو البرج عن العام السابق المشكلة الوحيدة هي أن القمر لم يقترب أكثر"[51] وهو تعليق جاء في ذات السياق نظرًا إلى التقدم الهائل الذي يشهده العالم على المستوى التكنولوجي، مما يشي بأن الذكاء الصناعي قد برز كقوة مؤثرة، وأضحى يتطور بوتيرة متسارعة متجها صوب القمّة لتحقيق إمكانياته الكاملة، كما يصرّح مشيو كاكو في كتابه "مستقبل العقل" بأنه ذات يوم سأل الدكتور منسكي متى ستعادل الآلات ذكاء البشر وحتى تتفوّق عليه؟ وكان جوابه يحيل على أنه واثق بأن هذا سيحدث في يوم من الأيام، لكنه لم يقدّم أي تنبؤات حول مواعيد حصول ذلك، ويقرّ بأن علينا أن نخطّط لمستقبل الذكاء الصناعي من دون وضع جدول زمني محدّد[52]، فضلا عن ذلك يشير مشيو كاكو إلى أنه من المشكلات التي تواجه الذكاء الصناعي هي تلك المرتبطة بكيفية التعرّف على النموذج والحس السليم، مما يحيل على أن الدماغ الإنسالي لا يمكنه إدراك ما يراه بنفس الكيفية التي يراها الإنسان، كما أن الإنسالي لا يفهم الحقائق البديهية حول العالم المادّي والبيولوجي[53]، وممّا لا شكّ فيه أن العلوم المعرفية تبتغي بالاستناد إلى الذكاء الصناعي نمذجة السلوك الإنساني ومن ثم محاكاته، وإجمالا يمكن الإقرار بأن الذكاء الطبيعي متفوق عن الذكاء الصناعي بالحدس كخاصية إنسانية.
تعدّ مسألة الهوية الشخصية من بين المسائل التي تطرّقت إليها فلسفة العقل، حيث إنه لمِن المؤكّد أن الإنسان يمرّ عبر مراحل حياته بثلة وسلسلة من التحوّلات، تسهم في إحداث تغيّرات جذرية على مستوى جسده وفكره، بيد أنه بالرغم من ذلك فهو يعي بأنه نفس الشخص فوراء هذا التغيّر والتبدّل يوجد عنصر يُبقي الشخص هو نفسه، وللشخص سمات لا يمكن أن يصيبها التلف أو التغيّر مهما بلغت به التحولات البيولوجية والفكرية، فالهوية الشخصية هي المحدّد الرئيس للشخص؛ إذ ثمة عنصر ثابت لا يتغيّر يحقق مطابقة الذات لذاتها، فديكارت يقرّ بأن الفكر خاصية إنسانية تميّزه وحده دون سواه، والفكر حسبه جوهر الذات وماهية وجوده، في المقابل نجد أن الجسد مجرّد معطى بيولوجي قابل للتغيّر والتحلّل باستمرار. إنه عرضة للتلاشي والفناء فالشيء الثابت في الشخص هو الفكر حسب ما أدلى به صاحب الكوجيطو "أنا أفكر، إذن أنا موجود"، معتبرا بذلك الهوية الشخصية معطى أصلي يتحقق قبل الوجود الفعلي للذات أي العقل نور فطري وبهذا فالهوية سابقة عن الوجود. "إن ما يجعل الفرد في وقت ما هو الشخص نفسه كفرد في وقت آخر ليس النفس أو الجسم، بل استمرارية الوعي التي تمكن الفرد في وقت لاحق من تذكر خبرات الفرد في وقت سابق"[54] مما يشير إلى أن فقدان الذاكرة على سبيل المثال، لا يعني بأن هذا الشخص قد فقَد هويته، بل ثمة دائما عنصر يبقيه هو هو أي نفس الشخص ألاَ وهو الهوية، وفي الوقت الذي يرى فيه العقلانيون أنّ المعرفة الكاملة يمكن بلوغها عن طريق العقل وحده، راح التجريبيون وعلى رأسهم جون لوك يدافعون عن الأطروحة القائلة إن العقل مجرّد صفحة بيضاء، ومن ثمّ المعرفة الإنسانية تجد أساسها في التجربة وحدها؛ أي في الإدراكات الحسية التي تأتي عن طريق الاحتكاك بالعالم الخارجي، ممّا يعني حسب هذا التصور رفض الأفكار الفطرية التي قال بها ديكارت، وبهذا ليس بمقدور الإنسان تجاوز حدود ما اكتسبه عن طريق الحواس، ونستنتج في الأخير أن أساس الهوية الشخصية يختلف من تيار لآخر، لكن بالعودة إلى الأنساق المنطقية التقليدية والكلاسيكية نجد أنها جميعا قائمة على أساس منطقي واحد ومشترك هو النسق الأرسطي، سواء صرّح أصحابها بذلك أم لم يصرّحوا، فهي أنساق تُسلّم بما سمّاه ارسطو بقوانين الفكر (قانون الهوية، قانون الثالث المرفوع، قانون عدم التناقض) بالتالي مشكلة الهوية الشخصية كمشكلة فلسفية بغض النظر عن الأساس الذي وضعه كلّ من العقلانيون والتجريبيون للهوية الشخصية، إلاّ أن كليهما أسّس نظريته على مفهوم الهوية المنطقي. ومن ثمّ، فإنّ الفلسفات الكلاسيكية حتىّ وإن كانت متعارضة فيما بينها، إلاّ أنها جميعا متطابقة من حيث الأساس المنطقي، ويظهر ذلك جليّا من خلال النفاذ إلى النظريات الفلسفية والنظر في أسسها المنطقية "قد يختلف الفيلسوفان في تحديد ما به تكون للشيء هويته وتعيين ما تحمل عليه هذه الهوية من موضوعات، ولكنهما يلينان معاً للأخذ بقانون الهوية المنطقي بلا منازعة. وقد ينفي الفيلسوف ما يشاء من أفكار غيره مفنّدا إيّاها بما يشاء من الأدلّة، وكذلك يفعل خصمه، ولكنّهما لا يفعلان ذلك بغير قانون النفي المنطقي"[55]، ومن الملاحظ في هذه النظريات الفلسفية عبر التطور التاريخي هو أنها جميعها سواء اتفقت أو اختلفت، كانت تهدف في مجملها إلى تحديد المحدّد الرئيس للهوية الشخصية، بيد أنه راهنا يتوجّب علينا أن نعكف على بحث عميق حول المحدّد الرئيس للهوية الإنسانية؛ لأنه قبل ظهور الذكاء الصناعي كان الأمر متعلقا فقط بالسمات الجوهرية للإنسان كالعقل الذي يميّزه عن باقي الكائنات، ولكن مع ظهور الذكاء الصناعي أضحى تفرّد الإنسان بالذكاء أمرا مشكوكا فيه، لدرجة لم يعد الإنسان نفسه قادرا على التمييز بين أداء الإنسان وأداء الآلة، بل أكثر من ذلك أصبح الذكاء الصناعي متفوّقا إلى حدّ رهيب عن الذكاء الطبيعي، وخير مثال على ذلك chatGPT وGemini، وكان لهذا التقدّم الصارخ والتطورات المهولة انعكاس سلبي على فهم الذات لذاتها وتحديد ماهية هويتها الشخصية "بالأمس، من خلال العمل على خط التجميع، أصبح الإنسان آلة، أما اليوم وبوجود الذكاء الاصطناعي، الآلة هي التي تصبح إنسانية"[56] ففي ظلّ الثورة الرقمية، أضحى السؤال الأكثر إلحاحا هو - ما الإنسان؟ وما أساس الهوية الشخصية؟ حيث حمل الإنسان منذ الأزل طموحا لا محدودا، ورغبة ملحّة في تحقيق التقدّم والكمال، وهو طموح دفعه إلى السعي الحثيث لتطوير تقنيات تمكنه من استنساخ قدراته العقلية، ممّا أدى إلى ظهور تقنيات جدّ متقدّمة في مجال الذكاء الصناعي تستوجب إعادة النظر في ماهية الإنسان.
منذ بزوغ الفجر الإنساني والفلسفي عكف الإنسان على تأمل ذاته ومحاولة فهم فحوى هذا التأمل والتفكّر، وكان للإنسان اهتمام جدير بالعقل بوصفه ملكة خلاّقة تعين الكائن البشري على إدراك وتحليل الوجود وطبيعته. ومن ثمّ شكّلت فلسفة العقل الدعامة الرئيسة للفلسفة المعاصرة، وجليّ للعيان أن فلسفة العقل ترتبط ارتباطاً وثيقا بفروع الفلسفة وسائر العلوم المعرفية وكافة العلوم الأخرى[57]، لا سيما وأن القضايا الشائكة في الفلسفة، نجدها حاضرة وبقوة في فلسفة العقل، خصوصا تلك المتعلّقة بنظرية المعرفة والميتافيزيقا وعلم الأخلاق وغيرها من الفروع الفلسفية والعلمية والمعرفية، إذ تتناول الميتافيزيقا[58] على سبيل المثال قضايا متعلقة أساسا بالهوية الإنسانية وطبيعة الوجود والموجودات، نجد أيضا فلسفة العقل تتناول بدورها طبيعة العقل وكيفية اشتغاله، حيث تتقاطع اهتمامات الميتافيزيقيين وفلاسفة العقل، ويعمل هؤلاء على دراسة طبيعة وأنواع الموجودات التي تملك عقولا، إلى جانب نظرية المعرفة[59] التي تشتغل على تحديد شروط المعرفة وحدودها وتتقاطع مع فلسفة العقل في تحديد وسائل اكتساب المعرفة فالإدراك والوعي والاستدلال والاستبطان وغيرها من العمليات العقلية هي وسائل يتوسل بها الإنسان لاكتساب المعرفة، زد على ذلك، فإن فلسفة العقل تتقاطع أيضا مع الأخلاق[60] حيث ترتبط القيم الأخلاقية بالوعي، مما يحيل على أن القيم الأخلاقية تستلزم وجود الوعي، فالكائنات الواعية لها قيم أخلاقية كونها كائنات تملك عقولا، وبهذا فإن فلسفة العقل تلعب دوراً مهمَّا وفعّالا في جميع المجالات وكافة الفروع الفلسفية والعلمية وكذا المعرفية، فهي تمكّن الإنسان من فهم طبيعة وجوده والتعرّف على الوسائل الإدراكية والعقلية التي يتمّ بها هذا الفهم، وتعد فلسفة حيوية قابلة للتفاعل مع مختلف الفروع والتخصصات خصوصا ما يتعلّق منها بالعلوم المعرفية.
خاتمة
إجمالا يمكن الخروج بخلاصة مفادها أن فلسفة العقل تعدّ تتويجا لمسيرة حافلة بتراكمات طويلة من الأسئلة الفلسفية والمعرفية حول طبيعة الوعي والعقل والإدراك، بدءًا من الجذور اليونانية التي وضعت بدورها اللبنات الأولى لفلسفة العقل، مرورا بالمرحلة الوسيطية والحديثة، وصولا إلى الجهود المعاصرة التي جاد بها فلاسفة وعلماء كبار كان لهم الإسهام البارز والدّور الفعّال، حيث ظلّ العقل مدار بحث وتساؤل فلسفي مستمر، بوصفه قضية جوهرية في التفكير الفلسفي عبر تاريخه الطويل، وتجدر الإشارة إلى أن فلسفة العقل تمثّل تقاطعا معقّدا بين ما هو معرفي وما هو فلسفي، وبين من ينظر إلى العقل كمجرّد آلة معرفية، ومن يراه كجوهر ميتافزيقي يتجاوز المعنى المادّي. بالجملة، فإن هذا البحث يرمي إلى بلورة مفاهيم متعدّدة، تتقاطع فيها المفاهيم الفلسفية مع التطبيقات العلمية المتقدمة في مجال التقنيات المتطورة مثل الذكاء الصناعي، فضلا عن كيفية تأثير هذه التطورات على فهم الذات لذاتها وماهية هويتها الشخصية، ومن ثمّ الغرض من هذه الدراسة هو الغوص في ثنايا فلسفة العقل عبر النفاذ إلى جذورها الفلسفية والمعرفية، التي مهّدت السّبل لتطورات علمية ومعرفية غير مسبوقة، ممّا يوحي بأن ادراك جذورها يعدّ بدوره انفتاحا وخطوة جديرة لفهم منزلة الإنسان في عالم تطبعه الوفرة في كلّ شيء، هذا الكائن الذي أضحى يوصف في ظل الثورة الرقمية بالإنسان الرقمي.
لائحة المصادر والمراجع
باللغة العربية
_ أندري لالاند "موسوعة لالاند الفلسفية" المجلد A G تعريب خليل أحمد خليل أستاذ في الجامعة اللبنانية، تعهّده وأشرف عليه حصرا أحمد عويدات، منشورات عويدات بيروت، باريس الطبعة الثانية 2001
_ جون سيرل "القصدية: بحث في فلسفة العقل" ترجمة أحمد الأنصاري، دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة العربية دار الكتاب العربي 2009
_ مشيو كاكو "مستقبل العقل: الإجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره وتقويته" ترجمة سعد الدين خرفان، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت أبريل 2017
_ جون هيل "مدخل معاصر إلى فلسفة العقل" ترجمة عادل مصطفى مؤسسة هنداوي 2017.
_ الغالي أحرشاو "العلوم المعرفية: من مخاض التعريف والتأسيس إلى رهان التطبيق والإستثمار" شعبة علم النفس كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المغرب 2018
_ دانيال كوهين "الإنسان الرقمي والحضارة القادمة" ترجمة علي يوسف أسعد عن صفحة سبعة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2022
_ محمد الشقيف "فلسفة التفكيك بين منطق الغموض واللامنطق" مؤمنون بلا حدود، مايو 2023
_ صلاح إسماعيل "مقدمة فلسفة العقل: تعريفها ومشكلاتها" مركز نماء للبحوث والدراسات، القاهرة أكتوبر 2024
باللغة الأجنبية:
_ Rosenblatt Frank "Principles of Neurodynamics. perceptrons and the theory of Brain Mechanisms" Wachington 1962
_ Andler. D "Introduction Aux Sciences Cognitives" Paris Gallimard 2004
_ Gilbert Ryle "The Concept of Mind" 60 Anniversary Edition. first published 1949 By Hutchinson. this Edition Published 2009
_ Michio Kaku "The Future of Mind. the scientific quest to understand Enhance and Empower the mind" Doubleday. N. Y 2014
_ M. Benasayag "La tyrannie Des Algorithmes" Paris Textuel 2019
[1] تعود جذوره إلى فكرة الآلة المفكرة التي صاغها آلان تورينغ، وكذا مؤسس السيبرنطيقا نوربرت واينر إلى جانب دونالد هيب وروزنبلات وشانون، وتعدّ سنة 1956 هي السنة الرسمية لميلاده.
[2] عادة ما يتم اعتبار هذه العلوم علوما تجريبية تشي بالصلة الوثيقة بين فلسفة العقل وعلوم تجريبية عديدة، وهو ما يصرّح به جون هيل في كتابه "Philosophy of Mind" (1998) مؤكّدا بذلك أن الأسئلة الفلسفية الأساسية في فلسفة العقل تظلّ أسئلة ميتافزيقية في جوهرها.
[3] الغالي أحرشاو "العلوم المعرفية: من مخاض التعريف والتأسيس إلى رهان التطبيق والاستثمار" شعبة علم النفس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، ظهر المهراز، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس المغرب 2018، (و هذه العلوم تشكّل رزمة من برامج البحث ذات التخصصات المتنوعة التي تحكمها ممارسات وفرضيات جوهرية، ومرجعيات نظرية ومنهجية مشتركة تنصهر كلها في إطار البراديغم المعرفي) ص 8
[4] وثمّة من يؤرخ لظهورها حسب ما ورد في المرجع السابق الغالي أحرشاو (2018) منذ أوائل الخمسينيات من القرن العشرين ص 9
[5] Massachusetts Institute of Technology
[6] الغالي أحرشاو (2018) "العلوم المعرفية: من مخاض التعريف والتأسيس إلى رهان التطبيق والاستثمار" ص 9. وهي الفكرة التي صرّح بها هووارد جاردنر Howard Gardner
[7] حضور إشكالية العقل لدى سقراط وأفلاطون وأرسطو قديما، وكذا لدى الفلاسفة المسلمين وسيطا وحديثا لدى ديكارت وكانط وغيرهم.
[8] صدر خلال أواسط الثلاثينيات ونهاية الأربعينيات من القرن العشرين مقالين للعالم الإنجليزي آلان تورينغ Alan Turing, سيؤطّران فترة ظهور العلوم المعرفية. حسب ما ورد في المرجع السابق ل الغالي أحرشاو (2018).
[9] Move The Imitation Game (2014) وهو فيلم إنجليزي يتناول قصة آلان تورينغ ومساهمته في فكّ شفرة آلة إنيغما خلال الحرب العالمية الثانية.
[10] يقصد بالآلة الذكية، آلة إنيغما Enigmaوهي جهاز تشفير ألماني استخدم خلال الحرب العالمية الثانية لتشفير الرسائل العسكرية وهي آلة معقّدة وذكية.
[11] الغالي أحرشاو (2018) "العلوم المعرفية: من مخاض التعريف والتأسيس إلى رهان التطبيق والاستثمار" ص 9
[12] ويأتي في مقدّمة هؤلاء Mc Culloch. Norbert Wiener. John Von Neumann. Arturo Rosenblueth. Julian Bigelow. Walter Pitts. Kurt Lewin. Margaret Mead. Leonard Savage. Roman Jakobson. Claude Shannon.
[13] الغالي أحرشاو (2018) ص 10
[14] Donald Hebb (1949) The Organization of Behavior. A Neuropsychological Theory. أي "تنظيم السلوك: نظرية في علم النفس العصبي".
[15] الغالي أحرشاو (2018) ص 10.
[16] الإبستمولوجيا التكوينية épistémologie génétique، وهي مشروع فكري صاغه جون بياجيه Jean Piaget وهو فيلسوف وعالم نفس سويسري، في جامعة جنيف وتهدف إلى دراسة نشأة وتطوّر المعرفة لدى الإنسان من خلال تتبع مراحل النمو العقلي والمعرفي لدى الطفل ومن ثم فهم الشروط التي تنتج المعرفة.
[17] Andler. D. (2004) Introduction aux Sciences Cognitives. Paris. Gallimard.
[18] الإطار العام الذي تمخّض عنه ميلاد الذكاء الصناعي هو الحلقة الدراسية التي استمرّت لمدّة ثمانية أسابيع خلال 1956 بمعهد دارتماوت Dartmouth College , حسب ما ورد في المرجع السابق الغالي أحرشاو (2018) ص 10
[19] Jorome Bruner وهو عالم نفس أمريكي ولد سنة 1915 وتوفي 2016، يعدّ من رواد علم النفس المعرفي.
[20] George Miller وهو عالم نفس أمريكي مؤسس علم النفس المعرفي ولد 1920 وتوفي 2012
[21] مركز الدراسات المعرفية في هارفارد Harvard Center for Cognitive Studies، ويعدّ من المراكز الرائدة في البحث العلمي بمجال العلوم المعرفية، تأسس في ظل الاهتمام بالعلوم المعرفية ويهدف إلى تعزيز التداخل بين تخصصاتها المختلفة.
[22] فرانك روزنبلات عالم نفس وعالم في الذكاء الصناعي والعلوم العصبية وهو من الأوائل الذين عملوا على الربط بين علم النفس وعلم الأعصاب والحوسبة.
[23] Rosenblatt Frank "Principles of Neurodynamics. perceptrons and the theory of brain mechanisms" wachington (1962)
[24] لينيبرغ Lenneberg وهو عالم لغوي وعصبي يعدّ من رواد علم اللغة العصبي Neurolinguistics من أشهر كتبه "Biological Foundations of Language" (1967).
[25] اللسانيات العصبية وتسمى أيضا علم اللغة العصبي وهي فرع من فروع اللسانيات تدرس العلاقة بين اللغة والدماغ أي دراسة الأسس البيولوجية والعصبية للغة البشرية.
[26] وأبرز هذه الجامعات MIT , Stanford , Californai , Minnesota.
[27] الغالي أحرشاو (2018) ص 10
[28] علوم الأعصاب المعرفية Cognitive Neuroscience وتدمج بدورها بين علوم الأعصاب والعلوم المعرفية لدراسة كيفية اشتغال الدماغ في عمليات التفكير، الذاكرة، الإدراك وغيرها، بمعنى أنها تعمل على دراسة الأسس العصبية للوظائف المعرفية.
[29] علوم الأعصاب الحاسوبية Computational Neuroscience وتهدف إلى بناء نماذج رياضية وحاسوبية تحاكي عمل الخلايا العصبية في الدماغ وفهم كيفية اشتغال الجهاز العصبي.
[30] John Heil (1998) Philosophy of Mind.
[31] جون هيل "مدخل معاصر إلى فلسفة العقل" ترجمة عادل مصطفى عن مؤسسة هنداوي عام 2017
[32] Gilbert Ryle "The Concept of Mind" 60 Anniversary Edition. first published 1949 by Hutchinson. this edition pulished 2009 by Routledge.
[33] غلبرت رايل (1976/1900) وهو محاضر في الفلسفة في كلية كنيسة المسيح بأكسفورد، وفي عام 1945 انتخب لرئاسة كرسي واينفليت Waynflet للفلسفة الميتافزيقية وهو المنصب الذي شغله إلى حين تقاعده عام 1968 , كما كان محرّرا لمجلة Mind لما يقرب من 25 سنة.
[34] Gilbert Ryle (2009)" The Concept of Mind". p 11
[35] صلاح إسماعيل "مقدمة "فلسفة العقل: تعريفها ومشكلاتها" مركز نماء للبحوث والدراسات، القاهرة أكتوبر 2024. ص 18.
[36] أندريه لالاند "موسوعة لالاند الفلسفية" المجلّد A: G تعريب خليل أحمد خليل أستاذ في الجامعة اللبنانية، تعهّده وأشرف عليه حصرا أحمد عويدات، منشورات عويدات بيروت، باريس الطبعة الثانية 2001.
[37] نفسه أندري لالاند (2001) ص 1159/ 1160
[38] جون سيرل "القصدية: بحث في فلسفة العقل" ترجمة أحمد الأنصاري، دار الكتاب العربي بيروت، لبنان، الطبعة العربية دار الكتاب العربي 2009 ص 10
[39] نفسه جون سيرل (2009) ص 17
[40] نفسه جون سيرل (2009) ص 21
[41] دانيال كوهين "الإنسان الرقمي والحضارة القادمة" ترجمة علي يوسف أسعد، عن صفحة سبعة للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2022 ص 39
[42] نفسه دانيال كوهين (2022) ص 31
[43] M. Benasayag. la tyrannie Des Algorithmes. Paris. Textuel 2019
[44] دانيال كوهين (2022) ص 39
[45] نفسه دانيال كوهين (2022) ص 42
[46] التعلّم المتعمّق أو التعليم العميق هو مجال بحث جديد يتناول إيجاد نظريات وخوارزميات تتيح للآلة أن تتعلم بنفسها عن طريق محاكاة الخلايا العصبية في جسم الإنسان أحد فروع العلوم التي تتناول علوم الذكاء الصناعي، ويعدّ فرعا من فروع التعلّم الآلي.
[47] دانيال كوهين (2022) ص 44
[48] نفسه ص 45
[49] The Future of Mind. The scientific quest to understand. Enhance and empower the mind. by michio kaku Doubleday N: Y 2014
[50] مشيو كاكو "مستقبل العقل: الإجتهاد العلمي لفهم العقل وتطويره وتقويته" ترجمة سعد الدين خرفان، عالم المعرفة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت أبريل 2017 ص 266
[51] مشيو كاكو (2017) ص 267
[52] نفسه مشيو كاكو (2017) ص 267
[53] وتطرّق لهذه الفكرة مشيو كاكو بالشرح التفسير في الفصل العاشر من الكتاب الذي أسلفنا ذكره تحت عنوان "الفصل العاشر: العقل الإصطناعي والوعي السيليكوني" ص 268 وما بعدها.
[54] صلاح إسماعيل (2024.) ص 27
[55] محمد الشقيف "فلسفة التفكيك بين منطق الغموض واللامنطق" مؤمنون بلا حدود، مايو 2023 ص 1
[56] دانيال كوهين (2022) ص 24
[57] نفسه صلاح إسماعيل (2024) وهي فكرة وردت في محور عنونه ب "علاقة فلسفة العقل بفروع الفلسفة والعلوم الأخرى" ص 29
[58] نفسه ص 29
[59] نفسه ص 30
[60] نفسه ص 30