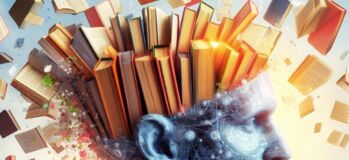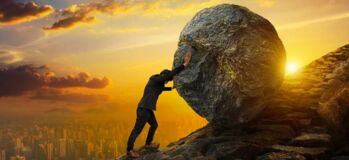القصدية
فئة : مقالات

القصدية
تقديم
لقد أضحى الذهن وآليات عمله موضوع الساعة في العديد من المناقشات المتداولة عبر العديد من الحقول المعرفية: علم النفس، علوم المخ، الذكاء الاصطناعي، وفلسفة الذهن، وجميعها حقول تنتمي إلى ما اصطلح على تسميته بالعلوم المعرفية، هذه الأخيرة (العلوم المعرفية) تعد مجموعة من العلوم المختلفة، والتخصصات المتباينة التي تشكل المعرفة ووسائلها المختلفة، بما في ذلك تلك المتعلقة باللسانيات، اللغويات، علم الإحياء العصبي، الدلالة، فلسفة اللغة، علوم الحاسوب، الذكاء الصناعي، علم النفس، فلسفة العقل... وغيرها؛ إذ يكمن هدفها الأسمى في محاولة فهم كيف نفكر، ما معنى أننا كائنات مفكرة؟
ظهرت هذه العلوم المعرفية في أواخر الخمسينيات من القرن العشرين، وركزت اهتمامها على دراسة كيفية اشتغال العقل البشري: هل يعمل وفق طرائق نمطية ثابتة، أم وفق آليات متجددة وخلاّقة؟ كما سعت إلى مقاربة مسألة غموض العقل ولغز الوعي، معتمدةً على ركيزتين أساسيتين: الذكاء الاصطناعي وفلسفة العقل (أو فلسفة الذهن). وتندرج هذه الفلسفة ضمن إطار العلوم المعرفية، وهي بدورها حقلٌ يضجّ بالإشكالات العميقة، وفي مقدمتها:
مشكلة الوعي ومشكلة القصدية.
تُعدّ القصدية من أكثر مباحث فلسفة العقل عمقاً وإثارة للاهتمام؛ فقد حظيت باشتغالٍ واسع من لدن مفكرين وفلاسفة ينتمون إلى اتجاهات متباينة، بالنظر إلى أهميتها وصعوبة مفاهيمها. وتَرجع مركزيتها إلى كونها انعكاساً مباشراً لإشكالية الوعي؛ فالقصدية خاصية عقلية تتمثل في قدرة الحالات الذهنية على تمثيل الموضوعات، واتجاهها نحو العالم الخارجي؛ أي إن للحالات العقلية توجهاً من الذات إلى الموضوع.
أما مشكلة الوعي، فترجع جذورها الحديثة إلى ديكارت الذي بلورها عبر الكوجيطو الشهير: «أنا أفكر إذن أنا موجود»، حيث بلغ الوعي الذاتي لديه ذروته، وجُعل العالم الخارجي ثانوياً أمام أولوية الفكر في تأسيس معرفة الذات. وعلى هذا الأساس، ارتبطت القصدية كذلك بمفهوم النية والانبعاث نحو الشيء، سواء بوصفها توجهاً إراديًّا أو توجهاً ذهنيًّا محضاً.
وقد كان فرانز برينتانو أول من أدخل مفهوم القصدية إلى الفلسفة الحديثة، قبل أن يطوّره تلميذه إدموند هوسرل ضمن مشروعه الفينومينولوجي، حيث اعتبر القصدية السمة الجوهرية لكل وعي: فالوعي دائمًا وعيٌ بشيء، ولا يمكن أن يُعطى في فراغ. وهكذا أصبحت القصدية عند هوسرل علاقة بنيوية بين الذات المُدرِكة والموضوع المُدرَك.
ومع الفلسفة المعاصرة، وخصوصاً مع جون سيرل، استمر البحث في الوعي والقصدية داخل فلسفة العقل، ولكن في إطار مغاير للرؤية الفينومينولوجية. فقد ربط سيرل القصدية باللغة والعقل والإدراك، واعتبرها إحدى أكبر “المشكلات” الفلسفية، مباشرة بعد مشكلة الوعي، وصرّح قائلاً في كتابه "العقل: مدخل موجز": "لكي نفهم حياتنا، علينا أن نفهم القصدية."
وتتجلى أهمية القصدية لدى سيرل في كونها تمثل مدخلاً لحل أحد أعقد إشكالات فلسفة العقل: العلاقة بين العقل والجسم، وهي المشكلة التي أفرزت اتجاهات فلسفية متعددة مثل: المادية، والوظيفية، والمثالية، والواحدية… وغيرها. ويطرح سيرل القصدية بوصفها ظاهرة عقلية بيولوجية طبيعية تخضع - مثل بقية الظواهر- للدراسة العلمية والملاحظة والتحليل.
جذور القصدية (مشكلة القصدية)
على الرغم مما حققته البشرية من تقدم هائلٍ في فهم العالم وأنفسهم، فما تزال هناك ألغاز كثيرة وعميقة، وهذه الألغاز غالبا ما يكون لها ارتباط وثيق بالعقل؛ ففلسفة العقل حافلة بالخلاف شأنها في ذلك شأن الفلسفة بصفة عامة، ومن أهم هذه الإشكالات التي تواجه العقل نجد مشكلة الإدراك، ومشكلة الذكاء الاصطناعي، مشكلة الوعي، وكذا مشكلة القصدية التي تعد من أبرز الإشكالات الأساسية التي تخبط فيها العقل خاصة عندما نفكر حول أشياء: مثلا أنا أفكر في كوكب المشتري الآن، كوكب المشتري شيء، وتفكيري حوله شيء آخر، وهذا المصطلح أدى دورا مركزيًّا في النقاشات المنطقية في فلسفة العصور الوسطى، حيث كان يستعمل في معنيين: معنى عملي، والآخر تقني، القصدية لفظ تقني يستعمله الفلاسفة للإشارة إلى تلك القدرة في العقل. إذا كان لدي معتقد، فإنه يتعين على هذا المعتقد أن يكون معتقدا بشيء ما، وإذا كانت لدي رغبة، فإنه يتعين أن تكون رغبة بفعل شيء ما، وإذا كان عندي إدراك، فيتعين علي أن أعتبر نفسي أنني أدرك شيئا أو حالة واقعية في العالم، " يقال إن جميع هذه الحالات هي حالات قصدية من الدرجة الأولى". إن عملية القصد التي أمارسها في الحالات العادية عندما أقصد الذهاب إلى السينما هذا المساء، هي نوع واحد من أنواع القصدية، بالإضافة إلى أنواع أخرى، كالاعتقاد والأمل والخوف والرغبة والإدراك. بناء على ما سبق، يمكن القول إن القصدية فعل إنساني بدرجة كاملة؛ لأنها قائمة على الوعي بالأشياء المحيطة به.
هناك سجال واختلاف واسع في صفوف الباحثيين حول البداية الفعلية للقصدية؛ ففئة تعيد تأسيس هذه الأخيرة ل برينتانو، وفئة أخرى تنفي هذا القول؛ إذ تفيد أن الكثير من البحوث لا نجد أنها تشير إلى ظهور فكرة القصدية لدى برينتانو، وبالتالي فتأسيسها يعود إلى هوسرل، هذا السجال الفكري استمر كثيرا، بيد أن برينتانو كان له دور مهم في ظهور القصدية، على الرغم من أن البعض يعيدها إلى أرسطو الذي اهتم هو الآخر بالنفس والشعور وغيره، لكن انبثاقها كان مع برينتانو في كتابه "علم النّفس من وجهة نظر تجریبیة" الذي يعد مصدر التفكیر الفلسفي في العقل والقصدیة في الفكر الأوروبي المعاصر، وتعد القصدیة من أشهر نظریاته على الإطلاق، فهذا الفيلسوف (برينتانو) هو أول من أدخل فكرة القصدية إلى الفكر الحديث، قصد التمييز بطريقة صارمة بين الظاهرة الطبيعية والظاهرة النفسية، فالقصدية عنده تعني الإشارة إلى موضوع داخل الوعي؛ أي مضمون معين داخله أو موضوعية محايثة.
نقاط رئيسة من مفهوم برينتانو للقصدية:
كل ظاهرة ذهنية تتميز بوجود قصدي لشيء ما، يعني أن كل ظاهرة ذهنية تتضمن شيئًا ككائن داخلها، هذا الوجود القصدي خاص حصريًّا بالظواهر الذهنية، وبالتالي يمكن تعريف الظواهر الذهنية بأنها تلك الظواهر التي تحتوي على شيء قصديًّا داخلها، وبهذا قدم برينتانو ثلاث أطروحات رئيسة حول القصدية تتلخص فيما يلي:
ü الأطروحة الأولى: تُعد القصدية، كما تظهر في الحالات الذهنية، مثل الحب والكراهية والرغبة والاعتقاد والحكم والإدراك والأمل، سمة أساسية لهذه الحالات الذهنية، وهي أنها موجهة نحو أشياء مختلفة عنها.
ü الأطروحة الثانية: تتميز الكائنات التي يتوجه إليها العقل بفضل القصدية بامتلاكها خاصية يسميها برينتانو "الوجود القصدي".
ü الأطروحة الثالثة: القصدية هي سمة العقل، وجميع الحالات الذهنية فقط هي التي تظهر القصدية.
الأطروحتان الأوليتان مترابطتان، إذا كان من الضروري لطبيعة القصدية ألا يتمكن المرء من تجسيد حالات ذهنية معينة ما لم يكن هناك "شيء ما" يُحب أو يُكره أو يُرغب فيه، فإنه يتبع من طبيعة القصدية نفسها (كما وصفتها الأطروحة الأولى) أنه لا يمكن لشيء أن يظهر القصدية ما لم يكن هناك "كائنات؛ أي كائنات قصدية تلبّي خاصية الوجود القصدي، وقد أدى بذلك قبول الأطروحتين الأوليتين لبرينتانو إلى إثارة سؤالا وجوديا أساسيا في المنطق الفلسفي: هل توجد مثل هذه الكائنات القصدية؟، هذا السؤال أدى إلى انقسام كبير في الفلسفة التحليلية. الإجابة السائدة (الأرثوذكسية) هي "لا" بشكل قاطع.
عدد كبير من الفلاسفة الفيزيائيين يشتركون في مهمة التوفيق بين وجود القصدية والوجودية الفيزيائية، بافتراض أن القصدية هي مركزية للعقل، فإنه لا يوجد هوة لا يمكن ردمها بين العقلي والفيزيائي، أو أنه يمكن للمرء أن يؤيد كلًّا من الفيزيائية والواقعية القصدية، من وجهة نظر برينتانو الخاصة بأن "لا ظاهرة فيزيائية تظهر" القصدية غير مقبولة ببساطة لفيزيائي. إذا كانت الفيزيائية صحيحة، فإن بعض الأشياء الفيزيائية هي أيضًا أشياء عقلية. السؤال للفيزيائي هو: هل يظهر أي شيء غير ذهني قصدية؟
من الواضح أن إحدى طرائق تخفيف التوتر بين الفيزيائية والواقعية القصدية هي القول إن القصدية يمكن أن تظهرها، وهي في الواقع تظهرها، أشياء غير ذهنية، وبالتالي كانت هناك عدة مقترحات في الفلسفة التحليلية في العشرين عاما الماضية، واقتراح طرائق لتحقيق هذا البرنامج، والذي أطلق عليه اسم "تطبيع القصدية". الاستراتيجية الشائعة هي إظهار أن برينتانو كان مخطئا في ادعائه بأن الأشياء العقلية وحدها يمكن أن تظهر القصدية، وهذه الاستراتيجية ترتبط بافتراض أن العلاقات القصدية التي يكون أطرافها أشخاصًا ملموسين يجب أن تكون لها الأسبقية على العلاقات القصدية التي لا يكون أطرافها كذلك، إحدى الاستراتيجيات المؤثرة لإظهار أن الأشياء غير الذهنية يمكن أن تظهر القصدية كانت اقتراح دريتسكي، المعلوماتي النظري: الجهاز الذي يحمل معلومات يُظهر درجة معينة من القصدية. هذه النظرة هي امتداد لمفهوم بول جرايس (1957) عن المعنى الطبيعي، ويمكن النظر إلى النظرية القصدية في المعنى عند جرايس على أنها تأتي على مرحلتين: تهدف المرحلة الأولى إلى تحليل مفهوم المعنى لدى المتكلم. أما الثانية، فتسعى إلى استعمال مفهوم المعنى لدى المتكلم، بالإضافة إلى فكرة الموضعة، كأساس للنظرية في المعنى اللغوي.
إضافة إلى ما قدمه برينتانو، نجد امتداد القصدية عند تلميذه هوسرل الذي كان الفضل الكثير لبرينتانو في استدراجه للفلسفة، بعد أن انشغل بعض الوقت بالرياضيات؛ فقد كان لهذا الفيلسوف أثر كبير ومباشر في تكوين فينومينولوجيا هوسرل، خاصة وأن هوسرل كان تلميذ برينتانو وواظب على حضور محاضراته ما بين عامي 1884-1886 في جامعة فيينا، في فقرة عابرة من كتاب "السيكولوجيا من وجهة نظر تجريبية"؛ إذ أشار برينتانو إلى أننا نتناول العقل من حيث مقاصده، فأفكارنا دائما في شيء أو عن شيء؛ إذ يقول: "في الحب يوجد شيء محبوب، وفي الكره يوجد شيء مكروه، وفي الحكم يوجد شيء مثبت أو منفي"، وبعد أن التقط هوسرل هذه البذرة من برينتانو، جعلها مركزية في فلسفته بأكملها، وواجهته هذه المشكلة في مساره(صلة الوعي بموضوعاته)، هذه المشكلة التي شاركت فيها جل المدارس الفلسفية والاتجاهات الفكرية آنذاك، قصد ابتكار حلول وإجابات عنها، وهذا ما أدى به إلى استلهامها من أستاذه، ليغلق تلك الفجوة بين الوعي والعالم، وبالتالي أعجب هوسرل كثيرا بآراء أستاذه؛ إذ نجده يقول في كتابه أزمة العلوم الأوروبية، "هاهنا مقام الإشادة بالفضل العظيم الذي استحقه برينتانو عندما ابتدأ محاولة إصلاح السيكولوجيا بفحص الخصائص المميزة لما هو نفسي في مقابل ما هو فيزيقي وإظهار القصدية كواحدة من هذه الخصائص"، حيث رأى برينتانو أن الظواهر النفسية تتصف بولوجها إلى داخل الوجود القصدي. إضافة إلى هذا یجمع الباحثون على أن المدرسة الظاهراتیة في ضوء أعمال "هوسرل" من أهم اللحظات التي شهدها تطور فلسفة برينتانو، ویرون أن الاتجاه السیكولوجي الذي بلوره ینبني على منظور فلسفي هو في العمق امتداد لسیكولوجیة المقاصد التي بدأها أستاذه، لكن على الرغم من إعجابه العميق بأستاذه إلا أنه انتقده في بعض الأمور؛ بمعنى أخذ بعضا من آرائه وتخلى عن بعضها، كما أنه طور الكثير منها، فقد انتقده بشكل خاص في تعريفه للشعور الجازم بأنه الإدراك الداخلي، في مقابل الإدراك الخارجي، وبذلك يستبدل هوسرل الإدراك الداخلي بالإدراك المطابق، في مقابل الإدراك غير المطابق، كما رأى أن برينتانو لم يتمكن من فهم الطبيعة القصدية للوعي بشكل صحيح، فهوسرل على العكس تماما من برينتانو كونه لم يهتم بشكل أساسي بإيجاد "علامة عقلية"، في البداية ينكر هوسرل بشكل مباشر أن كل ظاهرة عقلية مقصودة "ليست كل التجارب معتمدة على وجه الخصوص، يدعي أن الأحاسيس وبعض المشاعر كالألم الجسدي والتعب باعتبار هذه الأفعال ليست مقصودة جوهريًّا، فالقصدية عند هوسرل تتلخص في أن الأشياء في العالم الخارجي موجودة، لكي يدركها الشعور، فتكون من فعل وموضوع ملتحمين. فالشعور عند هوسرل في ارتباطه بالقصدية ينقسم إلى نوعين: شعور محايد، وشعور واضع.
الشعور المحايد: هو شعور لم يبدأ بعد في تحليل القصد المتبادل بين الموضوع والفعل، ولا يكون فيه موضوع فعل القصدية واضحًا.
أما الشعور الواضع: فهو الشعور الذي يبدأ فعلا في تحليل عملية الإدراك القصدي لمختلف الظواهر المعرفية (التذكر، التخيل، الرغبات...)؛ بمعنى يكون فيه موضوع فعل القصدية واضحًا ومحددًا، وأن الوعي يستطيع أن يحمل الموضوع ويجعله موجودًا في الإدراك بغرض اكتشاف العلاقة بين فعل القصد وموضوعه، كما لا يمكننا أيضا إنكار أن قضايا الفينومينولوجيا قد بدأت مع قضايا القصدية التي أخذها من أستاذه برينتانو؛ ذلك أن هوسرل قد تأثر بآراء برينتانو في مجال النفس. لذا ارتبطت البحوث الفينومينولوجية الأولى بالبحث في مواضيع الشعور، لكن لا نقصد المفهوم الكلاسيكي للشعور المرتبط بالمحسوسات، بل الشعور الخالص في صورته الماهوية المتعالية. فالشعور بالنسبة إليه يرادف الوعي؛ بمعنى أن الشعور بالشيء هو وعي بالشيء، هذا الوعي ذو طابع قصدي؛ أي إن القصدية تتيح لنا الالتفات إلى الأشياء ذاتها. أما في ما يتعلق بالمبادئ في الفينومينولوجيا، فقد لخصها هوسرل من خلال إقامة جسر قصدي بين وعي الإنسان وموضوعاته، ولم يكتف بما قدمه برينتانو في مجال القصدية، بل عمل على تطويرها وهذا ما نراه في جلّ مؤلفاته، حيث إنها تطورت بتطور المنهج الفينومينولوجي، ويمكن أن نشير إلى أهم هذه المراحل:
*- المرحلة الرياضية: إذ اتخذت القصدية في هذه المرحلة طابعا رياضيا محضا؛
*- المرحلة المنطقية: إذ انتقلت القصدية إلى الصيغة المنطقية.
*-المرحلة الفينومينولوجيا: أصبح للقصدية هنا دور محوري في بناء المعرفة الفينومينولوجية، التي تعد من أهم المناهج الفلسفية المعاصرة التي أثرت بدرجة كبيرة في الفكر الغربي ككل، ساهمت في تجاوز المشاكل الفلسفية الكلاسيكية، وتوحدت عن طريق مفهوم القصدية (الوعي وموضوعاته)، فالفينومينولوجيا كمحاولة منهجية في التحليل وفهم الظواهر المختلفة عبر تلك البحوث السيكولوجية التي ابتدأها عالم النفس النمساوي فرانز برينتانو، وكان للقصدية دورًا في غاية الأهمية في بناء هذا المنهج الفينومينولوجي، كانت بمثابة حلًّا سحريًّا لتلك المشكلة المعرفية التي اتصلت بالوعي ومواضيعه، وكذا من خلال اكتشاف هوسرل لعاملين هما: الفعل القصدي، والتحليل القصدي، فقد كان هدفه يكمن في محاولة تأسيس معرفة فلسفية وعلمية آمنة. لذا أدرك أن نقطة انطلاقه يجب أن تكون من الوعي؛ لأنه من دون الوعي لا يمكن تحقيق أي شئ، وهو الذي أطلق شرارة بداية اللفينومينولوجية؛ فالموضوع الذي يشير إليه الوعي ليس مجرد شيء يقصد إليه الوعي، بل هو من إنتاج الوعي ذاته، وبمعنى أدق ذهب هوسرل إلى أن الأفعال القصدية للوعي هي المنتجة للموضوعية، مما أدى إلى اختلافه عن برينتانو الذي ذهب إلى أن الوعي لا يقوم بشيء إلا أن يقصد إلى موضوع محايث له؛ لأن هوسرل يذهب إلى أن القصدية لا تعني مجرد قصد الوعي إلى موضوع بل تعني أنها تنتج الموضوع ذاته. ويبني هوسرل مفهومه عن القصدية على أساس الوعي الذاتي، كما يذهب إلى أن الحكم هو وعي بالشيء، والإدراك الحسي هو توجه قصدي نحو الشيء. بالإضافة إلى هذا، نجد هوسرل يميز ضمن هذا الفعل القصدي الذي ذكرناه آنفا للوعي، بين نوعين من القصد:
*- "القصد الذاتي": وهو حضور الذات والوعي في فعل الخبرة القصدية نفسها؛ وذلك من ناحية فاعليته وإدراكه لموضوعه.
*-"القصد الموضوعي": يعني طريقة الوعي في إدراك تلك الخبرة، حيث إن طريقة خبرة الوعي بموضوعه تتغير بتغير محتوى الموضوع نفسه، فقد يكون موضوع الوعي ذكرى أو خيالا أو موضوعا فيزيقيا أو عاطفة... بمعنى النية التي يتجاوز بها الفرد ذاتيته، ويهدف إلى الواقع الخارجي، هو بمثابة الملاحظة المنعكسة على كيفية إدراكنا للظواهر، وفي اندماج هذين العنصرين تتكون بنية الفعل القصدي ككل، بوصفها عملية التفكير أو فعل التفكر والتأمل البسيط.
ويرتبط الجانب الذاتي بالموضوعي في أفعال الوعي بأربعة آفاق عند "هوسرل" هي:
-الأفق الداخلي
-الأفق الخارجي
-الأفق الزمني
-الأفق البینذاتي
هذا "الأفق" مفهوم نشأ من صلب الفینومینولوجیا على ید "هوسرل" من أجل توضیح بنیة الوعي القصدیة؛ فكل فعل یقوم به الوعي یتصف بتغیره المستمر، سواء من ناحیة ترابطه بالوعي، أو من ناحیة المراحل المختلفة لانسیابه بأفق متغیر، أفق قصدي لإمكانیات الإحالة، وهذه الإحالة هي إحالة على إمكانیات خاصة بهذا الأفق، فكل إدراك لموضوع ما یكون إدراكا حسيا...
وعلى الرغم من اعتراف جمیع الفلاسفة المعاصرین بأن برينتانو هو أول من أحیا مفهوم القصدیة وصاغه صیاغة كاملة، بيد أنهم یؤكدون أیضا أن دعواه في ذلك لیست صحیحة تمام الصحة، حيث إن برينتانو يقر أن الظواهر العقلیة هي وحدها التي تظهر القصدیة، في حين أن "سیرل" في كتابه "القصدیة "يخالفه في ذلك من غیر إشارة صریحة إلى أنه ینقده؛ إذ يقول سیرل: إن بعض الحالات والحوادث العقلیة ليست جمیعها تملك قصدیة، إشارة واضحة إلى أن نظرية القصدية امتدت للفترة المعاصرة نظرا إلى أهميتها البالغة في الحقل الفلسفي، نجدها بشكل أساسي مع الفيلسوف جون سيرل، فقد خصص لها حيزا كبيرا في كتابه "القصدية بحث في فلسفة العقل"؛ إذ عالج في هذا الكتاب بشكل مركز تلك القدرات البيولوجية الأساسية، وأن اللغة تقع في نهاية فرع فلسفة العقل؛ لأن أعمال الكلام هي أشكال من الفعل البشري، هل معناه أن العقل يربطنا بالعالم الخارجي عن طريق القصدية بفضل اللغة؟ يجيب سيرل عن هذا السؤال في عبارة وجيزة مبينا أن المشكلة تكمن في أننا لا نستطيع أن نفسر قصدية العقل بالاحتكام إلى قصدية اللغة؛ لأن اللغة تعتمد أصلا على قصدية العقل. ومن هنا لا يمكن تفسير القصدية إلا باستخدام مفاهيم قصدية أو باستخدام لغة قصدية، فالقصدية توجد في الحالات اللغوية والحالات غير اللغوية.
تعد القصدية عند جون سيرل الفكرة الجوهرية التي باستطاعتها تقديم حلٍّ أمثل لمشكلة العلاقة بين العقل والمخ، والقصدية هي السمة الأساسية للوعي، وهي التي تميز الحالات العقلية عن الحالات غير العقلية. فالقصدية تضمن تحليل مناقشات واسعة للإدراك والفعل والمعنى والمنطوقات لأسماء العلم...، هذه الأخيرة أي أسماء العلم نجدها في الفصل التاسع من كتاب جون سيرل الذي ذكرناه سلفا، تناولها بالجملة والتفصيل، فقد تناول فيها التفسير الوصفي لهذه الأسماء، كما تناول الفروق بين التفسيرين...، فالهدف الرئيس من استخدام أسماء العلم يكمن في تمكيننا من الإشارة للموضوعات، وطالما يوجد مضمون قصدي معين مرتبط بالاسم، فإنه يظهر كجزء من المضمون اللغوي للعبارة التي تستخدم الإسم، وبالتالي المضمون القصدي المرتبط بالاسم لا يكون جزءا من تعريف الاسم.
نخلص في النهاية إلى أن استخدام الأسماء يتم للإشارة إلى الناس والأماكن التي نحتك بها يوميا، ولتحليل هذه الحالات القصدية اعتمد جون سيرل على المساواة بين الحالات العقلية وأفعال الكلام، وبالتالي تم نقل صفات أفعال الكلام وصفات الظواهر البيولوجية الطبيعية إلى الحالات القصدية، هذه أي أسماء العلم ينقصها وجود المضمون القصدي، لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق، هو هل تجعل كل من المتحدث والمستمع يركزان بطريقة قصدية؟، أم إنها تشير فقط للموضوعات من دون تدخل أي موضوع قصدي؟
طالما أن الإشارة اللغوية تعتمد دائماً على العقل، أو تمثّل صورة للدلالة العقلية، فإنه يجب أن ترتبط أسماء العلم بمضمون قصدي. توجد أسماء لها استخدامات خاصة يكون المضمون القصدي المرتبط بها مستمدّاً من الآخرين، ومع ذلك يكون كافياً للمعرفة بالموضوع، حيث يحدد الضوابط التي تمكّن الإشارة من الإحاطة بالأشياء التي تُستخدم هذه الأسماء للإشارة إليها.
تلعب القصدية دوراً حاسماً في اللغة؛ إذ إن أفعال الكلام تمثل حالات قصدية، وهي الوسيلة التي تمكّن البشر من التواصل والتفاعل مع بعضهم البعض. ومن هنا، تدخل القصدية أيضاً في مجال اللغة، فاللغة تُعد الأداة الأساسية التي يعبر بها الإنسان عن حالاته الذهنية المقصودة؛ فمن دون القصدية تصبح اللغة مجرد أصوات أو رموز خالية من المعنى.
وفي هذا السياق، يشير جون سيرل إلى أن "المعنى هو القصدية المشتقة": عندما يتحدث شخص ما، فإن الكلمات التي يستخدمها ليست مجرد تراكيب لغوية، بل هي تجسيد لمقاصده وأفكاره. على سبيل المثال، عندما أقول: «أريد كوباً من الماء»، لا تُعبّر الكلمات عن نفسها فحسب، بل عن رغبة في الحصول على الماء. ومن ثم، تُظهر اللغة كيف يمكن للعقل أن يوجّه مقاصده عبر الألفاظ.
تُستخدم القصدية أيضاً للدلالة على توجه الوعي نحو موضوعه، أو نمط العلاقة التي تربط الوعي بمضمون ظاهرة ما. أما بالنسبة للأساس الذي يقوم عليه نهج سيرل العام، فهو الرأي القائل إن أي انقسام بين العقلي والمادي منطقي وليس كونيًّا؛ إذ يرى أن الحالات القصدية ناتجة عن الهياكل الفيزيائية وتتحقق فقط ضمنها. وعلى عكس الفلاسفة السائدين الذين يقلقون بشأن كيفية امتلاك الظواهر الفيزيائية لخصائص قصدية، يؤكد سيرل منذ أواخر السبعينيات أن مشكلة العقل والجسد يمكن تبسيطها بشكل كبير. وبدلاً من الانشغال بهذه المشكلة، يرى سيرل أن الوعي هو القضية المركزية في فلسفة العقل، وقد نجح بذلك في جذب اهتمام الكثيرين لإعادة توجيه التركيز الفلسفي نحو دراسة الوعي.
لقد عالج جون سيرل أيضا في فصله العاشر تحت عنوان "القصدية والمخ" مسألة علاقة القصدية بالمخ، فهناك مجموعة من الظواهر العقلية التي لا يمكن التصدي لها والتخلص منها وجعلها في غياهب النسيان، كالآلام والمخاوف، الأفكار، المشاعر، الخيرات...وغيرها، وعلى الرغم من وضوح هذه الأمور، إلا أنها لم تنل قدرًا من الاهتمام الكافي من معظم الفلاسفة الذين درسوها؛ إذ إن هناك نظريات متعددة ترى أن الحالات العقلية تتحدد وتتم معرفتها من علاقتها السببية، أو إن الآلام والمخاوف... ليست سوى حالات آلية منتظمة، أو إن المساهمات القصدية الصحيحة ليست إلا النجاح المتوقع الحصول عليه من اتخاذ موقف قصدي معين تجاه نظام معين، وتتمثل الصورة التي أقترحها، والتي أعتقد أنها تؤدي في النهاية إلى حل المشكلة، في اعتبار أن الحالات العقلية تحدث بسبب عمليات في المخ، وتتم وتتحقق في المخ وباقي الجهاز العصبي، وتستطيع هذه الحالات العقلية التي حدثت بسبب عمليات مستقبلية في المخ وحدوث حالات عقلية أخرى، فإن الطبيعة المنطقية لأنواع هذه العلاقات بين العقل والمخ لا تبدو غامضة ولا أراها صعبة بأي حال من الأحوال.
المصادر والمراجع:
- جون سيرل "القصدية" بحث في فلسفة العقل، ترجمة أحمد الأنصاري، دار الكتاب العربي: بيروت لبنان، حقوق الطبعة العربية.
- أنطوان خوري، مدخل إلى الفلسفة الظاهراتية، دار التنوير للنشر، بيروت لبنان، ط1، 1984
- Franz Brentano descriptive psychologie
- جون سيرل "العقل" ترجمة ميشيل حنا ميتاس، عالم المعرفة، الكويت 2007
- عبد الواحد المرابط "مفهوم القصدية في تاريخ الفلسفة".
- جميل صليبا: المعجم الفلسفي، الجزء الثاني، دار الكتاب، ط1، بيروت.