كلنا سيزيف/ أو عن سؤال الجدوى من الحياة
فئة : مقالات
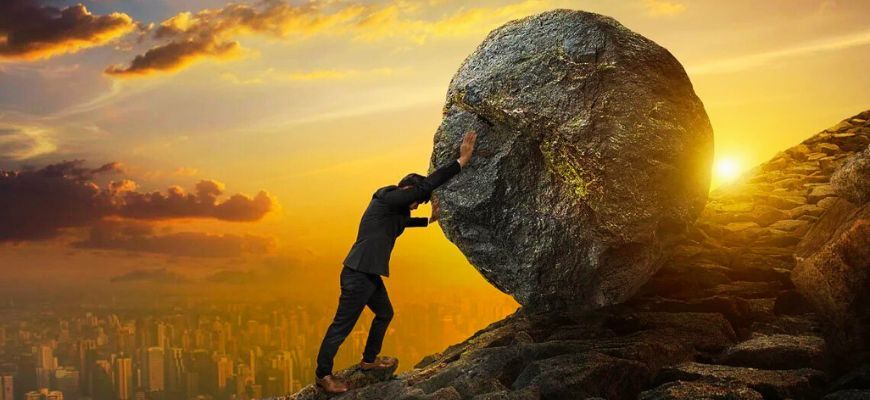
كلنا سيزيف/ أو عن سؤال الجدوى من الحياة
"كلما خلت الحياة من المعنى كانت أجذر من أن تعاش"
ألبير كامو
شغلت جدوى الحياة والمصير الإنسان ي المحتوم (الموت) -لا تزال- اهتماما كبيرًا في الفكر البشري، ولا سيما الفلسفة، تحديدا الوجودية والعدمية والعبثية...، لكن ليس بالضرورة أن تكون فيلسوفا حتى تصفعك اللاجدوى، وتدرك ذلك الفراغ والضباب من العدم، حتى تسأل عن معنى الوجود؛ فجميع الكائنات البشرية التي تتميز بملكة العقل تحاول أن تفهم وتفسر معنى هذا العالم اللامتناهي الغير معقول؛ ومعنى ذلك هو أن يخضع الإنسان هذا العالم للقواعد العقلية والمنطقية، حيث يجادل البير كامو في هذا الصدد بأن البشر غير قادرين على الهرب من طرح سؤال: "ما معنى الوجود؟"[1] وهو بذلك يقبل الفكرة الأرسطية القائلة إن الفلسفة تبدأ بالتساؤل. ومع ذلك ينفي كامو وجود إجابة عن هذا السؤال، ويرفض كل غائية، ميتافيزيقيا، أو غاية بشرية مختلفة من شأنها أن توفر الإجابة الوافية[2]، ومن هنا يبقى سؤال المعنى سؤال يزعج ويؤرق البشرية؛ لأنه سؤال يعبر عن لغة الوعي في محاولته لسبر أغوار هذا الوجود وتفكيك التناقض القائم فيه، وهذا طبعا يعود إلى ابتلاء الإنسان بوعيه، هذا الوعي الذي يعيش بدوه مفارقة كبيرة، فمن جهة يحاول أن يفهم الأشياء ويجد المعنى ويحدد لكل شيء غاية، لكن من جهة أخرى يجد أن الحياة في مختلف تجلياتها مليئة بالعشوائية والفوضى والعبث، وتبتعد في أحيان كثيرة عن المنطق، على الرغم من وجود هذه المعضلة العبثية، فالإنسان مبتلى بوعيه؛ لأنه لا يرضيه إلا النظام والمعقولية لا يستطيع إلا أن يتصور أن لكل شيء هدفا وغاية ويحمل في صميمه معنى ما، وإذا استطاع المرء أن يقول مرة واحدة فقط: هذا واضح، فسيتم إنقاذ كل شيء[3]، فعلى سبيل المثال لا الحصر غموض المصير الإنسان ي النهائي (الموت وما بعدها) جعل الإنسان الذي يرعبه هذا الفناء أن يبتكر الأساطير والآلهة والأديان لعلها تخفف من عبئ هذا الثقل؛ فالإنسان بهذا المعنى هو حيوان يدرك أنه سيموت، أو "كائن من أجل الموت" كما يقول هايدغر. على الرغم من كون الإنسان يشترك خاصية الموت مع الكائنات الأخرى، لكن الفرق هو أنه كائن يدرك جيدا أنه سيموت، وبالتالي هذا ما سيجعله يطرح من جديد سؤال الجدوى، ما الغاية من ذلك؟ لماذا نعيش ونواجه مصاعب الحياة وإكراهاتها القاتلة ونمطيتها، وينتهي بنا المطاف في المقابر؟ إذن لعنة الوعي هذه كما يطلق عليها سيوران هي التي تدفع الإنسان إلى طرح ذلك السؤال الكبير ما الجدوى؟، لكن إذا اتفقنا أن الإنسان يتميز بالوعي سنطرح السؤال التالي: هل جميع الكائنات الواعية تصيبها هذه الحيرة المرعبة وتطرح كلها سؤال الجدوى؟ بطبيعة الحال الجواب سيكون بالنفي؛ لأن الغالبية العظمى منغمسة في انهماكات ومشاغل الحياة التي لا تنتهي؛ لأن الإنسان محكوم عليه بالحياة التي تتكرر دائما بتفاصيلها الرتيبة والروتينية، والتي لا جدوى منها، ولكن علينا مواصلة هذا العبث حتى الموت فعلى سبيل المثال مرحلة الدراسة هناك برنامج روتيني لابد أن تلتزم به وتكرره كل يوم..، النهوض الباص، أربع ساعات في الدائرة أو المصنع، وجبة الطعام، النوم، والاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة،/ السبت، طبقا للنسق نفسه[4]، هذا ما يمكن أن نطلق عليه السيزيفية نسبة إلى سيزيف المغضوب عليه من طرف الآلهة والحكم عليه بحمل الصخرة كعقاب أبدي، فإن مصيره لا يختلف كثيرا عن مصيرنا نحن كبشر لأن كلاًّ منا محكوم عليه بأن يحمل صخرته يوميا، بل أكثر من ذلك نواصل في حملها، رغم كل أنواع الشقاء والألم والقلق الذي ينجم عنها، لكن لا تسير الأمور دائما على هذا النحو، قد يقف أحيانا كائن بشري أمام هذه الروتينية ويفيق من سباته فتصيبه الدهشة والحيرة ليطرح على نفسه ذلك السؤال الوجودي الكبير الذي يبدأ ب لماذا؟ أي سؤال المعنى، وطبعا هذا السؤال يأتي نتيجة هذا الروتين القاتل الذي يطبع مجريات الحياة. "وهنا يبدأ كل شيء من ذلك الضجر بالاصطباغ بالدهشة، فالضجر يأتي في نهاية أفعال الحياة الميكانيكية"[5].
بأي معنى يمكن القول إن سيزيف هو رمز للإنسانية جمعاء في كل زمان ومكان؟
إذا كانت حياتنا فعلا شبيهة بحياة سيزيف الرتيبة والعبثية، ألا يكون الموت خيارا للإنسان للتخلص من هذا الضجر السرمدي؟ هل هذه الحياة الرتيبة والعبثية تستحق أن تعاش؟
ما هو العبث من منظور ألبير كامو؟ وما هي طبيعته وأسبابه؟ ماذا يأتي بعد اللاجدوى؟ وما هو الحل لمواجهة اللاجدوى؟ هل يمكن أن يكون الانتحار هو الحل لإنهاء هذا الشقاء والضجر والعبث؟ لماذا لا يقوم سيزيف بإنهاء حياته للتخلص من هذا العذاب الأبدي اللامجدي؟ هل يستطيع الجميع الاستمرار في هذه الحياة ويقاوم طابعها العبثي كما فعل سيزيف؟
في مفهوم العبث عند ألبير كامو
إن مفهوم العبث أو المحال[6] في الدلالة الفلسفية يعني "كل ما يتعارض مع قوانين المنطق؛ فالفكرة المحالة هي فكرة لا سبيل إلى التوفيق بين عناصرها، والحكم المحال هو الحكم الذي يتضمن غلطا ينتهي به بالضرورة إلى نتيجة باطلة ويكشف عن الفساد في بنائه الصوري"[7].
أما إذا عدنا إلى مفهوم العبث L’absurdre عند ألبير كامو، فإننا سنجد مجموعة من الأحداث التي من شأنها أن تجعل حياته بلا معنى، فمن اليتم إلى الفقر إلى المرض إلى البؤس، كلها كانت عوامل في نشأة العبث لديه. عندها أدرك أن الحياة عبثية وغير معقولة، وعليه ففكرة العبث عند كامو لم يستمدها من فراغ، فالكثير من الوقائع التي عاشها الفيلسوف في طفولته أو في مراهقته وحتى في أوج شبابه هي التي ساهمت تشكيل اتجاهه الفلسفي. "لقد قذف بألبير كامي وسط صراعات العصر، وهو عصر مزقه التناقض، وانفصلت فيه السياسة عن الأخلاق، والقيم عن المجتمع، والفكر عن الحياة، وبالتالي بات العصر يؤمن بموت القيم التي تعدّ الوسيط بين الله والإنسان"[8]، بل أكثر من ذلك حتى موته كان عبثيا، حيث كانت نهايته إلى الأبد بسبب حادثة سير سنة 1960. "مات عبثا، وهو الفيلسوف الذي عاش طوال حياته القصيرة ينادي بفلسفة العبث"[9].
وتجدر الإشارة إلى أن كامو "يقصد من لفظة العبث، بوجه عام، انعدام التوافق أو الانسجام بين حاجة الذهن إلى الترابط المنطقي، وبين انعدام المنطق في تركيب العالم، الأمر الذي يكابده الذهن ويعانيه"[10] والسؤال المطروح هنا أين ينبع الشعور بالعبث؟ وما طبيعته وأسبابه؟
إن هذا الشعور باللاجدوى قد يأتي للإنسان في أي لحظة وفي أي مكان، بوصفه شعورا مفاجئا ومباغتا. إنه تجربة شخصية تعاش بشكل ذاتي، "إن لكل الأفعال العظيمة بدايات مضحكة. وغالبا ما تولد الأعمال العظيمة في زاوية الشارع أو في الأبواب الدوارة في مطعم كذلك الأمر مع اللاجدوى"[11]. هذا الإحساس يصعب وصفه كما يعترف ألبير كامو نفسه، "المشاعر العميقة، كالأعمال العظيمة، تعني دائما أكثر ما تدرك قوله"[12]، ومن هنا يظهر قصور وعجز اللغة عن التعبير عن ما يشعر به الإنسان في أعماقه، "حين يصبح الخواء بليغا، حين تتحطم سلسلة الحركات اليومية، حين يفتش القلب عبثا عن الرابطة التي تربطه ثانية، فان ذلك يشبه العلامة الأولى من علامات اللاجدوى"[13].
أسباب العبث من منظور ألبير كامو
يرد كامو هذا الشعور باللاجدوى والعبث إلى عدة أسباب أهمها: طابع الآلية والروتين الذي تتسم به حياتنا في أدق تفاصيلها وحركاتها، فمثلا كل يوم نأتي بأعمال معينة في أوقات محددة، الاستيقاظ، تناول وجبة الفطور، العمل، الغداء، العشاء، النوم...إلخ، وهكذا نستمر طوال أيام الأسبوع والشهور والسنين في دورة رتيبة مملة، يتخذ الإنسان من هذه الحركات الآلية موقف اللامبالاة، فهي متساوية بنظره، ولم تعد تلفت انتباهه وتؤثر فيه بسبب تكرارها، "والبشر أيضا يحتفظون في أنفسهم باللابشرية. ففي لحظات معينة من الوضوح والمظهر الميكانيكي لحركاتهم، تجعل تلك الحركات الخرساء السخيفة التي لا معنى لها كل شيء يحيط بهم يتصف بالسخافة"[14]. وهذا ما نجده واضحا وجليًّا في بداية رواية الغريب L’étranger الصادرة سنة 1939، حيث يجسد بطل الرواية "ميرسو" دور الإنسان العبثي الذي لا يؤثر فيه أي شيء، فالطابع الروتيني للأشياء جعله لا يحرك أدنى انفعال لديه، فحتى الموت الذي يشكل الرعب الأكبر للبشر لا يبالي به، ففي بداية الرواية المذكورة نقرأ على لسانه: "اليوم ماتت أمي. أو ربما ماتت أمس، لست أدري"[15]. وينعكس هذا العبث الذي تسير عليه حياتنا اليومية على داخل الإنسان، فالإحساس بالسأم والضيق قد تسببه ملاحظة عادية نراها بشكل اعتيادي. "رجل يتحدث في التلفون وراء حاجز زجاجي. أنت لا تستطيع أن تسمعه، ولكنك ترى منظره الصامت غير المفهوم: وتتساءل لماذا هو حي؟"[16]، هذا ما يستدعي البحث عن معنى هذه الحياة؛ اذ لا يستطيع الإنسان أن يعيش ان لم يقتنع بوجوده، ولكنه يصطدم بحقيقة جهله بها، وأن معرفته بها ليست سوى وهم من أوهام العقل الأعمى، وهذا يتقاطع مع ما قاله نيتشه ذات يوم "لا توجد حقائق، هناك فقط تأويلات" اذن ليس من السهل إدراك معنى هذه الحياة التي أعطي فيها كل شيء ولم يفسر فيها أي شيء، "فكل شيء واضح ما هو إلا فوضى، أن كل ما لدى الإنسان هو وضوحه ومعرفته الأكيدة للأسوار المحيطة به"[17]، ومن أسباب العبث أيضا حسب كامو هو صراع الإنسان مع قدره، إذ قذف بالإنسان في هذا العالم دون رغبة منه خاضعا لسلطة القدر الذي لا مفر منه، وهذا ما تجسده حياة سيزيف* التي تمثل رمز الحياة العبثية التي يقوم فيها بعمل لا جدوى منه؛ لأنه فرض عليه كعقاب سيقوم به إلى ما لا نهاية، آملا في الخلاص والحصول على السعادة شريطة تحمل كل أنواع التوتر والشقاء والمعاناة التي تتخلل هذا العمل، "وهكذا، وخلال كل يوم من أيام الحياة العادية، يحملنا الزمن. ولكن تأتي لحظة يكون علينا نحن أن نحمل الزمن فيها. إننا نعيش على المستقبل: -غدا - بعد ذلك -، حين تكون قد بدأت -، ستفهم حين تكبر-. ومثل هذه الأمور رائعة؛ لأننا على كل حال نجد أن المسألة هي مسألة موت"[18]، ومن هنا يبدو الزمان كأنه العدو الأكبر للإنسان؛ لأن من خلاله يتسرب اليه اللاجدوىّ "يأتي يوم يلاحظ فيه الإنسان أو يقول إنه في الثلاثين. وهكذا، فهو يبين كونه شابًّا، ولكنه في الوقت نفسه يبين نفسه بعلاقتها ىالزمن. إنه يأخذ مكانه فيه. وهو يقر بأنه يقف في نقطة معينة في قوس يعترف بأن عليه أن يستمر فيه إلى نهايته. إنه يخص الزمن، وبالرعب الذي يقبض عليه، يدرك أسوأ أعدائه غدا. إنه يحن إلى الغد، بينما كان عليه أن يرفضه وثورة الجسد هذه هي اللاجدوى"[19].
وتأتي بعد ذلك تجربتنا المحدودة مع العالم؛ وذلك التقابل بين رغبة الوعي في الفهم والوضوح وعقلنة الأشياء، وبين العالم المستعصي على الفهم والمليء بالتناقضات والمفارقات، "وهذه التلال، ونعومة السماء، وخط تلك الأشجار في هذه اللحظة بالذات تفقد كلها المعنى المضلل الذي كنا نلبسها إياه، وتصبح أشد بعدًا عنا من الفردوس المفقود".[20] ولو استطعنا أن نلمس الطبيعة نفسها، لنزعنا القناع عن شيء يختلف تمام الاختلاف عن الوعي البشري، "ويواجهنا عداء العالم عبر آلاف السنين، ونكف لحظة عن فهم ذلك؛ لأننا لم نعرف فيه عبر القرون غير الصور والأشكال التي كنا نعزوها اليه من قبل، ولأننا مند ذلك الحين فقدنا القوة على الإفادة من تلك الوسيلة. وهكذا، يضللنا العالم لأنه يصبح هو نفسه ثانية. وتصبح تلك المشاهد المسرحية المقنعة بقنع العادة مرة أخرى هي نفسها"[21]، الأمر هنا أشبة بطرح شبنهاور في كون العالم إرادة وتمثل، حيث لا يمكن تفسيره ولا البحث عن طريقة وجوده في ذاته أو جوهره أو ماهيته الحقيقية. وعليه، فالعبث ينتج من الصدمة التي يتعرض لها الوعي عندما يفاجأ بانعدام الأمل مستقبلا؛ وبتلاشي رغبته في الوضوح والفهم.
وأخيرا: اللاجدوى عند كامو يتولد من تجربة الموت، غم أن تجربة الموت لا يعرفها الا من ينتهي مصيره ويموت، ولكن اليقين الذي نملكه ولا شك فيه هو أننا سنموت لا محالة، ولا سيما أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يدخل الموت في صميم كينونته، بوصفه أعلى ما لديه من إمكانيات حسب هايدغر، وموتنا هذا لا مفر منه ولا تفسير له، "فلن يندهش المرء من أن الجميع يعيشون وكـأن أحد منهم لم يعرف- شيئا عن الموت. وهذا هو لأنه ليس هناك في الواقع تجربة للموت"[22]. إذن ليس لما نعيشه أي معنى، ومغامرة رحلتنا في هذا العالم باطلة ولا جدوى من ورائها، وهذه أصعب مهمة قد يواجهها الإنسان؛ أن يتعايش مع فكرة موته الخاص؛ أي إنه سينهي إلى العدم، في حين أن العالم سيستمر من دونه، وهذا ما وضحه ألبير كامو على لسان بطل رواية الغريب (مورسو) الذي تولدت لديه مجموعة من الانفعالات والمشاعر العنيفة في لحظة اقترابه من حافة الموت، "سأموت اذن أكثر شبابا من آخرين، هذا بين بنفسه. لكن الجميع يعلم أن الحياة لا تستحق أن تعاش. وفي قراراتي ما كنت أجهل أن الموت في الثلاثين أو الستين لا يشكل فرقا، ما دام في الحالتين سيستمر رجال ونساء آخرون في الحياة، وسيدوم هذا آلاف السنين"[23]. "ما كان يشوش قليلا على استدلالي، آئند، هو ذاك الاهتياج الذي كنت أحسه بداخلي كلما فكرت في العشرين عاما القادمة"[24]، فحينما يواجه الإنسان الموت يدرك حقيقة وجوده العبثي والرتيب، فيستيقظ لديه إحساس بالغربة عن الآخرين الذين كانوا يعيشون معه ويحيطون به ولا ينتبه إليهم، لدرجة أنه يتمنى الموت أمامهم، كما يقول في نفس الرواية (الغريب) على لسان بطلها: "حتى يكتمل المشهد، حتى أحس نفسي أقل وحدة، بقي لي أن أتمنى شيئا واحدا: أن يحضر إعدامي جمع غفير، وأن يستقبلوني بصرخات حقد"[25].
سبل الانعتاق من العبث
كيف يمكننا الاستمرار في العيش في ظل هذه الحياة الرتيبة والمملة، والتي لا جدوى منها؟ هل معرفة العبث معرفة عقلية يؤدي إلى الانتحار؟
إن هذه الحالة التي يسميها كامو الوعي الذاتي بالعبث، وهي حالة تواكبها حالة أخرى في أعماق هذا الإنسان، وهي حالة الثورة أو التمرد بلغة كامو، وتتم الثورة على هذا العبث من خلال ما يلي:
الانتحار الجسدي
يبدأ ألبير كامو كتابه "أسطورة سيزيف" بسؤال فلسفي وجودي عميق، كثيرا ما نوجهه إلى أنفسنا في لحظات نادرة من حياتنا: هل تستحق الحياة أن نحياها؟ "هناك مشكلة فلسفية هامة وحيدة، هي الانتحار. فالحكم بأن الحياة تستحق أن تعاش، يسمو إلى منزلة الجواب عن السؤال الأساسي في الفلسفة"[26]، من هذا المنطلق يوجه البير كامو نقدا لاذعا للفلسفة، فهو لا يبالي بالأسئلة الميتافيزيقيا التي طرحها الفلاسفة منذ القدم من قبيل من نحن؟ من أين جئنا؟ ما مصيرنا...؟ لذلك فكامو اهتم أساسا بمشكلة الوجود والمعنى، وهنا تنبثق مشكلة الانتحار بوصفها من أخطر المشكلات وأكثرها جدية. إن كل ما عداها من مشكلات مثل السؤال عما إذا كانت الأرض تدور حول الشمس أو العكس، وعما إذا كان عدد المقولات خمسا أو ستا، لا تستحق السؤال عنها؛ لأنها لا ترتبط أساسا بالسؤال الجوهري: هل تستحق الحياة أو لا تستحق العيش؟ "لم أر أحدًا مات من أجل الكينونة. فغاليليو الذي عرف حقيقة علمية ذات أهمية عظيمة، تخلى عنها بكل سهولة في اللحظة التي هددت فيها حياته. وبمعنى من المعاني، نجد أنه حسنا فعل، لم تكن تلك الحقيقة لتستحق المشنقة، فكون الأرض تدور حول الشمس أو الشمس تدور حول الأرض هو من الأمور التي تتصف بأعمق اللا اكتراث"[27]، إذن السؤال عن معنى الحياة سؤال جدي بامتياز ولا يضاهيه أي سؤال آخر، ومن تم كان كامو ضد مجموعة من الفلاسفة والشعراء الذين يمتدحون الانتحار، لكنهم أجبن من أن يمارسوا ما يفكرون فيه (فعل الانتحار). "مثل شبنهاور الذي كان يمتدح الانتحار وهو يجلس إلى مائدته الحافلة بأشهى ألوان الطعام والشراب"[28]، ومن هنا، فالخلاص الذاتي أو الانتحار الجسدي قد يكون حل للهروب من اللاجدوى، لكن يرفضه ألبير كامو بشكل مطلق، فحسب كامو هو حل جبان لا ابتكار فيه، بل أكثر من ذلك هو أكثر عبثا. "ينطوي الانتحار على قدر من التناقض هو في نهاية الأمر هروب من المشكلة وليس حلا لها"[29].
الانتحار الفلسفي Le suicide philosophique
وهذا النوع من الانتحار في رأي كامو هو موقف الفلاسفة الوجوديين من قبيل كيركيغارد وهيدجر وياسبرز...إلخ. لقد أعجب كامو بالفيلسوف كيركيغارد، بل إنه يكن له كل معاني الحب التقدير والاحترام، بصفته أول من أحس بالفزع من عبثية الوجود وعاشها، "كان كيركيغارد أول من أحس بالفزع أمام محالية الوجود وأول من عاشها وعبر عنها. إنه يقول في مذكراته اليومية لعام 1839: إن الوجود كله يفزعني بالقلق، ويؤلمني..."[30]، لكن يبقى العبث الذي عبر عنه كيركيغارد يأخذ معنى دينيًّا على خلاف العبث الكاموي الذي يرفض الدين المنافي للعقل والمنطق.
"ولكي أحصر نفسي بالفلسفات الوجودية، فإنني أجد أنهم كلهم بدون استثناء، قد اقترحوا خلاصا. فبالتعليل الغريب، مبتدئين باللاجدوى على خرائب العقل، وفي كون مغلق محصور بما هو بشري، نجدهم يؤلهون ما يسحقهم ويجدون سببا للأمل فيما يفقرهم؛ وذلك الأمل المفروض هو ديني فيهم جميعا"[31]، وبالتالي فإن كامو يرفض الأمل الذي يشعر به الإنسان مثلا حينما يؤمن بعالم آخر وبحياة بعد الموت كخلاص يمكن أن يردع الإنسان عن الانتحار، ويحقق نوعا من الطمأنينة من الناحية السيكولوجية، وسيكون الثمن غاليًا، حيث يتم التنازل عن العقل لصالح الدين، وهذا هو الانتحار الفلسفي، "هذه القفزة التي يقفزها كيركيغارد من المحال إلى المرحلة الدينية هي التي يسميها كامو بالانتحار الفلسفي؛ لأنها تعلو على المحال الذي يريد هو أن يصمد فيه، وتنكر العقل الذي يظل وفيا له."[32]
"وكيركيغارد المفكر الديني حاول التغلب على العبث بإنكار الطريقة الوحيدة التي جعلته يدرك هذا العبث ويعيه، وهو العقل الإنسان ي ذو المدى الضيق والقدرة المحدودة."[33] وعليه فكامو يرفض إلى جانب الانتحار الجسدي الإيمان بالغيبيات ووعود إلى ما بعد الموت من حيث إنه يماثل ذلك الانتحار، من حيث أنه انتحار عقلي أو ما يسميه الوثبة الميتافيزيقيا، "ولا يقبل كامو هذا المنهج؛ لأنه يريد أن يتعامل مع العبث في الوقت الذي يبقى فيه على الوسائل التي ساعدته على إدراكه والوعي بوجوده."[34]
إذن يبقى الانتحار سواء كان جسديًّا أم فلسفيا حلا زائفا ولا يخرج الإنسان من أزمة العبث؛ لأنه لا يصدر عن رفض أو تمرد؛ فالمنتحر يترك هذا العالم معزيا نفسه بأنه سيعثر وراءه عن غاية أو معنى لم يجدهما فيه.
الحرية
إن الحديث عن الحرية هنا مع كامو ليس بالمعنى الفلسفي كمشكلة نظرية ميتافيزيقية، بل يبحث عن موقف عملي ظاهري للحرية، "إن معرفة كون الإنسان حرا أو غير حر، أمر لا يهمني. أستطيع فقط أن أجرب حريتي أنا"[35]؛ إذ لا يمكن بحسب كامو تأسيس الحرية على المستوى الميتافيزيقي؛ لأن ذلك يعود بالضرورة إلى الله، الأمر الذي يكون نفيا للحرية برأيه. لذلك ينبغي أن نجرب هذه الحرية فعليا "إن مشكلة الحرية بذاتها هي مشكلة لا معنى لها؛ لأنها مرتبطة بطريقة مختلفة بمشكلة الله."[36] فالحرية بهذا المعنى، لا تقوم على أساس وجود الله والإيمان بهذا الوجود؛ لأن ذلك سيؤدي إلى المفارقة التي يصعب حلها "فنحن إما أن نكون غير أحرار، وأن يكون الله القوي القوي مسؤولا عن الشر، أو أن نكون أحرارا ومسؤولين، ولكن الله ليس قويا قويا."[37]؛ ذلك أن الحرية تقوم على أساس أنطولوجي لا نعرف عنه أي شيء، تنبثق في اللحظة التي يعي فيها الإنسان وجوده؛ فبما أن كل شيء يبدأ بالوعي اليقظ والإدراك، فإن الحرية أيضا تبدأ من صحوة الوعي "والعودة إلى الإدراك؛ أي الخلاص من نوم الحياة اليومية، تمثل الخطوات الأولى نحو الحرية اللامجدية"[38]، وبالتالي فإدراك الإنسان لعبثية الوجود والموت المحتوم يحرره من كل القيود؛ لأنه لم يعد يعبأ بماهية هذا العمل لعلمه بمصيره المحتوم، وأن كل شيء ينتهي بموته، ومن هنا تنبع الحرية الحقيقية "هنا يتضح أن الموت والتفاهة هما مبادئ الحرية الوحيدة المعقولة"[39].
التمرد
يعدّ مفهوم التمرد من أبرز المفاهيم التي ركز عليها ألبير كامو في فلسفته لمواجهة عبثية ولا معقولية هذا الوجود، وأعلن عن تمرده في كتابه "الإنسان المتمرد" L’homme révolté الذي صدر سنة 1951، مؤسسا كوجيطو جديد على غرار الكوجيطو الديكارتي "أنا أتمرد إذن نحن موجودون". ويلخص هذا الكوجيطو أن من شروط التمرد عند كامو أن يكون جماعيًّا يجلب منفعة للمجتمع ككل، عكس الكوجيطو الديكارتي المنغلق على ذاته، حيث تكون "الأنا" منطلقه ومنتهاه، وهذا ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: من هو الإنسان المتمرد عند كامو؟
المترد هو الإنسان الثائر والرافض للوضع الذي عليه "من الإنسان المتمرد؟ إنه إنسان يقول: لا. ولئن رفض، فإنه لا يتخلى"[40].
وفي هذا المستوى يميز ألبير كامو بين شكلين من التمرد: التمرد بوصفه تجربة شخصية أو ما يسميه بالتمرد الميتافيزيقي، والتمرد على وضع الإنسان الاجتماعي بصفته عبدا، أو ما يسميه بالتمرد التاريخي.
- التمرد الميتافيزيقي: هو تمرد الإنسان على المواقف القاسية التي عاناها في حياته، كما يتمرد العبد على سيده الذي يضطهده، تم تمرد على الغيب وعلى المصير الظالم الذي كتب له فيه الشقاء، "التمرد الماورائي هو الحركة التي بواسطتها يثور إنسان ما ضد وضعه، وضد الخلق كله. إنه ما ورائي؛ لأنه ينكر غايات الإنسان والخلق."[41]
يختلف العبد المتمرد عن المتمرد الميتافيزيقي من حيث إن العبد لا يستطيع أن يتحمل المعاناة التي يفرضها عليه سيده إلى آخر مدى؛ لأنه لابد أن يأتي وقت ويطالب بحقوقه، وهو بذلك لا يلغي وجود السيد، بل يطالب بالمساواة معه. أما المتمرد الميتافيزيقي، فهو يتمرد ضد وضعه كإنسان له الحق في الاختيار وتقرير مصيره بنفسه "العبد المتمرد يحتج ضد الوضع المخصص له من حالته. أما المتمرد الماورائي، فيحتج ضد الوضع المخصص له كإنسان"[42]، وفي القراءة التاريخية للتمرد الميتافيزيقي حسب كامو، يستعرض مجموعة من المتمردين والثوار كبروميثيوس الثائر على الإله زيوس، "لكننا لا يمكن أن ننسى أن بروميثيوس حامل النار، الحد الأخير في الثلاثية الاسخيلية، بشر بسلطان التمرد الذي نال الغفران، ...إن متمردهم لا يثور ضد الخلق كله، بل ضد الإله زوس فقط."[43]، ويعتبر أيضا الماركيز دو ساد واحدا من أكبر الثوريين الميتافيزيقيين في التاريخ "إن ساد لا يستخلص من التمرد سوى الرفض المطلق."[44]
- التمرد التاريخي: يسميه أيضا كامو الثورة، يرفض ألبير كامو هذا النوع من خلال استقرائه للتاريخ، فموقفه إزاء الثوريين، على اختلاف نزعاتهم موقف تشاؤمي وسلبي، فهو يرى أن يحاولوا تجسيد الآمال الثورية في الحرية، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل، بل وأكثر من ذلك، إن هذه الثورات لم تولد إلا الإرهاب والطغيان "الحرية، هذا الاسم الرهيب المكتوب على مركبة العواصف هي مبدأ الثورات كلها."[45] يبدأ كامو بتحليله للتمرد السياسي تاريخيًّا من تمرد "سبارتاكوس" في روما؛ ذلك العبد الذي تضامن مع غيره من العبيد المقهورين، فأسسوا جيشا وطالبوا بإلغاء التفرقة بينهم وبين السادة المتغطرسين، وحققوا نتائج مهمة، ومع ذلك فقد فشلتهم ثورتهم. "إن تمرد سبارتاكوس يوضح دائما مبدأ المطالبة المذكور، فجيش العبيد يحرر العبيد، ويدخل فورا أسيادهم القدماء تحت نير عبوديتهم"[46]. إن التمرد السياسي تاريخيا يتمسك بقيم عليا مستقبلية، وهذا ما يطلق عليه نيتشه العدمية، وهذا الموقف يحيد عن التمرد الحقيقي الذي يرف فيه التمسك بأي مثل عليا لم توجد بعد. وبالتالي فالتمرد الذي يدعو إليه كامو تمرد ضد القتل والطغيان "شعر كامو بأن دراسة هذه المواقف بشكل نقدي قد أصبح ملحا، في عالم أصبح فيه القتل المدروس أمرا شائعا."[47]
وعليه، فإن فعل التمرد بمقتضى الحرية التي يمتلكها الإنسان، الشيء الذي يضفي على عبثية وجودنا معنى، تماما كما حصل مع سيزيف الذي قاوم مصيره وتمرد عليه باستمراره في رفع الصخرة صعودا نحو القمة، لذلك ينبغي أن نتخيل سيزيف سعيدا، وأيضا كما فعل أيضا الدكتور (ريو) بطل رواية الطاعون الذي ظل يتحدى المرض، ويحاول أن ينتزع من بين مخالبه أكبر عددا من الأحياء، رغم علمه بأن كفاحه قد لا يجدي نفعا؛ لأن الطاعون أقوى وبالتالي سينتصر عاجلا أم آجلا.
على سبيل الختام
إن فلسفة كامو تحاول أن تبرز الحقيقة الوجودية للبشر التي لا مفر منها، وهي عبثية هذا الوجود الرتيب؛ وذلك من أجل التكيف معها والتمرد عليها، وليس الانسحاب والهروب من هذه العبثية، كما فعل سيزيف؛ لأن حياتنا تشبه إلى حد كبير ذلك الشقاء الذي حكم به على سيزيف؛ بمعنى ذلك الروتين اليومي الذي نعيشه وتلك الأعمال التي نقوم بها ونكررها كل يوم بلا جدوى، بل ربما أكثر تعاسة من سيزيف؛ لأنه حكم علينا أن نحيا هذا العبث حتى الموت، لكن الأهم هو ألا نستسلم وأن نتشبث بالحياة، من خلال تقبل قواعد اللعبة العبثية التي فرضت علينا مند أن قدف بنا في هذا العالم.
إن المخرج من أزمة العبث بحسب كامو هو الحفاظ على علاقة التوتر الموجودة بين الإنسان والعبث؛ وذلك من خلال مواجهة هذه العبثية والاستمرار في العيش بشكل بطولي سيزيفي.
إن كامو يحاول إنقاذ البشرية من هذه العبثية القاتلة التي تهدد الوجود الإنساني؛ لأن كامو كان متشبعا بالإنسانية التي جعلته يقف عند أهم المحطات الحياتية ويقف موقفا سليما بعيدا عن الانتحار والتمرد السلبي والقتل. لذلك، ينبغي أن نتخيل سيزيف سعيدا دائما وأبدا.
المراجع والمصادر
ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، 1983.
موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة سارة اللحيدان، 2019
عبد الغفار مكاوي، البير كامي: محاولة لدراسة فكره الفلسفي، مؤسسة هنداوي، 2022.
جون كروكشانك: ألبير كامي وأدب التمرد، ترجمة جلال العشري، الهيئة المصرية العامة للكاتب، القاهرة مصر، 1986.
ألبير كامو، الغريب، ترجمة محمد آيت حنا، منشورات الجمل،2015.
ألبير كامو، الإنسان المتمرد، ترجمة نهاد رضا، منشورات عويدات بيروت/ باريس، ط، 3، 1983.
[1] موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة سارة اللحيدان، 2019، ص3.
[2] الرجع نفسه، ص4.
[3] البير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ص 36.
[4] البير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ص21.
[5] المرجع نفسه، ص 21.
[6] مفهوم استعمله عبد الغفار المكاوي كترجمة للكلمة الفرنسية L’absurdre بدلا من كلمة العبث الشائعة.
[7] عبد الغفار مكاوي، البير كامي: محاولة لدراسة فكره الفلسفي، مؤسسة هنداوي، 2022، ص20.
[8] جون كروكشانك: ألبير كامي وأدب التمرد، ترجمة جلال العشري، الهيئة المصرية العامة للكاتب، القاهرة مصر، 1986، ص6.
[9] المرجع نفسه، ص 5.
[10] المرجع نفسه، ص، 78.
[11] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ص21.
[12] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ص، 19.
[13] المرجع نفسه، ص، 21
[14] المرجع نفسه، ص، 23
[15] ألبير كامو، الغريب، ترجمة محمد آيت حنا، منشورات الجمل،2015، ص، 7.
[16] [16] المرجع نفسه، ص، 23
[17] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ص، 36.
*سيزيف الذي ذكرناه كثيرا لابأس أن نعرفه، هو واحد من أشهر الشخصيات بالمكر والخداع حسب وصف الميثولوجيا الاغريقية، حيث تمكن من خداع اله الموت مما أغضب كبير الآلهة زيوس، فعاقبه بحمل صخرة من أسفل الجبل إلى قمته، فأصبح رمز العذاب الأبدي.
[18] المرجع نفسه، ص22.
[19] المرجع نفسه، ص22.
[20] المرجع نفسه، ص، 23.
[21] المرجع نفسه، ص، 23.
[22] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ص، 23.
[23] ألبير كامو، الغريب، ترجمة محمد آيت حنا، منشورات الجمل،2015، ص، 131.
[24] المرجع نفسه، ص، 131.
[25] لمرجع نفسه، ص، 141.
[26] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ترجمة أمين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ص، 11.
[27] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ص، 12.
[28] عبد الغفار مكاوي، البير كامي: محاولة لدراسة فكره الفلسفي، مؤسسة هنداوي، 2022، ص، 43.
[29] جون كروكشناك: ألبير كامي وأدب التمرد، ترجمة جلال العشري، الهيئة المصرية العامة للكاتب، القاهرة مصر، 1986، ص 102.
[30] عبد الغفار مكاوي، البير كامي: محاولة لدراسة فكره الفلسفي، ص، 48.
[31] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ص، 41.
[32] عبد الغفار مكاوي، البير كامي: محاولة لدراسة فكره الفلسفي، ص،49.
[33] جون كروكشناك: ألبير كامي وأدب التمرد، ص، 102،(بتصرف).
[34] المرجع نفسه، ً 102.
[35] [35] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ص،65.
[36] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ص،65.
[37] ألبير كامو، أسطورة سيزيف، ص،66.
[38] المرجع نفسه، ص، 69.
[39] المرجع نفسه، ص، 69.
[40] ألبير كامو، الإنسان المتمرد، ترجمة نهاد رضا، منشورات عويدات بيروت/ باريس، ط، 3، ص، 18.
[41] المرجع نفسه، ص، 32.
[42] المرجع نفسه، ص، 32.
[43] لمرجع نفسه، ص، 37.
[44] لمرجع نفسه، ص، 43.
[45] لمرجع نفسه، ص، 135.
[46] لمرجع نفسه، ص، 140.
[47] موسوعة ستانفورد للفلسفة، ترجمة سارة اللحيدان، 2019، ص،20.






