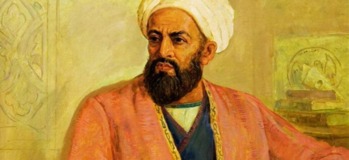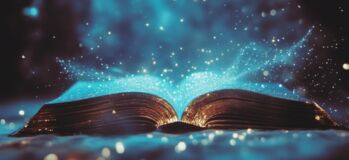لقاء حواري مع الدكتور خالد كموني حول مجمل أعماله الفكرية
فئة : حوارات

لقاء حواري مع الدكتور خالد كموني حول مجمل أعماله الفكرية
حاوره د. حسام الدين درويش
"العلاقة بين اللغة والفكر لا يمكن إلا أن تبدأ من الراهن"
د. حسام الدين درويش:
مساء الخير، ويسعد أوقاتكم جميعًا في لقاء جديد من سلسلة لقاءات "مؤمنون بلا حدود"، من مقرّ المؤسسة في بيروت. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتور خالد كموني، الصديق العزيز، فهو صديق المؤسسة، وصديق شخصي أيضًا، في لقاء نخصصه للحديث عن مجمل فكره، وعن أعماله المنشورة وغير المنشورة.
الدكتور خالد كموني أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية. باحث في فلسفة اللغة والتأويل وقضايا الفكر المعاصر. له عدد من الكتب والدراسات، آخرها كتاب "ما الذهنية؟" (الصادر عن بيت الفلسفة في الفجيرة- الإمارات العربية المتحدة). وهو عضو في عدد من الحلقات الفلسفية والبحثية، مثل "حلقة الفجيرة الفلسفية"، وهو رئيس "وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي"، وعضو الهيئة الإدارية في "الاتحاد الفلسفي العربي". وسنتناول خلال هذا اللقاء ثلاثة من كتبه، مع الإشارة إلى أعمال أخرى، فضلًا عن أبحاث متعددة نشرها في هذا المجال. "مئة أهلاً وسهلاً بك، دكتور خالد".
د. خالد الكموني:
أهلًا وسهلًا بك، وأهلًا بالجميع.
د. حسام الدين درويش:
دعنا نبدأ مباشرة. كان لدينا لقاء مع السيد الوالد، الدكتور سعد، وسأبدأ بما انتهينا إليه. كان الحديث عن مدى التأثير والتأثر، المتبادلين، بينك وبينه؛ حيث يبدو لمن ينظر من بعيد أنكما تسيران في مسارٍ فكريٍّ واحدٍ تقريبًا. فما طبيعة هذا التأثير أو التأثر، عمومًا وبالتفصيل؟ ويمكن أن تكون مسألة اللغة منطلق حديثنا ومحوره. فالدكتور سعد مختص في اللغة العربية، وفي أبحاثك الفلسفية، أنت أيضًا، اللغة محور أساسي، وربما هي المحور. فلنتحدث إذن عن هذه المسألة: التأثير والتأثر، ومسألة اللغة خصوصًا؟ تفضل.
د. خالد كموني:
شكرًا جزيلًا، وكلّ السرور والسعادة بالحوار. ومن خلال هذا الحوار، أعود إلى الحوارات الأولى مع الوالد. مسألة اللغة كانت مسألة التربية نفسها. تربَّيت لُغويًّا؛ أي كانت القضية أن تعرف مسألة لغوية، أو إعراب كلمة في اللغة، أو استخدامًا لغويًّا معينًا، فهي من مكونات الشخصية. وخاصة عندما يكون الشاب أو الطفل صغيرًا، ويصطحبه والده إلى أمسيات شعرية، أو لقاءات حوارية، وما إلى ذلك، فتشعر أنك بحاجة إلى أن تفهم ما يُقال، بل إن ما يتيح لك الشعور بوجودك هناك هو انك تدرك ما تسمعه.
وأيّ سؤال كنت أطرحه بعد هذه الندوة على والدي، كان يفتح بابًا للحوار، ويفتح نقاشات عميقة في قضايا كبرى، ومجمل هذه النقاشات كان الوالد، ولا يزال، يفتحها على مصراعيها، إذ لا شيء يحسم فيه الجدل، أو ينتهي برأي قاطع. فهو لا يكتفي بالإجابة، مأن تسأل مثلًا: ما هذه؟ فيقول: وردة. بل يجيبك بما يجلبُ إلى مخيالك معنى الشِّعر، مثلًا. لذلك أنت بحاجة لأن تفهم مفهوم الوردة بحسب ما يريدُ هو من انفتاح يتيحه لك في مثل هذه الجلسات. وكان يتعامل مع الأمر بهذه الجديّة، إلى درجة أنَّ تكوين الشخصية كان تكوينًا لغويًّا. بمعنى: وصلتُ إلى لحظة كانت اللغة فيها هي التي فتحت أمامي السؤال الفلسفي. فاللغةُ مجالٌ يقدِرُ فيه الإنسانُ مواكبةَ وعيه لذاته وهي تتعرَّف، إنها المجال المرئي للفكر، إذا ما تحولت إلى لحظة وعي دائم.
هذه اللحظة هي الحدثُ الدائم في حياتي، إذا ما أردتَ أن تعرف لماذا ولجتُ الهجسَ الفلسفي من مضارب اللغة. أما اللحظة المعيشة لابتداء درس الفلسفة، فكانت عندما سألته مرة: "هل يوجد في الجامعة تخصص يتناول الفلسفة؟" وكان سؤالي بسيطًا في تلك الفترة، وقد كنت تلميذًا في المدرسة، فأجابني: "نعم، الفلسفة".
وكان هذا المسار الذي اخترته بشغف، لدرجة أنه لم يقبلْ حتى أن أدرسَ الفلسفة في فرع كلية الآداب القريب من بلدتنا، بل قال: "إذا أردتَ الفلسفة، فعليك أن تذهب إلى العاصمة، إلى بيروت، وتدرسها هناك."
سألته: "لماذا؟" فقال لي: "لأنك لا بد أن تنشغل كليًّا بالدرس." ما اكتشفته أيضًا هو أن التربية على الانفتاح كانت تربية على المغامرة والتأمُّل في الأفق الأوسع للعيش. السؤال الممكن أن يولِّدَ لغةً مختلفة، هو ما أثاره لدي اختيار والدي: أن تكون في مجتمع مديني، لتتفلسف. وقد ذكرت هذه المسألة في إحدى المقالات، بأن الفيلسوف مدني، وحين يتفلسف يظهر مدنيته، وليس توحُّشَه أو غربته عن المجتمع الأوسع. في هذا سياق هذه التربية، كانت اللغة المجال الذي إليه انتميت، لأحدِّدَ انتماءات وهويَّات ارتبطُّ بها أو جادلتُها وفكرتُ فيها وبها أحيانًا. وقد تبيَّنتُ في ما بعد أن أي مسألةٍ لا يمكن أن تتكلم فيها بشكل يفصِّلُ إشكاليتها ومثاراتِها، إلا بلغةٍ سليمةٍ تفي بالغرض. والآن أقول كل مشاكلنا السياسية والاقتصادية والأخلاقية والعلمية والمعيشية كافَّة، سببٌ أساسٌ فيها سوء علاقتنا بلغتنا؛ فلو أننا نقيم اعتبارًا للغتنا في تحديد علاقتنا بالكون، لكان لنا دورٌ مؤثرٌ في وضع أنفسنا في مقامها، أي في الإقامة النافعة في هذا العالم. وهذا ما أصرُ عليه في كل كتبي.
د. حسام الدين درويش:
سنتحدث عن الكتب لاحقًا، لكن دعني قبل ذلك أبدأ ببعض المداخل العامة، وأتحدث عن العلاقة العامة بين اللغة والفكر. فهل اللغة مجرد أداة للفكر يعبّر بها عن ذاته؟ أم إنها هي الفكر في حالة كمون، إلى أن يُعبَّر عنه في حالة صريحة؟ هل يمكن للغة، بمعنى ما، أن تكون بيتًا للكينونة أو للوجود، كما قال هايدغر، وتكون، في المقابل، عائقًا أيضًا؟ فنحن نتحدث أحيانًا عن اللغة بوصفها عائقًا، وعن ضرورة تحريرها. السؤال العام: ما رؤيتك للعلاقة العامة بين اللغة والفكر عمومًا؟ وبعدها يمكن أن نتحدث عن الفكر الفلسفي بشكل خاص.
د. خالد كموني:
العلاقة بين اللغة والفكر لا يمكن أن تبدأ إلا من الراهن: إشكالية الفكر المعيش عندما يتعارض مع لغة الفكر السائدة. فإذا قبلتَ السائد كما هو، ستصبح كائنًا ذا فكر هجين؛ يعني مشكلتنا اليوم ليست في انعدام التفكير، ولكن في أن التفكير الذي نتداولُه لاإراديًّا أحيانًا، بما يسقط عنه ماهية التفكر نفسها، لا يفي بحاجات وجدانية لدى الفرد. أن تفكِّر بلغة غيرِك، أو تفكر بلغة لا تكفي لشرح وجدانك أو تواصلك الصريح، يؤدي بك إلى شعور بالنقص الدائم. هذا الشعور بالنقص يؤثر في كل جوانب العيش الكريم، وصولًا إلى الهم الوجودي عينه بالحضور القوي في العالم.
لو تحدثنا عن العلاقة بين اللغة والفكر، مثلاً على الصعيد السياسي أو على الصعيد الاجتماعي، لا يمكنك أن تفكر من دون لغةٍ تستطيع من خلالها أن تواكب الحدث؛ بمعنى أن تملك القدرة على أن تصنع أنتَ بنفسِك الحدث. ولستُ هنا بصدد بحث الإشكال المتوارث في الدرس اللساني، أعني أسبقية الفكر للغة أو العكس، بل ما أحدِّدُ وجهتي إليه هو العلاقة بين النفس ولغتها، فإذا كانت لغة المرء سيئة، كما الخطاب السياسي الحالي عندنا مثلًا، كأن نرى السياسيين لا يعرفون التعبير سوى باللهجة العامية أو لديهم رطانة في الكلام لا تجعلهم في مستوى أن يبتكروا موقفًا في أوانِه. فالسياسي من هذا النوع الوضيع لا يقدر أن يوصِل خطابه إلى مواقع القرار، وبالتالي لا أحد يحترم خطابه. لذا إنَّ الحضور اللغوي حضور شخصي أولاً، والحضور باللغة هو الذي ينسحب على أمور الحياة كافة. إذا لم يكن لديك حضور بلغتك، معنى ذلك أنه ليس لديك علوم تستدعي خطابَك للظهور أمام الناس. فما الحاجة للغتك الآن، إذا لم يكن من مكوناتها أي شيء من الحاضر؟
فإذا فارقت اللغةُ حاضرها انقطعت، وهذا ما يحجب عنك القوة والإرادة. لذلك، التنازل اللغوي المجاني، وهو ما يحدث الآن، يؤدي بكل بساطة إلى سطحية، سطحية قصدية، يعني تسطيحًا للفكر بشكل أنه لم تعد هناك مقبولية لأي خطاب فصيح، كما حلَّ بالخطاب الأدبي أو الخطاب الفلسفي في الأوساط الثقافية عينها؛ فأنا لا أتكلم عن أوساط عامية. يعني، تخيل أن تجد "مثقفين وأساتذة" يستصعبون كلامَك. ماذا يعني مثلاً أن تجد بين "مفكرين" من يقول لك: لغتك صعبة؟ ترى، ما الصعب في هذه اللغة؟! إن القارئ الذي يقول لك: لغتك الفلسفية صعبة، هو بكل بساطة ليس مطّلعًا لغويًّا، أو لا تعمُّق لديه في اللغة. وأكثر من ذلك، لو تطرَّقنا إلى اللغة في حالة التعليم: هل يُعقل، في أي بلد في العالم، ألّا تُدرَّس العلوم باللغة التي يتحدث بها الناس منذ الصفوف الأولى، بشكلٍ يجعلها لغة ثقافة، لغة وجدان؟
هذا ما يجب أن نهتم به: الوجدان، يعني شاعريّة الإنسان، حضوره الأخلاقي في هذه الحياة. إذا لم نهتم بهذه الشخصية، وهذا ما تحدثتُ عليه في الجانب التربوي، يعني أننا سنصل إلى مراحل قاسية من عيش اللافهم والغموض الدائمين. أنت عندما تقول لفظة معيّنة، كأن تقول لفظة "حب" مثلاً، ويمكن أن تستخدم "عشق، هيام، غرام، ..."، ويمكن أن تستخدم أكثر؛ يعني كل ما أقصده أن هذا التوسع، أو الحقل الدلالي لخطابك، لن يتوسع إلا إذا تعلّمتَ لغتك، وإلا إذا كانت العناية باللغة هي المشروع الفعلي للتعليم والتربية.
د. حسام الدين درويش:
بدا لي من خلال كل حديثك أن اللغة أقرب إلى الأداة التي نتعلمها لنعبر عن أفكارنا؛ وكلما اغتنت مفرداتنا أكثر، أصبحنا أكثر قدرة على التعبير. طبعًا، هناك رؤية ثانية أن اللغة ليست أداة فقط، وأنا أميل إليها جزئيًّا، على الأقل. ويمكن أن ننتقل إلى الرؤية الثانية من خلال علاقة اللغة بالفلسفة. اللغة بالنسبة إلى الفلسفة ليست مجرد أداة تعبير، وإنما هي، أيضًا، موضوعها. فأنت لا تفكر بالكلمات فقط، بل تفكر فيها أيضًا. ومن خلال اللغة يُفكَّر فيك. ففي اللغة، لغتنا، ثمة فكر غير مفكر فيه. ولهذا السبب، نكتشف، أحيانًا، أننا نقول أشياء لم نقصدها؛ بمعنى أن اللغة تقول ما لا نقوله. فإذا خرجنا عن كون اللغة أداة، وضمن علاقتها بالفكر بشكل عام، وفي الفلسفة بشكل خاص، بأيّ معنى لا تكون اللغة مجرد أداة؟
د. خالد كموني:
العلاقة بين اللغة والفلسفة متعلقة بعلاقة المتفلسف بذاته. فهو من يصنع هويته بكل صراحة بلغته؛ مثلًا، لماذا تجد للمفهوم الفلسفي فهومات متنوّعة، أو قراءات متعددة؟ لأن كل واحد يقرؤه بما يمتلك من قدرات لغوية وكفاءة في إخراج هذا المصطلح مجدِّدًا في الوضعية الفلسفية التي يفرضها السؤال المتذهَّن عنده. لذلك، العلاقة بين اللغة والفلسفة علاقة تجديد دائم، علاقة تتناسل منها المفاهيم الجديدة. اللغة هي الهوية الوحيدة الممكنة. ولغة الفلسفة، في هذا الجانب، هي الشخصية الحقيقية للفلسفة في أوانها، في راهنيّتها. فعندما نسأل عن الفلسفة اليوم عربيًّا، فإن ما نعنيه هو هذا الانهمام بقولٍ يؤكد حضورية اللغة العربية في الاشتغال الفلسفي الراهن؛ إذ بذلك يبرزُ ما يستأهل البروز في تفكُّرنا الفلسفي.
كان أستاذي موسى وهبة يقول: "أنا أتحدث الفلسفة بالعربية ليس لأجل العربية، بل لأجل الفلسفة". ما المقصود من ذلك؟ نعم، هو لأجل الفلسفة. لماذا استخدم اللغة؟ لأجل الفلسفة، ولأجل أن ينتج فهمه، مثلاً، للمفهوم الكانطي حول العقل المحض، حول الشروط القبلية للمعرفة، بلغته هو، التي ستُنتِج مفهومًا فلسفيًّا يعبِّر عن حضوره هو مع النص الكانطي، حضوره هو في هذا النص الفلسفي. لذلك، اللغة والفلسفة صنوان في لحظة الإبداع، والفلسفة مطالبة بعدم التكرار، ومطالبة بالغرابة، شرط ألا تُخالف سيرورة المفهوم في استحضاره؛ لذلك يكون وعي اللغة هو أداءُ المفهوم في الواقع.
وهنا نصل إلى العلاقة بين الفلسفة والترجمة في يومنا. ما الإشكالية في الفلسفة عندنا؟ أحيانًا تبدرُ من سوء الترجمة، إذن سوء اللغة. ما الترجمة؟ ليست حالة نقلٍ من لغة إلى لغة فحسب، بل هي، في الفلسفة، حالة استكمال التفلسف باللغة المنقول إليها. فما بدأه فيلسوفٌ، ولو في أي جهة من الأرض، أنا أريد أن أستكمله عندما أتقصَّد ترجمته إلى لغتي. لذا لا بد من استكماله بطريقة قويمة، تتيح إبراز سمات الإبداعية والفرادة والبراعة. هذه القوامية أو مشروعية قولي أنا فلسفيًّا الآن، هي مشروعية استخدامي للغة، وتوظيف هذه اللغة بالشكل الذي تحتاجه هذه اللحظة الراهنة.
إذن، اللغة لا يمكن أن تفارق اللحظة الفلسفية، وبالتالي، الفلسفة هي التي تُنمّي اللغة؛ لأنها توثق الصلة بين الفكر والواقع الراهن. فالفلسفة لا يمكن إلا أن تكون فلسفة علم ما، وبالضرورة فلسفة علم حاضرٍ، إذا كانت مواكبةً للإنسان اليوم. لماذا؟ لأن اللغةَ تحيا بتجدُّد العلوم، فاللغة تنمو بالعلم، وهذا ما ينعكس على الفلسفة التي تتيحها هذه اللحظة المولِّدة للتفكر والتأمل الفلسفيين. لماذا نقول: تخلّفت اللغة؟ لأنها لا تحكي علمًا. لذا لا تقدر أن تنبت فلسفةٌ دون التفكر بعلم الكون، ووعي هذا التآثُرِ بين الفكر واللغة والكيان البشري الذي يحيا بالعلوم التي ينتجها كلما تفكَّر وأحدث تقانةً توثِّق الصلة بينه وبين محيطه.
د. حسام الدين درويش:
يبدو لي – وأرجو أن تُخبرني إن كنت مخطئًا - أنك عندما انتقدت من يستصعب فهم بعض النصوص، كنت بصدد "الدفاع عن ذاتك"؛ بمعنى أن هناك من استصعبَ قراءة بعض نصوصك، وكان هذا ردّك عليهم. ولأسباب معرفيةٍ وأخلاقية، سأحاول الدفاع عن المجهولات والمجهولين الذين كنت تردّ عليهم. هل من الضروري، بالفعل، التعقيد والصعوبة لكي يُعبّر الفكر عن ذاته؟ مثلاً، لدينا نصوص أفلاطون، وليس هناك من يمكن أن يُنكر عمقه وشموله وأهميته ومركزيته، ومع ذلك لغة من أجمل وأسلس ما يكون، ويمكن أن يفهمها حتى القارئ العادي. فمثلًا، كتاب الجمهورية يمكن عده (أحد) أهم الكتب الفلسفية في تاريخ الفلسفة، وأرى أنه متاح لفهم كل القراء المهتمين فعلًا بالمسائل التي يثيرها. في المقابل، هناك هايدغر وفلاسفة آخرون، ألمان وفرنسيون خصوصًا، يصعب جدًّا فهم نصوصهم، حتى بالنسبة إلى المختصين.
صحيح أنه ينبغي للقارئ أن يبذل جهدًا، لكن إلى أيّ حدّ يكون الكاتب أيضًا مسؤولًا؟ دعني هنا أُميّز بين فلسفتين أو رؤيتين في هذه المسألة. في الرؤية الأنجلوسكسونية، يُعدّ القارئ هو الأساس، وعلى الكاتب أن يكتب بما يُمكِّن القارئ المستهدف من الفهم، ويكون فهم القارئ مسؤولية الكاتب، وغايته الأساسية. أما في الرؤية الألمانية، فالوضع مختلف: على الكاتب أن يعبّر عن فكرته بأفضل طريقة ممكنة، حتى وإن كانت معقدة، وصعبة الفهم. ويبدو أنك، في هذا السياق، أقرب إلى الرؤية الألمانية منك إلى الرؤية الأنجلوسكسونية، ما رأيك؟
د. خالد كموني:
أعتقد جازمًا أن الكاتب الواثق من فكرته، ينبغي أن يتمتع بلغة متينة. عندما يُطوّر خطابه، فإنه يعدُّ نفسه شارحًا لما يقول. وعندما يُفصّل الفكرة، هو لا يُعقّدها، بل يشرحها، يستفيض فيها، يجود بإيضاحها. فلا أعتقد أن هناك فيلسوفًا يُعقّد النص، بل هو يعتقد أنه كلما توسّعَ في نبشِ إمكانات المفهوم، فإنه يثبتُ جدوى استخدامه واستحضاره إلى مدار البحث والمحاورة. لكن صدقًا إن المسألة في التلقي، هي أن من لا يتمتع بهذا المستوى العالي من اللغة، لن يستسيغ المفهوم الفلسفي. لذلك علينا استحداث ساعات لتدريس القراءة الفلسفية للنصوص، وهي بالطبع ستخالجها كل معطيات الدرس البلاغي، والبياني، إذا خصصنا النصَّ العربي؛ لأن تنمية قدرات الفهم هي الخطوة الابتدائية الأولى في تهيئة الذهن القارئ لاقتبال الإبداع والقول الجديد في أي نص.
أنا إذا استحضرتُ مفهومًا من عند الفارابي للبحث اليوم، فرضًا، ستجد كأنه هبط من الأعلى على بعض مجتمع الفلاسفة، ولا أتحدث على مجتمع مثقفين عاديين. طيب، لماذا؟ لأن القراءة اللغوية للنص الفلسفي، أو القراءة التي تنظر إلى هذا النص الفلسفي بيانيًّا بهذا المستوى العالي من اللغة، لم تُنجز في التدريب على القراءة في مراحل التدريس والتعلم، لم يقم بها أحد قبلَ الفيلسوف نفسِه عندما يبحث في مفاهيم أو ينبت مفهومًا جديدًا. لذلك سيجد نفسه غريبًا عندما يكتب، وليس ذنبُه أنه كتبَ تفصيلًا موسّعًا حول مفهوم يجب ألا يكون عاديًا.
لذلك، إن بناء التقليد الفلسفي، يقترن بتشييد عمارة اللغة المواكبة. بالمناسبة، مثلاً، إذا قرأتَ نصوص لغويين كبار مثل الجاحظ، أو أبي الهلال العسكري في بعض النصوص، وأبي حيّان، وغيرهم، ستجد شرحًا فلسفيًّا لبعض المفاهيم، شرحًا فلسفيًّا بلغة عربية فصيحة مفهومة. الجاحظ يعتمد، في شرحه، على البيان، والبيان له القيمة الكبرى عنده في بناء الذهنية، والعقلية، وفي إحداث الانطلاقة الأولى للتفكّر، أي لإفساح ممكنات التفلسف. هذا الشرط البياني الذي وضعه الجاحظ ووسم به، مثلاً، الأمم، يعني عندما تحدث أن الفُرس يتميزون برجاحة عقلهم، العرب بوجدانهم وشاعريتهم، والروم بكذا، وإلى ما هنالك، فهو قد وضع عندنا مسؤولية بيانية للإفصاح.
أما بخصوص أني أميَلُ إلى الفلسفة الألمانية وأسلوبها المعقَّد في الصوغ النص، أقول إن النص الذي أصوغه هو نص فلسفي عربي، وأنا لستُ ألمانيًّا في هذه المسألة، بقدر ما أني عربي في الكتابة الفلسفية؛ أي إن بيانية اللفظ العربي ضرورية في كتابة النص الفلسفي، وإلا سيصبح النص ركيكًا. فالركاكة لا تُنجز تواصليّة حقيقية مع الجمهور الفلسفي. بالعكس، عندما يفهمك الجمهور الساذج؛ فمعنى ذلك أن هناك خللًا فكريًّا، ليس هناك تواصل حقيقي مع الفلسفة عينها. هناك مشكلة أن يكون الفيلسوف مقبولًا جماهيريًّا، فهذا يدل على خلل في معاينة المفاهيم في حيثياتها الفكرية. إن المفاهيم ترتحلُ بحرية بين الفلاسفة، لذا إن إقامتها لا تصلح في ديارٍ لا تعرفُ قيمتها، من هنا نقول إن الفلسفة الألمانية أو غيرها هي المفاهيم التي سكنت الديار اللائقة بالفهم، ومن حقنا التأثُّر بها لنحسِنَ ضيافةَ الفلسفةِ في ديارنا، فتأتي نصوصنا على قدر هجسنا بمواكبة الفهم وتأويل المقاصِد.
ثم إن كثافةَ النص الفلسفي ناجمة عن وظيفة الفلسفة في تظهير التجربة الذهنية وخوالجها الشعورية والعقلية والحسابية والمنطقية والوجدانية كافة في العبارة؛ لذا من الاهمية بمكان أن يحرص الفيلسوف على متانة التصريح. فالصراحةُ هي مجال إظهار الصدق في التجربة المعيشة، أي هي مرتعُ البيان في أداء الفكر الكامن، الذي يحمِّلُ اللسان مسؤولية التحيُّز الذي تطمح إليه النفسُ في العالم، بأن تعرِّف محيطها بضميرها. هذا التعريف الذي يفترض كل هذه العناية والدقة في توصيل المطلوب.
د. حسام الدين درويش:
طيب، يمكن أن نُعنون هذا الحوار ﺑ "الفلسفة واللغة" أو "اللغة بوصفها محورًا فلسفيًّا"، لكن دعني أنتقل إلى مسألةٍ أرى أنك تشدد عليها بإلحاحٍ، وهي مسألة "الراهن، وأهميته. ونظرة ناقدة لهذه المسألة، وكيف يمكن أن توضّح مفهومك للراهن، وعلاقته بالفلسفة، أو علاقة الفلسفة من خلال هذه المسألة.
يقول هيغل: "بومة مينيرفا لا تفتح أجنحتها حتى يحلّ الغسق"، أي إنه لا إمكانية للتفلسف أثناء جريان الحدث، بل لا بدّ أن تكتمل صورته، ويكتمل معناه، حتى نقدر أن نراه فلسفيًّا. في المقابل، يمكن لإعطاء الأولوية للراهن أن يؤدي إلى التفلسف قبل نضوج إمكانيات التفلسف؛ بمعنى قبل أن يكتمل المعنى وتتضح آفاق أو أبعاد الحدث، وبالتالي، هنا، نقع في خطر أن تكون رؤيتنا جزئية او تجزيئية وغير شاملة. فكيف يمكن لنا أن نفهم العلاقة بين ربط الفلسفة بالراهن من ناحية، وكون الفلسفة، بوصفها بومة مينيرفا، لا تفتح أجنحتها إلا عند حلول الغسق، وبعد اكتمال الحدث والمعنى؟
د. خالد كموني:
الراهنية بحد ذاتها أيضًا معطى ذهني معيش، فهو الشعور بالحضور، وقد تكوَّن لدي أيضًا من الناحية اللغوية، ولكن من ناحية أخرى، عندما تحدثت عنها في فلسفة الصرف العربي، عنيت بالفعل المضارع، بكلمة مضارع؛ أي يضارع فاعله؛ يوازيه في الحضور، يضاهيه حضورًا، أليس كذلك؟ هذه المضاهاة تعني أن يحضر الفاعلُ فعلَه. وبرأيي هذه الكينونة الأنطولوجية هي الوحيدة المتحققة حدثيًّا. أنت تتحدث عن الماضي، وتتحدث عن المستقبل، أما الحاضر فتتحدث فيه. لذلك، وأنت تعي راهنيتك في عيشك، ستعي زمانك. لا يمكن أن تستغني عن هذه الحضورِيّة وأنت تريد أن تتحدث عن أزمنة غير مرئية. فمن الجدية بمكان أن تعي حضورَك، وعندما تعي هذه الحضورِيّة، تضارِع فعلَك، أي توازي شعورَك بفعلٍ يوجِدُه. وأن توازي فعلك فإنك موجود باقتدار، وعندما تقدر على ربط زمانك بمكانك ستجد ذاتكَ هنا حيث أنت، نبيهةً في هذا الحدث القائم، مرهونةً بمشهدِها الواقعي الحقيقي. من هذا الراهنِ المتحقِّق نبدأُ التفكر، فلا أحد يبدأ من وراء ولا أمام إلا بما تقتضيه نقطة البداية الراهنة المتوسطة لكل الأبعاد.
لذلك تجد الإشكالية في الفكر العربي قائمة، في القراءة للتراث، والقراءة للحداثة، والقراءة للمستقبل؟ حتى إن المفكر يستريح عندما يتحدث عن أمرٍ في الماضي، وعندما يؤشكل عليه الفعل في الحاضر يبدأ بالتنازل عن الحاضر، وينسحب إما إلى الماضي للتبرير – والتبرير من التبرئة في اللغة العربية، وقد شرحت ذلك مؤخرًا في تبرير ما قاله أديب صعب – أو قد يهرب إلى المستقبل لكي يفارق لحظة الحاضر الحقيقية؛ لأنها تقتضي التنبُّه الصادق لمشهد الذات حاضرةً كما هي.
من هنا إن القراءة الفينومينولوجية للحدث، هذه الحضورِيّة، متحققة عربيًّا، بشرطِ وعي الحضور والفاعل الحاضر فيه، إذ عندما تتنازل عن الفاعل تتنازل عن الفاعلية. وفي المقابل، تتنازل عن هذه الكينونة الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها. المطلق الحقيقي الذي لا يمكن تجاوزه أو إخفاؤه وإغشاؤه في الذهن العربي هو الحدث الذي يستدعي التعامل مع لحظة العيش، فهمًا وتفسيرًا وتأويلًا إلى لحظاتها الممكنة. هناك آية تقول: ﴿وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ﴾، ترى، لماذا فكر العربي بهذه الطريقة، ما هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا سوى الدهر؟ لأن الدهر هو الزمان غير المؤقت. أما حياتنا الدنيا، فهي مؤقتة، وما هي إلا حياتنا الدنيا. ما هي إلا لحظتنا التي نعي وجودنا فيها؟ ما هي إلا هذه الحياة الدنيا التي نبني بها حقيقة العيش المطلق، والمطلق عربيًّا يقتضي إدراك راهنيتها وحضورها؛ إذ لا يمكنك أن لا تعي مضارعتكَ لفعل وتدعي تبصُّرًا بالعيش وإدراكًا لزمانية الوجود فيه. فالحضور هو الوجود الظاهر، وهو الذي يؤمن ما سميتُه اللحظة الشَّيْمِيَّةَ التقديرية التي من شأنها أن تؤكِّدَ الكينونة التأملية للكائن في الكون، تمكينًا وتكوينًا.
د. حسام الدين درويش:
بالمعنى الفلسفي وحتى التقني، "ما الحاضر؟" أو ما الراهن؟" في مفهوم الزمن الحاضر أو الراهن؟ هل هو هذه الساعة، هذا اليوم، هذه الدقيقة، هذه الثواني؟ في بحث سابق لي عن مسألة مفارقات زينون، ناقشت مسألة تقسيم الزمن، فتبين أنه عند أرسطو كان "الآن" هو الوحدة الأصغر للزمان، لكن المفارقة فيه أن الآن في الزمان ليس له أبعاد، مثل النقطة في المستقيم الهندسي التي ليس لها أبعاد مكانية، لكونها مشكّلة من عدد لا متناه من النقاط، والنقطة ليس لها أبعاد؛ أي ليس لها طول، وليس لها عرض. والسؤال هنا هو: "كيف يتشكل شيء (الزمان، والمستقيم) من لا شيء؟" وهكذا يبدو أن الحاضر غير موجود، فالحاضر هو الآن، والزمن إما ماضٍ مضى، أو مستقبل لما يأت بعد. وبكلماتٍ أخرى، إذا لم يكن يكتمل الحاضر بماضيه ومستقبله، ليس له وجود أصلاً، أو ليس له وجود بالمعنى الكامل. بل يبقى وجوده جزئيًّا. وإلى أن يكتمل ذلك الوجود، لا أستطيع أن أحكم، ولا أستطيع أن أقدم رؤية فلسفية تستوعب ذلك الحاضر. طبعًا يمكن قراءة أشياء جزئية، لكن الرؤية الفلسفية الشاملة الكاملة بحاجة إلى بعض التأني. ولهذا، قد يكون من الضروري للفيلسوف أن يبتعد عن الراهن، وأن يتخذ منه مسافة، لا أن يقترب منه كثيرًا.
د. خالد كموني:
الفلسفة طبعًا ليست ابتعادًا من الراهن بقدر ما هي وعي بشيء. لذلك هناك مسافة. الوعي ليس فاعلية حركيَّة، وإنما فاعلية تأملية، ولذلك بين التأمل والفعل هناك مسافة، لا شك في ذلك. لكن الزمان الحقيقي للماضي والمستقبل هو الآن. لماذا؟ أنا عندما أقول "الآن أكلته"، يعني وعيي بأنني ماضٍ، أو أن الأكل أصبح ماضيًا، هو الآن. يا ليت وعينا يصبح إنِّيًّا، يعني مدركًا هذه الإنية. في اللغة العربية، عندما أقول "إن" كذا، فإن التقرير بهذه الإنية فيه شيء من أن تنظر إلى هذا الموجود الظاهر؛ لأن الإنية فيها حضور، هذه الإنية تخيل أنها مقابل الماهية في الفلسفة. الماهية لا توجد بذاتها في الفلسفة العربية. فهي، دائمًا، تحتاج إلى الإنية، تحتاج إلى وجود يبديها. الوجود يسبق الماهية، طبعًا، هذه فرضية في الفلسفة. لكن ماذا لو رهنا فهمنا لهذه العبارة الفلسفية بحدثيتنا اليوم؟
الوجود سابق للماهية، هذا يقتضي منا مسؤولية فلسفية بأن نعي إمكان الماهية بعد هذا الانوجاد؛ أي إمكانية التخلي عن ثوابت ليست بثوابت، عن هويات ليست بهويات، عن إيديولوجيات لم تعد نافعة، عن تصورات لم تعد ناجزة، عن ماهيات ممكن أن نحققها، وتنازلنا عن فاعليتها بسبب عدم حضورنا لو أننا صنعنا الحدث. هذا الحضور المقصود، يعني الحضور الحدثي، وعي الحدث والاشتراك فيه، إذ الحضور أن تعي استمراركَ وأنت في الحدث، يعني أن تعي اكتمالك المستمر في هذا الحدث، وإلا عندما تقنع نفسك أنك أنجزت ما عليك قبل الحضور، فستظل في الماضي، والبقاء في الماضي، ماذا نسميه؟ استراحة عن الحاضر؟ بل هو تخلٍّ قصدي، تخلٍّ عن الممكن الذي هو أفسح من المطلق، مطلق هيجل معروف، فيه شيء من اللاهوت، لسنا مضطرين لهذه اللاهوتية.
د. حسام الدين درويش:
كل هذا كان تمهيدًا للحوار الذي سنجريه عن كتبك. وإذا قلنا إن اللغة هي المحور الأساسي في تفكيرك الفلسفي، ما رأيك في الانقسام الذي حصل في الفلسفة، منذ نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، على الأقل، بين الفلسفة الهيرمينوطيقية الفينومينولوجية، والفلسفة الأنجلوسكسونية التحليلية؟ وتجدر الإشارة هنا إلى أن الاهتمام باللغة هو أحد أهم القواسم المشتركة بين هذين الاتجاهين الفلسفيين. فثمة مركزية للغة في كليهما. لكن على الرغم من هذا التقاطع بين هذين الاتجاهين، فإن مقاربة كل منهما للموضوع مختلفة. عن مقاربة الأخرى، فما رأيك في هذه المسألة؟ وهل مقاربتك الفلسفية للغة أقرب إلى الفلسفة الهيرمينوطيقية أم التحليلية؟
د. خالد كموني:
في ما يتعلق بالفلسفة التحليلية ثم الهيرمينوطيقية، التحليل كما ذكرت قبل قليل، أن الفلسفة متعلقة بالعلم، يعني لغة الفلسفة هي لغة العلم، فلولا تطور العلم، لما أمكن الفلسفةَ أن تظهر بشكلها الحقيقي؛ أي بلغتها التي تواكبُ مشهدية هذا التقدم الذي يشغل الكون.
د. حسام الدين درويش:
قد يعترض كثيرون من الفلاسفة على قولك "لغة الفلسفة لغة العلم".
د. خالد كموني:
طبعًا هناك مسألة محددة، مثلًا كان فيتغنشتاين يريد أن تكون هذه اللغة مصاقبة؛ أي أن يكون اللفظ مصاقبًا للمعنى دون خروج عن العالم كما هو. لماذا؟ لأن، في تلك الفترة، كانت الاختراعات تظهيرًا لما في الذهن، لكن بعد فترة تأمُّلٍ في الاختراعات احتيج إلى تأويل ما تكوَّن في الذهن من انطباعات. لذلك كان تطورًا حتميًّا أن ننتقل من التحليلية إلى الهرمينوطيقية، إلى هذه القدرة على أن نجرِّدَ الفهم مجددًا. لقد أصبح الشيء أمامي في الآلة، لكن الارتداد من الآلة إلى الذهن يحتاج إلى تأويل؛ لأن علاقتي بالآلة اختلفت عن علاقتي بفكرتي عن الآلة. عصر فيتغنشتاين غير عصر الوجودية. لماذا وُجدت الوجودية أصلاً طالما أن التحليلية تكفي علميًّا؟
الوجودية دليل أن هناك مشكلة للإنسان دائمًا في حضوره. إذن، الهرمينوطيقا تولد طبيعيًّا في التأمل الفلسفي والتطور التجريبي الذي يلحق اللغة الفلسفية. والهرمينوطيقا صياغة تفسير، وبالنتيجة إحداث معنى. الهيرمينوطيقا تستدعي تأويل اللغة باللغة؛ بمعنى أن من يمارس الهيرمينوطيقا يمارس خصوصية أيضًا في إظهار المعنى. واحترام هذه الخصوصية بأن يظهره بهذه الطريقة المختلفة، يعني النص ملكي، وأنا ملك القارئ. وعندما يصبح النص ملكًا للقارئ، هذا إقرار بالحرية، فيه نوع من الليبرالية الذاتية في إبراز الفكرة. لذلك، التطور الهيرمينوطيقي في الغرب أحدث هذا التنوير الكبير، وأحدث هذه الحداثة الكبرى، وأوصل إلى إمكانات ما بعد الحداثة، التي نبتت أسئلةً هناك وأنبتت إشكالات في أماكن أخرى.
د. حسام الدين درويش:
هل لك توجه؟ يعني هل تتبنى توجهًا محددًا؟
د. خالد كموني:
لا أتبنّى توجهًا محددًا، ولكني أراقب هذه الانفتاحات الفكرية الحرة لأننا نحتاجها عندما نسأل؛ لأنها أسئلة سبقتنا، وبالتالي أنا أرهن هذه الأسئلة بسؤالي الحاضر عنها، وأحتاج إلى كل هذه الأسئلة وصولًا إلى حضوري الآن، بالحدث الذي نعيشه، مثلًا هذه الحرب الظالمة على غزة، هذا الاعتداء المشهود الذي علينا، هذا الانعدام مثلاً لفلسفة الحق، ألا يثير ذلك التفكر في ذاك السؤال الذي طُرِحَ مرةً، وفي كل مرة، عن الحق، أين مجاله؟ وكيف نطبقه؟ وبالتالي عندما أسأل هذا السؤال مجدَّدًا، أتجاوز ما سُئل وأتجاوز الإجابات أيضًا، وأطرح لغةً جديدة لإفهام فلسفة الحق مجددًا؛ لأنه يبدو أن هناك نقصًا في فهم الحق أحدث هذا التفكك بل التشظي البشري؛ إذ لا اشتراك في فهم الحق، ولا اتفاق على ميثاق للعيش المشترك فعلًا. كل ما في الامر انحلال قيمي يتيح ممارسة الوحشية دون اكتراث القوي بما يحدث للضعيف.
د. حسام الدين درويش:
طيب، دعنا ننتقل الآن إلى كتابك الأول: "المحاكاة: دراسة في فلسفة اللغة العربية"، الصادر عن مركز الثقافة العربي، الطبعة الأولى سنة 2013، والثانية سنة 2014. لنبدأ بالعنوان، هناك مسألتان تثيران الانتباه: أولاهما كلمة "المحاكاة" بوصفها العنوان؛ إذ يمكن أن تثير معاني متعددة، وفيها شيء من الضبابية. ما المقصود بالمحاكاة هنا؟ لكن قبل أن نصل إلى الأطروحة الأساسية في الكتاب، أود أن أسألك: ما الذي أردت قوله من خلال العنوان؟ وسؤالي الأوسع هو عن فلسفة اللغة العربية نفسها: ما المقصود بها؟ بأي معنى يمكن أن نتحدث عن فلسفة للغة العربية؟ هل هي، مثلاً، بالمعنى الذي يجعلنا نرى أن الموجودات تظهر من خلال هذه الأداة؟ وهل لها منطقها الخاص؟
أذكر أننا حين تحدثنا مع والدك، الدكتور سعد، كان يطرح فكرة "العقل العربي"، فاستحضرتُ حينها المناظرة الشهيرة بين السيرافي ومتى بن يونس، حيث دار النقاش حول النحو والمنطق: السيرافي كان يرى أن النحو منطق عربي، والمنطق نحو يوناني. ومن ثم انتقلنا من فكرة "العقل العربي" إلى فضاء آخر، هو "فلسفة اللغة العربية" تحديدًا. فهل يمكنك أن تشرح لنا هذا المفهوم؛ لأنه قد يكون بالفعل مهمًّا جدًّا، وربما مثيرًا أو حتى إشكاليًّا، وبعد ذلك ننتقل إلى عرض أطروحة الكتاب؟
د. خالد كموني:
لو تعطيني فقط تعليقًا على مسألة السيرافي. بما يتعلق بالنظرة إلى المنطق والنحو، حتى إلى الثقافة اليونانية والفلسفة اليونانية، وإلى الثقافة العربية أيضًا في تلك الفترة، في رأيي يجب فعلًا أن نفصل النظرة القومية المعاصرة لتشكلنا دولًا وأممًا في النظام العالمي اليوم عن نظامنا العالمي في تلك الفترة. أعتقد أن العلاقة بين اليونان ومصر وفينيقيا وبلاد الرافدين، وغيرها من البلدان، لم تكن علاقات دول أو إمبراطوريات حادَّة كما في عصرنا، عصر ما بعد العولمة؛ فالثقافة تبدو مشتركة، ليست غريبة، أو إنها سلعة تحتكرها أمم تحجبها عن غيرها. يبدو أن هناك استكمالات ثقافية ومعرفية بين تلك الشعوب القديمة، ويمكننا قراءة الدراسات التاريخية والأنثروبولوجية، وحتى الفلسفية التي تعنى بتاريخ الفلسفة، لنجد تأثيرالفلسفة والعلوم والديانة في مصر أو العراق على الفلسفة اليونانية. المهم، العقل بشريًّا يستكمل بعضه بعضًا، البشر يستكملون أفكارهم.
أما بخصوص الوعي الفلسفي للغة عربيًّا، فسأبدأ بإمكانات هذه اللغة نفسها لأن تنتج فلسفة. فقبل أن أبدأ بفلسفة اللغة العربية من المحاكاة، من هذا الصوت الطبيعي الذي انبعث في الكون، أقول إن اللغة هي حكي الطبيعة، تقليدها، فأنت عندما تتكلم تحاول التشبه بالطبيعة، وبالتالي أنت تجرب نفسك في الطبيعة، ومن ثم أنت تنطق أصواتها، فأنت تسمي وتتعلق بهذه الأشياء، وأنت تبدع وتخلق وتنجز فكرًا لا يهدأ. هذا الوعي للعلاقة بالكون بدا لي من خلال اللفظة العربية أنها تشكُّلٌ فلسفيٌّ وجداني محض للعلاقة بين الإنسان والكون. فهي لفظة تضم الدلالات من المادة غلى ما بعدها تجريدًا، بحيث تجد أبعادًا روحية ومادية، مرئية وخفية، في الوقت نفسه، ما يشير إلى عمق العلاقة وطولها وعراقتها بين الإنسان والعالم. وقد دلت على ذلك سعة المفردات للشيء الواحد ما يوحي بأن كل لفظة هي ضميمة تجربة وجودية حرة، لا تخلو من تفسيرٍ مشهود لتصورات قائلها عن المفاهيم الكبرى، كالعدم والوجود والزمان والدهر والله والعالم وغيرها.
لكن قبل كل هذا، كانت البداية عندي هي أن نحكي بالحداثة، كيف يمكن أن تتم الحداثة العربية، هذا السؤال الذي يشغل بالنا عندما كنا طلابًا في كلية الآداب، نرى في أنفسنا مشاركين فعليين في حركة النهوض الفكري والنضالي المؤثر. ثم وجدت من خلال القراءات وما تلاها من تجويد الاهتمامات وتحسين مستوى الفهم للفلسفة وجدواها أن المشكلة عندنا تكمن في الخطاب، الخطاب الحداثي العربي نفسه. كيف يجب أن يكون هذا الخطاب. وكان في تلك الفترة من البراعة في إتقان الفهم الفلسفي للحداثة أن يقرأ الطالب الجابري وحسن حنفي والطيب تيزيني وأبو يعرب المرزوقي وناصيف نصار، وغيرهم من أبناء هذا الجيل الفلسفي العربي ليدخل في معترك قضايا النهوض والتنوير والتحديث والتراث وغير ذلك من القضايا. وقد وجدت أن المشكلة أيضًا في نوع الجملة التي فعلاً تكون أصيلة، تعبِّرُ عن فكرك، وهي غير مستعارة؛ بمعنى أنه إذا ما وصلنا إلى حل إشكالية راهنة في رأسنا نلجأ إلى فوكو ونلجأ إلى غيره من الأشخاص. طيب، كيف نلجأ إلى ما يتذهن في مخِّنا فعليًّا، إلى هذا الـ نحن الذي في رأسنا، نحن الذي في بالنا، ما يخطر في هذا البال، هذه الكلمة أذكر أنها أتت في بالي، قلت "يخطر في البال" أي يهجس، أي يفكر، يذهن، قلتُ: تخيَّل يا صبي كم مصطلحًا في العربية لحالات التفكر؛ معنى ذلك أن هناك علاقة بالأصوات، وهذا يعني أننا في حاجة إلى أن ننظر في ذلك.
وأنا أبحث في أحد كتب اللغة، مرَّ معي عند الثعالبي، فقرة بسيطة في "فقه اللغة وسر العربية" على ما أظن، 86 تسمية للمطر، إذًا هناك 86 تجربة مع المطر. هذا الإنسان الذي عاش في هذه المنطقة عنده 86 رؤية وموقف وحضور مع المطر. ويصل هذا الموقف إلى حدود التجريد أخلاقيًّا، ويهبط إلى حدود المادية. فالمطر يمكن أن نسميه الخير والرذاذ والرشاش والبعاق، على سبيل المثال، إذا فاض عليه بعاق، يبعق الأرض، وإذا كان يحتاج لسقاية القمح، يقول له: الخير... إلخ. فإذا كانت تسميات المطر من تجارب أخلاقية واجتماعية واقعية وحتى سياسية مع المطر، فهذا يعني أن هناك انعكاسًا للعلاقة بين الطبيعة والكائن في اللغة.
د. حسام الدين درويش:
دعنا نكمل، وصحح لي فهمي، إن كنت مخطئًا. فهمي لوجهة نظرك يذكرني بأفلاطون، لكنها حسب علمي تم تجاوزها. في محاورة "كراتيلوس"، يرى أفلاطون أن هناك علاقة وثيقة بين اللغة والأشياء أو ما تدل عليه، وأن اللغة ليست مجرد مجموعة من الأصوات والرموز الاصطلاحية، بل هي تعبير عن طبيعة الأشياء وجوهرها. طبعًا، ثمة أحيانًا ترابطٌ وثيقٌ ين المبنى والمعنى، لكن يبدو أن هذا محدود جدًّا في عدد قليل من الكلمات ذات المدلول المادي/ الحسي. فإذا عدنا إلى دو سوسور وفريجه، يمكن الحديث، مع طريقة فوكو، عن انفصالٍ بين الكلمات والأشياء. فليس هناك علاقة منطقية طبيعية بالمعنى و/ أو بالمبنى، او بالصوت، بين كلمة "شجرة" والشجرة. لكن يبدو أنك ما زلت تتبنى الرؤية الأفلاطونية القائلة بوجود ترابط وثيق بين الكلمات والأشياء، بين الدال والمدلول. ما رأيك؟
د. خالد كموني:
ليس المشكلة أني أرى الرؤية الأفلاطونية، لكن لو رجعنا إلى سوسير، هذا الباحث اللغوي الذي أحال تفسير فلسفة اللغة إلى الاعتباطية بدل المحاكاة، انطلاقًا من همٍّ هرمينوطيقي؛ يعني هو يريد أن يملك السلطة على النص، عندما نقول النص نقصد النص الديني بالدرجة الأولى. أراد أن يقول إن هذا النص يمكن أن تقوله اللهجات، لذلك اللاتينية لغة أم، واللهجات لغات أخرى، يمكنك أن تعبر بهذه اللهجات عن مقصودك؛ فاعتباطية العلاقة بين اللفظ والواقع أو اللفظ والصوت، بين الدال والمدلول، ضرورية في فكر سوسير، وليس فقط ضرورية بل تحررية، هي إذًا من جراء اعتباره لهذه الاعتباطية، وخروجه من "Mimetic Words" الكلمات المحاكية، حرَّر النص من سلطة الكنيسة؛ لأن الاعتباطية تحرّر، وأعطيك أكثر من ذلك، قال عن المسيح:
"صحيح هو سامي، ولكن ذهنه آري"، وصل معه إلى درجة أنه حرر الذات من واقعيتها، لكي يثبت أن الاعتباطية فيها الحرية، لإفاضة الدلالة وإغنائها. أما مشكلتي أنا مع اللغة ليست المشكلة نفسها، هناك ألفاظ ليست اعتباطية، نعم، نحن نقول بذلك. وهناك نظرية عربية في اللغة تقول بالمواضعة، التي تعني التواضع أو الاتفاق على الاصطلاح والتوافق، وتحدث فيها القاضي عبد الجبار. والقاضي عبد الجبار تفكيره معتزلي، يعني تفكير عقلي، وبالتالي كان المعتزلة يحتاجون، أيضًا، إلى أن تكون ألفاظهم متحررة من محاكاتها، وبالتالي من نمطيتها. أما البداية اللفظية، فهي محاكية، البداية اللفظية محاكية، يعني الصوت الطبيعي إلى آخره. وخلاصة القول بالمحاكاة في اللغة هو براءة العلاقة بالطبيعة التي نحتاجها في كل مرة نعاين فيها علاقتنا بالواقع.
الآن، مثلًا، عندنا مشكلة مع الطبيعة، تتمثل في هذه الجوائح الموجودة، والحروب القائمة، والبيئات المغتربة عالميًّا، واستسهال الأمراض، والقتل، ...إلخ؛ لأن علاقتنا مغتربة مع الطبيعة، استعادة العلاقة مع الطبيعة، هي استعادة الحكي البسيط، هذه المحاكاة التي ليست تقليدًا أعمى، بل هي لحظة وعي إبداعية للعلاقة المتناغمة مع الطبيعة.
د. حسام الدين درويش:
طيب، امنحني فرصة أخرى، جولة أخرى ننهي فيها هذا الكتاب. أول شيء، سوسير الذي نتحدث عنه، هو لغوي فيلولوجي، ليس معروفًا عنه أنه فيلسوف أو هيرمينوطيقي، أو مؤول نصوص (دينية). وهو القائل باعتباطية العلاقة بين الدال والمدلول. وقد كان مع فريجه، الذي فصَّل في التمييز بين المعنى والمرجع، من الأقطاب المؤسسين للتحول اللغوي في الفلسفة (التحليلية) المعاصرة. ومع الإقرار بوجود بعض الاستثناءات المتعلقة بالكلمات المحيلة على ما هو مادي/ حسي، لا أرى كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الدال والمدلول غير طبيعية، لا اعتباطية. أما في عالم من الأفكار والقيم، فتقريبًا، الكلمات كلها أصلاً ليست محاكاة. نعم هناك محاكاة، لكنها محدودة جدًّا. فما معنى المحاكاة التي تحدثت انت عنها، في كتابك؟ وما حدودها؟
د. خالد كموني:
حدود المحاكاة هي أنها ابتداء كما قلنا ابتداء، لكن أنت في كل فترة، كما قلت لك، تجد نفسك في لحظة الابتداء، يعني في لحظة الصدق في العلاقة. مثلاً أنا ليس كل مرة أنظر إلى فتاة لأحبها، أعي أن حرف الحاء هو حفيف، وحرف الباء هو خبط الحفيف وتثبيته، لكن كلمة "حب" بهذه الطريقة، حيث الحاء - ذلك الحرف الحميمي الداخلي - لها فاعلية، مثلاً عند أبناء هذه المنطقة أكثر من كلمة "love". وهذا يبيّن لك البعد الاجتماعي للمسألة؛ فلو ردّدت مئة مرة عبارة "I love you" فلن يكون لها الوقع نفسه مثل "أحبك". وحين يقول لها "أحبّك" أكثر، فإنه يتعلق بنفسها. ومهما تحدّث بالإنجليزية وتفاخر، فإن نار العشق في داخله- في النهاية - ستدفعه ليقول لها "أحبك". هذا الحرف، بحدّ ذاته، لماذا؟ لأنه يريد أن يقولها بحميمية، يريد أن ينطق بكلمة "حميمية"، فاستعمل حرف الحاء. لذلك سنتحدث في الصرف عن موقع الحرف في أول الكلمة أو في آخرها من منظور أنطولوجي.
د. حسام الدين درويش:
هذا الكتاب كان رسالة الدكتوراه، أليس كذلك؟ الكتاب الثاني هو "فلسفة الصرف العربي: دراسة في المظهر الشَّيْمِي للكينونة". وأنت مصر، مع والدك الدكتور سعد، على وجود، فلسفة للغة العربية وللصرف العربي. فما هي هذه الفلسفة؟ وما الصرف العربي؟ وما الفكرة أو الأطروحة الأساسية في هذا الكتاب؟ وما الفلسفة التي تحدثت عنها في العنوان الرئيس لرسالة الدكتوراه؟
د. خالد كموني:
باختصار: لماذا فلسفة الصرف؟ التصريف هو سحب هذا الفعل في الواقع، كيف لكل حدث فعله: "أفعل"، "يفعل"، "تفعل"، ...إلخ. إن الفلسفة العربية لا يمكن أن تُفهم إلا عبر التعمق في بنية اللغة العربية؛ لأن العربي أبدع صور المكان والزمان والنفس في لغته، التي تقوم على ثلاثية الفعل والفاعل والمفعول، وعلى طاقات اشتقاقية وصرفية مثل القلب والإبدال والإعلال. هذه الطاقة الاشتقاقية تعكس تجربة العيش العربي في أبعادها الواقعية والأسطورية، وتكشف جدلية الحضور والغياب في اللفظ والدلالة.
وعند معاينتنا تطور الدلالة في العربية اليوم، وجدنا أنه يقتضي العودة إلى أصل النظام الصرفي واستكشاف أبعاده الفكرية، على خطى علماء الصرف الأوائل الذين درسوا الكلمة منذ الصوت حتى التركيب. ومن هنا، بحثنا في أربعة أقسام: أنطولوجيا الإنسان العربي، حيث درسنا مفهوم الكائن المبدع (فاعلية العربي في صياغة وجوده) ومفهوم الكائن القيمي (علاقته بالزمان والمكان). ثم عالجنا إبستيمولوجيا الصرف العربي، لمعاينة الظاهرة الصرفية من حيث الحاجة العلمية والاجتماعية إليها، وعلاقتها بالمورفولوجيا وتوليد المعاني. ثم تبيَّنا منطق الصرف العربي، لنكشف البعد الميتافيزيقي للصرف باعتباره ضبطًا للدلالة ورؤيةً وجودية قائمة على جدلية الفعل والفاعل والمفعول. ووجدنا أن الفكر ينتظم صرفيًّا، فدرسنا فكر الصرف العربي، حيث تفاعلنا مع حيوية الصرف كعلم معاصر قادر على تجديد اللغة، ومواكبة التحولات العلمية والاجتماعية، ومواجهة تحديات العولمة والهيمنة اللغوية.
فبرز من دراستنا أن علم الصرف ليس مجرد قواعد تاريخية، بل هو طاقة إبداعية تؤسس لفهم الذات العربية ولتجديد اللغة، بما يضمن حضورها في العصر ومساهمتها في إنتاج المعرفة.
د. حسام الدين درويش:
ماذا عن الحاء؟
د. خالد كموني:
الحميمية، يا (ﺣُ)سام. تأمَّل معي الحاء في أول اسمك، وما فيها من جوانية الشعور الحميم. فلسفة الصرف هي فلسفة هذا العقل في ظهوره الحركي في الواقع؛ لأن تصريف الحركة، وحتى تصريف الأسماء وقضايا التثنية والتفريد والتجميع، هو مشهدية المفرد والمثنى والجمع في ملء العالم؛ يعني هناك مسألة تتعلق بنوعية العيش. التصريف يعني تصريف الأفعال بحسب الحاجة إلى الوجود الفاعل: فوضعية "آكل" غير وضعية "يأكل"، وليس كلهم to eat""، بل هناك آكل ويأكل وتأكل ونأكل ويأكلان، كلاها مواضع بين الجمع والواحد؛ معنى ذلك أن هناك ذهنية تتصرف بهذا الواقع، هذه الذهنية تفيد فلسفة الحضور التي تشغلنا في الحقيقة.
د. حسام الدين درويش:
يبدو لي أن هذه مسألة لغوية أكثر من كونها فلسفية. يعني، إذا أردت أن تبحث عنها، تجدها في كتب اللغويين، وليست في كتب الفلاسفة. كما أننا في تعلم اللغة العربية وتعليمها واستخدامها، لا ندرس اللغة العربية بهذه الطريقة أو بهذا المضمون، يعني لا ندرس الفرق بين "أكل" و"آكل" و"تآكل"، ولا ندرس المعاني أبدًا، بل نركِّز على المباني. ندرس اللغة كشكل، كنحو وصرف، لكن حتى الصرف ليس من حيث تعدد معانيه. أما إذا تعلمت الألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية، تدرس المعاني، تدرس الفرق في المعنى بين الأفعال أو الأسماء، أي التوازي بين المبنى والمعنى. في حين نركز نحن في تعليم اللغة العربية، تقريبًا دائمًا، حتى في أعلى الدرجات، على المبنى، على الشكل، وليس على المعنى. لكن استكمالًا لهذه المسألة، أين الفلسفة في الصرف العربي؟
د. خالد كموني:
من هذه الدراسة الصرفية لو انطلقنا إلى المشكلة التي بدأت عَقَدية؛ يعني الفعل أولًا أو الاسم، أو مشكلة المصدر أولًا أو الفعل، مثل "الخلق" أو "الخالق"، أو اقتران الفعل بالاسم: "خالق بخلقه"، فهذا التصور للكون قائم على هذا الصرف، قائم على أسبقية الفعل، في الذهن الذي يتحدث بهذه المسألة، من ناحية تحقيق اطمئنان وجودي، فممكن لمن يعتقد أن "الخلق" قبل "الخالق"، تحقيق تصور للكون مبني على الحركة أولًا. إذا قال "الخالق" أولًا، معناه أنه لا يفترض عدم، بل يفترض وجودًا يبدأ بهذا الخالق. إذا افترض كليهما معًا، له قول آخر.
تأمَّل أيضًا في بنية الكلمة العربية التي لا تجمع ساكنين، لا يلتقي ساكنان في اللفظ العربي، لماذا؟ لأن الذهنية العربية قائمةٌ على أن كل سكون يقابله حركة، معنى ذلك أن الأفضلية للحركة والظهور والبيان في تظهير قيمة الوجود. والتنوين، مثلاً، هو حاجةٌ إلى إظهار التحريك، إذ لا يمكن أن تنهي بساكن لا ينفتح مداه على حركة تحدد مجال دلالته، بل يجب أن تنهي بحركة مدركة مرئية. معنى ذلك أن هذا الكائن متحرك، وجودُه ظاهر. ومن هنا دخلنا إلى الكينونة، ما معنى الكينونة؟ هي مصدر من فعلين. تخيل هذه الميزة في اللغة العربية: مصدر "كينونة" من فعلين: "مكن" و"كون"، الذي يؤدي إلى المصدر "المكان"، كلمة "مكان" من الفعل "كون" في المكان، كون مكانًا ومكن مكانًا. فمصدر واحد من فعلين. في تحليل الكينونة وصلتُ إلى أنها تمكين في التكوين؛ لأنها من هذين الفعلين وتؤدي إلى المكانية الواحدة. تحدثت عن العقل المكاني هنا، وماذا يعني أن يتمكن الإنسان في تكوينه؟ فوجدت الصلة بين أو الرابط بين أن تتكون مكانيًّا. كيف يمكن أن يحدث هذا التكون؟ لذلك هناك شيْم، هناك ترقب، هناك مشيمة تفتقها لتنوجد. هذا العقل المكاني الذي يتحقق بأن نقول الكينونة في البينونة.
د. حسام الدين درويش:
ما دمت ذكرت الانوجاد، دعني أشير إلى نقطة، هي بالفعل هنا تساؤل، يمكنك أن تجيبني عنه: أين البعد الفلسفي في الموضوع، بدلًا من «كينونة» دعنا نذهب إلى الوجود. الطريف أنه في اللغة العربية، على عكس اللغات الأخرى، ليس هناك فعل مبني للمعلوم مقابل مثلًا لفعل إكزيست «existe» أو فعل الكون في اللتين الإنجليزية أو الفرنسية أو فعل «الكون». فما الفلسفة وراء هذه الاستثنائية في اللغة العربية؟
د. خالد كموني:
ذكرنا أن العربي لا يبدأ من العدم، لا يعرف العدم، هو دائم الوجود، حتى وصلت إلى مفهوم أنه «دائم الحياة»، لا يموت، ولا يقبل الموت، لماذا هو دائم الوجود؟ حتى في الحساب، عندما اشتغلوا بالرياضيات اخترعوا قيمة للعدم، وهي الصفر، وقبل الإسلام كانت الذهنية قائمة على تفضيل اليمين على اليسار (الميمون طائرُه، تيمنوا...) واستمرت هذه الذهنية إلى يومنا، لذلك كتبوا الصفرَ ذا القيمة من جهة اليمين «إذا لم تكن للصفر قيمة على اليسار، فإن له قيمة على اليمين. وإذا كانت له قيمة على اليمين، فالصفر على اليمين ذو قيمة». هذه الصفرية التي هي ابتداء، الصفر يعني ابتداء، ولا يوجد في أي معطى شعري أو نصي أو نثري عند العرب شيء يحاكي العدم السابق للوجود. العدم غير موجود؛ لذلك نتساءل: هل طبيعة الأديان منسجمة مع طبيعة الأذهان، أم الأذهان نتاج هذه الأديان؟ فإذا كانت الأديان متوافقة مع هذه الأذهان أو نتاجها، فهذا يعني أن هذه الأديان ظاهرية معيشة تحاكي أفعال الوجود الظاهر.
نعود إلى إشكالية: هل الفاعل أولًا أم الفعل أولًا؟ نوع التأليه مثلاً عند العرب، هل كان لصنم، أم كان لفعل؟
مفهوم الإله عند اليونان، يمكن القول «أوجد أنا» أو «أنا أوجد» أو «الوجود»؛ لأن الإله صناعة بشرية،
الإله في 4000 إله، 4000 حركة موجودة، وهي ببساطة صناعة بشرية. الكلام معهم يقتضي أن يكون هناك رسولُ إله «هرمز»، لكن عند العرب ليس هناك صناعة آلهة، أنت عندك إله واحد، تخيل حتى في وقت الصنمية المتأخرة، أنهم عبدو الأصنام تقربًا إلى الله زلفى. ما هو الله هنا؟ في بحث من الأبحاث، تحدثتُ عن «ال» التعريف، «الألْ» و«الأوْل»، والـ «الأُيَّل» ماء الرحم الأول، «الأل» الله، «ال» التعريف، تخيل، في اللغة العربية تعرّف كل شيء وتسبق كل شيء «ال»، والـ «أيْلُ» كما قلت لك هو ماء الرحم، يعني الماء الأول، لا يصبح «الأيل» أيلًا، إلا إذا أصبحت هذه الـ «ال» ماء الرحم مفسورًا، لا يمكننا فسْرُه تفسيرُه إلا أمام عيني طبيب. إذن الأوْل ثم الفسر، سميتها سياسة الدلالة، الأوْل ثم الفسر؛ يعني عندما يفسُر الماء، مثلاً البول عندما يخرج يفسر، يصبح مادةَ بحثٍ ونظرٍ أمام عيني طبيب، عند ذلك يفسُر، لكن الماء الأول «أيل» تصوُّر للابتداء الأول المعروف، أي الله، «ال» التعريف، انتبه كم فيها من زخمٍ حضوري هذه "ال" الوجودية التظهيرية؟ هذه ابتداء تعريفي للكون.
د. حسام الدين درويش:
إذا كان للغة فلسفة، وللصرف فلسفة، واللغة ليست مجرد أداة، بل يمكن أن تكون أيضًا جزءًا من عوائق معرفية بما تتضمنه من معانٍ، وما تتأسس عليه من فلسفة، إلى أي حد نحن في طور الحديث عن التقدم والتحضر والتطور؟ إلى أي حد يمكن وينبغي أن تكون هناك إعادة التفكير في هذه الفلسفة وتغييرها بما أنها تمارس دورًا (سلبيًّا)؟ سؤالي هنا: إلى أي حد يمكن أن تكون اللغة عائقًا، من حيث المبدأ؟ وإلى أي حد نحن بحاجة إلى إعادة النظر، والتفكير، والتفاكر، حول هذا العائق، لكي نقوم بالتغييرات الإيجابية المطلوبة؟
د. خالد كموني:
في أي لغة، وليس فقط العربية، لا عائق أمام أي لغة بأن تتعصرن وتواكب زمانيتها، بشرط دوام الاستخدام ووعي هذا الاستخدام. كيف أتحدث عن تقدم في اللغة العربية، وهي ليست لغةَ التدريس اليوم؟ كيف أتحدث عن تقدم في اللغة العربية، وهي ليست لغة العلم؟ أن تبقى اللغة تتلقى من دون إبداعية في المفاهيم والمصطلحات والاستخدامات، فسوف تندثر، حتى لو أقيمت لها أيامٌ فلكلورية أو ندوات اعتزاز وتفاخر بها، فهذا لا يكفي لتكون لغةً بمستوى الحضور الأنطولوجي الفاعل للناطقين بها. أما إذا كانت اللغة وسيلة استخدام، فستتطور الخطابات بناء عليها، وتتطور الذهنيات المستخدمة لها، وبالتالي ستتجاوز ألفاظها البائدة تلقائيًّا.
يجب أن تبيد بعض الألفاظ ليحدث تجديد يقتضي دوام العيش في لغةٍ ما، وهي مسألة ليست بسيطة، كيف تبيد بعض الألفاظ لأجل استمرار حياة اللغة التي وردت فيها؟ مثلاً، كم مرة تستخدم في اليوم لفظ «الشرف» و«المروءة» لتحلل واقعةً سياسية بدقة؟ ربما لا تستخدمها، وهذا هو الطبيعي أن يجري. لماذا؟ لأن هناك تقدمًا حصل في القيم. مثلاً، أنت لا تنظر إلى المسألة في الحرب الآن من باب الشرف الفردي، بل ربما يرتبط الشرف اليوم بمصالح اقتصادية وعلمية وتصنيعية كبرى هي التي ترسم التحالفات وتحدد سير الحوادث الكبرى في التاريخ. إذا قال أحد «يجب أن نقاتل من أجل شرفنا»، فما هو شرفنا؟ هناك مسألة أكثر من الشرف، وهي الوعي بضرورة استمرارنا على قيد الحياة، هي التي تجعل لغتنا بمستوى عيشنا، أي هي تحدد الألفاظ التي علينا انتقاءها لمواجهة أسلحة الدمار الشامل وتقنيات الذكاء الاصطناعي، فلا تصلح ألفاظٌ واجهت السيوف والرماح لأن تستخدم اليوم في مواجهة صواريخ التوماهوك والكروز.
إن مفارقة الوعي تكون في العودة إلى قيم تسبق الوعي الراهن، ما يؤدي إلى خلل لغوي، فيصبح خطابك رجعيًّا عندما تغادر وعيك. أنا أتحدث عن الشرف مثلاً في قتال العدو، ولكن عندما ألتزم بوعيي، أتحدث عن ضرورة قتال من لا يعرف الحق اليوم، وضرورة ألا يكون هناك احتلال في بلادي، وتصبح هذه اللغة حديثة. عندما تلتزم الحدثَ، تلتزم راهنيتك، أي تجدد فلسفتك للكون. عندها يكون مثلاً مشروع تحرير فلسطين مشروعَ وعيٍ حضوريٍّ مطلق، قوامه لغةٌ تحرر النفسَ التي ستفهم وطنًا للإنسان في فلسطين، يستأهل أبناؤه المتحدثون بجدوى قيامته أن تكون فلسطين محررة؛ لأن لغتهم تناسب العيش في هذا المكان.
وهذا ما قصدناه بالتمكين في التكوين، عندما تكون لغتي سابقة للوعي، لا أستطيع أن أوجد في أي مكان، بل سأوجد مارقًا في المكان، سأوجد عائقًا في المكان.
انظر معي إلى الأشخاص "المتدينون اليوم" يتحدثون اللغة الفصحى، مثلاً، ولكن اللغة التي عمرها ألف سنة من بداية التدوين، هذه اللغة لماذا هي مفارقة للواقع؟ لأن كل قيمها وكل مضامين الخطاب سابقة لوعي الراهن، بينما لو كانت لغتهم راهنة، تلقائيًّا ستتغير ذهنيتهم.
د. حسام الدين درويش:
بما أنك ذكرت مفهوم الشرف، يقول الفيلسوف الكندي تشارلز تايلر إن انتقالًا أساسيًّا ومهمًّا، حدث في الحضارة الغربية، من مفهوم الشرف إلى مفهوم الكرامة. مفهوم الشرف تراتبي، فهناك من هو أشرف من آخر. ومفهوم الشرف في اللغة العربية، كما تعلم، يحيل على مسألتين أساسيتين: مكانة قائمة على النسب؛ أي الشريف فلان أو هذا، إذ هي نسبةً إلى شيء في الماضي، نسبة ليس له أي خيار فيه، فأحدهم وُلد شريفًا، لكنه لا يفعل شيئًا ليكون شريفًا. كما يحيل على مسألة أخرى: جسد المرأة. هاتان الحالتان تبدوان مفارقتين. في المقابل، مفهوم الكرامة مفهوم مساواتي، فوفقًا له، كل فرد بغض النظر عن كونه رجلًا أو امرأة، غنيًّا أو فقيرًا، شريفًا أو غير شريف، لديه الكرامة نفسها. في الواقع العربي حتى الآن لدينا مشكلة لم تحسم: المعركة بين أولوية الشرف وأولوية الكرامة. هل هناك مساواة أولية بين كل الناس؟ هل ينبغي استباق الواقع، أم إننا بحاجة إلى واقع يسمح لقيمة الكرامة أن تحظى بالأولوية والمكانة التي تستحقها، من منظور كثيرين، وأنا منهم، لكي يحدث التغير في اللغة العربية؟ بصيغة أخرى: التغير اللغوي يكون نتيجة تغير واقعي وبنيوي، وليس تغيرًا مرهون بإرادة أو إرادات معرفية.
د. خالد كموني:
هذه المسألة التي تطرحها شديدة الأهمية في توطين المفاهيم. لو قلنا مثلاً الاشتراكية، هل أحدثت كائنات اشتراكية في الوطن العربي؟ إذا أحدثت، فنزر يسير لا يؤثر، أو لو قلنا توطين المفاهيم وتمكينها عندنا، مثل مفهوم الكرامة، كيف سيتمكن عندئذٍ؟ هل اللغة تحدد الواقع، أم الواقع يحدد اللغة؟ سألتني قبل قليل عن دور الفلسفة، أقول إن وعي الواقع هو الذي يحدد لغة الواقع، وهذا الوعي يتطلب كائنًا يتأمل، يتفكر. وكما قلنا، الذهنية تتبدل عندما أعي أني أتفكر في مسائل معينة. وأنا لا أنفكِرُ؛ إذ لو كنت أنفكِرُ بنفسي فقط، لكان لدي مفهوم للعيش، أعيش فيه بمفردي، لكن طبيعة الإنسان أنه يتفكر بـ، يعني تلقائيًّا يتواصل. مفهوم التواصلية عند الإنسان هو مفهوم اتصال بالآخر. معنى ذلك أن القيم لا يمكن أن تنجز بانفراد، بل بالاشتراك. يجب أن تشترك قيم الآخر في صناعة قيمك أنت. هذا يعِد دائمًا بأن لغتك ستتحدث تلقائيًّا بقيم الواقع، لا يمكن اليوم أن تفارق عيشَك وتتحرر من مشاكل هذا الزمان. مثلاً، افرض أنك في مجتمع قرية معينة محافظ، ثم حدث أن ذهبت إلى المدينة للعيش أو الدراسة والإقامة فيها، دعاك رفقاؤك المدنيون لتنزل معهم إلى البحر، وأنت في مبادئك ومعتقداتك أن البنت لا يمكن أن تلبس وتظهر على البحر. أول شيء نزلت إلى الشاطئ، ومشي الأمرُ كما نقول، وصار عاديًّا أن ترى ما أنت فيه، بعدها صرت تنظر وتفكر في الموضوع، من جهة قبوله وربطه بالقيم والتحرر. فالصبية صديقتك، وتصل في قناعتك أنها مثل أختك، وهي حرة تعمل ما تريد، أنا ليس لي دخل في ما تلبس. ثم تخاطب نفسك وتهمس "يا أخي، الحرية حلوة". انطلقت من قيم سابقة كانت عندك إلى تجديد قيمِك بشجاعةٍ وفق ما يقتضيه الواقع. هل تنازلت عن أخلاقيتك، أم جددت قيمك بما يتناسب مع كائنيتك الحاضرة، أي ما قبلته أنت قيمًا جديدة تُرضي بها وجودك؟
الاتصال بالمجموعة هو الحقيقي الذي صنع كل شيء. فلو بقيت على قيمك السابقة في لغتك الراهنة، لحدث بينك وبين حضورك المدني في هذا المكان افتراق وتباعد، ستكون مفارقًا للمجتمع، لا تصلح للعيش فيه. إذا كانت قيمك سابقة على لغتك الراهنة، فلا يمكن للغتك السابقة أن تشرح واقعيتك الراهنة. فإذا جرى تطور ما، سيُحدث تحولًا لغويًّا يطال خطابك اليومي، بل هو تطور قيمي وأخلاقي، وبالتالي تفكيري، وسيحدث عندك نقلة نوعية في إحداث أي شيء تريده من الآن فصاعدًا.
د. حسام الدين درويش:
دعنا ننتقل إلى النص الأخير، وهو أصغر وآخر النصوص، وقد يكون أخطرها: نص "ما الذهنية؟". لقد تساءلت عن معقولية استخدام الدكتور سعد لمفهوم العقل العربي، قال: إذا كان هناك إشكال حول مصطلح العقل العربي، فلنقل الذهنية العربية. لم أقل حينها إن مصطلح الذهنية العربية أخطر وأكثر إشكالية، في هذا السياق، على الأرجح، من مصطلح العقل العربي. فإذا انتقلنا من الحديث عن كونية العقل، وعن كونه - كما قال ديكارت - موزع بيننا بالتساوي، إلى الحديث عن خصوصيات ثقافية، وعن عقل عربي، عقل أوروبي، ...إلخ، فقد يفضي ذلك إلى مقارنات وتفاضلات: عقل أفضل من عقل، وهكذا. فالسؤال مبدئيًّا: ما الذهنية؟ ولمَ البحث في الذهنية أو في هذا المفهوم؟
د. خالد كموني:
أولًا، من ناحية تاريخية، هذا المفهوم ودراسته هو مفهوم استعماري؛ أي ذهنيات الشعوب؛ لأن هناك ذهنية تحكم على ذهنيات أخرى، وبالتالي الذي يبرز مفهومًا معينًا، يريد أن يميز نفسه عن الآخرين. لكن المشكلة ليست في الذهنيات الموجودة، المشكلة أنه الآن لم يعد لديك خيار في التذهن الفردي مقابل، مثلاً، أي ذهنيات موجودة. الذهنية اليوم تُصنع بالقدرة على الفاعلية؛ أي إن الكائن اليوم كائن رقمي. ذكرت قبل قليل مسألة تتعلق بقروي نزل إلى مدينة. طيب اليوم، إذا قلت لي «الكينونة من وراء الشاشة»، فرضًا هذه العبارة التي تجمع كل الهويات على التزام محدد بشروط الفيسبوك مثلاً لتنزيل منشورٍ معين، بهذه الطريقة، هناك شروط أخرى للذهنية تفرضها عليك التقنية، وتشترك أنت في هذه الذهنيات مع كثيرين مثلك في أنحاء العالم. فإذن، الفاعلية هنا لمن تكون؟
د. حسام الدين درويش:
إذن، الذهنية هي طريقة تفكير معينة، معرفة منهجية؟
د. خالد كموني:
هي طريقة تفكير معينة، لكن ما سألت عنه أنا، هل يمكنك أن تمارسها بالمطلق؟ لا يمكن، يعني ما صار واقعًا اليوم، هو أن الذهنية فعليًّا لا يمكن إلا أن تقوم على تواصل مع الآخر، يحدد لك شروط العيش في هذا الكل. وأكثر من ذلك، لا يمكن أن نبدأ من عندنا ممارسة ذهنيتنا. ما نظَّرت إليه في هذا الكتاب أنه لا أحد من الشعوب مارس ذهنيته بالمطلق.
د. حسام الدين درويش:
كيف نعرف الذهنية دون ممارسة؟
د. خالد كموني:
عندما تواصل العرب مع غيرهم من الشعوب، يقال تأثروا بغيرهم من الشعوب وأخذوا من عاداتهم، وهم أعطوا عاداتهم لغيرهم من الشعوب. لذلك عندما نشأت الدراسات اللغوية الأولى، مثلاً، ذهب العلماء الأوائل إلى ابن البادية ليأخذوا منه العربية الأصيلة. هل تعتقد من الناحية الواقعية التاريخية أن الذهاب إلى البادية واستجلاب المفردات هو الذي سرى فعليًّا في تجديد اللغة؟ أم ما استجدَّ من ألفاظ نتيجة التواصل العربي مع المحيط؟ ما استجد من ألفاظ هو فعلاً الابتداء الحقيقي للذهنية العربية الراهنة يومها، هو الابتداء الحقيقي للهُوية أيضًا؛ الذهنية مسألة هوية. لذلك، صحيح أن الغرب فرض متغيرات كبرى على العالم وفرض ذهنيته في كثير من المواضع اليوم، ولكنه لا يستطيع السيطرة كليًّا على ذهنيات مقابلة له، بالتآثر المتبادل لا بالسيطرة، في مواضع يظن أنه مسيطر عليها مطلقًا بمجرد تهديدها باستخدام السلاح الفتاك.
د. حسام الدين درويش:
يبدو مفهوم الذهنية ضروريًّا، من ناحيةٍ أولى، للتمييز بين أطراف متعددة، لكنه يبدو فيه مجازفة خطيرة، وهو خطر الانزلاق إلى التنميط. وهذا التنميط والتصنيف فيه عنصرية وتفاضلية، مثل ذهنية متخلفة، ذهنية متقدمة، ذهنية عربية، ذهنية إسلامية، ... إلى آخره. ونحن هنا لا نتحدث عن مجرد مخاطر أو احتمالات نظرية أو احتمالات، وإنما نتحدث عن أمور مورست فعليًّا. فسؤالي هنا: إلى أي حد نحن مضطرون أو بحاجة إلى مثل هذا المفهوم؟ ألا ترى أن مخاطره ومحاذيره أكبر، ومن ثم، ينبغي الابتعاد عنه؟
د. خالد كموني:
المشكلة، كما قلت لك، في هذا المفهوم أنه إلى الآن لم يحدث تجاوزُه. أعطيك مثلًا من ناحية النظرة السياسية إلى ما يجري الآن في فلسطين، مشروع الصهيونية مشروع تجاري تستفيد منه الدول الكبرى عبر هذه المجموعة اليهودية، ولكن الاستثمار في أن يستفيدوا من هذه المجموعة تجاريًّا يكون بتطوير مفاهيم دينية معينة قديمة، وأساطير تحفز على تفكير نشِطٍ بالهيمنة، وصولًا إلى تطوير صورة الدم في ذهن الممارسات اليومية، وتقديس القتل في سبيل فكرة إنشاء دولة وقومية متخيلتين، وإلى ما هنالك من قباحة الوجود العنفي في العالم. إذن، فاعلية الذهنية لا يمكن تجاوزها، لذلك من الخطورة بمكان التغاضي عنها. تجنب البحث في الذهنيات ليس فيه سلامة وعافية لتحقيق مفهوم التواصل الذي هو واجب بين بني البشر. هناك ذهنيات مختلفة، لكن الذهنيات القاتلة هي ما يجب الاشتغال عليه. والمهم هو كيف يتم الاشتغال بقرار واعٍ لضرورة بناء المشترك الإنساني؟ ليس بالمقصود قرار، كأن تقول مثلاً: أغير ذهنية فلان بالسيطرة، أو أن ألغي ذهنية أحد، لكن أن تجري دراسة الشعوب لبعضها. مثلاً، نتحدث عن نزعة إمبراطورية عند هذه الدولة، وعن نزعة هيمنة عند أخرى، أو عن نزعات تفكيك وإقصاء عند شعوب حاضرة اليوم. هذا الوسم للآخر بكذا وكذا ناجم عن تفكير بما هو أبعد من ذلك، هو محاولة لمعرفة طريقة تفكيره بالآخر. المجتمع الإسلامي مقابل المجتمع الغربي، يبرز في هذه الحيثية مفهوم الكفر؛ إذا وسم المسلمُ المجتمع الغربيَّ بأنه كافر، مثلاً، ممكن أن تجد نفسك ترفض هذا الوسم في كثيرٍ من الأحيان، لكن قد تتغاضى عنه في حالات الانفعال، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه وارد في ذهنيتك أنه كافر. وكذلك نجد رئيس أميركا جورج بوش قبل أن يحتل العراق يقول هذه حرب صليبية وربي سينصرني.
معنى ذلك أن الاشتغال على مفهوم ما الذهنية اليوم ينبغي أن يكون ابتداء لا يمكن استثناؤه. من هنا نفهم ما قلته لك في بداية اللقاء "أن تصبح الفلسفة فلسفة علم". نعم، لأنها إذا ارتبطت بعلم اليوم فربما ستتذهَّن بأخلاقيات الحضور العلمي الممكن ليومنا. وعلى اللغة أن تصبح لغة علم؛ لا تفارق ثقافة اليوم. فبدلاً من الشرف نصبح نتحدث عن الكرامة، لكن تبديل هذه الذهنية ليس بقرار جمهوري، بل يكون بالاشتغال الفكري الدؤوب، وبتحفيز الدرس الفلسفي للواقع، حتى تنبت مفاهيم تجعل التصور دائم المحايثة للأشياء في المشهد المعيش.
د. حسام الدين درويش:
أظن أن المسألة متصلة بعلاقة الفلسفة بالعلم. أنا أرى أن الفلسفة غالبًا ما تخون أمومتها، أو كونها "أمًّا"، حين تتنكر لأبنائها وترفض استقلالهم عنها. لكن أيضًا، إذا أردنا من الفلسفة أن تتحول إلى لغة العلم، فإنها في نظري تخون ذاتها؛ لأن اللغة الفلسفية ليست هي اللغة العلمية. فهل يمكنك التعليق على هذه المسألة. تفضل. وما مشاريعك الفكرية الجديدة؟
د. خالد كموني:
لن تكون لغة الفلسفة إلا لغة الفلسفة، لكن ألا تخون أبناءَها أو تستغني عنهم؛ فهذا يعني ألا تتجاوز حضور أبنائها. أما إذا كان العلم، قد فرض علينا إشكالياته الراهنة، مثلًا مع الذكاء، ترى أن الذكاء الاصطناعي أصبح موضوعًا فلسفيًّا، لماذا؟ لأن هناك علاقة قيمية مع الذكاء الاصطناعي، علاقة بيولوجية مع الذكاء الاصطناعي، العلاقة مع هذا الذكاء الاصطناعي هي على مستوى الوجود الفاعل في العالم، ترى هنا لغة الفلسفة هي التي تطور العلاقة بالكون، بما يضمن إبداعية الإنسان.
أما المشاريع القادمة، فإن ما أكتب فيه حاليًا، هو تطوير بحث عن منمنمات حسام الدين درويش، إذ أثارتني هذه الدقة في التنبه إلى تفصيلات سلوكية أعدتها يا حسام إلى مبعثها القيمي أو سببها الواقعي أو غير ذلك. ثم أريد استكمال بحث بدأتُه مع مؤمنون بلا حدود عن الحاجة إلى فلسفة الدين، فسأضيف إليه تجريبًا معينًا، وسيصبح كتابًا، ليستكمل هذا المفهوم بأناةٍ تحقق جدواه التأويلية.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا جزيلًا، وشكرًا لمؤسسة مؤمنون بلا حدود التي جمعتنا، وأرجو أن يكون الحوار قد حمل بعض الاستفزازات المفيدة. وبالتأكيد، نبقى على تواصل.
د. خالد كموني:
شكرًا لك.