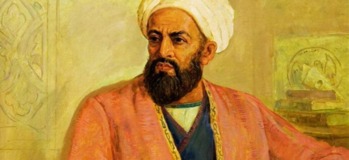قراءة في الرؤية والمنهج مع د. خالد كموني - ذ. ريم الدندشي
فئة : حوارات

قراءة في الرؤية والمنهج
مع د. خالد كموني - ذ. ريم الدندشي
"الوعي الكوني لا يمكن أن يتم قبل وعي الذات في محلِّها، والمحلُّ هو الوطن"
حاورهما د. حسام الدين درويش
د. حسام الدين درويش:
أرحّب بالسيدة ريم الدندشي، الباحثة في مرحلة الدراسات العليا - قسم الفلسفة في الجامعة اللبنانية، ورئيسة هيئة المقرّرين في المعهد العالمي للتجديد العربي، ومقرّرة وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد ذاته. وهي أيضًا مهندسة زراعية حاصلة على ماجستير في أمراض النبات، وأخصائية تربوية لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد عملت مدرّبة في هذا المجال. السيدة ريما متعددة المواهب، وما ذُكر هنا إلا بعضٌ ممّا مارسته وعملت فيه.
كما أرحّب الدكتور خالد كمّوني، أستاذ الفلسفة في الجامعة اللبنانية. باحث في فلسفة اللغة والتأويل وقضايا الفكر المعاصر. له عدد من الكتب والدراسات، آخرها كتاب "ما الذهنية؟" (الصادر عن بيت الفلسفة في الفجيرة- الإمارات العربية المتحدة). وهو عضو في عدد من الحلقات الفلسفية والبحثية، مثل "حلقة الفجيرة الفلسفية"، وهو رئيس "وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي"، وعضو الهيئة الإدارية في "الاتحاد الفلسفي العربي".
كان هناك تعاون سابق، ويوجد تعاون حالي، بين مؤمنون بلا حدود والمعهد العالمي للتجديد العربي، وقد يكون هناك تعاون مستقبلي أيضًا. ولنستهل الحديث بالتعريف ﺑ "المعهد العالمي للتجديد العربي" بصورة عامة، ثم ننتقل بشكل خاص إلى وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية داخل هذا المعهد. من الناحية الهيكلية والتنظيمية والمؤسساتية، هل يمكنك أن تُحدّثينا، العزيزة ريم، عن ذلك؟ وطبعًا، هناك أيضًا جانب فكري؛ تفضّلي.
ذ. ريم الدندشي:
تحياتي للجميع، وشكرًا جزيلًا على الاستضافة وعلى هذا التقديم؛ ويسرّني أن أتحدث عن المعهد العالمي للتجديد العربي. لقد كنا سعداء جدًّا بالتعاون مع مؤسسة مؤمنون بلا حدود، من خلال الندوات المشتركة التي نظمناها معًا.
المعهد العالمي للتجديد العربي منظمة فكرية ثقافية، غير ربحية، وغير سياسية، تسعى بجدّية إلى النهوض بالفكر، والاهتمام بالشباب، وتعزيز الحركة الفكرية في العالم العربي، في ظل التحديات الحضارية والثقافية المتسارعة التي نواجهها في عالمٍ يتقلّب بين الثورات والتحوّلات الكبرى، يسعى المعهد إلى مواكبة كل هذه التطوّرات من خلال قراءتها وتحليلها ضمن فضاءاته الفكرية والثقافية المفتوحة. ثمة نقطة أساسية أحبها في المعهد، وهي ما الاستفادة من هذه الأنشطة؟ إن ما يميّز المعهد - في رأيي - إلى جانب تنظيمه المُحكم، هو التنوع في انتماءات الأعضاء، وهو يُتيح إمكانًا حقيقيًّا لقراءة المجتمعات العربية من مختلف الزوايا: الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية، وغيرها، بما يقدّم صورة معمّقة عن قواعد هذه المجتمعات، ويسمح بالاشتغال الفكري الجدّي الذي يمكن أن يُغني هذا الواقع العربي.
أما من الناحية الهيكلية، فيتكوّن المعهد من مجلس للمعهد، والهيئة العامة للمعهد، والهيئة التنفيذية والإدارية والعديد من الفروع والأقسام تنفيذية، مع وحداته الفكرية المتعددة. وأحب أن أتوقّف هنا عند مسألة مهمّة، وهي التنوّع الثقافي الكبير الذي يحتضنه المعهد؛ إذ يضمّ 21 وحدة مختلفة، تتيح قراءة متعددة الأبعاد للواقع العربي، والوحدات الفكرية منها: الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية، الترجميّة، الفلسفية، ...إلخ. وكل وحدة لها رئيس، ومقرّر، وأعضاء، ويتعاون الرئيس مع المقرّر على إعداد برنامج سنوي، يُحدَّد في بداية كل عام، خلال اجتماع مجلس المعهد بحضور رؤساء الوحدات، ورئيس المعهد، والهيئة التنفيذية والإدارية. خلال هذا الاجتماع، يتمّ اختيار "التيمة" أو المحور الأساسي الذي سيشكّل الإطار العام لأنشطة المعهد خلال العام، وهو محور يستجيب لما يفرضه الواقع العربي ويجول في راهن العالم. ويُبنى على هذا المحور برنامج يتضمّن 12 ندوة، بمعدّل ندوة كل شهر، يُشارك فيها محاضرون من اختصاصات متعددة. وإلى جانب هذه الندوات المركزية، تُنظّم الوحدات الـ21 ندوات خاصة بها، فضلًا عن اجتماعات أخرى دورية، تعكس حيوية النقاش الفكري والحوار المتعدّد.
ولابد من الوقوف عند هذا النشاط الفكري المهم الذي يحرص المعهد العالمي للتجديد العربي على إنجازه انطلاقا من الموضوعات الراهنة التي تشغل الواقع العربي، والتي يمكن أن تُطرح كعنوان أو كمبحث لمؤتمر سنوي يعقده المعهد، يشهد لقاء الأفكار والعصف الذهني والحوار الذي يحثّ الفضاء الفكري المعرفي والروح النقدية في تناول إشكاليات العالم العربي وواقعه الراهن.
وأحبّ أن أختتم هذه الكلمة بالإشارة إلى أمر أراه جوهريًّا في تجربة المعهد، وهو الحرية الأكاديمية والفكرية: فلم يُفرَض يومًا على أحد طريقة محددة في تناول الموضوعات، ولا تمّ تقييد أي رأي. كلّ فرد له حريته الكاملة في التعبير عن تصوّره. وأنا، كمقرّرة لوحدة الدراسات الفلسفية، أمارس هذه الحرية بكل مسؤولية. وربما لاحظتم ذلك في الأنشطة التي نظّمناها؛ إذ لم يكن هناك أي تقييد، بل على العكس، هناك دومًا سعيٌ حقيقي لفتح الآفاق أمام رؤى جديدة ومقاربات غير تقليدية؛ لأنّ هدفنا في النهاية هو التجديد، والخروج من أسر السائد والمألوف.
د. حسام الدين درويش:
لننتقل إلى مسألة فكرة "التجديد العربي". ما المقصود بالتجديد هنا؟ ما نوع التجديد الذي يسمح به المعهد؟ وبأي معنى هو "عربي"؟ هل هو مرتبط بالواقع العربي، بالفكر العربي، أم فقط بالعرب الذين ينفّذونه؟ وفي هذا الإطار، ما دور وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في هذا التجديد؟
د. خالد كموني:
شكرًا على السؤال حول ما يقوم به المعهد الذي يعمل على بناء مشروع للمستقبل العربي، وفق معايير مدنية إنسانية، كما جاء في ميثاقه. معايير المدنية الإنسانية تفرض التجديد في الرؤية والتخطيط لبناء منظومات فكرية حرة. وكما ذكرت الصديقة ريم، فالدراسة النقدية، العلمية، المنهجية لتيارات الفكر العربي والعالمي، هي من طبيعة الاشتغال الفكري في المعهد. لماذا كل هذا؟ لأنّ نظرةً إلى التجديد قائمة على فكرة أن نواكِب، كما نذكر دائمًا، أن نشغل الفكر بالراهن، لنُحدِث شيئًا جديدًا. فالدافع إلى إنشاء هذا المعهد هو تساؤل يراود كل مفكر عربي عرف بنشاطه وطلب الانضمام إلى أي وحدة من وحداته الفكرية، ويراود كذلك أيّ باحث أصبح داخل هذا المعهد، ذلك أن الاشتغال الفكري المنتظم عربيًّا، من حيث تحشيد الطاقات وتوزيعها بحسب الاختصاص لتحصيل إنتاج بحثي فكري نوعي، يأتي بعد مرحلة – لم تؤدِّ ما كان منوطًا بها سياسيًّا واجتماعيًّا وأيديولوجيًّا حتى؛ ذلك أن انعطابات كبرى حدثت في التطبيق والاختبار للأفكار والمبادئ في تجارب الحكم العربية وإداراتها للبلاد ما يقرب نصف قرن وأكثر. فلا بد من مرحلة ما بعد الأيديولوجيا، وهي مرحلة التفكّر النقدي، مرحلة التفاكر والتفكر، والإفساح في المجال لنرى العلوم على هيئتها، لنرى الحوارات كيف تكون بعد كل ما جرى، وأن نراها كما هي، لندرك ممكنات التجاوز وفرص الإبداع والانطلاق من جديد.
لذلك، كان تفصيل الوحدات وتوزيعها داخل المعهد، كما ذكرت الأستاذة ريم، ومن ضمنها وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية. وقد كانت نشأتها نشأةً قصديِّة واعية لوظيفتها الراهنة؛ إذ كانت هذه الوحدة مدمجة مع وحدة الدراسات الحضارية وعلم الأديان، فتابعتُ نشاط هذه الوحدة لفترة تقارب شهرين أو ثلاثة، لثلاث أو أربع ندوات، وجدتُ من خلال مراقبة الزخم التفاعلي للفكرة الحوارية، أو التي تكون موضوعًا للمحاضرة الشهرية، أن هناك ضرورة لفصل الفلسفة بمفردها وتعزيز مكانتها في التجديد؛ لأنّ هناك مشروعًا لا يقوم فقط على النقد، ولا على الجمع الثقافي للمعلومات أو نقدها، بل هناك حاجة إلى فلسفة للخطو التجديدي المحايث. وهذه الفلسفة حرَّرت الانشغال التجديد من إمكان الوقوع في لحظات اتِّباعيَّة أو تقليدية، وفتحت الجدلَ على الموضوعات الكبرى التي تُطرح كل سنة في المعهد ومؤتمراته، حيث إن الارتقاء من الجدل إلى التأسيس صارَ واردًا في كثير من المواقف التي حضرت فيها الفلسفة. وبالتالي حدث هناك تفاعل حقيقي داخل كل ندوة، مسَّ انشغالات الوعي داخل كل حوار يجري بين المحاضر والمعقّب أو بينه وبين المتداخلين، ذلك أننا لمسنا جرأةً حضورية في تعديل الآراء وبناء المواقف استنادًا إلى ما يدور من تطوير للفكرة وصقلها ومعاينتها الحرة في كلِّ جلسةٍ أو أمسية نعقدها.
وقد وجدتُ، في الفترة الأولى وما تلاها، ما يؤسس لشيء فلسفي جديد بمعنًى معيّن، حيث زاد عدد أعضاء الوحدة الفلسفية كما أعضاء المعهد عمومًا، وهو قد بلغ الآن ما يقرب من ألف ومئتي مفكر وباحث، فصار التجديد نتيجة هذا الجمع الذي يتيح إمكان الاختلاف والتحاور؛ مثلًا، قضيّة التجديد لا تُطرح فقط بصيغة "التجديد العربي" أو نحو ذلك، بل طُرح في البداية: ما الفلسفة؟ وما التجديد؟ وما التجديد الفلسفي؟ وما الجديد في الفلسفة؟ وهل يمكن للفلسفة أن تقدّم جديدًا؟ إضافة إلى هذه الأسئلة، وجدنا أنّ هناك، لا نقول أبحاثًا مغمورة، بل مواقف ضرورية لم تكن قادرة على أن تبرز؛ لأنّ أحدًا لم يُفسح لها المجال لتظهر بالطريقة التي تلائمها، وفي السياقات التي تتوضح فيها. مثلًا، لم نطرح مسألة فشل سياسي أو فشل أيديولوجي أو غير ذلك من الجدالات العمومية، بل طرحنا مثلًا: لماذا نحتاج إلى فلسفة الأطفال؟ مثلًا، مع الدكتورة هدى الكافي وهي المختصة الرائدة في هذا المجال عربيًّا، فكان لديها تفصيل لفلسفة الأطفال، برنامج كامل متكامل، واحتجنا فيه إلى استدعاء أحدهم في الفلسفة التطبيقية، واحتجنا إلى رأي آخر ممّن يرى أن الفلسفة للكبار وليس للأطفال، فتنوعت الآراء حول هذه الفكرة. ما يلي هذه الندوة، أو ما يلي كل ندوة، هو تجميع الأوراق لنشرها، وبالتالي توثيق هذا النتاج، والارتكاز عليه عند تجميع الأوراق البحثية والفكرية لعقد المؤتمر.
فالمؤتمر يتقرر دائمًا بناءً على الموضوع الأكثر إثارة للجدل، ويكون الهدف منه إبراز عنوان معيّن، كأن يكون الهدف العمومي: بناء منظومة فكرية عربية حول قضية ما، بناء فكرة المواطنة حول قضية ما، بناء تصوّر للمستقبلات...إلخ. مثلًا، ما تحدثت عنه من مفهوم للحرية، برز في مصطلح أعجبني طرحه الباحث في دراسات المستقبلات الدكتور مازن رمضاني؛ إذ لم يقل "البحث في المستقبل"، بل قال: "ليس هناك مستقبل واحد للإنسانية، بل مستقبلات"، وأنا أختصر رأيي بالقول: نعم، هناك مستقبلات. وسرى هذا المصطلح في أدبيات المعهد، فصرنا نقول: مستقبلات بدل مستقبل. فمثلًا، هذا النوع من التفكير؛ لأنّ الطموح داخل المعهد كان هو تأسيس مدرسة فكرية عربية، قوامها هذا الفكر النقدي الجمَّاع، الذي يؤسس منطلقات نظرية، كما نقول.
ذ. ريم الدندشي:
لفتني سؤال الدكتور حسام حول موضوع "العربي" في الاسم. أنا مقررة وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية، وكان يُطرح عليّ سؤال: لماذا "التجديد العربي"؟ من منظوري أنا – مع التأكيد على كل ما ذكره الدكتور خالد – فإنني أرى "التجديد العربي" انطلاقًا من مظلّة لغوية. أنا أؤمن بجذرية التجربة اللغوية في قدرتها على تغيير أنفسنا. أنا، كما قيل، باحثة أشتغل على الهيرمينوطيقا وأحبها، بل إنّ بحثي ينتمي إلى هذا المجال. وحين نقول "هيرمينوطيقا"، فإننا نتحدث، حتمًا، عن اللغة، وندخل في معارجها، سواء من جهة منطلق الفلسفة التحليلية أو الفلسفة التأويلية. فاللغة، فعلا، هي الأساس الذي يمكن أن ننطلق منه في التغيير والتجديد؛ لأنّ التجربة الإنسانية تجربة لغوية، والحدث اللغوي ليس مجرد حدث تواصلي. هناك كثير من النظريات التي تطرح أسئلة مثل: هل اللغة أداة تواصل فقط؟ هل الفكر يسبق اللغة؟ لكن الحدث اللغوي هو، في جوهره، ما يُحدث التغيير. حتى إن لم نتوقف عند أعلام الهيرمينوطيقا الكبار، مثل شلايرماخر ودلتاي إلى غيرهم، فسنجد أنفسنا نقف عند غادامر؛ لأنّه مهم جدًّا، حين نتحدث عن موضوع التراث وموضوع اللغة؛ لأن لديه حدث الفهم الذي يحصل كنتيجة للوعي المتأثر تاريخيًّا. وهذا يُدخلنا في علاقة اللغة بالتراث، ويفتح على إشكاليات فعلًا تُعاني منها المجتمعات العربية. فعندما نقول "الفهم" و"هيرمينوطيقا" و"تراث" و"تجديد"، فإننا نفتح على إمكانات تأويلية حقيقية في هذا المعهد، تحت مظلّة اللغة. وربما تصبح اللغة المنطلق الذي يحدث التجديد وتؤثر به وحدة الدراسات الفلسفية.
د. حسام الدين درويش:
بعد هذا التقديم العام للمعهد والوحدة، وسنعود إلى موضوع الهيرمينوطيقا وغيرها، دعونا ننتقل من هذه العمومية الكبيرة إلى الخصوصية والفرادة، وهي متمثلة بحضرتك، الأستاذة ريم. لا شكّ أنّ كل إنسان فريد، كل إنسان فرد مميز وفذّ، لكن هناك حتى فرادة بين الفرادات، وما شاء الله، أنتِ كذلك. فأنتِ متعددة التخصصات والمسارات المهنية؛ فقد انتقلتِ من مجال إلى مجال: من الهندسة الزراعية إلى أمراض النبات، ثم إلى التربية الخاصة، فالفلسفة ...إلخ. كيف وإلى أيّ حد يمكن أن يكون هذا الانتقال عاملًا مساعدًا؛ لأنه يُتيح نظرة من الخارج ونظرة من الداخل؟ هل يمكن أن يكون عاملًا معيقًا، من حيث غياب التراكم في المجال نفسه؟ هذا ما نود أن نسمعه منكِ: كيف، ولماذا، ومعاني ذلك ودلالاته عندكِ؟ تفضلي.
ذ. ريم الدندشي:
الآن، تريد أن تُرجعني كثيرًا إلى أيّام زمان؛ لنقل إنّني بدأتُ دراستي في مجال الهندسة الزراعيّة، وتخصّصتُ لاحقًا في الماجستير بأمراض النبات. أتذكّر أنّه كان يُمكننا، في الجامعة، أن نعمل كمُعيدين أو مشرفين. لكن حصل أنني تزوّجت وسافرت إلى السعودية. وفي أواخر الثمانينيّات، لم يكن هناك مجال لعمل المرأة في تخصّصات الهندسة عمومًا، وخاصّة الهندسة الزراعيّة؛ إذ كان العمل يتطلّب الخروج إلى الحقل ومواقع أخرى، فكان المجال مسدودًا تمامًا. وأنا بطبعي، لا أستطيع أن أبقى من دون عمل. لا أستطيع أن أكون "ربّة منزل فقط" - مع أني أنا سيدة بيت -. في جدّة، بالمملكة العربية السعودية، عدتُ للدراسة، واخترتُ مجال "التربية الخاصّة" مع فترة الأمومة. عملتُ في "مركز العون لذوي الاحتياجات الخاصّة"، ودرّستُ فيه، وبقيتُ فيه ما يقارب 15 سنة. كنتُ خلال تلك الفترة سعيدة جدًّا؛ لأنّهم أشخاص في وضع خاص، وكان لديّ في عائلتي أيضًا حالة مماثلة: فقدنا أخًا كان من ذوي الاحتياجات الخاصّة. هذا العمل حقّق لي ذاتي فعلًا، وأعطيت فيه بقدر ما أخذت. كنتُ راضية تمامًا عن تلك المرحلة، رغم ما فيها من مشقّة جسديّة.
بعد 15 سنة، قدّمتُ استقالتي وعدتُ إلى لبنان، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتي. لم أستطع أن أبقى بلا متابعة أو انقطاع، فأنا كنتُ أقرأ دائمًا، منذ صغري، وكنتُ أحبّ التاريخ. ثمّ شيئًا فشيئًا، بدأت أوجّه نفسي نحو الفلسفة، وكأنها هي التي كشفتني. الفلسفة، بما تحمله من تساؤلات عن الوجود، والمعنى، والحياة، والإشكالات الكبرى، جعلتني أعود إلى الجامعة اللبنانيّة. لم تُعادَل لي الجامعة المواد السابقة، فبدأت من السنة الأولى، ثم الثانية، وها أنا اليوم في مرحلة الماستر. اخترتُ "الهرمنيوطيقا" تخصّصًا؛ لأنني أحببتُ هذا الفضاء الواسع الذي يفتحك على لا نهايات محددة، وربما هذه الاتجاهات النقدية الحديثة التي لاتقف عند النصوص، بل تأخذنا إلى إمكانات فتحها وتأويل المعنى وتجديده، ودور المتلقي في معاني ومستقبلات غنية وجديدة ومغايرة، فنحن نمتاز أن ثقافتنا ثقافة نص، ولا سبيل إلا التعامل مع النص بأدوات جديدة. هذا هو ما كنت أبحث عنه. أحببتُه، وتوقّفتُ عنده.
د. حسام الدين درويش:
لدي سؤال متعلّق بالمعهد، وبمسألة اختيار اسم الوحدة: وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية. فمن الواضح سبب تسميتها بالفلسفية، لكن لماذا إضافة كلمة "التأويليّة"؟ هل التأويليّة إضافة إلى الفلسفة؟ أم إنها تأكيد لهذا الجانب؟ يمكن المحاججة بأن التأويلية ضمن الفلسفة، فلمَ إضافة "التأويليّة"؟ هل هي مرتبطة بكَ؛ لأنكَ تأويليٌّ، أم إن لها معنًى أعمق من ذلك؟ هل التأويليّة لتأكيد أهمية هذه المسألة أو للتجديد عينه؟ أم إن هناك شيئًا آخر؟ وقد قيل أحيانًا - مثلما ذكرتُ في محاضرة لي في تونس - إنَّ التأويلية هي الفلسفة، وليست مجرد فلسفة، وهناك من قال إن التأويلية ليست مجالًا معرفيًّا ولا فلسفة، وإنما هي "روح الفلسفة والفكر" بمعنى ما. فهل من الممكن توضيح هذه المسألة؟
د. خالد كموني:
بالضبط، يمكن القول إن التأويليّة هي الفلسفة، بمعنى ما. ربما لو استعدنا الجانب الشخصي في هذه المسألة، لاستحضرت فكرةً كتبتها مرةً، وهي أن الفلسفة بلا اشتغال ذهني في ممكنات التأويل لجاءت كالمراسيم أو القوانين الدستورية، فيها من الجفاف ما يحجب سبر أغوارها بحثًا عن ماء السؤال؛ أي لولا تأويلية القول الفلسفي لما تماهى فعلُ التفلسف عينه بالتحرر أثناء الفكر والانهمام بالإشكالية التي تراود البال وتجول في الخاطر. لكن أقول إنّ عودة الوعي من الإيديولوجي إلى الفلسفي، عربيًّا، تمّت عبر التأويل. إن التأويل هو المجال المفتوح الذي أتاح تظهير التفسير من دُرْجَة التسويغ والتبرير المقترن بالجو الإيديولوجي أو الفكري السائد إلى مجالات استعادت فيها الذاتُ فرادَتها. والفرادة في هذه الوضعية هي التي تمكِّنُ الفيلسوف من محايثةِ الواقع في حدثيَّته، بأن يقرنَ سؤاله بتجربته الحية واختباره الفكري الحضوري، بدل التحجج بممكنات التطبيق الجماعي للفكرة، أو بمواكبة الفلسفات الكبرى السائدة.
إذا نظرنا إلى تجربة الفلسفة العربية في الجيل ما بعد الستينيات (مرحلة المدِّ القومي واليساري)، نجد أنَّ الفلاسفة استعادوا أجسادهم من شوارع التظاهرات الشعبية وأعادوا الانشغال بالنصوص والأفكار في لحظاتها التأسيسية. فما بقي من التطبيق الاشتراكي مثلًا، لن يظهر إلا بالكتابات النقدية الفلسفية التي استدعت المفهوم في إقامتِه فينا، فبدأت الكتابات التأويلية تعلو على الكتابات التنظيرية الأيديولوجية. فبدل الانشغال بقراءة أدبيات الحزب الشيوعي هنا وهناك، انصرف البحث إلى قراءة الماركسية في ذاتها، والماركسية العربية، وبدل قراءة فكر البعث أو الناصرية وتعزيز الشعور القومي، كما كان عند ميشيل عفلق، وأنطون سعادة، وكمال الحاج وغيرهم، وجدنا القوميين المتفكرين بالتجربة الحية يشتغلون بفهم التجربة الراهنة وشرح مفاهيم الدولة والاشتراكية والحزبية والثورة، والكل بدأ منفتحًا على مناقشة العلاقة بالتراث، وبالنص التراثي. وبدلًا من تحميل المسؤولية إلى أشخاص، بدأ الفكر الفلسفي العربي ينقذ المستوى الفكري بأن استعاد العلاقة بالنصوص؛ لأن المشكلة هي في كيفية التفاعل الفكري مع هذه النصوص. وهذا ما برز مع نصر حامد أبو زيد، والجابري، وحسن حنفي، وطيب تيزيني، وأبو يعرب المرزوقي، وصادق جلال العظم، وناصيف نصار، وفتحي التريكي، وأحمد برقاوي، ومحمد المصباحي وغيرهم، واستمرت الفلسفة العربية اليوم بشكل أنضجَ مناهج التفاعل الفلسفي التأويلي مع النصوص كما عند محمد محجوب، ومحمد شوقي الزين، وفتحي المسكيني، ومحمد الحيرش، وطه عبد الرحمن وغيرهم، هي أيضًا استعادةٌ للعلاقة مع النص، وقد تمّت عربيًّا بجرأةٍ تأويليّة، بمعنًى ما، كانت الجرأة تأويليّة؛ أي إن التأويل عاد ليمنحنا القدرة على إنتاج الفهم، وبالنتيجة إعادة الاعتبار إلى الذات في تجربتها الخاصة مع الفكر والواقع، حيث لا نستهين بالحدث القائم فنعبر بلا قدرة على تفسير مآلاته.
وبالعودة إلى تسمية الوحدة في المعهد، فلو أبقينا التسمية فلسفيةً فقط، لفتحنا المجال للبقاء ضمن دائرة النقاش الفلسفي التقليدي الذي يكتفي بالطروحات الأكاديمية والدراسات البحثية لمعالجة الموضوعات، وهو ما لا نسعى إليه، بل نريد التفلسف، وإدراك الفيلسوف الممكن اليوم. أما حين نقول "الفلسفة التأويليّة"، فنحن نفسح المجال لأن يكون هذا الفيلسوف، حاضرًا ضمن وحدة الدراسات الفلسفية، منفتحًا على البُعد التأويلي.
ونحن نتقصّد في كلّ محاضرة أن نُبرز الجانب التأويلي؛ لأنّ الفلسفة التأويليّة هي فعلًا الفلسفة المعاصرة، بعد كل ما مررنا به من تجارب فلسفية شارحة. ومن خلال التأويل، نؤدّي دورًا في الحريّة، وهو دور نحن بحاجة إليه. نحن بحاجة إلى أن نستكمل تفسيراتنا بتأويلات؛ أي أن نثبّت التفسير ضمن جدوى وجوديّة معينة. ما يُغري في الفلسفة، أيضًا، على الصعيد الشخصي والعملي، هو البُعد الوجودي. فخروجنا من إحباطات الإيديولوجيا لا يتمّ إلا إذا بقيت المسألة الوجوديّة استشكالًا مفتوحًا، بأن نعي أن وجوديتنا مفتوحة؛ أي قابلة للتجويد الدائم. وهذا يتمّ عبر التأويل، عبر هذا المنفذ الذي يربط الذات بتأثيرها وتأثُّرِها، سواء على النص أو الحدث أو على ذوات أخرى. فانفتاح الذات على الذات هو أحد أهداف التفلسف الراهن.
وبذلك أكون قد فتحت أمام وحدة الدراسات الفلسفية إمكانيّة التجديد من خلال التأويل؛ أي إمكانيّة أن يبقى هدفها قائمًا. وقد كتبتُ مرةً نصًّا لتبرير عمل "الحلقة الفلسفية" أو وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية، وسمّيتُه: "الاشتغال بالفلسفة حلقيًّا"؛ أي إنك لا تكتب موضوعًا فلسفيًّا وحسب، بل تهيّئ أيضًا لعقد ندوة فلسفيّة، تعرف فيها أنّ المُعقّب سيكون فلانًا وفلانًا، وهم أشخاص معروفون، لا مجهولون. فمثلًا، تقول: أريد أن أبحث في موضوع "التراث والحداثة"، ويكون من سيُعقّب على الموضوع شخصٌ مختصّ بقضايا التراث، وآخر يرى أنّه لا بدّ من القطع مع التراث. هذا هو الإغناء التأويليّ. فماذا نعني بالإغناء؟ ليس مجرد رأيٍ يقابل رأيًا. أحيانًا، يكون التعقيب، كما تعرفان يا حسام وريم، مدخلًا لإضفاء جديد، عبر تأويليّة صاحب الرأي. ليس بالضرورة أن يكون التعقيب قراءةً للورقة أو تعليقًا بسيطًا، بل قد يُدخل فيها رأيًا جديدًا، حتى ولو كان بسيطًا. وأحيانًا، تكون الآراء ساذجة، وأحيانًا عميقة، لكن الفرصة التي تتاح للتأويل هي الأساس. لذلك، جاءت هذه الفكرة.
ذ. ريم الدندشي:
أتذكّر أننا نحاول دائمًا أن تكون هناك وجهة نظر مغايرة. فأحيانًا، أتصل برئيس الوحدة، وأقول: "يا دكتور، صار المشاركون كلهم من لون واحد: تحليليّون! صاروا كلهم هيرمينوطيقيين! كلهم مع التراث! صاروا كلهم حداثويّين!" فنحاول أن ننوّع في المشاركين، لكي يكون هذا "الإغناء"، كما قلنا، وسيلة لخلق حوار فكري، ولإيجاد تنوّع، بل حتى لتوليد تضارب، أي آراء متنافرة، وهذا هو المقصود.
د. خالد كموني:
هناك أيضًا مسألة مهمّة في الجانب الفلسفي التأويلي، وفي كل وحدات المعهد، وهي أنّ الندوات المثمرة غالبًا ما تكون مشتركة بين وحدتين. فمثلًا، نقيم ندوة في موضوع فلسفيّ، فتشارك فيها وحدة الفلسفة مع وحدة الحضارة أو علم الأديان؛ لأن الموضوع مشترك. وهكذا، يغتني النقاش بشكلٍ كبير. فخلال انعقاد الندوة، تجد توليدًا حقيقيًّا للآراء، وهذه فرصة تتيحها طبيعة النقاش وطبيعة الوحدة التي تسمح بالحوار الجدليّ.
د. حسام الدين درويش:
في سياق الحديث عن الترتيب التاريخي، طُرِح موضوع اختيار "الهيرمينوطيقا". كيف وصلتِ، العزيزة ريم، إلى الهيرمينوطيقا؟ أحيانًا، تكون الدوافع عمليّة: كأن نجد تخصّصًا معيّنًا، أو نكتشف كتابًا بعينه، أو نلتقي بشخصٍ يثير فينا سؤالًا أو فكرة. وأحيانًا، تكون الأسباب أعمق: كأن تجذبنا فكرة وجوديّة، أو ينفتح أمامنا أفقٌ جديد لم نكن ننتبه إليه. لذلك، أخبرينا، انطلاقًا من تجربتك الشخصية، وبما أنّ بحثك في رسالة الماستر يدور حول الهيرمينوطيقا، كيف تمّ هذا الوصول؟ ما الأسباب التي دفعتكِ إلى اختيار هذا الحقل المعرفي؟ وما الذي وجدتِه في هذه الرؤية الفلسفية. وما الذي حفّزكِ على تبنّيها موضوعًا للبحث؟
ذ. ريم الدندشي:
كما نعلم، في الجامعة ندرس الهيرمينوطيقا كمادة من مواد الفلسفة؛ أي مادة من ضمن مناهج أخرى: الفلسفة التحليليّة، المنعطف اللغوي، وهكذا، إلى أن نصل إلى "الهيرمينوطيقا الفلسفية". أنا استوقفتني هذه النقطة؛ لأنها تستوقفني دائمًا وأشعر أن الكون كلّه نص يُقرأ، والوجود نصّ يُقرأ. هذا الوجود، كما أراه، لا نهائيّ التأويل، لا نهائيّ الانفتاح. ما جذبني إلى الهيرمينوطيقا هو هذا المجال غير المحدود، غير المنغلق على نهاية، المفتوح دائمًا، والذي يواكب أهمية الإنسان في الوجود. لا يمكننا أن نقول: هذا هو الإنسان، ونقف، بل يجب أن نسأل دائمًا: من هو الإنسان؟ والإنسان دائمًا "قادم"، ولا يمكن أن يكون الإنسان "قادمًا" إلا عبر الهيرمينوطيقا.
وكما قلت سابقاً، ثقافتنا ثقافة نص، والهيرمينوطيقا أفق فلسفي حديث، بدءًا من الهيرمينوطيقا التقليدية مع شلايرماخر ودلتاي، وارتباطها بالنصوص المقدسة، وصولًا إلى الهيرمينوطيقا الفلسفية ببعدها الوجودي المنفعل بالعالم، يدعونا إلى الوقوف عند إمكان هذه الفلسفة في الانفتاح على اللغة وإمكان المستقبل، علاقتنا بالتراث. وكيف يمكن أن نتلقاه تلقياً جديدًا.
د. حسام الدين درويش:
دعينا ننتقل الآن إلى مسألة اختيار موضوع رسالة الماستر. نحن، في الواقع، اخترنا "المنطقة" عمومًا؛ أي المجال التأويلي، لكنّ موضوع الماستر، شأنه شأن أيّ بحث علمي وأكاديمي، يحتاج إلى الحفر لا إلى التوسّع، إلى التعمّق لا إلى التشتّت. حدّثينا عن كيفية اختياركِ لموضوع البحث. وبالطبع، فإن لهذا الاختيار ظروفًا متعدّدة: منها ما هو شخصيّ، ومنها ما يرتبط بالعلاقة مع الأستاذ المشرف، بل أحيانًا يكون للمشرف دور في توجيه مسار البحث، أو في بلورة الموضوع. فلنبدأ من هنا: كيف تمّ اختيار هذا الموضوع؟ ما أسبابه؟ وما سيرورة الوصول إليه؟ ثم ما أهمية هذا الموضوع، وما قيمته البحثيّة، من وجهة نظركِ؟ ولمَ اخترتِ محمد محجوب تحديدًا؟ ولمَ "التأويليات" دون غيرها؟ إذا كان العنوان المقترح للرسالة، "مقامات الابتداء في تأويليات محمد محجوب"، لافت؛ لأنّ محجوب يُعدّ (من) أبرز الفلاسفة الهيرمينوطيقيين العرب، وهو متعاون أيضًا مع مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، وقد أقمنا له مؤخرًا ندوةً تكريمية واحتفائية بفكره.
ذ. ريم الدندشي:
بدايةً، يمكن القول إنّه "أبو التأويليّات" بامتياز. لكن، وبكلّ صراحة، نحن في المشرق لا نحظى كثيرًا بكتب الدكتور محمّد محجوب، ولا حتى بكتب الدكتور فتحي إنقزُو أو فتحي التريكي غيرهما من الفلاسفة المغاربيّين. ما حدث هو أنني صادفت بعض كتبه عن طريق الاستعارة، ووجدت بعضها الآخر في المكتبة، فبدأت القراءة.تعرّفت إليه أولًا من خلال نشاطات المعهد، ثم توالت قراءاتي له، ولفتني منذ البداية هذا الغنى المعرفي الذي لا حدود له، وتلك الشبكة الواسعة من الإحالات التي تتخلّل كتاباته. حين تقرأ له، ترى أمامك نسيجًا معرفيًّا متعدد اللغات: العربيّة، الفرنسيّة، الإنجليزيّة، الألمانيّة، واليونانية... وأنت أعلم بشؤون الترجمة: فقد ترجم عن الجميع، واستحضرهم بلغاتهم. في فكره، تعمل الإحالات والاستحضارات معًا، بتناغم مدهش. كيف؟ أشعر أحيانًا وكأنّ فكره غيمةٌ نورانيّةٌ من العلاقات؛ قادرٌ في اللحظة نفسها على استحضار-لا أقول جميع-، بل عددٍ هائلٍ من الموضوعات والمفاهيم المرتبطة بقضيّة بعينها. ذلك الترابط، وذلك الامتداد، وتلك القدرة على الربط، تخلق غنىً معرفيًّا ملفتًا وفريدًا. وأودّ الآن أن أقول شيئًا قد يضحكك: أحيانًا، وأنا أقرأ له، أشعر أنّني أريد أن أبكي. لا أدري لماذا. ليس فقط لأسباب معرفيّة، بل لأني أقول في نفسي: هل هذا الشخص موجود فعلًا؟! وحين التقيت به شخصيًّا، قلت لنفسي: معقول؟! أنا الآن أجالس محمد محجوب؟! إنّه شخصية تُشعرك بأنّ دماغه محيطٌ بالإمكانات، مكتنزٌ بالإحالات والروابط.
ما حدث هو أننا قرّرنا أن نبدأ، وبدأت تصلني مؤلفات الدكتور محجوب، لا سيما أحدث إصداراته؛ إذ يمكن القول إن إنتاجه الفلسفي يمتدّ من مطلع عام 2021 إلى اليوم. له عددٌ من الكتب المهمّة، من بينها: "في استشكال اليوم الفلسفي: تأمّلات في الفلسفة الثانية من أجل إعادة التأسيس"، و"قصيد الفلاسفة: مجاورات شعرية"، و"مسالك الابتداء: دراسات هيدغرية"، إضافة إلى الثلاثية السيرية التي حملت عنوان "قدري الذي اخترت". بهذه الطريقة، بدأت هذه الكتب تصلنا تباعًا، شيئًا فشيئًا، وكان لذلك أثر كبير في توجيهي، خاصة وأن موضوعه المحوري يدور حول "الاستئناف" أو ما يسمّيه أحيانًا "الابتداء الثاني"، وهو ما يطرحه كمشروعٍ فلسفي متكامل. وأثناء قراءتي، خصوصًا لكتاب "في استشكال اليوم الفلسفي"، بدأت ألتقط خيوط هذا المشروع، وراودتني فكرة التناول البحثي له. فعرضتُ على الدكتور خالد أن أشتغل على جانبٍ من هذا الفكر، يتمحور حول ما أسماه "الفلسفة الثانية" أو "فلسفة الاستئناف"، كما يصوغها الدكتور محمد محجوب. تواصلنا في هذا السياق، وطبعًا شجّعني، فبدأت رحلة العمل على هذا الموضوع.
د. حسام الدين درويش:
هل اخترتِ الموضوع أم الدكتور محجوب؟
ذ. ريم الدندشي:
اخترتُ الدكتور محجوب أولًا.
د. حسام الدين درويش:
أحيانًا تُذكّرني مسألة اختيار موضوع البحث بالزواج؛ فبعض الناس يحبّون شخصًا ثم يتزوّجونه، بينما بعض آخر يُريد أن يتزوّج، فيبدأ بالبحث عن شريك. أنا لن أحدّد أين أضع نفسي تجاه هذين النموذجين، لكن دعونا نقول إنّ مسألة اختيار الموضوع، وكيفيّة هذا الاختيار، مسألة بالغة الأهميّة. كنتُ أقول دائمًا – إذا بقينا ضمن مثال الزواج – إنّ اختيار موضوع الرسالة قد يكون أخطر من الزواج نفسه؛ لأنّ الزواج، في أسوأ الأحوال، قد ينتهي بالانفصال. أمّا هنا، فلا وجود لانفصال! بل الأمر أقرب، في ما يشبه المجاز، إلى الزواج الكاثوليكي؛ التزامٌ أو ارتباطٌ لا انفكاك منه، بمعنى ما. فكيف تحدث هذه المسألة، عمومًا، وكيف حدثت في هذه الحالة، خصوصًا؟
د. خالد كموني:
أعتقد في تلك الفترة، وريم تذكر، كان الحوار يدور حول "المنتَج التأويلي"، ومعنى التأويل، وبروز فكرة التأويل في الفلسفة. ولا زلت أدرِّس هذه المادة: "فلسفة اللغة والتأويل". وقد أثارت هذه المادة عند ريم، وعند غيرها، سؤالًا مفتوحًا. في تلك الفترة، بدأتُ شخصيًّا أقرأ لمحمد محجوب مقدمات الترجمة، والترجمات والمقالات والدراسات التي كتبها. مثلًا لـ "الأنطولوجيا" التي ترجمها، مقدمة رائعة، يفتح فيها مصطلحًا مثيرًا. المثير في كتابات محمد محجوب، لو ربطنا الشخص بالظاهرة، أننا نجدها ظاهرة تأويلية. فلسفة محمد محجوب فلسفة واعية تمامًا بالمطلق للعلاقة بين المحلّي منتِجًا للفكرة وليس مجرد متلقٍّ، والعالمي بما هو شريك في الفكرة وليس مصدِّرًا فحسب. هذه القوة في هذا الشخص أثارت عندي مسألة الحافز، أننا لسنا أدنى فلسفيًّا؛ لأنني كل مرة أقرأ فلسفة، أجد الأبحاث تكرّر: "قال فلان"، "قال علّان"، "قال كانط". أما عند محمد محجوب، فنجد: "يقول محمد محجوب". جميلة هذه الفكرة. وبالمناسبة، هناك فلاسفة من المغرب العربي وجدتُهم على هذا القدر من الاقتدار. ربما هناك مدرسة فلسفية، كما تحدثنا، المعهد العالمي للتجديد العربي يسعى أن يكون مدرسة فكرية عربية. وربما الفلسفة في تونس والمغرب وكذا، قد شكّلت مدرسة فلسفية أنجبت عقولًا حرّة، برزت في فلسفات التريكي، ومحجوب، والمسكيني، وغيرهم.
هناك آراء ومواقف وجودية ظهرت في التأويليات، وربما برزت في تأويليات "مؤمنون" أيضًا، المقصودة في ناحية التأليف، ولكن أيضًا القصديّة في ناحية الفرادة. هناك فرادة في فكره وفلسفته، وهي واعية للعلاقات الثنائية في الفلسفة: تراث وحداثة، غرب وعرب، محلي وعالمي، مغاربي وعالمي... كلّها واعٍ لها. إذن، لديه ما يقوله. فعندما تقف أمام فكر فيه جديد، من الواجب دراسة هذا الجديد، ومن الواجب إشراك التأويل بالتأويل. لهذا، قلت إن الباحث بالتأويل فيلسوف بالقوة، حتى نرى الفلسفة بالفعل. لا يمكن البحث في التأويل إلا لمن هو فيلسوف بالقوة. وريم هي هذا الفيلسوف بالقوة عندما بدأت الكتابة. وانتظروا ما سيسرّ القارئ.
ذ. ريم الدندشي:
لا يمكننا اختيار الفيلسوف قبل أن نختار فكره. نحن نقول إننا اخترنا الدكتور محمد محجوب، ثم بعد ذلك قررنا عنوان البحث الذي سنتناوله. وكما ذكرنا، بعد القراءة، خصوصًا في كتاب "الاستشكال"، قرّرتُ أن أتناوله من زاوية مهمّة: العلاقة بين محجوب واليومي، الحدثيّ منه. فهو قد ترجم كتاب "تأويليات الحدثية"، الذي هو كتاب هايدغر "ما قبل الوجود والزمان"، سنة 1927، فتدرك إلى أيّ مدى يحضر الحدث واليومي والرّاهن، وأيضًا مسألة "الابتداء" عند هايدغر. إلى جانب ذلك، نجد موقفه من التراث، وأنا شخصيًّا أؤمن بهذه الثنائية: لستُ مع القطيعة، بل مع استحضار التراث وفق معاصرة، كما يقول محجوب، لننطلق منه. يمكن القول إنّ محجوب يُؤسّس "ابتداءه الثاني" على الفارابي، وعلى ابن خلدون، وعلى ابن رشد، لكن من منظور مغاير. حتى ضمن ما يُسمّى "مغاربية الفلسفة"، فهو يطرح أطروحات مغايرة تمامًا، وابتداءً مختلفًا عمّا طُرح كمشاريع فكرية في هذا السياق. لم يكن مجرد إعجابٍ به، بل شعرتُ أنّه يتكلم بلساني كفيلسوف، ولهذا رغبت في البحث في مشروعه؛ لأنه يُجسّد فكرًا حيًّا.
لعلنا تخيرنا مع محجوب الخروج عن التأسيس الميتافيزيقي للفلسفة الذي يفتح إمكانًا للتحرر من كوجيتو مسيطر، ليكشف أن مقامات الابتداء ليست مقامًا واحدًا، وأننا لن نسّرح ابتداء تأويليًّا مناسبًا إلا عندما نغادر واحدية البدء على الطريقة الميتافيزيقية التأويلية.
إن بدءًا مُستأنفًا في طرح نتسّيره مع محمد محجوب في استجلاء مقامات متعددة الابتداءات، سوف يدفعنا إلى تلمس إمكان ندرأ فيه الميتافيزيقي، نبتعد عن أنا "أنانوية "تعود إلى نفسها دائمًا بيقينها المطلق.
بهذا نتمشى مع محجوب "نحواً من تفلسف جديد" ارتبطت بطروحاته وفق ما يسمى "ابتداء ثاني" في استشكال اليوم الفلسفي، يطرحها بين، المنثنى والمنعرج. إنه العودة إلى النفس حين نتمثل الوعي بالعالم مختزلاً ومشمولاً في وجهة نظر، وذلك في استبدال "الذاتية الميتافيزيقية" الغربية إلى "أنا نفسي" التي تخصنا، تثنى من حدثها، لغتها معينات لغتها ومن تراثها ومن تجاربها التي لم تُستنطق وإحراجات هي سداة الخطابات الفلسفية الممكنة.
بهذا تأتي أهمية تأويلية محجوب في استشكال اليوم في سياق درء الميتافيزيقي باليومي وعلى استئناف الثاني للأول، وعلى تتّبع هذه الابتداءات.
لذا سيكون عملنا التمشي مع هذه الابتداءات داخل المفهوم الفلسفي وخارجه، كبارديغمات تحمل مواجهة الكوجيتو في التأسيس، نتوخى مع محجوب استجلاء مقامات الابتداء مع "البدء الذي لنا من قبل"، لعلنا ننخرط إذن فيما هو تأسيسي بالمعنى الهيرمينوطيقي، فيما هو إمكان للإقامة في تأويليات ابتداء، لا نزعم تحددها وانتهاءها، أو تبلور تصور عنها. إنها تسيّير لإمكان فيه نكون، مع طروحات محجوب.
إنها إذاً الوقوف عند الهيرمينوطيقا الفلسفية، عند البعد التطبيقي الذي يقف عنده محجوب، حيث مشروعه الابتداء الثاني، استئنافاً، نقف مع محجوب تأويليًّا بعد هايدغر وكتاب "الوجود والزمان"؛ إذ الوجود هو الفهم، فالوجود ينكشف في "الحدثيّة "و الحياة اليومية والمعيش وفي مقارعة "اليومَ" الهايدغري. بعد غادامير والموقف من التراث، يحايث الفهم الوعي التاريخي بالتراث. بعد "أنا نفسي" طرحها محجوب في العودة إلى النفس في موقف من الحداثة، يغدو معها التعقل هو مجال الأحداث ومجال الأفعال، والترجمة فعلاً فلسفيًّا تعقليًّا. بعد ريكور وهذا التماسف عن النصوص، والاستعارة وهذا التفكير الأكثر والخلق الدائم للمعنى. بعد كتاب ريكور "الزمان والسرد"، بعد سؤال "من نحن؟" وإمكان لهوية قصصيّة، بعد سيرة ذاتية لمحجوب في مجموعة كتبه: "قدري الذي اخترت"، تكتبه "أنا تاريخ" وتجسّد فينومينولوجيا التأمل الانعكاسي، فلسفة تفكرية مقابل فلسفة الوعي المباشر للذات، بعد إمكان متجدد للمعنى والابتداء الدائم مع اليومي، بعد ابتداء واستئناف على ميتافيزيقا الذاتية، وإبحار ثانٍ، في فضاء يخصّنا ويجمعنا تحت مظلة الفلسفة الكونية.
إذن، بعد طرح أصيل يطرحه محجوب في "استشكال اليوم الفلسفي، تأملات في الفلسفة الثانية"، التي مثلت نازلة فكره، استئنافًا وحيدًا (على حدّ قوله) يؤسس له مع الفارابي، وحداثةً، من العبرة إلى المعنى، يؤسس لها مع ابن خلدون، فيرسم بهذا ابتداءات مفهومية تعقلية، كما مقامات ابتداء لا مفهومية، توسّع الإمكان وتؤكد هذا المأتى اللافلسفي الذي يرتبط بتجربة الحياة، ويمثّل إبداعًا يوسّع المفهوم ويغنيه. بعد التوقف عند ذلك، اتفقتُ مع الدكتور خالد واخترنا العنوان الرئيس للبحث. لا أدري، الآن بعد الإيضاح، أي نوع من أنواع الزواج سيسميه د. حسام؟
د. حسام الدين درويش:
من الذي يُختار أولًا؟ وعلى أيّ أساس؟ أنتِ، العزيزة ريم، اخترتِ فكره، ثم اخترتِ الموضوع؛ لكن هناك طريقة ثانية: يختار أحدهم الموضوع، ثم يبحث عمن سيتناوله بالبحث. فأنتِ اخترتِ فكره، ثم بعد ذلك كان من الممكن أن تختاري أكثر من موضوع. وإن أردتِ الاستمرار في التشبيه، فقد اخترتِ "الزواج بالفكرة"، ثم بحثتِ عمّا تبحثين فيها. أعود وأسأل إلى أي حد، وبأي معنى، ترى، دكتور خالد، أن مسألة اختيار موضوع التخصص مهمة بالفعل، وليست، وينبغي ألا تكون، اعتباطية؟ ما المعايير التي يُبنى عليها اختيار الموضوع؟ هل يكون المشرف مثلًا؟ بالنسبة لي، كان هذا معيارًا مهمًّا؛ فالأهم في المشرف هو أن يكون لطيفًا، أن يكون إنسانيًّا. هذا هو الأهمّ. ثم تأتي المعايير العمليّة: هل لهذا الموضوع سوق؟ هل له أهمية وراهنية، في الزمان الحالي؟ ما رأيك؟ أنت اخترت موضوعًا، والآن تساعد أخريات وآخرين على اختيار مواضيعهم. فما أهميّة هذه المسألة؟ وما معاييرك فعلًا في اختيار الموضوع أو تحديده للبحث؟
د. خالد كموني:
اختيار البحث أو موضوع البحث لا تحدّده جهة واحدة؛ يعني الطالب والأستاذ يختاران الموضوع، ولكن هناك شيء مشترك، وهو أنّ اختيار الموضوع في البحث الفلسفي لا يمكن أن يتمّ دون حوار. فعندما تحاورتُ مع ريم، أثمر هذا الحوار شيئًا يمكن أن نستثمره: لماذا نبحث في فلان؟ معياري الشخصي هو أن نختار موضوعًا؛ لأننا بحاجة إلى من يبحث فيه ليستكمل أفكارًا ويستأنفها، فنحن نحتاجها. بالتالي، هو شريك في البحث، المستكمِل في هذا الموضوع.
أمّا إذا لم يكن الطالب بهذا المستوى، وكنتَ مضطرًّا إلى أن تختار له موضوعًا، أو هو يختار موضوعًا تقليديًّا، مثلًا "ابحث في كذا"، وهو فقط سيجمع معلومات، فهذا شيء آخر. أمّا أن تختار - أنت والباحث -موضوعًا، فهذا يعني الاستكمال، وهنا يوجد جانب شخصي معيّن، لا أقصد به الأنانيّة أو الشخصنة، بل الجانب الشخصي الضروري؛ أي أن ترى في الآخر كيف يُستكمل التفكير معه، لا أن تناقشه فقط كما أنت.
فمثلًا، عند محمّد محجوب، هناك فكرة "الابتداء"، وقد التقطت ريم "الابتداء" من خلال العناية بـ "الاستئناف" الذي طرحه محجوب، وغير ذلك؛ أي فهمت مقصودَه. وأنا عناني موضوع معيّن، وقلت لمحمد محجوب إنّ فكرة "الابتداء" جذبتني، فوجدتها – مثلًا – في عنوان كتاب وضّاح شرارة: "استئناف البدء"، بعد أن ترك تجربة أيديولوجيّة وبدأ بداية جديدة، فذكر أنّه استعاد اسمه الأبوي، وكان يُكنّى مثلًا بـ"أبو الليل"، وهذا يعبّر عن رحلة شخصيّة: ترك تجربة أيديولوجيّة، وانفتح فلسفيًّا. وهذا "البدء"، هذا "الاستئناف"، هو ما أغراني، هذه الانفتاحيّة المصطلحيّة تساوقت مع انهمامي في استئناف ذاتي بعد تجربةٍ لا بدَّ من تجاوزها، كي أواكبَ المفهمَة المنجية للفكر في المعيش.
أقول، إذا وُجد من يبحث في هذه الفكرة التي تقضُّ رأسكَ، فستجد نفسك في نصِّه تسبحُ بأريحيّة وهناء، لا بوصفك شخصًا أنانيًّا أو ذاتيًّا مع الطالب، بل ستجد نفسك موجودًا في اشتغاله بقدرة على تجاوز كلّ الأناوات الشخصيّة، في التعاون معه، أو مع هذا الآخر الإبداعي. فربما في هذه الفترة اخترنا فلانًا من الفلاسفة للبحث، ولكن في فترة أخرى، ستفرض الراهنية موضوعًا آخر، من أجل استكمال البحث؛ لأنّ اللامنتهي فعلًا هو البحث، واللامستكمَل بحثيًّا هو الشخص. كلّ ما تكتبه، تقول: "لو ذكرت كذا… لو قلت في هذا الموضع كذا… لكان الكتاب الذي كتبته آنذاك أنفع."
مثلًا، حين سألتَني عن كتابي "المحاكاة"، قلت لك إني أعدُّه ابتداءً فلسفيًّا لوعي قصديَّة الدلالة؛ إذن يُفهم بحثي في تلك الفترة على أنّه لحظة تساؤل أولى حول فلسفة اللغة، في هذا الجانب المتعلّق بالصوت والحرف. ولا تنسحبُ "المحاكاة" على كل الاشتغال الفلسفي التالي في فلسفة اللغة، ففي مفهوم "الكينونة الشَّيْمِيَّة" الذي أطلقته في كتابي "فلسفة الصرف العربي دراسة في المظهر الشيمي للكينونة" أو في دراسة "سياسة الدلالة بين الأَوْل والفَسْرِ" مثلًا، تطوَّر القول الفلسفي ليواكب حيثية المفاهيم في عيشها المواكب للذهنية المصاقبة للحدث، ولنمو الفهم عينه في التجربة المتراكمة، التي تُحَسِّنُ المقدرة على تجويد المفاهيم والتعمق في استنباتها المصاقب.
د. حسام الدين درويش:
العزيزة ريم، لدينا صديقٌ مشتركٌ، تحدّثت معه قبل يومين. هو لا يزال متأخّرًا في اختيار موضوع الدكتوراه وتسجيلها، لأسباب مختلفة، منها أنه اختار موضوعًا لا يملك أدواته حاليًّا. وهو الآن بحاجةٍ إلى سنواتٍ لجمع أدواته. قلتُ له إنّ هناك وجهتي نظر في مسألة اختيار الموضوع؛ وجهة نظر تقول: "أحبّه يا بابا، وسأقضي عمري كلّه لأحصل عليه"، ووجهة نظر عمليّة، "هذا مساري المهنيّ، وله وقت محدّد، وثمن محدّد، - ثلاث أو أربع سنوات- وانتهى. لا يصحّ أن يبقى أحدهم خمس عشرة سنة "يحضر"، "يُعدّ"، "يعمل"، لإتمام رسالة دكتوراه فقط. فبدل أن أختار موضوعًا لا أملك أدواته، يجب أن أعمل على تطوير أدواتي وأرى ما الأدوات التي أملكها، وأختار موضوعًا في ضوء ذلك. أعود الآن إلى السؤال: ما المعايير؟ غير "أحبّه يا بابا"، ما المعايير الأخرى الممكنة؟ مثلًا: مسألة توفّر المراجع. هذه مسألة مهمّة، قد تكون معيقًا أو عائقًا. هل يمكننا أن نتحدّث عن هذه المسألة؟
ذ. ريم الدندشي:
لا يمكننا أن نقول غير: "علينا أن نشتغل." أقول: "أريد أن أشتغل على الهيرمينوطيقا." حسنًا، هنا تقف وقفتنا الكبرى. في هذا الموضوع، نريد أن نطرحه كما أفكّر فيه أيضًا، فأنا أفكّر في ابتداء آخر. دائمًا السؤال هو: لماذا لم ننجح في طرح ابتداءات خاصّة بنا؟ لماذا لم يُكتب لمشاريعنا الفكرية أن تُسمع؟ لا أريد أن أقول إنها فشلت، بل إنها لم تلقَ صدى في الفضاء الفكري العربي. إذن، هذه من أسباب اختيار الموضوع أيضًا؛ لأنه ابتداء مغاير. في كتاب "الاستشكال"، يقدّم قراءة تاريخيّة، للعديد من الطروحات الفكرية الموجودة، ويقترح ابتداءً ثانيًا، ابتداءً مغايرًا، استئنافًا مختلفًا، لكن من دون قطيعة. حتى حين نتحدّث عن أزمة الحداثة، وهي التي تُتناول وفق المعياريّة الذاتية الأوروبيّة، نجد أن محمد محجوب قد تجاوزها إلى حدّ ما. كذلك، فإنّ طروحاته تثير الانتباه، ومنها موضوع الترجمة عنده. أنا أعدّ المترجم فيلسوفًا، وقد كنت أقول ذلك حتى قبل أن أسمع بمحمد محجوب. أذكر أول مرة قرأت له نصًّا – أعتقد كان عن هايدغر – ولم أكن أعرفه من قبل، فأرسلت منشورًا على فيسبوك أسأل فيه: "هل هذه العبقريّة من المترجم أم من الفيلسوف؟" كان ذلك أول تواصل مع فكره. المترجم فيلسوف. محمد محجوب؟ كذلك، يمكن أن نتحدّث عن مسألة القطيعة، أو بالأحرى عن ذلك التراث الذي يمكن أن نرفعه إلى مستوى الإنسانيّة والعالميّة، لا ذلك التراث الثقافي الضيّق، القطريّ. الكونيّة في فكر محجوب تُطرح تحت المظلّة الإنسانيّة، وهذا أمر لافت، يجعلنا نسأل الكثير من الأسئلة.
د. خالد كموني:
يبدو مفهوم الابتداء، أيضًا، عند محجوب بنقاء؛ إذ لو قلنا كان هناك ابتداء أول مع الفارابي والكندي، فثمة ابتداء ثانٍ معه دون تردُّد. فقضية "الابتداء" هي قضية "الاستئناف"، واستئناف التراث لا يعني إماتته، بل إحياؤه وبعثُه في لحظة تزمُّن الوعي لليومي. لا يمكنك أن تحيي التراث بشكل جيّد إلا وتستأنفه بشكل جيّد. فمن تكلّم عن المدينة الفاضلة، لا نحتاج اليوم مدينته إلا لنعرف كيف نبتدئ مدننا الفاضلة، ونستأنف بناءها من جديد. لذلك، مغاربية الفلسفة عند محجوب كانت هي طرحه في "الابتداء"، وكانت هي أيضًا تلقيه الأول، وهو تلقٍّ إبداعي. قدّم مقايسة بين الموجود وما يمكن أن يوجد، بفضل هذا "الابتداء".
ذ. ريم الدندشي:
من أحد أوجه الاختلاف بين المشرف والباحث، أنه مثلًا يريدني أن أدخل في الفلسفة المغاربية، بينما أنا لا أريد أن أدخل مع المعاصرين، بل مع الأسلاف حين يستحضرهم المعاصرون. هنا يظهر كيف يغنينا الحوار؛ عندما يشتغل المشرف والباحث على الموضوع نفسه، ونحن نقرأ له معًا، ويُثرى النقاش بالاختلاف أحيانًا.
د. حسام الدين درويش:
جميل أن يكون هناك اختلاف بين المشرف والطالب. في كلامكما، ثمّة حديث من جهة أولى عن كونيّة الفلسفة، إنسانيّتها، عالميّتها، عموميّتها. ولكن، في المقابل، ثمة حديث عن شيء خصوصي، عن تجديد عربي راهن، عن واقع معيش ومتعيّن. أنتِ، مثلًا، أستاذة ريم، قد تواجهين هذا في بحثك الفلسفي؛ تسألين عن الواقع العربي المعيش، عن أسئلة مباشرة، من منظور فكر كوني وقيم كونية. فكيف تتعاملين مع هذه الثنائية؟ كيف تجمعين بين الكوني والخصوصي؟ بين الفلسفة كفكر عابر للثقافات والأديان، وبين راهنٍ متعيّن خاصّ؟
ذ. ريم الدندشي:
يمكن القول إنّ هذا الموضوع حاضرٌ في بحثي، كما هو حاضر في طروحات محمد محجوب؛ لأنّ فلسفته تنبني على جدليّة الفلسفة واللافلسفة. وهذه إحدى النقاط التي استوقفتني؛ إذ لا نتوقف فقط عند ما هو فلسفي أو مفهومي. وإذا أردتُ أن أتناوله في بحثي، فسيكون ذلك من خلال ما يسمّيه محجوب بـ"الفلسفة التعقليّة"، التي تتضمّن مساءلةً لمفهوم التعقّل نفسه، تعقل يعنينا. نحن نتعقّل الفلسفة كما نحتاجها، وكما تناسبنا، كما تفضلت، لا كما تُفرض علينا. فرغم محليّة الطرح إلى حدٍّ ما، إلا أنّه منفتح دائمًا على المظلّة الإنسانية. الفلسفة التعقليّة التي يدعو إليها محجوب تقوم على نوعٍ من العودة إلى النفس، لا إلى "الذات" بالمعنى الذي بلورته الحداثة الغربية. هذه العودة تندرج ضمن مشروع "الاستئناف"، أو ما يسمّيه محجوب "التثنّي على النفس"؛ أي الولوج إلى بداية جديدة تنطلق من مساءلة النفس لا بوصفها موضوعًا معرفيًّا، بل كمجالٍ تأمليّ وفلسفيّ. ويعيد محجوب هذا المنظور إلى الفارابي؛ إذ يرى في مؤلفه الحروف بذورًا أولى لتعقّلٍ فلسفي خاص بنا. لقد استُحضرت الفلسفة الإغريقية ضمن الفكر العربي، عبر بوّابة الحروف عند الفارابي، حيث تمّت أقلمة المفاهيم؛ أي تبيئتها داخل سياقنا المعرفي واللغوي. وكيف تلقّى العقل العربي هذه المفاهيم، لكنّ محجوب يطرح إمكانًا جديدًا بين "التثنّي" و"المنعرج"؛ أي بين العودة إلى سؤال النفس، وفتح مسار مغاير للمسارات الحداثيّة ومنعرجاتها، التي سلكها الفكر الغربي. ذلك كله في إطار فلسفة تعقليّة متجذّرة في إرث الفارابي وأرسطو، ولكن بوجهٍ يتّسق مع حاجاتنا وأسئلتنا. بهذا المعنى، يمكننا الحديث عن فلسفة تُعبّر عنّا حين العودة إلى النفس وفق تعقلية تُسائل وقوع المعنى، العودة إلى النفس، التي تمارس الفهم في كل مرة مع إعادة السؤال عن علاقتها بالعالم!، وبهذا لا تنفصل عن أفق الكونيّة. وهنا نصل إلى الجانب "اللافلسفي" في فكر محجوب، حين يمنح مكانة للشعر، للسرد، للسيرة الذاتية، ويطرح عدم إمكان الاحتواء الفلسفي للاستعارة الشعرية والمشاركات السردية والأدبية، وبالتالي عدم استنفاذ الممكنات في الخطاب الفلسفي العقلاني وتقدير ما لا يُختزل في العقلي والمفهومي. إذن يبصرّنا د. محجوب بأهمية هذا المأتى اللافلسفي الذي يرتبط بتجربة الحياة، ويمثّل نبعًا أنطولوجيًّا إبداعيًّا يوسّع المفهوم، ويفتح الإمكان، وهذه الجوانب بدورها تنتمي إلى الإنساني الكوني؛ لأنها تندرج ضمن سؤال "من نحن؟"، وهو سؤال وجودي مشترك بين البشر، يتجاوز الخصوصيّات الضيقة نحو أفقٍ إنسانيّ أرحب. إننا لا نريد أن نتكلّم عمّا "يخصّنا" وحسب، بل عمّا يُعبّر عن وجودنا داخل الكونية الإنسانية.
د. خالد كموني:
الأمور كما هي، الوعي الكوني لا يمكن أن يتم قبل وعي الذات في محلِّها، والمحلُّ هو الوطن. معنى الوطن في اللغة العربية "محلُّ الإنسان"، كم جميل هذا الاعتبار لقيمة الإنسان، فالأرض التي يحلُّ فيها هي الوطن، أما الأرض في ذاتها فليست وطنًا. والحلول له شروط تديمه ليصبح المكان محلًّا للإقامة، وهنا تحسين نوعية العيش في العالم. لا يمكن ادّعاء الكونيّة من موقع متعالٍ على ما في ذاتك.
مثلًا، لو عدنا إلى الانطلاق من مشروع التجديد العربي، كما طُرِح في "الميثاق"، وفق القيم المدنية الإنسانية، فإنّ العلاقة بين العربي والإنساني ليست علاقة صِدام، ولا مشكلة بين الإنسان والعالمية. السؤال هو: كيف يُقبِل الإنسان على الكونيّة إذا كان فارغًا من قيمِ المحلِّ الذي منه يبتدئ؟ بالعكس، إذا عرف ذاتَه، فإنه يستطيع أن يقدّمها للآخر بشكل جيد. أما مَن يُنكر ذاته، فإنه يُخيف الآخر.
والإنسان ليس ذئبًا للإنسان. النظرة الهوبزية التي ترى الإنسان ذئبًا لأخيه الإنسان هي نظرة ضد الكونية؛ لأنها تحجم القيم بخصوصية اجتماعية قاتلة. أما عندنا نحن، فإذا قلتُ "عربي"، لا يتناقض قولي هذا مع كوني "إنساني". وإذا قلتُ "كوني"، حين أتكلم فلسفيًّا عن "الذات"، فأنا أقصد كلّ ذات. ولكن، هل تظن أن هايدغر حين يتحدث عن "الإنسان" يقصد الإنسان المطلق، ألا يكون في ذهنه الإنسان الألماني؟ وهل نيتشه لم يكن يعني الإنسان الغربي؟ كلّ فيلسوف ينظر إلى مجتمعه ليتفلسف، كما فعل ابن باجة حين كتب عن "المتوحد"، ألم يكن ينظر إلى إنسان زمنه؟ والفارابي حين يقول: "الفلسفة تسبق الملة"، ألم يكن يعالج مشكلة زمانه؟ الكوني يصبح كونيًّا عندما يصدق الفيلسوف نفسه. أما مَن لا يعرف ذاته، فبماذا يتكلم؟
أعود إلى الراهن والحدث اليومي: ما المشكلة اليوم في القضية الفلسطينية؟ في الصراع العربي–الإسرائيلي؟ نحن لم نتحدّث بعد عن "فلسفة فلسطين"، عن "فلسفة الحق"، ليس خجلًا، أو قلة معرفة، بل لعدم ثقة بأننا إذا قلنا "فلسطين"، لها معنى. بالمجمل عدم ثقة، ولهذا لا توجد لدينا فلسفة حقيقية عن "الحق". الفلسفة الحقيقية التي ستبحث في "الحق" اليوم هي جرأة الفيلسوف، وشجاعة قول الحقيقة: الحقيقة هي كذا وكذا. تكرار الوسائل السابقة في الدفاع عن "الحقيقة"، من سلاح أو مساعدات، لا تنفع الحقيقة. حتى تكرار الوسائل السابقة بالقول مثل "فلسطين لنا" دينيًّا لا تنفع فلسفيًّا، القول العادي "القدس لنا" لا يخدم الفلسفة، بل يجب أن نبحث: ما القدس؟ ما الحق؟ من هو الـ "أنا" الذي يقول: "أريد القدس"؟ ما هي الحقيقة التي أريدها من هذه الأرض؟ ما العلاقة بالجغرافيا؟ ما مفهومي للانتماء، للوطن، للمقاومة، للحرية؟ هذه المفاهيم، عندما تأخذ حيثيتها وأرضيتها، وتُبنى كأرضٍ للمفاهيم – كما عند جيل دولوز – عندها أتحرّر، وهنا يبدأ التأويلي، وهنا تبدأ إمكانات التجديد الذاتي، هذا الاهتزاز الحثيث المولِّد للجديد. فما الداعي إذًا لادّعاء الكونية، إن لم أكن أنا كونيًّا؟ كيف أطرح كونية معينة وأنا لستُ موجودًا؟ كيف أدّعي الانتماء إلى فلسفة معيّنة، إذا اكتفيت بالقول: "ما هي فلسفة الحق؟" وأذهب إلى كتاب كانط. هذا تاريخ الفلسفة، وليس الفلسفة. الفلسفة الحقّة هي أن أتكلم من مكاني، مما ليس "حقًّا"، عندها أدرك القيمة الفلسفية، القيمة المفهومية هي "الحق" اليوم. فإذا خرجتُ من مفهوم اليومي، فأقرأه وأفسِّره وأؤوِّله؛ إذن أنا أُبرز مفاهيم تطرح القيم للنقاش والحوار مجددًا، ومن ثم تبرز الفلسفة في أرضها.
هذا ما سمّيته "إيطان" الفلسفة، وهو مفهوم أضفتُه إلى مشروع محجوب الذي يتحدث عن "الاستشكال" و"وضعيّة الأرض". ذلك كان في ندوة قدّمتها بالمعهد العالي للدكتوراه، قلت: إيطان الفلسفة؛ كيف تبني وطنًا، محلًّ، ترتحل إليه الفلسفة. تبني هذا الوطن بأن تعي، بثقةٍ واعتزاز لا تخاتُل فيه، ذاتَك، ومكانَك، وزمانك.
لا يمكن أن يكون هناك اغتراب قصدي، أن أغترب عن قصد، يعني أن أتقصَّد أن أعيش في فلسفة الآخر. لا داعي لوجودي الفلسفي عندئذٍ. بينما فلسفتي، هي أن أعود إلى "منمنماتك" يا حسام وأدرسها، فهي من عيشنا اليوم. أتذكُر، ثارَ جدل في النقاش الذي أجريته: هل كانت "المنمنمات" فلسفة أم ليست فلسفة؟
قلت لك يومها، علينا أن نسأل: ما البداية؟ هذا الوعي بأن تكون المنمنمات ابتداء؛ يعني أن يكون الوعي حدثًا معينًا أثار ابتداء فلسفيًّا، لأن نتفكّر في ما بعد، وليس الهدف أن تُذكر مثلًا "السيّدة الفلانيّة قالت لي كذا" أو "جرى معي كذا في دمشق". ليس هذا هو الهدف من الحدث، بل ما بعده. لا أعتقد أن العمل الأكبر لحسام الدين درويش سيكون "منمنمات"، ولكن ما يلي، وما يلي هو الفلسفة. ففي هذه الحالة، هل ما طرحه حسام كونيٌّ أم محلّيّ؟
د. حسام الدين درويش:
هنا تكمن الإشكالية؛ المنمنمات. لن أطيل في الحديث عنها، لكنّها محاولة للتفكّر في الراهن، في المتعيّن، في الحدث، في اللحظة. وهذا هو ما دفع البعض للقول إنّها قد لا تكون فلسفة؛ لأنّها قصيرة الحجم، ومحدودة التناول لفكرة معيّنة، إلى آخره، رغم أنّه يمكن القول بالعكس: إنّ الفلسفة تغتني بالراهن وتُغني به من خلال تفكّرها فيه.
ذ. ريم الدندشي:
أريد أن أتحدث عن "المنمنمات"، لكن بما أنّ الحديث جارٍ، أذكر أن الطرح ذاته طُرح سابقًا، وعلّقتُ حينها وقلت: "أنا محجوبيةٌ الهوى، وسأقرأ المنمنمات انطلاقًا من الحدثيّة، ومن هذا اليوم الهايدغري كما يأتي عليه محجوب." فقلنا حينها: "نحن نتحدث فلسفة". إذن، كلامي هو ردٌّ على المنمنمات، لا على الدكتور خالد.
د. حسام الدين درويش:
قد لا يدرك كثير من الناس أنّ الشخص، في لحظة ما، لا يهمّه كيف يُصنَّف فكره، بل يهمّه أنّه مشغول بمسألة ما، ويريد أن يبرزها، أن يعطيها ضوءًا، اهتمامًا. لذا، لا أرى لا مدحا أو ذمًّا في أن يُوصَف فكرٌ ما بأنه فلسفي أو غير فلسفي؛ فقولنا إنّ هذا "فلسفة" لا يعني بالضرورة أنه جيّد، كما أنّ قولنا إنه "ليس فلسفة" لا يعني أنه سيّئ. هناك فلسفة رديئة، وهناك فكر غير فلسفي لكنه جيّد. أحيانًا، وهذا سيكون ختام نقاشي في هذه المسألة، بعد وفاة صادق جلال العظم، طُرح السؤال: هل هو فيلسوف أم لا؟ وقد كُتبت مقالات حول ذلك. لكنّي رأيت أن السؤال الأهم هو: إلى أي مدى قدّم فكره إضافة؟ فالأحكام ليست وصفية فقط (هذا فلسفة" أو "غير فلسفة")، وإنما معياريّة: إن كان "فلسفة" فهو جيّد، وإن لم يكن فلسفة، فهو سيّئ.
د. خالد كموني:
هل يمكنني أن أطرح السؤال على هذا النحو: لماذا يقلقنا أن يكون ما يُقدَّم فلسفيًّا أو غير فلسفي؟ أليس هذا القلق ذاته دليلًا على وجود وعي فلسفي لدينا؟ لكن، هل يكفي هذا الوعي لنجزم بأننا ننتج فلسفة حقًّا؟
أتذكَّر أني حين كنت في سنَتي الجامعيّة الثانية أو الثالثة، قرأت نصًّا لحسن حنفي يقول فيه: "التاريخ حامل للفكرة، لا مُنتِج لها."، فردّ الأستاذ قائلاً: "حسن حنفي ليس فيلسوفًا." لم أقتنع حينها، لا بدافع التعصّب لحسن حنفي، بل لأنّ الأمر أثار لديّ سؤالًا أوسع: هل نحن، كعرب، لا نُنتج فلسفة؟ هذا سؤال لا يمسّ فقط الجانب العلمي أو المعرفي، بل يمتدّ إلى بُعد سيكولوجي عميق: الثقة. أن تقول عن أحدهم "أنت فيلسوف"، لا يكفي. الأهمّ أن يكون كذلك في فعله وفكره. ولكن، ما الذي يدفع إلى إنكار ما أنت عليه، أو إلى ادّعاء ما لست عليه، هل هو محاولةٌ في تعريف الفلسفة؟ ربما...
د. حسام الدين درويش:
نحن جميعًا تقريبًا ملتزمون بشيء، والوقت قد شارف على الانتهاء، دعيني أقول، العزيزة ريم: نحن موعودون بإنتاجٍ ما. سنقول لهم: "انظروا، نحن ننتج فلسفة." متى سيحصل ذلك؟
ذ. ريم الدندشي:
هل تعني أنني سأنتج فلسفة؟ حقيقة، أنا بدأتُ بالكتابة، مبدئيًّا. التقميش يمكن القول إنه انتهى. لكن الحقيقة أنّ عليّ أن أخصص وقتًا أكثر من هذا. يجب أن أُغلق الباب وأبدأ العمل الجاد. لا مزيد من العزائم، يجب أن أُغلق الباب وأبدأ في كتابة الفلسفة.
د. حسام الدين درويش:
دعيني أؤكّد نقطة مهمّة، يجب ألّا تأخذ المسائل أكثر من وقتها أو حجمها؛ فهناك الدكتوراه، وهناك ما بعد الدكتوراه.
ذ. ريم الدندشي:
هناك شيء خاص: أن تكون لديك علاقة مباشرة مع فيلسوف حيّ. قلتُ للدكتور محجوب حين التقيتُ به: حين تتناول موضوعًا مع فيلسوف حيّ، وهذا ما يحدث لي. أركض بين بحثي، ومتابعة الطروحات الراهنة لهذا الفيلسوف، بين محاولتي العثور على "الخيط الناظم" في فكر الدكتور محجوب. هذا ليس سهلًا، أن تجد هذا الخيط في كتاباته، وليس فقط في فكره.
وأعتقد أنّه يكتب أحيانًا لنفسه، وأحيانًا لإنسان قادم، وأحيانًا لباحث من ثقافة أخرى. وأحيانًا لطرح اكتمل في كتابٍ آخر. هو كثير النشاط فعلًا. لذلك، أنا أركض بين ما يُنتَج من جديد، بين "استئناف صفري" و"ابتداء ثاني" الذي نحن واقعون فيه. قال لي: "من مصلحتك أن تحصري الموضوع"؛ لأنّ المسألة تكبر. كلما مضيتُ، كلما اكتشفتُ أنّي أغوص أكثر. لذا، لا بدّ من التحديد والبدء والتثبيت.
د. حسام الدين درويش:
من يشتغل على رسائل أكاديميّة، يعرف، أن الموضوع المختار للبحث يكون، في البداية، ضخمًا وأكبر مما يمكن إنجازه، غالبًا، ثم نبدأ بالبحث عن المراجع. وبعد ذلك، نبدأ بالتساؤل: ما الذي سأختصر؟ ما الذي لن أقرأه؟ ما الذي سأتجاوزه؟ وبالنتيجة، يتم اختصاره وتصغير حجمه تدريجيًّا. أظن أنني في رسالتي للدكتوراه، دون مبالغة، ما كتبته فيها لا يتجاوز 5% ممّا كنتُ قد خطّطت له في البداية.
ذ. ريم الدندشي:
فقط أريد أن أقول عن كتاب د. حسام الدين درويش "إشكالية المنهج في هيرمينوطيقا بول ريكور"، وهو كتاب الدكتوراه، أنّك تقول إنه "كتاب"، وأنا أقول إنه "مرجع" على ريكور.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا جزيلًا لكِ.
دكتور خالد، ، كيف ترى دورك، بوصفك مشرفًا، لأنّ مسألة الإشراف أحيانًا هي قمع ضروري، بل قمع مُنتج للحرية. فالإشراف ليس نقيض الحرية، بل الفوضى، وعدم القدرة على الفاعلية، أو على الحسم. وهنا يأتي دور المشرف: أن يُحدّد الإطار؛ لأنّ الحماس والاندفاع قد يؤديان إلى التيه. ما رأيك؟
د. خالد كموني:
دوام الحوار؛ فنحن دائما في جلسات متكررة، هناك نقاشات... تقميش، وتدوين للأفكار. الجميل، والذي يجب ألّا يتوقّف، هو ما ذكرته: علاقتك مع فيلسوف حيّ. تحديد الموضوع بالاستشكال يتطلب تتبّعًا للأفكار التي جاءت بعده. لكن بدء الكتابة هو الذي يُحدّد. عندما تشرعين في هذه الخطوة الأولى، ستبدأ الفقرات بتحديد ذاتها، ثم هناك أفق زمني أعتقد أنّه في غضون خمسة أشهر يمكن إنجاز المشروع.
د. حسام الدين درويش:
أرى أن الأشهر كافية. لسنا بحاجة لسنوات أو عقود أو قرون، وأقول هذا الكلام أيضًا لطلّاب وطالبات آخرين: من الضروري إدراك أهمية الوقت، ودور المشرفين في المساعدة على الوصول إلى الهدف. وننتظر نتاجك البحثي/ الفلسفي، العزيزة ريم.
شكرًا جزيلًا لكم، على الحضور الجميل، شكرًا لكم جميعًا. ونأمل أن نلتقي قريبًا، خصوصًا بعد إنجاز الرسالة.