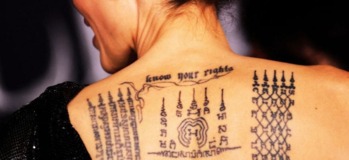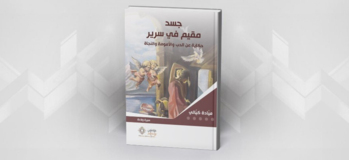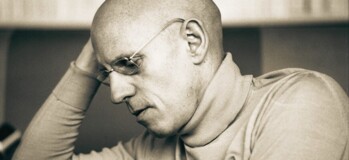المحايثة المضاعفة والجلاليَّة والإتيقا بينَ التفجِّي والصّمديّة أو مِنَ الثنائيّات إلى الزّوجيّات
فئة : أبحاث محكمة

المحايثة المضاعفة والجلاليَّة والإتيقا بينَ التفجِّي والصّمديّة
أو
مِنَ الثنائيّات إلى الزّوجيّات
(بحث في الاستعداد الهيولاني للعقل والجسد والفن والاستطيقا مابعد الأنطو-لاهوت)
"وِحدةُ ذاتٍ في صورٍ شتّى كالبَحر في صورةِ الأمواجِ سرى
فالعِبارات مُختلفات والمعنى واحِدٌ
كالنَّقشِ وهو في كلِّ حائطِ"
ملّا هادي السبزواري
ملخص البحث:
يدرس هذا البحث الاستعداد الهيولاني (الغريزي) للعقل والجسد والفن في مرحلة ما بعد الميتافيزيقا واللاهوت، من خلال تحليل التقاطع الأنطو-أكسيولوجي بين العقل الهيولاني والجسد، والعلاقة الاستعارية التبادلية بين المرئي واللامرئي. يعتمد على نماذج من الفكر الإسلامي (الفارابي، الغزالي، الرازي) والفلسفة الغربية (نيتشه، دولوز، آرتو). يخلص إلى أن الجلالة تشكل وحدة هذه العلاقة، وأن الإيمان الحي شرطٌ لها. يقدّم أيضًا مفهوم "المحايثة المضاعفة" كإطار لفهم العلاقة الزوجية بين الموجودات، وينتهي بمناقشة إيتيقا التقوى والتوبة ودور الفن والاستطيقا في ظلّ الرؤية الجديدة.
أهداف البحث:
- تحليل التقاطع الأنطو-أكسيولوجي بين العقل الهيولاني والجسد.
- كشف الآلية الاستعارية التبادلية بين الخطاب الميتافيزيقي-اللاهوتي وخطاب ما بعده.
- بلورة مفهوم "الجلالة" كوحدة للعلاقة بين المتقابلات.
- تقديم مفهوم "المحايثة المضاعفة" كمنظور جديد لفعل التعبير والتوليد.
- دراسة الإيمان الحي كشرط لإدراك الجلالة والمحايثة.
- تحليل الضلالة والهدى، والفن والاستطيقا، في إطار الأنطو-أكسيولوجيا المشتركة.
- اقتراح نموذج إيتيقي قائم على التقوى والتوبة بديلاً عن النموذج الفلسفي المحض.
1- التقاطع الأنطو-أكسيولوجي بينَ العقل الهيولاني (الغريزي) والجسد:
في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة"، يقول الفارابي: "وأول الرتبة التي بها الإنسان إنسانٌ هو أن تحصل الهيئة الطبيعية لأن يصير (العقل) عقلاً فعلاً" (1). والعقل هنا مجرّد إمكان لم يتم تفعيله بعد، ولا هو بالقادرِ على أداءِ مهمّته التي من شأنه. وتلاه في ذلك ابن سينا وغيرهم. إلّا أنّ الغزالي في "إحياء علوم الدين" يغيّرُ اللفظ الدال على العقل في هذه الحالة إلى لفظ أشدَّ جوهرية فيسمّيه بالغريزي، وهو ما هو في لبِّ طبع الشيء؛ أي محايث للإنسان، محافظًا على ذات الصورة الكمالية له عند الفارابي. فالوظيفة التي يمتاز بها العقل كاستعداد أو العقل الغريزي هي بلوغه المعرفة النظرية؛ أي إنّ التجريد استعداد. وما يهمُّ في هذا الاستعداد القادر على التجريد هو أوجه الذي تتبدّى فيه فائدته. فالعقل الغريزي بحسب الغزالي يجب أن ينتهي في الإنسان إلى "أن يعرف عواقب الأمور، ويقمع الشهوة الداعية إلى اللذة العاجلة ويقهرها. فإذا حصلت هذه القوة، سمّي صاحبها عاقلاً، مِن حيث إقدامه وإحجامه، بحسب ما يقتضيه النظر في العواقب، لا بحكم الشهوة العاجلة. وهذه أيضًا مِن خواص الإنسان التي بها يتميَّز عن سائر الحيوان" (2). وأما ضد العقل، أي اللا-عقل، فنجد أبا بكر الرازي يسمّيه بالهوى والطباع، وتعريفه لهما هو النقيض التام لغاية أو ما ينتهي إليه العقل الهيولاني أو الغريزي، فهما "يدعوان أبدًا إلى اتباع اللذات الحاضرة وإيثارها من غير فكر ولا روية في عاقبة، ويحثان عليه ويعجلان إليه" (3). إنّ قدرة الإنسان على تأجيل الرغبةِ التي تغلِبه هي معيار العقل الأول، والذي يشهد على فاعليّته عند الفلاسفة والمتكلمين الأصوليين المسلمين.
يعني هذا أن معيار العقل هو القدرة على تدبير العيش. فالإمساك والقدرة على تأجيل رغبة ملحّة لصالح رغبة أخرى يعني أن الإنسان قادرٌ على ترتيب أفعاله حتى يوجهها إلى غاية بعينها ومقصودة. وهذا يدل على أنّه شرطُ القصدِ أيضًا. والتدبير عملية موازنة وتقدير وتحديد نسب معيّنة بين الأشياء. والمحصلة لهذه التفاعلات هي الغاية المقصودة. لذا، فإنّ تدبير العيش، والذي هو معيار العقل، هو في الآن نفسه عملية تقويم أو "نسابة" تفاضل بين الأشياء. والقيم يتحدّد وزنها بشرطِ عملية الإمساك والتأجيل للرغبة العاجلة؛ لأنّ هناك تناسبًا بين مقدار ما يُمسك وثمن تحقيق الشيء. فكلما زاد الأول تبدت الأشياء الثمينة، وصارت بمقدور الإنسان.
إنّ التقاطع بين تدبير العيش كمعيار لتحقق العقل الهيولاني بالفعل، وعملية التقويم والمفاضلة، وإقامة النسب بين الأشياء، يمثّل حجة حاسمة على إمكانية امتداد الإرث الميتافيزيقي اللاهوتي داخل ما يعد متجاوزًا له، كالإتيقا السبينوزيّة وقلبِ القيم عند نيتشه. فالقَلْب أو نفي المُثبت وإثبات المنفي كائنٌ في مسارِ تحقّق العقل الهيولاني أو الغريزي. فيصبح هذا التقاطع وقتئذٍ بمثابة الشاهد على راهنيته. وفي هذا التقاطع يتبيّن أنّ الاستدلال على العقل كمقوّم أنطولوجي وفصل نوعي منطقي للإنسان إنّما يُستدلُّ عليه أكسيولوجيًا. وما يمكن أن يُستدلَّ عليه أيضًا عبر هذا التقاطع هو أنّ التقويم نفسه، الذي يمثّل الأرضية لهذا التعريف الذي بمقتضاه يعدُّ العاقل عاقلاً، هو اعتباره للعواقب؛ لأننا لو نظرنا إلى هذا التقويم من الجهة المناقضة له؛ أي من حيث اللا-عقل، فسيتبيّن لنا بطريقة مباشرة تحديد هو أكثر دقة من هذا. فالعاقبة أو الوعيد كخطر محتمل ومهدّد للحياة إن لم يفنها تمامًا ينقصُ مِن إمكانيّاتها، يحيلنا إلى أنّ ديمومة الحي هي أسُّ هذا التقاطع. وإنّ كون العقل الهيولاني يُستدلُّ على تحقّقه أو إمكانه أكسيولوجيًا باعتبار العواقب، ليعني أنّ معيار العقل هو ذاته معيار الجسد، وهو: الحفاظ على استمرار الحي. فما يحفظ ديمومته هو النافع، وما يهدّدها بأي درجة مِن الدرجات هو الضار. وبهذا نشهد إتيقا أصيلة (على غرار السبينوزيّة) في الإرث الميتافيزيقي اللاهوتي، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بقلب القيم من خلال اعتبارها معيار تحقق العقل الهيولاني معيارًا أكسيولوجيًا. وترتبط أيضًا بالتحوّل النيتشوي في السؤال عن الضرورة. فهي شأنٌ منطقي لأنّها شأنٌ جسدي، وهي شأنٌ جسدي لأنّها شأنٌ منطقي. مِن نتائج ذلك المباشرة هو أنّ البحث في الميتافيزيقا أو اللاهوت وكل ما يخصُّ اللامرئي هو بحثٌ فيما يخصُّ الفيزيقي والمرئي في الآن نفسه، والعكس صحيح.
2- العلاقة الاستعارية التبادلية بين المرئي واللامرئي:
بعد التقاطع السابق في شأن الحي، والذي يُمكن لنا أن نسمّيها بالأنطو-أكسيولوجي، سنرى أنّ تعبيرَ الثنائيات عن نفسها يشترط ما يناقضه وينفيه ويسلبه. وقبل أن نحلل هذه التعبيرات التي يعبِّر من خلالها اللامرئي والمرئي عن نفسه، يجبُ علينا أن نحيلَ إلى معنى يخصُّ العقل والمعقول لنفهم العلاقة الاستعارية التبادلية بين المرئي واللامرئي. وسنبدأ مِن التراث الميتافيزيقي والذي تضمَّنه اللاهوت أولاً، ليس لأي سبب سوى أنّ الفيزيقا أو نفي الميتافيزيقا واللاهوت يعدّانه الأصل أو البدء الذي يجبُ التخلّص منه. فلذا نعمدُ هنا إلى التمشّي مع فرضية تتواطأ عليها الأطراف. وهذا المعنى يتعلق بأصل اللفظ eidos/المثال الأفلاطوني، الذي تتعين وظيفته في الوحدة والشمول. إنّ هذا اللفظ الشديد الارتباط بالميتافيزيقا واللاهوت يتضمَّنُ الـ "بصر" في أصله، مما يعني أنّ الإيدوس، وهو المفهوم العقلي الذي لا يبلغ بالحس، يتضمّن ترئية للمعقول؛ أي جعله منظورًا كما لو أنّه المحسوس. وفقًا لهذا، فإنّ المثال الأفلاطوني هو سلب الهيغلي (Aufheben) للمعنى الأول الذي يحيل على الهيئة والمظهر (4). وهذا الشكل مِن السلب هو ما حدى بدريدا في مقالته "الميثولوجيا البيضاء" إلى أن يعدَّ نشوء المفهوم الميتافيزيقي المجرَّد صورة من صور التناوب في معنى يراه ريكور موفقًا لترجمة السلب (Aufheben) الهيغلي (5). فالتناوب لا يعني فحسب أنّ شيئًا يحلُّ محلَّ شيء آخر، بل هو يشيرُ إلى معنى أشدَّ أساسية. إن السلب الهيغلي كتناوب يُحتِّم إخفاء ما أنبناه.
يمكن لهذا الإخفاء أن يتأوّل على ضوء صورٍ شتى، كالنسيان أو الكبت أو نموذجي إرادة القوة الفاعلة والارتكاسية كما يحدث لدى نيتشه. إلّا أن المرئي واللامرئي لم ينجُ أحدٌ منهما عن توصيفِ نفسه عن طريق نقيضه بالمرّة. لذا، فإنّ الإخفاء وإن حدث، فهو ليس تامًّا، وقد لا يستطيع أن يكون كذلك لضرورة يتعيَّن البحثُ عنها مباشرة بعد أن نستكشِف ونبيّنَ من خلال أمثلة تتعلّق بكلٍ منهما انثقابه بالآخر. وهذا عند الفارابي والغزالي كممثلين للإرث الميتافيزيقي واللاهوتي؛ أي اللامرئي وغير المحسوس، وعند نيتشه وأنطوان آرتو ودولوز وغوتاري كممثلين للقطيعة التي تجري مع هذا الإرث باسم ما غادره، أي المرئي والمحسوس.
2.1- العلاقة الاستعارية مِن المرئي إلى اللامرئي:
عند الفارابي والغزالي، نجد الأول يستعير علاقة أجزاء المدينة ببعضها البعض ونسبة كل جزء منها بالنظر إلى الآخر، ويراها طوبولوجيا يمكن بحسبها فهم علاقة العقل كأكسيولوجيا موجّهة بالكليّة لوجود الإنسان. فأجزاء المدينة هي أجزاء الحياة الإنسانية. فـ"كما أن الرئيس الأول في جنس لا يمكن أن يرأسه شيء من ذلك الجنس، مثل رئيس الأعضاء، فإنه هو الذي لا يمكن أن يكون عضو آخر رئيسًا عليه. وكذلك في كل رئيس في الجملة. والرئيس الأول للمدينة الفاضلة ينبغي أن تكون صناعته صناعة لا يمكن أن يخدم بها أصلًا، ولا يمكن فيها أن ترأسها صناعة أخرى أصلًا، بل تكون صناعته صناعة نحو غرضها تؤم الصناعات كلَّها، وإياه يقصد بجميع أفعال المدينة الفاضلة. ويكون ذلك الإنسان إنسانًا لا يكون يرأسه إنسان أصلًا؛ وإنما يكون ذلك الإنسان إنسانًا قد استكمل، فصار عقلاً ومعقولاً بالفعل" (6). أما الغزالي، فيستعير علاقة العين بفعل الإبصار لإفهام علاقة العقل بكليّة الحياة الإنسانية (7). وما يشيرُ إليه كِلاهما هو البُعد التقديري والتقويمي للعقل، أي التدبير. وفي الاستعارتين نجد بُعدًا يحيل إلى ما هو سابقٌ منطقيًا على التدبير، وهو الاهتداء. فالمحصلة من التدبير تُنظَرُ من خلال ما هو معطى وتزمعه الإرادة أو الرغبة تبعًا لما تمّ نظرُه دون أن يكون كائنًا بعد. والرئيس لا يرأس إلّا لامتلاكه إمكانية هدي نفسه وغيره إلى تدبيرات معينة. والعين لا تساند في التدبير فحسب، بل هي تمكّنُ منه وتتملى في الموجودات قبل أن تقوم بتدبيرها. إنها أقرب ما تكون إلى وضع المجيب عن سؤال ما إذا كان شيء ما يمكن تدبيره أم لا. وبهذا، فإنّ استعارية الغزالي هي أشمَلُ وأكثر إحاطة من استعارية الفارابي.
2.2- العلاقة الاستعارية من اللامرئي إلى المرئي:
ما دام التوجّه اللاهوتي والميتافيزيقي الفلسفي يناوِب بين المحسوس والمعقول، فإنّ التوجّه المضاد لا يتوقّف في لغته على مجرّد الإرجاع والرد. فما يصرّح به نيتشه قائلاً: "الحقائق هي أوهام نسينا أنّها كذلك؛ أي استعارات قد كانت مستهلكة وفقدت قدرتها الحسية، قطع نقدية فقدت نتوءاتها واعتبرت بهذا مجرَّد قطع معدنية وليس قطعًا ذات قيمة" (9)، يشهد على أن استعارات اللاهوت الفلسفي تنزع القيمة مما تستعير منه حتى تكون. بهذا المعنى، فإنّ استعارة الفارابي من المدينة وأجزائها، واستعارة الغزالي عن العين وعلاقتها بفعل الإبصار أو الرؤية لبيان قيمة العقل والمعقول، إنّما هما إبطال للمستعار منه.
إذا كان الموقف المضاد للاهوت الفلسفي لا يحير أمامه دربًا لتقويضه إلّا لغة ما يزمع تقويضه؛ لأنّ المعجم اللغوي المفاهيمي بجملته منذ أفلاطون قائم على إبطال المرئي، فإنّ عليه إذّاك أن يُبطِل المُبطَل وفعل الإبطال بذات الطريقة، ليقوم بمناوبة التناوب. نعني أن عليه أن يستعير من اللغة التي تصف اللامرئي ما يصفُ به المرئي. هكذا مثلاً، حتى يحلَّ نيتشه الجسد محلَّ مقولة الروح، يقول: "الجسد هو عقلٌ عظيم" (10). وفي بعض الترجمات تستخدم كلمة كبير بدلاً من عظيم. على أيّ حال، فإنّ العقلَ العظيم كمقولة لغوية فلسفية-لاهوتية تستعار لأجل توصيف النقيض المرئي والمحسوس. وإذا كان التناوب يقتضي إخفاءً لما أنيب عنه حسب دريدا، فإنّ هذا القول يمثل إخفاءً للإخفاء، أو إظهارًا للمخفي عبر إخفاء خفائه. وهذا منطقيًا نفي للنفي، والمحصلة هي إثبات المنفي. أما عند أنطوان آرتو، فنجد مفهوم "الجسد بلا أعضاء"، الذي استثمره كل من دولوز وغوتاري للإحالة على الحرية وكسرِ الهيمنة فيما بعد في كتابهما "ألف هضبة" (Mille plateaux). ويمكن في شأن هذا الأخير أن يسأل المرء: ماذا يتبقّى مِن جسدٍ دون أعضاء؟ أليس الجسد هو أعضاؤه المكوّنة له؟ نعم بالتأكيد. لكنّ هذا المفهوم إنّما يحيل إلى ذلك الجسد الذي لا يحيل إلى شيء قد ضيّق عليه إمكانيّاته، أي جسد يحيل على الجسد لا إلى شيءٍ خارجه. وبذلك يتموضع الجسد كإبداع وخلق وجدة وتدبيرٍ ذاتي. وفي حالة هذا المفهوم بالذات تتجلّى بنية المركّب الكثير والبسيط الواحد. فالجسد من حيث هو مركّب من أعضاء، يتم التعبير عنه بالبسيط الواحد أو بسلبِ أعضائه التي يكون بها هو هو. ومعلوم أنّ البسيط والواحد إنّما هما مفهومان ميتافيزيقيان ولاهوتيان.
3- الجلالة كوحدة للعلاقة الاستعارية التبادلية بين المرئي واللامرئي:
إنّ البنية واحدة إذن، سواء عند الفارابي والغزالي أو عند نيتشه وأنطوان آرتو ودولوز وغوتاري. فما هو ضيق أو بسيط أو واحد يُتحدّث عنه بالأوسع والمركّب والكثير في الميتافيزيقا واللاهوت، والضيّق والبسيط والواحد تمثِّل مقولاتهما، والواسع والمركّب والكثير هو ما يسلِبانه لكن يتحدّثان عن مقولاتهما من خلاله. وفي المنظورات التي تُقرُّ بالفيزيقي والمرئي المحسوس وحده، يُتحدّث عن الواسع والمركّب والكثير بالضيّق والبسيط والواحد. بدَهي أنّ التناقض بين الاستعارتين، إنّما يحيل على استحالة الجمع بينهما. لكن من خلال الأمثلة التي ذكرناها، فإنّ عملية الإفهام لكلٍّ من العقل الهيولاني (الغريزي) والجسد إنّما تتمُّ من خلال النقيض. وهذا يدفع إلى الاستنتاج أن شرط ظهور كل واحد منهما، إنّما يستلزم منه المرور بنقيضه. لابدَّ إذا من البحث عن وحدة؛ إذ يبدو الأمر كما لو أنّ ثمّة جوهرًا واحدًا يتعاقب عليه كلٌ من اللاهوت الفلسفي الميتافيزيقي ومحاولات تقويضه الفلسفية.
والدرب نحو هذه الوحدة بيّن كفاية. فعند الفارابي يتم الحديث عن الاستعداد الهيولاني للعقل في فصل مسمّى بـ"العضو الرئيس" (11). وعند الغزالي يوجد الحديث عن المعاني المتعددة للعقل بما في فصل مسمّى بـ"شرف العقل" (12). أما الرازي (أبو بكر)، فيصف في فصل معنون بـ"فصل في شرف العقل ومدحه" بالجلالة. فمن العقل كرئيس إلى العقل كمشرّف إلى العقل كجليل. ويتضح هنا أنّ العلاقة بالعقل هي العلاقة بالجلالة أو الشعور بالجليل. والأمر نفسه عند نيتشه، فالعظم أو الكبر الذي يصف بهما الجسد اصطلاحان حجميّان يقالان على الجليل بغرض تشبيهه. والتعبير الحجمي عن الجليل بالعظيم يفترض، كما يقول كانط، وحدة قياسية (13)؛ أي إنّ الجلالة التي ينسبها نيتشه للجسد هي جلالة رياضية في معجم مؤلف "نقد ملكة الحكم". ولغرض إجرائي، يجب أن نفرّق بين الشعور بالجليل والجلالة في ذاتها. إلّا أنّه يجب علينا أن نستنتج أيضًا الشعور بالاختلاف أو المسافة داخل انفعال الرهبة والخشية داخل شكلي العلاقة الاستعارية التبادلية (من المرئي إلى اللامرئي والعكس)؛ لأنّ عبرهما يتم التأكيد على حضور الجليل.
لقد رأينا في بداية الفقرة الأولى في هذا البحث كيف أنّ السلب (Aufheben)، الذي يعدّه دريدا تناوبًا، يقتضي أنّ الشيء الذي ينوب عن شيء عليه حتى ينوب عنه أن يخفي أو يعدم ما ينوب عنه. إنّ المسافة كائنة هنا بالضبط، وهي بين سلسلة من المتقابلات: الوجود والعدم، الغير محسوس والمحسوس، اللامرئي والمرئي، الظهور والخفاء، الحياة والموت. وكلُّ طرفٍ يمثّل بالنظر إلى نقيضه تهديدًا وشرط إمكانٍ في آن واحد. إنّ المهم في كل هذه المتقابلات هو نوع العلاقة بينها؛ لأنها قادرة على بيان الجلالة كوحدة لهذه العلاقة الاستعارية التبادلية بين المرئي واللامرئي. وهي تتحدّد بافتراض مفادُه أنّ كل متقابل أو نقيض، إنّما يفترض أنّه آخر مختلف بالمطلق عما يقابله ويناقضه. وتجلي هذه العلاقة بعدين:
الأول: الشعور بالعجز الناجم إثر مواجهة شيء جليل. وهذا العجز هو بالتحديد عجزُ في الإحاطة به بالسُبل التي يقرّها كل طرف عن نفسه ويتعامل بها مع الموضوعات التي تنتمي لجنسه. ولو كانت الإحاطة تحيل على إمكانية التحكّم والسيطرة والتوجيه للشيء المحاط به، فإنّ العجز عن الإحاطة بما له الجلالة يعني إمكانية أن يتحكم ويسيطر علينا فنتوجّه من خلاله.
الثاني: التعبير عن الفرادة، أي نفي إمكانية وجود مثل له. وبذلك تكون إمكانية استبداله غير ممكنة. فهو موجود لأنّه لا مثيل له. فإجلال اللامرئي يعني عجز المرئي عن الاستغناء، وإجلال المرئي يعني عجز المرئي عن الاستغناء عنه. وكلاهما غير قابل للاستبدال أو التعويض بالآخر؛ لأنّ كل واحد منهما لا يكون جليلاً ومصدر إكبار واحترام للحد الذي يوكل فيه إليه تدبير العيش وهدي الإنسان والحفاظ على نموّه إلّا بالنظر لغيره؛ أي ما عُدّ معيارًا أكسيولوجيًا للعقل كاستعداد هيولاني في التراث اللاهوتي الفلسفي والميتافيزيقا، وهو الشرطُ نفسه الذي يعدّه الموقف المناقض للاهوت الفلسفي والميتافيزيقا معيارًا يمتازُ به عليهما.
يكشف لنا البعد الأول عن اللاتناهي، ويشير محدّدًا لنا كيفية معرفته به متمثلة في العجز عن الإحاطة؛ فلو أنّه كان يستطيع الإحاطة به لأدرجه تحت وصف التناهي من حيث هو قابل للإحاطة والحد. أما البعد الثاني، فيكشف لنا أنّ الفرادة أو الجلالة هي السبب الرئيس خلف اشتراط تعبيرِ الثنائيات أو المتقابلات كلٌ منهما على حدة لنقيضها لتعبّر عن نفسها. وإن هذا لداخلٌ فيما عبّر عنه فريدريش شليغل من قبل في الفلسفة المتعالية/Über die transcendentale Philosophie من أنّ التعبير إنّما هو بمثابة نتيجة، والنتيجة إنّما تشترط الانسجام، والانسجام يشترط الوحدة (13)". بذلك، فإنّه كما يمكن أن تكون هناك "الفلسفة (الفلسفة كتعبير عن العقل أو الذهن) في الجسد/philosophy in the flesh"، فمن الضروري أن يوجد الجسد في الفلسفة. وإذا وجدت هذه، فلا مناص من أن توجد الفلسفة في الجسد. وهذا ليس من حيثية أكسيولوجية، بل من حيث إنّ التعبيرات الوصفية للجسد هي كذلك سلب تناوبي للعقل، كما رأينا في تعبيرات نيتشه. بمعنى أنّه يمكن اشتقاق اللامرئي من المرئي كما يمكن اشتقاق المرئي من اللامرئي. إنّ العلاقة هي إذا بالمجمل: زوجيّة.
4- الإيمان الحي كشرطٍ مُسبَق للجلالة:
إنّ كون الجليل يُوصَف بتعبيرات لغوية حجمية تسري على الميتافيزيقي والفيزيقي على السواء يعني أنّه يعلو عليهما على جهة الشمول والضم، رغم التنابذ البائن بينهما منطقيًّا بوصفهما متناقضين، ورغم أنّ أحدهما لا يوجد وينوب عن الآخر إلّا بشرط إخفائه. ولكن رغم ذلك، فقد بينّا قبل قليل انتفاء إمكانية استغناءِ أحدهما عن الآخر من حيثيّة تعبيرية، متّخذين من الفارابي والغزالي نموذجًا حول الميتافيزيقي اللامرئي، ونيتشه وسبينوزا ولايكوف وجونسون بما في ذلك التجريبية والطبيعانية بعامّة بالنظر للفيزيقي المرئي.
نسمّي إيمانًا تسليم النفس للجليل الناتج عن فرضِه لنفسِه عليها؛ لأنّها غير قادرة على الإحاطة به. ولا يكون الإيمان كتسليم إلّا في العلاقة بهذا. وهو يشمل الميتافيزقي اللاهوتي اللامرئي كما يشمل الفيزيقي المرئي، بما أنّ الجليل يمثّل وحدتهما، وكل ما شابه ذلك من متناقضات ومتضادات كما رأينا. والجليل الذي يؤمن به هو الحي؛ لأنّه ما دام العقل الهيولاني (الغريزي) لا يتعرّف عليه إلّا من خلال اعتباره للعواقب التي هي مهددة لحياة الحي واستمراريّتها، وكان هذا الشرط الذي هو بمثابة الحفاظ على نمو النامي هو ذات الشرط لما بعد الميتافيزيقا والثيولوجيا، فإنّ الأساسين كلاهُما يفترضان معطى غير مسبوق باختيار؛ أي الحياة. فانخلاقُها في الإنسان أو انعطاؤها له لم يكن نتيجة لسؤالٍ أو طلب. وبهذا، فإنّ الحياة واقعة جملية تحتل الحي أولاً وتقهر ديمومته ثانيًا؛ أي إنّها من جنس الضرورة التي تنغّص ما يعترضها حتى يتشكّل بحسبها. ولا يملك الإنسان تجاهها غير الاعتراف بها. وهذا يعني وجود شيء يشمله. وبذلك، نرى أنّ ما تعجز النفس عن الإحاطة به يرجع إلى أنّه سلفًا مُحيطٌ بها.
وما دام هذا هكذا، فإنّ ما قبلَ أو في حالة عدم النفس المحاط بها من قبل الجليل والمنقهِرة به هو ذاتُه ما تواجهه في الجليل بوصفه الحي؛ لأنّ الموت أو العدم المقبل والذي لا يمكن تخطيه هو ذاتُه ما كان يُحيط بالحي قبل حياته وسيحيط بحياته. وبذلك، فإنّ حفاظ الحي على نموه النامي، والذي هو الشرط الميتافيزيقي والفيزيقي على السواء للقيم، ينبعُ ضرورته من ضرورة الموت نفسه. إنّ الموت هو ما جاء بفضله عطية الحياة، وسلبُه لها إنّما يؤكّد على كونها أعطية وامتيازًا. بلغة أخرى، فإنّ الحفاظ على البقاء هو وفاءٌ لأعطية من رحم الموت. لكن ليس العدم أو الموت بعينه هو ما تواجهه الحي في الجليل؛ لأنّه لو كان كذلك لكانت على حال العَدم ولانتفت إمكانية أي تمايز بين العدم والوجود وما شاكل ذلك من متقابلات، بل هو يواجه الجلالة كإمكانية له، مثلما منحه الموت الحياة كإمكانية له؛ أي إنّه يواجه الأعطية والنعمة والفضل في الجلالة من خلال الموت. وليس ما يقدّم من براهين حول وجود الله أو خلود النفس أو الحرية، ولا ما قُدّم من نقض لها، يغيّرُ شيئًا من إمكانية العلاقة بالجلالة. وليس الجسد والمرئي الفيزيقي كافٍ لذلك أيضًا؛ لأنّ إمكانية الجلالة حسبُها أن تجعل أولاً إمكانية وجود ما لا قِبَل للإنسان به ممكنة. والميتافيزيقا أو الأنطو-لاهوت إنّما يفترضان تعيينات ومسارًا يُخبِر بدرجة من الدرجات عن قدرة النفس على تمييز ما تحاول البرهنة عليه. أما الفيزيقيا، فتفترض أيضًا أنّ نقض البراهين على إمكان وجود موضوعات الميتافيزيقا الأنطو-لاهوت أو بيان عجز الإنسان عن بلوغها، إنّما ينقضُ الجلالة بدورها. وما دام إنشاء البراهين ونقضها، إنّما يتّبعان مسارًا واحدًا يفترض أن الجلالة قابلة للتمييز قبل مواجهتها، فذلك يعني أنّ كليهما لم يواجهها قط. والأمر هو أنّ كليهما قد افترضها لحظة اعتداده بنفسه. وحلُّ ذلك يكمن بالتحديد فيما يلي: العود إلى البدء. وسبيل بلوغ ذلك يختلف بالنظر لكل من المرئي واللامرئي. فالأول يقوم بذلك من خلال إجراء السلب التناوبي للمرئي المحسوس. أما الثاني، فيخفي المخفي تحت مسميات التجريبية والطبيعانية... إلخ. ويقوم بذلك من خلال إبطال ما يبطله كل ما يقف على طرف النقيض منه. إنّ الاعتراف المُضمَر أو المُعلَن بالحياة والرضى التام بواقعتها هو إذا مسلّمة واقعية (نسمّي واقعية ما لا خيار للنفس أمامه سوى التسليم به والانخراط فيه). ولئن كانت الجنيالوجيا قد ابتدأت عملية إرجاع للمتعاليات إلى محايثات بحيثية تجعل من الجليل أو العظيم عاديًّا تافهًا، فهي لم تكن لتستطيع ذلك لولا قطعها للطريق المعاكس؛ أي تحوّل العادي والتافه إلى جليل عظيم؛ بمعنى أنّها إعلان للمسار التناوبي من المرئي إلى اللامرئي؛ أي إنّ شرط إمكان الجنيالوجيا هو الميتافيزيقا، وشرط إمكان الميتافيزيقا هو الجنيالوجيا.
نسمّي حيًّا ما لا تحتاج فيه النفس لإثبات أو برهان، وما تعجز عن الشك فيه؛ لأنّ الشك ذاته يكون من خلاله، ولأنّه هو ذاته ظاهرة تجول في رحابه تشهدُ عليه إن حاولت إلغاءه؛ لأنّها منقَهِرةٌ به. وبذلك، فإنّ اليقينَ والشك هما شيءٌ واحد، بل يكادان لا يوجدان حقًّا إذا كان الأول يبدأ أو يبلغ بالشك، والثاني ينقضي باليقين. ولو كان ثمّة نقيض لليقين فهو غير الحي. وغير الحي ليس الموت، بل هو ما لم يُعطَ أعطية الحياة.
ويكون الحي جليلاً بقدر ما تعجز النفس عن القيام بأي فعل تجاهه. وإن قامت بفعل تجاهه فهي تقوم بفعلٍ تجاه نفسها. ونسمّي نفسًا استجابة الحي للجليل. ومن ثم، فإنّ الإنسان دون جلالة هو إنسان دون نفس. وإن كانت الجلالة امتلاكًا لشيء يُحترم دون حد، فإنّ الإنسان دون جلالة هو إنسان لا يحترم الإنسان أو إنسانيّته من حيث هي نفسُه أو الحي بما أنّ الحيَّ نفسُه. ويكون الحيّ الجليل قيومًا بتمام انقهار النفس به؛ فهذا الانقهار هو قيوميّته عليها وقيامها به. والانقهار انقهار النفس بالحياة، وانقهار بالشرط القيمي الأنطو-أكسيولوجي الذي خلصنا إليه من خلال النظر في العقل الهيولاني (الغريزي) وما بعد اللاهوت والميتافيزيقا، وهو الحفاظ على نمو النامي.
يتضمّن الحي حينما يكون قيّومًا معنى الأكسيولوجيا أو معيار التقويم المشترك بين الميتافيزيقا واللاهوت وما بعدهما ويناقضهما. ويتضمّن الأنطولوجيا من خلال القيومية؛ فهي إنشاء، ومن يُنشئ قيّوم يملك معيار إنشاء ما أنشأه كحياة حياتِه. لذا فهو ليس وصفًا ميتافيزيقيًّا مجردًا أو لاهوتيًّا متعاليًا، بل هو الوصف الجامع لما يتناحر من توجّهات. فالذي هو ضد الميتافيزيقا واللاهوت إنّما يشهد كذلك على اشتراكه معهما من خلال القول إنّ معيار الحياة يجب أن يُشتق منها هي ذاتها؛ بمعنى أنّ التوجّه الميتافيزيقي اللاهوتي وما يناقضه يمكن من خلال القيومية أن يُسمّى كل منهما بالآخر.
5- الإنسان بين الضلالة والهدى:
الضلالة والهدى تفترضان بلا ريب وجود مطلبٍ بعينه قارّ في الإنسان، وهو ليس بأكثر من المطلب الأنطو-أكسيولوجي المشترك الذي يعبّر عنه الاستعداد الهيولاني للعقل والجسد؛ أي حفظ نمو النامي. وبالنظر لهذا، تتحدّد الضلالة بالعجز عن بلوغ ما يحفظ نمو النامي، بل وأكثر من ذلك قد يطلب الإنسان ذلك من حيث يدمّر حياته. أما الهدى، فيتعين بالاقتدار على فعلي الصيانة والإرباء أو الإنماء والانتهاض بالشيء. مما يعني أنّ المسؤولية مكوّن لا ينفصم عن الهدى، وهي عن النفس في ذات اللحظة التي تكون فيها عن الآخر-الغير. فتكون الضلالة إذّاك سقوطًا مضاعفًا للمسؤولية؛ لأنّها إن سقطت عن النفس سقطت عن الآخر-الغير.
إنّ طرح بارمنيدس لثنائية طريق الظن وطريق الحق في قصيد يسميه هيدجر بالمواعظي (14)، هو بعيدًا عن مضمونه، إنّما يشكّل تجليًا من تجليات تموضع الإنسان بين الضلالة والهدى، حيث المطلب واحد لكن تثني الطرق أو تكاثرها لتحقيقه، إنّما يطرح سلفًا إمكانية الضلالة والهدى. أما سقراط المتجوّل السؤول، فمن خلال هذا الوصف فحسب يكفي أن نلحظ الاعتراف بالحاجة اللحوح إلى الهدى. وعنده نستشف إذا اعتبرنا علاقة هذه الحاجة اللحوح بالنهايات المفتوحة لسعيه نحو الهدى أنّ هذا الأخير، إنّما هو عيشٌ يستجيب لمطلبٍ لا ينفك عن الإنسان برهة من حياته. فما دام السؤال قد وُجد، فقد عبّر الإنسان عن حاجته للهدى وعن احترازه من الضلالة. أما أرسطو، فإنّ ما تتجلّى فيه الحاجة إلى الهدى والاحتراز من الضلالة عنده هو التشديد في مقالة الألف الكبرى على المرتبة التي للحكيم، والذي يوجب أرسطو طاعته لعلمه بالضروري والكلي. ومن ثم، فإنّ الائتساء بالحكيم هو اتباع ضمني للحقيقة؛ فهو من يعرف الأعسر، وهو الأقدَر على تعليم ما يعلم؛ أي تمليك الحقيقة. وهذه الجزئية الأخيرة بالذات (تمليك الحقيقة للآخر) هي ما يعدّه العلامة الأعَم على المعرفة (15)؛ أي إنّ علامة الاهتداء هي هدي الآخر. وبالنظر للشرط الأكسيولوجي الذي يلتقي فيه كل من الاستعداد الهيولاني للعقل والجسد، أي نمو النامي، فإنّ حفاظ النفس على نفسها هو حفاظ على نفس الآخر.
ولا نستطيع أن نغض الطرف عن الجدال حول الحلولية "Pantheismusstreit" الذي جمع كلًّا من يعقوبي ومندلسون وليسنج وفيتسمان وكانط، والتي كانت تدور حول السبينوزية، على وجه الخصوص سبينوزية يعقوبي، حيث "إما العدم وإما إله/also das nichts oder ein gott"، وسبينوزية موسى مندلسون المطهّرة (gelauterter spinozismus) إذ يجري الحفاظ على الدين والأخلاق. لكن في الحقيقة تخفي هذه السبينوزية المطهّرة لمندلسون منزعًا ديكارتيًا يكاد صداه لا يبلغ الأذنين، وهو ذلك الذي برّر من خلالها ديكارت تأمّلاته في الفلسفة الأولى للعمداء في كلية اللاهوت بباريس؛ أي إنّ الفلسفة تفضُل اللاهوت في البرهنة على مسألتي الله والنفس. وهذا يعني أنّ الفلسفة تعني إيجاد الآي المقدس داخل النفس بالنفس عينها. إن هذا المنزع ليتوافق مع التنوير كتفكير بالنفس مع كانط بصورة واضحة. والأهم أنّه إغواء قد لا تستطيع النزعة الكليانية للاهوت وقتها مقاومته. فديكارت يفضّل الفلسفة على اللاهوت في البرهنة على وجود الله والنفس لما في ذلك من قدرة على إدخال الكافرين في الإيمان (16). إنّ ما يهم في هذا الجدال هو ثلاث شخصيات هي، بتعبير بيتر فيلوننكو: العبقري صاحب الحدوس الباطنية (يعقوبي) أو ما يمكن اعتباره حالة غياب البرهان على الحدس، السلفي (فيتسمان)، ومحامي الفطرة السليمة (مندلسون). هذا الأخير الذي حافظ على منزعٍ ديكارتي خفي حتى من خلال اعتبار امتناع اكتمال معرفة الذات ذاتها برهانًا يتوسّل به لإثبات وجود الله في كتابه "ساعات الصباح" (17) (morgenstunden).
في تعبير فيلوننكو، فإنّ هذا تمرحلٌ له طابع الضرورة. فإذا كان على الفكر أن يهتدي، فإنّ اهتداءه يكمن في فهم هذه الضرورة. أما كانط نفسه، فإنّ مقالته حول "الاهتداء في الفكر" إنّما تعنى حسب قوله بـ: "إنهاء تاريخ العقل وهدايتِه نحو مهمته الخاصة؛ يتعلّق الأمر بإصلاحه إصلاحًا أبديًا" (18). إنّ إمكانية الضلالة ظلٌ مشترك بين كل من يعقوبي، كما يرى ذلك في توصيفه لنفسه بأنّه صاحب عقل وثني وقلب مسيحي (19)، وفي فيتسمان في وضعانية دينية على غرار القديس جوستينوس (الفيلسوف الشهيد) المُعدم في عهد الرواقي والإمبراطور ماركوس أوريليوس صاحب كتاب التأملات الشهير، حيث أوج الخوف من الضلالة بحيثية تفرض العماء. وفي مندلسون أخيرًا حيث الحيرة بين الفطرة السليمة وما يتبدى للعقل. أما بالنسبة إلى الكتب المقدسة (العهد القديم والجديد والقرآن الكريم) فلا حاجة لبيان ضرورة الاهتداء. فسواء تأولنا هبوط آدم وزوجه (حواء) من الجنة أو النعيم التام والمطلق أنّه قد كان بسبب الجهل (سبينوزا) أو الغرور أو طلبًا للمعرفة، فإنّ العاقبة تبقى سهمًا يمرّ تاركًا ثقبًا يشهد على ضرورة الارتواء من معين تعاليم الله (عز وجل). إنّ السقوط في العاقبة هو إذا ما يوقظ النفس على أنّ الحاجة إلى الاهتداء إنّما هي النفس ذاتها؛ لأنّ الحفاظ على البقاء، بما أنّه ضرب من الرغبة، فإن البنية الصورية للاهتداء المتمثلة في التقاء الطالب بمطلوبه هي أيضًا البنية الصورية للرغبة. بذلك، فإنّ الإنسان هو من يهتدي.
تتلاقى مقالة كانط حول الاهتداء في الفكر في بنيتها الصورية مع الاهتداء في النصوص المقدسة. وهذا يدلنا على أنّ الصورية ليست فراغًا. وإذا فهمنا كلًّا من يعقوبي وفيتسمان ومندلسون كضروب من العواقب صوب عملية الاهتداء كالتقاء للطالب بمطلوبه، فإنّ المحصلة النهائية التي تتبلور بين أيدينا بالنظر إلى نمو النامي كشرط أكسيولوجي مشترك للاستعداد الهيولاني للعقل، والذي يمثّل كلًّا من الميتافيزيقا واللاهوت (غير المحسوس) والجسد (المحسوس)، هي أنّ الاهتداء، والذي يشكّل الحقيقة الإنسانية، هو اقتدار الحي على حفظ حياته. إنّ التقاء الطالب بمطلوبه، والذي يشكل البنية الصورية للاهتداء في مقالة كانط ونصوص اللاهوت المقدسة، هو التقاء بالجلالة من حيث هي استجابة إلى ما لا رجعة فيه؛ لأنّه يخص الشيء نفسه في ماهيته الحقيقية أو باعتباره حقيقته. ومن هنا، نفهم لماذا يقتضي الاهتداء "الأبدية" بصورة فورية. وتعبّر الوحدة عن نفسها في ما له جلالة بقدر ما تعبّر عن نفسها في الطالب؛ لأنّه إذا كان الميتافيزيقي اللامرئي والفيزيقي المرئي كلاهما يعملان على حفظ البقاء، ومن ثم تكون المصادقة أو الاعتراف متبادلين، فما له الجلالة والمطلوب هو الحي، والاستجابة التي تحدث للطالب هي استجابة لما هو قائم به؛ أي الحي القيوم.
ويغدو مفهومًا هنا كيف أنّ علماء مقاصد الشريعة المسلمين الذين قدّموا حفظ الدين على حفظ النفس كالجويني وأبي حامد الغزالي والفخر الرازي والشاطبي لا يختلفون في شيء عن الذين قدّموا حفظ النفس كالآمدي والعز بن عبد السلام والطاهر ابن عاشور. فالآية القرآنية 32 من سورة المائدة والتي تقول: "من قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعًا، ومن أحياها فكأنّما أحيا الناس جميعًا"، إنّما تجعل من فعل الحي الذي يجلُّ الحي بالحفاظ على بقائه أو إنماء نموه فعلاً تجاه الأحياء جميعًا ضمناً. والفعل الذي يعيقه أو يفنيه فعلاً تجاه الأحياء جميعًا أيضًا. ومختصر الأمر هو أنّه ما دامت هذه الآية من الدين، فإنّ حفظ النفس يتضمّن حفظ الدين، وحفظ الدين يتضمّن حفظ النفس. وكأنّهما واحد، بل وبحسب هذه الآية فإنّه لا حاجة للحديث عن حفظ للنفس بعد حفظ الدين. وبالنظر إلى ما استبان حتى الآن، فإنّ هذا ما يجعل أي شريعة حقيقة بالاستجابة لها. وإنّ شريعة تستجيب لهذا المطلب في النفس هي شريعة تمتد من حيٍ قيوم؛ لأنّها تستجيب لما يطلبه المهتدي مسبقًا قبل إيجاد مطلبه الذي يهتدي به.
6- الفن:
معلوم على نحو كافٍ في تاريخ الفن أنّ حركة تحطيم الأيقونات التي تصوّر المقدسات لم يكن لها أن تتوقف دون مجهودات القديس يوحنا الدمشقي المحتواة ضمن كتابه المعنون بـ"الدفاع عن الأيقونات". ولكن يحدث في ذات الوقت أن يُمرّ مرور الكرام من المرافعة التي أقامها القديس يوحنا حول المحسوس/المادي/المرئي، والتي تتعيّن في نزع الشر والعيب والنقص عن المادة، من حيث إنّ الله (تعالى عن ذلك علوًا كبيرًا) قد "تجسّد" أو اكتسى هيئة الجسد (20). وبذلك، لا مجال لاستبعاد الأيقونات بحكم اعتبار المادة دنسًا. ولو كانت كذلك، فبحضور الإله فيها فهي تكون قد تطهّرت. إنّ نواة مفهوم الطبيعة ما وراء الخير والشر كما عند سبينوزا، أو الصيرورة البريئة عند نيتشه، قاطنة في مجهودات الفكر المسيحي، أو على الأقل هي إمكانية من إمكانياته.
خلاصة الأمر أنّ دفاع القديس يوحنا عن الفن كان ذا أثر أنطو-أكسيولوجي بالمعنى التام للكلمة. ومعلوم أيضًا أنّه قد تمخض عن ذلك "إنجيل الفقراء" أو الـ"Biblia pauperum"؛ أي الإنجيل المصوّر للفقراء الأميين. وما يجدُر لحظه هنا أنّ هذا الاعتبار للفقير الأمي يقترن بمنح الـ "عين" احترامًا خاصًّا (21)، من طبيعة الذي قدّمه أرسطو لها في الميتافيزيقا؛ فهي المفضّلة بإطلاق من سائر الحواس نظرًا لأنّها تفيدنا بالأكثر تنوعًا واختلافًا منها وبالجملة. إنّ الارتواء بالمحسوس وتبرأته يجد تعبيره الأمثل في احترام العين. إنها مشترك إنساني إذا من نواح ثلاث: فهي التي رغم أنّ المثال/eidos يسلبها إلّا أنّه من خلال الأصل الإيتيمولوجي للكلمة يحافظ عليها، ويجد هذا تجليه في المعرفة كتذكر عند أفلاطون، وهي التي تعبّر عن الاهتداء وتدبير العيش، وهي التي احترامها تبرئة للمحسوس وارتضاءٌ له وارتواء به. لكنّ الاهتداء يبقى الناحية التي تستجمع كل هذه التعابير للعين؛ لأنّه سواء كان غير المحسوس ما له الجلالة أو المحسوس، فإنّ الترئية أو جعل الشيء منظورًا مطلبٌ لازمٌ للوجهة الأنطو-أكسيولوجية (نمو النامي) وتدبير العيش من خلالها.
ومعلوم أيضًا أنّ عصر التنوير والتفكير بالنفس قد قطع مع شرعيات كثيرة للنشاط الإنساني، منها شرعية الفن المستمدة من مجهودات القديس يوحنا الدمشقي. بيد أن عصر القطع مع الشرعيات، والذي هو أيضًا عصر للأفول والعدمية في الآن عينه، هو عصر احتضار للنشاط الإنساني بحد ذاته. هذا ما يعبّر عنه الشعار "الفن لأجل الفن" عند كل من فيكتور كوزان وتيوفيل غوتييه. فشأن الفن هنا شأن أي شيء يحتضر ويريد البقاء، قد يتعذّر بأي شيء لأجله. ولو كان ذلك بكيفية مخاتلة تتوسّل بقالبٍ صوري قد ضمّنت فيه الميتافيزيقا واللاهوت وجملة المتعاليات نفسها فيه. فصورة القضية القائلة إنّ شيئًا ما هو لأجل نفسه لها من الإلزامات الأنطولوجية ما لا يستطيع الفن أن يستوفيه. وبذلك، يكون قد ضاعف خطواته نحو الموت من حيث أراد أن يبقى ويعيش. وسننظر تباعًا الآن في هذه الإلزامات لنستبينها من صورة القضية التي احتلّها الفن لنفسه.
لا بد أولاً أن ننظر في محاورة العدالة لأفلاطون، وبالذات تلك اللحظة التي يتدخّل فيها الغضوب ثراسيماخوس متذرعًا بأنّ العدل هو مصلحة الأقوى، ورد سقراط لادعائه بأنّ العدالة لا مفرّ منها حتى بين المجرمين الذين يزمعون فعل شيء. إنّ ما لا مفرّ منه هو ما يوجد لأجل ذاته (22)، من حيث إنّ الفعل البشري لا يمكنه بحال من الأحوال أن يتخلّص منه. وهذا تعيين أول للشيء الذي يمكن أن يوجد لأجل ذاته. أما أرسطو، فمعلوم أنّه يخصّص هذه الصورة القضوية للموجود الأسمى أو العلم الإلهي (اللاهوت)؛ لأنّ الذي ينشأ عنه كل شيء (الخالق) لا يمكن أن يحصل له أمران: أولهما: لا يمكن أن يُستخدم؛ لأنّه من أنتج كافة الاستخدامات، وهذا من جنس الآية 18 من سورة الأنعام: "وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ". ويشترك أيضًا مع أفلاطون في ذلك، وثانيهما: أنّ الذي لا يمكن استخدامه تجب طاعته والاهتداء به والعمل به. وهذه أيضًا بالإمكان استنباطها من رد سقراط على بوليمارخوس. وهي بالتحديد النقطة التي تظهر أنّ تموضع الفن في الصورة القضوية القائلة "الشيء لأجل نفسه" إنّما هو ضرب من اللاهوت والأنطو-لاهوت (الميتافيزيقا)، بل والإيمان؛ أي إنّه حالة من حالات ما أراد استبعاده وقطع علاقته به. وما قيل بخصوص الجلالة يقال عليه حتمًا. وأكثر من ذلك، فإن المؤلّفات المعاصرة في الفن كمؤلف رينيه جيرار "هداية الفن/rené girard la conversion de l art" إنّما يجد تبريره هنا، من حيث إنّ الاهتداء إنّما يتعلّق بالجلالة.
حق لنا إذا أن نقول إنّ تذمّر الفن من مبادرات إيجاد الشرعية والتساؤل عنها لأنّ لا حاجة له بها، بما أنّه موجود لأجل نفسه، إنّما هو تذمّر المتوجّس من أنّ عدم قناعة الآخرين به قد تفضي إلى انكشاف حيلته التي أبقى نفسه عبرها، وهي الحلول محل الإله بصورة مخاتلة غير مباشرة. فهو ليس بقادر على أن يستقل في استقلاله عن بنية ما أراد القطيعة معه، ولا هو بقادر على أن يعود إليه. ونتيجة ذلك هي الكذب صوريًا: تلفيق نفسه في صورة قضوية لا يعي إلزاماتها. ولا ريب أنّ مسائلات أدورنو في كتابه "نظرية استطيقية" تزداد وجاهة الآن، حول علاقة الفن بالكل أو ما ليس فنيًا (23). وبالذات أنّ القطيعة مع اللاهوت، إنّما خلّفت زخمًا في إمكانيات الفن للحد الذي يجعل دلالته موضع شكٍ دائم وإن كان جديرًا بالاعتبار. إنّ أدورنو، إنّما يذكّر بصورة غير مباشرة بالقول الأرسطي بأنّ الدلالة على أكثر من شيء هو عدم دلالة. إنّ الفن إذا إنّما يموت موتًا مضاعفًا بمحاولاته للبقاء بالذات حين نتفطّن إلى أنّ قطع علاقته باللاهوت أو الأنطو-لاهوت إنّما هي شكل من أشكال هذه الأخيرة. بذلك فإنّه ليس إنقاذًا من العدمية كما يذهب نيتشه، بل هو معين لها على نخرها في العالم. وإذا تحدّثنا في لغة نيتشه فإنّ هذه عدمية سلبية ترفض الحياة برفضها للموت. ولئن كانت العدمية انفكاكًا عن المطلقات، وكان تعاقب المطلقات إنّما يشهد على غياب الأصل، فذلك إنّما يعني أنّ تموضع الفن في الصورة القضوية "الشيء لأجل نفسه"، والذي هو تموضع في بنية الميتافيزيقا واللاهوت والأنطو-لاهوت والمطلقات التي انفكّ عنها العصر، هو تموضع يجعل من التعويل الاهتدائي والخلاصي عليه تعويلاً يفضي إلى عدمية جديدة، أو أنّه قائم أصلاً على عدمية بقيامه في الصورة القضوية "الشيء لأجل نفسه".
بناءً على ما سبق، يمكن لنا الآن أن نستدخل ما ذهب إليه هانس بليتينج في كتابه "نهاية تاريخ الفن/Das Ende der Kunstgeschichte?" حول ظاهرة الملل. فبما أنّ التعويل على الفن يعد بعدمية جديدة، فإنّه يبقينا في جحيم الرغبة وتعاقب إشباعاتها اللامتناهية. ونحن في هذا لا نغادر اللحظة الشوبنهاورية التي لا ترى في الرغبة قدرة على تخليص الإنسان من أزماته الوجودية. يقول بليتينج: "الملل [...] هو رد فعل على الفن الذي لم يعد قادرًا على تقديم إجابات مقنعة عن أسئلة وجودنا" (24). والحال أنّ "الفن لأجل الفن" والفن كتعبير عن إرادة القوة كلاهما يفترضان خلقًا يعترف بالخلق فحسب. ويمكن أن نتساءل إن كان هذا الخلق لمجرّد الخلق ليس إلّا نتيجة لعدم رغبة في الرؤية. فنيتشه يصرّح أيضًا: "لنا الفن حتى لا تقتلنا الحقيقة". ويمكن أن نتساءل أيضًا: هل تقتل الحقيقة سوى أولئك الذين يفرّون منها؟ لأنّ نهاية الطريق لهذه الوجهة، إنّما تعيدنا إلى جحيم الرغبة حيث خلق يتلوه خلق بلا حد. بهذا، فإنّ الفن الذي هو إنقاذ من الأزمات الأنطولوجية والمصيرية، إنّما هو إعادة إلى ذات الموقف. ويمكن أن نرى الآن كيف يتناقض هذا بصورة واضحة مع النمط الأرستقراطي لإرادة القوة؛ أي المنزع السيادي لها عند نيتشه. فهذا النمط الذي هو ثمر يانع متأخّر (25) هو على النقيض من ثمر وفعل النمط الارتكاسي لإرادة القوة الذي هو عبد للحظة والهوى والرغبة (26). وإذا كانت هذه هي الحال، فإنّ فنًا لأجل نفسه، حيث يُتاح له كل شيء إنّما هو فنّ يُكرِه على الالتذاذ به وارتضائه. فكل شيء يُعتبر ولا شيء لا يُعتبَر. إنّه والحق "فعّالٌ لما يريد". وهذه جزئية أخرى نخلص إليها تدل على علاقة ماهوية بين الفن وما ادّعى الاحتياء بالقطيعة معه؛ أي الميتافيزيقا واللاهوت.
يمكن أن نستنتج بعد أن بلغنا هذا المبلغ أنّ موت الفن ونهاية تاريخه يمكن أن تعني أيضًا حياة الفن في بدايته، متفقين في ذلك مع آرثر سي. دانتو (27). فقبل أن يتحدد الفن بشيء قد كان غير محدّد، وهي ذات وضعه الذي خلصنا إليه. وإنّ هذا ليس بالاستنتاج الفيدوني على طريقة أفلاطون في مسألة الخلود، حيث يُستنتج من تحوّل الشيء إلى نقيضه أن بعد الموت حياة، بل هو يعني حنين النهاية إلى البداية.
إلّا أنّ الحجة النهائية والتي يمكن من خلالها جعل قضية موت الفن قضية غير مستشكلة هي تلك التي يمكن توجيهها إلى الاعتبار الذي بمقتضاه يكون تعبيرًا عن الحياة. فهذه الأخيرة التي لا تستأذن أحدًا حينما تقرن به، إنّما تجعل منه أيضًا غير مسائل. لكن من حيث الشرط الأنطو-أكسيولوجي المشترك بين التوجهات كافة على تباعدها الظاهر لنا، هل تأخذ الحياة بأي شيء كوسيط لتنمو وتحافظ على نفسها؟ وكيف تأخذ وسيطًا وهو ذاته قائم بها؟ الإجابة هي لا. وإن كان ثمّ من وسيط، فهو يتوسّط بها. حتى داروينيًّا، فإنّ الحياة كتكيّف تقوم بعملية التشذيب والاستبعاد تخفيفًا من معيقات استمرارها وتخلق بما يعين ذلك. إذن، ومن منظور إتيقي، فإنّ مماثلة الفن بالحياة إنّما تكون في الحقيقة على حسابها. وهذا نظير خيانتها لصالح أي واحدة من الثنائيات.
7- الاستطيقا:
"وإن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه ليعلو ولا يعلى عليه، وما يقول هذا بشر" - الوليد بن المغيرة عن القرآن الكريم.
إنّ المماثلة بين الفن (art) والاستطيقا، والتي بحكمها يُعد الفن استطيقيًا، تجري على مستوى مخصوص، وهو مستوى الخلق والإبداع من حيث إنّه يفترض التقدير والتدبير؛ أي التذوّق. وهو ليس مسألة تلقٍّ أو تقييم، بل التقييم كائن في الفعل الفني نفسه. يكشف لنا الأصل الإيتيمولوجي في اللغة العربية عن ذلك، ففنّ الشيء يعني تزيينه. وهو ذات المعنى للكلمة في اللغة اللاتينية (ars)، حيث تعني الصقل ومنح الهيئة. لكنّ الاشتراك والتواطؤ في المعنى يتّضح من خلال الجذر الهندو-أوروبي (ar(e والذي يعني الملائمة والتركيب. ويقال في العربية أيضًا: "فنّ فلان فلانا" ويعنى بذلك أنّه أتعبه. والحالتان الخاصتان بالعربية تحيلان إلى إضافة شيءٍ إلى شيءٍ خام، بما في ذلك الدلالات الخاصة باللاتينية واللغات الهندو-أوروبية. لكن في الحالة الأولى نجد أنّ الفعل الفني كفعلٍ تزييني هو يستجدي النظر إليه. فالالتذاذ قائم إذا في ماهيّته. أما الحالة الثانية، والتي تحيل على العبء والإثقال، فتحيل لا ريب على ما ينزع الإنسان للتخلّص منه. وصورة فعل الإثقال، إنّما تحيل إلى تباطؤٍ في المسار لمتحرك هو الإنسان؛ أي الحي الذي ينمو. وبهذا يتضح لنا أنّ المعيار الأنطو-أكسيولوجي، والذي يحدّد عاقلية الإنسان أو اعتداده بالجسد باعتبار العواقب ليحفظ بقاءه، ثاوٍ مسبقًا في ماهية الفعل الفني. وبذلك يتّضح أنّ الفن لأجل الفن ومراوحته بين الحصول على الشرعية من اللاهوت أو التندّر له باسم نفسه، نسيانٌ للإنسان فاعله وماهية الفعل الفني نفسه الذي يزمع إزكاء قيمته.
لكنّ الأفدح هو أنّ فنًّا لا حاجة له بالشرعية إنّما يقطع علاقته بالاستطيقا من حيث إنّه يجعل من كل شيء قابلًا للتناول. والحالة هذه، فإننا إذا عددنا الاستطيقا على نهج بومغارتن أنّها تمد العلوم بالمجمل بالمواد المناسبة (28)، فإنّ الفن إنّما يستغلق على نفسه في صمدية تمنع عليه حتى القيام بفعل يُساهم في نمو النامي. ويتّضح أيضًا في العلاقة بينه وبين الاستطيقا من حيث الصمدية التي يتموضع فيها نظرًا إلى اكتفائه بنفسه، تموضعه في قلب مفهوم الإله في الميتافيزيقا واللاهوت والأنطو-لاهوت؛ أي غناه عن العالمين. إنّ فنًا لا يعتبر إلّا نفسه، إنّما ينصّبها بصورة مباشرة كضد أصيل للحياة بما هي كذلك. وما دام يحل محل الإله، فهو يقوم بدورٍ شيطاني في هذا المحل.
بما أنّ الالتذاذ والانتشاء قائمان في قلب ماهية الفعل الفني ومعرفِه، فلا محيد له من الأنطو-أكسيولوجيا أو من ألّا يكون لأجل نفسه بعامة. وبصورة خاصة، فلا محيد له من أن يكون تطهيريًا؛ والسبب في ذلك، أنّ أي فعل إنساني من حيث إنّه حفظ للبقاء أو النفس يعتَبر العاقبة اعتباره لماهيّته. وبذلك فهو حينما يطرح شيئًا، فإنّما يطرحه للإنماء والإرباء، والذي يأخذ دلالة الزينة في الفعل الفني، أي استجداء الناظر أو المقبل لالتذاذه. وشرط ذلك عدم وجود العاقبة، والتي تأخذ دلالة الثقل والعبء. إنّ الإنماء والإرباء إنّما يعنيان كون الفعل الفني طاهرًا؛ أي صالحًا للتماس معه أو هو مناسب إتيقيًا وتفاعليًّا. ولا إنماء وإرباء إلّا بفرض أنّه يزيح عائقًا يفرض احتباسًا وإعاقة لديمومة الحي؛ لأنّ الحي بالنظر إلى نفسه هو في ديمومة من طبعِه ما لم تُحجَز. ليس التطهير إذن، والذي فرضه أرسطو على الفن، ضربًا من تحديد المحايث بالمتعالي، بل هو ينتمي للفعل الفني بقدر كونِه فعلاً إنسانيًّا.
إنّ هذا لمناظرٌ لما ذهب إليه هانس ياوس من أنّ الالتذاذ الاستطيقي، إنّما هو تدميري وتربوي إنمائي في آن واحد. فعلى العائق أن يتدمر إثر التماس مع الفعل الفني (29). ومن ثم، فإنّ الالتذاذ استطيقيًا هو غير قابل للترويض اجتماعيًّا (30). وهذا يتّضح في تماس الوليد بن المغيرة مع القرآن الكريم. إنّه يعبّر لقريش لا عن حلاوة القرآن فحسب، وإنما عن عدم إمكانية احتواء أثره والهيمنة عليه لإلغائه. أو فلنقل إنّ الوليد بن المغيرة هنا إنّما يجحد فهمًا مسبقًا للعالم من نسج قريش باسم عالم نص أنتشي به استطيقيًا. إنّ اعترافات القديس أوغسطينوس هنا وبلاغيتها، إنّما هي من سنخ هذا؛ بمعنى أن الالتذاذ الاستطيقي إنّما هو التذاذ بالتطهر متمثلاً في مسيرة التوبة أو الرجوع إلى الله. والحال أنّ التوبة كائنة بعد في أي نشوة استطيقية؛ لأنّ الجحد للعالم إنّما هو جحد لعالم سبق للنفس أن انخرطت فيه. وبذلك، فإنّ النشوة الاستطيقية هي تطهّر من عالمٍ في النفس. أما القرآن الكريم، سواء كان ذلك في سردية توبة آدم وزوجه (حواء) أو دعوة الله تعالى للمؤمنين بالتوبة والرجوع إليه، فرغم سابق إيمانهم وتسليمهم له عز وجل بقيَت التوبة مطلبًا على عاتقهم. وإن اعتبرنا أسباب النزول باعتبارها مناسبات للآيات وكانت الآيات تزكية (تطهيرًا)، فإنّ الدعوة للتوبة كمطلب لازم يصبح الغرض منها استكمال صيرورة التزكي والتطهر، والتي من دلالاتها "شرح صدر العبد بالإسلام" لتتميم الرجع والرد إلى الله. بناءً على ذلك، فإنّ الفن لأجل الفن إنّما هو منزع متجانس مع إثارة انفعالات لا مبالية؛ لأنّ الصورة القضوية التي يموضِع نفسه فيها (الشيء لأجل نفسه) هي صورة من مضامينها أنّ الشيء غير قابل للاستخدام. وهذا بالطبع بالنظر للرغبة الإنسانية؛ أي إنّه بالمجمل لا يُسمِن ولا يُغني من جوع، ولا يُسعِف في شيءٍ نموَّ النامي.
8- الإتيقا بين التفجّي والصمديّة، حول الكينونة التقوية التائبة للإنسان:
من المتفقات بين الجمهور أنّ التوبة تركٌ ورجوعٌ عن شيء. ومن المتفقات المفترضة وراء ذلك أنّ الإنسان لا يترك ويرجع إلّا وهو مهتدٍ نحو شيء. وبذلك، فإنّ التوبة هي حصول الضلالة أو العاقبة من موضعٍ قدّر منه الحي ديمومته. وبما أنّ الحي لا يستطيع أن يفارق طلبه للحياة في كل حين، فإنّ الضلالة عن مطلبه هذا يستحيل أن يكون أمرًا قد رغبه وأراده. يكون الإنسان إثر مواجهة الضلالة إذا أمام ما يسلبه بالمعنى المنطقي للكلمة لا الهيجلي. أما بالمعنى الهيجلي، فإنّ السلب تحويل له من الضلالة نحو الهدى، وهو المعنى الأكمل لها. وهذا المعنى الأتم مفصّل عند الغزالي على نحو يظهر تمرحلات الكينونة الإنسانية ككينونة تائبة من الضلالة إلى الهدى. فمواجهة العاقبة، والتي تعني تفويت المطلوب أو المهتدى إليه، ثم ما يحدث فور ذلك من تبدّل في الحال من الاستمساك بما أُتجه نحوه إلى الإعراض عنه حتى القضاء باستدراك ما فات (31). وفي هذه الجزئية الأخيرة يتضمن حدوث الاهتداء الضلالة؛ لأنّ استدراك ما فات هو التيقظ نحو المطلوب الذي غُفل عنه؛ أي إنّ تمام التوبة كسلبٍ هيجلي تكون فعلًا قد تثبّت موضوعه أو مطلوبه.
لا ريب أنّ وخز الضمير حاضر هنا بالمعنى السبينوزي. فالتأثر أو التفاعل مع شيءٍ ما، سواء كان في الماضي أو الحاضر أو المستقبل، هو ما يجعل من الشيء حاضرا وموجودًا (32). وإذا كان الأثر الحزين/tristitia للذنب يشمل كلية الإنسان، فإنّ وجودَه يكون وجودًا مذنبًا. وهذا معنى يوافِق عليه نيتشه أيّما موافقة. إلّا أن المأخذ النيتشي إنّما هو الوقوف في الذنبِ دون الاستدراك نحو النفس؛ أي في الصيغة اللغوية "كان يجب علي أن أفعل" بدلاً من وجود هو أكثر حكمة وتحوطًا (33). فالنفس التي قدّرت ديمومتها من حيث قطعها هي ليست في صلحٍ مع زمنها الماضي. وهي بالأحرى لا تأمن نفسها نتيجة له. وهذا ما يمكن أن يكون علّة الحيرة في فهم النفس كما نجد عند أوغسطينوس، والتي لا تنتهي إلى عبر الله، باعتباره المطلوب الذي يهتدى إليه. لكن في شأن سبينوزا ونيتشه، فإنّ الإمام الغزالي من خلال اعتباره القضاء شرطًا لازمًا للتوبة، فهو حتمًا يرفعها إلى مصاف المفهوم الفلسفي للاهتداء؛ لأنّ القضاء يعمل على عين الشيء الذي فُوّت وكان تفويته يعني الوقوع في عاقبة تنقص من نمو النامي. وهذا يعني أنّه تطهير النفس مما التبس بها بفعل نفسها أو أنّه استدراك بالتنمية والإحياء لما هو في حالة تناقص بفعل العاقبة. إنّ الذنب أو الضلالة أو وخز الضمير ليست محض حالات يمكن أن نقع فيها أو لا نقع، بل إنّ حتمية الوقوع فيها من حتمية الاهتداء نفسه نحو ما ينمي النامي. من ثم، فإنّ الالتذاذ والنشوة الاستطيقية تتعلق عند الإنسان في المقام الأول باقتداره على نفسه. فالحديث النبوي الكريم القائل: "المجاهد من جاهد نفسه في الله" إنّما يعكس البنية الصورية البحتة للالتذاذ الاستطيقي. فالله كمهتدىً إليه بالنظر للإنسان، إنّما يمثُل هنا كغاية تبلغ بشرط التطهر من العوائق والعواقب أو الانفعالات اللا مبالية.
إنّ التوبة إذًا تجعل من الالتذاذ والانتشاء الاستطيقي "epithumiais khresthai" انفعالًا متحكّمًا فيه بصورة متفرّدة ومتعالية كما عند أفلاطون وسقراط (34). إلّا أنّ هذا الالتذاذ لا يكثف نمو النامي إلّا عبر الندم الذي يكشف بدوره سعة في إمكانيات النفس؛ لأنّ الندم الذي يلقي بالمسؤولية على كاهل النفس وحدها إنّما هو يؤنّبها. والتأنيب يحيل إلى أنّ النفس صمّمت عمل شيءٍ معين لكن ترددًا أو توترًا أعاقها. فالعاقبة التي يتطهّر منها كائنة بعد داخل انفعال الندم الذي يدفع إلى عملية التأنيب.
نسمّي التردد أو التوتر بالفجوة الإتيقية، وهي الوضع التفاعلي للحي الذي إما يقطع ديمومته أو يعيقها، أو الوضع الذي تسقط فيه العاقبة من الاعتبار، حيث يعتمل اللاإرادي واللاواعي وكل ما هو ضد الطبيعة السيادية للكوجيتو. إنّ الآية 27 من سورة الأعراف والتي تصف الشيطان بأنّه: "يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم" هي توصيفٌ لهذه الفجوة. بهذا المعنى، فإنّ الإنسان إنّما يكتشف نفسه دون اهتداء داخل مفهوم الفجوة الإتيقية؛ أي إنّ الضلالة إنّما هي إمكانية الإنسان للاتخطّف من كل ما يسقط العاقبة من الاعتبار بالنسبة إلى الحي أو لا يحاذر شيئًا صوبه.
إذا كانت الفجوة الإتيقية هي كل ما يسقط العاقبة ولا يحاذر شيئًا فيما يتعلق بالحي، فإننا نسمّي كل ما يعدّ العاقبة ويحاذرها بالصمدية الإتيقية. ويمكن أن نسميها تقوية إتيقية. والعرب في لغتها مجمعة على أنّ الوصية بالتقوى وصية بالمحاذرة من شيء له عاقبة. أما القرآن في سورة الأعراف الآية 26، فيوصي بالتقوى بأسلوب إتيقي قائلاً: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير". فالتقوى كلباس، إنّما هي تحجب الفجوة الإتيقية كالحصن الذي من خلاله يتفاعل الحي بصورة تنمي نموه دون فرصة تنقصه. وكريش فهي استطيقا التوبة واستعادة الاهتداء. قال حجة الإسلام الإمام الغزالي: "التائب قد أقام البرهان على صحّة نسِبه لآدم بملازمة حد الإنسان" (35). إنّ آدم عليه السلام بصفته شخصية مفهومية هو الحركة التي صمّمت ولم يكن لها عزم فترددت بفعل الوسوسة من الشيطان (في حدود ما يعبّر عنه هذا الأخير من إسقاط للعاقبة) حتى مثلت في الفجوة الإتيقية. وهو أيضًا من سدّها بفعل التقوى. إنّ الإنسان حينما يقيم الحجة من خلال التوبة على صحّة نسبه لآدم، هو إنسان قد اعتبر العواقب في العلاقة مع الحي؛ أي إنّه من خلالها يكون عاقلاً ويكون جسده عقلاً عظيمًا أو بلا أعضاء. ولما يقول النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنّه يتوب إلى الله في اليوم أكثر من سبعين مرة، فهو يجدد عهده بالآدمية المتمثلة في هذه الحركة سبعين مرة؛ بمعنى أنّه يتكشّف الفجوة ليصمدها بالتقوى. وكل ذلك بعمل ذاتي، حيث لا داعي للسقوط في العاقبة حتى تفعّل التقوى.
9- المحايثة المضاعفة، حول منبع الشرط التعبيري من خلال النقيض:
تبيّن لنا من خلال البحث عن وحدة بين الخطاب الذي يمثّل اللامرئي (الميتافيزيقا واللاهوت)، والخطاب الذي يمثّل المرئي (ما بعد الميتافيزيقا واللاهوت كالتجريبية العلمية والطبيعانية) تناسبٌ بين غير المتناسِبين، يقتضي كلٌ منهما نبذ الآخر؛ وذلك من خلال العلاقة التبادلية الاستعارية بين المرئي واللامرئي والعكس، حيث كلٌّ منهما بحاجة لما ينبذه ليعبّر عن نفسه. إنهما بإيجاز متناسبان في لا تناسبيتهما.
إنّ اقتضاء كل من المرئي أو اللامرئي لنقيضه حتى يعبّر عن نفسه يعني أنّ التطابق أو أنّ هوية الشيء حينما ترجع إلى نفسه لتطابقها تُصدر الغيرية من حيث هي إمكانيات جلالية (بمعنى أنّ المرئي يصدر اللامرئي للإحالة على جلالته، واللامرئي يصدر المرئي للإحالة لذات الشيء)؛ أي إنّه إذا كان الشيء هو هو، فإنّه يصدر غيره. فـ"هو" حينما تُضاعَف، إنّما تؤكد وتثبّت امتيازًا لهوية. وهذا الامتياز الذي يثبّت داخل غيرية هي هوية لا تطابق نفسها ولا ترجع إليها. بذلك، فإنّ ال"هو" كحضور حينما يُضاعَف فإنّه يكون حضورًا داخل غياب. وبهذا تكون الغيرية داخل وجود الوجود. وبما أنّ التطابق تعيّن والغيرية بخلاف ذلك، فإنّ المحايثة المضاعفة إنّما تقوم بجعل الفرق فرقًا؛ أي إنّها مجال للاتمايز. ومن الممكن للغيرية أيضًا أن توجد بذات الكيفية التي يوجد بحسبها المتطابق أو الهو هو. وهي إذّاك لن تلتبس به، حيث يمتنع عزلها عنه فتذوب فيه، ولن تنفصل عنهحيث يستوجب وجودها إلغاءه أو العكس. لندرب مثالين:
1- حينما نقول التفاحة هي التفاحة، فإنّ مضاعفة الدال أو محايثة المحايث هي امتيازه بمدلول معين. وهذا الامتياز الذي ينتج عن مضاعفة الدال، إنّما هو تعبير يعترف بالمطابقة من خلال تأكيد الامتياز. وعليه هو أيضًا تعبير يعترف بغيرية؛ إذ الامتياز الذي يجري تأكيده من خلال الهوهو هو امتياز على شيء أو بالنظر لشيء آخر. إنّ وظيفة المضاعفة تعمل عمل الإبراز والإظهار الأشد سورة لما يمكن أن يتوارى في الهوية.
2- حينما يقول ميستر إيكهارت: "أن الله هو الله وأنا إنسان، فكن متيقنًا من هذا لأنه حق، والحقيقة نفسها تشهد بذلك"، فإنّ الغيرية أو الاختلاف، إنّما تتضح حدودهما من خلال المضاعفة. فمطابقة الله لنفسه هي ذاتها ما جعلت الغيرية والاختلاف يكونان بذات الطريقة التي وُجدت بها المطابقة؛ أي كون الغيرية غيرية.
وبذات الطريقة، فإنّ الامتياز الذي يجري تأكيده من خلال الهوهو؛ أي مضاعفة الهو كحضور داخل الغياب، يؤكّد بالمقابل امتياز الغيرية؛ فهي غير بالنظر لشيء آخر؛ أي إنها غياب داخل حضور. والصورة الجدلية لكل من التطابق والغيرية هي: أنّ هوية المتطابق تبرز وتظاهر بقدر ما يتطابق، فتكشف هوية الغير بقدر ما يتطابق كذلك مع نفسه. فظهور امتياز في جانب هو ظهور امتياز مختلف في الجانب الآخر، والعكس صحيح.
والصورة المنطقية لكل ما سبق هي:
∀أ[(أ=أ)→∃ب(توليد(أ,ب)∧ب≠أ∧◊جلالة(أ,ب)].
حيث أ يمكن أن تشير إلى المحسوس أو غير المحسوس. وشرحها كالآتي: لكل أ، إذا كان أ متطابقًا مع ذاته (أ=أ)، فإنّ هناك "ب"، حيث تكون علاقة التوليد قائمة بين "أ" و "ب" و "ب" مختلفة عن "أ"، ومن الممكن حصول الجلالة لكل منهما. ومن هذه الصيغة نفهم أنّ التطابق إتاحة مجال لصدور الغيرية وانكشافها. إنّ الهوية أو المطابقة قادرة بذاتها تمتلك إمكان الغيرية.
إنّ المحايثة المضاعفة تعني إذن: أنّ المتطابق متطابق الغير غير (غير متطابق). فحين ترجع الهوية إلى نفسها في المحايثة المضاعفة هي تسمح للغيرية بالرجوع إلى نفسها في ذات الحين. ودون الأول ما كان الثاني، ودون الثاني ما كان الأول. وكلاهما متطابق وكلاهما غير. ولحظة حدوث أي منهما هي لحظة حدوث الآخر. ولحظة تحصيل المطابقة في المحايثة المضاعفة لامتيازها هي لحظة تحصيل الغيرية فيها لامتيازها الخاص أيضًا. وهذا ما يجعل من اشتراط كل من الميتافيزيقي والفيزيقي للآخر للتعبير عن نفسه، إنّما هو محاولة كل واحد منهما كشف الأخص عن نفسه بإصدار الآخر-الغير من خلال نفسه وتطابقه معها؛ لأنها مجالٌ يجعل من الفرق فرقًا. وهي أشبه ما تكون بالمجال الذي يضاء فيه المتطابق في ذات اللحظة التي يضاء فيها الغير. لربما يكون السؤال السبينوزي "ما الذي يستطيع جسد؟" حاسمًا هنا. فالجهل بإمكانياته نظرًا إلى أنّ المباحث الفلسفية بمجملها قد توجّهت نحو الروح اللامرئية وغير المحسوس، قد تناسى أنّه بحد ذاته لربما يكون قادرًا على إصدار الروح، مثلما أنّ العلم بالروح قد أنتج الجسد.
نأتي الآن إلى بيان الشرط التعبيري من خلال النقيض كما رأيناه متمثلاً في الفارابي والغزالي في شأن الميتافيزيقا، حيث يبيّن العقل نفسه مرة من خلال المدينة ومرة من خلال العين وفعل الإبصار. والعكس عند نيتشه كما رأينا في شأن المحسوس والتعبير بعبارة العقل العظيم أو الكبير. فلمّا كان التعبير بمثابة نتيجة، والنتيجة تفترض الانسجام، والانسجام يفترض الوحدة كما أسلفنا في الفقرة الثالثة حول الجلالة، فلا بد من وحدة بين المتناقضين ما دام كلاهما يعبّر عن نفسه من خلال غيره. وهذه الوحدة تتحقق في الجلالة. وإذا كان الاختلاف التام بين المتناقضين يظهر فيها، حيث بوسع غير المحسوس أن يرى أنّه آخر تمامًا بالنظر للمحسوس والعكس، فإنّ الجلالة تتماهى مع المحايثة المضاعفة في هذه الجزئية؛ أي إظهار الاختلاف والفرق. وإذا كان غير المحسوس بحسب الميتافيزيقا واللاهوت، أي الله أو العقل الكوني، ينتج المحسوس كالجسد، فإنّ غير المحسوس المتطابق يصدر غيره المختلف. وإذا كان المحسوس عقلٌ عظيم كبير أو بلا أعضاء منتجًا لغير المحسوس، فإنّ بنية الجلالة، والتي تتحدّد بأن يكون الجليل آخرًا تمامًا تعجز النفس عن الإحاطة به، ومن ثم يكون قادرًا على توجيهها والتحكم بها، وكانت فرادته تتمثل في ذلك، هي بنية المحايثة المضاعفة؛ لأنها تطابق مضاعف يصدر الغيرية. وهي بنية العلاقة الاستعارية التبادلية من غير المحسوس إلى المحسوس ومن المحسوس إلى غير المحسوس. وفيها يتم تطابق كل منهما مع نفسه، ويكون إصداره لغيره بمثابة البرهان على تماهيه مع نفسه؛ بمعنى أن استخدام كل من الفارابي والغزالي لتعبيرات محسوسة لبيان غير المحسوس، واستعمال نيتشه لتعبيرات غير محسوسة من أفق الميتافيزيقا واللاهوت لبيان المحسوس، إنّما يعبّران عن تطابق مع النفس للحد الذي يستطيع فيه المتطابق مع نفسه إصدار غيره.
ولبيان أكثر ما سبق، فإن القول بالجوهر غير المحسوس أو المحسوس لا يتم إلا بقدرته على الإحاطة بالآخر كغير له وإصداره من نفسه. إنها علاقة زوجية على اختلافهما. ومعجم كل منهما الوصفي وسيلة كل منهما لتبيان قدرته على الإحاطة بغيره.
إذا كانت لحظة المطابقة ولحظة الغيرية هما لحظة واحدة، فإنّ حدوث النفس بتحقق العقل الهيولاني (الغريزي) بالفعل أو الحفاظ على البقاء (كما في لغة الفيزيقيا) ونمو النامي باعتبار وزحزحة أي عاقبة قد تهدده أو تفككه حينما يتقاطعان، فإنهما يُكوّنان محايثة مضاعفة أو هوية راجعة إلى نفسها لكن باختلاف الوجهة لا أكثر. وهي أيضًا لحظة حدوث الجلالة. والدليل على ذلك يكون من خلال الجلالة نفسها. ففي المحايثة المضاعفة تكون الهوية الراجعة إلى نفسها فريدة وممتازة على الغير ولا نظير لها. وهذا هو مضمون الجلالة. فهي عظم يُعبّر عنه بلغة الأحجام كقولنا "هذا كبير" (جدير بالاحترام) دالين ومشيرين بذلك إلى عظمته وجلالته بالنظر لغيره وفرادته وغياب نظير له، قبالة ما يظاهر حينها أنّه صغير (غير جدير بالاحترام) وله نظير. وما دامت الجلالة يمكن أن تكون متعلقة بالمتقابلات كالمرئي واللامرئي، وهما يشتركان في التقويم الأنطو-أكسيولوجي القيمي المتمثل في الحفاظ على البقاء ونمو النامي من العواقب التي تتهدده، فإنّ لحظة استجابة النفس لها هي لحظة تضمين الجلالة لتقويمها في النفس. بمعنى أنّ المظهر الإنساني للمحايثة المضاعفة والجلالة هو نفسه التقويم وتملّك الإنسان له؛ أي تديره للعيش في صورة نماء.
إنّ دعاوى استبدال الميتافيزيقا بالعلم التجريبي أو بالجنيالوجيا لم تكن ممكنة دون شرط أن تتمكن هذه التوجهات التي تمثل الجوهر المحسوس من أن تفسّر وجود الجواهر غير المحسوسة عبر نفسها؛ أي إنّ شرط استبدال جوهر محسوس بنقيضه أو جوهر غير محسوس بنقيضه هو قدرته على إصدار وإنتاج نقيضه.
9.1- المحايثة المضاعفة والجلالة:
إنّ السلب التناوبي الذي هو بحسب دريدا في "الميثولوجيا البيضاء" شرط لازم لقيام الميتافيزيقا واللاهوت، والمتمثل في تقويض المحسوس المرئي وإنابة غير المحسوس اللامرئي وإحلاله مكانه، يجد إبطاله فيما بعد على يد الجنيالوجيا والمذاهب غير الميتافيزيقية كالتجريبية والطبيعانية، حيث يتم إبطال المبطَل أو إخفاء المخفي؛ أي إظهاره. والمسافة التي يخلقها السلب التناوبي شاسعة للحد الذي يبدو فيه الذي ينيب والمناب عنه آخرًا تمامًا للثاني. فأحدُهما يمكن أن يشبه الكثير وينسجم معه. أما الثاني، فلا يشبه إلا نفسه ولا ينسجم إلا معها. فنفسه هي نفسه.
يجب الآن أن نعود لما بيناه سابقًا حول الجلالة كوحدة للعلاقة التبادلية الاستعارية بين المحسوس وغير المحسوس. فالآخرية التي تخلق فجوة بين هاذين النقيضين وتبديهما كمستقلين عن بعضهما هي تعني على الصحيح أنّ ما نواجهه كآخر تمامًا بالنظر لأحدهما هو ذو جلالة أو محايث مضاعف يصدر غيره؛ لأنّ الآخر تمامًا لا مثيل له، واستبداله متعذّر وتعويضه ممتنع. والجلالة تتعلق بهذا على وجه التحديد؛ أي إنّه هوية لا تطابق إلا نفسها فحسب. ومثل هذا الشيء يعجز الإنسان أمامه وينقهر به. ولا يملك أن يكون أمامه إلا مستجيبًا أو منفعلاً كتعبير عن فقد للحيلة أمامه؛ لأنّ كل ما جرّبه ويشابه بعضه بعضًا له من الوسائل التي تسعفه للتصرّف حياله. ولأنّ ما له جلالة لا نظير له، فإنّ الشعور أو الانفعال والانقهار به إنّما هو انعكاس ذاتي لواقعة موضوعية في ذاتها؛ نعني أنّ العجز والانقهار، إنّما هما موضوعيان موضوعية الجلالة.
بالنظر للمحايثة المضاعفة، فإنّ الآخرية بين المتقابلات التي تنكشف في الجلالة هي آخرية الهوية الراجعة إلى نفسها؛ لأنّه إذا كانت جلالة الشيء آخرية مطلقة التي تعني غياب نظيرٍ له وأنّه لا يماثل إلا نفسه، فإنّ المحايثة المضاعفة من حيث هي هوية راجعة إلى نفسها هي هذه الآخرية عينها. فما تتعلق به الجلالة لا مثيل له إلا نفسه، والمحايثة المضاعفة هوية راجعة إلى نفسها (هو هو) ومثيلها نفسها. بذلك، فإنّ الآخرية التامة في الجلالة هي حدوث المحايثة المضاعفة. إنّ المحايثة المضاعفة إذا هي ما تجعل من الجلالة وحدةً للعلاقة الاستعارية التبادلية بين المحسوس وغير المحسوس وجملة المتقابلات التي تنتمي إلى كل منهما.
أما الغيرية فهي بالنظر للآخرية التي تنكشف في الجلالة، والتي ليست شيئًا آخر غير المحايثة المضاعفة عينها، هي مجرّد نتيجة لرجوع الهوية إلى نفسها. فالمحايثة المضاعفة تشملها دون أن تكون هي نفسها. وهذا يعني أمران:
1- الأول منهما: أنّ العلاقة بين الجوهر المحسوس وغير المحسوس تتحوّل من كونها علاقة بين كيانين مستقلين عن بعضهما البعض إلى علاقة بين هوية راجعة إلى نفسها (هو هو) وغير ناتج عن هذا الرجوع، وهو بدوره يرجع إلى نفسه ويتعرفها كغير؛ لأن رجوع الهوية إلى نفسها بما أنّه يثبت ويؤكد امتيازًا هو امتياز الفرادة وغياب المثل والنظير، فإنّ هذا الامتياز حضور داخل غياب. والغيرية هنا مفترضة في هذا. وهذا ما يجعل من العلاقة بينهما علاقة أغيار. فدون ذلك ما استلزم شرط التعبير عن أي منهما أن يكون من خلال النقيض، وما استطاع في البداية ذلك.
2- الثاني منهما: أنّ الانقهار الذي يحدث أمام ما لا مثيل له ولا نظير هو نتيجة حدوث المحايثة المضاعفة بما أنّها تثبت وتؤكد امتيازًا هو امتياز الفرادة. وهو بدوره لا مثيل له ولا نظير؛ لأنّ إيجاد الحيلة أمامه يستحيل.
بناءً على هذين الأمرين، فإنّ العقل الهيولاني والجسد اللذان يتقاطعان أكسيولوجيًا، حيث معيار الأول والذي يتمثل في اعتبار العاقبة التي هي أي مهدّد محتمل لنمو النامي هو ذاته النزوع الطبيعي للجسد، أي الحفاظ على البقاء، فإنّ هذا التقاطع هو ضعف الشيء الواحد الذي هو الحفاظ على نمو النامي؛ أي إنّه في هذا التقاطع رجوع هوية إلى نفسها. وعليه، فإنّ المحايثة المضاعفة تمثل من خلال الانقهار لحظة إتيقية تهب أكسيولوجيا تجمع بين جوهرين متناقضين تمام التناقض. لا حاجة إذا لمفاهيم من قبيل المحاكاة (mimesis) أو المشاركة (methexis) لإيجاد علاقة بين الثنائيات؛ لأنها زوجيات ومن نفس الواحد منهما يخرج الآخر.
9.2- المحايثة المضاعفة والإيمان الحي كشرط مسبق للجلالة:
سمّينا إيمانًا تسليم النفس للجليل لانفراضه عليها أو انقهارها به نظرًا إلى عجزها عن الإحاطة به. وما دام العقل الهيولاني والجسد يتقاطعان في الشأن الأكسيولوجي، وحيث يعني هذا التقاطع رجوع الهوية إلى نفسها، فهو محايثة مضاعفة؛ لأنّ كلًا من العقل متمثلاً في الجوهر غير المحسوس والجسد متمثلاً في الجوهر المحسوس من حيث هما يفترضان ذات التقويم الأكسيولوجي، يحدث مضاعفة كلٍ منهما لتقويم الآخر، والذي يعادل مضاعفة كل منهما لنفسه. وبهذا أيضًا يشكل هذا التضاعف، والذي هو تأكيد الامتياز أو الحضور داخل الغياب، حدوث الجلالة.
إنّ التقويم الأكسيولوجي المشترك أو المضاعف الذي يتقاطع فيه الجوهر المحسوس وغير المحسوس، والذي يمثل الجلالة، وهو على وجه التحديد: نمو النامي، إنّما يمثل تقاطعًا في شيء هو بمثابة الشرط المسبق للجلالة، والتي بفضلها يكون أحد الاثنين آخرًا تمامًا للثاني، هو الحياة. أي المعطى غير المسبوق باختيار ولا سؤال ولا طلب. وهذا يجعل منها واقعة يجب الاعتراف بها؛ لأنّه إذا كان اعتبار العاقبة التي تهدد نمو النامي هو ما يجعل العاقل عاقلاً، وكان الكوناتوس هو ما يجب قيس كل شيء بما فيه الإنسان من خلاله، فإنّ الحياة هي ما ينقهر أمامه ويعجز أولاً. مما يعني أنّها الجلالة. وثانيًا هي ما يتضاعف على وجه التحقيق. مما يعني أن الجلالة كحدوث للمحايثة المضاعفة، والتي هي الآخر تمامًا، ليست سوى رجوع الحياة إلى نفسها.
لا يعزب عن الحيِّ الجليل شيءٌ إذا، بما في ذلك الثنائيات والمتقابلات التي يبدو بعضها أقل تماهياً معها من بعضها الآخر. فحتى الذي يحدث ضدها يحدث من خلالها. وإذا كان هذا ضربًا من الإيمان، وكان الإيمان يستلزم طاعة لا مشروطة أو تبعية كما أتى بذلك شلايرماخر في عبارة "das schlechthinnige Abhängigkeitsgefühl" أي الإحساس بالتبعية المطلقة، فإنّ الحياة باقترانها بالجلالة وبالمحايثة المضاعفة، إنّما هي تعترف بنفسها. لكنّ هذا الاعتراف حينما يحدث من خلال المحايثة المضاعفة إنّما يمنحها "حرمة" بحيثية تجعل من العاقبة منظورة باليقظة في كل حين. إنّ هذا ليقَع في صلب تعريف الإيمان من خلال فعل التصديق في اللاهوت الإسلامي، والذي هو عملية اعتراف تعتمد المعطى وتعتبره. وبناءً عليه يتحدد غيره ويدبر عبره.
وحيث إنّ الحياة هي ما يجري في رحابها كل شيء، وهي التجسيد الحق للمحايثة المضاعفة؛ أي إنّها جلالة الجليل، وهي ما لا يمكن للإنسان إلا أن يصادق عليها ويعترف بها وكان ذلك إيمانًا، فإنّ غيرها يقوم بها كما تقوم الغيرية برجوع الهوية إلى نفسها؛ أي إنّ الغير هو ما يجعل من الحي قيومًا؛ لأنّ الأخرية التي لما له الجلالة ما دامت تنكشف في تقاطع الاستعداد الهيولاني للعقل والجسد ودلالتهما الأكسيولوجية-القيمية، وكان هذا التقاطع يمثل محايثة مضاعفة، والتي هي الحياة، فإنّ الغير الذي يصدر جراء التطابق المضاعف للحياة إنّما هو يصدر عنها. بذلك، فإنّ القيومية هي صفة الغيرية، والحي صفة رجوع الهوية إلى نفسها. والإيمان هو الاعتراف بجريان كل شيء داخل الحي. والنفس هي اعتبار الحي بيقظٍ مستجيب إلى القيومية به. إنها العناية بما استجابت له إثر مواجهة الجليل في نفسها.
إنّ اللحظة الإيتيقية التي تمثلها المحايثة من خلال الانقهار بما له الجلالة، والتي تهب الأكسيولوجيا، هي ذاتها ما تهب الأخلاق أو القوانين؛ لأنّ العاقبة ومهددات الحياة ما دام تضاعفها يمنحها "حرمة" فهما يتحددان باعتبارها ما يجب دفعهما عنها مرة بعد مرة. إنّ القانون إذًا هو حماية حرمة الحياة.
لقد عرفنا أنّه يجب علينا ألا نقتل قبل أن نتفلسف كما يقول ريكور، وعلى التفلسف والفكر أيًا كان أن يصعد من هذه الإتيقا التي يسلّم بها الأغلبية إلى منبع الإلزام (36). وهذا المسار هو عينه مسار الأخلاق إلى نيقوماخوس لدى أرسطو. فمن المجمع عليه بين الناس "endoxa" يتم التحول والانتقال إلى ما يجب بالنظر لحياة جيدة أي مدبّرة. بذلك، فإنّ الإلزام ينبع من القصدية. وبالنظر إلى سيكولوجيا التحليل النفسي، فإنّ اللاوعي الفردي والذي يتكوّن في الطفولة، فإنّ ما يُخزّن فيه ليس من الذات وإلى الذات، بل هو من الآخر، أي المجتمع بكافة أنساقه ومعيشاته ودلالاته ورموزه. فيصبح اللاوعي التقاء الخاص بالعام والذي يمثل العقلاء أو الأجساد الممتثلة للشرط الأكسيولوجي المتمثل في نمو النامي.
9.3- المحايثة المضاعفة والإنسان بين الهدى والضلالة:
إنّ حدث الاهتداء ذو البنية الصورية التي تتمثل في التقاء الطالب بمطلوبه أو اعتماده أبديًّا، ينبجس هو الآخر ضمن تضاعف. فالطالب إنّما يطلب ما هو داخل رحابه وما هو قائم به. فسواء كان عاقلاً بالمعنى الميتافيزيقي اللاهوتي أو محتفياً بالمحسوس ويتدبر به عيشه، فإنّ صولجان الحكم أو القسطاس المستقيم للوزن لا يُحصّل دون هذا الالتقاء. وهذا الالتقاء يضاعف؛ لأنّ الطالب في محيط المطلوب سلفًا. وبهذا يكون الالتقاء التقاء حياةٍ بحياة تقوم بها. وبشكل أكثر تفصيلاً: إنّ التضاعف كرجوع هوية إلى نفسها إنّما ينتج مباشرة علاقة قيومية من حيث أنّ التطابق (هوهو) يبثق الغيرية.
أما مسألة إثبات المطلوب للطالب أنّه الذي يهتدي به، أو أنّه الجليل أو ما يؤمن به ليست مسألة تدفع إليها حاجة؛ والسبب وراء ذلك بسيط. فواقعة أنّ الطالب يطلب ما هو ضمنه أو في غضونه، فإنّ التقاءه بمطلوبه يجلي أنّ الالتقاء ما كان حتى ممكنا دون قيام هذا المطلوب أولاً. ففي غضون الحياة وعبرها يتم الالتقاء بها. وههنا نجد سندًا ليس بالهيّن للحقيقة كتذكر أفلاطونيًا، أو حتى القول الشهير لأرخميدس "أوريكا" حينما وجد الحقيقة. وقبل كل ذلك، لاهوت النصوص المقدسة. فحينما يقول العهد القديم في سفر الخروج 20: 8: "أذكر يوم السبت لتقدسه"، فهو يقول استحضر لتُجلّ شيئا. أما القرآن فيربط بصورة بينة ومناسبات كثيرة بين الاستحضار والإجلال للرب.
لا تند السيكولوجيا كذلك بالمرة عن الذكر علاجيًا وشفائيًا. فمن خلال الاستحضار الذي يمارسه المعالج على المريض، والذي هو رفع المحتوى المكبوت إلى الوعي، يتم الالتقاء بما لم يلحظ بذاته وإنّما من خلال وسيط، أي الأعراض المرضية التي أتت بالمريض إلى المعالج. إلّا أنّ الفارق كائن بوضوح بين ذكر المريض في السيكولوجيا وذكر الفلسفة واللاهوت بنصوصه المقدسة وما بعدهما. فعند الأول إنّما الذكر ذكر ما يمنع نمو النامي، وربما من ذلك نستشف إلزام الطبيب بالعموم بمعالجة المريض ونعد ذلك واجبًا. ولنا في الشرط المحفّز والدافع إلى القيام بالعلاج دليل على ذلك؛ فالمريض لا يأتي إلى حين يعيق العرض المرضي عن الأداء وإنجاز المهام. أما البقية، فإنّ الذكر هو مباشرة رغبة في الالتقاء بما يتماهى مع ما يطلب في الاهتداء؛ أي حفظ البقاء أو النفس. والعرض المرضي يُعترف به خلال عملية الاهتداء نفسها. وإنّ صنافة إتيقا اللاهوت المقدس أو أخلاقه أو أي صناعة أخرى غير سيكولوجية أو طبية تعترف بالعرض المرضي كضربة لازم ما إن يُزمع الاهتداء. نظيرًا للشخصيات المفهومية في الجدال حول الحلولية (يعقوبي، فيتسمان، مندلسون) من حيث هي عواقب أو مرضيات "pathalogish" تمنع تحقق البنية الصورية للاهتداء. والأمر سواء هنا بين الإتيقا والأخلاق ما دامت اللحظة الإتيقية التي تهب تقويماً أكسيولوجيًا هي في الآن نفسه تضاعف الحياة بحيث تصبح ما له الجلالة، وكانت هذه الأخيرة تجعل من الحياة "حرمة"، فإنّ القانون الأخلاقي هو ما يمنع الاعتداء عليها بما هي حرمة. وهو ناتج عن الإتيقا. أي أنّها تمارس ذات المسار الإتيقي الأرسطي المتمثل في العثور على منبع الإلزام من الإتيقي والغالب بين الناس.
نستخلص تغيّرين ممّا سبق، في مسائل فلسفية كالوعي واللاوعي وقضية الكوجيتو المجروح:
1- الأول: أنّ الوعي واللاوعي إنّما هما في نطاق ظاهرتي اليقظة والغفلة؛ لأنّ المحايثة المضاعفة بما هي وحدة نطاق أيضًا، تحتّم أن تجعل من المقولات كالوعي واللاوعي وغير ذلك درجات من العلاقة بذات الشيء من حيث القرب والبعد منه؛ أي من مضاعفة الشيء نفسه.
2- الثاني: أنّ انجراحات الكوجيتو، حيث عدم تمام سيادة الإنسان على نفسه إنّما هي شكل من أشكال القيومية إلّا أنّها مبتسرة، بل معتورة بخلف منطقي. فالمجرّح ليس الكوجيتو على الحقيقة، ولا أن الكوجيتو هو مجروح من حيث هو كذلك، بل إنّ الكوجيتو حدث داخل الانجراح من حيث إنّه تملّك للمجرّح من خلال انجراحه نفسه؛ بمعنى أن التيقظ على الانجراح يتيح إمكانية السيادة عليه. وهذا الانجراح هو انجراح بالقيومية أو بالهوية الراجعة إلى نفسها.
يبقى صحيحًا باعتبار التغير الأول العلاقة التي أقامها لايبنتز بين الذرة/المونادة (monas) والنزوع واختلاف درجته وشدته بحسب كل ذرة وبحسب القدرة على الالتقاء بما ينزع إليه النزوع؛ لأنّ واقعة الاهتداء والضلالة إنّما تتمايزان بحسب مفهومي اليقظة التي تمثل هذا الالتقاء والغفلة التي تمثل مسافة منه. وإن كان للوعي من قيمة باعتباره قدرة على التوجيه، وللاوعي حيث العاقبة بالمرصاد، فذلك بدوره مردّه أيضًا إلى هذا التمايز. أما التغير الثاني، فيتعلق بالذكر ولا ريب أنّ الذكر يتعلق بالذي فات الإنسان. وهو يقوم في آن بعملية تجاه ما فات وحيازته. وإن توخّينا الدقة في شأن العملية الثانية، فإنّ الحيازة ليست أكثر من حيازة النفس كغير بُثق من المحايثة المضاعفة. وداخل هذه الحيازة تكون النفس هي المحوز عليها من حيث قيامها بها. إنّ الاهتداء إذا إنّما يقلب القضية. فالمطلوب في نهاية المطاف يتّضح أنّه هو الطالب.
9.4- المحايثة المضاعفة والفن والاستطيقا:
خلصنا إلى أنّ الفن إنّما يؤكد موته في شعاره الذي رفعه لأجل البقاء، والذي يصله بصورة مباشرة مع الميتافيزيقا واللاهوت عبر الصورة القضوية التي تموضع فيها القائلة: "الفن لأجل الفن"، والتي صيغتها البحتة هي: "الشيء لأجل نفسه". أما إلزاميتها الأنطولوجية، فهي على التوالي: أنّ ما لا مفر منه هو الشيء الذي لا بد من حدوث عبره، وأنّ ما هو كذلك تجب طاعته والتسليم إليه والعمل بهديه.
بالمجمل، فإنّه قد أعاد نفسه إلى ما أراد القطيعة معه. ولا ريب أنّه بدفع نفسه في صيغة قضوية خاصة بالموضوعات غير المحسوسة، إنّما يمارس ذات الاستعارية التي مورست تجاه الجسد أو المحسوس بعامة، كما وجدنا عند نيتشه وأنطوان آرتو ودولوز وغوتاري من بعد. وهذا يعني أنّه ضرب من الجلالة إلّا أنّها جلالة غير قابلة للاهتداء بها من حيث إنّها لا مبالية إتيقيًا؛ أي إنّه يرفض التطهير الذي هو الشرط لتماس الحي مع أي شيء. فهو لا يكترث إن أعاق نمو النامي، ولا يكترث إن هو ساهم في ذلك. وبهذا يفقِد البتّة علاقته بالاستطيقا. لكنّ الأمر الأدهى والشاهد عن عجزه على أن يكون كذلك يتبيّن في كتابات نيتشه الرومانسية الأخيرة، أي اشتراطه حول الالتذاذ بالعمل الفني أن يمر عبر ذات المخاض الذي أنتجه (37). إنّ هذا المخاض يقول عن دلالة العمل الفني أكثر مما يقوله هو حين يتلقى بصورة مباشرة؛ إذ نكون أمامه. فالعمل الفني الذي ينشى به هو "اختزال" وتقليص للكثير الذي جرى أثناء خلقه أو إبداعه. إنّ خلق العمل الفني هو "خزل" الكثير. وبهذا تكون النشوة الاستطيقية التي تذهب ما-قبل لحظة خلق العمل الفني هي بمثابة الفض لما خُزل. وفي هذا الموضع بالتحديد تتشكل صيغة الفيلسوف-الفنان في كتابات نيتشه المبكرة من شوبنهاور مربياً حتى ميلاد التراجيديا؛ لأنّ ما تفرضه النشوة الاستطيقية من ذهاب إلى لحظة خلق الفنان لعمله، والتي هي لحظة الـ"خزل" للكثير، هو نظير ذهاب الفيلسوف للأصول الغنية بالكثير والمتعدد.
إنّ هذا الاشتراط النيتشي، إنّما هو حركة مزدوجة. ففض المختزل في العمل الفني إنّما يفتح الباب لدلالات تبدو دون أفق تحد به. وكذا الأمر عند الفيلسوف في بحثه عن الأصل بما هو محدّد للكينونة. وفي الآن نفسه يستبطن زعمًا أنّ الفنان ليس محدّدًا لدلالات عمله، وأنّ الأصل ليس محدّدًا لما انبثق منه. إنّ التأويل أو الهرمنيوطيقا هي بحد ذاتها الفعل الذي يجمع بين الفيلسوف-الفنان والفيلسوف الباحث عن الأصول. وفي ذلك يتلاقى مع كل من الهرمنيوطيقا الاستطيقية أو التعليمية لدى كريستيان فولف، حيث يتم استبدال دلالات المؤلّف بدلالات أخرى بشرط أن يكون المؤوّل مفكّرًا في ذات معاني المؤلّف لكن الأخير لم يحسن اختيار الدلالات التي تبلغ المعنى المقصود. ويتلاقى وتجاوز الرمزية أو الحرف نحو المطلق/الروح لدى فريدريش شليغل و "ف.آست" المتمثلة في محاولة فهم المؤلّف أحسن من فهمه لنفسه، أو إعادة إنشاء الأثر الفني بالنظر للقيم الثلاث أي الحق والخير والجمال (38). يمكننا إذا استنقاذ الفن عند نيتشه من العدمية الفنية؛ لأنّ النشوة الاستطيقية، والتي تعيد إلى ما-قبل لحظة خزل العمل الفني بما أنّها تعيد إنشاءه، فهي حركة أنطو-أكسيولوجية ينظر فيها الحي في العواقب التي يمكنه أن يتحرر منها ليتكاثف نموه، أو الأعباء التي يتم تحميله إياها ليبتعد من الفعل الفني بصفته فعلاً يثقله أو يعيق نموه.
الفن إذا من خلال اقترانه بالالتذاذ والانتشاء الاستطيقي لا يعود محض فعل ضمن أفعال أخرى؛ لأنّ الحي الناظر في صيرورة انخلاق العمل الفني يتملى ضمنيًّا في سبل ديمومته وبقائه وعوائقه. وبهذا إنّما هو يتضاعف. وبهذا، فهو حدَثٌ بدوره للمحايثة المضاعفة. بيد أنّه يرتفع إلى سفح لا تكون فيه اللوحات والموسيقى وما شاكل ذلك تعبيرًا عنه، بل إنّ ماهية الفعل الفني هي ماهية الفعل الإنساني نفسه من حيث هو فعل على علاقة بما له الجلالة؛ أي إنّه الفعل الإتيقي والأخلاقي في الآن نفسه؛ بما أنّ المحايثة المضاعفة أو الهوية الراجعة إلى نفسها تهبه دفعة واحدة. نعني بذلك أنّ الإنسان هو كائن فني بقدر ما يكون منقهرًا بالحياة مسلّمًا لها عاملاً لها. وفعله آنذاك إنّما يشهد على تماهيه مع الحياة بكافة انفعالاتها. أما الفن الذي يكون لوحة أو موسيقى أو غيره، فإنّما شأنه شأن الزينة. وبالمعنى المباشر للكلمة، فإنّما شأنه شأن الفائض الذي يمكنه أن يكثف الإنماء أو يحفز على الارتماء في صيرورة التطهير دون اكتمال. ولهذا مبرره؛ فالحياة كمحايثة مضاعفة أو كهوية راجعة إلى نفسها هي ذاتها إنصقال وما عليه. والذي هو الخام الذي يصقله العمل الفني هو بحد ذاته زينة عليها. لذا، فإنّ الفعل الفني أو العمل الفني والذي يكون لوحة أو غيره هو خلق لزينة على زينة. وبهذا يبدو ما يفهم عادة بفعل فني عدمية قيد الحدوث.
وإذا كان الخام نفسه فعلاً فنيًا، فقد نتذكر والحالة هذه ما ذهب إليه هايدغر في منبع (أصل) الأثر الفني من أنّ الفن نفسه هو الأصل للفنان (39). وقد نتذكر أيضًا والحالة هذه أنّ الفنان، إنّما يحمل إلى الأثر الفني الخام والأرض التي يؤسس الإنسان عليها مقامه وتحتضنه، إلّا أنّ هذا الحمل الذي يقوم به الفنان مشروط بوضع تقني في العلاقة مع الحياة والأرض؛ بمعنى أنّ الفنان إنّما يقوم بعملية تطهير للحاضن والمقام من التقانة، إلّا أنّ الإنسان كمنقهر بالحياة لا محالة، وكان الخام فيها زينة تحدث انتشاءً أو التذاذًا استطيقيًا، فإنّه ليس بعوز لوساطة فنان أو أثر فني من جنس الرسم أو الموسيقى ليتطهر من تقانة أو غير ذلك.
لا بد في مقام كهذا، أن نستحضر الآية القرآنية 7 و8 من سورة الكهف والتي يقول فيها الله تعالى: "إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيّهم أحسن عملاً (7) وإنا لجاعلون ما عليها صعيدًا جرزًا (8)". والتي بالنظر إلى الالتذاذ والانتشاء الاستطيقي إنّما تحيل إلى أنّ الإنسان إذا لم يكن قادرًا على الالتذاذ والانتشاء بالأرض، والتي هي من الحياة بما هي كذلك ليكثف نمو النامي من إنسان آخر وغير الإنسان، وقام بدلاً من ذلك بإعاقته أو إفساده كما يسمي القرآن ذلك، فإنّه في الحقيقة إنّما يعيق ويفسد نفسه من حيث هو مقيم في الأرض أو الخام أو الزينة. بذلك، فإنّ القرآن حديث حول الحي وما يشد به عوده ويتأسس وينتشي استطيقيًا في صورة التطهير أو التزكية. وإنّ فعلاً تجاه ما على الأرض كزينة أو تجاه الخام يكثفه ويساهم في نمائه ليجعل من ماهية الفعل الإنساني ماهية الفعل الفني؛ لأنّ مقصد هذا الأخير هو الانتشاء والالتذاذ الاستطيقي. وما دام كذلك، بذلك فإنّ الفعل الفني يجد منبعه الذي لا ينضب ولا يتوقف بغياب أدوات أو بنقص في المهارة. فالإنسان فنان ويصبح كذلك ما دام ينمي.
9.5- المحايثة المضاعفة والإنسان كينونة تقوية تائبة:
يقال على المحايثة المضاعفة ما يقال على الكينونة الإنسانية التقوية والتائبة. وبالنظر للثنائيات كالميتافيزيقي والفيزيقي، فإنّ الأنطو-أكسيولوجيا التي تتضاعف فيها وتكون بمثابة رجوع الشيء إلى نفسه يمكن وصفها بالتوبة. لكن فعل الترك الذي في التوبة والانقطاع عن الشيء الذي يُتاب عنه، تجاه ماذا يكون بالتحديد؟ إنّ المحايثة المضاعفة في علاقتها بالكينونة التقوية التائبة للإنسان تجعلنا نفترض أنّ ما قبل رجوع الهوية إلى نفسها لا بد أن تكون مسبوقة بالاختلاف أو الغيرية. فيكون قبل الهوهو ثم هو ليس هو، أي غيرية داخل الشيء نفسه. لا تصدر عنه ولا تنتج عنه بل تخترقه. وإلا فإنّ تحديد الشيء الذي ترجع منه الهوية إلى نفسها سيبقى لا متعينًا أو عدمًا إن صح التعبير ودق. إنّ المحايثة المضاعفة إذا مسبوقة بالفجوة الإتيقية، حيث الحي المصمّم على إنماء نفسه بطبعه يفقِد تصميمه وعزمه فيها. بذلك، فإنّ هو ليس هو أو الغيرية بالنظر للحي تتجلّى فيه في عدم التناسب مع مطلبه الذي يهتدي إليه بطبعه.
إنّ مفهوم الفجوة الإتيقية التي تستحيل إلى صمدية إتيقية أو العكس الذي هو التماهي مع المطلوب المهتدى الذي يستحيل إلى فقدان للتماهي، يساعدنا على رصد حدثان المحايثة المضاعفة. فحينما يكون الحي في فجوة إتيقية أو "مفجّى إتيقيًا" ينفتح على إمكان صمدية إتيقية. وحينما يكون في صمدية إتيقية متماهيًا مع حياته يكون منفتحًا على إمكانية التفجّي الإتيقي من نفسه ومن غيره في ذات الآن. والأمر هو أنّ حدوث أي منهما يعني أنّ الآخر قد صار محيطًا بالثاني. ومن ثم، فإنّ حدوث المحايثة المضاعفة لا ينقطع إلا بانقطاع الحي عن التماهي عن جهده للبقاء. وهي تحدث بقدر ما يتوب الإنسان من خلال التقوى التي تعتبر العواقب وتغلق في الآن نفسه تفجيه الإتيقي. وليست المحايثة المضاعفة ثباتًا يُبقى عليه ولا صيرورةً ينجرف معها. إنها بالأصح استمساك بحدثان الجلالة والانقهار بالحياة أو الإيمان الحي وإنسانية الإنسان والانتشاء الاستطيقي الملتذ والفعل الإنساني الفني والكينونة الإنسانية تقوية وتائبة في بوتقة واحدة. أو بجملة موجزة، فإنّ المحايثة المضاعفة هي الحياة، وهي تظاهر بحياتها كضرورة من خلال الاستمساك بالذي يتضاعف؛ أي الأنطو-أكسيولوجيا المتمثلة في نمو النامي.
إنّ ما حاول فوكو تجذيره في تاريخ الفكر عبر جماليات الوجود بمباحث حول الفلسفات الهلينستية، والتي تركّز عملها حول الاهتمام بالنفس كما في "تأويل الذات"، والتي استهلها بيير هادو (Pierre Hadot)، وحدا حدوهما جان غرايش في كتابه "العيش بالتفلسف" في شأن الـ"باريسيا/parrhesia" والتي تعني "الكلام الحر" والاجتراء على قول الحقيقة، يكاد يغفل واقعة أساسية. فقد جرى التركيز على الحقيقة التي تُقال للآخرين مختزلين إمكان الباريسيا في الشجاعة. لكن التوبة التي تكون نتيجة لوضع التفجّي الإتيقي هي نتيجة لوضع قد يكون الآخر سببه أو النفس عينها. ومن ثم، فإنّ الحي متماهيًا مع نفسه عبرها إنّما يكون سلفًا قد قام بالباريسيا تجاه نفسه أو تكلّم كلامًا حرًّا معها قبل الآخر. وعليه فإنّ الجرأة على الباريسيا من خلال القول والكلام والأفعال ونمط العيش تكون نتيجة للتصرّم الإتيقي، حيث الحي متماهيًا مع نفسه؛ أي الحي. وبذلك يكون القول دعوى للحياة أو للتصرّم الإتيقي نفسه. بل حتى الموت في سبيل ذلك يكون قضاءً مبرمًا نتيجة لهذا التماهي. تؤدي المحايثة المضاعفة للكينونة الإنسانية التقوية والتائبة إلى الباريسيا أو قول الحق دون خشية لومة لائم؛ لأنّ الإنسان لا يعود داخل هذه الصمدية ناظرًا ومعتبرًا لشيء سوى التماهي مع الحي وتكثف نمو النامي. وهي شأن يخص الحياة واللاهوت الديني قبل الفلسفة. ويمكن هنا أن نتساءل ما إذا كان الضعف التحليلي الفلسفي أو محاولة الفلسفة للبقاء داخل أزمنة الأفول والعدمية قد تنتج لنا شيئًا من قبيل "التفلسف لأجل التفلسف" مثلما حدث مع الفن لتصبح وقتئذٍ عمياء عن الجذور والمصادر، بل وتعمل على ذلك كما حدث مع الفن حينما نصّب نفسه في الصورة القضوية "الشيء لأجل نفسه" فصار إحدى المطلقات التي ينفك عنها الإنسان.
10- العيش بالإيمان الحي بدلاً من العيش بالتفلسف أو تلدين التكبّر الفلسفي:
نُسلّم بدءًا أن الفلسفة أو التفلسف تجربة تُخاض. وتشترك في هذا مع الكثير. فالدين تجربة تُخاض، والحب والكره.. إلخ. ومن الضروري الإشارة إلى أنّ أي تجربة مهما كانت بالنسبة إلى الحي، فهي على وجهين: إمّا أنّها تكثف نماءه فتجعله متماهيًا مع طبعه في صمدية إتيقية، أو أنّها تعيقه فتكون فجوة إتيقية. وبالنظر لذلك فنحن حين نجرّب إنّما نكون في صيرورة تطهير وعلاج. إنّ التجربة حتى تكون تجربة، فهي لا بد أن تطهّر وتعالج بحد ذاتها وإن لم نفترض ذلك ونحن مقدمون عليها. وهذه الضرورة في مفهوم التجربة يمكن اشتقاقها من ضرورة لها طابع الواقعة، أي الحي الذي تعكس لنا طبيعته طبيعة الحياة ومطلبها. ونعني بذلك النماء والبقاء.
يمكن أن نعد تبعًا لما سبق التجربة طبًا للحي بقطع النظر عن الشيء الذي هي تجربته. والأمر سواء إن أضر هذا الطب أو نفع؛ فالضرر يتيب الإنسان توبةً، والنفع بما أنّه تماهٍ مع طبيعته لا يكون إلا تقويًا مصحوبًا باليقظة أو الوعي على الفجوة الإتيقية. لكن علينا تعيين ما يجرّبه الإنسان بصورة أنطولوجية. إنّ الإنسان يجرّب العالم أو الحياة أو الوجود. تتعدّد الأسماء والأثر عليه واحد. أي أنّه يتطَبّب في كل الأحوال: يتطهّر ويعالج نفسه ويتزكّى. إنّ التعليم والتربية ليسا إذن فعلاً مؤسساتيًّا أو أكاديميًّا أو تنظيميًّا بالذات، بل هو ضرب من التأسي بالعالم أو الحياة أو الوجود الذي أُعطيت خلاصته ونهاية أمره. وهذا يمكن أن نصفه باكتمال حدوثٍ في النفس في حدود طبيعتها كحيّة. إنّ معنى ذلك هو أنّ العيش بالتفلسف أو الفلسفة طريقة حياة وفنًا للعيش ليست بالمقولة التي تخدم العيش حقًّا، بل هي اختزال له؛ لأنّ كل ما يطَبّب يصلح لأن يكون فنًا للعيش. من الضروري أن نسأل سؤالين متوالين: ألا يدل لجوء الفلسفة إلى تعريف نفسها أو فنّها في العلاقة مع العيش على انقهارها بالحياة؟ أي إنّه مجرّد تحصيل حاصل؟ وإن كان كذلك، ألا يعني ذلك أنّها كغيرها بالضبط في علاقة قيومية بها؟ الإجابة هي نعم؛ لأنّ الحديث عن العيش حديث عن تدبير الحي، والحي قائم من خلال حياة فُرِضَت عليه، ومن طبعه النزوع للتماهي معها كما ظهر ذلك في تقاطع اللامرئي والمرئي الأنطو-أكسيولوجي. بيد أنّ الأهم من كل ذلك في هذا التعريف الذي اتخذته الفلسفة لنفسها أنّه يمثل القشرة الأخيرة قبل بلوغ المحايثة المضاعفة والجلالية التي هي ليست أكثر من حياة دون توسيط ينتهي به الأمر إلى ابتلاعها والاستئثار بها لنفسه. وهي قادرة بنفسها على العيش فنيًا؛ فالصمدية الإتيقية والتفجّي الإتيقي هما وضعان تفاعليان للحي لا يغادره ما دام حيًّا. فإن تماهى مع طبيعته واهتدى للإنماء كان عليه أن يحاذر العاقبة التي تعيقه وتنقصه؛ أي التفجّي الإتيقي. وإن لم يتماه وسقط في العاقبة وكان متفجّيًا إتيقيًا تحتّمت عليه التوبة من طبيعته للظفر بالصمدية الإتيقية ليكثف نموه النامي بطبعه.
وممّا يكون قد ساهم في مثل هذه التعريفات القشرية هو النظر الحسير في الفضائل اللاهوتية، ونعني على الخصوص الـ"تقوى" التي تسقط كثير من الأفهام أمامها حين تعتبرها محض أمرٍ لإله يفعل ما يريد (وهي كذلك) كيفما اتّفق دون ذكر مصلحة تخص حياة الحي. ولذا، تتجلّى فضائل اللاهوت في صورة الحرمان والعمل ضد الجسد وما شابه ذلك. إنّ ما يتبدى من خلال التقوى أنطولوجيًا من المهم بمكان، فهي تحيل على أنّ الفضيلة قد تثوي في حقيقتها أوليات أي فن للعيش، وأنّ العيش لا يكون دون أن تكون الفضائل مشتقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من التقوى بما هي صمدية إتيقية للإنماء والإعمار والانتهاض والوجود. ما دام العيش بالتفلسف يُقحم الكينونة برمتها كما يقول بيير هادو (40). وإذا كانت السعادة هي حقًا ذلك المطلب الذي تُلحّ الفلسفة عليه كهدف لها، فإنّ التقوى تكاد تعفي الحي من الطريق الذي يتوسّط المفهوم للحياة، أو حتى أقوال الفلاسفة والمفكرين وكتاباتهم. ولا بد لبيان هذا الأمر من محصٍ لمسألة التجربة نفسها.
في اليونانية يطلق على التجربة اللفظ empereia. أما في اللاتينية، فيطلق اللفظ experiri عليها. ومهما تعدّدت الألفاظ المشتقة من اللغتين فقد حافظت في الألمانية والفرنسية والإنجليزية على الشق per والذي يعني العدو أو الخطر أو العاقبة. ومن الضروري أن يكون ثم من معنى آخر يعطي هذا المعنى إمكانه. إذ لا عدو ولا خطر ولا عاقبة ما لم يكن الشيء مهتديًا إلى مطلب. وهنا يتّضح لنا شرط إمكان هذا المعنى الأول وهو التجاوز والعبور (41)*. لكن ما شأن التجربة في العربية وعربية القرآن الكريم واللاهوت؟ قبل أن ننظر في هذا السؤال يتعيّن أن نمهّد لإقامة علاقة ماهوية بين لفظ التجربة في اليونانية واللاتينية ولفظ itinerarium اللاهوتي كما نجد عند القديس بونافنتورا وميستر إيكهارت، والذي يستعمل للإشارة إلى التجربة كرحلة ومسيرة وطريق يُسلك. ولنقل مبدئيًّا أن العدو والخطر والعاقبة هي من الأشياء التي لا تواجه إلا في حالة وُجد مسلك يُسلك أو طريق يُقطع أو مسألة معتزمة نحو مطلب. وهذا يعني أنّ الاهتداء هو منبع التجربة وأصلها. وهذا الاهتداء يؤول إلى فتح حاسم. لذا، فإنّ تسمية التجربة بالهدى اصطلاحًا في اللاهوت هو ليس إضفاء لمعنى مناسب للنصوص المقدسة، بل هو استجابة لأخص دلالات معنى التجربة؛ أي إنّ experiri هي في الأصل هَدْيٌ itinerarium. وإن كان هذا اللفظ حاضرًا في اللاهوت والنصوص المقدسة في ألفاظ مثل الامتحان والفتنة والاختبار probatur، فما ذلك إلا لسببين: الأول: للتشديد على علاقة التجربة والاهتداء بالحقيقة من حيثية إتيقية، وهي حيثية تفاعل الحي المتفجية والمتصمدة إتيقيًا. والسبب الثاني هو ضمن السبب الأول لكنّه أكثر أصالة منه: وهو أنّ الادعاء أو الأقنعة التي تواجه الحي المهتدي بما أنّها قد تصرفه مطروحة به عن مطلبه الذي يهتدي إليه، لا بد من فضحها وإعلانها ليتميز عن المطلوب ولو كان ذلك نفسه. وإذّاك يتّضح أنّه متفجٍ إتيقيًا. وبصورة عامة، فإنّ الإشارة للتجربة بالهدي تتضمن ضرورة الوقاية من الانخداع بما يدّعي أنّه المطلب المطلوب للمهتدي. وعليه فإنّ تسميات العربية والقرآن والكتب المقدسة قاطبة للتجربة بما هي حياة بالاختبار أو الامتحان أو الفتنة أو الابتلاء هي بمثابة تأمين الحي مما قد يهلكه في هيئة ما ينميه. وقد يكون هذا الشيء هو نفسه نفسها فتصبح هذه التسمية كشفًا لما يوجب التطهر منه فيها. أما الفتح الحاسم أو الـdurchbruch الذي يحدث في نهاية الاهتداء، فهو يعني لغويًّا انبثاقًا عبر شيء. وبما أنّ الشق الأول من الكلمة durch يدل على المسار والطريق، وكان الطريق يفترض اهتداءً متقيًا للعواقب بعامة، فإنّ الانبثاقة bruch أو الفتح الحاسم إنّما هو تمام التغلّب على العواقب. وفي ذات الوقت هو حدوث الاهتداء بالتقاء الطالب بمطلوبه. ومن التشبيهات الممكنة لعلاقة الاهتداء بالفتح الحاسم هو أن نتصوّر المهتدي كمقتحم لطبقات يقبع وراءها ما هو هائل وغني وفيّاض. فلا يلبث أن يخترق مجتازًا آخر طبقة حتى ينهَمِر عليه ما حجبته الطبقات عنه. إنّ الطالب والمطلوب يطلب كل واحد منهما الآخر.
إنّ تمام التغلّب على العواقب، والذي هو ذاته حدوث الاهتداء الذي يجلب فتحًا، يكمن فيه أيضًا نزع القناع والادعاء عن الطالب. فلا يتغلّب على كافة العواقب إلا مخلص صادق مع مطلوبه. وهذا ما يتحدث عنه ابن عربي في مقام الـ"فتح في العبارة"، حيث يشمل الصدق جميع كينونة الطالب. يصف ابن عربي الكينونة التي فُتح عليها أو انفتحت عليها قائلاً: ".. يبلغ به الصدق أن يعرف صاحبه وجليسه ما في ظاهره وباطنه من حركة ظاهرة أو باطنة، حيث لا يمكن لصاحب هذا الفتح أن يصوّر كلامًا في نفسه" (42). أما حلاوة الفتح والتي هي أثره على المفتوح عليه، فهي لذّة ذات طبيعة وحدوية؛ فبالرغم من أنّ الفتح مسألة معنوية إلّا أنّ حلاوته ولذّته لها نفس صورة الإحساس بالمحسوس (43). إنّ الميتافيزيقي هنا أو البعيد له طبيعة الفيزيقي القريب، والفيزيقي القريب له طبيعة الميتافيزيقي البعيد. وإذا كنّا بذلك أمام زوج للشيء نفسه، فنحن أمام محايثة مضاعفة؛ لأنّه في الفتح يتقاطع الشيء نفسه على مستويين مختلفين ومتباينين تمام التباين. مثل الأنطو-أكسيولوجيا والجلالة. والإيمان الحي الذي هو تسليم للمنقهر به إثر العجز عن الإحاطة به. ويكون الحي الذي سلّم إنّما يسلّم بالذي هو قائم به، أي الحي القيوم. وقد سمّينا حيًّا ما لا حاجة للنفس فيه إلى برهان أو إثبات. ويمكن لهذا أن يُستنتج من مفهوم التجربة نفسها أو الاهتداء؛ لأنّ الحي ما دام محدّدًا بالشرط الأنطو-أكسيولوجي والمتمثل في نمو النامي، فهو سلفًا محدّد كمهتدٍ لمطلب وهو إنماء النامي وحفظه. وعليه فهو محدّد أيضًا سلفًا بالتجربة ما دامت هي بعينها الاهتداء.
يمكن الآن لحجتنا أن تستقيم. فإذا كانت الكينونة التقوية التائبة للإنسان بما أنّها كينونة مهتدية تستلزم التقوى كفعلٍ يحاذر ما يعطف بها عن المطلب المهتدى إليه، فهي كينونة التجربة نفسها؛ لأنّ التجربة هي الاهتداء عند التحقيق. وبذلك تستلزم التقوى كما يستلزمها الاهتداء، وهي تستلزم أيضًا في صميمها الصدق والإخلاص على جهة الاقتضاء؛ لأنّ الاهتداء أو التجربة اللذان ينتهيان إلى الفتح duchbruch، والذي يمثل تمام التغلّب على العواقب في سير المهتدي، يعتبران علاقة الحي المهتدي أو الحي المجرّب بالحقيقة من حيثية إتيقية، وبالتحديد ما إذا كان متفجّيًا إتيقيًا يقع في العاقبة من حيث قدّر الاهتداء، أو كان ذلك من خلال الانخداع بالقناع باعتباره دالاًّ على عدم تمييزه لمطلوبه الذي يهتدي إليه. إذن، فإنّ وظيفة الصدق والإخلاص هي تصميد أو المهتدي أو اتقائه (أي جعله متقياً) إتيقيًا. يمكن الآن أن يُضاف إلى التقوى كفضيلة تحدّد الكينونة الإنسانية كل من الصدق والإخلاص بوصفها برهنة الحي على وفائه للحي القيوم.
لقد طرح هنري برغسون في مدخل كتابه "التطور المبدع" ملاحظة دقيقة حول مفهوم العقل والتجربة العلمية. فلا العقل بمقولاته ولا التجربة العلمية بجرأتها بقادرين على مضاهاة الحياة. فهي تتوارى وتبتعد وتراوغ كل محاولة لظواهر تقع في نطاقها أو تكون قد أنتجتها هي لتملكها (44). إن التواري والإفلات ليسا صفتين للحياة بذاتها، وإنّما هو إباء القيوم بقيوميته. تشابه هذه الملاحظة ما ذهب إليه كانط من أنّ الفلسفة سبر حدود التناهي. لكن كيف يمكن لهذه الحدود أن تتضح دون انتهاء السعي المتجاوز للتناهي نحو اللامتناهي إلى مآزق وتناقضات لا تحل؟ (45). إذا نظرنا إلى تاريخ الميتافيزيقا الذي يسعى هذا المسعى لاستبان لنا فضله على غيره. فدون هذا المسار المفضي إلى مآزق وتناقضات ما كان لنا أن نتخذ موقفًا تجاه الحي المتناهي. أما بالنظر إلى اللاهوت، فإنّ مفهوم الغيب المستأثر به لدى الله -سبحانه وتعالى- إذا نظرنا له من جهة التناهي الذي تقر به الفلسفات الفيزيقية فستبدو كأنها تصادق عليه. وإذا نظرنا له من جهة الميتافيزيقا، فستبدو كما لو أنّها تتهذّب من خلاله. وفي الوقت نفسه تشهد كل من فلسفات التناهي واللاتناهي عن اللاتناهي الخاص لمفهوم الغيب؛ لأنّه يؤكد نفسه بصورة مضاعفة أيضًا بطريقتين مختلفتين: بطريقة المصادقة والاعتراف، وبطريقة التهذيب والتنبيه والاستدراك لما فُوّت. إنّ فلسفات التناهي تصادق على ما فات فلسفات اللاتناهي فتتوب إلى ما فات وتصادق عليه. وهما حركة واحدة في هذه النقطة. ولا يصادق على ما فات إلا تائب شهد تفجيًا إتيقيًا. ولا يتوب ليصادق على ما فات إلا مصمّد إتيقيًا.
11- خلاصة:
لقد سعينا في هذا البحث إلى تتبع التقاطعات بين الخطاب الميتافيزيقي-اللاهوتي وما بعده، مبرزين الدور المركزي للاستعداد الهيولاني للعقل والجسد كمحور أنطو-أكسيولوجي مشترك. وأظهرنا كيف أنّ العلاقة الاستعارية التبادلية بين المرئي واللامرئي ليست مجرّد أسلوب تعبيري، بل هي كاشفة عن بنية أعمق تتمثل في المحايثة المضاعفة والجلالة. وخلصنا إلى أنّ الإيمان الحي هو الشرط المسبق لإدراك هذه الوحدة، وأنّ الكينونة الإنسانية تتحدد إتيقيًا بين التفجّي والصمدية، أي بين الضلالة والهدى، وبين التوبة والتقوى.
كما ناقشنا كيف أنّ الفن والاستطيقا، رغم ادعاءاتهما بالقطيعة مع الميتافيزيقا، يظلان مرتبطين بها. وقدمنا مفهوم المحايثة المضاعفة كإطار لفهم كيف تصدر الثنائيات من واحد، وكيف يمكن للزوجيات أن تحل محل الثنائيات في رؤية أكثر شمولاً للوجود.
أخيرًا، اقترحنا أن العيش بالإيمان الحي، كاستجابة للجلالة والتسليم لها، يمكن أن يكون بديلاً عن النموذج الفلسفي المحض للعيش، معيدين الاعتبار للتقوى والتوبة كأولويات للكينونة الإنسانية الحية والمهتدية.
الهوامش:
1- أبو نصر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة (المملكة المتّحدة: مؤسسة هنداوي، 2016)، ص73
2- أبو حامد الغزالي، الإحياء في علوم الدين، ج1 (بيروت-لبنان: دار ابن حزم، ط1، 2005)، ص101
3- أبو بكر الرازي، رسائل الفلسفية (بيروت-لبنان: دار الآفاق الجديدة، ط5، 1982)، ص21
4- بول ريكور، الوجود والماهيّة والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو (تونس: المركز الوطني للترجمة، ط1، 2012)، ص16
5- بول ريكور، الاستعارة الحيّة (بيروت-لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، ترجمة: أحمد الولي، ط1، 2016)، ص443 وص445
6- أبو نصر الفارابي، مرجع سابق(2016)، ص71
7- أبو حامد الغزالي، مرجع سابق (2005)، ص101
8- بول ريكور، مرجع سابق (2016)، ص446
9- فردريش نيتشه، هكذا تكلم زرادشت (كولونيا-بغداد: منشورات الجمل، ترجمة: علي مصباح، ط1، 2007)، ص75
10- أبو نصر الفارابي، مرجع سابق (2016)، ص71
11- أبو حامد الغزالي، مرجع سابق (2005)، ص98
12- إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم (بيروت-لبنان: كلمة ومنشورات الجمل، ترجمة: سعيد الغانمي، ط1، 2009)، ص174
13- فردريش شليغل، الفلسفة المتعالية (الشارقة-الإمارات، ميلانو-إيطاليا: منشورات المتوسط، ترجمة: يوسف أشلحي، ط1، 2023)، ص27
14- مارتن هيدجر، مدخل إلى الميتافيزيقا (بيروت-لبنان: دار الفارابي، ترجمة: عماد نبيل، ط1، 2015)، ص364.
15- أرسطو، مابعد الطبيعة، كتاب الميتافيزيقا (الجمهوريّة التونسية: الدار المتوسّطية، ترجمة: أبو يعرب المرزوقي، ط1، 2023)، ص154
16- رينيه ديكارت، التأملات في الفلسفة الأولى (القاهرة-مصر: المركز القومي للترجمة، ترجمة: عثمان أمين، 2009)، ص39
17- جان غرايش، الكوجيتو التأويلي (الرباط-الجمهورية المغربية، بيروت-لبنان): مؤمنون بلاحدود للدراسات والأبحاث، ترجمة: فتحي إنقزّو، ط1، 2020)، ص319
18- جان غرايش، مرجع سابق (2020)، ص320
19- جان غرايش، مرجع سابق (2020)، ص303
20- القدّيس يوحنّا الدمشقي، الدفاع عن الأيقونات (كوسبا-لبنان: الهيئة الإنجيليّة الثقافيّة، 1997)، ص31
21- القدّيس يوحنّا الدمشقي، مرجع سابق(1997)، ص34
22- أفلاطون، المحاورات الكاملة، المجلّد الأوّل (بيروت-لبنان: الأهليّة للنّشر والتوزيع، ترجمة: شوقي داود تمراز، 1994)، ص79
23- ثيودور أدورنو، نظرية إستطيقيّة (بغداد-العراق، بيروت-لبنان: منشورات الجمل، ترجمة: ناجلي العونلي، ط1، 2017)، ص23-26
24- Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte? (München: Deutscher Kunstverlag, 1983); p. 25.
25- فردريش نيتشه، في جنيالوجيا الأخلاق (تونس: المركز الوطني للترجمة، ترجمة: فتحي المسكيني، ط1، 2010)، ص86
26- فردريش نيتشه، مرجع سابق (2010)، ص86
27- آرثر سي. دانتو، بعد نهاية الفن (المنامة-البحرين: هيئة البحرين للثقافة والآثار، ترجمة: د.هادية العرقي، ط1، 2021)، ص220
28- ألكسندر غوتلب باومغارتن، الإستطيقا، فصول تأسيسية (الرياض-السعودية: دار معنى للنشر والتوزيع، ترجمة: كريم الصيّاد، ط1، 2023)، ص6
29- بول ريكور، مقالات ومحاضرات في التأويليّة (تونس: المركز الوطني للترجمة، ترجمة: محمد محجوب، ط1، 2013)، ص116
30- بول ريكور، مرجع سابق، ص116
31- أبو حامد الغزالي، كتاب التوبة إلى الله ومكفرات الذنوب (القاهرة-مصر: مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع)، ص ص21-22
32- سبينوزا، علم الأخلاق (بيروت-لبنان: المنظمة العربيّة للترجمة، ترجمة: جلال الدين سعيد، ط1، 2000)، ص159-166
33- فردريش نيتشه، مرجع سابق، ص ص113-114
34- ميشيل فوكو، تأويل الذات (بيروت-لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر، ترجمة: د. الزواوي بغوره، ط1، 2011)، ص61
35- أبو حامد الغزالي، مرجع سابق، ص17
36- بول ريكور، مرجع سابق، ص51
37- د.فوزية ضيف الله، كلمات نيتشه الأساسيّة ضمنَ القراءة الهيدغريّة (تونس، المغرب، لبنان: منشورات الإختلاف وضفاف ودار كلمة، ط1، 2015)، ص110.
38- جان غرايش، مرجع سابق، ص232-233.
39- فتحي المسكيني، التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل؟ (بيروت-لبنان: دار جداول، ط1، 2011)، ص162
40- جان غرايش، العيش بالتفلسف، التجربة الفلسفيّة، الرياضات الرّوحيّة، وعلاجيّات النّفس (بيروت-لبنان: مؤمنون بلاحدود للنشر والتوزيع، ترجمة: محمد شوقي الزّين، ط1، 2019)، ص40
41*- جان غرايش، مرجع سابق، ص36، وللاستزادة حول معاني التّجربة يُمكن مراجعة الصّفحات من 29-40
42- محيّي الدّين ابن عربي، الفتوحات المكيّة، ج4 (بيروت-لبنان: دار الكتب العلميّة، ط1، 1999)، ص201
43- محيي الدين ابن عربي، مرجع سابق، ص202.
44- هنري برغسون، التطور المبدع (بيروت-لبنان: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، ترجمة: جميل صليبا، 1981)، ص1
45- هنري برغسون، مرجع سابق، ص3
المراجِع:
1- أبو نصر الفارابي، آراء أهل المدينة الفاضلة (المملكة المتّحدة: مؤسسة هنداوي، 2016).
2- أبو حامد الغزالي، الإحياء في علوم الدين، ج1 (بيروت-لبنان: دار ابن حزم، ط1، 2005).
3- أبو بكر الرازي، رسائل الفلسفية (بيروت-لبنان: دار الآفاق الجديدة، ط5، 1982).
4- بول ريكور، الوجود والماهيّة والجوهر لدى أفلاطون وأرسطو (تونس: المركز الوطني للترجمة، ط1، 2012).
5- بول ريكور، الاستعارة الحيّة (بيروت-لبنان: دار الكتاب الجديد المتحدة، ترجمة: أحمد الولي، ط1، 2016).
6- فردريش نيتشه، هكذا تكلم زرادشت (كولونيا-بغداد: منشورات الجمل، ترجمة: علي مصباح، ط1، 2007).
7- إيمانويل كانط، نقد ملكة الحكم (بيروت-لبنان: كلمة ومنشورات الجمل، ترجمة: سعيد الغانمي، ط1، 2009).
8- فردريش شليغل، الفلسفة المتعالية (الشارقة-الإمارات، ميلانو-إيطاليا: منشورات المتوسط، ترجمة: يوسف أشلحي، ط1، 2023).
9- مارتن هيدجر، مدخل إلى الميتافيزيقا (بيروت-لبنان: دار الفارابي، ترجمة: عماد نبيل، ط1، 2015).
10- أرسطو، مابعد الطبيعة، كتاب الميتافيزيقا (الجمهوريّة التونسية: الدار المتوسّطية، ترجمة: أبو يعرب المرزوقي، ط1، 2023).
11- رينيه ديكارت، التأملات في الفلسفة الأولى (القاهرة-مصر: المركز القومي للترجمة، ترجمة: عثمان أمين، 2009).
12- جان غرايش، الكوجيتو التأويلي (الرباط-الجمهورية المغربية، بيروت-لبنان): مؤمنون بلاحدود للدراسات والأبحاث، ترجمة: فتحي إنقزّو، ط1، 2020).
13- القدّيس يوحنّا الدمشقي، الدفاع عن الأيقونات (كوسبا-لبنان: الهيئة الإنجيليّة الثقافيّة، 1997).
14- أفلاطون، المحاورات الكاملة، المجلّد الأوّل (بيروت-لبنان: الأهليّة للنّشر والتوزيع، ترجمة: شوقي داود تمراز، 1994)، ص79.
15- ثيودور أدورنو، نظرية إستطيقيّة (بغداد-العراق، بيروت-لبنان: منشورات الجمل، ترجمة: ناجلي العونلي، ط1، 2017)، ص23-26.
16- Hans Belting, Das Ende der Kunstgeschichte? (München: Deutscher Kunstverlag, 1983.)
17- فردريش نيتشه، في جنيالوجيا الأخلاق (تونس: المركز الوطني للترجمة، ترجمة: فتحي المسكيني، ط1، 2010).
18- آرثر سي. دانتو، بعد نهاية الفن (المنامة-البحرين: هيئة البحرين للثقافة والآثار، ترجمة: د. هادية العرقي، ط1، 2021).
19- ألكسندر غوتلب باومغارتن، الإستطيقا، فصول تأسيسية (الرياض-السعودية: دار معنى للنشر والتوزيع، ترجمة: كريم الصيّاد، ط1، 2023).
20- بول ريكور، مقالات ومحاضرات في التأويليّة (تونس: المركز الوطني للترجمة، ترجمة: محمد محجوب، ط1، 2013).
21- أبو حامد الغزالي، كتاب التوبة إلى الله ومكفرات الذنوب (القاهرة-مصر: مكتبة القرآن للطبع والنشر والتوزيع).
22- سبينوزا، علم الأخلاق (بيروت-لبنان: المنظمة العربيّة للترجمة، ترجمة: جلال الدين سعيد، ط1، 2000).
23- ميشيل فوكو، تأويل الذات (بيروت-لبنان: دار الطليعة للطباعة والنشر، ترجمة: د. الزواوي بغوره، ط1، 2011).
24- د.فوزية ضيف الله، كلمات نيتشه الأساسيّة ضمنَ القراءة الهيدغريّة (تونس، المغرب، لبنان: منشورات الاختلاف وضفاف ودار كلمة، ط1، 2015).
25- فتحي المسكيني، التفكير بعد هيدغر أو كيف الخروج من العصر التأويلي للعقل؟ (بيروت-لبنان: دار جداول، ط1، 2011).
26- جان غرايش، العيش بالتفلسف، التجربة الفلسفيّة، الرياضات الرّوحيّة، وعلاجيّات النّفس (بيروت-لبنان: مؤمنون بلاحدود للنشر والتوزيع، ترجمة: محمد شوقي الزّين، ط1، 2019).
27- محيّي الدّين ابن عربي، الفتوحات المكيّة، ج4 (بيروت-لبنان: دار الكتب العلميّة، ط1، 1999).
28- هنري برغسون، التطور المبدع (بيروت-لبنان: اللجنة اللبنانية لترجمة الروائع، ترجمة: جميل صليبا، 1981).