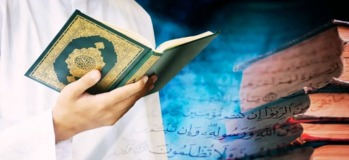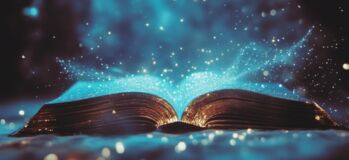ما الأدب ما بعد العلماني؟ نحو مقاربة نقدية جديدة
فئة : مقالات
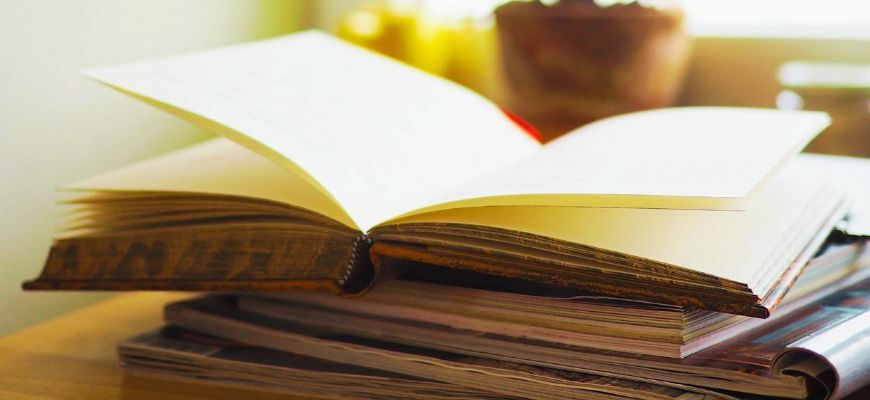
ما الأدب ما بعد العلماني؟ نحو مقاربة نقدية جديدة
كان الأدب، في أصوله الأولى، جزءا لا ينفصل عن التجربة الدينية للجماعات؛ فالنصوص المقدّسة، كالقرآن الكريم والكتاب المقدّس، قدّمت نماذج بلاغية وسردية عليا، وأرست وظيفة تربوية-أخلاقية للحكاية والشعر والخطابة، حيث تُصاغ القيم وتُستعاد الذاكرة الطقسية، وتُوجَّه السلوك ضمن أفقٍ يتجاور فيه الجمالي والروحي. كان المتلقي يعبر عبر القصص والأمثال والتراتيل إلى معاني الخلاص والعدل والرحمة، وتُبنى الهوية الجمعية بوساطة سردياتٍ تُعيد تربية الوجدان جيلاً بعد جيل، حتى بدا أن المبدأ المُنظِّم للخيال هو المقدّس ذاته: النص يتعلّم من الطقس، والبلاغة تُشتقّ من لغة الوحي أو تتجاور معها، والآداب تشتغل، على اختلاف تقاليدها، بوصفها وسيطا تربويا وفضاء روحيا.
ومع القرن الثامن عشر وبزوغ التنوير، تحوّل المشهد جذريًّا: صار الأدب مشروعا دنيويا مستقلا عن المرجعيات اللاهوتية، ومساحة للتخييل الحرّ والتعبير الفردي ونقد المجتمع والسلطة. برز فولتير وروسو وكانط بوصفهم رموزًا لعلمنة الذائقة وتسويغ استقلالية الفن، وشيئا فشيئا استقرّت في القراءة الأكاديمية عادةُ تأويل الثيمات الدينية - حين تحضر - بوصفها استعارات نفسية-اجتماعية أو بُنى أيديولوجية، حفاظا على دنيوية الحقل. على هذا الأساس تشكّلت الرواية الحديثة بوصفها أرشيفا للذات والعقل والأمّة، واشتدّ الشعور العام بأنّ الأدب ´مشروع علماني´ يشتغل على الدولة والطبقة والجندر والعاطفة والحقّ، فيما تُختزل الخبرة الروحية إلى رموزٍ أو تُقصى من قلب التأويل؛ ومع أفكار ´النقد العلماني´ و´المثقف العلماني´ ترسّخت مسافة نقدية من الميتافيزيقا في قراءة النصوص، فتهيّأ لتوسّع هذا المزاج خارج أوروبا.
تشرّبت النهضة العربية هذا الخيال العلماني؛ فتقدّم جيل من الروائيين والمفكّرين بأجندة إصلاحية-عقلانية تُعلي من العلم والحرية، وتُحاصر سلطة المؤسسة الدينية. يمكن تلمّس ذلك في مسارٍ ممتدّ من زينب لمحمد حسين هيكل، حيث تُبنى دراما الفرد الحديث على مساءلة العادات، إلى الأيام لطه حسين بوصفها سيرة تحدٍّ معرفي لا يتوسّل قداسة التقليد، مرورا بـعودة الروح ويوميات نائب في الأرياف لتوفيق الحكيم، حيث يتقدّم نقد الإدارة والتعليم والمجتمع بأدوات دنيوية، وصولا إلى الذروة الجدلية في أولاد حارتنا لنجيب محفوظ التي تُقرأ استعارة كبرى للسلطة والمعرفة خارج ضمانات التفسير الديني، وإلى قنديل أم هاشم ليحيى حقي التي تُعالج التدين الشعبي من زاوية تعارض العلم والخرافة. ومع اختلاف الحساسية بين نص وآخر، تبلور طويلا مزاج يثمّن القيم المدنية، ويُضيّق المساحة الممنوحة للإسلام في المتن أو يوجّه نقدا حادًّا لتمثلاته المؤسسية، حتى غدا الأدب يُحتفى به بصفته علمانيا وقوميا، بينما وُضع الدين في خانة الماضي والجمود.
لكن أواخر القرن العشرين وبدايات الحادي والعشرين، كشفت أن أطروحة ´تلاشي الدين´ مضلّلة؛ فالدين ظلّ فاعلا في المجال العام والخيال السردي، وبلغت اللحظة ذروتها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 عندما انداحت الأسئلة الروحية والأخلاقية في الأدب المعاصر. في علم الاجتماع والفلسفة أعاد يورغن هابرماس صوغ العلاقة بطرح ما بعد العلماني لا بوصفه عودة لاهوتية، بل اعترافا باستمرار الموارد الدينية في الديمقراطيات الحديثة والحاجة إلى تعلّمٍ متبادل وترجمةٍ مشتركة تجعل المفاهيم الإيمانية قابلة للتداول العمومي دون امتياز لاهوتي أو إقصاء دنيوي؛ وعند تشارلز تايلور لم تُنهِ الحداثةُ الإيمان، بل بدّلت ´شروط إمكان الاعتقاد´، فصار الإيمان خيارًا ضمن تعددية البدائل، وتجاورت الروحانية واللّاإيمان داخل التجربة نفسها؛ فيما يبيّن طلال أسد أنّ العلمانية تكوين تاريخي-سياسي يعيد تعريف الدين وحدوده، وينظّم الشعائر والأجساد والخطاب. هذه التعريفات تضع إطارا لمسألة عودتِه: لسنا بإزاء نفيٍ للعلماني ولا تصالحٍ ساذج مع اللاهوت، بل حقلٍ تتفاوض فيه اللغات الدينية والمدنية على المعنى والعدالة والكرامة في المجال العام وفي النصوص أيضا.
ومن هذا الأفق، جاءت الدعوة إلى إعادة النظر في علاقة الأدب بالدين ضمن ما يسمّى اليوم الأدب ما بعد العلماني Postsecular Literature. لا يفهم هذا بوصفه نقيضا للعلماني، بل توسيعا لأفقه: تتلاقى فيه الديانة، والروحانيات غير المؤسسية، والعَلمانية؛ تتباين وتتجاور وتتبدّل حول أسئلة المعنى الإنساني، والتعالي والمحايثة، والألم والفرح، وحقيقة الحياة ولا حقيقتها في عالم القرنين العشرين والحادي والعشرين. إنه ليس مجرّد عودةٍ للمقدّس، بل انفتاح على طيف علاقاتٍ بين الديني والعلماني يتراوح من التعايش والحوار إلى الترجمة والامتزاج، بل وحتى تلاشي الحدود في الخبرة المعاشة، وهذا ما يفسّر لماذا تقبل المتون الحديثة حضور اللغة الروحية بطرائق ملتوية أو هادئة بدل إعلان قطيعة معها. ومن هنا أيضا تنبع فائدة الحديث عن موارد دلالية يستمدّها الخطاب العمومي من التقاليد الدينية- معنى وتضامنا وعدالة - على نحوٍ يُغني النقاش بدل أن يصادره.
وليس الأدب ما بعد العلماني مجرّد اسمٍ لكتلةٍ من النصوص، بل أيضا طريقة قراءة. عمليا تقترح هذه المقاربة خمس حركات متداخلة: (1) الانطلاق من فرضية الاستمرارية لا القطيعة؛ أي إنّ الديني لم يغب عن المتون الحديثة، بل تبدّلت طرائق تمثيله؛ (2) التحرّر من اختزال التجربة الروحية إلى وظائف اجتماعية–نفسية، والبحث عن منطقها الداخلي، وكيف يُعيد تشكيل الرغبات والأخلاق واللغة السردية؛ (3) تتبّع مسارات الترجمة المتبادلة بين مفردات الإيمان واللغة الحقوقية/القانونية داخل النص- النعمة/العدالة، البركة/المواطنة، الضمير/القانون - حيث تُصبح التجربة الدينية قابلة للتداول العمومي؛ (4) توسيع الأرشيف المقارن؛ إذ تُقرأ الموارد الإسلامية واليهودية والهندوسية والأفريقية كطاقاتٍ جمالية ومعرفية لا كفولكلور؛ (5) الانتباه إلى الابتكار/المراجعة الدينية بوصفهما آليتين سرديتين مركزيتين: النصوص تعيد تشكيل موروثها المقدّس لتجعله معقولا وملائما لعصرها، لا بالوعظ، بل بإبداع صيغٍ جديدة للخبرة والإيمان والشكّ. والأهم أنّ ما بعد العلماني يمكن أن يكون مجموعة نصوص ومنظور قراءة في آن، على نحوٍ يُذكّر بالتلازم المعروف في النقد النسوي بين أدبٍ نسوي ومنهجٍ نسوي لقراءة أي نص.
هنا تكتسب الأمثلة المضمّنة قوّتها التفسيرية. في Gilead لماريلين روبنسون تُستعاد مفردات النعمة والبركة والضمير داخل يوميات قسٍّ يتأمل العدالة والذاكرة، فتغدو البركة مبدأ أسلوبيا ينظّم السرد ويصل الأخلاقي بالمدني؛ وفي Life of Pi ليان مارتل يتحوّل التعدّد الديني إلى تقنية سردية لابتكار معنى في مواجهة العدم؛ وبعد 11/9 يتسرّب الطقس والحداد إلى تفاصيل اليومي في Falling Man لدون ديليلو، بينما تُجسّد The Reluctant Fundamentalist لمحسن حامد مفاوضات الشكّ والإيمان داخل خطابٍ عمومي قابلٍ للترجمة تتأرجح فيه الهوية بين ولاءات متقاطعة؛ وفي سياقٍ تركي تفكّك Snow لأورهان باموق ثنائية العلماني/الديني عبر مسرحٍ عامّ تتنازع فيه الحساسية الجسدية والسياسية والطقسية. تُقْرأ روايات ليلى أبوالعلا، وفي مقدّمتها Minaret وThe Translator، بوصفها نصوصا ما بعد علمانية تُعيد مركزية الإسلام في بناء الذات الأخلاقية داخل الرواية الأنجلوفونية العلمانية، في محاولة لخلق توازن بين الالتزام الديني وأفق الحداثة العلمانية، فيما تُظهر Home Fire لكاميلا شمسي توتّر القانون والولاء والواجب الديني داخل مجتمعٍ تعدّدي يحاول ضبط الانتماء والعدالة، وتعيد عزازيل ليوسف زيدان التاريخ اللاهوتي المبكّر إلى سؤال الضمير والهوية، بينما تجسّد Frankenstein in Baghdad لأحمد سعداوي ميتافيزيقا الذنب والعدالة في مدينةٍ مفكّكة بالحرب، وتُثير The Da Vinci Code لدان براون أسئلة السلطة والمعرفة الدينية عبر حبكةٍ شعبية تُفكّك السرديات الكنسية وتُظهر كيف يتفاوض الخطاب الإيماني مع العقلانية الحديثة وثقافة الإعلام، بما يتيح قراءتها مثالا لاشتغال الحساسية ما بعد العلمانية في الثقافة الجماهيرية. هذه النماذج تُظهر أن النصوص لا تستعيد الدين بوصفه بديلا عن العقل الحديث، بل تفكّك الثنائية أصلا عبر أشكالٍ من الامتزاج والترجمة وتبادل الموارد الدلالية بين الخطابين.
وإذا كانت السردية الحداثية قد افترضت قطيعة صافية بين نصٍ ديني ونصٍ علماني، فإن الدرس الأهم اليوم أنّ هذا التصنيف التاريخي يحتاج إعادة نظر: فما بعد العلماني ليس مرحلة زمنية فحسب، بل أيضا طريقة لإعادة قراءة التقليد الأدبي بأسره. إنه جديد لأنه يستجيب لتعدديات القرن الحادي والعشرين، وتجديد لأنه يذكّرنا بأن الأدب ظلّ، في أزمنةٍ كثيرة، ساحة تتجاور فيها لغات الإيمان والشكّ وتُراجع فيها التقاليد الدينية لتستبقي قيمها الخبرية وتؤهّلها لعصرها.
لذلك، يتقدم الأدب ما بعد العلماني بوصفه موردا إيجابيا يبتكر طرائق جديدة في التفكير والرؤية والكينونة والمحبّة، ويقدّم، إلى جانب المعنى، خبرات بالتضامن والعدالة والجماعة والصداقة والاندهاش؛ أي تلك القيم العنيدة التي تُغني الحياة اليومية وتفتح للخيال إمكاناتٍ لا تختزلها الأطر الاجتماعية وحدها.
والأدب، من هذه الزاوية، يخلق حيّزا مشتركا يمكن أن يلتقي فيه المختلفون حول حكايةٍ أو صورةٍ أو إيقاعٍ، حتى لو لم يتفقوا على قضايا لاهوتية أو فلسفية، فيختبرون معنىً مشتركا يتجاوز مجرّد دلالات الألفاظ.
يبدأ تاريخ الأدب في حضن المقدّس، ثم يتنسّب ضمن علمنةٍ واسعة منذ القرن الثامن عشر، وتتلقّفه الحداثة العربية بوصفه مشروعا مدنيًّا ناقدًا للمؤسسة الدينية. لكنّ عودة الدين إلى الفضاء العمومي بعد هجمات الحادي عشر من سمتمبر عام 2001 وما رافقها من تنظيراتٍ فلسفية وسوسيولوجية حول ما بعد العلماني تكشف أن القطيعة كانت وهمًا تأويليا أكثر منها واقعا. اليوم، مع التعريفات التي قدّمها هابرماس وتايلور وطلال أسد وسابا محمود، ومع خبرة النقد الأدبي التي تُصغي للطقس والنعمة والبركة والضمير داخل المتون، يتبدّى الأدب ما بعد العلماني لا كوعظٍ جمالي ولا كإنكارٍ للعقلانية، بل كمنظور يوسّع حقل الرؤية، كي يرى كيف تتفاوض اللغات الدينية والمدنية على المعنى والعدالة والكرامة، وكيف يمدّ الأدبّ المجال العمومي بموارد دلالية وخبراتٍ للعيش المشترك، في عالمٍ تتقاطع فيه خطابات الإيمان والشكّ على نحوٍ لا يلغي أحدهما الآخر.