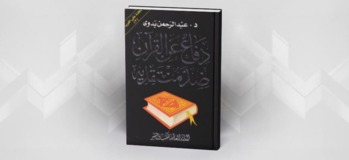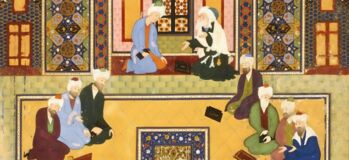مراجعة كتاب أنثروبولوجيا الإسلام، بقلم جينز كريناث
فئة : قراءات في كتب

مراجعة كتاب أنثروبولوجيا الإسلام،
بقلم جينز كريناث
تحرير جابرييل مارانسي، بيرج:
أكسفورد ونيويورك، 2008
كتاب "أنثروبولوجيا الإسلام" هو محاولة أصيلة ومثيرة لتغطية مجموعة واسعة من الموضوعات في مجال بحثي يقع على الحدود بين أنثروبولوجيا الدين ودراسات الإسلام. في هذا الكتاب، يجمع جابرييل مارانسي، الأستاذ المشارك في علم الاجتماع في الجامعة الوطنية في سنغافورة، بين مراجعة نقدية للاتجاهات الرئيسة في الأدبيات الحالية وتأملات نظرية ومنهجية تستند إلى عمله الميداني الأخير. تستمد الأفكار الإثنوغرافية الرئيسة جزئيًّا من تجاربه بين المسلمين في فرنسا وأيرلندا، وتنتج عنها مقترحات متنوعة لمشاريع بحثية مستقبلية. في تحديد النغمة لما يلي، يبدأ الفصل الأول بحوار بين طالب وأنثروبولوجي حول "ما هو الإسلام؟" (ص. 1-3). بعد الإشارة إلى اتجاه ردّه الخاص من خلال تفكيك حجج الطالب بشكل منهجي، يستمر في نفي التوقعات المحتملة الناتجة عن عنوان هذا الكتاب. بينما يناقش بعض المواقف البرنامجية الأساسية لهذا المجال من الدراسة، يجادل بأنه لا يوجد شيء اسمه "أنثروبولوجيا الإسلام".
الفصل الثاني، "الإسلام: المعتقدات، التاريخ، والطقوس" (ص. 13-30)، يعيد النظر في السؤال الافتتاحي "ما هو الإسلام؟". هنا، يستخدم مارانسي سردًا سيريًّا بتذكره لأولى لقاءاته مع الإسلام خلال طفولته في إيطاليا. بعد الإشارة إلى تقديره للطرائق المتنوعة لممارسة الإسلام، يقدم المبادئ الأساسية للإيمان من خلال تقديم روايات شهدها خلال عمله الميداني بين المسلمين في غرب أوروبا. تماشيًا مع منهجه الإثنوغرافي، يعطي مارانسي محاوريه صوتًا من خلال عرض مفاهيمهم الشخصية لتاريخ وطقوس الإسلام من مقاطع مقابلاته معهم. الإزعاج الوحيد الذي يواجهه المرء هو أن مارانسي يعترف بأنه صحح أحيانًا المعلومات المقدمة من محاوريه عند الضرورة، مما يضع مخبريه في موقف غريب. هذا يؤدي إلى السؤال عن سبب عدم إحالته إلى الأعمال الأكاديمية بدلاً من ذلك إذا كان لا يزال يفترض وجود مجموعة صحيحة ومحددة بوضوح من المعرفة عن الإسلام. بعد تقديم حسابه الميداني عن أركانه الأساسية، يتناول الطقوس كعنصر عالمي في الإسلام. في "الاحتفال بالله والحياة: طقوس العبور الإسلامية" (ص. 23-29)، يتطرق إلى الممارسات الطقسية للصيام والصلاة والزواج وفقًا لمبادئه وتقاليده.
في أحد الفصول الموجهة منهجيًّا، "من دراسة الإسلام إلى دراسة المسلمين" (ص. 31-51)، يفتتح مارانسي خط حجته بإعادة النظر في بدايات الأنثروبولوجيا كتخصص أكاديمي في القرن التاسع عشر. هنا يتأمل في كيف كانت المفاهيم المبكرة للإقليمية والاستشراق متأصلة في النهج الأنثروبولوجي. دون الدخول في تفاصيل تاريخية أو سياسية كثيرة، يستمر مع تشكيل دراسة أنثروبولوجية للإسلام والمجتمعات المسلمة منذ منتصف القرن العشرين. طوال الفصل، ينتقد مارانسي الأنثروبولوجيا، لكونها لا تزال مهووسة بشكل مفرط بالغريب و"تأخير" موضوع دراستها دون تقديم أدلة مقنعة أو رؤى إضافية عن كيفية نيته تجاوز المعلومات المعروفة بشكل شائع من الكتب المقدمة للأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية. علاوة على ذلك، يفشل مارانسي في الاقتراب من الاتجاهات التحديية في مجال الأنثروبولوجيا، مثل المناقشات حول الأنثروبولوجيا الانعكاسية، أو أنثروبولوجيا الإعلام، أو تحليل الخطاب النقدي. هذا مجرد إعادة صياغة للحجج التي عبر عنها الجيل السابق من العلماء.
يضيق الفصل الرابع التركيز الموضوعي إلى اهتمامه البحثي الخاص. تماشيًا مع عمله الميداني في أوروبا، يراجع مارانسي الأدبيات حول البحث الأنثروبولوجي والسوسيولوجي بشكل predominant الذي أجراه مسلمون في الغرب قبل وبعد 11 سبتمبر. على غرار الفصول السابقة، يستخدم نفس الحجج في مناقشة تحولات الخطاب الأنثروبولوجي على نطاق أوسع. هنا، كما في الفصل اللاحق، يرى تحولًا نموذجيًا في التركيز من الغرائبية لدراسة القرى والأولياء إلى السوسيولوجيا في دراسة المهاجرين المسلمين في المدن الكبرى. دون إيلاء اهتمام جاد للرؤى المكتسبة من الإثنوغرافيات حول أجزاء أخرى من العالم مثل أمريكا الشمالية وجنوب آسيا وغرب أفريقيا والشرق الأوسط، يتعمق في التفاصيل الخاصة بالبحث الذي أجري على المسلمين في أوروبا الغربية بعد ١١ سبتمبر، مشيرًا إلى أن هذا الحدث كان له تأثير مخيف على مشروعه البحثي في فرنسا.
تظهر اعتباراته المنهجية الرئيسة (المعروفة بالفعل من منشوراته السابقة، مثل "الجهاد خارج الإسلام"، أكسفورد ونيويورك: بيرج، 2006) في الفصل الخامس، بعنوان "من الغريب إلى المألوف: تذكر العمل الميداني بين المسلمين". هنا، يناقش مارانسي انعكاساته الخاصة على العمل الميداني في ضوء أنثروبولوجيين آخرين يعملون في مجتمعات مسلمة بشكل predominant. في انتقاده لقصورهم المنهجي واتهامهم بالتركيز فقط على تجاربهم الشخصية دون فهم الأبعاد الإيمية للحياة المسلمة، يجادل بأن هؤلاء الأنثروبولوجيين انتهى بهم المطاف إلى إجراء عمل ميداني ليس بين المسلمين ولكن "وراء المسلمين" (استعارة مستخدمة كثيرًا في عمله للحفاظ على حيويته البلاغية).
على الرغم من انتقاده للدراسات الأنثروبولوجية السابقة والأكثر حداثة، يتبنى مارانسي رؤية معيارية للملاحظة المشاركة كمفتاح للعمل الميداني الأنثروبولوجي. في تحديد نهجه النظري، يفضل بوضوح عمل أنطونيو داماسيو ("شعور ما يحدث: الجسد، العاطفة وصنع الوعي"، نيويورك: هاركورت، 2000) كمصدر رئيس لاعتباراته (انظر ص. 96-97). من المدهش أن مارانسي لا يشرح بشكل أكثر شمولاً عمل غريغوري بيتسون، الذي كرس له مارانسي كتابه (عن بيتسون انظر ص. 95-96- 98). بينما يتجاهل أدبيات المناقشات الأنثروبولوجية حول العاطفة، والتأطير والتفاعل وكذلك حول الوكالة والهيمنة، فإنه لا يحسب تعقيدات وديناميكيات كون المرء مسلمًا. على الرغم من أنه لا يطور نموذجًا نظريًّا، إلا أنه يحث الأنثروبولوجيين على التركيز بشكل مباشر أكثر على مشاعر مخبريهم كمفتاح لفهم سلوكهم البشري وتفاعلهم. على طول هذه الخطوط، يجادل بأنه يجب على المرء أن يتذكر أنه يجب الحديث عن المسلمين بدلاً من الإسلام، مقترحًا أن الإسلام لا يمكن تصوره إلا كـ"خريطة للخطابات" دون توضيح ما قد تعنيه هذه الخريطة. على الرغم من أنه يقدم هذه النقاط، إلا أن مارانسي لا يشير إلى كيفية نيته تصور مفهوم الخطاب هذا فيما يتعلق بمشاعر الفعل أو كيفية دعم فهمه لخريطة الخطابات بالممارسات الخطابية بين المسلمين.
بعد تعريف "المسلم" كشخص يشعر ببساطة بأنه مسلم (ص. 78، انظر أيضًا ص. 99)، يعود إلى مناقشة العمل الميداني في المجتمعات المسلمة في الغرب وكيف تحدت أحداث 11 سبتمبر العمل الميداني على المسلمين في أوروبا وأمريكا الشمالية (ص. 81-85) من الواضح أن هذه الأفكار تكرر ما تناوله سابقًا في هذا الكتاب. يناقش الفصل السادس، "ما وراء الصورة النمطية: تحديات فهم الهويات المسلمة"، عمل علماء آخرين حول أنثروبولوجيا الذات والهوية (ص. 89-93؛ انظر أيضًا ص. 95-101). في القسم الفرعي حول "ما قد يكون المسلم؟" (ص. 93-95)، يذكر أنه يجب التغلب على الصور النمطية الأحادية للخطاب الغربي (المنتجة بشكل رئيس بواسطة الإعلام [ج.ك.]) من خلال التركيز على التواصل الرمزي للهوية المسلمة كما يتم التعبير عنه في مشاعرهم. على الرغم من أنه يشارك القناعة العامة للعلماء في هذا المجال، إلا أن حلوله تظل غامضة من الناحية المفاهيمية وغير مرضية نظريًّا، حيث لا تتجاوز إلى حد كبير ما اقترحه كليفورد جيرتز وأنثروبولوجيون رمزيون آخرون بالفعل. في "مفارقة الأمة" (ص. 103-115)، يشكك في المفاهيم الغربية للمجتمع المسلم. من خلال معالجة الجوهرية المحتملة التي يراها في قلب مفهوم المجتمع نفسه، يواصل مارانسي نقده. بالاستناد إلى نظريات أقدم للمجتمع كما طورها علماء الاجتماع والفلاسفة الألمان خلال أوائل القرن العشرين، يعرف الأمة كـ"مجتمع من المشاعر" (ص. 101-103) مع التركيز بشكل خاص على تصورات الأفراد المسلمين.
يتساءل الفصل الثامن، "ديناميكيات النوع الاجتماعي في الإسلام"، عن المعادلة النمطية لقضايا النوع الاجتماعي مع النساء في الإسلام، مذكرًا بأن النوع الاجتماعي لا يشير فقط إلى النساء، ولكن يشمل أيضًا العلاقة بين الذكر والأنثى. يجد مارانسي هذا الدمج مضللًا؛ لأنه يلخص المنظور الاستشراقي على الإسلام. أخيرًا، يحدد المناقشات الحديثة حول المثلية الجنسية في الإسلام على أنها "آخر تابو" يهدف إلى تفكيكه (ص. 131-134).
في النهاية، هذا الكتاب هو محاولة شجاعة لتوطين عمله الميداني على المسلمين في أوروبا ضمن المجال الأوسع للبحث الأنثروبولوجي، الذي يحتاج إلى تبرير نظري كبير وتحسين مفاهيمي. في تكراره تقريبًا بنية وخط حجج منشوراته السابقة، لا ينجح مارانسي تمامًا في رسم ملامح دقيقة لأنثروبولوجيا الإسلام كمجال جديد للبحث. هذا يرجع إلى ما يبدو أنه اهتمامه الأساسي: الدفاع عن بحثه الخاص في ضوء المناهج الأنثروبولوجية الأخرى. من المدهش رؤية كيف أن هدف مارانسي لمعاملة مخبريه بانعكاسية، كما في مبادئ الإسلام، يتناقض بشكل حاد مع النغمة المستخدمة في نقده، في بعض الأحيان، المستقطب لأقرانه الأكاديميين العاملين على المجتمعات المسلمة. على حساب الكتاب، يتأرجح بين التفاهات مثل شرح "جوجل سكولار" (ص. 115) أو اختراع صورة نمطية (ص. 94) والنقد المفرط المستند إلى انتقادات معروفة بشكل شائع لكليفورد جيرتز وإرنست جيلنر وتمديد هذه بحدة متزايدة إلى طلابهما، بول رابينو وديفيد شانكلاند. هذا يؤدي إلى إخفاء أجندته العلمية والجمهور المقصود. في عرض البيانات، ينتقل بشكل متكرر بين تشكيل الأنثروبولوجيا كتخصص من خلال التركيز على حسابات الكتب المقدمة لتايلور، دوركهايم، مالينوفسكي ورادكليف براون وتأطير اهتماماته البحثية فيما يتعلق بالمسلمين في الغرب، على حدود سوسيولوجيا وسيكولوجيا الإسلام. ربما بسبب التغطية واسعة النطاق للموضوعات والقضايا، يفشل مارانسي في تطوير خط متوازن ومستدير جيّدًا من الحجة بنفسه. تصبح الحقيقة أنه لم يقم بإعداد إطار مفاهيمي متسق لأنثروبولوجيا الإسلام مع تركيز دقيق على مجال بحثه واضحة بشكل خاص حيث يتناول نفس الموضوعات في سياقات متغيرة، مما يجعل الحجة تبدو دائرية ومتكررة.
بتغطية كمية كبيرة من الأدبيات بسرعة، يواجه مشكلة معالجة الأدبيات بشكل سطحي فقط، مما يؤدي إلى مناقشات متوقعة ونقد يمكن التنبؤ به. كما هو الحال مع مراجعته للبحث الأنثروبولوجي حول المجتمعات المسلمة، يتبع بشكل شبه ثابت نفس المخطط. بدلاً من الانخراط في مناقشات متعمقة للحجج المثيرة للجدل المحددة بمفردها، فإن القراءة المتحيزة تفشل بشكل متكرر في العثور على أسس صلبة لانتقاده. على الرغم من أن هذا قد يعطي بعض الطلاب في بداية حياتهم المهنية قدرًا معينًا من التوجيه، إلا أنه قد لا يكون مناسبًا لفهم أكثر تعمقًا للجوانب المختلفة المتعلقة بهذا المجال، وهو أكثر تعقيدًا بكثير مما يتم تكثيفه في هذا المجلد.
أخيرًا، إلى جانب بعض التناقضات الطفيفة في النمط الببليوغرافي، قد يجعل الإدراج غير الصحيح لبعض أسماء المؤلفين من الصعب على الطلاب تحديد مراجعهم الصحيحة (انظر، على سبيل المثال، م. إ. هيجلاند مثل "هيجلناد، م، إ."؛ س. ح. نصر مثل "ناصر، س. ح."؛ س. فيرتوفيك مثل "فيتروفيك، س."؛ إ. سينكلير-ويب مثل "سينكلير-ويب، إ."؛ س. م. موروف مثل "ماهر.
المصدر: