أصل اللغة ولغة الأصل: المعضلة الأولى في فلسفة اللغة
فئة : مقالات
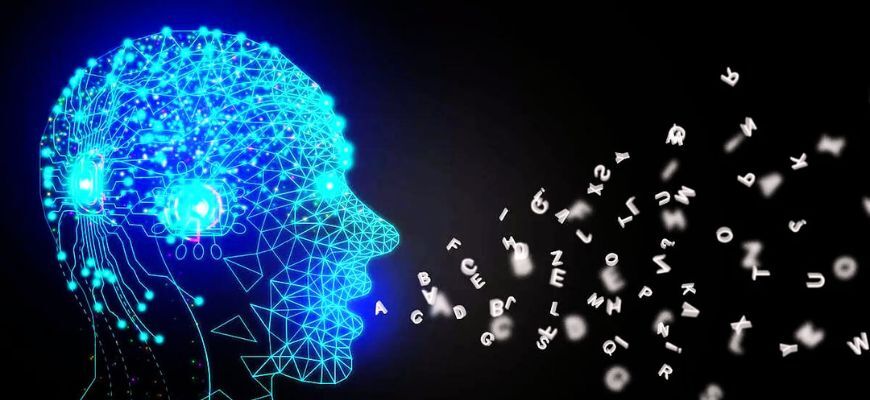
أصل اللغة ولغة الأصل: المعضلة الأولى في فلسفة اللغة
على سبيل التقديم:
يعرف الإنسان عادة على أنه حيوان عاقل، فيكون العقل بمثابة الحد الذي يفصل بين هذا الكائن وغيره من الكائنات الأخرى في هذا الوجود، ولأنه كذلك فقد لفّه الغموض وغلفه التعقيد، وإذا تبث أن هناك حيوانات تشترك مع الإنسان في صفة العقل، فحتما سيتبدد حوله الغموض والتعقيد، وإن نحن أضفنا إلى الإنسان خاصية أخرى نفترض أنه مالكها دون غيره، فلن تكون هذه الخاصية شيئا آخر غير اللغة، فنقول إن الإنسان حيوان ناطق، ولأنه كذلك فإنه يكتسب قدرة على التواصل، وهنا قد يعترض معترض مصرحا أن خاصية النطق يمتلكها الببغاء، وأن التواصل هو ملكة جميع الحيوانات التي تتزاوج؛ إذ لكل حيوان صوت يتواصل به مع بني نوعه، وبه يتم جذب الأنثى من طرف الذكر مثلا، نقول له إن الحد الذي يشمل كلا من العقل واللغة لا يمكن أن يخترقه أي كائن آخر، خصوصا حينما نوافق ونطابق بين الخاصيتين، صحيح أن الحيوان يتواصل، لكنه لا يفكر بما يتواصل به، فضلا على أن الأصوات التي يصدرها إنما تنبع من صميم وجوده الطبيعي، ولا يمكن أن تكون ذات طبيعة عقلية، فيغدو التواصل عنده شكلا من أشكال الوجود، بل شكلا يحفظ الوجود ويمنع الانقراض. أما الإنسان، فإنه يتواصل عن طريق الكلمات والرموز والأصوات والإيماءات لأنه أساسا يفكر، فلا تواصل بلا تفكير، ولا تفكير بلا تواصل، فإذا حدث تواصل بلا تفكير فما هو مضمون الكلام المراد منه التواصل؟ وإذا حصل تفكير بلا تواصل، فما غاية التفكير من الأصل إن لم يكن التداول والتواصل؟
وانطلاقا من هذا الافتراض الأول الذي يسم الإنسان بطابع التواصل عن طريق اللغة، نعرج إلى افتراض آخر لا يبتعد كثيرا عن سابقه، فإذا قلنا إن الإنسان كائن ذو لغة، وأن اللغة هي الخاصية التي تفصله عن باقي الكائنات، نطرح سؤالا: كيف حصل الإنسان على اللغة؟ ولا غرو أن طبيعة هذا السؤال تقودنا إلى افتراض ثان يجعل من اللغة أمرا مكتسبا، ويمكن أن نأخذ معنى المكتسب على مستويين: الأول طبيعي، ويعني أن اللغة انبعثت من العالم الخارجي وحصل تعلمها، وهي مضافة إلى ما هو فطري في الإنسان، وبمجرد أن نسلم بهذا الافتراض، يخامرنا سؤال آخر: أي شيء في العالم الخارجي ينتج اللغة؟ هل هي محاكاة للأصوات الطبيعية أم محاكاة للأشياء ذاتها أي في ماهيتها؟ فلو قلنا بالجواب الأول، فلم تختلف اللغات وتتعدد؟ ولو سلمنا بالجواب الثاني فلم تختلف ألفاظ الشيء الواحد في اللغات؟ والثاني اجتماعي ومرده أن اللغة تمخضت من اتفاق وتشاور الناس فيما بينهم على استعمال ألفاظ لأشياء بعينها، وبموجب هذا الاتفاق يسري التواصل عن طريق التواضع والاتفاق، وهما العنصران اللذان يحددان أي لغة ترتبط بالجماعة، والحقيقة أن هذا المستوى فيه يتوافر نصيب الصواب، إذا نحن أخذنا بعين الاعتبار تعدد اللغات، وقد يكون جوابا قاطعا على مشكلة التنوع اللغوي، لكن، إذا كانت اللغة اتفاقا بين جماعة معينة على استخدام ألفاظ ورموز، وأن قبل الاتفاق لا توجد لغة، فكيف اتفقوا إذن؟ هل يمكن أن يحصل اتفاق من دون لغة اتفاق؟ ولو افترضنا وجود لغة قبل اتفاق الناس عليها، فلا يمكن أن تكون هذه اللغة إنسانية أو بشرية، كما لا يصدق أن تكون نتيجة تشريط اجتماعي، فماذا يمكن أن تكون هذه اللغة إذن؟ هل يعقل أن توجد لغة أسطورية؟ ولعل هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر، وسنتجنب صيغة "الكيف"؛ لأنها تفضي بنا إلى جواب أولي يحدد اللغة كعنصر مكتسب، ونستعيض عنها بسؤال "أين" الذي يلتفت إلى المكان دون الزمان، وهو: من أين جاءت اللغة ؟ فلو افترضنا أنها فطرية، فمن فطرنا بها ومن غرسها في كياننا ومعدننا؟ وهذا الذي أوحى إلينا اللغة لا يمكن أن يكون من جنسنا ولا محايثا لنا، بل مفارقا، لأنه أكثر حكمة وجلالا، والمفارق المتعالي هو الإله، فهل اللغة وحي إلهي؟ وإن كانت كذلك، فلم تفرعت وانشقت وتشظت؟ إننا هنا أمام ثلاثة أجوبة أو أكثر لإشكال أصل اللغة الذي طال حوله الجدال والسجال، وتضاربت بخصوصه التصورات والمواقف، حتى صنف ضمن أعقد الإشكالات الفلسفية التي ليس لها حل، وهذا مرتع الفلسفة بالتحديد. إنها تنتعش بالقضايا العسيرة، وتنتشي بالمشاكل التي تفتقر إلى الحلول، فهمها الوحيد، ليس أن تقدم أجوبة، بل أن تطرح أسئلة، وكل جواب إلا ويتحول إلى سؤال آخر. إنها استشكال لا يكف عن مطارحة نفسه، وحفاظا على روح السؤال الذي تنبض به الفلسفة، واحتراما لخصوصية التفلسف، لن نطمع في جواب يحسم في هذه القضية، وسيكون هدفنا في هذا المقال بالمقابل أن نلمس عمق السؤال، ونتحسس لباب الإشكال، ونستشعر معضلة أصل اللغة التي لا يهتدى لجوابها.
1 - أصل اللغة: المعضلة في الأصل أم في اللغة ؟
ما يجب أن ننتبه إليه ها هنا، هو سؤال الأصل الملتصق باللغة، فقد كان بإمكاننا أن نطرح سؤالا بديلا حول ماهية اللغة ونقف على مجموعة من المواقف التي عرفتها وأبانت طبيعتها، والأكيد في هذه المواقف أنها ستسبر أغوار اللغة، ولن تنسحب منها، على عكس سؤال الأصل، فهو السؤال الذي لا يأبه باللغة في حد ذاتها، بل في علاقتها بالعالم، في صلتها بالوجود، في اشتراطاتها الاجتماعية، لذلك حرصنا على تقسيم المواقف إلى ثلاثة؛ موقف طبيعي، موقف اجتماعي، موقف ديني، ولعل هذا السؤال أشبه ما يكون بالسؤال الكوسمولوجي: من أين أتى الوجود؟ وكيف أتى؟ وهو مرتبط بشكل كبير بما يعتري العالم من تغير وتعدد وتنوع، سمي شتاتا وفوضى، فسعى الفلاسفة حينئذ إلى البحث عن عنصر يشكل الأصل الأول أو المبدأ الأوحد الذي انبثق منه الوجود، ونتج عن ذلك تضارب وتباين على مستوى التصورات، فكان الماء والهواء والتراب، وكان الواحد والعدد والعقل ... كذلك بالنسبة إلى اللغة، فالفلاسفة انطلقوا من اللغات المتعددة والمتشظية، منقبين عن الجذر الأول لجميع هذه اللغات، فكانت المحاكاة الصوتية وكانت المحاكاة الطبيعية وكان الاتفاق، وكان الوحي ... بيد أن السؤال الذي يعترضنا هنا هو: لماذا التفكير في الأصل معضلة؟
نرجع السبب إلى عاملين أساسيين: عامل المكان وعامل الزمان
فلما كان الأصل هو الأساس الذي يقام عليه والبداية التي تتخذ مرجعا في الزمان والمكان، فهو مبدأ الزمان وعلة الوجود، فالزمان بدأ منه، لذلك يستعصي على الإنسان أن يفكر في هذا الذي وجد خارج الزمان، على اعتبار أنه خالق الزمان، ولأنه الإنسان نفسه كائن زماني؛ أي لا يستطيع تصور الأشياء في ماهيتها ووجودها بمحيد عن العلة الزمانية، فإن تفكيره في الأصل الذي يسبق الزمان هو تفكير افتراضي، بمعنى يفترض فيه وجود الزمان بنزع الزمان عنه. أما المكان، فهو علة جميع الأشياء؛ إذ إنه لا يمكن تصور الأشياء دون تصور مكان تشغله، بل إن كل تفكير في العالم الخارجي هو بالضرورة تفكير في المكان، في الطول، في العرض، في العمق، وإذا كان الأمر كذلك، فإن التفكير في الأصل يكاد يكون مستحيلا، إلا إذا كان التفكير فارغا، والفراغ هنا لا يحمل معنى قدحيا، بل يفيد أن التفكير يتجه إلى موضوع يجهل معالمه، والاستحالة هنا تومئ إلى اضمحلال الإمكانات الممكنة لتعقل هذا الذي نفكر فيه؛ إذ بتوسط اللغة يتطفل الغياب على الحضور، واللازمني على الزمني، واللاواقعي على الواقعي، والفوق طبيعة على الطبيعة، على هذه الشاكلة يعلى على الزمان، فلا يعود مجالا للانتظار والتراخي، فاللغة هي انبثاق ما كان الزمان تأجيلا له. إنها أتت إلى الوجود ولم يسبقها شيء آخر يهيئ لها: إنها حاضر لا ماضي لها [1]. وإذن فمقولة الزمان والمكان كما عند كانط لا يمكن التنصل منهما، ولو ألححنا في ذلك، نهوي إليهما مرغمين؛ ذلك أن لكل فكر مقولاته، وإن تنكر لها الإنسان وهجرها، حكم عليه بالازورار عن طريق الصواب، والحقيقة أن المبدأ والأصل في الوجود ينطبق على اللغة كذلك؛ ذلك أن المبدأ هو كل ما يسبق وجود الشيء ويمنحه الوجود، وهنا نميز بينه وبين العنصر الذي يشير إلى ما يؤلف الشيء؛ فالأول مجرد (قد يكون ماديا). أما الثاني، فهو عيني بالضرورة. وإن أسقطنا هذا التمييز على اللغة، نجد أن مبدأها وأصلها هو محط جدال ونقاش بين الفلاسفة. أما عناصر اللغة، فلا يعدو أن يكون علما ينكب على دراسة المكونات التي تنبني عليها، والفلسفة تنتشي بالمبدأ أكثر من العنصر، بل تتوله له عشقا؛ لأن المبدأ بالنسبة إليها هو السبيل إلى فك شيفرة اللغة الموشومة بالطابع الجوهري، وارتباطها بالأصل هو الذي أفضى إلى خلق معضلة قل نظيرها في الفلسفة، معضلة أصل اللغة، حتى إن أشهر اللسانيين أقلع عن تناولها، وهو فردناند دوسوسير، وقال في هذا الأمر: "ولهذا كان السؤالُ عن أصلِ اللغة ليس بتلك القيمة التي تعطى له عامة. إن المسألةَ لا تستحق حتى طرح السؤال"، لكنه رغم ذلك اخترق حمأة المعضلة، وقدم تصوره حولها، وإن بطريقة غير مباشرة، حين قال باعتباطية الدليل اللساني؛ أي إن العلاقة بين الدال والمدلول علاقة اعتباطية[2] L’arbitraire، ودعانا دو سوسير هنا إلى تبني الحذر بخصوص كلمة "اعتباطي"؛ ذلك أن هذه الكلمة لا ينبغي أن توحي لنا إلى أن الدال يتوقف على الاختيار الحر للذات المتكلمة، بل تدل على أن الدال ليس خاضعا لداع أو لسبب؛ أي إنه اعتباطي في هذه العلاقة بالمدلول، الذي لا تجمعه به أي صلة طبيعية في الواقع، وهذا ما سيوقد مشكلة ميتافيزيقية - حسب إميل بينيفست - ترج تلك العلاقة الجامعة بين الفكر والعالم، وهي رجة أصابت المصطلحات اللسانية كذلك[3]. وقد حصل السبق عند أفلاطون في تناول معضلة أصل اللغة، وتلقفها من براثن الأسطورة ليمنحها بعدا فلسفيا، ونقصد بالأسطورة هنا مجمل التصورات الخرافية التي أبدعت حول اللغة، وتعد كشفا عن سر من أسرار الوجود وتفسيرا للغز من ألغازه، إن تقدم في قالب خيالي يفتقر للمنطق العقلي والعلمي أجوبة – وإن كانت ناقصة - عن أهم المشاكل التي يطرحها الوجود الإنساني.
2 - بلبلة الألسن: أسطورة عطلت مفعول المعضلة
من أبرز الأساطير التي يمكن أن نعرضها في هذا السياق أأأاأأأأاأسطورة "بلبلة الألسن" في بابل الواردة في سفر التكوين، والتي جاءت كنتيجة لمحاولة أهل بابل للتصلف على الله، عن طريق بناء برج بابل، فجنوا على أنفسهم أن غضب الله عليهم لتكون عاقبتهم تشتيت الألسن، لكي يمتنع التفاهم بينهم، فنجم عن ذلك التنوع اللغوي بعدما كانت اللغة واحدة. إن ما يمكن أن نستفيده من هذه الأسطورة هو إرجاعها اللغات إلى أصل واحد، ومنها وعبر حادث البلبلة تفرعت وتناثرت إلى لغات متعددة، والمعلوم لدينا أن إرجاع التعدد إلى الوحدة هو طريقة في التفكير ترقد في صميم البحث الفلسفي عن الأصل.
لكن الأسطورة لا يعتد بها، ولا تتبع في التفسير، فهي تظل مغشاة بالخرافة ومغطاة بالنزوع إلى الخيال المنقاد بغريزة الخوف. إن الأسطورة بهذا المعنى نعمة الفكر الراكد والجامد، ونقمة الفكر المتحرك والصائر؛ إذ إنها لا تقدم إجابة شافية تشفي الغليل، وما هي إلا تمهيد لأسئلة أخرى تقتضي أجوبة عنها، إلا أن احتضان النص المقدس لها قد أجهض كل محاولة للتساؤل، وأحبط كل جموح نحو فرضيات أخرى لأصل اللغة، وبناء على ذلك، وتفخيما في المعضلة التي نحن بصدد – ليس حلها – بل تأزيمها أكثر لخنق كل إجابة أو تصور يدعي إمكان الحسم فيها، ننتقل لكي نبحث عن المسألة عند أعظم فلاسفة اليونان أفلاطون، فكيف نظر لأصل اللغة؟
3 - أفلاطون ومحاورة كراتيليوس[4]: مطابقة الكلمات للأشياء
طرح أفلاطون إشكالية أصل اللغة لأول مرة في محاورته الشبابية "كراتيليوس"، والجذير بالذكر هنا، كملاحظة شكلية، فأفلاطون لم يستطع الحسم والبت في هذه الإشكالية، بل ويبدو من خلال المحاورة أنه ارتاب وارتبك ووقع في شراك القلق، فقرر أن ينسحب دون أن يعود إليها مرة أخرى، اللهم في بعض محاوراته اللاحقة، حيث طرقها بطريقة محتشمة وشاحبة، وهذا إن دلنا على شيء، فإنه يدل فعلا على عمق وصعوبة الإشكالية.
تدور أطوار المحاورة بين ثلاث شخصيات: سقراط، كراتيليوس، هيرموجين، هذا الأخير ذهب إلى القول إن الأسماء اصطلاحية واتفاقية، وآية ذلك أن كل اسم نطلقه في الحقيقة هو اسم صحيح، حتى وغن غيرنا الاسم وأطلقنا اسما آخر، فإن الاسم الجديد صائب صواب الاسم القديم، وهذا الموقف سبق أن عرضناه مع دو سوسير، ولكن بمفهوم آخر غير الاتفاق، هو الاعتباط، ومع هيجل كذلك في سياق تمييزه بين الرمز والعلامة، فالرمز عنده ليس اعتباطيا، فالأسد هو رمز الشهامة، في المقابل، العلامة اعتباطية؛ لأن وظيفتها تعويضية، فنحن نستعمل علامة لكي تقوم مقام موضوع معين، ونتفق عليها، وإذن فاللغة نسبية ولا تخضع لأي قانون طبيعي يضبطها؛ إذ بإمكان الناس أن يتواضعوا على كلمة مشيرة إلى شيء دون أن تجمع بين الكلمة والشيء أية علاقة، فلا مشاحة من تسمية "الباب" باسم آخر اعتباطي، ليكون صحيحا، ولا مناص من أن اللغة ستختل وتندحر، وستخترقها العديد من الألفاظ والكلمات التي لا تعبر عن شيء، وكونها كذلك، فهذا يعني أن هناك انفصاما بين الكلمات والأشياء، ومن ثمة هناك اندثار المعنى، وإن حصل ذلك، فمن المؤكد أن علاقة اللغة بالعالم ستتحطم، وتعدو كلماتنا تعبيرا عن شيء موجود في الخارج، وتعبيرا عن لا شيء في جوهرها في نفس الوقت، وهذا هو المشكل الذي أخذه سقراط على هيرموجين، فالرجل الذي يتكلم كما يهوى ويستلذ دون أن يستكين إلى نظام طبيعي في الكلام لا يمكنه البتة أن يكون على صواب، فالمتكلم الناجح هو الذي يتكلم بالطريقة الطبيعية للكلام وبالطريقة التي ينبغي لها أن تكون، وأي شكل آخر من الكلام سيفضي إلى الزلل والفشل. إذن فالأسماء حسب هذا التصور الأولي الذي قدمه سقراط طبيعية، وهو نفس التصور الذي يدافع عنه كراتيليوس.
نعود إلى موقف هيرموجين الذي يقول إن الأسماء اصطلاح واتفاق ومواضعة، وأن علاقتها بالأشياء هي علاقة اعتباطية؛ وذلك بغية طرح مجموعة من الإشكالات بصدد هذا التصور:
أولا: إذا افترضنا حقا أن الأسماء أتت عن طريق الاتفاق، وسلمنا بأن الاتفاق هو عقد حواري بين طرفين يرتضيان على إقرار شيء ما، وأنه لا يمكن أن يتحقق إلا بالتجاذب والتواصل، فكيف يمكن أن يتواضع الطرفين على أسماء قبل أن توجد؟ أو بعبارة أخرى بماذا تواضع الناس على الأسماء دون أن توجد أسماء؟ وهنا يضرب سؤال الأصل مرة أخرى بجذوره ليؤجج الإشكال ويرفعه إلى أقصى مدى، فلو قلنا أن الأصل هو الاتفاق، فماذا كان قبل الأصل ليحصل الاتفاق أصلا؟
ثانيا: إذا افترضنا بأن الأسماء تواضع عليها الناس، فمن يكون هؤلاء الناس؟ هل هم أناس عاديون أم لهم من العلم قصيا؟
لعل أفلاطون في محاورته لم ينتبه للإشكال الأول، ولربما انتبه له وسكت عنه قصد تخفيف حدة الإشكالية على عقله الشبابي، بيد أنه فطن إلى الإشكال الثاني، فعنده ليس هناك مواضعة بل وضع، ولا يعترف بالمتواضعين، بل بالواضع، وهذا الواضع يسميه بالمشرع، فكما أن النجار يصنع المثقاب دون أن ينظر إلى المثقاب المكسور؛ أي يصنعه على ضوء الصورة التي صنع بها، كذلك مشرع الأسماء يعرف كيف يضع الاسم الطبيعي الحقيقي لكل شيء بتوليد مقاطع وأصوات على ضوء الاسم المثالي المستنبط من عالم المثل، ويحيلنا هذا إلى أن اللغة تنتمي لهذا العالم ولا ترتبط بالناس والحواس والواقع، ولأنها كذلك فهي تنبجس من العقل، وكل ما يصدر عن العقل يستحق التقريظ والثناء، وما يخالفه يستحق الذم والهجاء. إنه لا يمكن أن ينجز أعمالا غير عاقلة؛ لأن أعماله من صلب طبيعته، فكل ما ينتج عنه بالضرورة هو شيء معقول ومقبول، فضلا على أن العقل هو القادر على استكناه طبيعة أو ماهية الشيء، فلو أخضعنا اللغة لمقتضى العقل لقلنا إن الأسماء إنما تعبر عن طبيعة أو ماهية الشيء الذي تشير إليه، فيغدو بذلك الاسم محاكاة بمعنيين: محاكاة طبيعية للأصوات، محاكاة لماهية الشيء، وقد يحصل أن يكون الصوت الذي تحاكيه الأسماء وتتماهى معه ينطوي على طبيعة جوهرية ليدخل في المعنى الثاني، ولتجنب اللبس الذي قد يرهصنا في هذا السياق، وجب أولا عقد تمييز بين ماهية الطبيعة، وماهية الماهية.
يقصد بالطبيعة أصل الشيء وجوهره وكنهه، كأن نقول: طبيعة الماء، طبيعة الإنسان (...) وقد يعني كذلك ما هو مغروز في الوجود، ليعبر عن الغريزة والفطرة، إنها بمعنى أرسطو العنصر الأول والمحايث الذي ينبغ منه ما ينمو، وقد تكون طبيعة الشيء من وظيفته، فلا معنى للسيارة إذا لم تكن تسير؛ لأن السير من وظيفتها التي صنعت لها أول مرة، ومن ثمة هي من طبيعتها، وهذا ما أشار إليه كراتيليوس في سياق حديثه عن وظيفة الأسماء، حيث قال: "فائدة الأسماء أن تعلم وترشد ... إن الذي يعرف الأسماء يعرف كذلك الأشياء التي أشارت إليها"، فمعرفة طبيعة الاسم الذي طبيعته هي طبيعة الشيء، تؤدي إلى معرفة الشيء نفسه على ما هو عليه.
وتشير الماهية إلى ما به يكون الشيء هو هو، لدرجة أنه يتعذر تصور هذا الشيء على نحو آخر غير تصورنا عليه. إنها الأصل في الشيء قبل أن يوجد، وإنها لا يطالها التغير ولا يصيبها التلف.
وإذا أسقطنا هذا التمييز على الأسماء، أمككنا أن نتجه إلى أن اللغة - من جهة أولى - في طبيعتها هي محاكاة لأصوات وإشارات بالأيدي والرأس وبقية أجزاء الجسم، فيكون إزاء ذلك الاسم تقليد ومحاكاة صوتية جسدية لذاك الذي سماه أو حاكاه المحاكي بالصوت أو بالجسد، مثلا تومئ طأطأ الرأس إلى القبول، ويوحي الفحيح إلى صوت الثعبان، والخشخشة إلى صوت ذيله، والهسهسة إلى صوت نفسه، وهذه الكلمات إذا دققنا في ألفاظها وحروفها نجدها مطابقة تماما للصوت الحقيقي والواقعي. وهذا التصور يتبناه ماكس مولر، ويسمي هذا النوع من المحاكاة بـ (Bow - wow) لكن، السؤال الذي يتولد هنا هو: لماذا لا تتشابه جميع اللغات في مثل هذه الكلمات؟ فمثلا، يقابل كلمة الهسهسة في اللغة الفرنسية كلمة Sifflé، ونلاحظ أن الكلمة الفرنسية لا تحمل في حروفها أي صوت مطابق للصوت الحقيقي للثعبان. ومن جهة ثانية، فاللغة في ماهيتها هي محاكاة للأشياء في ذاتها، فحينما نستعمل كلمة نطلقها على شيء ما، فلا يمكن أن نستعيض عنها بكلمة أخرى من ابتكارنا الخاص، جرب مثلا أن تسمي الطاولة بابا والباب طاولة، الأكيد أنك لن تتقبل هذا القلب اللغوي، إذن فنحن نسمي الأشياء بأسماء هي نابعة من صميمها، من ماهيتها، من جوهرها، وهو ما يضفي على الأسماء ذاتها طابع الجوهرية، ويعبر موريس غودوليي عن هذه العلاقة بمقولة: "امتلاك اللغة، امتلاك الأشياء"[5]، ويعبر عنها كذلك هيراقليطس حينما قال: "لا تصغ لي، اصغ للكلمة"، وتتلألأ الأسماء كلما ارتبطت بالأصل العقلي، وعلى المشرع أن يمتح من هذا الأصل ويستقي فيه من الأسماء ما يتناغم ويتآلف مع ماهية الأشياء، ليبوئ اللغة أولى درجات السعي إلى العلم، وهكذا عدها الفيلسوف الألماني نيتشه، وهذا هو سبيل جس نبض المعنى في قلب الوجود، فبالرغم من أن أفلاطون لم تنجل لديه الرؤية الفلسفية ليمتن (التمتين) صرحه الإشكالي القائم على العلاقة بين اللغة والمعنى، إلا أن مختلف إشكالياته في محاورة كراتيليوس كانت تثوي خلفها وبشكل ضمني إشكال المعنى، ويمكن أن نبرزه بمثال حي يتعلق بأسماء الأعلام، فقد تجد شخصا اسمه "كريم" وهو في صفاته بخيل.
يرى سقراط أن الأسماء الطبيعية الأصلية قد نسيت وأخفيت منذ زمن بعيد؛ إذ لحقها التحريف والتشويه بسبب إضافة الناس أو حذفهم حروفا من أجل تسهيل النطق، لذلك نجده بالمقابل يدعو إلى مراجعة اللغة وتفكيكها وتنقيحها، لنرى ما إذا كانت العناصر الأولية والثانوية قد أطلقت بصورة صحيحة أم لا؛ ذلك أنها إذا تنافت مع الطريقة الصحيحة، فإن المركب منها سيكون عملا تافها وفي الاتجاه الخاطئ، والمركب هنا هو القضايا التي تتكون من الألفاظ والأسماء، فلو سلمنا بفكرة هيرموجنيس في أن الأسماء تحتمل الصدق والكذب، فإن النتيجة الحتمية هي أن القضايا التي تحتوي هذه الأسماء تكون صادقة بصدق أسمائها، وكاذبة بكذب أسمائها. والواقع أن أي لغة تحتوي على أسماء لا تستجيب لمعيار المطابقة هذا وتخل بشرط المعنى تتحلل وتضمحل، أو إنها تفقد وظيفتها التواصلية أو التداولية، بالرغم من أن السياقات هي التي تحدد المعاني وليس الأسماء.
4 - ابن جني: التحير بين ثلاثة مذاهب
اهتم المعتزلي ابن جني بمعضلة أصل اللغة، وبحث فيها أول ما بحث من باب اللغة العربية، حيث عكف على دراسة أصولها ومميزاتها وتطورها في كتابه(الخصائص)، لتظهر معه اللغة العربية كلغة لا مثيل لها من ناحية جودتها على نقل الكلام وإبانتها للمعاني وإتقانها لفن الذرابة والجزالة، فهي لغة لا تدانيها لغة. وانطلاقا من هذه الروح العام التي وسمت كتابه، يعرف لنا ابن جني اللغة على أنها "أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"، وبالتركيز على كلمة الأغراض، نلمس في تعريفه نزوعا قبليا إلى ما يسمى في فلسفة اللغة المعاصرة بالاتجاه البراغماتي أو التداولي مع أوستين وياكوبسون، وهو الاتجاه الذي ينظر إلى اللغة من جهة منفعتها؛ إذ لا يهم فيها تماثلها واتساقها مع الأشياء التي تشير إليها بقدر ما يهم فيها ما تدر به من نفع على الإنسان الذي يتواصل بها. إن اللغة بهذا المعنى تنطوي على قيمة استعمالية وتعبيرية ونفعية، تخدم التواصل الذي يرمي إلى تحقيق وظائف أو أغراض معينة، وهذا ما يوحي إليه قول جون أوستين "أن تقول يعني أن تفعل"[6].
وقد أسهب ابن جني بالبحث عن مسألة اللغة، وجرد منها ثلاثة مواقف ومذاهب، نعرضها كالآتي:
1 - مذهب الوحي والتوقيف: وهو مذهب يرى أن اللغة وضعت عن طريق الوحي والإلهام، وأن الله قد أوحى إلى آدم أن يضع لها الأسماء فوضعها، وهذا القول يحتمل الكثير من التأويلات، خصوصا لو استحضرنا قول الله تعالى في سورة البقرة الآية 31 - 33: "وعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، قَالُواْ سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَآئِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُمْ بِأَسْمَآئِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ والأَرْضِ وأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ومَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ". واختلف المفسرون حول هذه الآيات، فمنهم من يقول إن الله علم آدم أسماء كل شيء، ومنهم من يقول إنه عز وجل علمه أسماء الدواب، وفي رواية أخرى تعتبر أن الأسماء هي أسماء الملائكة (...) أما ابن جني، فمال إلى القول بتوقيفية اللغة العربية، واعتبرها وحيا إلهيا، والدليل على ذلك بحسبه هو ما تنضح به هذه اللغة من أسلوب رهف وبلاغة عجيبة وكلمة دقيقة ولفظة رقيقة، وما تحبل به من مظاهر الفصاحة والذلاقة والبيان، وإنها اللغة التي تسحر الأذهان وتتغلغل إلى أعماق النفوس وتتسرب إلى أغوار المشاعر، فتذيب العقل في جمالها، وتفتن النفس ببهائها، وهذا ما يوضحه قوله: "إنني إذا تأملت حال هذه اللغة الشريفة الكريمة اللطيفة وجدت فيها من الحكمة والدقة والإرهاف والرقة، ما يملك على جانب الفكر، حتى يكاد يطمح به أمام غلوة السحر، فمن ذلك ما نبه عليه أصحابنا رحمهم الله، ومنه ما حذوته على أمثلتهم، فعرفت بتتابعه وانقياده وبعد مراميه وآماده صحة ما وفقوا لتقديمه منه، ولطف ما أسعدوا به، وفرق لهم عنه، وانضاف إلى ذلك وارد الأخبار المأثورة بأنها من عند الله جل وعز، فقوى في نفسى اعتقاد كونها توفيقاً من الله سبحانه، وأنها وحي"[7]، والجدير بالذكر هنا هو أن ابن جني اجتر هذا المذهب الأول من أستاذه أبا علي الفارسي.
لكن، لو سلمنا أن اللغة تطالها التغيرات وتتعرض للإفساد والتشويه، وافترضنا مع ابن جني أن اللغة صدرت من الله تعالى وانبثقت من حكمته الواسعة، فإننا نقابل النقص بالكمال، فاللغة ناقصة وعاجزة وعقيمة أحيانا على التعبير عن كل شيء، وإن عبرت فإنها في الحقيقة لا تعبر عن شيء، وإن وسمناها بمسكن الوجود، فهي لا تسكنه، وإن سكنته، فهي لا تمسك بكل ما فيه، أما الله خالق الوجود، فهو الكامل الذي لا كامل بعده ولا قبله، وكل ما ينبثق منه هو بالضرورة شيء كامل ككماله، واللغة نبعت منه، إذن فهي كاملة، والحاصل أنها ليست كذلك، إضافة أن افتتان ابن جني باللغة العربية جعله يتعامى على اللغات الأخرى كالفارسية والسريالية وغيرها، والمشكلة هنا هو أنه لو كانت هذه اللغة وحيا إلهيا، فماذا يمكن أن تكون اللغات الأخرى؟ وهذا سؤال فلسفي؛ لأنه ينسحب من اللغة الواحدة نحو جميع اللغات بحثا عن القاسم المشترك بينها جميعا، وإننا نعتبر مذهب التوقيفية مذهبا فارغا من الفكر الفلسفي، بل هو ينحو نحو الانزواء على لغة واحدة، ويتدانى إلى مستوى الفكر الثيولوجي، وفي ذلك تشطيب على الفخفخة والتبجح بلغة معينة، فهذا ابن جني باللغة العربية، وهذا جالينوس باللغة اليونانية، وهذا اليهودي باللغة العبرية (...) وإننا نتفق في ذلك مع ابن حزم[8].
2 - مذهب التواضع والاصطلاح: وهو مذهب يقر أن اللغة صدرت ونبغت عن طريق التواضع والاتفاق بين جماعة معينة، ولا علاقة بين الأسماء والأشياء المسماة؛ أي لا صلة تجمع بين الدال والمدلول، ويقول ابن جني في ذلك: "لنعد فلنقل في الاعتدال لمن قال بأن اللغة لا تكون وحيا، وذلك أنهم ذهبوا إلى أن أصل اللغة لا بد فيه من المواضعة، قالوا: وذلك كأن يجتمع حكيمان أو ثلاثة فصاعدا، فيحتاجوا إلى الإنابة عن الأشياء المعلومات، فيضعوا لكل واحد منها سمة ولفظا، إذا ذكر عرف به ما مسماه، ليمتاز من غيره، وليغنى بذكره عن إحضاره إلى مرآة العين"[9]. ونجد هذا المذهب عند الفارابي كذلك، والذي اعتبر أن اللغة تعبير عن حاجة ملحة في إخراج ما يختلج النفس من مشاعر وأحاسيس ونقلها إلى الآخر وإفهامه بها، إن اللغة عنده اختراع؛ إذ يقول: "كلما حدث في ضمير إنسان منهم شيء احتاج أن يفهمه غيره ممن يجاوره، اخترع تصويتا، فدل صاحبه عليه، وسمعه منه، فيحفظ كل واحد منهما ذلك، وجعلاه تصويتا على الشيء"[10]، ويضيف: "فهكذا تحدث أولا حروف تلك الأمة وألفاظها الكائنة في تلك الحروف، ويكون ذلك أولا ممن اتفق منهم، فيتفق أن يستعمل الواحد منهم تصويتا أو لفظة في الدلالة على شيء ما يخاطب غيره، فيحفظ السامع ذلك ويحتذي بذلك، فيقع به، فيكونان قد اصطلحا وتواطآ على تلك اللفظة، فيخاطبان بها غيرهما، إلى أن تشيع عند الجماعة"[11]. ونفس الانتقادات والإشكالات التي أثرناها سابقا مع موقف هيرموجين تسري كذلك على هذا المذهب، وعلى موقف الفارابي.
3 - مذهب المحاكاة: تستمد اللغة جذورها من محاكاة الإنسان لأصوات الطبيعة المحيطة به، وأقدم الأقوال حول هذه النظرية ترجع إلى الفراهيدي وسيبويه، وفيها يقول ابن جني: "وذهب بعضهم إلى أن أصل اللغات كلها إنما هو من الأصوات المسموعات، كدوي الرياح، وحنين الرعد، وخرير الماء، وشحيح الحمار، ونعيق الغراب وصهيل الفرس ونزيب الظبي ... وهذا عندي وجه صالح ومذهب متقبل".
إن هذه المذاهب الثلاثة تتضارب فيما بينها، وتكاد كل واحدة منها تكون إجابة مقنعة عن أصل اللغة؛ إذ إنها تقترب من الصواب بما تتحجج به من براهين. والحق أننا حرنا كذلك حيرة ابن جني، وبالكاد استقررنا مثله على مذهب واحد، بل نجد أنفسنا نتذبذب ونتراوح ونتأرجح بين هذا وذاك، وفي الأخير نجيب على جميع الإشكالات في أصل اللغة، والحقيقة أننا لم نجب على شيء، فالمشكلة لا تكمن في عدم وجود أجوبة، بل في وجودها، والمعضلة لا تتمثل في عدم توافر حلول، بل في توافرها. وإننا لا نسعى هنا إلى تبديد الغيوم حول المعضلة لكي تنقشع وتتبدى، وإنما في تكثيفها وتبليدها. إن الأسئلة ما تفتأ تتناسل، وطبيعة الحال تقتضي ذلك، فكلما وصلنا إلى جواب نرتاح له حتى تباغتنا أسئلة أخرى تربض على صدر الجواب، الشيء الذي يدفعنا إلى تأزيم معضلة اللغة أكثر، وتركها مجهولة غير معلومة، لنجعلها ذلك المجهول بتعبير جوليا كريستيفا أو أخطر النعم بتعبير مارتن هايدجر[12]. وهذا ما فعله ابن جني بالضبط حين بلغ من التحير والقلق والارتباط مرتبة، فوقف حسيرا بين القول بالتوقيف أو بالتواضع أو بالمحاكاة، فقال: "واعلم فيما بعد، أنني على تقادم الوقت، دائم التنقير والبحث عن هذا الموضع، فأجد الدواعي والخوالج قوية التجاذب لي، مختلفة جهة التوغل إلى فكري، ... فأقف بين تلك الخليتين حسيرا، وأكثرهما فأنكفئ مكثورا"[13].
المصادر المعتمدة
*- المصادر العربية
1. أفلاطون، محاورة كراتيليوس، ترجمة وتقديم الدكتور عزمي طه السيد أحمد، وزارة الثقافة، الأردن، ط 1، 1995
2. ابن جني، الخصائص، ج 1، دار الكتاب العربي بيروت
3. الفارابي: كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، 1970
4. مارتن هايدجر، هولدرين وماهية الشعر. ترجمة فؤاد كامل ومحمود رجب، مراجعة عبد الرحمن بدوي، القاهرة، 1974
5. ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، ج1
*- المصادر الأجنبية
1. Grimaldi Nicolas, Le désir et le temps, Paris, Presses universitaires de France. 1971
2. De Saussure Ferdinand, Cours de linguistique générale, Grande Bibliothèque Payot
3. Benveniste Émile, Problèmes de linguistique générale, Paris: Gallimard, 1976
4. Godelier Maurice, Pouvoir et langage, Revue de communication 28. 1998
5. Austin John, Quand dire c’est faire, trad. Gilles Lane, Paris, Seuil, 1970
[1] Nicolas Grimaldi, Le désir et le temps, Paris, Presses universitaires de France (1971), p 426
[2] Ferdinand de Saussure, Cours de linguistique générale, Grande Bibliothèque Payot, P 100
[3] Émile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, Paris: Gallimard, 1976, P 52
[4] أفلاطون، محاورة كراتيليوس، ترجمة وتقديم الدكتور عزمي طه السيد أحمد، وزارة الثقافة، الأردن، ط 1، 1995
[5] Maurice Godelier, Pouvoir et langage, Revue de communication, 28. 1978
[6] John Austin, Quand dire c’est faire, trad. Gilles Lane, Paris, Seuil, 1970, p.13
[7] ابن جني، الخصائص، ج 1، دار الكتاب العربي بيروت، ص 40
[8] ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، مطبعة الإمام، ج1، ص 32
[9] المرجع نفسه، ص 44
[10] الفارابي: كتاب الحروف، تحقيق محسن مهدي، دار المشرق، بيروت، 1970، ص138
[11] المرجع نفسه، ص 137
[12] مارتن هايدجر، هولدرين وماهية الشعر. ترجمة فؤاد كامل ومحمود رجب، مراجعة عبد الرحمن بدوي، القاهرة، 1974، ص 144
[13] المرجع نفسه، ص 41






