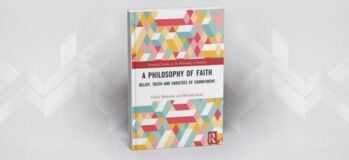الحقيقة: متاهات القول
فئة : مقالات
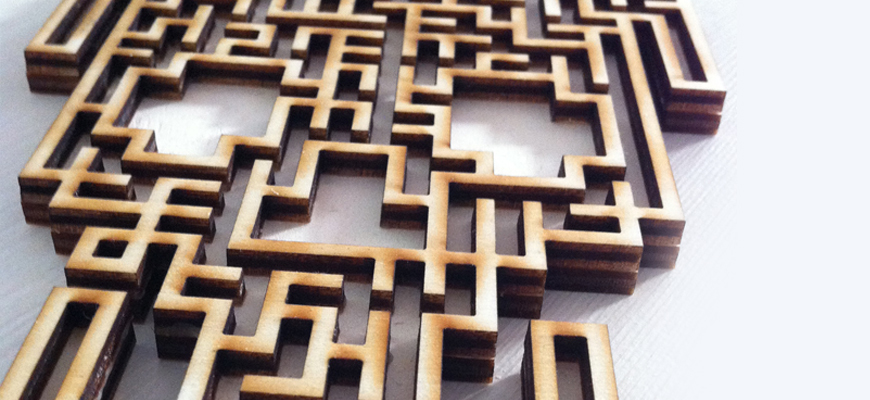
الحقيقة: متاهات القول*
ربّما لم يعرف مفهوم آخر من أشكال الجدل والصراع ما عرفه مفهوم الحقيقة، وإذا كان بريق هذه الكلمة يعود في جزء منه إلى هذا النزوع الفطري لامتلاك المعنى وإرواء الفضول الذهني والشغف الوجودي، فإنه يعود في جانب آخر إلى ما يقترن بمعنى الحقيقة من صراع حول المنافع والمصالح، وما يفضي إليه من امتلاك السلطة والتحكم في عقول وأجساد الناس.
وعلى الرغم مما يقال عن تقسيم مراحل التفكير الفلسفي إلى أطوار يتغير فيها مفهوم الحقيقة تبعاً لعوامل فكرية واجتماعية، فإنّ المتأمل يلاحظ أنّ دلالة المفهوم كانت دوماً تتراوح بين حدين أقصيين وبينهما درجات، فهناك دوماً رأي يجعل الحقيقة نهاية للمعنى وحصراً للتفكير في خلاصة وحيدة وثابتة، مستنداً إلى موضوعية المعرفة واستقلاليتها عن الذات ممّا يضمن الاتفاق والإجماع، ويكون المختلف إذ ذاك جاحداً ومنكراً. ورأي يذهب إلى أنّ الحقيقة معنى ذاتي متغير ومتعدّد بالنظر إلى اختلاف الذوات وزاوية النظر وظروف تكوّن المعرفة، ومن ثمّ يصبح الخلاف أصل الوجود وطبيعته. وإذا كان من اليسير القبول باختلاف التقدير في القضايا النظرية المحضة، فإنه من الصعب التسامح في الحقائق التي لها أثر على معاش الناس ومصالحهم، فإذ ذاك تصبح الحقيقة المضادة سلطة مهددة، والاختلاف مدخلاً لعدم الاستقرار، وربما يمكن القول إنّ تتبع تاريخ المفهوم ليس سوى عرض لتحوّل التاريخ الاجتماعي في أوجهه الفكريّة والسياسيّة.
لحظة تجريد الحقيقة عند الأوائل
لعل أهم الحقائق التي صنعتها سلطة تدوين تاريخ الفلسفة نفسها هي البدء مع اليونان، رغم وجود إشارات تدلّ على أنّ تجريد المفاهيم كانت له جذور في التجارب الفكرية للحضارات الأخرى، ولكنّ النصوص المدوّنة تفرض هذا التقليد الذي تحوّل إلى حقيقة.
تبدو بنية مجتمع المدينة اليونانية متماسكة وصلبة في تراتبها الطبقي وسلطتها المركزية بشكل لم يكن يسمح كثيراً بظهور خلاف حول الحقائق الأساسية التي يمكن أن تكون موضوع صراع بين مذاهب أو قوى اجتماعية، ولذلك كانت التجربة الأولى لسقراط المعلم، عندما حاول خلخلة المعتقدات السائدة أن اتُهم بكون أفكاره تفسد عقول الشباب، فكان من الواجب نفيه أو إعدامه. أمّا تلاميذه، فقد استفادوا من الدرس فانصرفوا إلى النقاش المجرّد الذي لا يمسّ التوازن القائم بشكل مباشر، فظهرت الفكرتان الأساسيتان حول الحقيقة: فكرة أفلاطون الذي يرى بالوجود المزدوج: المادي والمثالي، ويرجّح وجود موطن الحقيقة الأصلية في عالم المُثل. وفكرة أرسطو الذي يعتقد بالوجود المحايث للحقيقة الصوريّة في تجسّدها المادي؛ أي أنه ينفي إمكانيّة الفصل الفعلي بين الفكرة وتجليها الواقعي، وإن كان ممكناً من الناحية العقلية تجريد الصورة ذهنياً، ونتيجة لهذا ذهب إلى إمكانية تحوّل الحقائق في وجودها من القوة إلى الفعل، واستبدل مفهوم العدم بالإمكان. ومن التقاليد الفكرية التي دشنها اليونان القول بازدواج الحقائق العلمية والعملية، وفتح المجال للتفكير في مبحث القيم إلى جانب مبحث المعرفة.
لم يكن عصر التأسيس النظري للمفاهيم المجرّدة حول الحقيقة، ليسلم ممّن يشكّك في صفات الإطلاقية والثبات والموضوعية التي أضفيت إلى المفهوم، إذ ظهرت فئة من المجادلين سُمّوا بالسفسطائيين كان همهم الأساسي إعادة تنسيب الحقيقة بإرجاعها إلى الذاتيّة المحضة (الإنسان مقياس كلّ شيء)، وتفنّنوا في النقاش والمناظرة لتبيان إمكانية الاستدلال على الشيء ونقيضه باستعمال أدوات المنطق نفسها. وهذا يبيّن أنّ الصراع بين المذهبين الرئيسين كان قد نشأ مع محاولة التأسيس لها، وليس وليد اليوم.
ازدواجية الحقيقة في الفكر الإسلامي اليوم
قبل أن تتسرّب الأفكار اليونانية إلى الثقافة الإسلاميّة، بدأ النقاش حول الحقيقة لدى المسلمين من واقع الصراع بين قوة الدفع الأخلاقي المثالي الذي دشنته الرسالة، وبين قوة الجذب المنفعي الذي تمثله بُنية المصالح الاجتماعية والقوى المتنافسة حول الثروة والسلطة في المجتمع الجديد، فكان أن بدأ الخلاف سياسياً وعسكرياً، ثم انتهى كلامياً ومذهبياً في ثنائيّات الجبر والاختيار والعقل والنقل. وتتجلى الصياغة الكلامية لهذه الازدواجية في قول المعتزلة بإمكان التحسين والتقبيح العقليين للأفعال، ومن ثمّ جعلوا العقل مناط تأسيس القيم المعروفة والأخلاقية، وإن كان بعضهم مثل العلاف قد ميّز بين العلم الاضطراري (بالوحي) والاختياري (بالحواس)، ولكنهم انتهوا إلى أنّ مصدر فهم وتصديق الوحي نفسه هو العقل؛ أي الملكة التي تحوّل المحسوس إلى معقول وتصوغ الكليّات التي هي منشأ العلم.
في مقابل هذا القول، كانت المدارس التقليدية تحذّر من الزيغ بسبب اتباع العقل المعرّض للوهم والهوى وضرورة التمسّك بنصوص الوحي كما فهمها السابقون، ولعلّ هذا التحذير المستمر من ضلال العقل ليس في الواقع إلا حرصاً على الخضوع للسلطة القائمة بوجهيها الديني والسياسي. وإذا كان الجدل الكلامي في صورته الأولى امتداداً للصراع الاجتماعي والسياسي، فإنّ النقاش حول الحقيقة في الفكر الإسلامي قد انفصل تدريجياً عن الواقع بعد استقرار السلطة السياسية المشرعنة باستواء المذاهب الفقهية وترسيخها. ولهذا اتخذ التفكير منحى آخر ظهر مع التنظير اللغوي حول الحقيقة والمجاز، وأثر ذلك في الصياغة الفقهية وعلوم القرآن والتفسير، وكان الرأي الغالب للخط الأشعري الذي صاغه الجرجاني في مقولة الإسناد والمجاز اللغوي والعقلي، والذي يُعدّ مجرّد تطوير لفكرة الكسب في الأفعال الإنسانية، وفكرة تأويل آيات الصفات. أمّا التجربة الصوفية فقد صاغت ثنائية أخرى تتمثل في توازي الحقيقة الوجدانية مع الحقيقة الشرعية في المستوى اللغوي (الإشارة والعبارة) والسلوكي (الحقيقة والشريعة).
وكان الفلاسفة المسلمون أكثر انفصالاً من غيرهم عن الواقع الاجتماعي في تناول مفهوم الحقيقة، إذ لم يزيدوا على مذهب أرسطو وأفلوطين ومقولات الرواقيين في العقل والنفس سوى محاولة للتوفيق مع المرجعية السائدة تجسّدت في ثنائية أخرى عبّر عنها الفارابي في تعاضد الأدلة بين الحكمة والملة الفاضلة، وصاغها ابن رشد في ازدواج طريقي الحكمة والشريعة، وإن كان بعضهم قد ذهب إلى مستوى النقل المباشر للموروث الأفلاطوني الذي لم يجد له صدى في السياق الثقافي والاجتماعي الإسلامي.
ولم يصمد من هذا الموروث اليوناني سوى المنطق الذي اعتبره الفقهاء والأصوليون من مقتضيات التفكير السليم والمعرفة الموضوعية التي لا علاقة لها بالأصول اليونانية لكونها من لوازم الفطرة والعقل، ولم يجدوا بأساً في دمج الآلة المنطقية في العلوم الدينية. إلا أنّ هجوم ابن الصلاح على المنطق وتكفير المشتغلين به، وجهود ابن تيمية في نقد المنطق والقضايا الكليّة بنزعته الاسمية الرافضة لمقولات العقل لدى اليونان، حطّمت ما تبقّى من إمكان انفتاح العقل المسلم على آفاق جديدة في التفكير، وزاد الركود الاجتماعي والسياسي من صعوبة ذلك واستحالته.
العقل الحديث وإغراءات الحقيقة
دشّن العقل الحديث صراعاً مريراً مع البيئة الاجتماعية والسياسية والثقافية المتبقية من العصر الوسيط وحقائقها الراسخة، واقترن هذا الصراع بأحلام التحرّر من سلطة اللاهوت واستبداد السلطة السياسية وطغيان الطبقات الاجتماعية، معلياً من شأن الفرد العاقل الحر القادر على فهم العالم والسيطرة عليه.
ويُعدّ التصور الحديث للحقيقة امتداداً بشكل من الأشكال للصياغة اليونانية التي تقوم على مبدأ الهوية والتطابق؛ أي أنّ الشيء ذاته هو المتصور عقلاً فيكون الفكر مطابقاً للواقع ومعبّراً عنه في ملفوظ لغوي مطابق، وهذا ما كان وارداً بصيغته عند الفلاسفة المسلمين: "مطابقة ما في العيان لما في الأذهان وما في اللسان".
وعلى الرغم من أنّ الاتجاهات الفلسفية الحديثة اختلفت في تحديد معيار الحقيقة، وتنوّعت ما بين مذهب عقلاني يرى الحقيقة في مطابقة العقل لذاته، أو مذهب تجريبي يراها في مطابقة الفكر للواقع الحسّي، فإنّ مبدأ المطابقة نفسه كان مشتركاً بين كل الاتجاهات. وحتى النقد الذي وجّهه هيجل بإرجاع الحقيقة إلى الماهيّة في تحقيقها واكتمالها عن طريق النمو الجدلي وقبول فكرة التناقض والسيرورة بديلاً للحقيقة الثابتة، فإنه لم يبتعد كثيراً عن المناخ الفكري لعصره، وقبل بالتطابق في إطار الهويّة المتحركة والجدليّة. أمّا النقد الكانطي، فإنه حافظ على مصدريْ المعرفة التقليديين(العقل والتجربة)، وحاول الجمع بينهما عن طريق القول بتوافق القواعد الذهنية مع الأشياء المحسوسة، ولكنّه فتح ثغرة في جدار الحقيقة عندما صرّح بالتفريق بين الحقيقة في ذاتها (النومين) والحقيقة الظاهرية (الفينومين)، وإمكانية الوصول إلى الثانية وتعذر الإمساك بالأولى بشكل نهائي، ومن ثمّ بدأت أولى بوادر خلخلة التصوّر الذي ساد لعصور كثيرة حول مفهوم الحقيقة المقترنة باليقين النهائي القاطع.
ويستند تصوّر العصر الحديث عموماً إلى طغيان فلسفة الوعي بالذات التي تُعلي من شأن الإنسان المفكر والحاكم على الطبيعة، إضافة إلى سيادة النزعة العلمية التي رأت في الكشوف الجديدة ملاذاً للعقل وبديلاً عن الدين والأسطورة والخيال، وأصبح المجهول زاوية النظرة هذه مجرد وضع مؤقت سوف ينتهي بتقدّم العلم واتساع مجاله وتطوّر وسائله.
لهذا كان من الضروري تحطيم هذه الأسس لينهار التصوّر التقليدي برمّته، ويبدأ عصر جديد تصبح فيه الحقيقة أكثر انفلاتاً وتمنعاً عن الإمساك، بل إنّ الحقيقة الثابتة الوحيدة أصبحت هي اللاحقيقة.
الفكر المعاصر وتصدّع معمار الحقيقة
نشأ الفكر المعاصر وتميّز بتأثير عدة روافد: أولها فلسفي اشتغل بإعادة تعريف الإنسان، وحطّم التصور الكلاسيكي حول الذات العاقلة الحرة، ممثلاً في كلّ النزعات البنيوية والتفكيكية والعدمية التي ألغت آخر الحصون حول مفهوم "الذات"، ودشنت فترة ما سُمّي بموت الإنسان. وقد كانت الإرهاصات الأولى لهذا النمط من التفكير قد بدأت مع نيتشه الذي ناضل خلال مساره الفلسفي كلّه للتشكيك في مقولات التراث الفلسفي للأنوار مفككاً لمفاهيم الحقيقة والوعي والأخلاق والإرادة، ليخلص إلى أنّ الدافع الأساسي للمعرفة هو إرادة القوة والرغبة الغريزيّة في البقاء، مطلقاً العنان لكوامن النزعة البيولوجية على حساب ميتافيزيقا المعرفة والأخلاق. فكان من لوازم هذا التفكير أن جعل الحقيقة في مرتبة "الوهم" الذي اكتسب مصداقيته ويقينه بسبب نفعه للإنسان في معركة البقاء وحفظ الحياة، وقد امتدّت الخطابات الفلسفية فيما بعد تكرّر خطاب نيتشه بأوجه وأشكال مختلفة.
والرافد الثاني مرتبط بظهور العلوم الإنسانية التي حوّلت الذات العارفة للمرّة الأولى إلى موضوع للمعرفة، وساعدت الخطاب الفلسفي السابق في عملية تفكيك الذات هاته، بتفسير الوعي والمعرفة الإنسانيين وإرجاعهما إلى العوامل النفسية والاجتماعية والتاريخية، ومن ثمّ أصبح الإنسان مجرد حصيلة ونتاج للعوامل المختلفة، كما أصبحت المعرفة التي ينتجها حول نفسه وحول الواقع رهينة بتأثير العوامل المذكورة، فصارت كلّ الحقائق المتصوّرة مجرّد وجهات نظر ذاتيّة أو تاريخية قابلة للتغيّر والتعدّد.
أمّا الرافد الثالث، فقد مسّ أهمّ صروح المعرفة الحديثة وهو العلم، فقد انتقلت فلسفة العلوم من التصوّر التقليدي القائم على ثبات العلم ويقينيته ووحدته إلى عالم من نسبيّة الحقائق ومرونتها وقابليتها للخطأ. وكان العنوان الأهم في هذا التحوّل هو مسار الفيزياء المعاصرة التي غيّرت مفاهيم الواقع والأشياء والحس والتجربة التي كانت أساس العلم الحديث إلى مجرد تصوّرات تقريبية مصاغة في قواعد رياضية، كما أضحت معرفتنا عن الكون نتاجاً لوضعية الملاحظة التي نوجد فيها ممّا سمح بتغييرها كلما توفرت ظروف مغايرة للملاحظ والشروط التقنية للتجريب.
فكان المناخ الفكري العام للقرن العشرين إذاً موسوماً بطابع النسبية وهدم اليقينيات سواء في المعرفة العلمية الطبيعية التي توالت فيها الكشوف الجديدة مصحّحة ومعدّلة، لتبرز الانفتاح المستمر وإمكانات التطور الهائلة ممّا يقتضي العودة بالنقد والمراجعة إلى كلّ المكتسبات السابقة، أو في المعرفة الإنسانية والاجتماعية والمقولات الفلسفية التي أصبحت تطغى عليها النزعة التأويليّة التي تجعل من الذات منطلقاً أساسياً للأحكام، رغم أنّ مفهوم الذات نفسه قد وقعت إزاحته عن مركز عملية تكوين المعرفة بمعناها الكلاسيكي (كما هو الأمر عند ديكارت)، واستبدل مفهوم الذات العاقلة العارفة بالذات المتعينة؛ أي الكائن المشروط بظروف الممارسة المعرفيّة، وهذا هو أساس كلّ النزعات التأويليّة المعاصرة.
ويمكن أن نمثل لهذه الأقوال مثلاً بتصوّر هايدغر الذي رفض مفهوم التطابق التقليدي بين الفكرة والواقع واستبدلها بمفهوم انفتاح الكائن أمام الفكر، فتصبح عملية التعقل إمكاناً نسبياً يصاغ في قالب لغوي وتتحوّل صورة الوجود الفعلي إلى وجود لساني، واستكمل غادمير هذا المنحى بدعوته إلى الفصل بين الحقيقة كمتعيّن موضوعي مفترض ومنهج الوصول إليها باعتبارها الإمكان الفعلي المدرك، ومن ثمّ رأى ضرورة التركيز على المنهج واستحضار كلّ العوامل المتحكمة في تشكيل الوعي من أحكام مسبقة وبنيات ذهنية ولاشعورية وثقافة مؤثرة... ففتح الباب مشرعاً أمام التأويل الذي ليس سوى إمكان ضمن إمكانات أخرى للقراءة، تتغير معه أحادية المعنى وقطعية الحكم.
نحن وأصداء معركة الحقيقة
يبدو أنّ كل معاركنا الفكرية تكاد تكون مستوردة - على الأقل في شكلها وعنوانها -، فانتشرت في الخطابات العربية المعاصرة قضايا الصراع المعروف بين التقليد والحداثة، وبين الإسلاميين والعلمانيين، التي تقدّم على أنها صورة من التعارض بين أتباع مذهب الرأي الواحد والجمود الفكري وأتباع السلف ورفض الإبداع وبين أنصار التنوير وحرية الفكر والإبداع ومسايرة العصر. ولعلّ هذا الاختزال المخل قد أغلق الأذهان أمام إمكانات الإبداع الحقيقية خارج الاستلاب للنماذج الجاهزة.
إنّ ظروف التحوّل المقترن بالأزمات الاجتماعية والسياسية قد حوّل النقاش الفكري في الساحة الثقافية العربية والإسلامية إلى جدل إيديولوجي تختلف شعاراته ولافتاته، ولكن يخفي بنية ذهنية جامدة تخترق الجميع، إذ تحوّلت مقولات الحداثة والعلمانية نفسها إلى قوالب جاهزة ومكرّرة تلوكها الألسن تماماً مثل المقولات التراثية.
ولعلّ بعض المحاولات المحدودة والجادّة قد اخترقت هذا التقاطب العقيم، ودشّنت فرصاً جديدة لوصل ما انقطع في التجربة الفكريّة والتاريخيّة للمسلمين، وهذا ما يتجلى في عودة الاهتمام من طرف ثلة من الباحثين إلى إعادة قراءة التراث الفكري الإسلامي، ثم إعادة فتح إمكانات لإعادة قراءات النصّ الديني نفسه بشكل يسمح بتجديد الشعور بالانتماء الأصيل مع الانخراط في التجربة الإنسانية ككل دون مركبات النقص ومشاعر الانفصام التي تؤدي إمّا إلى الانكفاء على الذات أو الاستلاب لآخر متوهّم.
*- مجلة يتفكرون، العدد الثالث، شتاء 2014