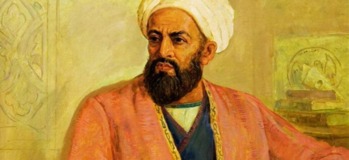حوار مع د. حسام الدين درويش سوريا: الفلسفة والثورة والانتقال الديمقراطي
فئة : حوارات

حوار مع د. حسام الدين درويش
سوريا: الفلسفة والثورة والانتقال الديمقراطي
حاوره د. ساري حنفي
د. ساري حنفي:
يسعدني كثيرًا اليوم أن أقدّم الصديق والزميل حسام الدين درويش. مرحبًا حسام، أهلًا وسهلًا بك.
حسام الدين هو فيلسوف سوري مقيم في ألمانيا، حائز على شهادة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة بوردو 3 في فرنسا، حيث تخصّص أساسًا في الهيرمينوطيقا ومناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية. حاضر في عدد من الجامعات؛ أذكر منها قسم لغات العالم الإسلامي وثقافاته في كلية الفلسفة بجامعة كولونيا في ألمانيا، فضلًا عن جامعات أخرى، وهو باحث مشارك في مشروع دراسة القوة التفسيرية في جامعة دوسبورغ–إيسن بألمانيا. كما يهتم أساسًا بالفلسفة السياسية وفلسفة الاعتراف، وبالإشكاليات والقضايا المتعلقة بالفكر العربي الإسلامي الحديث والمعاصر. نشر ثلاثة كتب باللغة الفرنسية وعددًا من الكتب باللغة العربية، بين يديّ ثلاثة منها هي أحدث ما صدر له. نُشرت هذه الكتب عن مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" في الإمارات العربية المتحدة. الكتاب الأول هو "جدل التأويل بين الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكور"، وهو في الأصل جزء من أطروحته للدكتوراه التي حوّلها إلى كتاب. أما الكتاب الثاني، فهو "درويش بين القدر والمصير في الفلسفة والثورة"، وهو حوار مع حسام الدين درويش أجراه محمد ديبو. والكتاب الثالث بعنوان "في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية: نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية"، وله كتب أخرى سنتناول بعض مضامينها لاحقًا. كما أنه يشغل منصب المستشار الأكاديمي ومدير الندوات والنشاطات الفكرية في مؤسسة "مؤمنون بلا حدود". مرحبًا بك مجددًا حسام، أنا مسرور جدًّا بأننا سنتحدث عن مسارك الفلسفي.
ما يهمني كثيرًا هو: لماذا اخترت الفلسفة؟ وما علاقتها بسياقك المجتمعي، والأسري، والطبقي في سوريا خلال ثمانينيات القرن الماضي؟
د. حسام الدين درويش:
عدتُ إلى دراسة الفلسفة في التسعينيات، بعد أن كنت قد انقطعت عن الدراسة منذ عام 1984 أو 1985، بعد وفاة والدي. حصلت على الشهادة الإعدادية، ثم درست نصف الصف العاشر، وبعد ذلك تركت الدراسة لرغبتي في الاستقلال المادي. اشتغلت في أعمالٍ مختلفة، أبرزها النجارة، كما عملتُ في مهن متفرقة كبسطات البيع؛ إذ كنت أذهب يوميًّا إلى البازار لأبيع البضائع، أو الخضار، أو حتى السجائر. هذه كانت الأعمال الأساسية التي مارستها قبل الخدمة العسكرية. بعد إنهاء الخدمة العسكرية كانت لدي رغبة شديدة في متابعة تعليمي. كنت وقتها أمضي فترة الخدمة العسكرية في منطقة حدودية بين المصنع اللبناني والحدود السورية. كنت أهرّب الموز من لبنان وأبيعه في سوريا، ثم أذهب لأداء صلاة الظهر أو العصر في المسجد، وبعدها أشارك في دورات الشبيبة، وهي دورات مخصّصة لمن يرغب في التقدّم إلى امتحان البكالوريا الحرة. في تلك الدورات درسنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة الفلسفة.
عندما عدت إلى الدراسة كان هدفي في البداية دراسة القانون، أو "الحقوق"؛ إذ كنت مهووسًا بفكرة العدالة، بوصفها مسألة توازن وإنصاف.
د. ساري حنفي:
لعلّ لذلك علاقة بحرمانك الشخصي من العدالة؟
د. حسام الدين درويش:
يصعب تفسير الأمر ذاتيًّا، لكن كان يلازمني شعور عميق بالظلم. أنت تعرف أن نظرية العدالة يمكن أن تنطلق من مفهوم العدالة لتُطبَّق على الواقع، بينما في رؤية أخرى، يفترض أن تبدأ من واقع الظلم لتحدد معنى العدالة. وقد كان إحساسي بواقع الظلم شديدًا؛ ليس ظلمًا اجتماعيًّا فحسب، بل سياسيًّا ومؤسّساتيًّا أيضًا، متصلًا بالدولة والقوانين. مسألة التوازن وإمكان إقامة العدل كانت تشغلني كثيرًا.
وما إن أنهيت البكالوريا حتى قرّرتُ، دون تردّد، ألّا أدرس إلا الفلسفة. الأسباب كانت كثيرة، لكن ما كان يشغلني آنذاك، هو تلك الأسئلة الكبرى التي تثيرها الفلسفة. من بينها الوجودية المرتبطة بوجود الله، ولنقل: سؤال الشرّ. كيف يمكن أن يكون الله موجودًا، وهو كلّ الخير، وكلّ القدرة، وكلّ المعرفة، ومع ذلك يوجد الشرّ في العالم؟
لجأتُ إلى طرائق متعددة متاحة، منها بعض الطرق الصوفية. لكن بعد أن سألتُ الشيخ كثيرًا، قال لي في النهاية: "أنا شيخ طريقة، لا شيخ علم". عندها تركتُ الصوفية؛ إذ كنت قد استنفدتُ ما في محيطي من إمكانيات إيجابية في هذا الباب، فوجدتُ أن الإجابة ربما تكون عن طريق الفلسفة. كنتُ أظنّ أن الفلسفة قادرة على أن تمنحني تلك الإجابة.
د. ساري حنفي:
وأنت تتكلم يا حسام، تذكرتُ فجأة أنّه حين كنتُ في مدرسة ابن خلدون، كنّا عندما نخرج من المدرسة نجد شخصًا يبيع لنا على عربة "الهريسة" (تلك الحلويات السورية). وكنتُ ألقاه أيضًا في المركز الثقافي العربي في حيّ المهاجرين، يحضر المحاضرات. وأكثر ما كان يؤلمني أنّ هذا الشخص كان فهيمًا جدًّا، يطرح أسئلة رائعة، لكن القائم على إدارة الجلسات في المركز الثقافي العربي كان يعرفه بأنه "بائع هريسة"، فكان يؤخّره إلى آخر النقاش، وأحيانًا يقول له: "لم يعد لدينا وقت لسؤالك". هكذا كان الظلم الطبقي ينعكس على مستويات أخرى في مجتمعاتنا، مع كلّ أسف.
د. حسام الدين درويش:
دعني أقول بصراحة: لم أكن أنظر إلى الفقر على أنه يجعلني أقلّ من غيري، ولم أشعر يومًا بأن الغني أفضل من الفقير. لكن الفقر كان يجعلني أتألّم من الحاجة والاضطرار. حتى في السنة التي قضيتها في دراسة الدبلوم في دمشق، كانت لديّ "بسطة" في شارع النصر، وأحيانًا كان بعض الأساتذة الذين يدرّسونني يأتون ويشترون مني. وحتى حين درستُ الدكتوراه في فرنسا، عملتُ هناك في قطف العنب وفي بعض المصانع، وبائعًا متجوِّلًا. وعندما ذهبتُ إلى بريطانيا، عملتُ أيضًا عامل بناء لأكثر من عام؛ أي إنني، على الرغم من حصولي على الدكتوراه وما بعد الدكتوراه، فقد عملتُ في مختلف المهن اليدوية الممكنة.
غير أنّ غايتي من الفلسفة كانت أن أصل إلى الحقيقة، أن أقبض على "الحقيقة الواحدة" الإيجابية. لكن ما خرجتُ به من الفلسفة هو أنّه من الضروري جدًّا، معرفيًّا وأخلاقيًّا وسياسيًّا، أن ندرك أنه لا وجود لحقيقة واحدة؛ أي إنّ البداية كانت عكس النهاية: في البداية كنتُ أبحث عن حقيقة واحدة. أما في النهاية، فقد أدركتُ أنّ علينا، أخلاقيًّا وسياسيًّا واجتماعيًّا ومعرفيًّا، أن نُسلِّم بعدم وجود حقيقة واحدة.
د. ساري حنفي:
هل ساعدتك فلسفة بول ريكور الفيلسوف الفرنسي الشهير في ذلك؟ فالتأويلية تقتضي بالضرورة التعددية.
د. حسام الدين درويش:
دعني أوضح: في البداية كانت انشغالاتي ذات طابع سياسي وأخلاقي، مرتبطة أساسًا بمسألة الشر، وبالوضع السياسي: كيف نفهمه؟ كيف نُغيّره؟ كيف نفسّره؟ لهذا السبب كان مشروعي الأول -أي الأطروحة التي قدمتها وقُبلت على أساسها في جامعة بوردو- حول الإيديولوجيا واليوتوبيا. إلى أيّ مدى يمكن أن يكون لنا مثل أعلى نسعى إلى تحقيقه؟ وكيف يمكن لهذا المثل أن يتأرجح بين أن يكون يوتوبيًّا أو إيديولوجيًّا؟ ثم إلى أيّ حدّ يكون ذلك ضروريًّا أو مفيدًا، أو على العكس قد يتحول إلى عائق.
لكن عندما ذهبتُ إلى فرنسا، اكتشفت أنّ البناء على فلسفة ريكور في هذا المجال ضعيف؛ إذ لم تكن من أولويات اهتمامها. غير أنّ الهيرمينوطيقا شدتني لهذا السبب بالذات. ومن الطرائف أنّه حين فكرتُ لأول مرة في موضوع رسالة الماجستير، في سوريا، كان العنوان المقترح لديّ ـ وكنت أقوله بجدية تامّة ـ هو: "الريبية هي الفلسفة الحقيقية". قد يبدو ذلك مفارقة: فلسفة حقيقية وريبية في آن! لكنني لاحقًا وجدتُ أنّه إذا كان هناك مجال للتعددية والريبية والنسبية في الفلسفة المعاصرة، فهو موجودٌ وجودًا خاصًّا وكبيرًا في الهيرمينوطيقا. فمجرد كلمة "تأويل"، أيًّا كانت اللغة التي نستخدمها، تحمل في ذاتها معنى الإقرار بالتعددية؛ إذ حين أقول: "أنا أُؤوِّل"، فهذا يعني بالضرورة أنّ ثمة إمكانية لتأويل آخر. وهذه الفكرة كانت شديدة الإغراء بالنسبة لي؛ إذ وجدتُ في نفسي رغبة في ألّا تبقى مسألة التعددية مجرد شعارات، بل أن أبحث لها عن أسسٍ معرفية أستند إليها.
د. ساري حنفي:
من الواضح، حسام الدين، أنّ مسارك، حتى عندما اشتغلت على أطروحة دكتوراه في الفلسفة الغربيّة، عند بول ريكور مثلًا، ظلّ مرتبطًا بالجدل الدائر في العالم العربي، وهو حاضر في كل كتاباتك في الحقيقة. أنا نسيت أن أذكر أنّه لو أردت أن ألخّص أهمّ القضايا التي اهتممتَ بها، لقلت إنّك تناولت الحركات الإسلاميّة، والمسائل الأخلاقيّة، والأخلاق العموميّة، وموضوع الديمقراطيّة، والانتقال الديمقراطي، والعدالة، والحريّات الفرديّة والجماعاتيّة. من الواضح أنّ البيئة التي عشتَ فيها ساعدتك على فهم كيف يبني الناس محاجاتهم الأخلاقيّة في المجتمع. دعني أذكّر مثلًا بمقالتين، رغم صغر حجمهما، إلا أنّهما في رأيي في غاية الأهميّة. وبصراحة، أرى أنّ من الشجاعة اليوم أن نفتح النقاش في قضايا الجنسانية؛ فهي في الحقيقة، كما يقول المثل الإنجليزي: "الفيل في الغرفة"؛ أي إن الجنسانية مسألة مهمة جدًّا في كل المجتمعات، وأشعر أنّ هناك أشياء يمكن أن نقولها، وأشياء أخرى لا نستطيع قولها. لكن أنت كانت لديك شجاعة في أن توضّح كيف يحاجج الذين لا يقبلون كلّ أشكال الجنسانية الموجودة. روعة هاتين المقالتين أنّهما قالتا ما لا يُقال عادةً في فضاءات مثل سوريا. أهمّيتهما أنّك كنت فعلًا بين الناس، تسمع حججهم وردودهم. فهل لك أن تحدّثنا قليلًا عن ذلك؟
د. حسام الدين درويش:
لقد حاولتُ تناول هذه المسألة؛ لأنّها غالبًا ما تُعالج إمّا من منظور تحقيريّ انتقاديّ، يرفضها بحجّة أنّها لا تمثّل "قيمنا"، وأنّها بضاعة غربيّة دخيلة، وإمّا من منظور تمجيديّ يرى فيها الحضارة والحداثة والتعدديّة، ويعدّ كلّ من يرفضها متخلّفًا أو فاقدًا للأخلاق. وقد واجهتُ هذا الموقف في مجتمعي، مثلًا مع أخي الذي قال لي: "لا أستطيع تحمّل فكرة المثلية". وهنا كان جوهر المقال: التمييز بين الاحترام والموافقة. فالاحترام لا يعني أن تحبّهم، ولا أن تتبنّى قيمهم، ولا أن تراهم على حقّ، ولا أن تشعر تجاههم بأيّ شعور إيجابي. المطلوب فقط ألّا تعتدي عليهم، وأن تتركهم وشأنهم، وهم كذلك مطالبون بأن يتركونك وشأنك.
د. ساري حنفي:
لهذا، هناك مقولة لطيفة في أحد المقالات: من حقوق الإنسان أن نمتلك القدرة على أن نقول إنّنا نعارض بعض الممارسات الجنسيّة، أو لا نعتبرها جزءًا من الحياة الطيبة (وهو مفهوم فردي وجماعاتي).
د. حسام الدين درويش:
خصوصًا في بلد غربي مثلًا، إذا نظر الناس إليك بوصفك مختلفًا عنهم أو مرفوضًا، فقد يرفضون وجودك أصلًا. لذلك، في إطار هذه التعدديّة، يصبح الاحترام السلوكيّ ضرورة متبادلة، وكأنّ المسألة تعاقدية. من ناحية أولى، أنا شديد الحرص على أولوية ومركزيّة مسألة الحريّات الفرديّة. في رأيي، هذه أهمّ أولويّة على الإطلاق بالنسبة إلى مجتمعاتنا، على مستوى الأفراد، وعلى مستوى القوانين، والمؤسّسات، والجماعات والمجتمعات والدول. إنّ الاعتراف بقيمة الفرد، بغضّ النظر عن أيّ انتماء أو نسبة، هو الأولويّة الأولى عندي على المستوى النظري والعملي، الاجتماعي أو المجتمعي والسياسي.
من ناحية أخرى، مع أنّي أتبنى مقولة فوكو "يجب الدفاع عن المجتمع"، فإنّني أطبّقها على نحو آخر: يجب الدفاع عن المجتمعات العربيّة، على الأقلّ، المجتمع السوري بوصفه مجتمعًا مستباحًا، مذلًّا، مهانًا. وكما يقول دوستويفسكي: "مذلّون مهانون". فبعد كل ما يتعرّض له، نأتي نحن فنقوم بعمليات التحقير والإذلال والإهانة الفكرية، ونصفه بالتخلّف، ونحمّله المسؤولية، وكأنّ الضحية هي السبب. وأنا دائمًا أحاول أن أوازن بين هاتين المسألتين: التأكيد على قضية الحريات الفردية، وحقّ الفرد في أن يكون ضمن الحدود العامة التي يمكن الاتفاق عليها، من غير أن تتحوّل إلى رؤية ثقافوية تقول: "أنتم بسبب دينكم أو ثقافتكم متخلّفون، وبالتالي تتحمّلون ذنب الجرائم التي تُرتكب بحقّكم". ولهذا، أرى أنّ هذا الإطار العام وهذه الموازنة بين الاتجاهين مسألة في غاية الأهمية.
د. ساري حنفي:
إلى أيّ حدّ أثّر الاشتغال على فلسفة الاعتراف لدى أكسل هونيث مثلًا في تفكيرك وطوّر مفهوم الحريات الفردية؟ سأذكر أنّ لك كتابًا بعنوان في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية؟
د. حسام الدين درويش:
بعد عودتي إلى سوريا، إثر انتهائي من الدكتوراه، كان الأساس أن أتابع أبحاثي بعد دراساتي حول الهيرمينوطيقا عند ريكور، وغادامر، وغيرهما، وكذلك عند هايدغر وشلايرماخر. وكان لديّ توجّه نحو فلسفات التفكيك عند دريدا وبول دومان وغيرهما. فمن الناحية الأولى، فلسفات الهيرمينوطيقا، وقضايا الحقيقة والمعرفة ونَسبيّتها وتعدديتها أسرتني، لكن في التفكيك استوقفني أمرٌ آخر، وهو أنّ هناك دائمًا جانبًا لا يمكن اختزاله في التماثل مع الأنا، جانبًا يظلّ مختلفًا لا يُفهم بالكامل. وبالتالي، إذا كان هناك آخر، فإنه لا يُختزل إلى الأنا ولا في الأنا. كنت في طور محاولة جادة، قضيت أكثر من سنة أقرأ وأسجّل توثيقات عمّا يمكن تسميته بالهيرمينوطيقا التفكيكية أو التفكيك الهيرمينوطيقي. لكن بعد أحداث الربيع العربي، ومع اندلاع الثورة في سوريا، كتبت أول نص لي باللغة العربية بعد نحو ثلاثة أسابيع من قيامها، وكان أفكار عن ثورات العال العربي.
د. ساري حنفي:
أين كنت حين قامت الثورة السورية؟
د. حسام الدين درويش:
كنت في سوريا،
د. ساري حنفي:
كنت تدرّس؟
د. حسام الدين درويش:
لا أدرّس، وقتها لم أكن قد حصلت على التعيين بسبب ظروف إدارية بيروقراطية، وربما أيضًا سياسية وأمنية. ومع ذلك، شعرت أنّ أضعف الإيمان، والناس يضحّون بحياتهم عمليًّا، أن أكتب، رغم المخاطرة. ومنذ ذلك الحين بدأت أكتب باللغة العربية. أكنت مقيمًا في حي العفيف/ المهاجرين في دمشق. وبعد أن بدأت بالكتابة، لم أعد قادرًا على الكتابة في الهيرمينوطيقا أو التفكيك، ولا على التفكير في الفلسفة النظرية المحضة؛ إذ أصبحت مهمومًا ومنشغلًا تمامًا بالواقع السياسي. فعُدت إلى فكرة العدالة، وكأنّ المرء يبتعد ويغيب، ثم يعود في النهاية إلى نفسه. والحقيقة أنّني عدت إلى العدالة، وأنا بالأصل كنت أرغب في دراسة القانون. قرأت في فلسفة العدالة عند جون رولز وغيرِه، ووجدت أنّها، آنذاك، من أبرز وأحدث القضايا، رغم ضعف حضورها عربيًّا. وقد رأيت أنّ العدالة بوصفها اعترافًا أفق أوسع من مجرد عملية قانونية مؤسساتية. فالاعتراف يمكن أن يأخذ شكل الاحترام على المستوى السياسي، أو التقدير على المستوى الاقتصادي، أو الحب في مستوى العلاقات الإنسانية. ووجدت في اللغة العربية أنّ كلمة "اعتراف" تحمل أكثر من معنى؛ فهي ليست فقط بمعنى recognition، بل أيضًا بمعنى confession. وهذا التعدد أضاء لي علاقةً بين المفهومين، رغم اختلافهما. فالاعتراف ليس فقط نقد الآخر بوصفه مخطئًا، بل هو أيضًا ممارسة للنقد الذاتي. لذلك انشغلت كثيرًا حينها بمسألة العدالة، وبفهمها على أنها اعتراف.
د. ساري حنفي:
أذكر أنك كتبتَ ذات مرة أنّ الثنائية بين نانسي فريزر وأكسل هونيث، حول الاعتراف أم العدالة التوزيعية، هي ثنائية أقرب إلى الوهم. فهل يمكنك أن تتحدث عن كسر هذه الثنائيات الماناوية الحادة؟ يجب أن أذكر أنك تُعَدّ أحد الأبطال في كسر الثنائيات الحادّة والقاتلة.
د. حسام الدين درويش:
هي ما يُسمّونها بالإنجليزية (Dichotomies)، وأنا أسميها مثنويات؛ بمعنى أنّها لا تقف عند ثنائية بسيطة، بل تتضمن تراتبية وتضادًّا أو تناقضًا بين طرفين: طرف أعلى وطرف أدنى، طرف يُلغي الآخر. وهنا لا أقول إنّه يجب أن نُنكر دائمًا وجود اختلاف، أو أنّه لا يكون أحيانًا طرفٌ أفضل من آخر، بل ينبغي الحذر من الوقوع في التلفيق. مع ذلك، تؤكد نانسي فريزر أكثر على الجانب الاقتصادي السياسي، وأنا أتفق معها في ذلك، غير أنّ ما أودّ الإضافة إليه هو أنّ نظريّة الاعتراف تُعطي أهميّةً للجانب الثقافي والروحي، وهو جانب برأيي لا يحظى بما يستحقه في كثير من النظريات الأخرى. فالطفل الذي لا يحظى بالحبّ والرعاية لأسباب ثقافية أو سياسية هو مظلوم، وهذا لا تفسّره دائمًا نظريات الاقتصاد السياسي.
د. ساري حنفي:
وكذلك التمييز بين البنت والابن مثلًا؛
د. حسام الدين درويش:
هنا تبرز أهمية نظريّات الاعتراف. لكن، هذه الفكرة ليست جديدة تمامًا ولا تجبّ ما قبلها؛ فماركس كان وما زال، وستبقى له قيمته في مسائل الاقتصاد السياسي، غير أنّ هناك جوانب أخرى تحتاج إلى تكميل. وبرأيي، جاءت نظريات الاعتراف والعدالة بوصفها اعترافًا لتكمل هذا الجانب؛ إذ تقول إنّ الإنسان لا يحيا بالخبز وحده، أي ليس بالمعنى الاقتصادي السياسي فقط، بل هناك جوانب روحية، ثقافية، معنوية، عاطفية، يجب أن تأخذ حقّها، بل ويمكن حتى قراءة الاقتصاد السياسي من خلال كونه اعترافًا؛ فحين نتحدث عن التقدير من خلال الأجر، فهذا لا يعني أنّ العامل يريد المال فقط، بل يريد التقدير. وأحيانًا يرفض الناس الأجر، إذا شعروا أنّه يُعبّر عن عدم تقدير، فالقيمة المادية لا تهمّهم إلا بوصفها تقديرًا. إذن، ليست المسألة فصلًا بين الطرفين، بل في أنّ الفلسفة – وهنا تكمن ميزتها وربما ضرورتها – تميل إلى دفع الاتجاه نحو أقصاه، عبر المحاججة التي تُظهر معقوليّة اتجاه ما مقابل اتجاه آخر، وتساعدنا على إدراك أقوى أشكال الدفاع عن فكرة مثل فكرة نانسي فريزر، من دون أن يعني ذلك استبعاد الاتجاه الآخر.
د. ساري حنفي:
في الحقيقة، كما تؤكد في كتاباتك، لا يكفي أن نميّز سلبيًّا، بل لا بدّ أن نميّز إيجابيًّا: فلا يكفي أن أعيب على إنسان بأنه لاجئ، بل يجب أن أُظهر له كيف أنّي أقدّره وأعامله بالمساواة.
د. حسام الدين درويش:
دعني أقول في قضية اللجوء مثلًا، يجب أن نأخذها بعين الاعتبار بوصفها حالة خاصة، لكن لا يجوز أن تتحوّل إلى هويةٍ تُلغي كل الصفات الأخرى: رجلًا كان أو امرأة، متعلّمًا أو غير متعلّم، من أيّ ثقافة أو دين أو فكر. فالاختزال هنا خطير؛ لأنه يُحوّل اللاجئ إلى هوية واحدة.
د. ساري حنفي:
وهذا يدعم إمكانية المظلومية المطلقة.
د. حسام الدين درويش:
طبعًا، أما بخصوص التمييز السلبي والإيجابي: فالتمييز السلبي لا يختلف اثنان على ضرورة استبعاده، ولا يجوز تبريره، ونحن - على الأقل في إطار النظام المعياري الحديث - في طور استبعاده معياريًّا، حتى لو ظلّ الواقع مخالفًا أحيانًا. فلا أحد يقبل معياريًّا اليوم أن يُقال إنّ المرأة أقل، أو أنّ العربي أقل من الأوروبي. لكن عمليًّا في الواقع، لا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الخصوص.
د. ساري حنفي:
من أهم ما أدخلته إلى الحقل الثقافي العربي مفهوم "المعيارية الكثيفة"، ودوره في التعامل مع قضايا مثل العلمانية، وفهمك للعلمانية، والشكل الذي يجب أن تكون عليه.
د. حسام الدين درويش:
دعني أقول: رغم أنّ له بُعدًا معرفيًّا، لكن فيه أيضًا بُعدٌ معياري. المقصود ببساطة أنّه إلى منتصف القرن العشرين على الأقل، كانت هناك رؤية تقول إنّ العالم منقسم إلى قسمين:
*-عالم حقيقي هو الواقع ويقوم عليه الوصف؛
*- عالم معنوي أو فكري فيه قيم كالحرية والحق والخير، وهذا لا صلة له بالمعرفة والوصف.
أي هناك إما واقع وإما قيمة، إما وصف أو تقييم. فمفهوم الخير مثلًا مفهوم معياري، بينما مفهوم السيّارة أو الكتاب مفهوم وصفي. إذا كان العالم مقسومًا إلى هذين القسمين، فبينهما قطيعة لا يمكن جَسرها. بعد ذلك، ظهرت رؤية جديدة مفادها أنّ معظم المفاهيم في حقل العلوم الاجتماعية ليست وصفية فقط ولا معيارية فقط. فهل كلّ مفهوم – كالحرية، الديمقراطية، العدالة – هو مجرد وصف لما هو كائن، أم إنّ فيه بُعدًا معياريًّا يتحدث عمّا يجب أن يكون؟ العلمانية مثلًا: هل هي وصفية بحتة أم إنّها تحمل قيمًا عما يجب أن يكون؟ إذن ببساطة: المعياري يتحدث عن "ما ينبغي أن يكون"، والوصفي يتحدث عن "ما هو كائن". ومعظم مفاهيم العلوم الاجتماعية تجمع بين الوصفي والمعياري. المشكلة هنا من الناحية المعرفية: الناس يعرّفونها بشكل مختلف. فالعلمانية عند البعض هي معاداة الدين، وعند آخرين هي حياد الدين. فإذا قال أحدهم: "العلمانية يمكن أن تكون معادية للدين"، أقول له: صحيح، لكنها ليست بالضرورة كذلك. وإذا قال آخر: "العلمانية ليست إلا حيادًا"، فهذا يفرض جانبًا معينًا ورؤية معينة.
في رأيي، ثمة غياب لوضوح وحضور الرؤية المعيارية؛ ففي العلوم الاجتماعية لا يكفي أن نقول ببساطة: هذا مفهوم وصفي أو ذاك مفهوم معياري، بل لا بد أولاً من تأسيس حدٍّ أدنى وصفي يتيح إمكانية التفاهم، مع الاعتراف في الوقت نفسه بوجود بُعد معياري متفاعل.
د. ساري حنفي:
وهذا جميل، لأنك تُناهض مثنوية وضعانية؛ أي إنني أصف الواقع، بينما الآخر يفكر بشكل مختلف عني، بمعنى أنه خارج الواقع، وهناك طرف آخر يقول لا.
د. حسام الدين درويش:
تمام، ما حدث هو أن الجدالات والنقاشات الشهيرة في هذا المجال – مثل النقاش بين جورج طرابيشي والجابري – توضح هذا الالتباس. فالجابري، مثلًا، في كتاب واحد وفي صفحات متقاربة، يقول من ناحية إنه يجب استبعاد مفردة "العلمانية" من قاموس الفكر القومي العربي، ثم يقول من ناحية أخرى إن الفصل بين الدين والسياسة ضروري جدًّا. فإذا لم يكن هذا علمانية، فما يكون إذن؟ وقوله: "العلمانية هي فصل الدين عن الكنيسة، ونحن لا كنيسة عندنا."
هذا الاضطراب ليس عَرَضيًّا؛ نحن نتحدث هنا عن مفكرين كبار. فإذا كان هناك اضطراب في المعنى على هذا المستوى، فإن الغرض من هذا كله هو الإشارة إلى أننا أمام مبحث جديد في الثقافة العربية لم يُكتب فيه بما يكفي، وهو مبحث ضبط المصطلح وضبط المفهوم وإدراك أبعاده المعيارية والوصفية المتعددة، من دون إرجاعه إلى تجربة واحدة (فرنسية أو بريطانية مثلًا). ولهذا نقول: هناك علمانيات متعددة، ويمكن أن تأخذ أشكالًا مختلفة.
د. ساري حنفي:
لقد لاحظتُ من خلال كتاباتك، حسام الدين درويش، نقاش زملائك والمثقفين والفلاسفة العرب، سواء الموجودين حاليًّا أو الذين كانوا قبل فترة قصيرة مثل الجابري، وأرى ان هذا مهم جدًّا، في التفكير بأن ثمة شيئًا اسمه جماعة علمية؛ إذ لا وجود لجماعة علمية ما لم نناقش بعضنا البعض. لاحظت أنك ألفت كتابًا عن عزمي بشارة، وجمال باروت، وناقشت حسن حنفي والجابري وصادق جلال العظم، ثم أدونيس. سؤالي هنا: هل مناقشة أشخاص أحياء تُسبب إشكالًا أو "وجع رأس"؟
د. حسام الدين درويش:
بالفعل، ومع أنني نادرًا ما أحكم على ثقافة ما، وأقول إنّ فيها شيئًا مختلفًا عن الثقافات الأخرى، لكن يمكن أن أجازف هنا وأقول إنّ هناك افتقارًا في الثقافة العربية، ثقافة الكتب والنخبة؛ للنقاشات الجدية بين الأطراف بغضّ النظر عن العلاقة بينهم. وأنا عندما أكتب غالبًا يكون هناك أمران: الأول تقدير لما أناقشه وأكتب عنه وعده مهمًّا ومؤثرًا، لكن لا يمكن أن تكون كتابتي إلا نقديً أيضًا؛ إذ لا يمكن أن أكتب عن شخص إذا لم يكن لديّ اختلاف معه، وإلا لماذا أكتب عنه؟ بمعنى أنّ مجرد كتابتي عنه اعتراف بأنّ له قيمة، لكن أيضًا بأن لدي ما اختلف عنه أو معه في أيضًا.
د. ساري حنفي:
الناس يحبّون الطرف الأول، لكن لا يحبّون الطرف الثاني.
د. حسام الدين درويش:
أول نص كتبته في هذه المسألة، نُشر وقت الثورة السورية وما تلاها، وكان في ردّ الفعل شيء من الامتعاض، لكن كان معقولًا؛ إذ تضمن رد الفعل الإقرار بمعقولية ما للنص وبأن إيجابياته أكثر من سلبياته. النص الثاني الذي كتبته كان نقديًّا بروح إيجابية جدًّا تجاه شخص (كنت) أقدّره وأقدّر مواقفه وقيمته وأعده بالفعل مؤثرًا، وهو مدير مؤسسة ثقافية ضخمة ومهمة، لكنه رفض نشر النص وقال إن أقل ما يقال عنه إنّه "مغرض". أنت تعرف كلمة "مغرض" وما تعنيه، مع أنّه نفسيًّا كنت بكل شعور إيجابي، وتقريبًا معظم من كتبت عنهم من الأحياء كان رد فعلهم هو الامتعاض، وأحيانًا وصل الأمر إلى القطيعة.
للأسف، هنا قدرت أنّ المسألة تحتاج إلى سؤال: من في العالم العربي بالفعل من الكتّاب تعرّض للنقد وظلّ على علاقة جيدة مع ناقده؟ هنا استذكرت العظم، فأنا متأثر به؛ كان شخصًا نقديًّا بروح عظيمة، يتقبل النقد بشكل رهيب ونموذجي وفريد من نوعه. أذكر علي حرب، المعروف بلسانه الطويل والنقد اللاذع، حين نقد العظم توقع أن يقابله بجفاء، لكن العظم قابله بودّ رحب، وهو نفسه، علي حرب، فوجئ بذلك.
تجاربي في هذا الخصوص – وأنا أتحدث عن عشرات النصوص، - لم تكن مشجعة جدًّا. ومع ذلك، أرى أنّ هناك ضرورة للقيام بمناقشات جدية ونقدية.
د. ساري حنفي:
طبعًا، أنا برأيي قوة الجماعة العلمية تكمن في أن نناقش بعضنا، وأن يكون هناك جدل، وإلا فكيف نقنع الناس العاديين، إذا كانوا يروننا لا نناقش بعضنا أو نهمل الآخر الذي يكتب مثلنا؟ أنا دائمًا مصعوق؛ لأنّ محمد أركون لم يستشهد يومًا بالجابري، والجابري أيضًا لم يستشهد به. حضرت لمدة سنتين في سيمينار عند محمد أركون، رحمه الله، وسألته هذا السؤال، فصمت دقيقتين أو ثلاثًا، ثم قال: "لا أعتقد أنّه يستحق التعامل مع فكره". وهذا شيء مؤسف.
د. حسام الدين درويش:
حضرت منذ فترة مؤتمرًا عن طه حسين. وهو معروف كناقد للشعر الجاهلي، وكناقد أدبي وفكري وثقافي، ومعروف أنّه كان ضحية، حيث تعرّض للتكفير. حاولت وقتها أن أبرز وجهًا آخر لطه حسين. وبرأيي، من الضروري ألّا نقتصر على القول إنّ الناقد له حق النقد فقط، بل أيضًا كيف يتعامل مع النقد حين يُوجَّه إليه. فطه حسين في شبابه، عندما تعرّض للنقد ردّ بألذع الكلمات وبالتهديد والوعيد، لكنه لاحقًا اعتذر عن قيامه بذلك.
المهمّ هنا ألّا نختزل الشخص؛ فكما أن له الحق في النقد، فإن عليه أن يرسّخ هذا الحق في تقبّله لنقد الآخر. وحتى جورجي زيدان مثلًا، لم يسلم من نقد طه حسين. وأنا هنا بدوري حاولت التمييز بين "النقد" و"الانتقاد". ولحسن الحظ، لغتنا العربية تميز بينهما، بينما بعض اللغات الأوروبية لا تميز، مثل الإنجليزية، حيث هناك فرق بين critique وcriticism؛ بمعنى بالنقد. لكن هل تعلم أنّ الكريتيسيزم هو نفسه النقد الأدبي؟ نعم، حتى مثلاً ما نسمّيه "النقد الذاتي" فهو في النهاية انتقاد؛ لأنه لا يقوم إلا على إبراز النقائص، وليس على إبراز الإيجابيات وما شابه.
لكن إذا عدنا إلى طه حسين وجورجي زيدان، نجد أنّ جورجي زيدان حين ألّف كتابًا وعُرض على طه حسين لمراجعته، جاء نقده شديدًا، لدرجة أنه قال له ببساطة: "ليتك لم تكتب هذا الكتاب". عندها ردّ جورجي زيدان قائلاً: "اذكروا محاسن موتاكم"؛ أي كأنه عدّ نفسه ميتًا، وقال: لماذا لا تذكر حسناتي؟ فأجابه طه حسين بأنّ دور الناقد ليس ذكر الإيجابيات.
الفكرة هنا أنّ النقد قد تحوّل أحيانًا إلى تحطيم صنم. فالناقد حين يتعرض للنقد أو حين يمارسه، لا يلتزم دائمًا بأصول النقد، ولا بأصول الرد على النقد. ومن هنا، ورغم أنّ لطه حسين مكانة أدبية وفكرية عظيمة، فإنّ من الضروري ألّا يتحوّل إلى صنم. والفكرة الأساسية هي: كيف نتقبّل النقد؟ وكيف نمارسه وفق أصوله؟ صادق جلال العظم، مثلاً، كان يقول: من حقّي أن أنقد طالما أنني ألتزم بأصول النقد. ولم يكن يقبل بالتابوهات، بل كان ناقداً للتابوهات نفسها.
د. ساري حنفي:
بالنسبة إلى حسام الدين درويش، فقد لاحظتُ في اشتغالك الفلسفي أنّك – كما يقول أهل الموسيقى عن "الترنيم" أو التأليف الارتجالي – في كتاباتك تبدأ أولاً بالتوجه نحو الجمهور. أكيد في كتابك أطروحة الدكتوراه ثمة شغل اشتغلته في الحقيقة من فوق إلى تحت، لكن جزءًا كبيرًا من عملك يتوجه للجمهور، ويظهر في لحظات حاسمة من الجدل داخل المجتمع المدني، ثم يأخذ لاحقًا شكل أطروحة متماسكة. أفكر هنا مثلاً في كتابك حول المفاهيم المعيارية الكثيفة، والعلمانية، والإسلام السياسي. لقد صاغ ذلك أطروحة متماسكة حول أهمية العلمانية، مع ملاحظة أنّ الحداثة ليست واحدة، وأنها لا تمر بالطريقة نفسها. كما أنّك تدخل في حوار رصين مع الحركات الإسلامية، تُبيّن فيه ما لها وما عليها، من دون أن تنفي عنها مبدئيًّا إمكانية الممارسة السياسية. هل يمكنك الحديث عن هذا الموضوع؟ وسأعود إلى فكرة ما معنى من تحت إلى فوق؟
د. حسام الدين درويش:
"نقد الرؤية الثقافية" هو نقد ضمن إطار أعلى لأيّ فكرة جوهرانية تفترض أنّ هذا الطرف له جوهر ثابت لا يتغير، سواء أكان سلبيًّا أم إيجابيًّا؛ أي إنّه دائمًا خير أو دائمًا شرير. فالعلمانية، على سبيل المثال، يمكن أن تكون مؤذية وشريرة وسيئة، كما يمكن أن تكون إيجابية. والسؤال الأهم هنا هو: عن أي علمانية نتحدث؟ والأمر نفسه ينطبق على الدين؛ إذ يمكن أن يظهر في أرقى أشكال الأخلاق والاجتماع البشري، كما يمكن أن يظهر في أحط أشكالها.
من وجهة نظر دينية، طبعًا، أحد أشكال التدين صحيح والآخر باطل، لكن من وجهة نظر معرفية، كلاهما ينتمي إلى الدين. ولذلك، فإن السؤال الأهم بالنسبة لي ليس: هل يحضر هذا الطرف أو ذاك؟ بل: بأي شروط يحضر؟ كونه إسلاميًّا أو مسلمًا أو غير مسلم لا يهم، وكونه علمانيًّا أو غير علماني لا يهم. المهم: هل يؤمن بقواعد العقد الاجتماعي المشترك بيننا؟ هل يقبل بالمساواة الأولية في الحقوق والحريات والمواطنة؟ إذا آمن بذلك، فليشارك في السياسة. والسياسة هنا ليست مضمونة النتائج، لكنها لعبة تُمارَس ضمن أساس أولي مشترك. ولهذا السبب أدافع بقوة عن حق الإسلام السياسي أو المسيحية السياسية أو العلمانية السياسية في الحضور، بشرط - وهو شرط على الجميع لا يخص طرفًا دون آخر- الالتزام بالعقد الاجتماعي. قد يقول أحدهم: "لن يلتزموا". حينها ينتهي النقاش. أما إذا التزموا، فهل نقبل بحضورهم؟
أما التسامح والعلمانية، فهما بالنسبة إلي قيم مشتقة وليستا مطلقات. فالتسامح ليس قيمة بحد ذاته؛ إذ يمكن أن تتسامح مع ما هو سيئ، فيكون ذلك خطأً، أو أن تتسامح بحق الغير، فيكون ظلماً. لذا فالتسامح قيمة فقط بقدر ما يحقق العدالة. وكذلك العلمانية، لا تُعد قيمة مطلقة بذاتها، بل تُقاس بمدى تحقيقها للعدالة.
حضور الإسلام السياسي، أو حضور الرؤية العلمانية، أو حضور الرؤية القومية، يجب أن يُقاس بمدى تحقيقه لقيم إيجابية أخرى. على سبيل المثال، أنا أعطي أولوية للديمقراطية أكثر من أي شيء آخر: الحريات، والمواطنة، والمساواة. ولهذا السبب أتجنب استخدام لفظ "العلمانية" إلا في إطار ضبط المصطلح. أما عند الحديث عن مفرداتها، فإذا كانت العلمانية تعني المساواة بين المواطنين، فلنتحدث عن المساواة بين المواطنين. وإذا كانت تعني عدم التمييز على أساس الدين، فلنتحدث عن عدم التمييز.
د. ساري حنفي:
أنت في هذه الحالة تتفق مع سيسيل لابورد بأن العلمانية ليست قيمة في ذاتها، بل القيمة في ذاتها تكمن في القيم الليبرالية، مثل المساواة، والحرية، والعدالة.
د. حسام الدين درويش:
نعم، وحين أقول حرية الفرد، أقصد أن كرامة الإنسان وقيمته وأساس وجوده تكمن في حريته. فحريته هي (جزء من) إنسانيته. وإذا لم يكن حرًّا، حتى لو كان كريمًا أو عالمًا، فليس له فضل ولا قدرة ولا شأن. إذن، الحرية هي الحد الأدنى، والمساواة كذلك. بهذا المعنى أُعدّ نفسي حداثيًّا؛ لأنني أرى أن المساواة بين جميع البشر، من دون أي تمييز، قضية حداثية لم يعرفها التاريخ من قبل. هذه المساواة بين الجميع، بغض النظر عن أي اعتبار، طبعًا هذا مفهوم معياري. ولكن المساواة المذكورة كمفهوم معياري في العالم تم التنظير لها آنذاك، ولم يُنظر لها قبل ذلك. بالنسبة لي، هذه القيمة الأساسية؛ أي الحرية. وكما أقول، حتى في داخلنا وفي كلياتنا، كيف نوازن بين هذه الحريات الفردية من جهة، وبين العدالة والمساواة من جهة ثانية، وبين الجماعة والمجتمع من جهة ثالثة؟ هي إذن توازنات، غير أن الحرية والأفراد، بالنسبة لي، وخصوصًا في عالمنا العربي والإسلامي، في حاجة شديدة إلى إبراز أهميتها وضرورتها.
د. ساري حنفي:
قبل خمسة أشهر ونصف تقريبًا، تحررت سوريا من طغيان الأسد. وقد تابعتك على "فيسبوك" وقرأت كتاباتك، ورأيت إلى أي حد كنت متأثرًا بذلك. ثم بعد ذلك حملت نفسك وذهبت مع الدكتورة ميادة كيالي، من "مؤمنون بلا حدود"، وسافرتما معًا إلى سوريا أول مرة وثانية. أريدك أن تحدثني أولاً عن مشاعرك لحظة التحرير، ثم كيف تقيّم هذه المرحلة الانتقالية الحساسة جدًّا التي تعيشها سوريا اليوم؟
د. حسام الدين درويش:
في الحقيقة، كان الأمر، عمليًّا، لا يُصدَّق. قد تُقال كلمة "رمزية"، لكنه كان بالفعل أمرًا لا يُصدَّق. نحن شهدنا لحظة أو مرحلة كاد معظم السوريين أن يفقدوا فيها الأمل، إن لم يكونوا قد فقدوه فعلاً. وكانت سوريا قد وصلت إلى مرحلة لم يبقَ منها إلا حطام، وإن لم تكن قد ماتت، فهي كانت في حالة موات مستمر. ولم يكن هناك أي أفق.
وبطبيعة الحال، لم يُدرك كثير من الناس معنى وعمق لحظة السقوط. إنها لحظة عظيمة؛ لأن تلك الحقبة الطويلة من الظلم المعاش، والتدمير الممنهج، والإفساد الكبير، والقمع، والجرائم التي لا توصف كمًّا وكيفًا، انتهت بسقوط هذا النظام. لقد كان حدثًا عظيمًا، حدثًا نادرًا لا يتكرر بسهولة.
قلت يومها: لو أُعطي لهذا الحق الحد الأدنى من حقه، لكان ينبغي أن نقضي ستة أشهر من دون أن نفعل شيئًا سوى أن نحتفل، لو سمحت الظروف بذلك؛ لأنه حدث يستحق أن يُعطى كامل حقه. لقد انتهت تلك الحقبة، وكان لا بد أن تنتهي كي تكون هناك حياة سورية جديدة، بصرف النظر عن أي شيء آخر. نهاية هذا النظام وفرت إمكانية لبداية جديدة.
د. ساري حنفي:
هذا مثل ما يقول الفيلسوف الروسي-البريطاني أشعيا برلين تحققت الحرية السلبية؛ أي الحرية من ظلم الأسد.
د. حسام الدين درويش:
تمامًا، لقد أصبح هناك إمكان لعدم تدخل تلك السلطة. وبعد ذلك جاءت المرحلة التالية. الشيء الإيجابي أيضاً أنه صارت هناك إمكانيات متعددة. سوريا سابقًا كانت في اتجاه واحد، بأفق واحد مسدود. أما اليوم، فقد أصبح هناك إمكان للتعددية. ثمة مقولة أنت وأنا وكثير من الناس انتقدناها، مسألة كما تكونوا يُولَّ عليكم. أنا قلت: إذا كان لهذه المقولة معنى، فهو اليوم. الآن أصبح هناك مجال لفاعلية البشر، أصبح هناك إمكانية لأن يكون لقول السوريات والسوريين، لفعلهم، لخطابهم، لممارستهم، لنشاطهم، جدوى ومعنى، وتسهم في هذا الأمر لأسباب مختلفة. وبالتالي طبعًا، أقول إن تقييم الوضع السوري حاليًّا يجب أن يأخذ بعين الاعتبار مسألتين: يجب ألّا ننطلق فقط من رؤية ما هو الوضع الأمثل في سوريا، وبالتالي نقول إننا في حالة كارثية يُرثى لها. فسوريا حاليًّا دون مستوى الدولة بكل معاني وتعريفات الدولة، والمجتمع محطّم وممزّق بكل الأبعاد. لكن، إذا أردنا المقارنة فينبغي لنا القيام بذلك ليس فقط مع المجتمع الأمثل فقط، بل مع المجتمع الذي كان سائدًا قبل ذلك أيضًا. فإذا قارنا الحالة السورية الراهنة مع ما كان قبل ذلك، فنحن في حال أفضل حال وبكثير، بالتأكيد. لكن مقارنة مع الحد الأدنى من المطلوب، فنحن في حالة يُرثى لها وكارثية جدًّا.
من الضروري ومن الإنصاف معرفيًّا وسياسيًّا أن نأخذ الحالتين، لا أن ننطلق فقط من المقارنة مع الحالة المثلى، ونقول إننا الآن في وضع كارثي. أنا، كما قلت، الديمقراطية دائمًا في أولوياتي، وهناك إشكاليات في عدم الحديث عن الديمقراطية من هذا النظام. لكن سوريا الآن ليست دولة، فكيف يمكن الحديث عن نظام سياسي، فما بالك عن نظام ديمقراطي؟ لم يحدث في بلد مثل بلدنا، أو بأدائه، أن تكون هناك ديمقراطية. فالديمقراطية لها أساس اقتصادي، ولها أساسات أخرى غير موجودة الآن في سوريا الحاضر والمستقبل القريب.
د. ساري حنفي:
يمكن أن نتحدث عن بعض المؤشرات التي تأخذ باتجاه بناء دولة القانون. وهذه كلمة كان يرددها كثيرًا الرئيس أحمد الشرع، الرئيس السوري، وهناك في المقابل مؤشرات تبعدنا عن ذلك؟
د. حسام الدين درويش:
بعد سقوط النظام، عندما ذهبت مع الدكتورة ميادة إلى دمشق، وكان للعودة إلى سوريا بعد سقوط الأسد معنى رمزيًّا عظيمًا. اكتشفت أن هناك سوريات وسوريون كثر كانوا مثلي يرون هذه العودة في أحلامهم، بوصفها كابوسًا، قبل سقوط النظام الأسدي. بالنسبة لنا كانت سوريا هي "سوريا الأسد". وكان يحضر كابوس متكرر، كل أسبوعين أو ثلاثة، أو كل شهرين أو ثلاثة. أنا من الناس الذين كانوا يرون الكابوس: أنني نائم وأرى نفسي في سوريا. فأصحو مرعوبًا. سوريا عندي كانت مرتبطة بالبرامكة، حيث صورة بشار أو حافظ الأسد، وحتى قرب كلية الآداب والسجون والأقبية. نمشي ونعرف أن تحتنا هناك أناس يُعذَّبون ويتألمون. فالعودة كان لها معنى رمزي: أردت أن أعيش حالة أن سوريا قد صارت لنا وليس لبيت الأسد، حيث نقدر أن نمشي ونتأكد من أنه لا يوجد أسد. بالنسبة لي كان ذلك ضروريًّا جدًّا. عندما نزلنا بهذا البعد الرمزي، كان مذهلًا. حتى الآن ما زال الناس يتعوّدون أن يتحدثوا دون أن يخفضوا أصواتهم حين يتحدثون بالسياسة. جلسنا في أماكن بآراء سياسية مختلفة: مع أو ضد، يميني أو يساري، وكنا نتكلم بصوت عالٍ. وهذا حدث لا يُصدَّق.
د. ساري حنفي:
هناك صديق له علاقة بتلفزيون سوريا الذي كان يُبث من إسطنبول، وهو الآن يُبث من دمشق، قال لي: آخر شيء كنت أتخيله في حياتي أنني سأستمع إلى نقاش على التلفزيون السوري أشعر خلاله بأن هناك نقدًا زائدًا، وأتمنى لو أملك الجرأة لأقول للمذيع أو المذيعة: بالله عليكم اسكتوا هذه الأصوات الناقدة الكثيرة للنظام السوري الجديد! أي هناك ديناميات رائعة.
د. حسام الدين درويش:
هناك أمرٌ مهمٌّ: نحن نقول إن الشعب لم يمارس السياسة ولم يتعلمها، لكن هذه هي السياسة! السياسة ليست أمرًا بسيطًا، لها قواعد. فالمعارضة السياسية غير المعارضة الثورية. المعارضة السياسية مبدئيًّا تعني اعترافًا بالآخر: لك حقك أن تكون موجودًا، ولي حقي أن أكون موجودًا. السؤال هنا هو سؤال حدود، لا سؤال وجود. أمّا مع النظام السابق، فالمسألة كانت مسألة وجود. إما هو، وإما نحن. فإذن عمليًّا، سوريا لن توجد ولم توجد إلا بعد رحيله. السؤال: هل هذا النظام الحالي يجب أن تكون المعارضة فيه محدودة أم مطلقة؟ هذا سؤال مهمُّ ومطروح باستمرار. هناك في سوريا من لا يعرف المعارضة إلا بمعنى المعارضة الجذرية او الثورية، ويبدو أن المعارضة السياسية تبدو أحيانًا مائعة أو غير حازمة، ومع المعارضة السياسية يجب دائمًا أن يكون هناك إقرار بوجودك. أنا، بغض النظر عن الاختلافات الشديدة والانتقادات التي يمكن توجيهها لهذا النظام، أرى مبدئيًّا أنه ينبغي الإقرار بحق الوجود، في هذه المرحلة. بعد حق الوجود، قد نختلف كثيرًا.
د. ساري حنفي:
الشرعية الثورية الحقيقية هي التي أعطت النخبة الحاكمة سلطتها.
د. حسام الدين درويش:
ليس هكذا (فقط)، بل هناك ضرورات وتأييد، وإذا كان هناك من تعرض لهذا، فإن هناك أيضًا ضرورات واقع. ليس معنى ذلك أن الناس غير موجودين، انهيار النظام السابق ترافق بالفعل مع انهيار الدولة. عندما نقول دولة، نقصد مؤسساتها الأساسية: الأمن، الجيش، الشرطة، بما فيها شرطة المرور، وحتى الحدود. هل حدث في بلدٍ أن انهار فيه نظام ولم يبقَ أيّ أحد على الحدود؟ نتحدث عن حدود بمعنى الجوازات والجمارك، وحتى الحدود مع إسرائيل. لنفترض أن هذا أمر متفق عليه بين الجميع، أنه عدو محتمل قد يختلف فيه البعض، حتى الحدود تُركت بالكامل بكل المواقع العسكرية. إذا تحدثنا عن المؤسسات الأمنية والعسكرية والتربوية والخدمية، ففي هذا الوضع، من أين نأتي بالقوة؟ مثلاً، كان الحديث مؤخرًا عن ظهور ملامح دولة، وملامح مؤسسات لضبط النظام. في حالة الفوضى لن يفوز أحد، سيكون الجميع خاسرًا.
فبرأيي، نحن بحاجة إلى ضبط الأمور. هناك خوف من أن تُبنى الدولة على هوية واحدة، وهذا فيه مخاطر حقيقية، لكن نحن بحاجة إلى مؤسسات أولية وطنية وخدمية، إلخ. بالنسبة لي، إذا سمح الوضع، حتى الآن أفهم وجود المعارضة، إذا كانت مرنة. علينا التعامل مع المعارضة ضمن حدود؛ بمعنى معارضة سياسية إلى أن يثبت العكس. طالما يُسمح لنا بالمجال، دعونا نفتح المجال.
د. ساري حنفي:
حسام، هل أنت قلق على الحريات الفردية في الفضاء العام، في رأيك هل ثمة فترة هوياتية؟
د. حسام الدين درويش:
دعني أجيب بثلاث نقاط أساسية: أولًا، انتقلنا في سوريا من حالة الخوف إلى حالة المخاوف. حالة الخوف هي أن تكون في وضع لا يسمح لك أو لا تستطيع حتى التعبير عن خوفك، وهي حالة دولة الرعب التي كانت أسدية، حيث لم يكن بإمكانك حتى في بيتك أن تتحدث، وربما كنت تهمس خوفًا من الحديث، وهو قمع ذاتي. حاليًّا، هناك مخاوف كبيرة، ومن لا يعترف بهذه المخاوف، فهذا فيه شيء من عدم المعقولية. الوضع مأزوم ومليء بالاحتمالات السيئة، وهناك مخاوف كبيرة حتى الآن، لم تترسخ. وثمة إمكانية أن تقول إنها ليست مؤكدة وحتمية. والعلاقة بين التوجهات الإسلامية السياسية أو الحركات الدينية والحريات الاجتماعية، هي علاقة متوترة، وهناك خطر على بعض أبعادها.
كنا في ندوة منذ مدة مع الدكتورة مية الرحبي حول النسوية والعلمانية، قالت: حتى الآن، إذا نظرنا إلى الوضع في دمشق، لم يتغير الوضع عليّ مطلقًا من حيث حضور النساء في المجال العام. هناك تغييرات في بعض المناطق لأسباب مختلفة، لكنها ليست وضعًا يثير الرعب أو الخوف من قمع. أحيانًا تُتخذ بعض الإجراءات ثم يتم التراجع عنها، وهذا يترك المجال للمناورة السياسية. قد تكون هناك بعض التوجهات التي لا أراها مناسبة، لكنها ما زالت قابلة للمعارضة السياسية، وهذا ما يجب أن يحصل. تعرف أن الثورة هي خروج عن النظام وعلى النظام عندما لا يسمح النظام بالمعارضة أو بالنضال ضمن الإطار السياسي أو القانوني.
في هذه النقطة، وهي الأخيرة هنا، أن الثورة كانت كلمة إيجابية هائلة في سوريا. يعني، يمكن تحويل أي انقلاب إلى ثورة، لكن بعد ذلك، نحن قضينا 14 سنة ضمن الثورة ولها ثمن هائل، ودفع السوريون ثمنًا هائلًا في سبيلها. والثورة لا تحدث أكثر من مرة في العقد الواحد، بل تحتاج إلى أجيال. فبرأيي، نحن بحاجة إلى مرحلة للنضال السياسي، ويجب أن نسعى جميعًا إلى النضال السياسي طالما أهدافنا مشتركة، وهي: الحريات للجميع، والعدالة للجميع، والمساواة للجميع، والمواطنة للجميع؛ فهناك مجال للنضال السياسي.
د. ساري حنفي:
الدكتور حسام الدين درويش شكرًا جزيلًا على اللقاء الممتع في الحقيقة، وآمل أن يستمر تفاؤلك. كما تعلم، أنا أيضًا لدي تفاؤل حذر مثل تفاؤلك عن سوريا. لقد أخذت من وقتك، وشكرًا لحسن استماعك.
د. حسام الدين درويش:
شكراً لك، وإلى اللقاء في مناسبات قادمة.