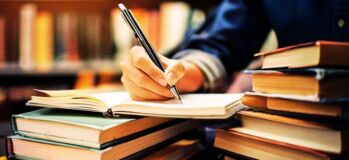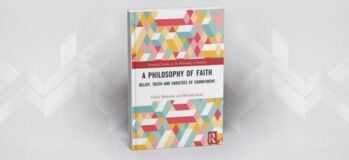اَلْبَحْثُ عَنِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ سْتِيفْن هَوكِينْغ
فئة : ترجمات

اَلْبَحْثُ عَنِ الْحَقِيقَةِ عِنْدَ سْتِيفْن هَوكِينْغ
تأليف: ألفريد دريسن[1]
تقديم وترجمة: الدكتور أحمد فريحي
من المعلوم أنَّ مصادرَ الحقيقة في المعرفة العلمية ترجعُ إمَّا إلى العقل، أو إلى التجربة؛ فالتَّجربة تسمحُ باستنتاج القوانين العلمية، الَّتي تفسِّر الظَّواهر الطَّبيعية؛ والعقلُ يصوغُ القواعد والمُعادلات الَّتي تصفُ الواقع على نحو صوري. وإذا كنتَ عالماً مُختصا، سواء في العلوم النَّظرية العقلية، أو في العلوم التَّجريبية الاختبارية، فإنَّك لا تخرج عن دائرة هذا الإطار الَّذي يُحيط بالعقل والتَّجربة. ولهذا، فإذا كان ستيفن هوكينغ لا يُؤمنُ بالله كخالقٍ للكون، فهذا أمرٌ طبيعيٌّ؛ لأنَّ الله ليس موضوع معرفةٍ بالعقل أو بالتجربة، وإنَّما هو موضوع إيمان خارجَ العقل والتَّجربة، وخارج المكان والزَّمن. لكنَّ يجب الإشارة إلى أنَّ الذين يُنكرون وجودَ الله من داخل المعرفة العلمية، يخلطون بين المَعرفة والإيمانِ؛ لأنَّ المعرفة تحصلُ بالتَّجربة، إما عن طريق الحواس لمعرفة الظَّواهر الكبرى، أو عن طريق وسائط لمعرفة الظَّواهر الصُّغرى، والمتناهية في الصِّغر، وتحصلُ بالعقل عن طريق البرهنة بالرِّياضيات والمنطق. ولهذا، فاللهُ ليس موضوعاً مرئياً بالحواس، ولا يُرى جهرةً، ولا حتى بوسائط؛ كما أنَّه لا توجدُ معادلةٌ قادرة على استخلاصِ اللهِ كنتيجةٍ من مقدماتٍ مفترضةٍ أو معلومةٍ. أمَّا الإيمانُ، فهو تسليمٌ بالقلبِ بوجودِ قوةٍ فاعلةٍ وخالقةٍ للكون.
إذا كانت التَّجربة مصدراً من مصادر الحقيقة، فإنَّها لم تصلْ بعدُ إلى قوانين ناتجة عن الاستقراء تمكننا من تفسير كل الظواهر، وتفسير الكون برمته؛ وإذا كان العقل مصدرًا فعالا في المعرفة العلمية، فإن وجود نظريات صحيحة من النَّاحية الصُّورية كنتيجة لعملية استنباطية، لا يعني بالضَّرورة أنَّها صادقة من النَّاحية الواقعية والتَّجريبية، فما يصحُ في العقل لا يصدق بالضَّرورة في الواقع. وإذا كانتِ العلوم قد استقلت عن الفلسفة، لَمَّا وجدتْ لها أجوبة، فهذا لا يعني انفصالها التَّام عنها؛ لأنَّه لا يخلو علمٌ من العلوم من أسئلةٍ فلسفيةٍ عالقةٍ. وعليه، ففي ظلِّ النِّسبية الَّتي تطالُ العقلَ والتَّجربةَ معاً، وفي ظلِّ ارتباط العلوم بالأسئلةِ الفلسفية، فما زالَ للإيمانِ مكانتُه عند الإنسان؛ لأنَّ العلوم لم تتوصل إلى الحقيقة النِّهائية بعد.
تناقش هذه المقالة الَّتي نترجم نصَّها مسألةً في غاية الأهمية، وهي: بحثُ العالِم الفيزيائي ستيفن هوكينغ عن الحَقيقة، وليست الحقيقةُ هنا سوى البحثُ عن سببٍ فاعلٍ في الكون، وبعبارة أوضح، البحث عن إمكانية وجود خالقٍ للكون. لقد أصدرَ هذا العالِمُ كتابين حقَّقا شهرةً منقطعة النَّظير؛ الأول صدر في حياته سنة 1988، وهو كتاب تاريخٌ موجزٌ للزمن، من الانفجار العظيم إلى الثقوب السَّوداء، والثاني صدر في السَّنة الَّتي تُوفي فيها؛ أي سنة 2018، وهو كتاب أجوبة موجزة عن الأسئلة الكبرى.
يصرِّح هوكينغ علانيةً في هذين الكتابين الرَّائعين بأنَّه عالِمٌ فيزيائيٌّ، يحقُّ له أنْ يبحثَ عن الحقيقةِ في الكونِ ويلامسَ القضية الدِّينية، لكنَّه يُوضِّح أنه لا يُملي على النَّاس ما يؤمنون به، ويُقرُّ بعدم وجودِ حدودٍ للكونِ، وبعدمِ وجودِ حافةٍ له، ممَّا يترتَّبُ عنه أنَّ الكونَ بلا بدايةٍ، وبلا نهاية، وهذا يترتَّب عنه كذلك عدمُ وجود مكانٍ للخالقِ فيه، وقد صرَّح في بعض الحوارات أنَّه مُلحد، كما كانَ يتصوَّر أنَّ لا وجود لسببية مُمكنةٍ من خارج المكان والزَّمن، مع فصله السبب عن النتيجة، وأنَّ كتاباته لا تندرج ضمن الكتابة الفلسفيَّة؛ لأنَّه يعتقد أنَّ الفلسفة ماتت، ما دامت لا تجيبنا عن سؤال الماهيات "لم؟".
لكنَّ القراءةَ الفاحصة للكتابين، كالَّتي قام بها مؤلفُ هذه المقالة، ألفريد دريسن، كشفتْ عن وجود عبارات فيهما، يُفهمُ منها أنَّه كان يعتقد في تتالي الأسباب، وأنَّ تصوُّرَه للسببية، وإن كانَ لا يختلفُ عن تصوُّر ديڤيد هيوم، فإنَّه هو نفسُه أو أقرب إلى تصوُّر الفيلسوف واللاهوتي توماس الإكويني في الدَّليل الثالث لإثبات وجود الله، وأقرب كذلك إلى المذهب الرُّبوبي، الَّذي يقرُّ بالنَّشاط العقلي، ويُنكرُ الوحي. كما أنَّه أقرَّ بأنَّه لو توصَّل العلمُ إلى نظريةٍ شاملةٍ، وموحِّدة لكلِّ شيء، فلنْ تكون هذه النَّظرية سوى صياغاتٍ على صورةِ قواعد ومُعادلاتٍ صورية، فما الَّذي نفخ الروح فيها لتصف الكون !؟ لا شك أنَّ هذا السُّؤال الاستنكاري يُخفي وراءَه خالقاً واجبَ الوجودِ كما أشار إلى ذلك توماس الإكويني في دليل الإمكان والضرورة المشار إليه، ثم إنَّ تشييع جنازَته في كنيسة له دلالةٌ روحيةٌ، وتقديرُه وامتنانُه لوجود تصميم عظيم في الكون يدلُ ربما على أنَّه خصَّ الامتنان لفاعلِ الكون ومُصمِّمِه، وكل هذه العبارات التي وردت عنه، تخفي وراءها لمسةً فلسفيةً، وإنِ امتنع عن اعتبارِها فلسفية.
يبقى ستيفن هوكينغ رجلَ العلمِ الاستثنائيَّ بامتياز، فهو ليس كأيِّ رجلِ علمٍ في التَّاريخ، إنَّه رجلُ التَّحدي، والصَّلابة، والقُوة؛ رجلٌ عاشَ لأكثر من خمسين سنة مَشلولاً، ومشدوداً إلى كرسيٍّ مُتحرك، بلا حراك، وبلا كلام، وجوده روحه التي تدخل وتخرج، وسلاحه عقله الذي يفكر به، ويترجم فكرَه على الحاسوب؛ ومع ذلك، صدرَ منهُ الامتنانُ لتصميم الكونِ.
ومُجملُ القول، فالمُشترك بين الإيمانِ وعدم الإيمان الصَّريحين هو الشَّك الخَّفي والباطني الَّذي يسكن كل واحد منهما؛ ففي قلبِ كلِّ مؤمنٍ توجدُ بذور الشَّك متناثرةً، ولا يمنعُها من النُّمو سوى الإصرارُ، والاستمرارُ في الإيمان من دون دليلٍ قاطعٍ يُذكر؛ وفي جُعبة كلِّ عديم الإيمان فراغٌ يسكنُه الشَّك، ولا يبقيه على عدم الإيمان سوى غيابُ الدَّليل القاطع. فغياب الدَّليل في كلتا الحالتين يجعلُ المؤمن وعديمَ الإيمان سيان، وفي مرتبةٍ واحدةٍ في منزلة الحقيقة. لكنَّ الإيمانَ تقتضيه الحكمةُ، ومهما فَرَّ الشَّخص من الإيمانِ بشيء، فالإيمان بشيء يطارده، ولنْ يفلحَ مطلقاً من الهروب من الإيمان، في عالم تسكنُه الألغاز. وعليه، فكلنا مؤمنون، لكنْ يجبُ أنْ يكونَ ما نؤمنُ به مفيداً لنا جميعا.
المقالة المُترجَمةُ:
استهلال:
لقد قدّم ستيفن هوكينغ في كتابه المشهور: تاريخ موجز للزمن: من نظرية الانفجار العظيم إلى الثقوب السّوداء، [3] نوعًا جديدًا من الأدب العلمي؛ وذلك من خلال ربط العلم الحديث بمسألة وجود الله. وقد واصل سعيه في هذا المضمار في كتابه الَّذي صدر بعد وفاته: إجابات موجزة عن الأسئلة الكبرى، [4] وراء البحث عن الحقيقة المطلقة. تُقدّم هذه المقالة الَّتي نحن بصدد كتابتِها تحليلًا فلسفيًا لهذا البحث عن الحقيقة من منظور الفلسفة الكلاسيكية عند كل من أرسطو وتوماس الإكويني. تُعدّ السَّببيةُ المفهوم المحوري الَّذي استعمله هوكينغ في هذه المسألة. وعلى الرغم من ذلك، ففي الأدبيات العلمية والفلسفية المعاصرة، يقتصر معنى هذا المفهوم على السَّببية الزَّمنية مقارنةً بوجهة نظر الفلسفة القديمة. فهذه الأخيرة هي الَّتي تقبل السَّببية من خارج المكان والزَّمن؛ أي تقبل واقعًا يتعالى على العالم المادي. وعلى الرَّغم من أنَّ هوكينغ يعرِّف نفسه بأنَّه مُلحد، إلاَّ أنَّ القراءة المتأنية لكتاباته، تُثير شكوكاً حول عدم إيمانه؛ وذلك ما سنعرضُ له في المناقشة.
تقديم:
لقد كانَ ستيڤن هوكينغ، قبل ثلاثين سنة مضت، من أكثر المؤلفين الَّذين حظيت كتبُهم بمبيعات أكثر، وذلك بفضل كتابه: تاريخ موجز للزمن. يُعتبر هذا الكتاب مميزًا من جهتين: مميزاً من جهة كونه حقَّق أكبر عدد من المبيعات ضمن فئة الكتب غير الرِّوائية، ومميزاً من جهة نطاق موضوعه، المتعلق بعلم الكونيات المتطور وعلاقاته بوجود الله. والأمرُ الَّذي يدل على أهميته يرجعُ كذلك إلى ما كتبه كارل ساغن[5] في آخر مقدمته لكتاب هوكينغ لمَّا قال: إنَّ هذا الكتاب يملأ لفظ "الله" كلَّ صفحاته. وهكذا، يتبع هوكينغ تقليدًا فلسفيًّا قديما: إذ يُمكن القول إنَّه تتبع سلسلة من الفلاسفة، ممتدة منذ ثلاثة آلاف سنة، طالت أرسطو ومؤلفين من العصور الوسطى مثل توماس الإكويني.[6] فقد تناول هذان الفيلسوفان في آرائهما الميتافيزيقية كلَّ الحقائق، بما في ذلك المُحرِّك الأول، والسَّبب الأول؛ اللذان عُرِّفَ الله بهما، واعتبر هو المُحرك الأول، وهو السَّبب الأول. إنَّهما لم يفعلا ذلك بدافع الإيمان. كلاَّ، لقد استعملا فقط التجارب البشرية الشَّائعة والأقل شيوعًا في عصرهما؛ أي استعملا العلم البدائي، بالإضافة إلى قوة العقل. وخلافًا لهذين الفيلسوفين القديمين، يتميز ستيفن هوكينغ بالاعتماد على البحث العلمي الَّذي تراكم منذ قرون بعد نشأة العلم الحديث حتى العلم المعاصر، بدلًا من العلم البدائي اليوناني القديم، أو المعرفة التي كانت سائدة في القرون الوسطى. لقد دعَّم أدلتَه باكتشافات خاصة، مثل التبخر الكوانطي للثقوب السَّوداء، وما يُسمى بإشعاع هوكينغ، [7] أو باقتراح اللاحدود.[8]
يبدو أنَّ الفلسفةَ المعاصرة تُفضّل مُقاربات أخرى في تناول كتاب هوكينغ، ولم تهتم بالمقاربة الميتافيزيقية اللهم إلاَّ بعض الدراسات القليلة، من قبيل مقالة كريغ "أي مكان للخالق إذن؟ هوكينغ حول الله والخلق"[9]، وكتاب سميث "مدخل إلى المسيحية"[10]، ومقالتي "مسألة وجود الله في كتاب ستيفن هوكينغ تاريخ موجز للزمن".[11] ويمكن الاطلاع على مقالة بيك "مراجعة ببليوغرافية للدليل الكوني.[12] كما يناقش سبيتزر أعمال هوكينغ في سياق التَّطورات المعاصرة في علم الكونيات في كتابه "أدلة جديدة على وجود الله: مساهمات الفيزياء والفلسفة المعاصرة".[13] إنَّ هوكينغ لا يرى كتاباته فلسفية، وإنَّما الأمر بخلاف ذلك، فهو يعتقد أنَّ الفلسفة ماتت.[14] ففي تصوُّره، ينبغي للفلسفة أنْ تُجيب عن "الأسئلة المتعلقة بسؤال لم". ومع ذلك، في التأملات الفلسفية حول نتائج العلم المعاصر، لا يُمكنها مواجهة "الإجابات عن السؤال لم" المتوقعة. وقد أشاد، في الآونة الأخيرة، كلٌّ من الباحثين، ويلكينسون وهوتشينغز[15] بمزايا عمل هوكينغ؛ لأنَّه خلقَ فرصًا جديدة لفهم أفضلٍ لله.
قد يُرسِّخُ كتاب تاريخٌ موجزٌ للزمن قناعةَ عند قرائه بوجود الله أو قد يُفنِّدها، لكن هذا لا يُؤثر في أهميته الأساسية، وهي الارتقاء بالدَّليل العلمي على وجود الله إلى مستوى أكاديميٍّ يُثيرُ اهتمام ملايين القراء. وفي كتابه الأخير الَّذي صدر بعد وفاته، والذي يُعدّ من أكثر الكتب مبيعًا كذلك، يكتبُ عن أهمية مسألة وجود الله قوله: «لقدِ انزعجَ النَّاسُ مِنْ أنْ يكونَ للعالِم رأيٌ في مسألة الدِّين. وإنَّني لاَ أرغبُ في أنْ أُملي على أحدٍ ما يُؤمن به، لكن بالنِّسبة إلي، السَّؤال عن وجود الله سؤالٌ مشروعٌ في مجال العلم. ففي النَّهاية، يصعبُ التَّفكير في لغزٍ أهم أو لغزٍ جوهري من خلال طرح السُّؤال: من خلقَ الكونَ ومن يتحكَّم فيه؟»[16]
تتناولُ هذه المقالة البحثية الَّتي نحن بصدد كتابتِها العناصر الآتية: فبعد المقدمة، نُقدِّم الإطار الفلسفي لكتاب تاريخ موجز للزمن، وفيه نلاحظ أنَّ هوكينغ يُفنِّد النَّظرة الرُّبوبية لأصلِ الكون. وبدلاً من ذلك، يُظهر هوكينغ، بأسلوبٍ غنائيٍّ جميل، دليلا آخر يُشبهُ الدَّليل الثالث لتوماس الإكويني لإثباتِ وجود الله. بعد ذلك، ومن أجل الربط بين الموضوعين، سنوظِّف أدلة من الفلسفة القديمة، ومن العلم المعاصر للتأكيد على وجود سببية من خارج المكان والزَّمان. وفي المناقشة الأخيرة، سنركِّز الاهتمام مجددًا على موقف هوكينغ، الَّذي يُظهِر عالمًا يبحثُ عن الحقيقة المُطلقة.
1. الإطارُ الفلسفيُّ لكتاب "تاريخٌ موجزٌ للزمن"
لمَّا يكونُ لديكَ إلمامٌ بالفلسفة، وتتأملُ هذا الكتاب الرَّائع، تجد أنَّ المفهومَ المِحوري الَّذي تدورُ الرحى حوله يتجلى في مفهوم السَّببية. فمع هذا اللَّفظ، يبدأ سوء الفهم، ومعه تبدأ الصُّعوبات. فماذا يمكن أنْ يُقال، على سبيل المثال، عن السَّبب الأول؟ أيعني كونَه سبباً أولا، بمعنى أنَّه الأول في الزَّمنِ، أم إنَّه يفيدُ الأول في التَّسلسل الهرمي؟ إنَّ معظم العلماء يفضلون المعنى الأول؛ أي إنَّه الأول في الزَّمن بما يتفقُ مع وجهة نظر ديفيد هيوم. فهذا الأخير يقدِّم تعريفًا للسبب من خلال قوله: «ليكون السَّبب سبباً، يجبُ أنْ يكونَ موضوعٌ آخر يترتبُ عنه، حيثُ تكون كلٌّ الموضوعات المشابهة للسبب الأول مترتبة عن الموضوعات المُشابهة للسبب الثاني.»[17]
إنَّنا لا نجدُ في هذا التَّعريف الَّذي قدَّمه هيوم إشارةً صريحةً إلى الزَّمن. ومع ذلك، لمَّا نُمْعن النَّظر فيه جيداً، من خلال قوله إنَّ حدثًا يترتَّب عن حدثًا آخر، يبدو أنَّ "التالي" المترتِّب عن الأول يفيد التتالي الزَّمني على وجه الحصر.
تتضمنُ الأدلة الموجودة في دراسة سابقة قمت بها[18] مناقشةً لمفهوم السَّببية في فلسفة أرسطو وفلسفة توماس الإكويني القديمتين. ففي أعمالهما، نجدُ معنىً أوسع للسبب. كما يتناولان الآثار الناتجة عن سبب يعملُ في الوقتِ الحاضر، ولا يعمل بالضرورة في الماضي. وتعتمدُ أدلة وجود الله؛ أي تلك الأدلة الخمسة للفيلسوف واللاهوتي توماس الإكويني، بشكلٍ حاسم على هذا المعنى الأوسع.
وفي هذا السَّياق، من المفيد أنْ نقتبسَ من كاليب كوهوي قوله: «إنَّ مفهوم توماس الإكويني للسببية أوسعٌ بكثير من المفاهيم المُعاصرة الشَّائعة عنها اليوم. ففي المفهوم المعاصر السَّائد، تُعتبر السَّببية علاقةً فردية بين حدثين، بحيث يكونُ الحَدث المُسبِّب سابقًا زمنيًا عن الحدث المُسبَّب. أمَّا عند توماس الإكويني، فالسَّببية تطالُ أيَّ نوعٍ من التَّرتبُ الوجودي بين الأشياء: فهي من حيثُ الأساس علاقةٌ عموديةٌ، وليست علاقةَ أفقيةً.»[19]
يُقدِّم هوكينغ، مثل معظم العلماء، تعريفًا للسبب مشابهًا للتَّعريف الَّذي قدمه ديڤيد هيوم من خلال قوله: «في داخل الكون، كنتَ تفسِّر دائمًا حدثًا واحدًا على أنَّه ناتج عن حدثٍ سابقٍ.»[20]
وبناءً على ذلك، يبدأ دليلَهُ بملاحظة: أنَّه لو وُجدَ خالقٌ، لكانَ عليه أنَّ يكونَ فاعلاً منذ البدء. وهذا يجعل كلَّ شيءٍ يحدثُ وفقًا لقوانين الطَّبيعة على نحو حتمي. وقد تقعُ أحداثٌ غير متوقعة، ولكنَّها تقعُ بمحض الصُّدفةِ والاتفاقِ. ويمكنُ ملاحظة هذا النَّوع من الأحداث العَشوائية في العالم المجهري لميكانيكا الكوانطا، وكذلك في التَّطور البيولوجي. وحسب تصوُّره، فإنَّ أيَّ افتراض للتدخل الإلهي بعد فعل السَّبب الأولِ سيكونُ مناقضًا للعلم.
فإذا حلَّلنا رؤية هوكينغ، يتضحُ تشابهُها الوثيق مع المذهب الرُّبوبي؛ إذ يُشدد هذا المذهب الفلسفي على القدرة الفكرية للعقل البشري، ويرفض أيَّ وحيٍّ خارقٍ للطبيعة. ووفقًا لبرن، يفترضُ المذهبُ الرُّبوبيُّ أنْ يكونَ اللاهوتُ الطَّبيعي هو الدِّين الحق؛ ويصفه هذا الأخير من خلال قوله: «يتضمنُ اللاهوتُ الطَّبيعيُّ مجموعةً من الحقائق حولَ اللهِ وعلاقتِه بالعالمِ، والَّتي يمكنُ اكتشافُها باستعمال العقل البشري غير اللَّدني، ويتناقضُ مع مجموعة من الحقائق، من قبيل اللاهوت المُوحى به، الَّذي يمكنُ اكتشافه فقط بالتأملِ في الوحي الإلهي في التَّاريخ.»[21]
تجدر الإشارة إلى أنَّ "العقل البشري" في الاقتباس يفترضُ سببية بالمعنى الضَّيق؛ أي يفترض السَّببية الزَّمنية فقط، بما يتوافقُ مع تعريفي كلّ من هيوم وهوكينغ المذكورين آنفًا. ويتضمنُ مفهوم الرُّبوبية عدة مواقف مختلفة بشأن الله. فمعَ عصر التَّنوير، اتجهت فكرةُ الله نحو إلهٍ ذي قدرة محدودةٍ، يتصرفُ بقدرته على نحو حصريٍّ في البدء دون أنْ يتدخل في الشُّؤون الجارية.
وبالرُّجوع إلى كتاب "تاريخ موجز للزمن"، يُلاحظُ أنَّ جزءًا كبيرًا منه مُوجَّه لدراسة سلسلة الأسباب من الحاضر إلى الماضي. ويخلُّص فيها هوكينغ إلى استحالة تحديد نقطة أولى فريدة في تاريخ الزَّمن. ويُلخِّص نتائجَه على النَّحو الآتي: «لو كانَ للكون بدايةً، لكانَ من المُمكن افتراضُ وجودِ خالقٍ له. ولكن، إذا كانَ الكونُ مكتفيًا بذاته على وجه الكمال، وبلا حدود وبلا حافة، فلنْ تكونَ له بدايةٌ ولا نهايةٌ: وسيكون موجودًا وكفى. فأيُّ مكانٍ فيه للخالقِ إذن؟»[22]
يتوصلُ هوكينغ هنا إلى استنتاج جوهري: فهو ينطلقُ من مفهوم السَّببية الَّذي ينطوي على الفصل الزَّمني بين السَّبب والنَّتيجة، مستعملا المعرفة العلمية فقط. ونتيجةً لذلك، يطرحُ تساؤلًا حولَ دور اللهِ كخالق. ففي كونٍ تحكمُه قواعد الفيزياء، ولا توجدُ ولا نقطةٌ واحدةٌ في بداية سلسلة الأسباب الزَّمنية. وعليه، فلا مكانَ في هذا الكون لله كخالق. الآن، يمكنُ التَّوصل إلى استنتاج مهمٍ بشأن المذهب الرُّبوبي. بافتراض هذه النَّظرة للواقع؛ أي قبول المنطق البشري فقط، والسَّببية الزَّمنية فقط، ويصبحُ وجود الله خالقًا أمرًا غير ذي جدوى. وبعبارة أخرى، ينفي هوكينغ صحة مقاربة المذهب الرُّبوبي.
بعد نشر كتاب "تاريخ موجز للزمن" سنة 1988، قدَّم الباحثون الثلاثة: بورد وغوث وفيلينكين دراسةً ذكروا فيها ما يلي: «يظهرُ دليلُنا أنَّ الخطوط الجيوديسية الصِّفرية والزَّمنية، بشكل عام، غير مكتملة في الماضي في النَّماذج التَّضخمية، سواء كانتْ شروط الطَّاقة صحيحة أم لا.»[23]
ينبغي قراءةُ عبارة "غير المُكتملة في الماضي" في هذا الاقتباس بوصفها "تتطلبُ وجود حدٍّ للزمن الماضي".[24] ويُطرح السُّؤال الآن عمَّا إذا كانتْ هذه النتيجة تتعارضُ مع اقتراح هوكينغ بعدم وجود حدود للكون، كما هو موضَّح، على سبيل المثال، في الاقتباس المذكور أعلاه. وهذه النقطة تترك للنقاش عند المختصين. لذلك، يبدو أنَّ إدخال الزَّمن التَّخيلي، [25] كفيل بتبين الطَّريق الصَّحيح لتجنب استنتاج نظرية بورد وغوث وفيلينكين.[26]
ربما يجدرُ بنا أن نلخِّص وجهة نظر هوكينغ في كتابه تاريخ موجز للزمن، انطلاقاً من أول الصَّفحة 173 إلى الصَّفحة 178، حيث يبدأ بتعريف مفهوم السَّببية، الَّذي يطالُ كلَّ حالات الفصل الزَّمني بين السَّبب والنتيجة. وعليه، فهو يبحثُ عن إله محتمل الوجود في الماضي فقط. فما دامَ كلُّ شيءٍ يتطَّورُ في الكون وفقًا للقوانين العلمية، فلا حاجة إلى خالق للكون. ففي الحدود أو التفرد فقط، حيث تنهار قوانين الفيزياء، ويمكن للخالق محتمل الوجود أن يتصرفَ. وباستعمال نظرية الجاذبية الكوانطية، يستطيع هوكينغ الآن طرح احتمالية عدم وجود حدودٍ للزمن والمكان. ومع ذلك، تُقدّم كلُّ الأدلة على نحو افتراضي على النحو الآتي: لو كانت هناك سببية مرتبطة بالزَّمن فقط، فلا مكانَ للخالقِ في الكون. هل هذه هي الكلمة الأخيرة الَّتي قد يقولها العلم بشأن وجود الله؟ لم يتخلَّ هوكينغ نفسه عن سعيه وراء الحَقيقة المطلقة. فهو يُقدّم الآن في جملتين منفصلتين دليلاً جديداً على نحو كليٍّ بقوله: «فحتَّى لو كانت هناك نظريةٌ مُوحِّدةٌ واحدةٌ ممكنة، فهي مجرد مجموعة من القواعد والمُعادلات. وما الَّذي ينفث لهيب النار في هذه المُعادلات، ويصنع كونًا تصفُه هذه المعادلات؟»[27]
في هاتين الجملتين، يُفرّق هوكينغ بين القواعد أو المُعادلات، من جهة، والواقع؛ أي الكون من جهة ثانية. في مقالتي الَّتي عنوانها "مسألة وجود الله في كتاب ستيفن هوكينغ: تاريخ موجز للزمن"، ناقشت الأسباب الأربعة الكلاسيكية: السَّبب المادي، والسَّبب الصوريّ، والسَّبب الفاعل، والسَّبب الغائي.[28] يرتبطُ مجموعُ القواعد والمعادلات، بطريقة ما، بالصِّياغات؛ أي بالجوانب الصُّورية. ويخلُص هوكينغ، في الاقتباس السابق، إلى أنَّ الجوانب الصُّورية وحدَها لا تكفي لتفسير النتيجة؛ أيْ تفسير الكون في هذه الحالة تحديدًا، وهناك حاجة أيضًا إلى السَّببِ الفاعِل.
يمكن توسيع نطاق التَّحليل الفلسفي الآن ليطال القواعد والمعادلات. تُعبَّر هذه القواعد عن نفسها بلغة الرياضيات، وتُوفِّر الشَّرط المنطقي الضروري للواقع. إنَّها توفر الشَّرط الأول؛ أي لكي يصبح الشَّيء حقيقيًا، يجبُ أن يكونَ مُتسقًا، وخاليًا من التَّناقض الدَّاخلي. على سبيل المثال، يُمكن الحديثُ عن الدَّائرة المربعة. وبما أنَّ هذا المفهومَ مُتناقضٌ، فإنَّه لا يبدو كشيءٍ واقع. وإنَّما الأمر بخلاف ذلك، فوفقًا لقوانين المنطق، فإنَّ ما هو مُمكن على المستوى الصُّوري، لا يوجدُ بالضَّرورة في الواقع. إنَّ الاحتمال المنطقي لا يكفي لضمان الوجود. يمكن الحديث مثلا عن استعمال الأجهزة الإلكترونية في العصور الوسطى. هذا لو كانت قوانين الفيزياء آنذاك هي نفسها الَّتي كانت سائدة في القرن العشرين، ولكن، لم يكن أحد حينئذٍ يمتلكُ المعرفة الكافية والتِّقنية المُتقدِّمة لدراسة هذه الأجهزة أو حتَّى تصنيعها.
إلى جانب الخاصية المنطقية، يبدو أنَّ هناك ضرورةً أخرى تتجلى في وجود فاعلٌ قادرٌ على تحويل المُحتمل، أي الوجود المُمكن [الوجود بالقوة]، إلى شيءٍ موجودٍ بالفعل. فقد، ركّزتُ في مقالتي، المشار إليها سابقا، النقاش حول هذه المسألة. مع ذلك، لم تُعنَ الأدلة هناك بإثبات وجود الفاعل بقوةٍ إبداعيةٍ كافية، وإنَّما اقتصرت على إمكانية وجودِه. فبعد قبول هذا الفاعل، أصبحت العلاقةُ الصَّعبةُ بين الواقع، والنَّشاطِ العقليٍّ واضحةً.[29]
لقد صاغَ توماس الإكويني الأدلة الخَمسة لإثبات وجود الله المعروفة. وفي الدَّليل الثَّالث، يُقدّم دليلاً نجدُه مُجدَّدًا في منطق هوكينغ. ولكي نوضِّح ذلك، يُقدّم برين ديڤيز ترجمة هذا الدَّليل من لسان توماس الإكويني جاء فيه: «إنَّ الدَّليل الثَّالث لإثبات وجود الله مبنيٌّ على ما لا ينبغي أنْ يكون، ومبني على ما يجبُ أنْ يكون، ويسلكُ هذه الدَّليل النَّحو الآتي: إذا كانت بعض الأشياء الَّتي نصادفُها من ممكنة الوجود، ولا توجد بالضرورة، لأنَّنا نجدها تتولد وتُفنى، توجد تارة، ولا توجد تارة أخرى، فلا يمكن أن يكون كلُّ شيء على هذا النَّحو؛ لأنَّ الشَّيء الَّذي لا ينبغي أنْ يُوجد، لم يوجدْ مطلقا في يوم من الأيام؛ وإذا لم يوجدْ كلُّ شيء بالضَّرورة، فإنَّه لم يوجدْ هناك شيء في يوم من الأيام. ولو كان هذا صحيحًا، لما كان هناك شيءٌ حتى الآن، لأنَّ الشَّيء غير الموجود لا يمكن أنْ يبدأ في الوجود إلاَّ من خلال شيءٍ موجودٍ بالفعل. وإذا لم يكن هناك شيءٌ في الوجود، فلا يمكنُ أنْ يبدأ شيءٌ في الوجود، ويكون العدم موجودا الآن، وهذا خطأ صريحٌ. إذن، فليس كلُّ شيء من النَّوع الَّذي لا ينبغي أنْ يوجدَ؛ وهناك بعض الأشياء يجب أن توجدَ، وقد تدينُ، أو لا تدينُ بالضرورة في وجودها لشيء آخر. ولكن كما أثبتنا أنَّ سلسلة الأسباب الفاعِلة لا يمكن أنْ تستمر إلى الأبد، فكذلك سلسلة الأشياء الَّتي يجب أنْ تُوجدَ وتدين في وجودها لأشياء أخرى. لذلك، نُضطر إلى افتراضِ شيءٍ ما يجبُ أنْ يوجدَ بذاته، وذلك لعدم وجودِ شيءٍ خارجَه، وإنَّما لأنَّه هو نفسُه السَّبب في وجوبِ وجود الأشياء الأخرى [هنا نتذكر "واجب الوجود" عند ابن سينا]. وهذا ما يُسمِّيه الجميعُ الله.».[30]
يبدأ توماس الإكويني دليلَه بملاحظة أنَّ هناك موجودات، موجودة، لكنها ليست موجودة بالضرورة: إنها موجودات طارئة. فلا يوجدُ ما يمنع وجودها من حيث المنطق أو من حيث القوانين الطَّبيعية، ولكن لا يوجدُ أيضًا ما يمنعُ عدم وجودها. انظر مثلا وجود الدَّيناصورات خلال فترة محددة من تاريخ الأرض. فلو كانت كلّ الموجودات طارئة، لوجب علينا النظر في الوضع الَّذي وصفَه توماس الأكويني بأنَّه: في قديم الزَّمان، لم يوجدْ هناك شيء. ويصلُ هوكينغ، بفضل امتلاكه إطارًا رياضيًا صوريا متطورًا للغاية، إلى موقف مماثل عند دراسة الموجودات التي تعتبرُها قوانين الطبيعة ممكنة، والَّتي لمْ تُوجد بالفعل بعد في الواقع. لقد قارنت في مقالتي[31] هذا بالواقع الافتراضي المُولّد في لعبة حاسوبية، فهو ليس الواقع الفعلي. فإذا قال هوكينغ في الدَّليل الأول: «فحتَّى لو كانتْ هناك نظرية موحِّدة واحدة ممكنة، فهي مجرد مجموعة من القواعد والمعادلات.»[32] فإنَّه يقول في الدَّليل الثاني مُستنكراً: «فما الشَّيء الَّذي ينفثُ لهيبَ النَّار في المُعادلات، ويجعلُها تصفُ الكون؟»[33]
يتضمن هذا السُّؤال إفادةً مُهمَّةً. وهي أنَّ القواعدَ والمعادلاتِ لا تقدِّم إجابةً؛ وإنَّما يجبُ النَّظر خارج نطاق الرِّياضيات والعلوم. لذلك يُضطر توماس الإكويني بدوره إلى افتراض شيءٍ لا بدّ أنْ يكون موجودًا في حد ذاته. وببحثه حيثُ وجد هذا المُوجِد الاستثنائي، ويستنتجُ أنَّ هذا المُوجِد هو ما يُطلق عليه الجميع اسم الله.
تتبادر إلى ذهني ملاحظة موجزة يمكن عرضها كالآتي: إذا كان هوكينغ يشكو من موتِ الفلسفة، فإنَّه هو نفسه يُقدّم عبارات ميتافيزيقية عميقة. وإن كان لمْ يستعملْ لغة الفلاسفة التِّقنية بالطَّبع، فإنَّه قدّم جملتين رائعتين تتضمنان قوة إقناعية.
2. السَّببيَّةُ من خَارجِ المَكانِ والزَّمنِ
لقد طرحتُ، في القسم السَّابق، وجهتي نظر مختلفتين من حيث الجوهر حول السَّببية: وجهةُ نظر ديڤيد هيوم الَّذي يرى أنَّ السَّبب والنتيجة قد يكونان في آن واحد، أو يكونان حتى خارج الزَّمن، ثم وجهة النظر المتعلقة بقوة الأدلة لإثبات وجود الله، الَّتي تقوم بالأساس على تطبيقِ مفهوم السَّببية.
من المفيد أنْ نقدِّم نصاً مقتبسًا من كتاب "الطَّبيعة" لأرسطو على سبيل المثال، ويتعلق هذا النَّص بالمُتحرك الَّذي لا يتحركُ، قال أرسطو: «إنَّ العصا تُحرِّكُ الحَجرةَ، والعَصا تحركُها اليدُ، واليدُ يُحركُها الشَّخصُ: وقد وصلنا في الشَّخص عند حركة ليست كذلك، حركةُ سببُها شيء آخر [يقصد هنا المُحرك الأول، الَّذي لا يتحرك].»[34]
يصفُ أرسطو هنا سلسلة العوامل المُحركة (أو الأسباب) المُؤثرة في تحريك العصا. ونرى أرسطو في هذا النَّص المُقتبس يستعملُ صيغ المُضارعة في الأفعال على المستوى النَّحوي. ممَّا يدلُ على أنَّ كلَّ العوامل المُحركة تعملُ في آنٍ واحدٍ؛ فإذا توقفَ أحدُها عن الحَركة، تبقى الحَجرةُ ساكنةً.
وإذا تقرَّر هذا، فماذا يمكنُ القول عن العلم الحديث؟ فمنذ إنشتاين ونظريته النسبية، أصبح من المعروف أنَّ التَّزامن، وما قبل وما بعد، ليس لها تعريف واحد. فالزَّمن أصبحَ متغيرًا، وتابعًا يتغيَّر بتأثير مجالي الجاذبية والسُّرعة. والأكثر إثارة للدهشة أنَّ نظرية النِّسبية تنصُ على أنَّ الفَترات الزَّمنية، بالنِّسبة إلى الجزيئات عديمة الكُتلة، وتتقلَّص إلى العدد صفر. وقد ألّف فوكر، وهو فيزيائي هولندي عمل لفترة قصيرة مع إنشتاين، كتابًا موضوعه النَّسبية، كتب في مقدمته ما يلي: «لعلّ أعمقَ لغزٍ كشفَته الكرونوجيومترية هو حدوثُ فتراتٍ صفرية، تربط الأحداث الَّتي يحدٍّدها الرَّاصدون بمسافة مكانية، ومدة زمنية بينها. فالفاصلُ الصِّفري لا يعني انعدامَ الفصلِ إطلاقًا، وإنَّما هو انتقالٌ فوريُّ لكمية الحركة والطَّاقة، كما لو كانَ هناك اتصال [...]. إنَّ الصِّيغةَ الرِّياضية بسيطةٌ وواضحةٌ، ومع ذلك، فهي تتعلقُ بأحدِ أسرارِ الله، وتشيرُ إلى وجوده الأبدي في كلِّ مكان.»[35] ويعبِّر بينروز عن نفسِ الفكرة بقوله: «والنُّقطة هي أنَّه وفقًا لجزيء عديمِ الكتلة، فإنَّ مرورَ الزَّمن لا يُساوي شيئًا.»[36]
ونجد في ميكانيكا الكوانطا أيضًا، أنَّ اللاَّمكان واللاَّزمان لهما أهمية في فهم أساسيات هذه النَّظرية. وهناك العديد من التَّجارب في ميكانيكا الكوانطا الَّتي تُشير إلى السَّببية من خارج الزَّمن؛ وللاطلاع على ملخَّص حول هذه المسألة يمكن قراءة مقالتي "السَّببية من خارج الزَّمن".[37]
لقد سبقَ أنِ استشهدْنا بقول هوكينغ، الَّذي جاء فيه: «فحتى لو كانتْ هناك نظريةٌ موحِّدة واحدة ممكنة، فهي مجرد مجموعة من القواعد والمعادلات. فمَا الَّذي ينفثُ لهيبَ النَّار في المُعادلات ويصنعُ كونًا تصفُه هذه المعادلات؟»
إنَّ "القواعد والمعادلات" تتضمنُ عباراتٍ حول مكانِ وزمن الجُزيئات والأحداث. وترتبط هذه المعادلات، في النَّظرية النِّسبية، بالزَّمن في أماكن مختلفة، الَّتي قد يحدثُ فيها انكماش زمني. لنفترض مثلا، ساعة على الأرض، وساعة بعيدة في مجرة بعيدة داخل كوننا الواسع. يبدو أنَّ السَّاعة البعيدة تتأخر، أو حتَّى تقتربُ من السُّكون التَّام في مجالات الجاذبية العالية بالقرب من ثقب أسود.[38] وتشيرُ هذه النِّسبية بين الزَّمن والتَّزامن في الفيزياء المعاصرة إلى خاصية فريدة للفاعلِ القادر على "نفث لهيب النَّار" داخلَ هذه المجموعة من القواعد والمعادلات. فلا ينبغي إخضاعُ هذا الفاعلِ لهذه "القواعد والمعادلات". ينبغي أنْ يأتي لهيبُ النَّار من الخارج؛ وينبغي أنْ يتجاوزَ الفاعلُ الكونَ الَّذي "يصنعُه"، ليس فقط فيما يتعلق بالمكان، وإنَّما فيما يتعلق بالزَّمن أيضا. لذلك، ويمكنُ للمرء أنْ يستنتجَ بكل ثقة أنَّ هوكينغ في هذا الاقتباس يفترضُ ضمنيًا وجود سببية من خارجِ المكانِ والزَّمنِ.
إنَّ مفهوم الخالق المُستعمل في الجزء الأول من كتابه تاريخ موجز للزمن يتوافقُ مع الرُّؤية الرُّبوبية: فإذا وُجدَ خالقٌ، فهو مُلازم للإطار المكاني والزَّمني الَّذي يطالُ الكون. وتتمثلُ مكانته الخاصة في علاقته بالبداية الزَّمنيةِ للكون. يوضح ويليام كارول، المُتخصِّص في فلسفة توماس الإكويني بجامعة أكسفورد، أنَّ الخلقَ مفهوم ميتافيزيقي، ولا يفيد التَّغيُّر أو البداية، قال: «إنَّ الخلقَ، من حيثُ الأصلُ، ليس حدثًا بعيدًا، وإنَّما هو السَّببُ المُستمر والكامل لوجود كلِّ ما هو موجود. وفي هذه اللَّحظة بالذَّات، لو لمْ يكنِ اللهُ هو السَّببُ في وجود كلِّ ما هو موجود، لمَا كان هناك شيءٌ على الإطلاق. ويتعلقُ الخلقُ بأصلِ الكونِ، ولا يتعلق ببدايتِه الزَّمنية. فمن المُهم إدراك هذا التَّمييز بين الأصلِ والبِداية.»[39]
تستعملُ البراهين القديمة على وجود الله الَّتي قدَّمها أرسطو، وتلك الَّتي صاغها توماس الإكويني، المعنى الغني للفظ "الله" (أو الخالق)، كما فسَّرها كارول. أمَّا أقوال هوكينغ، فتتناولُ في الغالب المفهوم الدِّيني المحدود للفظ "الخالق". وفي هذا السِّياق، ربما ينطوي اقتباس هوكينغ الشَّهير من كتاب تاريخ موجز للزمن عن الخالق، على حقيقة أعمق ممَّا كانَ مقصودًا في البداية، في قوله: «لو كانَ للكون بدايةً، لكان من المُمكن افتراضُ وجودِ خالقٍ له. ولكن إذا كانَ الكونُ مكتفيًا بذاته تمامًا، وبلا حدود وبلا حافة، فإنَّه لنْ تكون له بدايةٌ ولا نهايةٌ، وسيكونُ موجودًا وكفى. فأيُّ مكان إذن للخالق؟»[40]
إذن، فلا مكانَ لوجودِ خالقٍ في إطار الزَّمن والمكان، لا للخالق الرُّبوبي، ولا لإلهِ الدَّليل القديم. لأن هذا الأخير يتجاوزُ الكونَ الَّذي خلقَه تمامًا؛ ويتجاوزُ الزَّمنَ والمَكانَ.
3. مُناقشة
لقد بدا ستيفن هوكينغ، في القسمين السَّابقين كأنَّه عالمٌ يسعى بصدقٍ لإيجاد أجوبة للأسئلة الكبرى. ولكن، هل يُمكن أنْ يكون الدَّليلُ المذكور أعلاه مُبالغًا فيه بشأن موقفه؟ وهلِ اعتبر نفسَه غير مُلحد؟ لقد رد عن سؤال قدَّمه له بابلو غوريغي[41]، في مقابلة أجراها معه موضحاً بقوله: «قبل أنْ نفهمَ العلمَ، كانَ من الطَّبيعي الإيمانُ بأنَّ اللهَ خلقَ الكونَ. لكن الآن يقدِّم العلمُ تفسيرًا أكثر إقناعًا. إنَّ ما قصدتُه بـقولي: "سنعرفُ عقلَ اللهِ" هو أنَّنا سنعرفُ كلَّ ما كانَ سيعرفُه اللهُ لو كانَ هناك إله، وبما أنَّه غير موجود، فأنا مُلحِدٌ.»[42]
هناكَ وصفٌ شيِّقٌ لجنازة هوكينغ قدَّمته ابنته لوسي. تصفُ فيه بشيءٍ من التَّفصيل وصولَ النَّعش إلى الكنيسة العظيمة للقديسة مريم في كامبريدج.[43] أيتعلقُ الأمرُ هنا بمسألةً اجتماعيةً تُتيح إقامةَ جنازةٍ في كنيسةٍ مسيحية، أم كان ذلك بناءً على وصيته؟ وما موقفه من تشييع جنازته في الكنيسة؟
من الجدير بالذِّكر أنْ نقتبِس نصًّا حول هذه المسألة أدلى به ليونارد ملوديناو، الَّذي شارك في تأليف العديد من الكتب مع هوكينغ، وقد علَّق على الجنازة بقوله: «أشارت بعضُ كلماتُ التَّأبين إلى تناقض تشييع جنازة ستيفن هوكينغ في الكنيسة، مع أنَّه لمْ يكن يؤمنُ بالله. لكن الأمرَ بدا لي منطقيًا، فعلى الرَّغم من إيمان ستيفن العقلي والرَّاسخ بأنَّ قوانين العلمِ تحكمُ كلَّ ما يحدُث في الطَّبيعة، فإنَّه كانَ رجلاً روحانيًا عميقًا. لقد كانَ يؤمنُ بالرُّوح البشرية. وكان مؤمناً بأنَّ لكلِّ إنسان جوهرًا عاطفيًا وأخلاقيًا يميِّزه عن سائر الحيوانات، ويُحدِّدُه كفرد. وعلى الرّغم من أنَّ إيمانه بأنَّ أرواحَنا ليستْ خارقةً للطبيعة، وأنَّها نتاج لأدمغتنا، فإنَّ هذا لم يُضعف في شيءٍ من روحانيته. فكيف يُعقلُ هذا بالنِّسبة إلى رجلٍ لا يتكلَّمُ، ولا يتحرَّكُ، وكانتْ روحُه هي كلُّ ما يملكُ.»[44]
هناك ملاحظةٌ مثيرةٌ للاهتمام للشاب جوزيف راتزينغر[45] تتعلق بالشُّكوك الأساسية لدى المؤمنين والكافرين جاء فيها: «إذا كانَ المؤمنُ لا يستطيعُ إتمامَ إيمانِه إلاَّ على بحرٍ من العَدمية، والإغراء، والشَّك؛ وإذا خُصِّص له بحرُ الشَّك كمتنفسٍ وحيدٍ محتملٍ لإيمانه، فإنَّه لا ينبغي فهمُ الكافر على نحو غير جدلي بصفته مجرد إنسانٍ بلا إيمان. وكما أدركنا بالفعل أنَّ المؤمنَ لا يعيشُ مُحصَّنًا من الشَّك، وإنَّما يكونُ دائمًا مهدداً بالغَرقِ في الفراغ، فكذلك يُمكننا الآن أنْ نُدرك الطَّبيعة المُتشابكة للمصائر البشرية، ونقولُ: إنَّ الكافر لا يعيشُ حياةً منعزلةً، ومُكتفية بذاتها. فمهما حاولَ التأكيد أنَّه وضعيٌّ خالصٌ، فإنَّه قد تركَ وراءه منذ زمن طويل الإغراء، والضُّعف الخارقين للطبيعة، ولمْ يعد يقبلُ إلاَّ ما هو مؤكَّد على نحو مباشر، ولنْ يتحرَّر مطلقاً من الشَّك الخفي حول ما إذا كانتِ الوضعيةُ هي صاحبةُ الكلمة الفصل. وكما يختنقُ المؤمن بمياهِ الشَّك المالحة، يضطربُ الكافرُ بالشُّكوك حول عدمِ إيمانه، وحولَ الحقيقة الكلية للعالم الَّذي صمَّمه في ذهنه ليفسِّره ككلٍ مكتفٍ بذاتِه.»[46]
عند قراءة الجملة الأخيرة في الفصل الَّذي يتحدَّث عن "هل يوجد إله؟" من كتاب هوكينغ الأخير، يشعر المرءُ أنَّه يؤكدُ تصريح راتزينغر، بأنَّه حتَّى الكافر تراودُه شكوكٌ حول عدمِ إيمانه، وذلك بيِّنٌ من خلال قوله: «لدينا هذه الحياةُ الوحيدة لنقدِّر التَّصميمَ العظيم للكون، وأنَّا ممتنٌ للغاية بذلك».[47]
وإذا كُنا نجدُ في جل صفحات كتاب: تاريخ موجز للزمن أدلةً تُبرِّر عدم وجود إله، وخاصةً عدم وجود إلهٍ شخصي. فإنَّه في جملةٍ واحدة، يُعربُ الكافر عن شكوكِه في إيمانه، وينتهي بتصريح إيماني. إنَّه يتحدَّث عن التَّصميم العظيم. ولمَّا يوجدُ تصميمٌ، يوجد مُصمِّمُ، والأمر ليس مجرد تطوُّرٍ أعمى. ثم يختتمُ ذلك بعبارة لا يستطيعُ التَّعبير به إلاَّ العظماء الحقيقيون، والَّذي مفاده: أنا ممتنٌ للغاية بذلك. وعلى الرَّغم من أنَّه كانَ يعيشُ منذ أكثر من خمسين سنة مصابًا بمرض التَّصلُّب الجانبي الضُّموري، [48] وكان مُقيّدًا بكرسيٍّ مُتحركٍ، ويتواصلُ فقط عبر الكمبيوتر، فإنَّه يُعرِبُ عن امتنانه العميق. وإذا كان المرء لمَّا يستلمُ تذكرة اليانصيب الفائزة، يشعُر بالسَّعادة دون امتنان. وإذا كان الامتنان عادة ما يكونُ مرتبطاً بشخص آخر. فمنْ هو الشَّخصُ الَّذي يُقدّر له تصميمَه العظيمُ، ويُكنُ له امتنانًا بالغًا؟
وفي الختام، لا بد من الإشادة بالجُهد الاستثنائي الَّذي بذلَه هوكينغ في البحث عن الحقيقة. في مجالِ العلوم، من جهة، وفي معالجة الأسئلة الكبرى على نحو أعم، بما في ذلك وجود الله من جهة ثانية. فهل نجح في ذلك؟ ومهما يكن، فقد استطاعَ أنْ يُحفِزَ ملايين القُراء على أخذ هذه الأسئلة الكبرى على محمَل الجِد.
في هذه المقالة، كما في أعمال هوكينغ، يرتبطُ العلمُ الحَديثُ بالأسئلة، وبالأدلة الفلسفيَّة. ونأملُ أنْ تُثبت هذه المقالة أنَّ الفلسفةَ القديمة عند أرسطو وتوماس الإكويني تُقدم إسهاماتٍ قيّمةٍ في البحث عن الحَقيقةِ المُطلقةِ.
*- مصدر المقالة:
Driessen, Alfred., “The Quest for Truth of Stephen Hawking“, ScientiaetFides 9 (1) 2021, 47-61. (Received: February 20, 2020, Accepted: August 10, 2020. ISSN 2300-7648 (print) / ISSN 2353-5636 (online)).
*- مصادر ومراجع مُعتمدة من قبل المُؤلف:
- Beck, W. David. 2002.”The Cosmological Argument: A Current Bibliographical Appraisal.” Philosophia Christi 2 (2): 283–304.
- Borde, Arvind, Alan H. Guth, and Alexander Vilenkin. 2003. “Inflationary spacetimes are not past-complete.” Phys. Rev. Letters 90: 151301.
- Byrne, Peter. 2013. Natural Religion and the Nature of Religion, The Legacy of Deism. London, and New York: Routledge.
- Cohoe, Caleb. 2013. “Why Thomas Aquinas Rejects Infinite, Essentially Ordered, Causal Series.” Brit. J. for History of Phil. 21: 838–856.
- Carrol, William E. 2010. “Stephen Hawking’s Creation Confusion.” Mercatornet, 29-9-2010.
- Craig, William Lane. 1990 “What place, then, for a creator? Hawking on God and Creation.” Brit. J. Phil. Sci. 41: 473–491.
- Davies, Brian. 2001. “Aquinas Third Way.” New Blackfriars 82: 450–466.
- Driessen, Alfred. 1995. “The Question of the Existence of God in the Book of Stephen Hawking: A brief history of time.” Acta Philosophica: 4, 83–93.
- Driessen, Alfred. 2018. “The Universe as a Computer Game.” Scientia et Fides 6: 1–22.
- Driessen, Alfred. 2019. “Causality from Outside Time.” Presentation, DOI: 10.13140/RG.2.2.12414.33602,https: //www.researchgate.net/publication/335639016_Causality_from_Outside_Time.
- Fokker, Adriaan Daniël. 1965. Time and Space, Weight and Inertia. Oxford: Pergamon Press.
- Hardy, R.P., and R.K. Gaye. 2009. “Translation of Aristotle Physics.” The Internet Classics Archive, http: //classics.mit.edu//Aristotle/physics.html.
- Hartle, James B., and Stephen Hawking. 1983. “Wave Function of the Universe.” Phys. Rev. D. 28: 2960.
- Hawking, Stephen. 1975. “Particle creation by black holes.” Commun. Math. Phys. 43: 199–220.
- Hawking, Stephen. 1988. A Brief History of Time, from the big bang to black holes. New York: Bantam Books.
- Hawking, Stephen, and Leonard Mlodinow. 2010. The grand design. New York: Bantam Books.
- Hawking, Stephen. 2018. Brief Answers to the Big Questions. London: John Murray.
- Hawking, Lucy. 2018. “Afterword” in (Hawking 2018).
- Hume, David. 1748. An Enquiry Concerning Human Understanding. https: //ebooks. adelaide.edu.au/h/hume/david/h92e/
- Hutchings, David, and David Wilkinson. 2020. God, Stephen Hawking and the Multiverse, What Hawking said and why it Matters. London: Society for Promoting Christian Knowledge.
- Mlodinow, Leonard. 2020. Stephen Hawking: a memoir of friendship and physics. New York: Pantheon Books.
- Penrose, Roger. 2010. Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe. London: The Boldley Head.
- Ratzinger, Joseph. 2004. Introduction to Christianity. First German edition 1968, second revised edition 2004. San Francisco: Ignatius Press, 44–45.
- Smith, Quentin. 1994. “Stephen Hawking’s “Cosmology and Theism.” Analysis 54, 236–243.
- Spitzer, Robert J. 2010. New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy. Cambridge UK: Wm. B. Erdmans Publishing Co.
- Spitzer, Robert J. 2016. “Evidence of God from Contemporary Science & Philosophy.” https: //magiscenter.com/wp-content/uploads/2017/07/Contemporary-Evidence-for-God-from-Science-Philosophy.pdf
- Wilkinson, David, and David Hutchings. 2020. “How Stephen Hawking’s work creates new opportunities for understanding God.” The Tablet 1 February.
تعريف بالباحثين المستشهد بهم في المقالة:
- أدريان دانييل فوكرAdriaan Daniel Fokker: (1887-1972) فيزيائي، وعالم موسيقي هولندي، كان له اهتمام بالميكانيكا الستاتيكية.
- أرڤيند بورد Arvind Bord: كبير الأساتذة في الرياضيات، والفيزياء، والفلك، حاصل على الدكتوراه من جامعة نيويورك سنة 1982.
- ألان هارڤي غوث Alan Harvey Guth: (ولد سنة 1947) عالم كونيات أمريكي، واضع نظرية التضخم الكوني، وله اهتمام بنظرية الجزيئات الأولية.
- أليكساندر ڤيلينكين Alexander Vilenkin: (ولد سنة 1949) فيزيائي نظري، وعالم كونيات أمريكي من أصل أوكراني، عرف بنظرية التضخم الأبدي.
- بريان ديڤيز Brian Davies: (ولد سنة 1951) فيلسوف، وراهب كاثوليكي إنجليزي، اشتهر بكتاب "مدخل إلى فلسفة الدين".
- بيتر بين Peter Byne: (ولد سنة 1950) فيلسوف، وأستاذ جامعي بالكلية الملكية بلندن، له أعمال تركزت حول الدين الطبيعي، والأخلاق بصفة عامة.
- جيمس هارتل James Hartle: (1939-2023) عالم فيزياء نظرية، أمريكي، وأستاذ جامعي بجامعة كاليفورنيا، عرف باهتمامه بنظرية النسبية العامة، وبالفيزياء الفلكية، واشتهر بتأويل نظرية ميكانيكا الكوانطا.
- ديفيد هوتشينز David Hutchings: أستاذ جامعي للفيزياء، إنجليزي، وباحث.
- ديفيد وليامسون David Williamson: باحث جامعي بجامعة كمبريدج، من أصل إنجليزي.
- ر. ك. غاي R. K. Gaye: باحث، ومترجم لكتب أرسطو، ترجم كتاب "الفيزياء" لأرسطو بمعية ريتشارد هاردي.
- روبرت سبيتزر Robert Spitzer: (ولد سنة 1952) فيلسوف، ومربي، وكاتب، وخطيب، وراهب يسوعي أمريكي.
- روجر بينروز Roger Penrose: (ولد سنة 1931) رياضي، وعالم كونيات، وفيلسوف علم إنجليزي، حاصل على جائزة نوبل.
- ريتشارد ب. هاردي Richard P. Hardy: أستاذ جامعي، ومترجم، ومحاضر في اللاهوت وفلسفة الدين، اهتم بفلسفة أرسطو، وفلسفة توماس الإكويني.
- كاليب كوهي Caleb Cohoe: باحث، وأستاذ جامعي، له اهتمام بالفلسفة اليونانية، والفلسفة الرومانية، والفلسفة في القرون الوسطى، وفلسفة الدين.
- كوينتين سميث Quentin Smith: 1952-2020) فيلسوف أمريكي، اهتم بفلسفة الزمن، وفلسفة اللغة، وفلسفة الفيزياء، وفلسفة الدين.
- ليونارد ملوديناو Leonard Mlodinow: (ولد سنة 1954) عالم فيزياء نظرية، ورياضي، وكاتب أمريكي، خريج جامعة كاليفورنيا، عمل بمعهد ماكس بلانك للفيزياء، وبمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، له مؤلفات عدة في مجالي الرياضيات والفيزياء، وشارك ستيفن هوكين في تأليف كتاب "التصميم العظيم"، الذي برهنا فيه أن الاستشهاد بالإيمان بالله ليس ضروريا لتفسير الكون.
- و. ديفيد بيك W. David Beck: أستاذ فخري للفلسفة، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة بوسطن، له اهتمام بفلسفة الدين.
- وليام كارول William Carrol: أستاذ جامعي للفلسفة، بجامعة أكسفورد، اهتم بفلسفة توماس الإكويني، عمل كأستاذ زائر مميز بإحدى الجامعات الصينية.
- وليام لين كريغ William Lane Craig: (ولد سنة 1949) فيلسوف تحليلي أمريكي، ولاهوتي مدافع عن المسيحية، له اهتمام بالدَّليل الكوسمولوجي الكلامي على وجود الله. له مؤلفات عدة في هذا الباب.
[1]- Alfred Driessen، أستاذ جامعي سابق لعلم البصريات بجامعة تونتي بهولندا، ويعمل حاليا أستاذا فخريا، له اهتمام بالقضايا الميتافيزيقية، وبقضايا فلسفة العلوم، صدر له كتاب بالاشتراك مع أنتوان سواريز تحت عنوان: "عدم القدرة على الحسم الرياضي، وعدم المحلية الكوانطية، ومسألة وجود الله."، (صدر عن دار Springer سنة 1997)، وله مجموعة من المقالات في المجالين المذكورين.
[2]- أستاذ الفلسفة، حاصل على الدكتوراه في الفلسفة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، المغرب.
[3]- صدر الكتاب تحت عنوان: "A Brief History of Time: From The Big Bang to Black Holes" سنة 1988، وحقَّق أعلى نسبة من حيث المبيعات، بيعت من نسخه خمسة وعشرين مليون نسخة، ترجم إلى العديد من اللغات، وصدرت له بالعربية ترجمات.
[4]- Hawking, Stephen. 2018. Brief Answers to the Big Questions. London: John Murray.
[5]- Carl Sagan (1934-1996) عالم وفلكي أمريكي، ترجع أصول أبويه إلى اليهود المهاجرين من أوروبا الشرقية، كان فاعلًا في البحث العلمي، وعضوًا في كثير من مؤسسات البحث العلمي، واختير عضوًا ضمن البعثة التي استكشفت النظام الشمسي بين سنة 1970 و1980. له مؤلفات مهمة، ترجم بعضها إلى العربية.
[6]- لعل أهم كتاب أرسطي استلهمت منه الأدلة على وجود الله في القرون الوسطى هو كتاب "الطبيعة" أو "السماع الطبيعي"، فقد استلهم منه توماس الإكويني خمسة أدلة جعلها طرائق للبرهنة على وجود الله في كتابه الخلاصة اللاهوتية Summa Theologia، وهذه الطرائق هي: دليل الحركة، ودليل السبب الفاعل، ودليل الإمكان والضرورة، ودليل تدرج الموجودات وتراتبها، ودليل قيادة العالم. ويعدّ الدليل الثالث؛ أي دليل الإمكان والضرورة هو الدليل الأقرب إلى موقف ستيفن هوكين؛ أي ما دامت المعادلات الرياضية لا تفسر العالم، وهناك من يبث فيها الروح لتصف العالم، وهذا الذي يفعل ذلك هو الله، باعتبار وجوده ليس ممكن الوجود، وإنما واجب الوجود.
[7]- Hawking, Stephen. 1975. “Particle creation by black holes.” Commun. Math. Phys. 43: 199-220.
[8]- Hartle, James B., and Stephen Hawking. 1983. “Wave Function of the Universe.” Phys. Rev. D. 28: 2960.
[9]- Craig, William Lane. 1990 “What place, then, for a creator? Hawking on God and Creation.” Brit. J. Phil. Sci. 41: 473-491.
[10]- Smith, Quentin. 1994. Introduction to Christianity. First German edition 1968, second revised edition 2004. San Francisco: Ignatus Press, 44-45.
[11]- Driessen, Alfred. 1995. “The Question of the Existence of God in the Book of Stephen Hawking: A brief history of time.” Acta Philosophica: 4, 83-93.
[12]- Beck, W. David. 2002. “The Cosmological Argument: A Current Bibliographical Appraisal.” Philosophia Christi 2 (2): 283-304.
[13]- Spitzer, Robert J. 2010. New Proofs for the Existence of God: Contributions of Contemporary Physics and Philosophy. Cambridge UK: Wm. B. Erdmans Publishing Co.
[14]- Hawking, Stephen, and Leonard Mlodinow. 2010. The grand design. New York: Bantam Books
[15]- Wilkinson, David, and David Hutchings. 2020. “How Stephen Hawking’s work creates new opportunities for understanding God.” The Tablet 1 February. & Hutchings, David, and David Wilkinson. 2020. God, Stephen Hawking and the Multiverse, What Hawking said and why it Matters. London: Society for Promoting Christian Knowledge.
[16]- Hawking, Stephen. 2018. Brief Answers to the Big Questions. London: John Murray. p.29.
[17]- Hume, David. 1748. An Enquiry Concerning Human Understanding.
[18]- Driessen, Alfred. 1995. “The Question of the Existence of God in the Book of Stephen Hawking: A brief history of time.” Acta Philosophica: 4, 83–93.
[19]- Cohoe, Caleb. 2013. “Why Thomas Aquinas Rejects Infinite, Essentially Ordered, Causal Series.” Brit. J. for History of Phil. 21: 838–856.
[20]- Hawking, Stephen. 1988. A Brief History of Time, from the big bang to black holes. New York: Bantam Books. p.7.
[21]- Byrne, Peter. 2013. Natural Religion and the Nature of Religion, The Legacy of Deism. London, and New York: Routledge. p.1.
[22]- Hawking, Stephen. 1988. A Brief History of Time, from the big bang to black holes. New York: Bantam Books. Pp.130-131.
[23]- Borde, Arvind, Alan H. Guth, and Alexander Vilenkin. 2003. “Inflationary spacetimes are not past-complete.” Phys. Rev. Letters 90: 151301.
[24]- Spitzer, Robert J. 2016. “Evidence of God from Contemporary Science & Philosophy.” https: //magiscenter.com/wp-content/uploads/2017/07/Contemporary-Evidence-for-God-from-Science-Philosophy.pdf
[25]- ينبغي النظر في الفصل الثامن من كتاب هوكينغ تاريخ موجز للزمن.
[26]- Borde, Arvind, Alan H. Guth, and Alexander Vilenkin. 2003. “Inflationary spacetimes are not past-complete.” Phys. Rev. Letters 90: 151301.
[27]- Hawking, Stephen. 1988. A Brief History of Time, from the big bang to black holes. New York: Bantam Books. p.174.
[28]- Driessen, Alfred. 1995. “The Question of the Existence of God in the Book of Stephen Hawking: A brief history of time.” Acta Philosophica: 4, 83–93.
[29]- Ibid.
[30]- Davies, Brian. 2001. “Aquinas Third Way.” New Blackfriars 82: 450–466.
[31]- Driessen, Alfred. 2018. “The Universe as a Computer Game.” Scientia et Fides 6: 1–22.
[32]- Hawking, Stephen. 1988. A Brief History of Time, from the big bang to black holes. New York: Bantam Books. p.174.
[33]- Ibid.
[34]- Hardy, R.P., and R.K. Gaye. 2009. “Translation of Aristotle Physics.” The Internet Classics Archive, http: //classics.mit.edu//Aristotle/physics.html.
[35]- Fokker, Adriaan Daniël. 1965. Time and Space, Weight and Inertia. Oxford: Pergamon Press.
[36]- Penrose, Roger. 2010. Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe. London: The Boldley Head. p.146.
[37]- Driessen, Alfred. 2019. “Causality from Outside Time.” Presentation.
[38]- Penrose, Roger. 2010. Cycles of Time: An Extraordinary New View of the Universe. London: The Boldley Head.
[39]- Carrol, William E. 2010. “Stephen Hawking’s Creation Confusion.” Mercatornet, 29-9-2010.
[40]- Hawking, Stephen. 1988. A Brief History of Time, from the big bang to black holes. New York: Bantam Books. p. 130-131.
[41]- Paplo Jauregui، باحث وصحفي، حاصل على شهادة ماجستير في الأنثروبولوجيا الاجتماعية من جامعة أكسفورد، وعلى شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والاجتماعية من الجامعة الأوروبية في فلورنسا. بدأ مسيرته الصحفية سنة 1995 كمراسل علمي لصحيفة "إلموندو"، وفي سنة 2002 عُيّن رئيسًا لتحرير القسم العلمي المُنشأ حديثًا في تلك الصحيفة، والذي كان أول قسم في صحيفة إسبانية مُخصص بالكامل للمعلومات العلمية.
[42] - صرح بذلك في مقابلة أجرت معه من قبل صحيفة إلموندو، في 23 شتنبر سنة 2014.
[43]- Hawking, Lucy. 2018. “Afterword” in (Hawking 2018).
[44]- Mlodinow, Leonard. 2020. Stephen Hawking: a memoir of friendship and physics. New York: Pantheon Books.
[45]- المقصود هنا البابا بنديكت السَّادس عشر لمَّا كان شاباً.
[46]- Ratzinger, Joseph. 2004. Introduction to Christianity. First German edition 1968, second revised edition 2004. San Francisco: Ignatius Press, 44–45.
[47]- Hawking, Stephen. 2018. Brief Answers to the Big Questions. London: John Murray.
[48]- Amyotrophic Lateral Sclerosos.