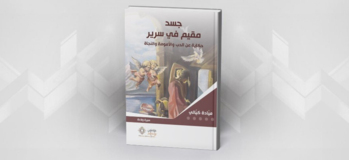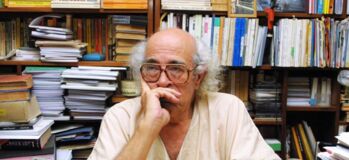حوار مع د. ميادة كيالي حول مؤلفها الجديد: "جسد مقيم في سرير، حكاية عن الحب والأمومة والنجاة" -الجزء الأول-
فئة : حوارات

حوار مع د. ميادة كيالي حول مؤلفها الجديد:
"جسد مقيم في سرير، حكاية عن الحب والأمومة والنجاة"
-الجزء الأول-
حاورها د. حسام الدين درويش
د. حسام الدين درويش:
مساء الورد للجميع، وأهلًا وسهلًا بكم في جناح مؤمنون بلا حدود ضمن معرض إسطنبول للكتاب العربي، الذي يقام هذا العام، 2025، تحت شعار "وتبقى العربية". لقد أعجبني هذا الشعار كثيرًا، ووجوده ووجود اللغة العربية في هذا المعرض بتركيا لهما دلالاتٌ ومعانٍ عديدةٌ وجميلةٌ.
موضوع حوارنا اليوم، مع الدكتورة ميادة كيّالي، هو كتابها الصادر حديثًا بعنوان: "جسد مقيم في سرير: حكاية عن الحب والأمومة والنجاة"، وعنوانه الفرعي "سيرة ولادة". وقبل الخوض في الحديث عن الولادة التي يتحدث عنها الكتاب، فلنبدأ بالحديث عن ولادة هذا الكتاب نفسه. فعندما اطّلعت عليه، فوجئت أن ثمة نصوصًا قديمة جدًّا، ظهرت فجأة. فمتى كتبت هذه النصوص، وكيف جاءت فكرة نشر الكتاب؟
د. ميادة كيالي:
منذ بداياتي اعتدت أن أدوّن ما أعيشه، لا كترفٍ أدبيٍّ، بل كحاجة وجودية للإمساك باللحظة قبل أن تضيع. تجربة الولادة التي مررت بها كانت طويلةً ومرهقةً، ومليئة بالأمل، في الوقت ذاته، فشعرت أن تدوينها ضرورةٌ وليس خيارًا. كتبت هذه النصوص بعد أشهر قليلة من ولادة طفليّ عام 1999، ثم عدت إليها عام 2007 مع انتقالي من بيروت إلى أبو ظبي، وكأنني كنت أفتّش عن ذاتي في مساحاتٍ جديدةٍ.
ظلّت النصوص في درجٍ مغلق سنوات طويلة، بعنوان أوّلي هو سبعة أشهر في حياتي. لم أكن أتصوّر أنها ستتحول يومًا إلى كتاب، إلى أن بدأت العام الماضي بكتابة سيرتي الذاتية الكبرى التي تستعرض محطات حياتي بين دمشق وبيروت وأبو ظبي؛ وهي ثلاث محطات شكّلت هويتي: في دمشق تخرّجت مهندسة، وفي بيروت خرجت كاتبة وأمًّا، وفي أبو ظبي تبلورت التجربتان في مشروع حياة متكامل.
بعد جراحةٍ بسيطةٍ أجريتها منذ شهرٍ فقط، استيقظ في داخلي هاجس الذاكرة. فاستعدت نصوصي القديمة بعين جديدة، وقررت ألّا أسمح لها أن تذوب في النسيان. تذكرت أبي الذي عاش سبع سنوات بعد إصابته بجلطة دماغية حُرم فيها من الكلام والحركة، فتحوّل من فارسٍ مشارك في الثورات إلى جسدٍ صامت لا يملك إلا نظرة واحدة. حزّ في نفسي أن قصصه لم تُدوّن، وأن حياته، ببطولاتها ومعاركها، ذهبت معه. عندها أيقنت أن الإنسان لا يملك ذاكرته إلا إذا كتبها.
من هنا جاء هذا الكتاب. أردته شهادةً شخصيةً، لكنها، في عمقها، تتجاوز الفرد إلى ما يهمّ المرأة العربية عمومًا: أن نروي تجاربنا بأنفسنا، وأن نمنح الألم والأمل صوتًا وصورةً. فالكتاب لا يقتصر على تجربة الحمل والولادة، كما حدثت أواخر التسعينيات، بل هو، أيضًا، محاولةٌ لتثبيت لحظةٍ إنسانيةٍ فيها القلق والانتظار والفشل، ثم الرجاء والانتصار. هو عبورٌ صعبٌ، لكنه، في النهاية، عبورٌ نحو الحلم.
د. حسام الدين درويش:
تذكرين، حين كنا قبل يومين في هذا المكان، وكان معنا الصديق العزيز محمد برو، قلتُ لكِ: بعد أن استذكرتُ عنوان كتابه "ناجٍ من المقصلة"، خطرت لي عناوين كثيرة يمكن الحديث عنها، ويمكن أن تكون أحد المحاور أو الأفكار التي قد يناقشها المرء بالنسبة إلى كتابك، ومنها أنك ناجية من الولادة، ولكن أيضًا ناجية من عدم الولادة. في كلتا الحالتين ثمة مجال للتفكير في ولادتك من منظور النجاة، من الولادة ومن عدم الولادة. فبأيّ معنى يمكن القول إنك حين ولدتِ، كنتِ ناجية من الولادة، لكنك كنت أيضًا ناجية من "عدم الولادة"؛ لأن عدم الولادة في مجتمعنا يُعدّ وصمة اجتماعية ونفسية. كيف كانت الولادة نجاةً من عدم الولادة؟
د. ميادة كيالي:
الولادة في مجتمعاتنا ليست مجرد حدثٍ بيولوجيٍّ، بل هي عبورٌ اجتماعيٌّ يقرّر اكتمال الزواج، وكأن العقد وحده لا يكفي، ولا يصبح للمرأة مكانها الكامل إلا إذا صارت أمًّا. منذ اللحظة الأولى للزواج، يُثقل كاهلها بانتظار الآخرين لخبر الحمل، فتشعر وكأنها أمام امتحان مصيري لا بد أن تنجح فيه بالإنجاب.
هذا التصور ليس وليد عصرنا الحديث، بل له جذورٌ ممتدةٌ في التاريخ الإنساني. ففي المجتمعات القديمة، لم تكن المرأة تُحاسب على عذريتها، بقدر ما كانت تُحاسب على عُقمها. كان الإنجاب هو الضمان الحقيقي لوجودها وامتداد عائلتها. فالطفل لم يكن مجرد ثمرة حبٍّ، بل كان رمز القوة، ويدًا عاملة، وسندًا اجتماعيًّا في حاضر الأهل ومستقبلهم وشيخوختهم. من هنا، ارتبطت كينونة المرأة، عبر التاريخ، بقدرتها على أن تلد، حيث أصبح العقم أخطر من أيّ نقص آخر.
حين تزوجت متأخرةً، ووجدت نفسي في مواجهة تأخر الإنجاب، شعرت بثقل هذا التاريخ يضغط عليّ. لم يكن الأمر شخصيًّا فقط، بل بدا، أيضًا، وكأنني أحمل معي صدى قرونٍ من التصورات التي جعلت الأمومة معيارًا لاكتمال المرأة. لذلك، كانت الولادة بالنسبة لي نجاة ًمزدوجةً: نجاة من محنة العقم ونقصه، ونجاة من حكم مجتمع يرى في غياب الولد تهديدًا لشرعية الزواج ومعناه.
د. حسام الدين درويش:
إذن، لم تكن المسألة متعلقة بالضغوط الاجتماعية فقط – والتي أشرت إليها في الكتاب – بل كانت، أيضًا، نتيجة رغبةٍ شخصيةٍ حقيقيةٍ.
د. ميادة كيالي:
رغبتي في الأمومة لم تكن استجابةً لضغط اجتماعي فحسب، بل كانت، أيضًا، رغبةً شخصيةً عميقةً. فمنذ طفولتي، أحببت الأطفال، وكنت أجد فيهم معنىً خاصًّا للحياة. وبعد الزواج، تضاعف هذا الشعور، وأصبحت كل مرة أحمل فيها طفلًا صغيرًا أُواجَه بنظرات شفقةٍ أو تلميحات؛ لأنني لم أنجب بعد، وكأن الأمومة لا تُحسب إلا إذا كانت بيولوجية.
أنا أرى الأمومة من منظورٍ أوسع من ذلك بكثير. إنها شعور داخلي وقدرة على العطاء، يمكن أن تتوجه إلى أي طفل يحتاج إلى الحب والرعاية، سواء كان ابنًا بيولوجيًّا أو ابنًا بالتبني. ولطالما كنت منفتحة على فكرة التبني، رغم صعوبة تقبّلها في ثقافتنا. فما يهم حقًا أن يجد الطفل من يضمه ويهبه الحنان، لا أن يكون مجرد استمرارٍ بيولوجي فقط.
أتذكر فيلمًا مؤثرًا شاهدته مرارًا، جسّد هذه الفكرة حين قالت أم متبنية لطفلها: "من قال إن الله حرمني من الأطفال؟". أنا لم أختر الإنجاب، بل اخترت أن أكون أمًّا لطفلٍ يتيمٍ بحاجةٍ إلى عائلةٍ". هذه العبارة لامستني بعمقٍ؛ لأنها تذكّرنا أن الأطفال، أحيانًا، بحاجة إلينا أكثر من حاجتنا نحن إلى إثبات قدرتنا على الإنجاب.
د. حسام الدين درويش:
بالفعل لدي صديق لديه تماماً هذه الفكرة. وقد كان قد قرّر ألّا يُنجب أطفالاً وأن يتبنّى، فتَبَنّى طفلًا كان يعيش في أوضاعٍ صعبةٍ؛ فالأب كان مهملًا جدًّا، والأم تتعاطى المخدرات ولا تقوم برعايته جيدًا. وكان الطفل يعاني صعوبات في النطق؛ إذ لم يكن أحد يتحدث معه. وقد أنقذه التبني من هذا الوضع المأساوي، وهو يعيش، الآن، حياة مختلفة، وأفضل بكثير بالتأكيد من حياته المأساوية مع والديه السابقين أو في مؤسسة الرعاية الاجتماعية. فصديقي رفض أن يكون والدًا لطفلٍ، لكنه حاول أن يكون أبًا. فالأب غير الوالد، والأم غير الوالدة. ويمكن أحيانًا لغير الوالدة ان تمارس الأمومة، وهذا ما أرى أنك تفعلينه، أحيانًا، في علاقاتك مع أخريات وآخرين.
وبالعودة إلى الكتاب، أرى أنه أكبر من أن يكون مجرد سيرة ولادة؛ ففيه أفكارٌ كثيرةٌ تتجاوز ذلك. وبصفتك ناجيةً من (عدم) الولادة، من المهم الكتابة عن هذه التجربة والتعبير عن رؤى النساء اللواتي لم يصل صوتهن أو لم يُعَبِّرن عن تجاربهن. ومن موقع الرجل، أوضح لي الكتاب أنّ الولادة يمكن أن تكون، بالفعل، تجربةً خاصةً جدًّا ومؤلمةً للغاية؛ إذ تمتزج فيها مشاعر الألم مع الأمل، والتوتر، والخوف، مع عدم القدرة على التحمل في لحظاتٍ معينةٍ. فإلى أيّ حدٍّ، يمكن النجاة من هذه التجربة والخبرة الجسدية؟
وإذا كان العنوان الفرعي للكتاب "سيرة ولادة"، فإن هذه السيرة لا تتعلق بالمولودات والمولودين فحسب، بل هي – كما تؤكدين أكثر من مرة في كتابك – "سيرة ولادة الأم"، و"سيرة ولادة الإنسانة"، أيضًا. فبعد الولادة، تعود الأم لتبدأ وتقوم بترتيب أولوياتها من جديد. ومن ثم، تُولد كامرأة من جديد، كإنسانة، وكأمٍّ من جديد.
د. ميادة كيالي:
نعم، هي، بالفعل، نجاةٌ؛ لأن الولادة، في حد ذاتها، تجربة نجاة. قد تبدو "طبيعية" بحكم تكرارها، لكنها، في حقيقتها، اختبار قاسٍ يتداخل فيه الألم بالخوف وبالأمل. تجربتي كانت استثنائيةً، لكنني أؤمن أن كل امرأة تعيش استثنائيتها الخاصة، سواء في حمل توأم أو في مواجهة آلام أخرى قد لا تُرى ولا تُقال.
اعتاد المجتمع أن يتعامل مع الحمل والولادة، وكأنها أمرٌ عاديٌّ مفروضٌ على المرأة، بينما الحقيقة أنها رحلةٌ يوميةٌ من الصبر والتحمّل. أتذكر حكايةً للراحل السيد هاني فحص، حيث نصح شابًّا يشتكي من تذمّر زوجته بأن يضع ثِقلًا يزن خمس كيلوغرامات على بطنه شهرًا كاملًا ويعيش حياته به، ليدرك معنى ما تحمله زوجته في كلّ حمل. مجرد الفكرة بدت له مستحيلةً، لكنها واقع تعيشه النساء مرارًا.
في كتابي وصفتُ سبعة أيام قضيتها مربوطة بالسرير لا أتحرك، أثقلني وزن توأميّ والأجهزة والدواء المؤلم. كنت أحلم فقط بلمس الأرض بقدميّ. أحد أصدقائي، حين قرأ النص، قال لي: "بعد أن أنهيت القراءة، ذهبت مباشرةً إلى زوجتي، وقبّلت يدها، فقد شعرت كم مرة عانت بصمتٍ، ولم تحدّثني عنها."
هذه بالضبط هي المشكلة: معاناة النساء تُعدّ عادية، وحديثهن عنها يُستقبل بالتقليل أو بالمقارنة. كم مرة سمعنا امرأة تقول لأخرى: "ولادتي كانت أصعب من ولادتك"، وكأن الألم مسابقة. بينما في الحقيقة، الألم تجربة شخصية لا تقارن، بل تكشف جوهر الخلق نفسه: كل ولادة هي خلق جديد، وكل خلق يمرّ عبر المخاض والتعب.
السرّ في استمرار الكون هو أنَّ المرأة، رغم كل الألم، تختار أن تكرر التجربة. ولولا المحبة التي تحملها في قلبها، لما كان هناك أمٌّ تعود لتلد مرة ثانية. إنّها المحبة التي تُحوّل الألم إلى حياة، والنجاة إلى بداية جديدة.
د. حسام الدين درويش:
لكن ما معنى أنّكِ، مع الولادة، وُلدتِ كامرأة، وُلدتِ كإنسانة، ووُلدتِ كأمٍّ، في الوقت نفسه؟ وبأيّ معنى تقولين باختلاف الوضع بين المرأة والرجل، في هذا الخصوص، حيث تكون هناك استمرارية في حياة الرجل، بينما تُضطر المرأة إلى البدء من جديد مراتٍ عديدةٍ؟
د. ميادة كيالي:
لا تسير المرأة في خط مستقيم متصاعد كما يفعل الرجل، بل تمرّ بمحطات تُعيد تشكيلها من جديد. أما الرجل، فحين يدخل مسار الدراسة أو العمل، فإنه يستمر فيه غالبًا بلا انقطاعات كبرى، مراكماً للخبرة والمعرفة. أما المرأة، فحياتها تُعاد صياغتها، مع كلّ مرحلة: الزواج، الحمل، الولادة، وحتى مع كل محاولةٍ للإنجاب.
أنا، مثلًا، مررت بأربع تجارب للحمل، وكانت كل تجربة بداية جديدة. في التجربة الثالثة شعرت أنني وصلت إلى الحدّ، وقلت لزوجي: "إن لم تنجح هذه المرة، فلن أكررها، فقد استنزفتني المحاولات".
عشت لحظاتٍ أليمةً، حين ظننت أن الحمل قد حصل في المحاولة الثالثة، ولم يثبت، فانتهى سريعًا. كانت صدمةً، لكنها، في الوقت نفسه، بشارة بأنَّ جسدي أصبح أكثر استعدادًا. ومع كلّ خيبة أملٍ، كنت أعود وألملم نفسي، وأبدأ من جديد.
هذه الدورات المتكررة من الأمل والانكسار، ثم النهوض، هي ما يجعل المرأة تولد مراتٍ عديدةً: تولد كأمّ، وتولد كإنسانة تتصالح مع جسدها، وتولد كامرأة تعيد ترتيب أولوياتها مع كل تجربة. ولهذا أقول إن الولادة ليست مجرد قدوم طفل إلى العالم، بل هي، أيضًا، ولادة جديدة للمرأة نفسها.
د. حسام الدين درويش:
دعيني أذكرك أيضًا بتاريخك في الكتابة؛ بدأتِ بالكتابة الأدبية أو الفكرية، ثم انتقلت إلى الكتابة البحثية، فحصلتِ على الماجستير والدكتوراه، وكان لديك دائمًا مشاريع للاستمرار في الكتابة البحثية. آخر هذه المشاريع كان عن فاطمة المرنيسي. أما هذا الكتاب، وبعيدًا عن مسألة التصنيف، فيهيمن عليه الطابع الأدبي، مع حضورٍ كثيفٍ للفكر التأملي في قالبٍ أدبيٍّ جميلٍ.
لقد منعك مسارك المهني الإداري من التفرغ للكتابة. وفي مثل هذه الظروف يصعب الاستمرار في الكتابة البحثية، لكن يبدو أنّ توجهك إلى هذا النمط من الكتابة أمر مناسبٌ وإيجابيٌّ؛ لأنّك تكتبين من روحك، ومن الواضح أنّك متأثرة جدًّا بتجربة عميقة، وتحاولين التعبير عنها. فكيف ترين إذن مسارك في الكتابة؟ وكيف اختلف؟ وكيف ترين نَفَسك في الكتابة؟ هل تجدين ذاتك في الكتابة بهذه الطريقة، أم ما يزال لديك ميلٌ إلى الكتابة البحثية التي لم تسمح لك ظروفك بممارستها بعد الدكتوراه؟
د. ميادة كيالي:
مساري الفكري والبحثي لم يكن يومًا منفصلًا عن حياتي الشخصية، بل كان انعكاسًا لها. قراءاتي في الفكر النسوي وتجديد الدين، وما التقيت به من أساتذة ومفكرين، كل ذلك ارتبط بتجربتي كامرأة وأمّ. فما قيمة الأفكار إذا لم نختبرها في ذواتنا ونرى أثرها في حياتنا اليومية؟
حين كتبت هذا النص، قبل خمسةٍ وعشرين عامًا، كنت أعيش الحلم من الداخل، واليوم، بعد أن بلغ أبنائي الخامسة والعشرين، أستطيع أن أقرأه، من الخارج، بوعيٍ مختلفٍ. صرت أرى الأمومة، لا كحدثٍ فرديٍّ، بل كرحلةٍ طويلةٍ من الولادة والنمو والتجدد.
بالنسبة لي، الأمومة إحساسٌ كاملٌ بالمسؤولية، يتجاوز أطفالي ليشمل كلّ ما أُبدعه أو أنشره. لذلك أقول، دائمًا، إن كل كتاب يولد عندي كطفلٍ. أتأمل فيه، أتابع طباعته، وأحرص أن تصل نسخه الأولى إلى صاحبه بسرعةٍ، تمامًا كما تحرص الأم أن يُحتضن وليدها.
كتبي وأطفالي أحلامٌ جاءت بعد صبرٍ وانتظارٍ وتجربةٍ ومعاناةٍ، ولهذا أحمل تجاههم شعورًا مضاعفًا بالمسؤولية. ومثلما عشتُ أمومتي مع أبنائي، بكل تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، أعيشها مع كتبي ومشاريعي. ربما يكون ذلك مرهقًا، لكنه جوهر وجودي: أن أظلّ مسؤولةً، وأن أستمر في العطاء ما دمت قادرة. الأمومة عندي ليست حدثًا بيولوجيًا فقط، بل هي موقفٌ وجوديٌّ يرافقني في كل ما أفعل.
د. حسام الدين درويش:
لقد اكتشفتُ متأخّرًا – وهي فكرة يمكن أن نناقشها مطوّلًا لاحقًا – أنّ فطام الأطفال أسهل أو أقلّ صعوبة من فطام الأمّ والأب. فحين يدرك الوالدان أنّ دورهما التقليدي كأمّ أو أب قد بلغ نهايته، يصبح دورهما مختلفًا، ربما أقرب إلى المرافقة أو الصداقة، ويبقى جزءٌ من المسؤولية قائمًا. لكن لم تعد الأمّ هي التي تحتضن الطفل وترعاه وتأخذ كلّ حياته؛ فلا بدّ أن يصل إلى مرحلة يتوقف فيها هذا الدور.
د. ميادة كيالي:
صحيح أنّ الطفل يُفطم تدريجيًّا في مراحل حياته؛ من الرضاعة، إلى الاعتماد على نفسه في اللباس والطعام والمدرسة، حتى يصل إلى استقلاله الكامل. لكن مع الأمّ تحديدًا، الأمر مختلف: فارتباطها بالطفل يبدأ منذ اللحظة الأولى، ولا ينتهي. فكلّ استقلال يحققه الطفل يفتح في داخلها مساحة تعلق جديدة، لا تقلّ قوة عن السابقة.
ولهذا، لا أظن أن هناك ما يمكن أن يُسمّى "فطامًا للأم". الأم لا تنفصل عن أبنائها، بل تراهم امتدادًا لها، وقطعة من جسدها، ورفاق وحدتها في الكِبر، وحراس ذاكرتها. حتى الأب، وإن كان بطريقة مختلفة، يجد في الأبناء امتدادًا له يقاوم بهم فكرة الفناء. في العمق، علاقة الوالدين بأبنائهم ليست فقط مسؤولية بيولوجية أو تربوية، بل هي أيضًا محاولة لا شعورية لمواجهة الموت عبر الامتداد في حياة الأبناء.
لا أدري، بالنسبة لي، أرى أن "فطام الأم" بالمعنى الحقيقي غير موجود، بل هناك تحولات في العلاقة. أما الرابط، فباقٍ حتى ما بعد غياب الأم نفسها.
د. حسام الدين درويش:
أعود إلى صورة أخرى؛ الكتاب حين يولد كطفل. لقد تشاركنا فرحة صدوره، وأحسستُ بأنّ هذا الكتاب طفل خرج إلى العالم. غير أنّ لهذه الولادة خصوصية؛ فقد اطّلع بعض المقرّبات والمقرّبين على الكتاب، وكان بينك وبينهم تفاعل مميّز. وأنا أرى أنّ الكاتب الحقيقي يبقى دائمًا في حالة شكّ تجاه نصّه حتى يقرؤه الآخرون. أمّا أن يكون الكاتب واثقًا مئة في المئة ولا يأبه برأي الغير، ففي ذلك جانب سلبي على الأقل. أمّا هنا، فقد كان للتفاعل خصوصيته؛ إذ منح هذه الولادة طابعًا أكثر جمالًا، حدثينا عن هذا.
د. ميادة كيالي:
بالنسبة لي، التفاعل مع القرّاء الأوائل للكتاب، كان أشبه بولادة ثانية للنص. حين أرسلته أول مرة إلى الروائي الكبير والصديق ممدوح عزام، كنت أترقّب كالتلميذة التي تنتظر علامة أستاذها، فجاءني ردّه مشجّعًا ودافئًا، أعاد إليّ الثقة بأنَّ هذه التجربة تستحق أن تُروى. ثم أرسلته إليك د. حسام، وكان لتجاوبك أثر كبير عندي؛ إذ شعرت أن هناك من قرأ النص بعين فاحصة، ووجد فيه ما يستحق النقاش. كما أنني شاركت النص مع د. موسى برهومة، ففاجأني بأن التجربة وصلت إليه كرجلٍ، بكل ألمها ووجعها.
الأجمل أنّ بعض القرّاء أخبروني أنهم شعروا جسديًّا بثقل التجربة، حتى إن أحدهم قال لي إنه، بعد القراءة، قبّل يد زوجته تقديرًا لصمتها ومعاناتها. عندها، أدركت أن الغاية قد تحققت: أن يصل صوت المرأة في تجربة الولادة إلى من لم يعشها بجسده.
وفي النهاية، حين قرأت د. لطيفة البصير المخطوط، منحتني كلماتها المشجعة دفعة أخيرة لإخراجه إلى العلن. لقد كان النص بالنسبة إليّ جزءًا حميميًّا وخاصًّا، لكن حين لامس الآخرين بهذا الشكل، أيقنت أن ولادة الكتاب لا تكتمل إلا حين يُقرأ ويصبح جزءًا من حياة غيري.
د. حسام الدين درويش:
قد تكون هذه هي الولادة الحقيقية للكتاب. فتفاعل القرّاء مع الكتاب بهذه الطريقة هو ما أعطاه حياة جديدة. فالكتاب، عندما يُطبع، يموت من منظور كاتبه؛ إذ لم يعد يفكّر فيه أو يشعر به، بل يصبح أمرًا منتهيًا. غير أنّه يُبعث من جديد مع كلّ قراءة، وربما في ذلك سرّ جماله. ومن هذه القراءات، كانت قراءة العزيزة رنا وقراءة العزيز عبد السلام شرماط.
د. ميادة كيالي:
لقد كانت قراءات الأصدقاء من أكثر ما منحني الاطمئنان. رنا صديقة عمري، رغم معرفتها بكل تفاصيل الرحلة، خطوة بخطوة، ومع ذلك، حين قرأت النص شعرتُ أنني أقدّم لها شيئًا جديدًا. وكذلك أختي ريما التي واكبت التجربة منذ بداياتها، فكان لرأيها وقعٌ خاص عليّ.
أما د. عبد السلام شرماط، فقد كتب نصًّا رائعًا ومكثّفًا عن الكتاب، مليئًا بالتعليقات العميقة التي أعادتني إلى النص بعين مختلفة. وكان د. يونس الوكيلي شغوفًا بمعرفة شعور المرأة تجاه هذا النص، وأخبرني أنّه وجد فيه تعبيرًا صادقًا عن التجربة الإنسانية للولادة، وإن لم أكن قد أرسلت إليه النسخة الكاملة بعد.
د. حسام الدين درويش:
في ذلك الوقت، كان الجميع يقرأ الكتاب دفعة واحدة.
د. ميادة كيالي:
لقد كان لافتًا أنّ من اطّلعوا على المخطوط قرأوه دفعةً واحدة، ولم يتركوه حتى أنهوا صفحاته. واكتشفوا معه ميادة من جديد، عندها أيقنتُ أنّ الكتاب لم يخرج منّي فقط كحالة شخصية، بل أصبح تجربة مشتركة تولد مع كل قراءةٍ جديدةٍ.
د. حسام الدين درويش:
دعينا نختم بسؤال يمزج بين هذا الكتاب وكتاب المذكرات أو السيرة الذاتية، في إطار مقولة: "ميادة وما أزال". من ناحية أولى، هناك الاستمرارية، فأنت أصدرت كتابًا كُتِب قبل 25 سنة يتعلق بذاتك، فهل ما زال يعبر عنك ويعكس فكرك وأسلوبك، من ناحية الاستمرارية، حتى الآن. فهل تتبنينه وكأنك كتبته اليوم؟ فنحن جميعًا نمرّ بانقطاعات كبيرة في حياتنا، ننتقل من مرحلة إلى أخرى، ونشهد تطورًا مستمرًّا. فكيف يمكن الجمع بين هذه الاستمرارية من جهة، وبين كون النص مكتوبًا قبل 25 سنة وكأنه وُلِد للتوّ؟ إذن أنت ميادة وما تزالين في هذا النص نفسه.
إذا نظرنا إلى الموضوع من منظورٍ فلسفي؛ هوية الإنسان متغيرة دائمًا أو عبر المراحل العمرية والخبرات المختلفة، لكن يبقى هناك عنصر ثابت فيها؛ بمعنى أن "ميادة ما تزال". فكيف تجمعين، بين "ميادة وما أزال"، بين هذا الثابت، الذي يعكس ذاتك منذ كنتِ في الخامسة أو العاشرة، وبين التغيرات التي طرأت عليكِ؟ وهل ترين أنّ هناك قاسمًا مشتركًا أكبر من الاختلافات؟
د. ميادة كيالي:
هناك أشياء أساسية ظلّت ثابتة في حياتي، تشكّل جوهر "ميادة وما أزال". منذ طفولتي وأنا أؤمن بخيرية الإنسان، وبالطيبة والبساطة، ولم تفقدني التجارب القاسية ولا الانكسارات المتكررة هذا الإيمان. لقد مررتُ بمواقف كثيرة أحزنتني وكسرتني، ومع ذلك لم أتخلّ عن الصبر، ولم أتخلّ عن الثقة بالإرادة، ولم أتخلّ عن اليقين بأن الإنسان قادرٌ على صنع المستحيل وتحقيق أحلامه.
"ما أزال" أؤمن بأن الاجتهاد يقود إلى النجاح، حتى وإن رافقني الفشل أحيانًا. وما أزال أحتفظ بتلك الإنسانة العفوية، الطفلة التي تسكن داخلي، التي تضحك على أبسط الأشياء، وتجلس لتلعب مع الأطفال وتشاركهم براءتهم. هذا الجوهر لم يُسرق مني، رغم كلّ ما عايشته من صعوبات.
أقول دائمًا: ما زلت أؤمن أن على هذه الأرض ما يستحق الحياة. فهويتي تبدّلت كثيرًا عبر المراحل المختلفة: من فتاة صغيرة، إلى طالبة وباحثة، إلى أمّ، إلى مديرة وناشرة، لكن هناك خيطًا رفيعًا يربط بين كل هذه المراحل: إيماني بالإنسان، وبالمحبة، وبأن المعنى الحقيقي للحياة يكمن في أن نحيا بصدق ونواصل الحلم.
د. حسام الدين درويش:
حياة كلّ إنسان تستحق أن تُروى، وإذا استطاع أن يرويها، فذلك شيء جميل. وفي حياة الإنسان كثير من الأمور المميزة، لكنها مليئة بالتحولات الجذرية؛ من ميادة الزوجة التقليدية، إلى ميادة المرأة الإدارية المشرفة على تأسيس وتطوير شركة أو مؤسسة كبيرة، ومن ميادة الكاتبة الأدبية إلى الباحثة، إلى الأم، إلى أدوار أخرى. فهناك أشياء قد يصعب ربطها معًا، فكيف يمكن أن يكون هذا الشخص نفسه هو نفسه، على الرغم من كل التغيرات التي طرأت عليه؟ فما الذي بقي من ميادة الزوجة أو الطالبة أو الموظفة الحكومية أو المهندسة؟ أي ماذا بقي من صفاتك السابقة، أو ما زال موجودًا في شخصيتك حتى الآن؟ وما الذي تغيَّر؟ وعلى الرغم من أنه يبدو أن هناك اختلافًا كبيرًا، فما زلت ميادة تحتفظين بالطيبة نفسها، بالكثير من السمات نفسها، ولا أدري إذا كنت ما زلت تحتفظين بالطموح ذاته وبالإرادة ذاتها؟
د. ميادة كيالي:
نعم، هذا بالضبط ما دفعني إلى إخراج هذا الجزء من سيرتي إلى النور، وما يدفعني إلى استكمال باقي المحطات. فقد رافقتني، في كلّ هذه التحولات، سمات أساسية لم تتغير: الطيبة، الإيمان بالنفس، والإرادة التي صنعت مساري. صحيح أنّ الأدوار تنوعت بين الطالبة والمهندسة والزوجة والأم والباحثة والمديرة، لكن الجوهر بقي واحدًا؛ الطفلة المحبة للحياة وللآخرين، الواثقة بأنّ رسالتها تستمد معناها من علاقة صافية بخالق الكون، الحارس على ضميرها، والهادي إلى الخير في كل خطوة.
د. حسام الدين درويش:
ألف مبارك مرةً أخرى، وأتمنى أن نكمل هذا الحوار قريبًا. وأطيب التحيات.