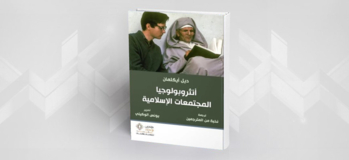ديل إيكلمان: صورة من حياة مثقف من البادية، سيرة الحياة لقراءة التاريخ الاجتماعي
فئة : مقالات

ديل إيكلمان:
صورة من حياة مثقف من البادية، سيرة الحياة لقراءة التاريخ الاجتماعي
مدخل عام:
تبرز أهم المعيقات التي تتعرض الباحث الأنثروبولوجي بشكل أساسي في مسألة المنهج وأدواته الاستقصائية والمنهجية، والتي تخول له النفاذ للعمق المستبطن، وأسرار ومكنونات الظاهرة؛ فالاستهتار بالمنهج أو عدم احترام مجتمعات الدراسة، واستخدام مناهج لا تتماشى وطبيعتها الثقافية والاجتماعية، شركٌ قد لا يوصل الباحث إلى أي نتائج مرجوة.
ويعد المنهج كيفي الوسيلة الناجعة لولوج البحث الإثنوغرافي، هذا الذي يعرف اصطلاحا أنه الكتابة عن شعب أو ثقافة، وهو مكون من الكلمتين اليونانيتين ethnos التي تعني الشعب وgraphi التي تعني الكتابة. ويعني مصطلح الملاحظة بالمشاركة البحث عن المكان الذي توجد فيه المعطيات التي تحظى بوجاهة في البحث وتنسجم مع أهدافه. بينما يشير مصطلح البحث الميداني إلى تقنيات جمع المعطيات وفق منهج علميّ يضمن توثيقها.[1] ولما له من قدرة على تقصي المواضيع المستفحلة في مجتمع وفهم الطبيعة الميكرو اجتماعية، ولعل أهم مداخل هذا الفهم هو تفكيك المعنى الذي تنتجه الأفراد والجماعات في حياتهم اليومية، خاصة أن الذهن البشري حسب شوتز يقوم باستمرار بعمليات تأويل للأحداث والوقائع.[2]
كما أن المنهج يسمح لنا أن نستقصي الظاهرة من خلال كلمات أصحابها، وغالبا ما يتم ربط البحث الكيفي بالمدرسة الـتأويلية في العلوم الاجتماعية، والذي لا يكون فيها منطق البحث هو اختبار نظريات معينة حول ما يتحكم في السلوكيات الاجتماعية، بقدر ما هو تقييم الدوافع الضمنية التي تحث الأفراد إلى فعل ما يفعلونه.[3]
و تعتمد البحوث الكيفية في الدراسات الأنثروبولوجية على مجموع من المناهج والأدوات التي تتغيا الاستقصاء المتغلغل للمجتمعات المدروسة، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، الملاحظة بالمشاركة، المقابلات التي تنقسم إلى عدة أنواع، موجهة ونصف موجهة والمفتوحة، إضافة إلى السيرة الاجتماعية وتحليل الوثائق، والأركيولوجيا البشرية، والاعتماد على الذاكرة وتوثيق الرواية الشفوية بشقيها المكتوب والمصور.
تروم هذه الورقة الانفتاح على أحد أهم المناهج الإثنوغرافية في المقاربة الأنثروبولوجيا، والمتعلقة أساسا بسيرة الحياة؛ وذلك عبر منهج استنباطي يقوم على ماهية المنهج كطريقة بحث تم توظيفها من طرف الباحث الأانثروبولوجي ديل إيكلمان 1942 في دراسته الشهيرة: المعرفة والسلطة بالمغرب؛ صورة حياة مثقف من البادية في القرن العشرين، التي استعمل فيها هذا المنهج لاستخراج معلومات في تلك الفترة، بُغية كتابة سيرة اجتماعية، تدل من خلال أحداثها عن واقع معين، هو الطريقة التي تطور من خلالها التعليم الديني في القرن العشرين.
وعبر هذا المنهج قرر دراسة مسار حياة القاضي عبد الرحمان المنصوري، بصفته مادة معرفية شهدت هذا التحول من نمط التعليم الديني التقليدي إلى نمط التعليم الحديث الذي جاء نتاج للحضارة الغربية، ونجد هذا التحول واضح بشكل جلي في مختلف فصول الكتاب، وسنلاحظ في هذه الورقة بعض الملاحظات حول طريقة توظيفه للمنهجية مع استحضار مناهج أخرى تتماشى مع طبيعة هذه الأداة في البحوث الكيفية.
البحث الأنثروبولوجي السيرة الذاتية أو سيرة الحياة:
لابد لنا من التوضيح بإسهاب الفرق بين كل من السيرة الذاتية وسيرة الحياة؟ وأيهما تستخدم كأداة للبحث في المقاربة الأنثروبولوجيا الكيفية، تعدّ السيرة الذاتية بشكل عام وواضح كما ميزها باسكل في تعريفه، أنها رواية ذات طابع تأملي في سيرة شخص بعينه، وتحاول أن تستعرض حياة كاتبها أو الشخصية الرئيسة بالكامل اعتمادا على الذاكرة وقد لا يتم الاهتمام بالمسار الاجتماعي وسياق التحولات التي تختزنها تجاربه الاجتماعية بالضرورة، حين تعتمد سيرة الحياة على حكي الأفراد ومساراتهم بوصفها تجربة اجتماعية وفينومنولوجية[4]، فنجد الدكتور مختار الهراس يقول: إن الأمر في الواقع لا يتعلق بصورة ذاتية autobiographie، فرغم أن المبحوث يتحدث عن حياته الشخصية، فإنه لا يقوم بذلك وحده ولا يكتب ما يمكن من تذكره، بل إنه يروي سيرة حياة بحضور الباحث وتماشيا مع الأسئلة التي قد يطرحها عليه هذا الأخير من حين لآخر، فالأصح أن نتحدث عن المنهج البيوغرافية عن منهج السيرة أو عن منهج تاريخ الحياة.[5] ويقول إيكلمان في كتابه، غير أن مفهوم السيرة للقراء الناطقين باللغة الإنجليزية يحيل مباشرة على الجنس الأدبي من العهد الفيكتوري يفترض فيه الكاتب أن قراءه، يشاطرونه ميراثا ثقافيا ومعرفة بالسياق التاريخي، ومن ثمة فإن أكثر القضايا العامة تثار بطريق ملتوٍ غير مباشر فحسب.[6]
المنهج السيكوبيوغرافي أو المنهج الإثنوبيوغرافي:
إن كنا وضحنا في البداية أنه يجب التفريق بين السيرة الذاتية التي لها طابع فلسفي تأملي وحتى أدبي في تركيزها على تجارب الأفراد وحياتهم، فلا بد في المستوى الثاني من المناقشة التفريق بشكل جوهري بين السيكوبيوغرافيا التي هي منهج معتمد في علم النفس بشكل كبير والذي له طابع سيكولوجي علاجي؛ وذلك من خلال الرجوع إلى التاريخ الشخصي للأفراد والوقوف على بعض الصدمات والمشاكل التي عاشوها وكذلك الدوافع الداخلية والأزمات النفسية ومحاولة التصالح معها، حيث إن المنهج الإثنوبيوغرافي، لا يجعل من الشخصية في حد ذاتها بؤرة اهتمامنا، بل السيرة ليست بالنسبة إليه سوى وسيلة للتعرف على الأحداث والوقائع ومجمل السيرورات والعلاقات الاجتماعية العامة، الإثنوبيوغرافيا، بتعبير آخر هي (البيوغرافيا الاجتماعية والثقافية للكائن الجماعي الذي لا يشكل الراوي سوى أحد مكوناته.[7] ويرى ايكلمان السيرة بوصفها وثيقة، حيث يقول في كتابه موضوع الورقة، أن منهج السيرة في الأنثروبولوجيا هو بمثابة وثيقة اجتماعية، وهكذا عنون الفصل الأول من الكتاب، فبعد إبراز النتائج التي حققها هذا المنهج في المغرب عبر استعمال مجموعة من الباحثين له أمثال كليفورد غيرتز وواتربيري، يعتبر ايكلمان السيرة كأداة لتحليل موضوعات مختلفة؛ مثل حالات المس من الجن، و........، ....... والعلاقات الاسرية، والاغتراب السياسي، و"الثقافي". وقد حققت كل هذه الدراسات نجاحا في الحدود التي تمكنت فيها من تقديم وصف مقنع للقضايا الاجتماعية والثقافية الرئيسة.[8]
السيرة من خلال مناقشة الدراسة:
استخدم الباحث إيكلمان الحاج عبد الرحمان المنصوري، للعمل على مقارنة بين التعليم الإسلامي وأشكال التعليم الحديث، موظفا ترسانة من المفاهيم التي سبق أن عرفها واستخدمها في دراسته للشرق الاوسط، ويقول: "بعد حصولي على شهادتي الجامعية الأولى لأشغر في تعلم العربية؛ مع التركيز على الشرق الأوسط. وبعد تخرجي في الأنثروبولوجيا من جامعة دارتموث، تابعت دراستي بمعهد الدراسات الإسلامية بجامعة ماكغيل بكندا........ بعد سنتين بماكغيل حصلت على الماستر في الدراسات الاسلامية، ثم التحقت بجامعة شيكاغو لإعداد الدكتوراه في الأنثروبولوجيا.[9]
بمعنى أن الباحث وهو يقوم بإنتاج مادة معينة، فهو يستحضر ما تعلمه عن ثقافتنا من خلال مجتمعات أخرى، ويقوم بإسقاط الضوء على شخص له القدرة الكشفية، من خلال تموقعه في المجتمع (المصداقية)، وعلمه بالحقائق الاجتماعية.
وفي هذه الدراسة، تم استخدام منهج السيرة الاجتماعية لكسر الصورة النمطية التي يحملها الغربيون على التعليم الإسلامي وحمولاته الدلالية، التي كان يتخذها في الفترة 1985.
التأويل طريق للفهم:
استعمل إيكلمان المنهج الوصفي التفسيري مركزا على تقنيات السيرة التي طبقها مع الحاج عبد الرحمان، والمدة الطويلة التي أخذها في العيش معه لفهم العمق المغربي، فكما تتعزز أهمية منهجية دراسة الحالة كمنهجية كيفية عندما ننظر لها من منظور المهمة الأولى للعلم الاجتماعي، يمكن الإشارة هنا على سبيل المثال لا الحصر، إلى ما قدمه ألفريد شوتز وبكيفية غير مباشرة ماكس فيبر قبله، بخصوص العلم الاجتماعي الذي يكمن في منح الأنشطة البشرية معنى دائما بممارسة عمليتي الفهم والتأويل كمنطلق منهجي وإبستمولوجي[10]، كما أن مسألة التأويل بُغية الفهم في تقنية السيرة، لاتزال معتمدة، حتى وإن خفت بريق المدرسة التأويلية في المقاربة الأنثروبولوجية، وقد شهد حقل الأنثروبولوجيا الاجتماعيَّة تغيُّراً مُستمرَّاً. لذا، أصبحت علامة «الأنثروبولوجيا التَّأويليَّة» أقلَّ استعمالاً اليوم بعد أن سادت في سنوات السَّبعينيات والثَّمانينيات. باعتراف الباحث؛ وهكذا، أجد نفسي أقلَّ فأقلَّ مقتنعاً باستعمال هذه العلامة أو غيرها؛ لأنَّ التَّاريخ الاجتماعيَّ والأنثروبولوجيا الاجتماعيَّة تتغيَّر بانتظام من حيثُ الشَّكل والنِّطاق، شأنها شأن كلِّ الحقول العلميَّة[11]، واستخدم هذه التقنيات على الحاج عبد الرحمان وكانت مطولة لفهم السياق العميق للمجتمع المغربي، ويقول صاحب الكتاب في هذا الباب: "ولعل أكبر مشكل يواجه البحث الأنثروبولوجي، هي الكيفية التي تمكنه من جعل الناس يشرحون إدراكهم للأحداث".[12]
كان إيكلمان، وهو يحاول فهم المجتمع عبر سيرة الحاج المنصوري يقوم بالكتابة وتحليل المحتوى وفك المقاطع ذات المعاني المركزة حول الظواهر التي يتغيا فهمها، من خلال الدراسة، ويؤكد أن العمل الميداني هو رهين بموضعة الذات في الموضوع وإعادة الكتابة الإثنوغرافية، يقول: "فالعمل الأنثروبولوجي الأكثر أهمية بالنسبة إلى الباحث لا يبدأ إلا عندما يسلم الناس جدلا بأن هناك تقويما مشتركا للقضايا، مع الإشارة إلى أن خلفية الإدراك هاته هي في الغالب أصعب القضايا للتوضيح"،[13] حيث لا يمكن الوقوف حد تأويل المبحوث، وإن الوقوف عند المعطى التأويلي للمشارك في هذه الدراسة، بوصفه تأويلا أوليًّا، هو بغرض بناء تأويل ثان للباحث/للملاحظ حول المعيش اليومي.[14]
المقابلة في منهج السيرة:
لا مشاحة في أن ما يجمع الباحث والمبحوث في المنهج السيرة هو الحوار، ما يجعله ضروري للمعرفة الإثنوغرافيا، وهو جوهر التفاعل بين إيكلمان والحاج المنصوري، للتقييم الممارسات الدينية ودراسة علاقة السلطة بالمعرفة، ولابد من تواجد شق مفاهيمي يوظفه المبحوث في أي سياق توجب على المشتغل بهذه الأداة استنباطه؛ وذلك لا يتأتى إلا في ما يسمى عادة بدليل المقابلة الإثنوغرافية، حيث تختلف هذه الطريقة في الاستجواب عن الطريقة السابقة بكونها تتم في وضعية محددة نطلق عليها عادة الميدان (terrain / field). إن الميدان الإثنوغرافي هو السياق الاجتماعي الذي يواجه المقابلة من خلال الأسئلة المطروحة، ونوع الذين تم استجوابهم، وكيف تم تأويل أجوبتهم، علاوة على ذلك يستعين الباحثون الإثنوغرافيون بملاحظات من الميدان في تقييم معنى معطيات المقابلات ومصداقيتها.[15]
و قد استعمل إيكلمان هذا النوع من المقابلة بشكل كبير في كتابه خصوصا عندا كان يرافق الحاج المنصوري في رحالته، أو يذهبان معا للتلبية دعوة أحد أصدقاء الحاج ويكون غالبا من الأعيان، أو حين كان يحضر مع الحاج جلسات الحكم التي كان غالبا فيها ما يستفسر عن بعض الأشياء والتفاصيل التي تجري بشكل فوري، ففي النص الإثنوغرافي غالبا ما نجد الراوي يشارك في التفسير للحياة المعيشة ويكشفها بوضوح عبر طريقة تتسم بالحذق؛ ذلك للكم الهائل التي قد توفره له تلك الأسئلة اللحظية من حقائق ونتائج قيمة.
خلاصة:
حاولنا من خلال هذه الورقة إبراز أهم الفروق التي تجعل منهج سيرة الحياة تقنية من التقنيات الأساسية في الأنثروبولوجيا، بحكم أن الأفراد المنصهرين في ماضيهم وفي سياقتهم الاجتماعية. وبما تمكننا هذه التقنية من الولوج إلى مكنونات الماضي واسترجاعه والتعبير عليه بما هو آني، وفي هذا السياق يعد منهج السيرة كما أبرزه كتاب ايكلمان في المعرفة والسلطة، وسيلة لتعرف على المجتمع وعلى الثقافة وعلى المختلف والبعيد مادام الأفراد هم مرآة المجتمع وانعكاساته، فمنهج السيرة يتحول بهذا إلى أداة تحاول أن تحاكي القيم الإنسانية للفرد ولمحيطه الاجتماعي، والتعرف على الأحداث والوقائع، ومجمل السيرورات والعلاقات الاجتماعية العامة التي قد قدمها باعتبار الأطراف المشاركة في البحث، ذوات منتجة للمعاني في العالم الاجتماعي.
لائحة المراجع:
- ديل إيكلمان، ترجمة، محمد عفيف المعرفة والسلطة في المغرب، صورة حياة مثقف من البادية في القرن العشرين، مركز طارق بن زيد للدراسات والأبحاث.
- حسن أحجيج/جمال فزة، البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية، فضاء آدم للنشر والتوزيعة الطبعة 1
- عبد الهادي الحلحولي مقال" المسنون والحجر الصحي في زمن جائحة كوفيد19 في المغرب
- مختار الهراس، المنهج سيرة في السوسيولوجيا، كتاب: إشكالية المنهج في الفكر العربي تقديم عبد السلام بن عبد العالي
- حوار مع ديل أيكلمان الأنثروبولوجيا وتحوُّلات المجتمعات الإسلاميَّة، ترجمة يونس الوكيلي مؤسسة مؤمنون بلاحدود https://is.gd/TZhWX0
[1] - حسن أحجيج/جمال فزة، البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية، فضاء آدم للنشر والتوزيعة الطبعة 1، ص 141
[2] - عبد الهادي الحلحولي مقال" المسنون والحجر الصحي في زمن جائحة كوفيد19 في المغرب... ص 17
[3] - حسن أحجيج/جمال فزة، البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية، فضاء آدم للنشر والتوزيعة الطبعة 1، ص43
[4] - د. عبد الهادي الحلحولي مقال" المسنون والحجر الصحي في زمن جائحة كوفيد19 في المغرب ص 14
[5] - د. مختار الهراس، المنهج سيرة في السوسيولوجيا، كتاب: إشكالية المنهج في الفكر العربي/ تقديم عبد السلام بن عبد العالي ص 85
[6] - د.ديل ايكلمان، ترجمة، محمد عفيف المعرفة والسلطة في المغرب، صورة حياة مثقف م البادية في القرن العشرين، مركز طارق بن زيد للدراسات والأبحاث، ص 24
[7] - مختار الهراس، المنهج سيرة في السوسيولوجيا، كتاب: إشكالية المنهج في الفكر العربي، تقديم عبد السلام بن عبد العالي ص 86
[8] - ديل إيكلمان، ترجمة، محمد عفيف المعرفة والسلطة في المغرب، صورة حياة مثقف م البادية في القرن العشرين، مركز طارق بن زيد للدراسات والأبحاث، ص26
[9] - حوار مع ديل أيكلمان الأنثروبولوجيا وتحوُّلات المجتمعات الإسلاميَّة، ترجمة يونس الوكيلي مؤسسة مؤمنون بلاحدود https://is.gd/TZhWX0
[10] - د. عبد الهادي الحلحولي مقال" المسنون والحجر الصحي في زمن جائحة كوفيد19 في المغرب... ص 16
[11]- حوار مع ديل أيكلمان الأنثروبولوجيا وتحوُّلات المجتمعات الإسلاميَّة، ترجمة يونس الوكيلي مؤسسة مؤمنون بلاحدود https://is.gd/TZhWX0
[12] - ديل ايكلمان، ترجمة، محمد عفيف المعرفة والسلطة في المغرب، صورة حياة مثقف م البادية في القرن العشرين، مركز طارق بن زيد للدراسات والأبحاث، ص ص36-37
[13] - ديل اكلمان، نفس الصفحة.
[14] - عبد الهادي الحلحولي مقال" المسنون والحجر الصحي في زمن جائحة كوفيد19 في المغرب... ص 16
[15] - حسن أحجيج/جمال فزة، البحث الكيفي في العلوم الاجتماعية، فضاء آدم للنشر والتوزيعة الطبعة 1، ص109