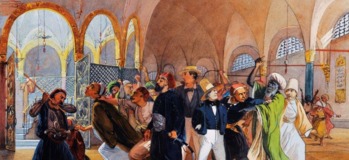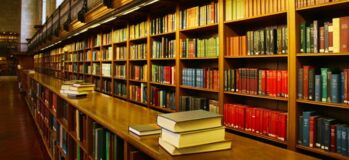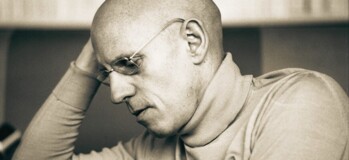الدرجة الثالثة من المعرفة في العلوم الاجتماعية تأملات ابستمولوجية في المعيش
فئة : مقالات
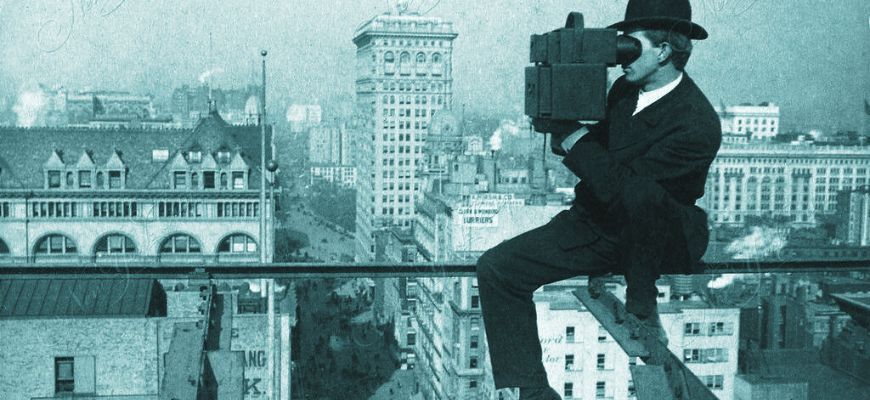
الدرجة الثالثة من المعرفة في العلوم الاجتماعية
تأملات ابستمولوجية في المعيش
"بدون وعي ناقد كافٍ يمكن للعلوم الاجتماعية أن تسهم في السيرورة الجماعية للتعتيم، مثل هذه العلوم مصابة بسوء المعرفة: تلك التي تخفي تورطها[1]"
مقدمة
يبدو أن اللغة التي يعبر بها عن الرغبات والحاجات في الحياة اليومية لا تعتمد على الجمل الخبرية التي تجيب معرفيًّا بمعطيات وبمواقف وباتخاذ قرارات، والتي تحتمل الصدق أو الكذب فحسب، بل هي لغة تعبر أيضا بجمل إنشائية تعتمد ما يرتبط بالحركة والفعل؛ من أمر ونهي، أو استفهام أو تمنٍّ أو تعجب؛ من إحجام أو إقدام أو توقف أو نكوص، والتي ترتبط بالحاجات سواء الأكثر غريزية، أو الثقافية والنفسية والاجتماعية، والمرتبطة بإثبات الذات ومقاومة الزوال.
يبدو للوهلة الأولى، أن هذه الجمل تشتغل بما يناقض العقل، هي الكهف الذي يجب أن يخرج منه الأفذاذ بالتجريد الذي يستطيع التحرر من أغلال الصور والاستعارة كما في أسطورة الكهف الأفلاطونية نحو المعرفة العالمة، لكن الفحص الدقيق يظهر عكس ذلك، حيث عالم الأشباح والصور والاستعارات لا يقل عقلانية، وحيث العالم الذي يبنيه الأفذاذ لا يقل رغبات وحاجات ومشاعر.
السؤال الذي تحاول هذه المساهمة مناقشته يتضمن خمسة مستويات مركزية؛ يتجلى أولها في التساؤل عن لاعقلانية المعرفة اليومية، أو بتعبير آخر هل لهذه المعرفة منطق؟ وهل تهتم هي أيضا بتحديد موضوعات اشتغالها؟ وهل تحدد أهدافها؟ وما مدى اعتمادها على وسائل توصلها لهذه الغايات؟ وكيف؟ وما علاقتها بعدم التناقض والثالث المرفوع؟ وهل تستطيع الاستدلال؟ وكيف؟
المستوى الثاني، يرتبط بما نجهل، وكيف يشتغل هو أيضا؟ بتعبير أدق، هل يمكن الحديث عن إبستمولوجيا للجهل؟ ضمن البحث فيما لا نعرف، أو في تخوم ما نظن أننا نعرف. متى نجهل؟ وكيف؟ ولماذا؟ وماهي الآلية التي نستعملها لنجهل؟ وما، ومن الدافع؟ وكيف؟ وهل هناك علاقة للجهل بالعقل؟ ثم ضرورة فحص أشكال الجهل، من الغلط الذي قد يرتبط بالعمد أو التهور أو التمادي، والخطأ الذي يكون عفويًّا ونستعد لتصحيحه، والوهم، الضار والمفيد، ودرجاتهما، والكذب بأشكاله، بنية الخداع أو بغيره، والافتراء العمد، إلى غير ذلك من الأدوات التي يستعملها الجهل، حتى لا يقترب من المعرفة أو يتبنى أسوأها، من أجل التبرير والاتقاء، كأسلوب حياة يغلف المعيش، وليس للسوسيولوجيا أن تحكم، وإنما أن تفهم.
أما المستوى الثالث، فيحاول فحص ذلك الفضاء الذي نظنه فارغا، ولا يفعل سوى أن يعرقل المعرفة والعلم والعقلانية والملاءمة. أليست هناك فوائد للجهل على المستوى الفردي والجماعي؟ عمليًّا ونظريًّا، الجهل كآلية سيطرة وهيمنة، والجهل كمنطلق للمعرفة.
يتجلى المستوى الرابع في المعرفة اليومية للعلماء، فيما يجهلون، فيما يبصرون، ومالا يبصرون، فيما يعون ولا يعون، العلماء أيضا يملكون وعيا ولا وعيا، وإلا أصبحوا آلات منطقية تقنية.
إن أي إدراك لا يمكن أن يكون استنساخا فجا للواقع، بل هو بناء يرتبط بالتعلمات السابقة وحتى بالرغبات المحيطة بها.
يتجلى المستوى الخامس في البحث في علاقة المعرفة بالأخلاق والالتزام. هل يكفي أن نعرف، أم علينا أن نتصرف وفق ما نعرف؟ ثم هل يجب أن نتصرف ونسلك وفق الأعراف والقوانين والمساطر المتوافق حولها؟ أم وفق الخير والشر المطلقين؟ وما هي درجة إمكانية ذلك عمليا في اللحظات الحاسمة؟ ثم هل تكفي المعرفة، أم يجب أن نتسلح بالتمرن الكافي من أجل اليقظة اللازمة لاتخاذ المواقف والقرارات؟
1. الرغبة والعواطف
الرغبة وما يتصل بها من الحاجات والانفعال والعواطف لا يمكن تركها في الظل على أساس أنها لا ترقى إلى الموضوعات المتصلة بالعقل والذكاء والكياسة والترشيد، سواء على المستوى النظري أم العملي. الرغبة هي المحرك الأساس للإرادة التي بدورها تصنع الأفعال والسيرورة والمصائر.
ومادامت الرغبة متصلة بالحاجة، فلابد من فحصها هي أيضا، ليس على المستوى البيولوجي أو النفسي، بل وفق السياقات التي تحتم الأولويات. البعد الاجتماعي للحاجة أمر ملح وفق الفئات الاجتماعية، سواء من حيث الوضع الاجتماعي أو الجنس أو السن، وكذلك وفق تضارب المصالح والقوى، وأيضا وفق التنشئة الاجتماعية، وإعداد وصناعة الجماعات والأفراد وتدبير حاجاتها وتقديرها وتقويمها.
تدفع الحاجات إلى الرغبة والإرادة اللتين تدفعان إلى المعرفة، ليس الملائمة ضرورة، بل المرتبطة بالمعيش كتمثلات جماعية وفردية تتراوح بين الرؤية الشجاعة في المرآة التي تستطيع رؤية الكمالات والنقائص، والقبح والجمال، وتتدرب على المواجهة ليس لأحكام وقيم الآخر فحسب، وإنما لذاتها أيضا، لمخاوفها وهواجسها وأوهامها، وكل ذلك من أجل الملاءمة والارتواء الكافي، أو التقاعس والتهرب من الخصائص مثل المريض الذي تخيفه التحاليل الطبية والفحوصات والتشخيص، ويفضل عليها الجهل من أجل إرضاء المخاوف والهواجس، بذلك يمكن للحاجات أن تصبح أمراضا مزمنة مستعصية وإدمانا لعشق للعيوب، وعدم القدرة على الانفكاك، بذلك تصنع الجهل بأنواعه مثل اختيار المسكنات والكذب على الذات، وهذا هو الاستلاب الذي تسهم آليات ذهنية عدة في صناعته وتنميته لعل أهمها الإيديولوجيا.
كما للمعرفة سياقات وشروط ومحفزات ومحبطات وعوائق وثورات وقطائع، أيضا للجهل سياقات ومشجعات وانتكاسات كبرى يمكن اعتبارها ثورات معكوسة وثقوب سوداء تبلع تراكمات ومجهودات قرون وأفذاذ، فيتم ذلك إما بالجمود على الموجود، والتثبت على الأوهام، أو التوجه نحو الخلف والعيش الذهني في ماضٍ يعدّ ذهبيا؛ لأن الحاضر مخيف ولا نستطيع مواجهته، من أجل ملاحظته ووصفه وتشريحه، ومحاولة انتاج معارف ملائمة حوله لتحسين وضعه. ولا يشمل التثبت والنكوص الحياة والمعرفة اليومية فحسب، بل وحتى المعرفة الأكاديمية.
بذلك يفضل التعبير عن الحاجة والرغبة، والمكبوتين خاصة، أسلوبا آخر لا يعتمد الثالث المرفوع، أسلوب الرمز والغمز واللمز والاستعارة والالتفاف على المطلوب، بحبال الرياء والكذب والنفاق على الذات قبل الآخر.
لكنه بالنسبة إلى السوسيولوجيا يعتبر التعبير عن المعيش أقوى من الواقع نفسه في الدلالة والملاحظة والمقابلة والمقارنة، هو مستوى ثان في التمثل والاستلاب والإيديولوجيا، لكنه أول كميدان بالنسبة إلى المستوى الثاني الآخر الذي هو البحث السوسيولوجي، والذي يملك هو أيضا مستواه الثاني والذي هو معيش العلماء وتمثلاتهم واستلابهم وعاداتهم، والإيديولوجيا التي يعبرون عنها بوعي أو بدون وعي.
كل ذلك حتى يأتي المستوى الثالث الأعلى الذي يفحص تمثلات الأفراد والجماعات، وتمثلات العلماء على حد سواء، وهذا ما تهتم به الابستمولوجيا وسوسيولوجيا المعرفة والإدراك.
من دون المستوى الثالث النقدي يمكن للعلوم الاجتماعية أن تسهم في التعتيم، عندما تبقى على مستوى الفحص الكمي مثلا فتحصل على نصف المعرفة، أو حتى سوء المعرفة، وهي أنواع من الجهل المغلف بالأرقام، أو حتى بالإثنوغرافيا المحايدة بسذاجة العلموية والموضوعية المدعية.
يعدّ التعبير عن الحاجات والرغبات هو المعيش نفسه الذي يتجلى في التمثلات التي بها ندافع عن الذات وبقائها، في حالات أقوى يصبح المعيش دفاعا أو هجوما، فيغلف الواقع بأشكال ثقافية وتعبيرية غير عقلية، مثل الخرافة والأسطورة والقراءات الانتكاسية للدين والايديولوجيا، وكل أنواع المعتقد المغلق، الذي يتجنب أي إمكانية الانتقال إلى معتقد آخر، وقد يتخذ الأمر نوعا من العلموية البدائية التي تريد القضاء على المعيش المعتاد والسقوط في آخر يتمظهر بالعقل والمنطق والعلم والفلسفة دون ملائمة.
ومع ذلك لا يجب نسيان أن المعيش نفسه يتطور، وقد يستبدل آليات بأخرى وقد تنتحر معتقدات لتبرز أخرى ودواليك.
2. منطق سوء المعرفة والجهل
لا تنبع الحاجة والرغبة من الذات الفردية، وإنما من التفاعل مع ذوات أخرى، من المقارنة؛ والاستلهام؛ والمحاكاة؛ والمنافسة؛ والغيرة، ثم إن التعبير عنها وكما مر وقلنا، ليس خبريًّا يصدق أو يكذب، بل هي سرديات إنسانية تنبع من ذوات خاصة وعامة وسياقات، وأحيانا متخصصة، كما لدى الزعماء والقادة والمرشدين والقساوسة والفقهاء والشيوخ، ليصبح المعيش مصنوعًا على مقاس المعابد ومصالها، وعلاقتها بذوي السلطة والجاه، والرساميل المادية والرمزية، فتصنع أسرار وقواعد لما ينبغي فعله وما لا ينبغي، تارة بكتاب مدون، وتارة بأفعال معقدة، وأعمال قد تقترب من السحر، والتأثير غير المرئي، تحذيرا أو نهيًا؛ أو أمرًا أو حمدًا؛ أو تقبيحا أو نصيحة.
وقد يصعد الأمر إلى مستوى أعلى نحو دعاة كبار يضعون تيارات وحركات وتنظيمات تؤثر في سلط دنيوية وأخرى دينية توجه إلى ما ينبغي أن يعرف وما لا ينبغي.
إن مسألة المعرفة ليست مؤسساتية فحسب، بل هي أيضا مسألة الجهل، وما يرتبط به، ومن الجهل أيضا عدم الالتفات لهذه الدينامية، والمنطق الذي به يصنع ويشتغل الجهل، بذلك يصبح ليس لا وعيًا فحسب، بل منطق وقواعد ومقومات.
ويعدّ الأمر جد مهم في سوسيولوجيا المعرفة التي تحاول فهم التوجهات والقيم، وكيف تصنع التصرفات كما في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، نحو التتفيه والتجهيل، أو التطرف بأنواعه الذوقي والعقائدي والسياسي.
3. في المصلحة
فوق الرغبة وتحت العواطف توجد المصلحة، وهي لا تعني فقط إشباع الحاجات وتلبية الرغبات، بل هي أيضا تعبير عن محاولة تنمية الرساميل، ليس المادية فحسب، بل الرمزية والثقافية والاجتماعية.
هناك إبستمولوجيا للمصلحة تساعد كثيرًا على فهم الفعل الاجتماعي ومسالك المعرفة والتصرف، خاصة ظلالها لما نحاول فهم معرفة حقل بتفسيره بمعرفة حقل آخر، فجل الإبداعات الرياضية، لم تكن في الأصل سوى محاولة خلق وسائل نظرية وذهنية تساعد على نمذجة الوقائع الفيزيائية، كذلك في السوسيولوجيا يمكن أن نفسر كثيرًا من النظريات والمفاهيم والأدوات بالعودة إلى العلوم الاقتصادية أو السياسية، أو حتى وقائعهما، وكذلك كثيرًا من الدين ليس سوى سياسة مقنعة.
المصلحة هي تلك الآلية المختفية غالبًا، والتي تحسن لبوس البراءة واللامصلحة، وحتى الفضيلة والأخلاق. هي مثل الرغبة والحاجة والعواطف، وأشكال الجهل جد مفيدة كأداة يمكن الغوص بها في ثنايا الفهم والتفسير، وكل إنتاج للمعرفة يستدعي الفهم، سواء في تتبع سيرورة العلاقات والتفاعلات، أو في الإنصات للذات، وهي تنتج المعنى. والفهم هنا سوسيولوجي لا يتتبع كيف تحدث الأشياء فحسب، بل وأيضا كيف يعبر عنها معاشيا في التمثلات كمعرفة أولى للفاعل الاجتماعي، ثم وحتى كيفية إنتاج المعارف العالمة التي لا تخلو من اصطباغ حياتي بشكل أو بآخر.
الفهم هنا هو محاولة تتبع كيف تدرك الذات ذاتها ليس كوعي بالعالم، وإنما كوعي معرفي للمعرفة.
4. المعيش اليومي والعالم
المعيش هو إعادة إنتاج مستقر، سواء على مستوى أساليب الإنتاج أو المعرفة بمعنييها العملي والعالم، أو القيم، تصبح له قواعد شبه قارة ومعالم تنظم اليومي، ويرجع إليها سواء في التفاعل؛ أم التفاوض؛ أم الخلاف أم التقييم. في المعيش تقل المفاجآت، ولا يختلف حاضره عن ماضيه، ومستقبله مسطر له ويمكن التنبؤ به بسهولة.
كل شيء يبدو كأنه ذلك العود الأبدي غير المنتبه له، والذي يرتبط به الناس بألفة ترضى عن كل شيء، الجميل والقبيح والمفيد والضار، يصبح فيه المرء يعرف ماذا يمكن أن يفعله وكيف ومتى.
وللمعيش أعراف تنظم العلاقات بشكل ملزم بالجزاء، وتغلف البنود بمرجعيات متعددة، رمزية واجتماعية مصلحية، وفئوية انقسامية ملائمة، سواء بالنسبة إلى بعض المجتمعات المحلية التقليدية، أم في التنظيمات والمؤسسات العصرية الإدارية والمقاولاتية، دون القفز على الأكاديمية.
حتى يستمر المعيش فهو يحتاج لآليات أربع أساسية هي التقليد والتلقين والتكرار واليقين.
التقليد
سواء على مستوى المعاش؛ أم على مستوى المعرفة؛ أم على مستوى القيم، يبدأ التقليد بالقرابة، بالانتباه إلى فعل الأب والأم، وأوامرهما ونواهيهما، ثم الإخوة والجيران. يتم التقليد بالمقارنة والمنافسة، وحتى بالغيرة والحسد ومحاولة تجاوز الآخر. إننا لا نعرف إلا بصناعة الآخر، وحتى عندما لا نجده نصنع لأنفسنا من ذواتنا آخر، نستفيد من أخطائنا ونحاول تكرار الناجح، وتجنب الفاشل محاكاة، نسقط مشاعرنا ورغباتنا وعواطفنا على تلبية الحاجات بوعي أو بدونه، نبرر بالتجارب السابقة أو بحماية الذات ولو على الخطأ. المعرفة المعيشية غير متخصصة وغير معقدة وغير عقلانية، في الظاهر فحسب، الغايات محددة في سيرورة تجريبية.
التلقين
يعني التلقين عدم إشراك المتعلم في التعلمات، لا على مستوى محاولة الفهم، ولا على مستوى حق الاستفسار. الكبير يلقن الصغير، والرجل يلقن الرجل، والمرأة تلقن المرأة، والمزارع يلقن الابن، والمعلم يلقن التلميذ، والأكاديمي يلقن الطالب.
غير أن الأمر في الواقع لابد أن يترك بعض التمايز، وحتى بعض الابداع حتى تتراكم وتتقدم المعارف، لكن في المعيش يتم الأمر ببطء وأحيانا شديد.
التكرار
المحاكاة والتلقين لا يتمان إلا بالتكرار، مادامت الوحدة طاغية، والتلقين مطمئن يجب أن تتكرر التعلمات من أجل حفظها واستدماجها وأحيانا بالتماهي. والتكرار لا يترك للفردانية مجال البروز والتميز والاختلاف.
يسعى تمثل المعيش إلى أن يتساوى كل شيء بكل شيء، وكل شخص بكل شخص حتى بإقرار الفروقات والتفاوتات والتراتب، يسعى أيضا إلى الانتماء إلى هوية واحدة، وقيم موحدة يرجع إليها حتى من أجل استساغة الظلم والاستغلال.
تعميم انقسامي يبدأ بالعام المهيمن وفق المقدس، وينزل إلى أشكال أخري للتعميم والتعويم وفق تفيئ، ووضع حدود تابعة للرهانات وموازين القوى.
التكرار مرتبط بمفهوم محايث للتقليد هو الهوية التي نتوهم الانتماء إليها، رغم ما يتبين بصددها من اصطناع وهشاشة؛ لأنها تلبي رغبات وحاجات أعلاها الدفاع عن الذات والبقاء.
هذا التكرار، وهذا التلقين، وهذا التقليد، هي الآليات التي تتسرب إلى المؤسسات، سواء المدرسة أو الإعلام أو الإدارة، حيث يجتهد الجميع وفق تمثل معيشي لتغيير أي شيء من أجل ألا يتغير أي شيء، نحو الركود المعمم.
اليقين
كل ما سبق هو ما يصنع اليقين الذي يتغذى منه المعيش، سواء كان يوميًّا أو عالمًا، اليقين ترميق يجمع من هنا وهناك تفاصيل تركب لكي تصبح كلا يصلح لكل شيء، مثل متلاشيات يمكن لأي واحد أن يأخذ منها ما يلبي حاجته الواعية وغير الواعية.
5. الدرجة الثالثة من المعرفة:
المعيش، منطقه وأنواعه
لا يجعل اليقين موضع شك غير الدرجة الثالثة من المعرفة التي تفحص التفاصيل من أجل ألا يوهمها الوهم. الدرجة الثالثة من المعرفة مسلحة بالأبستمولوجيا وعلوم المعرفة التي تفحص كيف يتمثل الناس حيواتهم، سواء في ممارساتهم المعاشية، أم في إنتاجاتهم المعرفية والثقافية، سواء العادية أو العالمة. وحتى يتم ذلك تمر الدرجة الثالثة من المعرفة إلى فحص المعرفتين اليومية والعالمة من المعيش.
المعيش هو تلك الصورة التي نكونها عن الواقع، ولما كان هذا الأخير متعددا ومعقدا ومتغيرا باستمرار، ولما كان من الصعب تتبعه من خلال حالاته الواحدة، سواء بالكلية أو التجزيء، ولما كان يشمل وجودنا ووجود الآخرين والتفاعل الذي يحصل، ولما كان مكون الصورة ذاتا قبل كل شيء، ذات تكافح من أجل أن تجد مكانة في الظل، تقارن وتنافس وتنفعل وتغضب وتحسد وتحقد، ذات تخلق آليات للتفاوض في كل لحظة، الأمر الذي يحيل الواقع إلى إمكان.
المعيش هو بناء الإمكان من أجزاء ولحظات الواقع، من أجل واقع أكثر استساغة ذهنيًّا وثقافيًّا وتحققا، حفاظا على الذات حتى لا تتحطم وتنكسر أمام هجومات عملية وافتراضية، بذلك تكون المعرفة المعيشية عملية لا تهتم كثيرا بالعلل المتسلسلة كما في العلم، والوضعاني خاصة، وإنما بالعلل التي تهم الذات في ظرفية خاصة، وهي معرفة لا تهتم بالقوانين الموضوعية التي تسير الطبيعة والعالم بالقدر ما تهتم بالقوانين التي تحفظ الذات وتزكيها وتمنعها أمام التقلبات، هذا الذي وقع إن لم يقع لي أنا فلا قيمة له، ثم إن هذه الأنا مطاطة قد تشمل القرابة أو الجيران أو أهل الملة، وحتى عندما أخطئ، فلإرضاء جهة ما أو الملاءمة مع سياق ما يحفظ أو يعيد لي توازني.
يتخذ المعيش تجليات أفعال وأقوال، وحتى نوايا وأهداف وغايات، كما أنه لا ينتبه كثيرا للصحة والخطأ بقدر ما يعتمد الملائمة العملية، والمصلحة التي تلبي حاجات خفية ومعلنة. المعيش مثل الواقع متعدد، منه الكوني الذي يعبر عن حاجات أولية، مثل البقاء والخوف والمنافسة والحسد والغيرة، كما أن منه ما يعبر عن الحاجات الثانوية مثل التميز وتنمية الرساميل أو البحث عن القوة، أو في الحاجات الثقافية، من ذوق وفن وجمال وأشكال التعبير.
المعيش كوني ومحلي، دائم ولحظي، ويتأثر بالزمن والمكان والسياق، كما يتلون بالتنشئة وأشكال الاعتقاد والقناعات. وقد يتخذ شكل صورة شمولية تحل محل الواقع كلية، تغلفه وتحفظه في تعيينات وأساطير مؤسسة ومعتقدات وايديولوجيات تسوغ وتبرر، وتساعد على الانتماءات الكبرى والصغرى، صورة قد يخضع لها كل الناس، خاصة من أجل تلبية الحاجات الأولى ولا يستثنى أحد في ذلك، صاحب المعرفة العملية والعالم، إلا الأفذاذ من الثوار والمبدعين والأنبياء، أفذاذ لا يفعلون سوى استبدال معيش بأخر.
إن العلماء وهم يشتغلون في المختبر ضمن مجموعات علمية لا يتخلصون من المقارنات والمنافسات والحقد والخوف والنزوع إلى القوة، ومن هنا أهمية فحص معيش العلماء لمعرفة درجة استجابتهم للنزوعات، وكذلك معرفة توجهاتهم ومعتقداتهم وما يؤثر في اختياراتهم الابستمولوجية، سواء عندما تقطع مع الأشكال ما قبعلمية أو عندما تتأثر بها، أو تستلهمها على الأقل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار سياقات ممارسة المعارف العلمية الذهنية والثقافية والاجتماعية، هل تمت مثلا في البدايات أم أثناء النضج؟ هل هي كاملة الشرعية أم تعاني من نقص الاعتراف؟ إلى غير ذلك من المؤثرات التي قد تدفع العالم ليتخذ أحيانا مواقف قبعلمية، وأحيانا أخرى علموية، وثالثة بالمعنى الذي ينتبه إلى المعيش كفاعل ضروري للفهم، ويتضح الأمر أكثر في العلوم الاجتماعية التي تعاني من عقدة تجاوز المعارف قبل العلم ولو بعلموية تضع الفواصل التامة مع السحر والأسطورة ولا وعي الثقافات الذي بدونه يصعب فهم الفعل الاجتماعي وبنائه.
إن المقاربة المعيشية في كثير من تجلياتها الإثنولوجية هي التي دفعت بنا نحو كون اعتبار التقابل التام بين العلم وغير العلم لا يفيد كثيرًا في فهم الظواهر المعقدة والحرجة، مثل المرض والنزوع نحو القوة في السياسة والدين، حيث تتداخل عوامل وتتعقد لتترك للاحتمال والامكان إمكانية التدخل من أجل فهم لجوء الطبيب مثلا لساحر، أو ببحث رجل أعمال أو تاجر إلى من يقرأ له أثر النجوم، إلى غير ذلك من السلوك والمعرفة التي لا يفهم فيها العالم العلموي شيئا، والتي استوقفت الأنثربولوجيين بالملاحظة لتتبع كيفية حدوث الأشياء في سيرورات اختيار موقف دون أخرى في سلسلة قد تتعب العقل.
المعيش أيضا هو تفاعل الفرد والجماعة كوجهين لعملة واحدة، لا يمكن تصور فرد إلا باستحضار أنه في جماعة، إلا في الحالات الافتراضية والأدبية الخيالية مثل حي بن يقظان أو روبنسون كروزوي، وحتى في هذه الحالات لا يتخذ البطل دلالة إلا في حالة اتصاله بالآخر، الآخر هو من يجعلنا نرى أنفسنا، هو المرآة المتفاعلة، هو من يقبل تصرفا ويرفض آخر، يشجع التواصل أو يقفل نوافذ إدراكه، وأبواب التفاعل معه، ثم إن الذات آخر أيضا بالنسبة للآخر، تحبذ تصرفا وترفض آخر، وبذلك يبدأ التآلف المشترك أو النبذ والخصام. المجتمع ليس مجموع أفراد، بل هو حياة ومعيش ولقاء وتواصل، هو الإخوة والأب والأم، هو الشارع والمؤسسة والسوق، هو المعايير التي تبنى عليها تصرفاتنا حتى تكون مقبولة أو مستهجنة، ثم إنه هو الذي نمارس عليه انتماءنا واستساغة قيمه أو الذي نرفضه ونشجبه كلية أو جزئيا.
مسألة الفرد والجماعة غير مطروحة في الحياة اليومية، هو معيش يمارس، وأحيانا كثيرة بنسيان كيف وصلنا إلى ما وصلنا إليه، كيف يكفي للتاجر أن يلقي نظرة على السوق حتى يتخذ موقف البائع أو المشتري، كيف نتصرف في الشارع والمؤسسات، في اختيار محامي في قضية، أو أفضل مدرسة للأبناء.
إن التفاعل هو الكيمياء النظرية والعملية للفعل الاجتماعي سواء كفعل بنيوي أو كأفكار وقيم. إن تتبع هذا اللقاء في تفاصيله، والذي لا يمكن استبعاد الحدس فيه، هو الذي يمكن الباحث الاجتماعي في أن يذهب إلى الأهم وفرزه عن الأقل أهمية، دون إغفال الأدوات المنهجية التي تساعد على ذلك.
أنواع المعيش
يجب التفكير في المعيش بصيغة الجمع، وليس بصيغة المفرد، كما يجب التفكير فيه أيضا بكون أشكاله تتداخل أحيانا ويؤثر بعضها في البعض، كما يتخذ التداخل أشكال عدة منها التعايش والتناضد والهيمنة، ومن أجل التقريب التصنيفي البيداغوجي لتشكلات المعيش يمكن الحديث عن نماذج منها:
- المعيش العملي: وهو المرتبط مباشرة بتحويل الطبيعة إلى خيرات، هو معيش البدائيين والمزارعين، والكادحين، ثم سكان القرى حيث الأشكال الأولية للتبادل والتجارة البسيطة. في هذا المستوى من المعيش تكون الدلالات التي تعطى للأفعال الاجتماعية موحدة وتواصلية وسهلة الانتشار والتفاهم وفق قيم ومعايير وسرديات مؤطرة وفق عوائد وأعراف ملزمة.
- المعيش المحول: هو أيضا عملي لكن بتغليف أكبر للنوايا والغايات والأفعال، ليبدأ يتخذ صيغا مصطنعة ومدبرة قابلة للنقل والتعلم، هو معيش السحرة والكهنة ورجال الدين في الكنائس والزوايا، وغالبا ما يرتبط بالكتابة والتدوين، وبذلك يبدو معيشا فوق المعيش. في هذا المستوى تبدأ العملية ملتوية ومقنعة وتشتغل بأدوات معقدة تخاطب الحاجات الأولية والثانوية، مثل الخوف والرجاء، تتعزز بالطقوس وتجتهد في التشريعات نحو إرساء أعراف وقوانين تبدو تعبيرا عن الحقائق الأزلية، كما أنها قد تتلمس سلطا زجرية كبرى مثل الدولة وحتى التحالفات فوقها.
هذا التشكل غالبا يخترق كل شيء من المعتقد حتى الحياة اليومية الفجة عبر احتكار العنف المشروع، والذي يتصرف بمؤسسات مباشرة مثل العدالة والسجن والأمن والدرك والجيش، أو عبر مؤسسات غير مباشرة مثل المدرسة والاعلام، والتنظيمات الموازية مثل الحزب والمجتمع المدني.
-المعيش التزيفي: يحتاج المعيش للوهم والزيف وكل أنواع الحيل والكذب، ليس على الآخر فحسب، بل وعلى الذات، ويبدأ التزييف بسرديات أحيانا مشروعة، وحتى محببة ترتبط بالوجدان والمعتقد، وتنمية إحساس الهوية، وكل ما يرتبط بها من حماس ومغريات، وقد تصنع من أجل ذلك إيديولوجيات تبرر وتسوغ وتجيش، وغالبا لمصلحة جهة تخفي المصلحة بإبراز اللامصلحة الدينية والدنيوية أو هما معا.
- معيش القوة: أحيانا يحتاج المعيش إلى القوة، والتي تتخذ صيغا قد تكون شرعية كما في القوانين والتشريعات والعادات، كما يمكن أن تتخذ شكل العنف السافر من أجل التحجيم والتخويف وفرض واقع الحال، وهذا المعيش يستعين أحيانا بمعيش التوسط:
- معيش التوسط: ارتبطت الوساطة الاجتماعية بتحديث الدولة والمجتمع، ومحاولة إشراك أكبر عدد من الناس في إعطاء المشروعية التمثيلية، ولما كان التمثيل يرتبط بأقلية، فهو يحتاج إلى وسائط مباشرة مثل الأحزاب والنقابات، وأخرى غير مباشرة مثل المثقفين والمجتمع المدني. غير أن الوساطة يمكن أن تتخذ صيغا شتى في تصريف التفاعل ولو بين فرد وفرد.
في الأخير وجب التنبيه إلى أن جل هذه التشكلات غالبا ما تكون متضافرة يصعب فرزها من أجل الفهم والتحليل. ومن أجل ذلك اكتسبت العلوم الاجتماعية مراسا في خلق أدوات بها تفكك الآليات التي يستعملها المعيش لبناء واقع فوق أخر.
6. الدرجة الثالثة من المعرفة مطبقة على المعرفة العالمة
العالم ذات كأي ذات أخرى مهما حاول أن يبدو غير ذلك، ذات تشعر، ولها حاجات ورغبات وتسطر أهداف وغايات وتبحث عن وسائل لبلوغها، ذات تقارن وتنافس وتحاكي وتعبر، كما أنها ذات تملك لا شعورا واسعا يمكن البحث فيه عبر الأدوات التي يستعمله والتي تستعمله.
اللغة: كما في اللغة اليومية، لا تعدّ اللغة العالمة محايدة، رغم التكلف الذي يحاول به الباحث أن يبدو فوق الذات واليومي. اللغة كائن ينتج المعنى وليس وسيلة فحسب، غير أن الأمر لا يعني أنها هي المعنى والفكر، هي وسيلة أحيانا قاصرة وأخرى بليغة، لكنها تملك القدرة على الخيانة وحتى الرشد إلى الخفي. هي المتاح المعجمي والاشتقاقي والتركيبي الذي يختلف من لغة إلى أخرى؛ لأنها كأي إنتاج اجتماعي تصطبغ بشكل أو بأخر بالمجتمع الذي تعيش وتشتغل فيه، بذلك يعدّ فحص لغة المعرفة العالمة في العلوم الاجتماعية مفتاح كثير من الأمور التي قد تساعدنا في فهم الموضوع الذي يبحث فيه الباحث، اللغة يمكن أيضا أن تؤثر في الدلالات التي يقصدها حتى تتخذ صبغة ما لم يقصده. هناك دوما حد أدنى من العفوية التي تتسم بها المعرفة اليومية في لغة المعرفة العالمة، ولا يرتبط الأمر بالانتباه إلى القواعد بقدر الانتباه إلى الاستعمال، هل هو استعمال فوقي وضعاني أم استعمال ينصت للغة اليومية أم استعمال مفاهيمي ينتج المعاني الممهدة للنظريات.
منذ اللغة يمكن أن ندرك نوع العلم الممارس ومستوى جودته.
السياق: كما في المعرفة العادية تعتبر السياقات في العلم حاسمة، وهذا ما جعل توماس كوهن يهتم بالبعدين السوسيولوجي والسيكولوجي للمعرفة العالمة. العالم ذات تملك وعيا ولا وعيا، عقلا وحاجات، بذلك تتعدد سياقات المعاني المنتجة للعلم، هل البحث أساسي؟ إعداد رسالة؟ أم تنموي عملي يحاول تقويم الصيرورة؟ أم تدخلي يرشد الفئات المستهدفة في الفعل الاجتماعي الفردي والجماعي؟ متى حصل البحث؟ وكيف؟ هي كلها أسئلة تنير سيرورات البحث العلمي، والمؤثرات الكمية والكيفية والتي قد تنير زوايا لا ينتبه إليها عندما لا نعتبر العالم ذاتا يصيبها كل ما يصيب أي ذات، عندما لا ننتبه سوى للمنتوج النهائي كنص، وكما أن الحياة ليست نصا، كذلك العلم ليس نصًّا بالمعني البنيوي الوضعاني.
إن البحث في السياق يدخل ضمن البحث نفسه، وانتباه الباحث لذلك يخفف من أوهام العلموية، هي الانعكاسية الحذرة التي تقود الباحث بأقل الأضرار وفق أعلى درجات الانتباه.
وعلى الرغم من ذلك، فللباحث لبوساته التي تخبر عن الذاتية ومدى حجم الانفلات منها، لغة البحث؛ وحجمه؛ والبيبليوعرافيا المعتمدة؛ والهندسة الشكلية؛ والمنهج المعتمد، يمكن أن تخبرنا عن قناعات الباحث الإبستمولوجية، وحتى عن انحرافاته واختلالاته الذاتية من غرور أو احتقار للجماعة العلمية وغير ذلك، ليس في أفق المحاكمات الأخلاقية، رغم أهميتها، ولكن في أفق تقويم العمل على أساس أن العلم هو القابلية للتفنيد والتجاوز.
خاتمة
قدر العلوم الاجتماعية أن يكون موضوعها لا يشبه موضوعات العلوم الأخرى الأكثر صلابة، سواء الصورية أو الطبيعية، غير أن الاختلاف هذا في طبيعة الموضوع لا يجب أن يؤدي إلى العدمية المعرفية واللاأدرية، العلوم الاجتماعية محاولة بناء نظريات على أخرى سبق وأن صاغها الفاعل نفسه، دون نسيان أن انتاج العلم نفسه فعل اجتماعي يعتريه ما يعتري أي فعل إنساني اجتماعي من الانطلاق من التمثلات المعيشية، غير أن الأمر لا ينقص من العلمية التي تتخذ النسبية معيارا لها في أي شيء، بل تعلمنا الدرجة الثالثة من أن العلم غير المكترث بإدراكات وأفكار الناس ليس غير صائب فحسب، بل يمكن أن يكون خطيرا، حيث يمكن أن يسهم في التعتيم وإضفاء الإطلاق سلبا أو إيجابا على مالا يمكن أن يكون إلا نسبيا، والحسم في ما لا يمكن أن يكون سوى رجحانا.
المراجع:
1 Berger,P. et Luckman. La construction sociale de la réalité, Armand Colin, Paris, 1986
2 Bernard Lahire. Monde pluriel, Seuil, 2012
3 Francis Farruga et Antigone Moutchouris. La pensée des sociologues, 2018
4 Francis Farruga et Antigone Moutchouris. Les outils des sociologues, L’Harmattan, Paris, 2020
5 François Dubet. Sociologie de l’expérience. Seuil, 1994
6 Kuhen,T. la structure des révolutions scientifiques, Flammarion, Paris, 2008
7 Patrick watier. Le savoir social, Desclee Debrouwer,Paris, 2000
8 Pierre Bourdieu, Misère du monde, Seuil, 1993
9 Pierre Bourdieu. Questions de sociologie, Minuit, 1984
10 Simmel, Georg. Sociologie, études sur les formes de la socialisation, PUF, Paris, 2eme 2dition, 2013
[1] Francis Farruga et Antigone Moutchouris._ Les outils des sociologues
Une sociologie de la connaissance sociologique, L’Harmattan, logiques sociales, Paris, 2020, p, 78