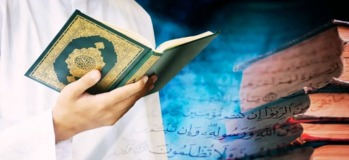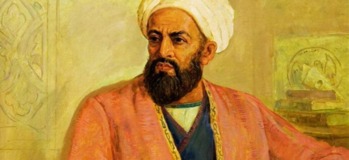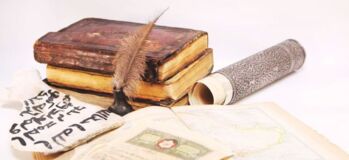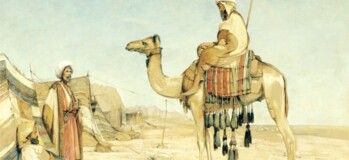عن البداوة والتراث... مدخل تفسيري وملاحظات أوّليّة
فئة : أبحاث محكمة
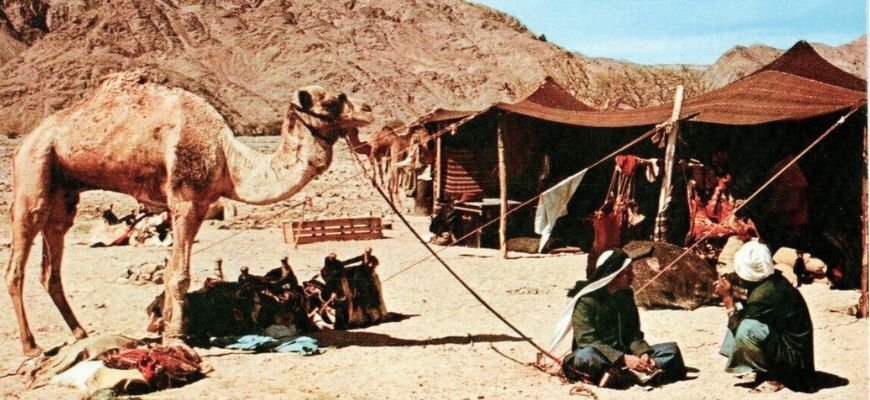
عن البداوة والتراث... مدخل تفسيري وملاحظات أوّليّة[1]
يكاد المنشغلون بالشأن العربيّ العامّ يجمعون على أن المجتمعات العربية -وربما الكثير من المجتمعات الإسلامية على العموم- تعيش حالة من الركود والعطالة التاريخية التي لم تفلح زخارف التحديث وألوانها الفاقعة، على مدى القرنين الفائتين، في التغطية عليها أو إخفائها أبداً، بل إنه يبدو -وللمفارقة- أن هذه الزخارف والألوان قد عملت على تعظيم تلك الحالة من العطالة والركود؛ لأنها خايلت بحدوث نوعٍ من «التغيير والحراك» الذي اتضح أنه لم يكن إلا محض أوهام أو أمنيات كاذبة[2]، لم يجاوز تأثيرها حدود سطح الواقع، واستفاق الوعي أخيراً على حقيقة الدور الذي لعبته تلك الزخارف كأقنعة يتحصَّن النظام القائم وراء سواترها البرَّاقة المبهرة. فبالرغم من أن النظام القديم قد ظل قائماً هو ذاته على مدى الأحقاب والعقود، فإن حداثة الشكل الذي راح يتبدَّل، ببراقعه الملوّنة الزاهية، فوق سطح هذا النظام العابر للقرون والحقب، كانت لابد أن تخايل بأن تغييراً ما قد طال هذا النظام الراكد. إنها (أعني حداثة الشكل تلك) لم تفعل، عبر هذه المخايلة، إلا أن أطالت أمد بقاء ذلك النظام القديم؛ وأعني من حيث ما بدا وكأنه الكشف عن قدرته على قبول ما هو حديث والتوافق معه، أو التبرقع به بالأحرى. وبالطبع، فإنها تؤول -إذ تطيل أمد بقاء ذلك القديم- إلى تكريس حالة العطالة والركود التي كان لابد أن يكتسب حضورها المزيد من الديمومة والرسوخ بفضل تخفّيها تحت زخارف الشكل «الحديث» بكل ما تزدهي به تلك الزخارف من ألوان فاقعة ومبهرة.
ولعله يُشار، هنا، إلى أن التحدّي الذي يجابه إشكالية التغيير المعرفي والسوسيوسياسي في العالم العربي، إنما يتأتى من ذلك الاختزال الفقير للواقع في مجرد مُكوِّنه «البراني» السطحي (وهو المكوِّن الذي كان -ولا يزال- يمثل الساحة الرئيسة، بل الوحيدة، لاشتغال فعل التغيير العربي على مدى القرنين الفائتين)، ومن دون الانتباه إلى ما يرقد كامناً تحت هذا السطح (البراني) من نظامٍ للمعنى هو بمثابة المكوِّن الجواني الذي يستحيل من دون السيطرة عليه إحداث أيّ تغيير حقيقي في الواقع؛ وذلك من حيث إن هذا المكوِّن بالذات هو القابض على جملة الشروط (المعرفية/العقلية والنفسية/الاجتماعية) التي يؤول كشفها والوعي بها إلى جعل مثل هذا التغيير ممكناً حقاً. وإذ تقوم تلك الشروط -والحال كذلك- في تجاويف وشقوق نظام الثقافة الذي يحتفظ، لم يزل، بمركز السيادة العليا في إطار الواقع العربي القائم الذي يتجه القصد إلى تغييره، فإن ذلك يعني أن التحدي الذي يجابه معضلة التغيير الحضاري في العالم العربي يقوم في قلب ذلك النظام الثقافي المهيمن (وذلك بما هو ساحة انبناء نظام المعنى الكامن تحت سطح الواقع)؛ وعلى نحو يلزم معه أن يمارس فعل النقد والمساءلة (التغيير) اشتغاله على ساحة هذا النظام بالذات؛ وذلك بالتوازي مع اشتغاله الضروري الحاصل الآن على سطح الواقع بالطبع[3].
إن هذا المكوِّن الثقافي الجواني لا يمكن اختزاله أبداً في بعض الرقائق الثقافية حديثة التكوين وإهمال ما يسبقها، بل إنه يشتمل على كافة الرقائق والطبقات المعرفية والثقافية التي يضرب بعضها بجذوره الغائرة فيما قبل التاريخ المكتوب، وبما يعنيه ذلك من أن هذا المكوِّن يتسع، من جهة، للثقافة بمعناها الأنثروبولوجي الواسع (أي بما هي تراث سابق غير مكتوب)، وللتراث (بما هو ثقافة مكتوبة) من جهة أخرى. وإذا جاز أن الثقافة بمعناها الأنثروبولوجي تكاد، هي نفسها، أن تنحلَّ إلى التراث -بل وحتى إلى ما يمكن اعتباره «ما قبل التراث»- وعلى النحو الذي تكون معه، والحال كذلك، أكثر تراثية من التراث نفسه[4]، فإن ذلك يعني أنه ليس ثمة إلا التقابل -في الواقع العربي والإسلامي الراهن- بين «التراث» (سواء كان مكتوباً أو غير مكتوب) من جهة، وبين إشكالية «التغيير الحضاري» -في صورتيه المعرفية والسوسيوسياسية- من جهة أخرى، وبما يحيل إليه ذلك من أن سؤال «التغيير» يستلزم -وبالضرورة- وجوب إثارة «سؤال التراث» الذي يكاد أن يكون السؤال الأكثر مركزية في هذا السياق.
وضمن سياق هذا التلازم بين التغيير وضرورة إثارة سؤال التراث، فإنه يلزم التنويه بأن هذا الضرب من التلازم يختص بالمجتمعات التي لم تقدر -حتى الآن- على صوغ تجربة حداثة تخصها؛ وذلك بسبب وقوعها في قبضة النموذج المُعَمّم للتحديث الذي راح يجرى فرضه عليها قسراً -أثناء الحقبة الإمبريالية، وحتى فيما بعدها- مع صرف النظر عن عدم مناسبته لمجمل الشروط التي تعيشها تلك المجتمعات، وعلى النحو الذي أدخلها فيما بات يُعرف بتجارب التحديث المُشَوَّه أو الكاذب التي تعاني من نتائجها الكارثية معظم مجتمعات العالم الثالث (ومع وجوب الإقرار بالوضع بالغ السوء للمجتمعات العربية، بالذات، بينها).
وهكذا، فإنه إذا كان الدرس الاجتماعي الحديث قد انتهى، أو كاد، إلى إقصاء التراث بالكلية من مجال الفاعلية والتأثير في عملية «التغيير» التي شهدتها -ولا تزال- مجتمعات الحداثة[5]، والتي يبدو وكأن التغيير فيها يرتبط، في الأغلب، بما يتحقق من تطور في أنماط العلاقات الإنتاجية التي تسود في تلك المجتمعات، وبما يترتب على ذلك من تغيير في بنية الوعي؛ وعلى النحو الذي يؤول، في النهاية، إلى جعل التغيير في العالم ممكناً حقّاً، فإن الأمر في مجتمعات «ما قبل الحداثة» -أو التي لم تزل تقف مرتبكة على أبوابها الموصدة- يمضي في مسارٍ معاكسٍ تماماً؛ وذلك من حيث يظل التراث فاعلاً بقوة، لا على صعيد مجرد «الفعل المعرفي» فقط، بل وعلى صعيد «الفعل الاجتماعي» أيضاً، وإلى حدٍّ يصبح معه التراث هو المحدد، ليس لوعي الناس فقط، بل ولأشكال وجودهم وإنتاجهم أيضاً[6]. ومن هنا، لا سبيل لإحداث أي نوع من التغيير في تلك الأبنية المجتمعية (التي يجوز اعتبارها -في العمق- أبنية محض «تراثية»)، ما لم يكن مسبوقاً بتغييرٍ يطال وعي الفاعلين فيها بالتراث أولاً، وحيث يتحول هذا الوعي من كونه موضوعاً للتراث (كالحال في وضعه الراهن) إلى أن يكون (أي هذا الوعي) هو القابض على هذا التراث كموضوعٍ لاشتغاله، توطئةً للسيطرة عليه؛ وأعني -بعبارة أخرى- ما لم يتحول من وعي يهيمن عليه التراث (ويحتويه ويُخضعه لتوجيهه) إلى وعي يكون هو المهيمن على التراث، والمُحدد -بالتالي- لشكل حضوره في العالم.
وإذا كان يبدو، هكذا، أن تفعيل «التغيير الحضاري» -بمضمونه المعرفي والسوسيوسياسي- مشروطٌ بالسيطرة على التراث والهيمنة الكاملة عليه؛ وأعني عبر استيعابه واستدماجه معرفياً في بنية «ذات» تقوم بتوظيفه في صيرورة تحقيق وجودها الخاص، بدل أن تكون هي الموجودة من أجله (وأعني كمجرد ساحة يستعرض عليها هذا التراث حضوره الخالد، ولكن الخامل)، فإن ذلك يقتضي إدراكاً أولياً للكيفية التي يمارس بها التراث حضوره في الوعي العربي الإسلامي؛ وعلى النحو الذي أصبح فيه هذا الوعي واقعاً في قبضة هذا التراث بالكلية، وأعني غير قادر على تجاوزه أو الانفلات أبداً من سطوته.
متى يصبح الماضي تراثاً؟
يُشار هنا -على العموم- إلى حقيقة أنه لا يتسنّى للذات -أي ذات- أن تتعاطى مع ماضيها كتراث إلا حين تحقق -كخطوة أولى وضرورية- انفصالها وتميُّزها عن هذا الماضي. ومن هنا ما يبدو من عدم إمكان الحديث عن «تراثٍ» لذاتٍ تتخذ من ماضيها قوقعة تقبر وجودها الخاص داخلها (حتى ولو كانت تغطي جدران هذه القوقعة/ القبر ببراقع وإكسسوارات الحداثة الزاهية)؛ وبمعنى أن ذاتاً تتطابق مع ماضيها كلّياً، هي -من دون شك- ذاتٌ ليس لها، بعد أي تراث، وهي -وللمفارقة- بلا ماضٍ أيضاً، لأن تحوّل ما كانت تعيشه الذات في لحظة ما إلى ماض مشروط بانفصالها عنه أيضاً؛ إذ التراث ينبثق، بما هو كذلك، حين تجد الذات نفسها في قلب صيرورة سوف تؤول بها حتماً إلى الانفصال عن ماضيها بالصورة التي كان -وظل- عليها لأحقاب مديدة، وأنها -وابتداءً من أن فعل الانفصال هو فعل «تملُّك» في جوهره- سوف تكون على أبواب علاقة جديدة مع هذا الماضي؛ وأعني على نحو يصبح فيه ماضيها «شيئاً» مملوكاً لها بعد أن كانت مملوكة له كمحض «شيء» يقع في قبضته ويتحدد به على نحو كامل. وبالطبع، فإن هذا التحوّل في وضع «الذات» من «المملوك» إلى «المالك»، إنما يحيل إلى موقف «تحرُّر»، حيث لا يعني فعل امتلاك الذات لماضيها كتراث إلا أن تتحرر منه كقيدٍ يحدد جوهر وجودها، على أن يكون التحرر هنا مفهوماً لا كرفض للماضي -على فرض إمكانه- بل بما هو مجرد سيطرة الوعي عليه. وبالتالي، تتكامل ثلاثية الانفصال والتملُّك والتحرُّر في تدشين علاقة جديدة للذات بماضيها، وبما يترتب على ذلك من لزوم التمييز بين «ذات تراثية» لم يزل ماضيها هو المحدد لوجودها؛ وبمعنى امتلاكه لها على نحو تكون فيه هي «التراث يكرر نفسه»[7]، وبين «ذات لها تراث»؛ وأعني بها تلك «الذات» التي تحررت من أعباء ماضيها بعد أن صار (هذا الماضي) تراثاً (مملوكاً لها)[8].
وإذا كان قد بدا أن فعل تحرر الذات وانفصالها عن ماضيها هو، في الآن نفسه، فعل امتلاكها لتراثها، فإنه يلزم التمييز بين ضرب من الانفصال عن الماضي يكون نتاجاً لعملية تطور تحققه الذات، عبر التراكم بمعنييه المادي والمعنوي، داخل تاريخها الخاص (وهو ما يؤول إلى امتلاك تلك الذات لتراثها حقاً)، وبين ما يبدو فعل انفصال عن الماضي يفرضه الضغط الصادم والمفاجئ من الخارج على الذات، والذي تكاد التجربة العربية أن تكون المثال النموذجي على تهافته وبؤسه.
وإذا كان ما يتم فرضه من الخارج، لا يمكن أن يتجاوز تأثيره حدود القشرة الخارجية للذات، فإن ذلك يعنى أن فعل الانفصال يظل -ضمن هذا السياق- فعلاً خارجياً بدوره؛ وبمعنى أنه لا يطال علاقة الذات بماضيها في العمق، بقدر ما يحيل إلى بعض التبدلات الحاصلة على سطح هذه العلاقة فحسب، وعلى النحو الذي تظل معه تلك الذات ممسوكة في القبضة القوية لماضيها، رغم محاولتها إخفاء تلك القبضة وراء زخارف وزركشات الأقنعة المتبدِّلة للحداثة الزاهية على السطح الظاهر. وإذن، فإن فعل الانفصال عن الماضي لا يقترن، حال كونه فعلاً خارجياً ومفروضاً على الذات، بفعل امتلاك التراث، بل يظلّ الماضي موجّهاً لحركة الذات ومتحكماً في مصائرها ومُحدداً لوجودها كله. وبالرغم من أن هذا التحديد يسعى إلى إخفاء نفسه وراء ما تدَّعيه الذات من الانتماء إلى اللحظة «الحديثة»، فإنه يبقى أن هذا الانتماء إلى الحداثة يتماثل مع فعل انفصالها عن ماضيها، في كونه محض فعل خارجي فقير؛ وذلك - على أي حال- ما تؤكده التجربة العربية الراهنة التي تتجاوب «خارجية» الانتماء إلى الحداثة فيها، مع ما عرفته من «خارجية» الانفصال عن ماضيها.
ولعل الجدير بالملاحظة هنا هو أن الذات حين تنفصل عن الماضي، فإنها تمتلكه كتراث. وأما حين تعجز عن إنجاز هذا الانفصال، فإنها تظل تتحدد به أبداً. وإذ يبدو، هكذا، أن الانفصال عن الماضي، إنما يكون بقصد امتلاكه كتراث (تحدده الذات بدل أن تتحدد به)، فإن ذلك يعني أن هذا النوع من الانفصال لا يتعلق -والحال كذلك- بالقصد إلى نفي هذا الماضي وإلغائه[9] (والذي هو موقف مستحيل على أي حال)، بقدر ما يتعلق بجعله عنصراً فاعلاً في عملية معرفية وتاريخية خلاقة تسعى فيها الذات إلى تحديد وجودها بنفسها وامتلاك مصائرها في العالم. وإذا كان عجز الذات عن إنجاز هذا الامتلاك للتراث، لا يعنى إلا أن تصبح هذه الذات محض ساحة خاوية يستعرض عليها ذلك التراث حضوره الخالد، ولكن الجامد والرتيب، فإنه يلزم التنويه بأن الأمر -والحال كذلك- لا يتعلق بالكشف عن مجرد خواء تلك الذات، بقدر ما يكشف عن خواء التراث كذلك. وإذا كانت الذات تعجز عن إنجاز الانفصال عن التراث وامتلاكه على نحو يسمح لها بتحويله إلى موضوعٍ لفعلها المعرفي الخلَّاق، فإنها لا تعرف إلا محض اجتراره وتكراره، وبما يترتب على ذلك من الدخول به إلى دائرة الجمود والموات؛ وأعني من حيث لا يقدر -مع هذا التكرار- على أن يكون موضوعاً للفهم والقراءة المعرفية التي تتيح له التفتُّح عن الممكنات الكامنة التي يطويها في جوفه، والتي تجعله جزءاً من صيرورة حيَّة يُضحي فيها بوجوده الخاص، ليصبح جزءاً من كينونة أرقى يكتسب فيها حياة فاعلة حقة. وإذن، فإنها مفارقة الانفصال عن التراث التي تتيح للذات أن تحقق «فاعليتها» من خلال تواصلها المبدع معه من جهة؛ وذلك بمثل ما تتيح للتراث، من جهة أخرى، أن يكون موضوعاً لنوعٍ من الحضور الحي المنفتح والمُنتج في العالم.
ووفق ما تقدم، تتبلور مفارقة التراث الذي لا يوجد بما هو محض «الماضي» المُتحدِّر عن السلف، بل يوجد كأحد تداعيات الانفصال عن ذلك الماضي بالأحرى[10]، وهو الانفصال ذاته الذي سرعان ما يعود، فيحدد نوعية حضور هذا التراث بالنسبة إلى الذات. ففي حال كون هذا الانفصال نتاج تطور تحققه الذات داخل تاريخها الخاص؛ وبما يعنيه ذلك من أنه يكون واقعة حقة تتحرر فيها الذات من الماضي، فإن ذلك يعنى أن التراث يصبح موضوعاً لفعل معرفي تتملكه به الذات من خلال آليات الاستيعاب والتجاوز. وأما حين يكون هذا الانفصال نتاج تطور مفروض على الذات من الخارج، فإنه يكون محض واقعة خارجية يظل معها الماضي (الذي لم يصبح تراثاً للذات بعد، والذي لا يمكن لذلك إلا أن يكون موضوعاً لفعل التكرار والاجترار)[11] يمارس هيمنته الباطنية العميقة على هذه الذات التي يصبح توحُّدها (الأنطولوجي) مع ماضيها (واستلابها الكامل فيما ينبغي أن يكون تراثها المملوك «معرفياً» لها) آليتها الدفاعية في مواجهة ما يجري فرضه عليها بضغوط الخارج وإكراهاته؛ وبما يعنيه ذلك من أن التراث لا يحضر -ضمن هذا السياق- كموضوع معرفي، بل بما هو أحد آليات الاحتماء النفسي-التاريخي؛ وكآلية احتماء، فإنه لا يمكن أن يحضر إلا كموضوع لمحض التأسي و«التقديس».
ولسوء الحظ، فإن الانفصال عن الماضي، بما هو محض واقعة خارجية، كان هو الذي حدد كيفية حضور التراث بالنسبة إلى الذات العربية الإسلامية. فإن ما خضعت له هذه الذات من الفرض الإكراهي للحداثة (كنموذج جاهز) يُراد من خلاله القطع مع حاضرها الراكد الذي لم يكن إلا محض «ماضٍ» يُعاد إنتاجه عبر الترجيع والتكرار، لم يسمح لها إلا بأن يكون انفصالها عن ماضيها محض انفصال خارجي متعسف؛ وبما يرتبط بذلك من أنها لم تقدر على أن تحيل هذا الماضي إلى تراث تمتلكه وتسيطر عليه، بل إنها ظلت مملوكة له وممسوكة في قبضته الخفيّة الباطشة؛ وذلك على النحو الذي ظل معه يوجهها ويحدد مصائرها من وراء الأستار الشفافة للحداثة التي تتبرقع بها. وهكذا، فإنها ظلت -ولم تزل للآن- تعاني من وطأة الضغط المزدوج عليها، في آن معاً، من الخارج (بما يفرضه عليها مما لا يمكنها أن تغض النظر عنه أو تتجاهله مما تنتجه الحداثة من منتوجات صلبة وناعمة)، ومن الماضي (الذي لا يكف بدوره عن الضغط عليها بأنظمته وآلياته ورؤاه التي لم تقدر على أن تتحرر منها أو تنفلت من سطوتها).
وبالطبع، فإن ذلك كان لابد أن يحدد آلية مقاربة هذه الذات للتراث وتعاطيها معه، حيث بدا وكأنها قد راحت تستدعيه ليؤدي أدوار «التعويض والتبرير» التي لا تجاوز دلالتها حدود «النفسي» إلى «المعرفي». ولأن فاعلية «التعويض» تنصرف -على المستوى النفسي- إلى التخفيف من حدة شعور الذات بدونيتها وتخلفها الراهن من خلال استدعاء التراث ليقوم، بما هو ماضيها الزاهر الذي كانت لها فيه الهيمنة والغلبة، بدور القطب المعادل لما يجرى فرضه عليها من نتاجات الحداثة الليّنة والصلبة التي تبرهن بمجرد حضورها على ما تعيشه تلك الذات من نقصٍ ودونية[12]؛ وإلى حد ما تعانيه من جرح لا يقبل الالتئام والتضميد[13]، فإن «التبرير» يرتبط بسعي ذات، لم تقدر على الانفصال عن ماضيها، إلى البحث في ذلك الماضي عما يمكنها أن تسوِّغ به ما تضطر للانصياع له مما تفرضه ضغوط الخارج وإكراهاته. وإذن، فإنه السعي -في الحالين- لا إلى إنتاج معرفة بالتراث، وبما يعنيه ذلك من ضرورة إنجاز الانفصال عنه الذي هو شرط لكل معرفة، بل إلى التطابق -أو حتى التماهي- معه التماساً لنوع من الأمان الداخلي الهش[14]. وإذ «المعرفة الحقة» لا يمكن أن تكون نتاج ذات أو وعي لا يعرف إلا السعي إلى التطابق مع ما ينبغي أن يكون موضوعاً له؛ وذلك من حيث تقتضي طبيعة أي معرفة حقة نوعاً من انفصال الذات عن موضوعها توطئة لتحديده وتعيينه والإمساك به كشيء مغاير (لها)، ليتسنّى لها استيعابه وابتلاعه في جوفها، وتحويله إلى جزء من وجودها، ولكن لا لتتطابق معه، بل لتمتلكه كتوطئة لتجاوزه، فإن ذلك يعني أن سياق «المطابقة والتماهي» الذي راح يحضر من خلاله التراث وغيره في وعي الذات، لم يكن ليسمح لها أبداً بإنتاج أي معرفة حقة بالتراث[15]، بقدر ما كان يرسِّخ نوعاً من الحضور الإيديولوجي له فقط. وفي كلمة واحدة، فإن سياق «المطابقة» -الذي لم يكن ممكناً للتراث إلا أن يحضر ضمنه فقط- لم يسمح له أن يكون موضوعاً لمعرفة منتجة، بل أتاح له أن يكون مجرد قناعٍ لمحض الإيديولوجيا.
إن الوعي في سعيه إلى التطابق والتماهي (سواء مع «تراث» الذات، أو -من خلال هذا التراث- مع «حداثة» الآخر) لا يعرف أبداً، إلا أن يقع في قبضة ضربٍ من المعرفة الامتثالية التي يخضع فيها الوعي لهيمنة هذا التراث الذي كان ينبغي أن يصبح موضوعاً لفاعليته. وبالطبع، فإنه لا يعرف، مع عجزه عن جعل (هذا التراث الذي يهيمن عليه) موضوعاً له، إلا السعي إلى مجرد التطابق معه، كنموذج جاهز. إن هذا النوع من «التطابق»[16] هو فعل انصياع وخضوع في جوهره[17]؛ وأعني من حيث يستحيل، ضمنه، ما يُفتَرَضُ أن يكون «موضوعاً» للمعرفة من محض عنصر تسعى «الذات» إلى امتلاكه في «فعل معرفي» من صنعها، إلى «نموذج» نهائي ومكتمل تسعى، عوضاً عن ذلك، إلى تكراره، وبما ينطوي عليه التكرار من وجوب الخضوع لهذا النموذج وتقليده. وإذ يغيب، هكذا، شرط المعرفة الحقة التي يسعى فيها الوعي، لا إلى التماهي مع موضوعه، بل إلى الانفصال عنه توطئة للإمساك به وتحديده، ثم تحويله إلى جزءٍ من بنائه وتركيبه، ولا يحضر إلا هذا النوع من المعرفة التي يخضع فيها الوعي لموضوعه على نحو امتثالي خالص، فإن ذلك يجعل من هذه الممارسة (التي لا يعرف الوعي فيها إلا مجرد السعي إلى التطابق مع ما ينبغي أن يكون موضوعاً له) مجرد نوعٍ من الفاعلية الإيديولوجية، وليست المعرفية. ويرتبط ذلك بحقيقة أن الإيديولوجيا هي ذات حضور امتثالي في الجوهر؛ وأعني من حيث تمثل إطاراً ضيقاً يحدد -بل يقيد- أفعال الإدراك التي يقوم بها الوعي. وإذ يحيل ذلك إلى أن كافة الممارسات ذات الطابع الامتثالي هي، في العمق، ممارسات «إيديولوجية»، حتى ولو اتخذت شكلاً معرفيّاً زائفاً، فإنه يبقى أن كلّ مقاربة للتراث، تتحقق ضمن سياق السعي إلى التماهي معه، سوف تكون مقاربة إيديولوجية، لا معرفية[18].
وبالطبع، فإن التراث كان لابد أن يستحيل من خلال تلك المقاربة (الإيديولوجية) إلى أن يكون مجرد حامل لأقنعة إيديولوجية حداثوية شتى (ليبرالية وقومية ويسارية)[19]، بل وأن يستحيل، هو نفسه -حين يجري استدعاؤه كنموذج جاهز ومكتمل- إلى مجرد إيديولوجيا (إسلاموية) لا تختلف عمّا عداها إلا في كونها مستعارة من صانعي (الماضي) التراثي، وليس من صانعي (الحاضر) الحداثي. ولعله كان لزاماً أن يتبدى التراث -ضمن هذا السياق- كساحة للصراع يتجاور عليها الشيء ونقيضه، على أن يكون مفهوماً أنها لم تكن من قبيل النقائض الذاتية التي تكشف عن ثراء التراث وغناه، بقدر ما كانت نقائض صورية زائفة تفرض نفسها عليه من خارجه[20]. ولذلك، فإنها قد انتهت، فعلياً، إلى إفقاره وتبديد ما ينطوي عليه من طاقة وحياة. وبما أن قانون ظهور تلك النقائض واختفائها يقوم، لا في التراث ذاته، بل في عملية تزاحم وتناحر الإيديولوجيات التي راح يجري استعارتها جاهزة ليتم فرضها على الواقع العربي بوصفها السبيل الأوحد لتغييره، فإن السعي -وبسبب افتقار الواقع إلى ما يسند حضور تلك الإيديولوجيات- قد تبلور للبحث عن سندٍ لذلك الحضور في التراث؛ وذلك كبديل عن غياب ذلك السند في الواقع، وهي العملية التي بدا -حسب أحدهم- أنها بمثابة «مذبحة للتراث»[21] الذي راح يتمزق إلى ركامٍ من النتف والشظايا التي تتسلق عليها تلك الإيديولوجيات المستعارة الجاهزة. وإذن، فإنَّ محض تمزيق التراث وتقطيع أوصاله هو ما تؤول إليه هذه المقاربة (الإيديولوجية)، وعلى نحو لا تتبدد فيه وحدته المعرفية فحسب، بل -وللمفارقة- الإيديولوجية أيضاً، بل إنه يتحول -ابتداءً من حضوره كمحض ساحةٍ لتناحر الإيديولوجيات التي تتساقط وتنهمر على سطحه- إلى مجرد تلال من الأنقاض المبعثرة التي لا روح فيها أو حياة[22]. وهكذا، يتبلور «التمزيق وتقطيع الأوصال» الذي يُلاشي التراث ويفنيه، وليس «التناقض» الذي يثريه ويغنيه، بوصفه النهاية المحتومة لآلية مقاربته على نحو إيديولوجي.
وإذا كان قد بدا أن المقاربة الإيديولوجية للتراث، إنما تقترن، على صعيد الوعي، بنوع من المعرفة ذات الطابع الامتثالي، وبنوع من «التفتيت والبعثرة» على صعيد الموضوع الذي هو التراث، فإن التحليل سيكشف عن أن هذا الذي يسم المقاربة الإيديولوجية من الامتثالية (كخصيصة للوعي)، والتفتيت (كخصيصة للموضوع الذي يقاربه هذا الوعي) يعدُّ من تعلُّقات نظام البداوة ولواحقه. وبالطبع، فإن ذلك يعني أن «نظام البداوة» لم ينقطع عن الحضور أبداً، ليس فقط ضمن ثقافة التراث، بل ضمن ثقافة الحداثة، وربما حتى فيما بعدها كذلك، بل إنه يبدو أن تجاوبه مع الشرط ما بعد الحداثي يكاد أن يكون هو الأظهر والأجلى؛ وذلك من حيث جملة المفاهيم التي تنبني عليها ما بعد الحداثة، والتي تكاد تمثل -وللمفارقة- استعادة، شبه كاملة، للمفاهيم التي يقوم عليها نظام البداوة ما قبل الحداثي؛ وأعني من قبيل الانفصال والتنقُّل والتجوال والبعثرة والتفتيت والاستهلاك الناعم وغيرها[23].
ولأن «الامتثالية» تغلب، من جهة، على الفعل المعرفي المهيمن داخل هذه الموجات الكبرى الثلاث (التراث والحداثة العربية وما بعدها)[24]، فإن «الانفصال والتفتيت» يظل، من جهة أخرى، هو الغالب على رؤية العالم السائدة داخلها. فمن جهة يكشف تفكيك الفعل المعرفي المنتج للتراث المهيمن عن حقيقة أن «الامتثالية» هي أحد أهم محدداته على الإطلاق؛ وأعني من حيث تنطوي «آلية التفكير بالأصل» -التي انبنى بحسبها هذا الفعل- على انصياع الوعي لسلطة «أصل» لا سبيل إلى الانفلات من سطوته[25]. وبالطبع من دون أن يؤثر في ذلك تباين وتنوُّع هذا «الأصل» الذي يتم التفكير به، حيث يمكن لهذا «الأصل» أن يكون «نصّاً» (من الوحي أو من النبي أو من الإجماع أو حتى من أرسطو أو غيره)، أو يكون «حدثاً» يقع ضمن حدود الزمان/النموذج عند السلف. وليس من شكٍّ في أن التباين بين اتجاه وآخر داخل التراث، إنما يتأتى من تباين «الأصل» الذي يفكر به الواحد منهما، عن ذلك الذي يفكر به الآخر. ومن جهة أخرى، فإن فعل المعرفة المهيمن في الخطاب العربي الحديث يتعيَّن بوصفه فعل «امتثال» وخضوع في جوهره. ولسوء الحظ، فإنه كان من قبيل الامتثال المزدوج؛ وأعني امتثالية كلٍّ من الوعي والواقع ضمن هذا الخطاب، وخضوعهما لما يفرض نفسه عليهما من الخارج. فقد ظل الوعي لا يعرف سبيلاً للتفكير في أزمة واقعه، إلا مُمتثِلاً وخاضعاً لسلطة نموذج/أصل يقيس عليه واقعه/الفرع، ثم يصير من ذلك إلى إكراه هذا الواقع/الفرع على الخضوع والامتثال لذلك النموذج/الأصل، بما يعنيه ذلك من أنها الامتثالية المزدوجة من جانب الوعي وواقعه لسلطة النموذج الجاهز المفروض عليهما. وهكذا، فإنه قد كان على الوعي أن ينطلق من نموذج مكتمل وناجز، ليقيس مدى انحراف واقعه (المتردّي) عنه، ليصير بعد ذلك إلى القطع بأنه لا سبيل لقهر تردّي ذلك الواقع وانحرافه إلا عبر التطابق مع هذا النموذج المكتمل الجاهز[26]. وإذا كانت الامتثالية قد دخلت إلى بناء التراث من خلال آلية في إنتاج المعرفة تستبطن كل سمات «المقايسة الفقهية» ومحدداتها؛ وهي المقايسة التي يمكن اعتبارها -بحسب ما بدا من تحليل الفعل المعرفي المهيمن داخل الخطاب العربي الحديث- بمثابة السلف التراثي لآلية «المقاربة الإيديولوجية» التي تسود فضاء هذا الخطاب على نحو كامل، فإن ما يقارن «الامتثالية» -التي هي بمثابة خصيصة ملازمة للوعى- ويصاحبها من «التشظي والبعثرة» التي هي -في المقابل- خصيصة الموضوع (الذي يقاربه هذا الوعي) ولازمته، والتي راحت تتجلّى فيما بدا، وكأنه التعاطي الحداثي مع التراث عبر تمزيقه وتقطيع أوصاله، وتحويله إلى ركام من النتف والشظايا، إنما تجد ما يؤسسها في بناء التراث أيضاً؛ وأعني من خلال هيمنة آلية «ذرية» لا تعرف إلا «الانفصال والتفتيت» على رؤية العالم المهيمنة داخله. فالعالم يستحيل، ضمن هذه الرؤية، إلى فضاء كامل من الظواهر المفككة والمبعثرة؛ وذلك لإفساح المجال لقدرة مطلقة تقف خارجه، هي التي تنظم تلك الظواهر وتجمع بينها على نحو يهبها المعقولية[27]. وهكذا، يتكامل حضور كل من «الامتثالية» من جهة، و«التشظي والبعثرة» من جهة أخرى، ضمن ثقافة التراث والحداثة معاً، وبما يحيل إلى نجاح البداوة في اختراق أبنيتهما العميقة على نحو كامل[28].
فإذ ترتد «الامتثالية» إلى أصل «أبوي» (بطريركي)؛ وأعني من حيث لا تجاوز تلك الامتثالية حدود كونها محض تجلٍّ في السياق المعرفي لهيمنة «الأبوية» في السياق الاجتماعي، فإن ظاهرة «الانفصال والتفتيت»، إنما ترتد، بدورها، إلى بناء عالم غابرٍ وبعيد، لم يعرف إلا أن يكون موضوعاً لمجرد «البعثرة والتفكك». والملاحظ أن كلاً من «الأبوية» و«التشظي والبعثرة» يجدان معاً ما يؤسس لحضورهما في بناء عالم وثقافة ما قبل الإسلام؛ وأعني عالم وثقافة «البداوة» التي يبدو أن «الأبوية» و«البعثرة» لم يحضرا فيها كممارسة «واقعية»، بل جرى -وهو الأهم- استبطانهما كممارسة «عقلية» وذهنية كذلك.
ومن هنا ضرورة الوعي بنظام عالم البداوة وثقافتها توطئة للوعي بما يؤسس، في العمق، للآليتين الأكثر فاعلية واشتغالاً في البنية العميقة لكلٍّ من الخطاب التراثي ووريثه الحداثي في آن معاً؛ وأعني آلية «المقايسة الفقهية» التي تسيَّدت فضاء الخطاب التراثي، وآلية «المقاربة الإيديولوجية» التي حددت طريقة اشتغال وريثه الحداثي على نحو كامل. فكلتا الآليتين تنبنيان على «الامتثالية» من جهة، وعلى «الفصل والتفتيت» من جهة أخرى، وهما اللذان لا يجاوزان محض كونهما انعكاساً لما يقوم عليه عالم البداوة وثقافته من «الأبوية» و«التشظي»، وإلى حد إمكان وصفهما -وفيما وراء زخارف السطح الذي يخايل بالاختلاف والمباينة- نوعاً من الاسترجاع المراوغ لعالم وثقافة البداوة.
وإذ يبدو -هكذا- أن نوعاً من المعرفة الحقة بكلٍّ من التراث والحداثة، هو مما يستحيل ويتعذر إلا عبر الوعي بنظام البداوة، وكذا بكيفية حضور هذا النظام واشتغاله في صميم بنائهما الأعمق، فإن نقطة البدء في سبيل إنجاز هذا الوعي، إنما تنطلق من حقيقة أنه إذا كانت البداوة قد استوعبت ثلاث موجات ثقافية كبرى؛ هي الإسلام، ثم الحداثة وما بعدها، فإنها لم تكن أبداً موضوعاً لتحليل يستجلي نظامها وكيفية حضورها واشتغالها تحت أردية هذه الموجات الكبرى الثلاث. ولعل ذلك يرتبط بحقيقة ما جرى من قران البداوة بما يجعلها موضوعاً للإدانة والوصم؛ وأعني ما جرى من كونها رديفاً لنوع من الجاهلية الغليظة التي جاء الإسلام لكي يرفعها وينفيها كلّياً.
وإذا كان الوعي قد مضى فيما بعد الإسلام، يحدد ما قبله بأنه محض «الجاهلية»[29]، فإنه كان يكشف بذلك عن مضمونه كوعي «طهوري» لا يرى في الإسلام حضوراً، ولو لبعض ما قام قبله على الأقل، بل يراه نقيضاً كاملاً لهذا السابق عليه، وإلى حد أنه لا يستبقي شيئاً منه البتة، بل إنه يسعى إلى نفيه ورفعه كلّياً.
وعلى الرغم من أن ذلك يتسق مع طبيعة الوعي الطهوري الذي هو -في الجوهر- وعيٌ إقصائي نقضي، فإنه يتعارض مع حقيقة أن الإسلام لا يكتفي بأن يستبقي من العالم السابق عليه بعض قيَمه وعاداته فحسب، بل ويستدمج في بنائه بعض شرائع هذا العالم وحدوده، بل وحتى بعض شعائر عباداته وطقوسه[30]. لكنه يبقى مع ذلك، أن الإسلام ينطوي -رغم احتفاظه ببعض العناصر الجزئية من العالم السابق عليه- على السعي الكلي إلى تجاوز هذا العالم وتخطيه تماماً[31]. وإذا كان ليس غريباً أن وضعاً مُستجداً، كالإسلام، سوف يستبقي بعض «الجزئي» من الوضع السابق عليه، والذي يكون، هو نفسه، موضوعاً للرفع والتخطي «الكلي» من جانب ذلك الوضع المُستجد اللاحق، فإن الغريب حقاً أن يكون عالم (الإسلام) المُستجد اللاحق قد خضع لتوجيه عالم (البداوة) السابق عليه، وبكيفية بدا معها واقعاً في قبضة هذا التوجيه على نحو شبه كامل.
وهكذا، فإن ما جرى من المبالغة في نفي النقيض السابق على الإسلام لم يكن فعلاً لوعي يسعى إلى إنتاج معرفة منضبطة بالعلاقة بين الإسلام والعالم السابق عليه، بقدر ما كان فعلاً لوعي «طهوري» يسعى للبراءة مما يراه دنساً وخطيئة، عبر إثبات السلب المطلق للسابق -المدنس، في مقابل الإيجاب المطلق للاحق- المقدس. وبالطبع، فإن قران البداوة بالجاهلية كان لابد أن يصمها بكل ما يلحق الجاهلية من وصمات الدنس والخطيئة، وبما يجعل من استدعائها «مُحرَّماً» لا يمكن مقاربته، وبكيفية تفسر نزوع الوعي، ذي الطابع الطهوري، إلى التطهُّر من البداوة أيضاً، ولكن مع ملاحظة أن التطهُّر هذه المرة، لا عبر إثبات السلب المطلق للبداوة، بمثل ما جرى الأمر مع الجاهلية[32]، بل عبر السكوت والصمت شبه الكامل عنها؛ وبمعنى عدم التفكير فيها على نحو معلنٍ وصريح. لكنه يلزم التنويه بأن عدم استحضار الوعي لشيء ما على مستوى المُعلن والمُفَكَّر فيه، لا يعني أبداً غياب هذا الشيء عن الحضور وتوقفه عن الفعل والتأثير بالكلية، بل يعني فقط أن فاعليته ستبدأ على مستوى «المسكوت عنه» و«اللا مُفكَّر فيه». وهكذا، فإن الغياب الظاهر والمُعلن للبداوة ليس إلا محض غطاء لحضورها غير المُفكَّر فيه، ولكن الفاعل والمؤثر، وهو النوع من الحضور الذي سوف يؤسس لفاعليتها المُنفلتة، وغير القابلة للسيطرة، في بناء الثقافة التي سادت في الإسلام، وظلت تحدد جوهر ومصير ما جرى من تطورات لاحقة.
ولكن -من حسن الحظ- أن حضورها واشتغالها داخل الثقافة لم يكن دائماً على هذا النحو من التخفي والإضمار؛ ذلك أن فعلها يظهر جلياً، بل ويجري التصريح به والإعلان عنه في بعض جوانب الثقافة؛ وأعني بالذات في تلك الجوانب الأكثر ارتباطاً بالوقائع والأحداث كالتاريخ والسياسة على وجه الخصوص. فالحق أن حضور البداوة واشتغالها الفاعل والمؤثر، ضمن هذين الحقلين، لم يكن مجرد حضورٍ واضح وظاهرٍ فقط، بل كان مُصرحاً به ومُعلناً، وهو الأهم. ولعل ذلك يعني أن الإضمار والتخفّي، إنما يتعلقان بطبيعة حضور البداوة واشتغالها في حقول الثقافة ذات الطابع النظري المجرد؛ وأعني الأكثر انفلاتاً ومفارقة لعالم الوقائع والأحداث. وإذن، فإنه التباين بين نوعين من الحضور للبداوة داخل الثقافة؛ وأعني حضورها المباشر والصريح في بعض الحقول المعرفية، ثم حضورها المراوغ والمنفلت في حقول معرفية أخرى.
ومن ثم، يُشار إلى أن حضور البداوة المباشر والصريح في التاريخ (سواء التاريخ/الحدث أو التاريخ/المكتوب) قد كان حاسماً حقاً؛ وإلى حد ما بدا أنها لا تسكن فضاءه، وتعمل فيه وهو مجرد «ممارسة» (فعلية وكتابية) فقط، بل وحتى حين يستحيل إلى «خطاب» -يكون فيه موضوعاً للتفكير- أيضاً. لقد استحال التاريخ إلى خطاب عند ابن خلدون؛ وبمعنى أن التاريخ عنده قد أصبح، هو نفسه، موضوعاً لتفكير يستقصي قواعده وأسسه ويتأمل مفاهيمه، وليس -مثلما كان عند سابقيه- مجرد «ممارسة» لا تضع نفسها وما يؤسسها موضوعاً لتفكيرٍ أو لمساءلة أبداً، فإنه يُلاحَظْ أن ابن خلدون قد راح يمحور هذا الخطاب بأسره، حول مفهوم ينتمي إلى عالم البداوة ونظامه؛ وأعني مفهوم «العصبية» التي يقرر ابن خلدون «أنه لا تتم دعوة من الدين والمُلْك (والتغيير والثورة أو الخروج وغيرها من الأفعال السوسيوسياسية) إلا بوجود شوكة عصبية تُظهره وتدافع عنه من يدفعه حتى يتم أمر الله»[33]، وأن معنى هذه العصبية أنها «إنما تكون من الالتحام بالنسب أو ما في معناه؛ وذلك أن صلة الرحم طبيعي في البشر إلا في الأقل. ومن صلتها النعرة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم أو تصيبهم هلكة. فإن القريب يجد في نفسه غضاضة من ظلم قريبه أو الاعتداء عليه، ويود لو يحول بينه وبين ما يصله من المعاطب والمهالك؛ (وتلك) نزعة طبيعية في البشر مُذ كانوا. فإذا كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريباً جداً، حيث حصل به الاتحاد والالتحام كانت الوصلة ظاهرة؛ فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها. وإذا بَعُدَ النسب بعض الشيء، فربما تنُوسي بعضها ويبقى منها شهرة فتحمل على النصرة لذوي نسبه بالأمر المشهور منه، فراراً من الغضاضة التي يتوهمها في نفسه من ظلم من هو منسوب إليه بوجه. ومن هذا الباب الولاء والحلف؛ إذ نعرة كل واحد على أهل ولائه وحلفه للأنفة التي تلحق النفس من اهتضام جارها أو قريبها أو نسيبها بوجه من وجوه النسب؛ وذلك لأجل اللُّحمة الحاصلة من الولاء مثل لُحمة النسب أو قريباً منها. ومن هنا، تفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم: تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم؛ بمعنى أن النسب إنما فائدته هذا الالتحام الذي يوجب صلة الأرحام حتى تقع المناصرة والنعرة، وما فوق ذلك مُستغنى عنه»، وأنها (أي تلك العصبية) لا توجد إلا بين البدو الذين «لا يصدق دفاعهم وذيادهم (عن أحيائهم) إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد؛ لأنهم بذلك تشتد شوكتهم ويُخشى جانبهم؛ إذ نعرة كل أحد على نسبه وعصبيته أهم.... وإذا تبيَّن ذلك في السكنى التي تحتاج للمدافعة والحماية، فبمثله يتبين لك في كل أمر يُحْمَل الناس عليه من نبوة أو إقامة مُلْك أو دعوة؛ إذ بلوغ الغرض من ذلك، إنما يتم بالقتال عليه، لما في طبائع البشر من الاستعصاء، ولابد في القتال من العصبية كما ذكرناه آنفاً. فاتخذه إماماً تقتدي به فيما نورده عليك بعد»[34]. وهكذا، فإنه لا تاريخ من غير عصبية، ولا عصبية من غير بداوة؛ وعلى النحو الذي يكاد فيه ابن خلدون أن يجعل عصبية البداوة إطاراً تفسيرياً لكل ما يقع من أحداث، لا في تاريخ العرب فحسب، بل حتى ضمن تاريخ غيرهم من العجم والبربر والأكراد والأتراك والصقالبة والتركمان.
وإذا كان قد بدا أن ابن خلدون لم يفعل، هكذا، إلا أن اختزل كل سمات البداوة وخصائصها ليصوغ منها مفهومه الأشهر عن «العصبية» التي يتمحور حولها خطابه التاريخي كله، فإن صوغه لهذا المفهوم ما كان ليصبح ممكناً أبداً ما لم يكن مسبوقاً بالاستيعاب الكامل، من جانبه، لكل مفردات التجربة التاريخية العربية الإسلامية بالذات، والممارسة التأليفيّة حولها، إلى عصره[35]؛ إذ إن تحليلاً للتجربة التاريخية الإسلامية، وكذا للممارسة التأليفية حولها من جانب المؤرخين المسلمين، إنما يكشف عن استحالة انبناء تلك التجربة بمعزل عن قانون البداوة من جهة، وعن استحالة أي ممارسة تأليفية حولها، تقوم بإقصاء هذا القانون من فضائها من جهة أخرى[36].
والحق أن البداوة وتقاليدها لتكاد أن تكون هي العامل الأكثر حسماً في مسار الأحداث ومجرى الوقائع بعد وفاة النبي مباشرة، بل وحتى في الكثير مما جرى أثناء حياته[37]. ومن هنا، إنّ مفردات من قبيل «قريش والعرب والقبيلة والعشيرة والقوم والأولياء، وغيرها من مفردات البداوة» لتكاد أن تغطي سطح الكتابة التاريخية حول تجربة الإسلام على نحو كامل، وإلى الحد الذي يصعب معه -حال استبعادها- استيعاب وفهم ما تؤرخ له تلك الكتابة. وهكذا، فإنه وبالرغم مما تفيض به تلك الكتابة من مفاهيم ومفردات ذات صبغة دينية ظاهرة، فإنه يبقى أنها لا تقدر على مزاحمة أو إزاحة ما يخص البداوة ونظامها الراسخ، بل إن قراءة مدققة يمكن أن تبلغ حدود الكشف عن أن «الديني» لم يكن إلا مجرد قناع للبدوي الذي يستتر ويعمل من تحته، وهو النوع من الاستتار الذي أوهم مؤرخاً في حجم ابن خلدون بأن مجتمع «النبوة والخلافة» يمثل نوعاً من المجتمع الخارق الذي يخرج عن قانون العصبية وفاعليتها المهيمنة[38].
ولعل مثالاً على المفهوم الذي يتخفى فيه «البدوي» تحت «الديني» يتبدى فيما يقرأه المرء عند «الطبري» من تسمية «الأنصار» أو أهل يثرب، لخصومهم على خلافة النبي من أهل مكة، بأنهم «مهاجرة قريش»[39]، حيث يبدو وكأن ثمة الإدراك لحمولة «قبليَّة» متخفية تحتجب تحت القشرة الدينية لمفهوم «المهاجرين». والحق أنه يظهر جليّاً أن كافة ما جرى الاصطلاح على إطلاقه على جملة الأحداث الأكثر مركزية بعد وفاة النبي؛ وذلك من مفردات الخلافة والردة والفتنة وغيرها، إنما تلوح كمحض أقنعة تغطي، بمسحة دينية تطفو على سطحها، على صراعات البداوة المستترة وتناحراتها التي لم تسكن أو تخفت أبداً.
الخلافة نموذجاً
يكشف تحليل مفهوم «الخلافة» عن كونه الأكثر اكتمالاً ونموذجية في الكشف عن تخفِّي القبليّ تحت قناع الديني؛ وذلك من حيث ينطوي المفهوم في جوفه على شكلي الصراع الجوهريين اللذين خاضتهما القبيلة من أجل السيادة؛ وأعني صراع القبيلة ضد غيرها من جهة[40]، ثم الصراع داخل القبيلة نفسها بين عصبيتين أو أكثر من عصبيّاتها المتنافرة. فإنه إذا كانت قريش، عبر ما رفعته في مواجهة الأنصار من حجج قبليَّة خالصة[41]، قد نجحت في مسعاها للاستئثار بالسلطة بعد وفاة النبي، فإن هذا النجاح سرعان ما سيفتح الباب أمام صراع البطون داخلها، والذي سيبلغ ذروته في حدث «الفتنة» الفاجع. ولقد راح ابن خلدون -مستعيناً بقوانين البداوة- يفسر الاصطراع داخل القبيلة بين بطونها؛ بأن «كل حي أو بطن من القبائل وإن كانوا عصابة واحدة لنسبهم العام، ففيهم أيضاً عصبيات أخرى لأنساب خاصة هي أشد التحاماً من النسب العام لهم، مثل عشير واحد أو أهل بيت واحد أو إخوة بني أب واحد لا مثل بني العم الأقربين أو الأبعدين. فهؤلاء أقعد بنسبهم المخصوص ويشاركون من سواهم من العصبيات في النسب العام. والنعرة تقع عن أهل نسبهم المخصوص وعن أهل النسب العام، إلا أنها في النسب الخاص أشد لقرب اللُّحمة»[42]. والملاحظ أن هذين الشكلين للصراع (أعني بين قريش وغيرها أولاً، ثم داخل قريش نفسها ثانياً) قد حددا جوهر ما وقع من أحداث «الردة» و«الفتنة» بالذات.
فعلى الرغم مما ينطوي عليه مفهوم «الردة» -الذي اصطلح المؤرخون على إطلاقه على ما جرى من تحدي القبائل في معظم أنحاء الجزيرة العربية لسلطة قريش إثر وفاة النبي- من دلالة دينية لافتة، فإن قراءة لذلك الذي جرى الكثيرون على اعتباره «ردة القبائل» يكشف عن أن الديني لم يكن، في الأغلب، إلا محض قناع للقبَلي. وعلى نحو ما، فإن ذلك ما تؤكده حقيقة ما جرى من التباين بين كبار صحابة النبي في تقييم سلوك تلك القبائل، وعلى النحو الذي انحاز فيه البعض من هؤلاء الصحابة، لموقف أبي بكر، في كونهم «مرتدين» عن الدين، فيما استقر بعضهم على الوصف الذي أعطاه عمر بن الخطاب لهم بوصفهم مجرد «مانعين للزكاة». والحق أن هذا التقييم لموقف «قبائل العرب»، لا كردة، بل كمجرد «منع للزكاة»، هو ما يفتح الباب أمام الكشف عن الجذر «القبَلي» المتخفي تحت أردية «الديني». ولأن التباين يتبدى، في جوهره، بما هو تباينٌ بين إطارين مرجعيين لقراءة حدث واحد؛ إحداهما مرجعية «دينية» والأخرى «قبليَّة»، فإن بروز المرجعية «القبليَّة» مع شخص في وزن عمر بن الخطاب، إنما يعني أن امتناع تلك القبائل عن أداء الزكاة لم يكن، في نظره، مما يمكن تفسيره ضمن حدود المرجعية الدينية فقط، بل إنه يجد تفسيره الأكمل -أو يكاد- ضمن إطار المرجعية القبليَّة؛ وأعني من حيث يرتبط توقف قبائل العرب عن أداء الزكاة بالسعي إلى الانعتاق مما يؤكد دونيتها في مواجهة قريش. ولعل ذلك يجد ما يدعمه في ما صار إليه ابن خلدون -في سياق كشفه عن تقاليد عالم البداوة- من أنَّ «المغارم والضرائب هي مما يوجب المذلَّة للقبيل، فإن القبيل الغارمين ما أَعطوا اليد من ذلك حتى رضوا بالمذلة فيه؛ لأن في المغارم والضرائب ضيماً ومذلة لا تحتملها النفوس الأبية، إلا إذا استهونته عن القتل والتلف، وأن عصبيتها حينئذ ضعيفة عن المدافعة والحماية»[43]. وبالطبع، فإنه يمكن القول -ترتيباً على ذلك- إن القبائل التي سُميت بالمرتدة، لم تقرأ في دفع الزكاة للخليفة، بعد وفاة النبي، إلا أنه من نوع «المغرم الموجب للمذلة» لقريش. ولقد كان ذلك - لحسن الحظ- هو ما جرى التعبير عنه صراحة على لسان «قُرة بن هبيرة» -وهو أحد وجوه تلك القبائل المُسماة بالمرتدة- مُخاطباً أحد وجوه قريش: «يا هذا، إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالأتاوة، فإن أنتم أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع، وإلا فلا أرى أن تجتمع عليكم»[44]. وهكذا، فإن «الزكاة» لم تكن، في تصور تلك القبائل، أكثر من أتاوة تدفعها لقريش. ومن هنا ما بدا لأولئك العرب من أن الامتناع عن أداء تلك الأتاوة ليس انتهاكاً لركن «ديني»، بقدر ما بدا وكأنه الانعتاق مما يترتب على أدائها من العار القبَليّ.
والحق أن المضمون «القبَلي» لم يفارق حتى ذلك النوع من الردة ذا الشكل الديني، والذي راح يأخذ شكل ادعاء للنبوة، وإلى حد ما بدا من أن التصارع بالنبوات (صادقة أو كاذبة) ينطوي على نوع من الاستعادة لما جرى من التنافس القبَلي على مستوى الأصول الأعلى بين «ربيعة» (التي تنتسب إليها القبائل المرتدة في اليمامة وشرق الجزيرة)، وبين «مضر» (التي ترتد إليها عصبية قريش الغالبة). ومن هنا ما ينطق به ذلك النص الذي يروي فيه «عمير بن طلحة النمري، عن أبيه، أنه جاء اليمامة، فقال: أين مسيلمة (الذي عُرِفَ بالكذاب)؟ قالوا: مه... رسول الله! فقال: لا، حتى أراه، فلما جاءه قال: أنت مسيلمة؟ قال: نعم، قال: من يأتيك؟ قال: رحمن، قال: أفي نور أو في ظلمة؟ فقال: في ظلمة، فقال: أشهد أنك كذاب، وأن محمداً صادق، ولكن كذَّاب ربيعة أحبّ إلينا من صادق مضر»[45]، بل إن ذلك الذي يرويه عمير، وعلى قوته في الكشف عن التأثير الحاسم الذي مارسته «القبيلة» على حركة «ادعاء النبوة»، يبقى أقل تطرّفاً مما صار إليه، قبلاً، أحد أبناء ربيعة نفسها من أنه «منذ أن بعث الله نبيه في مضر وربيعة غاضبة على ربها»[46]. وبالطبع، فإن الأمر يتجاوز هنا، مجرد القول بنقص الدين وقشريته لدى تلك القبائل، إلى تأكيد السطوة الكاملة لمواريث عالم القبيلة، وعلى نحو تكون فيه تلك المواريث هي ما يحدد الموقف من النبي (كُرهاً) ومن الله (غضباً). ولعل ذلك الطابع القبلي للردة هو ما يحضر فيما ردَّ به مسيلمة نفسه، على كتاب النبي الذي يدعوه فيه إلى الإسلام: «من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، سلام الله عليك. أما بعد: فإني قد أُشركت في الأمر معك، وإن لنا نصف الأرض، ولقريش نصف الأرض، ولكن قريشاً قوم يعتدون»[47]. وعليه، فالأمر -بحسب مسيلمة- لا يتجاوز حدود تقسيم السيادة بين قبيلتين؛ ولكن إحداهما قد راحت تنتهك قانون تقسيم تلك السيادة.
والغريب حقاً أن وعي قريش بجوهر صراعها ضد ما سُمّيَ بالقبائل المرتدة، لم يجاوز، بدوره، حدود هذا المضمون القبَليِّ، وعلى النحو الذي يبدو معه وكأن «الديني» لم يكن إلا محض قناع راحت تغطي به سعيها إلى ترسيخ سيادتها على العرب كافة. ولعل ذلك يجد تأكيده في ما يرويه «الطبري» من أنه «حين أقبل عمر بن الخطاب يريد التسليم على عمرو بن العاص (إثر عودته من رحلة إلى شرق الجزيرة تسمَّع خلالها إرهاصات تمرد العرب على قريش)، فمرّ بحلقة، وهم في شيء من الذي سمعوا من عمرو[48]، وفي تلك الحلقة: عثمان وعليٌّ وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، فلمّا دنا منهم عمر سكتوا، فقال: فيم أنتم؟ فلم يجيبوه، فقال: ما أعلمني بالذي أنتم عليه! فغضب طلحة، وقال: تا الله يا ابن الخطاب لتخبرنا بالغيب! قال: لا يعلم الغيب إلا الله، ولكن أظن قلتم: ما أخوفنا على قريش من العرب، وأخلقهم ألا يقروا بهذا الأمر (يعني أمر السيادة القرشية)، قالوا: صدقت، فلا تخافوا هذه المنزلة، أنا والله على العرب أخوف مني من العرب عليكم، والله لو تدخلون معاشر قريش جحراً لدخلته العرب في آثاركم، فاتقوا الله فيهم»[49]. وإذ يبدو، هكذا، أن ما يشغل رجالاً في وزن عثمان وعليّ وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد -وهم كبار وجوه الدين والقبيلة (قريش) في آن معاً- هو تأمين السيادة القرشية التي راح عمر بن الخطاب يطمئنهم على استحالة المساس بها، ابتداءً من وعيه الكامن -الذي سيتجلى في أكثر من واقعة- بما يبدو وكأنه التمازج، وإلى حد التماهي، بين الإسلام والقبيلة (التي هي قريش)[50]، فإن ذلك يعني أن الأمر على الناحيتين (أعني ناحية قريش وناحية خصومها من قبائل العرب) لم يجاوز حدود الاصطراع القبليّ، والذي حسمته قريش لصالحها على نحو كامل حين أخفته وراء ستار ديني، راحت -من ورائه- تتماهى مع الدين (حيث يصبح رفض سيادتها رفضاً للدين ذاته)؛ وذلك في الوقت الذي راحت تلقى فيه بخصومها خارج ساحة الدين التي ما كان لها أن تتسع لهم بعد أن أصبحوا، لا مجرد خصوم قبليين، بل كفرة و«مرتدين».
والمُلاحظ أنه حين استقر الأمر لقريش، وتم تثبيت سيادتها على سائر العرب من دون أي منازعة، فإنها قد راحت تتداول السلطة بوصفها شأناً يخصها دون غيرها؛ الأمر الذي تؤكده مقولة رجل من بني مخزوم (يرد على عمار بن ياسر مُعَيِّراً له بأمه جراء تدخُّله في مسألة تداول السلطة بعد موت الخليفة الثاني): «لقد عدوت طورك يا بن سميِّة، وما أنت وتأمير قريش لنفسها!»، وكان ذلك رداً على ما بدا وكأنه تصور «عمار» للسلطة كشأن عمومي، لا مجرد شأن يخص قريش دون سواها؛ وذلك حين راح يشير على عبد الرحمن بن عوف الذي أوصى به «عمر» على رأس جماعة الشورى قبل موته: «إن أردت ألا يختلف المسلمون، فبايع علياً»؛ وذلك رداً على ما صار إليه -في المقابل- عبد الله بن أبي السرح: «إن أردت ألا تختلف قريش، فبايع عثمان»[51]؛ وبما يكشف عن أنه التقابل، فيما يتعلق بالسلطة، بين رضا «المسلمين» من جهة، وبين قبول «قريش» من جهة أخرى؛ وذلك بالرغم من أن هؤلاء الذين أشار إليهم «عمَّار» بالمسلمين قد كانوا يضعون ثقتهم كاملة في أحد القرشيين أيضاً، وفقط فإنه كان ينتسب إلى عصبيتها المغلوبة آنئذ[52]، وبما يؤكد أنه الاصطراع داخل القبيلة نفسها، والذي مضى الإمام «عليّ» نفسه يقطع به مقرّراً: «إن الناس ينظرون إلى قريش، فيقولون: هم قوم محمد وقبيله، وأما قريش بينها، فتقول إن آل محمد (يعني عصبيته الأقرب) يرون لهم على الناس فضلاً بنبوته، ويرون أنهم أولياء هذا الأمر دون قريش، ودون غيرهم من الناس، وهم إن وُلُّوه لم يخرج السلطان منهم إلى أحدٍ أبداً، ومتى كان في غيرهم تداولته قريش بينها»[53]. وإذ يكشف تنزُّل الإمام علي من الناس (أو المسلمين عموماً) إلى قريش (القبيلة) إلى آل محمد (أو العشيرة داخل القبيلة) عن جوهر الإقصاءات المتعلقة بالسلطة في الإسلام، فإنه يبقى أن هذا الإقصاء الأخير من القبيلة للعشيرة قد كان هو ما آل، أخيراً، إلى «الفتنة» التي يقوم مفتاحها الأوحد في هذا الإقصاء دون سواه[54].
وإذ يبدو، هكذا، أنه وفيما تتكشَّف «الردة» عن صراع القبيلة (قريش) مع غيرها (من العرب)، ثم تتكشَّف «الفتنة» عن الاصطراع داخل القبيلة نفسها، بين عشائرها وبطونها[55]، فإن «الخلافة»، وابتداءً بما سيؤكده التحليل من أنها حقل التعيّن الأهم لفاعلية القبيلة في الإسلام، كان لابد أن تنطوي، في جوفها، على هذين الشكلين للاصطراع. ومن هنا إمكان الاستغناء بتحليلها عما سواها، حيث يكشف الصراع حولها عن الدور الحاكم الذي لعبته القبيلة في مسار السياسة في الإسلام.
الخلافة بين الديني والقبيلي
حين عدَّد ابن خلدون أنواع السلطة، فإنه قد ألحَّ على الحمولة الدينية لسلطة الخلافة، حيث عدّها من قبيل «حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الدنيوية والأخروية الراجعة إليها؛ ذلك أن أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة؛ فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به»؛ وذلك في مقابل نوعين من السلطة، لا أثر فيهما لأي وازع ديني هما: «المُلك الطبيعي (الذي) هو حمل الكافة على مقتضى الغرض والشهوة؛ و(المُلك) السياسي (الذي) هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار»[56]. وبالرغم من تلك الحمولة الدينية -التي انعكست في تجويز البعض اعتبار الخليفة هو «خليفة الله؛ وذلك اقتباساً من الخلافة العامة التي للآدميين في قوله تعالى: {إِنِّي جاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً} [البَقَرَة: 30] وقوله: {جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الأَرْضِ} [الأنعَام: 165]»[57]. فإن تحليلاً للمفهوم يكشف عن أن ما فيه من «الديني» لا يتجاوز حدود قشرته السطحية؛ وأعني من حيث ظل «وعي القبيلة» هو ما يمثل المضمون الحقيقي لمفهوم الخليفة أو الإمام[58]، بل وينتظم كافة ما جرى له من تحولات لاحقة. ومن هنا ما جرى المصير إليه من «إن الإسلام يسجل عوداً إلى البداوة في التصور الذي قدمه عن القيادة والزعامة. فلا ريب أن شرف الأصل والفخر القبلي والثراء تخضع لهذه الفضيلة الجديدة التي تسمى التقوى، والتي تجسدت في الاحترام الكلي للتعليم الإسلامي. يقول القرآن الكريم: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ} [الحُجرَات: 13]. لكن إلى جانب هذا المبدأ الجديد للتراتب نلاحظ أن الإسلام يجدد الصلة، إلى حد بعيد، مع المفهوم البدوي للسيادة والأشراف. وعلى غرار شيخ 'القبيلة' يدين 'أمير المؤمنين' بلقبه إلى الوراثة، وهي هنا الأصل القرشي (الأئمة من قريش)، كما يدين به إلى صفاته الشخصية التي تجعله المدبر الممتاز لمصالح الأمة. فالخليفة والرئيس البدوي يجدان نفسيهما أمام سنَّة ثابتة ومقدسة، أمام مدونة شرائع لا يستطيع مخالفتها ولا تعديلها، وعليها يجب أن يتوقف طموحهما عند تطبيق النصوص بدقة، وليس من مهام أي منهما التشريع، بل السهر فقط على حفظ النظام وصيانة الأمة بحكم عادل على غرار الحَكَم القديم»[59]. ويكاد يكون ما استقر للخليفة، في كتب الفقه السياسي، من شروط ووظائف هي محض امتداد لما استقر لشيخ القبيلة من الشروط والوظائف. ولهذا فإنه إذا كان الكثيرون قد شاغلتهم مخايلة الأصل الديني للمفهوم، فأبعدتهم عن إدراك جوهره الذي يتحدد بعالم القبيلة على نحو يكاد أن يكون تاماً، فإن ذلك ينتصب كالعائق أمام الوعي الذي لابد من رفعه والتحرر منه لكي يتسنى إنتاج معرفة حقة بالمفهوم.
والحق أن الأمر -وفيما يتعلق بالتحرر من القشرة الدينية للمفاهيم- لا يقف عند حدود مفهوم «الخلافة»، بل ويجاوزه إلى غيره من المفاهيم الملازمة والمصاحبة (مثل مفهومي المهاجرين والأنصار)، حيث إن المهاجرين الذين انشغلوا بأمر الخلافة لم يكونوا -وعلى قول أحد الأنصار من منافسيهم- إلا «مهاجرة قريش»[60] بالذات. وهكذا، فإن دلالة مفهوم «المهاجرين» حين يُستخدم في الكتابات التاريخية للإشارة إلى أولئك الذين انشغلوا بأمر خلافة النبي، وسعوا إلى حسم هذا الأمر لصالحهم، لا تنصرف إلا إلى القرشيين بالذات، وليس أحداً سواهم أبداً[61]. ولعل تأكيداً لتلك الدلالة القرشية للمفهوم يتأتى من حقيقة أنه قد فقد دلالته ومعناه تماماً بعد فتح مكة، وعودة «مهاجرة قريش» إلى ديارهم في مكة؛ وأعني من حيث «لا هجرة بعد الفتح» حسب الحديث المشهور نسبته إلى النبي. وإذ «لا هجرة بعد الفتح»، فإنه لا مجال -بالطبع- للحديث عن مهاجرين بعده[62]. ومع صرف النظر عن أن المفهوم قد فقد دلالته تماماً بعد الفتح، فإنه (ومعه قرينه الذي هو مفهوم «الأنصار») لا يصلحان لقراءة ما جرى بخصوص الخلافة، وذلك من حيث أن كليهما يشير بدلالته إلى ما يبدو وكأنه كتلة واحدة من الناس لا يقوم بينها أي تمايز أو تباين. ولسوء الحظ، فإن الأمر لم يكن كذلك أبداً، حيث لا تنصرف دلالة مفهوم المهاجرين -وبالذات حين يتعلق الأمر بطلب السيادة والسلطة- إلى كل أولئك الذين هاجروا من القرشيين وغيرهم، فراراً بدينهم، من مكة، بقدر ما ينصرف إلى القرشيين منهم بالذات. وحتى فيما يتعلق بهؤلاء القرشيين، فإن الوقائع كاشفة عن أنهم لم يكونوا كتلة واحدة بدورهم، بل كانوا يعانون ضروباً من التمزق والانقسام. وبالطبع، فإن الأمر نفسه، إنما ينطبق على «الأنصار» الذين لم يكونوا، بدورهم، كتلة واحدة متماسكة، بقدر ما كانت كل عوامل التنافس القبلي تقوم بينهم في انتظار ما يفجرها، والذي لم يكن إلا حدث الخلافة الذي يدرك قارئ وقائعه أن شيئاً لم تبلغ به قريش ما بلغت يوم السقيفة -من الإمساك بالسلطة من دون كبير عناء- إلا ما كان يتوارى مطموراً من التنافس القبلي بين الأوس والخزرج الذين لم يفلح تخفّيهم وراء تسمية «الأنصار» بما تنطوي عليه تلك التسمية -التي أطلقها القرآن عليهم[63]- من دلالة دينية كثيفة، في التغطية على ما ينتمي إلى عالم القبيلة. ومن هنا ما يُقال من أن «سعد بن عبادة الخزرجي (الذي قيل إنه كان مرشح الأنصار في سقيفة بني ساعدة لخلافة النبي) لم يكن محل إجماع الأنصار جميعاً خاصة الأوس الذين لم ينسوا -والمهاجرون- موقفه من سعد بن معاذ رئيس الأوس حين أشار سعد بن معاذ على الرسول بضرب عنق عبدالله بن أبي بن سلول الخزرجي قاذف أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك الشهيرة، فقال سعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على ذلك، فقام أسيد بن حضير (من الأوس) فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، والله لنقتله، فإنك منافق تجادل عن المنافقين»[64].
وهكذا، فإن الأمر لم يكن في حاجة إلى ما هو أكثر من حدث كبير -كحدث الصراع حول خلافة النبي- ليسقط القناع الديني كاملاً عن المضمون القبلي القابع تحته، فيعود من كان يُشار إليه بالمهاجر إلى أصله كقرشي، ويعود الأنصاري إلى أصله الأوسي أو الخزرجي.
[1] - البحث مقتطف من كتاب أنثروبولوجيا العقل في الإسلام عقل الإسلام أم عقل البداوة؟، الصادر عن دار مؤمنون للنشر والتوزيع.
[2] - ولعل المرء يلحظ أن وعياً بذلك قد بدأ في التبلور -لحسن الحظ- على مدى الربع الثاني من القرن العشرين الذي علا فيه -قوياً- صوت مراجعة تجربة النهضة العربية الحديثة، تحت تأثير ما تبدّى لدعاتها المتأخرين من أن «الاستعمار» يكاد -ولا شيء سواه- أن يكون هو حصادها المر الوحيد؛ وذلك بحسب ما يظهر مما قطع به كثيرون آنذاك، منهم «سلامة موسى» الذي مضى إلى أننا «يجب أن نعترف بأن كلمة الديمقراطية كانت في السنين الثلاثين الماضية (مجرد) أمنية في مصر، ولم تكن قط تدل على نظام في الحكم»؛ وبما يعنيه ذلك من أنها كانت محض برقع على وجه الواقع التسلطي القائم. ولقد راح «محمد حسين هيكل»، وهو أحد الكبار من مُجاييلي «سلامة موسى»، يفسر ذلك بأن كافة ما كان يُلقى في الأرض العربية من بذور «الحداثة» كان يُلقى «في غير منبته، فإذا تلك الأرض تهضمه، ثم لا تتمخض عنه، ولا تبعث فيه الحياة»؛ الأمر الذي اندفع معه «أحمد أمين» -وهو أحد كبار مفكري اللحظة نفسها- يقرر أن تلك البذور الحديثة لم تخضع «لسنّة النشوء والارتقاء، بل لسنّة التدهور والانحطاط». انظر: سلامة موسى: ما هي النهضة؟ (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة، 1996، ص102؛ والكتاب بأسره بمثابة إعلان عن إفلاس مشروع النهضة العربي. وكذا: محمد جابر الأنصاري: تحولات الفكر والسياسة في المشرق العربي (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب)، عالم المعرفة، الكويت، 1980، ص27-29
[3] - إذ الحق أن فاعلية التغيير، حال اشتغاله عند مجرد السطح، تبقى ضئيلة ومحدودة، ما لم ترتبط بتفعيل الشروط التي تجعلها مؤثرة ومنتجة، والتي تقع بكاملها ضمن إطار المكوِّن الجواني الثقافي. فالأمر لا يتعلق بالدعوة إلى إهمال التغيير عند السطح البراني، بقدر ما يتعلق بوجوب السعي إلى إنتاج الشرط الجواني الذي يجعله ممكناً ومنتجاً حقاً.
[4] - فإذ يبدو وكأن «التراث» يتحدد تاريخيّاً، فإن «الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي» تكاد أن تكون حضوراً فوق التاريخ. وهكذا، فإنه فيما يكون التراث نتاجاً لذات متعينة تاريخياً واجتماعياً، فإن الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي تكون، في المقابل، نتاجاً لذات مجاوزة تستعصي على التعيين والإمساك. ولعل ذلك يرتبط بكون التراث هو نتاج العمل الواعي لأولئك الفاعلين اجتماعياً وتاريخياً في المركز، فيما ترتبط الثقافة بالمعنى الأنثروبولوجي (والفلكلوري) -في المقابل- بأولئك الذين غيَّبهم المركز وأزاحهم إلى الهامش التاريخي والاجتماعي.
[5] - بل إن التراث نفسه هو الذي أصبح، في إطار تلك المجتمعات، موضوعاً لفاعلية وتأثير الحداثة، وحيث بات يُستعاد في أفقها، وبحسب شروطها. ومن هنا إن ما يشير إليه الأنثروبولوجيون على أنه «المخلفات أو الرواسب الثقافية أو الحفريات الثقافية في الثقافة الإنسانية» -والتي «هي العمليات الذهنية والأفكار والعادات وأنماط السلوك والآراء والمعتقدات القديمة التي كانت سائدة في المجتمع في وقت من الأوقات، والتي لا يزال المجتمع يحافظ عليها ويتمسك بها بعد أن انتقل من حالته القديمة إلى حالة جديدة تختلف كل الاختلاف عما كانت عليه في الحالة الأولى، التي أدت في الأصل إلى ظهور تلك الأفكار والعادات والمعتقدات»- لا تبقى كما هي، بل تكتسب -في الحالة الجديدة- معنى جديداً ووظيفة جديدة؛ وبما يعنيه ذلك من أن استعادتها تتحقق ضمن أفق مغاير بالكلية للأفق الذي تبلورت ضمنه قبلاً. انظر: كامل عبد المالك: ثقافة التنمية؛ دراسة في أثر الرواسب الثقافية على التنمية المستدامة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) القاهرة، 2008، ص17-20 وبالطبع، فإن تلك الاستعادة (الجديدة) تختلف عن الحالة التي تستمر فيها تلك الرواسب والحفريات الثقافية فاعلة بنفس معناها، ومؤدية لنفس وظيفتها التي تبلورت من أجل أدائها حال تبلورها للمرة الأولى؛ وذلك بحسب ما تعرفه المجتمعات التقليدية.
[6] - ولقد بدا أن «النظرية الاجتماعية» ذات الأفق الماركسي بالذات، هي الأكثر قدرة -سواء في شكلها الكلاسيكي أو ذلك الشكل الأحدث الذي أخذته لاحقاً، بعد انفتاحها على الأنثروبولوجيا البنيوية وعلى الأفق ما بعد الحداثي على العموم- على أن تفسح في بنائها مكاناً لدراسة هذه المجتمعات ما قبل الحداثية؛ وذلك من حيث انشغلت هذه النظرية بالسعي إلى استيعاب كافة أشكال تلك المجتمعات في إطار صيغة مُعممة تحضر (تلك المجتمعات) فيها كمجرد نماذج دالة على تلك اللحظات الأدنى والأكثر بدائية في مسار التطور الذي يمثل الغرب لحظته الأخيرة وذروته القصوى. ولقد راحت هذه النظرية تستخدم كل معطيات علم الأنثروبولوجيا ومنجزاته؛ سواء في شكله الكلاسيكي (عند الآباء الأوائل تايلور وماك لينان ولويس هنري مورجان بالذات) الذي عجز -ابتداءً من ارتباطه بحركة التوسع الإمبريالي الأوروبي في العالمين القديم والجديد- عن التفكير خارج سياق مفهوم «المركزية الأوروبية»، فكان إخفاقه جلياً في استيعاب هذه المجتمعات ضمن سياق يفسح المجال لاعتبار خصوصيتها وتنوُّعها، وسعى إلى إلحاقها قسرياً بقانون للتطور تمثل أوروبا مركزه وذروته، أو حتى في الشكل الأحدث لهذا العلم الذي اتسع (مع الأنثروبولوجي الفرنسي الكبير موريس جوديلييه) لاستيعاب خصوصية تلك المجتمعات وتنوُّعها؛ وعلى النحو الذي راح معه يجرى تحريرها من قبضة الصيغ المُعممة، وقوانين التطور التي لا تخصها، والتي كان عليها قبل ذلك أن تخضع لسطوتها في استسلام وصمت.
[7] - محمد عابد الجابري: نحن والتراث (المركز الثقافي العربي) الدار البيضاء، ط3، 1983، ص18
[8] - والملاحظ أن اشتقاق اللفظة في العربية من الجذر «ورث -يرث- إرثاً أو تراثاً» ينطوي على دلالة الامتلاك؛ وذلك من حيث يشير إلى أيلولة شيء (هو الإرث أو التراث) كان مملوكاً لشخص، ثم آلت ملكيته لآخر بعد موته. وفي المرة الوحيدة التي وردت فيها اللفظة في القرآن {وَتَأْكُلُونَ التُّراثَ أَكْلاً لَمّاً} [الفَجر: 19]، فإن دلالة كون التراث موضوعاً للامتلاك لا تفارق هذا الاستعمال.
[9] - إذ الحق أن الأمر لا يتجاوز حدود الانتقال من علاقة ما مع التراث إلى علاقة أخرى معه؛ وأعني الانتقال من مجرد علاقة الاتصال -وإلى حد الاتحاد- الأنطولوجي مع التراث (والتي تتلاشى معها المسافة بين الذات والموضوع اللازمة لانبثاق فعل المعرفة)، إلى علاقة الاتصال الإبستمولوجي أو المعرفي (والتي لا يمكن حصولها إلا مع قيام مسافة بين الذات والموضوع تستحيل المعرفة من دونها).
[10] - وأعني أن ما يحدد كينونة التراث ليس محض حضوره الفيزيقي أو الأنطولوجي، بل يحدده فعل الانفصال المعرفي بالأحرى. والحق أن ما يحدد كينونة التراث يبقى الفعل أو الموقف المعرفي منه، سواء كان فعل انفصال أو اتصال. فإذا كانت الذات تجعل من ماضيها تراثاً حين تنفصل عنه معرفياً، فإنه لا يتحدد كتراث حين تظل تلك الذات متطابقة معه (معرفياً)، بل يبقى من قبيل الماضي المستعاد، ومن دون أن يؤثر في ذلك أن هذا الماضي لا يُستعاد صريحاً وصافياً، بل مراوغاً ومتخفياً.
[11] - وذلك على فرض إمكان اعتبار مجرد التكرار أو الاجترار أفعالاً لذاتٍ حقة.
[12] - ولعله يمكن القول إن الخطاب الإصلاحي يقدم نموذجاً مثالياً لخطاب التعويض؛ فقد بدا للوعي الإصلاحي أنه لا سبيل إلى مجابهة الحاضر الذي لا يعرف فيه إلا البؤس في ناحيته، فيما الغلبة من نصيب الأوروبي، إلا باستدعاء الماضي الذي كانت له فيه الغلبة، بينما كان البؤس من نصيب الأوروبي. إنه يحاجج بأن حاضره البائس ما هو إلا ماضي الأوروبي، فيما الحاضر الزاهي للأوروبي ما هو إلا ماضيه. وهو إذ يطمح إلى أن يكون الحاضر الأوروبي الزاهي هو حاضره أو حتى مستقبله، فإن ذلك يعني أنه يتصور حاضره ومستقبله قائمين في ماضيه. ويبقى -بحسب ذلك أيضاً- أن ما يعانيه المسلم من البؤس سوف يكون مردوداً لأوروبا؛ وذلك فيما سيكون ما يزهو به الأوروبي مردوداً للإسلام. وبهذا يستريح الوعي ويبرأ من جرحه، وخصوصاً أنه لم يقف عند حد رد التهمة عن الإسلام، بل وجعل منه الأصل فيما يزهو به الأوروبي.
[13] - «وإذا كان -ما يعدّه جورج طرابيشي- الجرح النرجسي ذو الطبيعة الأنثروبولوجية قاسماً مشتركاً بين العرب وبين سواهم من شعوب الشطر غير الغربي من الكرة الأرضية، وهو جرح ناجم في الأساس عن السبق الحضاري المنقطع النظير في التاريخ العالمي الذي حققه الشطر الغربي من الكرة الأرضية، بالقياس إلى الشطر غير الغربي -وعلى حسابه أيضاً إلى حد ما- فإن هذا الجرح النرجسي عينه يبدو في الحالة العربية قيد تفعيل مضاعف، وعصياً على الالتئام بحكم الهزيمة العربية أمام المشروع الصهيوني». انظر: جورج طرابيشي: مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة (دار الساقي) بيروت، ط1، 1993، ص6
[14] - فإنه إذا كانت «الرغبة في تضميد الجرح النرجسي قد أدت في الحالة العربية، في طور أول، إلى تضخم في إيديولوجيات الثورة الحارقة، فإنها قد أدت في طورٍ ثانٍ، ولا سيما منذ أن كشفت هزيمة 1967 عن مأزق الإيديولوجيات الثورية وفشلها، إلى نقل الصراع الإيديولوجي إلى ساحة التراث، وكذلك إلى تبلور إيديولوجيا تراثية خالصة؛ أي إيديولوجيا تريد الاستغناء عن كل إيديولوجيا 'مستوردة' لتنزل التراث نفسه منزلة الإيديولوجيا». انظر: المصدر السابق، ص6
[15] - حيث «المعرفة الحقة» هي -فيما يتعلق بالتراث تحديداً- فعل مراوحة يصعد فيه الوعي من موضوعه إلى نموذج تفسيري يستوعبه، ثم يتنزَّل من هذا النموذج إلى الموضوع المدروس مُختبراً لكفاءته (أي النموذج) وقدرته على استيعاب وتفسير كافة جوانب هذا الموضوع الذي سرعان ما يصعد منه الوعي مجدداً إلى نموذجه موسِّعاً له؛ وذلك في مراوحة مستمرة يتسع فيها الواحد منهما للآخر ويوسِّعه ويزيد ثراءه. وتستمر هذه المراوحة إلى أن يستنفد الوعي سائر ممكنات موضوعه (الذي هو التراث)، وتتحقق له -عبر هذا الاستنفاد لممكناته- الهيمنة عليه، وامتلاكه كخطوة ضرورية في سبيل تجاوزه إلى ما هو أرقى.
[16] - وأعني هذا النوع من التطابق الذي يقدم صورةً لذات تسعى إلى مطابقة وجودها مع تراث/إيديولوجيا جاهزين؛ وهو ما يختلف بالكلية مع ما قدمته الحداثة من صورة لذات تسعى إلى مطابقة وجودها مع «العقل» بما هو بنية تطورية مفتوحة.
[17] - فالمقهور حين يتوحد مع قاهره ويتطابق معه يكون قد استبطن خضوعه وانصياعه له على نحو كامل، وذلك رغم ما يبدو من إعادته إنتاج القهر كفاعل، وليس كمجرد مفعول به.
[18] - بهذا «فإن اللحظة الطاغية في التعاطي مع التراث تبقى هي اللحظة الإيديولوجية بكل مسبقاتها وتحيزاتها وإسقاطاتها ومسكوتاتها وعماءاتها، مثلما تبقى اللحظة الغائبة أو الواهنة الحضور هي اللحظة المعرفية». انظر: جورج طرابيشي: مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة (دار الساقي) بيروت، ط1، 1993، ص7
[19] - فإذ يلاحظ قارئ الطهطاوي (الداعية الرائد لليبرالية)، أن ما يزخر به نصه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية وأشعار وحكايا وسرديات عن الخلفاء والأعلام، إنما يحضر كحامل لما يستعير من أفكار روسو ومونتسكيو ونصوص الدستور الفرنسي، فإنه سوف يلاحظ أيضاً أن داعية «المادية الجدلية» حين ينقب عن دعائم وأسانيد يركن إليها ماديته -ليس فقط عند مفكرين عقلانيين كالرازي وابن رشد، بل وحتى- وللغرابة -عند متصوفة وإشراقيين كابن سينا الذي احتفى به «حسين مروة» كثيراً في قراءته للنزعات المادية في الفلسفة الإسلامية- لا يفعل إلا أن ينتقي من التراث ما يصلح حاملاً لماديته المفروضة. وبالطبع، فإنه لن يكون غريباً، ضمن لعبة البحث عن حوامل، أن يكون ابن خلدون (وهو الأشعري الصريح) المبشِّر الأول -حسب أحدهم- بالمادية التاريخية.
[20] - وأعني من تلك الأبنية الإيديولوجية التي راحت، لغربتها فوق سطح واقع لا تنتمي إليه، تبحث لنفسها عما يسند وجودها فيما اعتبرته تراثه.
[21] - انظر: جورج طرابيشي: مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة (سبق ذكره)، والكتاب بأسره بمثابة استعراض لتلك المذبحة الكبيرة.
[22] - وضمن هذا السياق من «التشظي والبعثرة»، فإنه لن يكون غريباً أن تنطق واحدةٌ من شظايا التراث بمضمون إيديولوجي لا يغاير فقط ذلك المضمون الذي تنطق به أخرى تجاورها، بل ويغاير ذلك الذي سوف يكون مطلوباً منها، هي نفسها، أن تنطق به في لحظة أخرى، بل وحتى ضمن نفس اللحظة أحياناً. ولعل مثالاً على ذلك يأتي من «الخوارج» الذين اتخذ فكرهم السياسي الاجتماعي -حسب أحد الباحثين- طابعاً ثورياً ديمقراطياً اشتراكياً، حتى وُصفوا «ببولشفيك الإسلام» و«جمهوريي الإسلام» و«كلافنة الإسلام». انظر: محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي ج1-2، (مكتبة مدبولي) القاهرة ط3، 1988، ص141. وهكذا... بلاشفة وجمهوريون وكلافنة، بل وحتى ديمقراطيون وأشياء أخرى...وكل ذلك في لحظة واحدة. والأمر نفسه ينطبق على «ابن خلدون» الذي كان عليه -حسب الطهطاوي- الليبرالي أن يكون سلفاً لمونتسكيو، ثم كان عليه -حسب قارئ ماركسي لاحق- أن يكون حامل البشارة بماركس.
[23] - انظر: علي مبروك: عصر الأوهام... العرب والبداوة وما بعد الحداثة (مجلة سطور) القاهرة، عدد مايو 2001
[24] - فالأمر لا يتعلق بحداثة أو ما بعدها حقاً، بقدر ما يتعلق بالحداثة وما بعدها بصفتها زخارف تزركش بها النخبة العربية الراهنة سطح خطابها البائس.
[25] - انظر تحليلاً واسعاً لذلك في: علي مبروك: ما وراء تأسيس الأصول...مساهمة في نزع أقنعة التقديس (دار رؤية للنشر) القاهرة 2008. والكتاب كلّه هو محض تفكيك للكيفية التي ساد بها هذا النوع من التفكير.
[26] - فإذ تتبلور المعرفة كفعل فقير لا ينطوي إلا على قياس مدى انحراف واقع فرع وتردّيه عن نموذج/أصل، فإن ذلك يحدد قصدها الفقير الذي لا يتجاوز -والحال كذلك- مجرد السعي إلى بلورة وإنتاج نوع من التماهي والتطابق بينهما؛ وذلك عبر الإلحاح على تكرار هذا النموذج، وليس استيعابه واستدماجه في بناء جديد، لابد أن يكون -ككل جديد- مغايراً حقاً.
[27] - انظر تفصيلاً لذلك في: علي مبروك: الخطاب السياسي الأشعري؛ نحو قراءة مغايرة (دار رؤية للنشر) القاهرة، 2007، والكتاب يطرح قراءة مستفيضة للدلالة السياسية لهذا التصور الذري للعالم.
[28] - ولعله ليس أكثر صراحة في الدلالة على هذا الاختراق من ذلك الشاهد الذي راح صاحبه يرصد ما عدّه «سمات ثقافتنا السائدة» على نحو بدا معه أنها ثقافة اغتراب الإنسان عن ذاته، عن قضايا وطنه وعصره وإنسانيته (وبما يعني أنها ثقافة الانفصال الكامل). إنها ثقافة الانفتاح على أسواق المتاجرة والمضاربة والربح السريع والمتع الرخيصة وتكديس الدولارات النفطية (وبما يعني أنها ثقافة الاستهلاك الرخيص). إنها ثقافة التلقِّي والتقليد البليد (أو الامتثالية والأبوية)، ثقافة التسطُّح والتشتت والتمزُّق النفسي والاجتماعي والقومي والإنساني (أي ثقافة التشظِّي والبعثرة). إنها ثقافة التسلية الفجة والاستمتاع المبتذل (أو ثقافة الترف بالتعبير الخلدوني). إنها ثقافة الغيبة في مطلقات الماضي ومسلماته، أو الضياع في شطحات مستقبل هو ماض معكوس (أو ثقافة الأبوية ماضوية ومستحدثة). انظر: محمود أمين العالم: مفاهيم وقضايا إشكالية (دار الثقافة الجديدة) القاهرة، ط1، 1989، ص138
[29] - فالجاهلية هي «اسم حدث في الإسلام للزمن الذي كان قبل البعثة.... وذلك لما كان عليه العرب في هذا الزمن من مزيد الجهل في كثير من الأعمال والأحكام». انظر: محمود شكري الألوسي: نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب، ج1 (المكتبة الأهلية بمصر) القاهرة، ط2، 1924، ص15-17. ويستوعب «أركون» مفهوم «الجاهلية» ضمن مفهوم «الفكر المتوحش» بالمعنى الذي يحدده «كلود ليفي ستروس»، وهو يميزه عن مفهوم «الفكر العليم» الذي يمثله الإسلام، ومع التأكيد أن الازدراء كان هو جوهر موقف الإسلام من الفكر المتوحش السابق. انظر: محمد أركون: الفكر العربي، ترجمة عادل العوا (منشورات عويدات) بيروت-باريس، ط3، 1985، ص ص27-28
[30] - انظر تفصيل الشعائر والشرائع والحدود والسنن التي كانت الجاهلية قد سنَّتها، فأبقاها الإسلام في: أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية: المُحبَّر، نشرة إيلزة إشتيتر (مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية) حيدر آباد- الدكن، 1942، ص236، ص ص309-340
[31] - وضمن هذا السياق، يمكن استيعاب ما مضى إليه البعض من أن «الإسلام يقدم تنازلات كبيرة لضرورات الحياة (البدوية) المتشردة لدرجة أن طقسه إذا قُورن بطقس مكة القديمة، يمكنه أن يسجل تراجعاً إلى البداوة. عملياً يلغي جنين الإكليروس الذي عرفته الجاهلية العربية من قبل، ويقيم التيَمّم، وأخيراً يسهل البقاء في الحياة المتشردة، فلا يفرض إقامة الصلاة في الجامع حصراً. في المقابل يُبقي على الأضاحي، وهي إرث مباشر من الحياة الرعوية، ويعتمد تقويماً قمرياً محضاً، وهو أقرب إلى عادات البدو من التقويم الشمسي. إن الممارسات الشعائرية الأساسية في الإسلام لا تتعارض مع نمط الحياة البدوية، وتبدو فوق ذلك متطابقة مع حياة الصحراء البسيطة والمتقشفة أكثر من تطابقها مع مستلزمات المدن». انظر: يوسف شلحد: بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده، ترجمة خليل أحمد خليل (دار الطليعة للطباعة والنشر) بيروت، ط1، 1996، ص16. فالحق أن ما يشير إليه النص من تطابق الإسلام مع البداوة لا يجاوز حدود تلك المظاهر الجزئية إلى دلالة الإسلام الكلية التي تمثل تجاوزاً كاملاً لدلالة عالم البداوة.
[32] - فلعل الوعي حين ابتدع مفهوم «الجاهلية» للحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام، وأسقط عليها كل سمات السلب المطلق، إنما كان يراوغ قصد إفساح المجال للبداوة للحضور على نحو ما. فإنه إذ راح يبتدع ما يحمل عليه كل سمات السلب (وأعني الجاهلية)، فإنما ليترك «البداوة» موضوعاً للمخايلة بالسلب والإيجاب أيضاً، وهو ما كان لابد أن يفتح الباب أمام حضورها المتخفي والمراوغ. انظر في فضل البداوة: المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد (دار المعرفة) بيروت 1982، ج2، ص119-122. وانظر حديثاً مطولاً في فضائل عرب البادية قبل الإسلام في: الألوسي: نهاية الأرب في معرفة أحوال العرب، ج1 (سبق ذكره) ص18-159. وكذا: أحمد محمد الحوفي: الحياة العربية من الشعر الجاهلي (مكتبة نهضة مصر) ط3، القاهرة 1956. والحق أن الموقف من البداوة قد ظل قلقاً ومضطرباً ومتراوحاً بين السلب والإيجاب، حتى فيما يخص النصوص المؤسِّسة داخل الثقافة؛ وأعني القرآن والسنة.
[33] - ابن خلدون: المقدمة، نشرة على عبد الواحد وافي (دار نهضة مصر) القاهرة، ط3، دون تاريخ، ج2، ص817
[34] - المصدر السابق، ج2، ص483
[35] - ولقد كان ذلك من بين ما أنجزه ابن خلدون بالفعل، حيث مضى يقول: «لم أترك شيئاً في أولية الأجيال والدول، وتعاصر الأمم الأُول، وأسباب التصرُّف والحول، في القرون الخالية والملل، وما يعرض في العمران من دولة وملَّة، ومدينة وحلَّة، وعزة وذلِّة، وكثرة وقلة، وعلم وصناعة، وكسب وإضاعة، وأحوال متقلبة مُشاعة، وبدو وحضر، وواقع ومنتظر، إلا واستوعبت جُمله، وأوضحت براهينه وعلله»، منطلقاً فيه من وعي بحدود الكتابات التاريخية السابقة عليه، وهي الكتابات التي لم يفعل أصحابها، على قوله، إلا أن راحوا «يكررون الأخبار المتداولة بأعيانها، اتباعاً لمن عني من المتقدمين بشأنها...، ثم إذا تعرضوا لذكر الدولة نسَّقوا أخبارها نسقاً، محافظين على نقلها وهماً أو صدقاً، لا يتعرضون لبدايتها، ولا يذكرون السبب الذي رفع من رايتها، وأظهر من آيتها، ولا علة الوقوف عند غايتها. فيبقى الناظر متطلعاً بعد إلى افتقاد أحوال مبادئ الدول وتراتبها، مفتشاً عن أسباب تزاحمها أو تعاقبها، باحثاً عن المقنع في تباينها وتناسقها». انظر: ابن خلدون: المقدمة، ج1 (سبق ذكره) ص282-287
[36] - تجدر الإشارة إلى أن مقاربة «حداثية» لتاريخ التجربة الإسلامية لم تفعل، حين أقصت «البداوة» كمفهوم مركزي يتمحور حوله هذا التاريخ، إلا أن راحت تُسقط عليه مفاهيم غريبة عنه بالكلية. وضمن هذا السياق، فإنها قد مارست ضروباً من التعسف أفضت بها إلى القطع مثلاً بأن «المجتمع العربي قبل الإسلام (قد) شهد نمطاً 'بورجوازياً' على 'إقطاع' مضعضع، وأن عصر الرسول والشيخين (أبي بكر وعمر) يمثل محاولة لإقرار مجتمع 'الأخوة' (القريب من المجتمع المشاعي)، لكن التناقضات الاجتماعية لم تُجتث جذورها، حيث ظلت في حالة كمون، ثم تفجرت في خلافة عثمان بفضل اتساع دار الإسلام، وظهور علاقات تجنح نحو الإقطاعية. وجاءت التجربة الأموية لتؤكد سيادة الإقطاعية، وفي نفس الوقت لتشهد ميلاد 'بورجوازية' تصدَّت لقيادة الثورة العباسية....، التي سرعان ما ستختفي لتفسح المجال للإقطاعية المرتجعة». وهكذا من «البورجوازية» التي سادت على «إقطاع مضعضع» إلى مجتمع «الأخوة» شبه المشاعي، ثم جنوح إلى الإقطاعية، تتبعه «ثورة بورجوازية» سرعان ما ترتد أخيراً إلى «إقطاع مرتجع». تتساقط كل تلك المفاهيم -التي لم يكن ينقصها إلا مفهوم «الثورة البروليتارية» ليتحقق النموذج الماركسي على نحو كامل- على حقبة لا تجاوز قرنين أو ثلاثة، وغاب المفهوم الحاكم والمفسر لأحداث تلك الحقبة فعلياً. انظر: محمود إسماعيل: سوسيولوجيا الفكر الإسلامي (مكتبة مدبولي) القاهرة، ط3، 1988، ص76 و323
[37] - فكثير من الأحداث والوقائع -التي أوردها كاتبو السيرة النبوية- لا تقبل التفسير إلا في ضوء ما يمكن اعتباره قانون القبيلة؛ الذي جعل من مشركي قريش حُماة للإسلام ونبيه في أحايين كثيرة. ومن هنا مفارقة أن القبيلة التي جاء الإسلام يسعى لتجاوزها قد كانت أداته في بناء قوته.
[38] - فقد بدا لابن خلدون أنه لا أثر لعصبية أو بداوة في ذلك المجتمع؛ «لأن أمر الدين والإسلام كان كله بخوارق العادة من تأليف القلوب عليه، واستمالة الناس دونه؛ وذلك من أجل الأحوال التي كانوا يشاهدونها في حضور الملائكة لنصرهم، وتردد خبر السماء بينهم، وتجدد خطاب الله في كل حادثة تُتلى عليهم، فلم يُحتجْ إلى مراعاة العصبية لما شمل الناس من صبغة الانقياد والإذعان، وما يستفزهم من تتابع المعجزات الخارقة والأحوال الإلهية الواقعة، والملائكة المترددة التي وجموا منها، ودُهشوا من تتابعها. فكان أمر الخلافة والمُلك والعصبية وسائر هذه الأنواع مندرجاً في ذلك القبيل (الخارق)». ابن خلدون: المقدمة، ج2 (سبق ذكره) ص616
[39] - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف بمصر) القاهرة، ط4، 1979، ج3، ص218
[40] - ويتسع هذا «الغير» ليشتمل، من جهة، على «الأنصار» الذين أدارت قريش صراعها معهم من أجل الاستئثار بالسلطة على حجة «القبيلة»، وليشمل، من جهة أخرى، غيرهم من «قبائل العرب» في سائر أنحاء شبه الجزيرة؛ والذين أدارت قريش صراعها ضد تحديهم لسلطتها من خلال توظيف مفهوم «ديني» هو مفهوم الردة. ومع ملاحظة أن فريقاً من القرشيين أنفسهم هو الذي سيفضح ما يخفيه هذا المفهوم (أعني الردة) وراء ظاهره الديني من حمولة «قبليِّة راسخة».
[41] - «يذكر سفيان الثوري (- 161)، ومالك بن أنس (- 179) أن أبا بكر احتج، يوم السقيفة، بما يشبه الكلام المنسوب لمعاوية (في فضائل قريش)، فقال: 'لن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذا الحيِّ من قريش'، أو كما قال في رواية ابن إسحاق (- 150): 'إن هذا الحيِّ من قريش بمنزلة ليس بها غيرهم... وإن العرب لا تجتمع إلا على رجل منهم'. وليس في المصادر التاريخية ما يشير إلى أن أبا بكر أو غيره من الصحابة استخدم آثاراً نبوية (أو بالأحرى دينية) للتدليل على أحقية قريش بالأمر». انظر: رضوان السيد: الجماعة والمجتمع والدولة (دار الكتاب العربي) بيروت، ط1، 1997 ص64. ومن هنا وجوب التريث بخصوص ما يمضي إليه البعض من «إن أبابكر الصديق رضيّ الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار في دفعهم عن الخلافة، لما بايعوا سعد بن عبادة عليها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: 'الأئمة من قريش' فأقلعوا عن التفرد بها ورجعوا عن المشاركة فيها حين قالوا: منا أمير ومنكم أمير، تسليماً لروايته وتصديقاً لخبره». فعلى فرض صحة هذا الحديث، فإن إسراع الأنصار إلى مبايعة أحدهم بالخلافة إنما يعنى أن الحديث لم يكن معروفاً أو متداولاً بينهم، وإلا فكيف لهم أن يتجاهلوه ويسارعوا بالمبايعة لواحدٍ غير قرشي متنكرين لأمر النبي. والحق أن ذلك يدفع إلى وجوب افتراض أن الحديث لم يكن موجوداً آنذاك، وأن قريشاً المنتصرة قد وضعته تثبيتاً لسيادتها التي انتزعتها بقوتها القبلية، ولكي تغطي بالديني على القبيلي. وحتى على فرض أن الحديث كان موجوداً ومعروفاً للأنصار، فإن تجاهلهم له إنما يكشف عن قوة «القبيلي» الذي راح، هكذا، يناوئ «الديني» ويتحداه. وإذا كان ابن خلدون قد أورد رواية احتجاج أبي بكر -في مواجهة الأنصار- بحديث النبي: «الأئمة من قريش» ليبني عليه اشتراط النسب القرشي في الإمام، فإن قراءته للحكمة من ذلك تكشف عن اعتباره الديني مجرد غطاء للقبيلي الراقد تحته. «فنحن إذا بحثنا عن الحكمة في اشتراط النسب ومقصد الشارع منه، لم يُقْتصَر فيه على التبرك بوصلة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو في المشهور، وإن كانت تلك الوصلة موجودة والتبرك بها حاصلاً، لكن التبرُّك ليس من المقاصد الشرعية كما علمت، فلابد من المصلحة في اشتراط النسب، وهي المقصودة من شرعيتها. وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية والمطالبة، ويرتفع الخلاف والفرقة بوجودها لصاحب المنصب. فتسكن إليه الملة وأهلها، وينتظم حبل الألفة فيها؛ وذلك أن قريش كانوا عصبة مضر وأصلهم وأهل الغلب منهم، وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف. فكان سائر العرب يعترفون لهم بذلك ويستكينون لغلبهم. فلو جُعِل الأمر في سواهم لتُوقِّع افتراق الكلمة بمخالفتهم وعدم انقيادهم؛ ولا يقدر أحدٌ من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف، ولا يحملهم على الكرَّة (الرجوع)، فتفترق الجماعة وتختلف الكلمة والشارع محذِّر من ذلك حريص على اتفاقهم». انظر: ابن خلدون: المقدمة، ج2 (سبق ذكره) ص585
[42] - المصدر السابق، ص488
[43] - ابن خلدون: المقدمة، ج2 (سبق ذكره) ص503. وضمن هذا السياق، فإنه يلزم التنويه بأن ابن خلدون قد استخدم «الديني» ليدعم به «القبَلي»؛ وذلك حين رأى أن «قوله صلى الله عليه وسلم في شأن الحرث لما رأى سكة الحرث في بعض دور الأنصار: 'ما دخلت هذه دار قوم إلا دخلهم الذل'، دليل صريح على أن المغرم موجب للمذلة»، ص503، وتفسير ذلك أن كون «أهل الزراعة والحرث» قد اعتادوا على دفع المغارم والضرائب «لأهل الغزو والغُنم» قد أوجب عليهم المذلة والضيم.
[44] - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج3 (سبق ذكره) ص259
[45] - المصدر السابق ص286. والغريب حقاً أن ذلك بعينه هو ما سوف يعيد إنتاجه، ولكن معكوساً هذه المرة، أحد القرشيين؛ وأعني به صفوان بن أمية، «وقوله عندما انكشف المسلمون يوم حنين، وهو يومئذ مشرك في المدة التي جعل له رسول الله حتى يُسلم، فقال له أخوه: ألا بطل السحر (يعنى الإسلام) اليوم؟ فقال له صفوان: اسكت! فض الله فاك؛ لأن يُربْني (يشككني) رجل من قريش أحب إليَّ من أن يربني رجل من هوازن». ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر (دار الكتاب اللبناني) بيروت 1983، مج3، ص5. وهكذا، فإن ما ينتمي للقبيلة كانت له الأولوية دوماً على ما ينتمي إلى الدين.
[46] - المصدر السابق، ص288
[47] - محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة (دار النفائس) بيروت، ط5، 1987، ص305
[48] - فلقد كان عمرو هو القرشي الذي سمع من «قرة بن هبيرة» قوله مهدداً: «يا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفساً بالأتاوة، فإن أنتم أعفيتموها من أخذ أموالها فستسمع لكم وتطيع، وإلا فلا أرى أن تجتمع عليكم». انظر: المصدر السابق، ص259
[49] - المصدر السابق، الصفحة نفسها.
[50] - وبما يعنيه ذلك من اعتبار المساس بقريش وتحديها مساساً بالدين وتحدياً له. ولعله يُشار هنا إلى ما يمكن ملاحظته من أن الروايات تضع دوماً على لسان عمر بن الخطاب ما يكشف عن إدراكه لما يخص عالم «القبيلة» قائماً تحت الستار الشفاف لما هو «ديني».
[51] - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج4 (سبق ذكره)، ص ص232-233
[52] - «ثم إن شرف بني عبد مناف لم يزل في بني عبد شمس وبني هاشم. فلما هلك أبو طالب وهاجر بنوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمزة كذلك، ثم من بعده العباس والكثير من بني عبد المطلب، وسائر بني هاشم. خلا الجو حينئذ من مكان بني هاشم بمكة، واستغلظت رياسة بني أمية في قريش، ثم استحكمتها مشيخة قريش من سائر البطون في بدر وهلك فيها عظماء بني عبد شمس: عتبة وربيعة والوليد وعقبة بن أبي معيط وغيرهم. فاستقل أبو سفيان بشرف بني أمية والتقدم في قريش، وكان رئيسهم في أُحد وقائدهم في الأحزاب وغيرها....، واتصلت رياستهم على قريش في الإسلام برياستهم قبيل الفتح التي لم تُحلَّ صبغتها ولا يُنسى عهدها أيام شغل بني هاشم بأمر النبوة، ونبذوا الدنيا من أيديهم بما اعتاضوا عنها من مباشرة الوحي وشرف القرب من الله برسوله. وما زال الناس يعرفون ذلك لبني أمية». انظر: ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر (سبق ذكره) مج 3، ص ص5-6، وهو نفس ما يؤكده قول المقريزي: «فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسس هذا الأساس، وأظهر بني أمية لجميع الناس بتوليتهم أعماله فيما فتح الله عليه من البلاد، فكيف لا يقوى ظنهم، ولا ينبسط رجاؤهم، ولا يمتد إلى الولاية أملهم؟ وكيف لا يضعف أمل بني هاشم وينقبض رجاؤهم ويقصر أملهم وكبيراهم العباس بن عبد المطلب، وابن أخيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهما يريد أحدهما استعلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته عن هذا الأمر، هل هو فيهم أم في غيرهم (فيوصي بهم بما يعنيه ذلك من إحساسهم بالضعف)، ويأبى الآخر ذلك (مخافة أن يمنعها منهم فلا يعطيها الناس لهم أبداً)». انظر: المقريزي: النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم تحقيق حسين مؤنس (دار المعارف بمصر) القاهرة، 1984، ص ص74-75. ويُشار هنا إلى أن ثمة من يرجع بأصل التخاصم إلى ما حدث من المنافرة بين هاشم بن عبد مناف وأمية بن عبد شمس. «قال: كان هاشم بن عبد مناف قد أتى الشام فأقام به حيناً، ثم أقبل منه يريد مكة ومعه الغرائر مملوءة خبزاً قد هشمته ومعه الإبل تحمل الغرائر حتى قدم مكة؛ وذلك في سنة شديدة قد جاع فيها الناس وهلكت فيها أموالهم وأنفسهم، فعمد هاشم إلى الإبل التي كانت تحمل الغرائر فنحرها، وأقام الطهاة فطبخوا، ثم أخرج الخبز الخشيم فملأ منه الجفان، ثم أمر بالقدور فكفئت عليها، فأطعم الناس أهل مكة وغيرهم، فكان ذلك أول خصبهم، فقال في ذلك رجل من قريش وهو حذافة بن غانم العدوي: (الكامل) عمرو العلا هشمَ الثريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف وقال في ذلك وهب بن عبد بن قصي بن كلاب: (الوافر) تحمّل هاشم ما ضاق عنه وأعيا أن يقوم به ابن أبيض أتاهم بالغرائر متأقات من أرض الشام بالبر النفيض، فأوسع أهل مكة من هشيم وشاب الخبز باللحم الغريض، فظل القوم بين مكللات من الشيزى وحائرها يفيض ويروى: من الشيزى جابرها. وكان أمية بن عبد شمس مكثراً فتكلف أن يصنع ما صنع هاشم فعجز عنه وقصر، فشمت به ناس من قريش وسخروا منه وعابوه بما صنع ثم قصر، فهاج ذلك بينه وبين هاشم شراً ومفاخرة ومخاصمة حتى دعاه إلى المنافرة وألب أمية إخوته ووبخوه وحربوه، وكره ذلك هاشم لسنه حتى أكثرت قريش في ذلك وذموه، فقال له هاشم: أما إذا أبيت إلا المنافرة فأنا أنافرك على خمسين ناقة سوداء الحدقة ننحرها بمكة والجلاء عن مكة عشر سنين، قال: فرضيا بذلك وجعلا بينهما الكاهن الخزاعي. وخرج أبو همهمة بن عبد العزى عامرة بن عميرة بن وديعة بن الحارث بن فهر، وكانت أمة بنت أبي همهمة عند أمية بن عبد شمس، فخرج معهما كالشاهد، فقالوا: لو خبأنا له خبيئاً نبلوه به قبل التحاكم إليه، قال: فوجدوا أطباق جمجمة بالية فأمسكها معه أبو همهمة، ثم أتوا الكاهن وكان منزله بعسفان فأناخوا الإبل ببابه، وقالوا: إنا قد خبأنا لك خبيئاً فأنبئنا به قبل التحاكم إليك، فقال: أحلف بالنور والظلمة وما بتهامة من بهمة، وما بنجد من أكمة، لقد خبأتم لي أطباق جمجمة مع الفلندح أبي همهمة قالوا: أصبت فاحكم بين هاشم بن عبد مناف وبين أمية بن عبد شمس أيهما أشرف، فقال: والقمر الباهر والكوكب الزاهر والغمام الماطر وما بالجو من طائر وما اهتدى بعلم مسافر، منجد أو غائر، لقد سبق هاشم أمية إلى المفاخر أول منها وآخر. قال: فأخذ هاشم الإبل فنحرها وأطعمها من حضر، وخرج أمية إلى الشام فأقام به عشر سنين». انظر: محمد بن حبيب بن أمية: المنمق في أخبار قريش، تحقيق خورشيد أحمد فاروق (عالم الكتب) القاهرة 1964، ص103-106. وعلى الرغم مما تنطق به الرواية، صراحة، من علو شأن هاشم على أمية، فإن ما تنتهي به من نفي أمية إلى الشام كعقوبة على تطلعه لمنافسة هاشم في الشرف، كاشف عن «دهاء التاريخ» الذي جعل من هذا النفي إلى الشام بالذات سبباً من أسباب سيادة بني أمية وتفوقها على بني هاشم في الإسلام، وخصوصاً بعد كل ما تعرض له هؤلاء الأخيرون -والطالبيون منهم بالذات- من المقاتل والمصارع.
[53] - ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف بمصر) القاهرة 1959، ج9، ص ص57-58
[54] - ويُشار هنا إلى أن الإمام علي قد ظل لا يرى تفسيراً لموقف قريش الرافض لتوليه السلطة (سواء بعد وفاة النبي مباشرة، أو حتى حين ذهبت إليه بعد مقتل عثمان) إلا في صراع العصبيتين الأقوى داخل قريش (وأعني بنى هاشم وبني أمية)، والذي يضرب بجذوره الأبعد فيما قبل الإسلام. انظر: الشريف الرضي: نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين عليّ، شرح الشيخ محمد عبده (دار الشعب) القاهرة، ص78، 295، 304. وكذا: المقريزي: النزاع والتخاصم فيما بين بني أمية وبني هاشم (سبق ذكره) ص37 وما بعدها.
[55] - وبدورها، فإنه يمكن النظر إلى حروب الفتنة على أنها -كحروب الردة- كانت جزءاً من حروب العرب ضد قريش، لكنهم وهم العرب لا يدَّعون لأنفسهم نبوة هذه المرة، بل وهم ينضوون تحت لواء رجل من قريش اقترب بسلوكه ومعتقده من وضعية الخارج على قريش؛ وأعني به الإمام عليّ بن أبي طالب الذي تتواتر الروايات بيأسه الكامل من موقف قريش تجاهه، حتى لقد كتب لأخيه عقيل «دع عنك قريشاً وتركاضهم في الضلال، وتجوالهم في الشقاق، وجماحهم في التيه، فإنهم قد أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله، صلى الله عليه وآله قبلي؛ فجزت قريشاً عني الجوازي، فقد قطعوا رحمي، وسلبوني سلطان ابن أمي». ولقد كان الإمام «زيد بن علي بن الحسين» هو من راح يفسر هذا الموقف القرشي الرافض لجَده حين مضى -في رواية الشهرستاني- إلى «إن عهد الحروب التي جرت في أيام النبوة كان قريباً، وسيف أمير المؤمنين عليّ عن دماء المشركين من قريش وغيرهم لم يجف بعد، والضغائن في صدور القوم من طلب الثأر كما هي. فما كانت القلوب تميل إليه كل الميل ولا تنقاد إليه الرقاب كل الانقياد». ومن هنا كان لابد أن يكتسب الإمام وضعية «القرشي الخارج» أو المنبوذ، وهي الوضعية التي جعلته موضع قبول من غير القرشيين بالذات. ولقد سبق إيراد رواية الطبري المتعلقة بالاختلاف بين القرشيين وغيرهم حول الأحق بالسلطة بعد موت عمر، ولوحظ أن الرواية قد جعلته اختلافاً بين «القرشيين» يصرون -من جهة- على تولية عثمان، وبين «المسلمين» يصرون على تولية عليّ من جهة أخرى. انظر: الشريف الرضي: نهج البلاغة من كلام أمير المؤمنين عليّ (سبق ذكره)، ص320-321. والشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق عبد العزيز الوكيل (مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع) القاهرة 1968، ج1، ص155
[56] - ابن خلدون: المقدمة، ج2، (سبق ذكره)، ص578
[57] - المصدر السابق، ص579
[58] - ولعله ليس غريباً أن يكون الخليفة الأول أبوبكر قد استوعب المفهوم ضمن تلك الحدود القبليَّة؛ إذ يروي البخاري أن أبا بكر «دخل على امرأة من أحمس يُقال لها زينب، فرآها لا تكلِّم، فقال ما لها لا تكلِّم، قالوا حجت مصمتة (صامتة)، فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية، فتكلمت، فقالت: من أي من أنت؟ قال: امرؤ من المهاجرين، قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش، قالت: من أي قريش أنت؟ قال: إنكِ لسؤول، أنا أبوبكر، قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم، قالت: وما الأئمة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم، قالت: بلى، قال: فهم أولئك على الناس». فالأئمة (في الإسلام) هم رؤوس وأشراف القوم (في الجاهلية). انظر: البخاري: يبدو أن هناك شيئاً ناقصاً).
[59] - يوسف شلحد: بنى المقدس عند العرب قبل الإسلام وبعده (سبق ذكره)، ص11
[60] - الطبري: تاريخ الرسل والملوك، ج3 (سبق ذكره) ص218
[61] - ولا يرتبط الأمر فقط بحقيقة أن «القرشيين» كانوا -في احتجاجهم على الأنصار- يردفون وصفهم لأنفسهم، بأنهم «المهاجرون الأولون رضي الله عنهم بتصديقه والإيمان به...، وأنهم أهل السابقة؛ فهم أول من عبد الله في الأرض، وأول من آمن بالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم...، وأول الناس إسلاماً والناس لنا فيه تُبَّع»، بأنهم «هم أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بالأمر من بعده لا ينازعهم فيه إلا ظالم، ونحن مع ذلك أوسط العرب أنساباً، ليست قبيلة من قبائل العرب إلا ولقريش فيها ولادة»؛ وبما يكشف عنه ذلك من الانتقال الناعم من دلالة المهاجر (الدينية) إلى دلالة القرشي (القبليَّة). وبالطبع فإنه لن يكون غريباً أن يكون ذلك بعينه هو استقر في وعي الأنصار بدورهم. ولعل ذلك يتأكد مما أوردته المصادر - بشأن ما جرى في السقيفة- من القول على لسان أحدهم رداً على ممثلي قريش الثلاثة (أبوبكر وعمر وأبو عبيدة): «والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم، وإنا لكما وصفت يا أبا بكر والحمد لله، ولا أحد من خلق الله أحب إلينا منكم، ولا أرضى عندنا ولا أيمن. ولكنا نشفق مما بعد اليوم، ونحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس منا ولا منكم، فلو جعلتم اليوم رجلاً منا ورجلاً منكم بايعنا ورضينا، على أنه إذا هلك اخترنا واحداً من الأنصار، فإذا هلك اخترنا آخر من المهاجرين أبداً ما بقيت هذه الأمة، كان ذلك أجدر أن يعدل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن يكون بعضنا يتبع بعضاً، فيشفق القرشي أن يزيغ فيقبض عليه الأنصاري، ويشفق الأنصاري أن يزيغ فيقبض عليه القرشي». والملاحظ هنا هو التسوية التي يقيمها النص -بوعي أو دون وعي- بين المهاجر والقرشي، وذلك ما يظهر من انتقاله من الواحد منهما إلى الآخر دون تمييز بينهما في الدلالة. انظر: ابن قتيبة الدينوري: الإمامة والسياسة، ج1، تحقيق طه الزيني (مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، القاهرة 1967، ص ص13-14
[62] - «وأما بعد الفتح وحين كثر المسلمون واعتزوا وتكفل الله لنبيه بالعصمة من الناس، فإن الهجرة ساقطة بعد الفتح». انظر: ابن خلدون: المقدمة، ج2 (سبق ذكره) ص475
[63] - التوبة: 100، 117
[64] - زكريا بن خليفة المحرمي: الصراع الأبدي؛ قراءة في جدليات الصراع السياسي بين الصحابة (مكتبة الغبيراء) سلطنة عُمان 2006، ص53