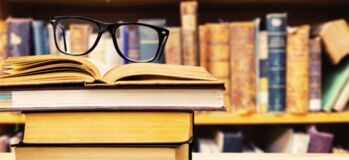عيسى ومحمّد السّياقات
فئة : ترجمات

عيسى ومحمّد[1]
السّياقات
فرانسيس إدوارد بترز
ترجمة: علي بن رجب
في سياق البحث النّقدي الذي دام ما يقرب من قرنيْن من الزّمان حول حياتهما، أنكر بعضهم وجود كلّ من عيسى ومحمّد. إنّ مثل هذا الإنكار الراديكالي لا تحفزّه عموماً الأدلّة بقدر ما يحفزّه الجدل، أو ربّما مجرّد التّمنّي. فالمؤمنون هم الذين يضايقون أساساً المتشكّكين الذين يلتزمون بعقيدتهم، أولئك المُتعصّبون الذين يُشتَبه أنّهم قد يكونون على استعداد تامّ لاختلاق أيّ شيء بما في ذلك مؤسّس عقيدتهم. هناك آخرون كُثُر ممّن يحكمون على شهادات ما يسمّى بالشّهود على أنّها شهادات مغرضة لدرجة أنّهم يجدون صعوبة في قبول أيّ منها، حتى في أهمّ النّقاط الأساسيّة. وببساطة، يسيء بعض المتشكّكين فهم طبيعة التّاريخ، ولا سيما تاريخ عالم ما قبل الحداثة. إنّ الأدلّة على وجود يسوع ومحمّد أفضل بكثير من معظم معاصريهم، حتّى الأكثر شهرة. نحن لا نعرف دائماً ما الذي يمكن أن نفعله بالأدلّة التي تخصّهم، لكنّ الأدلّة نفسها كثيرة نسبياً، وتأتي كما هي من عالم لم تبق محفوظاته. ليس لدينا سجلّات معموديّة من يهودا القرن الأوّل أو من حجاز القرن السّابع، ولا سجلّات زواج أو وصولات ضريبيّة. لا توجد توقيعات ولا صور (1).
على الرّغم من أنّنا نفتقر إلى هذه الرّوابط المباشرة المطمئنة مع الرّجليْن -وجميع المعاصرين لهما- فإنّ هناك قدراً كبيراً من الموادّ الأخرى التي يمكن دراستها. إنّ أفضل الأدلّة المتاحة وأكثرها جدوى لسيرتيْ كلّ من يسوع ومحمّد هي الأدلّة الأدبيّة؛ أي الروايات المكتوبة عنهما، حيث يتأتّى العديد منها ممّا يبدون كشهود عيان، بل ويزعم بعضهم أنّهم احتفظوا جيّداً بكلمات الرّجليْن. سيقع تناول كلّ هذه المسائل في الفصل التّالي؛ وهنا يجب علينا أوّلاً أن نلقي نظرة أوسع، جولة في أفق البيئة التي قضى فيها الرّجلان حياتهما.
يرى أتباع كلا الرّجليْن أنّهما ملهمان من الله، لكن ليس لدينا أدوات لسماع صوت هذا الوحي من السّماء. يمكننا أن نغوص، إلى حدّ ما، في لاوعي كلّ واحد منهما، لكن لا يمكننا الاستماع إلى المحادثة بين يسوع و«أبيه الذي في السّماء» أو سماع ما حدث بين محمّد والملاك جبرائيل. إنّ وسيلة استشعارنا الأوّلي مخصّصَة للأشياء الأقلّ دقّة للصّور البشريّة وللمشاهد الطّبيعيّة والاجتماعيّة والسياسيّة، وقبل كلّ شيء للبيئة الدينية التي جاء منها كلّ منهما وإليها توجّه بالخطاب. هذا لا يعني أن يكون عيسى أو محمّد نتاج تلك البيئة؛ ولكن حتّى لو كان وعظ كلّ واحد منهما آتياً من السّماء، فإنّ طريقة إيصاله وكيفية تلقّيه كانت من وظائف الأجواء في فلسطين في القرن الأوّل والحجاز في القرن السّابع. نبدأ، إذن، بنقل تلك الأجواء.
عيسى وفلسطين القرن الأوّل
لم يعتن الرّومان بالأسماء، ولم يكونوا أبداً دقيقين بشأنها: فقد أطلقوا على اليونانيّين القدامى اسم «Graeci» بناءً على اسم إحدى القبائل الهِيلينيّة الأقل أهمّيّة التي قابلوها بالصّدفة. لذلك، ليس من المستغرب أن يطلقوا على أرض كنعان، التي اعتقد اليهود أنّها مملكة إسرائيل، اسم «فلسطين»، بناءً على اسم الفلسطينيّين الذين اختفوا منذ فترة طويلة. في النهاية أصبح الاسم «فلسطين»، عندما انقسمت مملكة إسرائيل، منذ فترة طويلة، إلى ثلاث مقاطعات صغيرة: يهودا، المنطقة المحيطة بأورشليم المقدّسة: شرقاً حتّى الأردن، وغرباً حتّى البحر الأبيض المُتوسّط، وفي الشّمال: الجليل الرّيفي والزّراعي حول البحر الذي يحمل الاسم نفسه وحتّى منابع نهر الأردن، وبينهما: السّامرة الانشقاقية، بسكّانها الذين كانوا يعدّون أنفسهم عبرانيّين حقيقييّن، لكنّهم كانوا خليطاً من الغرباء وكذّابين غير شرعيّين في نظر اليهود المحيطين بهم.
سُمّي كلّ من سكّان يهودا والجليل، بشكل مربك نوعاً ما، «يهوداً»، على الرّغم من أنّهم لم يكونوا جميعاً يعيشون في المنطقة المسمّاة يهودا. لقد قرّر الرّومان أنّ هؤلاء الأشخاص المزعجين يشكّلون مجتمعاً دينياً وعرقياً، وأنّهم كانوا جميعاً (يُوداي، Ioudaei)، وهم الأسلاف اللّغويّون الذين نعرفهم الآن بــــ «اليهود». كان معظم سكّان يهودا بالفعل يهوداً بهذا المعنى، إلّا أنّ سكاّن الجليل كانوا خليطاً إلى حدّ كبير: العرب الإيتُوريّون، وبقايا السكّان السوريّين الكنعانيّين القدامى، الذين عبدوا هناك آلهة أخرى غير يهوه، إله إسرائيل القبليّ والعرقيّ، الذي كان هيكله في أورشليم اليهوديّة (2).
لقد مرّت المنطقة الواقعة تحت سيطرة «يهودا» بمراحل توسّع وانحسار على مرّ القرون، تماماً كالأماكن التي تواجد فيها اليهود. ومنذ أن أدّى تهجيرهم في القرن السّادس قبل الميلاد إلى بابل إلى الشتات اليهوديّ الأوّل، انتشر اليهود ببطء في جميع أنحاء حوض البحر الأبيض المُتوسّط، وانتهوا بالاستقرار في المدن السّاحليّة التي تحيط بهذا البحر. وبحلول القرن الأوّل كانت هناك أيضاً مستوطنات يهوديّة على الضّفّة الشّرقيّة لنهر الأردن وفي مرتفعات الجولان شرق بحيرة طبريّا. امتدّت السيادة اليهوديّة هناك أيضاً، لا سيّما في عهد هيرُودس، الملك نصف اليهوديّ، الذي كان دمية في يد الرومان، والذي حكم (37 ق.م-4ق.م)، على النّمط المماثل لمملكة إسرائيل باسم الرّومان، الذين كانوا السّادة الحقيقيّين لحوض البحر الأبيض المتوسط.
نعرف الكثير عن هيرُودس، وعن مملكته؛ وذلك بفضل المُؤرّخ اليهودي جوِزيفوس الذي نشر ما بين 75 و95 بعد الميلاد تاريخيْن رئيسيْن للشؤون اليهوديّة، الحرب اليهودية وآثار اليهود، واللّذيْن لم يشيرا فقط إلى عيسى ويُوحنّا المعمدان ويعقوب أخي عيسى (3) ولكنّهما شكّلا عنصراً رئيساً في فهمنا للبيئة الفلسطينيّة التي ولد فيها عيسى، والتي منها تطوّرت حركته. كان كلّ من الدّين والسياسة والقضايا الاجتماعيّة والاقتصاديّة جزءاً من محاولة جُوِزيفوس لشرح اليهوديّة لجمهور غير متعاطف كثيراً من القرّاء غير اليهود وكذلك أبناء دينه اليهود، الذين كان من المتوقّع أن يقرؤوا كتاباته. وتجدر الإشارة إلى أنّ كلا الفَريقيْن قد قرأ عمله، ولكن لم تكن قراءتهم له بلاتينية البلاط أو آراميّة فلسطين العامّيّة، ولكن باليونانيّة، اللّغة المشتركة لمُثقّفي حوض البحر الأبيض المُتوسّط.
إنّ جُوِزيفوس، وهو أيضاً من سكّان الجليل، هو الذي ينبّهنا إلى الاضطرابات الاجتماعيّة والسياسيّة في تلك المقاطعة. وبفضله حصلنا على بعض الفهم عن الملك اليهوديّ هِيرودس والحاكم الرّوماني بيلاطس البُنطي، Pilate Pontius، وهِيرُودس أنْتيباس، Herod Antipas، حاكم الرّبع (لقب غُرور) في الجليل، ورئيس الكهنة قيافا Caiaphas، وجميعهم أطراف رئيسة فاعلة في حياة يسوع النّاصرة. كما إنّ جوزيفوس، الفريسيّ، وأيضاً المؤرخ، هو الذي يرشدنا كذلك إلى الأحزاب والطّوائف اليهوديّة الفلسطينيّة في الفترة التي سبقت الحرب الكبرى مع روما (66-70م).
إنّ ما جلب اهتمام المُؤرّخين لعيسى في الآونة الأخيرة هو ملاحظات جوزيفوس على موسى وإيليا، اللّذيْن كانا أيضاً نموذجيْن بارزيْن في الأناجيل، واهتمامه الكبير بظاهرة النّبوّة الجذّابة، التي غالباً ما ترتبط بالتّمرّد، في فلسطين تلك الحقبة. كان هناك ثيوداس Theudas (حوالي 44-46م) -يصفه جوزيفوس بــــــــــــ«الدجّال»- الذي صَوّر نفسه على أنّه موسى الجديد الذي سيفرق مياه نهر الأردن. تدخّل الرّومان: قتلوا أو اعتقلوا أتباعه وقُطع رأس ثيوداس نفسه. لقد تذكّره المسيحيّون جيّداً (أعمال الرّسل 5: 36) وتذكّروا المتمرّد المصريّ (أعمال الرّسل 21: 38)، هو «نبيّ كاذب» بالنسبة إلى جوزيفوس، الذي قاد قوّة كبيرة من الرّجال المسلّحين ضدّ أورشليم، ويهوذا الجليلي (أعمال الرّسل، 5: 37)، وربّما كان متمرّداً مسيانياً، وأبا وجدّ المتمرّدين، الذين ينتشر تبجّحهم العائلي بالشجاعة عبر العديد من صفحات المُؤرّخ اليهودي -وهو تبجّح غير مدروس وفقاً لجوزيفوس-. وأخيراً، هناك يسوع الذي يصرخ بالأشياء الغريبة، كما يخبرنا بذلك جوزيفوس، وقد كان مصدر إزعاج لليهود والرّومان على حدٍّ سواء في أواخر الخمسينيات في أورشليم. إذ لم تكن فلسطين الرّومانيّة مكاناً هادئاً أبداً في النّصف الأوّل من القرن الأوّل.
تظهر المسائل السياسيّة والطائفيّة التي تهيمن على رواية جوزيفوس لفلسطين المعاصرة أحياناً في روايات أتباع يسوع لسيرته -حيث يتعرّض، على سبيل المثال، إلى مسائل تتعلّق بالضّرائب (مرقس 12: 13-17 وما شابه)- إلّا أنّ هذه المسائل تبدو هامشيّة بشكل ملحوظ عند النّظر إليها من منظور الأناجيل. نادراً ما يتواجد الرّومان في الجليل الإنجيلي ويظهرون في مركز الصّدارة فقط في الأيّام الأخيرة من حياة يسوع، عندما يكونون المسؤولين عن محاكمته وإعدامه. لا تتحدّث الأناجيل عن الرّومان، ولا عن أعمال الرّسل. هناك بالطّبع قائد المائة الورع كورنيليوس Cornelius، الذي وعظه بطرس في أعمال الرّسل، إصحاح 10 و11، وهناك أيضاً مختلف المسؤولين الذين اضطرّوا إلى التّعامل مع بولس المزعج، ولكن في أعمال الرّسل، ليس أقلّ ممّا ورد في الأناجيل، فالرّومان هم مسؤولون عن عملية جنائية وليس عن عمليّة سياسيّة.
ماذا كان يدور في أذهان اليهود في القرن الأوّل؟
تحيط بِالمُؤرّخ جوزيفوس مجموعة من الكتابات الدينية اليهوديّة التي لم يتمّ تضمينها في نهاية الأمر في البيْبل (4). هذه هي الكتب «الأبُوكْريفا» أو «الكتب المحدودة» التي وقع اعتبارها في نهاية المطاف، لأسباب طائفية أو لأسباب أخرى، غير جديرة بأن تُدرج ضمن الشّهود الحقيقيّين على عهد الله مع إسرائيل، لكنّها كانت تُقرأ من قبل يسوع ومعاصريه وتشكّل جزءاً من المشهد الرّوحي لتلك الحقبة. إنّ الأعمال غير البيْبليّة التي تهمّنا هنا بالتّحديد هي تلك المتداولة في زمن عيسى. إنّها تتناول مجموعة واسعة من الأجناس والمواضيع: إعادة كتابة الكتب البيْبلّة القديمة، في كثير من الأحيان لأغراض طائفيّة، وأدب الحكمة، ومواعظ أخلاقيّة قائمة بذاتها حيث يظهر التّأثير الهيليني في تمجيد «صوفيا» وتأثيراتها؛ وأخيراً، التّنبّؤات الوفيرة («الكشوفات») التي وَصَفت، بطريقة جدّ خياليّة وعاطفيّة، الأحداث المتوقّعة في الأيام الأخيرة.
إنّ الأبُوكْريفا البيْبليّة هي مجموعة غير متجانسة من الكتابات. فلقد تمّ تأليف العديد من هذه الأعمال أساساً باللغة اليونانيّة، وهي اللّغة الرئيسة لليهود في الشتات؛ والكثير منها عبارة عن مُؤلّفات مختلفة مجمّعة معاً تحت اسم واحد (زائف) مثل اسم إبراهيم وموسى وعزرا وبَاروخ؛ والكثير منها تعرض إقْحامات مسيحيّة واضحة. إنّ سبب تحريف المسيحيّين بالنصوص هو نفسه الذي يعزّز مصلحتنا الخاصّة. تُظهر هذه الكتابات بمعناها الواسع، ما كان يدور في أذهان العديد من اليهود في تلك الحقبة، بمن فيهم أتباع عيسى نفسه. وبمعناها الضيّق، فهي منشأ لمفاهيم وُضِع فيه كلّ من عيسى وأتباعه، وتحديداً عيسى، كشخصيّة مسيانيّة مُعلِنة عن ومقدّر لها أن تلعب دوراً يوم القيامة.
لم يكن البيْبل كما نعرفه، مجموعة محدّدة بدقّة من الكتب المقدّسة، موجوداً بعدُ في فترة يسوع. كان هناك بالفعل إجماع واسع على «التشريع والأنبياء»؛ أي ممّا تشكّلت التوراة ومَن كان ينبغي إدراجه بين الأنبياء. لكنّ القسم الثّالث من التقسيمات اليهوديّة التقليدية للبيْبل، والذي يحمل عنواناً غامضاً «كتابات»، كان صنفاً مفتوحاً، وكانت محتوياته لا تزال قيد المناقشة بعد قرنيْن أو أكثر من موت يسوع.
كان عيسى وأتباعه طلّاباً متعطّشين للبيْبل. كان إشْعياء ودانيال من بين قراءاتهم المفضّلة، لكنّهم كانوا مهتمّين بالقدر نفسه بما سمّيناه نحن -وليسوا هم- الأبُوكْريفا، والأعمال المختلفة المنسوبة إلى عزرا وبَارُوخ، وتولّي موسى، وعهد إبراهيم. ومن هذه الأعمال، كان عيسى وجمهوره يرسمان فهم الماضي والمستقبل للعهد. وعلينا أن نحاول عمل الشيء ذاته. ليس فقط في «التشريع والأنبياء»، كما يسمّي العهد الجديد البيْبل، الذي يمكننا أن نتوقّع وجود الجوهر الرّوحي لعيسى وحركته، ولكن أيضاً في خليط كلّ من «الكتابات» البيْبليّة والأبُوكْريفيّة التي كانت متداولة في القرن الأوّل الميلادي.
إشارات طائفيّة
يبدو أنّ المُؤلّفين أو المحقّقين أو المجتمعات المحلّية بأكملها التي أنتجت ما نطلق عليه الآن الأبُوكْريفا البيْبليّة يُمثّلون أحياناً سلالات متباينة من اليهودية المعاصرة، والتي يمكن أن تسمّى الآن «طوائف» أو «أحزاب». قد يكون هذا التصنيف مضلّلاً إلى حدّ ما؛ لأنّه لم يكن هناك في تلك الحقبة ما يمكن وصفه بــــ «اليهوديّة المعياريّة» التي يمكن، على أساسها، قياس التّباين الطائفيّ. لكن جوزيفوس استخدم مصطلح hairesis في عرضه البياني للانقسامات الأيديولوجية الرئيسة بين يهود عصره، لذلك سيكون لزاماً عليه استخدامه. تعني كلمة haireseis حرفياً «خيارات»، إلّا أنّها كانت تُفهم عموماً على أنّها «مدارس»، وهو المعنى الذي كان يُفهم بأكثر سهولة عند قرّاء جوزيفوس غير اليهود، بيد أنّ معنى «مدارس»، يبدو أكاديميّاً جدّاً، في حين أنّ المعنى البديل «أحزاب» له الكثير من الإيحاءات السياسية، وأنّ معنى «طوائف» هو أيضاً طائفيٌّ جدّاً.
في واقع الأمر، ثمّة قدر كبير من الطّائفيّة في الأعمال الأبُوكْريفيّة، وهي دعوة خاصّة لرؤية ذاتيّة مُميّزَة لليهوديّة، تماماً كما هو الحال في الكتابات الموازية لتلك الطائفة اليهوديّة الأخرى التي انبثقت من تعاليم يسوع النّاصري. كما ذكرنا سابقاً، فإنّ جوزيفوس هو الوحيد الذي يخبرنا عن المجموعات والأحزاب اليهوديّة المختلفة التي تظهر بعد عودة اليهود من المنفى البابليّ في القرن السّادس قبل الميلاد. لكنّ مكانة جوزيفوس المُتميّزَة والفريدة تَغيّرت فجأة وبشكل جذريّ مع اكتشاف عام 1947 لما يبدو أنّه مكتبة طائفيّة كاملة كانت مخبّأة ومقفلة وبالكاد يمكن الوصول إليها، في كهوف أعلى الرّكن الشّمالي الغربيّ للبحر الميت.
يبدو أنّ الطائفة ومستوطنتها المُدمَّرَة في قمران أسفل الكهوف وأقرب إلى السّاحل، كانت تلك التي وصفها جوزيفوس وآخرون باسم «إسّينيّيس»، «Essenes»، وهي جماعة زاهدة عالية التنظيم، وكانت قضيّتُها الرئيسة هي كهنوت الهيكل، وكان تركيزها على نقاء الطّقوس الصّارم في الوقت الحاضر -يبدو أنّ طقوس الاستحمام قد بدأت يلوح في الأفق في قمران- وعلى التّصديق باقتراب الآخرة. وبعد وقت قصير جدّاً ظهرت أهمّية ذلك الاكتشاف. كانت هذه رؤية استثنائية، فيما عبّرُوا عنه، حول كيفيّة فهم بعض اليهود ليهوديّتهم بالضّبط في الفترة التي عاش فيها يسوع ومات في مكان ليس ببعيد (5). هل كان عيسى المسيح موجوداً في المخطوطات؟ هل كان عيسى إسّينيّاً؟ هل كان يُوحنّا المعمدان؟
اتّضح أنّ عيسى لا يوجد في المخطوطات -ولا الإسّينيّين في الأناجيل!- وبالتّأكيد لم يكن هو نفسه إسّينياً. لكن هناك كثير من التّعليم والإرشاد في قمران بالنسبة إلى مُؤرّخ العهد الجديد. لم يكن الأسّينيّون، أو على الأقلّ فرع قمران (6) أقلّ إيماناً بالآخرة وأقلّ مسيانيّة، على الرّغم من أنّ الأمر قد لا يكون أكثر إلحاحاً من حركة عيسى، القريبة منهم في الجليل. ومع ذلك كانت هناك اختلافات ملحوظة. تماماً مثل بعض الجماعات الأخرى، فقد انتظر إسّينيّو قمران مِسّييَيْن على الأقلّ؛ أحدهما ملكيّ داودي والآخر كهنوتي، يُمَثّل الأوّل موضوعاً مشتركاً في الفكر الدّيني اليهوديّ، وهو استعادة السلطة والمجد للمُؤسّسة الملكيّة ومن خلالها لإسرائيل، ويُمثّل الثّاني انعكاساً للمسألة الإسّينيّة الأساسيّة والمُتَمثّلة في استعادة الشّرعيّة لكهنوت الهيكل.
إذا كانت المخطوطات تساعد في إلقاء الضّوء على الادعاءات المسْيَانيّة لعيسى وأتباعه، فإنّها تقدّم لنا أيضاً، فيما عبّرت عنه بأسلوبها الخاصّ، حركة طائفية يهودية، على الرّغم من أنّها حركة أكثر تنظيماً وأفضل قيادة من حركة عيسى. كما أنّ هذه المخطوطات لا تلقي الضّوء على المِسْيَانيّة اليهوديّة فقط، بل إنّ واحدة من أكثر الجوانب التي تكشفها هي طريقتهم في قراءة البيْبل: إنّ فهمهم المجازي (والمصلحة الذّاتية) للنصّ المقدّس لا يختلف كثيراً عن فهم الأناجيل لذلك النصّ.
ما لدينا إذن بالنسبة إلى عيسى هو قدر كبير من المعلومات الأساسيّة حول الفترة والمكان اللذين عاش فيهما، وأنواع اليهوديّة التي ازدهرت هناك، وكذلك الإحساس بآمال ومخاوف وتطلّعات معاصريه. وانطلاقاً من المعلومات التي قدّمها جوزيفوس، ومخطوطات البحر الميت، والتنقيب المحموم لآثار إسرائيل، يمكننا أن نوازي حياة يسوع الناصري، التي تبدو غير واضحة المعالم، بخلفية جليلية ويهودية غنية جداً وعميقة للغاية..
هل يَتضمّن هذا السياق أيضاً الكتابات الحاخاميّة مثل المِشنا (دُوِّن حوالي 200م) أو التلمود (دُوِّن حوالي 400-600م)؟ هكذا كان يُعْتقد في السّابق، لكنّ هذه القناعة تضاءلت بشكل تدريجيّ في الآونة الأخيرة. من الواضح أنّ عيسى لم يكن نتاج اليهوديّة الحاخاميّة الأكثر ترسيخاً وتنظيماً وبشكل تدريجيّ الأكثر اتّساقاً والتي تبيّنت لنا في كتابات رجال الدّين المجتهدين الذين شكّلوا الجاليات اليهوديّة بعيداً وعلى نطاق واسع منذ أكاديميّاتهم في «بابل»، وربّما تحوّل تركيزهم إلى ما أصبح بالفعل تهديداً «مسيحيّاً». كان يسوع وحركته ينتميان إلى يهوديّة القرن الأوّل الأكثر انفتاحاً وانسيابيّة وفوضويّة، والتي لا يزال قلبها ينبض بالحيويّة في أرض إسرائيل Eretz Israel المضطربة.
سياق ظهور محمّد
إنّ حجاز محمّد، المنطقة التي تمتدّ من الأراضي المرتفعة لساحل غرب الجزيرة العربية، وشمالاً إلى حدود الإمبراطوريّة الرّومانيّة (بالقرب من حدود الأردن اليوم) وجنوباً إلى حدود اليمن، هو بالنسبة لنا الرّبع الخالي. إنّها منطقة من شبه الجزيرة العربية التي لم تكن خالية من الحياة في القرن السّادس وأوائل القرن السّابع من العصر المسيحي، ولكنّها للأسف خالية من الأدلّة، ليس فقط بالنسبة إلى وجود محمّد كما يمكن أن نتوقّع، ولكن حتّى بالنسبة إلى مكّة. وبين آخر بقايا أثريّة في الشّمال لعرب الأنباط، الذين انهار نظامهم في القرن الأوّل الميلاديّ، وآثار القرنيْن الثّامن والتّاسع للنشاط الإسلامي الأوّل هنا وهناك في المنطقة، لم ينتُج عن الحجاز سوى القليل من الكتابات والرسوم على الصّخور تركها البدو الذين عانوا من الضجر، والذين بالكاد يعرفون الكتابة والقراءة، والذين كان اهتمامهم بلعن حارث [حارث، اسم ابليس قبل طرده من الجنّة (المترجم)] أو طرد عفاريت الصّحراء أكثر من التّفكير في يوم الآخرة.
صمت المصادر
ربّما لم يكن هذا الشّحّ في المصادر غير متوقّع. لم تكن في المنطقة أيّ مدن - الآثار الدائمة هي ظاهرة العيش في المدن- وكان سكّانها أمّيّين في الغالب. الأمر غير المنتظر هو صمت الملاحظين من خارج المنطقة. في القرن السّادس، كانت مجتمعات على درجة عالية من الدّراية بالكتابة والقراءة، تحدّ الحجاز شمالاً وجنوباً وشرقاً حتّى الحبشة غرباً في الجهة الأخرى من البحر الأحمر. وكان هؤلاء الجيران مهتمّين بغرب شبه الجزيرة العربية، التي يمكن لرجال القبائل العربية أن يكونوا مفيدين تجاريًّا عبر نقل البضائع من هناك، أو أن يكونوا أيضاً خطيرين، إمّا كمُغيرين على الحدود أو بصفتهم ناهبين جشعين للأراضي الآهلة على تخوم السّهوب. وعلى الرّغم من أنّ جيرانهم كانوا على دراية جيّدة بالعرب كأمّة وبالبدو كمشكلة أمنية، فليس هناك من بيزنطيّ أو ساسانيّ أو يمنيّ واحد من الذين خطّوا بأقلامهم المخطوطات ونقشوا بأزاميلهم على الحجر قد زعم أنّه يعرف أيّ شيء عن مكّة وكعبتها. إنّ المُؤرّخ البيزنطي بروكوبيوس Procopius على وجه الخصوص، الذي أجرى، في وقت ما حوالي منتصف القرن السّادس تحقيقاً دقيقاً شاملاً ومنهجياً لغرب شبه الجزيرة العربية، لم يجد سوى حفرة صامتة في المكان الذي يمكن أن تكون فيه مكّة. تتحدّث مصادرنا العربية كثيراً عن النّشاط التّجاري لمكّة في تلك الحقبة نفسها، ولكن لا بروكوبيوس، الذي كان قد قام بالبحث، ولا أيّ شخص آخر، على ما يبدو، قد سمع عن المكان.
ليس لدينا اليوم أيّ وثيقة من الحجاز يعود تاريخها إلى القرن السّادس أو السّابع، وإذا كان لدى مصادرنا الموجودة وثائق، فلن تكون كثيرة، وبالتّأكيد ليس بالقدر الذي يتطلّب منّا بعض منها تصديقه (7). لم يكن لمكّة والمدينة أيّ محفوظات في فترة محمّد، ولا كذلك، على ما يبدو، لفترة طويلة بعد ذلك. لقد كانتا، في القرنيْن السّادس والسّابع مراكز لمجتمع شفهيّ، حيث كانت الكتابة، إن وجدت أصلاً، ذات استخدام محدود ومُتخصّص للغاية.
لدينا إذن موارد قليلة لإعادة بناء مجتمع مكّة والمدينة من مصادر مكتوبة معاصرة، أو حتّى من مصادر أثريّة، نظراً لأنّه لم يُسمح أبداً بأيّ استكشاف أثريّ رسميّ في تلك المناطق المقدّسة (8). إذا كانت إعادة البناء هذه ستتمّ أصلاً، فلا بدّ من إنجازها انطلاقاً من أشعار شعراء القبائل في السّهوب، ومن التّاريخ الإسلامي اللّاحق في تلك الفترة وتلك الأماكن، وفي كلتا الحالات، من كتّاب لم يهتموا كثيراً بالاقتصاد السياسي للحجاز قبل الإسلام، وبدرجة أقلّ اهتماماً من الممارسات الدينية الوثنيّة لتلك الأيّام غير المقدّسة (الجاهليّة).
إعادة البناء
ينبغي إذن، أن تكون النُّظُم الاجتماعيّة والسياسية والدّينيّة لبيئة ما قبل الإسلام في غرب شبه الجزيرة العربية مستخرجة من مادّة صلبة. وللقيام بهذه المهمّة، كانت المحاولة الأولى في نهاية القرن التّاسع عشر من قبل العالم البيْبلي الشّهير Julius Wellhausen، يوليوس ولهاوزن وأكملها، بطريقة إبداعيّة رائعة، اثنان من العلماء: الأمير الإيطالي ليون كايتاني Leone Caetani واليسوعي البلجيكي هنري لامنس Henri Lammens. ومن المفارقات، أنّ كلا الرّجليْن كان متشكّكاً جدّاً في المصادر العربية التي كان يتعامل معها، لكنّ صورة لامنس لمكّة على وجه الخصوص، وهي عبارة عن بناء جذّاب للغاية ومفيد جدّاً، وفّرت، ولا تزال توفّر، المرجعيّة لعديد من الكتابات الغربية الحديثة لسِيرة محمّد. إنّ هنري لامنس، هو، في الواقع، جوزيفوس البحث عن محمّد، وهذه الحقيقة تشير بدقّة كبيرة إلى أحد الاختلافات الرئيسة بين دراسة سيرة محمّد وسيرة يسوع.
استخراج
لا يوجد نقص في الأدلّة على وجود مكّة محمّد. ومع ذلك، فهي أدبيّة بالكامل، وتعود إلى أكثر من قرن بعد وفاة النّبيّ، وهي نتاج مجتمع مختلف يعيش في مكان مختلف تماماً عن مكّة الوثنيّة والقبليّة في القرن السّادس وأوائل القرن السّابع.
لقد أدّى مرور المسيحيّة من منشئها اليهوديّ إلى بيئة تغلب فيها الوثنيّة، إلى إضعاف مشاعر المسيحيّين اللّاحقين فيما يتعلّق بيهوديّة يسوع وأتباعه الأوائل في «الكنيسة» الوليدة. لكنّ هؤلاء المسيحيّين لا تزال لديهم النّصوص اليهوديّة المقدّسة، «العهد القديم» كما أطلقوا عليها، بالإضافة إلى «التشويش» النّاتج عن الخلفية اليهوديّة في الأناجيل كي ترشدهم على الأقلّ إلى إحساس عامّ بموقع عيسى التاريخي (9). لا تتوفّر في مصادرنا الإسلاميّة حول أصول الإسلام أيّ مساعدة من هذا القبيل. لقد كان المسلمون أبعد بكثير عن الوثنيّة المكّية، ممّا كان عليه المسيحيّون غير اليهود الأوائل من اليهوديّة. لقد رفض المسيحيّون اليهوديّة بعد بولس، وكذلك رفض المسلمون بعد نزول القرآن، الوثنية المكية وتبرّؤُوا منها تماماً ودمّروها. ولم يكن لديهم عهد قديم ليذكّرهم بما كان من قبل، كما لا يعطي القرآن سوى تلميحات خاطفة عن المحيط الدينيّ الذي عاش فيه محمّد؛ أي الـــ Sitzim Leben الخاصّ به.
لقد تمّ استخراج معلومات نادرة وثمينة من هذه المدوّنة غير الواعدة. فقد تمّت دراسة الشّعر الجاهلي بعناية للاستخدام بالنّحو المناسب، وفُرِّغ القرآن من تلميحاته المعاصرة. إنّ العمل الوحيد الباقي إلى الآن حول آلهة مكّة هو «كتاب الأصنام» لابن الكلبي (ت 820) الذي تمّ تشريحه وتحليله، كما أنّ ملاحظات المُؤرّخين والمدوّنين اللّاحقين العشوائيّة في غالبها قد جُمِّعت، وأنّ بعض ما اتّفق مع شكل مّكة والحجاز قبل الإسلام قد بُنِي من خلال تلك الملاحظات. لكن في نهاية المطاف، يظلّ كلّ ذلك إعادة بناء، بناء بدون أساس ماديّ ولا تأكيد مستقلّ.
أخيرًا، هناك مسألة القرآن نفسه. ليس لدينا أمثلة دقيقة على الأعمال المسمّاة «الأخبار السارّة» (euangelion) في الأدب اليهودي أو اليوناني أو الرّوماني، ولكن يمكننا التعرّف على آباء هذا الهجين الأدبي في السّير Bios أو حياة العصور القديمة اليونانية الرومانية وفي مجموعات الشّعارات logoi أو الأقوال لحكماء حوض البحر الأبيض المتوسط. وكقطع فنّيّة أدبية، تندمج الأناجيل بشكل مريح نوعاً ما في مأثور غنيّ من الكتابات، اليونانيّة والعبريّة، الوثنيّة واليهوديّة، وفي مكان التقت فيه كلّ هذه المأثورات واختلطت.
إنّ القرآن محيّرٌ إلى أبعد الحدود. إنّه أقدم عمل محفوظ باللغة العربية، يسبقه فقط أربعة أو خمسة نقوش مختصرة منتشرة عبر الأطراف النائية لسهوب سوريا. أولاً، يجب التنويه أنّ القرآن ليس تشكيلاً أدبياً على الإطلاق. فهو كالعهد الجديد تماماً، هو عبارة عن مجموعة تدْوينات مجمّعة ومرتّبة، تكمن وحدتها في حقيقة أنّ مضامينها هي كلمة الله المنزلة (10). كان قرآن محمّد في الواقع هو الأجزاء المكوّنة لكتابنا، تلك الوحدات التي تشبه المقاطع وتسمّى (السّور)، حيث لم يعد من السّهل تمييز معالمها الأصليّة (11). وبمعزل عن العناصر الأصلية للعمل، يجب أن نؤكّد أنّه إذا كان القرآن ابتدائيّاً، فإنّه ليس بدائياً. يبدو أنّ تعقيده، مثل قصائد هوميروس الشّعريّة، يشير إلى الوجود المسبق لتقليد دينيّ شعريّ. لا يوجد أيّ أثر لمثل هذا، ومع ذلك؛ يبدو أنّ القرآن جديد من نوعه. وإذا كان من الغامض معرفة أيّ نوع من التّقليد السّابق قد يكون أنتج القرآن، فإنّ الأمر الأكثر غموضاً هو معرفة مَن ذا الذي يملك المهارات اللّازمة لتدوينه، في ذلك المجتمع الذي بالكاد خرج من الأميّة.
أفكار ثانويّة: الأنبياء في منطقتيْ فلسطين والحجاز
نحن الآن في وضع أفضل إلى حدّ ما، لنعُدْ خطوة إلى الوراء ونلقِ نظرة مقارنة على الرَّجُليْن في بيئتهما المناسبة. وُلِد عيسى وعمل في مجتمع متعدّد الثقافات والديانات. كانت الثّقافة الإسرائيليّة واليونانيّة موجودتيْن جنباً إلى جنب في فلسطين في القرن الأوّل، وكانت هناك أيضاً ثقافة ثالثة، وهي رومانيّة لاتينيّة: بالإضافة إلى المحاكمة الرومانية ليسوع وإعدامه، يصادفنا وجود القادة الرّومان في الجليل وكذلك اليهود الذين استخدمهم الرّومان كجامعي ضرائب، الضّرائب سيّئة السمعة. وكانت فلسطين يسوع موطناً لأكثر السكّان معرفة بالقراءة والكتابة في حوض البحر الأبيض المُتوسّط بأكمله -الأناجيل مليئة ب«الكتبة» (grammateis).
كانت اليهوديّة هي دين جماهير الشّعب، لكن بعض المدن الكبرى في فلسطين مثل المدن القريبة من ديكابولس عبر الأردن وقيصريّة عن طريق البحر في يهودا نفسها كانت وثنيّة تماماً، وكان كافياً عبور الحدود الشّمالية للجليل، كما فعل يسوع أحياناً، لمقابلة سكّان لم يكونوا من ثقافة بني إسرائيل ولا من ديانة اليهود. وبالمثل، فإنّ السّامرة المنشقّة حيث سافر يسوع أيضاً، كانت في نواح عديدة أرضاً أجنبيّة لليهود الذين عاشوا حولها.
عاش محمّد في مكان مختلف تماماً، ولا يمكننا التأكّد من أنّه غادره يوماً. كان سكّان مكّة في الحجاز عرباً بشكل استثنائيّ، قبائل انتقلت حديثاً نسبياً من ثقافة قبليّة إلى ثقافة حضريّة مع القيم المشتركة بينها، ناطقين بالعربيّة على وجه الخصوص وأمّيّين إلى حدّ كبير. أمّا من الناحية الدّينيّة، فقد كان المكّيّون يعبدون الأوثان. كان هناك يهود في بعض الواحات الشّمالية مثل المدينة وأكثر من ذلك إلى الجنوب في اليمن، ولكن لم يستقرّ أيّ واحد منهم في مكّة. كما لم يكن هناك مسيحيّون. كان اليمن مسيحياً رسمياً، وكذلك كانت الحبشة في الجانب الآخر من البحر الأحمر، وكانت هناك بلا شكّ اتّصالات غير مباشرة؛ لأنّ محمّداً عرف شَيئاً عن الديانتيْن، وعرّف الإسلام على أنّه مُغاير لهما، لكن يبدو أنّ النّبيّ لم تكن لديه لقاءات مباشرة مع المسيحيّين حتّى نهاية حياته.
قضى عيسى معظم حياته القصيرة تقريباً على أرضه في الجليل السّفلي مع توغّل عرضيّ خارج حدوده وزيارات طقسيّة قصيرة إلى القدس. ربّما سافر محمّد على نطاق أوسع، حتّى أثناء إقامته في مكّة، فقد كان يسافر قصد التّجارة وقبل أن يكلّف بالنّبوّة. لا نعرف إلى أيّ مدى أوصلته رحلاته التّجارية، ولكن يبدو، من منظور تقلّص شبكة مكّة التّجاريّة، أّنّه من المستبعد جداً أن يكون محمّد قد ترك الحجاز من قبل: إذ تتجاوز سوريا واليمن والعراق آفاقه الشّخصيّة (12). وبمجرّد أن تولّى منصبه «كمنذر» في الحرم المركزيّ في مكّة، يبدو أنّ محمّداً بقي دائم الاستقرار داخل الحدود الضيّقة لمسقط رأسه. لقد كان عيسى متنقّلاً، وهو الذي رفض بشكل غريب نوعاً ما أن يعظ في مسقط رأسه بسبب ضعف إيمان السكّان المحلّيّين بل وافتقارهم إليه أو، بشكل أكثر وضوحاً، بسبب عدم قدرته على عمل أيّ معجزات هناك (مرقس 6: 4-5 وما يلي)، إلّا أنّ محمّداً لم يكن كذلك، ولم يكن بحاجة إلى أن يكون كذلك: يوجد الحرم المكّي في قلب الميدان الواسع للقوّة الدّينيّة، وهو مجمع الحجّ العربي.
الجليل ومكّة
كان عيسى ومحمّد من سكّان المدن الصغيرة: عيسى حِرفيّ في قرية زراعيّة في الجليل المكتظّ نسبياً بالسكّان، ومحمّد تاجر في مكان أكثر أهمّيّة في منطقة أقلّ أهمّية. إنّ منطقة الحجاز التي كانت في الأساس منطقة غير ساحليّة لا يوجد بها موانئ على البحر الأحمر يمكن الحديث عنها، كانت مأهولة بالسكّان في أواخر القرن السّادس، مع تجمّعات ضئيلة وهامشيّة للغاية. لقد كان معظمها، مثل المدينة، واحات تضمّ جماعة من المزارعين العرب لبساتين النّخيل وعدد قليل من المُتخصّصين في الحرف اليدويّة -قد يكون وجود النجّار عيسى في المدينة مناسباً للغاية، لكن لن يكون للتّاجر محمّد عمل في النّاصرة. لقد كانت بساتين النّخيل المزروعة في الواحات توفّر مستوى عيش هشّ وغير مستقرّ، إلّا أنّ المزارعين كانوا يتعرّضُون للمشاكل نفسها التي أتت بمحمّد إلى المدينة: لم تتمكّن بساتين النّخيل أن تتوسّع مع التوسّع السكّاني. لقد تطوّرت المنافسات العائليّة والقبليّة على المكان والإنتاج داخل حدودها الضيّقة: كانت الفتنة حالة متوطّنة وخطيرة في بساتين النّخيل في غرب شبه الجزيرة العربيّة.
ومع ذلك، لم تكن مكّة واحة. ولم تكن بها زراعة، والأشخاص الذين عاشوا هناك فترة محمّد، ولفترة طويلة بعد ذلك، يعتمدون على حركة التّجارة: تنقّل الحجّاج -كانت القبائل الكبرى تسيطر على كلّ منافذ الوصول إلى المزارات وسقاية الزوّار وإطعامهم- ولقد استفادت التّجارة، التي ربّما كانت في الغالب تجارة محليّة، من حركة الحجّاج. ينتمي محمّد إلى الفئة الأخيرة من المكّيّين: أفضل ما يمكن أن نقول عنه، إنّه كان تاجراً صغيراً، وبالتّأكيد لم يكن زعيماً، في عشيرة من الدّرجة الوسطى.
كان لمكّة مشاكلها الاجتماعيّة الخاصّة بها، ليس من حيث المساحة والسكّان كما كان الحال في المدينة، ولكن في انهيار الولاءات القبليّة وصلات القرابة والاستعاضة عنها بتحالفات مُتغيّرة باستمرار للمصالح والمكاسب. لقد وُلدت هذه التوتّرات من الدّاخل. لكن في الجليل، وفي فلسطين بشكل عام، جاءت الضغوط أساساً من الخارج. عاش محمّد في مكّة في بلدة تَتمتّع بالاستقلاليّة في تسيير شؤونها، وفي العقد الأخير من حياته، كان في الواقع هو الحاكم الأوّل لأمّته في المدينة، ثم لــــ ـ«إمبراطورية» مزدهرة كانت تَتوسّع بسرعة خارج حدود المدينة. قضى عيسى حياته تحت الاحتلال، بشكل غير مباشر تحت حكم هيرودس أنتيباس، أحد أباطرة روما الأربعة في الجليل (حكم 4 ق.م-39م) وبعد ذلك، بعد 6م، تحت الحكم الرّوماني المباشر في المقاطعة الرّومانيّة يهودا Provincia Ioudaea.
كان وجود روما في فلسطين مرهقاً بكلّ ما في الكلمة من معنى. فلقد حمّل هيرودس الكبير أعباء الضرائب على رعاياه لدفع تكاليف برامجه للأشغال العامّة الفخمة، بما في ذلك إعادة بناء هيكل القدس (20 قبل الميلاد-66 بعد الميلاد)، وقد أضاف الرّومان وبكلّ سلاسة إلى تلك الأعباء الثّقيلة إنشاء نظام استغلال جبائيّ، وفرض دفع الضرائب بالعملة الرومانية. وقد أضيف إلى ذلك التّدخّل الرّوماني في شؤون الهيكل -كان هيكل القدس، بشكل لا يمكن مقاومته، أكبر مؤسّسة ماليّة في البلاد- والأكثر إيلاماً من ذلك دفع روما اليهود التّوحيديّين على تبنّي أبشع شكل من أشكال تعبّدهم، وهو عبادة الإمبراطور.
كلّ هذا السياق المتوتّر والمُتنوّع تعكسه الأناجيل وتبرزه. بداية، وفي البيئة نفسها، هناك ظهور لنواة سرد يونانيّ لحياة عيسى الذي كان يتحدّث بالآرامية، ولمجموعة أقواله باليونانيّة. كما أنّ هناك، بالتّأكيد، محاكمة الرّومان لعيسى وإعدامه من جهة، ومن جهة أخرى، انخراطه اليهوديّ الشديد مع كلّ من مؤسّسة الهيكل والفرّيسيّين، ذوي العقيدة الدينية المُسيطرة في عصره. لم تُظهر لنا الأناجيل الأنظمة العسكريّة والقضائيّة في روما أثناء العمل فقط، بل أيضاً تابعيها دافعي الضرائب والرومان جامعي الضرائب، كما أظهرت لنا أرستقراطيّين يهود مُتجمّعين مطمئنّين مثل نيقوديموس ويوسف الرّامي ومرضى نفسيّين؛ معافين من المرض ومصابين بأمراض خطيرة، أغنياء وفقراء، عمّالاً يوميّين كادحين وأصحاب العمل، مستأجرين ومالكي الأراضي، حكّاماً ومحكومين. وعرضت لنا جميع القضايا التي كانت بين هؤلاء. وأخذتنا داخل بيوت متواضعة وفخمة، وقصور، ومحاكم رومانيّة، ومعابد يهوديّة، والهيكل.
هناك بالتّأكيد قضايا أثارها القرآن، لكنّها بالأساس قضايا فوق الطبيعة ولاهوتيّة ودائمة: الخضوع أو الرّفض، الطاعة أو الكفر، العقاب الأبديّ أو الثّواب الأبديّ. إنّ الحياة اليوميّة مغمورة بعمق من منظور الأبديّة sub specie aeternitatis. وبناءً على أدلّة القرآن وحده، فإنّنا لا نعرف إلّا الشّيء القليل أو قد لا نعرف شيئاً عن مكّة إلّا إذا كان هناك احتمال لوجود مثل هذا المكان - لكن هل كان يُسمّي بكّة (آية 96، سورة آل عمران)؟ قد نستنتج أنّ القريشيّين كانوا تجّاراً هناك والأدلّة واضحة تماماً على أنّ عديد المكيّين كانوا أشدّاء عنيدين في مقاومتهم للواعظ ورسالة «الخضوع» التي جاء بها. ليست هناك بيوت أو أصدقاء أو عائلات في الصورة التي لدينا لذلك المكان. إنّ جبال القرآن نمطيّة، مثل جبل سيناء وجبل الزيتون، كما أنّ بحاره عامّة. وكما قال بعضهم عن مكان آخر مختلف تماماً، «لا وجود 'هناك' لــــــــ 'هناك'».
إنّ تحديد موقع مكّة الحالي قد تمّ اخْتلاقه من طرف مُؤلّفين عرب مسلمين في فترة متأخّرة، وهم يقيمون في أماكن أخرى شديدة التحضّر، وعلى مدى قرن عاصف من الزّمن. وكما هو الحال في التّصوّر التّوراتي لإسرائيل في العصر الحديديّ من قِبل مُؤلّفي البيْبل، فقد تكون هناك بعض الذّكريات القديمة جداً والحقيقيّة كذلك، متأصّلة في صلب ذلك البناء المكّيّ، على الرّغم من أنّه وفي عدم وجود تأكيد خارجي، لا يمكننا تحديدها في غالب الأحيان. لقد كان كتّاب السيرة العراقيّون على علم بحجاز المسلمين عن كثب، وقد قاموا بملء الفراغات إلى ما قبل الإسلام من خلال الذّكريات المنقولة التي حاولوا توثيقها، وتخيّلوا الماضي من خلال حضوره الغامض في خلفيّة القرآن. لا ينبغي رفض حدس المسلمين في العصور الوسطى في ما يتعلّق بما يكمن وراء شكاوى وأوامر ومحظورات القرآن الغامضة في كثير من الأحيان. ونحن نفعل الشّيء نفسه من خلال القياس: نستنتج ممّا نحكم عليه على أنّه حالات متوازية. وغالباً بالنتائج نفسها وبالدّرجة نفسها من اليقين.
[1] - مقتطف من كتاب "عيسى ومحمد" فرانسيس إدوارد بترز، ترجمة علي بن رجب، الصادر عن مؤسسة مؤمنون بلاحدود للنشر والتوزيع.