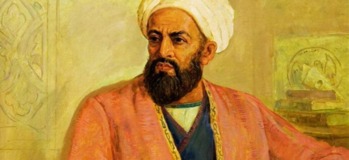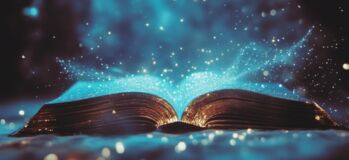ندوة فكرية بعنوان: قراءات ومراجعات نقدية لفكر حسام الدين درويش في كتابيه: "درويش بين القدر والمصير: في الفلسفة والثورة" "منمنمات فكرية وحوارية: في الفلسفة والحياة (اليومية) والقضية الفلسطينية"
فئة : حوارات

ندوة فكرية بعنوان:
قراءات ومراجعات نقدية لفكر حسام الدين درويش في كتابيه:
"درويش بين القدر والمصير: في الفلسفة والثورة"
"منمنمات فكرية وحوارية: في الفلسفة والحياة (اليومية) والقضية الفلسطينية"
تنظيم: المعهد العالمي للتجديد العربي ومؤسسة مؤمنون بلا حدود
"ليس الهدف من الفلسفة أن تقدّم أجوبة نهائية، بل أن تفتح بابًا للسؤال، وأن تقلق الطمأنينة الزائفة"
ذ. ريم الدندشي:
مساء الخير للجميع، وأهلاً وسهلاً بكم جميعًا. يسعدنا أن نرحب بكم في المعهد العالمي للتجديد العربي، وتحديدًا في فضاء وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية، حيث نستضيف اليوم هذه الندوة المتميزة ضمن برنامجنا الثقافي لشهر أيار/ مايو2025، تحت عنوان: "قراءات ومراجعات نقدية في فكر حسام الدين درويش"؛ وذلك من خلال كتابيه: "درويش بين القدر والمصير: في الفلسفة والثورة"، و"منمنمات فكرية وحوارية: في الفلسفة والقضية الفلسطينية".
لن أدخل في تفاصيل الندوة التي أتوقع أن تكون غنية وطويلة. وبداية، أودّ أن أرحّب بحرارة بجميع الحضور، سواء من داخل المعهد أو من خارجه، ضيوفًا وأصدقاء. وأرحب ترحيبًا خاصًّا بضيوفنا الكرام الذين يشاركوننا من خارج المعهد: الدكتور سهيل الحبيب من تونس؛ الأستاذ ماهر مسعود، الكاتب والباحث السوري؛ الدكتور وائل العظمة، الباحث السوري في الفكر الديني والفلسفة. كما أرحب بحرارة بأهل الدار، وأعمدة هذه الندوة: الدكتور حسام الدين درويش، صاحب الفكر الذي نتحاور حوله اليوم، وعرّاب هذه الحلقة؛ والدكتور قاسم المحبشي؛ الأكاديمي والشاعر والناقد الأدبي اليمني، والدكتور اللبناني خالد كموني، رئيس وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية، والمشارك في هذه الندوة، والدكتورة المغربية نزهة بوعزة، وهي باحثة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، ومهتمة بالفكر الإسلامي العربي.
وأخيرًا، يسعدني جدًّا أن أُسلم إدارة هذه الندوة إلى من نثق في حكمتها وحضورها المميز، الدكتورة ميادة كيالي. لكن كيف يمكن لنا أن نقدّم الدكتورة ميادة كيالي؟ فهي اسمٌ بارزٌ في الساحة الثقافية والمعرفية، وشخصية سورية مرموقة، وصاحبة خلفية أكاديمية ومهنية غنية. فهي تحمل شهادة الهندسة المدنية، في مفارقة جميلة بين التكوين العلمي والتوجه الفكري. وأسست مؤسسة "سراج" للأبحاث والدراسات، المعنية بتجديد الفكر الديني ومواجهة التطرف. ومنذ عام 2011، شاركت في تأسيس مؤسسة "مؤمنون بلا حدود" في المغرب، وأسست لاحقًا دار النشر التابعة لها في لبنان، ومن ثم فرعًا آخر في الشارقة. بهذا تكون الدكتورة ميادة قد لعبت دورًا محوريًّا في تأسيس وإدارة واحدة من أهم دور النشر في العالم العربي، لا سيما في مجال الفلسفة والعلوم الإنسانية والدراسات الدينية. تحمل درجة الماجستير والدكتوراه في تاريخ الأديان والحضارات القديمة من هولندا، وتمتد إنجازاتها من تأسيس المؤسسات الثقافية إلى إصدار ونشر كتب معرفية مهمة؛ فهي نقطة مضيئة في مسار العمل الثقافي والفكري، تسعى دائمًا لبناء جسور التفاهم وتعميق فهم الفكر العربي والإسلامي. وعلى الصعيد الشخصي، أودّ أن أقول: أنتِ مُلهمتنا يا دكتورة ميادة، وسعيدة جدًّا بوجودك معنا. المنصة لك، تفضلي.
د. ميادة كيالي:
مساء الخير، وكل الشكر لمن انضم مشاركًا معنا في هذه الندوة التي يسعدني أن تكون ثمرة تعاون بين وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي في لبنان، ومؤسسة مؤمنون بلا حدود. واسمحوا لي بداية أن أشكر وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي في لبنان، وعلى رأسها الدكتور خالد كموني والسيدة ريم الدندشي، على تنظيم هذه الندوة وإتاحة الفرصة لي، للمرة الثانية، بإدارتها. فقد كانت الأولى في ندوة حول كتاب "في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية: نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية" الصادر عن مؤمنون بلا حدود في بداية عام 2023. وهي تجربة ساهمت، بلا شك، في تشجيعي على خوض غمار تجربة مهمة، بعد أن فتح كل من معرضي تونس وأبو ظبي أفقًا جديدًا للحوار مع فكر الدكتور حسام الدين درويش، فبادرنا بالتنسيق معًا لإطلاق سلسلة من الحوارات الفلسفية والفكرية، التي تطورت لاحقًا إلى ما عُرف بـ"لقاء الجمعة"، وسجلنا حتى الآن ما يزيد عن العشرين حوارًا، قد تجد طريقها إلى كتاب من جزأين أو أكثر.
وقبل المضي بالحديث عن هذه الندوة، أشير إلى أنَّ "وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي" تهتم بقضايا الفلسفة والتجديد، وكذلك بالتجدد الفلسفي الذي ينبثق عن التفكر في قضايا الراهن، والانشغال بالمبحث التأويلي الذي تراه قابلًا لأن يُبقي باب النظر مفتوحًا إلى معطيات الواقع، من خلال الجمع بين إمكانات اللغة الدلالية وإمكانات الفكر المساوق لإشكالات الحدث. لذا تلتزم الوحدة في نشاطها مواكبة كل حدث يمكن أن يطرأ في مجتمعاتنا، وتحاول تظهير التفسيرات والتأويلات والفهوم المتنوعة من خلال الندوات التي تقيمها، وكذلك عبر الأعمال المنشورة التي تعالج هذه الإشكاليات وتوثق إنتاج الفلسفة ضمن نشاط المعهد.
هذا باختصار ما يتعلق بوحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية. وأما عن لقائنا، فدعوني أقول إننا نلتقي اليوم ليس فقط كقرّاء أو نقّاد، بل كأصدقاء للفكر ومتحاورين مع صاحب الفكر، لمناقشة إصدارين جديدين للدكتور حسام الدين درويش، وهما:
- "درويش بين القدر والمصير"، وهو ثاني ثلاثة إصداراتٍ صدرت عن مؤمنون بلا حدود.
- "منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة اليومية والقضية الفلسطينية"، الصادر عن مؤسسة ميسلون.
في الكتاب الأول، يقارب درويش موضوعات الاعتراف والقدر والمصير برؤية نقدية، من داخل الحقول المعرفية الغربية التي يُحسن أدواتها، ومن موقع ذاتٍ سوريّةٍ مجروحةٍ تنظر إلى نفسها والعالم من خلال منظار مزدوج: فلسفي وإنساني. وقد كتب يقول: إنَّ التفكير في مسألة القدر والمصير هو تفكيرٌ في شروط إمكان الإنسان وسقوطه في آنٍ معًا".
أما في الكتاب الثاني، فنقترب أكثر من صوته الحواري الداخلي، في "منمنماته"، التي اختار لها عنوانًا يوحي بالبساطة، لكنه يخفي وراءه كثافة فكرية وتأملية نادرة، تمتد من قضايا الحياة اليومية وصولًا إلى مأساة فلسطين. نقرأ له: "لم يعد سهلًا الفصل بين الفلسفة والقضية الفلسطينية، حيث اندفع فلاسفة العالم للتعبير عن مواقفهم الأخلاقية والسياسية، وأصبحت فلسطين جزءًا من حياتنا اليومية".
نحن اعتدنا على الدكتور حسام محاورًا بارعًا يملك مفاتيح الحوار وأدواته، يصنع من أيّ لقاء مساحةً لنقاشٍ عميق ومفتوح. واليوم تُعكَس الأدوار قليلاً: أنتم تحاورونه، تتبادلون معه الأفكار، وتتفاكرون معه على طريقته. ولا أشك أن ما سنسمعه الليلة سيكون أكثر جرأةً وعمقًا؛ لأن شروط الكتابة التي عايشها العام الماضي قد تغيرت، والظروف تجاوزت النصوص.
وأنا، كناشرةٍ لأحد هذين الكتابين - أو لجزءٍ من هذه الرحلة على الأقل - أعيش لحظةً فريدة من خلال أن أكون في موقع من يتأمّل ويترأس نقاشًا حول فكر كنتُ شاهدةً على ولادته، وناشرةً لجسده الورقي، ومستمعةً الآن إلى روحه، وهي تُقرأ وتُناقش وتُختبر. فمرحبًا بكم جميعًا في هذه الندوة التي نتمنى أن تكون على قدر عمق الأسئلة التي يثيرها فكر الدكتور حسام، وعلى قدر التحديات التي يضعها أمامنا. وقبل أن نبدأ بالاستماع إلى القراءات، نودّ أن نقدم لمحة عن الدكتور حسام، الذي أصبح معروفًا للجميع دون حاجة إلى تعريف.
الدكتور حسام كاتبٌ وباحثٌ ومحاضرٌ في عددٍ من الجامعات الألمانية. حاصلٌ على الدكتوراه في الفلسفة، اختصاص الهيرمينوطيقا، بدرجة مشرٍّف جدًّا مع تهنئة من لجنة التحكيم (أعلى درجةٍ ممكنةٍ)، من جامعة بوردو 3 في فرنسا. تتناول كتاباته مواضيع تتعلق بالفلسفة والفكر العربي والدراسات الإسلامية والدراسات الثقافية. صدر له العديد من الكتب – عشرة كتبٍ باللغة العربية، وثلاثة كتبٍ باللغة الفرنسية – إضافة إلى عشرات الدراسات المحكّمة والترجمات، باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية، ومن أبرزها:
- "في المفاهيم المعيارية الكثيفة: العلمانية، الإسلام (السياسي)، تجديد الخطاب الديني"؛
- "في فلسفة الاعتراف وسياسة الهوية: نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية"؛
- "درويش بين القدر والمصير: في الفلسفة والثورة"؛
- "منمنمات فكرية وحوارية: في الفلسفة والحياة (اليومية) والقضية الفلسطينية".
- وآخر ما صدر له هو كتاب "جدل التأويل بين الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكور"، الصادر عن مؤمنون بلا حدود في أبريل الماضي 2025.
والآن نبدأ القسم الأول من الندوة، المخصص لقراءة ومراجعة كتاب "درويش بين القدر والمصير: في الفلسفة والثورة". ويتألف الكتاب من مقدمة وأربعة فصول، ناقش فيها الدكتور حسام الدين درويش مفاهيم القدر والمصير من منظور فلسفي ووجودي، وانفتح من خلالها على مفاهيم الاعتراف، والتجربة السورية، والسياسة، والديمقراطية، والعلمانية، والإسلام السياسي. كما مزج بين تحليل المفاهيم ونقدها، وبين مساءلة الذات والواقع، مستندًا إلى مرجعية فلسفية عميقة، دون أن يبتعد عن موقعه ككاتب سوري معنيّ بثقل التجربة ومعناها.
يشاركنا النقاش في هذا القسم، ثلاثة باحثين مرموقين، سيستهلون الندوة بمداخلاتهم القيّمة. ومسك البداية د. نزهة بوعزة، وهي باحثة في الفلسفة الحديثة والمعاصرة، مهتمة بالفكر الإسلامي العربي. لها العديد من الأبحاث والدراسات المحكمة في عدد من المراكز. صدر لها كتابان في الفلسفة السياسية: "الدين، الدولة، فلسطين" و"جذور العنصرية الغربية: قراءة في نمذجة التاريخ الغربي"، وهي كاتبة رأي في عدد من المنصات.
د. نزهة بوعزة: قراءة في كتاب: "درويش بين القدر والمصير في الفلسفة والثورة"
يبدو عنوان "درويش بين القدر والمصير: في الفلسفة والثورة" مثيرًا نوعًا ما، فهو يجمع بين ما يشكل في أذهاننا، للوهلة الأولى، تناقضًا أو على الأقل صعوبة في التسليم بالجمع بين مفهومي القدر والمصير، بين القدر الدنيوي والمصير البشري. غير أن هذه التوليفة كان لها حظ وفير في تشكيل هوية الكتاب، الذي ظل يتأرجح فوق أرضية الاحتمال أكثر من ترسيخ توجه يقيني أو مسار يجنّب، على الأقل، إعادة استشكال ما تم تناوله، مما وفر إمكانية لإعادة بلورة إشكالاتنا الفلسفية والسياسية العربية بصورة يصعب طرحها في قالب جاهز أو مسلم به.
فالكتاب في الحقيقة اكتسب طابعًا فلسفيًّا بامتياز، ولم يمنحنا طمأنينة الجواب. وقد يكون تقديم الكاتب محمد ديبو لماهية الكتاب عبر مصطلحي «الاختلاف» و«المودة» هو ذات ماهية الكاتب نفسه، الذي ينهج طريق المودة لترسيخ الاختلاف، أو العكس. فالحوار المبني على الاعتراف بالاختلاف قد يؤسس لعلاقات إنسانية تنحو نحو المودة، أكثر رحابة وإنسانية، وهو ما أكّدته التجربة الفكرية والإنسانية التي جمعت بين مقدم الكتاب وصاحبه، وما انعكس، بالتالي، على طبيعة الأسئلة وعمقها، وكذلك على رحابة وانفتاح الكاتب وتلقائيته في الأجوبة. فالكتاب يقف على مشارف معرفة الآخر ورصد مجرى الأفكار، ما بين الأمس واليوم، في قالب حواري بناء.
إن تقديم قراءة نقدية لأيّ كتاب هو مهمة ليست بالهينة. فإذا كان مقدم الكتاب، محمد ديبو، قد غلب عليه جانب المودة كنتاج لقبول الاختلاف، فإننا نجد أنفسنا أمام جوٍّ مغناطيسي يغلب عليه الترحاب بالاختلاف، لدرجة جعله بابًا من أبواب تشكّل المودة والحب؛ مما يؤثر، بشكل ما، على رؤيتنا النقدية. غير أن صاحب الكتاب يؤكد على ضرورة النقد، وهنا لا نثير المفهوم في إطار ما يُشاع عادة ويُحصر في الجانب السلبي؛ لأن جوهر النقد هو الاختلاف، والاختلاف هو ما يؤسس للحوار، وعبر الحوار نجدد تصوراتنا. فصاحب الكتاب من دعاة النقد الذي لا يستثني حتى الذات أمام ذاتها (النقد الذاتي)، أو على طريقة بول ريكور التي يحاكيها صاحب الكتاب، القائمة على مشروعية العملية النقدية وحدود هذه المشروعية؛ أي عملية التوفيق أو التوليف بين النقد ونقد النقد، أو رسم حدوده.
يتألف الكتاب من 332 صفحة، موزعة على ثلاثة أجزاء، ويبدأ بتقديم من تأليف محمد ديبو. كما يختتم بملحق في نهاية الكتاب يحتوي على قصص شخصية تعكس علاقة الذات بالنظام السياسي السوري وتوجهها الفلسفي.
*- الجزء الأول: حول الفلسفة وشؤونها وشجونها
يمكن القول إن هذا الجزء شمل السيرة الذاتية لدرويش في مراحلها الأولى، وصولًا إلى ما هو عليه الآن. فهذا الجزء لا يعني أنه كان ذا طابع شخصي بقدر ما كان يحاول أن يقيم خيطًا ناظمًا للتأصيل النظري للوعي التأملي للكاتب في ارتباطه بمحيط عائلته، وعادات المجتمع، وطبيعة النظام السياسي المتوغّل في بنيات الأشخاص ومصائرهم.
تُذكرنا هذه السيرة بالفلسفة الوجودية لسارتر؛ فالإنسان هو مشروع وجودي، وهنا لا نقول: "الخلق من عدم"، بقدر ما يتعلق الأمر بالإرادة والرغبة في المعرفة التي وُجدت بالقوة، فما احتاجت سوى للفعل لتتبلور. كأننا أمام توليفة بين كارل ماركس وبول سارتر، وقد تكون هذه التوليفة التي تبدو متعاكسة هي ما يعكس توجه فكر الكاتب: خلق توالف بين ما يبدو، عن وعي أو بغيابه، متناقضًا حدّ التطرف: الدين/ العلمانية، الإسلام السياسي/ العلمانية، الإسلام السياسي/ الديمقراطية، الليبرالية/ الإسلام السياسي، وهكذا.
لقد حاول الكاتب من خلال هذا الحوار أن يُطلّ على ذاته، تلك الذات التي يختلط في تكوينها البُعد الشخصي والمعرفي، منذ بداياتها إلى لحظتها الآنية. فهذه الإعادة لا تتوانى عن سرد تمحورات الوعي الداخلي والخارجي. إنه الوعي الذي يعبر، بشكل ما، عن مسيرتنا العربية؛ إذ نجد أنفسنا أمام انعكاس للقدر باتجاه رسم مصير يصعب التنبؤ بسقفه أو بما سيمثله حاضره، لكنه، في المقابل، يتحرر من حتميات القدر بمعناه الدنيوي.
يشمل الحوار المتضمَّن في الكتاب أهم مراحل تشكّل وعي صاحب الكتاب، وأبرز الأحداث الشخصية التي تُشكّل في جوهرها أحداثًا اجتماعية وسياسية وطنية. فإدراج أمثلة من الواقع السوري، الذي تختلط فيه كل التناقضات المجتمعية - من صورة ومكانة المرأة (الأم، الأخت...)، إلى الوعي الديني والواقع المعيشي، والفساد المجتمعي، والإداري، والأكاديمي، ثم التدين المجتمعي الذي تكرّسه الطقوس وأخلاقيات التدين على أرض الواقع - كل ذلك أثار عدة مفاهيم مهمة مثل: الموت، الزواج، الطلاق، العمل، الفساد، الأخلاق، السلطة، الشر الطبيعي، الشر الأخلاقي، والدين.
الأساس المتفق عليه، في فحوى الكتاب، هو تجلّي الغموض المفهومي الذي يطبع البناء المعرفي العربي، والذي غالبًا ما يتسم بالحشو الإيديولوجي، عن وعي أو من دونه؛ أي يتم تغليب الجانب المعياري على الجانب المعرفي، حيث تظل الغايات الإيديولوجية للصرح المعرفي كامنة بشكل ضمني، دون التصريح بها أو البناء الصريح عليها؛ وذلك لأن الجانب الإيديولوجي يحمل صبغة سلبية كثيفة جعلت المفهوم مذمومًا معرفيًّا، رغم ضرورة حضوره. ومن ثم، يستغرق الفكر العربي النخبوي فيما ينبغي أن يكون، هربًا مما هو كائن، رغم أن "الكائن" هو ما يستدعي الفحص والدراسة والفهم بوضوح، حتى نتمكن من رسم ما سيكون. وهذا ما يجعلنا أمام مبحث "المفاهيم المعيارية الكثيفة"، وهو مبحث حديث نسبيًا، مثل مفاهيم: الديمقراطية، العلمانية، الليبرالية...
*- الجزء الثاني: حول الربيع العربي والثورة السورية
خُصِّص هذا الجزء لإعادة موضعة الربيع العربي ومآلاته في المنطقة العربية، وسوريا تحديدًا، وهي موضعة تتطلب قراءة نقدية جريئة، تأخذ مسافة معينة من الحدث الثوري بشكل شامل ودقيق، خصوصًا وأن إثارة موضوع الربيع العربي ومآلاته تستحضر، في المقابل، تلك الفجوة القائمة بين الثورة الشعبية والثورة الفكرية، وكيف أن إحداهما لا تؤسس بالضرورة للأخرى في السياق العربي.
من هنا، قدّم الكاتب رصدًا لأهم منجزات الفكر العربي في هذا الخصوص، ما أتاح فرصة لتعميق التحليل الفلسفي والمفاهيمي لعدة مفاهيم محورية، مثل: الحرية عند ماهر مسعود، الثورة عند عزمي بشارة، فلسفة الثورات عند سلمان بن نعمان، الثورة المستحيلة عند ياسين الحاج، وتجليات الثقافي في الربيع العربي عند كمال عبد اللطيف، إلى جانب تحليلات صالح هشام للاستقطابات الإيديولوجية بين العلمانية والإسلاموية.
ومن هذا المنطلق، لا يمكن الجزم بغياب مسافة تنظيرية للثورة، بل قد تكون تلك المسافة أشبه بما يمثله طائر المنيرفا عند هيجل. لذلك، نشأ مناخٌ ثريٌّ لتحليل فلسفي وتفكيك مفاهيمي لمجمل آليات الفعل السياسي، انطلاقًا من شعار "السلمية" وصولًا إلى طبيعة الفعل السياسي. فالسلمية والعسكرة خياران يرتبطان بالسياق السياسي وطبيعة النظام، وهو ما يثير مفهوم الديمقراطية، لا بوصفها خطابًا قيميًّا ذا شحنة إيجابية، بل بوصفها ضرورة بنيوية ترتبط بالبنية الفوقية.
لقد خُصّص هذا الجزء لتفكيك مسار الثورة السورية، وكيف انتهت إلى العسكرة والمواجهة المباشرة مع النظام، حيث لعب الداخل والخارج - بالنسبة إلى النظام والثوار على حدّ سواء - دورًا مهمًّا في رسم مسارها خارج إرادة السوريين. وهكذا تحوّلت الثورة التي حملها الربيع العربي إلى ثورة تحرّر وتنفيس سيكولوجي أكثر منها حركة نحو بناء مجتمع ديمقراطي واضح المعالم. وعلى الرغم من ذلك، فقد أحدثت الثورات العربية تغييرًا في مضمون مفهوم "الثورة" ذاته؛ إذ إن مفاهيم مثل: الثورة، الانقلاب، التغيير الجذري، العسكرة، الإسلام السياسي، إسقاط النظام ... كلّها مصطلحات فقدت، إلى حد بعيد، دلالتها الإيجابية، وصارت تميل - بمعنى ما - إلى شحنة سلبية.
*- الجزء الثالث: حول الديمقراطية والعلمانية والاسلام السياسي
تتعلق الرؤية التي تتحكم في هذا الجزء بمسألة التعاطي مع عملية المفهمة؛ أي الرؤية التي تجمع بين التوجه الوصفي أو التحليلي لما هو قائم، والتوجه الإيديولوجي المعياري لما ينبغي أن تكون عليه الأمور. فالمعرفة دون إيديولوجيا عمياء، والإيديولوجيا دون معرفة أيضًا عمياء. ولهذا تُبيَّأ أغلب المفاهيم المؤسسة للمناخ السياسي إيديولوجيًا، وقد يُغلَّب البعد الإيديولوجي على البعد المعرفي، مما يؤدي إلى إفقار هذا الأخير.
ويعكس هذا التوجه عددًا من المفاهيم المؤسسة للفعل السياسي؛ فمفهوم الديمقراطية ظل حبيس التوجهات الإيديولوجية اليسارية والقومية والإسلامية، دون أن يُفضي هذا الحضور المفهومي، في السياق العربي، إلى تتويج ديمقراطي فعلي. لذلك بقي المفهوم، حتى في كتابات النخبة، أسير الرؤية المتطرفة أو البراغماتية، التي تخدم التوجه الإيديولوجي على حساب التوجه المعرفي. لقد تم إفراغ المفهوم من مضمونه أو تم التركيز والرفع من شأن عنصر معين فيه على حساب تهميش باقي العناصر. ولهذا، لم يحقق الواقع العربي صيرورة تراكمية في ما يخص بناء الديمقراطية، تحت ذرائع متعددة، أغلبها لم يتحقق؛ إذ يتم فصل مكونات الديمقراطية، فنصير أمام ديمقراطية انتقائية، مع أن مفاهيم مثل الليبرالية، والفردانية، والعلمانية، لا تُحيل على تعريف ثابت، بقدر ما تعكس وتُعبّر أساسًا عن سياق انبثاقها وكيفيات تبيئتها. وهذا ما يجعلنا أمام مقاربة معرفية للفعل السياسي العربي، تُشكّل، في المجمل، إطارًا مفهوميًّا أجوف، سواء تعلق الأمر بالديمقراطية، أو الليبرالية، أو العلمانية، أو النظام السياسي، أو الإسلام السياسي.
إن الإشكال الديمقراطي أو الممارسات اللاديمقراطية لا تقتصر على الدول العربية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى الدول التي تُعدّ نموذجية في هذا المجال. وقد تجلّى ذلك بوضوح بعد السابع من أكتوبر، في كيفية تعاطي الغرب مع ردود أفعال المهاجرين فوق أراضيه. فالسمة اللاديمقراطية تنخر كذلك في البُنى السياسية الغربية.
وقد اختُتم الكتاب بملحق يحمل عنوان "سرديات (ذاتية–موضوعية) سورية"، خُصِّص لذكريات مرتبطة بالوطن، سوريا، حيث حاول صاحبها أن ينقل لنا صورة حيّة عن الوضع السوري في ظل الحكم العسكري، والطريق نحو الفلسفة الذي بدأ بعد انقطاع دام سنوات عن الدراسة.
إن أهم ما يمكن استخلاصه من قراءة الكتاب، يأتي كالآتي:
- في السيرة الذاتية، نقف غالبًا على أرضية تمثل مستقبل ماضينا، أو ما كان أملنا في الماضي. فننطلق نحو هذا الماضي من موقع تحقق فيه طموحنا، أو ما لم يكن متوقعًا أن يتحقق. ونعيد ترتيب الأحداث الماضية وفق آلية تُضفي على كل حدث قيمة ودورًا في تأثيث الحاضر. ومن هنا تنشأ تبريرات تُرسم من خلالها صورة لواقع يتجاوز الماضي. فرغم وجاهة ومنطقية هذه التبريرات، إلا أنها قد تسلب الأحداث شحنتها الدلالية، أو تُغلفها بستار من التفسيرات التي تُمكّننا من تقبّلها والتعايش معها.
- ما نعاينه مع درويش في هذا الكتاب، هو انخراطنا معه في تتبّع أولى خطوات تشكّل الذات، وصولًا إلى تأمل مسار هذه الصيرورة ومآلاتها. وربما لو عكسنا الاتجاه، وانطلقنا من الحاضر إلى الماضي، لما أُعطي الحاضر ما يستحقه من التثمين والاعتبار الذي يليق بمكانة الكاتب. ولذلك، فإن الانطلاق من الماضي نحو الحاضر يحمل ميزة خاصة، تتمثل في رصد عملية البناء وهي قيد التشكل، وصولًا إلى لحظة راهنة تتوج هذا المسار وتكافئه بقيمة اعتبارية. ومن هنا، يتخذ الكتاب مسارًا يقود إلى تقييم عطاء الكاتب بشحنة إيجابية.
- تغلب القراءة القطبية على معظم المفاهيم التي تناولها الكاتب؛ إذ يؤسس فهمه على رصد قطبية متطرفة تُميز أنماط تفكيرنا السياسي العربي. وهذه القطبية، الناتجة - بمعنى من المعاني -عن هيمنة المقاربة المعيارية، بل وتشكل في ذاتها تجلّيًا لها، تُقدَّم بديلًا عن مقاربة توازن بين المعياري والمعرفي.
- لقد غلب على الكتاب استحضار مختلف الرؤى، بشكل يجعلها تحت أعين نقدية تُسائل الجزء والكل، وتُبرز محدوديتها وتطرفها، وبالتالي عدم جدواها وعجزها عن تجاوز الوضع العربي القائم. وقد وعدنا الكاتب بالتوجه نحو مسار بنائي، يقوم بالضرورة على الحوار واستحضار الآخر، في مناسبات وآمال لاحقة. غير أن هذه الرؤية الشمولية، القادرة على الهدم وإعادة البناء، تطرح بدورها سؤالًا جوهريًّا مفاده: أليست هي أيضًا خاضعة لتوجّه إيديولوجي مسبق؟ توجه يسعى، من خلال النقد الهدّام، إلى تهيئة الأرضية لبناء بديل، فيُحمّل التصورات السابقة شحنة سلبية، ويُضفي على البديل طابعًا إيجابيًا؟-
تهيمن القراءة البَعدية على تحليل مسارات الثورة والواقع السياسي العربي، بما في ذلك الربيع العربي، في هذا الكتاب. وهي قراءة ترصد النواقص والمطبات، كما تستشرف المآلات. لكن، هل تمنحنا هذه القراءة البَعدية للواقع العربي أفقًا حقيقيًا للاستفادة مستقبلًا؟ وهل القول بنعم يعني أن التاريخ السياسي العربي يعيد نفسه؟ خصوصًا وأن الكاتب تنبّأ بأن سوريا ستثور بعد ثلاثة عقود، على غرار تجارب ماضية مشابهة.
د. ميادة كيالي:
شكرًا جزيلاً لك د. نزهة على هذه القراءة المركّزة والعميقة، التي شملت جميع فصول الكتاب، وشكّلت بذلك تقديمًا مهمًّا له. وننتقل الآن إلى د. وائل العظمة، وهو طبيب بشري حاصل على ماجستير في الأدب الإنجليزي من جامعة دايتون، وماجستير في الإلهيات من جامعة شيكاغو. تفرغ مبكرًا للبحث الأكاديمي والكتابة في مجالات متعددة، من بينها الفكر النقدي والفلسفة.
د. وائل العظمة:
كان سقراط يمارس الفلسفة، وهو يتجوّل في أسواق أثينا، باحثًا عن الحقيقة. وكان مولعًا بسؤال محاوره مرة تلو أخرى، حتى يدفعه إلى الشك في فهمه لمسألة ما، ويضطر لإعادة التفكير فيها بحثًا عن جواب أكثر معقولية. والنتيجة أن فهم السائل والمسؤول معًا يصبح أكثر عمقًا وجدّة من خلال هذا الحوار.
كان سقراط يشبّه نفسه بالقابلة التي تُساعد الأم على إخراج المولود إلى العالم؛ وهكذا، كان يساعد الآخرين على استخراج أفكارهم بأنفسهم. لقد درّب الناس في السوق على التفكير الذاتي دون حاجة إلى التلقين في قاعات هادئة، معزولة عن تيار الحياة اليومية.
أرى في ما قرأته في كتاب "درويش بين القدر والمصير" ما يُذكّرني بسقراط في معمعة السوق. فقد اضطر حسام الدين درويش إلى ترك الدراسة في الصف العاشر ليعمل نجارًا، كي يكسب قوته اليومي، بعد مقتل والده في حلب في ظروف غامضة. لقد مارس مهنة النجارة، ثم البيع على بسطات بسيطة على أرصفة حلب ودمشق، كما عمل في بيع الخضار ولفافات التبغ والموز المُهرّب.
وبعد سبع سنوات من الانقطاع عن الدراسة، تقدّم كطالب حرٍّ لامتحان الثانوية العامة السورية – الفرع الأدبي، دون أن يكون منتسبًا إلى أي مدرسة، ونجح بتفوق، حائزًا المرتبة الأولى بين الطلاب الأحرار في حلب. وقد كان بإمكانه دراسة أيّ فرع أدبي في الجامعة، لكنه اختار الفلسفة، رغم اعتراض الأهل وزملائه من النجارين الذين لم يفهموا لماذا يختار أحدٌ أن يعيش على دخل التدريس، الذي لا يعادل سوى ثلث دخل النجارة.
كان حسام الدين درويش يرى في الشك وسيلةً لبلوغ معرفة أعمق وأكثر توازنًا من أيّ فلسفة أخرى. وقد لاحظت، في أول لقاء معه، حرصًا شديدًا على إضافة وجهة نظر واحدة على الأقل تُخالف الرأي الذي يتبناه هو نفسه في أي موضوع يتطرق إليه، كي يبقى الديالكتيك حيًّا، نابضًا، ومفتوحًا على احتمالين مختلفين على الأقل.
وقد لفت انتباهي أسلوب المنمنمات في كتابه "منمنمات فكرية وحوارية"، حيث يجد القارئ في كل منمنمة نقاشًا حول موضوع يتعلق بالحياة اليومية، مطروحًا في ما لا يتجاوز متوسط ثلاث صفحات، في توازن محكم بين الفكر الفلسفي العميق والبساطة العملية للفعل الإنساني اليومي.
يروي حسام الدين درويش حكاية بسيطة في البداية تطرح الإشكال الفلسفي الذي ينوي مناقشته، مثل عادة بعض الناس السيئة في الاستعاضة عن التفكير باقتفاء حكم جاهز مسبق دون تدبر، أو الاستعجال في استدعاء نمطية غير مبررة لتفسير سلوك شخص آخر دون تمعّن؛ كاستنتاج أن الألماني الذي قال إنه لا يتكلم الإنجليزية يكذب لإخفاء عنصرية ألمانية. أو توضيح عدم صواب تحويل الخطأ إلى خطيئة تشل القدرة الإيجابية على التعلم والتجاوز، وتحويلها بدلاً من ذلك إلى ممارسة أخلاقية أفضل.
عندما قرأت المنمنمات، شعرت بروح سقراط الذي هجر قاعات المحاضرات والغرف المغلقة، ليتجوّل في أسواق أثينا، كما تجوّل حسام الدين درويش على أرصفة حلب ودمشق بائعًا ومتأملاً؛ عين قلقة تترقب حضور دورية الشرطة الفاسدة التي تهدد رزقه، وأخرى تحرس رأس ماله البسيط، بينما ينخرط فكره في حوار عميق مع سقراط، وأفلاطون، وديكارت، وكانط.
أرجو أن نقرأ المزيد من المنمنمات في المستقبل القريب. أقول هذا كقارئ أمضى جلّ حياته طبيب قلب، يمشي يوميًّا لساعات طويلة في ردهات المشافي، كما مشى سقراط في شوارع أثينا، وحسام الدين درويش في شوارع حلب ودمشق، باحثًا عن الحقيقة الخجولة في صدر كل من المرضى، ليتعلم الطبيب والمريض معًا، ليس عن المرض فحسب، بل عن أحلام الحياة الإنسانية وطموحاتها النبيلة.
يتعلم الطبيب من مرضاه كيف يواجهون الموت والخطر، حيث تظهر قوة الإنسان وعظمته، وهو في أضعف لحظاته أحيانًا، كما تظهر ضعفه ومحدوديته أحيانًا أخرى. ففي الإنسان تجتمع التناقضات، الكوميديا والتراجيديا الإغريقية. تسكت الكلمات، وتتحول الفلسفة والتدين إلى لحظات صمت أخيرة، أبلغ من الكلمات، في حياة شارفت على الانتهاء.
ولعل ما شدّني إلى مقاربة حسام الدين درويش بشكل عام، والمنمنمات بشكل خاص، هو التصاق جذور فكره بالحياة اليومية التي تتجلّى في ثمار حواره الفلسفي. فرحلة البحث عن الحقيقة من خلال التأمل الفلسفي تجمعنا جميعًا، وتميزنا عن أقرب الكائنات الحية إلينا من الناحية البيولوجية.
يقول حسام الدين درويش في كتابه "درويش بين القدر والمصير"، إننا نرتكب ثلاثة أخطاء قاتلة عندما نمارس النقد: أولاً، ننسى موقعنا داخل الظاهرة المنتقدة؛ ثم ننتقي انتقاداتنا، حيث نحمي أنفسنا (فلا يقول أحد إن زيته عكر)، وأخيرًا ننتقد عدم تقبل الآخرين للنقد، بينما نرفض قبول نقدهم لنا في سياقات أخرى. ويوصي حسام الدين درويش بالاستفادة من نقدنا للآخرين لنقد أنفسنا.
ولعل غياب التفكير النقدي يتعدى الممارسة الشخصية إلى كليات الفلسفة في الجامعة، كما يقول، حيث ننتهي بدراسة تاريخ الفلسفة بدلاً من ممارسة الفلسفة كنقاش حي مفتوح ينبع من عقول الطلاب الشابة. ويذكرني هذا بأحد الأسلحة الكلامية الفتاكة التي يسمعها الإنسان باستمرار في الكثير من برامج الحوار التلفزيونية العربية: "لا أسمح لك المساس بالرموز!"، وما أكثر الرموز في كل مجالات الحياة عندنا، وخاصة "القائد الرمز!" ويتناسى كثيرون القول الذي تناقله علماء الكلام المسلمين الأوائل: "لولا الشك ما كان اليقين"؛ أي إن الشك كانت له وظيفة محورية عند مؤسسي علوم العقيدة الإسلامية، قبل أن يُسدل الستار على حيوية الأمة الفكرية والدينية والفلسفية.
يقول حسام الدين درويش إن الفلسفة لا تقدم حلولًا للمشاكل العملية، وأن العلم هو من يقوم بهذه الوظيفة، كما أن الفلسفة لا تمنح معرفة يقينية كما يفعل الدين. أما أنا، فأرى أن العقل الإنساني، في اعتقادي، هو كيان واحد لا يتجزأ، ولا يمكن الفصل التام بين الفلسفة والدين والعلم التطبيقي الذي ينتجه وينتج تأويلاته العقل الإنساني الواحد.
وسأبدأ بالدين؛ إذ أرى أن الدين يقوم على التفكير العقلاني الذي يهيئ للـ"قفزة الإيمانية"- وهو تعبير أستعيره من الفيلسوف كيركغارد:" a leap of faith"؛ فالإيمان حالة وجدانية تنطلق من المرحلة العقلية الأولى نحو فضاءات تتجاوز حدود العقل ومحدودية الواقع المحسوس. وبذلك، فإن المعرفة الدينية هي في جوهرها معرفة عقلية، مما يجعلها بطبيعتها معرفة غير يقينية، نظراً لمحدودية العقل الإنساني. أما الإيمان، فهو الذي يتيح إمكانية اليقين المطلق من خلال طبيعته الوجدانية التي تتجاوز العقل. وهذه آلية يمارسها الناس جميعًا في حياتهم اليومية، حتى غير المتدينين. ويمكن التفكير في أمثلة عديدة على ذلك، مثل شعورنا بالثقة المطلقة في صديق عزيز، أو حبّ الإنسان لزوجته، أو ثقته ببناته وأبنائه.
ويروي لنا القرآن قصة إبراهيم عليه السلام، الذي لم يكن يشك في إيمانه- فهو كان يخاطب الله ويحاوره مباشرة- ولكنه مع ذلك كان يسعى إلى سدّ فجوة في معرفته العقلية، قال إبراهيم: "ربِّ أرِني كيف تُحيي الموتى"، قال: "أولم تؤمن؟" قال: "بلى، ولكن ليطمئن قلبي". والقلب هنا يُشير إلى العقل، كما يُشير إلى مركز الروح والوجدان. فالمعرفة الدينية تظل ناقصة في عالم الشهادة بحكم محدوديته، ولا يُزال الحجاب عنها إلا بعد الموت، كما يرد في القرآن: "لقد كنتَ في غفلةٍ من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد".
ولعل استحالة الوصول إلى اليقين العقلي البحت تفسّر المكانة الرفيعة التي يمنحها القرآن للمؤمنين الذين تمكنوا من تحقيق "نقلة كيركغارد" والانفتاح على عالم الغيب؛ ذلك العالم الذي يستحيل فهمه أو الإحاطة به بالطريقة نفسها التي يُفهم بها عالم الشهادة في حياتنا اليومية. وليس في هذا نفيٌ لأهمية السعي نحو اليقين العقلي في الدنيا، بل هو إدراك لضرورة تجاوز محدودية العقل، حتى تتمكن الروح من الانطلاق حرة طليقة في دروب الحياة.
فعلم الغيب يقين، نعم، لكنه يقينٌ لا يقوم على المعرفة أو الفهم التفصيلي، بل على إشارات وعناوين ورموز، لأنه ينتمي إلى عالم مغاير تمامًا لعالمنا. وحتى إن أطلقنا عليه اسم "علم"، فسيكون علمًا مختلفًا جذريًا عمّا اعتدنا عليه في هذه الدنيا.
لا أرى أن الفلسفة كانت دخيلة على العرب والمسلمين، أو على الأقل لا أرى أنها بقيت كذلك بعد القرن الأول الهجري، إلا في القرون الأخيرة لدى عامة الناس. فقد هضم الغزالي الفلسفة وحاول نقدها بأسلوب فلسفي، بينما قال ابن تيمية بقدم العالم بعد نحو 250 عامًا من الغزالي، رغم أن الغزالي نفسه قد كفّر من قال بذلك. أما ابن عربي، فإن كتابه "الفتوحات المكية"، يكشف عن عقل فلسفي من الطراز الأول، رغم انتقاده السطحي أحيانًا للفلاسفة. ولا شك أن كتب العقيدة الإسلامية والتصوف مدينة، في بعض مناهجها ومصطلحاتها، لابن سينا والفارابي.
أحبّ أن أُعلّق على الفرق بين الفلسفة والعلم. ينطلق حسام الدين درويش من مقولة هايدغر: "العلم لا يفكر"؛ أي إن العلم لا يستطيع أن يقدم رؤية كلية للإنسان والعالم؛ لأنه يقوم على أسس المعارف والحقائق الجزئية. وأرى في هذه المقولة شيئًا من المبالغة؛ لأنها ترسم حدودًا متخيّلة بين العلم والفلسفة. فالفلسفة هي أمّ المعارف الإنسانية، وصحيح أن حقول المعرفة قد توسعت في عصر الحداثة، وأصبح من الصعب الإلمام بها جميعًا كما كان الحال في العصور الوسطى، إلا أن الإنسان واحد، وعقله واحد، وبصمات العقل الإنساني الجمعي لا تخطئها عين.
ولم يتوقف التفاعل والتلاقح بين هذه الفروع يومًا؛ فالدراسات في علم الإنسان (الأنثروبولوجيا)، على سبيل المثال، تستفيد من الطب، ومن الفيزياء، بل ومن تقنيات كالنظائر المشعة. كما أن النظرية النسبية لأينشتاين، والفيزياء الكوانتية، قد أثّرتا بعمق في الفلسفة واللاهوت المعاصرين. وقد تمأسست هذه المقاربة فيما يُعرف اليوم ب"المقاربة متعددة الاختصاصات" (Multi-disciplinary) وهي مقاربة نجدها في معظم حقول المعرفة العلمية والفلسفية، بل إنها وجدت طريقها حتى إلى المجامع الفقهية الإسلامية في الغرب. فما تفرّق مؤقتًا، عاد واجتمع، بعد أن أصبح الإلمام بجميع هذه المعارف مستحيلاً على شخص واحد. وحتى يتمكّن العاملون في هذه الحقول من التعاون، لا بد لهم من بناء فهم مبدئي للحقول الأخرى: فالفيلسوف مطّلع على مجالات العلم التي يتفاعل معها، وكذلك العلماء لديهم إلمام أولي بأساليب التحليل الفلسفي.
والواقع أن العالِم لا يمكنه العمل دون رؤية فلسفية في مجاله، تسمح له بطرح فرضيات حول الآليات التي تعمل بها الطبيعة، قبل أن يعود إلى المختبر لاختبارها، ثم إلى التأمل والنقد لتحليل النتائج، وتعديل النظرية أو إدخال مفاهيم جديدة، وهي آلية شبيهة بما يقوم به الفيلسوف، مع فارق أن مختبر الفيلسوف يكون غالبًا داخل رأسه.
أما علوم الكونيات والمجرات، فلا شك أنها مجال واسع يتجاوز الجزئيات، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا باتساع الفلسفة وشمولها. وقد دخلت نظرية الانفجار الكبير (Big Bang Theory) إلى حقل الفلسفة واللاهوت. وإذا كانت الفلسفة تطرح الأسئلة لا لتصل إلى أجوبة نهائية، بل لتبقي على الشك الفلسفي حيًّا، فإن العلم كذلك يطرح الأسئلة، ويواصل تطوره وتجاوزه لذاته دون ادعاء.
يقول حسام الدين درويش: إن الفلسفة لا تقطع علاقتها بالماضي، وكذلك العلم، وإن كان يتجاوزه. فكثيرٌ من الأدوية اليوم مُصنَّعة أو مُعدَّلة انطلاقًا من خلاصات نباتية استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، قبل تطور العلم الحديث. وحتى المواد الدوائية التي لا توجد في الطبيعة، فإن عددًا منها بدأ تطويره استنادًا إلى أعشاب طبية. ويمكن النظر إلى العلم أسلوبًا إنسانيًّا في النظر إلى الطبيعة، والنظريات العلمية بمثابة نظارات مختلفة تتيح لنا تطبيقات متنوّعة لما نراه من خلالها، إلى أن يحين موعد ارتداء نظارة جديدة. وهذا يعني أن للعلم بعدًا ذاتيًّا جمعيًا، كما هو الحال في الفلسفة. ولا يزال هناك فلاسفة يمارسون العلم، وعلماء يمارسون الفلسفة، وإن كان ذلك على نحو أقل مما كان عليه في العصور السابقة، بسبب اتساع المعارف الإنسانية وتعقّدها.
سأختم بالقول إن الفلسفة تسعى إلى نظرة أوسع وأكثر شمولًا من العلم، غير أن العلم أيضًا يسعى إلى تجاوز معادلاته الرياضية نحو استشراف نظري يتجاوز مجرد التطبيقات العملية. الفلسفة والعلم متداخلان، ويصعب الفصل التام بينهما رغم تمايزهما، ولا غرابة في ذلك، فهما نابعان من مصدر واحد هو عقل الإنسان.
د. ميادة كيالي:
شكرًا لك د. وائل على هذا الطرح الجميل الذي سلّطتَ من خلاله الضوء على السيرة الذاتية والبوح، بكل ما فيهما من جوانب سلبية وإيجابية، وتحدثت عنهما بمشاعر تفيض احترامًا ومحبة. كما تطرّقت إلى التفاصيل الدقيقة، فدمجتَ قراءتك للكتابين معًا، متوقفًا عند أسلوب الدكتور حسام السهل الممتنع.
ونختم هذه الجولة من القراءات حول الكتاب الأول مع الدكتور سهيل الحبيب، الباحث التونسي المتخصص في الفكر العربي المعاصر. من مؤلفاته: "خطاب النقد الثقافي في الفكر العربي المعاصر"، "الأزمة الأيديولوجية العربية وفاعليتها في مآزق مسارات الانتقال الديمقراطي ومآلاتها"، "الإسلاميون والعلمانية: قراءة جديدة في نظرية بشارة العلمنة".
د. سهيل الحبيب:
اخترت أن يكون مدار حديثي في هذه الكلمة الموجزة حول موضوع الثورة في كتاب "درويش بين القدر والمصير في الفلسفة والثورة". وباختصار، سأحاول أن أكثّف الحديث في فكرتين أساسيتين:
- كيف تكون الثورة عند درويش عنوانًا للمصير الجمعي.
- جدلية ثورة التحرر وثورة الحرية عند درويش.
الثورة والمصير الجمعي
في النقطة الأولى، سأسمح لنفسي أن أمارس ضربًا من التأويل على العنوان، يتّصل بهذه الكلمات الأربع التي ارتبطت بدرويش في هذا العنوان: القدر، والمصير، والفلسفة، والثورة.
يبدو لي أنه من الجائز، استنادًا إلى محتويات الكتاب، أن أصنّف هذا الرباعي اللفظي أو المفهومي في ثنائيتين: القدر والفلسفة من جهة، والمصير والثورة من جهة ثانية. والظاهر أن العلاقة قائمة بين القدر والفلسفة في هذا الكتاب من ناحية كون الفلسفة كانت الطريق الذي من خلاله أفلت درويش من قدر شبه محتوم بالنسبة إلى أي إنسان كابد ظروفه الاجتماعية (عن طريق الفلسفة تحدّى درويش قدر التهميش الاجتماعي والثقافي، وهو اليوم من النخب العالِمة أو المثقفة). أما العلاقة بين المصير والثورة، فتتجلّى بشكل واضح في كون الأخيرة تمثّل العنوان الأبرز، بل أكاد أقول الأوحد، للمصير في الكتاب. وهنا أتحدث عن المصير بمعناه الجمعي: مصير الجماعة التي ينتمي إليها درويش، سواء تعلّق الأمر بالجماعة الوطنية السورية أو الجماعة القومية الحضارية العربية.
طبعًا، هذا التأويل هو وجه من وجوه العلاقات الممكنة بين الرباعي اللفظي أو المفهومي الذي يشكّل عنوان الكتاب. ويمكن أن نستخلص وجوهًا أخرى للعلاقة بين الفلسفة والمصير، والثورة والفلسفة، والقدر والمصير... ما أردت تثبيته في هذه المقدمة هو أن العلاقة قائمة، بل قوية، بين الثورة والمصير الجمعي في هذا الكتاب، وأن التفكير في هذا المصير الجمعي، بالنسبة إلى درويش، يكاد ينحصر في التفكير في الثورة.
إن فكر درويش، في هذا الصدد، يبدو ابن عصره بامتياز؛ فقد وسمت موضوعة الثورة جدالات الفكر العربي منذ بداية العشرية الثانية من هذا القرن. لكن، إلى أي حدٍّ من المشروع اختزال التفكير في المصير الجمعي في موضوعة الثورة؟
ثورة التحرّر وثورة الحرية
وقد احتلت موضوعات الثورة حيّزًا واسعًا في الكتاب، وتعدّدت بشكل يضيق معه هذا المقام عن الإتيان عليها جميعًا. لذلك، سأنتخب منها فكرة يتيمة تبدو لي الأكثر راهنية، من منظور متغيرات الثورة السورية بعد منعطف 8 ديسمبر الماضي، وأعني بها فكرة جدلية "الثورة العفوية التحررية" و"ثورة الحرية". يقول درويش في هذا الصدد (ص 132): "الثورات العفوية غير المنظمة من قبل نخبة ما، عمومًا، ومنها الثورات العربية، تفهم على أساس ما تثور ضدّه أكثر من إمكانية فهمها على أساس ما تثور لأجله، فهي ثورات، تحرّر أكثر من كونها ثورات حريةٍ أو حرياتٍ واضحة المعالم النظرية".
ولا تخفى راهنية هذا الزوج المفاهيمي الذي استفاد درويش في وضعه من تجارب الثورات العربية في العشرية الماضية، استفادة مكّنته من استباق إشكالات المرحلة الراهنة التي أعقبت إسقاط نظام الأسد. يقول مثلا (ص 141): "هل يمكن لثورات التحرّر هذه أن تكون نقطة انطلاق مستقبلاً لثورات حرية بالمعنى العميق للكلمة؟ أعتقد أنّ المستقبل مفتوح والممكنات المتعدّدة موجودة. والأمر ليس مسألة قدر يحصل للناس، خبط عشواء، من يصب يحرره ومن يخطئ يبقه غير متحرّر، بل هو، أيضًا وخصوصًا مصير يسهم الناس في تحديده، بالتفاعل مع الظروف القدرية المحيطة بهم".
أعتقد أن هذا الزوج المفاهيمي "الثورة التحرّرية العفوية" و"ثورة الحرية الواعية" يمكن أن يكون إطارًا يتصل فيه تفكير درويش في الثورة في هذا الكتاب، بقضايا الثورة بعد ديسمبر 2025. ولعلّ معطيات المسار السوري خلال الأشهر الأخيرة تبيح لنا أن نسائل درويش نقديًّا: إلى أيّ مدى يمكن أن ننتظر من أي ثورة على الاستبداد أن تكون تحررية بحقّ، إذا لم تتضمن من بدايتها، أو لم يتبن الفاعلونّ الرئيسيون فيها، برنامجًا واضحًا للحرية، أو للأدقّ برنامجًا للحريات بمعناها الليبرالي الحديث؟ ألا تعيد الثورات التي تغيب فيها برامج من هذا الجنس إنتاج أشكال أخرى من الاستبداد؟
د. ميادة كيالي:
شكرًا لك د. سهيل على هذه الإضاءة النقدية الثمينة، من خلال إعادة ترتيب العنوان للربط بين القدر والفلسفة من جهة، والثورة والمصير من جهة أخرى. وربما يكون هذا الربط والمقابلة بحاجة إلى توسع من قِبل د. حسام، وأن يجيب عن السؤال الجوهري الذي طرحته، حول فكرة المصير الجمعي والثورة، وإمكانية الانتقال من ثورة التحرير إلى ثورة الحرية.
ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الندوة، والمخصص لكتاب "منمنمات فكرية وحوارية: في الفلسفة والحياة (اليومية) والقضية الفلسطينية". ويتضمن الكتاب مقدمة وأربعة فصول، موزعة بين مقالات قصيرة (منمنمات فكرية) وحوارات (منمنمات حوارية)؛ إذ يتناول بالطرح قضايا الفلسفة، الهوية، الأخلاق، والموت، ويصل في جزئه الثاني إلى قراءة معمقة للفكر والفلسفة في علاقتها بالقضية الفلسطينية بعد السابع من أكتوبر 2023. كما يُظهر هذا الكتاب حسًّا جدليًّا وكتابة تأملية تجمع بين التحليل والتجربة، بين الفلسفة والواقع. ويشارك في قراءة هذا الكتاب ثلاثة باحثين مميزين، أولهم: الأستاذ ماهر مسعود، كاتب سوري مقيم في برلين، ويحمل ماجستير في الفلسفة الغربية. صدر له أربعة كتب، من أبرزها: "ما الجسد" و"أفول النخبة".
ذ. ماهر مسعود:
بما أن الكتاب يحتوي على عدد كبير جدًّا من المنمنمات الفكرية ضمن فصوله، وبما أن الزمن المتاح للنقاش قصير جدًّا، فقد اخترتُ مناقشة منمنمة فلسفية بحتة جاءت ضمن منمنمات في (فلسفة) المعرفة والأخلاق، التي تناقش موضوع الإجابة في الفلسفة، وقد وُضعت تحت عنوان: "إعادة الاعتبار للإجابة الفلسفية".
يناقش الكاتب بوضوح ومن عدة اتجاهات الفكرة السائدة فلسفيًّا، التي تعطي الأهمية دائمًا للسؤال الفلسفي، محاولًا إعادة الاعتبار للجواب في الفلسفة ضد مركزية السؤال. يقول حسام درويش: "تحاجج هذه المقالة بأن أهمية الإجابة في الفلسفة لا تقل عن أهمية التساؤل، وتسعى إلى رد الاعتبار للإجابة الفلسفية من خلال إبراز أهميتها وعلاقتها الجدلية بالتساؤل الفلسفي".
بدايةً، أفهم وأتفهم وجهة نظر الكاتب في محاججته ومساءلته ل"السؤال الفلسفي"، حيث يختبئ بالفعل كثير من المشتغلين في الفلسفة خلف القول الشائع إن "مهمة الفلسفة هي السؤال"؛ وذلك للهروب من إعطاء أيّ إجابة، أو لجعل المسألة تبدو ذاتية تابعة للرأي الشخصي فقط، الذي لا يمكن دحضه، ولا نفيه، ولا إثبات صحته أو خطئه؛ أي في المحصلة ليقولوا لا شيء، أو لكي لا يقولوا شيئًا مهمًّا (وهو الاعتراض الذي تقدمه المدرسة التحليلية عبر نقدها للفلسفة القارية، وهو ما يُلمّح له الكاتب ضمن النص).
لكن الطرح الذي يقدمه الكاتب في مقاله يقوم على سوء فهم جوهري للسؤال الفلسفي أصلاً، قبل الحديث عن الجواب في الفلسفة. فهو يتحدث وكأن السؤال والجواب الفلسفيين هما مسائل بديهية واضحة بذاتها ولا تحتاج إلى توضيح، أو كأن الجميع يعرف معنى السؤال ومعنى الجواب في الفلسفة، وهنا يكمن جوهر المشكلة في الطرح.
لكن ما السؤال الفلسفي؟ أجيب أولًا بالسلب، وبما ليس هو، لأقول إنه ليس استفسارًا، ولا استقصاءً، ولا تحقيقًا (على طريقة تحقيقات الاستخبارات، أو استفسارات وتحقيقات وسائل الإعلام). ليس استفهامًا يُجاب عنه بتوضيح غموض أو إزالة التباس ما، ولا حتى استنكارًا مثل: "هل تدين حماس؟".
السؤال الفلسفي هو طرح مشكلة؛ أي أشكلة موضوع معين، سواء كان طرح مشكلة لم تُطرح من قبل، أو أشكلة مشكلة موجودة وإعادة طرحها بطريقة جديدة ومن منظور مختلف. بهذا المعنى، تكون الفلسفة إبداعًا: إبداع مشكلة وخلق مفهوم، ولذلك كانت الفلسفة تُعرف ب "فن خلق المفاهيم" عند دولوز.
عندما تُطرح المشكلة بشكل جيّد، فإنك تحدد مسار الإجابات الممكنة ضمن السؤال ذاته، فتصبح الإجابة مُستغرقة في السؤال أو موجودة به ضمنًا، ويصبح الحل مسألة تطبيقية لا أكثر. وقد عبّر ماركس عن ذلك بشكل أفضل عندما قال، بمعنى ما، إن البشرية لا تطرح على نفسها إلا المشكلات التي تستطيع حلّها.
عندما طرح باسكال مشكلة الله، لم يكن ما يعنيه هو وجود الله أو عدم وجوده، فهذا ليس سؤالًا فلسفيًّا، بل دينيًّا. سؤال باسكال الإشكالي كان يريد النظر في أيهما هو الوجود الأفضل: الوجود مع إله أم من دونه. سؤاله كان يتعلق بالوجود والموجود، إذن، وليس بالغيب.
وعندما أعلن نيتشه موت الله، لم يكن سؤاله مرتبطًا بوجود إله فعلي في العالم قد مات، بل كان مرتبطًا بالوجود الذي لم يعد للإله فيه دورٌ جوهريٌّ أو قيمة أخلاقية وعملية كبيرة. ومن ثم، كان سؤاله الفلسفي هو: ماذا علينا أن نفعل في عالم لم يعد للإله فيه الدور التاريخي والسياسي والأخلاقي والقانوني الذي احتله سابقًا عبر الدين المسيحي في الغرب؟ وبعد موت نيتشه، لم يتأخر جواب البشر كثيرًا؛ إذ حلّت الأيديولوجيات الفاشية والنازية والشيوعية، التي غطت كامل القرن العشرين، محلّ الدين الذي احتل تلك الأدوار سابقًا، ولعب أدوارًا حاسمة في صناعة تاريخ أوروبا والعالم.
على سبيل المثال: عندما تعرف كيف تطرح مشكلة نفسية، وعندما تشرّحها جيّدًا وتُسائل معترضاتها بشكل عميق، تصبح الحلول متعددة للمشكلة ذاتها، وتختلف طرائق العلاج باختلاف الأشخاص، والأعمار، والجنس، واللون... إلخ. لكن يبقى الأهم هو معرفة السؤال الصحيح الذي يُبيّن المشكلة ويُبرزها إلى السطح، ويخترق مغاليقها.
إن إعادة الاعتبار للجواب في الفلسفة، كما يطرحها الكاتب، تسلب الفلسفة روحها. ففعل التفلسف لا علاقة له بالإجابات الجاهزة، بل هو بحث دائم عنها. الفيلسوف لا يعمل بالإجابات، ومن يكتفي بنقل إجابات الفلاسفة هو مؤرّخ للفلسفة وليس فيلسوفًا. عندما تعرف الإجابة، تتوقف عن التفلسف، تطمئن، وترتاح. الأجوبة هي وسائد للراحة. أما السؤال، فيدفعك إلى الشك، يُفقدك الراحة، يوقظك في الليل، ويخلق كوابيسك أحيانًا... بحثًا عن إجابة.
الجواب دائمًا حدّ، نهاية، إيقاف للنقاش. أما السؤال، فيدفع دائمًا كل الحدود إلى أقصاها، ويفتح حدودًا جديدة كانت إجابات سابقة قد وضعتها؛ يخرقها ويعبرها نحو طرح جديد.
السؤال مرتبط بالصيرورة، وهو تعبير عن الصيرورة، يدفع الحياة ويحركها لتصير ما لم تكن عليه. في المقابل، الجواب مرتبط بالتاريخ. الصيرورة لا علاقة لها بالتاريخ. إنها كثافات، وشدّات، وتوترات، وموجات، وحركات جديدة، لا مجرد سيلان زمني نُسمّيه 'التاريخ' ونقسّم به أيامنا وحيواتنا، ونعرف نهايته قياسًا على بدايته.
يميّز "غيلبرت رايل" في المعرفة بين نوعين: "المعرفة بأن "(Knowing that) و"المعرفة كيف" (Knowing how). الأولى هي معرفة مخزونة في الكتب، نتعلمها ونحفظها، فتصبح لدينا دراية بما لم نكن نعرفه مسبقًا. أما الثانية، فهي معرفة لا تكون موجودة مسبقًا، بل نتعلمها بالتجربة، والتدريب، والمحاولة، والخطأ. إنها معرفة استقرائية، لا يمكن معرفة نتيجتها استنادًا إلى مقدماتها؛ لأن نتيجتها دائمًا جديدة، وليست معطاة مسبقًا قبل التجربة.
السؤال الفلسفي لا علاقة له بـ Knowing that؛ أي أن نعرف أن... (مثلاً: أن نعرف أن كولومبوس اكتشف أمريكا سنة 1492 كإجابة)، بل هو مرتبط بـ Knowing how؛ أي أن نعرف "كيف". ولكي نعرف كيف، علينا أن نجرّب، أن نتمرّن فكريًّا، وأن نضع الفكر ذاته أمام معضلة لاختبار ما يُنتجه من أفكار. فالسؤال العادي يُقدّم معلومات، ويطلب معلومات، وتكون إجابته بدورها معلومات. أما السؤال الفلسفي، فلا يطرح معلومات بل يطرح أفكارًا، لا يطلب "معلومة" بل معرفة. Knowledge is not information.
أعتقد أن إعادة الاعتبار للإجابة في الفلسفة، كما قدّمها الصديق حسام الدين درويش، هي مساهمة - حتى لو لم تكن مقصودة - في ما سمّاه "جيل دولوز": "اغتيال الفلسفة"، وهو المشروع الذي بدأه "فتجنشتاين" وما يزال مستمرًّا حتى يومنا هذا. شكرًا لكم جميعًا.
د. ميادة كيالي:
شكرًا جزيلًا للأستاذ ماهر على مداخلته الفلسفية المكثفة، التي تناول فيها مفهوم السؤال ومفهوم الإجابة، وكيف تعامل معهما الدكتور حسام في منمنماته. وقد فتحت هذه المداخلة المجال للتعقيب، خاصةً في ضوء تعبير الأستاذ ماهر عن السؤال بوصفه أشكلة للمفهوم، وفي سياق تناول قضية الفلسفة بين طرح السؤال والسعي إلى إيجاد الجواب.
الباحث الثاني الذي سنستمع إلى قراءته هو د. قاسم المحبشي، أستاذ فلسفة التاريخ والحضارة، ونائب عميد كلية الآداب في جامعة عدن. د. قاسم أكاديمي، وشاعر، وناقد أدبي. من إصداراته: "فلسفة التاريخ في الفكر الغربي المعاصر"، "مقاربات نقدية في فلسفة العلوم والتربية"، "فيما يشبه الانتظار؛ قضايا وأفكار"، و"استئناف الدهشة؛ تأملات في آفاق الفلسفة وواقعها".
د. قاسم المحبشي:
منذ أن عرفته في الفضاء الافتراضي، وأنا أتابع نشاطه الفكري والثقافي المتميز. وحين التقينا لأول مرة في القاهرة، خلال مؤتمر "لاهوت التعايش" الذي انعقد في 22 يوليو 2022م، بتنظيم من المعهد الألماني للدراسات الشرقية، في مبنى الهيئة الألمانية للتبادل العلمي بالزمالك، تأكد لديّ الانطباع الأول. وقد حضرت المؤتمر بدعوة كريمة من الدكتور أحمد عبد السلام، مدير المعهد الألماني للأبحاث الشرقية بالقاهرة (OIB)، وبتحفيز من الصديق العزيز الدكتور حسام الدين درويش، أستاذ الدراسات الإنسانية للبحوث المتقدمة بجامعة لايبزيغ، ومحاضر في قسم الدراسات الشرقية بكلية الفلسفة في جامعة كولونيا، في ألمانيا، والحاصل على شهادة الدكتوراه من قسم الفلسفة بجامعة بوردو 3 في فرنسا، في تخصص "الهرمينوطيقا ومناهج البحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية".
خلال ذلك اللقاء المهم، ومع نخبة من الزملاء الأعزاء، تبادلنا أطراف الحديث، وأهداني مشكورًا كتابه: "نصوص نقدية في الفكر السياسي العربي والثورة السورية واللجوء (بشارة وباروت نموذجاً)". بعد ذلك، جمعتنا مؤسسة (OIB) مرة أخرى في مؤتمرها الثاني، المكرَّس لموضوع "الترابط بين الإنسان والدين والبيئة"، الذي نُظم في درة الأطلسي، مدينة الإسكندرية، من 10 إلى 13 ديسمبر 2023م. وقد كانت مناسبة سانحة لتعزيز معرفتي بالدكتور حسام الدين؛ إذ وجدت بيننا قواسم مشتركة كثيرة، منها تشابه الحال والمآل بين اليمن والشام، إضافة إلى الهمّ السياسي العربي العام. فضلاً عن كوننا (هو وأنا) نتاج المدرسة الفكرية البرقاوية، نسبةً إلى أستاذنا أحمد نسيم برقاوي، أستاذ الفلسفة ورئيس قسم الفلسفة في جامعة دمشق سابقاً؛ فقد وجدت مع الدكتور حسام الدين درويش تقاربًا واضحًا في الاهتمامات الفكرية والثقافية، النظرية والمعيشية معًا. نتقاطع في الانشغال بالإنسان والحاجة إلى الاعتراف، وفي مفاهيم العدالة، والحرية، والكرامة، والثورة، والدولة، والديمقراطية، والعلمانية، وفلسطين، والثقافة، والعلم، والتعليم، والصحة، وغيرها من مشاغل الحياة الحاضرة، الفورية، والمباشرة؛ تلك التي نمنحها تسعة أعشار وقتنا في عالمنا الواقعي المعيشي، حيث نعيش من دون ماضٍ أو مستقبل، بل في اللحظة الراهنة الآنية. إنها الحياة بتدفقها، بملموسيتها، وشموليتها: الحياة اليومية البسيطة، المملوءة بالانشغالات الروتينية والمتطلبات المعيشية الملحّة، الصغيرة منها والكبيرة، التي تستهلك الكائن الاجتماعي الساعي إلى إشباع حاجاته بوسائل شتى: بالحيلة، والتقنية، والعادة، والتقليد، والأسلوب، والصراع، والرهان، والتفاعل، والنجاح، والفشل، والمكسب، وبكل أنماط العلاقات والممارسات اليومية التي ننخرط فيها مع سائر الأحياء في مجتمعاتنا، والتي تُشكِّل في مجملها عصب الجسد الاجتماعي.
إنها الحياة "بلا مزايا"، كما يسميها عالم الاجتماع "جلبر دوران" ﺑ "الجوّ الخانق". وتلك الانشغالات اليومية، في تفاصيلها الصغيرة والكبيرة، هي ما يرمز إليه بعض الكُتّاب بمصطلح "منمنمات فكرية". والسؤال المطروح هنا هو: كيف يمكن للفكر، عمومًا، وللفلسفة، خصوصًا، أن تنخرط في مناقشة الراهن، والمباشر، والمحسوس، والمعيش، دون أن تفقد شموليتها النظرية، ودون أن تفقد الفلسفة روحها المجردة الشمولية؟
هذا ما يسأله الدكتور حسام الدين درويش في مستهلّ كتابه المهم الذي سعدتُ بقراءته: "منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة (اليومية) والقضية الفلسطينية"، الصادر عن مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، سنة 2024م. وبعد قراءتي للكتاب، تبيّن لي بجلاء المعنى العميق الذي قصده الدكتور حسام في نقده لبعض التصورات السائدة حول الفلسفة ووظيفتها. وقد عبّر عن ذلك في مقال بالغ الأهمية والراهنية، نُشر في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 22 أغسطس 2024م، بعنوان: قدر الفلسفة ومصيرها في العالم العربي. قال فيه: "تعالت صيحات أو أصوات واستغاثات الفلاسفة و/ أو المشتغلين في الفلسفة والأطراف المحبة للفلسفة أو "المقدِّسة" لها، وتضمّنت تلك الأصوات إبرازًا مُحقًّا، حينًا، ومفرطًا وغير محقٍّ، أحيانًا، لقيمةِ الفلسفة وأهميتها، وما عُدَّ دورها الفريد الكبير والعظيم في (كلّ) مناحي الحياة الإنسانيّة."
ثم أشار إلى ما كتبه الفيلسوف اليمني قاسم المحبشي، الذي عدّ الفلسفة "أم العلوم وملكة الحكمة وأميرة المعارف"، وأكّد أنها "ليست اختياراً من بين اختيارات أخرى، بل هي ضرورة قصوى وملحّة؛ إذ إنها الوحيدة من بين فعاليات العقل البشري التي تعلّم الإنسان جهله وحدود عقله، وتمنحه فضيلة الاستنارة والتسامح مع غيره من الناس". وهنا يطرح حسام الدين درويش تساؤلاً مشروعًا: ألا يمكن للدين، مثلاً، أن يسهم في منح الإنسان "فضيلة التسامح مع غيره من الناس" من دون فلسفة؟ ولماذا يُمنح الفكر الفلسفي هذا الموقع الفريد وتلك المكانة الاحتكارية؟
ونجد إفراطًا وتفريطًا مشابهين في البيان الصادر عن وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية (في المعهد العالمي للتجديد العربي) لأجل الفلسفة في مصر. ففي ذلك البيان زعمٌ بأنّ "كل الحروب والسياسات التي تتحكّم بالعالم هي نتاج الفلسفات الكبرى في الوجود". ليس واضحًا ما تعنيه الفلسفة في هذا البيان أو في غيره من النصوص المُدافعة عن الفلسفة. ويبدو أنّها تعني كلّ رؤيةٍ كليّة أو عامة للوجود. لكن، ألا يعني هذا أنّه إذا كان لدى كلّ إنسان رؤية كليّة أو عامة للوجود، فإنّ كلّ إنسانٍ فيلسوف أو لديه رؤية فلسفية؟
لا أودّ التعليق هنا، بقدر ما يهمني التأكيد أن كتاب المنمنمات الفكرية والحوارية جعلني أتعجّب من قدرة الدكتور حسام على جعل روح الفلسفة تسري في كل الجسد الفكري لفيلسوف الشام الصاعد، دون أن تدّعي تمثيل الحقيقة أو النطق باسمها. ومنمنمات؛ كتاب شمل بين دفّتيه حوالي 428 صفحة. ليست نصوصًا طويلة، ولا مقالات تقليدية، كما أنها ليست شذرات صغيرة على نمط شذرات هرقليطس أو شيشرون، الذي كتب: "أيتها الفلسفة، يا أشرف العلوم، كيف يمكن للحياة أن تكون بدونك؟"
لقد ابتكر حسام الدين هنا مفهومًا جديدًا لوصف الأفكار والحوارات اليومية التي أنجبتها انشغالات الفيلسوف بالحياة، فيما يشبه فلسفة الحياة اليومية؛ إذ تحضر الفلسفة، في نصوص هذا الكتاب، من خلال بعض المفهومات والمضامين والإحالات المعرفية، وبعض الأدوات والمقاربات المنهجية، وهي تحضر لتغيب، ولتكون وسيلةً لتحقيق غايةٍ أهم. وفي مثل هذه السياقات، الفلسفة، مثل فن التمثيل، "تنجح" عندما لا تثير الضوضاء، ولا تلفت الانتباه إلى كونها فلسفة. فالممثّل (للفلسفة) يكون أو يبقى ممثّلًا بائسًا، عندما يستمر في تذكير الناس، بقصدٍ أو من دونه، أو عندما يظلّ الناس يتذكّرون، في أثناء التمثيل، أنه ممثّل.
إذا سلَّمنا، مع الفيلسوف السوري الراحل بديع الكسم، بأن الفلسفة هي «البحث عن أكثر الحقائق أهميةً في حياة الإنسان الروحية»، فقد تبدو الحياة اليومية، بتفاصيلها وجزئياتها، وبمباشرتها وتعيّنها، غير مؤهلةٍ، ولا صالحة لأن تكون موضوعًا للتفكير الفلسفي. في المقابل، الحقائق المذكورة ليست موجودةً في عالمٍ أفلاطونيٍّ مفارقٍ، والحياة الروحية المذكورة محايثةٌ لجسدٍ فرديٍّ متعيّنٍ، ومن ثمّ، لا يمكن أن يتجاهل المذكور تفاصيل الحياة اليومية. ففي تلك التفاصيل، لا تكمن الشياطين فحسب، بل الملائكة والآلهة أيضًا.
أتذكّر أنني حضرت ندوة حواريّة عن كتابه الجديد (منمنمات فكرية وحوارية) في صالون تفكير بتاريخ 14 ديسمبر 2024م، ندوة أدارها الدكتور وائل العظمة بكفاءة واقتدار، وحديث مفعم بالأمل والتفاؤل عن الحالة السورية الراهنة. تحدّث فيها الدكتور حسام، وهو من أهل مكة وشعابها! ولفت نظرنا إلى مواقف إيجابية مبشّرة، منها: خروج السوريين، بكل شرائحهم وطوائفهم ومذاهبهم، إلى الميدان العام بدون خوف ولا محاذير، والحفاظ على المؤسسات العامة وعدم المساس بها، وانفتاح السوريين على عهدٍ جديد يحمل من الممكنات ما لا عهد لهم بمثله فيما مضى، ورغبة السوريين في بناء دولتهم الوطنية العادلة والمستقرة، وأشياء أخرى إيجابية جدًا.
ربما كانت الحالة السورية الأسدية المتوحشة أهم درس في قيمة المؤسسات المحايدة لحماية الناس وكرامتهم. فما أضعف الناس بدون مؤسسات عامة وعادلة تحميهم من بعضهم، ومن غيرهم، ومن غوائل الدهر وصروف الحياة. وحينما تكون المؤسسات ضدهم وتسعى إلى سحقهم والإمعان في قهرهم، كما يتنضّد أمامنا الآن من سجون الأسد الرهيبة، فاعلم أنّ الجرائم التي ارتُكبت بحق كلّ من وقع في مخلب ذلك الوحش المسعور، من السوريين من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية (نساء ورجال وشيوخ وأطفال وفتيات وفتيان وأمهات وزوجات وطالبات وتلميذات... إلخ)، ربما مئات الآلاف من المواطنين السوريين قضَوا نحبهم، أو أمضوا حياتهم في غرف التعذيب وفي ظلام السجون.
وسوف نشاهد ونسمع قصص عذابات لم تكن تخطر على بال الشيطان ذاته. فإذا كان التعذيب هو فنُّ إمساك الحياة في الوجع؛ وذلك بتقسيمه إلى «ألف موتة» قبل أن تتوقّف الحياة على أشدّ حالات الفزع، بحسب "ميشال فوكو"، فيمكن القول مع "جان بول سارتر" إن نظرة الضحية في وجه الجلاد السادي الذي يتلذّذ بتعذيبها، تحيله إلى كائنٍ غريبٍ عن أفق الحياة وقيمها الإنسانية، الأخلاقية والجمالية، التي تستحق الفرح والمحبة لا القتل والتدمير. وهذا هو موقف الشعب السوري العظيم مع أقذر طاغية في تاريخه. ويقصد بجريمة إمساك الحياة في قاع الوجع، أنّ الضحية، من شدة التعذيب، تلفظ أنفاسها الأخيرة، أو تفقد قدرتها على الوعي والإحساس، ويُغمى عليها من شدة الوجع.
حدثني الدكتور حسام الدين درويش عن الأيام العصيبة التي عاشها في سورية الرهيبة قبل أن يتمكن من الخروج منها والحصول على حق اللجوء في ألمانيا، كما حدثني عن الضحايا من أقاربه وأصدقائه الذين قضوا نحبهم في سجون الأسد الرهيبة، وفي أتون الحرب التي شنّها ضد المواطنين السوريين العزّل.
انتهيت الآن من قراءة كتاب الدكتور حسام الدين درويش (منمنمات فكرية وحواريّة في الفلسفة والحياة اليومية والقضية الفلسطينية) الصادر عن مؤسسة ميسلون للثقافة والترجمة والنشر عام 2024م. على مدى شهر كامل، وأنا أتجوّل مع درويش في فضاءات الفكر والفلسفة ومنمنمات الحياة اليومية والقضية الفلسطينية؛ رحلة فكرية سياحية ممتعة ومضنية أعادتني إلى ما قبل الحضارة الرقمية؛ زمن القراءة والكتابة الورقية والدراسات العليا، حينما كنت أقرأ مؤلفات الفلاسفة الكبار، ومنها: الوجود والزمان لهيدغر، والوجود والعدم لجان بول سارتر، وكتاب الكلمات والأشياء لميشيل فوكو، وغيرهم.
مع منمنمات الدكتور حسام، أحسست بجرعة عالية من التغذية الراجعة والعصف الذهني، الذي جعلني أفتح عيوني على أوسع مدى، وأنا أطوف بين دروب فلسفة الحياة اليومية لفيلسوف عربي حنّكته الظروف القاسية، فوجد في التفكير والكتابة شكلًا من أشكال المقاومة للقهر والظلام والحرمان. وربّ ضارّةٍ نافعة! ومن قلب الألم يتولّد الإبداع والأمل.
ومن يقرأ كتاب منمنمات حسام، يفهم الدوافع والعوامل التي جعلته ينضج فلسفيًّا بهذه السرعة الزمنية؛ ففي بضع سنوات قليلة ومتقاربة، أنتج سلسلة من الإصدارات المهمّة، منها:
1- هيرمينوطيقا بول ريكور وعلاقتها بالعلوم الإنسانية: نحو تأسيس هيرمينوطيقا للحوار، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدوحة، 2016؛
2- نصوص نقدية في الفكر السياسي العربي والثورة السورية واللجوء، 2017؛
3- المعرفة والإيديولوجية في الفكر السوري المعاصر، 2022؛
4- في المفاهيم المعيارية الكثيفة: العلمانية، الإسلام (السياسي)، تجديد الخطاب الديني، 2022؛
5- في فلسفة الاعتراف وسياسات الهوية؛ نقد المقاربة الثقافوية للثقافة العربية الإسلامية، 2023؛
6- درويش بين القدر والمصير: في الفلسفة والثورة، مؤسسة مؤمنون بلا حدود، 2024؛
7- منمنمات فكرية وحواريّة في الفلسفة والحياة اليومية والقضية الفلسطينية، 2024؛
8- جدل التأويل بين الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكور، مؤسسة مؤمنون بلا حدود 2025.
وفي كتاب منمنمات فكرية، كنت معنيًا بالقراءة، وربما كان أكبر إصداراته وأكثرها تنوعًا في الموضوعات. في خمسمائة صفحة من القطع الكبير، تناول الدكتور حسام الدين درويش مشكلات وموضوعات بالغة الأهمية في تجربة فكرية مميزة، تجمع بين العمق الفلسفي والبساطة الأسلوبية، بالتأكيد على إعادة التفكير في القضايا الحيوية المعاصرة من منظور فلسفي وإنساني، مشدّدًا على أهمية الحوار والتفكير النقدي في مواجهة التحديات الراهنة، ومنها: الديمقراطية، والعلمانية، والدولة، والمدنية، والمرأة، والهجر، والاغتراب، واللغة العربية، والهوية، والانتماء، والثقافة، والسياسة، والمعرفة، والأيديولوجية، والكوارث، والشرور، والأسئلة والأجوبة الفلسفية، والمناظرة، والحوار، والرغبة، والخشية في التنميط، والأحكام المسبقة (نقد سينمائي)، في السيرة الذاتية حينما طاحت المخدة من البلكونة ووقعت في حديقة الجيران وفهم المعنى الحرفي للكلام! وحينما اضطر للعمل في البناء بلندن بعد تخرجه من جامعة بوردو 3 في فلسفة بول ريكور، وسأله زميله العامل عن معنى "من أنا"، وفي الأخلاق وتدمير المعرفة أو تعزيزها، وفي الدعوة إلى المحبة المجانية، في الحق أن نكون على خطأ، الحقيقة بوصفها خطأ ممكنًا في منهج بوبر التكذيبي، ونقد التاريخانية، في التناقض الذاتي وخطابات المظلومية، في مجتمع الاعتراف والاحتقار ("الأعمال بالنيات")، في التعبير عن الأسف والاعتذار، وثقافة الاعتذار في العالم العربي، في النقد والاختلاف في المجال الثقافي الأكاديمي العربي، الجابري وطرابيشي مثالًا.
الفلسفة والموت (عجز الفلسفة في مواجهة الموت)، كتب عن أساتذته (بديع الكسم، يوسف سلامة، وغيرهما)، وكتب عن طفله ريمي ذي السبع سنوات، والطريقة "الريميّة" في فهم العالم ومواجهته، في الأثرة والإيثار، أو في الأنانية والغيرية، وحدود الحرية وماهيتها، وعن تجربته البحثية، وعن الثورة السورية ومداراتها. كما كرّس الفصلين، الفصل الثالث والرابع من المنمنمات الفكرية، للبحث في الفلسفة والقضية الفلسطينية، في نقد الصورة النمطية اللاهوتية للذات والآخر: اليهود وإسرائيل، والعرب والإسلام، في حق المقاومة وحدودها، وفي نقد بيان هابرماس المؤيد لإسرائيل وبيان الفلاسفة العرب المضاد، في الفصل بين القول وقائله، في العنف وإدانته، حوار مع "جوديث بتلر"، في المفاهيم المتضايفة؛ نجاح العملية وموت المريض! وذكرني في فصله الأخير، الذي احتوى على حوار مع صديقته الأكاديمية الألمانية "كورنيليا زنغ" ("نرفض أن نكون أعداء")، برسالة "جان بول سارتر" (إلى صديقي الألماني) 1944م، كتبها "سارتر" من السجن.
حوار الدكتور حسام مع صديقته الألمانية مهم جدًّا. ومقال مهم عن غسان الحاج، الأستاذ الباحث في معهد ماكس بلانك الألماني، الذي تم الاستغناء عن خدماته بعد نصف قرن من العمل في المعهد، بتهمة "معاداة السامية"؛ وذلك في 2023م. وفي سؤال وجواب في قناة الجزيرة مع طارق القيزاني، عرض عقلاني لموقف ألمانيا من العرب وإسرائيل (ص486). وتحدث عن أهمية الإصلاح الديني في ظل دولة تحميه؛ وذلك في سياق مقابلة أجراها معه محمد أبو سمرا في مجلة "المجلة". وكانت الفقرة الأخيرة في منمنمات عن الطفلة الفلسطينية الجريحة دارين البياع، التي فقدت معظم أفراد عائلتها في العدوان الإسرائيلي على غزة ("الناس كلهم يحبون دارين، لكنهم لا يجدون الكلمة الملائمة المعبرة عن ذلك الحب"، ص484).
تجدر الإشارة إلى أن الدكتور حسام الدين درويش قد أهدى كتابه إلى ولده ريمي "بوصفه ذاتًا تملأ حياتي وموضوعًا في كتابي"، وإلى طفلة فلسطين الجريحة دارين البياع "بوصفها المعبرة عن حالة القضية الفلسطينية، واستجابةً لرسالتها / طلبها بكتابة أي شيء للتعبير عن حبنا لها؛ إذ فقدت معظم أهلها الذين كانوا يحبونها وتحبهم في غزة"، وإلى كل الأطفال الأبرياء في هذا العالم، "هذا المسكون بالقهر والخوف والجريمة؛ إذ إن كل عدالة العالم لا تساوي دمعة في عيني طفلٍ مفجوع."
د. ميادة كيالي:
أشكر د. قاسم على هذه القراءة المتأنّية، التي تطرّق فيها إلى الأسلوب الذي ينتهجه د. حسام، وإلى عمق طرحه ومقدرته على بناء حوارٍ ممتدّ. كما توقّف عند مسألة الإجابات، مُبرزًا أن التفكير هو جوهر الفلسفة، وأنها لا تهدف إلى تقديم أجوبة نهائية، بل إلى إثارة الأسئلة وفتح أفق التأمل. وقد أشار كذلك إلى تفرّد د. حسام في استخدام مصطلح "المنمنمات" في سياق فلسفي، وهو توظيف لافت ذو دلالة جمالية ومعرفية.
وأخيرًا، نصل إلى مسك الختام في سلسلة هذه القراءات، مع د. خالد كموني، رئيس وحدة الدراسات الفلسفية والتأويلية في المعهد العالمي للتجديد العربي، التي نتحاور في رحابها الآن. وهو أستاذٌ محاضر في الجامعة اللبنانية، ومحرر أول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. له العديد من المؤلفات والكتب، نذكر منها: "المحاكاة: دراسة في فلسفة اللغة العربية"، "فلسفة الصرف العربي: دراسة في المظهر الشكلي للكينونة"، "ما الذهنية؟".
د. خالد كموني: حسام درويش وتقريح الفلسفة
أقصد بالتقريح[1] في قراءة المعطى الفلسفي في منمنمات حسام، هذا الإجراء القادر على استنباط المعنى البارزِ في المعيش اليومي، من دون أن يخالطه شيء يكدِّر ظهوره أو نباته الابتدائي الأوَّل، بعدَ التألُّم من قروحِه في التذكُّر والانفعال المجتمعين في لحظة التفكُّر الناجمةِ عن قريحةٍ صافيةٍ تستقبلُ الممكِنَ من خلال الحاصل المرئي في الواقع. إن التفلسفَ في الموقف الحيّ هو محاولة التجاوز الحرّ للقَرْح المنكوء بالقدرة على مبادرةِ المشهدية القائمة بفهمٍ يحتوي استشكالات العيش المتداخلة بروحيَّة الاقتراح؛ أي بمزاولة القريحة لبَعث قيم الطيبة التي لا يخالطها ما يشوب تربتها من نوابِت وأعشاب وأشجار قد تحجب التفكير بأصلها في كل مرة، والتفكير بهذه الطيبة هو مِراس الصدق لتحقيق الحضور الهنيء. ليس المطلوب عند حسام الزهد بحركة الكائنات الاجتماعية والانكفاء إلى الذات بحجة ملازمة الخير، بل الانفتاح على التفلسف من القلب؛ أي الجرأة في إبداء الموقف والاشتراك مجدَّدًا في ما ينتقده من الأفعال الجارية في الحوادث الراهنة. إن التفلسفَ السيكولوجي هو الذي يسمح بمراقبة الكينونة الأخلاقية للفرد في السيرورة اللاواعية للحوادث. إنه تزمين الوعي في الحدث، وتوقيتُ الفهمِ أثناءَ جريان المفهوم، حيث يحدثُ اختراقٌ لما هو عادي بما هو إبداعي لتجاوز مثالب الإقامةِ في المياه الراكدة. هذا الاختراق هو التقريحُ الممكن، المقرون بالوعي الشعوري المطلق بضرورة التعقُّل؛ أي بتفسير الظاهرة حتى ننجز تجاوزًا لآلامها وأكدارها.
من هنا، يمكننا معاينة المبحث الثالث من الباب الأول في كتابه المنمنمات، والمتعلق بـ "منمنمات في (فلسفة) المعرفة والأخلاق"؛ وذلك لهجسٍ يقضُّ بال كلِّ واحدٍ منَّا، وهو يراقبُ اليومي الذي يأويه من دون ابتذالٍ أو استسهال للهذرِ بما يستدعي الجد. وأول القرائح التي تلفتنا إلى الاعتبار هي تنبُّهٌ إلـى "رد الاعتبار للإجابة الفلسفية"[2] عنوان المقالة الأولى. ففي بحثه لممكنات هذه الإجابة، وجدَ أنها تضاهي السؤال عينه من حيثُ الاشتغال الفكري في ما يستدعي التفلسف؛ إذ يسعى إلى سبر الممكن في لحظة انهماميَّة يواقِتُ فيها السؤالُ الإجاباتِ المفتوحةَ، فـ "الإجابة الفلسفية استجابةٌ للانهمام المحايث للتساؤل بالحصول على إجابة، ولسعيه إلى سبر الإجابات الممكنة عن ذلك التساؤل"[3]. وهذا ذروة الانفتاح الحرِّ على إمكانية التأويل الحَدَثي للتساؤل المتولِّد في الراهن؛ ذلك أن تأويليَّة الموقف ناجمةٌ من عدم الاكتمال في الإجابة نفسها، واللايقين يكون في الدرجة نفسها من الأهمية أثناء الإجابة، وليس في هذا المقامِ نقصٌ في الثقة بجدوى السؤال الفلسفي المطروح، بل إن اقتراحَ الإجابة هو عينُه اعتراف باستكمال السؤال بناءً عليها؛ أي هو تجاوزٌ صريحٌ لها. وما التجاوز سوى قدرةٌ على التقريح والابتداء من جديد.
يقول حسام الدين: "تتضمن الإجابة الفلسفية اعترافًا، صريحًا أو ضمنيًّا، وفي هذا الاعتراف، تحديدًا أو خصوصًا، يكمن كمالها الفلسفي"[4]. هنا تكمن إذًا ماهية التفلسف الحقيقي المبني على هذا الاعتراف الاجتماعي الذاتوي للفرد بالحيثية التي يكون فيها، وعيًا بلقاء الإنسان بذاتِه في ذروةِ الحدَث، وبالتالي بلقاء الآخر الذي سيتحدَّد هو تبعًا للعلاقة به، انطلاقًا من ذروة تصريح العلاقة بذاته؛ فلكل موقفٍ صريح لا بد من آخرٍ تصرِّحُ له الذاتُ هواها لتضمن هُويَّتها الحضورية واستمرارها. وإن هذا التفاعل الحي هو الذي يؤمّن للفرد إمكان الانفتاح على أسئلة الهوية والقيمة والكرامة والعدالة وغيرها، ما يؤسس لخصوصيَّةٍ التفلسف الراهن.
من هذا التأسيس الفلسفي ينطلق حسام الدين لمعاينة ظاهرات معيشةٍ كتلك التي وجدها في المقالة الثانية من هذا المبحث، والمتعلقة بـ "جدل القراءة والكتابة". واللافت في كتابته الفلسفية هو مطاردة الشعور في خلال الشرح للفكرة. لذلك، قلت إن حسام الدين فيلسوفٌ مِن القلب؛ أي يبدأ من مشاعرَ صريحةٍ تختلج فيه، لا يبخل عليها بالتفسير والتأويل اللذين يحتاجان إلى تعقُّلٍ قويم أثناء القول. يقول: "لكن حلم القراءة الكاملة ليسَ أقلَّ استحالةً من حلم الكتابة الكاملة"[5]، هنا نراه يهجسُ بشعور تذكُّريٍّ لحادثةِ نقصٍ ذات وقعٍ في نفسه، أثَّرت عنده في تلقي نصٍّ ما، ما استثارَه لوصف عملية التلقي نفسها إضافةً إلى القدرة الإبداعية للنص المكتوب أمام القارئِ الكاتبِ أيضًا. وهذا ما بدا لنا من عبارتِه "يمكن أن تترك قراءاتنا أثرًا كبيرًا فينا... وليس من الضروري أن يحصل ذلك التأثير بطريقة درامية انقلابية حادة... بل يمكن أن يحدث ذلك بطريقةٍ حادثةٍ وجزئية وتدريجية وتراكمية"[6]. نلمس في هذه العبارة نفسًا ضيِّقًا من ادعاءات القُرّاء للأثر الكبير للنصوص، أو بالأحرى للأثر السريع لها، خاصةً إذا ما احتوت تنظيرًا يستدعي التفاعل التغييري معها. حسام الدين في هذه الحالة ليس انقلابيًّا، بل هو يريد التلقي العلمي للفكرة أينَ أتت، وذلك وفق منهجية بناء الموقف الفلسفي، الذي يقتضي مراكمة الاختبار في النص بوصفه حدثًا قابلًا للتساؤل والإجابة في آن. وهنا يتضح إضمارُ حسام لحالةٍ من النقد الذاتي الدائم لظاهرة فاعلية النص الكبرى، أو سِحريَّة النص، وهو غالبًا ما تنجزه في واقعنا النصوص الأيديولوجية والخطابات السياسية طبعًا من بعد طغيان تأثيرية النص الديني.
غير أن هناك إفراطًا تفكيكيًّا لفعل القراءة أبداه حسام الدين في اقتبال النص، ربما سعيًا لمحاكاة استحالة الاكتمال المنشود في الحُلُم؛ إذ يرى أن "إمكانية تعبير النص عن نقيضِ مَقصد كاتبه المعلَن متحققة بوصفه نصًّا"[7]. وهنا نرى أن ارتباك الأسلوب بذاته قد يؤدي إلى قراءة تخالف القصد الأوَّل لصاحب النص، كما أن القراءة الحرة قد تأتي بنتائج تغاير هذا القصد. هذا مع الأخذ في الاعتبارِ أن مخالفةَ النصِّ جزءٌ من قراءَتِه عند حسام، وهنا لحظةُ القطع المطلق التي يريدها الكاتب بين الإنسانِ وأي قيدٍ يكبِّلُه في مسيره الحر.
وضمن تسلسله في إظهار القروح التي تشوب إمكان استنباط النافع في أي إجراء فلسفي ممكن، يقترحُ موقفًا في المقالة الثالثة عن غنى الحوار وجدواه بما يفوق المناظرات وما سماه "ذهنية الضربة القاضية"؛ إذ يحجب عن المناظرات التي "لا تهدف حتى إلى الإقناع، بل تهدف أساسًا إلى الإفحام"[8] إمكانية أن تحقِّقَ الفهم، كما يقصِرُ دورَها على الجدل السياسي، أو على النقاش الأيديولوجي المحض، هذا الذي لا يبغي سوى الرد لمصلحة طرفٍ على طرف، وليس اقتراح الفكرة في أرضٍ خصبة للحوار بهدف المعرفة؛ "تبدو المناظرات السائدة في الثقافة العربية عمومًا أيديولوجية أكثر من كونها معرفية"[9]. وهو هنا لا يخرج في تعقُّله الشعوري للمناظرة من حدَثيَّة الموقف التأويلي المطلق لإمكان عيش الحرية دون شوائب؛ ذلك أن حسام الدين لا يقصد مناظرةَ النحوي (السيرافي) للمنطقي (متى بن يونس)، وما حوته من سمات المحاورة الأولى في الثقافة العربية بين الأصيل النابت في الحدث؛ أي علمُ النحو من جهة، والوافد الجديد في الحدث؛ أي المنطق من الجهة الأخرى. فما يقصده حسام الدين هو بالضبط مشهدية الجدل السياسي العقيم الذي يملأ الشاشات دون اعتبار لأيّ فكرٍ يلتمسه المتابِعُ لمثل هذه المناظرات أو المنازلات الكلامية الضروس.
من هذا التوصيف لنمطية الجدل العقيم، حيث لا فكر ينبت بإرادة وحزم يضمنان مبادرة الوجود بعزيمة وإقدام للتعرف بحرية، يقترح حسام الدين في مقالته الرابعة موضوع "المعرفة بين الرغبة والخشية"، وضمن انتصاره للرغبة على الخشية أو للإرادة على الخوف، يطرح أمثلةً على تجاربه وتجارب أصدقائه تظهيرًا لمواقف الاتباع للحكمة وأثرها في إخماد جذوة المغامرة الحرة في الحياة، وأحيانًا أخرى في ضرورة تبنِّي الحكمة لإحداث التروي، وبالنتيجة لإنجاز التعقُّل المرجو من أي فعل، وهو إحراز المعرفة إراديًّا. فهو إذ يرى في الحكمة ثقافةً اتِّباعيَّة قاتلة، أو "زاد الفكر الكسول [مقابل الفلسفة التي هي] تحليل المركب وأشكلة البسيط وإعادة النظر والتدقيق..."[10]. إن الابتداء من القَلب إذًا، كما لاحظنا، يقتضي من حسام إفساح الرغبة وإخماد الخشية؛ أي إجراء المغامرة.
ومن خلال الأمثلة التي يضربها حسام الدين من حياته اليومية ومجتمع الأصدقاء الذي يكون فيه، يمكننا التماس شعوره الدافع للكتابة بالفرق بين الحكمة والفلسفة؛ "وعلى العكس من الحكمة القائلة «لا يتعلم الإنسان إلا من كيسه»، يمكن القول إنه من الممكن ومن الأفضل، عمومًا، التعلم من أكياس غيرنا، فثمن الاقتصار على التعلم من كيسنا فقط باهظٌ جدًّا، كما لا يمكن أن يتسع كيسنا لجميع الدروس الضرورية التي نحتاج إلى تعلمها"[11]. من خلال هذا التفاعل الاعتباري المضاد للحكمة السائدة، يمكننا التماس القصدية الواعية لضرورة الانفتاح على التجربة الراهنة، كما هي، والجرأة على الاشتراك في تقويمها والاستفادة من حيثيَّتها التي تخالف السائد أو العادي أو التقليدي المتذَهَّن كل الوقت.
وحسام الدين لا ينكِرُ المعارف السابقة على التجربة الحية، لكنَّه لا يقبل بأن تؤخَذَ المعلومات التي تحويها على عواهنها، ولا أن تكون تلك الأحكام المتقادمة، بمفردها معيارًا لكل جديدٍ حادث. لذا، نراه في المقالة الخامسة التي عنوانها "في التنميط والأحكام المسبقة" يؤكد أهمية وجود الفهم المسبق، بل ضرورته للمعارف المستجدة، لكنه يطلب "مراجعته والتفكير فيه، وليس به فقط، في سياقات كثيرة"[12]. هنا وإن كان الحديث يدور حول التقويم الأخلاقي للآخر في حدثٍ مفرد، إلا أن براعة المنهج التفسيري لظاهرة التقويم عينها، أو اجتماع التنميط بالحكم في لحظةٍ تأويليةٍ حضورية، فإن إمكان إحداث نقلة نوعية في مجال ربط الفكر بزمان الاستشكال الحي لمضمونه هو الأمر المثير من الناحية الفلسفية. استشكال لا يستثني تاريخية أنطولوجيا الفهم وما تراكم من فهوم مسبقة في أن تحضرَ بحكم الضرورة في التقويم الحدثي، أو في الحضور النقدي الواعي للذات في وضعية حيَّة. وهذا يؤدي إلى إمكان الخروج بموقف جديد يجاوز ما هو غير مجدٍ في الاعتبارات السابقة للفهم، ويؤسس لفهمٍ منفتح على اعتبارات راهنة، متولِّدة الآن، في فينومينولوجيا تأويلية توسطية قادرة على إبقاء التصوُّر راهنًا أو إبقاء القراءة فعلًا لا ينتهي. لذلك، بدت الحاجة عند حسام إلى ريكور فعليًّا، لتشريع موقفه الأخلاقي التوسطي التأويلي، الحر بالضرورة. لذا، حاول إيضاح وجهة نظر كلٍّ من غادامر وهابرماس ليظهر أصالةَ الجهتين في إنشاء الموقف النقدي الفاعل، ثم طرح الموقف الذي عدّه جمعًا بين رأيي الحكيمين، وهو موقف ريكور.
وطالما أن حسام أشار إلى القوس التأويلي عند ريكور، فقد رأينا من الضرورة بمكان العودة إلى هذا البُعد التأويلي التأسيسي عند ريكور في شرح العلاقة بين الزمان والسرد، أو بين الذاكرة القرائية والقدرة المحاكاتية التي تفتح الأفق التأويلي لإعادة إنتاج الفهم، أو لإبداع الفهم مجددًا، يقول ريكور: "لكن التأويليَّة (الهيرمينوطيقا) تهتم بإعادة بناء القوس الكامل للعمليات التي تزوِّد بها التجربة العملية ذاتها... ولذلك، فإن ما تراهن عليه هو العملية الملموسة التي يتوسط فيها التصور (configuration) النصي بين التصوير السابق (prefiguration) للحقل العملي وإعادة التصوير (refiguration) من خلال تلقي العمل... فنحن نتابع مصير زمن مصوَّر سابقًا يتحول إلى زمنٍ يُعاد تصويره من خلال وساطة زمن متصوَّر"[13]. إنه استئنافُ التصور السابق إذًا، بابتداء تصوُّر آنيٍّ حاضر نقدِرُ به على المرور إلى المستقبل؛ أي الحضور بالفهم الجديد في هذا الزمان العبوري الراهن.
وبعد هذا الشرح لإمكانيات الموقف التأويلي في إصدار حُكمٍ ما، يلتفت حسام الدين إلى مفهوم النمط المثالي عند ماكس فيبر وذلك لمعاينة ظاهرة تشكُّل المفهوم بما هو يتوبيا التصور المجرَّد للمعيش. وعلى الرغم من أن هذا النمط المثالي هو تنميط قصدي يتجرَّد فعليًّا من قلب الواقع الحي الملموس، إلا أنه قد يفارق إمكان العيش الممكن في التجريب، إذا ما بقي مغرقًا في المثالية. إلا أن هذه المثالية غالبًا ما تبقى على صلة بالواقع. لذا، فإنها تقيم حالة تصنيفية دائمة، تحاول موضعة المفاهيم التجريدية للشكل المثالي في المضمون التجريبي للنماذج المعيشة، "والأنماط المثالية بذاتها نادرًا ما توازي تمامًا الأمثلة المعقَّدة الموجودة في الواقع"[14]. وهذا بالضبط ما يشير إليه حسام في نقده، ليس ليدحض دورها بالمطلق، بل ليؤكد حضورها المشوب، والذي يتظهَّر في الموقف الأخلاقي الانفعالي الفردي. إذن هذه الأنماط المثالية هي مكوِّن لا بد من استحضاره في اللحظة الفينومينولوجية لإطلاق الأحكام والتنميط، لكن يمكننا بوعي يوتوبيتها أن نُعمِل التأويلية المجاوزة لها إلى أفقٍ أرحب؛ ذلك أنه "لا يمكن دحض الأنماط المثالية وتفنيدها بشكل مباشر إذا كان الواقع يتواءم معها ولو بشكل تقريبي"[15].
ما نريد تأكيده في هذا السياق، هو أن الموقف الأخلاقي لحسام الدين هو هذا التوسُّط الحر بين الدحض والمواءمة، وبين تجويز وصف موقف أخلاقي معين بأنه مفارق ويوتوبي، ولكن في الوقت نفسه يحدث وهو ممكن وضروري، كما يشرح بلغته.
أما في المقالة السادسة "في الأخلاق يمكن للتفكر تدمير المعرفة"، يقول: "يمكن للتفكر أن يدمِّر المعرفة الأخلاقية، بإظهار نسبيتها الزمكانية والثقافية، واختلاف المنظورات المعقولة التي يمكن تناولها من خلالها، وافتقار بعضها، على الأقل، إلى أسسٍ معرفية ومعطيات واقعية تسوِّغ تبنِّيها بعموميتها وشموليتها المظنونتين"[16]. نلاحظ في هذا السياق، الموقف الكانطي بارزًا في الاعتبار الحسامي لوضعية الإرادة الخيِّرة التي تقوم على التفكُّر في شروط الخيريَّة نفسها لتبقى إرادةً خيِّرةً. إن التفكُّر هو الذي ينقذ من الميول، إنها أخلاق الواجب إذًا، التي تبدأ من العقل التأسيسي العملي لهذه الإرادة الخيِّرة، التي لا يمكن أن تكتفي بالتأمل النظري وادِّعاء المعارف السليمة دائمًا أو الاكتمال، بل يجب المرور في معيش ديالكتيك طبيعيٍّ تشكيكي واجب لفهم أخلاق الواجب، "وهكذا يدفع العقلُ الإنساني المشترك، لا عن حاجةٍ إلى التأمل النظري (لا تعتريه أبدًا ما بقي مكتفيًا بكونه عقلًا سليمًا) بل عن دوافع عملية بحتة، إلى الخروج من دائرته والسَّير خطوة في حقل فلسفة عملية، لكي يحصل هناك على معلومات وتوجيهات واضحة تتعلق بمصدر مبدئها وبالتحديد السليم لهذا المبدأ، ومعارضة المسلمات التي تقوم على الحاجة والميل"[17]. هذا التوسط التأويلي الفينومينولوجي هو ما يمكِّنُ من الفرد من ممارسة الإرادة الحرة في الوجود الأخلاقي القويم المطلوب عيشُه بأمانةٍ وصدقٍ تامَّين يضمنان الانفتاح الدائم على الأخلاقية المثلى. يقول حسام: "لكن كما هو الحال في كل عملية بناء، يمكن أن يكون هذا التدمير مرحلةً موقَّتةً، أو خطوة ضرورية، للوصول إلى أخلاق أكثر انفتاحًا على الآخر... باختصار يمكن أن يجعل التفكر أخلاق الفرد أكثر أخلاقية"[18]. إذن، لا بدَّ من هذا التوسُّط الإرادي النافع من الناحية العملية في ربط الأحكام المعيارية التقويمية بالوقائع المصدِّرة للأفعال الحُكميَّة عينها. ويتحدث ريكور في شرح لهذه الحيثية القيمية، بأن "التوسط الرئيس بين مبدأ الخلقية وبين القرار الخلقي المفرد يكون باستعادة التقويمات المحايثة للبراكسيس في مجرى المداولة"[19]. إن اختبار الخيرية إذًا، لا يقوم على جانب شعوري عاطفي يميل إلى الخير، بل هناك ممارسةٌ تؤمِّن تقاطع الفعل مع المحتوى النظري للخيرية، لكي يتمَّ المرور من المعرفة الإيثيقية المتذهَّنة إلى المعرفة القانونية للإيثيقا الواجبة؛ لأنها صادرة عن هذا التقاطع الحر في الممارسة. فالسعادة ليست وجهة نظرٍ في السعادة، بل هي القدرة على توظيف الإرادة الأخلاقية الحرَّة في توجيه المبادئ الخلقية للتطبيق في حالات فردية أو خاصة، وهذا يتطلَّب الإقامة في مجرى التداول الحر للأخلاق؛ أي في العيش الإرادي للمعرفة المحايثة أو في معرَفِها، "وفي فكري، فإن الوظيفة الإبستيمولوجية لمَعْرَف الخيور الإنسانية الأساسية هي توفير التوسط الذي تنطلق منه الفرونيسيس ["الحكمة العملية"]، وينطلق منه الفرونيموس ["إنسان الفرونيسيس"] للمداولة في وضعيات مفردة، وبمحضر حالات جديدة"[20]. إنها الكينونة الأخلاقية التي تقوم على تفاعلية "المَوجِد (Dasein)" بالتعبير المحجوبي عن الكينونة الحدثيَّة؛ أي هذه المشهدية الراهنة للأخلاق في موضِعها، حيثُ تُمارَس. في هذه المحايثة تكون الممارسة هي الأخلاق الممكنة؛ أي هي ما يمكن للتفكر أن يجاوِز به المعرفة أو يدمرها عيشًا في سبيل بنائها، بحسب فهمنا للحالة الفردية مع حسام الدين.
يتحدث حسام في المقالة السابعة عن مجانية القيم، حيث يشرح هذه الحيثية النسبية التي على أساسها يمكن اختيار المصلحة بعقلانية تسوغها الظروف الشخصية والاجتماعية للفرد التي تتيح له هذا الاختيار الذي لا يمكن وسمه بالشر المطلق ولا بالخير المطلق. فالمسألة ليست "إما المصلحة أو المنفعة، وإما المبادئ الأخلاقية"[21]. إذن، هناك نسبية في الاعتبار الأخلاقي توجبها الظروف العملية التي تفسح أمام الفرد الكائن في وسط الحدث أن يمارس تأويليَّته الحرة لإجراء القيم في الواقع. مع العلم أن هذا ليس تلفيقًا أو تدجيلًا أخلاقيًّا لما هو شر، بل هو التفهُّم لممكنات تطبيق واقعي للأخلاق، وهو لا يخلو من التعقل، بل التأويل الصريح للاعتبار الأخلاقي، أو للضمير الأوَّلي المحايث. يقول نيتشه: "فتِّحوا العيون!: ما من ظاهرات أخلاقية البتة، بل ثمة تأويل أخلاقي لظاهرات ما وحسب..."[22]؛ أي ليس هناك أخلاق عالمية مطلقة، بل توجد سياقات ينوجد فيها الفرد تتكوَّن فيها أنساق تتغير وتتبدَّل باستمرار، وهو ما لا يتيح الحكم المطلق على سلوك الأفراد بأنه إما خير وإما شر، بل هناك ما وراء يحضر في كل فعلٍ حدثي راهن. وربما قصدية نيتشه في قوله "فتحو العيون" تُفهمنا عيانية الظاهرة المفحوصة؛ أي التزام تفسيرية الحدث بممكناته المرهونة في أنه أرضيَّة محايثة، بل مَوجِدُ ابتداء.
خلاصة
الحكيُ يطول لمنمنمات حسام، وخاصة هذا الفصل الذي يحوي اثنتي عشرة مقالةً أخلاقية، أمكنَتْه ممارسةَ ما وصفت به تنبُّهاته الفلسفية الضمنية؛ أي تقريح الفلسفة. فهو يتألَّم لقروح هذا الواقع، ويدلِّلُ على الشوائب، ثم يبادِرُ بموقفٍ معيش يتأوَّلُ به ممكنات القيم. إنها المشهدية المعيشة المفتوحة على التأويل. لذا، كان التوسط الفردي للشخص ضرورةً في إفهام الجانب العملي، بل الواقعي من القيم الأخلاقي. وبالنتيجة إن ما فهمته في هذا المرور المتأني بين مقالات حسام هو ترك الجرح ينزف حتى نفهم لماذا انجرح صاحبه، وما الذي يجرح مجددًا، وكيف يتعامل مع جره. إنها منمنمات، تلتفُّ وتجتمع إنفاذًا لانهمامٍ كليٍّ بتفسير معيشٍ أخلاقي صريح، يستدعي الاستشكال الدائم محاولةً في رفعه لما هو فلسفيٌّ في تأويل مراميه.
د. ميادة كيالي:
شكرًا د. خالد على مداخلتك الفكرية القيّمة، وقد لفتني مصطلح "تقريح الفلسفة" عند د. حسام، و"فيلسوف من القلب". في الحقيقة، استمعنا اليوم إلى عدة مفاهيم: أشكلة السؤال، تقريح السؤال، نمنمة السؤال. وسبق أن قال الدكتور أحمد البرقاوي إنَّ حسام ليس تقميشيًّا؛ بمعنى أنَّه يُبدع ويصكّ مفاهيمه ومصطلحاته بحرفية عالية، ويجبلها بواقع وبمشاهد حيّة من لحم ودم، وبنكهة مرحة لا تفارقه. ربما لهذا السبب أصبح "فيلسوف القلب"، على حدّ قول د. خالد.
والآن، بعد أن استمعنا إلى هذه القراءات النقدية المتنوعة والعميقة لكتابَي، د. حسام، التي فتحت لنا نوافذ متعددة على مضامينها وأسئلتها، ننتقل إليك لتُعلّق، وتفتح بدورك باب النقاش والتفاعل، كما اعتدنا عليك دائمًا: محاورًا يُنصت، يُجادل ويُضيء، ولا يُغلق.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا جزيلًا على جميع المداخلات، لقد غمرتموني بلطفكم نقدًا وعرضًا، وبكلّ الأشكال، فشكرًا لكِ دكتورة ميادة.
دعيني أبدأ بسرعة من عبارة أن الواقع تجاوز النصوص. وأودّ أن أقول إنني أرى أن أقول إن للكتاب عن الثورة السورية قبل عام 2024، أو قُبيل انتهاء 2024، ميزة خاصة؛ إذ إن كثيرين أعادوا قراءات أو قدّموا أشياء. انتهت الثورة، وكان الناس، في تلك الفترة، يسخرون ممن يقول إن الثورة لم تنتهِ بعد، بوصفها حدثًا تاريخيًّا، لكنهم بعد ذلك، قالوا إن ما حصل هو من نتائج الثورة.
إذن، الكتابان، خصوصًا كتاب "درويش بين القدر والمصير" يتضمنان نوعًا من "الحساب النهائي" مع الثورة، قبل أن تقع أحداث عام 2024 أو في نهايته. وهنا، أعني أن هذه الكتابات تتناول قراءة للتاريخ اللاحق وما يحدث الآن، وهذا لا يزال يحتاج إلى وقت للتفكير وإنتاج المعرفة.
سأقتصر، بطبيعة الحال، على بعض الملاحظات التي سجلتها، فربّما أحتاج إلى ساعات طويلة للتعليق عليها كلها؛ لذا، سأركّز على بعض النقاط فقط.
دعيني أركّز، د. نزهة، على مسألة السيرة الذاتية؛ من ناحية أولى، السيرة الذاتية ليست مجرد سرد لحياة شخص، بل هي معنى كامل بالنسبة إلى أيّ شخص. فلكل شخص سيرة، وهي تخلق المعنى. يُقال إن حياة الشخص لا تكون ذات معنى، إن لم تكن اشبه بحكاية أو رواية. وكما نعلم، في الحكاية أو الرواية تتداخل الأحداث وتتمفصل، وتصاغ لها بداية ونهاية، ويُستنبط منها معنى من خلال إسقاط تاريخي يمتد من الماضي والحاضر إلى آخره. لكن حين تكون السيرة الذاتية موجّهة إلى العموم، فإنها لا تكون ذات معنى إلا إذا حملت معنًى للآخرين؛ أي إنها تتجاوز الذات. كل حدث في حياة أي شخص له معنى وأهمية، لكن ما دلالته بالنسبة إلى الآخرين؟ ما أهميته لهم؟ بهذا المعنى، لا تكون السيرة الذاتية ذات معنى، إن بقيت مجرد سيرة ذاتية، بل تصبح سيرة يمكن أن يتقاطع فيها أي حدث مع حياة أي شخص. ومن هذا المنطلق، كانت المحاولة، حين تحدّثت عن شخصي، ومحاولة ربطها بأفكار أو قيم أو أحداث أو سياقات تتجاوز الفرد الواحد.
سأتناول لاحقًا مسألة حدود النقد، لكن دعوني الآن أعلّق على ما ذكره الدكتور وائل حول مسألة استحضار الآخر. كما قلنا، السيرة الذاتية لا تكون ذات معنًى، إن انغلقت على الذات، بل لا بد أن يُستحضر الآخر، أو أن يُحضر بطريقة أو بأخرى. أعني أنه ينبغي أن يكون لما أقوله معنًى، وأن تكون له دلالة خاصة به، سواء في المعرفة أو في الأخلاق، التي تقوم - من وجهة نظري - على استحضار الآخر. فالأخلاق، في جوهرها، لا تقوم بين "الأنا" و"الأنت" فحسب؛ فالعلاقة بين الأنا والأنت قد تكون علاقة سياسية تقوم على التفاوض: أنت تقبل، أنا أتنازل، وهكذا. لكن الآخر الغائب، غير الحاضر، إن لم يُستحضر، ولم يُؤخذ في الحسبان، فهنا تكمن المشكلة. والأمر نفسه في المعرفة، لنقل إن الفلسفة أصبحت أقرب إلى العلم في هذا الجانب؛ لم يعد الأمر مجرد أن أقول ما أقول، أو حتى أن أقدّم له الحجج، بل ينبغي أيضًا أن أستحضر الحجج المضادة؛ أي أن آخذ بعين الاعتبار الآخر الغائب، الذي يقول. ومن دون ذلك، يصبح الحوار، بمعنى ما، حوار طرشان، ولا يكون لا فلسفة ولا علمًا. فاستحضار الغائب، في رأيي، يدخل في إطار ما يمكن تسميته "النزاهة". فإذا عرّفنا العدالة، في أحد تعريفاتها، بأنها الإنصاف؛ أي إعطاء كل ذي حق حقه، فذلك يعني أنه مهما كنّا مقتنعين بكلمة أو فكرة أو حجة، علينا أن نُقرّ بوجود "آخر". هذا الآخر ربما... وقد قلت سابقًا إنني رغم سنواتٍ طويلة قضيتها في التأويل والفهم والهيرمينوطيقا، فإن التفكيك جذبني لاحقًا؛ لأنه يرى دائمًا أن الآخر لا يُفهم تمامًا، ولا يمكن اختزاله ضمن فهمنا أو معرفتنا أو ما نألفه. دائمًا هناك "آخر"، لا بمعناه الصوفي الباطني، بل آخر وجودي، ليس أنا، وليس مجرد "أنا أخرى". وربما هذه هي المفارقة.
كثيرًا ما يُقال إن الفلسفة هي بحث عن الحقيقة. وفي كتاب يتناول الفلسفة من منظور نقدي، هو "البحث عن اليقين" لجون ديوي، يمكنني أن أقول: دخلت الفلسفة بحثًا عن الحقيقة، لكن الحقيقة لم تخرج منّي. أنا خائف من الحقيقة، وأهرب منها، إذا كانت الحقيقة تعني اليقين، والرؤية الأحادية، تلك التي - كما قال ماهر - تمنحنا راحةً زائفة وتنهي التساؤل. لذلك، أنا أخاف من هذه "الحقائق" وأتجنّبها، وإذا أردت أن أقدّم رؤية نقدية لها، فإنني - بهذا المعنى - أتفق مع ماهر: إذا أرادت الفلسفة أن تعيش، فعليها أن تقلّل من حقائقها قدر الإمكان، ومن إجاباتها كذلك.
أعود إلى مسألة "الإجابة الفلسفية"، لكن دعني أولًا أشكر الدكتور سهيل على هذه القراءة. فلأقل، كما قال محمود درويش لمن سأله عن معنى قصيدته، فأجابه: "معنًى جميل، لكنني لم أقصده." لم أفكّر بهذه الثنائيات: الفلسفة والمصير، أو الفلسفة والقدر، أو الفلسفة والثورة. لكنه تأويل جميل. وإذا استعدنا ما قاله بوانكاريه: "الحقيقة لا يمكن إلا أن تكون جميلة، وكل ما هو جميل يجب أن يكون حقيقيًّا"، فإن ذلك لا يعني فقط تطابقًا بين الحقيقة والخير كما عند أرسطو أو أفلاطون.
هل الثورة مصير نحدده نحن؟ أم إنها أشبه بقدر تبدو أشبه بسيل جارف؟ في رأيي، كانت الثورة في سوريا اشبه بالقدر. لم يكن الناس، بمعنى ما، قد قرروا وخطّطوا ووعَوا ما سيفعلونه، لكنهم بلغوا حدًّا لم يعد ممكنًا فيه احتمال الواقع القائم، ولا السكوت عنه. لم يكن ذلك نتيجة إيمان نظري بما يجب أن يكون، ولا قناعة بجدوى الفعل، بل لأن الفعل، حتى إن بدا بلا جدوى، كان له معنًى وقيمة. وهنا علينا أن نُميّز بين أن يكون للفعل معنًى، وأن تكون له جدوى.
وبالنسبة إلى السؤالين: هل يمكن التفكير في المصير الجمعي خارج إطار مفهوم الثورة؟ في رأيي، لا يمكن فقط، بل يجب ذلك. فبعد الصورة الوردية التي أُضفيت على الثورة، أو على مفهوم الثورة في الثقافة العربية عمومًا – كما تعلمون، كان يُطلق على الانقلاب اسم "ثورة"، وحتى الأمور السلبية، بل حتى في سوريا كان يرفض أن تكون الثورة – أظن أن ما حصل لاحقًا بيّن أن للثورة أثمانًا باهظة، وأنها ليست ذلك الواقع الجميل.
لهذا السبب، يمكن القول إن هناك مفكرين أيّدوا الثورات، لكنهم ظلوا يؤكدون دومًا أن الإصلاح هو الضروري، وحتى إن حصلت الثورة، فإن الإصلاح التدريجي يظل ضروريًّا. وعندما أقول "قدر"، فماذا تعني الثورة؟ إذا عدنا إلى تعريف المفهوم، فهي خروج على النظام ومن النظام؛ أي على النظام بمعناه الواسع. فعندما لا يكون بالإمكان إحداث إصلاح، ولو تدريجي، ضمن النظام، وعندما يُفقد الأمل، لا بمعنى الإيمان بإمكانية الأفضل، بل عندما يُفقد الأمل ذاته، هنا نقول إن اليأس هو الدافع، لكن ليس اليأس العدمي، بل اليأس الذي يحمل معنًى.
لذا، نعم، يمكن، بل يجب أصلًا، والثورة لا ينبغي أن تكون، طالما توجد إمكانيات أخرى: إمكانيات للتحسّن، للتغيير، للإصلاح، للحوار. لكن أحيانًا، يكون التغيير لواقع سيئ إلى درجة أننا نصل، كما يقول سارتر، إلى أبواب موصدة أو جدران مغلقة. وهنا، يصبح من الضروري القيام بهذا الفعل التدميري. وفي هذا السياق، أقول إن الثورة، في مثل هذه الحالات، فعل تدميري، تدمير لهذا الجدار أو لهذا الأفق المسدود أو لهذا الطريق الذي لا يفضي إلا إلى نتائج سلبية.
أنتقل الآن إلى السؤال الثاني، وقبل ذلك، أشرح لماذا أقول إن الثورة، في هذا الحالة هي فعل تدميري. حتى في نظريات العدالة، هناك اتجاهان: هل ندرس العدالة أو مفهوم العدالة أو واقع العدالة، انطلاقًا من مفهوم نظري أو تأطير نظري لماهية العدالة، ومن ثم ندرس، إلى أيّ حد يقارب الواقع أو لا يقارب هذا المفهوم، بعيد أو غير بعيد، أم إن هناك طريقًا آخر؟ أنا أرى أنه في هذه الحالة، هو الأدق. ننطلق من واقع الظلم، من واقع اللاعدالة، ومن ثم نرى كيف يمكن تجاوز هذه الموانع أو العقبات أو الأشكال السلبية التي تتسبب في هذه اللاعدالة حسب رأيي، الثورة إذا انطلقنا من الرؤية الثانية، هي نتاج وضع سلبي جدا لإنتاج واقع ظالم أكثر من أنها تنطلق من مفهوم ناجز مسبقا عن ماهية الحرية أو الديمقراطية أو العلمانية أو الدولة؛ فهي مرتبطة بواقع عملي أكثر ما هي بتأطير نظري على الأقل، عندما نتحدث عن الثورات العربية.
الآن، إلى أي مدى يمكن للثورات أن تبقى تحررية من دون أن تفضي إلى ثورات حرية؟ دعني أقول: إلى حدٍّ كبير، فهذا الأمر لا يتعلق فقط بوعي الناس وتوجّههم في هذا الاتجاه أو ذاك. فمثلاً، في حالة الثورة السورية، إذا سلكت طريقًا معينًا، فهذا يرتبط بعاملين:
بعد سقوط النظام، شدد بعض الناس كثيرًا على العوامل الخارجية في سقوط النظام الأسدي، لكنهم عندما كانوا يتحدثون قبل أربع عشرة سنة الماضية، فترة ما قبل عام 2011، كانوا يتحدثون عن عدم وعي الشعب، أو عدم قدرته، أو عدم فهمه؛ بمعنى أن الفشل كان يُنسب إلى الشعب، بينما النجاح كان يُنسب إلى العوامل الخارجية. مع أن العوامل الخارجية في الفترة الماضية، لم تكن أقلّ قوّة وتأثيرًا، ولو اختلفت العوامل الخارجية، لكان من الممكن أن تختلف الأمور كثيرًا. ما أريد قوله هنا هو أننا حين نتحدث من حيث المبدأ، فإن الثورات التحررية قد تفضي إلى ثورات عنفية أو تعيد إنتاج الاستبداد بأشكال مماثلة، إن لم تكن أسوأ. هذا من حيث المبدأ، من حيث الفعل، فالأمر مرهون طبعًا بعوامل داخلية وأخرى خارجية. فالعوامل الخارجية، كما تعلمون في الحالة السورية، هناك من يعتقد أن الوضع السيئ في سوريا ناتج عن التاريخ، وأن سوريا ضحية للتاريخ، لما فيها من تنوع واختلاف إثني، وطائفي وديني. لكنني أرى أن سوريا، بهذا المعنى، هي أكثر ضحية للجغرافيا، وبالضبط للجغرافيا السياسية، وكونها محاطة بعوامل مؤثرة. وهذا العامل، في رأيي، أشدّ تأثيرًا من العامل التاريخي.
لكن إذا أردنا أن نركّز على العامل الداخلي، فأقول إن الوضع الحالي يجعل من غير المجدي تكرار القول: "كما تكونوا يُولّى عليكم". إن كان لهذا القول معنى، فهو الآن موجود. الآن صار لفاعلية الناس، لقولهم، لحركتهم، لنشاطهم - سواء كان سياسيًا أو غير سياسي- معنًى وجدوى. سابقًا، كان المعارض السياسي، أو أيّ فعل معارض، أشبه بمنتحر؛ إذ لم تكن له جدوى للمعارضة السياسية، بل فقط لتحقيق المعنى.
وأنتقل هنا إلى ما قاله الدكتور قاسم، حين ميّز بين نوعين من الأخلاق: أخلاق الفعل وأخلاق أخرى. ويمكن هنا الاستشهاد بالتمييز الذي أورده ماكس فيبر بين "أخلاق القناعة" و"أخلاق المسؤولية". إلى أي حد في أخلاقنا، ينبغي أن ننفّذ قناعاتنا بغض النظر عن النتائج المترتبة عنها؟ أم ينبغي أن نأخذ في أفعال ناس، وأنا أفكر قريبًا أن أكتب مقالًا عن الموضوع، يسعون إلى الطهارة الذاتية؛ أي أن أكون طاهرًا أخلاقيًّا، متبرئًا من الشرور ومن الأشياء، لكن كما قلت، الأخلاق هي علاقة مع الآخر، لا مجرد علاقة مع الذات. ليست الغاية أن أكون بريئًا أو طاهرًا فقط. ولهذا السبب، أرى أن الأخلاق، رغم أنها قائمة على القناعة، إلا أنها بالدرجة الأولى أخلاق مسؤولية.
بالنسبة إلى "منمنمات"، فعلى حد علمي، لا يُستخدم فلسفيًّا كتسمية أو تصنيف، لكنه يُعرف في سياق المنمنمات التاريخية عند سعد الله ونوس. فهي انتقال من الفنون التشكيلية كالرسم والتصوير إلى النص المسرحي، الذي يبقى بدوره فنًّا. وكما نعلم، الفلسفة غالبًا ما تقع بين قطبين: قطب النصوص المطوّلة جدًّا التي قد تمتد إلى آلاف الصفحات، وقطب آخر هو الأسلوب النيتشوي، الذي يقوم على "الشذرات". وهذا في رأيي، أحد هواجسي. أنا لم أدخل الفلسفة ترفًا أو عبثًا، وإنما دخلت الفلسفة لأتفاعل مع قضايا تهمّني، هي البحث عن حقائق حاولت الوصول إليها من خلال طرائق أخرى، كالتصوّف، أو دراسة الدين، أو الحوارات الاجتماعية. لكنني دخلت الفلسفة؛ لأنني مشغول بأسئلة.
وهنا سأنتقل إلى مسألة الأسئلة والإجابات، مع العزيز ماهر. أول شيء يمكن قوله: إن قيمة الأشياء، أو الأشخاص، أو الأفكار، لا تتبيّن إلا من خلال المقارنة. وهذه مسألة أحاول الآن معالجتها مع ابني. ابني يحصل على المرتبة الأولى، لكنه لا يريد فقط أن يكون الأول، بل يريد أن يتفوق على غيره، أي يريد للآخرين أن يكونوا في مستواه أو دونه، حتى تكتسب المرتبة الأولى قيمتها. وبالنسبة لي، أرى في ذلك مشكلة: أن تُستمد القيمة من التفوق على الآخر، في حين أنه يمكن أن تكون القيمة ذاتية. وكما لاحظتم في النص الذي دفعني إليه النقاش، أنا لم أقلّل من قيمة السؤال الفلسفي، بل قلت إنه يتمتع بمركزية. وحتى حين رفعت من شأن الإجابة، قلت إنها تضاهي السؤال أو تقاربه، لكن يبدو أن هذا استفزّ البعض؛ لأن في ثقافتنا هناك مركزية للسؤال وأولوية له، حيث لا يكون الأول إلا إذا كان هناك ثانٍ. أما إذا كانا اثنين في المرتبة الأولى، فعلى من يتفوق الأول؟ كأننا بحاجة دائمًا إلى "شعب نحكمه"، أو طرف نحكم عليه. هذه ملاحظة، وأكرر أنني لا أقلّل من قيمة السؤال الفلسفي، لكن في الوقت ذاته، السؤال الفلسفي لا ينبثق من العدم، ولا ينطلق من فراغ. وأنا أتفق مع ماهر على تمييز السؤال الفلسفي عن غيره من الأسئلة، لكن أيضًا، السؤال الفلسفي ليس نقطة بداية، بل يتضمّن مسبقًا مشكلات وإجابات وأنماطًا سابقة.
فعندما نقول إن الفلسفة تُقلقنا أحيانًا بسؤال مثل: ما العدالة؟ فهذا السؤال لا يُطرح من فراغ، بل يتضمن مشكلات وصورًا وإجابات موجودة. والمشكلة تظهر حين يُطرح هذا السؤال في سياق تهيمن فيه إجابة واحدة. خذوا مثلًا كتاب الجمهورية لأفلاطون، أحد أعظم كتب تاريخ الفلسفة "الجمهورية"؛ ينقسم إلى قسمين: في القسم الأول، مساءلة الإجابات الموجودة، وكلما تقدم إجابة تنقد، بوصفها ناقصة. فهو يريد أن يحصل على إجابة ماهية العدالة. وفي القسم الثاني، يقدّم أفلاطون إجابته. وأفلاطون يُؤرخ له ليس بأنه سأل "ما العدالة؟" إلا بالتاريخ التقني، وإنما ساءل وقدم إجابات. هذه الإجابات، قد تكون بالنسبة إلى الآخرين- وخصوصًا من يشتغل بالفلسفة - لا تُعد نهائية، ولا ناجزة، ولا حقائق مريحة. كلنا قرأنا أفلاطون، وأظن أننا لم نشعر بالارتياح، بل ازداد التوتر والأسئلة والاضطراب في المعنى والمعرفة. ومع ذلك، فإن أفلاطون قدّم رؤيته للعدالة بعد بحث وتفكير. وبخصوص "الارتياح"، أعتقد أن الفيلسوف وحده هو المرتاح، خلافًا لما يُشاع. كما تحدثنا سابقًا أنا وماهر، الفلاسفة أكثر دوغمائية مما نظن، وأقلّ فلسفية مما نتوقع. كثير من الفلاسفة، وأكاد أجزم أن معظمهم، قدّموا الفلسفة بطريقة مناقضة للفلسفة ذاتها، كما أعتقد. الفلسفة هي سؤال، وتعدديّة. انظروا إلى هيغل، مثلًا، الذي قدّم الحقيقة على انها شيء لا خارج عنها. حتى من عارضه، اعترف أنه لا يمكن الاعتراض على هيغل إلا من خلال هيغل نفسه. الرجل كان "مرتاحًا". سؤال "الشيء في ذاته": هل يمكن معرفته؟ أجاب اثنان بالدوغمائية نفسها. أجاب كانط، قائلاً: كلا، من المستحيل. لا نملك الإمكانيات لمعرفة الشيء في ذاته. ردّ عليه هيغل: من أسهل الأشياء، معرفة جوهر الشيء في ذاته! وكلاهما أجاب بثقة مفرطة.
أما ماهر، حين يطرح السؤال، فلا يستكين لإجابة نهائية، لا تلك ولا هذه. وهذا هو ما يجب أن يفعله الفيلسوف. فعندما تصبح الإجابة ناجزة، تتوقف عن أن تكون فلسفة، وتتحول إلى عقيدة. ونعرف كيف تحوّلت الفلسفة. أنا لا أقصد بالإجابة هنا موقفًا محددًا، بل أقصد أن هذه الإجابات ينبغي أن تثير أسئلة جديدة. فالأسئلة تنطلق من هذه الإجابات أيضًا. حين نسأل: ما العدالة؟ الإجابات التي قدّمها أفلاطون، العدالة والحق، العدالة والحرية، العدالة والاختلاف... العدالة وغيرها، تُطرح من خلال الإجابات، وليس فقط من خلال الأسئلة. دعني أقول إن التفلسف هو بحث عن إجابات، كما هو تقديمٌ لها. وأريد أن أكرر هنا أنّ تقديم الإجابات لا يقلّ أهمية، من حيث المضمون والتأثير والتاريخ والفاعلية، عن الأسئلة الفلسفية.
لكن كما أردتَ أن توضح، أن الحديث هو عن الأسئلة الفلسفية، وأنا أتحدث عن الإجابات الفلسفية، وربما تكون إجابات بعض الفلاسفة غير فلسفية. ولهذا ينبغي أن نُميّز. مثلًا، هايدغر، يُعدّ فيلسوفًا، بل ربما أكثر من اللازم، إلى درجة أن البعض يرى أنه لا يمكن أن يفهم، وهذا في ألمانيا، موطن هايدغر. لكنه عندما قال إن هناك لغتين فقط تعكسان الوجود، هما اللغة اليونانية واللغة الألمانية، ففي هذا القول قدرٌ كبير من السذاجة، ومركزية ثقافية لا مبرر لها. هل يعرف كل اللغات؟ حتى لو كان يعرفها، فهل يملك أن يحكم على هذا النحو؟ هذا ينطوي على نزعة قومية واضحة، رغم عمقه الفلسفي ومكانته المهمّة، على الأقل من وجهة نظر الكثيرين، وأنا منهم. ومع ذلك، ثمة إجابات وأفكار لا فلسفية.
تحدث الدكتور قاسم عن بعض الإجابات. وبرأيي، أن أحد تعريفات "الإجابة الفلسفية" هو أن تكون عابرة للتاريخ. فإذا كانت هناك إجابات قدّمها الكندي، أو الفارابي، أو كانط لم تعد ذات قيمة اليوم، فهي ليست فلسفية أصلاً. من أهمية الإجابات الفلسفية أن تكون عابرة للتاريخ، حتى الآن يمكن أن يكون لكتاب أفلاطون قيمة، رغم كل ما طرأ من تطور. بهذا المعنى، نقول إن للفلسفة عناصرَ عابرة للتاريخ، لا بمعنى أنها لا تاريخية، طبعًا أفلاطون مشروط بمعرفته، وتحدث عن واقعه، لكن ثمة أشياء عابرة للتاريخ. وبهذا المعنى، ربما تكون هذه من أهم المسائل في الفلسفة. واستخدم الدكتور قاسم تعبيرًا، وهو أكثر من أطلق أسئلة، بغض النظر عن كونها فلسفية أم لا، لكن دعني أركّز على مفهوميْ الفهم والتفسير.
قال دلتاي إننا "نُفسّر الطبيعة، ونفهم الإنسان". فالتفسير للطبيعة، والفهم للإنسان. لكن، برأيي، سأعيد ربط الفهم والتفسير بمفاهيم القدر والمصير والفعل والحدث. أرى أن التاريخ الإنساني هو دائمًا حصيلة ما سماه بول ريكور بـ"المتناهي واللامتناهي"، أو ما يمكن تسميته بالقدر والمصير. فلا يمكن فهم الإنسان فقط من خلال وعيه أو غايته أو إرادته؛ نعم، نفهمه من هذه الزاوية، ولكن هناك أشياء تُفسّر أيضًا. هناك قدر وضعه في هذا الموقع، في هذه الظروف. وهذه -برأيي - من أهم الثنائيات، ليست في العلوم الاجتماعية فحسب، في العلوم الاجتماعية يسمونها ب: ثنائية البنية والفاعلية، أو ما يُعرف بالـ structure and agency؛ هناك بنية تحكمنا، ظروف موضوعية لسنا فاعلين فيها، تؤطرنا وتقيّدنا جزئيًّا على الأقل، وهناك في المقابل إرادة إنسانية وفاعلية. مثلًا، في مسألة التوقّع: لماذا التوقّع غير دقيق في العلوم الإنسانية؟ لأن الشخص، بمجرد أن يُخبَر بالتوقّع، قد يغيّر رأيه لمجرد رفضه لهذا التوقع. لهذا، فالتاريخ - كما قال العزيز قاسم - هو دومًا جدل بين فاعلية الذات من جهة، والبنية الموضوعية من جهة أخرى.
دعني أنتقل إلى مسألة الحوار والاختلاف؛ أصبح الاختلاف مسألة بالغة الاستخدام حتى إن البعض صار يحذّر من الحديث عنها. لكن: ما هو الاختلاف الذي يمكن التحاور معه؟
جرى حديث مع صديقتي الألمانية، وكان هناك اختلاف كبير في وجهات النظر، في الحديث عن فلسطين، والوضع في غزة، وإسرائيل، إلى آخره. وهنا، دعوني أبوح بشيء: أعتقد أن المختلفين جذريًّا، لا توجد إرادة حقيقية للحوار بينهم. فقد سألتُ مرة في أحد الحوارات، في لقائي الأخير مع العظم، عن جدوى أو معنى الحوار مع أدونيس، مثلاً؛ إذ من الواضح أنه لن يكون هناك حوار، بل ربما سجال أو مناظرة، فما الجدوى إذن؟ عندها، نبّهني إلى أن الحوار في المجال العام ليس حوار أفراد يهدفون إلى إقناع بعضهم البعض، بل هو حوار لعرض هذه الحجج أمام آخرين قد يستفيدون منها، يردّون عليها، أو يبنون عليها. فبهذا المعنى، الحوار ليس للإقناع، بل لعرض الحجج بأقوى صورها الممكنة. فأنا، في حواري مع الألمانية، رغم أنني أوضحت منذ البداية أنني لا أتحدث بوصفي عربيًّا أو سوريًّا أو مسلمًا، بل من منظور إنساني، إلا أنني شعرت أنني أعبّر عن وجهة نظر كثيرين، أراها جديرة بالحضور في هذا السياق، السياق الألماني، حيث وجودها ضعيف لأسباب عديدة، بعضها مخيف. من هنا، أعتقد أنها تستحق أن تُستحضر.
أعود هنا إلى مسألة القناعة والمسؤولية؛ فبغض النظر عن قناعتي بجدوى الحوار من عدمه، أحيانًا يكون الأمل ليس فيما نعرفه، بل فيما لا نعرفه. بدلاً من أن نحكم مسبقًا على جدوى الاختلاف، أرى أنه طالما توجد إمكانية لتبادل الرأي بحدّ أدنى من النزاهة والود والاحترام، فيجب أن نجرّب ذلك، حتى لو بدا الاختلاف غير قابل للتصديق. في بعض الندوات عن سوريا، كان هناك مشاركون مؤيدون للنظام، وكنت أتساءل: كيف يمكن لشخص أن يظل حتى الآن مؤيدًا لنظام البراميل؟ ومع ذلك، كان النقاش يدور حول أنه إذا توفر حدّ أدنى من الرصانة المعرفية والأصول الفكرية، فيجب أخذ ذلك بعين الاعتبار.
أما عن الكتابة، فأقول إنها ليست مجرّد تقرير لإجابات مسبقة. الكتابة ليست، في رأيي، تدوينًا لمعارف جاهزة. عندما تتحول الكتابة إلى مجرد تدوين للمعرفة، تصبح شيئًا آخر، لا علاقة له بالكتابة المنتِجة. الكتابة لا تُنتج المعرفة فقط، ولا تعبّر عن حقائق مسبقة، بل هي محاولة للتفكير بصوت عالٍ، للتعبير أحيانًا عن القلق والتوتر. لسنا مضطرين إلى أن نحمل حقائق ناجزة أو عقائد مسبقة لنفكّر. أقول إنني أستمتع بهذه الكتابات، وأشعر بانزعاج حقيقي من الكتابات التي تُقدَّم كحقائق خالصة، نهائية، كأن الكاتب "مرتاح"، كما قال ماهر، وهذا ما لا يريحني. فثمة شيء غير مريح مع الراحة.
حدث لي مرة أنني كنت في نقاش مع شخص، وقلت له: "أنا مرعوب من اليقين الذي أشعر به. طالما أنني مصيب تمامًا في كل شيء. ساعدني أن أرى الجانب الذي أخطأت فيه؛ لأنني غير قادر على رؤية الخطأ في هذا الجانب أو في هذا الجانب." كنت خائفًا من هذا اليقين؛ لأنه لا يترك لي مساحة للشك أو لإمكانية الخطأ، وهذا، برأيي، خطر حقيقي. وعندما كنت أتحدث مع شخص ما، طلبت منه أن يساعدني في الخروج من هذه الحالة التي أرهقتني كثيرًا؛ إذ لم أعد قادرًا على استيعاب وجهة نظر الآخر، وأن أُقرّ بإمكان أن يكون هو على حق. وبهذا المعنى، أستطيع القول إن الهروب من اليقين هو الكتابة، أكثر ما هو بحث عن اليقين. وعلى عكس ما هو شائع، أقول إن يقين المؤمن أكثر قلقًا من قلق غير المؤمن؛ فالشخص الذي لا يحمل يقينًا مطلقًا قد يتعامل بهدوء أكبر، أو باستيعاب أكبر مع قلقه؛ فبهذا المعنى، وبمعنى النقد الكانطي أو الريكوري هي إدراك المحدودية أيضًا، فهي لا تقتصر على إدراك ما يمكن للإنسان أن يعرفه أو يقوله أو يفعله من حقائق وقيم، بل تشمل كذلك إدراك للمحدودية. وهذه المحدودية هي معرفية، وقد تختلف من مكان إلى آخر، ومن زمن إلى آخر. وهنا أعود إلى ثنائية البنية والفاعلية، أو القدر والمصير.
شكرًا جزيلًا مرة أخرى، فأنتم تفضلتم عليّ بنقاط كثيرة أكرمتموني بها، وسأكون أنانيًّا قليلًا في أن أحتفظ بها لنفسي أو لمناسبات لاحقة. شكرًا جزيلًا لكم.
د. ميادة كيالي:
شكرًا جزيلًا، د. حسام، على هذا التعقيب الغني، الذي أضاء لنا أبعادًا إضافية لما قرأناه وناقشناه. والآن، وقبل أن نفتح باب الأسئلة من الحضور، اسمح لي، د. حسام، أن أطرح عليك سؤالًا ينبثق من العنوان نفسه، ومن عمق تساؤلات الكتاب: كيف تفهم أنت "القدر" في سياقك الفلسفي؟ هل هو قيد مفروض سلفًا، أم مجال مفتوح للتأويل والتفاوض؟ وهل يتحكم القدر بالمصير فعلًا؟ أم إننا، في لحظة ما، نستطيع أن نعيد كتابة مصائرنا؟ هل نملك حرية الاختيار؟ وإن كنا نملكها، فإلى أي مدى؟ وتحت أي ظروف يمكن للحرية أن تُمارس بشكل فعلي لا وهمي؟ سؤالي في جوهره: هل القدر يُغيّر؟ وهل المصير يُصنع؟
هذا سؤالي لك، وسأضيف سؤالين من الحضور:
الأول من الدكتورة هبة محرم، التي أثنت على المداخلات، وتمنّت أن يتم التطرّق إلى الفلسفة الإعلامية، وأضافت سؤالًا تقول فيه: هل يخلط بعض الفلاسفة العرب المعاصرين بين الفلسفة الغربية والعربية؟ وإذا كان الجواب نعم، فهل يمكن أن تعطينا مثالًا على ذلك؟
أما السؤال الثاني، أو لنقل التعليق، فهو من الباحثة في مرحلة الدكتوراه من تونس، السيدة روضة الدرواز، تقول فيه: "الإشكال في استيعاب مفهوم الثورة في صفّ الشعب؛ لأنّ الثورة الحقيقية تدفع إلى رسم طريق جديد ينهض بالمجتمع سياسيًّا، واجتماعيًّا، واقتصاديًّا، وفكريًّا، وثقافيًّا، لكن ما حدث في سوريا أو غيرها من الأقطار العربية كانت حالة ثورية نتجت عنها فوضى وتدمير لمفهوم الدولة والحرية والعدالة والتنمية. والثورة، منطلقاتها تكون من أهل الأرض، لا من الخارج."
د. حسام الدين درويش:
في الفلسفة، هناك ما يُسمّى أحيانًا باﻟ "ترنسندنتالي"؛ بمعنى أنه لا معنى للشيء، أو لا إمكانية لوجوده، من دون وجود هذا الشيء. دعوني أقول: إذا كنّا، بالفعل، على طريقة "صخرة سبينوزا" - كما شبّه سبينوزا – وهي صخرة موجّهة بالجاذبية وبقوة الدفع، وتظن أنها حرّة، وأنها متوجهة نحو هذه الجهة بإرادتها أو بوعيها؛ فإذا كنّا مثل صخرة سبينوزا، فلا معنى، ليس فقط للإجابة، بل للسؤال أصلًا. ما معنى أن نطرح هذا السؤال؟ ليس له معنى، إلا إذا افترضنا أننا أحرار في طرحه. أما إذا كان السؤال حتميًّا، والإجابة حتميّة، فلا مجال للحرية أو للاختلاف. وبالتالي، فلا معنى للسؤال وللإجابة، ولا معنى للوجود ولا إمكانية لأيّ نقاش، من دون وجود إمكانية وفاعلية للذات. ولا أقصد هنا بالشعور أو الخبرة الحيّة فقط، بل أيضًا انطلاقًا من تأطير نظري لما يمكن أن يكون عليه الإنسان. والإنسان، بطبيعة الحال، حرية بحدود، وبقدر معين.
فإذا كان السؤال: هل القدر يتحكّم فينا؟ أقول: هذا التحكم يختلف من شخص إلى آخر، ومن سياق إلى آخر. تعرفون الوضع الاقتصادي، مثلًا نقول: "حرية المرأة" و"تحرّر المرأة". إذا لم تتحرر المرأة اقتصاديًّا، فحتى وإن امتلكت ما يمكن تسميته بالحرية السلبية (أي: ألا يتدخّل فيها أحد)، فهل ستكون قادرة على ممارسة هذه الحرية بفاعلية إذا كانت مأسورة أو متحكَّمًا فيها اقتصاديًّا؟ لا يمكن. كلّما تحرر الإنسان من الشروط، أصبح أكثر حرية. ونحن، حين نتحدث عن الحريات، نميز بين الحريات الاجتماعية والحريات السياسية. كلما كان الوضع الاجتماعي ضاغطًا، تقلّ الحرية، حتى وإن كان الشخص واعيًا بها.
وهنا أعود إلى مسألة الفردية. في رأيي، هذا حجر الأساس، وربما أهم ما تحتاج إليه المجتمعات العربية والدول العربية: الاعتراف بالفرد، وحماية حقوقه وحريته، بغض النظر عمّا إذا كان ذكرًا أم أنثى، متعلّمًا أم غير متعلم، غنيًّا أم فقيرًا، من هذه القبيلة أو تلك، من هذه الطائفة أو تلك، من هذا الدين أو غيره. الفرد له قيمة بحد ذاته، ومتساوٍ مع جميع الأفراد في الحرية والكرامة، إلى آخره. فدعوني أقول: حتى لو لم يكن، بالمعنى الوجودي، نحن متحكّمون، لكن بالمعنى القيمي، ينبغي أن نكون كذلك. لن يكون لحياتنا معنى إذا اعتبرنا أنفسنا مجرّد نتيجة لقدَر لا سلطة لنا عليه.
الآن، بخصوص السؤال: هل يخلط بعض الفلاسفة العرب بين الفلسفة العربية والفلسفة الغربية؟ دعوني أطرح السؤال بطريقة أخرى: هل يُعدُّ هذا الخلط مشكلة أو سلبية ينبغي تجنبها؟
في رأيي، إذا لم يحدث هذا الخلط، فهنا تكون المشكلة. البحث عن فلسفة عربية "نقيّة" أو "طاهرة" أو "مختلفة جذريًّا" عن باقي الفلسفات، هو المشكلة. قبل أن تكون الفلسفة عربية أو غربية، ينبغي أن تكون "فلسفة"، بالمعنى الذي يجعلها مهمة لكلّ إنسان، أو تتناول الشأن الإنساني عمومًا. فعندما نتحدث فقط عن "قيمة الإنسان العربي" أو "وضع الإنسان العربي"، هنا تتوقف الفلسفة عن أن تكون فلسفة أصلًا. إذن، قبل أن تكون عربية أو غربية، ينبغي أن تكون فلسفة، ثم يمكن، بعد ذلك، أن تتناول أو تركّز أكثر على الشرط الإنساني في هذا السياق أو ذاك. فدعوني أقول: لحسن الحظ، هناك الكثير ممن "يخلطون"، وأنا منهم، وإن شاء الله لا يتوقف هذا "الخلط"، ولا يعود ذلك "العزل".
أما بالنسبة إلى مفهوم الثورة: عندما نقول إن "الثورة الحقيقية هي كذا"، فنحن نتحدث عن مفهوم معياري؛ أي إننا نضع تصوّرًا لكيف يجب أن تكون الثورة. أما أنا، فأحاول الانطلاق من حد أدنى وصفي. عندما قلت إن الثورة هي "سعي إلى التغيير الجذري"، فهذا التغيير يمكن أن نراه سلبيًّا أو إيجابيًّا، لكن طالما هناك سعي لتغيير جذري، وقلت إنها "خروج عن النظام وعلى النظام"، فهذا يعني أن هناك نظامًا ما (سياسيًّا أو غير سياسي) نخرج عنه، ولا نتقيد بأدواته في التغيير؛ لأنها غير مناسبة، ونخرج عليه. هنا يمكن أن نحكم: هل هذا الخروج مناسب أم لا؟ إذن الحكم المعياري يأتي بعد ذلك. بهذا المعنى، في رأيي، نعم، كانت هناك ثورة في سوريا، إذن كان هناك خروج عن النظام، وعلى النظام.
أما السؤال: هل كان هذا النظام يسمح بتغييرات؟ وهل كان من الأفضل ألّا نخرج عليه؟ وهل كانت هناك إمكانية لحدوث الأفضل؟ أم إن الوضع كان في انحدار؟ هذه أسئلة يمكن مناقشتها. إذن، دعونا نتفق على حد أدنى وصفي، ولا نقول "الثورة الحقيقية" فقط، بمعنى أنها هي الثورة التي تحمل كذا وكذا؛ لأننا حينها قد نصل إلى نتيجة مفادها أن كل الثورات السياسية ليست ثورات. فمن يعرف تاريخ الثورة الفرنسية، مثلًا، ويعرف ما حدث فيها، قد يغير رأيه حتى الآن. وبالمناسبة، الثورة الفرنسية كان لها تأثير هائل بسبب مركزية أوروبا، لكن من قادها - كما تعلمون - ذبحوا بعضهم بعضًا في النهاية، أكثر حتى مما حصل في بعض البلاد اليوم. سأكتفي بهذا، شكرًا.
د. ميادة كيالي:
نأخذ ثلاثة أسئلة: من السيدة هدى، والسيدة ريم، والسيد مراد.
د. هدى الكافي:
شكرًا أستاذة ميادة، وشكرًا للأستاذ حسام، ولكل الذين شاركوا في هذه الندوة. سؤالي موجّه مباشرة إلى الأستاذ حسام، ويتعلّق بهذا الشكل الجديد من الكتابة؛ أعني "المنمنمات:" هل أنت بصدد ابتكار أسلوب جديد في الكتابة الفلسفية؟ لكن سؤالي الأهم: هل هذه الكتابة تُعدّ فلسفية أم لا؟ عندما اطّلعتُ على "المنمنمات"، وجدتها شبيهة بالمقالات، قريبة نوعًا ما من الكتابة الصحفية؛ إذ تتناول أحداثًا راهنة، وهناك سرعة في التفاعل مع هذه الأحداث. لذلك أتساءل: هل يحتاج الفيلسوف، في رأيك، إلى أن يُمهِل نفسه بعض الوقت، حتى تهدأ الأمور، قبل أن يُقدِّم قراءة فلسفية مناسبة لتلك الأحداث؟ لأنّ التفاعل اللحظي، أو "الحرارة" التي تجذب الكاتب في لحظة معينة، قد تدفعه للابتعاد عن الكتابة الفلسفية بالمعنى الدقيق. هذا هو الانطباع الأول الذي تكوَّن لدي. وسؤالي الآخر: هل هناك فكرة موجِّهة أو خيط ناظم لهذه "المنمنمات"؟ أي، هل ثمة ما يُيسّر على القارئ فهمها دون أن يشعر بأنه يقفز من موضوع إلى آخر؟ وشكرًا.
د. ميادة كيالي:
شكرًا جزيلاً.
السيدة ريم الدندشي:
في الحقيقة، كنت أرغب في قول شيء، لكن سؤال الدكتورة هدى استوقفني، وأرجو أن يسمح لي الدكتور حسام بأن أُقارب قراءتي له انطلاقًا من سؤال هدى، لا مما كنت أنوي قوله سابقًا. كنت أودّ الحديث عن البساطة والسهولة في كتابة حسام الدين درويش. صحيح أنني لا أدّعي أنني قرأتُ كتبه كاملة، وإنما قرأتُ جزءًا منها بسبب ضيق الوقت، وكانت قراءتي خلال اليوم وأمس تقريبًا. وللمفارقة، فإنّ هذه السرعة في القراءة دون تعقيد، تُظهر لنا كم أن هناك سلاسة واضحة في الكتابة. وهنا أتفق مع الدكتورة هدى في سؤالها: هل نحن أمام نص فلسفي؟
وأود أن أجيبها من خلال قراءتي: نعم، أرى أن النص فلسفي. وربما لا يرضى الدكتور حسام عن ذلك؛ لأنني أودّ أن أُحيل كتابته إلى مرجعية كبار الفلاسفة، وخصوصًا الهيرمينوطيقيين. فمع أنه انتقد هايدغر منذ قليل، إلا أنني أقول للدكتورة هدى، وشكرًا لها على السؤال الذي جعلني أفكر، إنني أرى في كتابته أصداءً لما طرحه "هانس- جورج غادامر" عن "يوم الحدث التأويلي"، وهو ما يمكن إدراجه ضمن ما نسميه "الانفعال في العالم".
دعونا نذهب إلى "دولوز" مثلاً، ونلاحظ تلك المحايثة التي يقتطعها حسام دائمًا بين المتناهي واللامتناهي. وهنا أستحضر التقاطًا جميلاً للأستاذ ماهر، حين تحدّث عن مفهوم "السيرورة" لدى "دولوز"، ورأى أن المفهوم سيرورة وليس تاريخا، ووجّه بذلك سؤاله للدكتور حسام.
إذن حضر معنا "دولوز"، فلنقل إن "ريكور" أيضًا حضر معنا في مسألة السيرة الذاتية مع حسام. ويمكن القول كذلك إن غادامر كان حاضرًا في "تاريخنا" الذي يمكن اعتباره "هذا الذي لنا"؛ أي ما ننتمي إليه من قبل.
أود أن أعود إلى "ريكور"، وإلى مفهوم السيرة الذاتية لديه. يحضرني أنني قرأت مقطعًا للدكتور حسام - لا أذكر إن كان في "المنمنمات" أو في كتاب الدرويش: القدر والمصير - يتحدّث فيه عن التعليم في الجامعة السورية. نحن هنا لا نقرأ أحداثًا وسيرة ذاتية فحسب، بل نقرأ إعادة ترتيب للذاكرة؛ لأن السيرة الذاتية هي استشراف للمستقبل.
في هذا المقطع الذي تحدّث فيه عن التعليم في سوريا، حضر "ريكور" بوضوح؛ بمعنى أنا التاريخ هنا طُرح بعيدًا عن موضوعية التاريخ. السيرة الذاتية، كما تُطرح هنا، تجعل الكاتب يقول: "أنا التاريخ"، بعيدًا عن الموضوعية التاريخية، بل كشاهد على عصره. وطبعًا، أنا أستعير هذا الطرح من الدكتور محمد أبو هاشم محجوب.
هنا، يحضر الدكتور حسام كشاهد على عصره. وللمقارنة، يمكننا الرجوع إلى قدري الذي اخترته لمحمد أبو هاشم محجوب، الذي تحدّث فيه عن التعليم في تونس في فترة معينة. ويمكننا أن نوازي بين ما قاله محجوب وما كتبه حسام عن التعليم في الجامعات السورية؛ فكلاهما يعيدان ترتيب الذاكرة ويستشرفان المستقبل.
في هذا المعنى، يصبح الكاتب هو تاريخ، والفيلسوف شاهدًا على عصره. لذلك، أودّ أن أستعير من محجوب أيضًا فكرته حول كيف يمكن أن تكون السيرة الذاتية استئنافًا وابتداءً في الوقت نفسه.
وفي الختام، أقول إن الفلسفة كانت حاضرة، رغم اتهام البعض للدكتور حسام بأنه ابتعد عن الفلسفة، واتجه نحو السوسيولوجيا، والثورة، والسياسة. لكنني أرى، وأردّ هنا على الدكتورة هدى، أن ما يكتبه هو فلسفة فعلًا. أخيرًا، ما أريد أن أنهي به وأقوله: حضرت الفلسفة، مع أن الدكتور حسام مُتَّهم بأنه لا، بل نزل كثيرًا إلى الأرض، وأصبح يشتغل بالسوسيولوجيا والثورة، وإلى آخره، والسياسة. لا، أنا الآن أراها، وأردّ على الدكتورة هدى، وشكرًا لسؤالها، لا، هو يتحدث في الفلسفة. وأريد أن أقول كلمة أخيرة: هل يمكن، لما فيها من بساطة وعذوبة، يعني أنا اليوم قرأت للدكتور حسام، قرأت له بعمق، قرأته كفلسفة بمعنى آخر.
أما هذه المنمنمات، التي فيها من البساطة واليومي والعذوبة، فأني لم أعد أستطيع كتابة الكتاب. فلذلك أريد أن أسأل: هل يمكن أن نطلق على هذه الفلسفة اسم "فلسفة عذبة"؟ هل يمكن أن نقول إن هناك فلسفة عذبة؟ لا أعلم، هذا ما تذوقته اليوم. وشكرًا جزيلًا.
د. ميادة كيالي:
تَصلح فلسفة عذبة مع فيلسوف القلب، شكرًا جزيلا.
ذ. مراد:
شكرًا لكم جميعًا على ما قدمتم، وشكرًا للدكتور درويش على كتاباته المميّزة.
لكن أودّ أن أضمّ صوتي إلى صوت الدكتور سهيل لحبيب في مسألة الحرية والتحرّر، حتى فلسفيًّا: أليس من الممكن أن يكون فعل التحرر هو ذاته قمّة الحرية؟ هذا أولًا. ثانيًا، وأنا أعرف وأتابع كتابات الدكتور درويش، فقد كتب عن مسائل الاعتراف، وعن فلسفة الاعتراف، وها هو الآن يحدّثنا عمّا حدث في العالم العربي، وفي سوريا تحديدًا - وأنا أتناول سوريا كنموذج، ولا أريد التركيز على هذا النموذج السوري تحديدًا، حتى لا تثار أيّ حساسيات - حيث قال إنها حالة يأس.
في حقيقة الأمر، أنا أُشاطرك الرأي في هذا جزئيًّا، وأرى أن مجتمعاتنا هي مجتمعات احتقار في كثير من الأحيان، وهي مجتمعات لا وجود فيها للإنسان بالمعنى الأخلاقي للإنسان، وبالمعنى السياسي للإنسان، وبالمعنى السياسي للمواطن. ولذلك، إلى أي مدى يمكننا أن نعدّ هذه الثورات "ثورات"، وهي نابعة من شعور بالاحتقار، قد يؤدي إلى حالة انتحارية، فقد أصبحت هذه الثورات قفزًا إلى الوراء لا إلى الأمام؟ وإلى أي مدى يمكن حينها أن نتحدث عن مسألة "الحرية القادمة"، في ظل ما نراه من تجارب الثورات العربية؟
المسألة الأخيرة التي أود الإشارة إليها، هي أنني، في الحقيقة، لا أفهم مسألة "القَدَر" كما قدّمتها. بصراحة، لم أفهمها. ومن باب المزاح: الدكتور درويش نجّار، وقد أنقذته الفلسفة من أن يكون نبيًّا، فالحمد لله! ولذلك أسأل: أيُّ فهمٍ للقدر تقصده؟ هل القدر بمعناه الديني؟ أم لديك فهمٌ خاص لمسألة القدر؟ لأن "القدر" أيضًا استُخدم، في مرحلة من المراحل، لتبرير الاستعمار. فالشابّي حين قال: "إذا الشعبُ يومًا أراد الحياةَ فلا بدّ أن يستجيب القدر"، كان يردّ على موجة كانت ترى أن الاستعمار "قَدَرٌ"، وينبغي القبول به.
ونقطة أخيرة في مسألة القدر: إذا كان "القدر" قدرًا بالمعنى الديني، فأنا أعتقد أن إحدى مآسي الثقافة العربية هي فكرة أن التاريخ ملكٌ لله، وليس ملكًا للبشر، وأن الله - من عليائه - يُشرف ويتدخّل في كل لحظة في تاريخ البشر ليوجّههم. وبالتالي، تُفقَد كل قيمة للإنسان في واقع الثقافة العربية.
وشكرًا، وآسف إذا أطلت.
د. حسام الدين درويش:
شكرًا لكم على هذه الأسئلة والمناقشات؛
دعوني أبدأ بالمسألة الأولى:
أنا لم أكن منشغلًا، وتقريبًا لا يهمّني على الإطلاق، ولم أسعَ أصلًا لأن يكون النص فلسفيًّا أم غير فلسفي؛ بمعنى أنني لم أنشغل بإنتاج فلسفة، أو بأن يكون النص فلسفيًّا، أو مناسبًا لما يُعدّ نصًّا فلسفيًّا، فهذا الأمر لم يكن يهمّني على الإطلاق. بالعكس، بدلًا من أن أوظّف الواقع ومعرفته وقراءته والمعرفة في خدمة الفلسفة، أو لإنتاج فلسفة، كان همّي العكس: أن أوظّف الفلسفة في قراءة الواقع. فتوظيف الفلسفة - وهنا الحديث عن الفلسفة بهو حديث عن أفكار، مفاهيم، وأطروحات موجودة في الفلسفة- هو دائم الارتباط؛ بمعنى أنه لا وجود تقريبًا لأي "منمنمة" (كما قال ماهر) أو أي تركيب جزئي دقيق، إلا وفيه استحضار لفكرة فلسفية ما، أو أخرى.
برأيي، لا تتلوّث الفكرة الفلسفية، ولا تفقد فلسفيّتها عندما تُناقَش في هذا السياق، بل على العكس، يمكن أن تُغني النقاش، ويمكن أيضًا أن تغتني هي نفسها. ودعونا نتذكّر هنا الجدل الصاعد والهابط عند أفلاطون، بمعنى ما، هناك تجريد، لكن هناك أيضًا نزول إلى المسألة، وليس الحديث هنا عن تطبيق فقط. فالجدل لا يصعد مرة واحدة ويهبط مرة واحدة فقط، وإنما هو دائمًا في حركة. لذلك، في هذه المرحلة، كانت المحاولة هي محاولة اغتناء الفكر - سمّوه ما شئتم - بالواقع، وإغناء الواقع أو قراءته بالفلسفة أو بالمعارف الفلسفية التي أمتلكها. فإذا كان السؤال: هل هو نصٌّ فلسفي؟ فالسؤال الأعمق هو: ما النص الفلسفي؟
برأيي، هناك أشياء ومناقشات تُناقش من حيث المبدأ. مثلًا، قصة في وقت ما أثارت دهشتي كثيرًا، لكنني عمّمت رؤيتي من خلالها: عندما لعبت مع "ريمي" كرة قدم، لم يكن يريد أن يُسجَّل عليه هدف، فألغى المرمى، وقال إنه لا يملك "مرمى نهائيًّا". أما أنا، فكنت أملك مرمى. كان يلعب، ويهجم عليّ، وهو لا يملك مرمى. برأيي، هذه رؤية نمطية لأشخاص ليست لديهم مواقف، بل فقط ينتقدون هذا الشخص وذاك، وهذا الطرف وذاك الطرف. فما المعنى؟ كيف يمكن أن نسجل هدفًا عليك؟ أو كيف يمكن أن نلعب معًا في ملعب، وأنت لا تملك مرمى؟ لكن في هذا موقف فلسفي، فلنقل إن له صلة بمسألة النقد للآخر دون أي نقد ذاتي، ومرتبط بمسألة الأحادية في تناول القضايا، ومفاهيم التوازن والندية، إلى آخره. فكان الربط قائمًا، بهذه المسائل.
الآن، أنتم تعرفون أن شهادتي مجروحة في الفلسفة، رغم أنني أطعن فيها كثيرًا من منظورات أخرى. لكن الفلسفة، إن لم تكن عذبة، فكيف تكون فلسفة أصلًا؟ أنا عندما أقرأ الفلسفة، لا أفعل ذلك لأنها واجب أو ضرورة أو عمل شاقّ. النص الفلسفي، مهما كان ثقيلًا أو غليظًا أو صعبًا، إذا لم يتمتع بحدٍّ أدنى من العذوبة، كما قال الدكتور خالد، "يدخل القلب"، لا يلامس العقل فقط، ففي رأيي، هناك مشكلة في فلسفية النص.
أما بالنسبة إلى ثنائية "الحرية والتحرر"، فدعوني أُحيل إلى نقطة تتعلق بفترة الستينيات؛ وقد وجّهتُ نقدًا شديدًا لمعظم المفكرين العرب في تلك المرحلة؛ لأنهم كانوا فلاسفة تحرّر، لا فلاسفة حرية، أو مفكري تحرّر لا مفكري حرية. صادق جلال العظم، مثلًا، اتخذته نموذجًا، وهنا أُوضّح أنني حين أنقد، فإنما أنقد أولئك الأقرب إليّ، ومن أقدّرهم، لا بمعنى الانتقاص منهم. فمن يطّلع على نصوص صادق جلال العظم في الستينيات، لا يجد فيها كلمة "حرية" أو "ديمقراطية" أو ما شابه ذلك مطلقًا؛ الكلام كله عن "التحرّر"، أو إذا أردنا الدقة، عن "التحرير"؛ أي تحرير هذا الشعب، وكأن هناك جهة، نخبة، أو سلطة حاكمة، تقوم بتحرير هذا الشعب من جهله، من تخلّفه، ومن الجوانب السلبية التي يحملها. ليس هناك مفهوم للحرية. وبهذا المعنى، أنا ضد الحديث عن التحرر أو التحرير دون ربطه بالحرية، لا بدّ من أن تكون هناك حرية.
لكن، أيضًا، أقول: من وجهة نظري، كان الوضع في سوريا سيئًا إلى درجة لا يمكن معها، في ذلك الوضع، الحديث عن تأطير نظري جاهز وكامل لمفهوم الحرية، بل، ليس فقط آنذاك؛ حتى اليوم، أرى أن الحديث عن الديمقراطية في سوريا حديث غريب وعجيب. لا توجد دولة، أعني حتى قبل النظام السياسي، لا توجد دولة بكل معاني الكلمة: لا بالمعنى النظري، ولا العملي، ولا الفلسفي، ولا السياسي. أي تعريف للدولة لا يجد ما ينطبق عليه: لا توجد وحدة أرض، لا توجد وحدة شعب، لا توجد مؤسسات ناظمة، لا يوجد احتكار للسلطة. لا يوجد أيّ معنى للدولة. فكيف، في ظل غياب الدولة، يمكن الحديث عن الديمقراطية؟
طبعًا، أنا من الأشخاص الذين انتقدوا غياب كلمة "ديمقراطية"، وقد كتبت في هذه المسألة. لكن، بالنسبة لي، الديمقراطية هي أفق مستقبلي. نحن الآن بحاجة إلى "دولة"، لكن بالمعنى الأدنى للدولة الوطنية، للدولة الحديثة، للدولة؛ بمعنى أن تكون لكلّ أبنائها. الآن، دعني أقول: جزء من هذا هو ما أسمّيه "القدر". يمكن تعريفه ببساطة على النحو التالي: كلّ شيء لا إرادي يؤثّر في الإنسان، كلّ ما لا يخضع لإرادة الإنسان، سواء أكان فردًا أم مجموعة أو جماعة أو مجتمعًا أو دولة. كلّ ما يخضع له الإنسان أو يؤثّر فيه، وليس خاضعًا لإرادته، هو ما أسمّيه "القدر". كما قلت، أنا ربطت هذا بثنائية البنية والفاعلية (Structure and Agency). لدينا بنية، وتعرفون هذه الثنائية عند ماركس، عندما قال إن الناس يُولَدون في شروط لا يختارونها، لكنها تحدّد مجال حركتهم؛ أي إن هناك أشياء خارجة عن إرادتنا تؤثّر فينا وتحدّد نطاق حريتنا، لكن ضمن هذا النطاق، هناك حرية تعمل وتشتغل.
بهذا المعنى، عندما زرت مدينة الشابّي في تونس، قرأت لافتات تحمل أشعاره. كانت موجودة، طبعًا، جميلة ومؤثّرة، وتبعث على الحماسة. لكن الرؤية هنا تقول شيئًا معاكسًا: القدر لا يستجيب بالضرورة. قد يريد الشعب شيئًا، ولكن الأمور ليست إرادوية بالكامل. ليس كلّ ما نريده نُحقّقه. تعرفون: "ليس كل ما يشتهيه المرء يدركه، تجري الرياح...". الرياح هنا هي "القدر"، والاشتهاء أو الإرادة هي "المصير". يعني، ما نحدّده نحن لأنفسنا. لكن دائمًا، حتى في السفينة، أنت لا تجدّف كما تشاء، بل تتأثّر بالرياح. ربما نتحكّم أكثر من غيرنا، لكن يبقى للقدر أثر دائم. ما أريد قوله هنا: على الرغم من الطابع التحفيزي أو الحماسي أو التشجيعي لقول الشابّي، والذي له معنى طبعًا، فمن منظور معرفي، أظنّ أنه ينبغي ألا نختلف على أنه غير صحيح إطلاقًا. يمكن للشعب أن يريد، ويلعن سماء قدره.
ذ. مراد:
لكن هل هذا "قدر"، أم حتميّات تاريخية يا دكتور؟
د. حسام الدين درويش:
تعرف أن كلمة "الحتمية" تغلّب "القدر" على المصير، بل تنفي أصلًا وجود الإرادة. لهذا السبب، أنا سميتُه "قدرًا"، بمعنى "الظروف الموضوعية". وأعتقد أنني قلت هذا قبل عام 2024 أو قبل 2011 يعني، لم تكن لإرادة الإنسان إمكانية لتحديد مصيرها في سوريا، بالمعنى السياسي؛ أي أن نعيش في دولة، وكذا... لم تكن هناك إرادة. ولهذا السبب، كنا كما كان علينا، ولم يكن ما كان من كان علينا. برأيي، حاليًا أصبح لدى السوريات والسوريين إمكانية، مهما كانت محدودة، لكنها معقولة مقارنةً بالسابق، لأن تكون لإرادتهم ووعيهم وفعلهم وتوجهاتهم جدوى ما؛ بمعنى أنه أصبح لهم دور معقول في تحديد مصيرهم، رغم القدر المحيط بهم، سواء أكان النظام الحاكم أو الظروف الخارجية، إلى آخره.
لكن، برأيي، ليست هناك حتمية. وإذا كان هناك اختلاف، فأنا دائمًا أقول: أكبر اختلاف بين الوضع الحالي في سوريا والوضع قبل ستة أشهر أو سنة، هو أن الآن هناك إمكانيات متعددة، قبل ذلك لم تكن هناك إمكانيات متعددة، كانت سوريا في حالة موات مستمر، إن لم تكن ميتة، لم يكن هناك أي أفق، لم تكن هناك أي إمكانية موضوعية لأن يتغيّر الوضع إلى الأفضل. كانت في انحدار، ولم يكن ذلك حتى بطريقة تميل إلى الأعلى قليلاً، بل إلى الأدنى. حاليًا، الوضع أبعد ما يكون، عن الوضع السابق، وأبعد ما يكون عما نريده أو عن الوضع المثالي. لكن إذا كانت هناك إيجابية، فهي أن هناك ممكنات مختلفة، ويمكن لفاعلية الناس أن تُسهم في تحديد مصيرهم، ولا يكونوا خاضعين لنظام أشبه بقدر، لا حول لهم ولا قوة معه.
د. ميادة كيالي:
الدكتورة نورية والدكتور أنس تفضلا.
د. نورية العبيدي:
السلام عليكم؛
معكم الدكتورة نوريّة، فلسفة علم النفس العام. دكتور، عندي مداخلة، صراحة، هي ليست سؤالًا مثلًا أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة لي، أبدأ من الدكتور مراد، عندما طلب إجابة قاطعة أو مطلقة من الأستاذ حسام، أعتقد أنه، في تقديري، لا يطلب من الفيلسوف تقديم إجابة قاطعة أو مطلقة؛ فلا توجد إجابات مطلقة لأيّ سؤال. أنا، بحكم تخصصي في علم النفس، وأعتقد - بل هذه حقيقة - أن الفلسفة هي أساس كل العلوم. فكيف نربط الفلسفة بعلم النفس؟
أحيانًا في حلقات السيمينار، في الدراسات العليا، يطرح بعض الطلبة مواضيع، عناوين البحوث، فأنا أقول لهم دائمًا: لا تطرحوا لي مثلًا عنوان بحث هو بديهي، معروف، وإجابته واضحة. فدائمًا، عندما تكون هناك إجابات عن أسئلة معينة غير واضحة، وهناك عليها جدل، فإنها تحتاج إلى بحث للإجابة عنها. فأيّ إنسان قادر على أن يطرح سؤالًا، ليست هناك إجابة قاطعة لهذا السؤال، أو هناك إجابات، ولكن هناك من يعارضها، وهناك جدل حول الإجابة. هناك، يعني، إمكانية أن نشتغل على بحث للإجابة العلمية عن هذا السؤال، والبحث سيحتاج إلى إحصاء وجمع معلومات ودقة وبيانات، حتى نُعطي حلاًّ لهذا السؤال أو إجابة عليه. فمشكلة أي بحث تتحوّل، إن لم تكن، إلى مشكلة عبارة عن سؤال يبحث عن إجابة عن طريق البحث، والأسئلة، وذوي الخبرة، واستعمال الإحصاء، إلى آخره. فهذا السؤال هو فلسفة، هذا السؤال هو السؤال الفلسفي، هو سؤال يبحث عن إجابة، ودائمًا الإجابات أو الحلول ستطرح أسئلة أخرى. يعني، دائمًا نحن في البحوث، في نهاية البحث، نعطي مقترحات لبحوث مستقبلية جاءت من العصف الذهني؛ أي جاءت بسبب هذا البحث، فدائمًا الإجابات، يعني، لا، قصدي أنه لا توجد إجابات مطلقة عن أيّ سؤال، حتى عندما نجري بحثًا ونعطي إجابات، يطرح الباحث مقترحات لبحوث مستقبلية حول نفس الموضوع. فدائمًا العملية مستمرة، لا تقف. يعني لا نستطيع أن نقول، مثلًا، إن هذا الموضوع مدروس؛ لأن هناك مناهج مختلفة لدراسة الموضوع، وهناك وجهات نظر مختلفة. يعني العينات تختلف، والمجتمع يختلف لطرح الآراء في هذا الموضوع. فكل العلوم، يعني الاقتصادية، علم النفس، تبدأ من الفلسفة، كلها تبدأ من سؤال يبحث عن جواب. فدائمًا، نحن، لا توجد إجابات جاهزة. مثلًا، سؤال الأستاذ، مثلًا: هل القدر كذا؟ هل الحتمية كذا؟ هل كذا؟ يعني، لا يستطيع إنسان أن يجيب.
ذ. مراد:
عذرًا على المقاطعة، سؤالي كان عن القدر؛ لأن القدر مفهوم ديني، سيدتي، ليست المسألة أنني أطلب إجابة قاطعة. أنا فقط أردت توضيحًا من الدكتور؛ لأن المسألة تتعلق بالقدر. عندما تحدث عن "القدر"، هذه كلمة لها تاريخ طويل، معجميًّا وفلسفيًّا، وهي راسخة في المجال الديني. هذا كان سؤالي...
د. نورية العبيدي:
لا، أنا أتحدث بشكل عام، عن الفلسفة فقط، مداخلة عن الفلسفة؛ أي إن الفلسفة، من وجهة نظري، هي أساس كل العلوم، ودائمًا هو السؤال الذي يبحث عن إجابة، ليست إجابة مباشرة، وإنما إجابة، مثلما تفضل دكتور ماهر، أعتقد، يعني، هذا السؤال، أنه لا توجد إجابة. والفيلسوف دائمًا، الفيلسوف الشاطر، هو الذي دائمًا يثير الأسئلة. يعني، يسأل ويترك الآخرين يجيبون بطريقتهم الخاصة، عن طريق بحوثهم، عن طريق البحث عن الحقيقة.
د. ميادة كيالي:
فلنُعطِ الكلمة للدكتور أنس.
د. أنس الطريفي:
مرحبًا بالجميع، عندما يكون الحديث عن حسام الدين درويش، الدكتور حسام الدين، لا أستطيع أن أسكت، عليّ أن أتكلم. هي شهادة في الواقع، وليست سؤالًا. أنا لا أطرح أسئلة هنا. ما يعجبني في كتابات صديقي حسام هو هذه القدرة على تيسير الفهم في الخطاب الفلسفي. نحن عادةً، عندما نقرأ الفلسفة، التي تسائل في أي خطاب أو في أي موضوع معيّن تهتمّ به، نجد صعوبة في الفهم. هذا الأمر لا يقع مع صديقي حسام. أعتقد أن حاجز اللغة، هذا الحجاب الذي يمنعنا من الإحاطة بالمعاني التي تُمسَك عادةً بالفلسفة، لدى حسام القدرة على جعْل اللغة تصف هذا المعنى ببساطة شديدة جدًّا، حتى وإن لم ننتبه إليه مسبقًا. وهذا، بصراحة، يفيدني كثيرًا عندما أقرأ للدكتور حسام.
سؤال بسيط فقط، خطر في ذهني من خلال متابعتي المتقطعة للحوار الدائر: هل الثورة، بالنسبة إلى مفهوم الثورة، هل نفرض مصطلحًا على الواقع، أم إن الواقع هو الذي يفرض على المصطلح معناه؟ في كل تعريف ننطلق منه للثورة، نكون معياريين حتمًا، ونفرض على الواقع هذا المتشظي المشتت، المكوَّن من تعدد أنطولوجي لا يمكننا أن نحاصره، ولا يجوز لنا أن نفرض عليه نموذجًا مسبقًا نجبره على أن يدخل فيه.
بمعنى آخر، لا يمكن للثورة أن تكون مفهومًا سابقًا لما يحدث، وإنما يجب أن يُصاغ هذا المفهوم متابعةً لما يحدث، وعلى ضوء ما يحدث. أين يمكن أن يسير هذا الذي يحدث في اتجاه أسلم؟ كيف يمكن له أن يسير في اتجاه أسلم؟ لا ينبغي لنا، حين نفرض على الواقع مفهومًا ثابتًا للثورة، أن نطالبه بأن يوجد في ما لا يمكن أن يوجد فيه. هذا ما عنيته، والحديث يطول معك، ولا أريد أن أستحوذ على الكلمة. لست جاهزًا كل الجهوزية، وأرجو أن يكون سؤالي مفيدًا. شكرًا لك العزيزة ميادة.
د. حسام الدين درويش:
سأل الدكتور مراد عن مفهوم القدر، حين فكّرنا في العنوان، حصل نقاش حول ما إذا كان يجب أن نتحدث عن القدر والمصير أم الأقدار والمصائر. المفهوم الديني المقبول هو الأقدار والمصائر. أما مفهوم القدر له سمعة سيئة من المنظور الديني. وهو مرتبط بالقدرية والقدريون، وغير ذلك، كما في حال الدهريّة والدهريين، إلى آخره. فالقدر، كمفهوم، أقرب إلى الفلسفة؛ أي إنّه ليس مسألة إيمانية تتعلق بالإله، أو أنّه بديل عن الله أو ما شابه. نحن نتحدث عن شيء خارج عن الإرادة، شيء يتعلّق بتراجيديا الحياة التي تجعلنا نواجه أمورًا مأساوية، أو أشياء لا نرغب فيها. إذن، ليس بالمفهوم الديني هنا، بل على العكس، كان الغرض منه الخروج عن المفهوم الديني. المفهوم الديني هو: "الأقدار". إذن، هنا الأقدار تصير، كما تعلم، تفتيتًا لهذه الظروف الموضوعية لأشياء ثانوية، ولكن يبقى هناك فاعل رئيس هو الله. إذن، الأقدار تتحكم في الأقدار والمصائر. أما الحديث عن القدر، فيصبح حديثًا فلسفيًّا، قد يكون بمعنى ما موازيًا لمفهوم الله في الدين. القدر دائمًا كان محل نقاش بين كون الإنسان مخيّرًا أو مسيرًا، والحديث هنا بين الله وإرادة الإنسان هو بالمعنى الديني. أما هنا، بالمعنى الفلسفي أو العلمي أو ما شابه، فهو شيء خارج عن إرادة الإنسان، وشيء إرادة الإنسان بهذا المعنى تعني ماذا؟ فقط أردت أن أضعك في خلفية النقاشات لأنه أريد له ألا يكون مفهومًا دينيًّا.
وعلى الرغم من أن شهادتي مجروحة كثيرًا بالفلسفة، فإن كل ما أراه فيها من تمجيد، يثير حفيظتي، فأسارع إلى إعطاء وجهة نظر أخرى. فلسفة الفلاسفة غير الفلسفة كما نتحدث عنها، أو على الأقل غير جزئيًا. مثلاً، عندما نقول الفلسفة لا تقدّم أجوبة، لا أعرف، إذا استبعدنا الأجوبة من الفلسفة، لا أعلم كم يبقى منها. على الأقل فلسفة الفلاسفة تقدّم أجوبة، ليس هناك فيلسوف اكتفى بالأسئلة. عندما نقول إن الفلسفة لا تقدّم أجوبة قاطعة، ربما أو هكذا يراد لها.
د. نورية:
لا، عفوًا أستاذ، قصدي لا، ليست هكذا. تعطى الأجوبة بعد البحث.
د. حسام الدين درويش:
إذا دقّقنا في المسألة، قد نجد أن الفلسفة لا تقدّم، على الأغلب، أجوبة قاطعة أو نهائية، في حين أن فلسفة الفلاسفة تقدّم، في كثير من الأحيان، أجوبة قاطعة ونهائية. وكل شيء غير ذلك يعني أن الناس لا يفهمون؛ أي إن هناك سخرية أحيانًا بين الفلاسفة، فالفلاسفة يسخرون من بعضهم بعضًا أو لا يتحملون بعضهم بعضًا، لدرجة أن "برغسون" ربما في جملة واحدة يسخر منهم، ولا تستغرب ما كتبه "نيتشه" عن الفلاسفة الآخرين، يعني بينهم حرب أهلية أصلًا، وهذا جزء من الفلسفة، وهذا هو الجميل فيها، والفرق هو أنه لا توجد سلطة. فالفلاسفة أديان متعددة؛ يمكن للناس أن يؤمنوا جزئيًّا، تموت الفلسفة عندما تصبح دينًا، عندما تصبح إجازة، ونطبقها مثلما قال ماهر. لكن عندما تدرس الفلسفة وتقرأ "أفلاطون"، ثم بعده تأخذ "أرسطو"، ثم تأخذ "أفلاطون"، ثم تصل إلى "ديكارت"، و"كانط"، و"هيجل"؛ فثمة تنويعات. لا أقول ذلك بالمعنى الانتقائي أو ما شابه. فالتعددية للمتفلسفين، لكن الفلاسفة قد ينتهون إلى أجوبة وانتهى. وهنا يتوقف الفيلسوف عن أن يكون فيلسوفًا عندما ينتهي بهذا المعنى. ولهذا السبب، ففلسفة الفلاسفة غير الفلسفة كما يراد لها أن تكون.
تكلمتِ عن الفلسفة وعلم النفس، وهنا دعني أقول إنني، بالنسبة إلى العلوم، لدي وجهتا نظر يجب التشديد عليهما، ومن ناحية أولى، الفلسفة لديها عقوق شديد تجاه أبنائها، أمّ عاق؛ لأن هناك عدم تقدير للأبناء ومحاولة فرض الوصاية الدائمة عليهم؛ بمعنى أنهم لا يفهمون، ولا يعرفون، وأنا أمكم، استمعوا لي، دائمًا. جزء من الأمومة أن تجعل الابن مستقلًّا عنها، وجزء من الأمومة أن تريد الأم للابن أن يكون أفضل منها، وهذا بمفهوم الأمومة بالمعنى المعياري.. الأمومة أن تريد الأم أن يكون الطفل أفضل منها ومستقلاً عنها. أما عندما تُفرض الوصاية، فهذه خيانة للأمومة.
إذن، الفلسفة في اتجاه قوي نحو استمرار الوصاية، هذا من ناحية. لكن في رأيي، العلوم، وخصوصًا العلوم الاجتماعية، لا غنى عنها للفلسفة. كما أن الفلسفة لم يعد باستطاعتها الاستغناء عن العلوم الأخرى. الفلسفة الآن بدون علوم ضعيفة كثيرًا، فهي تستفيد منها وتغتني بها وتأخذها في الحسبان. لكن العلوم أيضًا، وأنا موافق كثيرًا على هذه الفكرة، رغم تجاوزها المعنى الذي أراده هايدجر، لا تفكر، أو لا يمكنها أن تفكر في أسسها ومنهجها وأدواتها كلها. عندما تفعل ذلك، فإنها تسلك طريقًا فلسفيًّا. عندما تحاول بناء رؤية شمولية جذرية، وتسأل: ما المنهج؟ ما العلم؟ في رأيي، مثلاً علم النفس، دعني أقول علاقة الفلسفة بعلم النفس من حيث المضمون قبل "فرويد"، مثلاً النظريات السلوكية قبل "فرويد"، وربما "فرويد" نفسه يمكن أن نقرأ "سبينوزا" و"نيتشه"، ونرى الكثير، ﻓ"نيتشه" سبق "فرويد" بكثير من الأفكار المهمة عن النفس البشرية وعن توجهاتها، وعن غريزة التدمير وغريزة البناء، وعن الرؤية والتصعيد الذي يمكن أن ينتج الأخلاق أو غير ذلك. فنجد عنده الكثير من الأفكار بهذا المعنى. من حيث المضمون نجد عند الفلاسفة الكثير من الأفكار عن النفس البشرية؛ لأنه منذ سقراط على الأقل، عندما هبطت الفلسفة من السماء إلى الأرض، صار البحث في الكون بحثًا في النفس البشرية. فصار للفلسفة الكثير من الأفكار التي تقدمت بها في هذا الخصوص. لكن يمكن للفلسفة أن تسمح بإعادة مساءلة الدوغمائية العلمية أو الرؤية العلمية؛ إذ تُسأل عن المناهج، عن السؤال عن الحدود. بالنسبة لي، دائمًا السؤال عن الحدود هو أهم سؤال في المعرفة. مهما يكن، هذا هو سؤال كانط: أنت تعرف، لكن ما حدود هذه المعرفة؟ هذه المعرفة محدودة، ليست مطلقة بهذا المعنى. هناك شيء آخر يحدّ من المعرفة. إذن يمكن أن يُسأل عن العلمية والمنهجية وبأي معنى. وهنا يُطرح السؤال. وبهذا المعنى، دعني أقول إنني أربط مع العزيز أنس مسألة: هل نفرض مفهوم الثورة نظريًّا على الواقع، أم نستقرئ الواقع؟
يعني هنا نعود إلى: هل نستقرئ أم نستنتج؟ أنا في رأيي، مثلاً، في علم التاريخ صار من المتفق عليه القول الشهير: إن النظرية تسبق الواقعة؛ أي لا توجد عندنا واقعة في التاريخ من دون أن تكون هناك رؤية نظرية تحدد ما هي الواقعة أصلًا. نحن نختار هذه أو تلك، ونعطيها هذا المعنى أو ذاك، ونربطها بهذا أو ذاك انطلاقًا من رؤية نظرية.
برأيي، طبعًا، هي عملية جدلية، لكن لا يمكن مقاربة الواقع، للفيلسوف أو للعارف أو للمفكر، من دون رؤية نظرية مسبقة، ولو أولية، تخضع للاختبار، للتعديل، للتطوير، أو لغير ذلك. لكن الحد الأدنى الذي ينبغي تقليله هو البعد المعياري. لا نريد أن نأتي لفهم الثورة ونحن نراها أسوأ ما في الدنيا أو أحسن شيء في الدنيا. الثورة الحقيقية هي ثورة الحرية والكرامة. بهذا المعنى نقول، كما قال روسو أحيانًا، إنه أحيانًا نكون نظريين في صورتنا للإنسان، حيث لم يبق أيّ إنسان نقبل به، ونكره كل البشر؛ لأن صورتنا للإنسان أكثر مثالية؛ إذ لا يوجد أصدقاء مهما كان مفهوم الصداقة، وأن هذا الصديق غير مرغوب فيه. فالصورة النظرية أحيانا حسب رأيي، هي الحد من المعياري والحمولة القيمية. لهذا السبب، ينبغي محاولة الوصول بدايةً إلى مفهوم وصفي لما هي الثورة، حتى نميزها عن التمرد، عن الانقلاب، ... إلى آخره. لكن بعد ذلك، وهذا هو الواقع، حتى لو انطلقنا من مفهوم وصفي للثورة، فهو يحمل قيمة إيجابية؛ فالثورة شيء إيجابي عندنا أصلًا: تغيير إيجابي ضد شيء سلبي، والثائر شيء إيجابي. لكن بعد ذلك، وهنا، قد يتبيّن في الواقع أن الحمولة المعيارية السلبية ليست قليلة، ونحن لا ننتبه إليها، لا نعرف ما في الثورة من تضحيات ودمار وموت، وتوتر وخسائر. ولهذا، ينبغي أن نكون حذرين. في عام 2011، كان مفهوم الثورة عندي غير ما هو عليه الآن، رغم أن الوصفي الأولي واحد، لكن حاليًّا، برأيي، لا، الثورة ليست مسألة طريق مفروش بالورود وتحقيق الإيجابيات، وإنما يمكن أن تُسبّب دمارًا كبيرًا وكثيرًا. إذن هي آخر الكي. فلا نستسهل هذه المسألة، وهذا لم يكن في ذلك الوقت، يعني الثورة كانت مرتبطة أكثر بالإيجابيات. لهذا السبب، برأيي، إذا بدأنا معرفيًّا، بالحد الأدنى، ولا نخجل، سواء وافقنا أو لم نوافق، ممكن أن يكون التغيير الجذري من السلبي إلى الإيجابي أو من الإيجابي إلى السلبي، لكنه يبقى تغييرًا جذريًّا. إذن، إذا أردت أن أقول تعريفي للثورة، فهي حراك أو سعي، مسنود بجزء كبير من الناس؛ لأنك تعرف أنه لا توجد ثورة شارك فيها أكثر من 10% من الناس، يعني، إذن جزء كبير من الناس، نحو تغيير جذري في المجال السياسي، لكنه خروج عن النظام وعلى أو ضد النظام، هذا هو المفهوم. وربما تعرفون، أحيانًا الثورة تقوم ضد نظام ديمقراطي. إذن، بعد هذا يمكن أن نُقيّم المسألة.
باختصار، مع الدكتور أنس، لا يمكن من ناحية وجودية أو معرفية، أن نكون بلا فهمٍ مسبق، لا يمكن أن نأتي من لحظة صفر، دائمًا تعرف أن هذه الدائرة الهيرمينوطيقية: فهمٌ مسبق يغتني بالفهم اللاحق، ينتج فهمًا مسبقًا جديدًا، وهكذا دواليك. وهذا الفهم المسبق ينشأ، ويحدث فينا أكثر مما نُنتجه نحن، يحدث فينا نتيجة إدراكنا، حياتنا، خبراتنا، علاقاتنا، إلى آخره، ينتج الفهم المسبق. لا مشكلة في الفهم المسبق، وأنا هنا أميل إلى "غادامر" على "هابرماس"، لا مشكلة في الفهم المسبق، إلا إذا كان غير خاضع للنقد الذاتي وللتغيير. دائمًا عندنا فهم مسبق، أصلاً، ضروري الفهم المسبق أصلاً لا يمكن ألّا يكون موجودًا، لكن عندما يكون جامدًا غير قابل للتغيير، هنا المشكلة. فهنا نعود إلى أن الواقع ينبغي أن يسمح لنا بتغيير مفاهيمنا إذا كان قد أنتج أشياء جديدة، شكرًا جزيلًا.
أمين اليافعي:
مساء الخير، تحياتي للجميع. أمسية كانت على أعلى مستوى، وهي تقريبًا تناولت كل المواضيع والأفكار التي طرحها الدكتور حسام، وقد نوقشت وتحدث عنها. لكن سؤالي ربما يتعلق بالمشروع أو الاستراتيجية التي يستخدمها الدكتور حسام، باستثناء رسالة الدكتوراه، تبدو كتاباته وكأنها عبارة عن منمنمات، وقد أشار إلى أنه هروب من اليقين، يحاول أن يشتبك مع هذا اليقين ومع الآخرين. كأنني أتخيل الدكتور حسام، كلما وجد أحدًا قد استكان إلى راحة أيديولوجية أو فكرية معينة، حاول أن يوجه له صفعة نقدية، على طريقة الفيلسوف اليوناني واستخدام العصا. أيضًا، هو أشار إلى شذرات "نيتشه"، وربما الآن، مع عصر السرعة، والحاجة إلى نصوص قصيرة، والتحولات التي حصلت حتى على مستويات كثيرة في الكتابة، من الرواية إلى القصة القصيرة، وكذلك في الشعر. لكن سؤالي هو: في ظل واقع عربي مفكك، كيف يُصنّف الدكتور حسام اليوم نصوصه؟ هل الواقع العربي- نحن نتحدث عن الحالة الغربية أو الحالة الأوروبية والأمريكية التي قد تشبعت بالأفكار وبالفلسفات- لكن الوطن العربي ما زال يفتقر إلى بناءات فلسفية كبيرة، فهل هذه الاستراتيجية تصلح لإعادة تأسيس الفكر العربي؟ هل مثلًا كتاباته، هذه الشذرات أو المنمنمات، تُعد تذاكر قانونية صالحة للدخول، يمكن منها الدخول إلى بناءات فلسفية تستطيع أن تتعامل مع هذا الواقع العربي المفكك؟ شكرًا.
د. حسام الدين درويش:
نعم، شكرًا جزيلاً العزيز أمين؛
سؤالٌ، جعلني أعود إلى سؤال الدكتورة هدى؛ لأن هناك نقطة لم أجب عنها بعد. وهنا سيكون- دعني أقول- على طريقة ماهر، أو على طريقة أرسطو. كان أرسطو يبدأ كل كتبه بمراجعة نقدية للمعرفة السائدة، يصفّي حسابه معها، ثم يبدأ بالبناء. على طريقة ماهر، إذا لاحظتم، أول شيء بدأ به في الإجابة هو النفي؛ بمعنى: ليس هكذا، ليس كذا، ليس كذا، ثم قال: ما هذا؟ ما السؤال الفلسفي من وجهة نظره. دعني أقول إنني لن أنفي هنا، لكن حتى الآن، أعدّ بصدق أن كل ما كتبته كان تمهيدًا لما أريد كتابته الآن، أصفّي حساباتي مع المعرفة السائدة والاتجاهات الموجودة، لكن لديّ مشروع لأكتب ما أريد كتابته. إذن، كل ما كتبته غلب عليه الطابع النقدي. أما من ناحية أخرى، في المعرفة في العالم حاليًّا، فإن الكتابة الأهم والأقوى هي الكتابة البحثية؛ أي النصوص التي تتراوح ما بين ستة إلى عشرة آلاف كلمة. هذا الحجم هو الأهم في الإنتاج المعرفي الأكاديمي وغير الأكاديمي، وليس الكتابات؛ الكتاب، وليس النصوص القصيرة.
شخصيًّا، كانت لديّ في لحظات معيّنة خيارات، كان عليّ أن أقرر: هل أتابع الكتابة على الطريقة الأكاديمية، التي قد تستغرق عامًا أو أكثر في كتابة نصّ بحثي واحد، وقد يستغرق عامًا أو عامين حتى يُنشر؟ وأحيانًا قد يحدث أكثر من ذلك، أم أتناول المسائل بطريقة نظريّة عامّة، لا بمعنى الطرح المباشر؛ لأنني كنت ضمن قسم للفلسفة المحضة، الفلسفة التحليلية المحضة، أم تحاول أن تواكب بصورة أكثر مباشرة وعينية، أو أن يخضع للنصّ. الكتاب بالمعنى القديم، ربما لديّ كتاب أو كتابان هنا، لكن ليست جميعها نصوصًا بمعنى المنمنمات. في فلسفة الاعتراف، هناك نصوص مطوّلة جدًّا، وهناك كتاب عن المفاهيم المعيارية، وهناك نصوص وأبحاث أكاديمية تمامًا.
في قادم الأيام - ولا أدري متى سيسمح لي الوضع - أحلم بأن أكتب "كتابًا"، بمعنى مشروع ذي رؤية بنائية، أطروحة متكاملة لما أريد قوله. لكن، كما قلت لك، هناك ضرورات مواكبة الحدث؛ لأنه أحيانًا من غير المعقول أنا - مثلًا - في كتاب ليس لي فقط، أو حتى في كتيبي، أظن في 2020 أو 2021، أرسلت بحثًا إلى مجلة جامعة الكويت للعلوم الإنسانية، واستغرق الأمر ثلاث سنوات ونصف، أو أربع سنوات حتى نُشر. وكنت قد قلت إن هذا الموضوع، عندما أرسلته، لم يكن قد كُتب عنه أو استُخدم عربيًّا على الإطلاق: لا المفهوم، ولا المبحث، ولا الموضوع، ولا أي شيء من هذا القبيل. وقلت لهم إن التأخير قد يضعف من قيمة الريادة في هذا المجال.
لذا، أحيانًا حين تتأخّر جهة ما في النشر، أتراجع عن النشر معها؛ لأن ما يهمّني هو سرعة النشر. وأنا، شخصيًّا، حتى عندما بدأت الكتابة، كنت قد حصلت على الدكتوراه، ولم أكن أكتب في المجال العربي على الإطلاق. لقد حصلت على الدكتوراه باللغة الفرنسية، ولم أكتب (بالعربية)، وغالبًا لا أكتب إلا مستثارًا. وكان أول نص كتبته هو نصوص حول الثورة السورية، وقد تابعت هذا الموضوع. أول بحث كتبته كان عن كتاب أو أبحاث صَدرت في بيروت، وكنت حينها مستثارًا.
أعود إلى سؤال الدكتورة هدى: إلى أيّ حد ينبغي لنا أن نأخذ مسافة؟
طبعًا، أنا أعرف رأي هيغل، الذي يقول إن الفلسفة لا تبدأ إلا بعد نهاية الحدث، وإنها لا تُمارَس أثناء الحدث. لكنني، كما تعلمون، أختلف مع "هيغل"، وربما يُعَدّ هذا كُفرًا بالفلسفة بحسبه. فأنا أرى أن الفلسفة يمكن أن تكون حاضرة أثناء الحدث، وقد يُراد لها أن تكون جزءًا من فاعلية الإنسان في تحديد مصيره ضمن هذا الحدث الذي يشكّل قدرًا.
لست إرادويًّا حتى أقول إن الإنسان يمكن أن يأخذ مسافة مطلقة، أو ألّا يتأثر بالواقع، لكننا - بوصفنا كائنات عاقلة- يمكننا، حتى أثناء الحدث، أن نتّخذ مسافة نقدية، خصوصًا بعد المرور بالتجربة والخبرة والتاريخ. في رأيي، عندما تبتعد الفلسفة عن الواقع الراهن بحجة أنه لم يكتمل بعد، لتكتمل الصورة، فإن الفيلسوف قد يتحوّل إلى مؤرخ أكثر منه منظّرًا؛ لأنه إن اقتصر دوره على نقل الواقع كما حدث، فهو يؤدي وظيفة المؤرخ، لا الفيلسوف، بينما يمكن للفلسفة أن تفهم الواقع في سيرورته.
دعني أقول، في هذه المسألة، وسأستخدم هنا كلمة لا أستخدمها كثيرًا: أنا فخور قليلًا بأن الكتاب الذي كتبته عن درويش بين القدر والمصير وحول الفلسفة والثورة، قد صدر قبل سقوط النظام؛ لأن فيه أشياءً كان من السهل على كثيرين أن يقولوها بعد السقوط، لكنها كانت مستبعَدة في وقتها، مثل مسألة السلمية، أو الثورة، أو الديمقراطية. أنا قلت أشياء في وقتها، والآن، كثير من الناس يقولون: "أوكي، يمكن للثورة المسلحة أن تُنتج، بل بالعكس، السلمية قد لا تُنتج"، خصوصًا بعد أن تحوّلت السلمية إلى دين أو عقيدة، وبعد أن تحوّلت مسألة الثورة أنها انتهت، وأنا كنت أميّز بين الثورة كفعل، والثورة كحدث، وأن نتائجها لم تنتهِ بعد. قد تحدث أشياء لاحقًا. ولهذا السبب، برأيي، أن نقول إن هذه الأمور الآن أقلّ قيمة مما لو قيلت سابقًا. نحن لا نحتاج إلى أن نكون مجرد ترجمة للواقع. الفيلسوف ليس دوره أن ينقل الواقع كما هو، فربما هناك أشخاص أو معارف أخرى تقوم بذلك؛ أي ترجمة الواقع. أما الفلسفة، فهي رؤية للواقع لا تكتفي بوصف ما يجري، بل تتضمن ما يجب أن يكون.
هنا تأتي الفلسفة. ما الفرق، مثلًا، عندما تحدّثتُ عن مفهوم الأمومة؟ الأمومة هنا لا تعني فقط أن هناك أمهات لا يردن الخير لأبنائهن، أو أنهن قد يكنّ ظالمات أو ساعيات للسيطرة عليهم. نعم، هناك أمهات كذلك. لكن مفهوم الأمومة الفلسفي يجمع بين ما هو كائن في واقع الأمهات، وما يجب أن يكون. فالأم، هنا، هل تطابق هذه الصورة المعيارية؟ لكن هذه الصورة المعيارية ليست من اختلاق الفيلسوف؛ أي إنها ليست مجرد خلق ذاتي له، بل ربما يتفق معظم الأمهات -أو كثير منهن - في سياق ما، على أن هذه هي صورة الأم. وهنا نعود إلى مفهوم "الأم الحقيقية"، من دون أن ننفي وجود "الأم غير الحقيقية" أيضًا؛ أي تلك الأم التي يمكن أن تقوم بخيانة لأمومتها، كما قلتُ، هي فعل قامت به. الفلسفة غالبًا، كما أرى، تتقاطع مع العلوم. وكما ذكرت، هذه مسألة تاريخ، ليس فقط بالنسبة إلى الفلاسفة. أنتم تعرفون أن التاريخ عادة يُنظر إليه كقراءة للماضي، لكن هناك ما يسمى الآن في علم التاريخ بـ"تأريخ الحاضر".
وفي ندوة أخرى، أشرنا إلى أن جرأة الباحث، أو الفيلسوف، أو المفكر على قراءة الحاضر تجعله يقدم معرفة قد تكون أكثر فائدة، وأكثر أهمية، وأكثر راهنية في هذا السياق. لكنه، بالطبع، يغامر بأن يخطئ أكثر. وقد ذكرتُ لأحد الأشخاص، كان سيقوم بدراسة حول هذه الكتابات، إلى أي مدى دفعت أخطاء هؤلاء الكتّاب والباحثين والفلاسفة - وغالبًا ما يخطئون أكثر من غيرهم - إلى مزيد من النقد الذاتي ومراجعة الذات. مثلًا، في سوريا، عندما دخل الجولاني حينها إلى حلب، ثم إلى حماة، قالوا: من المستحيل أن يُسمح له بالوصول إلى حمص، ثم دخل حمص، ثم بالتأكيد قيل إنه لن يصل إلى دمشق. كان هناك تأكيدات من أشخاص علماء، ومثقفين، ومفكرين، ومتابعين.
فبرأيي، على الشخص أن يفهم نفسه، وأن يدرك أنه قد يكون أشبه براعي الكذاب، ليس بالمعنى الأخلاقي، بل بالمعنى المعرفي: أي إنه يمكن أن يخطئ مرة ومرتين. وفي البعد الأخلاقي، الناس الآخرون قد لا يصدقونه بعد ذلك، لكن في البعد المعرفي، هو نفسه سيبدأ بالتشكيك في ذاته، يتأنّى في الجزم، ويدرك أن هناك احتمالات وممكنات متعددة، وأن المسألة ليست حتمية. كما قال الدكتور، ليست المسألة مسألة حتمية، بل هناك قدر، وهناك أشياء تقع خارج نطاق الإرادة، وخصوصًا في عالم السياسة، وشكرًا جزيلًا.
د. ميادة كيالي:
لقد تجاوزنا ثلاث ساعات ونصف، بينما كنا نتوقع ساعتين أو ساعتين ونصف على الأكثر، لكن هذا هو المعتاد. شكرًا للجميع، لقد استمعنا إلى قراءات مهمة جدًّا، ومن زوايا ورؤى مختلفة، أضاءت على نواحٍ جديدة في النصوص، كما قلتَ يا حسام، ربما لم تخطر لك من قبل. أودّ أن أشكر، باسم مؤسسة "مؤمنون بلا حدود"، وباسم وحدة الدراسات الفلسفية، جميع المشاركين والمشاركات. وأكيد، أخصّك بالشكر على حضورك الفكري المستمر، ومحبتك للحوار، وهذه الطاقة الجبارة. كما أود أن أشكر الدكتور خالد كموني، والعزيزة السيدة ريم الدندشي، على هذه الثقة التي منحاني إياها في إدارة ندوة اليوم.
وأختم بالقول: هذه ليست نهاية النقاش، بل بداية لتفكير متجدد، أو كما قال حسام: "ليس الهدف من الفلسفة أن تقدّم أجوبة نهائية، بل أن تفتح بابًا للسؤال، وأن تقلق الطمأنينة الزائفة". شكرًا لكم جميعًا، وإلى لقاء قريب في فضاء جديد من التفكير المشترك.
[1] في معنى قَرَحَ، انظر: "ثَلَاثَةُ أُصُولٍ صَحِيحَةٍ: أَحَدُهَا يَدُلُّ عَلَى أَلَمٍ بِجِرَاحٍ أَوْ مَا أَشْبَهَهَا، وَالْآخَرُ يَدُلُّ عَلَى شَيْءٍ مِنْ شَوْبٍ، وَالْآخَرُ عَلَى اسْتِنْبَاطِ شَيْءٍ" (ابن فارس، أحمد، مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ - 1979م، ج5، ص 82).
[2] حسام الدين درويش، منمنمات فكرية وحوارية في الفلسفة والحياة (اليومية) والقضية الفلسطينية، ميسلون للثقافة والترجمة والنشر، اسطنبول-باريس، 2024، ص 98
[3] المصدر نفسه، ص 99
[4] المصدر نفسه، ص 100
[5] المصدر نفسه، ص 103
[6] المصدر نفسه، ص 104
[7] المصدر نفسه، ص ص 104-105
[8] المصدر نفسه، ص 106
[9] المصدر نفسه، ص 107
[10] المصدر نفسه، ص 111
[11] المصدر نفسه، ص 112
[12] المصدر نفسه، ص 116
[13] بول ريكور، الزمان والسَّرد الحبكة والسَّرد التاريخي، ترجمة سعيد الغانمي وفلاح رحيم، مراجعة: جورج زيناتي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط 2، 2022، الجزء 1، ص 111
[14] كريغ كالهون، معجم العلوم الاجتماعية، ترجمة: معين رومية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة-بيروت، 2021، مادة "النمط المثالي"، ص 681
[15] وليم آوثوايت، قاموس بلاكويل للفكر الاجتماعي الحديث، ترجمة فالح عبد الجبار، هيئة البحرين للثقافة والآثار، المنامة، 2022، مادة "نمط مثالي"، ص 961
[16] منمنمات، ص 117
[17] أمانويل كانت، تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق، ترجمة عبد الغفار مكاوي، مراجعة عبد الرحمن بدوي، منشورات الجمل، بيروت-بغداد، ط 2، 2014، ص 61
[18] منمنمات، ص 117
[19] بول ريكور، مقالات ومحاضرات في التأويلية، ترجمة محمد محجوب، مراجعة جلال الدين سعيد، المركز الوطني للترجمة ودار سيناترا، تونس، 2013، ص 57
[20] المصدر نفسه، ص 60
[21] منمنمات، ص 119
[22] فريدريش نيتشه، ما وراء الخير والشر تباشير فلسفةٍ للمستقبل، ترجمة جيزيلا فالور حجَّار، مراجعة موسى وهبة، دار الفارابي، بيروت – المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار، الجزائر، 2003، شذرة "108"، ص 110